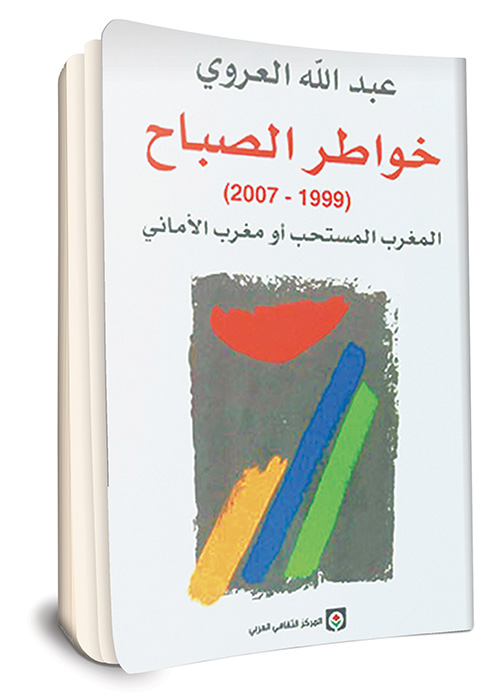 نستطيع أن نقول: إن البورتريه الذي رسمه عبدالله العروي للفنان البلجيكي ر. ماغريت في الجزء الأول من كتابه «خواطر الصباح»، هو، إلى حد ما، «بورتريه ذاتي». نقرأ في هذا الكتاب: «روني ماغريت: لم أتأثر بألوان فنان مثلما تأثرت بأعماله التي تمزج الحلم والعقل. لوحاته، ملصقاته في الواقع، تمثل أحلام رجل رصين متعقل طلق الرومانسية بعد، أو قبل، أن يعرفها. أثر فيَّ لأنه أبعد ما يكون عن ميلنا الغريزي إلى دغدغة العواطف. لا أتصوره يضحك أو يبكي، قد يمزح وهو مقطب». يحكي ابن أخي العروي، الكاتب فؤاد، في إحدى مقابلاته التلفزيونية، أنهما التقيا مرة في معرض باريس، وأنه عندما قدم عمه لناشره الفرنسي مازحًا، علق عبدالله العروي قائلًا: «هذا هو الوحيد في عائلتنا الذي يمزح، أنا يتعذر علي ذلك، وحتى إن مزحت فمقطبًا».
نستطيع أن نقول: إن البورتريه الذي رسمه عبدالله العروي للفنان البلجيكي ر. ماغريت في الجزء الأول من كتابه «خواطر الصباح»، هو، إلى حد ما، «بورتريه ذاتي». نقرأ في هذا الكتاب: «روني ماغريت: لم أتأثر بألوان فنان مثلما تأثرت بأعماله التي تمزج الحلم والعقل. لوحاته، ملصقاته في الواقع، تمثل أحلام رجل رصين متعقل طلق الرومانسية بعد، أو قبل، أن يعرفها. أثر فيَّ لأنه أبعد ما يكون عن ميلنا الغريزي إلى دغدغة العواطف. لا أتصوره يضحك أو يبكي، قد يمزح وهو مقطب». يحكي ابن أخي العروي، الكاتب فؤاد، في إحدى مقابلاته التلفزيونية، أنهما التقيا مرة في معرض باريس، وأنه عندما قدم عمه لناشره الفرنسي مازحًا، علق عبدالله العروي قائلًا: «هذا هو الوحيد في عائلتنا الذي يمزح، أنا يتعذر علي ذلك، وحتى إن مزحت فمقطبًا».
من الطرائف التي حكاها فؤاد العروي في هذه المقابلة أنه غالبًا ما يشعر، عند مجالسة عمه أنه يصبح أكثر ذكاء. فكأنما تدفعه تلك المجالسة، هو الكاتب الحائز على كثير من الجوائز الغربية وأهمها غونكور، وخريج مدرسة القناطر والطرق الباريسية، إلى أن «يدفع» بذكائه لمتابعة أحاديث عمه. لعلنا محتاجون، نحن كذلك، إلى شيء من هذا لمحاولة رسم بورتريه مفكرنا الكبير.
لا يمكن أن نرسم بورتريه العروي (1933-) بمتابعة علاقاته الاجتماعية، أو بحشره في سياق الفكر العربي المعاصر، وتحديد مواقفه ومكانته بين أقطاب هذا الفكر. ذلك أن المعروف عنه هو انعزاله، وكونه لا يحشر نفسَه مباشرة ضمن علاقات وسياقات. فعلى الرغم من أنه يقول: إنه يمارس النقد الأيديولوجي، فإن ما يميز كتاباته هو صمته فيها عما يجري بالقرب منه، وتفضيله محاورة البعيد على مجادلة القريب. لا يعني ذلك مطلقًا أنه لا يهتم بقضايا الساحة العربية ولا ينخرط فيها، كل ما في الأمر أنه، حتى عندما يود وصف تلك الساحة وتحليل ما يروج فيها، يكتفي ببناء نماذج ثقافية مثل «الشيخ» و«رجل التقنية» أو «رجل السياسة»، من غير أن يمثل لتلك النماذج بالأشخاص الأحياء الذين قد يكونون من ورائها. فما يهمه هو «اجتماعيات الثقافة» وليس «اجتماعيات المثقفين».
في التاريخانية
نستطيع أن نقول: إن السؤال الذي ما فتئ هذا المفكر يطرحه بأشكال متباينة، ومنذ الستينيات من القرن الماضي هو: كيف يستوعب الفكر العربي مكاسب العقل الحديث؟ وقد مهّد لإجابته عن هذا السؤال في كتابه الأول الأساس «الأيديولوجية العربية المعاصرة»، بأن فضَح النظرات الأيديولوجية التي نهجها المفكرون العرب على اختلاف مناحيهم للإجابة عن هذا السؤال، فرأى أن الطريق الوحيد لتجاوز هذا القلب الأيديولوجي، وتجنب الانتقائية والسلفية هو نهج سبيل التاريخانية بكل مقوماتها، أي: الإيمان بـ«صيرورة الحقيقة، وإيجابية الحدث التاريخي، وتسلسل الأحداث، ثم مسؤولية الأفراد عنها». لا بد إذًا من التسليم أولًا أن التطور التاريخي يخضع لقوانين لا يحيد عنها، وأنه يتجه وجهة واحدة لا تختلف من جنس لآخر، مما يمكن كل ثقافة من أن تتفتح على هذه الوجهة، ويسمح للمثقف والسياسي بأن يقوما بدورهما الإيجابي.
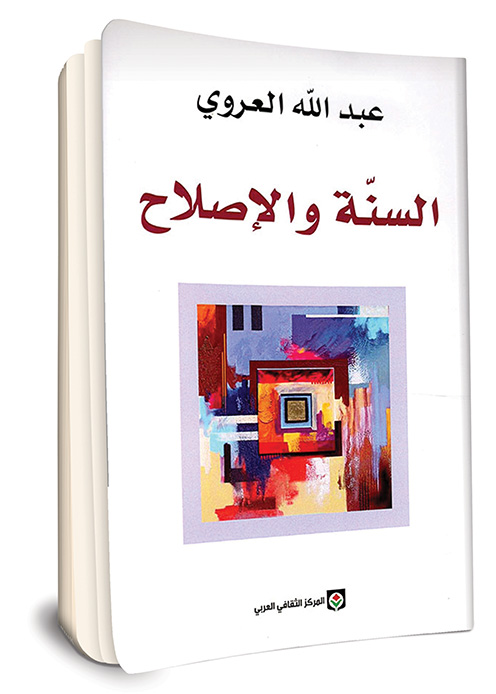 في كتاب «السنة والإصلاح» نستشف معنى للتاريخانية أكثر تركيزًا. فهي إيمان بقوة الزمن، إيمان بأن «الوقوف على البدايات يكشف حتمًا الدوافع والغايات»، إيمان بأن السابق يحدد اللاحق، إيمان بالتسلسل الزمني. (نقرأ في ص 28 من هذا الكتاب: «فالإلغاء التعسفي للتسلسل الزمني يدعو حتمًا إلى معاداة التاريخانية وتحويلها إلى نظرية عامة يسهل تفنيدها»). ثم إن التاريخانية إيمان بقوة الحدث. فالحدث هو الذي «يميز ما هو نيو، وما هو بوست».
في كتاب «السنة والإصلاح» نستشف معنى للتاريخانية أكثر تركيزًا. فهي إيمان بقوة الزمن، إيمان بأن «الوقوف على البدايات يكشف حتمًا الدوافع والغايات»، إيمان بأن السابق يحدد اللاحق، إيمان بالتسلسل الزمني. (نقرأ في ص 28 من هذا الكتاب: «فالإلغاء التعسفي للتسلسل الزمني يدعو حتمًا إلى معاداة التاريخانية وتحويلها إلى نظرية عامة يسهل تفنيدها»). ثم إن التاريخانية إيمان بقوة الحدث. فالحدث هو الذي «يميز ما هو نيو، وما هو بوست».
يميز العروي مع بنيديتو كروتشي، بين التاريخية l’historisme، التي تفسر كل حدث بشروط نشأته، وبين التاريخانية l’historicisme، أي التاريخية من الدرجة الثانية نوعًا ما، التي ترى بأنه في التاريخ الذي يصنعه البشر، وفي مستويات الفعالية جميعِها، لا وجود لمبدأ نظام وتوجه ممكن، إلا داخل التجربة التاريخية ذاتها. فالتاريخ ينظم نفسه بنفسه، وهو في الوقت ذاته تعالٍ ومحايثة. يكون محايَثَة طالما تجلى كفعالية واعية للإنسان، وهذا هو مستوى التاريخية، ويكون تعاليًا عندما يفرض نفسه كنظام ومثالٍ يُحتذى تحت طائلة الفشل، وهذا مستوى التاريخانية. التاريخانية مفهوم يستعمله إنسان العمل، والمنظر السياسي. عندما يؤلف ماكيافيلي «تواريخ فلورنسية»، فهو في نطاق التاريخية، أما عندما يكتب «الأمير» فهو تاريخاني.
وفي الحالتين كلتيهما، ليس من السهل الانفلات من التاريخ. فـ«وحدَه التاريخ، مثل المختبر في علوم الطبيعة، يمكن من الفصل بين الآراء المتعلقة بالإنسان ومصيره. بالإمكان دومًا تصور إمكانيات أخرى غير التي تمت بالفعل، إلا أن هذا يبقى مجال الفن». عند الوصول إلى هذه النقطة، يمكن للمرء إما أن ينكر البعد التاريخي، أو يُهمله، فيخوض في الفلسفة، وإما أن يعيَه بوضوح وينتهيَ بأن يتكيف معه مُخاطرًا بالتعرض لتهمة الانهزامية.
الأطروحة التي يعتمدها العروي إذًا هي أن كل مثقف عربي، إذا ما وعى، حق الوعي، الوضع الذي يعيشه، هو أيديولوجي عن طواعية وطيب خاطر، وبما هو كذلك، فإنه يسقط بالضرورة تحت نير التاريخ المشترك، ويكون فكره جدليًّا بالضرورة، وهذا الجدل يكشف له أن أفقه هو التاريخانية، بما هي استعادة واعية وإرادية، لكونها ضرورية، استعادة لفترة تاريخية سبقت معرفتُها، كما سبق تحليلُها والحكمُ عليها. هذه التاريخانية ذات المنحى العملي تجرّ من يعتنقها نحو أخلاق نفعية وفلسفة وضعانية. وهذه قد تؤدي إلى عدم الثقة في أي مشروع يرمي إلى استعادة الميتافيزيقا أو تجديد الأنطولوجيا. بهذا المعنى، ستغدو الفلسفة نوعًا من العمل الترفيهي. إلا أن التاريخانية، إذا اقتصرت على مجالها، لا يمكن تفنيدها؛ لأنها تعبر عن واقع مجرب. والأخبار تشهد دون انقطاع أنه من دونها، لا يمكن تصور نظرية للعمل السياسي.
يعتبر العروي النظرية فقط مرحلة في عملية الفهم، الهدف منها توضيح المفهومات قبل العودة إلى الواقع المشاهد. لحظة النظرية هي بالضبط الكشف عن هذه القدرة على الانسلاخ عن المؤثرات الموروثة والمفروضة، وعلى الرغم من ذلك فهي ليست سياسة، ولا يمكن أن تكون مصدر سياسة؛ إذ «السياسة ممارسة ليس إلا، وما قد يستنتج عن النظرية من سلوك ليس سياسة».
في التحديث
التاريخانية إذًا هي السبيل الوحيد للانفتاح على أبواب التحديث ما دامت هي وحدها الكفيلة بأن تجعلنا نميز بين الخصوصية والأصالة. فالأولى حركية متطورة، والثانية سكونية متحجرة ملتفتة إلى الماضي. الأصالة تصورٌ وهمي يجعلنا نعتقد أن التراث ما زال يغذي تفكيرنا الحالي. هذا في حين أن الرباط الذي يشدنا إليه «قد انقطع نهائيًّا، وفي جميع الميادين، وإن الاستمرار الثقافي الذي يخدعنا لأننا ما زلنا نقرأ المؤلفين القدامى ونؤلف فيهم إنما هو سراب… إنه أصبح حسًّا رومانسيًّا منذ أزمان متباعدة». ما يتبقى لنا إذًا هو «طي الصفحة، أي القطيعة المنهجية».
في القطيعة
يريد العروي أن ينفصل توًّا عن التراث، لا عن هذا التيار أو ذاك، وإنما عن الذهنية العامة التي تسوده والتي تخالف كل المخالفة الذهنية الحديثة. إلا أننا لن نتمكن، في نظره، من الوقوف على مفارقات هذه الذهنية العامة التي تسود التراث ما لم ننظر إليه من منظور مقومات الفكر الحديث. لو اكتفينا بإنجازاتنا الثقافية لاستحال أن نصل بمحض الاستنباط إلى المفهومات التي تقوم عليها الحداثة الفكرية. «فالدور التاريخي الغربي الممتد من عصر النهضة إلى الثورة الصناعية هو المرجع الوحيد للمفهومات التي تشيد على ضوئها السياسات الثورية الرامية إلى إخراج البلاد غير الأورُبية من أوضاع وسطوية مترهلة إلى أوضاع صناعية حديثة».
سيعمل العروي في كتبه المتأخرة على محاورة التراث، بل نقده و«الاهتمام بالتقليد» على حد تعبيره. فربما سيتبين أن الانفصال عن التراث ليس عملية تلقائية. كما أنه ليس خصامًا وإنما تملكًا وإحياء. نقد التراث هنا حكم على التراث انطلاقًا من مفاهيم غير نابعة من صلبه، فنحن لسنا بصدد وصف تقريري، وإنما أمام موقف انتقادي معياري. هذه المعيارية تطبع سلسلة كتب المفهومات التي نشرها العروي كلها. فهذه المفهومات لا تطابق المجتمعات العربية مطابقة كاملة؛ «إذ إننا لو انطلقنا من المجتمعات العربية وحدها، من إنجازاتها الثقافية الماضية والحاضرة لاستحال أن نصل بمحض الاستنباط إلى كمال المفهوم». يستحيل أن نجد الآن عند الغزالي مفهوم الأدلوجة، أو عند ابن عربي مفهوم الحرية، أو عند ابن خلدون مفهوم التاريخ، أو عند الشاطبي مفهوم الدولة، أو عند ابن رشد مفهوم العقل. ينظر العروي إلى التراث، كما يقول، من «منظور مكتسبات الفلسفة الغربية الحديثة»، أي من موقع ذاك الذي أدرك تلك المفهومات مكتملة فجاء لينتقد.
قد يقال: إن العروي قد عاد في بعض مؤلفاته المتأخرة للوقوع فيما عَابَهُ على المفكرين العرب في كتابه «الأيديولوجية العربية المعاصرة»، إلا أنه ينبهنا إلى أنه يميز في الفكر الحديث بين مقومات الفكر الحديث وبين أيديولوجية الغرب. فالمنهج ليس هو الأيديولوجية. المنهج نوع من التفكير على أساسه تتكون أيديولوجية: «الأيديولوجية هي التي تتشبث بها الطبقة، أما المنهج فقد أصبح قاعدة مشتركة لكل التيارات الفكرية العصرية».

في نقد العقل العربي-الإسلامي
لهذا التمييز في نطاق الفكر الغربي ما يقابله في الفكر العربي-الإسلامي. هنا أيضًا يميز العروي بين الموقف الكلامي والمذهب أو المنهج ثم الذهنية. الموقف يشير إلى نوعية التعامل مع النصوص وتناول الأسئلة والوقوف عند الأجوبة. أما الذهنية فهي تتعدى علم الكلام لتغدو إبيستمي ثقافة بكاملها؛ ذلك أن الأصل الذي انبنت عليه العلوم الإسلامية بأكملها هو أن العلم واحد لا يتبعض ولا يتفاضل ولا يتحول. وهذا الأصل تقرر في علم الكلام ومنه انتقل إلى العلوم الأخرى؛ لذا فـ«الذهنية الكلامية» عامة يخضع لها الفيلسوف والباطني والفقيه والمتصوف، ولا تقتصر على علم الكلام. ومن أهم مميزاتها أنها لا تكتفي بتحديد العقل بالمعقول، بل تجعل الثاني سابقًا على الأول. وهذا المعقول السابق على العقل الذي يحل فيه ولا يتولد عنه هو «العلم» بالمعنى المطلق. هذا المعقول يُعرف باسم خاص في كل مذهب وهو يسمى الخبر، أو الحكمة، أو السنة، أو التقليد، أو سر الإمام، أو الكشف. هذا المعقول مستقل لا يتوقف على طريقة تحصيله. فليس طلب العلم والحالة هذه بحثًا وتقصيًا. كما أن العقل الفردي ليس منبع المعقولات، ولا مصدر المعارف. متى تهيأ العقل الفردي حل فيه العلم بصورة مكتملة مباغتة نهائية.
وما يقال عن تدرج لعقول الفلاسفة لا ينبغي أن يفهم على أنه درجات من وعي العقل بنفسه، وإنما هي «شخوص على مستوى واحد من الوجود في الكون». ليس المنطق والحالة هذه أداة ومنهجًا وقواعد لبلوغ العلم اليقين؛ ذلك أن العلم اليقين سابق على العملية المنطقية. لا فرق هنا بين الوجود وما يقال عنه وما يتوصل به إلى معرفته. والعقل مرآة ينعكس عليها الحق المطلق. إن حضور المنطق الأرسطي عند أنصاره المسلمين وعند خصومه لا يدل، في نظر العروي، على أن الثقافة الإسلامية ثقافة عقل. فالعقل الذي تحتفل به مفهوم ملتصق بها ومفارق لما يعرف بالاسم نفسه في المجتمع المعاصر. سِمَتُهُ الأساسيةُ أنه عقل المطلق أي عقل المجردات، عقل الحدود والأسماء، وهو وعاء لعلم مطلق. لقد فهم المنطق بطريقة جعلت ذهن المسلم لا يلتفت إلى الطبيعة. وإن اختار المسلك الاستقرائي فليطبقه على نصوص وأقوال، لا على أعراض وأحوال طبيعية.
قد يرد بعضٌ على هذا بأن ما يقوله العروي هنا لا يصدق على مفكري الثقافة العربية الإسلامية جميعهم، وهو لا يصدق، بصفة خاصة، على ابن خلدون الذي اشتهر بنقده لعقل الفلاسفة. يعترف العروي بأن العقل عند صاحب «المقدمة» لا يورَث ولا يُكتشف، وإنما يُكتسب بالتجربة المتجددة؛ فهو دومًا عقل مشخص، محدد ومحدود بظروف الممارسة، إلا أن هذا التشخيص بالضبط هو الذي سيحد في نظر العروي، من منظور صاحبه إلى العقل. فبرغم أنه أعرض عن علم الكلام، وتوخى تأسيس علم الواقعات، ومع أنه توصل إلى مفهوم العقل التجريبي المرتبط بالصنائع، إلا أنه وقف في المجال الذي ابتدعه حيث وقف غيره في ميدان الكلام. فهو لم يتصور أن يصبح العقل التجريبي عقل إنشاء وإنجاز؛ لذا فقد حصر المرئيات في المتحقق، ومنع نظريًّا الانفتاح على التجارب الوهمية الكاشفة عن المحتمل. وبعبارة واحدة فقد حرم نفسه من خوض تجربة الممكن الموضوعي التي هي تجربة الفن التي تفتح العقل على آفاق الممكنات. وبهذا فقد جعل العقل محاصرًا: «قانون تفكيره هو التوقيف والحصر في كل المجالات: في السياسة، في العلم، في التعبير… موضوع العلم الحق، العلم اليقيني عنده هو الواقعات، أي الحاصل المحقق بالفعل، وأما المقدر المتوهم المحتمل فهو وهم. والوهم لا يُحد فلا يعلم». بهذا يتنافى علم الواقعات مع التوقعات وحساب الاحتمال؛ «إذ علم ما يستقبل هو من الغيب الذي لا يتم إلا بالكشف».
هذا الانسداد هو ما يجعل صاحب المقدمة عاجزًا عن إقامة منطق حقيقي للفعل؛ ذلك أن الفعل لا يكون فعلًا إلا إذا كان تجرؤًا على أمر غير محقق. إن علم العمران الخلدوني علم طبيعي، علم ما هو محقق وليس علمًا إنسانيًّا ناتجًا عن الإبداع والإقدام. لقد طبق ابن خلدون على الواقعات منطق الطبائع بالمعنى الكلامي فسد الطريق في وجه عقل العمل البشري، وبالتالي عقل الطبيعة كما فهمها الفكر الحديث، مجال تجارب الإنسان المتجددة. لقد أبدل ابن خلدون العقل التجريدي بالعقل التجريبي، فكان مجددًا في ذلك؛ إلا أنه لم يستطع أن يطور هذا العقل الثاني إلى عقل يعم كل أوجه الممارسة بما فيها من انفتاح ومخاطرة واعتبار الممكنات نسيجًا للوقائع ذاتها.
المثقف بين السياسة والسياسي
هناك وعي حاد عند العروي بأهمية دور المثقف في المجتمعات العربية المعاصرة؛ «لأن عمله اليومي هو بالضبط نقض الظاهر»، ولأن اسمه وشهرته تُستغلان «للتأثير على الرأي العام»، ولأنه مجبر على أن يثبت أنه أدرك «سن الرشد»، خصوصًا أمام المستشرقين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم الأوْلى بالحديث عن مجتمعاتنا، بل التحدث باسمها، وهم يتعجبون اليوم ويتساءلون: «كيف حصل أن يسأل اليوم العرب عن مستقبل ثقافتهم؟».
كتب العروي في إحدى خواطره: «التاريخ بلا سياسة أبكم، والسياسة بلا تاريخ عمياء». أنا «أنقب على الماضي القريب لأفهم الماضي البعيد، وكذلك الراهن». إن من يأمل ويتطلع إلى المستقبل، لا بد أن يتجاوز التخصص، «قد يقرر حقيقة. لكن السياسي ملزم بافتراض إمكانية». لا يعني هذا أن المثقف العروي مشارك فعال في الحياة السياسية، ولا هو منخرط في اليومي السياسي. إنه لا ينضوي في حزب بعينه، ولا يتخذ موقفًا سياسيًّا مقابل آخر، وإنما هو محلل مهووس بالسياسي، وهو ينتمي، كما يقول، «إلى فكرة لا إلى حزب»: لا أستطيع أن أقول مثل ماء العينين: أنا مخاوي، أي أخ لكل شيخ زاوية. لا يرضيهم الانتماء إلى فكرة، إلى حركة، إلى مشروع، المطلوب هو التعلق بأهداب رجل، أن تعلن الولاء لشخص بعينه؛ لذا فإن حضور السياسة عنده لا يتم إلا من خلال همّ ثقافي.
في المدة من 1988م إلى 1999م، أي حتى رحيل الملك الحسن الثاني (وهي المدة التي يغطيها الجزء الثالث من مذكراته)، كان العروي قد تقلد مهمة رسمية، وكُلِّف بشرح قضية الصحراء واستكمال وحدة التراب الوطني لدى بعض رؤساء الدول العربية والأوربية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الاضطلاع بهذه المهمة لم يجعله يغرق في السياسة ويتخلى عن عين المحلل الناقد. ويمكننا أن نجزم بأنه لم يكن، حتى في هذه المدة، مشاركًا فعالًا في الحياة السياسية، مع ما تجر إليه من اتخاذ مواقف، وتعيين مواقع، وخلق «عداوات»، والخوض في جدالات، وكل ما يترتب عن الانخراط الفعلي في اليومي السياسي. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظل محللًا مهووسًا بالسياسي، ظل «أستاذ تاريخ»، يلحظ ويسجل «كما يفعل المؤرخون القدامى»، لكنه ليس مؤرخًا لوقائع وأحداث، وإنما هو محلل مهتم بالسياسي، متابع للتطورات الدولية والعربية، حامل لهموم بلاده وقضاياها المصيرية.
لكنه، كما قلنا، يحلل «من بعيد»، يتحاشى الغرق في السياسة أو إصدار الأحكام، أو الميل لكفة ضد أخرى. فحينما يعقد، على سبيل المثال، مقارنة بين قطبين سياسيين مهمين لعبا أدوارًا كبيرة في الحياة السياسية المغربية غداة الاستقلال، بل ربما قبله، يكتفي بوصف «موضوعي» بارد، ويعمل جاهدًا على الوقوف «عن بعد». كتب مقارنًا بين الزعيم اليساري عبدالرحيم بوعبيد، وبين رضا كديرة: «أقارن بين الرجلين؛ لأنهما وُلِدَا في السنة نفسها (1922م)،
ومارسا المهنة نفسها (المحاماة)، وتأثرا على المستوى نفسه بالثقافة الفرنسية. ثم كان بينهما تشابه ملحوظ في البنية والملامح سوى السحنة… لو كان المغرب في مستوى إسبانيا، لو عاش مثلها تجربة ديمقراطية أصيلة لكُنّا رأينا الرجلين يتواجهان تحت قبة البرلمان كما تواجه في الكورتيس فيلبه غونزاليس وأدولفو سوارس؛ الأول باسم الديمقراطية الشعبية، والثاني باسم الليبرالية الديمقراطية. لو حصل ذلك -وكان واردًا في وقت ما- لَتَرَبَّى المغرب، والنخبة الشابة بخاصة، على تقاليد النقاش الحر المسؤول، ولَدَخَلَت البلاد فعلًا عهد الرشد السياسي. لكن مُنع كلاهما
من تحقيق أهدافه».
لا يعني هذا مطلقًا أن العروي لا يكترث لقضايا بلده. الضدُّ ربما هو الصحيح. فهو يحملها معه حتى عندما يكون خارج الوطن، وهو لا ينفك يقارن ويتذكر ويتحسر: «يبدو أن ما كنت أشعر به من إرهاق لا يعدو أن يكون تضايقًا من جو المغرب الخانق، من انسداد الأفق أمام الجميع، صغارًا وكبارًا. غيرنا يترقب، ويأمل: المتدين الكشف، العالم السبق، الفنان الإنجاز، السياسي الفوز. أما نحن فإننا نسبح في الفضاء، نعد الأيام، ونسمي الشهور». وقضايانا الكبرى لا تفتأ تطرح ولا تفتأ تتعقد وتتشابك: «نبحث، ونتيه في البحث، عن أسباب الركود والتخلف.. السبب واضح: الدولة تعلم الناس الكسل والخمول… بحث عن أدنى فرصة لإنشاء عيد جديد.. نتساءل ونتيه مجددًا في التأويلات، عن عدم تجذر الديمقراطية عندنا… فلننظر في الوضع العائلي، علاقة الأب والابن، الزوج والزوجة، ربة البيت والخادم».

العروي والفلسفة
نقرأ في كتاب «السنة والإصلاح»: «لا أرى نفسي فيلسوفًا، من يستطيع اليوم أن يقول: إنه فيلسوف؟ ولا أرى نفسي متكلمًا ولا حتى مؤرخًا همه الوحيد استحضار الواقعة كما وقعت في زمن معين ومكان محدد. لم أرفع أبدًا راية الفلسفة ولا الدين ولا التاريخ، بل رفعت راية التاريخانية في وقت لم يعد أحد يقبل إضافة اسمه إلى هذه المدرسة الفكرية لكثرة ما فُندت وسُفهت».
منذ كتاباته الأولى والعروي ينبهنا إلى أنه لا يقصد بانتسابه إلى التاريخانية انضواء ضمن تيار فلسفي وجد منشأه في الفكر الأوربي. فليس المقصود بالانتساب إلى التاريخانية عنده اتخاذ موقف فلسفي يجد أسسه عند فلسفات بعينها.
عيب الفلسفة الميتافيزيقية هو أنها ترى أن التاريخ مفتوح على الدوام، من غير أن تدرك أنها بذلك تعمل على نفيه. ونفي التاريخ، هو عدم رؤية الواقع والجدل واللامساواة والصراع والتبعية، وأولوية المجتمع وعدم أهمية الفرد مؤقتًا ربما، ومجمل القول، هو التصريحُ بعدم فاعلية السياسة والانزواء في البيت بعيدًا من صخب البشر. أليس هذا هو المعنى الذي اتخذه لفظ الحكمة على الدوام؟ وما معنى محبة الحكمة (التفلسف) إن لم تكن اتخاذ هذا الموقف؟
على هذا النحو تبدأ الفلسفة: فهي تتحدث عن نسيان الوجود، في حقيقة الأمر إنه نسيان التاريخ. التاريخ يُخضع والفلسفة تُحرر، هذا ما تَعِدنا به الحكمة، ونحن نميل بطبيعة الحال إلى تصديقِه. كلٌّ منا، شاعرًا بمرارة وخيبةِ أمل، يتمنى لو كان مكانَ الحكيم، سعيدًا في عزلته.
لكن، لو أن تجارب أخرى قد عُرفت، لو اضطر المرء إلى القيام باختيارات أخرى، ألن يكون هناك ميْل إلى القول، على العكس من ذلك، إن التاريخ يحرر وإن الفلسفة تُخضع. تبدو هذه الأطروحة أقل وضوحًا، إلا أنه، بعد تفكير، يمكن تبريرها بسهولة. فأيهما أقرب إلى الإخضاع؟ وأي سجن أشد إحكامًا من منظومة سبينوزا أو كانط؟ ما الذي يتبقى قوله والتفكير فيه أو تخيله إذا انطلقنا من مبادئ أحدِهما أو الآخر؟
العروي والنقد الأيديولوجي
لكي تقوم الفلسفة بدور، ينبغي عليها، والحالة هذه، أن تتحول إلى انتقاد للأيديولوجيا: «ودور منتقد الأيديولوجيا، وهو دور الملاحظة والتقويم، هو أن يعرض المنهجيْنِ معًا ويوضحهما؛ منهجَ الباحثين الذين يكتفون بالرغبة في فهم ما كان (التاريخية أو التاريخانية من الدرجة الأولى)، ومنهجَ رجال العمل الذين قرروا التحرر من الماضي (التاريخانية من الدرجة الثانية)».
ما يجعلنا نحكم بأن هذا الفكر أيديولوجيًّا هو حركة التاريخ، فـ«هناك مجرى للتاريخ لأن هذا يُدرَك كحلبة صراع تتواجه فيها مشروعات متضاربة. ليس هناك حَكَم لتعيين الغالب، هناك فقط تشكل جديد للواقع، ونتيجة مؤقتة، واضحة للجميع، تجعل أحد الخصمين يستعيد مشروع الآخر لمعاودة المباراة سواء في الميدان نفسه أو خارجه، ضد الخصم ذاته أو ضد آخر».
يتعلق الأمر إذن بتاريخ آخر، يتجدد عبر استعاداته المتواصلة، على عكس التاريخ السابق الذي كان يُستأنف كي لا يتبدل، وهذا ما يحدد العصر الجديد. من هذا الإدراك لمعنى التاريخ واتجاهه تتولد الأيديولوجية التي هي الشكلُ الجديد للفكر، كل ما هناك أن ما يرمي إليه الفكرُ لم يعد هو هو.
هكذا يربط ذنب السمكة برأسها، وتتشابك المفهومات الأساسية عند العروي، فيستخلص المفهوم المنطلق، مفهوم الأيديولوجية، من مفهوم التاريخ، ليعطي محتوى جديدًا لمفهوم العقل. ومن ثمة، يحددُ هذا الأخير بشكل مختلف، الفردَ والحرية والمجتمع الذي ينوي الفرد العيش فيه.
على هذا النهج سلك صاحب «الوطنية المغربية»، فهو لم يخض في أطروحته في دراسة تاريخية أو اجتماعية حول نشأة الأمة المغربية وهيكلها، وإنما سعى إلى تحليل الخطاب الذي كان الوطنيون المغاربة يبررون به أقوالهم وأعمالهم؛ لذا يؤكد: «أخذتُ الوطنية المغربية كمستوى من مستويات المفهوم العام للأيديولوجية». وهكذا فقد ظل العروي وفيًّا لنقد الأيديولوجية، ونقد الواقع الثقافي لعالمنا العربي، ماضيًا وحاضرًا، حتى وإن كان نقده قد تم دائمًا «عن بعد».







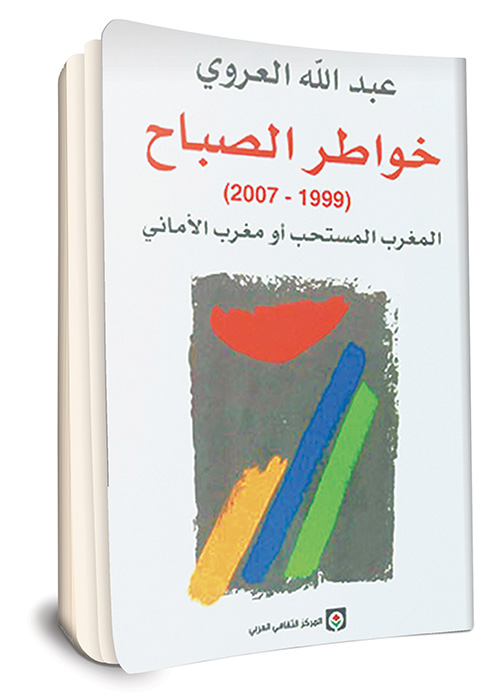 نستطيع
نستطيع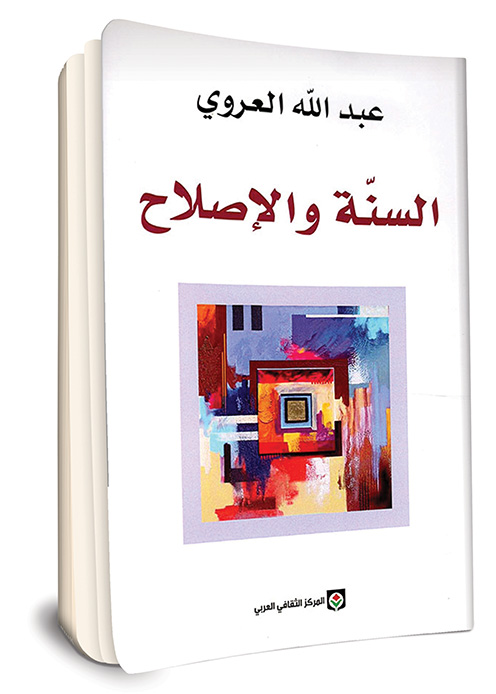 في كتاب «السنة والإصلاح» نستشف معنى للتاريخانية أكثر تركيزًا. فهي إيمان بقوة الزمن، إيمان بأن «الوقوف على البدايات يكشف حتمًا الدوافع والغايات»، إيمان بأن السابق يحدد اللاحق، إيمان بالتسلسل الزمني. (نقرأ في ص 28 من هذا الكتاب: «فالإلغاء التعسفي للتسلسل الزمني يدعو حتمًا إلى معاداة التاريخانية وتحويلها إلى نظرية عامة يسهل تفنيدها»). ثم إن التاريخانية إيمان بقوة الحدث. فالحدث هو الذي «يميز ما هو نيو، وما هو بوست».
في كتاب «السنة والإصلاح» نستشف معنى للتاريخانية أكثر تركيزًا. فهي إيمان بقوة الزمن، إيمان بأن «الوقوف على البدايات يكشف حتمًا الدوافع والغايات»، إيمان بأن السابق يحدد اللاحق، إيمان بالتسلسل الزمني. (نقرأ في ص 28 من هذا الكتاب: «فالإلغاء التعسفي للتسلسل الزمني يدعو حتمًا إلى معاداة التاريخانية وتحويلها إلى نظرية عامة يسهل تفنيدها»). ثم إن التاريخانية إيمان بقوة الحدث. فالحدث هو الذي «يميز ما هو نيو، وما هو بوست».




0 تعليق