منذ ظهور أعماله الأولى في الخمسينيات من القرن الماضي، لفت هانس ماغنوس إنسنسبرغر المولود عام 1929م الذي توفي في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي، أنظار القراء والنقاد على حد السواء؛ بسبب براعته في رصد وتصوير واقع بلاده بعد كارثة الحرب الكونية الثانية. وهو واقع مرير ولّدَ أدبًا سُمي «أدب الأطلال». وفي مدة قصيرة، تمكن هانس من أن يكون «صوت الشبيبة الجديدة الغاضبة»، والناطق باسمها عن جدارة. وفي كتاباته، لم ينشغل بالبكاء على مأساة بلاده في ظل النظام النازي، بل ركّزَ على نقد وإدانة الأفكار القديمة التي كانت سببًا أساسيًّا في الكوارث التي ضربت بلاده. ولم يقتصر هانس على كتابة الرواية والشعر، بل عمل منشّطًا في الإذاعة، وصحافيًّا، ومؤسسًا لمجلات رفيعة، وناشرًا. هنا ترجمة لحوار أجرته معه «المجلة الأدبية» الفرنسية في عددها رقم320، الصادر في شهر إبريل -نيسان 1994م…
● إذن أنت كنت في سن السادسة عشرة عندما انتهت الحرب… ما التجارب التي أثّرت فيك؟
■ في تلك السنوات، لم يحدث في حياتي ما يمكن أن يثير الاهتمام. حتى وإن حدث ما يمكن أن يكون غريبًا، فإن الغرابة هي سمة أغلب سير الناس في تلك المدة. وتجربتنا كانت تجربة جماعية لانهيار شامل. فلم تكن هناك دولة، وعلى المستوى الاقتصادي كنا نعيش كارثة بأتم معنى الكلمة. وكانت المدن والبيوت مُخربة. لكن بالنسبة لشاب مثلي كان الأمر أقلّ خطرًا، وأشدّ إثارة. وكنا نمارس «السوق السوداء»، ونحاول تجاوز المصاعب اليومية بشتى الطرق والوسائل. وكانت هناك مخاطر. لكن بما أني تمكنت من النجاة من كل ذلك، فإنه يحقّ لي أن أقول: إني محظوظ، وإن الحياة لم تكن مُضجرة إلى حدّ كبير…
● لكنك عشت تجربة الحرب بما أنك جُنِّدْتَ…
■ في الأشهر الأخيرة من الحرب، حاولوا تجنيدي. لكن بما أن هزيمة النظام النازي كانت مُتوقعة ووشيكة بالنسبة لي، فإنني فررت حالما علمت بأني سوف أرسلُ إلى الجبهة. وقد توصلت إلى إخفاء ملابس مدنية في أماكن مختلفة. لم أكن أرغب في أن أكون من ضمن آخر القتلى في تلك الحرب، أو أسيرًا عند الأميركيين. لقد توقعت كل شيء، ودبرت لذلك طريقة كأن أحصل على خرائط جغرافية على سبيل المثال. وفيما بعد، حين وُضعتْ ألمانيا تحت سيطرة الحلفاء، ساعدتني معرفتي باللغة الإنجليزية على ربط علاقات مع القوات الأميركية إذ عملت مترجمًا، وكنت نادلًا في بار الضباط.
● هل كانت معارضتك للنازية ناتجة من تأثير عائلتك، أم كانت صادرة من موقف عفوي من مراهق؟
■ لا أزعم أن موقفي كان صادرًا من إرادة في المقاومة، أو عن وعي سياسي. والحقيقة أني لم أكن أتحمل أن يأتي النازيون كل يوم ليعرفوا نشاطي، ويتجسّسوا على ما يدور في ذهني. لذا يمكن أن أقول: إن ردّ فعلي كان بدائيًّ، أو بالأحرى غريزيًّ. لكن يتوجّبُ عليّ أن أشير إلى عائلتي التي كانت بورجوازية، كانت تنظر باحتقار إلى النازيين الغلاظ القادمين من الأرياف، ومن المقاطعات الداخلية، ويتصرفون مع الآخرين بخشونة وعنف؛ لذا كنت مُتَحَمّسًا لتوجهاتهم السياسية.
 ● بفضل معرفتك اللغة الإنجليزية، لا بد أنك اطلعت مبكرًا على الأدب الأميركي… أليس كذلك؟
● بفضل معرفتك اللغة الإنجليزية، لا بد أنك اطلعت مبكرًا على الأدب الأميركي… أليس كذلك؟
■ نعم… ثم لأن القوات الأميركية كانت تتميز ببرنامج ثقافي. وبمبادرة من الحكومة الأميركية، وُزّعتْ مجانًا كتب جيب بأعداد وفيرة. وبما أن كثيرًا من تلك الكتب لم تكن تهمّ الجنود، فإني انتفعت منها. وهكذا اكتشفت فوكنر، وهمنغواي، بل اكتشفت أيضًا كتابًا ألمانًا: كافكا مثلًا الذي قرأته في البداية باللغة الإنجليزية.
● مِنْ الكتَّاب الألمان الذين قرأتلهم في تلك المدة بلغتك الأم؟
■ كانت عائلتي تملك مكتبة ضخمة مثل كل العائلات البورجوازية. وفي تلك المكتبة هناك أعمال غوته، وشيللر، ثم فونتانا، وبالزاك. باختصار كانت تحتوي على أعمال الكلاسيكيين. أما المحدثون، فإنه كان من الصعب العثور على أعمالهم. إضافة إلى كل هذا، كان هناك نقص فادح في الورق، وفي مواد أخرى كثيرة؛ لذا كانت الكتب الجديدة شبه نادرة. وللحصول عليها، كان لا بدّ من اللجوء إلى «السوق السوداء». وكانت السجائر ثمنًا لها. وكانت علبة السجائر الواحدة تساعد على اقتناء ديوان بودلير.
● هل بدأت بكتابة قصائد تحت تأثير تلك القراءات… أم فعلت ذلك من قبل؟
■ إنها قصة طويلة… فتى، كنت أمضي أيامًا بكاملها في القراءة. وعوض أن أحضر تظاهرات «الشبيبة الهتلرية»، كنت ألجأ إلى مكتبة البلدية. وكان حب الكتابة قد استهواني، واستبدّ بي؛ لذا كنت أكتب، وأحاول الكتابة. وفي سن الثانية والعشرين، أحرقت كل ما كتبت تقريبًا…
● لكنك سرعان ما عدت للكتابة، لكن في هذه المرة كنت عازمًا على المضيّ قدمًا…
■ عدت إلى الكتابة كعصامي رغم أني أمضيت سنوات في المعهد، ثم في الجامعة. وكنا مجبرين على أن نكتشف كل شيء بأنفسنا. ولم يكن أساتذتنا جهلة، لكنهم كانوا من الزمن القديم؛ لذا لم يكن باستطاعتهم أن يفتحوا أمامنا آفاقاً جديدة.
● في الجامعة، ما الدراسات التي اخترتها؟
■ لم أشأ أن أتخصص في مادة معينة. وطريقتي لم تكن خاضعة لبرنامج محدد، بل كنت أخيّر أن أحضر دروس أساتذة مختلفين في الاختصاصات، وفي التوجهات. وفي كل جامعة، نحن نجد ثلاثة أو أربعة أساتذة لهم وزن حقيقي. على هذا الأساس، كنت أتردد على المحاضرات. مثلًا حضرت دروسًا حول اليونان القديمة، وأيضًا دروس يسوعيّ كان قادرًا على فكّ ألغاز الماركسية. واليسوعيون غالبًا ما يكونون قادرين على الإلمام بالموضوع الذي يخوضون فيه. وكان ذلك مُهمًّا لي حتى لو أنني لم أكن متفقًا معه في توجهاتهم وآرائهم. وكان هناك أساتذة مشهورون مثل هايدغر في فرايبورغ. وقد تابعت بعضًا من محاضراته. كما تابعت دورسًا في الألسنية، وفي علم النفس.
كاتب مستقل لا ينتسب لمؤسسة
● ألمْ تفكر في استعمال هذه المعارف لاختيار وظيفة ما؟
■ لا… أبدًا… مبكرًا كان واضحًا لي أن أكون مستقلًّا في عملي، ولن أنتسب أبدًا إلى أيّ مؤسسة…
● النقاد لم يُخطئوا في هذا الشأن… فحين أصدرت أول مجموعة شعرية لك عام 1957م، التي كانت بَعنوان: دفاعًا عن الذئاب، هم تيقنوا أنك مبدع مُتمرد…
■ حدث ذلك في وقت متأخر نسبيًّا، وكنت آنذاك في الثامنة والعشرين من عمري. وقبل ذلك، كنت قد خضت تجربة الصحافة إذ إن كاتبًا هو ألفريد أندريتش، اقترح عليّ أن أعمل في إذاعة شتوتغارت. وكان هو قد ابتكر شكلًا جديدًا لبرنامج إذاعي به نصيب من الثقافة. وأنا كنت مساعدًا له. وعلى الرغم من نفوري من الأعمال القارة، فإنني أمضيت سنة كاملة في هذا العمل. وكان هدفي التعرف إلى عالم الإعلام من الداخل. كما أنني تدربت على العمل في التلفزيون. وفيما بعد عملت قارئًا في دار «سوركامب» في فرانكفورت. وفي كل عمل كنت أمضي سنة فقط لا غير. وكان ذلك كافيًا لكي أدرك هدفي.

● وفي الوقت نفسه، واصلت كتابة الشعر…
■ كنت أكتب الشعر والمقالات. إلا أنني لم أشرع في الكتابة بجديّة إلا عام 1954م. فبعد الدراسة الجامعية، أعددت أطروحة لكيلا أغضب والدي الذي كان مُنشغلًا بابن لم يكن معنيًّا بوظيفة قارّة. وقد أعددت تلك الأطروحة لكي أبدّدَ مخاوفه.
● هل كنت مهتمًّا حقًّا بتلك الأطروحة؟
■ نعم… كنت مهتمًّا وإلا ما كنت أعددتها. علينا أن نقاوم الضجر… ذاك هو مبدئي الذي لا أحيد عنه أبدًا…
● إذن أنت أعددت أطروحتك عن كاتب تربطك به علاقة عاطفية قوية…
■ نعم…اخترت كليمانس برانتانو، وهو رومنطيقي ألماني من جيل ما بعد جيل غوته. وقد فتنني عالمه الشعري، وأسلوبه، ولغته. وأنا أعتقد أنني مدين له. وتلك الأطروحة تطلبت مني عملًا جادًّا ودقيقًا. فكما لو أترجم عملًا صعبًا إذ إننا حين نترجم، يتوجب علينا أن نتوخّى الدقة والانتباه لمضمون النص. وربما لهذا السبب، مارست الترجمة بمتعة، وبعناية كبيرة. وأنا أحب ترجمة الشعر؛ لأننا نحصل دائمًا على فائدة ما من خلال ذلك.
● أطروحتك حول أساليب الكتابة في أعمال برانتانو الشعرية ناقشتها عام 1955م في جامعة «إيرلنغن»، ثم أصدرتها عام 1961م. كيف كان تأثيرها فيك، وفي أسلوبك في الكتابة؟
■ هو يلعب على التباس اللغة. وربما كان أولَ شاعر ألماني يستغلّ الأمثال الشعبية، والحكم، والعبارات الشائعة في اللغة اليومية، التي نسي الناس مصدرها. وبرانتانو كان يحذقُ اللعب بمثل هذه الجمل الجاهزة التي تحيل إلى أكثر مما نحن نظن.
الشعر النفعي
● أمّا شعرك، فأنت تحدثت في تلك المرحلة عما سميته «الشعر النفعي»… كيف استعملت اللغة بطريقة برانتانو نفسها؟
■ عبارة «الشعر النفعي» أثارت كثيرًا من الجدل. ففي الوضع التاريخي لألمانيا في تلك المرحلة، كان الشعراء يواصلون الكتابة بالطارئق التقليدية القديمة، ويثيرون مواضيع لا علاقة لها بالواقع. وكنت أرى أنه من العبث في بلاد كان الناس فيها يجوعون، وكانوا يعيشون على وقع الجرائم النازية، أن نكتب قصائد للتغني بالطبيعة، وبالورد، ووصف الحشرات، كما لو أنه لم يحدث أي شيء؛ لذلك أردت منذ البداية أن أضع الشعر في إطار التفاعل مع الواقع. والعلاقة مع الواقع تكون دائمًا مُعَقّدة، غير أنه سيكون مضحكًا تجاهلها، وتجاوزها، ورفض النظر إليها. في هذا الإطار، تحدثت عما سميته «الشعر النفعي». وبطبيعة الحال، كان مُقترحي عنيفًا ومُفجّرًا لجدل واسع…
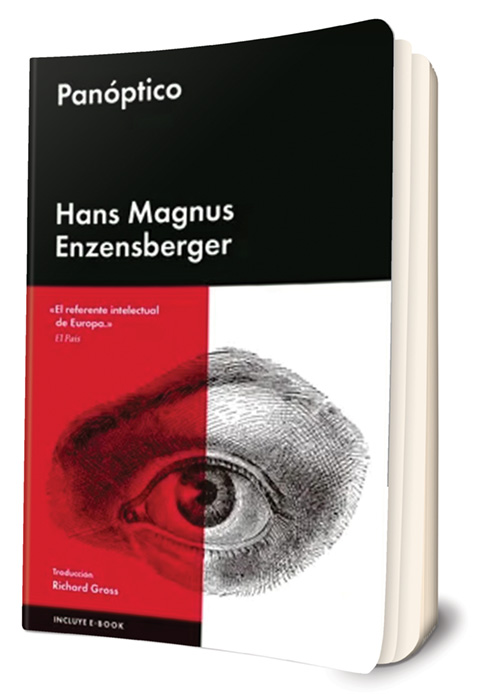 ● إذن أنت أدخلت اللغة اليومية في قصائدك؟
● إذن أنت أدخلت اللغة اليومية في قصائدك؟
■ لقد كان التأخير هائلًا في اللغة الألمانية. تأخير استمر خمسة عشر عامًا، أي في أثناء المدة التي كانت فيها النازية مُهيمنة على البلاد، وفيها ظلت اللغة خارج الآداب العالمية. ولم يكن كتّابها واعين بذلك. وربما لهذا السبب، ظهرت نزعة رومنطيقية بائدة بعد الحرب؛ لذا كان لا بدّ من وضع حد لذلك الشعر المُتعَب، وفي الوقت نفسه، كان لا بد أيضًا أن يكون التجديد مرتبطًا بما حدث ويحدث في الآداب العالمية. وكانت السريالية لنا الألمان البؤساء، اكتشافًا كبيرًا رغم أنه كان قد مر على ظهورها ربع قرن من الزمن.
● في شعرك، عالجت قضايا سياسية، بل أنت أعلنت أن الشعر في النهاية لا بد أن يكون سياسيًّا…
■ في البداية كان هناك مشكل، مشكل يكاد يكون صحيًّا. فألمانيا من وجهة نظر سياسية وأخلاقية، كانت مُلوثة ومريضة. صحيح أن النظام النازي كان قد انتهى، إلا أن البنى والعقليات والسلوكيات التي أنتجها، كانت لا تزال ماثلة للعيان؛ لذا كان لا بد من القيام بعملية تنظيف وتطهير. والجو كان موسومًا بالأكاذيب على نحو لا يُحْتَملُ. وكان من الضروري أن نضع بعضًا من القضايا على الطاولة. ولم يكن العمل سهلًا، وممتعًا، بل كان مريرًا وشاقًّا. مع ذلك كان لا بد من القيام به. وكنت مهووسًا به إلى درجة أني لم أقبل التخلي عنه بأيّ حال من الأحوال. أنا لست مُغْرَمًا بالسياسة، ولو أنني كنت في حالة أخرى لما قبلت التورط فيه…
● هل تغير وضعك الآن؟ وهل تشعر أن كتاباتك لا تزال مثيرة للجدل في بلادك؟
■ في كتاب لبي نشرته عام 1993م، وعنوانه: «آفاق حربية أهليّة»، حاولت أن أبيّنَ أن الحرب الأهلية ليست فقط ظاهرة في إفريقيا، وفي آسيا، وفي بلاد البلقان، بل هي ظاهرة لها بوادرها عندنا. وأنا هنا أتحدث عن حرب أهلية جزئية. ومن جانب آخر، أنا أقول شيئًا يبدو واضحًا: نحن نعيش في كونية بلاغية، كونية تفتّت نفسها في البلاغة. هاتان الفكرتان كادتا تفجران فضيحة، وأنا أتساءل: لماذا كل هذه الضجة؟ انا أعتقد أني لم أكتب ما يمكن أن يثير كل هذا السخط، وهذا الغضب. كل واحد يمكن أن يتوصل إلى ما أنا توصلت إليه… لكن لا أحد يرغب في القيام بذلك…
● نعد إلى الشعر… في الستينيات كتبت شعرًا وصفته بـ «النفعي»… لكنك كنت ترفضُ أن تصفه بـ «الشعر السياسي»… وناهضت فكرة «الأدب الملتزم»…
■ نعم، فأنا أعتقد أن «الأدب الملتزم» له توجه محدد بطريقة صارمة. واللغة خائنة كما هو حالها دائمًا. وأظن أن الالتزام عبارة عسكرية. وانتشار هذه العبارة ليس بمحض الصادفة، فلقد كانت هناك دائمًا قوى سياسية تسعى لتجنيد الكتاب لصالحها. والكتاب مدعوون لأن يكونوا الزائدة الدودية لحزب، أو لحركة…
ضحايا السياسة
● لكنك تقول: إن شعرك الحقيقي ليس سياسيًّا…
■ بما أن السياسة تنتمي إلى تجربتنا اليومية، حتى إلى تجربتنا الذاتية، فإنه ممكن القول: إننا ضحية السياسة إلى حد ما. ونحن ليس باستطاعتنا أن نفصل أنفسنا عنها، وقد أكدت العشرية الأخيرة على ذلك بطريقة واضحة. إذن من الوهم أن نزعم أنه باستطاعتنا أن نعيش بمعزل عن السياسة. وإن نحن سعينا إلى ذلك، فإن الفشل سيكون في انتظارنا في أول منعرج. لكن إذا ما جاءني أحدهم ليدّعي أن حياته خالية من أي بعد جنسي، فإني لن أصدقه. وهذا سيكون ساري المفعول مع السياسة أيضًا…
● هل تعتقد أن الشعر قادر، رغم ضعف انتشاره، على أن تكون له أبعاد سياسية؟
■ كل الناس يعلمون أن الشعر لا يحظى إلا باهتمام الأقلية. ولعله وسيلة التعبير الوحيدة التي لها منتجون أكثر من المستهلكين. هناك آلاف وآلاف من الناس يكتبون الشعر، إلا أن عدد القراء قليل. وهذا أمر غريب، وهو أيضًا مُفَارقَة. لكن يتوجب علينا ألا نتذمّرَ لأن الشعر ليس مُنحصرًا في ناد خاص. والمواضيع التي يخوض فيها لا تخص الشعراء والقراء فقط، بل هو يتجاوزهم ليشمل كل الشؤون الإنسانية. ربما أبالغ، لكن هذا هو الوضع. وعلينا أن نشير إلى أن الشعر يتكلم مكانَ من لا قدرة لهم على الكلام، والتعبير عن مشاعرهم، وعن قضاياهم.

● هل هذا كان اقتناعك في الستينيات والسبعينيات، أي في تلك المدة التي كانت فيها الحركة السياسية المهيمنة على المشهد، تُبْدي نوعًا من الريبة والحذر تجاه الأدب؟
■ علينا أن نتذكر ما قاله سارتر في الجدل الذي حدث بينه وبين كلود سيمون: «ماذا علينا أن نفعل بالأدب إذا ما كان هناك أطفال يموتون جوعا في إفريقيا؟». وأنا حاولت أن أجيب عن هذا اللوم بما يلي: الأدب هو الوسيلة الأقل تأثيرًا بطريقة فورية في الواقع. إذن: إذا ما نحن أردنا أن يكون لنا تأثير مباشر لإحداث تغيّرات في الواقع، فإنه يتوجب علينا أن نترك الأدب جانبًا. لكن إذا ما نحن تمسكنا بالأدب، فإنه سيكون من الخطأ أن نزعم أن ما نقوم به له مفعول سياسي فوري. هناك وسائل أخرى يمكن أن يستعملها الكتّاب للتدخل في الشأن السياسي والاجتماعي، كأن يكتبوا في الصحافة، أو أن يعملوا في الإذاعة. وباختصار، يمكن أن نقول ما يلي: إما أن تقبل بأن تكون غير مبال بالنفعية الفورية، وتواصل الكتابة، أو أن تترك الكتابة، وتختاًر شيئًا آخر… وهذا ما كنت أؤكده في تلك المدة. لكن عندما نُعبّر عن أفكارنا بطريقة معقدة، فإننا نكون قد قلّصنا فكرتنا إلى جملة واحدة، على الأقل هنا في ألمانيا. وهذه الجملة تقول: «لم يعد مُجديًا ممارسة الأدب؛ لأن الأدب قد مات». إلا أنني لم أقل ذلك قط، إذ إن موت الأدب استعارة قديمة، وخالية من الإثارة. وكان هيغل قد تحدث عنها منذ زمن طويل.
● هيغل تحدث عن «نهاية الفن»…لكن هل أنت غيّرت المواد الأدبية التي كنت تملكها لكي تبتكر شيئًا آخر؟
■ لقد عشت أحداث ربيع 1968، كما لو أنه حدث مهم لأن ألمانيا نادرًا ما تعرف مثيلًا له. وكان ذلك الحدث تجربة اجتماعية من الدرجة الأولى، أكثر إثارة من رتابة الصحافة، وحتى من العمل في مجال النشر. لذلك فتنت به لأنطلق بحماس في التحريض على مساندته. ولم أندم أبدًا على ما فعلت. إلا أنني كنت قد تجاوزت شباب ذلك الجيل، ولم أكن طالبًا، وخلفي كانت هناك تجارب كثيرة. لذلك كنت أراقب ما يحدث بهدوء وتروّ، ومن دون هيجان أو حماس مُفرط. وربما لهذا السبب تمكنت من أن ألتقط الجوانب المسرحية، والكوميدية فيما كنت أسمع، وأرى. مع ذلك، سمحت لنفسي بأن أمضي بعيدًا في تلك المغامرة التي أعادتني على المستوى الأدبي إلى العشرينيات حيث جرّب الكتاب والشعراء الكولاج، واستعمال الوثائق، وتركيب النصوص المختلفة المضامين.
في تلك الفترة نفسها، أشرفت على مجلة حملت اسم: Kursbuch
● ماذا كان هدفك منها؟
■ كانت تلك المرحلة مواصلة لعمل ضروري. ففي المجتمع الألماني كنا لا نزال متخلفين. وكانت هناك بقايا لا فقط من النظام النازي، بل وأيضًا من زمن الإمبراطورية القديم، لا تزال مؤثرة في العلاقات بين العمال وأصحاب المصانع، وبين الطلبة والأساتذة. وكان لا بد من تغيير كل ذلك لأنها لا تتناسب أبدًا مع المرحلة الجديدة، مرحلة ما بعد انهيار النازية التي تميزت بالعنف، والتسلط، والاستبداد، وخنْق الحريات العامة والخاصة. ومن خلال المجلة كنت أرغب في أن أصفّي حساباتي مع المرحلة القديمة، ومع بقاياها…
وداع المرحلة البطولية في تاريخ الثورات
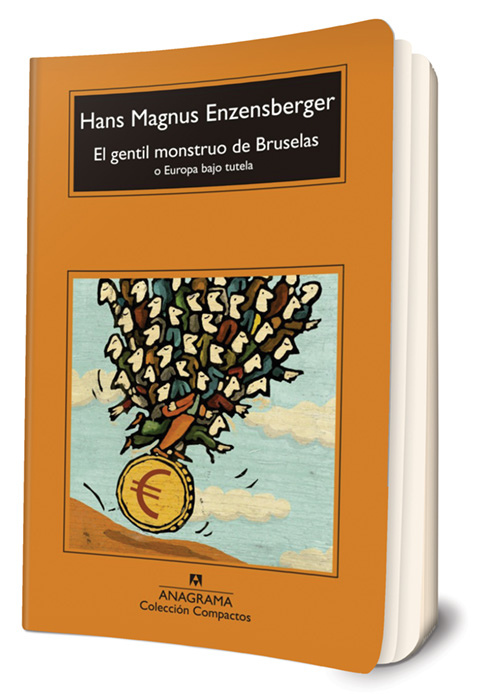 ● في تلك المرحلة أيضًا، كتبت رواية مستوحاة من سيرة الأنارخي الإسباني دوروتي في الحرب الأهلية الإسبانية…
● في تلك المرحلة أيضًا، كتبت رواية مستوحاة من سيرة الأنارخي الإسباني دوروتي في الحرب الأهلية الإسبانية…
■ في ذلك الوقت، كنت مُنْشَغلًا بالسؤال حول دور العفويّة في الحركات الاجتماعية والسياسية. مثلًا: هل يمكن أن يوجد فكر ثوري من دون أدوات، ومن دون جهاز؟ أمامي كان هناك المثال الشيوعي. لذا خيّرت أن أنتهج طريقة تحليل تاريخية تعود إلى الجدل بين ماركس وباكونين. وخلال بحثي، عثرت على تجربة دوروتي، وفيها وجدت جانبًا يكاد يكون فلسفيًّا. وآخر جملة في الكتاب تقول: لا يمكن أن نقوم بنفس الثورة مرتين. وقد كانت روايتي بمثابة توديع للمرحلة البطولية في تاريخ الثورات.
● وهل تعتبر كتابك «غرق التيتانيك» توديعًا للتقدم الصناعي والتقني؟
■ نعم هو توديع، وعن قناعة. فقلد أصبح من المكن أن نحلل صيرورة التطور الذي هيمن على أوربا على مدى بقرون عدة، والبداية تعود إلى القرون الوسطى. ففي تلك المدة، فُتن الأوربيون بالتقدم، على رغم كل المخاطر الناجمة عنه. وهو ما كنت أرغب في الكشف عنه لا في رواية تاريخية، وإنما عبر شخصيات. وقد استعملت شكل الأغنية الراقصة لكي أروي سير الشخصيات. ما يبدو لي مُثيرًا للفضول في حياة جميعها، هو مزيج من العظمة والبؤس. بل أقدر أن أقول بإن كل الذين كانوا مهووسين بالتقدم، وممهّدين له، كانوا حالات مَرَضيّة. وهذا أمر مثير للغاية خصوصًا فيما يتصل بالتفاصيل. من ناحيتي، هناك استعارة ضمنية إذ نحن نجد أنفسنا في وضع شبيه بطريق مقطوع، ونحن سجناء نموذج من التقدم هو من صنيعتنا. وبما أنني لست فيلسوفًا، فإني حاولت أن أعالج هذه الموضوعات الكبيرة من خلال التركيز على التفاصيل والجزئيات، حتى الحميمية منها. وأنا أعتقد أن الكاتب يمتاز على الفيلسوف لأنه يستطيع أن يُظهر الأشياء من دون أن يكون مُجبرًا على تقديم الأدلة على أنه على صواب. واستعارة: غرق التيتانيك ليست تجريدية مطلقًا فأنا أدخل في الشخصيات التي على الباخرة. فقط لا غير. هذا ما يهمني، وليس النقد المنهجي للقيمة الثقافية والحضارية للتقدم من خلال هذه الاستعارة.







 ●
●
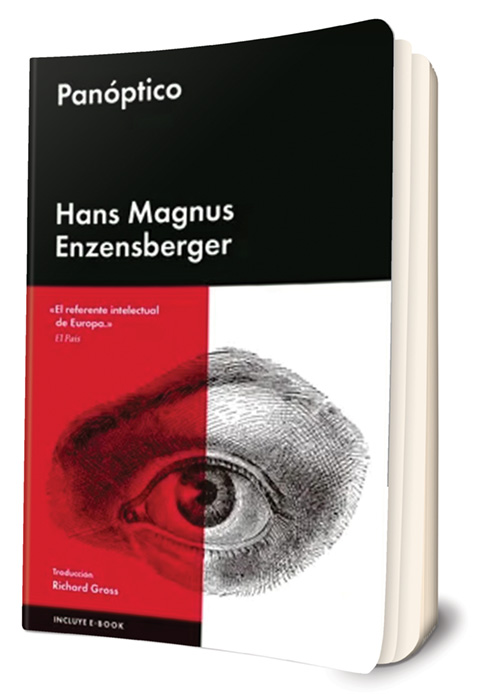 ●
●
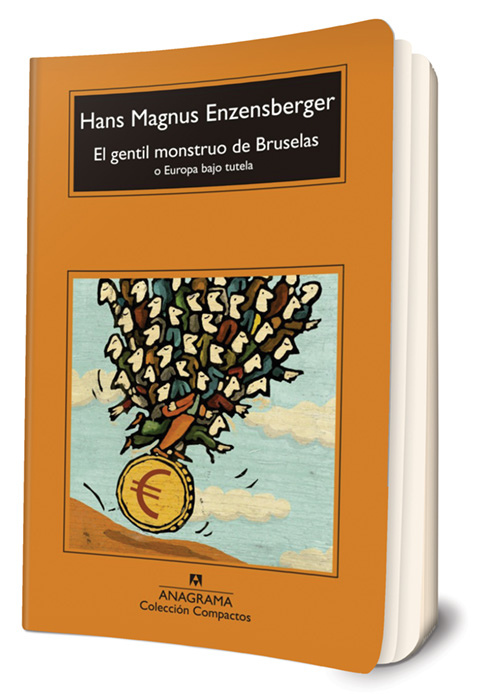 ●
●


0 تعليق