النقد لون من ألوان الترجمة، والترجمة لون من ألوان النقد.
هذه العبارة هي ما سأحاول التفصيل فيها لإيضاح وجوه صحتها. مع أن العبارة اختصار لما قلته في مواضع أخرى وتختصر كثيرًا مما حاولت وحاول غيري إنجازه عند تناول النصوص الأدبية وغير الأدبية من فلسفية وثقافية عامة وغيرها.
قبل الدخول في تفاصيل العبارة أرى أن البدء ينبغي أن يكون بالقراءة. القراءة بما هي محاولة للعبور إلى النصوص، عبور القارئ إلى ما يحمله النص. حين نفتح كتابًا أو نشرع في قراءة نص ما فإننا نبدأ رحلة باتجاه ما يعدنا به ذلك النص، تمامًا كما يحدث حين ندلف إلى مبنى أو حين نفتح حوارًا مع أحد. القراءة والحوار مساعٍ للعبور نحو النصوص أو الذوات المحيطة بنا. الناقد الفرنسي جورج بوليه يقول: إننا حين نمد أيدينا إلى كتاب في الرف فإننا كمن يوقظ روحًا غافية لنحاورها.
النص الأدبي كحاجة جمالية
الحوار هو المحك وبيت القصيد، هو مدار القراءة النقدية ومدار الترجمة أيضًا. والترجمة الأدبية لون من الحوار مع النص، الحوار الذي يحدث على مستوى مختلف أو بطريقة مغايرة للحوار الذي ينشأ مع النص غير المترجم، النص الذي نشترك معه في لغة واحدة، لا نترجمه إلى لغة أخرى وإنما نستوعبه مباشرة، أو هكذا يفترض.
وقد يستغرب بعضٌ لو قلت: إن القراءة، أي قراءة، هي في نهاية المطاف لون من ألوان الترجمة. إننا نترجم الحروف والكلمات إلى دلالات ومشاعر، نحولها من صورتها المرسومة على الصفحة إلى ما يقابلها في أذهاننا من معانٍ وأحاسيس في عملية سيميائية أو استدلالية ننساها لشدة ألفتها وطابعها اللاواعي. وبهذا يكون كل قارئ مترجمًا بقدر ما أن كل مترجم قارئ.
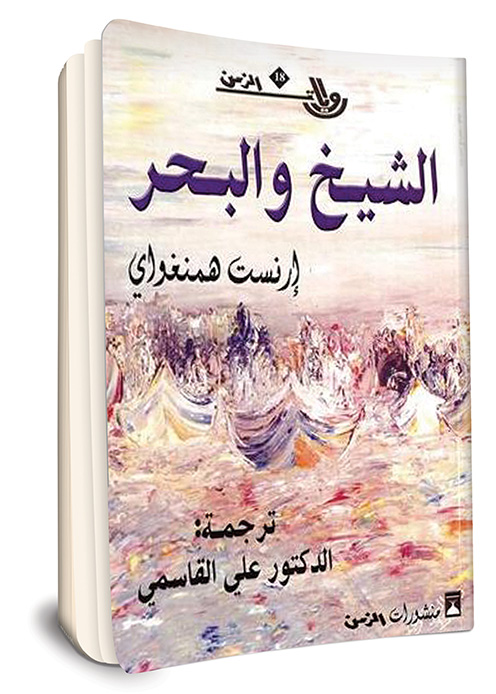 لكن القراءة حين تكون لنص أدبي، حين تكون نقدًا أي قراءة محكومة بمنهج ومعرفة أو خبرة، فإنها تأخذ بعدًا مختلفًا. إنها تتحول إلى عملية تفسير مكثف تبعًا لكثافة النص. فلكي يكون النص الأدبي أدبيًّا، لا بد له من أن يكون على قدر من الكثافة. وبالكثافة أقصد تحول المفردات والعبارات من دلالاتها المباشرة إلى دلالات مجازية ندرك حين نطالعها أننا لسنا أمام كلام عادي، كلام تقريري. النص الأدبي، كما أدرك النقاد طوال العصور، صعود باللغة إلى مستويات من الدلالة لا تلبي احتياجنا اليومي للتواصل، أي لا نحتاجها لكي نتواصل، لكنها تشبع احتياجنا الجمالي، حاجتنا لمتعة القول. هي متعة مترفة إلى حد ما، متعة من لا يريد من الطعام مجرد الشبع وإمداد الجسم بالطاقة، وإنما أيضًا متعة المذاق وإرضاء احتياج آخر، هو الاحتياج الجمالي، وهذا احتياج مترف دون شك، لكنه مهم؛ ذلك أن الاحتياج إلى الجميل والممتع احتياج إنساني تتحقق به إنسانيتنا أو تصعد به إلى مراتب أعلى.
لكن القراءة حين تكون لنص أدبي، حين تكون نقدًا أي قراءة محكومة بمنهج ومعرفة أو خبرة، فإنها تأخذ بعدًا مختلفًا. إنها تتحول إلى عملية تفسير مكثف تبعًا لكثافة النص. فلكي يكون النص الأدبي أدبيًّا، لا بد له من أن يكون على قدر من الكثافة. وبالكثافة أقصد تحول المفردات والعبارات من دلالاتها المباشرة إلى دلالات مجازية ندرك حين نطالعها أننا لسنا أمام كلام عادي، كلام تقريري. النص الأدبي، كما أدرك النقاد طوال العصور، صعود باللغة إلى مستويات من الدلالة لا تلبي احتياجنا اليومي للتواصل، أي لا نحتاجها لكي نتواصل، لكنها تشبع احتياجنا الجمالي، حاجتنا لمتعة القول. هي متعة مترفة إلى حد ما، متعة من لا يريد من الطعام مجرد الشبع وإمداد الجسم بالطاقة، وإنما أيضًا متعة المذاق وإرضاء احتياج آخر، هو الاحتياج الجمالي، وهذا احتياج مترف دون شك، لكنه مهم؛ ذلك أن الاحتياج إلى الجميل والممتع احتياج إنساني تتحقق به إنسانيتنا أو تصعد به إلى مراتب أعلى.
ولأضرب لذلك مثالًا: لو أن أحدًا قال لصديقه: كان الليل طويلًا ليلة البارحة ومملًّا وثقيلًا، أتاني بالهموم فلم أستطع النوم. كلام واضح لا يحتاج إلى إعمال الذهن؛ لأنه مباشر، كلام ذهب إلى الكلمات في دلالاتها الأساسية أو المألوفة. لكن لو أنه قال مثل امرئ القيس: «وليل كموج البحر أرخى سدوله/ عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي»؛ لأدرك القارئ أو السامع أنه ليس إزاء كلام مباشر مألوف. إنه كلام لا يقصد الإخبار فحسب، وإنما يقصد المتعة والجمال أيضًا. إنه كلام يتوسل المجاز أو اللغة المكثفة ليقول شيئًا ويحدث أثرًا يدرك قائله أن العبارة المباشرة لن تحدثه. لكن الفارق، بين الأدبي وغير الأدبي، ليس دائمًا بذلك الوضوح؛ ففي الشعر، ومنه معلقة امرئ القيس نفسها أبيات كثيرة لا تصعد إلى الكثافة التي رأينا في البيت السابق، ولا تستدعي من ثم مستوى موازيًا من القراءة النقدية التي تدقق في الدلالات والأبعاد المجازية. مطلع المعلقة المعروف جدًّا يقول: «قفا نبكِ من ذِكرى حبيب ومنزل…» إلى آخر البيت: هنا بداية لرسم مشهد شعري سيتنامى ويصل إلى مستويات عالية كالتي رأينا، لكن البداية نفسها ليست مكثفة: هي أقرب إلى التقرير لأن الخطاب شديد الوضوح. وكلما طال نص القصيدة تضاءلت مساحات التكثيف؛ لأن من الصعب أو المرهق للشاعر وللمتلقي معًا أن يظل النص على الوتيرة نفسها من الكثافة أو التصوير المجازي. لكن القصائد القصيرة تسمح بذلك الضغط سواء في الدلالة أو المجاز. من هنا قيل: إنه لا توجد قصيدة كلها شعر، وهو ما ينسحب على القصائد الطويلة ومنها قصائد كبار الشعراء والأعمال الملحمية في مختلف الثقافات من جلجامش والملاحم السنسكريتية إلى ملحمتَيْ هوميروس إلى الشعر العربي في عصوره العربية القديمة والحديثة إلى الشعر الغربي القديم والحديث وغيره.
من المباشر إلى المكثف والشعري
وما يحدث في الشعر يحدث في النثر، ومنه السرد. الرواية نص طويل ولغته مباشرة في الغالب، ما تتوخاه هو سرد الحكاية ورسم الأشخاص وإدارة الحوار توصيلًا لرؤية أو موقف أو فكرة ما، وهذا لا يستدعي لغة مجازية أو رمزية أو مكثفة. لكن الرواية نفسها تتخللها أحيانًا مقاطع أو لحظات من السرد نفسه تصعد إلى الشعر، وهناك أمثلة كثيرة لكن يصعب التوسع في الاستشهاد بها لكيلا يخرج هذا الحديث عن إطاره المعقول.
ومن الطبيعي أن تتأثر ترجمة الأدب بذلك التفاوت، فمترجم الأدب قارئ وناقد له بالضرورة. وليس من الضروري أن يكون النقد عملية مركبة من التحليل والحِجَاج والحكم. قد يكون النقد رؤية ضمنية تنطوي على تذوق ورؤية. وهذا ما أقصده حين أقول: إن الترجمة لون من النقد. أترجم النص الذي يهمني أو يعجبني وهذا بحد ذاته حكم نقدي، وإنْ كان في أبسط صوره. لكن الترجمة الأدبية لا يمكن أن تكون إلا مركبة، فازدواجية اللغة تعني ازدواجية الثقافة وتعني بالتبعية التفاوت في الفهم والاستدلال وفي التذوق أيضًا. ومع أن التفاوت ليس نهائيًّا أو عامًّا، بمعنى أن هناك كثيرًا من المشتركات التي لا تختلف فيها لغة أو ثقافة عن أخرى، فإن قدرًا لا بأس به من البِنَى اللغوية والمعايير الجمالية والمواضعات الاجتماعية والبيئية تختلف وتختلف معها إمكانيات النقل والاستيعاب ومستوى التفاعل أو نوعه.
وإذا كانت الترجمة بطبيعتها عملًا مركبًا، بغض النظر عن مستوى اللغة المترجم منها وإليها، فلنا أن نتخيل ما يحدث حين تصعد اللغة المترجم منها من المباشر إلى المكثف أو الشعري سواء كان المترجَم عملًا شعريًّا أو غير ذلك. ستتضاعف تركيبية الترجمة عندئذٍ وتتضاعف الصعوبة معها. لكن الترجمة يمكن أن تكون أيضًا وسيلة لاكتناه النص، أي قراءة نقدية له تساعد على تبين الدلالات والجماليات خلف كثافة اللغة وغرابة المفردات والتراكيب. وأضرب مثالًا من تجربتي الخاصة.
في المراحل الأولى من دراستي لأدب اللغة الإنجليزية وجدت صعوبة في منافسة الطلاب الأميركيين في تناول أدب كتب بلغتهم. اكتشفت في ترجمة النص إلى العربية وسيلة للوصول إلى جوانب دلالية وأحيانًا جمالية يصعب على القراءة المباشرة الوصول إليها. كان تمرير النص الأجنبي على مناظير اللغة العربية وسيلة لاكتشاف ما يصعب اكتشافه دون ترجمة. ومع أن الهدف لم يكن عندئذٍ التوصل إلى رؤية نقدية حول دور الترجمة في القراءة النقدية، وإنما كان المنافسة الطلابية المعهودة، فإنني الآن إذ أعود إلى تلك الوسيلة أرى أنها كانت مبررة ومثمرة، كأن النص يفتح مغاليقَ له لم تكن لِتنفتحَ لو ظل بلا ترجمة. فحين نتخلى قليلًا عما ألفنا من لغة وأساليب عيش في بيئة غير بيئتنا التي اعتدنا نكتشف أنفسنا من زاوية جديدة مغايرة. ومع أن ما قد نكتشفه ليس رائعًا بالضرورة إلا أنه مختلف على أية حال.
الاقتراب من النص من بعيد
وإذا كانت النصوص الأدبية بطبيعتها ابنة ثقافتها والأكثر إخلاصًا للثقافة من النصوص الأخرى كالعلمية وغيرها، من حيث هي ملتحمة بالموروث ومؤسسة على التصورات الفردية المنبعثة من تفاعل الإنسان مع بيئته، فإن ترجمة تلك النصوص سبب آخر لاكتشاف الجوانب التي يصعب تبيّنها بلا ترجمة، أو التي تكون الترجمة عاملًا مساعدًا على اكتشافها.
في إحدى أشهر قصائده التي كتبها في شكل السونيته، يقارن شكسبير بين المحبوب ويوم من أيام الصيف قائلًا: «هل أشبهك بيوم صيف؟ أنت أجمل وأكثر هدوءًا». ذلك التشبيه يصعب تصوره في قصيدة عربية؛ لأن الشاعر العربي يعرف أن الحبيب سيغضب لذلك التشبيه الذي يجعله ملتهبًا لا يطاق. الصيف الإنجليزي هو ما تغنى به الشعراء الإنجليز من شكسبير نفسه إلى كيتس في العصر الرومانسي إلى أودن في القرن العشرين. لكنه بالتأكيد ليس ما نجد في الشعر العربي أو شعر الصحراء عامة. إنه التحام بالبيئة يتكرر في استعمال الرموز والأساطير والحكايات التاريخية التي تحدّ من قدرة الترجمة وقدرة أهل البيئات المغايرة على التفاعل مع النص، أو تلون تفاعلهم بطرق لم يتوقعها الشعراء والكتاب.
في الترجمة تتجلى تلك الإشكاليات الأدبية بصورة واضحة. وكلما زاد التحام النص بخلفيته الثقافية أو ازدادت كثافته المجازية كلما ازدادت صعوبة الترجمة، واضطر المترجم إلى البحث عن بدائل تقترب من النص وإنْ مِن بُعْد. الترجمات الناجحة أو المتميزة عند أكثر القراء هي تلك التي تنسيك أنها ترجمة، أي التي تجعل النص كما لو كان قد كُتب بلغة القارئ نفسه. لكن من يستمتعون بتلك الترجمات لا يدرون في الغالب عن الثمن الذي دُفع لكي يصل النص إليهم بتلك الصورة. ما يحدث هو أن النص أعيدت كتابته من زاوية اللغة المترجم إليها، فبدلت الإحالات الغريبة وأزيلت أو خففت المجازات المعقدة.
نماذج تطبيقية
سأضرب مثالًا بثلاثة أعمال مترجمة؛ أحدها من الشعر، والآخران من السرد. العمل الشعري هو قصيدة عمر الخيام «الرباعيات» التي يرى بعضٌ، أو كثيرٌ ربما، أن أنجح ترجماتها هي تلك التي توارى فيها الأصل وحَلَّت مَحَلَّه قصيدةٌ عربية جديدة. ذلك ما سعى إليه الشاعر والمترجم العراقي أحمد الصافي النجفي، مثلما سعى أيضًا الشاعران المصريان أحمد رامي وأحمد زكي أبو شادي. ومع ذلك فإن بعض العارفين بالنص الفارسي يُثنون على ترجمة النجفي من حيث إنها أقرب إلى الأصل من معظم الترجمات الأخرى. لكن من المهم أيضًا أن كل الترجمات كانت نتاج قراءة نقدية للعمل، قراءة أفضت ابتداءً إلى اختيار النص للترجمة، أي الإعجاب به والقناعة بجدارته بالنقل إلى العربية.

جوخة الحارثي
يقول النجفي: إنه قرأ الرباعيات بترجمة اللبناني وديع البستاني، وتركت أثرًا عميقًا فيه، فقرر تعلم الفارسية ودراسة الأدب الفارسي بُغْيةَ «النفوذ إلى معانيه الدقيقة ومراميه السامية لأصل منها إلى الينبوع الصافي الذي سالت منه خيالات عمر الخيام الشاعر الذي شغفت به من دون باقي شعراء الفرس». بل إن النجفي يذهب أبعد من ذلك إلى شرح كيف كان ينتقي الرباعيات. يقول: إنه سعى إلى «تقريب التعريب بقدر الطاقة من الذوق العربي، وكان ذلك يلجئني أحيانًا إلى أن أفرغ الرباعية الواحدة في أكثر من عشرين سبكًا حتى أختار منها السبك الوافي بأداء المعنى والمطابق للذوق العربي…»، وإلى جانب ذلك الانتقاء النقدي بطبيعته نجد النجفي حريصًا في مقدمته لما أسماه تعريب الرباعيات، ومن باب الأمانة، على إخبارنا أن «هناك رباعيات جميلة لم أستطع مع إفراغ الجهد أن أبرز معانيها المهمة كاملة في الترجمة مع الموافقة للذوق العربي فنكبت عن ترجمتها معترفًا بعجزي وقصوري» (رباعيات عمر الخيام، تعريب السيد أحمد الصافي النجفي، د. ت. ص5، 7).
المثال السردي استمده من ترجمة إحدى أشهر الروايات في الأدب الأميركي: «الشيخ والبحر» لهمنغواي. لقد ترجمت هذه الرواية مرات عدة، أشهرها وربما أقدمها ترجمة منير البعلبكي التي صدرت عام 1958م. من المسائل التي طرحت في ترجمة رائعة همنغواي الجزء الأول من عنوانها: The Old Man، هل الأنسب ترجمة old man إلى الشيخ، كما في بعض الترجمات أو إلى العجوز، كما في ترجمات أخرى. والعنوان، كما يقول لنا نقاد السرد، هو العتبة الأولى التي ندلف منها إلى النص، ما يجعله بالتالي حاكمًا إلى حد مهم لقراءتنا للنص، فمنه تنشأ توقعات وتولد دلالات. ثلاث ترجمات، كما تخبرنا إحدى الباحثات، اختارت «العجوز» (العجوز والبحر)، في حين اختار علي القاسمي في ترجمة حديثة للرواية كلمة «الشيخ»، التي سبق أن اختارها البعلبكي. تقول الباحثة فتحية تمزارتي: إن القاسمي برر رفضه لكلمة «عجوز»؛ لأن تلك الكلمة «مشتقة من »العَجْز«؛ أي: عدم القدرة على العمل، في حين أنَّ الغاية الأساسية من قصة همنغواي هي تصوير نضال الإنسان المستمر، وكفاحه المتواصل وعمله الدائم من أجل التحكم في الطبيعة وترقية مستوى الحياة». هنا رؤية نقدية واضحة وحاكمة للاختيار الترجمي. ولا شك أن ثنايا الرواية مليئة بأمثالها من الاختيارات، وإنْ لم تكن بالمستوى ذاته من الوضوح.
المثال الثاني والأخير أجده في ترجمة معاكسة، أي من العربية إلى الإنجليزية. وهي رواية عربية حديثة (2010) ومترجمتها بريطانية. إنها رواية الكاتبة العمانية جوخة الحارثي «سيدات القمر» التي فازت عام 2019م بجائزة مان بوكر الدولية للترجمة. إشكالية النقل بدأت، كما هي الحال في رواية همنغواي، بالعنوان. قررت المترجمة، كما ذكرت الناشرة في إحدى المناسبات، أن الترجمة الحرفية للعنوان العربي سيقود القارئ إلى دلالة غير مناسبة؛ لأن «سيدات القمر» في الثقافة الأنغلوسكسونية لسن سيدات وإنما بائعات هوى؛ لذا استبدلت «أجرام سماوية» بالعنوان الأصلي، ليكون العنوان: Celestial Bodies. لكن هذا التعديل النقدي لم يتوقف عند العنوان وإنما شمل وضع عناوين لفصول الرواية التي لم تحمل عناوين في نصها العربي. كما تضمن إضافة شجرة نسب لشخوص الرواية، فضلًا عن أن المترجمة اقترحت حذف الفصل الأخير لولا أن الكاتبة اعترضت على ذلك. واعتراض المترجمة كان لضبابية ذلك الفصل وانتهاء الرواية بنهاية غير واضحة. كل تلك وغيرها في ثنايا النص ملحوظات نقدية تصب في صلب عملية الترجمة التي يتضح المرة تلو الأخرى أنها عملية نقدية أيضًا.
ولعلي بهذا أكون قد وضحت صحة العبارة التي ابتدأت بها: النقد لون من ألوان الترجمة، والترجمة لون من ألوان النقد.







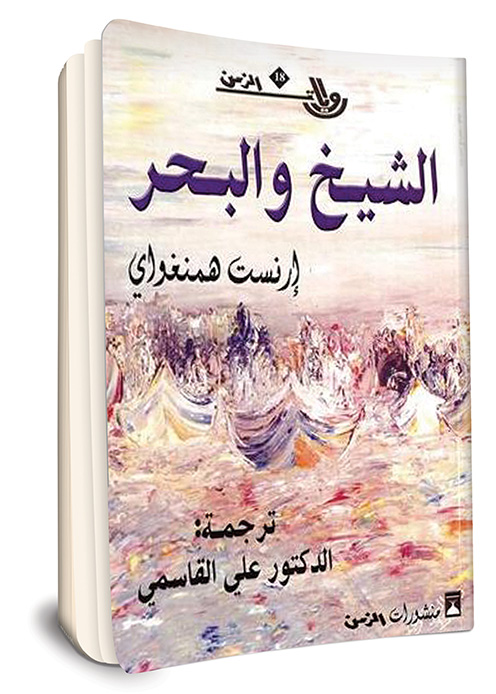 لكن القراءة حين تكون لنص أدبي، حين تكون نقدًا أي قراءة محكومة بمنهج ومعرفة أو خبرة، فإنها تأخذ بعدًا مختلفًا. إنها تتحول إلى عملية تفسير مكثف تبعًا لكثافة النص. فلكي يكون النص الأدبي أدبيًّا، لا بد له من أن يكون على قدر من الكثافة. وبالكثافة أقصد تحول المفردات والعبارات من دلالاتها المباشرة إلى دلالات مجازية ندرك حين نطالعها أننا لسنا أمام كلام عادي، كلام تقريري. النص الأدبي، كما أدرك النقاد طوال العصور، صعود باللغة إلى مستويات من الدلالة لا تلبي احتياجنا اليومي للتواصل، أي لا نحتاجها لكي نتواصل، لكنها تشبع احتياجنا الجمالي، حاجتنا لمتعة القول. هي متعة مترفة إلى حد ما، متعة من لا يريد من الطعام مجرد الشبع وإمداد الجسم بالطاقة، وإنما أيضًا متعة المذاق وإرضاء احتياج آخر، هو الاحتياج الجمالي، وهذا احتياج مترف دون شك، لكنه مهم؛ ذلك أن الاحتياج إلى الجميل والممتع احتياج إنساني تتحقق به إنسانيتنا أو تصعد به إلى مراتب أعلى.
لكن القراءة حين تكون لنص أدبي، حين تكون نقدًا أي قراءة محكومة بمنهج ومعرفة أو خبرة، فإنها تأخذ بعدًا مختلفًا. إنها تتحول إلى عملية تفسير مكثف تبعًا لكثافة النص. فلكي يكون النص الأدبي أدبيًّا، لا بد له من أن يكون على قدر من الكثافة. وبالكثافة أقصد تحول المفردات والعبارات من دلالاتها المباشرة إلى دلالات مجازية ندرك حين نطالعها أننا لسنا أمام كلام عادي، كلام تقريري. النص الأدبي، كما أدرك النقاد طوال العصور، صعود باللغة إلى مستويات من الدلالة لا تلبي احتياجنا اليومي للتواصل، أي لا نحتاجها لكي نتواصل، لكنها تشبع احتياجنا الجمالي، حاجتنا لمتعة القول. هي متعة مترفة إلى حد ما، متعة من لا يريد من الطعام مجرد الشبع وإمداد الجسم بالطاقة، وإنما أيضًا متعة المذاق وإرضاء احتياج آخر، هو الاحتياج الجمالي، وهذا احتياج مترف دون شك، لكنه مهم؛ ذلك أن الاحتياج إلى الجميل والممتع احتياج إنساني تتحقق به إنسانيتنا أو تصعد به إلى مراتب أعلى.



0 تعليق