في هذا الحوار الذي يجمع بين منطق الأفكار ومنطق الخيال يتحدث عبدالفتاح كيليطو وعبدالسلام بنعبد العالي عن مسألتين مركزيتين هما: علاقة الأدب بالفلسفة والترجمة بوصفها إعادة كتابة. في المسألة الأولى يتحدثان عن الكتابات خارج إطار التصنيف وتماسها مع الفلسفة، ويستشهدان بنماذج بارزة؛ سارتر وكامو، وبارت ودريدا، من ناحية استناد مفاهيم الفلسفة إلى مجازات متوارية واتصاف الأدب بأنه حامل التجربة الإنسانية العميقة، وشهادة على حياة المفهومات. وفي المسألة الثانية يتناولان حالة استثنائية يكون فيها الكاتب مترجمًا لأعماله: هل يلجأ إلى الترجمة لتوضيح الغامض في الأصل؟ ويتساءلان، في ظل هذه الازدواجية اللغوية، عن مكان النص الأصلي: أهو في اللغة الأولى التي كُتب بها النص أم في اللغة المنقول إليها؟ أم هو بينهما؟ كما في حالة بيكيت وكونديرا.
 في هذا الحوار، الذي أنجزه الدكتور بنعبد العالي باقتراح من «الفيصل»، بمناسبة فوز كيليطو بجائزة الملك فيصل العالمية، يتكلم كيليطو وبنعبد العالي جميع اللغات بالعربية ويعيدان النظر في مفهوم الأصل الذي يرقى بالنسخ إلى مرتبة النماذج، ويجعل الأصول وليدة الفروع. عن الترجمة التي تجعل الأصل نسخة، أو مسودة، تنفخ فيها الحياة من جديد. ويطرقان باب الحديث عن الأدب بوصفه منبعًا لا ينضب عن الإنسان، وعن الرواية التي تفتح لنا العالم بمختلف قاراته وأراضيه وبحاره، وعن الشعر وهيمنته على العقل في عصر وارتباطه بالتسول في عصور لاحقة، وعن الاغتراب ودلالة تمزيق الكتب وعلاقة ذلك بالتخلي والخروج ومحو الأثر، عن البقاء بالمحو، والحضور بالغياب.
في هذا الحوار، الذي أنجزه الدكتور بنعبد العالي باقتراح من «الفيصل»، بمناسبة فوز كيليطو بجائزة الملك فيصل العالمية، يتكلم كيليطو وبنعبد العالي جميع اللغات بالعربية ويعيدان النظر في مفهوم الأصل الذي يرقى بالنسخ إلى مرتبة النماذج، ويجعل الأصول وليدة الفروع. عن الترجمة التي تجعل الأصل نسخة، أو مسودة، تنفخ فيها الحياة من جديد. ويطرقان باب الحديث عن الأدب بوصفه منبعًا لا ينضب عن الإنسان، وعن الرواية التي تفتح لنا العالم بمختلف قاراته وأراضيه وبحاره، وعن الشعر وهيمنته على العقل في عصر وارتباطه بالتسول في عصور لاحقة، وعن الاغتراب ودلالة تمزيق الكتب وعلاقة ذلك بالتخلي والخروج ومحو الأثر، عن البقاء بالمحو، والحضور بالغياب.
الفيصل
بين الأدب والفلسفة
بنعبد العالي: أنت تكتب كتابات، حتى وإن كان يتعذر تصنيفها ضمن جنس بعينه من الأجناس الأدبية، فهي تندرج، في النهاية، ضمن ما نطلق عليه اليوم “أدبا”، فبأيّ معنى ترى إمكانية حوار مع من ينصبّ اهتمامه على ما يدعى “فلسفة”؟
كيليطو: عندما نشرتُ أوّل كتاب لي، “الأدب والغرابة”، تفضلتَ بنشر مقال عنه “الألفة والغرابة”. تفاجأت لأنه كان أوّلَ مقال حظي به الكتاب، وأيضًا لأنك عاملته ككتاب فلسفي، فكان حالي كحال السيد جُورْدان في مسرحية موليير، حين اكتشف أن النثر هو الكلام الذي يصدر عنه يوميًّا. مازحت نفسي بكوني فيلسوفًا دون أن أعي ذلك، وبعض القراء يعتقدون هذا. في الواقع ليس لي أيّ تكوين فلسفي، كل ما أتخيل أني أعرفه من الفلسفة هو، من جهة ما التقطته من روايات كـ “الإخوة كرامازوف” لدوستويفسكي ومن “هكذا تكلم زاردشت”، الكتاب الوحيد الذي قرأته لنيتشه باعتباره نصًّا شعريًّا، ومن جهة أخرى ما تعلمته من بعض كتب النقد الأدبي، رولان بارت، تزفيتان تودوروف، ومن فلاسفة يحيلون ضمنيًّا أو علانية على الأدب، أمثال جاك دريدا وإميل سيوران، دون أن ننسى فرويد الذي استفدت منه كثيرًا.
بنعبد العالي: ألا تعتقد، بالرغم من ذلك، أن ما تقوم به في أعمالك يلتقي مع انشغالات الفيلسوف، خصوصًا أمثال هؤلاء الذين أتيت على ذكر بعضهم، والذين نعجز اليوم عن تصنيفهم. ولكي نأخذ مثالًا واحدًا من هؤلاء، ألا تذكر أنّ دريدا كان يأتينا إلى الكلية، لا بدعوة من قسم الفلسفة، وإنما من القسم الذي كنت تدرِّس فيه، أي الآداب الفرنسية؟ فضلًا عن أن الذين كانوا يحضرون محاضراته، كانوا مزيجًا من القسمين معًا.
 وكما تعلم، يمكننا أن نعطي أمثلة كثيرة على ذلك، بل يمكننا أن نتراجع حتى الرومانسيين الألمان، أي بالضبط الحقبة التي تحدّد فيها الأدب بالمعنى الذي نتداوله الآن. وعلى ذكر هؤلاء الرومانسيين، لنتذكر ما قاله عنهم بلانشو من أنهم “كانوا يشعرون وهم يكتبون، بأنهم الفلاسفة الحقيقيون”. سيتمخض عن موقف هؤلاء أن الفلسفة تتحدد بنتائجها التي تتحقق في الكتابة، وأنها تخضع، مثل أي كتابة، للتدفق الدلالي غير المحكوم، وأن مفهوماتها تستند إلى مجازات متوارية، وأنها لا يمكن أن تُتصوّر خارج المجال النصي المتحقق.
وكما تعلم، يمكننا أن نعطي أمثلة كثيرة على ذلك، بل يمكننا أن نتراجع حتى الرومانسيين الألمان، أي بالضبط الحقبة التي تحدّد فيها الأدب بالمعنى الذي نتداوله الآن. وعلى ذكر هؤلاء الرومانسيين، لنتذكر ما قاله عنهم بلانشو من أنهم “كانوا يشعرون وهم يكتبون، بأنهم الفلاسفة الحقيقيون”. سيتمخض عن موقف هؤلاء أن الفلسفة تتحدد بنتائجها التي تتحقق في الكتابة، وأنها تخضع، مثل أي كتابة، للتدفق الدلالي غير المحكوم، وأن مفهوماتها تستند إلى مجازات متوارية، وأنها لا يمكن أن تُتصوّر خارج المجال النصي المتحقق.
إضافة إلى خضوع الكتابة الفلسفية إلى هذا التحقّق النصّي، فإن مفهوماتها لا “تحيا” في انعزال مطلق. على هذا النحو، وكما بين دولوز، فبقدر ما يرسم العمل الأدبي من شخوص، بقدر ما ينحت من مفهومات. المفهومات شخوص والشخوص مفهومات. كأن الأدب، بوصفه حامل التجربة الإنسانية العميقة، شهادة على حياة المفهومات. أذكر أنني عندما كنت قد كتبت مقالًا عن كتابك “الغائب” لم أستطع أن أفصل السروجي عما كتبه بودريار عن آلية التشبه وعن النسخ والسيمولاكرات. ها أنت ترى أنك تعرض في كتابك أفكارًا، صحيح أن ذلك لا يتمّ عبر تحليل مفهومات مجردة، ولكن عبر تحليل لشخوص المقامة. ها أنت إذن “في” الفلسفة أكثر بكثير من السيد جوردان مع النثر.
كيليطو: متى أخذتُ أهتم بالفلسفة؟ في البداية، إن كان لهذه الكلمة من معنى، لم أكن مطلعًا إلا على مقالات مونتيني، وزرداشت نيتشه. أما غيرها من المؤلفات فكنت أتجنبها رهبة منها. ومن جهة أخرى كنت حبيس الاختصاص، فما شأني، أنا الأديب، بالفلسفة؟ لذا كنت أقرأ روايات سارتر وكامو، وأعرض عن كتبهما الفكرية. اليوم حين أتذكر تلك الحقبة أرى أنني كنت شبه أمي وأخجل من نفسي. في 1970م ألقى رولان بارت دروسًا في كلية الآداب، حضرت أربعة منها متهيبًا وجلًا. في أحدها ذكر اسم جاك دريدا وقال إنه ذو أمانة فكرية كبيرة. قرأت “الكتابة والاختلاف” فإذا بي أكتشف أن اهتمامه ينصب ليس على الفلسفة فحسب، وإنما أيضًا على الأدب، فشعرت بالاطمئنان، وأن عليَّ أن أعالج تقصيري وأتخلص من فكرة الاختصاص، فدخلت مرحلة جديدة ملؤها الحيوية والفضول المعرفي. أشاطر جيل دولوز حين يدعو، بجانب قراءة الفلسفة، إلى قراءة غير فلسفية للفلسفة، وغير موسيقية للموسيقا، وغير أدبية للأدب…
بنعبد العالي: في حديثك عن علاقة الفلسفة بالأدب، أشرت إلى جيلين: جيل سارتر وكامو، ثم جيل بارت ودريدا. أعتقد أن الفرق بين موقفي هذين الجيلين من شأنه أن يوضّح لنا ما يمكن أن يكون اليوم علاقة بين الفلسفة والأدب.
أكاد أجزم أن تلك العلاقة عند جيل سارتر ظلت إلى حد ما علاقة مرآتية إن صح التعبير، فمؤلفات سارتر الأدبية “مرآة” لكتبه الفكرية، حتى لا نقول تجسيدًا. وربما، الأمر أكثر وضوحًا عند كامو. فحتى إن كانا يربطان الأدب بالفلسفة فهو ربط خارجي، ربط منفصل. لهذا نميز بسهولة تأليفهم الأدبي عن الفكري، الأمر الذي نعجز عنه بصدد دريدا على سبيل المثال. ولعل هذا هو ما سمح لك أن تقول إنك اقتصرت على المؤلفات الأدبية لسارتر وكامو. وفي رأيي، يمكن أن نقول إن قراءة الأدب في هذه الحالة تعفي من قراءة المؤلفات الفكرية. الأمر مخالف لذلك عند بارت ومن نحا منحاه. هنا الحمولة الفكرية مبثوثة في ثنايا التحليل الأدبي. ليس هناك تنظير مستقل. وبالعودة إلى ما قاله بلانشو عن الرومانسيين الألمان، لنقل معه إن هؤلاء أيضًا فهموا النظرية كأدب والعكس.
كيليطو: لماذا أندهش حين أعلم أن سارتر كان يفضل قراءة الروايات البوليسية على كتب الفلسفة؟ أما بارت فكانت له طقوس قرائية ليلية من طينة روايات جول فيرن، وفي وقت ما كان يحب الاستشهاد بروايات أيان فليمينغ، صاحب جيمس بوند؟ أتخيل أن هيجل كان يفضل قراءة الجريدة، هو الذي قال عنها إنها صلاة الصباح بالنسبة للإنسان الحديث.
العين التي نقرأ بها
بنعبد العالي: ربما ستزداد دهشتك إذا ذكّرتك بأن سارتر لم يكن، عند كتابته لـ “الوجود والعدم”، قد قرأ لفرويد أو لنيتشه إلا كتابين لكل واحد منهما، على حد اعتراف رفيقة دربه سيمون دو بوفوار. ولكن المهم في نظري، ليس العناية التي نوليها لتاريخ الفلسفة، وإنما الكيفية التي نتعامل بها مع ذلك التاريخ. كما أن المهم ليس ما نقرأ، وإنما العين التي نقرأ بها. فقد ينصب اهتمام القارئ على ما أهمله التاريخ، إلا أن قراءته قد تكون أكثر إنتاجًا وربما تجديدًا. يحضرني هنا مثال دولوز الذي قال عن نفسه: «كنت أفضل الكتاب الذين كان يبدو أنهم ينتمون إلى تاريخ الفلسفة، إلا أنهم كانوا ينفلتون من أحد جوانبه، ومن ثمة يخرجون منه كلية، أمثال لوكريتيوس وسبينوزا وهيوم ونيتشه وبرغسون».
أعتقد أن اهتمامك أنت بالمقامات والجاحظ والمعري، يمكن أن يدخل في هذا الباب، فمتون من هذا القبيل، تنتمي إلى تاريخ الأدب، إلا أنها «تنفلت من أحد جوانبه، ومن ثمة تخرج منه». ربما كان هذا الانفتاح على “الخارج” هو ما يمكن من “إنعاش” الكتابة. والخروج يمكن أن يتم في الزمان، كما يمكن أن يكون بين النصوص، ولعل القراءات التي أشرت إليها عند بارت، تدخل أيضًا في هذا السياق: إنه الخروج نحو اللانص.
كيليطو: ربما أن أفضل وصف للكاتب المتميز، ولبارت بالتحديد، أن له أسلوبًا “لا يعوّض”. وفي هذا الصدد قال أندري جيد: «ما قد يفعله غيرك بالجودة نفسها، فلا تفعله». وقّع بارت على عقد مع ناشر لترجمة أحد كتبه إلى الإيطالية، فاقترح الناشر أن يقوم بتحوير نص بارت «بحيث يصير مفهومًا بسهولة حتى من طرف قراء غير مختصين». رفض بارت هذا الاقتراح رفضًا قاطعًا: «لست معممًا، وإنما أنا كاتب، ولا يمكنني قبول أي تصويب خارجي على شكل ومضمون ما أكتب، وهو تمييز، من جانب آخر، لا أعتقده».
الكتابة بين لغتين
بنعبد العالي: ذكّرتني بشذرة سيوران التي أوردتها في كتابك “التخلي عن الأدب”، والتي يقول فيها: «إنه لمن شقاء المؤلف أن يتمّ فهمه». وقد ذهبتَ، في ذلك الكتاب، حتى اعتبار الغموض خاصية الأدب العربي القديم، الذي يصر «ألا يُفهم لأول وهلة، وأن تصادف القارئ صعوبة في إدراك معنى النص. فكأن أدبيته تكمن في غموضه». ما همني، في هذا السياق، هو أنك جعلت مترجم اليوم يحل محل شارح الأمس، فذهبت إلى أن النص لم يعد يشتاق لشارحه، وإنما أصبح يحنّ إلى مترجمه.
لو كنت مكان هذا الناشر الإيطالي، لما تدخلت، ولتركت الترجمة، واللغة الإيطالية تفعلان فعلهما. فهما لابد أن «تدخلا الضيم» على لغة بارت، حتى وإن أوصى بارت بالحفاظ على نصه، وحرص المترجم على أن يراعي وصية صاحب النص الأصلي.
 بودّي أن أعرف ما الذي يفعله المترجم إذا كان هو نفسه صاحب النص. ولعلك تعيش هذه التجربة عندما تنقل أعمالك من الفرنسية إلى العربية، أو العكس. فهل تكتفي الترجمة، هنا كذلك، بشرح ما ظل غامضًا في الأصل؟ هل تلجأ إلى الترجمة لتوضيح الغامض، أم لتوليد الأصل وجعله يرقى ويستمر في البقاء Sur-vivre على حد تعبير دريدا؟
بودّي أن أعرف ما الذي يفعله المترجم إذا كان هو نفسه صاحب النص. ولعلك تعيش هذه التجربة عندما تنقل أعمالك من الفرنسية إلى العربية، أو العكس. فهل تكتفي الترجمة، هنا كذلك، بشرح ما ظل غامضًا في الأصل؟ هل تلجأ إلى الترجمة لتوضيح الغامض، أم لتوليد الأصل وجعله يرقى ويستمر في البقاء Sur-vivre على حد تعبير دريدا؟
كيليطو: الغريب في الأمر في تجربتي الكتابية أنني أعتبر النص المترجَم كأنه النص الأصلي، فيصير الما بعد زمنيًّا هو الما قبل. هذا ما حصل على سبيل المثال مع رواية “والله إن هذه الحكاية لحكايتي” التي أنجزت أولًا بالفرنسية، لكنني أراها مجرد تمرين، مسودة للنص العربي. تبدو لي النسخة العربية هي الأصل، والنسخة الفرنسية مثل ملحق، تذييل، ظل ونظير. ومما يزيد في شعوري هذا أن النسخة العربية صدرت قبل النسخة الفرنسية. وحين يسألني القراء عن لغة النسخة الأولى يتملكني شعور بالدهشة وأفكر هنيهة قبل أن أهتدي إلى الجواب وأصرح أنها بالفرنسية، على الرغم من رفضي غير المنطقي لهذه الحقيقة.
بنعبد العالي: ربما لست وحدك من يعيش هذه التجربة. تحضرني الآن حالة م. كونديرا الذي، بعد أن عمل على تدقيق معظم الترجمات الفرنسية لرواياته التي كانت قد حُررت بالتشيكية، قرر ألا يعتبر الصيغة الفرنسية لأعماله مجرد ترجمة، فكتب في صحيفة لوموند الفرنسية سنة 1993م: «أعتبر النص الفرنسي كما لو كان نصي أنا، وأسمح بنقل رواياتي إما عن اللغة التشيكية أو عن الفرنسية، إلا أنني أميل إلى تفضيل الاختيار الثاني».
كأنكما بالفعل تجعلان الترجمة ترقى بالنص، كما قال دريدا، بل وكما قال الجاحظ قبله في كتاب الحيوان: «وقد نُقلت كتب الهند، وتُرجِمت حكم اليونان، وحُوّلت آداب الفُرس؛ فبعضها ازداد حسنًا». كأن الترجمة تجعل الأصل نسخة، أو كما تقول، تجعله ظلًّا لها. ها هو الأدب يمارس الفلسفة في عقر داره، فيفكك ثنائية الثنائيات الميتافيزيقية، ثنائية نموذج/نسخة، ويعيد النظر في مفهوم الأصل، ويقلب الأفلاطونية، ليرقى بالنسخ إلى مرتبة النماذج والمُثل، ويجعل الأصول وليدة الفروع، والمابعد زمانيًّا هو الماقبل.
غير أنك، على ما يظهر تذهب أبعد من ذلك حينما تقول إن النص الفرنسي لروايتك الأخيرة، هو مجرد مسودة. وأنت تلتقي هنا، لا مع الكاتب التشيكي هذه المرة، وإنما مع الأرجنتيني الذي يقول إن النص لا يعتبر أصليًّا إلا من حيث كونه إحدى المسودات الممكنة التي تعبّد الطريق لنص سيُكتب بلغة أخرى. في هذه الحال، وإن تشبثنا بالحديث عن خيانات الترجمة، فإن الأصول، وكما يرى بورخيس أيضًا، هي التي ستخون ترجماتها.
ولكن، ألا ترى معي أن موقف بورخيس يمكن أن يحمل معنى أقوى؟ فربما كان مسعى المفكر الأرجنتيني أن يبين أن الترجمة إذ ترى في الأصل مسودة، فلأنها تنظر إلى كل نص على أنه دومًا قبل-نص pré-texte. بهذا تغدو الترجمة نوعًا من التنقيب عن مسوّدات الكاتب الثاوية خلف مُبيَّضته. فكأن مسعاها هو أن تعيد إلى النص مخاض ميلاده، فتنفخ فيه الحياة من جديد، وتلبسه حياة أخرى ولغة أخرى وميلادًا آخر.
ولكي نعود إلى ما سبق أن قلتَه، هل لي أن أسألك ما إذا كان ينبغي أن نفهم من ترددك بين لغتين، أنك تعتبر الفرنسية لغة تسويد، والعربية لغة “تحرير” بمعاني الكلمة جميعها؟
كيليطو: لا أستطيع الجواب عن هذا السؤال، ولا أطرحه على نفسي، وإلا يلزمني أن أروي علاقتي مع اللغتين منذ أن ولجت المدرسة في سن السابعة، بل قبل ذلك في المدرسة القرآنية. ثم إنني لم أمارس الترجمة، وما قلته ينطبق على رواية “والله…” فحسب، فنادرًا ما أنقل ما أكتب إلى لغة أخرى. وليس لي أن أقول إنني أشعر بالراحة أكثر في إحداهما، بل أتذمر في كلتيهما. ثم إنني لعلة ما كتبت نصوصي السردية بالفرنسية، وهي قليلة على كل حال، وألحظ أن المفرنسين لا ينتبهون إلا إليها، أما المعرّبون فتظل مهمشة عندهم لأنهم يعدّونني “ناقدًا”. ينبغي أن نُدخل في اعتبارنا القراء. بعضهم من معارفي ينتظرون صدور النسخة الفرنسية لقراءة روايتي، لأنهم ببساطة لم يألفوا قراءة الروايات بالعربية، وبعضهم قرأ النسخة العربية ويتوق إلى الاطلاع عليها في لغة أخرى، ربما لأن ليس فيها اسم مترجِم.
جماليات متقشفة
بنعبد العالي: أتذكّر أنني قرأت عن ص. بيكيت شيئًا شبيهًا بما تقول. إلا أن نقطة الاختلاف بينكما، على ما يبدو، هو أن الكاتب الإيرلندي لم يكن ليختار لغة “الأصل” جزافًا، أو لأسباب بعيدة من الكتابة. فإن كان ينطلق في رواياته من الفرنسية، فـ “لجماليتها المتقشفة”، كما يذهب أحد النقاد، وإن كان في مسرحياته ينطلق من اللغة الإنجليزية، فـ “لبراعة خطابها”، هذا إن سلمنا أنه ينطلق من نص أصل، إذ إنه، وكما بيّن بعض المهتمين بأعماله، لم يكن يتعامل مع النصين واللغتين كمترجم، ولم يكن يشعر في الحالتين كلتيهما أنه أمام أصول مكتملة، فهو كان يعيد الكتابة حتى وهو يترجم، ولم تكن الترجمة الذاتية عنده إلا إعادة كتابة.
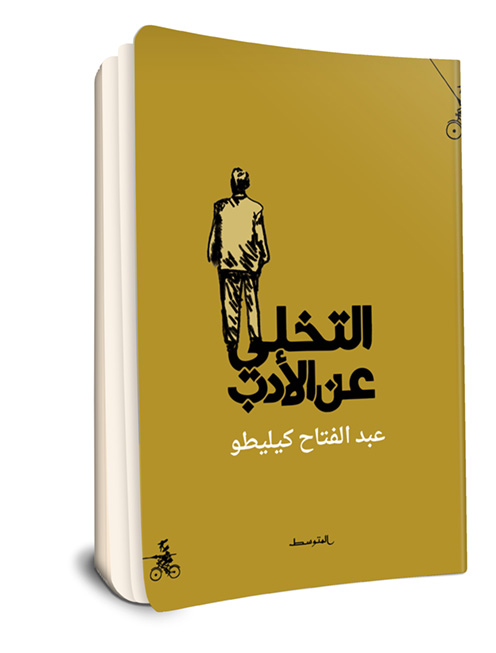 لعل ذلك ما دفع بعض الدارسين إلى القول إن الأصل، عند بيكيت، يوجد بين اللغتين، وهم يستدلون على ذلك بكون الأكاديمية السويدية، عندما قدمت له جائزة نوبل، فإنها أخذت في الحسبان مؤلفاته جميعها، الفرنسية والإنجليزية، فكأنّما اعتبرت النص الأصلي بين اللغتين.
لعل ذلك ما دفع بعض الدارسين إلى القول إن الأصل، عند بيكيت، يوجد بين اللغتين، وهم يستدلون على ذلك بكون الأكاديمية السويدية، عندما قدمت له جائزة نوبل، فإنها أخذت في الحسبان مؤلفاته جميعها، الفرنسية والإنجليزية، فكأنّما اعتبرت النص الأصلي بين اللغتين.
كيليطو: الفرنسية، وعلى الرغم من كونها أساسية في تكويني وقضيت حياتي أدرُسها وأدرِّسها، تظل بالنسبة إليَّ “اللغة الثانية”، أي لغة أجنبية. وإحدى الدلائل على ذلك أنني حين يلزم أن أترجم قطعة ما، أرتاح أكثر حين يكون النقل من الفرنسية إلى العربية. نشرت كتبًا عدة بالفرنسية، لكنني لم أسع إلى نقلها إلى العربية. تولّى المستعرب فرنسيس غوان هذه المهمة ولولاه لبقيت رهينة العربية. هذه المسألة شبه عامة وتنطبق على جل الذين يكتبون بلغة الضاد. أستطيع أن أذكر لك روايات وأشعارًا عربية نقلت إلى لغة أوربية، لكن ما حظ المؤلفات النقدية والفكرية في ذلك؟ تقريبًا لا شيء. وفيما يخصني ليُسمح لي أن أضيف شيئًا، وهو أنني لن أقبل أن أترجَم إلى الفرنسية إلا من طرف فرنسي قح أصيل الولادة واللسان. أما لغات أخرى فلا أعير اهتمامًا لهوية من يتفضلون بنقلها.
بنعبد العالي: لديَّ بعض التحفظ في كون ازدواجية اللغة تترك لصاحبها أن يقرر ما هي لغته الأولى، لأن اللغتين في نظري تتسابقان، إن لم يكن على لسانه، فعلى الأقل في قلمه وكتابته. وقد سبق لك أن قلت ذات مرة إن النص عندك يبدأ بلغة وينتهي بأخرى. بهذا المعنى، فليست التعددية اللغوية هي أن نكون أمام كثرة من اللغات المنفصلة عن بعضها، وإنما هي أن تتشابك هذه اللغات في عمليات ترجمة، وهذا يعني أن مزدوج اللغة لا يكفّ يترجم. إنه مثلك «يتكلم جميع اللغات»، حتى وإن تكلم بالعربية. كان المرحوم عبد الكبير الخطيبي قد كتب: «ليست الازدواجية اللغوية، وتعدّد اللغات، مجرّد علائق خارجية بين لغة وأخرى، وإنما هي عناصر تدخل ضمن النسيج البنيوي لكل فعل كتابة، لكل غزو للمجهول تعبّر عنه الكلمات. في كل كلمة، وفي كل اسم أو لقب ترتسم دومًا كلمات أخرى، كتابتها الضيفة. في كل كلمة كلمات أخرى، في كل لغة لغات أخرى».
لعل هذا هو ما يدعوه دريدا في “أحادية لغة الآخر” بـ “الترجمة المطلقة”، أي الترجمة التي لا تُقيّد ولا تُربط بأصول تنسخها. كأنما يُلقى بازدواجية اللغة دائمًا في هذه “الترجمة المطلقة”، التي هي، كما يقول: «ترجمة من غير قطب يحال إليه، من غير لغة أصلية، من غير لغةٍ منطلق. فليس لديه، إن شئت، سوى لغات وصول».
كأنما ينصحنا الفيلسوف الفرنسي ألا نسأل عن الأصول ولغاتها، ما نكون متأكدين منه هو لغات الوصول، اللغات التي تنتهي إليها الكتابة. إلا أنها، كما يعقّب دريدا: «لغات لا تتمكن من بلوغ منتهاها، ما دامت لا تعرف أي وجهة سيتخذ مسارها».
كليطو: حين تحدثتُ عن اللغة الثانية كنت أعني أنني تعلمتها بعد العربية، فهي مضافة إلى العربية، في رتبة زمنية لاحقة. وحين قلت إنها أجنبية قصدت أنها في فضاء مختلف عن فضاء المدينة العتيقة حيث المدرسة القرآنية. إنها خارج السور لأنني في المدرسة الابتدائية كنت أخرج من فضاء “المدينة” إلى فضاء مختلف، لم أكن قد ولجته على الإطلاق قبل أول يوم في المدرسة العصرية، خرجت من الفضاء الأول وولجت الفضاء الآخر. هذا لا يعني أن كل لغة منغلقة على نفسها، ففي المدرسة الابتدائية كنا نتعلم يوميًّا اللغتين. وكذلك الشأن بالنسبة للكتابة بالفرنسية، تتم حقًّا في الفضاء الثاني، لكن الذهن لا ينفك عن الانشغال بالأول.
التخلي والاغتراب والمحو
بنعبد العالي: أنت تعيش بين لغتين، ولكن أيضًا بين أدبين. فأنت تتنقل بكل سهولة من “الليالي” إلى رواية “جاك القدري” لديدرو، إلى “أوجيني غراندي” لبالزاك، ورواية “السجينة” لمارسيل بروست، ومن بلزاك إلى “الإلياذة”، ومن السندباد إلى روبنسون كروزو، وقد أظهرت في كتابك الأخير “التخلي” قدرة فائقة على الربط بين أسماء متباعدة في المكان والزمان، أمثال ثيربانتيس ودانتي والمعري… وعلى رغم ذلك، فأنت تعترف أنك، بعد أن درّست الأدب الفرنسي حوالي أربعين سنة، فإنك لم تحتفظ بما ألقيته من دروس، بل إنك كنت، ما إن تنتهي حصة التدريس، حتى تمزق أوراق التحضير.
ما يهمني هنا هو دلالة فعل التمزيق هذا، الذي صرنا نلحظه اليوم أمام مدارسنا الإعدادية حينما يغادر التلاميذ صفوف الامتحان، فنلفي باب المدرسة مغطى بأوراق الدفاتر الممزقة، ربما محاولة منهم طيَّ صفحة، وتخطّيَ مرحلة، وتسجيلَ انفصال.
 لا أخفيك أن عملية التمزيق هذه التي تحدثت عنها تذكرني بعمليات إحراق الكتب التي عرفتها كثير من حقب التاريخ، وأنت أكثر الناس دراية بأنها كانت تبوء بالفشل على الدوام.
لا أخفيك أن عملية التمزيق هذه التي تحدثت عنها تذكرني بعمليات إحراق الكتب التي عرفتها كثير من حقب التاريخ، وأنت أكثر الناس دراية بأنها كانت تبوء بالفشل على الدوام.
أنت لا تقول إنك عملت على تفكيك الأدب الفرنسي، وإنما على إتلاف أوراقه. فهل يعني ذلك أن التمزيق هنا كناية عن “التخلي” عن ذلك الأدب، ونسيانه أو “الخروج” منه. تستعمل عبارة “محو الأثر” دلالة على نيتك في الانفصال عن تلك الحقبة من الدراسة والتدريس. ولكن، هل يُمحى الأثر؟ أليست بنية الأثر بالضبط هي البقاء بالمحو، والحضور بالغياب. وهي، كما تعلم بنية كل تراث. ولعل ذلك ما يسمح لك اليوم بأن تجد الكيخوتي في المعري، وروبنسون كروزو في السندباد، وما يجعلك، كما تقول، «تقرأ الأدباء المحدثين بالعربية، وذهنك منصرف إلى الفرنسية».
كيليطو: لست أدري كيف استقبلَ الطلبة ما ألقيت عليهم من دروس، وعلى العموم أحتفظ بذكرى جميلة لذلك الزمان. أما لماذا لم أحتفظ بأوراقي فذلك ربما راجع لكوني لم أر نفسي جديرًا بأن أخوض في الأدب الفرنسي. وهكذا حين ناقشت، في إطار شهادة الدراسات العليا، رسالتي عن روايات فرنسوا مورياك، سنحت فرصة ثمينة لنشرها، لكنني رفضت لأنها بدت لي ضعيفة جدًّا مقارنة بكتب النقد التي كنت أطلع عليها في ذلك الوقت (رولان بارت، شارل مورون…). بعد مدة من التردد قمت بتسجيل “المقامات” موضوعًا للدكتوراه.
ربما كان هاجس الكتابة بالعربية يسكنني منذ البداية. اجتزت كما قلت شهادات في الأدب الفرنسي، غير أنني كنت أنتظر أن أنتهي منها وأوطد قدميَّ في مهنة التدريس لكي أشرع، أخيرًا، في الكتابة بالعربية. لماذا لم أواظب على الكتابة بالفرنسية؟ لأنني دومًا أتوافق مع المهزومين، واللغة العربية كانت مهزومة، أقصد أدبها. لا مجال للمقارنة بين الأدب العربي والأدب الفرنسي في القرن العشرين، كان هذا شعوري آنذاك، اليوم أتجنب قدر المستطاع الأحكام المتسرعة. باختصار، نادرا ما أكتب عن الأدب الفرنسي، وحين أكتب بالفرنسية أتحدث في أغلب الأحيان عن الأدب العربي. أول كتاب نشرته “الأدب والغرابة” والأخير إلى حد اليوم “التخلي عن الأدب”، شاءت الصدف أن يصدرا بالعربية. أما بينهما فأعتقد أن الموازنة بين اللغتين عادلة.
أوافقك على أهمية الأثر، وعلى أن محوه قد يبرزه. لا شك أنك تتذكر ما كتبتُ في هذا الصدد عن المعلقات في “الكتابة والتناسخ” الذي تفضلت بنقله إلى العربية. وفي “التخلي عن الأدب” عقدت فصلًا للأثر في رواية “روبنسون كروزو”، أثر قدم على رمل شاطئ الجزيرة. انزعج روبنسون لأنه خمَّن أنها لمتوحش من أكلة لحم البشر، أما أنا فافترضت وجِلًا أنها لحي بن يقظان.
نظرة إلى العالم
بنعبد العالي: عندما تتحدث في كتابك الأخير عما تصفه بالقطيعة بين الأدب العربي الحديث والأدب العربي القديم، تنعت الأدب العربي القديم بأنه “الآخر”. كأنك في النهاية، تتعامل مع آخرين: الآخر الأوربي والآخر العربي القديم. وإذا استعملنا لغتك في كتابك الأول، يمكننا أن نقول إنك تعيش غربتين. كان تزفيتان تودوروف قد نعت المثقف بأنه «لا ينفك يغترب». ليس لأنه يهجر وطنه، وإنما، وكما يقول، لأنه «يميل إلى نظرة غربة عن العالم». على هذا النحو فهو يميز المناضل عن المثقف. فليس دور المثقف هو أن يقوم بعمل يهدف إلى غاية بعينها، وإنما هو «أن تكون له نظرة غربة عن العالم». المغترب لا يتقاسم العادات الفكرية نفسها. الغربة تبعث الدهشة وتخلق المسافات، فتسمح بإعمال الفكر. ولعلها هي الطريق الملكي للوعي بالذات. وربما بهذا المعنى، وبالضبط لخروجه وانفتاحه على اللغة والفكر الألمانيين، كتب جون بوفري: «نغترب حتى نبلغ ذواتنا».
ها أنت تلحظ أنني، بعد أكثر من أربعين سنة، أعود بك إلى كتابك الأول (والحب الأول)، الذي كنت ذكرت فيه العبارة المأثورة: «طوبى للغرباء»، والذي اعترفت لي مؤخرًا أنك «أحببته» بعد أن عدت إلى قراءته لتصحيحه.
كيليطو: أعيش غربتين؟ ربما، لكن نسبة لأي ألفة؟ هذا هو السؤال الذي من الصعب الإجابة عنه. ماذا كان الحال قبل الغربتين، إذا اتفقنا على صحة فكرة الغربة؟ ربما حقبة السنوات السبع الأولى من حياتي، قبل أن «أخرج من السور». كان العالم صغيرًا، الأسرة، الجيران، زقاقات، مسجد كان يؤمه جدي، ناس طيبون، رعاية شاملة… ثم حدث “الخروج”، اكتشفت المدرسة، فوجئت بمخلوقات غريبة، معلمون ومعلمات ذوو شعور شقراء، يتحدثون لغة عجمية عجيبة ويكونون مجموعة لا علاقة لها بمعلمي العربية.
تعلمتُ الفرنسية وابتليت بقراءة الروايات، فكان ذاك هو الخروج الثاني، الخروج من الفضاء المحلي والانتقال إلى الفضاء العالمي، ذلك أن الرواية تفتح لنا العالم بمختلف قاراته وأراضيه وبحاره، اكتشفت جوانب منه قبل أي درس جغرافي. كل رواية تمنحني هوية جديدة لأنني وأنا أقرأ سارق هويات، تتناسل بعدد أبطالها.
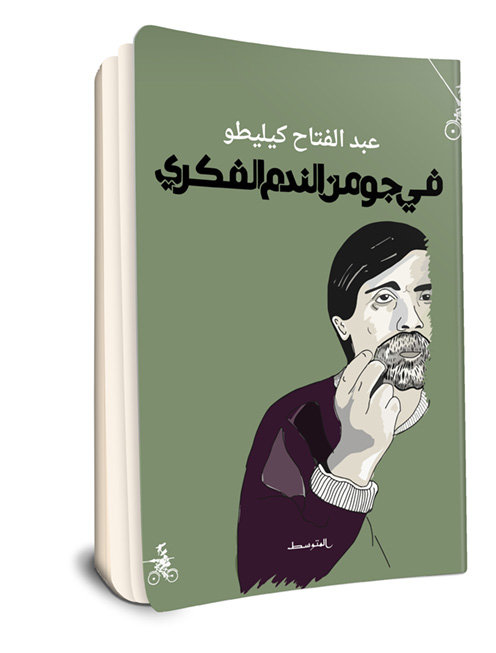 كنت أشعر بغبطة كبيرة، لكن مع من أشاطرها؟ لا أحد في أسرتي يقرأ الأدب، وباستثناء واحد أو اثنين لم يكن رفاقي التلاميذ يقرؤون خارج المدرسة. كنت أتعجب من حالتهم، كيف يغفلون عن هذا “العلم” الذي تتيحه الروايات؟ الغربة الحقيقية في النهاية هي أن تكون الوحيد الذي يقرأ. لا أتذكر أني قلت «طوبى للغرباء» في “الأدب والغرابة”. كنت أستغرب من ميل القراء إلى هذا الكتاب الذي كنت أنظر إليه ظلمًا ببعض الاحتقار إلى أن راجعت مؤخرًا بروفات نشر جديد له، فتبين أن اكتشفت أن في ثناياه نواة الكتب التي ألفتها بعده. أذعنت حينئذ لاختيار القراء. طوبي للأساتذة الذين يثابرون على تدريسه.
كنت أشعر بغبطة كبيرة، لكن مع من أشاطرها؟ لا أحد في أسرتي يقرأ الأدب، وباستثناء واحد أو اثنين لم يكن رفاقي التلاميذ يقرؤون خارج المدرسة. كنت أتعجب من حالتهم، كيف يغفلون عن هذا “العلم” الذي تتيحه الروايات؟ الغربة الحقيقية في النهاية هي أن تكون الوحيد الذي يقرأ. لا أتذكر أني قلت «طوبى للغرباء» في “الأدب والغرابة”. كنت أستغرب من ميل القراء إلى هذا الكتاب الذي كنت أنظر إليه ظلمًا ببعض الاحتقار إلى أن راجعت مؤخرًا بروفات نشر جديد له، فتبين أن اكتشفت أن في ثناياه نواة الكتب التي ألفتها بعده. أذعنت حينئذ لاختيار القراء. طوبي للأساتذة الذين يثابرون على تدريسه.
بنعبد العالي: ذكَّرني قولك بأن الرواية «تفتح لنا العالم بمختلف قاراته وأراضيه وبحاره». وأنك «اكتشفت جوانب منه قبل أي درس جغرافي» بما كان قاله بارت في درسه الافتتاحي بالكوليج دو فرانس من كون الأدب «يأخذ على عاتقه معارف متعددة. ففي قصة كقصة روبنسن كروزو، هناك معرفة تاريخية وجغرافية واجتماعية وتقنية ونباتية وأنثربولوجية، فروبنسن ينتقل من حالة الطبيعة إلى حالة الثقافة».
في المعنى نفسه يؤكد تودوروف بأن الأدب «كان هو العلم الإنساني الوحيد خلال قرون عدة». بل إننا يمكن أن نعتبره إلى اليوم منبعًا لا ينضب عن الإنسان. فـ«العلوم الإنسانية الحالية تظل مدينة للأدب. والحكايات حول أوديبوس أو أنتيغون هي من القوة، بحيث ما تزال تلهم أكثر من علم إنساني». فهل يصح في نظرك أن نجعل ما يقوله هذان المفكران العملاقان يمتد إلى ما يمكن أن ندعوه أدبنا الكلاسيكي؟ هل يمكننا أن نقول إن أدبنا العربي القديم كان هو “علومنا” الإنسانية؟
كليطو: حسب ما نعلم عن الأدب الجاهلي أن الشعر هو جوهره، مع أمثال وسجع كهان ورسائل يلفها الغموض. في العصر الأموي استمر الشعر يهيمن على العقول، ونظرا لاتساع الإمبراطورية تطور فن الرسالة ونما دور كتاب الدواوين، أبرزهم عبد الحميد الكاتب. أما في العصر العباسي فإن الشعر لم يعد له الدور الأساس الذي كان له من قبل، نافسته علوم جديدة، من بينها علم الكلام والفلسفة، وبالتدريج صار لفن الرسالة الدور المركزي الذي كان للشعر. في هذا السياق يمكن الحديث عن بزوغ للعلوم الإنسانية أو لبعضها. وانتهى الأمر بالشعر أن ارتبط بالتسول، وهذا ما تجسده مقامات الهمذاني.
حوار الفكر والخيال
بنعبد العالي: أقترح عليك في خاتمة هذا الحوار، أن نعمل معًا على انتقاد أنفسنا، وأن نعود القهقرى كي نربط خط الوصول بنقطة الانطلاق، فنحاول أن نتبين كيف بلْورنا العلاقة بين الفلسفة والأدب، وكيف مارسناها بالفعل.
لا أخفيك أنك، من خلال ردودك جعلتني ألمس فعلًا ما قد يكون عليه الأدب، أو على الأقل، كيف تمارسه أنت و”تحياه”. لقد كنت في أسئلتك وردودك ألصق مني بـ “الآن وهنا”. بينما كنت أسعى لأن أجرّك إلى “حياة الأفكار”، كنت تحاول أن تردني إلى “الحياة” وكفى، الحياة في تلقائيتها، بل ومفارقاتها. لم يكن يهمك أن تُخضع ما تقوله لمنطق عقلاني صارم، منطق الأفكار، بقدر ما كنت تحرص على إيصال خواطرك وإحساساتك على النحو الذي عشتهما به. لذلك لم تكن تستنجد كثيرًا بما قاله هذا المفكر أو ذاك، لم تكن تريد أن تتسلح بمعرفة. فكأنك كنت تفضل لغة الحلم والحنين والجسد على لغة المنطق والحجاج، كنت تفضل التلقائية على أي غلاف فكري. لنقل إنك كنت تفضل صدق الفكرة المستمد من إحساس ومعاناة وخبرة “بسيطة”، على حقيقة الفكرة المرتكزة على دعامة تاريخية وسلطة معرفية.
وربما قد نهجتُ أنا عكس ذلك، فكانت أسئلتي وردودي يحكمها أساسًا الانسجام المنطقي، والاستناد إلى تاريخ الأفكار، وأقوال من يعتبرون سلطات فكرية، أكثر مما كانت استجابة لمعيش، فأعطت السبق للغلاف الفكري على حساب حيوية التفاعل و”حرارة” الإحساسات.
أنا كنت أقتصر على “منطق الأفكار”، أما أنت فقد كنت تفتح الأبواب لمنطق الخيال. أنت تحدثت عن أمور عشتَها ومارستها والتقيتها في يقظتك وأحلامك، أما أنا، فلم أكن أرى للفكرة قيمة إلا حينما تكون جزءًا من تاريخ، ولم يكن يكفيها ويكفيني أن أراها قطعة من “حياة”. أيكون هذا بالضبط هو الفرق بين ممارسة الفلسفة والاشتغال بالأدب، على الأقل، مفهوم معين عن الفلسفة، وممارسة بعينها للأدب؟
كيليطو: أتفق معك في الموازنة التي عقدتَها بين الفلسفة والأدب. أنا شخصيًّا قرأت ما لا يحصى من الروايات والأشعار والحكايات، هي دومًا سندي وعضدي حين أكتب.







 في هذا الحوار، الذي أنجزه الدكتور بنعبد العالي باقتراح من «الفيصل»، بمناسبة فوز كيليطو بجائزة الملك فيصل العالمية، يتكلم كيليطو وبنعبد العالي جميع اللغات بالعربية ويعيدان النظر في مفهوم الأصل الذي يرقى بالنسخ إلى مرتبة النماذج، ويجعل الأصول وليدة الفروع. عن الترجمة التي تجعل الأصل نسخة، أو مسودة، تنفخ فيها الحياة من جديد. ويطرقان باب الحديث عن الأدب بوصفه منبعًا لا ينضب عن الإنسان، وعن الرواية التي تفتح لنا العالم بمختلف قاراته وأراضيه وبحاره، وعن الشعر وهيمنته على العقل في عصر وارتباطه بالتسول في عصور لاحقة، وعن الاغتراب ودلالة تمزيق الكتب وعلاقة ذلك بالتخلي والخروج ومحو الأثر، عن البقاء بالمحو، والحضور بالغياب.
في هذا الحوار، الذي أنجزه الدكتور بنعبد العالي باقتراح من «الفيصل»، بمناسبة فوز كيليطو بجائزة الملك فيصل العالمية، يتكلم كيليطو وبنعبد العالي جميع اللغات بالعربية ويعيدان النظر في مفهوم الأصل الذي يرقى بالنسخ إلى مرتبة النماذج، ويجعل الأصول وليدة الفروع. عن الترجمة التي تجعل الأصل نسخة، أو مسودة، تنفخ فيها الحياة من جديد. ويطرقان باب الحديث عن الأدب بوصفه منبعًا لا ينضب عن الإنسان، وعن الرواية التي تفتح لنا العالم بمختلف قاراته وأراضيه وبحاره، وعن الشعر وهيمنته على العقل في عصر وارتباطه بالتسول في عصور لاحقة، وعن الاغتراب ودلالة تمزيق الكتب وعلاقة ذلك بالتخلي والخروج ومحو الأثر، عن البقاء بالمحو، والحضور بالغياب. وكما تعلم، يمكننا أن نعطي أمثلة كثيرة على ذلك، بل يمكننا أن نتراجع حتى الرومانسيين الألمان، أي بالضبط الحقبة التي تحدّد فيها الأدب بالمعنى الذي نتداوله الآن. وعلى ذكر هؤلاء الرومانسيين، لنتذكر ما قاله عنهم بلانشو من أنهم “كانوا يشعرون وهم يكتبون، بأنهم الفلاسفة الحقيقيون”. سيتمخض عن موقف هؤلاء أن الفلسفة تتحدد بنتائجها التي تتحقق في الكتابة، وأنها تخضع، مثل أي كتابة، للتدفق الدلالي غير المحكوم، وأن مفهوماتها تستند إلى مجازات متوارية، وأنها لا يمكن أن تُتصوّر خارج المجال النصي المتحقق.
وكما تعلم، يمكننا أن نعطي أمثلة كثيرة على ذلك، بل يمكننا أن نتراجع حتى الرومانسيين الألمان، أي بالضبط الحقبة التي تحدّد فيها الأدب بالمعنى الذي نتداوله الآن. وعلى ذكر هؤلاء الرومانسيين، لنتذكر ما قاله عنهم بلانشو من أنهم “كانوا يشعرون وهم يكتبون، بأنهم الفلاسفة الحقيقيون”. سيتمخض عن موقف هؤلاء أن الفلسفة تتحدد بنتائجها التي تتحقق في الكتابة، وأنها تخضع، مثل أي كتابة، للتدفق الدلالي غير المحكوم، وأن مفهوماتها تستند إلى مجازات متوارية، وأنها لا يمكن أن تُتصوّر خارج المجال النصي المتحقق. بودّي أن أعرف ما الذي يفعله المترجم إذا كان هو نفسه صاحب النص. ولعلك تعيش هذه التجربة عندما تنقل أعمالك من الفرنسية إلى العربية، أو العكس. فهل تكتفي الترجمة، هنا كذلك، بشرح ما ظل غامضًا في الأصل؟ هل تلجأ إلى الترجمة لتوضيح الغامض، أم لتوليد الأصل وجعله يرقى ويستمر في البقاء Sur-vivre على حد تعبير دريدا؟
بودّي أن أعرف ما الذي يفعله المترجم إذا كان هو نفسه صاحب النص. ولعلك تعيش هذه التجربة عندما تنقل أعمالك من الفرنسية إلى العربية، أو العكس. فهل تكتفي الترجمة، هنا كذلك، بشرح ما ظل غامضًا في الأصل؟ هل تلجأ إلى الترجمة لتوضيح الغامض، أم لتوليد الأصل وجعله يرقى ويستمر في البقاء Sur-vivre على حد تعبير دريدا؟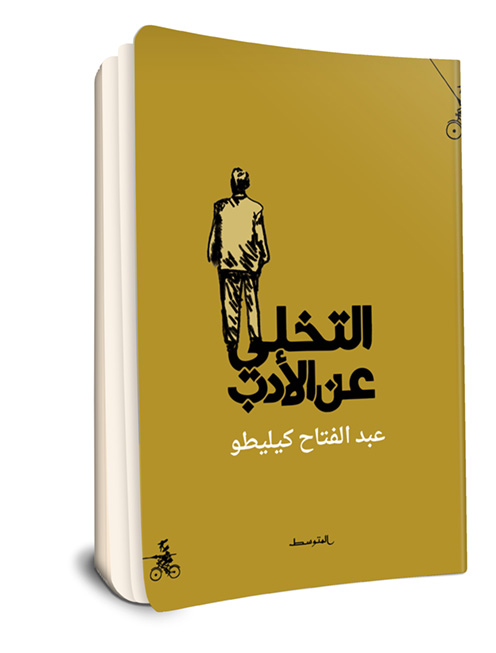 لعل ذلك ما دفع بعض الدارسين إلى القول إن الأصل، عند بيكيت، يوجد بين اللغتين، وهم يستدلون على ذلك بكون الأكاديمية السويدية، عندما قدمت له جائزة نوبل، فإنها أخذت في الحسبان مؤلفاته جميعها، الفرنسية والإنجليزية، فكأنّما اعتبرت النص الأصلي بين اللغتين.
لعل ذلك ما دفع بعض الدارسين إلى القول إن الأصل، عند بيكيت، يوجد بين اللغتين، وهم يستدلون على ذلك بكون الأكاديمية السويدية، عندما قدمت له جائزة نوبل، فإنها أخذت في الحسبان مؤلفاته جميعها، الفرنسية والإنجليزية، فكأنّما اعتبرت النص الأصلي بين اللغتين. لا أخفيك أن عملية التمزيق هذه التي تحدثت عنها تذكرني بعمليات إحراق الكتب التي عرفتها كثير من حقب التاريخ، وأنت أكثر الناس دراية بأنها كانت تبوء بالفشل على الدوام.
لا أخفيك أن عملية التمزيق هذه التي تحدثت عنها تذكرني بعمليات إحراق الكتب التي عرفتها كثير من حقب التاريخ، وأنت أكثر الناس دراية بأنها كانت تبوء بالفشل على الدوام.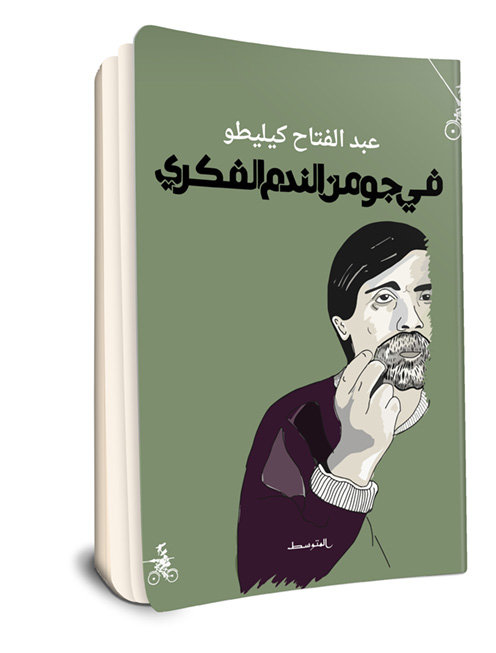 كنت أشعر بغبطة كبيرة، لكن مع من أشاطرها؟ لا أحد في أسرتي يقرأ الأدب، وباستثناء واحد أو اثنين لم يكن رفاقي التلاميذ يقرؤون خارج المدرسة. كنت أتعجب من حالتهم، كيف يغفلون عن هذا “العلم” الذي تتيحه الروايات؟ الغربة الحقيقية في النهاية هي أن تكون الوحيد الذي يقرأ. لا أتذكر أني قلت «طوبى للغرباء» في “الأدب والغرابة”. كنت أستغرب من ميل القراء إلى هذا الكتاب الذي كنت أنظر إليه ظلمًا ببعض الاحتقار إلى أن راجعت مؤخرًا بروفات نشر جديد له، فتبين أن اكتشفت أن في ثناياه نواة الكتب التي ألفتها بعده. أذعنت حينئذ لاختيار القراء. طوبي للأساتذة الذين يثابرون على تدريسه.
كنت أشعر بغبطة كبيرة، لكن مع من أشاطرها؟ لا أحد في أسرتي يقرأ الأدب، وباستثناء واحد أو اثنين لم يكن رفاقي التلاميذ يقرؤون خارج المدرسة. كنت أتعجب من حالتهم، كيف يغفلون عن هذا “العلم” الذي تتيحه الروايات؟ الغربة الحقيقية في النهاية هي أن تكون الوحيد الذي يقرأ. لا أتذكر أني قلت «طوبى للغرباء» في “الأدب والغرابة”. كنت أستغرب من ميل القراء إلى هذا الكتاب الذي كنت أنظر إليه ظلمًا ببعض الاحتقار إلى أن راجعت مؤخرًا بروفات نشر جديد له، فتبين أن اكتشفت أن في ثناياه نواة الكتب التي ألفتها بعده. أذعنت حينئذ لاختيار القراء. طوبي للأساتذة الذين يثابرون على تدريسه.

أين هي مجلة الفيصل الورقية لم تعد تدخل الى المغرب ؟.
حوار عميق يسافر بنا في تضاريس الكتابة بين الحضور، وبين الغياب، ويلقي بنا في يم الترجمة بين الأصل، وبين الصورة . وأهم ما فيه ،هو هذا التلاقح بين افكار كاتبين مغربيين ،أحدهما جاء من الفلسفة الى الادب” ع السلام بن عبد العالي” ،والآخر لانجد صعوبة في تلمس آثار سفره تحت جنح الظلام من الادب الى الفلسفة. حوار يضيء للمهتم بكتابات كيليطو مناطق أخرى من علاقته الأخرى بتجربة القراءة/ الكتابة ، ومغامرة الترجمة.
ممتع هذاالحوار بين نمطين الفكر: الادب و الفلسفة