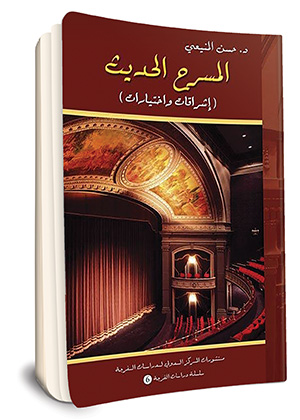 للمسرح قابلية مرنة، على التحوّل ما بين الأجناس الأدبية، وما بين التقنيات كذلك: استيعاب كتابة الشذرات، التي تعكس مستوى التراجيديا في النص، وهنا نقلة تاريخية في مسيرة المسرح. مرورًا بالاستفادة من شعرية الجسد؛ إذ تسهم في جعل التعبيرات والانفعالات مرئية كما النصّ مرئيًّا، وعليه، فقد اختلف الأداء المسرحي، ولم يعد وقفًا على حركة الممثّل ذاته فحسب، بل أصبح الجسد وتعبيراته وأطرافه هي نيابة عن الحركة الشخصية للممثّل. ومن جهة التقنية، فقد تُجُووزَ عن المسرح كخشبة تقليدية لا غير إلى المفهوم المسرحي الشامل؛ وذلك لاعتماده السينوغرافيا والتأثيرات البصرية، وهكذا، فنحن أمام مفهوم شامل للمسرح تنظيرًا وأداءً وتقنية في وحدة تعاون وتوافق ما بين النص والجسد والانفعالات والتقنية.
للمسرح قابلية مرنة، على التحوّل ما بين الأجناس الأدبية، وما بين التقنيات كذلك: استيعاب كتابة الشذرات، التي تعكس مستوى التراجيديا في النص، وهنا نقلة تاريخية في مسيرة المسرح. مرورًا بالاستفادة من شعرية الجسد؛ إذ تسهم في جعل التعبيرات والانفعالات مرئية كما النصّ مرئيًّا، وعليه، فقد اختلف الأداء المسرحي، ولم يعد وقفًا على حركة الممثّل ذاته فحسب، بل أصبح الجسد وتعبيراته وأطرافه هي نيابة عن الحركة الشخصية للممثّل. ومن جهة التقنية، فقد تُجُووزَ عن المسرح كخشبة تقليدية لا غير إلى المفهوم المسرحي الشامل؛ وذلك لاعتماده السينوغرافيا والتأثيرات البصرية، وهكذا، فنحن أمام مفهوم شامل للمسرح تنظيرًا وأداءً وتقنية في وحدة تعاون وتوافق ما بين النص والجسد والانفعالات والتقنية.
تاريخ الكاتب المغربي حسن المنيعي، الذي رحل مؤخرًا، هو تاريخ المسرح، تنظيرًا وكتابة وترجمةً، وهو ما جعله يُراكم ويبني مكانته المرموقة في المسرح المغربي خاصة، والعربي عامة. أصدر المنيعي مؤلفات عدّة منها: «المسرح والارتجال»، و«المسرح والسيميولوجيا»، و«الجسد في المسرح» و«المسرح الحديث». والمنيعي يرى أنّ الحداثة العربية شاخصةٌ في المسرح حصريًّا، بخلاف الآداب والفنون الأخرى، بحسب ما يؤكد في هذا الحوار، الذي أُجرِيَ معه قبل وفاته:
● ألا يعد المسرح نصًّا أدبيًّا؟ إذا كان الجواب بنعم! إذن ينطبق عليه ما قاله رولان بارت في التأليف الأدبي «موت المؤلف»، الذي يقابله في المفهوم المسرحي «موت الدراما»، بحسب هانز تيزليمان؟
■ لا يمكن أن نقدّم في هذا الحوار، تفسيرًا مطوّلًا لمفهوم «موت المؤلف» لدى رولان بارت؛ لأننا سنضطر إلى استحضار معجمه النقدي الذي يرتكز على علوم عدة كاللسانيات، والفلسفة، والسوسيولوجيا والسيميائية. لكن ما يمكن قوله باختصار شديد هو، أن هذا المفهوم يعبّر عن موقفه من النقد التقليدي الجامعي، الذي لا يدرس النتاج الأدبي من الداخل «أي في بنيته»، بقدر ما ينحاز إلى الوقوف على بيوغرافية المؤلف وعلاقة إنتاجه بشيء خارج عن الأدب. بعبارة أخرى، إن قراءة النصّ في نظر بارت يجب أن تتمّ في غياب المؤلف «موته»؛ الشيء الذي يحوّل القارئ إلى فكر واعٍ يعيد بناء معاني هذا النصّ ودلالاته الفكرية واللفظية، كما يعمل على ملء بياضاته لتحقيق راهنيته، بما في ذلك النص الكلاسيكي الذي يجب أن يتحرّر من ثقل تاريخه لينكتب خلال كل قراءة تمارس عليه.
من هنا، فإذا نظرنا إلى المسرح بوصفه نصًّا أدبيًّا، فإن بالإمكان الحديث عن مؤلفه من وجهة نظر «بارت»، وبخاصة إذا ما تمّت مقاربته من منظور نقدي حداثي كما هو جارٍ في بعض الرسائل الجامعية، وبما أن الأدب قد ساعد المسرح على تحقيق حضوره منذ العصر اليوناني إلى الآن، فإن هذا الحضور لم يتحقّق، فعليًّا، إلّا عبر الممارسة الركحية: أي عن طريق العرض المسرحي، الذي يتكفّل بإنجاز محطاته المخرج المسرحي.
وعليه، فإذا كان المسرح الدرامي التقليدي يعطي الأولوية للنصّ على حساب وسائل التعبير الفنية الأخرى، فإن ما عرفه المسرح من تطورات على يد مدارس فنية كالرومانسية (التي ردمت الحدود بين الأجناس المسرحية)، قد أدى إلى إعادة النظر إلى النصّ. كان أول من فعل ذلك الفرنسي «أنتونان آرتو»، الذي نادى بإمكانية التخلّي عنه، وتعويضه بجسد الممثّل من أجل ممارسة مسرح طقوسي شامل يربط علاقة متينة مع أصوله الاحتفالية. وهذا ما سيؤدي، لاحقًا، إلى بروز مسرح ينظر إلى العرض بوصفه فرجة متفجّرة، أو إذا شئنا بوصفه «منظومة»، من العلامات يلعب الإخراج في نطاقها الدور الرئيس.
على ضوء هذا التطور، ظلت مكانة النصّ متأرجحة بين الحضور والغياب. وهذا يعني أنّه لم يُلْغَ أو يَمُتْ مؤلفه. كل ما حصل، هو تحوّل في الفرجة جعلت المسرح الدرامي التقليدي يقف في موازاة مسرح حداثي، مثل مسرح «ما بعد الدراما»، الذي نظّر له الألماني هانز تيزليمان، الذي يدعو إلى مسرح «ملعوب» أي «أدائي»، متحرّر من النصّ الدراما.
أما عن موت «الدراما»، فهذا غير حاصل. صحيح أنها عرفت أزمة في نهاية القرن التاسع عشر إلى حدود منتصف القرن الماضي، كما أشار إلى ذلك بيترزوندي في كتابه نظرية «الدراما الحديثة»، لكنها لم تمت؛ إذ تظل حاضرة في فضاء اللعب بوصفها أداء «برفورمانس». وهذا ما تؤكده الكتابة الدرامية المعاصرة. وفي هذا الصدد، يمكن الحديث عن موت «التراجيديا» بمفهومها الكلاسيكي، الذي شكّل موضوع دراسات علمية مهمة مثل كتاب جورج شتاينر «موت التراجيديا». وقد عوضها مفهوم «المأسوي» الذي أصبح ينعكس في معالجة المسرح لحياة الإنسان اليومية والباطنية، كما نقف على ذلك مثلًا في المسرح التعبيري ومسرح العبث اللذين ساهما في تطور الدراما.

الشذرية وتحرير الجسد
● هل يتوافق المسرح مع النصوص الشذرية؟ وهل يمكن إخراجها؟ وعلامَ تعتمد؟ وبمَ تختلف عن إخراج النصّ المسرحي التقليدي؟
■ بدءًا، يجب الإشارة إلى أن معظم الأشكال المسرحية المعاصرة تقوم على الشذرية والتفكّك لتحرير الجسد من هيمنة الكلمة، التي أصبحت بدورها عنصرًا ركحيًّا لا يؤدي وظيفته إلّا حينما يقتضي العرض وجوده. أما إذا أردنا تحديد مرجعية الشذرة في المسرح، فإنها تعد ابتكارًا مهمًّا، حيث ظهرت نماذجها الأولى مع الكتّاب الألمان أمثال لينز وبوشنر وكلايست، غير أن برتولد برشت هو، الذي أشار إليها تنظيرًا في كتابه «الأورغانون الصغير للمسرح»، كما أنه طبّقها في مسرحه، وهي كتابة تجعل النصّ يتكوّن من مشاهد ولوحات يحمل كل منها عنوانًا خاصًّا، بحيث يغدو المتفرج أمام كتابة درامية تحطّم عنصر الإيهام لديه لإدماجه في الفعل المسرحي، وذلك عبر تناسل أحداث عدة تشكّل في النهاية، بنية كبرى تنعكس فيها أيديولوجيا المحكيّ الرئيس.
أما أسلوب إخراجها، فإنه يرتبط بثقافة المخرج، علمًا أن أسلوب التقطيع يخوّل له توظيف نقلات فنية خارجة عن النص، يتحكّم فيها الاختيار الفني والبعد الفكري. وبما أن برشت كان له تأثير كبير في المسرح العربي والمغربي على الخصوص، فقد ارتكز هذا الأخير (خصوصًا لدى الهواة) على نصوص شذرية تعالج قضايا اجتماعية وسياسية، انطلاقًا من حدث تاريخي قديم يتم إسقاطه على الحاضر، كما يتم إخراجه ومعالجته عبر نصوص فرجوية صغيرة تنضاف إلى النص الأصلي لتحطيم الإيهام.
يستنتج قارئ كتابك «شعرية الدراما المعاصرة»، أنك تتبنى رأي أنتونان آرتو في مسرح «القسوة» القائل: «إن المسرح الذي يُخضع الإخراج وينجز الفرجة للنصّ هو مسرح الأغبياء والمجانين والبقالة واللاشعراء والوضعيين».
إن كتابي لا يتبنى رأي آرتو المشار إليه، وإنما غايته هي الوقوف على أهم شعريات الدراما المعاصرة، التي تمرّد أصحابها على الجمالية المحاكاتية لدى «أرسطو». إن هذه الشعريات تعد مصدر ثراء المسرح الأوربي بعد ما تأثّر صانعوه بما ورد في تنظير آرتو عن «مسرح القسوة»، وتحديدًا في كتابه الشهير «المسرح وقرينه». وكما أشرت إلى ذلك سابقًا، فإن آرتو قد أكد إمكانية تجاوز النصّ لممارسة مسرح طقوسي شامل يقوم على لغات عدة (جسدية/ حركية/ صوتية/ إنشادية،… إلخ). إضافة إلى ذلك، أردت دفع القارئ العربي إلى الاطلاع على هذه الشعريات في مصادرها الأساسية، وطرق تمفصلاتها في الممارسة المسرحية العربية. وهذا ما حاولت القيام به أيضًا في كتب أخرى أذكر منها: («المسرح والارتجال»، و«المسرح والسيميولوجيا»، و«الجسد في المسرح»، «المسرح الحديث»).
تحول جذري في الممارسة
 ● أين تكمن قوة المسرح المغربي، أفي التنظير، أم في التجريب؟ وهل يحقّ لنا الحديث عن مسرح مغربي ذي تجارب متنوّعة ذات تأثير فرنسي إسباني بسبب العلاقة الوثيقة بثقافة البلدين؟
● أين تكمن قوة المسرح المغربي، أفي التنظير، أم في التجريب؟ وهل يحقّ لنا الحديث عن مسرح مغربي ذي تجارب متنوّعة ذات تأثير فرنسي إسباني بسبب العلاقة الوثيقة بثقافة البلدين؟
■ بعد ما اجتاز المسرح المغربي مرحلة التعلّم في عهد الحماية، أي من خلال ما اكتسبه من تجارب متأثّرًا بالمسرح العربي المصري، والمسرح الفرنسي على الخصوص، عمل رواده على تقديم نصوص من الريبرتوار الكلاسيكي الأوربي (موليير، غولدوني، بنجونسون، وشكسبير،… إلخ)، وقد أدى ذلك إلى تنوّع في الإنتاج المسرحي الذي كان يتأرجح بين الكوميديا والتراجيديا، ثم لجأ بعد ذلك إلى مسرح «الفودفيل»، والمسرح الطليعي «مسرح العبث»، ومنذ منتصف الستينيات، حدث تحوّل جذري في الممارسة وذلك من خلال مساهمة الهواة، الذين تشبّعوا بالتقنيات الدرامية الغربية، كما أنهم اعتمدوا التنظير لإضفاء طابع الخصوصية على أعمالهم «الاحتفالية» مثلًا. لكن الملحوظ هو أنّ قوة المسرح المغربي، لا تكمن في التنظير فحسب، الذي أنتج فرجات تبتعد صيغتها من المسرح التقليدي الدرامي، وتهدف في الأساس إلى خلق «تمسرح» جديد يقوم على معادلة الأصالة والمعاصرة. بل كان للتجريب دور فعّال في تطوير الفعل المسرحي تجسدت معالمه، منذ نهاية التسعينيات، في مساهمة خريجي «المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي»، وبعض المحترفين المستقلين.
وهي مساهمة تبلورت في الإخراج المسرحي، والسينوغرافيا، وإدارة الممثّل، والاهتمام بجماليات العرض ولو أدّى ذلك إلى اختراق الأبعاد الأدبية التي يرتكز عليها النصّ، وقد كان من حصيلة هذا التوجه بروز «كتابة دراماتورجية»، جديدة متنوعة الأشكال ذات مرجعيات غربية، ومنها على الخصوص مسرح «المونولوغ» الفرنسي، و«المسرح السردي»، ومسرح «الأداء الأوربي».
● هناك رأي يقول: إنّ مشكلة السينما المغربية هي في السيناريو وإعداد الممثّل! هل نواجه المشكلة ذاتها في المسرح المغربي الذي تشيد به على الرغم من المشكلات الهيكلية، كما تقول.
■ حسب رأيي، ليست لدينا سينما تؤطّرها منظومة اقتصادية. وبدل ذلك، يمكن القول: إنّ ما لدينا هو، أشرطة مغربية تعمل الدولة على دعمها بسخاء، كما يتم إنجازها من طرف مخرجين بعضهم درس في الخارج، وبعضهم الآخر حصل على صفة مخرج في بورصة الفنون العامة. من هنا مصدر المشكلات التي يواجهها الشريط المغربي، وضمنها كما ورد في سؤالك؛ السيناريو وإعداد الممثّل؛ لأن صانعيه يعملون في زاوية مغلقة وفي نطاق تقوقع ذاتي لا يساعدهم على خلق علاقات دائمة مع الأدباء والفنانين. لهذا أتجنب الحديث عن السينما المغربية، وإن كنت أعرف أن ذخيرتها تحتوي على أفلام رائعة، حصل بعضها على جوائز عربية ودولية.
أما عن سؤالك إن كان المسرح يواجه المشكلة نفسها؟ فأنا لا أظن ذلك؛ لأنه، هو، فن إنتاجي جماعي لا يمكن الحديث عن مشكلاته الحقيقية إلّا على مستوى دعمه، وترويج إنتاجيته، من هنا حرصي على الإشادة بالمسرح المغربي (والعربي عمومًا) لأني أعرف تاريخه، وما حقّقه من طفرات بعيدة على مستوى الممارسة والإبداع.
خصوصية الفرجة
 ● ثمّة تجربة واعدة لرواد المسرح في المغرب، وهي، مسرح «الفرجة» مثلًا. ما التجارب الجديدة تأليفًا وإخراجًا؟
● ثمّة تجربة واعدة لرواد المسرح في المغرب، وهي، مسرح «الفرجة» مثلًا. ما التجارب الجديدة تأليفًا وإخراجًا؟
■ إنّ ما يطبع «الفرجة» المغربية هو، تنوع أساليبها، وارتكازها على روافد ثقافية متعدّدة، تتأرجح بين ما هو تراثي أصيل، وما هو كتابة دراماتورجية حديثة. لهذا حرص الرواد الأوائل على تحقيق خصوصية هذه الفرجة كما فعل الطيب الصديقي مثلًا، عندما أسس الفرجة الشعبية المفتوحة، التي انعكست في مسرح «البساط»، بوصفه، كما يقول، مسرحًا مغربيًّا، يهدف إلى إمتاع الجمهور، ويؤكد هويته مثل مسارح أخرى عريقة كـ«مسرح النو» و«الكابوكي»، وغيرهما.
أما الرواد الجدد، الذين أسسوا «حساسية جديدة»، فإن فرجاتهم قد استحضرت أشكالًا درامية تتداخل فيها عدّة فنون لغوية/ صوتية/ بصرية وجسدية. وهذا ما جعلها تحقّق نجاحًا كبيرًا على مستوى التلقي بوصفها تجارب جديدة، تقوم على نصوص مغربية، وإخراج فنيّ حديث. نذكر من بين هذه التجارب المسرحيات الآتية: «المتفرج المحكوم عليه بالإعدام»، و«تمارين في التسامح»، و«دموع لكحول»، و«سكيزوفرينيا»، و«بين بين»، و« شيء عن أبي»، و«خريف»، و«صولو».
● ثَمّة من يعتقد أن التشكيل هو، حداثتنا بامتياز. هل هناك حداثة مسرحية عربيًّا؟
■ من الأكيد أن التشكيل يحتل مكانة مرموقة في المنجز الثقافي العربي، نظرًا لما حقّقه من إنجازات ولغات بصرية تستمد أصولها من التراث العربي، ومن جماليات الفنّ الغربي ومدارسه الكبرى. إلّا أنّه يظل، في الغالب، متأرجحًا بين الهواية والأكاديمية. وإذا أمكن لبعض الرسامين الارتقاء إلى «العالمية»، في المغرب مثلًا: (الشعيبية، محمد القاسمي وفريد بلكاهية)، فإن ما يعرفه من تراكم مرتبط بالاستهلاك المادي، لا يجعل، منه ممثِّلًا للحداثة الفنية العربية، علمًا أنّ صناعته تتم من لدن فنانين لا يمكن حصر عددهم، كما أنها تكشف عن تفاوت كبير في المهارة والأساليب، وكذا عن وضعية رواجه في الوسط الثقافي، وخصوصًا في سوق بيعه التي تخضع للفوضى والتزوير والربح السريع.
لذا أرى أنّ الفنون الأخرى؛ أي الرواية والشعر والمسرح هي التي حقّقت حداثة الإبداع الفني العربي، نظرًا لارتباطها بجدلية التاريخ، والأوضاع العربية السوسيو/ثقافية. لكن المؤسف هو أن الرواية أصبحت متعثّرة اليوم على مستوى الكتابة لتهافت أصحابها على الجوائز. وهذا ما يجعلني أقرّ بحداثة المسرح العربي الذي يعمل باستمرار على تجديد عوالمه، وابتكار خطابات فنية/ شاعرية ترصد موقف الإنسان العربي من الأحداث اليومية، وتوقه إلى الانعتاق والحرية.

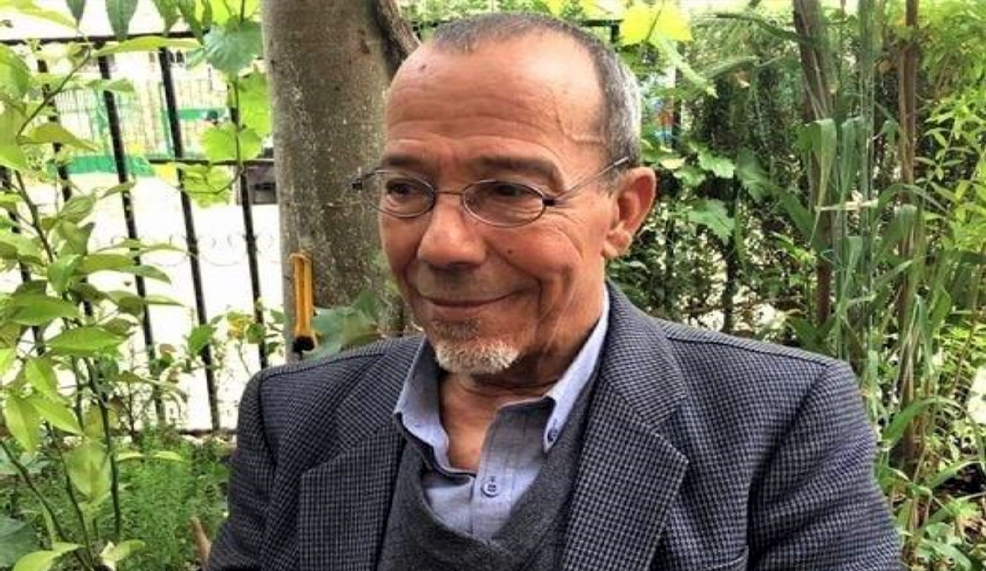





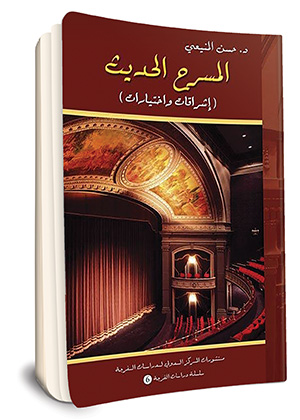 للمسرح
للمسرح
 ●
● ●
●


0 تعليق