أسطورية التجربة الشعرية
في ديوانه الأول «رياح المواقع» الذي أعدّه من أهم دواوينه الشعرية كان قد أهداه لي في عام 1991م وجاء فيه: «أحمد..ما نقوله الآن واقفين.. نرجو أن يبقى مستمرًّا كالنصل في الأفق..». لهذا الإهداء بالنسبة لي أكثر من معنى، فنهوضنا الأدبي وحداثتنا الشعرية والإبداعية التي كان علي الدميني أحد ركائزها ومحركيها كان لا ينبغي لها أن تنتكس متأملًا لها أن تبقى شامخة كالنصل في أفق الوعي، وأفق التغيير الاجتماعي.
المعنى الأكثر دلالة، وبالرغم من الانتكاسات التي شهدها مشهدنا الإبداعي بسبب الرياح الجاهلة للمتشددين والظلاميين في الثمانينيات وبداية التسعينيات، وتجارب (…) عانى شاعرنا علي مرارتها وشظاها على مديات زمنية متفرقة إلّا أننا ما زلنا نراه نصلًا شامخًا شاهقًا في القيمة الإبداعية والوعي التنويري، والبعد الحقوقي الوطني. مع علي وبرفقة أصدقائه ومحبيه من الكوكبة الأدبية الحداثية تجاوزنا هذه المحنة في صراعٍ دؤوب وإنساني من أجل تثبيت كل معاني التجديد والتحديث والحوار والإبداع في ارتباطٍ جوهري بوشائجها الحلمية بتغيير الواقع.
وما زال الأفق مفتوحًا وتعددت النصول في الآفاق وتجذّرت شجرة الحداثة في تربة واقعنا الثقافي واستطالت فروعها وأوراقها الوارفة.. وها هي التغييرات الاجتماعية والبنيوية والثقافية تترى وتتواثب من شرق البلاد إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها في ظل الرؤية المؤسسية الجديدة (٢٠٣٠).
أرجع لديوانه الأول الاستثنائي لأقول: إن هذا الديوان يكتسب أهميته الفريدة في تجربة علي الدميني كلها لكونه جذّر المفهوم الحقيقي لمعنى الحداثة الشعرية في أبعادها الأسطورية والأيديولوجية والحضارية والحلمية، وخصوصياتها المكانية، كامتداد أصيل لبادئتها الرائدة التي تحققت على يد شاعرنا الكبير محمد العلي، بل أرى فيها امتدادًا محليًّا ومغايرًا للحركة ذاتها التي انطلقت في العراق وسوريا ومصر ولبنان، فلم تكن حداثتنا الأدبية في انفصالٍ عما كان يجري عربيًّا وإن جاءت متأخرة بضعة عقود، لكنها اكتسبت خصوصيتها وأسطوريتها ومنابعها المحلية ونكهتها المائزة، واستمراريتها في بيئتها المتشددة الضروس.
وأجدني أميلُ كثيرًا إلى ديوان علي الأول هذا لما يكتنزه من ملحمية ورموز أسطورية وشعبية ونَفَس لغوي حارق عالي الوتيرة ينتمي ويتقاطع مع التجربة الشعرية العربية القديمة برمتها تفعيليًّا وكلاسيكيًّا أمتحها من رؤيته الحداثية الخاصة ومن قدرته العالية (النقدية الشعرية) في امتصاص واستيعاب تجربة الحداثة الشعرية العربية المعاصرة كلها التي تخلّقت وأنجزت في تجارب الرعيل الحداثي الأول: السيَّاب وأدونيس وسعدي يوسف ونازك الملائكة وعبدالوهاب البياتي مرورًا بأحمد عبدالمعطي حجازي وأمل دنقل وصلاح عبدالصبور وصولًا إلى تجربة محمود درويش في أوج فنيتها وخروجها من حصار الهاجس السياسي المباشر مع القضية وهمومها الإنسانية اليومية.
بل إنني أجد كل دواوينه اللاحقة وربما في شيء من المبالغة والحب معًا ليست إلا تنويعات تجريبية على هذا الديوان الماستر، نتلمس فيها الدفق الشعري نفسه والقلق المعرفي وقد اختفت عنها تلك الإنشادية القلقة وملحمية اللغة المؤسطرة، التي كتب بها شاعرنا ديوانه الأول وتميزت بها قصائده الأولى كما نجده في قصيدة «الخبت» الشهيرة.
الإبداعي والأخلاقي
يكتنز علي الدميني في داخله منجمًا من الصدق الإبداعي والوعي الإنساني الرفيع، ومدًى لا يحد من الأفق الرحب الطليق، معجونًا بالموقف الأخلاقي النبيل وعذوبة الروح وطفولتها المتجددة الدائمة.. ويفور بين جوانحه حب غزير للآخرين لا يوازيه حب.
علي لا يفصل القيمة الإبداعية في تجربته عن القيمة الأخلاقية في تجربته الإنسانية؛ لأنها شعور حقيقي وأصيل في قلبه وعقله؛ عقله الطليق المنفتح على فضاءات إبداعية وفكرية متعددة متقاطعة أم مغايرةً لقناعاته، محلية أو كونية كرّست لديه مفاهيم أخلاقية وفلسفية تخطّت دوائره الأيديولوجية والسياسية، ومدرسته الأدبية اليسارية، وانتماءاته المرنة للتيار الواقعي النقدي، فنجده يحتفي بفرحٍ وطني غامر بالتيار البنيوي والشكلاني والمابعد حداثي في النقد الجديد عندما انبثق في واقعنا الأدبي في الثمانينيات، كما مثله في مشهدنا الثقافي كلٌّ من عبدالله الغذامي وسعيد السريحي، وأفاد من معطياته المنهجية والإجرائية في اشتغالاته النقدية، تمامًا كانفتاحه على تجربة قصيدة النثر في تجربتنا الشعرية المحلية والنظر إليها في مدى تحققها لشعريتها وبعدها التجريبي الإنساني بعيدًا متسامحًا مع شكلانيتها وتمردها الحاد على قصيدة التفعيلة التي يكتب بها على مدى تاريخه الشعري حتى اللحظة.
كما أنه يفرح لكل عمل إبداعي جاد ولكل إضافة حقيقية لتجربتنا الشعرية والسردية والفنية مهما اختلف معها أو كانت خارج حدود مدرسته الأدبية والفكرية. هذا الاتساق في الموقف الأخلاقي الإبداعي لا يرقى إليه كُثُر من المشتغلين في الحقل الإبداعي والنقدي في مشهدنا كما يرقى إليه شاعرنا بامتياز. ويحزنه ويحزننا أن نجد غيتوات وجزرًا إبداعية منفصلة، فهناك غيتو لشعراء قصيدة النثر وغيتو لكتاب القصة القصيرة جدًّا وغيتو للأدب التقليدي وكل غيتو ينتصر لكتابه وممارسيه ومحازبيه، ولا ينتصر لقيمة النص الإبداعية في جوهرها المطلق والطليق.
ومن خلال تجربتي العتيدة معه، وجدت من فضائله المدهشة أنه لا يتكلم عن أحد الأصدقاء المقربين أو البعيدين بأي كلمة سوء، حتى لو كان أي منهم ممتلئًا بكل الصفات السلبية أو مختلفًا معه، يكفيه أن يجد فيه خَصْلة واحدة إيجابية فيأخذه عليها بالتقدير، ولا ينظر إلى ما عداها على حد قول أستاذنا العلي، وهو في الآن نفسه ينأى عن الانزلاق إلى المواقف الفجة المجانية في تقويمه للشخص أو إبداعه.. وهذه لعمري من صفات الرسل والأنقياء.
ولأنّ صديقي عليًّا تطبّع فطريًّا ببيئته الطفولية، بطبيعتها الجبلية القاسية فهو ابن الباحة القروي البسيط الذي تربى على معاني الصلابة والخشونة والصبر على الشدائد، وتشبّع بكثير من عاداتها وإكراهاتها الاجتماعية، فوجدته أنا ابن المدينة الليّن العريكة، والأكثر عاطفية، لا يشغف كثيرًا بالتفاصيل الحميمة المدينية الصغيرة التي يعدُّها بعضنا واجبات يومية مقدّسة، بل يوليها قليلًا من العناية عند الظرف المواتي.
فقد تمضي أيام وشهور لا يسأل عنك أو يزورك أو يلبي دعوتك على العشاء، فتعتقد أنه أقام بينك وبينه جدارًا من النسيان لكنه في الحقيقة قريب منك، ويتابع أخبارك من بعيد ويكنّ لك في قلبه حبًّا جمًّا سرعان ما يبوح به بحفاوته بك حين تجالسه أو تحادثه على الهاتف أو تجالسه في جلسة سمر.. أو ترافقه في رحلة ثقافية.. فتغفر له ما هو عليه..!

علي الدميني خلال تكريمه في نادي الشرقية الأدبي
الانتصار للرمز
لم أر عليًّا غاضبًا البتة في حدود أزمنة علاقاتي الخاصة المتغيرة معه إلّا مرة واحدة معي، فقد كنا ذات ليلة في مجلس الأصدقاء المقربين منه في بيته العامر وكان الحديث يدور حول شاعرنا الكبير محمد العلي كظاهرة شعرية وكتابية في مشهدنا الثقافي، وعندما حان دلوي في الحديث أنكرت على شاعرنا العلي قلة إنتاجه الشعري والنقدي، وعزوفه غير المبرر عن نشر نتاجاته الكتابية نثرًا وشعرًا وقلت بطريقة ناقدة إن الأجيال القادمة ستنسى العلي لأنه لم يحافظ على مكانته الأدبية بنشر كتبه، قلت هكذا بتمرديّة عالية أو بشيء قريب من هذا وكان هذا فيما أذكر بداية التسعينيات من القرن الماضي، ويبدو أن حديثي هذا استفزّ صديقي الأثير عليًّا وردَّ عليَّ ردًّا حادًّا مستهجنًا، أذكرمنه: ما تقوله يا أحمد ليس بالكلام المتحضّر اللائق.
فأسقط في يدي..!
فهو يعدّ الأستاذ محمد العلي رمزًا أدبيًّا لا يُمَس. وأنا كنت وما زلت أحب وأقدر رموزنا الأدبية لكني لا أقدسها وأنزهها عن النقد .. والمناوشات. ولي مناوشات وانتقادات حادة لناقدنا القدير عبدالله الغذامي ولم أعبأ برمزيته المحسومة من دون شك في مشهدنا النقدي فكنت أكتب بما أنا مقتنع به من دون حسابات شخصية، ومجاملات، وقد رفض صديقي علي فيما أذكر نشر بعض هذه المقالات في موقعه الشهير «منبر الحوار والإبداع» حينها، حفاظًا على مسافات الودّ العميقة التي كانت وما زالت بينه وبين رموز المشهد الأدبي والنقدي كله.
علي لم يعتذر لي، والمسألة عنده كانت محسومة كدَيْدَنِهِ في كثير من المواقف والتصورات، والقناعات، غير أنني استدركت في قراءتي لكتابه «أمام مرآة العلي» وقلت عنه: «الحقيقة لم نكن نعرف نحن محبيه ومريديه سرّ عزوفه المزمن عن هذا الحضور التوثيقي المرجعي التدويني، و كانت تندلق أمامنا علامات استفهام كبرى، إلّا أن «علي الدميني» أشار في كتابه هذا بشكل مقتضب إلى أسبابٍ متفرقة أو مجتمعة، كالزهد في الأضواء أو القناعة الناقصة لأهمية ما كتب أو السأم الوجودي أو اللامبالاة الثقافية وقد أزيد عليه وأقول: إنها ربما راجعة للحس السقراطي الفلسفي الذي انطوت عليه شخصية محمد العلي».
دكتاتورية الدميني وديمقراطيته
كيف تتجاور الدكتاتورية والديمقراطية في مواقف علي وسجالاته؟.. سواء في حديثك معه أو في إدارته الصارمة للجلسات الحميمية لأصدقائه المقربين التي يطول فيها السهر حتى ساعات الفجر الأولى.. كثيرًا ما يقترح علي بشكلٍ ديمقراطي رفيع محاور الحديث في جلسات السمر الليلية التي كان يدعو لها في تسعينيات القرن الماضي لكنه يتخذ سمت الدكتاتور العادل حين يدير الحديث ويوزعه بالقسطاس، ويلتزم بالموضوع ويبتعد به من أي نوع من مداخلات الدعابة والتفكه من المتحلقين، وحين كان صديقي المرحوم حسن السبع يضيق بالجدية العالية وبوتيرة الأحاديث التنظيرية الصارمة، يلكزني أنا الذي بقربه ويفجر نكتة مباغتة، فينقطع سياق الحوار، وتختلط القهقهات بقهقهات علي الممتعضة.
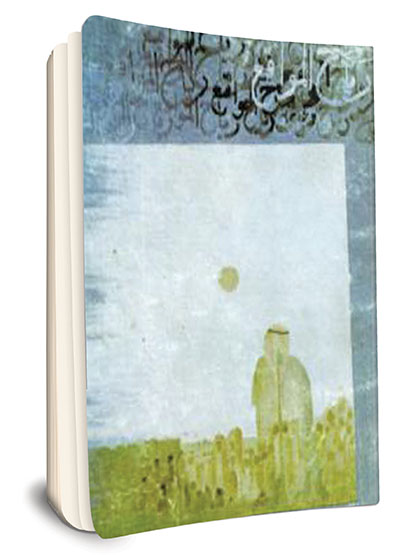 ولأنني عملت معه من قرب في تحرير مجلة «النص الجديد» في التسعينيات حتى بدايات الألفية الجديدة فكنت أجد متعة فكرية عندما يفاجئني بمحاور وملفات المجلة، ويوكل إلي الموضوعات الفكرية والنقدية التي يعرف مدى قدراتي الحقيقية في إنجازها بالطريقة التي يرتضيها وتنال إعجابه.. كانت دكتاتوريته من النوع المنتج وفي جدلٍ مع روحه الديمقراطية، كان يفرض علي الموضوع الذي أجده مفاجئًا وتحدِّيًا قاسيًا لقدراتي وانشغالاتي لكنه يترك لي فضاء البحث واختيار المشاركين والكتاب، ويتابع معي ويلحّ على إنجاز العمل في زمنه المحدد بطريقة «الأمر الإيجابي» كما أسميها، وكنت أكتب وأنجز ما أكلف به من دون مقابل مادي بالطبع وذلك انتصارًا لمشروعه الثقافي والأدبي الذي يسجّل له في تاريخ الحركة الأدبية السعودية المعاصرة بأحرفٍ من نور.. بل كنت من غير أن يعلم علي أكافئ ماليًّا من جيبي الخاص من كنت أستكتبه من خارج الوطن وأدّعي أنها مكافأة من المجلة.
ولأنني عملت معه من قرب في تحرير مجلة «النص الجديد» في التسعينيات حتى بدايات الألفية الجديدة فكنت أجد متعة فكرية عندما يفاجئني بمحاور وملفات المجلة، ويوكل إلي الموضوعات الفكرية والنقدية التي يعرف مدى قدراتي الحقيقية في إنجازها بالطريقة التي يرتضيها وتنال إعجابه.. كانت دكتاتوريته من النوع المنتج وفي جدلٍ مع روحه الديمقراطية، كان يفرض علي الموضوع الذي أجده مفاجئًا وتحدِّيًا قاسيًا لقدراتي وانشغالاتي لكنه يترك لي فضاء البحث واختيار المشاركين والكتاب، ويتابع معي ويلحّ على إنجاز العمل في زمنه المحدد بطريقة «الأمر الإيجابي» كما أسميها، وكنت أكتب وأنجز ما أكلف به من دون مقابل مادي بالطبع وذلك انتصارًا لمشروعه الثقافي والأدبي الذي يسجّل له في تاريخ الحركة الأدبية السعودية المعاصرة بأحرفٍ من نور.. بل كنت من غير أن يعلم علي أكافئ ماليًّا من جيبي الخاص من كنت أستكتبه من خارج الوطن وأدّعي أنها مكافأة من المجلة.
روعة النص
ذات ليلة من الليالي المعتّقة، حيث الكتاب يغفو على صدري والتأمل في هدأة الليل والأفكار المتناقضة تتقاطر وتتسلق أسوار الروح، والكأس المشعّة تلفظ آخر أنفاسها، والقلم المتعب يسقط من يدي، ونعاس المعنى يجرجر رداءه تاركني في صحراء ذاتي، وبينما كنت أتأهب لمغازلة أنثى النوم وأراقصها، أضاء هاتفي بغتة بقصيدة من صديقي علي، في ظني كتبها من وحي ثورات الربيع العربي حادثني شاعرنا بعدها قائلًا: هذه قصيدة جديدة في طور الكتابة، اقرأها يا أحمد وقل لي رأيك.. رددت عليه بعد ساعة وقد استعدت القلم والكأس ويقظة المعنى فكتبت إليه:
هذه قصيدة حب باذخة للمرأة: الحلم. لمصر: الحلم. مصر: ماء النيل. للضوء القادم، للتاريخ، للطمي الراعف يتحدث بلغة الوجود، لعشتار وأوزوريس حيث الخصب والحب والجنس بعث للحياة والجمال والامتزاج العشقي. عشتار الحزينة الملتاعة، تلتقي أوزوريس المنتفضة لتصنعا معًا حلمًا قريبًا من معنى الانبعاث الجديد..
إنه حلمك.. حلمنا يا علي/ المتخلق كفينيق من رماده. هذه القصيدة تأتي كنبوءة لا ترتهن لغواية امرأة العزيز بل ترتهن لمعنى الغواية العاشقة، غواية إيزيس ربة الأمومة والقمر، وما أجمله من قمر وقد أصبح ضوءًا تنتبه أصابعنا إليه وقد أطل على صفحة النيل تمثالًا منتصبًا من جنوب الوادي حتى الواحات في الشمال. هذه أنشودة تليق بحبك يا صديقي لكنانة الأرض وقد فاض لها الغمر.
أبدعت حبًّا وعشقًا للماء وللطمي والتاريخ، للمكان والزمان ممتدين من وادي النيل حتى أعالي الفرات. نحن من يمتلك التاريخ من الماء إلى الماء. نحن من يصنع الزمن وندحض النسيان. نحرس عشتار وإيزيس من غوايات الغريب.
المرأة المــاء
بين الدميني وأبي نواس
علي جعفر العـلّاق – شاعر وناقد عراقي
القصيدة والوعي
للقصيدة الحقة شروطها الخاصة دائمًا، لا تتأتى وفق مزاج عائم في فراغ لا ينبثق من تاريخ الناس، وسجل أرواحهم المكلومة، أو رفاه قلوبهم الممنوعة من الفرح إلا في أوقات بالغة الندرة. والشاعر علي الدميني من شعراء الجمال المحفوف بالمخاطر. جمال قصيدته، حيّ، ولصيق بالآخرين. لا تستهلكه القراءات المتعجلة، ولا يلبي حاجة سطحية لقارئ ملول، بل هو جمال راسخ في تربة الوعي، وموجّهاته التي لا تخطئ.
وجمالٌ كهذا ليس جمال اللحظة العابرة، أو الجمال المصنوع لتمضية الوقت الفائض عن الحاجة؛ لأنه يذهب بقارئه إلى مَدَيَاتٍ أبعد، وأعمق، وأكثر ثراء. وهذه صفة شديدة اللصوق بما يكتبه شاعر ابتُلي بالوعي والجمال معًا، فلا يكتب قصيدة عائمة في فضاء مترامي الأطراف من التجريد المبتوتة صلته بالحياة وأحلام البشر وشظفهم اليومي. إن شاعرًا كهذا ضروري للحياة ولازمة من لوازم مخيلة الناس، وما في الكون من عظمة الجمال المحلوم به للبشر وهم يكدحون للبقاء على قيد آدمية كريمة ومستقبل يليق بها.
وبذلك يمكنني القول وبثقة أستمدها من نصوص الدميني نفسه: إن الجمع بين هاتين الركيزتين لا يتأتى دائمًا لكل شاعر. قد نجد شاعرًا تتميز قصيدته بوعي واضح، لكنه وعي يكون، في الأغلب، وعيًا عاريًا، من دون غطاء جمالي، أخاذ، ومشغول بعناية، يشف عنه نص يفتقر إلى الكثافة، وفتنة التفاصيل.
وفي الجهة المقابلة، يواجهنا جمال، ضيق، محشور في ممر خانق. لا يؤدي إلى بشر ينتظرونه بلهفة المهمومين ولا يوقظ فيهم حلمًا بالخلاص، أو الكرامة، أو تطلعًا إلى رفاه روحي.
يحدث أحيانًا أن نقرأ نصوصًا عربية أو خليجية، تتمتع بترفٍ شعريٍّ كبير، غير أنها تفتقر أحيانًا إلى الإحساس العالي بالحرمان والألم. ولا أعني هنا دلالتهما الشخصية، بل دلالتهما الأشمل والأعم. كما تفتقر تلك النصوص إلى تشبث الشاعر بحلم جمعيّ يهدر بعيدًا في الطبقات الجوفية من الأرض، وفي الصميم من تطلعاتها الموجعة. وقد نتوهم، للوهلة الأولى، أنها نصوص تنحدر من نفس ومخيلة مليئتين بالرضوض، لكننا سرعان ما نكتشف أنها رضوضٌ لغويةٌ لا أكثر.
وأنا هنا، لا أنظر إلى حركة الشاعر داخل لغته فقط، ولا أتصوره منقطعًا عن إحساسه بذلك الألم الجمعي، البعيد، وغير المرئي أحيانًا. لذلك، ومن هذه الزاوية تحديدًا، فإن تجربة الشاعر علي الدميني تحتل مكانة مميزة إلى حدّ كبير.
في تجربة الشاعر علي الدميني تلتقي طاقتان مهمتان: طاقة القصيدة، وطاقة الفعل. وربما أمكنني القول: إن حياته وقصيدته، في تفاعلهما الحي، تقفان نموذجًا يصعب تكراره في قصيدة الشعر الخليجي عامة، وفي الشعر السعودي خاصة. فهو لا يذهب إلى اللغة هربًا من فعل التاريخ. ولا يذهب إلى التاريخ والواقعة هربًا من متطلبات المخيلة. إن قصيدته تصعد من مخيلة مجروحة وحنجرة محشوّة بالشوك والابتهالات.
امرأة المــاء بين أبي نواس والدميني
وتتجلى في قصيدة الدميني، إضافة إلى هذا الوعي، أنها قصيدة تنفتح بغزارة على الموروث الشعري والأسطوري العربي الحافل بالمكابدة وسرديات الفجيعة، في التراث الرافديني، وتراث وادي النيل: جلجامش، وأنكيدو، وأوزوريس، وإيزيس. وتنفتح أيضًا على النص القرآني، حيث قصص العذابات الكبرى: قصة يوسف، وقصة مريم، ومكابدات نوح في الطوفان. وموسى وفضوله المهلك..
وفي حوار خصب مع الموروث الشعري يعمل علي الدميني بكل طاقاته اللغوية واللونية من أجل لوحة شعرية تحتشد بالضوء والماء والأنوثة. ففي قصيدته «تمثال الماء»، على سبيل المثال، يلتفت الشاعر التفاتة بارعة إلى تراث الشاعر أبي نواس الشعري؛ ليستثمر لحظة جسدية مدهشة، لم يسعَ الشاعر العباسي إلى إعلاء شحنتها الإيروتيكية بقصد الإثارة، بل للوصول إلى الثناء على الجمال الأنثوي وتمجيده بوصفه ذروة الجمال الحسي الذي يصلح برهانًا من دون غيبيات على عظمة هذه الفتنة الكونية.
أبو نواس: أسبلت الظلام على الضياء:
تبدأ قصيدة أبي نواس على هذا النحو:
1-نَضَت عَنها القَميصَ لِصَبِّ ماءٍ
فَوَرَّدَ وَجهَها فُرطُ الحَيـــاءِ
2- وَقابَلَتِ النَّســيمَ وَقَــد تَعَـرَّت
بِمُعتَدِلٍ أَرَقَّ مِنَ الهَــــواءِ
3- وَمَدَّت راحَةً كَالمــــاءِ مِنها
إِلى مــــاءٍ مُعَـدٍّ في إِنــــــــاءِ
4- فَلَمّا أَن قَضَت وَطَرًا وَهَمَّت
عَلى عَجَلٍ إِلى أَخــذِ الرِّداءِ
5-رَأَت شَخصَ الرَّقيبِ عَلى التَّداني
فَأَسبَلَتِ الظَّــلامَ عَلى الضِّيـاءِ
6- وغابَ الصُّبحُ مِنها تَحتَ لَيلٍ
وَظَلَّ المــــاءُ يَقطِرُ فَوقَ مــاءِ
7- فَسُبحـانَ الإِلَـهِ وَقَـد بَراهــا
كَأَحسَنِ ما يكونُ مِنَ النِّســاءِ
 في هذه القصيدة القصة، ثمة امرأة تستحم، أو، بعبارة أقرب إلى رُوح اللحظة، تتهيأ للاستحمام. هذا المشهد المائي في بداية اشتعاله، وعُدّته جاهزة للعمل: الماء، الإناء، قميص المرأة، العُرْي، النسيم، وفي البدء تمامًا تأتي سيدة المشهد السردي كله: أعني المرأة وافتتانها بذاتها، كما سيبدو من خلال النص.
في هذه القصيدة القصة، ثمة امرأة تستحم، أو، بعبارة أقرب إلى رُوح اللحظة، تتهيأ للاستحمام. هذا المشهد المائي في بداية اشتعاله، وعُدّته جاهزة للعمل: الماء، الإناء، قميص المرأة، العُرْي، النسيم، وفي البدء تمامًا تأتي سيدة المشهد السردي كله: أعني المرأة وافتتانها بذاتها، كما سيبدو من خلال النص.
شرارة الدلالة يطلقها البيت الأول بكثافة عالية وبتفصيل لافت. المرأة تنضو قميصها عن جسدها لتصب عليه الماء، فيتورد وجهها من شدة الخجل. فعلان يرتبطان ببعضهما ارتباطًا شديدًا، فيُضاء المشهد كله من خلال حركتهما: خلع القميص وحمرة الحياء. يحتشد شطرا هذا البيت بِشِحْنةٍ من التفاصيل، فالمرأة، في الشطر الأول، تنضو «عنها القميص لصبِّ ماء» على جسدها العاري، وفي الشطر الثاني يصعّد أبو نواس من حركة الضوء على وجه المرأة من خلال الفعل المشدد «ورّدَ»، وكلمتي «فرط» و«الحياء». وإذا كان جسد المرأة قد أضاء الشطر الأول من البيت، فإن وجهها يصبح مسقطًا للضوء في الشطر الثاني. وهكذا يبدو الشاعر هنا شديد الحرص على ذكر مكونات هذا المشهد الثمين واحدًا واحدًا، وكأنه لا يريد التفريط بأي منها. وفي البيت الثاني إكمال لما أطلقه البيت الأول من شحنة حسية، إعلاء واضح لعري الجسد وهو يواجه النسيم باستقامته ورقته، بينما لم يبدأ فِعل الاستحمام إلا في البيت الثالث.
الروابط السردية
وإذا كان مفتتح القصيدة محتشدًا بهذا الفيض من الإثارة الجسدية الذي عززه البيت الثاني إلى حد كبير، فإن الأبيات الأخرى تشتبك في علاقات دلالية وسردية متماسكة. ويشكل صبّ الماء مفتتحًا لشرارة السرد لدى أبي نواس، ولدى علي الدميني كما سنرى لاحقًا. المرأة، في البيت الثالث مثلًا، تمدّ راحة مائية إلى الإناء، لتغترف منه.
حين نعود إلى البيت الأول، ولا سيما في شطره الثاني، قد نضع أيدينا على إضاءة ما لهذا الوطر الذي تتحدث عنه القصيدة في البيت الرابع، ففي هذا الشطر تحديدًا يواجهنا انفعال غير مألوف ربما بالنسبة لامرأة تغتسل. المرأة كما يبدو من البيت ليست بصدد استحمام عادي، وإلا لما طفح وجهها بكل هذا الحياء. إنها الآن تعرّي جسدها المائي في حضرة الماء، لا بد أنه عرْيٌ خاص تمامًا بما يتكشف عنه من مفاتن مخصوصة تدعو إلى حرج الأنثى وزهوها الخفي في الآن نفسه:
نَضَت عَنها القَميصَ لِصَبِّ ماءٍ
فَوَرَّدَ وَجهَها فُرطُ الحَيـــاءِ
ويستمر الشاعر في سرد حركة المرأة وهي تقابل النسيم عارية بقوام شديد الرقة والاعتدال، وحين تمد يدها لاغتراف الماء فإنما تمد «راحة كالماء»، أو كأنها تمد إلى الماء ماءً مثله. راحة المرأة المستحمة هنا جزء من جسد مائي. نحن، إذًا، أمام لوحة يعمق أبو نواس ألوانها وخطوطها وانحناءاتها. ولإنجاز هذا التشكيل الأخّاذ، يمزج أبو نواس بين السيولة والصلابة، الضوء والماء، والحركة السردية الموحية. لوحة لامرأة تستحم في مـاءيـن: ماء الجسد وماء الطبيعة، وكأنها في خلوة بذاتها ترتقي بها إلى الذروة من الوله والتشهي، تتماهى مع جسدها بافتتان كامل، وتستغرق في سيولته المائية وفي لطفه الضوئي الغامر.
ويحفز البيتان التاليان حركة النصّ ودلالته بطريقة مثيرة :
فَلَمّـــا أَن قَضَت وَطَرًا وَهَمَّت
عَلى عَجَلٍ إِلى أَخــذِ الرِّداءِ
رَأَت شَخصَ الرَقيبِ عَلى التَداني
فَأَسبَلَتِ الظَــلامَ عَلى الضِيـاءِ
غير أن الأول منهما يثير أكثر من سؤال:
ما هو الوطر الذي قضته المرأة؟ ولماذا كانت على عجلة من أمرها، لأخذ الرداء، بعد قضاء هذا الوطر مباشرة؟ لا بد من القول أولًا إن ظهور الرقيب لم يكن سببًا في انتهاء المرأة من خلوتها تلك لأن ذكره جاء لاحقًا على انتهاء المرأة من فعل الاستحمام.
ولإضاءة بعض هذه الأسئلة لا بد من الالتفات هنا إلى أول البيتين السابقين: هناك فعلان لا يخفى على المتلقي ما فيهما من ظلال حسية: «قضت وطرًا» و«همت»، حيث دلالة الفعل الأول على المعاشرة المكتملة، ودلالة الثاني على الشروع بها. كما أن إسراع المرأة، إلى تناول ردائها، لا يخلو من دلالة تقع في هذا الإطار الحميم ذاته. لقد كانت في حضرة عريها المثير للحياء والثمل. وكما يقول إميل شارتييه: إن الخجل الذي يعقب العري يدفع إلى محبة الثياب.
ويؤكد ذلك ما قلناه عن البيت الأول من القصيدة. كانت المرأة تختلي بجمالها العاري، وتحتضنه بافتتان يبلغ بها حد النشوة والارتواء المشوبين بالارتباك، وهو الأمر الذي دعاها إلى قطع لحظة الانتشاء تلك، مخافة أن تطول إلى حد إثارة فضول الآخرين أو ارتيابهم.
علي الدميني: تمثــــال المــــاء
وإذا كان أبو نواس يقدم، في قصيدته السردية، امرأة تستحم، فإن الشاعر «علي الدميني» يضع لقصيدته، التي لا تقوم على السرد إلا بشكل جزئي، عنوانًا مائيًّا بامتياز: «تمثال الماء»، ويقدم فيها امرأة «يسيل الماء فوق صفاتها». وبذلك فإن الماء، في القصيدتين، يشكل جوهر المرأة لدى أبي نواس وجوهر التمثال لدى الدميني. وهكذا يكثف كلا الشاعرين من مائية هذا الجسد الأنثوي، ومن ضوئيته وسيولته الفاتنة.
من خلال العنوان، يتكشف لنا عناية الشاعر علي الدميني بهذا الجانب المائي والضوئي من جسد المرأة، كما يتجسد جانب التضاد والتلاحم في هذا الجسد أيضًا. تضاد السيولة والصلابة من جهة، واتصال المضاف بالمضاف إليه من جهة أخرى.
تتكون هذه القصيدة من ثلاثة مقاطع؛ يضع الشاعر كلمة الماء مفتتحًا لكل مقطع منها. والملاحظ أن المقطع الأول ينتهي بالتساؤل عن قدرة الكلام على وصف الماء. والكلام هنا هو اللغة بوصفه التجسيد الفردي لها. كما أن الماء، بحكم اتحاده بالمرأة في سياق هذه القصيدة، يمثل الجمال في أروع لحظاته:
هل كان الكلامُ يجيد وصفَ الماءِ،
حين يفرّ عن معناهُ،
عريانًا، نحيلًا، دونما صفةٍ،
ولا لغةٍ، ولا أسماء؟
ويمكننا، إذًا، أن نضع الكلام في مقابل الجمال وتجلياته، ولا شك في أن المرأة والماء، كليهما، يمثلان أكثر تجليات الجمال بهاءً وأوثقها صلةً به. وهكذا يكون الكلام، أي اللغة، في هذه القصيدة، أمام واحدة من تحديات الجمال للغة، وتعصّيه على الوصف.
كان الدميني يكثف من الحضور المباشر للضوء أو الماء، في قصيدته، وكان أيضًا يستقطر بعض صوره المشعة الأخرى، من خلال مجموعة من المفردات النضّاحة بالضوء والبريق واللذة مثل اللؤلؤ، والنجوم، ومنابت الشعر، وابتسام الساق والقدمين، كما في المقطع الآتي:
المـاءُ
لو أن الكلام رآهُ، حين تصبه امرأةٌ
فتنحل النجوم على سواعدها،
ويقطر لؤلؤًا ثملًا، تحدرَ
من منابت شعرها،
حتى ابتسام الساق والقدمين..
يرتدي الماءُ، في كلتا القصيدتين، جسدَ المرأة كما تأخذ المرأةُ، في كلتيهما، شكلَ الماء. تجسد قصيدة أبي نواس ذلك التداخل الموحي بين الماء والمرأة، في صورة مائية سردية تموج بغزارة أخّاذة في اللون
والضوء والعتمة:
وغابَ الصُّبحُ مِنها تَحتَ لَيلٍ
وَظَلَّ المــــاءُ يَقطِرُ فَوقَ مــاءِ
وكما جعل أبو نواس من المرأة، في البيت السابق، عالمًا يمتزج فيه الصبح في الظلمة ويقطر فيه الماء فوق الماء، فإن الدميني يمزج المرأة بالماء والمادي بالمجرد في صورة لافتة على شكل امرأة «يسيل الماء فوق صفاتها» كما أشرنا سابقًا.
وما يلفت الانتباه أن أبا نواس يختتم قصيدته بالوقوف أمام لحظة الجمال هذه بطريقة يقر فيها بقدرة المدبِّر الأعلى على خلق ما يستعصي على من سواه:
فَسُبحـانَ الإِلَـهِ وَقَـد بَراهــا
كَأَحسَنِ ما يكونُ مِنَ النِّســاءِ
ويلامس الشاعر علي الدميني هذه اللحظة ذاتها، بطريقته الخاصة، فهو يسير في اتجاه أرضي يتغنى فيه بانتصار الكلام أو اللغة، وإن حضر القاموس هنا بديلًا عنها، ويكرس قدرتها على استحضار الجمال في هيئة متعينة عبر الإشارة، وعلامة التعجب، والقسم الصريح، والجملة الأخيرة في دلالتها الجميلة الحاسمة:
يا سيد القاموس !
هذا الماء !
والله العظيم،
قد اهتديتُ إلى صفات الماء!
علي الدميني
الشاعر الاستثنائي
منصف الوهايبي – شاعر وناقد تونسي
أفتتحُ هذه المقاربة بالإشارة إلى أنّي أفضّل مصطلح «كتاب شعري» على «ديوان» وهو عمل يختصّ بشعريّة الغرض. وهذا موضوع يحتاج إلى شيء من فضول القول، ليس هنا مجاله حتى لا يحجزني الاستطراد عمّا أنا فيه؛ بيْد أنّي أشير إلى أنّ «الكتاب الشعري» كما هو الشأن عند علي الدميني، هو الذي تنتظم كلّ مكوّناته داخليًّا بحبل سرّيّ معرفيّ يصل بين مختلف صوره على نحو لا تهتدي إليه قراءة تكتفي باعتماد «الحساسيّة». وإنّما ذاك أمر موكول إلى قراءة تعتمد بالإضافة إلى الحساسيّة العقل (الحسابيّ)؛ لأنّ الأمر لا يتعلّق بمجرّد انطباع وإنّما بــ«تقدير» كمّي للصّورة وللمعنى في القصيدة.
على أنّ ما يجدر الانتباه إليه في «الكتاب الشعري» إنّما هو الشكل «اللولبيّ» أو «الحلزونيّ»؛ ذلك أنّ القصيدة تتعهّد موضوعها من كلمة إلى كلمة، بما يعني أنّها تفتح ولا تغلق كما هو الشّأن في الدّائرة. واللولب حتّى وهو يدور كالدائرة، فإنّه يفتح على اللانهائيّ. وفي هذا ما يجعل الشكل اللولبي يعود أدراجه وقد أضاف إليها، وبخاصّة كلّما عالجنا ذلك من زاوية «جماليّة التّلقّي». والديوان الشعري غير هذا، فهو أغراض وسجلّ مفاخر ومآثر.
نصّ متحرّر من «الدغمائيّة»، تنتظمه رؤية مدارها على تمجيد الإنسان، وعلى الجميل والعقل، لكن في سياق سؤال الشاعر الذي يتنازعه «برد» الحيرة. وهذا شاعر ماهر مثقّف ثقافة لا شعريّة فحسب، وإنّما علميّة أيضًا؛ وهو يدرك أنّ تفوّق العلم لم يفضِ بنا نحن البشر إلى «برد اليقين» كما قد يقع في الظنّ، بل جعل الصدفة قانونًا نافذًا أبدًا. على أنّ هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الإنسان، لم تجعل الأشياء عند علي الدميني عبثًا أو خلوًا من المعنى، مثلما لم تجعله مستغرقًا في عالمه الخاصّ المغلق؛ أو ما يمكن أن نسمّيه، على قلق العبارة «نسخ تحفه» أو «أيقوناته» كما هو الشأن عند شعراء غير قليلين قديمًا وحديثًا: يا ملاكَ الصدفْ/ كيف لم نختلفْ/ أنت عرّيتني من صبايَ/ وهيّأتني حارسًا للمسرّات في كلّ هذي الغرفْ…/(مثلما نفتح الباب)
لعلّه «الشيء/ الأشياء» التي تأتينا من دون توقّع أو انتظار، أو هي المرأة المحبوبة التي تعرض ثمّ تصدِف؛ أو تلك التي تناجينا بها الظنون والأحلام، ونفيض عليها من صفاتنا وأخيلتنا. بل إنّ الصدفة في هذا النصّ أو «المصادفة» وهي أمسّ رحمًا بالسياق، تزاوج على نحو غريب لافت بين «الميْل عن الشيء» و«الميْل إليه» في الآن نفسه. ولذا سوّغت المصدر «مصادفة» من «صادف» أي «فاعل» التي تفيد المشاركة في الأغلب أو اشتراك طرفي المفاعلة في الفاعلية والمفعولية معنًى ولفظًا، فيكون البادئ فاعلًا صريحًا والثاني مفعولًا صريحًا، ويجيء العكس ضمنًا بعبارة النحاة؛ وهي بعبارتي صيغة «من/ إلى». بل إنّ عنوان الكتاب نفسه، يمكن من هذا المنظور؛ أن يكون أيضًا «مثلما نغلق الباب»، والأبواب إنّما تفتح وتغلق؛ وإن استثنيت باب الموت الذي يُفتح ولا يُغلق، ويُغلق ولا يُفتح، أو باب أبي الشمقمق في قصيدته «برزت من المنازل والقباب»: فأنت متى أردت دخلت بيتي/ عليّ مسلّمًا من غير باب/ لأنّي لم أجد مصراع باب/ يكون من السحاب إلى التراب.
وفي فتح الأبواب وغلقها متعة وغبطة، وذهاب وخروج، أو خروج ودخول، وجهر وخفاء، وضيق أو غيظ وانفراج؛ والأبواب تفتح وتغلق برفق مثلما تفتح وتغلق بغلظة؛ بل فيها تلصّص واستراق سمع؛ وما إلى ذلك من معانٍ شتّى يغري بها هذا الكتاب الشعري. وللباب عين هي النافذة: إذا ما حان وقت «الباص» أرنو خلف نافذتي/ وأمضي صوب مشيتها/ كمن يتعقّب الأمطار/ (الكتاب نفسه). وهذا وغيره يجعل قصيدة علي الدميني تُكتنه، في ضوء سيميائيّات الصورة، وفي إيقاعها الذي يجري مجرى دوّامات الماء. وقد دأب أكثرنا على القول: إنّ لـ«البعد اللغوي» في القصيدة الصدر دون سائر المكوّنات؛ إذ يُعرّف الشعر باستخدامه الخاصّ للغة؛ وليس بمعنى «الفرق» عن اللغة المتداولة أو «المحكية» فحسب، وإنّما بتطعيمها ونحتها؛ وتخليصها من الإسراف في التنغيم دون أن يمنعها ذلك من أن تكون نصًّا شعريًّا له إيقاعه الخاصّ. أقول هذا على إدراكي أنّ هناك فروقًا بين كتابيِ الشاعر «بأجنحتها تدقّ أجراس النافذة» و«مثلما نفتح الباب»، وكتبه الشعريّة الأخرى مثل: «رياح المواقع» و«بياض الأزمنة»، وبخاصّة قصائده «بروق العامريّة» و«فنار» و«برج الغبار» و«أناشيد على باب السيّدة العظيمة» و«حواريّة النيل ونيويورك».

تعبيرات شبه استعارية
أقول هذا وأنا أقرأ ما يرشح به النصّ، أو ما يخفيه أو يضمره ظاهره؛ بالرغم من أنّه لا فرق بين «ظاهر» و«باطن» في الشعر. من ذلك مثلًا اطّراد المماثلات والمحاكيات التي تحيل على مطابقات ذات طبيعة استعاريّة حيث ماهية الشيء من ماهية شبيهه؛ فبدل أن يقوله الشّاعر يقول ما يشبهه مثل استحضاره بل تمثّله لابن حزم. وهذه المطابقات ليست استعاريّة بالمعنى الدّقيق للكلمة، وإنّما هي تعبيرات شبه استعاريّة؛ إذ هي لا تمثّل بأيّ حال نقل المعنى نقلًا اختياريًّا أو مقصودًا كما هو الشأن في الاستعارة الشعريّة:
ما كان أشبهنا «بعذريّ الهوى» يا شيخنا في الإلف والإيلاف/ في التقوى وفي الإنصاف/ (الكتاب نفسه). ذلك أن الكلمة عند شاعر مثل علي الدميني يبني نصّه بإحكام لافت؛ إنّما تتحد جزئيًّا بكل الكلمات التي تملأ مكانها، ولكن حلّت هي محلّها. وربّما أمكن إدراكها، طالما هي تنضوي إلى كلمات أخرى إمّا معنى أو دلالة. كما هو الشّأن في المترادفات والمتضادّات، وإمّا أصواتًا وأجراسًا كما هو الشّأن في الكلمات المتجانسة؛ أي الرّاجعة إلى علاقة المجاورة أو إلى علاقة المشابهة؛ أو إلى الشاعر وهو يدفع كلمة بأخرى، حتى يظفر بضالّته في الكلمة التي يمكن أن تنهض بالدور المناسب في التّركيب الذي يبنيه.
وأقدّر أنّ تخيّره لـ«عذريّ الهوى» إنّما مردّه إلى الوضع المفارقيّ الذي تتنزّل فيه صورة «الحبّ العذري»؛ فهي لا تنفكّ عن «ديوان العرب»؛ ولكنّها تسير إلى جانبه؛ لا لكونها تنتسب إليه نَسَبَ اللّغة، وإنّما لكونها أمارةً دالّة على إعادة تشكيله داخل لغة أخرى؛ وما عساها تكون هذه اللّغة الأخرى؟ إنّها بكلّ بساطة «الاستعارة العذريّة»: صبيّة شاميّة مغسولة برهافة الأسلاف، أو «قميص ابن حزم» أو العدول عن الطريق: « فضللت الطرقات/ حتّى مسّني ما يشبه النسيان/ أو «وشم المكان» و«رائحة القبر والمقبرة» أو تهجية المكان: أخطو على أوّل السلّم الحجريّ/ لكيما أدرّب نفسي على لغة البيت/ (الكتاب نفسه).
هذه القصائد وغيرها في هذا الكتاب أو في «بأجنحتها تدقّ أجراس النافذة» يمثل الحبّ في سجلّات من القول فهو رغبة وحاجة ومتعة، وما على ذلك من المقولات والمفردات التي من شأنها أن تنتسب إلى دائرة الممارسة الغراميّة أو دائرة عاطفة الحبّ عمومًا. لكنّ ذلك لا يسوق إلى القول: إنّنا إزاء نصّ «عذريّ» حديث أو مراوغ.
إنّما هي ثقافة الشاعر، وهو يومئ بذكاء إلى بعض ما يترسّمه الفلاسفة من منزلة للهوى من منازل النفس؛ سعيًا إلى الظّفر بحقيقة الحبّ إن كان حالة للقلب أو اقتضاء للعقل، أو ما يقال عن أدواء العشق وتبعاته من اعتلال يعتري البدن أو يعلق الرّوح، حتّى عن طريق انزياح بعاطفة الحبّ نحو الإلهيّ في سياحة للمتصوّفة حلولًا أو فيضًا؛ كما في هذا النصّ القويّ الجميل:
ليكن لحبيبي عليّ ثلاثون حجّة/ أوّلًا: أن أصلّي وأبكي عليه/ ثانيًا: أن أغنّي إذا جاع بين يديه/ ثالثًا: أن أعبّ هواء المدينة عنّي وعنه/ لأتلو صباح الحدائق من شفتيه/ (بأجنحتها تدقّ).
وأجمل ما في هذا النصّ أنّه يحرّرنا من ربقة النفعيّة، ويهبنا حريّة التداعي حيث نغمض عيوننا، ويسرح خيالنا. بل تجعلنا كلّ هذه النصوص التي أتمثل بشذرات منها، نتساءل ما إذا كانت الاستعارة تابعة ضرورة لوصف اللّغة الواقعيّ أو هي خاضعة لنظام مراجعها أو وصفها المرجعيّ؟ قد لا يكون ثمّة اختلاف كبير بين مقترب يقابل مقولات استعاريّة بأوضاع العالم وهيئاته ومقاماته وأشيائه، ومقترب يقحم في وصف هذه المقولات علاقات سياقيّة أو نوعيّة أو توافقيّة؛ فالمقتربان يتواردان الاستعارة من عالم «خارج لغويّ» أو من «خارج القول». وكأنّ الحقائق اللّغويّة تتحدّد بواسطة تصوّر بسيط لـ«أشياء العالم»، أو بمجرّد استحضار صورتها في الذّهن، أو أنّ العالم قائم كما هو، بمنأى عن أيّ تدخّل للّغة، أو أنّ الشّيء الذي يخصّ الموصوف هو الذي يحدّ الوصف ويوجّهه إلى صفة دون أخرى، وكأنّ التعبير المجازي لا يتمتّع بقيمة جماليّة منفصلة عن جمال الشّيء أو قبحه. وهذه صور للشاعر وحده أي هي مملوكه الشعري، وليس فيها ما يجعلنا نقرنه بغيره.
وأظهر ما يميّزها ما يسمّى «روح الأشياء» حيث لا نراها مادّة محضًا؛ بل نحن قد نفزع من مادّيّتها؛ وفي هذا يكون الشكل الشعري هو المعنى نفسه أو ما نسمّيه «معنى الشكل»، وتتجلى مهارة الشاعر وهو يجعل «المرئيّ مرئيًّا» (بعبارة الرسام بول كلي) وليس جعل المجهول أو «اللامرئي» مرئيًّا كما دأبنا على القول:
منذ سطوع الأهلّة في قلب آدم/ وهو يجادل أنثاه/ حتى اشتعال الأنوثة في ضلع حوّاء/ حين رأت ما تخبّئه سرّة الشجرة/ (مثلما نفتح الباب)
فهذا النصّ قد يتمثّل عاطفة لا نتردّد في نعتها بـ«الحسيّة»، ولكنّها حسيّة معقودة على الانفعال أو الوجدان، وعلى الإدراك؛ وفيها يتداخل النّفسيّ والجسديّ في منحى يخفّف من المغالاة في روحنة الحبّ؛ وفي التّعفّف عن شهوانيّة الجسد حيث التغنّي بالجسد وتكثيف الاستعارة بشأن بعض أعضائه «ضلع» مناسبة لكشف شوق يغلب على النّفس أكثر ممّا يغلب على ميول الجسد. صحيح أنّ هناك مرجعيّة دينيّة، وليس هذا بالمستغرب، فوشائج القربى بين الديني والشعري لا تخفى في تاريخنا البعيد والقريب. بل ثمّة سحر خبيء متبادل بين الشعراء والأنبياء والفلاسفة، وكأنّ كلًّا منهم يرغب في أن يكون له ما للآخر، أو أن يكون القرين. فالنبوّة تحملنا إلى عالم مفارق، والفلسفة تنشد عالمًا مرتّبًا منظّمًا بصورة أفضل من الماثل للعيان. وهي تدفعنا إلى التفكير فيه؛ إذ ليس بميسورها أن تطلعنا عليه.
أما العالم الذي يطلعنا عليه الشعر فهو يباين، بل يضادّ إلى درجة عالية، العالم الذي مُنحناه أي عالمنا المعيش؛ وهو ليس بالوهم أو السراب، كما قد يقع في الظنّ، بل إنّ الشعر يستطيع في هذه الحال أن يضع الوهم في مرتبة أعلى من حقيقة الشيء، مثل الفلسفة أو النبوّة التي تضع الفكرة أعلى من الشيء ومن الواقع أو فوقه. ولن ندهش أو نستغرب إذا ما التقى الثلاثة مصادفة أو ضرورة في تجربة علي الدميني.
أختم، وإن كان هناك متّسع من القول، فأقول استئناسًا بنصّ الشاعر «ذاكرة» وهو ذاكرة الزمن نفسه (الأحياء/ الموتى/ أنا)، أو سؤالنا كلّما قرأنا نصًّا يُسند فيه الكلام إلى «أنا»من هو المتكلّم؟ أو المتلفّظ؟ الجواب الأرجح أن نقول هي الذات/ الذوات التي تتعلّق عيانًا بسلطة خاصّة قد يتعذّر تعيينها في هذه التجربة الشعريّة الحيّة التي لا تنفصل عن تجربة الحياة. ويعرف صاحبها وهو المتمرّس بإيقاعات العربيّة ولطائفها، كيف يحوّل شكلًا لغويًّا إلى شكل من أشكال الحياة، ويحوّل شكلًا من أشكال الحياة إلى شكل لغوي. شاعر لا تستغرقه الاستيهامات الاستعاريّة التي تفسد الشعر، بل هو يعرف كيف تتخفّف (الشّعريّة) من فائض شعريّتها أو مِمّا زاد منها على الحاجة أو من فضل القول وفضوله.
بخاصّة أنّ مسائلها عند الشّاعر محكومة بنية وإيقاعًا بعقليّة رياضيّة صارمة. أمّا عالم الصورة، وهو ما هو في هذا النصّ إذ هو مدار المعنى، وما إليه من أساليب إدارة الكلام، وتوزيع الألوان والأضواء والظلال؛ فيظلّ لونًا من الحقائق اللّطيفة ومن دخائل الذّات؛ إذ تتعلّق الصّورة وتحديدًا الاستعارة الشعريّة أو التشكيليّة، بمعنى المتكلّم أكثر منها بمعنى الجملة، وقد تفيدنا أكثر عن نبرة الشّاعرالخاصّة أكثر ممّا تفيدنا عن اللّغة أو عن بناها الدّلاليّة، والتلفّظ أو القول إنّما يكون استعاريًّا لأنّ صاحبه أراد كذلك.
خيبة الأمل في العالم
وما دامت الصورة عند علي الدميني، تتّسع لهذه الظواهر سواء تعلّقت بشعريّة الدال أو بشعريّة المدلول، فلا ضير، في تقديرنا أن نصل بعضها ببعض، وأن نتنبّه إلى أنّ منبتها الأصلي هو الشعر نفسه. والشعراء يعانون أكثر من غيرهم، من خيبة الأمل في العالم الذي حولهم: ما الذي حبس الماء في لثغة القلب/ بوحك بالسرّ أم قدر الأمكنه/ (بأجنحتها تدقّ) أو «بهو الأصدقاء»: هؤلاء الذين يربّون قطعانهم في حشائش ذاكرتي/ هؤلاء الذين يقيمون تحت لساني موائدهم كالهواء الأخير (بأجنحتها تدقّ). أو: أدع لي أيّهذا الحجرْ/ بغبار يجفّف أغصانيَ السائلةْ/ وعليّ لتدع المياه الصديقة في متها أن أكون لها شبهًا يابسًا في الكؤوس وفي الساعة المائلةْ/ (الكتاب نفسه).
فلا مكان دون احتفالات جماعيّة، والإيقاع نفسه طقس جماعيّ حميم؛ ومهمّة الشاعر هي أن يقدّم نوعًا من «التعبّد» أو «شعيرة ج. شعائر» من شأنها أن تشبع الفكر؛ أو تغذّي رؤيا أو خيالًا أو حلمًا «ناقصا»، وكمال الأشياء إنّما هو في نقصانها أي في ما تعد به. ذلك أنّ الشعر نفسه كان قد طاله «التبديل» وكأنّه صورة من تبديل الفِراش لدود القزّ. والسؤال هو كيف للشعر أن يكون طقسًا اجتماعيًّا جماعيًّا فيما «شعائره» أو إيقاعاته تتحلّل وتكاد تندثر، لولا مثل هذه النصوص القويّة التي تجعلنا نقول: نعم. لا يزال الشعر بخير.
علي الدميني شاعر «استثنائي» حقًّا حيث الشاعر هو قصيدته نفسها. أعني الذي لا نسب له، لا أب له ولا أمّ حتى من ثقافته؛ وهو الذي يعرفها، لكن دون أن ينسج على مناويلها. والنسج على المنوال «تشعير» وليس شعرًا كما يقول هنري ميشونيك. وعلي ينشد أن يكون وصيًّا على أحد.. أعني هو «الحرّ الذي لا ولاء عليه لأحد» بعبارة قدماء العرب، الشاعر الذي لا يقرن بأحد، ولا يشبه إلا نفسه.
وأقدّر أنّ في هذا جانبًا من جماليّة نصّه ومن قوّة شعريّته. وهي تحتاج لا شكّ إلى وقفة غير هذه.
علي الدميني:
حب وشعر وكرة قدم…
مسفر الغامدي – شاعر وكاتب سعودي
يقول المشهد: إنني جلست في صف متأخر، بينما جلس هو على المنصة، مع رفيقين من جيله الذهبي (محمد الثبيتي وعبدالله الصيخان). هو اللقاء الأول بعلي الدميني، وربما الصدمة الأولى. حدث ذلك في منتصف ثمانينيات القرن المنصرم، في نادي جدة الأدبي، حين وصل الصراع إلى ذروته بين الحداثة وخصومها، وقبل صدور كتاب «الحداثة في ميزان الإسلام» بنحو عام.
يقول المشهد: إنه كان نجمًا حداثيًّا يومها، بينما كنت أحبو في أولى سنوات الجامعة، مع بضع قصائد تتخبط بين العمودي والتفعيلة. كنت أراه ولا يراني، ليس لأنه بارز على المنصة، أو لأنه من الصنف المغرور من الشعراء، ولكن لأنني كنت خائفًا وحائرًا يومها، وربما مختبئًا؛ إذ إننا كنا كاللصوص، نخشى أن يُقبض علينا متلبسين بقصيدة حداثية مشؤومة… قراءةً أو كتابةً أو حتى مجرد سماع.
يقول المشهد: إنه كان منتشيًا على المنصة، يقرأ الشعر وكأنما يغنيه، فيما كنت متوثبًا في مكاني، أتقدم إلى الأمام رافعًا رأسي، شابكًا بين أصابعي العشرة، أَتَحَيَّنُ الفرصة لكي أَنقضَّ على صورة شعرية نادرة، أستلمها بصدري، أُروِّضها بين قدمَيَّ، أتسلَّل بها من الجناح الأيمن، أُحاوِر أكثر من لاعب، أنفرد بحارس المرمى، أضعها من بين قدميه… أصرخ بملء فمي: جووووول.
نعم… كنت قادمًا من عالم كرة القدم، أحب مارادونا أكثر من محمود درويش، وأعرف سقراط البرازيلي، أكثر من معرفتي بسقراط اليوناني. حتى الشعر الذي كنت أكتبه، كان شبيهًا بعالم كرة القدم، فبعد تجربة رومانسية أولى في مراهقتي المبكرة، باءت فيها كل محاولاتي (الشعرية) البائسة بالفشل، ولم أتمكن معها من استعادة محبوبتي الضائعة، أو حتى انتزاع لفتة تعاطف منها، لجأت في مراهقتي المتأخرة، وربما كنوع من الانتقام، إلى الركل بالكلمات… إلى الهجاء. لم أترك صغيرًا أو كبيرًا، صديقًا أو عدوًّا، إلا وركلته بكلماتي. كانت الكلمات بالنسبة لي شبيهة بالكرات الصلبة، ولكي يكون أثرها قويًّا، كنت أحاول أن أصوِّبها أسفل البطن، وبين القدمين بشكل مباشر.
ارتعاشة موسيقية نادرة

عبدالله الصيخان
أما هو فلم يكن يركل الكلمات، بل كان يدللها، يراقصها، يحنو عليها… أذكر أنه افتتح قصائده بما يشبه المقدمة: «هذه القصيدة لم يجفّ حبرها بعد…» ثم كان «إيقاع الزجاج»، أو تلك اللحظة التي مرَّر فيها أنامله برقة على كريستال ثريّا ضخمة؛ ليحدث ارتعاشة موسيقية نادرة، أو ذلك المطلع الذي ترقص فيه اللغة، وتحتضن الكلمات بعضها بعضًا:
«اعوجاجك أم ضلعها؟
فتق النار في الآنية
خوصة البحر أم وجدها
أم تدلّيك من ثديها
زاوج الآس بالأغنية…»
يقول المشهد: إنه كان يقرأ من أوراق بدا لي أنها تتحرك تحت يديه، فيما يحاول جاهدًا أن يثبّتها على الطاولة التي أمامه، مخافة أن تهرب منه، أن تطير فوق رؤوسنا ونظراتنا المشدوهة، خارجة من قاعة فندق العطاس، حيث كان يقيم النادي الأدبي محاضراته، إلى سماء المدينة… من قال: إن الأوراق لا تتوق إلى الحرية أيضًا؟
كان يقرأ كلمات يبدو أنها ما زالت حية بالفعل، كلمات لم يجف حبرها، ولن يجف، طالما التبس المعنى، وتوالدت الصور مع كل لحظة استماع، أو قراءة جديدة. أذكر أنني انتشيت، وربما بكيت من شدة النشوة، ليس لأنني فهمت شيئًا، وما أندر ما كنت أفهمه في تلك الأيام، بل لأنني اكتشفت طريقًا آخر للشعر، طريقًا لا علاقة له بالركل والرفس، أو البكاء على أطلال الحبيبة. طريقًا لا يمتّ بصِلة إلى حجرات الفصول، وشروحات المعلمين، ومعاني المفردات… اكتشفت أن عليّ أن أتقرب من القصيدة، أن أنال ثقتها، أن آخذها من يدها، وأمضي بها بعيدًا من صاحبها (الشاعر)… تيقنت أن عليّ أن أكتب القصيدة (إذا كتبتها في يوم من الأيام) بطريقتي، لا حسب طرق الأسلاف وقواعدهم.
كبر المشهد… عرفت بعد ذلك أن علي الدميني، لم يكن شاعرًا ومناضلًا ومهتمًّا بالشأن العام فحسب، لم يكن ناقدًا فقط، لم يخترق عالم الرواية بجرأة وشجاعة وكفى، بل كان وعيًا متجددًا وقلقًا، لا يعرف الثبات أو الجمود، وربما هذا ما يميزه من أفراد جيله.
العقد الصامت
اقتربت منه، بشكل أكبر، في تسعينيات القرن المنصرم، أو (العَقد الصامت) كما أحب أن أسميه. كان كثير التردد على جدة في تلك السنوات؛ للاطمئنان على رفيق دربه، الراحل الكبير عبدالعزيز مشري، الذي حل في المدينة الساحلية ضيفًا عزيزًا، ليختتم فيها آخر عشر سنوات من حياته القصيرة، والعامرة بالكتابة والحب والأصدقاء والعزف والرسم، والكفاح بشراسة ضد المرض… كانت فرصة نادرة، بالنسبة لي، لكي أتعلم المعنى الحقيقي للثقافة والمثقف: التضحية، الوفاء، الصدق، التسامح، الاحتواء، التواضع، الإصغاء، النبل… علي الدميني هو كل هذا وأكثر، وفوق ذلك هو الشاعر الذي لم يتخلَّ عن حسه الفني والإبداعي، فرغم كل القضايا الكبيرة التي دافع عنها… لم يصرخ، ولم يتوسل الجمهور باستثارته عاطفيًّا، ولم يتكئ على الشعارات، بل ظل مخلصًا للفن والحياة والحب والأصدقاء والوطن، في كل ما كتب من شعر أو نثر:
«ها أنا أعبر الجسر
أملأ بعض البطاقات عن مولدي
وعناوين بيتي، ورقم جوازي…
كان ينقصني كي أطل على فرحي:
أن نكون معًا في عروق المدينة
مثل بريق التعارف في الحافلة،
أو أنين الحكايات خلف الصور…»

محمد الثبيتي
هكذا يطل على فرحه، ورفيقة مشواره الطويل (فوزية العيوني)، في قصيدة مهداة إليها. أو هكذا ينحني ليقبل يد القصيدة:
«أكلّم شيئًا نسيت اسمه
ربما كان غصنًا من الوقت يضحك والعشب
أو شامةً تتراقص تحت القميص…»
علي الدميني لم يترك جسرًا إلا وعبره، ولا شباكًا يصطاد بها القصيدة إلا وجربها، وصولًا إلى قصيدة النثر، التي ربما كانت الشكل الأكثر مناسبة للانتقام من الآباء:
«أيها الآباء
هل استشرتم أحدنا
حين أغويتم أمهاتنا
* * *
لا تقولوا كنا نبحث عنكم
فيقينًا نعرف:
أنكم كنتم مثلنا
تتلهون بعصافير الوقت
وتركضون في المسراتِ
حتى أصبتمونا
حجلًا طافيًا فوق الأنهار…»
وتماهيًا مع عالم كرة القدم، الذي أحبه الدميني كما أحببته، وربما كاستعارة شعرية على الأقل: كم مرةٍ سجَّل علي الدميني هدفًا، وكم هدفٍ استقبلت شباكه! كم مرة انتشى بانتصاره ورفع يديه عاليًا، وكم مرة خسر وأرخى رأسه حزينًا ومتألمًا! كم مرة لعب أساسيًّا، وكم مرة وُضع على الدكة؛ لأنه خالف توجيهات المدرب! كم مرةٍ غضب عليه الحكم، فرفع في وجهه البطاقة الصفراء أو الحمراء…
ثم: كم مرةٍ عبر الجسر، وكم مرةٍ وقف عاجزًا عن العبور!
إشـارات
1- علي جعفر العلاق: الحلم والوعي والقصيدة، دائرة الثقافة، الشارقة، 2018م. ص 267-270.
2- ديوان أبي نواس: شرح وضبط وتقديم: علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، 2016م، ص 28.
3- مع أن المقاربات الحديثة للنص الشعري لا تعوِّل كثيرًا على صلته بأية واقعة حقيقية، يذكر الصديق دواره أن أبا نواس قال هذه القصيدة بعد أن راقب جاريته خلسة وهي تستحم. الحوار المتمدن، العدد 4809 في 17-5-2015م.
4- إميل شارتييه، آلان: منظومة الفنون الجميلة، ترجمة: سلمان حرفوش، دار كنعان، دمشق، 2008م، ص 278.
5- علي الدميني: خرز الوقت، الانتشار العربي، بيروت، 2016م، ص 1-3.








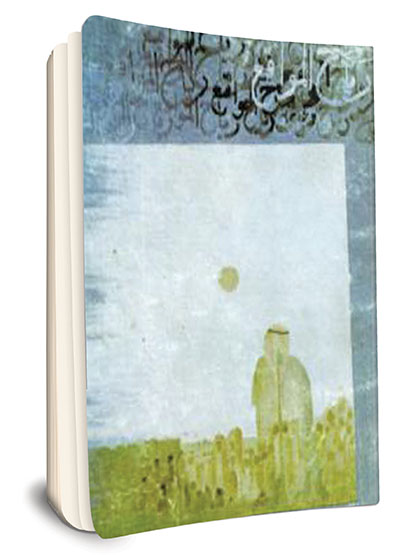 ولأنني عملت معه من قرب في تحرير مجلة «النص الجديد» في التسعينيات حتى بدايات الألفية الجديدة فكنت أجد متعة فكرية عندما يفاجئني بمحاور وملفات المجلة، ويوكل إلي الموضوعات الفكرية والنقدية التي يعرف مدى قدراتي الحقيقية في إنجازها بالطريقة التي يرتضيها وتنال إعجابه.. كانت دكتاتوريته من النوع المنتج وفي جدلٍ مع روحه الديمقراطية، كان يفرض علي الموضوع الذي أجده مفاجئًا وتحدِّيًا قاسيًا لقدراتي وانشغالاتي لكنه يترك لي فضاء البحث واختيار المشاركين والكتاب، ويتابع معي ويلحّ على إنجاز العمل في زمنه المحدد بطريقة «الأمر الإيجابي» كما أسميها، وكنت أكتب وأنجز ما أكلف به من دون مقابل مادي بالطبع وذلك انتصارًا لمشروعه الثقافي والأدبي الذي يسجّل له في تاريخ الحركة الأدبية السعودية المعاصرة بأحرفٍ من نور.. بل كنت من غير أن يعلم علي أكافئ ماليًّا من جيبي الخاص من كنت أستكتبه من خارج الوطن وأدّعي أنها مكافأة من المجلة.
ولأنني عملت معه من قرب في تحرير مجلة «النص الجديد» في التسعينيات حتى بدايات الألفية الجديدة فكنت أجد متعة فكرية عندما يفاجئني بمحاور وملفات المجلة، ويوكل إلي الموضوعات الفكرية والنقدية التي يعرف مدى قدراتي الحقيقية في إنجازها بالطريقة التي يرتضيها وتنال إعجابه.. كانت دكتاتوريته من النوع المنتج وفي جدلٍ مع روحه الديمقراطية، كان يفرض علي الموضوع الذي أجده مفاجئًا وتحدِّيًا قاسيًا لقدراتي وانشغالاتي لكنه يترك لي فضاء البحث واختيار المشاركين والكتاب، ويتابع معي ويلحّ على إنجاز العمل في زمنه المحدد بطريقة «الأمر الإيجابي» كما أسميها، وكنت أكتب وأنجز ما أكلف به من دون مقابل مادي بالطبع وذلك انتصارًا لمشروعه الثقافي والأدبي الذي يسجّل له في تاريخ الحركة الأدبية السعودية المعاصرة بأحرفٍ من نور.. بل كنت من غير أن يعلم علي أكافئ ماليًّا من جيبي الخاص من كنت أستكتبه من خارج الوطن وأدّعي أنها مكافأة من المجلة. في هذه القصيدة القصة، ثمة امرأة تستحم، أو، بعبارة أقرب إلى رُوح اللحظة، تتهيأ للاستحمام. هذا المشهد المائي في بداية اشتعاله، وعُدّته جاهزة للعمل: الماء، الإناء، قميص المرأة، العُرْي، النسيم، وفي البدء تمامًا تأتي سيدة المشهد السردي كله: أعني المرأة وافتتانها بذاتها، كما سيبدو من خلال النص.
في هذه القصيدة القصة، ثمة امرأة تستحم، أو، بعبارة أقرب إلى رُوح اللحظة، تتهيأ للاستحمام. هذا المشهد المائي في بداية اشتعاله، وعُدّته جاهزة للعمل: الماء، الإناء، قميص المرأة، العُرْي، النسيم، وفي البدء تمامًا تأتي سيدة المشهد السردي كله: أعني المرأة وافتتانها بذاتها، كما سيبدو من خلال النص.





0 تعليق