في محبة بيروت كتب ربيع جابر خمس روايات بارزة. وقد يتبادر إلى ذهن القارئ في بادئ الأمر ثلاثيته «بيروت مدينة العالم» (الصادرة بأجزائها الثلاثة في الأعوام: 2003م و2005م و2007م). إنما لا يمكنه إغفال روايته «بيريتوس مدينة تحت الأرض» (2005م)، في أركيولوجيا المكان ودهاليز ذاكرة تضم من رحلوا، أو أن يتجاهل «تقرير ميليس» (2005م) في فزع سكان المدينة من التفجيرات المتلاحقة، وفي الهجرة يأسًا أو البقاء تشبثًا بوجود تاريخي لا يعوضه أي مكان آخر. وإن كان المكان مقومًا رئيسًا في السرد، فالزمان لا يقل عنه حضورًا في مشروع جابر السردي. وهو مشروع يحجز له موضعًا في الرواية اللبنانية التي اتخذت من الحروب المتلاحقة، في إرهاصاتها ومفرزاتها، خطابًا سرديًّا حفر عميقًا في الذاكرة والوجدان اللبنانيين.
بيروت في مرايا الذاكرة
الحروب اللبنانية المتكررة أيقظت في الروائي روح البحث عن البداية فوجدها في تاريخ لبنان السياسي والديني والثقافي؛ عله يعثر على منفذ للخلاص والتغيير. العنف صبغ تاريخ شخصياته، غير أن إيمانه بأن «الذاكرة التي تروى لا تموت»، وبأن «كل تعاسة مهما قست يمكننا أن نتحملها إن نحن رويناها كقصة» على ما يعبر الفيلسوف الفرنسي بول ريكور، دفعه في اتجاه اختيار طريق السرد. فمقاصد رؤيته تتبدى في تسريب القلق الوجودي إلى إدراك قرائه، لإيقاظهم وجعلهم يستشعرون وجودهم والماضي في خطوهم، وفي التحرر من طغيان الفكر الانغلاقي، وبلورة قيم مشتركة تتلاقى الجماعات الروحية عليها، في انفتاحها على الإنسانية. البداية إذن، غالبًا ما تكون في «إنسان المكان» وسط هذا المكان الحافل باصطخابه وتحولاته.

ربيع جابر
لبيروت حضور في جل روايات ربيع جابر، وستركز السطور التالية على بعض منها. في روايته «شاي أسود» (1995م)، تتحرك شخصية حسام المأزومة في شوارع بيروت، مع ذاكرة تهلوس في استعادتها الفقد والألم وأيام الملاجئ، في حركتين واضحتين بين شبكة مكانية بيروتية، وشريط زماني لذاكرة لا تهدأ. وكان للأكاديمية مهى جرجور قراءة فيها مقارنة مع رواية «الطيون» لأحمد علي الزين، في كتابها «الذاكرة والرغبة في الكتابة». وفي «البيت الأخير» (1996م)، وإن اتكأ في متخيله السردي على واقع مرجعي في رسم شخصية المخرج مارون بغدادي، فإن شخصية «ك» محكومة بذاكرة المدينة في مرايا متداخلة الوجوه والصور والشوارع والأبنية، تبحث عن توازن ما وسط عالم كل شيء فيه مؤقت وهش. والشخصيتان (ك وبغدادي) تمعنان في قراءة شخصية إسكندر المحورية في ثلاثية يوسف حبشي الأشقر، ولا سيما في الجزأين: «لا تنبت جذور في السماء»، و«الظل والصدى». ليس هذا فحسب، بل إن ذاكرة الراوي ذاتي السرد مسكونة بالشخصيتين المذكورتين.
بالمثل تطالعنا شخصية رالف رزق الله التي لقيت مصرعها أمام صخرة الروشة في بيروت، وهي شخصية ذات حضور مرجعي لأكاديمي وكاتب لبناني. يبحث الراوي ذاتي الحكاية في أسباب انتحارها ليس بعيدًا من ذاكرة بيروت المدماة بالمعارك، في عمله «رالف رزق الله في المرآة» (1997م). ولا ينسى القارئ بناية المبرومة التي ضمت في طبقاتها سبع عائلات نازحة ومهجرة من المناطق والضواحي بتفاصيل يومياتها في بدايات الحرب الأهلية (1975-1976م)، في رواية «طيور هوليداي إن» (2011م)، ولعله اختزل نصها في روايته اللاحقة المعنونة باسمها «المبرومة» (2014م).
متاهات العنف في «بيريتوس مدينة تحت الأرض»
بيريتوس اسم يحفر في التاريخ، وفي الحضارات الغابرة، فهو الاسم الإغريقي لمدينة بيروت. يصفها الراوي بأنها متاهة مدينة مطمورة تحت الأرض، موقعها كائن تحت بيروت الحالية. أما كيف دخلها الراوي ذاتي الحكاية واكتشفها، فذلك عبر حفرة انزلق فيها مطاردًا ياسمينة بثوبها الأبيض، متماهيًا مع شخصية بارزة من شخصيات لويس كارول، «أليس» التي طاردت أرنبًا أبيض في قصة «أليس في بلاد العجائب».
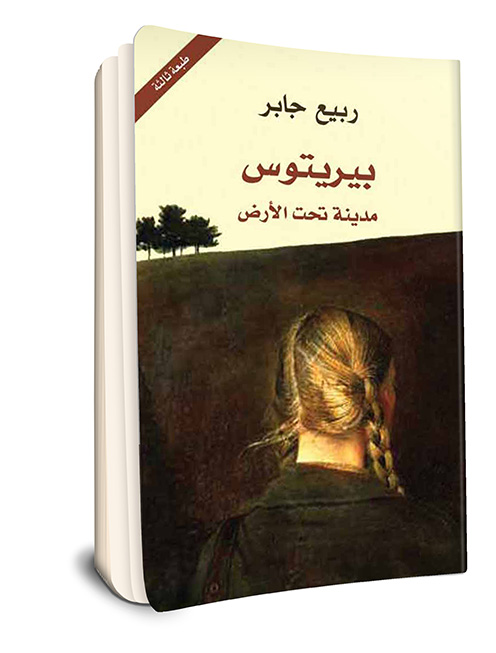 توجد هذه الحفرة في خربة «سيتي بالاس»، الأثر الماثل من زمن الحرب الأهلية اللبنانية، والكائنة على خط التماس الذي يقسم بيروت بين شرقية وغربية. لهذا المعلم رمزيته الدلالية التي تحيل إلى الذاكرة الكابوسية للحرب، ذاكرة طفولة بطرس الراوي المعذبة. يُخبر هذا الأخير عن أهل بيريتوس ومأزوميتهم ومأزقية المكان المهدد بالانهيار والتلوث. وما دهاليز المتاهة الأرضية وطبقاتها إلا طبقات الذاكرة وتلافيف الدماغ؛ حيث يصفها بأنها منخورة، مجازًا، بسوسة المنخوليا وهي «مرض الاكتئاب الشديد»: «إذا دخلت سوسة المنخوليا إنسانًا سكنت قلبه. إذا بلغت المخ صارت تأكل المادة الرمادية، وتقضم التلافيف الطرية التي تشبه الدهاليز، وتتغذى على الذكريات والأحلام والخيبات، وتنمو كالدودة». فناس بيريتوس ليسوا غير أطياف من خُطفوا وفقدوا، كما هي حال إبراهيم ابن خالة بطرس المخطوف، وقد عثر عليه في المتاهة.
توجد هذه الحفرة في خربة «سيتي بالاس»، الأثر الماثل من زمن الحرب الأهلية اللبنانية، والكائنة على خط التماس الذي يقسم بيروت بين شرقية وغربية. لهذا المعلم رمزيته الدلالية التي تحيل إلى الذاكرة الكابوسية للحرب، ذاكرة طفولة بطرس الراوي المعذبة. يُخبر هذا الأخير عن أهل بيريتوس ومأزوميتهم ومأزقية المكان المهدد بالانهيار والتلوث. وما دهاليز المتاهة الأرضية وطبقاتها إلا طبقات الذاكرة وتلافيف الدماغ؛ حيث يصفها بأنها منخورة، مجازًا، بسوسة المنخوليا وهي «مرض الاكتئاب الشديد»: «إذا دخلت سوسة المنخوليا إنسانًا سكنت قلبه. إذا بلغت المخ صارت تأكل المادة الرمادية، وتقضم التلافيف الطرية التي تشبه الدهاليز، وتتغذى على الذكريات والأحلام والخيبات، وتنمو كالدودة». فناس بيريتوس ليسوا غير أطياف من خُطفوا وفقدوا، كما هي حال إبراهيم ابن خالة بطرس المخطوف، وقد عثر عليه في المتاهة.
المتاهة هي شكل التيه لتقاطع طرق، بعضها مسدود بلا مخرج؛ فلا بد للتائه من البحث تاليًا عن مخرج. كان سبيل بطرس، طفلًا، للخروج مما تولده المعارك من ضيق هو الهروب إلى النوم، حيث يقول: «لماذا لا أذكر من الحرب كلها إلا نومي في الملجأ؟». يمني الراوي نفسه لو أن كل ما شاهده في بيريتوس منام لا حقيقة: «هذا كله منام طويل لن ألبث أن أستيقظ منه». ليس ذلك وحسب، بل يتصور أن الخروج من أنفاق الذاكرة الكابوسية قد يتأتى له في الكتابة، حين يحدث جليسه الروائي: «إذا أخبرتك القصة وكتبتها أنت في رواية صارت تبدو لي خيالية غير حقيقية، ولم تعد تفسد عليَّ نومي».
الشخصية الرئيسة الثانية هي شخصية ياسمينة، حبيبة بطرس، وقد استحالت رمزًا عندما شبهها بأوفيليا: «أراها تطفو مثل أوفيليا على وجه المياه. أنا الذي قرأت كل تلك الكتب لم تساعدني الكتب على احتمال الألم». وأوفيليا هي حبيبة هاملت، شخصيتان في مسرحية «هاملت» لشكسبير. أخفقت أوفيليا في إنقاذ هاملت من رغبته الجامحة في الانتقام، عن طريق الحب والغناء، لتسقط نفسها في البحيرة وترحل عن ذلك العالم المضطرب.
كانت ياسمينة أمل بطرس في الكهف البارد والمظلم في بيريتوس، مثلما هو أملها بالخلاص في الخروج من متاهة المدينة، حيث الزمن يتحجر. يرمز إليه بالساعة المتوقفة، والقنديل الذي لا يُضاء، المعلقان على الحائط الأبيض لبيت إسحاق، حيث قبع بطرس بعد سقوطه في الحفرة. الحائط نفسه استحال شاشة بيضاء تتلاحق عليها الصور، فيغدو سكان الكهف ظلال أشخاص في عالم من حركات خفِرة وأصوات هامسة ووميض أنوار خافتة، يدل ذلك كله على حياة تنضب وأرواح تتلاشى، بالتوازي مع اندثار مجد سينما سيتي بالاس. إشارة أخرى إلى سير الزمان وئيدًا، المكتبة الفقيرة بالكتب (عشرون كتابًا)، وقول إحدى الشخصيات: «الذي يتعلم هنا يصير شقيًّا… ما فائدة العلم؟». انحلال الحياة يرمز إليه أيضًا نضوب النهر الذي يغذي المدينة الجَوَّانِيّة، وشح الغذاء وفقدان كثير من المواد الغذائية، وهي إشارات استعارية تقرأ قراءة ثانية في خطاب بيئي ينجدل مع الخطاب السياسي-التاريخي.
أبواب الأمل موصدة، والحلم بالسماء مبتور، يقمعه الخوف من أمرين؛ أولهما: انطفاء الأعين إذا ما احترقت في الشمس، وثانيهما: عبور الأسوار لوجود «ناس الوحل» الذين لم يرهم أحد. ولفكرة ناس الوحل وإيهام الناس بوجودهم دلالة التسلط الاجتماعي الموروث، واستغباء السكان لاستبقائهم داخل الأسوار ومنعهم من ترك الجماعة والتفكير في الخروج. فرواية «بيريتوس» تزخر بالدلالات الرمزية، وتُحمل بمآزق زمكانية تستنطق الماضي. في عوالمها الغريبة يهرب الراوي مع شخصياته من ثقل الواقع ماضيًا وراهنًا، محذرًا من مستقبل بائس ومصير مشؤوم. فهي أمثولة الفكاهة المرة بالعودة إلى تاريخ تشكلها من سكان هاربين من حروب وقعت باسم الدين والعصبية الطائفية، فاختاروا العيش بغير دين، ومن دون علوم تفسد أفكارهم.
البينيات القاتلة في «تقرير ميليس»
عسى القارئ يستعيد أحداث هذه الرواية بُعيد تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020م؛ لأن محرك أحداثها تفجير «سان جورج» 2005م استهدافًا لموكب رئيس الحكومة رفيق الحريري؛ وقد وصفه الراوي أنه دائم المشي في شوارع مدينته، يتشرب بصره الأبنية، ويقول: «لا أحد أكبر من بلده». ولعله (القارئ) يستحضر عبارات جابر السردية الشهيرة: «ما هذه الحقيقة التي لا تُعرف أبدًا؟ لن يتحسن نومنا قبل أن يتكلم ميليس». وبات تقرير القاضي الألماني ديتليف ميليس (رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني ورفاقه) علامة على انتظار اللبنانيين لإشهار الحقيقة وإحقاق العدالة. والقاضي «أمام طريقين: يكشف الحقيقة أو لا يكشف الحقيقة.. المشكلة ليست فيما سيقوله التقرير، المشكلة ماذا سيحدث لنا بعد ذلك». تتعمق حالة الشخصيات البينية أكثر فأكثر بين رغبتها في كشف الحقيقة وعدم كشفها؛ «فقول الحقيقة يجر حروبًا عالمية». كل شيء مبهم وملتبس، يطرح أكثر من علامة استفهام تؤشر إلى مآزق متلاحقة: «فهل سيقول ميليس كل الحقيقة أم يختار منها ما يقتضيه التوازن الدولي؟».
المهندس سمعان يارد في الرواية، شاب ميسور عليل القلب، استحال رمز العبثية والعيش في اليوميات، حين ترك مشاريعه الأصيلة مترقبًا صدور التقرير. يشبه حاله حال سكان مدينته المسمرين على شاشات الفضائيات وأمام الجرائد. يصفه صوت أخته جوزفين في مناجاتها: «ما هذه الحياة الفارغة التي تعيشها؟ أنت معلق وحائر ومقسوم على نفسك». أو كما يخبر هو عن نفسه: «كأن إرادتي ليست لي. تحركت بليدًا كبزاقة أو سلحفاة. جسمي لم يعد لي». بات على مفترق طريقين؛ بين أن يبقى في مدينته على الرغم من القلق، أو أن يهاجر، ويلتحق بأختَيه في أميركا، كما فعل جل من يعرفهم.
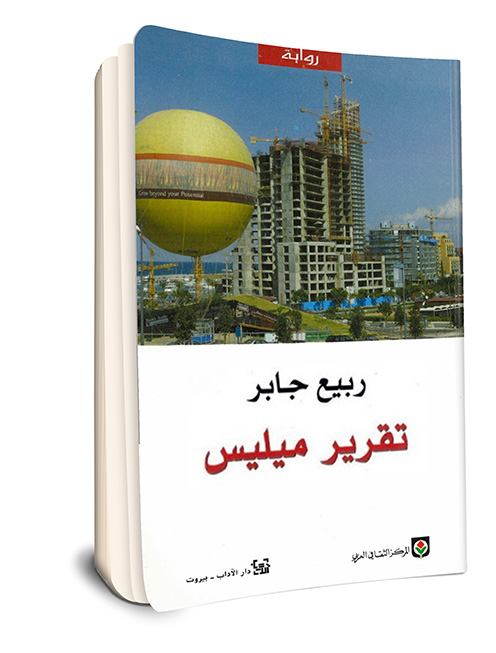 ومن دلالات البينية انشطار الفضاء الروائي إلى عالمين: عالم الأحياء، وعالم الموتى. لتشتبك مآسي الماضي بآفاق الحاضر المرعبة. هذا الربط بين الحياة والموت أدت دلالته شخصية جوزفين القتيلة في زمن الحرب الأهلية، تناجي أخاها من عالمها الآخر محاولةً مهاتفته. فالهاتف بين عالمَي الأموات والأحياء يرنّ كثيرًا في منزل سمعان. آلة الاتصال هذه لها رمزية الخشية من الاستجابة للفتنة التي تعيد ذكرى مأساة الحروب السابقة؛ كأن الموتى يراقبون ويشهدون. أضحى الموت قريبًا جدًّا قربَ رفع السماعة للرد على المتصل. كيف إذا ما كان هذا المتصل ينتمي إلى عالم الموتى؟! ذلك، فضلًا عن وجود التلفزيون أحادي الوجهة في عالم الموتى، إذ بوساطته تتابع جوزفين أحداث عالم الأحياء. وهي بدورها عالقة بين عالمَي الأموات والأحياء؛ لأن الجرذ آكل الأرواح لم يرتشف ما تبقى من دم في عروقها. تتعذب لأن الحياة الباقية في جسمها كثيرة، وتطاردها صور الحياة: «لم أنسَ ذلك الجانب بعد». رمزية «العلوق» تتجسد في مكان مقتلها، خط التماس تحت الجسر الذي شبهته بنهر الجحيم في الأوديسة، فتقول: «قطعت النهر ولم أقطعه. لكل نهره. نهري خط التماس بين الشرقية والغربية، ومستنقع وحل».
ومن دلالات البينية انشطار الفضاء الروائي إلى عالمين: عالم الأحياء، وعالم الموتى. لتشتبك مآسي الماضي بآفاق الحاضر المرعبة. هذا الربط بين الحياة والموت أدت دلالته شخصية جوزفين القتيلة في زمن الحرب الأهلية، تناجي أخاها من عالمها الآخر محاولةً مهاتفته. فالهاتف بين عالمَي الأموات والأحياء يرنّ كثيرًا في منزل سمعان. آلة الاتصال هذه لها رمزية الخشية من الاستجابة للفتنة التي تعيد ذكرى مأساة الحروب السابقة؛ كأن الموتى يراقبون ويشهدون. أضحى الموت قريبًا جدًّا قربَ رفع السماعة للرد على المتصل. كيف إذا ما كان هذا المتصل ينتمي إلى عالم الموتى؟! ذلك، فضلًا عن وجود التلفزيون أحادي الوجهة في عالم الموتى، إذ بوساطته تتابع جوزفين أحداث عالم الأحياء. وهي بدورها عالقة بين عالمَي الأموات والأحياء؛ لأن الجرذ آكل الأرواح لم يرتشف ما تبقى من دم في عروقها. تتعذب لأن الحياة الباقية في جسمها كثيرة، وتطاردها صور الحياة: «لم أنسَ ذلك الجانب بعد». رمزية «العلوق» تتجسد في مكان مقتلها، خط التماس تحت الجسر الذي شبهته بنهر الجحيم في الأوديسة، فتقول: «قطعت النهر ولم أقطعه. لكل نهره. نهري خط التماس بين الشرقية والغربية، ومستنقع وحل».
يتخذ الجرذ دلالة الفتنة الكامنة في إعلان إحدى الشخصيات أن «الجرذ الكبير إذا خرج من هذا العالم إلى عالم الأحياء قلب المدينة»، فخروجه ينبئ بالمآسي. يعضد هذه الدلالة رمزية الساعة الأثرية المعلقة في بيت سمعان للتكرار التاريخي والعَودوية: «تدق الساعة بحركة البندول منذ ستين سنة. لم تدخل محل تصليح ساعات. مرت كوارث وحروب عليها.. مالت واستندت إلى الدريسوار ولم تقع وتتهشم.. أثناء قصف الأشرفية صارت تؤخر، في حرب السنتين لم تتعطل، أثناء النصف الثاني من الثمانينات صارت تقدم.. يومًا بعد يوم تفاقمت أخطاؤها.. عام 1990م تم إصلاحها، وعام 1999م رجعت تؤخر لكنها لم تتعطل.. تدق دقاتها وتتكرر بصداها المعدني.. قديمة ساكتة تنظر ولا تنظر». فبحركة الساعة وسلامة دقاتها إحالة إلى سيرورة الحياة الفاعلة في المدينة، وبتأخيرها تقدم القهقرى. أما إذا تعطلت، وخشية سمعان أن تتعطل بفعل التفجيرات، فهو إيذان بوقوف الزمن وابتداء ساعة الصفر، ساعة حرب أهلية أخرى: «حين تتكرر الدقات المعدنية في بيت العائلة الفارغ، يشعر سمعان يارد أن الأشياء لم تتغير».
يطرح أحد سكان عالم الموتى سؤالين وجوديين: «كيف تعثر على قصة لحياتك، كيف تكتب قصة حياتك؟». فممنوع عليهم تمزيق الأوراق، كأن ما كُتب قد كُتب وانتهى الأمر، لا يُمحى ولا يزول. هوذا القدر! إذا كانت الورقة تمثل حياة الإنسان، في هشاشتها وسرعة تمزقها، فقد تكون البديل الهزيل عن الحقيقة. وفتح صفحة جديدة لتدوين قصة حياة أي من سكان عالم الموتى، يؤشر استعاريًّا إلى بدء عمل جديد ونسيان الماضي وضرب الصفح عنه. أما الظمأ المستديم إلى الماء فتناسبه الرغبة في الارتواء الروحي والفكري والإنساني. تقرير ميليس هو الحد الفاصل لاتخاذ القرارات، وكشف المصاير. عليه تتوقف الحياة أو به تتوقف: «الحقيقة ساكتة والناس يموتون». هي صرخة اعتصام بالعدالة والإنصاف إزاء القتل المعنوي في الترويع الممنهج، حيث تسود بَينية سالبة: لا حياة ولا موت، لا بقاء ولا رحيل، لا حقيقة ولا كذب، بل علامات استفهام تنتشر كالذباب على جبل النفايات في «برج حمود»، ومثل الجرذان التي تكاد تعبر من نهر جحيم عالم الموتى.
المدينة المسورة تغدو كوزموبوليتية
كانت بيروت مدينة مسورة، أو بلدة شبه مربعة؛ هذا ما يذكره الراوي في ثلاثية «بيروت مدينة العالم» كما يؤكده سمير قصير في كتابه «تاريخ بيروت»، (دار النهار، 2006م). في هذه الثلاثية يصور الروائي تحولات المدينة، بهدم سورها وتوسع مينائها وتجارتها، وتغير ديمغرافيتها بتوالي النازحين إليها، وفتح أبوابها الستة، وصعودها. يحكي بمحبة، فنخاله يحنو على المدينة، أو هذا ما يتسرب إلينا من خلال متابعة قصة درامية لحارة البارودي ومؤسسها عبدالجواد أحمد البارودي. وذلك طيلة قرن صاخب من الزمن، بدءًا بالربع الأول من القرن التاسع عشر مع وصول الشاب العشريني من دمشق إلى بيروت للاستقرار فيها، مرورًا بدخول العساكر المصرية، بقيادة إبراهيم باشا، واندحارها، وبالأوبئة والويلات التي حلت بقاطنيها، وانتهاءً بخروج العثمانيين. نجد لهدم سور المدينة على دفعات معادلًا في هدم سور الحارة، وانقراض سلالة عبدالجواد، فيخبر الراوي:
«حارة البارودي بسورها المستطيل.. هدمت على دفعات بين 1915م و1919م. أعمال الهدم لتوسيع دروب بيروت القديمة بدأها العثمانيون في مطلع الحرب العالمية الأولى، وأنهاها الإنجليز والفرنسيون بعد انتهاء الحرب بهزيمة الأتراك وخروجهم من بلادنا. أعمال الهدم أزالت من الوجود البيوت الأربعة التي بناها عبدالجواد، أزالت حارة القرميد التي رفعها ابنه الثاني عبدالرحيم».
فأي وجه للمدينة يريد الروائي؟ يؤكد إلحاح الروائي على موضوعات التدمير والحرائق نتيجة الحروب، وعلى قصور الرؤية السياسية، موقفَه النقدي، وقد عاين المخاطر المهددة هواء بلده ومياهه، وتربته، وجباله والمساحات الخضراء فيه. الأمر يتعدى الاعتداد بالسياحة الطبيعية في وطنه إلى الخوف على ناس المكان. وأكثر ما يُلمح هذا التوجس في روايتَي «بيريتوس» و«تقرير ميليس» اللتين كُتبتا في مرحلة متأخرة، أي خلال إعادة الإعمار وازدهار السياحة، وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان. ولعل صرخته في متوالية أسئلة، خير معبر عن الأسى الذي يعتريه: «الأشجار قليلة في بيروت. كيف؟ لماذا قليلة؟ هناك شمس وسماء!».
حين بدأت مرحلة نهوض الدولة بعودة مؤسساتها وشرعيتها، تكشف عمق الأزمة فيما خلفته سنوات الحرب من تدمير متواتر لبيروت تحديدًا، بانت في الإمعان في التخريب من غير مراقبة ومحاسبة، ومن دون اشتراع خطط بيئية جادة. فمدينة بيريتوس تُحتضر، أتربة دائمة التساقط على رؤوس «الجَوَّانِيّين»، تطمر أحياءهم وتخنق بعضًا منهم، ومخلفات المصانع المتسربة إلى التربة ومجاري المياه الجوفية تسممهم. غارت مياه النهر وتلوثت بسلفات الحديد المتسرب من المعامل. وصار النهر أصغر من ساقية، واعتكر بالوحل وبمواد غريبة. ومن الأعراض التي ظهرت على السكان، تورم السيقان، وأورام في الحلق، وإسهال مميت، علاوة على معاناة العطش الدائم.
وفي أحياء بيروت (البَرَّانِيّة)، سببت المطامر والمكبات والمسالخ الأمراض للسكان المقيمين في محيطها. يذكر الراوي أسماءها في «تقرير ميليس»: «مكب العمروسية، وبرج حمود، والنورماندي، ومسلخ الكرنتينا»، ويعدد مفاعيلها؛ فهي تنشر الحشرات، وتسبب حساسية الربو، وأمراض العيون، وضيق التنفس لدى الأطفال والعجائز. كما أنها تبعث الغازات السامة والروائح الكريهة؛ فالمسلخ برميل غازات، والسكان لا يستطيعون النوم في الليل. الضرر إذن لم يصب هواء بيروت وشاطئها وبحرها وترابها فحسب، بل الطبقات الجَوَّانِيّة للأرض.
الخروج من المعتم إلى المضيء
ترهص الملفوظات السردية في رواية «يوسف الإنجليزي» بانعطافة تاريخية مهمة في المستويات: السياسي، والاجتماعي، والثقافي في الجبل اللبناني وبيروت، بمجيء الإرسالية الإنجيلية وتأسيسها المدارس في المناطق وبعض المدن، مثل دير القمر وعين عنوب وعيتات، وفي صيدا وبيروت. وإنشاء «الكلية الإنجيلية السورية» (الجامعة الأميركية اليوم)، والمرصد الفلكي (عام 1877م)، والمطبعة التي دُعيت بمطبعة الأميركان. كما أسست مدرسة البنات في «بيت الصوصة» في بيروت، تتعهّدها المسز شافرد، ويدرس مستر شافرد في مدرسة البنين. تزامن نشر الثقافتين العلمية والدينية مع صراع الولاءات إما للعثماني- الإنجليزي وإما للمصري- الفرنسي. وقد سطع اسم كارنيليوس فاندايك في نقل العهدين القديم والجديد إلى العربية في السنوات 1860م و1865م، وإنشاء المرصد الفلكي، واسم بطرس البستاني الذي عاون فاندايك في مشروع الترجمة، مثلما اشترك مع الدكتور عالي سميث في تأليف المعجم الإنجليزي- العربي. كانت نهضة علمية، وبداية التحول/ المنقلب الثقافي في ولاية بيروت ومتصرفية جبل لبنان.
 يُطرح غير سؤال حول مفاهيم الأصالة، وحفظ ذاكرة المكان، والحداثة واتجاهاتها. فهل ثمة حداثة بغير عودة إلى ما كان، واختيار ما سيعود؟! تبدو هذه المفاهيم في حالة نزاع لوجود تعددية أصوات، يؤيد بعضها المظاهر العمرانية التراثية للمدينة، والمحافظة على الإرث الثقافي، ويرى بعضها الآخر ضرورة الانتقال إلى فضاء حداثوي، وإيجاد سبل المعاصرة لتأسيسه.
يُطرح غير سؤال حول مفاهيم الأصالة، وحفظ ذاكرة المكان، والحداثة واتجاهاتها. فهل ثمة حداثة بغير عودة إلى ما كان، واختيار ما سيعود؟! تبدو هذه المفاهيم في حالة نزاع لوجود تعددية أصوات، يؤيد بعضها المظاهر العمرانية التراثية للمدينة، والمحافظة على الإرث الثقافي، ويرى بعضها الآخر ضرورة الانتقال إلى فضاء حداثوي، وإيجاد سبل المعاصرة لتأسيسه.
في «يوسف الإنجليزي»، سعى الضابط المصري محمود نامي، إلى تأسيس مدينة عصرية في الشرق تحاكي العاصمة الفرنسية باريس، فاختار بيروت. أنشأ دور بغاء تسهم في بعث الحياة الليلية، فاستقدم «العوالم» من خارج البلاد، وبخاصة بعد ازدياد عدد الجنود الأجانب، كما زاد عدد المشارب وبيوت الإفرنج. جُوبِهَ مشروعُه بالرفض من سكان بيروت الذين يرغبون في حياة هادئة كما ألفوها. يرون هذا التغيير في مدينتهم يتجه نحو الأسوأ لا الأفضل. فقدموا عريضة شكوى لإبراهيم باشا لإقفال سوق «العوالم». أما حين حضرت مشاريع الإنجيليين لتأسيس المدارس والمؤسسات العلمية، فرحبوا بها لإسهامها في نهضة المدينة والمناطق.
وفي «تقرير ميليس»، يبدو صوت الراوي مؤيدًا للحداثة، ومؤكدًا، في الوقت نفسه، وعيه بصون ذاكرة المدينة. يخبر بأنه حين وُضعت المشاريع لإعادة إعمار بيروت، غُيبت خطة تقضي بالحفاظ على البيوت التراثية، وإعادة ترميمها، والإبقاء على مساحات خضراء فيها. اندثرت البيوت القديمة من حي «غندور السعد»، هدموها لترتفع مكانها أبراج الزجاج. أمست المدينة مريضة، وغابة من باطون مسلح، متشنجة في زحمة الحديد والزجاج والتنك، ومبانيها كما «علب السردين». يصف الأشرفية حين كانت غابة من شجر الجميز وجلول التوت والصبار والشوك. ويعرج على «حي السراسقة» التراثي، ومنزل سمعان يارد الكائن في حي «غندور السعد»، فهو ليس طارئًا على المدينة: «بيت عالي السقف، فسيح، فيه قطع أثاث قديمة وضخمة، كوة من زجاج ملون محجر مدورة، جنبات السقف فيها تخاريم- نقوش في الحجر. لا ضرورة لتشغيل المكيف، كان البيت يُغمر بنور الغروب.. أمامه سنديانة عمرها 85 سنة». فلا حداثة إذن لمدينة هجينة تتأسس على أنقاض ماضيها، وخواء ذاكرتها؛ لمدينة مبتورة الأصل.
يغدو الخوف شخصية محورية تستوطن الذاكرة في روايات ربيع جابر، ويحكم أفق الحاضر ليسطر ملحمة الذات الإنسانية. فللعنف وتنويعاته رائحة تتسرب وتنتشر في الكراهية والفساد والظلم والعبودية والدمار؛ هي رائحة واحدة، رائحة الرعب الكبير من أن تشيخ الذات وما زالت تحبو، ومن أن تعود الأمة المعتقة بالتاريخ إلى مرحلة الحَبو.
بيروت اليوم تشبه ساكنيها، لكنها لا تتماثل مع مراياها في وجدان من تسكنه. فأية قراءة لهذه المدينة، بما مر عليها، وبمن مر بها، لا تفصح. كتب ربيع جابر ما يشبه بيروت «المدينة» (بالألف واللام)، وحفر في طبقاتها المتعددة، ولملم مراياها الحضارية: مرآة في حب بيروت، تعكس وجوهًا بيروتية من داخل السور ومن خارجه. ومرايا حداثة «بيروتية» وانفتاحها، شرقيتها وغربيتها، كوابيسها وأزماتها، نهوضها وازدهارها، وأجيال الوافدين والنازحين الذين ضمتهم واستوعبتهم، فباتوا طبقة من طبقاتها. وليس بغير تبصر روائي أن يجعل صاحب «دروز بلغراد حكاية حنا يعقوب» (2011م)، وقد فازت بجائزة بوكر لعام 2012م، بنية روايته هذه -في مطلعها وختامها- من مرفأ بيروت منطلق الأحداث ونهايتها في تماهٍ مع رحلة أوليسيوس الهوميرية من حيث التجربة والمصاير والأسئلة حول ما يبدو عبثيًّا وموجعًا بعبثيته؛ ليستدل القارئ على معاني تلك التجارب.








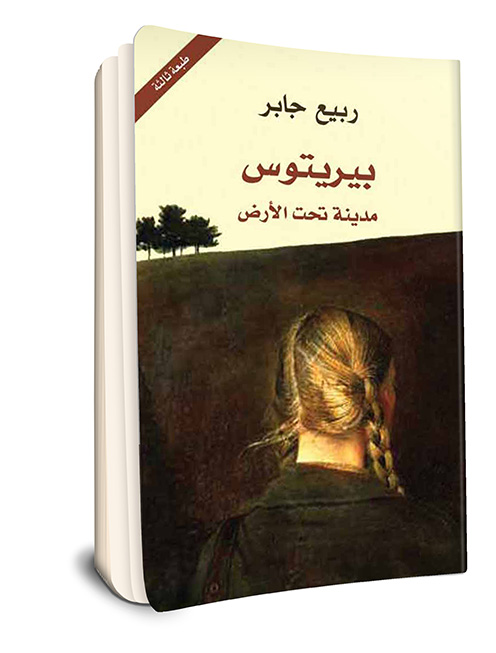 توجد هذه الحفرة في خربة «سيتي بالاس»، الأثر الماثل من زمن الحرب الأهلية اللبنانية، والكائنة على خط التماس الذي يقسم بيروت بين شرقية وغربية. لهذا المعلم رمزيته الدلالية التي تحيل إلى الذاكرة الكابوسية للحرب، ذاكرة طفولة بطرس الراوي المعذبة. يُخبر هذا الأخير عن أهل بيريتوس ومأزوميتهم ومأزقية المكان المهدد بالانهيار والتلوث. وما دهاليز المتاهة الأرضية وطبقاتها إلا طبقات الذاكرة وتلافيف الدماغ؛ حيث يصفها بأنها منخورة، مجازًا، بسوسة المنخوليا وهي «مرض الاكتئاب الشديد»: «إذا دخلت سوسة المنخوليا إنسانًا سكنت قلبه. إذا بلغت المخ صارت تأكل المادة الرمادية، وتقضم التلافيف الطرية التي تشبه الدهاليز، وتتغذى على الذكريات والأحلام والخيبات، وتنمو كالدودة». فناس بيريتوس ليسوا غير أطياف من خُطفوا وفقدوا، كما هي حال إبراهيم ابن خالة بطرس المخطوف، وقد عثر عليه في المتاهة.
توجد هذه الحفرة في خربة «سيتي بالاس»، الأثر الماثل من زمن الحرب الأهلية اللبنانية، والكائنة على خط التماس الذي يقسم بيروت بين شرقية وغربية. لهذا المعلم رمزيته الدلالية التي تحيل إلى الذاكرة الكابوسية للحرب، ذاكرة طفولة بطرس الراوي المعذبة. يُخبر هذا الأخير عن أهل بيريتوس ومأزوميتهم ومأزقية المكان المهدد بالانهيار والتلوث. وما دهاليز المتاهة الأرضية وطبقاتها إلا طبقات الذاكرة وتلافيف الدماغ؛ حيث يصفها بأنها منخورة، مجازًا، بسوسة المنخوليا وهي «مرض الاكتئاب الشديد»: «إذا دخلت سوسة المنخوليا إنسانًا سكنت قلبه. إذا بلغت المخ صارت تأكل المادة الرمادية، وتقضم التلافيف الطرية التي تشبه الدهاليز، وتتغذى على الذكريات والأحلام والخيبات، وتنمو كالدودة». فناس بيريتوس ليسوا غير أطياف من خُطفوا وفقدوا، كما هي حال إبراهيم ابن خالة بطرس المخطوف، وقد عثر عليه في المتاهة. 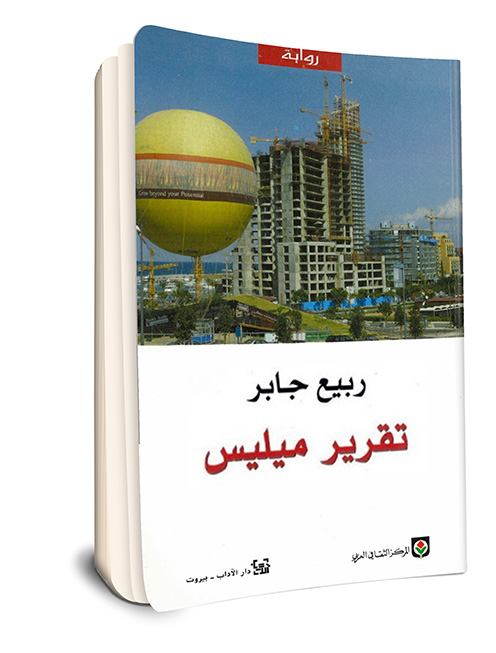 ومن دلالات البينية انشطار الفضاء الروائي إلى عالمين: عالم الأحياء، وعالم الموتى. لتشتبك مآسي الماضي بآفاق الحاضر المرعبة. هذا الربط بين الحياة والموت أدت دلالته شخصية جوزفين القتيلة في زمن الحرب الأهلية، تناجي أخاها من عالمها الآخر محاولةً مهاتفته. فالهاتف بين عالمَي الأموات والأحياء يرنّ كثيرًا في منزل سمعان. آلة الاتصال هذه لها رمزية الخشية من الاستجابة للفتنة التي تعيد ذكرى مأساة الحروب السابقة؛ كأن الموتى يراقبون ويشهدون. أضحى الموت قريبًا جدًّا قربَ رفع السماعة للرد على المتصل. كيف إذا ما كان هذا المتصل ينتمي إلى عالم الموتى؟! ذلك، فضلًا عن وجود التلفزيون أحادي الوجهة في عالم الموتى، إذ بوساطته تتابع جوزفين أحداث عالم الأحياء. وهي بدورها عالقة بين عالمَي الأموات والأحياء؛ لأن الجرذ آكل الأرواح لم يرتشف ما تبقى من دم في عروقها. تتعذب لأن الحياة الباقية في جسمها كثيرة، وتطاردها صور الحياة: «لم أنسَ ذلك الجانب بعد». رمزية «العلوق» تتجسد في مكان مقتلها، خط التماس تحت الجسر الذي شبهته بنهر الجحيم في الأوديسة، فتقول: «قطعت النهر ولم أقطعه. لكل نهره. نهري خط التماس بين الشرقية والغربية، ومستنقع وحل».
ومن دلالات البينية انشطار الفضاء الروائي إلى عالمين: عالم الأحياء، وعالم الموتى. لتشتبك مآسي الماضي بآفاق الحاضر المرعبة. هذا الربط بين الحياة والموت أدت دلالته شخصية جوزفين القتيلة في زمن الحرب الأهلية، تناجي أخاها من عالمها الآخر محاولةً مهاتفته. فالهاتف بين عالمَي الأموات والأحياء يرنّ كثيرًا في منزل سمعان. آلة الاتصال هذه لها رمزية الخشية من الاستجابة للفتنة التي تعيد ذكرى مأساة الحروب السابقة؛ كأن الموتى يراقبون ويشهدون. أضحى الموت قريبًا جدًّا قربَ رفع السماعة للرد على المتصل. كيف إذا ما كان هذا المتصل ينتمي إلى عالم الموتى؟! ذلك، فضلًا عن وجود التلفزيون أحادي الوجهة في عالم الموتى، إذ بوساطته تتابع جوزفين أحداث عالم الأحياء. وهي بدورها عالقة بين عالمَي الأموات والأحياء؛ لأن الجرذ آكل الأرواح لم يرتشف ما تبقى من دم في عروقها. تتعذب لأن الحياة الباقية في جسمها كثيرة، وتطاردها صور الحياة: «لم أنسَ ذلك الجانب بعد». رمزية «العلوق» تتجسد في مكان مقتلها، خط التماس تحت الجسر الذي شبهته بنهر الجحيم في الأوديسة، فتقول: «قطعت النهر ولم أقطعه. لكل نهره. نهري خط التماس بين الشرقية والغربية، ومستنقع وحل». يُطرح غير سؤال حول مفاهيم الأصالة، وحفظ ذاكرة المكان، والحداثة واتجاهاتها. فهل ثمة حداثة بغير عودة إلى ما كان، واختيار ما سيعود؟! تبدو هذه المفاهيم في حالة نزاع لوجود تعددية أصوات، يؤيد بعضها المظاهر العمرانية التراثية للمدينة، والمحافظة على الإرث الثقافي، ويرى بعضها الآخر ضرورة الانتقال إلى فضاء حداثوي، وإيجاد سبل المعاصرة لتأسيسه.
يُطرح غير سؤال حول مفاهيم الأصالة، وحفظ ذاكرة المكان، والحداثة واتجاهاتها. فهل ثمة حداثة بغير عودة إلى ما كان، واختيار ما سيعود؟! تبدو هذه المفاهيم في حالة نزاع لوجود تعددية أصوات، يؤيد بعضها المظاهر العمرانية التراثية للمدينة، والمحافظة على الإرث الثقافي، ويرى بعضها الآخر ضرورة الانتقال إلى فضاء حداثوي، وإيجاد سبل المعاصرة لتأسيسه. 


0 تعليق