
تبنى إسلام التنوير وكرَّمته فرنسا بينما اختزله العرب في كتب الحب والجنس مالك شبل .. في أفول العقل التنويري
يعد المفكر الجزائري (مالك شبل: 1953-2016م)، من بين المفكرين القلائل الذين زاوجوا العلم بالعمل، والقول بالفعل، بانيًا بذلك هوية فكرية مفارقة للهويات الفكرية الأخرى التي تبني جدارًا عاليًا بين ذاتها في الحياة، وذاتها مع الفكر، فقد وعى المفكر مبكرًا بهذه الإحراج المعرفي، فقام بتذويب فكره، ليصبح فن العيش متسامحًا مع الآخر، وطريقه للتفكير الحر والمستنير في الأنا متساكنًا مع الآخر. والقارئ لسيرته الذاتية التي نقلتها عنه الروائية الفرنسية (جانين بواسار، مالك، قصة حقيقية، منشورات فايار 2008م)؛ سيدرك ما قلناه سابقًا، فهو الذي عاش يُتم المجتمع، بعد فقدانه والده وممتلكاتهم بعد الاستقلال، لولا وجود السند الأمومي الذي عوضه بعضًا من هذا اليُتم القسري، لتنفتح ملكاته الوجودية على يُتم آخر وهو في مركز الأيتام، حيث كان يدافع عن نفسه وأخيه من تعنيف بعض الأطفال في المركز، لتبدأ الأسئلة الطفولية تكبر في عقل رجل المستقبل، متجاوزًا بذلك أسئلة يُتم المجتمع إلى أسئلة يُتم المعرفة: لماذا الإنسان يتعدى على أخيه الإنسان؟ وعن الحرية المسلوبة؟ وعن الحب الضائع؟ وعن المستعمر القامع؟ وعن الدين المانع؟
العقل الجريح يُسمع هـنــ(ـا)ك
لتكبر هذه الأسئلة عنده في سنوات دراسته الثانوية في مدينة العلم قسنطينة، أين كان صوت المرأة خافتًا داخل المجتمعات العربية، ومنها المجتمع الجزائري، والحب لا تسمع همساته وراء الجدران. غير أن هذا المنع المجتمعي، أضرم في نفسه نورانية الشعر، ونارية المشاعر، وهو يتعرف إلى أولى مغامرات الحب واستيهامات الجسد في هذه المرحلة؛ هذه الاستيهامات الشبابية سرعان ما تحولت إلى هاجس وجودي قابل للتفكير، داخل أسوار الجامعة، إلا أنها غير قابلة للتدبير العلمي، داخل السياق المجتمعي في ذلك الوقت، ولم يجد متنفسًا لما كان يريده إلا بعد أن نال منحة دراسية إلى إحدى الجامعات الفرنسية؛ وهنا بدأت الانطلاقة الفعلية للعقل، واندملت بعض جراحات هذا العقل الجريح. فقد عكف شبل على دراسة علم النفس، وتحصل على دكتوراه في هذا التخصص، وأردفها بدكتوراه ثانية في الأنثروبولوجيا، ورسالة أخرى في العلوم السياسية، ليصبح هذا العقل الجريح في وطنه، عقلًا يجترح أفكارًا تنويرية جديدة عن الإسلام والمسلمين في العالم، ويُسمع صوت المسلم هنا وهناك، لتكون هذه بحق قصة حقيقية، لمفكر جعل حياته موضوعًا للتفكير المعرفي، وتفكيره آل للتدبير الحياتي.
إسلام التنوير… هو السبيل للتعايش
إ
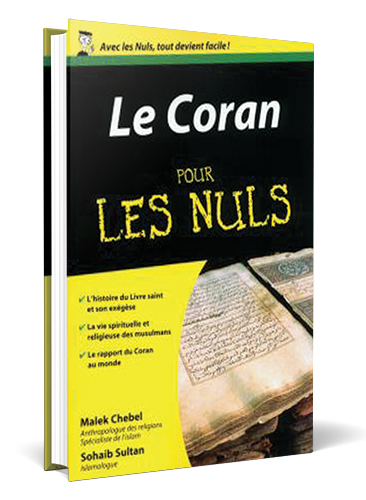 ن مالك شبل مفكر شمولي كما يقول عن نفسه، فهو لما أراد أن يعيد قراءة الإسلام قراءة جديدة، قراءة جمعية شمولية، متسلحة بمنهجيات متعددة التخصصات، لا تركن للجاهز من الأفكار، ولا إلى الأحكام السابقة، ولا إلى التصورات المتوارثة؛ فهو دائمًا ما يعرض كل هذه المقولات والأطروحات على محك النظر المعرفي، ومقياس العقل العلمي، لهذا كثيرًا ما أخذ منه المفكرون الأجانب الحذر ، على الرغم من إعجابهم بفكره المستنير، وكثيرًا أيضًا ما ارتاب منه بعض المفكرين العرب إلى حد التهجم، من أجل أفكاره المغامرة في تحليل مناطق يصعب عليهم التفكير فيها أو مقاربتها مقاربة علمية (كالجنس والشهوة، والمثلية…). فهو لم يتمكن من الحفر في بنية العقل العربي الإسلامي، إلا من خلال هذه المنهجية العلمية الشمولية المتعددة التخصصات، فهو سليل المدرسة الفكرية الأركونية (نسبة لمحمد أركون)، التي تدرس الإسلاميات في شموليتها، وهذا ما نجده في العديد من كتبه ( الجسد في الإسلام 1984م، المخيال العربي الإسلامي 1992م، قاموس الرموز الإسلامية 1995م، الذات في الإسلام 2002م، لا شعور الإسلام: تأملات حول الحظر، الخطيئة والاختراق 2015م).
ن مالك شبل مفكر شمولي كما يقول عن نفسه، فهو لما أراد أن يعيد قراءة الإسلام قراءة جديدة، قراءة جمعية شمولية، متسلحة بمنهجيات متعددة التخصصات، لا تركن للجاهز من الأفكار، ولا إلى الأحكام السابقة، ولا إلى التصورات المتوارثة؛ فهو دائمًا ما يعرض كل هذه المقولات والأطروحات على محك النظر المعرفي، ومقياس العقل العلمي، لهذا كثيرًا ما أخذ منه المفكرون الأجانب الحذر ، على الرغم من إعجابهم بفكره المستنير، وكثيرًا أيضًا ما ارتاب منه بعض المفكرين العرب إلى حد التهجم، من أجل أفكاره المغامرة في تحليل مناطق يصعب عليهم التفكير فيها أو مقاربتها مقاربة علمية (كالجنس والشهوة، والمثلية…). فهو لم يتمكن من الحفر في بنية العقل العربي الإسلامي، إلا من خلال هذه المنهجية العلمية الشمولية المتعددة التخصصات، فهو سليل المدرسة الفكرية الأركونية (نسبة لمحمد أركون)، التي تدرس الإسلاميات في شموليتها، وهذا ما نجده في العديد من كتبه ( الجسد في الإسلام 1984م، المخيال العربي الإسلامي 1992م، قاموس الرموز الإسلامية 1995م، الذات في الإسلام 2002م، لا شعور الإسلام: تأملات حول الحظر، الخطيئة والاختراق 2015م).
لهذا نجد مالك شبل لا يكتفي بالتنظير للظاهرة، بل يشفعها بكثير من التطبيقات العملية، فالعديد من كتبه تنطلق من السؤال المشروع: كيف يمكن للعالم العربي أن يجعل من الحداثة النابعة من العقل مبدأ لمستقبله؟ لأنه يرى ديننا عظيمًا، ولكن المقاربات التي حللته لا ترقى لعظمته، لأحادية مقارباتها، فهي لا تريد أن تؤقلم تحليلاتها مع المنهجيات العلمية عقلانية كانت أو اجتماعية، وأن تواجه الإسلام بأسئلته الحقيقية كما جاء في أحد كتبه (الإسلام أمام مئة سؤال، 2015م)، فلا يمكن الإجابة عن كل ذلك في رأيه إلا بفتح كليات ومعاهد تدرس هذه المنهجية المتعددة التخصصات لفهم الأديان ومقارنتها ومقاربتها، مراهنة على دعوى الانفتاح والتنوير. ولما وجد مفكرنا بعض الصدّ والمواجهة، حمل على عاتقه منذ ثلاثين سنة، سؤال مشروعه الذي يهتم بتاريخ العقليات في العالم العربي، فاهمًا للإسلام بمقاربة أنثروبولوجية، يحاور فيها بالتحليل موضوعات جديدة غير مفكر فيها، وإن كانت هي من أسهم في تكوين العقل العربي، من قبيل: الذات، والجسد، والعشق، والمخيال…، وهذه المقاربة العقلانية الأنثروبولوجية بنية العقل الإسلامي، هي التي ولدت مفهومه الذي أصبح علامة مسجلة باسم مالك شبل في العالم الغربي قبل العالم الإسلامي وهو إسلام التنوير؛ ذلك الإسلام ذو المنابع الصافية، الذي يعلمنا مبادئ التسامح والتعايش مع الآخر في اختلافيته، بعيدًا من دعاوى العنف، وسلب الحريات الفردية، وإذكاء روح الكراهية للآخرين.
وهذا ما دافع عنه شبل في كتبه ولقاءاته، ففي كتابه عن «تغيير الإسلام: قاموس المصلحين المسلمين إلى اليوم، 2013م»، يرجع بنا إلى أصل المسألة، وهو سؤال النهضة، الذي لم يجب عنه إلى الآن، ودور المصلحين في ذلك الوقت، فعلى الرغم من جهودهم الكبيرة، فإنهم لم يتمكنوا من دفع شبهة خطر الإسلام على المسيحية، التي كان ينسجها المفكرون الغربيون في مراكز دراساتهم داخل الوطن العربي في الشام والقاهرة وقتئذ، ولم تجد من يرد على هذه الدعوى، لقصور الآلية التحليلية، والرؤية الحداثية للإسلام، وهذا المبحث الدراسي المهم الذي خاض فيه شبل كثيرًا ما تجنَّبَه الدارسون العرب.
وإيمانًا من مفكرنا أن يُسمع صوته هـنا(ك) داخل المجتمع الغربي عامة، والمجتمع الفرنسي على وجه التحديد، الحامل لهويته أيضًا، فهو يتكلم اللسانين ويحمل الهويتين ولا بد أن يدافع عن المجتمعين، فلهذا لم يتجاهل وضع الإسلام في المجتمع الفرنسي الممثل للمجتمع الغربي؛ لأنه هو المتلقي الفعلي لأفكاره، وكتاباته التي تريد أن ترسخ داخل هذا المجتمع فكرة «إسلام التنوير»، مقابل «إسلام الظلام»، ومحمولاته المفاهيمية وبخاصة العنف والإرهاب؛ وهذا ما ظهر جليًّا في كتابات ومحاورات وندوات مالك شبل بعد أحداث 11 سبتمبر، حين تعالت أصوات الكراهية ضد الإسلام، والكتابات المعادية للمسلمين، فما كان من هذا المفكر العقلاني، إلا أن يحارب ويدافع عن فكرة إسلام التنوير، ذلك الدين المتسامح والمتعايش مع كل الشعوب، فكان من حكمته أن وجه خطابه عن الإسلام التنويري منذ البداية لفئة الناشئة في المجتمع الفرنسي؛ لأنها مستقبل الشعوب والمجتمعات، فكان يحرص في محاوراته الصحفية ولقاءاته التلفزيونية على أن يوجه خطابه لها، حتى أصبح كتابه عن «القرآن للمبتدئين والناشئة، 2005م»، من أكثر الكتب مبيعًا على الإطلاق، وأعيدت طباعته العديد من المرات بعد هجمات 11 سبتمبر، إلى جانب كتابه الدال على سماحة الإسلام «بيان من أجل إسلام التنوير، 2004م».

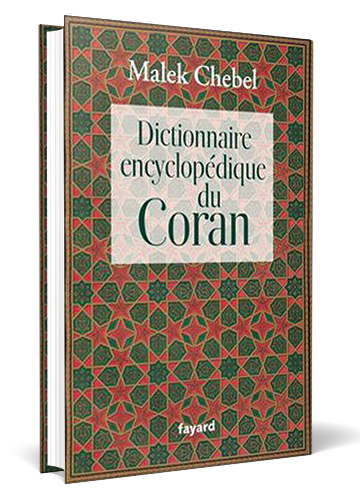 أما أكبر تحدٍّ واجهه فهو المسيرة العلمية لترسيخ فكرة إسلام التنوير، وقضى فيها أكثر من عقدين من الزمن، لصعوبة مسالكها المعرفية، وتعقيد تركيباتها الترجمية، «ترجمة القرآن الكريم،2009م»، فهو يرى أن الترجمة المتكررة للقرآن تغني معناه لدى قارئه، فكانت ترجمة مالك للقرآن ترجمة للمعاني لا للمباني؛ لأنه يريد أن يحافظ على روح النص الأصلي، وهذا ما جعل ترجمته تختلف عن الترجمات السابقة كما يذهب في مقدمة ترجمته، وقد ساعده في ذلك معرفته الواسعة باللغة العربية وجمالياتها، واطلاعه الواسع على تفاسير القرآن، وبخاصة اهتمامه البالغ بأسباب النزول، فنجد ترجمته كثيرة الحواشي الشارحة، والهوامش الموضحة، وقد وضع قاموسًا تفصيليًّا لبعض كلماته ورموزه، وهذا لتمكين القارئ من اتباع المسار التاريخي للآية والسورة، وتنزيلها تنزيلًا خادمًا لسياق العصر ومقتضياته، محافظًا في كل ذلك على القيم الإنسانية الموجودة في سور القرآن لأنه صالح لكل فرد في كل زمان ومكان.
أما أكبر تحدٍّ واجهه فهو المسيرة العلمية لترسيخ فكرة إسلام التنوير، وقضى فيها أكثر من عقدين من الزمن، لصعوبة مسالكها المعرفية، وتعقيد تركيباتها الترجمية، «ترجمة القرآن الكريم،2009م»، فهو يرى أن الترجمة المتكررة للقرآن تغني معناه لدى قارئه، فكانت ترجمة مالك للقرآن ترجمة للمعاني لا للمباني؛ لأنه يريد أن يحافظ على روح النص الأصلي، وهذا ما جعل ترجمته تختلف عن الترجمات السابقة كما يذهب في مقدمة ترجمته، وقد ساعده في ذلك معرفته الواسعة باللغة العربية وجمالياتها، واطلاعه الواسع على تفاسير القرآن، وبخاصة اهتمامه البالغ بأسباب النزول، فنجد ترجمته كثيرة الحواشي الشارحة، والهوامش الموضحة، وقد وضع قاموسًا تفصيليًّا لبعض كلماته ورموزه، وهذا لتمكين القارئ من اتباع المسار التاريخي للآية والسورة، وتنزيلها تنزيلًا خادمًا لسياق العصر ومقتضياته، محافظًا في كل ذلك على القيم الإنسانية الموجودة في سور القرآن لأنه صالح لكل فرد في كل زمان ومكان.
ولكننا نأسف أن القارئ العربي مفكرًا كان، أو مهتمًّا بالشأن الإسلامي، لم يقرأ لمالك شبل سوى تلك الاجتهادات المعرفية التي سجلها في برنامجه الفكري وهو يحفر في عقليات الثقافة العربية الإسلامية، وهو يلامس بحس المحلل النفسي الخبير بمكبوتات الذات العربية، واستيهاماتها النفسية، من مثل موضوعات «الجسد في الإسلام، 1984م»، والكشف عن رغبات الجسد الجامحة، وراء أسوار القصور والبيوتات، ليضع موسوعة خاصة بالحب والمحبين «موسوعة الحب في الإسلام، 1995م»، كاشفًا عن العقل الشهواني بكل طقوسه السوية والمثلية، وهذا ما ظهر جليًّا في كتابه المترجم للغة العربية والذي عرفه القارئ من خلاله، وقرأه قراءة المستمتع، لا قراءة المتدبر، وهو «الجنس والحريم، روح السراري، ترجمة 2010م»، غير أن القارئ العربي نسي أن هذه الكتب هي ضمن سلسلة فكرية تبحث في بنيات العقل العربي المنتج عنده لإسلام التنوير.
العقل التنويري الجريح.. مشروع لم يكتمل
بعد طول تأمل في مشروع مالك شبل التنويري، نجد أن هذا العقل التنويري ولد جريحًا، وذهب عنا جريح اليد والوجه واللسان، هو المفكر الذي قضى كل حياته مدافعًا عن إسلام تنويري، خارج أرض الإسلام، فتسلح بروح المناظرة المتصالحة والمحاورة الحسنة؛ لكي يرسخ في العقليات الغربية في كل مكان في أرقى الجامعات، وأكبر الندوات، وأصعب الحوارات، أن الإسلام إسلام تنوير وتسامح، وليس إسلام عنف، غير أن العالم العربي واجهه بتجاهل مطبق حيًّا وميتًا، والدليل على ذلك أن فكره يختزل عند القارئ العربي بكتب الحب والجنس فقط، متجاهلين أن مشروعه التنويري أكبر من ذلك؛ بدءًا من مالك بن نبي وصولًا إلى مالك شبل اللذين دافعا عن الإسلام بلغات متعددة، ومقاربات متعددة أيضًا. ألا يحق لهذا المفكر التنويري التفاتة من المؤسسات العلمية العربية تدرس فكره في جامعاتها، ومراكز الترجمة، وأن تخرج للقارئ العربي مشروعه التنويري الأصيل، فقد تسارع الغرب قبلنا مفكرين وساسة لتكريمه بأرفع الأوسمة والجوائز، نظير تعريفه بإسلام التنوير الذي يعايش الديمقراطية ويعززها، داعين إلى تبني أفكاره في مجتمعاتهم، فمن باب أولى أن ندافع عن مفكرينا ومشروعاتهم، وأن نبقيهم أحياء بيننا فيما نقول ونعمل، وهذا هو إسلام التنوير المصالح والمتسامح مع ذاته والآخرين.



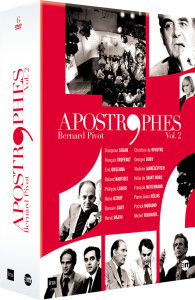 ولا يمكن تناسي دَوْر
ولا يمكن تناسي دَوْر 