سئلتُ ذات مرة: ما الذي يمكن أن تقدمه ثقافة السينما لجيل مثلنا؟ نحن نجلسُ على أريكةٍ مريحة بالبيت وندير ثقافة كاملة لشراء الأفلام على الإنترنت؛ إذ نتناقلها ونسربها من دون مقابلٍ ولا مشاركةٍ غالبًا. بل ينطلق أكثرنا شغفًا لصرف بعض الدولارات في سبيل نتفلكس. نجلس بعدها في عزلتنا خارج الزمن، نسهو بالشاشة الكبيرة لوحدنا. هل سيختلف العالم حقًّا لو أننا تشاركنا قاعة واحدة، نضحك على النكتة ذاتها في الوقت ذاته؟
دفعني كل هذا للتفكير: هل هذا ما فعلته السينما في أماكن أخرى؟ جمع الناس قبالة شاشةٍ واحدةٍ؟ أم ماذا تحديدًا؟
السينما هنا: أتذكر جيدًا كيف تناقل تويتر خبر السماح بدور السينما في السعودية، بدءًا بمرحلة اللا- تصديق الكوميدية، وانتقالًا للتعبير عن الدهشة بتحويل الأمر لموضوع سخرية، ومرورًا بعدها بفكرة أن هذا لن يحدث بالفعل: لن يمضي الأمر لنهايته. مثل هذه الأخبار تبدو مثيرة لاستياء بعضٍ لسبب أو لآخر. لكن أكثر ما شدني وقتها هي تلك التغريدات التي تناقش سعر تذاكر الدخول باهظة الثمن قياسًا بأسعارها في دول الخليج المجاورة. وبعفوية تامة، وجدتني أجيب بأننا -عمليًّا- نقطع تذاكر سفر، أو نعبر طريقًا طويلًا بالسيارات، كل ذلك في سبيل أن نعود لمنازلنا مصطحبين جملة أثيرة: «ذهبنا للسينما حين كنا هناك!».
لن أناقش الكلفة هنا. كل صناعةٍ جديدةٍ تأخذ وقتها في البداية. لكن إذا كانت السينما زاهية للحد الذي يجعلها طابعًا لثقافةٍ أو ثقافةً كاملةً بحد ذاتها، فعلينا أن نؤسس لها وأن نمتلك أثمانها نحن أيضًا.
بناء الطابع وثقافة الفكرة: كثيرًا ما نجد «أصالة الفكرة» شرطًا أساسيًّا في أي مسابقة متمحورة حول الفن. ولأن القصص والأهداف البشرية تتكرر بطبيعتها بطريقة أو بأخرى ضمن سياقات الحياة المختلفة (كالموت والحياة والمرض والزواج… إلخ)، ولأننا في غياب سينما تخصنا نُكوّن بنًى راسخةً وموروثًا هائلًا في أذهاننا عبر ما نراه من أفلام العالم، فإننا نحتاج لإيجاد طريقٍ في منتصف هذا كله لأجل بناء طابعٍ يخصنا.

فليم : فنسيس
إعادة كتابة ميراثنا من الأدب
يكمن الفن في تحويل محتوى تاريخي ثري بطريقةٍ تحفظ له قيمته وتوصله -إن صح التعبير- في آنٍ واحد. فعلى سبيل المثال، أردتُ حقًّا تحويل أحد أجزاء خماسية مدن الملح لعبدالرحمن منيف إلى فِلم. تمكنت تلك الخماسية من تأسيس عالمٍ بصريٍّ محليٍّ كاملٍ لحقبةٍ تاريخية مفصلية من تاريخنا الخاص. ما جعلها أكثر تميّزًا، أنها لم تعتمد حكاية بطلٍ واحد، بل جعلت الرواية تتناقل دور البطولة في أثناء تقدم خطها الزمني. يتجلى ذلك في اعتمادها مثلًا على قصة سائق «الباص» وشرح حقبة ذهبية من عمله قبل تركه يتدهور ويختفي فجأة؛ لتحكي قصة سائق السيارة. تقوم الرواية لاحقًا بقتل هذا السائق في السياق لتحكي قصة تأسيس مدينةٍ لم يعد هناك من ينتقل إليها، بل سكانٌ وحسب. فيما يليها، تنتقل القصة بدورها لصراع آخر في تلك المدينة. المغزى من كل ذلك أن كل سياقات الأبطال الثانويين بالرواية تخدم سير الزمن وتكوين صورة تأريخيةٍ كبرى. هذا يشبه تقطيع كعكة حلوة، ودعوة العالم إلى مأدبة كبيرة. يمكن دومًا للقصة القوية في ذاتها أن تنجح في قالبٍ غير الذي كانت عليه. تمكنت التجربة الأميركية مثلًا من تحويل «Fences» من نصٍّ مسرحي مكتوب في الخمسينيات إلى فِلم طويلٍ حصد جوائز الأوسكار. قامت هذه التجربة على أساس بناءٍ متينٍ يمكن أن يتجاوز خشبة المسرح إلى العالم الرحب. في المشهد السعودي، يوازي هذه التجربة إلى حدٍّ ما فِلم «أغنية البجعة» للمخرجة هناء العمير. رغم أن المسرح شاعريٌّ بطبعه في قصصيته، لا يمكن تجاهل محاولة نقل القالب المسرحي إلى السينما.
بناء عالمٍ جديد
لطالما بدت محاولة بناء صورة خارج المألوف شهية جدًّا. صنع العالم غير المألوف نمى صناعة الرعب وطوَّر الكوميديا السوداء وصوَّر الفانتازيا والخيال العلمي. على كل حال، يتضمن بناء عالم جديد بشكل أساسي فكرةً جوهرية: دمج هدف واقعي مع ظروف غير واقعيةٍ أو مع أوضاع جديدة. في هذا السياق، قدم عبدالعزيز الشلاحي في فِلمه الطويل «المسافة صفر» تجربةً جديرة بالذكر؛ إذ تمكن من صناعة القصة في حبكةٍ احتفظت بغموضها حتى كشفت عن نفسها في نهاية الفِلم. وفي أثناء كل ذلك، دارت أحداث القصة داخل ميراثنا وقصصنا الاجتماعية الخاصة. يمكن القول: إن قصة الفِلم مجموعةٌ من الأحداث التي يمكن أن تحدث فعلًا في الشارع المجاور أو القرية الثانية ولأشخاص نعرفهم، بيد أنها عالجتْ قالبًا ذكيًّا وجديدًا.
 صناعة السيناريو
صناعة السيناريو
إن أكثر النصائح إثارة للغيظ فيما يتعلق بالكتابة: اكتب، جرب الكتابة وحسب، اكتب كل يوم.
نعم، يمكن القول: إن فعل الكتابة في حدِّ ذاته تمرينٌ جيد، وإن الكتابة عملية مستمرةٌ ومتنامية للتعبير عن شيء. لكن هذا في حد ذاته ليس كافيًا. النصيحة التي يمكنها أن تكون حقيقةً وسريعةً لشخص في مأزق الكتابة هي: حاول محاكاة أنموذجٍ ما. بالنسبة للكثير من المهام العملية، يحقق الالتزام بهذه النصيحة الغاية التي نريد. لكن فيما يتعلق بالقصص وما إلى ذلك، لا يمكن اللجوء لنصائح سريعة كهذه. يُنمّى المنتج القصصي عبر قراءات كثيرة أو مشاهدات غير واعية. بل إن حالة اللاوعي هذه، وإن كانت ضرورية، تسهم أحيانًا في التورط بمحاكاةٍ تُعيد إنتاج القصص والأساليب بطرق سيئة.
على كل حال، في كل تجربة إنسانية، يمكن للأدوات المتاحة أن توفر الوقت. يقول بيتر كلارك: «الكتابة حرفةٌ يمكن تعلمها»، وبصراحة، يبدو كلارك محقًّا. تخيلوا لو امتلكنا خرائط واضحة لانتقاء الأساليب، أو لقياس حدة التصاعد في قصةٍ ما، أو لانخفاض الجودة في مادة سينمائية معينة. ما الذي يمكن جنيه من كل ذلك؟ سؤال «كيف نكتب» يوازيه سؤال «كيف نقرأ»، لكن ما الذي يجعل من تلك الحبكة جيدة دون غيرها؟ أو يجعل من ذلك الفِلم ممتلئًا دون غيره؟
الكتابة بوصفها عملًا تقنيًّا
تُقسِّم الأعمال الصحافية والمقالات أجزاءها بطريقة واضحة، فهي تضع النموذج الذي يمكن محاكاته لأجل تحقيق نتائج معينة. فمتوسط عدد الأحرف أو المقاطع تندرج مثلًا ضمن سياق العناصر التي يجب توافرها في مجمل المعنى. نَمَت الكتابة التقنية في كثير من المجالات عبر نماذج مثل هذه. يُطرح السؤال هنا مجددًا: ما الذي يمكنه أن يحدث للسيناريو لو خلق ووظف نماذجه الخاصة؟ بدأ العالم فعليًّا في محاولة صنع أدواتٍ لكتابة السيناريو، بدءًا من القراءة مرورًا بالنصوص الجيدة وانتهاء بالتجارب التي أثَّرت في جمهورها بشكل واسع.
أما بناء القصص، فتبدأ الأشياء متتابعةً على خط درامي. إذا لم نستطع تلخيص القصة في كلمات بسيطة (أي عبر سؤال درامي متبوع بإجابة أو نتيجة)، لن يمكن حتى لإنجازٍ مثل هذه أن يأخذنا إلى أي مكان.
في نهاية المطاف، للقصة في حد ذاتها ثيمة محددة، إطار بشري يعاود التكرار بطريقةٍ ما. يحاول الكتاب تصنيف أنواع السيناريوهات بحيث يكون لكل نوعٍ قاعدةٌ معينةٌ يتصاعد وفقها. يقول بليك سنايدر: «لكي تستطيع تفكيك الفكرة المبتذلة وتقديم الشيء نفسه بصورةٍ مختلفة، يتعين عليك أن تعرف النوع الذي ينتمي إليه عملك وأن تأتي بلمستك الخاصة».
هي السياقاتُ إذن؟ في تجربة جديدة، يقدم نتفلكس حلقةً تفاعلية من حلقات Black Mirror، وهي الحلقة المعنونة بـ Bandersnatch. يشترك المشاهد في التحكم بسياق القصة. تثير هذه التجربة التساؤل بشأن محدودية السياق الذي يمكن لقصةٍ ما أن تأخذه، كما يثير التساؤل حول الخيارات التي يمكن أن يأخذها سياق تلك القصة وأن ينتهي عليها (كاختيار السياق المناسب أو التوطئة التي يمكن خلقها للبطل أو المشكلة التي يمكن أن يقع فيها أو النهايات التي تؤول إليها الأحداث).
 كيف تدور القصص؟
كيف تدور القصص؟
تدور القصص في سياق ما. إما أن تسقط هذه القصص إلى نهايةٍ ما، أو تعاود البدء. فللقصة الدائرية مثلًا شكلٌ يعتمد العودة بالقصة إلى نقطة الصفر. يحاكي هذا الشكل القاعدة التي تقول: «التاريخ يعيد نفسه، مرة على شكل مأساة ومرة على شكل مهزلة»، ولكن بغض النظر عن هذا، بدء الأحداث ومن ثم التصاعد بها إلى الذروة ثم إعادة تدميرها كليًّا أمرٌ جدير بالدراسة. أما شأن بناء السياقات التي تصبّ باتجاه نهايةٍ ما، فعلينا أن نأخذ في الحسبان أن الحياة بأجملها مجرد سيناريو ما، وليس الفِلم سوى جزء حيوي منها. لا يمكن أن نخلق فِلمًا من مجرد التفاصيل اليومية، فللحكاية التي تروى عبءٌ لا بد من حمله. في هذا الشأن تحديدًا، يقول الناقد عبدالله السفر: «الفِلم الوثائقي ينجح؛ لأنه يحمل عبء الإعداد والتصوير فقط. لكنه لا يحمل ثقل الحكاية»، وفي هذا السياق، يمكن أن نقول: إن التساؤلات حول جدوى الحياة أو ما نريده منها أو ما يمكن أن يحدث لاحقًا أو ما يمكن أن نفعله لنعيش القصة التي نريدها ونرتضيها، تساؤلاتٌ تخلق العوالم داخل القصص.
الجدير بالذكر هنا هو الحبكة الذكية التي يقوم عليها الفِلم السعودي القصير «حرق» لعلي الحسين. تلتقي الشخصية ذاتها بذاتها في المكان نفسه سوى أنها في عمر متقدم. تتصارع الشخصيتان بين طلب النسخة الأصغر عمرًا معرفة ما تؤول إليه الأمور لاحقًا ومحاولة الأكبر عمرًا تقديم النصائح لما يجب فعله الآن من أجل تغيير سياق المستقبل واحتمالات بؤس الحياة.
فِلم، مسابقة، مهرجان، سينما: بدأنا نصنع ثقافتنا السينمائية بالتدرج المذكور أعلاه. بدأنا نصنعها ببذل كل قدراتنا الممكنة في كل مرحلة. نحن الآن تحت سماءٍ منفرجة الأفق. لا يبدو الوقت متأخرًا حين نفكر بكل الأوقات المقبلة، بيد أن من اللازم علينا القفز إلى المستوى الذي بلغناه في الهواء الشاهق الذي أخذتنا إليه أفلام العالم. صار العالم يأخذنا على محمل الجدّ بعد إقرار السينما، ولم يعد البقاء تحت مظلة الأفلام القصيرة كافيًا.
يمكن أن تنهض الحركة السينمائية بالكتابة إلى جانب قدرة الإنتاج. فعلى سبيل المثال، هل فكرنا كيف يمكننا تحويل فِلم طويل إلى مسلسل كامل؟ بالطريقة نفسها يمكن أن يتحول فِلم قصير إلى فِلم طويل. يتعلق كل شيء في المقام الأول بكثافة القصة، بالقدرة على خلق شخصيات وأحداث مساندة بحيث يكون لكلٍّ منها أهدافٌ درامية وغايات تتزامن مع خط القصة الرئيس. إضافة لذلك، يمكن للتركيز على الكتابة أن يطور من تمهيد الفِلم وتقديم شخصياتٍ قادرة على التنقل في مساحات كبرى. على سبيل المثال في الفِلم القصير «سعدية سابت السلطان» للمخرجة جواهر العامري. كان الخط الدرامي قابلًا للتطوير. وبعد الثلاثين دقيقة الأولى من بدايته، لم يخبرنا الفِلم عن قصة البطل كثيرًا؛ عن الظروف التي جعلته كما هو عليه الآن، عن أسباب تعقد علاقته بزوجته. نعم، كان ثمة هدف ونقطة نهاية، بيد أن الحبكات الجانبية الصغيرة افتقدت للكثافة التي تؤهلها لأن تنمو إلى جوار خط القصة الرئيسي بشكل كبير.
الدراما في تلك القصة وفي كل قصة متينة لا نواصل الحكي فيها، تصنع أحلامنا في حضورها السينمائي، من الآن، من البدء، للحظة المقبلة.









 صناعة السيناريو
صناعة السيناريو كيف تدور القصص؟
كيف تدور القصص؟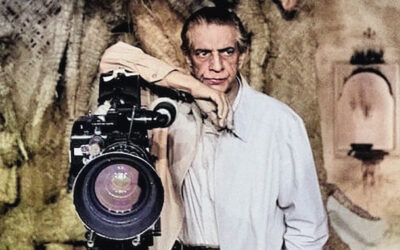


0 تعليق