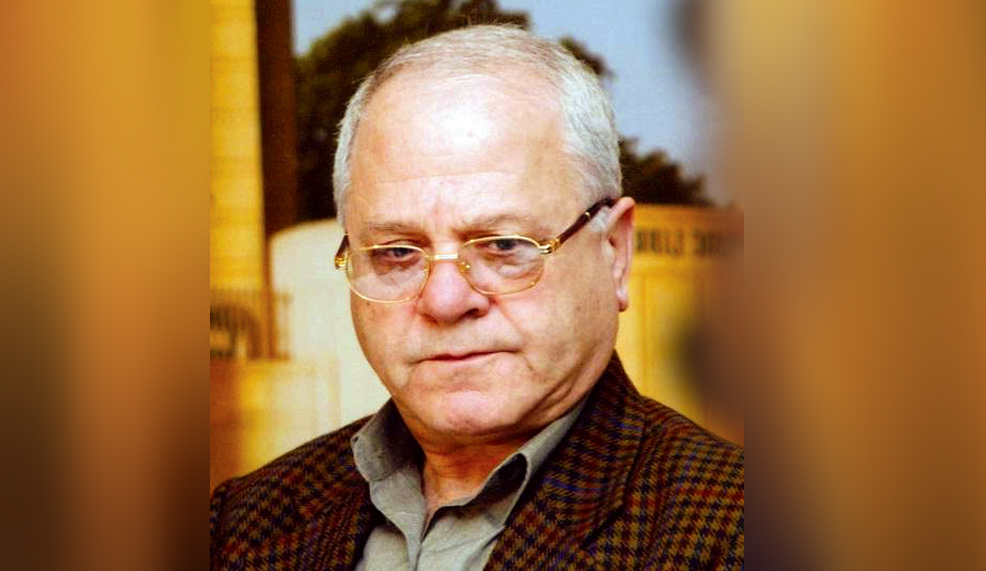بواسطة نبيل سليمان - ناقد و روائي سوري | سبتمبر 1, 2022 | فضاءات
انعقدت في جامعة حلب ندوة (لسان الدين بن الخطيب) بين الثاني والرابع من ديسمبر 2003م، وكنت أنا وجمال الغيطاني من المشاركين فيها. وفي عشية اليوم الأخير دعانا الصديق الباحث محمد قجة إلى سهرة في منزله العامر، ودعا معنا صديقيه الموسيقيين: ظافر الجسري صاحب الصوت الذهبي، وبخاصة حين يغني لمحمد عبدالوهاب، وابنه أيمن الجسري العازف الذهبي أيضًا على العود والقانون. وفي غمرة السهرة أخذ العزف والغناء بالألباب، فتربعت أنا وجمال على السجادة بين يدي الأب وابنه. ولما عدنا إلى الفندق (بيت رسمي) من بيوت حلب العتيقة في سوار القلعة، باغتني جمال بإعجابه بمرافقتي المتقطعة للغناء والعزف: «أنت مش سميع وبس، أنت بتغني كمان». وما أكثر ما ناشدني من بعد في سهراتنا المتباعدة أن أغني، وما أكثر ما أبدى إعجابه بما للموسيقا في بعض رواياتي قبل وبعد أن يحثني على أن أُعنى بالموسيقا في كل ما أكتب.
تلك كانت سهرة لمحمد عبدالوهاب «الوردة دي ريحتك فيها/ أحفظها تذكار لهواك»، و«قالوا لي هان الود عليه ونسيك/ وفات قلبك وحداني»، وسهرةً كانت لأصابع أيمن الجسري كلما استقلت عن الغناء، سكرى بالتقاسيم والارتجالات، تنادي روح فريد الأطرش ومنير بشير ومحمد القصبجي، وتتوحد مرة بالعود ومرة بالقانون.
عبدالحليم حافظ
قبل ندوة ابن الخطيب الحلبية بأقل من شهرين، كان ملتقى القاهرة للإبداع الروائي في دورته الثانية يجمعنا –عزت القمحاوي وأنا وكوكبة من الصديقات والأصدقاء– كل عشية بعد ماراثون الجلسات المتطاول من العاشرة صباحًا إلى التاسعة مساءً. وفي العشية الأخيرة حيث لم يبقَ مطرح في غرفتي في أوتيل بيراميزا لعزت ولي إلا على الموكيت، بدأنا نتناوب على (الأعمال الكاملة) لعبدالحليم حافظ. وكانت المستشرقة الرومانية رودريكا أكثر المحكومين والمحكومات بالسماع ذهولًا وإعجابًا بالوحدة (الفنية) السورية المصرية.
كانت حكايتي مع أغاني عبدالحليم حافظ قد بدأت سنة قيام الوحدة السورية المصرية في دولة الجمهورية العربية المتحدة (1958- 1961م) كما يليق بالمراهق الذي سيدمن على أفلام العندليب الأسمر، ويسمي شقيقه الذي ولد عام 1962م عبدالحليم، ويحفظ أغانيه، ويدندن بها في أماسي الكورنيش في طرطوس أو في اللاذقية. ولا تزال تلك (الأعمال الكاملة) تسكن ذلك المراهق بعد أكثر من ستين سنة. بيد أن أيًّا منها لم يتسلل إلى رواية له.
ذات صيف من أواسط السبعينيات جمعنا بيت والدتي في مدينة جبلة: محمد ملص ونائلة الأطرش وصنع الله إبراهيم وأنا. بعد سفر الأولين رابط الآخران في البيت حتى أمرت أم نبيل ضحى الجمعة بالخروج ليتسنى لها ولإخوتي تنظيف البيت، فمضينا إلى مقهى الزوزو على الكورنيش. وعلى مشهد من البحر الساجي انفرد كل منا بطاولته وأوراقه وقهوته. وأكرمنا النادل بالأعمال الكاملة لفريد الأطرش، وبالصوت العالي في المقهى الخالي. فلما شكونا الصوت أخرسه النادل دقائق، ثم أكرمنا بالأعمال الكاملة لعبدالحليم حافظ، وبالصوت العالي، فلما شكونا الصوت سألنا عما نريد أن نسمع، ولم يرقْ له أن ننشد الصمت. وقبل أن يختفي حدثني صنع الله عن الفرق بين أغنية «أهواك» عندما غناها عبدالحليم حافظ أول مرة، وبين ما آلت إليه. ولأني أعلنت عجزي فورًا، راح يشرح أن الأغنية كانت تنساب ناعمة، وبخاصة حرف الألف في «أهواك وأتمنى لو أنساك» فصار الحرف ينبتر لتأتي الكلمة مثل اللحن صارمة تعبيرًا عن المزاج العسكري الذي حل محل المزاج الرومانسي.
الغناء العراقي
أما التوله بالغناء العراقي فسرّه عند ذلك الشاب (بدر عبدالهادي) الذي ناصف الثلاثين حين بلغت العاشرة. إنه أبي الذي كان يجمعنا (أمي وأنا وصبيّان وثلاث بنات والزوجة الجديدة) كل عشية على البساط الذي يتصدره هو، وأمامه منقل تتراقص جمراته منذ الخريف إلى الربيع. وعلى المنقل يبدع (زوج التنتين) بشيّ ثلاثة أسياخ من اللحم، ويطعمنا جميعًا –ثمانية أفواه– منها حتى الشبع، ويبقى له ما يصاحب رشفاته من الكأس الصغيرة –كأس الشاي– المشعشع بسحر الماء والعرق. وقبل أن يأتي على الكأس الأولى يبدأ بالدندنة التي يوشيها بنتف من حكاية أو خبر: سليمة مراد أول امرأة تحمل لقب باشا، سليمة يهودية لم تغادر العراق إلى إسرائيل: «خدري (الجاي) الشاي خدريها/ عيوني المنْ أخدره؟ بويه/ لمنْ أخدره؟». ومن سليمة يسرع إلى ناظم الغزالي: زوج سليمة، زوج الباشا، يشرح ثم تبدأ السلطنة: «عيرتني بلشيب وهو وقار/ ليتها عيرت بما هو عار»، أو «سمراء من قوم عيسى/ من أباح لها/ قتل امرئٍ مسلمٍ قاسى بها ولها؟» أو «أقول وقد ناحت بقربي حمامة». وحين كان ينتهي نواحه بشعر أبي فراس الحمداني، كان يحدق فيّ طويلًا ثم يسألني –في كل مرة يسألني– عما إذا كنت قد حفظت هذه القصيدة، وينقذني هو من الجواب إذ لا ينتظره، بل يتابع الغناء/ النواح: «ميحانة ميحانه/ غابت شمسنا الحلو ما جانا/ حيّاك/ حياك بابه حياك..».

محمد القصبجي
كان المطرب العراقي الأثير لوالدي هو حضيري أبو عزيز، ليس فقط لأن غناءه يملأ العيون بالدمع –هل من غناء عراقي لا يملأ العيون بالدمع؟- بل لأنه كان شرطيًّا في مدينة الناصرية. ربما كان والدي (الدركي/ الشرطي) يتماهى مع حضيري، أما أغنيته الأثيرة في شيخوخته فكانت «عمي يا بياع الورد». وما أكثر وما أمتع مقارناته التي لم تشخ بين غناء حضيري أبو عزيز وناظم الغزالي وأنطوانيت إسكندر، ومن بعد: سميرة توفيق لأغنية «عمي يا بياع الورد».
لقد سمعت الغناء العراقي من كثيرين وكثيرات، لكن الصوت الذي ظل يشجيني هو صوت الصديق العراقي، المخرج المسرحي الكبير والكاتب المسرحي الكبير جواد الأسدي. وأول ذلك كان في سهرة في تونس في أثناء إحدى دورات معرض تونس للكتاب قبل ثلاثين سنة ونيف. وكانت السهرة قد بدأت بسحر (المالوف) الذي رمانا في دوار من الأصداء الأندلسية وفي غوايات القانون والعود والكلمات والطار والكمان والارتجالات والإيقاع الذي يقطع الأنفاس، والجوق يُحيي ضيوفه من العراق ولبنان وسوريا، حتى إذا ودعنا في منتصف الليل، بدأ جواد السهرة العراقية، وحاولت أن أجاريه مرة، وأن أكون الرداد مرة، وجواد يغرق في الشجن والحزن والنواح.
لم أرع إرثي من والدي من الغناء العراقي فقط، بل نمّيته، وما أكثر ما أسعدت والدي وأنا أذكّره بما غنّى عراقيًّا في شبابه، أو إذْ أضيف إليه جديدًا: من لميعة توفيق: «هذا الحلو گاتلني (قاتلني) ياعمة/ فدوة اشقد أحبه وأريد أكلمه/ وانتي شلون عمتي/ وبيّه ما افتهمتي/ روحي كلها يمّه يا عمه». ومن زهور حسين «غريبة من بعد عينج (عينك) يا يمّة/ محتارة بزماني/ يا هو اليرحمْ بحالي يا يمه/ لو دهري رماني». ومن مائدة نزهت هذه الأغنية «للناصرية بو جناع خذني وياك للناصرية». وقد جاء في منتهى رواية «تحولات الإنسان الذهبي» أن الشخصية المحورية (كارم أسعد)، وبينما كانت للّا فاطمة تقدمه على المنبر، هام مع صوت والده أقرب إلى الهمس والنشيج يدندن بالأغنية، ويكرر أنه يفضلها من أنطوانيت إسكندر على مائدة نزهت وعلى لميعة توفيق.
بسببٍ من إقامتي في مدينة الرقة من 1967م إلى 1972م تجذّر وتضاعف إرثي الغنائي من والدي. ففي الرقة، كما في شرق سوريا، يصدح الغناء العراقي مثله في أية مدينة عراقية. وبالطبع كانت الرقة –مثل دير الزور– تضفي على هذا الغناء لمستها. وقد كان لكل ذلك فعله العميق في رواية «ليل العالم» التي كانت الرقة فضاءها الرئيس منذ ستينيات القرن الماضي إلى البارحة عندما جعل داعش من الرقة عاصمةً له.
يتخيل منيب صوت هفاف في ليلة– وهما الشخصيتان المحوريتان في «ليل العالم» جمرةً نديةً تتهجد: «احتسيت مرّ العمر جرعات دفلى وسمّ». وفي ليلة تتهجد بالأغاني التي اشتهرت بها فرقة الرقة للفنون الشعبية بقيادة مؤسسها إسماعيل العجيلي، وهي الفرقة التي شهدتُ تأسيسها سنة 1969م في الرقة، وأحيت تراث وادي الفرات، وكتب لها عبدالسلام العجيلي، وتفرد فيها صوت خولة الحسن، وطافت على باريس وبراغ ولندن وقرطاج و…
من أصداء هذه الفرقة في رواية «ليل العالم»: «من فوق جسر الرقة/ سلّم عليّ بيده/ ما قدرت أردّ السلام/ خاف يقولون تريده» وكذلك: «أبو الخديد الوردتين/ گالت (قالت) لا لا/ يا دهب مشغول مابك لولا/ گلتلها (قلت لها) أروح وياج (ويّاك)/ گالت (قالت) لا لا/ نفسك دنّية وزادْ طبعي أكشرْ». وبالشطرة الأخيرة عنونتُ فقرة من الرواية، كما عنونت فقرةً بهذه الجملة من أغنية للمطرب الرقّي صلاح هليّل: «جرحْ قلبي نهارْ وليلْ ينزف». ويتخيّل منيب والده يدنو من هفاف وصوته يقطر حنانًا: «أمدوّر الخدين بدر المطاليع/ نجمة الثريا بجبينهْ أظني». وحضرت في الرواية الأهازيج التي أطلقها داعش، ومنها ما كانت لازمته «يا قاطع الراس وينكْ؟».
في ذلك الزمن البعيد عندما كانت جبلّة دخيلتي تنتسج من غناء عبدالحليم حافظ– ومعه غناء شادية ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد وفيروز…– ومن الغناء العراقي، كانت الإذاعة الإسرائيلية تفرد كل مساء حصة للمقامات والأبوذيات العراقية وللغناء العراقي عامة. ومنذ تلك الأيام إلى هذه الأيام –وما جدّ مع سعدون الجابر وإلهام مدفعي وكوكب حمزة ونصير شمّة…– ما زالت جِبِلّة دخيلتي تنتسج من الغناء العراقي.
التراث الشعبي
تحفر رباعية «مدارات الشرق» في النصف الأول من القرن العشرين في سوريا، ونادرًا فيما حولها وفي فضاءات أبعد. وهذا الزمن هو ما أفسح للغناء التراثي المجهول النسب غالبًا. ومن ذلك في الجزء الأول «الأشرعة» الأهزوجة الشهيرة: «وسعوا المرجة/ المرجة لينا/ وبأرض المرجة/ تلعب خيلنا». وإلى الأهازيج المدينية ثمة الأهازيج البدوية، ومنها: «نار الحرابة أشعلت/ يا من يطفّي نارها/ خيل النشامى وأقبلت/ تريد تأخذ ثارها/ الله من قومٍ طغت/ بالسيف حنّا اذعارها». وفي الجزء الثاني «بنات نعش» يحضر جوق القباني أبي خليل الذي يغني: «ناحت وأجبتها لِمْ نوحك ليش/ من دون سبب/ ذا إلفك والغصون تبكي عليش؟/ ذا أمر عجب». ويأتي رقص السماح، ويأتي قدٌّ، ويأتي موشح– مثلًا: «رب ساق قام يسعى/ صاد قلبي بالذوائب». ويردد عزيز اللباد الذي اكتوى بنيران الزمن العصملّي (العثماني): «يا ويل ويلي من جمال وأنور/ خلّوا العالم سبع سنين تتمرمر/ شنقوا اللي شنقوا بأول عمنول/ يشنقهم ربي هالعالي الفوقاني».
ولا يزال هذا اللحن متوارثًا في الأغنية الشائعة «مرمرْ زماني يا زماني مرمرْ»، وقد تواتر على أدائها و(عصرنتها) فيروز وطلال المداح وعلي الحجار وصباح فخري و… وثمة أيضًا هذا اللحن الذي تلهج به شخصيات أخرى في الرواية: «حنّ الغريب على حالي/ وأنت ما حنّيتْ/ لو كنت تعلم بحالي/ يا ولد حنّيتْ». وقد تواتر على أدائه وعصرنته جوزيف صقر الذي غنّى «حنّ الحديد على حالي وأنت ما حنّيتْ». وهكذا يترجّع الغناء (الروائي) من بداية القرن إلى منتهاه، ويوالي الترجيع. وفي الرواية متناصات غنائية زاخرة بالمحرم الجسدي، مثل أغنية «مديت إيدي…»، أو طالعة من القاع الاجتماعي مثل غناء الجارة: «حبيبي عاشق وأبوه عاشق وأخوه عاشق/ راحوا يجيبوا الطبيب لاقوا الطبيب عاشق/ دسّ المفاصل وقال يا ولد مالك؟/ مجروح جرح الهوى/ اللي جارحك عاشق».
وتابعت في الجزء الثالث «التيجان» على السبيل نفسه، كما في الأغنية السائرة التي أرسلها عمر الزعني: «يا توت الشام يا شامي/ الشفا على الله يا شامي»، أو هذا الذي كان يترنم به الشيخ الضرير في مدينة حمص سنة 1930م «قلوب العارفين لها عيون/ ترى ما لا يراه الناظرينا». وفي مدينة السويداء، حيث الغناء للجهّال، أي للذين لم يسلكوا سبيل الشيوخ، يترنم هزاع نصر: «سريت بليل وبوجهي بنات نعش/ واللهمّ بقلبي بنى تلّ/ هذول البيض والبنات الغوى/ ولّنْ وانطوني قفا».
من التراث الشعبي في جبل الدروز ما تلهج به الشخصية الروائية، وهو من شعر الأمير (الزعيم) شبلي الأطرش (1850– 1904م) الذي قال مناجيًا دياره وهو في السجن العثماني: «يا دارْ قلبي دايمْ الدوم بطاريك (بذكرك)/ وإن نمت أشوفك بالهواديسْ (بالمنام) يا دارْ». وقد كان لي مع هذا البيت ما لا يصدق، حين انتهت مشاركتي في ندوة في مدينة صفاقس التونسية، واصطحبني الصديق الروائي والناقد الراحل محمد الباردي إلى مدينته (قابس). ولما انفردت بي غرفتي في نُزُل شمس وجافاني النوم، قلّبت في نسخة كنت أحملها من رواية «بنات نعش». ولما وقعت عيني على هذا البيت أخذت أردده في ترانيم ظلت تتوالد حتى شروق الشمس، ولله في خلقه شؤون.
من الشخصيات الكبرى في «التيجان» وفي الجزء التالي «الشقائق» شخصية المغنية ترياق الصوان التي تغني في بيروت ثم في الشام، وتدفعها الاضطرابات في ثلاثينيات القرن الماضي إلى فلسطين لتغني في حيفا ويافا. أما أقصى ما بلغه حضور التراث الغنائي الشعبي في «التيجان» فلعله في هذا الذي يزيد الأغنية الشهيرة «ع الروزانا» معلومية ومجهولية في آن، بل التباسًا وغموضًا، وهي الأغنية الشائعة في بلاد الشام. لكن رواية «التيجان» وقعت على نص مختلف للأغنية، يدندن به من شخصياتها من الشباب المثقفين حسام النقشة ابن مدينة حماة ونهرها (العاصي) على مسمع صديقيه هشام الساجي ومؤيد عبد البر: «ع الروزانا الروزانا/ كل الهنا فيها/ شو عملت التنتنا حتى فرقتيها/ يا رايحين ع حماة صفّوا لي نيتكم/ تلتين عقلي شرد بهوى بنتكم/ حلفتلكم بالنبي منين ميتكم؟/ ميتنا عاصي حماة شرب الأفندية». في الجزء الرابع «الشقائق» عدت إلى جريدة سورية ساخرة وفريدة هي «المضحك المبكي» التي أسسها حبيب كحالة (1898– 1965م)، وعاشت ما بين (1929– 1969م) حين أوقفتها سلطة حزب البعث. وقد جعلتُ لهذا الكنز ظلًّا روائيًّا في الجريدة التي يعلقها عدي البسمة على الحبال في حي الشويكة الدمشقي. ومما نشرت الجريدة الأم وظلها الروائي هذا النص الذي ما زال يخاطب يومنا في سوريا وفي أخواتها: «سوريتنا فيها العجب/ ربطت دبًا وله ذنب/ فيها قوم أكلوا شربوا/ شفطوا لبطوا/ ناموا شخروا/ نهضوا قبضوا/ ثم انقبروا/ صمٌّ بكمٌّ/ أذن طرشت/ زفت زفت هذه الحالة». وكذلك هذا النص: «هالبترول هالبترول/ نهر ذهب بوسط الشول/ من نص أرضك طالعوه/ بالأساطيل جمعوه/ تقاسموه ووزعوه/ ومسكين السوري حرموه/ وعملوه لعبة فوتبول».

من التراث الغنائي ما جاء نظامًا للبناء الروائي في رواية «مدائن الأرجوان» وذلك في فصل «أشلاء حلبية»، حيث يفتح اسم كل قدٍّ من القدود والموشحات فقرةً في الفصل، والزمن هو مطلع الثمانينيات، والمكان هو حلب، والحدث هو الصراع الدموي الشهير بين السلطة والطليعة المسلحة للإخوان المسلمين. وتبدأ اللعبة بموشح بهاء الدين زهير: «يا من لعبت به الشمول/ ما ألطف هذه الشمائل»، ويليه موشحًا «املالي الأقداح صرفًا، واسقينها حتى الصباح» و«يا غصن نقا مكللًا بالذهب/ أفديك من الردى بأمي وأبي»، وهما من ألحان أبي خليل القباني (1833– 1903م). وفي «مدائن الأرجوان» أيضًا عيّنت الأغاني الجغرافية الروائية في مدينة اللاذقية، من شعر الشيخ عبدالرحمن المحمودي. وتقوم الحكاية هنا على (السيران/ النزهة) كل يوم جمعة، ومن ذلك: «براس النبع واصلني حبيبي/ وفي عين البحر أطفى لهيبي/ وفي القلعة أكلنا كل طيب/ وبالفاروس فيه غدا الشرابا»، وهكذا بعد حي القلعة وحي الفاروس وراس النبع ثم الطابيات، تلي أضرحة البطرني والخضر وأبي الدرداء.
من شخصيات «مدائن الأرجوان» الحكواتي (الخباص العجوز الأثرم) الذي يستذكر عرسه ومهاهاة أم حنا «قومي اركبي يا عروس والخيل تنقط عرق/ ونحنا حطينا بإيدي ميتين ليرة ورق…». كما يستذكر عشقه لصبية من مدينة الحفة (في سوار اللاذقية) ستغدو المطربة السورية كروان التي اشتهر من أغانيها في خمسينيات القرن الماضي أغنية «شدوا لي الهودج يلله/ مشتاق لحبيبي والله» وأغنية «ياه يما وانا ع العين/ شافني حسينو غمزني بعينه/ ياه ياه». وبالوصول إلى رواية «تحولات الإنسان الذهبي» التي صدرت مطلع هذا العام، جاء من الفُلكلور المجهول الأصل والمنسي، ما غنى المختار بصوته الشجي: «جنح البورصيص (طائر) جنح البورصيص/ ديري لي خدك تبوسه كيس». وفي ليلة أخرى يغني والد كارم أسعد: «زنوبا زنوبتنا/ ما منفوتا لو متنا» فدندن كارم: «حبق زنبق بيلالي/ عطلني عن أشغالي». ويهدر الراديو في مقام آخر مرجعًا أصداء ثورة التحرير الجزائرية التي غنت لها سعاد محمد: «أنا أسمي جميلة/ وأخوي كل ثائر/ وهبنا حياتنا لحياة الجزائر (…) حراير جميلة/ جميلة بوحيرد/ جميلة بوباشا/ جميلة بوعزة/ وكل بنات العروبة جميلة». وبالمقابل يسكت كارم الراديو بضيق حين ينقل أغنية لودي شامية «بدي يا أمي روب يلبق لي» لأن المطربة –كما تردد– كانت صديقة أحد ضباط حزب البعث في مستهل حكمه لسوريا سنة 1963م.
يحاول كارم أسعد الذي يعتقد أنه كان حمارًا وقد تقمص شخصية إنسان، أن يكتب سيناريو حول الحمار. ومن أجل ذلك، يختار أغاني تتعلق بالحمار منها ما غناه الممثل المصري سيد زيان: «يللي ظلم البشر منقوش على ظهرك كرابيج» وأغنية سيد درويش «حمار ويسوى ألف حصان يجري السبق»، وأغنية إسماعيل ياسين في فِلْم قديم «يا حمار.. انت طيارة شايلة طيار» وأغنية فؤاد المهندس في فِلْم قديم مغازلًا شويكار: «برسيمي انت وحدوتي/ وتين روحي ومهجتي» أما المخرج الذي سيخرج السيناريو فيغني من مكنونات (أبو الزلف): «لطلع ع راس الجبل/ واشرفْ على دوما/ ولْقى خيول العرب/ بالمرج ملموما/ رمّان يا مستوي/ ع صدير نمنوما/ جابوه من حمص/ تجّار حمويّا».
خاتمة
ربما يوفّر الغناء في الرواية لحظة استرواح، أو لعله يعبر عما لا تعبر عنه إلا به، وعلى نحوٍ يذكّر بالغناء في الحياة الشخصية أو الحياة العامة. وللأخيرة (العامة) حاولتُ أن أتقرى في كتابي «طغيانياذا: حفريات في التاريخ الثقافي للاستبداد» الأغنية الموالية للأنظمة والأغنية المعارضة لها خلال العشرية الأخيرة، في سوريا خاصة، وفي ليبيا واليمن وتونس أيضًا. وإذا كان لمثل هذا الحديث دومًا بقية، فلتكن الخاتمة تلويحة للصديقات والأصدقاء، ممن أثار غناؤهن وغناؤهم غبطتي وغيرتي: رشا عمران، عناية جابر، فوزية المرعي، أحمد عبدالمعطي حجازي.

بواسطة نبيل سليمان - ناقد و روائي سوري | يناير 1, 2022 | يوميات
«يُغمض المراهق عينيه ويفكر: الآخرون يرونني».
عندما سأقرأ ذلك وقد طويت خمسًا وستين سنة، أجزم أن إدواردو غاليانو قد كتبها لي وحدي.
ها هو الدركي المنقول من حديدة إلى الدريكيش يكوّم في السيارة الصغيرة (جيب لاندروفر) زوجتيه وأبناءه وبناته وصررًا متخمة بالثياب وفرشًا وألحفة وطناجر نحاسية وصحونًا من التشينكو وملاعق خشبية… وقبل أن يأمر السائق بالانطلاق تسرق عيناه نظرة من الشريطة السوداء على شكل حرف V، التي زيّنت عضده منذ أيام، معلنةً أن الدركي بدر عبدالهادي عباس سليمان قد تم ترفيعه إلى رتبة صنف أول، أي نصف عريف.
تنطلق السيارة، وأتكوّر في عمقها. أغمض عينيّ؛ كي أتسلل منذ الصباح إلى الخان الطويل العريض العتيق. أبي يحكي لزوجته الجديدة –أنا ابن العتيقة– أن هذا الخان الذي تلعب فيه الخيل، وجدرانه أعلى من شجرة الدلب خلف بيتنا، بناه جبّار ليس مثله جبّار، لا من الإنس ولا من الجن، باسمه تسمّت هذه القرية (حديدة)، والناس كانت تعبده في زمن الكفر، أعوذ بالله.
على كِبَر سأستعيد حديث والدي لنصرة –اسم زوجته الثانية– وأنا مغمض العينين، أفكر في أنه/ أنهم كانوا يرونني أقطع الساحة التي ينهض بيتنا على طرفها المحاذي لطريق السيارات من حمص إلى طرابلس أو إلى اللاذقية.
وقبل أن أبلغ الخان تكون سعاد بنت جارنا الدركي جوزيف بيطار الذي لم يتم ترفيعه إلى رتبة صنف أول، قد لحقت بي، فينفرد الطفلان ابني العاشرة فيما نظّما من الأحجار السود الصغيرة، لترسم بيتًا لهما وحدهما، مقابل بيوت مثله لإخوتها وإخوتي. وقريبًا وبعيدًا من بيوت الأطفال أحجار هائلة تزينها بالحُفَر والنتوءات نقوشٌ عجيبة، أصغرها يربو طوله على متر، وعرضه كما ارتفاعه يربو على نصف متر. فالخان الذي تلعب فيه الخيل، ويحتشد بالتوابيت الحجرية، تقوّض، وأنا سأقص كبيرًا على أبي وعلى نصرة –أين هي أمي؟- أن هذا الخان كان معبدًا للإله حدد، إله العواصف والأمطار الذي يرمح في السماء على عربة يجرها حصان مثل حصان أبي –كان للدركي الخيال حصان– ويجلد الغيوم بسوطه فتتساقط الأمطار، بينما يزمجر الثور الذي يجر عربة الإله فترتجّ الأرض بالرعود.
بينما كنت ألملم وجعي
لن أنسى أن نصرة قاطعتني تتمايل ظفرًا: حصان أم ثور يجر العربة يا ذكي يا متعلم يا ابن المدارس؟ فاندفعت في عراكها: أنت ماذا تعرفين؟ هل تعرفين أن الجامع الأموي بدمشق قد قام على معبد الإله حُدُد؟ هل تعرفين معبد الإله حُدُد في قلعة حلب؟ الآن أكتب اسمها مجردًا: نصرة، لكن أبي علمني وإخوتي من أمي على أن ننادي هذه الغريبة: خالتي، وأمرنا أن نقبل يدها كما نقبل يد أمي في الوداع أو العيد أو… وخالتي نصرة هي من بسببها حفظت صغيرًا من الأمثال ما حفظت. ومن ذلك ما كانت أم سعاد تقوله لأمي التي كانت تندب حظها: عقربة في الغار ولا ضرّة في الدار، فتنهدت أمي عميقًا وزفرت زفرة كاوية، وقالت: الضرة مُرّة ولو كانت جرّة. وفي مصادفة أخرى كانت أمي وأم سعاد واقفتين تحت شجرة الدلب العملاقة، وكنت أتلصص عليهما من خلف شبك النافذة الصغيرة، سمعت أم سعاد تقول: زوج التنتين يا قادر يا فاجر، فردت أمي: حرام عليك، أبو نبيل لا قادر ولا فاجر.
بعد دقائق اقتربت السيارة من المفرق الذي يقود صعدًا إلى أن يبلغ قرية المشيرفة الأصغر من حديدة. أبالغ في التكور في عمق السيارة كي أحمل حقيبتي القماشية المحشوة بكتبي وزوادتي، وأنتظر مع أبي أية سيارة عابرة تنقل ابن الدركي –وكل دركي مهاب– إلى مفرق المشيرفة. يتسلى حذائي الكاوتشوكي بحصى الطريق القصيرة إلى أن تنمهد الساحة الصغيرة أمام بيت صغير هو المدرسة الابتدائية ذات الصفوف الخمسة والمعلم الوحيد. أتحسر على البيت الصغير المقابل لبيتنا في حديدة، فهو المدرسة الابتدائية ذات الصفوف الأربعة والمعلم الوحيد. ولأن ابن الدركي في الصف الخامس، في صف الشهادة (السرتفيكا) الابتدائية، فعليه أن ينتقل إلى المشيرفة، وينام في بيت المختار، ويسرح بعد المدرسة مع أقرانه الجدد من الفتيان والفتيات– ليست سعاد هنا.
في العصر الربيعي نمضي من المدرسة وسط القرية إلى خدّها المرشوش بالزهور من أعلاه وبيت المختار إلى منتهاه في النهر الذي يفصل سوريا عن لبنان: هنا الحدود. نهر صغير يمكن لمثلي أن يقطعه. ابن المختار وحده يحثّنا، يعيرنا، يروح ويجيء، يمثل أن دركيًّا لبنانيًّا ضبطه وهو يقاوم. ابن المختار تفوق على ابن الدركي هنا. لكن ابن الدركي السوري تفوق هناك، في المدرسة، وسيذهب الولدان المتنافسان إلى ثانوية عبدالحميد الزهراوي في أطراف حمص ليتقدما إلى امتحان الشهادة الابتدائية.
في بيت صديق للدركي –لا بد أنه دركي مثله– في حيّ بلا اسم في حمص، يودع الدركي ابنه أيام الامتحان. كنت أخرج من البيت الذي لم تحتفظ ذاكرتي منه برسم، فأمشي محاذيًا سكة القطار حتى باب ثانوية الزهراوي، وصوت أبي وصديقه يلاحقانني: لا تمشِ وسط السكة. لا تعرف متى يظهر لك الترين ويبلعك شربة ماء. لا تبتعد عن السكة فتضيع. أنت في حمص، لست في حديدة ولا المشيرفة.
مثل حلم جميل يوشيه الخوف أحيانًا مضت أيام الامتحان. وفجأة ركبنا البوسطة: أمي وإخوتي من أمي وأنا –مطرودين؟ ربما– وبقيت الزوجة الجديدة وبناتها في حديدة التي ودعتها خائفًا، أغالب البكاء. ودعت مفرق المشيرفة، ها هي (جسر قمار) القرية الأصغر من حديدة ومن المشيرفة، نحن في الأرض اللبنانية، وهذا نهر الكبير الجنوبي، وهذه الأرض السورية، والسيارة تهرّ وهي تصعد إلى صافيتا حيث ولدت، ثم تترجرج نزولًا إلى طرطوس، بانياس، جبلة. ومن المفرق الذي يقودنا إلى قريتنا (البودي) تستأجر أمي حمارًا لها وللصغيرات، بينما نتبع الحمار أنا وأخي الذي يصغرني: ثلاث ساعات صعودًا، ومن يوم إلى يوم تصير حديدة وسعاد وأبي ونصرة وبناتها بعيدين بعيدين حتى النسيان. وفجأة يناديني عمي الشاب ملوحًا بظرف كبير وورقة كبيرة، وعندما وقف قبالتي أخذ يدور حول نفسه راقصًا وراغطًا، ثم حملني وقذفني عاليًا وتركني أسقط على التراب الأحمر. وبينما كنت ألملم وجعي بارك نجاحي وصاح عاليًا ومباهيًا بابن أخيه الذي نشرت الجريدة خبر نجاحه، وصار يحمل السرتفيكا.
صياحُ عمي صيّرني جنّيًّا يفتح جريدة الفيحاء الدمشقية على مصراعيها، ويسابق سبّابة العم إلى اسمي الذي خطّ أبي سطرًا تحته بالقلم الأحمر. والصحف كانت إذن في خمسينيات القرن الماضي تنشر أسماء الناجحين في الشهادات في عموم سوريا… يا للهول.
بيوت بلا أبواب
اخترقت السيارة صافيتا وتركتني أتقرى مطرح ولادتي، وتابعتْ هريرها إلى الدريكيش. ولأن عيني أمي امتلأتا دمعًا، ولأن صوتها حشرج وهي تترحم على أيامها في صافيتا، ضاعفت من تكوّري في عمق السيارة، ومن إغماض عينيّ، كي أرى أمي عروسًا جاء بها الدركي الخيّال الشاب من قرية جرماتي التي لا يفصلها عن قرية الدركي (البودي) غير واديين صغيرين، تصل بينهما تلّة مجلّلة بأشجار السنديان والبلوط والخرنوب العملاقة.
رأيت أمي فتاة قروية ساذجة، بالطبع أمية، مبهورة بالمدينة الصغيرة– بالأحرى: البلدة، رأيتها تنظر إلى أبي والهةً وغير مصدقة، رأيتها تنام حاملًا وتصحو عليّ في حضنها، ثم تنام حاملًا وتصحو على أخي في حضنها، ثم تظل تنام حاملًا وتصحو على بنت في حضنها، فبنت ثانية، فثالثة، وإذا بشابة أصغر منها تشاركها الدركي والبيت (نصرة)، ورأيت أمي تبكي ملء بيتنا في حديدة.

بيتنا؟ أي بيت هذا؟
هي غرفة من الحجر البازلتي مثل بيوت حديدة وكل هذا الأفق المترامي من ثانوية الزهراوي في حمص إلى الحدود اللبنانية. رحم الله نسيب عريضة الذي صب لوعته شعرًا: يا حمص يا أم الحجار السود. الغرفة مربعة وكبيرة، يتجاوز ضلعها خمسة أمتار، تتحول في الليل إلى فراش يضيق بأمي وأبنائها الذين ازدادوا أخًا فصرنا ستة. ويضيق الفراش الهائل بنصرة وابنتها الأولى وأبي. الذي ما عاد ينام إلا محشورًا بين الحائط ونصرة.
ذات ليلة حلمت –يقظان أو غافيًا– بأبي يطرد من الغرفة البيضاء المغناج (نصرة) وأمي (السمراء المتحفظة) تحل محلها. وذات نهار حلمت –يقظان أو غافيًا– بأمي تذكّر ضرتها: جئت لا تعرفين كيف تعملين فنجان قهوة، علّمتك كيف تمشطين شعرك وكيف تطبخين وكيف تلمّعين بوط جوزك، والآن تتنمّرين عليّ؟ زعقت نصرة: الجدي ما بيضلّ جدي، بيكبر وبيصرلو قرون، بعدين لمّا أنت ستّ وأنا ستّ مين بدها تكب الطشت؟
لا، لم يكن حلمًا. كان كابوسًا اشتبكت فيه الضرتان: واحدة تنتف شعر الأخرى، والأخرى تعض ذراع الواحدة، وأنا أحاول أن أفكّ الاشتباك وأصرخ مستنجدًا إلى أن جاء جارنا أبو سعاد وأم سعاد وبددا الكابوس.
لا، لم يتبدد الكابوس. خرجت من الغرفة/ البيت ولم أعد حتى أعتمت: أين هو الباب؟ ولماذا لن أراه من بعد؟ لماذا لن أرى بابًا على المدرسة، ولا على بيت/ غرفة جيراننا، ولا على الدكان الذي تظلله شجرة الدلب العملاقة، ولن أراه من بعد في مدرسة المشيرفة ولا في بيت المختار، ولم أجرؤ على أن أكلم أحدًا بذلك إلا سعاد التي جرتني إلى أمام بيتها وبيتي والمدرسة، ومرّغت كفيّ على كل باب، وضحكت وجرت صوب الخان وجريت خلفها جذلان.
وإذا كنت سأصحو يومًا على صوت الراديو يلعلع بالغناء، وأسمع أبي يوشوش نصرة: هذا عرس الملك حسين في عمّان، فجافاني النوم، إلا أنني صحوت يومًا ويومًا وثالثًا على أمي تبكي و/أو على نصرة تحبس ضحكة أو شهقة، و/أو على أبي يشتم أمي ويتوعدها. وفي كل مرة أتكور في عمق الفراش وأغفو عميقًا على هدهدة خوفي وقلقي. وكان مثل هذا الخوف ومثل هذا القلق يتسللان إليّ في غفلة مني، أو يهجمان فجأة في غفلة أيضًا، عندما كان الأستاذ كامل حصرية يثني عليّ أمام التلاميذ، وينصّبني عريفًا على الصفوف الأربعة المحشورة في غرفة واحدة شبيهة ببيتنا -غرفتنا وبيت- غرفة جيراننا، حيث سعاد بنت الدركي المسيحي. أما سبب قلقي وخوفي من أستاذي فجاء بعدما حذرني أبي من أن أدع الأستاذ يلاطفني أو يقترب مني كما يفعل مع شقيق سعاد– ماذا كان اسمه؟
بعد انتقالي إلى مدرسة المشيرفة بمدة سمعت أمي تحدّث ضرّتها عن الأستاذ الذي (نزع) الولد –أي شقيق سعاد– وعن حبس الأستاذ في نظارة (تخشيبة) المخفر.
والآن، وبينما تلوح الدريكيش وهي تتعربش –تتسلق– على الجبل، أتكور في عمق الجيب اللاندروفر، وأغمض عينيّ لأرى جدي الشيخ عبدالهادي بقامته الطويلة وصلعته اللامعة وقنبازه المخطط الغامر لسرواله الأبيض، ينزل في بيتنا –غرفتنا المربعة السوداء، ثم أراه يمسك بكفي وإلى يساره أبي، ونحن في ساحة قرية (قزلاخر) القريبة من حديدة: ضوء باهر ربما كان لأكثر من (لوكس) أو للقمر في تمامه، رجال ونساء، أولاد مثل ابن الدركي، صخب ربما كان غناءً أو تهليلًا، الجد يتشامخ ويزداد طولًا ومهابة ولا يفلت كفي. هل هو عرس؟ عيد؟ استقبال للشيخ؟
العودة إلى حديدة
قزلاخر: كروم الزيتون، الزعتر البري مروج فوّاحة برائحة تميل بالرأس وترقّص خطوات وضحكات ابن الدركي في الغروب الذي تحررت كفّه فيه من كف جده، محطة للقطار مقدودة من الحجر الأسود، منام وذكريات مفلوشة. وسوف يظل كل ذلك غامضًا مثل غموض الشهور القليلة التي أعقبت حملي لـ(السرتفيكا). ما هو جليّ أنني عدت إلى حديدة في نهاية الصيف. وبعد أيام اصطحبني أبي إلى بيت صديق له في مدينة تلكلخ– من المؤكد أن ذلك الصديق لم يكن دركيًّا، فماذا كان إذن؟- حيث افتُتح في مدرستها الابتدائية منذ السنة الماضية الصف السادس (الأول الإعدادي).
كان بيت أبو صبري أول بيت في تلكلخ يستقبل القادم من حمص، أو آخر بيت يودع القادم من طرابلس أو طرطوس أو اللاذقية. كان بيتًا مقدودًا أيضًا من الحجار السود. غرف عديدة متلاصقة أمام فسحة/ حديقة مسوّرة ولكن بلا باب، تمرح فيها القطط السود دائمًا، وكلاب سود أحيانًا، الغرفة التي سينام فيها ابن الدركي مقابلة لغرفة نجيحة. وسوف أنسج من شتات ما أسمعه في البيت، لأرى نجيحة تفكّ الحرف، وتحفظ جدول الضرب، وأرى أم نجيحة، أي أم صبري –لماذا لم يظهر صبري خلال شهوري الثلاثة في بيت ذويه؟- قد ابيضّ شعرها، وانحنى ظهرها كأنها وجدتي لأبي (نمنوم) توأمان. ومع كل يوم جديد كنت أقضيه في هذا البيت كنت أزداد دهشة من نشاط هذه العجوز، ومن أنها زوجة هذا الذي يبدو أوفر شبابًا من أبي– لم يبلغ الأربعين أي منهما– فلماذا تزوج من هي في عمر أمه؟ وصبري الذي لا يغيب ذكره عن السهرة، أين هو؟ ولماذا تريدني نجيحة أن أعلمها إلى أن تجيد القراءة والكتابة مثل بنات الأكابر؟
أما الأكابر في تلكلخ، فكنت أسمع أبو صبري يتحدث في العشايا عمّن عرف منهم: الأستاذ عبدالرزاق الدندشي الشاب الذي أسس مع زكي الأرسوزي ومع صبري العسلي وأساتذة كثيرين (عصبة العمل القومي) في قرنايل في لبنان قبل عشرين سنة، بل أكثر. وفي السهرة التي روى فيها أبو صبري ذلك، غزلت عيناي الساهمتين لعبدالرزاق الدندشي صورة من وجوه من رأيت من الأساتذة في المشيرفة وفي ثانوية عبدالحميد الزهراوي وفي ابتدائية/ إعدادية تلكلخ. وحين كانت تتلامح صورة الأستاذ كامل حصرية كانت عيناي تمزقانها.
ها هو صوت أبو صبري يسحج كأنه يغالب البكاء أو الانفجار: اغتالوا عبدالرزاق الدندشي. تسأل نجيحة: شو يعني؟ تشرح أم صبري: قتلوه. ليش؟ تسأل نجيحة. ينهض الأب وبالكاد يُسمع صوته: قوموا ناموا.
في ليلة أخرى كانت هبّات الهواء فيها تصمّ الآذان وتخلع الشبابيك والأبواب كما تقول أم صبري وتسأل الله اللطف بعبيده؛ في تلك الليلة سمعت «أبو صبري» يسأل ضيفه –ستخبرني نجيحة أنه عمها، وأنه سينام في البيت– عن ابن العم الذي يغني في الإذاعة: (سمعت عنين الناعورة/ وعنينا شغل بالي/ هيّ عينينا ع الميّة/ وأنا عنيني ع الغالي/ أوف يابا). وفاتني من الكلام ما فاتني بسبب العاصفة القادمة من (فتحة) حمص. وقالت أم صبري متباهية: معن ابن عمنا، أبوه شاعر، وأمه ليس لها مثيل في العزف على العود، وهي علمت «معن» العزف. صوت أم معن ولا صوت أم كلثوم، ولا صوت أسمهان. وذات نهار سأرى نجيحة قد ألصقت أذنها بالراديو، وأمها واقفة تصغي بتأثر. وحين انتهت الأغنية –ماذا كانت؟- تروي أم صبري أن ابن عمنا معن هو من درّب فيروز على أن تغني (أبو الزلف) و(ع اللالا) و(الدلعونا) و(بردا بردانة بردا). وكنت أحب هذه الأغاني، وأرى أبي يميل برأسه يمينًا ويسارًا عندما يسمع إحداها ونصرة تدندن مع الراديو.
حضر والدي مرة واحدة إلى بيت صديقه. ورأيتهما يشربان كلٌّ من كأس بلون الحليب، سأعلم بعد سنوات أنه العرق ممزوجًا بالماء. وسمعت أبو صبري يحدّث أبي عن أبيه الفارس الذي كانت له فرس ليس لها أخ ولا أخت. والدنادشة يا صاحبي عشاق الخيول الأصلية: قال، وروى عن أبيه أنه كان من قواد المقاومين الذين تصدوا للجيش الفرنسي سنة 1919م، ورفضوا رفع علم فرنسا على السرايا –ربما كانت السرايا وحدها في تلكلخ من طابقين– وأنهم رفعوا علم الحكومة العربية في دمشق، وأن جنودًا من الجزائر كانوا في صفوف الجيش الفرنسي. وسوف يكون لكل ذلك حضوره الفعّال في الجزء الأول (الأشرعة) من رباعية (مدارات الشرق).
في حضن نجيحة
في الليلة التالية، وقبل أن أذهب إلى المدرسة، سمعت أم صبري تأمر نجيحة: إياك أن تظهري ما دام خطيبك هنا. انقبري في غرفة نبيل حتى يرحل عريس الهنا. ولعَنت أبا العريس وأمه. وما همني من ذلك إلا أن نجيحة ستكون حبيسة غرفتي. وفي الطريق إلى المدرسة تمنيت أن ينام العريس في البيت لتنام نجيحة في غرفتي. واستذكرت متلذذًا طوال الدرس الأول –كان للغة الفرنسية التي فرضتْ علينا لأن تلكلخ ليس فيها من يدرس الإنجليزية– المرات التي ضمتني فيها نجيحة إلى صدرها، أو داعبت شعري، أو قرصت خدي. بيد أن الدرس التالي، وكان للرياضة، جعل نهاري غمًّا. كانت الأمطار لم تهدأ منذ أيام، لكنها صحت فجأة في الفرصة الفاصلة بين درسَيِ الرياضة واللغة الفرنسية. وسبق أستاذ الرياضة إلينا أمره بالخروج إلى الساحة حيث بدأ يدربنا على السير مثل العسكر. ثم بدأ يدربنا على الاستدارة بأمره: يمين دُرْ، يسار دُرْ. وفجأة عميت أذناي وعيناي، فدرت يمينًا عندما أمر بالدوران يسارًا، والعكس بالعكس في الأمر التالي. وفيما يشبه البرزخ بين النوم واليقظة، رأيت الأستاذ يترك زملائي ويقبل عليّ، يأمر فأنفذ، ولكن عكس ما يأمر به، ينفجر صوته ويتطاير زبده، وأنا أمعن في الخطأ غير قاصدٍ لا والله. ما الذي برمجني على الدوران عكس ما يأمر به؟ ولماذا يضحك الملاعين؟ لماذا يضربني الأستاذ على خدي الأيمن ويأمرني: يمين دُرْ، فأدور يسارًا وأدير له خدي الأيسر، فيغرس أصابعه في خدي ويأمر، وأخيرًا أوقعتني لبطة منه على أرض الساحة المنقوعة بالماء والطين.
في نهاية الدرس مسحت الطين عن بنطالي، غسلت، ساعدني زملاء، صرت مبللًا بالماء، وقضيت بقية النهار أرتجف، حتى إذا عدت إلى البيت تسللت يتأكلني الخجل، وكانت نجيحة لي بالمرصاد، شهقت وسألت ولم تنتظر جوابًا. تسللت بي مدارية أمها إلى الحمام. لا بد أني صرت عاريًا بين يديها حتى وقعت مغشيًّا عليَّ، أو هكذا شبه لي إلى أن كستني وأدفأتني –بماذا؟- وفي العشية لم تدعني أغادر حضنها بينما كان خطيبها في ضيافة أبيها وأمها.
غافيًا أو يقظان قذفتني انفجارات الرعد من حضن نجيحة إلى باب الغرفة. اختفى الباب. عدوتُ إلى الصالون. اختفى الباب. اختفت الأبواب المفضية إليه. غافيًا أو يقظان طرت إلى المدرسة. لم أر لبيتٍ بابًا، وأنفاس نجيحة تلفحني الآن وأنا مغمض العينين، متكور في عمق الجيب اللاندروفر التي دخلت الدريكيش. نجيحة تتسلل كل ليلة بعد أن يغفو أبواها إلى غرفتي، تملأ فراشي وتحضنني، تدفئني وتحكي ما لا أذكره، إذ أكون مغشيًّا عليّ. ولما عدت إلى حديدة في نهاية الأسبوع لطوت في المساء قرب باب غرفة /بيت سعاد/ غرفتها، وطال انتظاري، وهمست مناديًا، ولما ظهرت احتضنتها، فملصت مني، فاحتضنتها بقوة كأنني صرت نجيحة، فلبدت في حضني إلى أن جلجل صوت أمها: وينك يا سعاد؟ وينك يا مضروبة؟
لم أر حديدة من بعد إلا في المنام. ولم أرها في منام إلا كانت أبوابها مخلّعة، ثم صرت أراها بلا أبواب، حتى إذا انطوت خمسين سنة…
كنت عائدًا من لقاء بين فنانين تشكيليّين وكتّاب، نظمته مديرية الثقافة في السويداء باقتراح مني. وكان الناقد صلاح صالح يقود السيارة على أوتوستراد حمص اللاذقية. ولما اقتربت السيارة من المفرق الذي يقود إلى حديدة، طلبت من صلاح أن يمضي إليها. وحدثته عن مقامي فيها. ولما وقفت السيارة في وسط الساحة، رجّني قبل أن أنزل منها أن بيتنا بلا باب كما في المنام الذي نسيني منذ سنوات. وهذا بيت سعاد بلا باب، وهذا بيت المدرسة، والدكان، والمخفر الذي لوّح لي بصورة أبي من بعيد بلا أبواب. هذه أبواب حديدة التي تضاعفت بيوتها أضعافًا بلا أبواب.
عدت مبلبلًا، كسيرًا، إلى السيارة، وأسلمت روحي إلى صوت فيروز تغني:
وبوابْ بوابْ/ شي غربْ شي صحابْ/شي مسكّرْ وناطرْ تيرجعوا الغيّابْ/ آه يا باب المحفور عمري فيك/رح انطرْ وسمّيكْ باب العذابْ/ في باب غرقانْ بريحة الياسمينْ/ في باب مشتاقْ/ في باب حزينْ/ في باب مهجور وأهلو منسيّيين/ هالأرض كلها بوابْ/ يارب خلّيها/ مزينة ببوابْ ولا يحزنْ ولا يتسكّر باب.

بواسطة نبيل سليمان - ناقد و روائي سوري | يناير 1, 2021 | يوميات
شباب في مثل عمرك (22 سنة)، بل أصغر، بل أكبر، يملؤون شوارع وساحات باريس، يتقدمهم ساحرك جان بول سارتر، وها هو شرطي يضربه وأنت تتهادى في مشوارك المسائي على الجسر العتيق، مُشْهِدًا نهر الفرات على ما فتنك من شعارات شباب 1968: كل السلطة للخيال.
إلى مكتبة الخابور كنت تسعى كل مساء منذ أيامك الأولى في الرقة، تتصفح صحفًا وتقلّب مجلات وكتبًا وتشتري ما يؤنس ليلتك. ومن جريدة إلى جريدة، ترجّك المظاهرات الشبابية في جامعة عين شمس في القاهرة، وفي المظاهرات العمالية في حلوان، ضد من لا تزال تصفق له قائدًا: جمال عبدالناصر. وها هم شباب باريس والقاهرة يرمونك بالسؤال عن مظاهرات شباب سوريا، في دمشق أو حتى هنا في الرقة، فتتكوم على ضفة الفرات، تحت الجسر، خوفًا من أن يكون شباب سوريا قد نسوا المظاهرات بعد ما تقوضت الجمهورية العربية المتحدة، وانفصلت سوريا عن مصر في (28/9/1961م).
من غرفة المدرسين في ثانوية الرشيد إلى المركز الثقافي إلى مكتبة الخابور إلى المقهى إلى المقصف إلى الجسر العتيق، تتقافز وأنت لا تصدق هذا الصمم في الرقة عما يزلزل العالم، كما الصمم الذي سيلاقيك طوال العطلة الصيفية في اللاذقية أو دمشق أو جبلة أو القرية.
رسائل بوعلي ياسين: إلى ملجئك الوحيد إذن: الخيال.
كل شيء للخيال، وليس فقط السلطة. وها هي رسائل بوعلي ياسين تلهب الملجأ واللاجئ. فبعد صمت شهور يكتب بوعلي عن كومونة فرانكفورت، عن صديقته ألفونزا، عن جامعته في ماينتس التي ودعها مؤقتًا ملبّيًا نداء الثورة. ويكتب سطرًا عن يوهانس غوتنبرغ الذي حملت الجامعة اسمه، واخترع المطبعة التي طبعت أول كتاب في التاريخ. ومن النادر أن يكتب بوعلي سطرًا عن الأطروحة التي سينال عنها الماجستير: القطن وظاهرة الإنتاج الأحادي في سوريا. لا للحرب في فيتنام، لا لسيطرة الدولة على الفنون، لا للقيود التي يكبلنا بها المجتمع، كن واقعيًّا واطلب المستحيل، نعم للحب، نعم للحب، نعم للحب: يكتب بوعلي وأنا ببغاء أردد، وأتلعثم، وأردد، وأشوّه، وأردد.
بوعلي إذن واحد من الثوار، عاشق، وباحث. بوعلي: خيال.
نبيل بدر
يبدأ حديث السينما عندي من اسمي، ذلك أن أبي (بدر) كان دركيًّا في صافيتا منذ 1944 سنة حمل أمي بي. وفي نهار أو ليل، كما سيحدثني أبي مرارًا، كان يلبي مع أي من زملائه نداء مدينة طرابلس (لبنان) القريبة، حيث يشاهدان فِلْمًا سينمائيًّا عربيًّا في سينما دنيا، وفي أحيان نادرة يكون الفِلْم أجنبيًّا في سينما أمبير. في نهاية العام عاد أبي من مشاهدة فِلْم «رابحة» نشوانَ يبشر باسم ابنه الذي سيولد بعد أسابيع: نبيل، لماذا؟ لأنه سيكون نبيل بدر، لماذا؟ لأن بطل فِلْم «رابحة» هو الممثل الفلسطيني بدر لاما، وفي الفِلْم اسمه نبيل، وسيكون اسمي إذن قادمًا من السينما. اسمٌ خيالٌ لكائن من خيال. فهل يكون ذلك ما أورثني من أبي عشقَ السينما؟
نجيب محفوظ: خيال
ربما تواتر هربي/ لجوئي إلى السينما؛ لأنني عجزت عن أن أتابع الكتابة بعد ثمانين صفحة في الرواية التي كان عنوانها أولَ ما كتبت منها: «نحو الصيف الآخر». ولا يزال هذا «المشروع» هاجعًا في الدرك الأسفل من المكتبة إلى اليوم.

روبرتو روسيلليني
ثلاث دور للسينما كانت في الرقة 1969م
في بداية شارع تل أبيض كانت سينما الزهراء تتلألأ، وغير بعيد كانت سينما الشرق، وكانت سينما غرناطة التي احترقت العام الماضي وأُغلقت، وقد تردد أنها ملك عبدالسلام العجيلي وأخيه عبدالعظيم. من سينما إلى سينما، ها أنذا أتنقل في العرض المسائي و/ أو الليلي، أستقبل 1969م بفِلْم «اللص والكلاب»: هذا سعيد مهران بقميص شكري سرحان، وهذه نور بقميص شادية، هذه ليلى نظمي تغني: العتبة جزاز والسلم نايلون في نايلون. إنه نجيب محفوظ، ورواياته تسكنني كما أفلامها.
نجيب محفوظ خيال. وهذا فِلْم طازج يطير من القاهرة إلى الرقة: «ميرامار»: به أودع 1969م، مع زهرة بقميص شادية أيضًا، عامر وجدي بقميص عماد حمدي، محمود أبو العباس بقميص عبدالمنعم إبراهيم، صفية بقميص نادية الجندي. من مكتبة الخابور اشتريت «أولاد حارتنا» والثلاثية دفعة واحدة. وفي سينما غرناطة عشيّة احتراقها، شاهدت للمرة الثانية «بين القصرين»، وكانت الأولى في اللاذقية قبل أن أقرأ الرواية، وهذا سي السيد بقميص يحيى شاهين، هذه أمينة بقميص هدى سلطان، هذا فهمي بقميص صلاح قابيل، هذه العالْمة جليلة بقميص ميمي شكيب. وهذه رواية «زقاق المدق»: حميدة بقميص شادية، المعلم زيطة بقميص توفيق الدقن، المعلم كرشة بقميص من؟ لعن الله النسيان. من الرواية إلى الفِلْم، حين قرأت وحين شاهدت «بداية ونهاية»، سحرتني ريري التي ستحيا بقميص نادية لطفي، وأرّقني السؤال عن عاهرات روايات/ أفلام نجيب محفوظ. وفي مجلةٍ ما قرأت أن «بداية ونهاية» تنتقد ثورة 1952م، فزعلت منها، ومن نجيب محفوظ ونادية لطفي وعبدالله غيث ومحمود مرسي وعادل أدهم، وزعلت من حالي لأني لم أكتشف ذلك الانتقاد. ربما كان عبدالناصر لا يزال ضروريًّا لروحي.
أخيولات
كما لو أنك مسرنم تمضي مع مناة الثالثة الأخرى نحو الزواج، مثلما مضيتَ نحوه من حب غرير سرعان ما قوضته، بدعوى أن مناة الأولى أمّية، إلى حبٍّ أكبر غرارةً قوّضه ذوو مناة الثانية، لأنك أسرعت إلى طلب الزواج منها وأنت طالب جامعي في الحادية والعشرين. أما الآن فها هو حب هادئ، عاقل، يمضي بك وبمناة الثالثة الأخرى إلى.. إلى أين؟ لا، ليس ذلك سرنمة، ولا أضغاث أحلام. ليس كل ذلك إلا خيالًا، مثله مثل هذا الذي يعصف بك هذا اليوم، الثاني والعشرون من شباط 1969م، في ذكرى قيام الوحدة السورية المصرية، وفي إعلان قيام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعدما تشققت الجبهة الشعبية في الصيف الماضي. وماذا كانت إذن غارة الطيران الإسرائيلي على ميسلون منذ ثمانية عشر يومًا؟
نساءٌ خيال. الوحدة خيال. فلسطين خيال.
الطلاب الأصدقاء
واحد من الطلاب الذين أدرّس لهم هو عبدالله أبو هيف (1948- 2017م)، كان يخطط بخطه الجميل المتقن إعلانات هذه السينما أو تلك عن الفِلْم المعروض والفِلْم القادم، وبالأجر يتغلب على البؤس المادي. وسيغدو عبدالله إلى أن ينال الشهادة الثانوية ويمضي إلى جامعة دمشق، صديق السينما بالنسبة لي؛ إذ كانت له ذائقته السينمائية المميزة، مثلما كانت له ذائقته الشعرية والقصصية، هو وزملاء له، منهم الشاعر إبراهيم الجرادي (1951- 2018م). وكانوا قد أسسوا منذ السنة الماضية جماعة «ثورة الحرف»: إبراهيم الخليل وخليل جاسم الحميدي (1945- 2007م) ووفيق خنسة وآخرون. وثمة من عدّني من المؤسسين لهذه الجماعة التي ما كانت لترضى بأقل من تفجير اللغة وتأسيس أدب جديد. ولكني لم أكن من المؤسسين، وفيما عدا ذلك كنت واحدًا منهم، نتناهب الكتب كما نتناهب الأفلام التي كان يستهويني منها وبخاصة ما جاء من رواية، فيطلق خيالي، مثل قراءة الرواية، إلى يوم أكون فيه كاتبًا من، من… خيال!
روايات/ أفلام
هذا فِلْم «الرجل الذي فقد ظله»، هذه رواية فتحي غانم، هذا صلاح ذو الفقار وماجدة وكمال الشناوي، هذا هو الصحفي الانتهازي الذي ما أكثر ما سأصادفه من بعد في الحياة الثقافية. وهذا فِلْم «قنديل أم هاشم»، هذا يحيى حقي، وهذا فِلْم «أرض النفاق»، هذا يوسف السباعي الذي أسرت مراهقتي رواياته والأفلام المأخوذة عنها (ردّ قلبي، بين الأطلال، اذكريني)، مثله مثل إحسان عبدالقدوس. وهذا فِلْم «دعاء الكروان»، هذا طه حسين، هذه فاتن حمامة، وهذه زهرة العلا، وهذا أحمد مظهر.
أخيولات
البلاد تتلاطم منذ الهزيمة– حرب 1967م؛ لذلك عليك أن تصدق أن العقيد عبدالكريم الجندي انتحر بخمس رصاصات. وما راءٍ كمن سمعا. كان المنتحر مدير المخابرات العامة، أي أمن الدولة، ومدير مكتب الأمن القومي الذي يشرف على أجهزة الأمن جميعًا – ويتبع قيادة الحزب الحاكم: حزب البعث العربي الاشتراكي – ما عدا المخابرات العسكرية؛ إذ فرض استقلاليتها وزير الدفاع اللواء حافظ الأسد. وكانت أصداء الصراع بينه وبين القائد الحزبي صلاح جديد، تتردد من دمشق إلى الرقة، منذ السنة الماضية. أطبقت المخابرات العسكرية على الإذاعة والتليفزيون، وعلى جريدة الثورة التي هاجمت وزير الدفاع. واستقال رئيس الدولة نور الدين الأتاسي، وعاد إلى بيته في حمص حتى عقد الحزب مؤتمرًا استثنائيًّا، وعاد رئيسًا.
حاشية: سُجن صلاح جديد منذ 1970م حتى وفاته 1993م، وسجن نور الدين الأتاسي من 1970 حتى قبيل وفاته 1992م.
وهذا كتاب «حرب العصابات» الذي يعلمك كيف تهزم العدو الصهيوني، ألّفه المقدم مصطفى طلاس، القيادي المناصر لحافظ الأسد. وها هو القائد الحزبي في الرقة المحامي الفلسطيني أحمد الشيخ قاسم يهزّ الكتاب في وجهك ووجوه من جمعهم من مثقفي المدينة في مكتبه، ويهدر وإصبعه تخترق اسم المؤلف: «هذا ليس كاتبًا، هذا جاسوس». وفجأة، في منتصف ليلة ليلاء، تزفّ إذاعة دمشق خبر انتخاب الرفيقين المحامي والمقدم في القيادة القطرية للحزب، أي في قيادة البلاد، فتقفز من السرير مكذبًا أذنيك، وتنسى أنك عريس، وتنظر إلى العروس مكذبًا عينيك.
الزواج خيال. السياسة خيال. وأنت، ما أنت ومن أنت؟

فرناندو أرابال
بارقة المسرح
هنا أفتح قوسين للمسرح، فأسارع إلى ما كانت تنعم عليّ به المجلة المصرية «المسرح»، وهي التي كانت قبل سنة «المسرح والسينما». كانت تلك المجلة لا تقرّب القاهرة وحدها إلى عيني وقلبي، بل كانت تجعلني أجالس، بفضل ما كتب صلاح عبدالصبور عن العنف والجنس في مسرح أرابال، نعم أجالس أرابال، وأجالس وول سوينكا بفضل ترجمة فريدة النقاش لمسرحيته «الطريق»، وأجالس بريخت بفضل من كتب عن مفهوم التغريب عنده، وبفضل من ترجم «الخطايا السبع للبورجوازي الصغير»: لعن الله النسيان.
وهذه هي التغطية الصحفية لمهرجان المسرح العربي في دمشق، كما كتبها بهاء طاهر، ومنها ما خص به من وصفه بـ:«الكاتب الموهوب المسرحي الشاب»، وهو سعد الله ونوس الذي عُرضت له في المهرجان مسرحيتان: «بائع الدبس الفقير» بإخراج رفيق الصبان، و«الفيل يا ملك الزمان» بإخراج علاء الدين كوكش، وكنت قد طرت من الرقة إلى دمشق لأشاهد هذه المسرحية التي كتب بهاء طاهر أنها، وشقيقتها، أعنف وأصرح احتجاج ضد السلطة وضد الجماهير معًا.
أخيولات
في غرفة الضيوف الصغيرة انتصبت الرفوف أطول منك، في هيئة خزانة، وامتلأت بالكتب، تتصدرها هدية صديقات العروس لكما في عرسكما: كتاب إلياس مرقص «الماركسية والشرق».
في الرف الأعلى بجوار ذلك الكتاب الضخم الذي علّمك الكثير، أوقفتَ ما اجتمع لك من كتب إلياس مرقص: «الماركسية في عصرنا» و«نقد الفكر القومي عند ساطع الحصري»، وما زلت تزداد عُجبًا بالكاتب الشاب الذي لم تجرؤ على اللقاء به، مع أن اللاذقية لا تفتأ تجمعكما. وإذا كانت كتب إلياس مرقص تنفخ في روحك بالفكر النقدي ضد عبادة الفرد، فماذا فعل بك إذن كتاب صادق جلال العظم «نقد الفكر الديني»؟ وماذا فعلت بك هذه الكتب التي تتراصف رفًّا فوق رف/ تحت رفّ: سارتر: الأيدي القذرة، دروس الحرية، الحزن العميق، وقف التنفيذ، كامو: الطاعون، سيمون دي بوفوار: قوة الأشياء…؟
الكتب خيال، المكتبة خيال، الماركسية خيال، الوجودية خيال، وأنت؟
نجماتي
كانت هديتك الأولى للعروس هي فِلْم «رجل وامرأة» الذي ستعود إلى مشاهدته وحدك، لعلك ترتوي، ولن ترتوي، من الأغنية (A man and woman). بفضل مجلتي «الكوكب» و«المسرح والسينما» ثانيًا، وبفضل دور السينما في الرقة أولًا، تجدد وتعمق تولّهي بنجمات السينما الإيطالية، وكان هذا التَّوَلُّهُ بالنجمات عامة قد بدأ في اللاذقية ولكن بفاتن حمامة. ومع بقائها في سويداء القلب منذ رأيتها أول مرة عام 1958م في سينما المشبكة في طرطوس، في فِلْم «طريق الأمل»، ها هي الرقة تبرق بجينا لولوبريجيدا في قميص إزميرالدا، من الفِلْم القديم «أحدب نوتردام»، وبقميص أدريانا من الفِلْم الجديد «امرأة من روما». أما ما زاد الفتنة افتتانًا فهو أن إزميرالدا قادمة من رواية فيكتور هوغو، وأدريانا قادمة من رواية ألبرتو مورافيا الذي ستحضر صوفيا لورين من روايته «امرأتان» بقميص سيزيرا.
هكذا ستظل روايات وأفلامٌ ننفخ من روحها في هذا الذي يتحول، أسرع فأسرع، من كائن من لحم ودم إلى كائن من خيال، مرة مع مارغريت ميتشيل في «ذهب مع الريح»، أي مع فيفيان لي في قميص سكارليت أوهارا، ومرة مع ليو تولستوي في «آنّا كارنينا»، أي مع غريتا غاربو في قميص آنا، ومرة مع تينسي وليامز في مسرحية «قطة على سقف من صفيح ساخن» أي مع قطة هوليود المدللة إليزابيث تايلور التي ما كان لي أن أبرأ من سحرها منذ حلّت في قميص كليوباترا. وهذه ريتا هيوارث تطيشني في فِلْم سالومي حين حلت في قميص سالومي، ورقصت الرقصة التي جعلتني أجزم أنّ ما من راقصة مثل ريتا هيوارث. لكني تهت بين الحزن عليها والشماتة بها حين شتمت الشعب المصري في باريس، فضربتها تحية كاريوكا بالشبشب على المنصّة، ونتفت شعرها.
في هذا الخضم خوّضت أيضًا مع رواية ألبرتو مورافيا «الاحتقار» وفتنة بريجيت باردو، وبلعت خوفي من أن يأتي يوم يكون لي فيه من عروسي الاحتقار الذي رمت به إميلي زوجها في الرواية/ الفِلْم. وخوّضت في رواية فرانسواز ساغان «هل تحبين برامز» وفتنة إنجريد برغمان. وما أكثرَ ما نغص عليَّ الحسد والعُجْب، فهذه فرانسواز ساغان تشرع سيجارتها، ولا أذكر أني رأيت من قبل امرأة تدخّن إلا عمتي نجاح، وأين؟ في القرية (البودي)! أما الأهم فهو أن هذه الكاتبة التي تكبرني بعشرة أعوام فقط، كانت قد أطاشت الألباب وهي في التاسعة عشرة بروايتها «صباح الخير أيها الحزن»، ولا يفتأ السؤال يسوطني كلما طاب له: ها أنت في الرابعة والعشرين، فماذا كتبت؟

بعد ساغان، ها هو روسيلليني، لا يكفيه أنه مخرج وشاعر ورسام وصحافي ومسرحي، كما تقول مجلة «المسرح والسينما»، بل هو أيضًا زوج إنجريد برغمان التي بدأ افتتاني بها بفِلْم «روما مدينة مفتوحة».
بهذا الزواج، وبتعدد مواهبه، كان روسيلليني يلهب غيرتي، ويستفزّ وعودي للمستقبل القريب. ومثل ذلك أيضًا كان يفعل بي ما علمت من أن بازوليني مفكر ومخرج وروائي ورسام ومسرحي وصحافي، ولم أكن قد رأيت له فِلْمًا. من الروايات العالمية التي أنجبت أفلامًا عالمية، ما أنجبت أيضًا أفلامًا عربية. ومن هذه ما كنت قد شاهدت الأجنبي من قبل، والعربي في الرقة 1969م. ولا أذكر أنني صادفت الحالتين معًا. وما أكثرَ ما ترجّحت بين السخط والإعجاب للمآل السينمائي العربي لرواية ما، كما في فِلْم «نهر الحب» المأخوذ من رواية «آنّا كارنينا»، على الرغم من تولّهي بفاتن حمامة، أو كما في فِلْم «الجريمة والعقاب» المأخوذ من رواية دوستويفسكي الشهيرة، على الرغم من تولّهي بماجدة منذ فِلْمها عن جميلة بوحيرد والثورة الجزائرية. وأظن أنه كان من النادر أنْ تفرّد الإعجاب بفِلْم من هذه الأرومة، كما في فِلْم «شهداء الغرام» المأخوذ من «روميو وجولييت»، ومن يسأل عن هذا الميل بالهوى، أشير عليه بأغنية ما لليلى مراد في هذا الفِلْم: يكفي بكا يا دموع العين. أو مين اللي يعطف على حالي.
نجومي
كيلا يبدو أن السينما كانت لي فقط روايةً ونجمة، ثمة أفلام لن أنساها لنجومٍ لن أنساهم، مثل: «أبي فوق الشجرة» وعبدالحليم حافظ الذي سميت باسمه شقيقًا لي سنة 1960م، وفِلْم «انتصار الشباب» للشقيقين أسمهان وفريد الأطرش، أو فِلْم «الزوجة الثانية» – من ينسى سعاد حسني؟ أو فِلْم «لورنس العرب»، وبالأخير أبدأ بالسلام على نجومي: عمر الشريف الذي شقّ له هذا الفِلْم دروب العالمية، أنطوني كوين، كلارك غيبل، غريغوري بيك.. أما الحسرة التي ستلازمني طويلًا فكانت على فِلْم «تشي» الذي قرأت أنه أُنجز للتو، وقام فيه عمر الشريف بدور تشي غيفارا، وكنت قد علّقت في زاوية مكتبي صورة صغيرة ملونة له، قصصتها من مجلة «آخر ساعة» من بين صور الشباب في مظاهرات السنة الماضية. وليس يخفى في تلك الذكريات جهلي بما يعنيه الإخراج أو السيناريو، على الرغم من أن اسم المخرج والسيناريست يظهران دومًا في أفيشات وفي تاترات الفِلْم.
أخيولات
من العازب إلى الزوج إلى الأب الذي ستكونه عما قريب، إلى الحكم بالإعدام على صلاح البيطار، تنطوي 1969م. قبل ست سنوات حملت شهادتيك الثانوية الصناعية والثانوية العامة (الفرع العلمي) وطرت إلى دمشق طمعًا بوظيفة. كان المحكوم عليه بالإعدام رئيسًا لمجلس الوزراء، فطرقتَ بابه، لكن الباب ظل مغلقًا حتى نصحك البواب مشفقًا عليك: اذهب إلى بيته بعد صلاة العشاء، وأرشدك إلى البيت القريب. لكن الشرطي الوحيد الذي يحرس الباب نصحك، مشفقًا عليك، بالعودة إلى اللاذقية، فالمحكوم عليه بالإعدام سافر إلى باريس.
الآن أنت تعلم أنه درس الفيزياء في باريس، وفيها التقى ميشيل عفلق. ولما عادا عملا مدرسَيْن كما تعمل الآن، ثم خطفتهما السياسة. وها هو الحزب الذي أسساه وحكم البلاد منذ ست سنوات ينفيهما، ثم يحكم على صلاح البيطار بالإعدام. ولأن الحكم غيابي، سيؤجَّل التنفيذ إلى أن يجري اغتياله في (21/7/1980م).
ختامًا
هذه رواية تنسيك فجأة السينما، والقراءة، والعروس التي تركتها تعد وحدها ما تبقى على ولادتها من أيام أو أسابيع. وكما يسرع إليك اسم ابنتك القادمة: مائسة –ادع كيلا تكون ذكرًا– يسرع إليك عنوان روايتك الأولى القادمة: ينداح الطوفان.
مائسة خيال، ينداح الطوفان خيال، وأنت كائن من خيال في عالم من خيال.

بواسطة نبيل سليمان - ناقد و روائي سوري | سبتمبر 1, 2020 | يوميات
(1)
تتوقف السيارة عند الحاجز، وتحيي العسكري. لستُ من أوقفها، ولا من حيّا بكفه متمنيًا أن يكتفي العسكري بذلك. بالأحرى لست من رشاه بالتحية كيلا يطلب البطاقة الشخصية، فيكون عليّ أن أنقّب عنها في جيب البنطال الخلفي، حيث تعودتُ أن أودعها منذ أن تمكّن مني الرعب من أن أضيعها، ليس فقط لأن الحاجز لن يسمح بالمرور من دون بطاقة، بل لأنك ستغدو مشبوهًا، بل متآمرًا، بل مطلوبًا لواحد من فروع الأمن على الأقل. ولن يعبأ العسكري عندئذٍ بأنك في الخامسة والسبعين، ولا بأن لك عشرين رواية أو أكثر منها في النقد وفي الشأن العام. لن يعبأ بتوسلاتك هذا الشاب المدججُ بثيابه المبرقعة وذقنه الشعثاء الفاحمة والكلاشينكوف.
إنه عيشك السوري الرغيد المديد.
(2)
في مثل هذا الضحى، وربما في مثل هذا اليوم الصيفي، ولكن قبل أربعين سنة، عندما كانت سوريا تتزلزل أيضًا مثلها منذ تسع سنوات، انحشرتَ بين ركاب التاكسي الذي يطير من اللاذقية: حلب قصدنا وأنت السبيل. وعلى كل حاجز تبرز بطاقتك الشخصية غير هيّاب ولا وجل. وبأسرع من التاكسي أنجزتَ ما قصدت حلب من أجله. وقبل أن تودع الصحب في دار الحضارة، تتفقد البطاقة السحرية، ويصعقك ما تكتشف، فهذه بطاقة زوجتك، وأنت لا تحمل إذن بطاقتك، والحمد لله أنْ ضرب على أبصار الحواجز، ولكن ماذا لو أن عينًا واحدة فقط تنبهت في طريق العودة إلى جريمتك؟
(3)
عبر خمسةٍ وأربعين كيلو مترًا بين اللاذقية -حيث مقامي منذ 1978م- والبودي (القرية) -حيث مقامي أيضًا منذ 1989م- هو ذا الحاجز الوحيد، فلماذا تخشى إذن أن يظهر لك من يستوقفك، ثم ينتر البطاقة اللعينة من أصابعك، ثم ينقّل نظراته المستريبة بين وجهك وبين الصورة الهلوعة في البطاقة، بينما يزيّفُ خفقُ قلبك ابتسامتك البلهاء؟
فجأة يهجم الرجل الذي ليس بشاب وليس بكهل على السيارة. وقبل أن تعود البطاقة إلى حضنها الدافئ في قفا البنطال، يكون هذا العسكري الغاضب المدجج بثيابه المبرقعة وذقنه الشعثاء الفاحمة والكلاشينكوف، قد نكش حقيبتك على المقعد الخلفي، وقلّب في كتبك وأوراقك، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه: ها هي السيارة الهلوعة قد أفلتت من الحاجز، وطارت حتى بلغت مدخل القرية، وانحنت أمام الصورة الكبرى التي تتوسط صدر معمل السجاد اليدوي. ها هي السيارة تئنّ تحت الصور الصغيرة والكبيرة، الحائلة والطازجة، لشبابٍ قضوا من سنة إلى سنة طوال تسع سنوات، فزفّهم الرصاص والأغاني والزغاريد ملء النهارات والليالي، فأنّى لك أن تكتب؟ وماذا ينفع أن تفر من الكتابة إلى القراءة؟ ماذا ينفع أن تفر من القراءة إلى التلفزيون الذي سينهال عليك بانفجار، أو اغتيال، أو قصف، أو براميل متفجرة، أو بشحنات التعفيش، أو بهياج المراسلين وسعار المذيعات، وضاع/ انطوى، يضيع/ ينطوي نصف النهار.
إنه عيشك السوري الرغيد.

(4)
لا، لن أضيّع الكثير المتبقي من هذا اليوم (الثلاثاء الرابع من آب/ أغسطس 2020م) على الرغم من أنه بدا بلا صباح.
أجل، يومٌ هو بلا صباح، وإن تكن قد نهضتَ في السابعة، وخرجتَ قبل الثامنة إلى ساعة المشي، متحاشيًا كعادتك أن تنظر إلى أول ما يصادفك على الأوتوستراد: صرحان، أي عمارتان، ما عاد يطردك من العبور بهما على مرمى خمسين مترًا حراسٌ، ولا سيارتٌ فارهة أو مموهة أو مدججة بما لم ترَ حتى في أفلام حروب الخيال العلمي. ويبهج خطواتك في سرها أن أهل الصرحين- العمارتين، جَدًّا فأبناءً فأحفادًا، قد تفرقوا بين ميتٍ بالسرطان وميتٍ اغتيالًا وطالبٍ للنجاة في حصنٍ من حصون العاصمة أو من
غياهب بيروت.
 الآن، وعيناك تسبقانك إلى البحر القريب البعيد، لكَ أن تفكر بالرواية التي تراودها منذ أكثر من سنة ونصف، حين ملصتْ «تاريخ العيون المطفأة» من بين أصابعكَ إلى شوقي العنيزي ودار مسكلياني. لكنه يوم بلا صباح، لذا لن تبلغ خطواتكَ البحر البعيد القريب، فهذا حاجزٌ طيارٌ يباغت مبكرًا على غير عادته في المباغتة بعد أن ينتصف الليل، وليس هنا في مدخل ساحة اليمن ومحطة القطار، بل هناك في قلب المدينة في ساحة الشيخ ضاهر، أو هنالك في ذيل المدينة في مدخل الرمل الفلسطيني. والآن إذن، عليك أن تستدير هاربًا، فبذلتك الرياضية لا تتسع للبطاقة الشخصية، وحسبك أن تتلوى في الشوارع الفرعية بحثًا عن
الآن، وعيناك تسبقانك إلى البحر القريب البعيد، لكَ أن تفكر بالرواية التي تراودها منذ أكثر من سنة ونصف، حين ملصتْ «تاريخ العيون المطفأة» من بين أصابعكَ إلى شوقي العنيزي ودار مسكلياني. لكنه يوم بلا صباح، لذا لن تبلغ خطواتكَ البحر البعيد القريب، فهذا حاجزٌ طيارٌ يباغت مبكرًا على غير عادته في المباغتة بعد أن ينتصف الليل، وليس هنا في مدخل ساحة اليمن ومحطة القطار، بل هناك في قلب المدينة في ساحة الشيخ ضاهر، أو هنالك في ذيل المدينة في مدخل الرمل الفلسطيني. والآن إذن، عليك أن تستدير هاربًا، فبذلتك الرياضية لا تتسع للبطاقة الشخصية، وحسبك أن تتلوى في الشوارع الفرعية بحثًا عن
الصباح الفقيد.
بعد دهر يتطاول حتى العاشرة، ستكون قد أكملتَ طقوسك الصباحية، وصرتَ جاهزًا للعمل. لكنك بدلًا من أن تبدأ بالكتابة، ستهرب، أي ستميل بك عادتك الجديدة منذ قرابة سنة ونصف، فتنط على الشاشة الزرقاء بين مانشيتات ونتف من مقالات وأخبار جرائد الصباح الفقيد. وفجأة تكتشف أن ساعة بطولها قد ضاعت، وأن عزمك على الكتابة مشوّش، وهذا المكتب في هذا البيت في اللاذقية يضيق بك، فتحشو في الحقيبة الملفَّ الذي يكبر كل يوم منذ سنوات -وبخاصة منذ ملصت من أصابعك «تاريخ العيون المطفأة»- مقدار قصاصة أو صفحة أو كتاب، وتَعِدُ/ تتوعد الكتابة على مرمى خمسة وأربعين كيلو مترًا، في هذا المكتب، في هذا البيت، في البودي. وها هي الرواية «تفلش» الملفَّ أمامك، والملف يتقلّب بشوق إلى بياض صفحة وليس إلى زرقة شاشة، يحرضك ويغويك ويتحداك، فتحرن أصابعك مثلما تحرن روحك، فبأي أفنونٍ من الأفانين سيكون هربك الآن؟
(5)
أن تبكر في الغداء، فهذا أفنون، وأن تطيله، وتتجرع معه وبعده الجرعة السميّة التلفزيونية اليومية من أخبار وتقارير وتحليلات، فهذا أفنون آخر، سيعقبه آخر من القيلولة التي يزيدها الهرب من الرواية قداسة.
لكن الرواية ستتسلل إلى غفوتك، وستهمي عليك بصور من سبقوك إلى رواية أو قصيدة أو أية كتابة عن الحمير، فتتوه بين حمير فولتير، وإميل حبيبي، وعباس محمود العقاد، ويحيى حقي، وأبي منصور الثعالبي، وبريجيت باردو، ولوقيانوس السميساطي، وأحمد فؤاد نجم، وعتيق رحيمي، وغازي القصيبي، ومحمود درويش، وإبراهيم المازني، ومحمود السعدني، وغونتر ديبرون، وتوفيق الحكيم، وخوان رامون خيمينيز، وأحمد شوقي، وحسن أوريد، وواسيني الأعرج، ومصطفى صادق الرافعي، ومجيد طوبيا، ومحمود شقير، ووجدي الأهدل، وأوغست رودان، وجميل السلحوت، وعزيز نيسين، وابن المقفع، وإبراهيم الفرغلي، و… وتختفي الرواية، فتنتفض من غفوتك وأنت تجأر: لماذا نسيت لوكيوس أبوليوس؟ ولأن سؤالك يظل بلا جواب، تنهض وملء عينيك الجحش الذهبي الذي كتب أبوليوس تحولاته في رواية ما برحتَ تأتمّ بها منذ أهداك علي فهمي خشيم نسخة من ترجمته لها، في تونس قبل ثمانية وعشرين صيفًا مثل هذا الصيف الخانق في تونس أو في اللاذقية، ولكن ليس كما في طراوة العصاري الجبلية التي تخفق من البودي إلى البحر بأخيلةٍ تنشد من يكتبها، فتهتف: أنا لها…
(6)
بدلًا من أن تشرع في الكتابة، تهرب إلى آخر ما يخبئ الملفّ الضخم، وجعلتَ عنوانه: «حمار حمزة شحاتة». من جديد تُكْبر في هذا الكاتب السعودي أنه سبق توفيق الحكيم إلى الكتابة عن الحمار، وتبرق عيناك بما كتب: «وفي الحمار خفة، وفي حركاته حلاوة، ونظراته لا تخلو من معانٍ تفيض منها العذوبة، وفيها أناقة ووجاهة يفوقان كثيرًا من الآدميين، وله ابتسامة محجوبة يدركها ويدرك موضع السحر والفتنة فيها كل من يعنيه من أمر الحمير ما عنانا».

علوية صبح
في أعداد من جريدة صوت الحجاز سنة 1936م نشر حمزة شحاتة عددًا من المقالات تحت عنوان «حنفشعيات»، والكلمة تقال لمن يخلط بين المتناقضات. وقد تنكّر الكاتب بما وقّع به مقالاته: هول الليل، فأكبر في الحمار ديمقراطيته التي تصرفه عن الخيلاء، وشدد على أنه أكثر الحيوانات شبهًا بالإنسان. وبلغ حمزة شحاتة أن كتب «… حتى تصورتُني حمارًا أرعى وأعيش في هذا الجانب من الأرض عيشًا خفيضًا».
كنتُ قد قرأت هذه المقتطفات مستحسنًا مرة بعد مرة، لكنني أجفلت هذه المرة، وأسرعتُ إلى الشرفة بينما كانت تخترق السمع والسماء طائرة روسية عائدة من القصف أو ذاهبة إليه، ولكن أين تراها قصفت؟ وأين ستقصف؟
أعادني السؤال إلى محاولة الكتابة، ورأيتني ملهوفًا حقًّا، وعازمًا حقًّا، فهل أبدأ بحزب الحمير المغربي، أم بحزب الحمار في السليمانية من كردستان العراق؟ لماذا لا أتجاوز الأحزاب في الكتابة كما تجاوزتها في الحياة، وأكتب عن مهرجان الحمير في زرهون المغربية أو في كولومبيا؟ ولكن لماذا أذهب بعيدًا، فلا أكتب عن الحمار السوري أو عن حمير القامشلي أو حمير عامودة من سوريا رقم 2 أو رقم…
ما همّ الترتيب، ما دامت سوريتك قد غدت سوريات بجمع المذكر السالم -وعلامة ذكورته وسلامته تاء التأنيث المبسوطة- فها أنت قد عشت حتى صارت سوريا التي تعيش أنت والروسي والإيراني فيها رقم 1 مثلًا، وسوريا التي تحتلها تركيا رقم 3 مثلًا، وسوريا رقم 2 مثلًا هي هذه التي يتناهبها الأميركان والإدارة الكردية والشركة الروسية التركية الإيرانية المساهمة المغفلة، وقد كانت حتى البارحة دولة داعش منذ كانت (باقية وتتمدد) إلى أن صارت (فانية وتتبدد). ولك أن تتأسّى بما كانت عليه سوريتك قبل مئة سنة وحربٍ عالمية، حين شققوها فتشققتْ إلى لبنان والأردن وفلسطين، وتركوا لك هذه السوريا التي لهطت تركيا منها لواء إسكندرون، ويزعزعك الخوف الآن من أن تلهط إدلب وعفرين قبل أن يكحّل الموت عينيك.
(7)
يحرن القلم، تحرن الورقة، تغمض عينيك، بالأحرى تعصرهما مستجديًا كلمة، صورة، أخيولة، فتحرن ظلمة عينيك، ويهتف بك هاتف: أيتها الرواية الحرون، فيرجّع الصدى: قل أيتها الكتابة الحرون، وتكرر العبارة المرّة، فتداهمك الأصداء: حتى ألف كلمة لمقالة صارت حرونًا!
ما بقي لك إذن إلا الهرب، ولكن إلى أين؟ البحر من ورائك والعدو من أمامك.
لا لا.

فواز طرابلسي
البحر من ورائك والحبيبة من أمامك. وليس لك والله إلا الصدق والصبر. واعلم أنك في هذه الرواية أَضْيَعُ من الأيتام في مآدب اللئام. واعلم أنك إن صبرتَ على الأسف قليلًا، استمتعت بالأَرَفَة الألذ طويلًا، وقد بلغك ما أنشأت الرواياتُ من الحور الحسان، الرافلات في الدرّ والمرجان والحلل المنسوجة بالعقيان، فاهتف: أنا لها، واهرب متدرعًا هذه المرة بحكمة ماركيز عندما شبّه الرواية بالمرأة: إذا ما تمنّعتْ فلا ترقْ ماء وجهك، لا تتذللْ ولا تغتصبْ، بل دعها حتى ترضى.
حسنًا، إذن أنا لها.
(8)
لكنك لست لها، لذلك تراك لا تغادر الشرفة بانتظار أن تغطس الشمس في البحر. غير أن هذا اليوم يبدو بلا مساء، فتلحّفْ بالعتمة وعدْ إلى المكتب، لملمْ ما فلشتَ عليه، وتظاهرْ بالأسف لأن أفنونًا جديدًا للهرب يذكرك بسهرة الليلة مع من تبقى من مجموعة الثلاثاء، وسهرة اليوم في مدينة جبلة التي تنصّف الطريق بينك وبين اللاذقية.
هو حقًّا يومٌ بلا مساء.
منذ مطلع القرن الحادي والعشرين -يا لفخامة القول!- كانت المجموعة التي تلتقي كل ثلاثاء، وعُرفتْ بالثلاثائيين، بعدد أصابع اليد. وبعد أن صار العدد ثلاثين بدهر، حلّ صيف 2011م، فشقّ الخلافُ المجموعةَ على الإصلاح والتغيير والانتفاضة والسلمية والعسكرة والأسلمة مما سيتعنْوَن بالثورة، وسأُعَنْونه بالزلزال. ومن سنة إلى سنة مات من مات، وهاجر من هاجر، إلى أن عادت المجموعة إلى عدد أصابع اليد، لكن كل واحدة من الأصابع الخمس تضاعفت بانضمام الزوجات.
هكذا، وعلى إيقاع البدد الذي أودى بالزلزال أو الثورة، باتت الثلاثائية لقاءً أُسَريًّا، كأنها لم تكن يومًا ظاهرة فريدة في سوريا، تمور بالثقافة والسياسة والصداقة قبل أن تستبد بها السياسة فيبدأ الضمور.
والآن تقودك السيارة إلى كورنيش جبلة حيث تتهادى الأسراب كما في يومٍ بلا مساء، فأين هي الكورونا إذن؟

رفيف صيداوي
تُخرس الطائرةُ السؤالَ وهي تخترق السمع والسماء، وأقرب إليك من حبل الوريد، ليس كما كانت للتو في كبد سماء البودي، فمطار حميميم على مرمى حجر من هذا الكورنيش، وما عاد الكورنيش يترنق بمشاوير الناس المسائية، وما عاد نومهم يهنأ إذا لم تخترق الطائرة السمع والسماء.
على إيقاع الطائرة العائدة من القصف أو الذاهبة إليه تبدأ سهرة الثلاثاء في بيت يتوسط البساتين في سوار المدينة. وفجأة يرمينا موبايل أحدنا بالنبأ العظيم: انفجار في بيروت كأنه قنبلة نووية.
(9)
قبل أن يطوي التلفزيون والموبايل والإنترنت هذا اليوم الذي بلا صباح ولا مساء، بلا ليل ولا نهار، بلا يقظة ولا نوم، بلا حياة ولا موت، ستكون قد أرسلت رسالة صوتية أو مكتوبة إلى بيروت فواز الطرابلسي، بيروت إلياس خوري، بيروت عبده وازن، وجمانة حداد، ويسرى المقدم، وحسن داود، ومنى فياض، ونجوى بركات، ومنى سكرية، وأحمد فرحات، و… ولا تصدق أن أرقام عباس بيضون، ورشيد الضعيف، وسماح إدريس قد اختفت من هذا الموبايل الذي تدفقت رسائله: فواز الطرابلسي يكتب: سالمون في مدينة منكوبة، جمانة حداد تكتب: آه من هذه البلاد المقرفة، علوية صبح تنشج رسالتها الصوتية الذبيحة، وكلمة (زمطنا) توحّد بين رسائل رفيف صيداوي وجهاد الزين ومنى سكرية. ويأتي شرح (زمطنا) لمن لا يعلم، في رسالة حسن داود: نجونا هذه المرة أيضًا. ولكي لا ينطوي/ يضيع هذا اليوم تلحق بمن سبقوك وسبقنك إلى بيروتشيما. ولأنك في عيشك السوري الرغيد، لن تلحق بهم، وحسبك أن تتفجر حناياك بالنداء: سوريتشيما، حلبشيما، عفرينشيما، عراقشيما، يمنشيما، ليبياشيما، فلسطينشيما، عربشيما، ولأن النداء يذهب بددًا، رددْ مع من قال:
«لقد أسمعت لو ناديت حيًّا ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو نارٌ نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد»،
أما الرواية فدعها لأفانين الهرب.
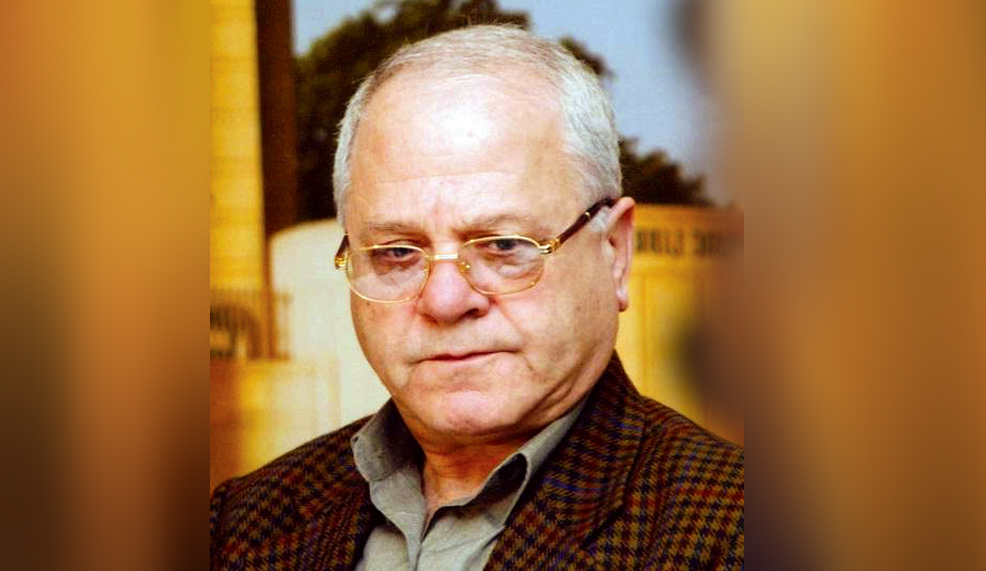
بواسطة نبيل سليمان - ناقد و روائي سوري | مايو 1, 2018 | مقالات
في السنوات الخمس الماضية من عمر الزلزال السوري الذي تفجر سنة 2011م، تواتر حضور الأصوات الجديدة في الشعر والرواية، ومنها ما نيّف على الأربعين؛ إذ لم يكن الظهور لأول مرة حكرًا على شباب العقد الثاني أو الثالث. وقد توزعت تلك الأصوات، كسواها، بين لاجئ أو منفي أو مهاجر، وبين مقيم أو نازح، أي بين الداخل والخارج. وهنا تأتي فيما أظن الإشارة المهمة إلى أصوات الداخل، الجديدة أو المخضرمة التي تتوحد في مثل هذا المقام مع أصوات الخارج في التعبير الحر والنقدي عن كل ما يعنيه الزلزال، ابتداءً من الحراك السلمي ضد الطغيان إلى العصف المدمر الذي لم يوفّر حجرًا ولا بشرًا، واستوت فيه البراميل المتفجرة مع الاحتلالات والتشققات جميعًا. ولأنه لا بد من الاختيار، فقد اخترت الروايتين التاليتين، وكل منهما هي الأولى لصاحبها:
«حقول الذرة» لسومر شحادة: فازت هذه الرواية لسومر شحادة بالمركز الأول في جائزة الطيب صالح في دورتها السادسة. وعلى الرغم من أن الرواية لا تسمّي فضاءها بمقتضى إستراتيجية اللاتعيين، فإن في منتهاها ما يكفي من الإشارات إلى اللاذقية وريفها. وعبر جمهرة من الشخصيات الشبابية، ترسم الرواية لوحات للزلزال منذ بدايته في المظاهرات السلمية، إلى قمعها، إلى العنف المتأسلم. ومن الكثير الذي تثبته ألسنة ملهم أو لمى أو موفق أو عدي أو هاني… أن المدينة باتت سجنًا كبيرًا، تقطعها الحواجز وانهيار الثقة بين الناس، وبين أركان السلطة، وبينها وبين الناس. فهذه لمى التي تعمل في الإغاثة ترى أن السلطة سوقت للإجرام كي تسيء إلى قيم الثورة، لكن ذلك لا ينفي الإجرام عن الثوار، لكأن المطلوب إعادة الدولة إلى الصفر، وإعادة المجتمع إلى ما قبل نشوئها، أو تسليم البلد للمنتصر وهي (على العظم) وهذا ملهم الذي يكتب رواية الزلزلة كما يحياها، يخالف أقرانه الشباب؛ إذ يرى أن المشكلة ليست مع شخص الرئيس، بل مع (شخصيته). وإذا كان الأقران يرون أن إسقاطه سيحل مشاكل الفقر والفساد ومصادرة الرأي، فملهم يرى أن إسقاطه دون إسقاط كامل المنظومة التي يمثلها ستعيد المجتمع إلى حلقة أكثر شناعة. وفي موقع آخر يتساءل ملهم عن أيقونة الدولة الفاشلة التي شققت أهلها الانتماءاتُ المختلفة. وعن الطائفية يذهب ملهم إلى أن الطوائف هي دم الطغاة الفاسد، ولا يفرق بين المقاتلين المتأسلمين ومن ينادون بعبارات عصرية بتسليحهم من بقايا اليسار أو بقايا من المنافي أو في سجون السلطة.
حراس الثورة وحراس السلطة
كما يرى ملهم أن هناك ما يحاك (ضدنا جميعًا)؛ إذ يتلاقى حراس الثورة مع حراس السلطة بتلقائية. ومما تحفل به الرواية من (التنظير) ما تذهب إليه من أن الحياة مع الاستبداد ممكنة، ولكن بوجود الحب. ومن ثم فـ(هم) أي رجال السلطة، يعلمون ما يفعلون؛ إذ يطلقون الحريات الشخصية مع انعدام شبه كامل للحريات العامة، ويطلقون حريات المحافظين في تغييرهم لسلوكيات المجتمع. ومن هذا التنظير في الدفتر الرابع «الحرائق» من الرواية المبنية كدفاتر، ما يبثه ملهم بعد مصرع صديقه موفق، وبعد انغماسه في الحرب بمقاتلة أهله سعيًا إلى جعلهم يفكرون بمصير مختلف. وهكذا انضم إلى من يصفهم بالمتمردين الذين أرهبوا قرى الريف بفهمهم البدائي للدين، وعدَّ نفسه المخلص الذي سيجمع الجميع. فملهم يرى أن الحرب تحتاج إلى كم هائل من اللاعقلانية، وأن أول استكانة لإرادة القطيع تعني وداع الحرية الذاتية. وقد قرأت لمى في أوراقه التي عثرت عليها أن العاقل (الآن) هو من يتمسك بالسلطة.
«موسم سقوط الفراشات»: هذا صوت (نور) الكسير الناعم كرموش عينيها الصغيرتين/ ينسحب الصوت على رؤوس أصابعه ليغطي العاشق نزار، كي لا يبرد/ هو صوت يسيل مبحوحًا كماء وعسل/ هو صوت حافٍ يلهث والرصاص يلاحقه…
بمثل هذه الصور المتفردة والشفيفة، تزدان رواية «موسم سقوط الفراشات» لعتاب عدي شبيب. ولكيلا توهمنا الصور بالرومانسية، تصفعنا الرواية لنصحو على السفينة المثقوبة المسماة وطنًا، وعلى وطن كل من فيه مريض، وكل من فيه يفر من ناره بطريقة مختلفة. هكذا تبدو مدينة حمص – فضاء الرواية – امرأة ماتت بالذبحة القلبية، منذ مستهل الرواية، لتمطر رصاصًا في نهايتها، وتحترق في حفلة حقد وهزيمة. وهي الحرب إذن التي جعلت الوطن في بؤرته حمص، على ما تقول هذه الرواية، كما ستقول: إن الحرب حولت الوطن إلى موسم واحد تتشابه به طقوسنا في سقوطنا. ومنذ ذلك اليوم الحمصي من شهر إبريل 2011م – الإشارة إلى الاعتصام السلمي الشهير في ساحة الساعة – «لم نكن سوى فراشات»، وكل من سقط كان طوباويًّا حد الهوس،… وما أكثر وأوجع حكايات الحرب.
بالحكاية نهضت هذه الرواية، فبعد مهاد قصير يعلن نزار أنه سيكون الحكواتي، وستبذّه نور التي تقلب البداية المألوفة للحكاية «كان ياما كان» لتجعلها الخاتمة. ونور تحسن الحكي كجدة عجوز، وتجزم بأنه لا يمكن إلا للمرأة أن تحكي الحكايات. أما نزار فإنه يسجل الحكايات ليكتب الرواية، وهو من كتب قبل الحرب مسرحيات لأطفال التوحد، وعمل مدرسًا لهم. ولسوف يتولى الحكاية هذا الذي يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية، منذ الفصل الذي حمل اسم أحد أحياء حمص: «باب السباع»، فيحكي حكاية العجوز المقيم في هذا الحي (السني)، الذي يمضي إلى صديقه أبي سليمان في حي عكرمة (العلوي) حاملًا طاولة النرد، ليلعبا وليغلب صاحبه. وقد ألف الحاجز العسكري مروره بسيارته العتيقة، حتى إذا جاءت بالسيارة امرأة، فوجئ الضابط، وكان جواب المرأة أن أباها أصيب باكتئاب جراء الحرب، وتعذرت مغادرته البيت، وأوصى بطاولة النرد لصديقه.
زمن الحرب والتعفيش
في فصل «لولو» تتولى نور حكاية الفتاة لولو التي كان صبي النجار يملأ الجدران باسمها، حتى إذا اختفى أخذت كتابات لا تشبه الحب تحتل الجدران، كإبر لئيمة في العيون، تشتم النظام وتهدد سكان الحي من طائفة الفتاة العلوية. وفي الحكاية أن الصبي اختفى لأنه ينام النهار بطوله، كيلا يرى لولو، في حين يخرج ليلًا في المظاهرات. لكنه سيكتب «سامحيني» وقد علمت في أيام القطيعة أنها صارت عدوته كما شاء جنون الوطن. من شخصيات الرواية المرسومة بفرادة: بشارة النحات الذي يصمم المناظر لمسرحيات نزار. لقد بات حلم بشارة في زمن الحرب والتعفيش (أي نهب الغنائم من حيث أمكن) أن يشتري كل كتاب منهوب، وكل ثوب وكل خزانة، ليعيدها إلى مالكها الحقيقي. وبعد موت بشارة يؤلف صديقه نزار حكاية عن موت رجل واحد، بعدما أصغى لألف حكاية، وهو ينتظر الحكاية الواحدة بعد الألف لتكون هي الحقيقة. وكان بشارة قد اختفى أيامًا، ثم عُثِر عليه موسومًا بالتعذيب، واتهم الأمن المعارضة بقتله، في حين اتهمت المعارضة الأمن، وعلى صفحة الشهيد النحات بات كل ما يكتب عليها موسومًا بالطائفية.
تؤكد الجملة الأخيرة في الرواية أنْ لا نهاية للحكاية. ولكن في هذه النهاية المفتوحة، وبعد أن يعود نزار عن عزمه على الهجرة، يتّقد مشهد حمص القديمة إبان استسلام المسلحين وخروجهم منها بالباصات سنة 2013م، بعدما أضرموا النار عشية التسوية في البيوت والسيارات، وفاحت رائحة شواء مرعبة، وأعقبهم اللصوص، ثم الفضوليون، ثم طائفة غريبة من الممسوسين بالشوق، وهذا ما يتصادى مع ما آلت إليه شخصية أخرى بالغة التفرد، هي شخصية جاد المثلي والموسيقي الذي بدا في النهاية / اللانهاية حرًّا من الخوف، ولسان حاله: لقد انتهينا وهزمنا، فما في هذه الحرب من منتصر، وإنها لحرية الهزيمة.
أليس هذا هو نبض روايتي عتاب شبيب وسومر شحادة، كما هو نبض أغلب روايات الزلزال؟












 الآن، وعيناك تسبقانك إلى البحر القريب البعيد، لكَ أن تفكر بالرواية التي تراودها منذ أكثر من سنة ونصف، حين ملصتْ «تاريخ العيون المطفأة» من بين أصابعكَ إلى شوقي العنيزي ودار مسكلياني. لكنه يوم بلا صباح، لذا لن تبلغ خطواتكَ البحر البعيد القريب، فهذا حاجزٌ طيارٌ يباغت مبكرًا على غير عادته في المباغتة بعد أن ينتصف الليل، وليس هنا في مدخل ساحة اليمن ومحطة القطار، بل هناك في قلب المدينة في ساحة الشيخ ضاهر، أو هنالك في ذيل المدينة في مدخل الرمل الفلسطيني. والآن إذن، عليك أن تستدير هاربًا، فبذلتك الرياضية لا تتسع للبطاقة الشخصية، وحسبك أن تتلوى في الشوارع الفرعية بحثًا عن
الآن، وعيناك تسبقانك إلى البحر القريب البعيد، لكَ أن تفكر بالرواية التي تراودها منذ أكثر من سنة ونصف، حين ملصتْ «تاريخ العيون المطفأة» من بين أصابعكَ إلى شوقي العنيزي ودار مسكلياني. لكنه يوم بلا صباح، لذا لن تبلغ خطواتكَ البحر البعيد القريب، فهذا حاجزٌ طيارٌ يباغت مبكرًا على غير عادته في المباغتة بعد أن ينتصف الليل، وليس هنا في مدخل ساحة اليمن ومحطة القطار، بل هناك في قلب المدينة في ساحة الشيخ ضاهر، أو هنالك في ذيل المدينة في مدخل الرمل الفلسطيني. والآن إذن، عليك أن تستدير هاربًا، فبذلتك الرياضية لا تتسع للبطاقة الشخصية، وحسبك أن تتلوى في الشوارع الفرعية بحثًا عن