
بواسطة حاوره حسن الوزاني - كاتب مغربي | سبتمبر 1, 2022 | حوار
تُعَدّ تجربة لوان ستاروفا الشعرية والروائية معْبرًا ضروريًّا لقراءة مسارات الأدب المقدوني الحديث. في فضائها تلتقي آثارُ أصوله الألبانية وذكرى دولة كانت تسمى يوغوسلافيا وصوتُ بلد حديث من مفارقاته أنه ذُكر في الإنجيل.
ولد لوان ستاروفا سنة 1941م في ألبانيا. انتقل رفقة عائلته المسلمة إلى مقدونيا حيث يعيش منذ سنة 1945م. عمل سفيرًا ليوغوسلافيا لدى منظمة التحرير الفلسطينية بتونس، ثم سفيرًا لمقدونيا في باريس بفرنسا. مارس تدريس الأدب الفرنسي بجامعة سكوبجي بمقدونيا، وعُرف بثلاثيته الروائية التي تدون لمأساة شعوب منطقة البلقان، وقد ترجمت إلى لغات عدة. وهي تضم «كتُب والدي»، و«زمن الماعز»، و«متحف الإلحاد». له أعمال سردية أخرى، من بينها: «حدود الربيع»، و«العصفور الأسطوري»، و«المفتاح البلقاني»، و«الأرض المجتثة». وإلى جانب حضوره على مستوى الكتابة الروائية، استطاع لوان ستاروفا أن ينسج لنفسه فضاءه الشعري الخاص.
صدرت الترجمة الفرنسية لمجموعته «قصائد قرطاج» بكندا بعد أن ظهرت باللغتين المقدونية والألبانية. وقد حفل الإصدار الأخير بمقدمة عميقة للشاعر العربي أدونيس.
ظلال الأيديولوجيا والتاريخ
● مقدونيا بلد جديد على الرغم من أن اسمها ورد في الإنجيل. كيف تتمثل هذه المفارقة؟
 ■ بالفعل. مقدونيا هو اسم بلد عريق يوجد منذ قرون. وقد ورثَ الشعب السلافي، الذي حل في هذا البلد، كثيرًا من علاماته الثقافية، وانطفأتْ أخرى مع توالي السنين. وتُمثل مقدونيا الآن الجزء العاشر من يوغوسلافيا السابقة، وقد ارتبط ظهورُها من جديد بالانفجار الذي عرفته المنطقة وبانهيار الاتحاد السوفييتي والنظام الشيوعي. والحقيقة أنه إذا كانت يوغوسلافيا قد استطاعت أن تحقق تطورًا معينًا وأن تجمع حولها عددًا من الشعوب، فإن نظامها الشيوعي لم يكن يحمل حلولًا بعيدة المدى لمشكلات هذا التعدد. وقد ورثت مقدونيا جزءًا من هذا الماضي. إنها منطقة حافلة بسكونيتها الخاصة، التي تشكل أحيانًا، بشكل مفارق، منطقةَ قوة. وهي سكونية تكمن أهم علاماتها في استمرار ظلال الإمبراطورية العثمانية وظلال الأيديولوجيا والتاريخ. وذلك بشكل يجعل من مقدونيا أشبه بمتحف لمختلف الثقافات والحضارات واللغات والتجارب. حيث نجد مثلًا أن أغلب سكان مقدونيا ينحدرون من جذور سلافية، كما أن 30% منهم هم ألبانيون أو أتراك، ويشغل المسلمون 90% من هذه النسبة. وللأسف، عرفت المنطقة، بعد سنوات من التعايش، نزاعات مؤلمة بين المقدونيين والألبان، لم تلبث، لحسن الحظ، أن خمدت.
■ بالفعل. مقدونيا هو اسم بلد عريق يوجد منذ قرون. وقد ورثَ الشعب السلافي، الذي حل في هذا البلد، كثيرًا من علاماته الثقافية، وانطفأتْ أخرى مع توالي السنين. وتُمثل مقدونيا الآن الجزء العاشر من يوغوسلافيا السابقة، وقد ارتبط ظهورُها من جديد بالانفجار الذي عرفته المنطقة وبانهيار الاتحاد السوفييتي والنظام الشيوعي. والحقيقة أنه إذا كانت يوغوسلافيا قد استطاعت أن تحقق تطورًا معينًا وأن تجمع حولها عددًا من الشعوب، فإن نظامها الشيوعي لم يكن يحمل حلولًا بعيدة المدى لمشكلات هذا التعدد. وقد ورثت مقدونيا جزءًا من هذا الماضي. إنها منطقة حافلة بسكونيتها الخاصة، التي تشكل أحيانًا، بشكل مفارق، منطقةَ قوة. وهي سكونية تكمن أهم علاماتها في استمرار ظلال الإمبراطورية العثمانية وظلال الأيديولوجيا والتاريخ. وذلك بشكل يجعل من مقدونيا أشبه بمتحف لمختلف الثقافات والحضارات واللغات والتجارب. حيث نجد مثلًا أن أغلب سكان مقدونيا ينحدرون من جذور سلافية، كما أن 30% منهم هم ألبانيون أو أتراك، ويشغل المسلمون 90% من هذه النسبة. وللأسف، عرفت المنطقة، بعد سنوات من التعايش، نزاعات مؤلمة بين المقدونيين والألبان، لم تلبث، لحسن الحظ، أن خمدت.
● يبدو أن ثقل التراكم التاريخي محدِّدٌ لجانب من الوضع الثقافي الراهن بمقدونيا. كيف تحدد أهم علامات هذا المشهد؟
■ أستطيع أن أميز بين مستويين يحددان خصوصيات المشهد الثقافي والإبداعي المقدوني. فمن جهة، ورثت مقدونيا ثروة حقيقية على مستوى أشكال التراث الشعبي والأدب، ومن جهة ثانية، لم تستطع بناء مؤسسات منتظمة، كما يقتضي ذلك منطقُ التطور. لقد كان الماضي حافلًا بالشروخ، وذلك بالرغم من مجهودات الأجيال التي كانت منكبة على محاولة تجاوزها، وعلى البحث عن منافذ جديدة وعن أفق للاستمرار على مستويات الفن والأدب والتاريخ. وهي مجهودات شكلت بالتأكيد مؤشرًا على حركية ثقافية معينة. وإضافة إلى ذلك، تركت مرحلة الشيوعية آثارها الخاصة، حيث إن سيادة مفاهيم الواقعية الاجتماعية في هذه اللحظة، كانت تحد من إمكانيات التواصل والإبداع، اعتبارًا لتمثله كممارسة خاضعة لقوانين الحزب الواحد. وهو الأمر الذي تَكرسَ أيضًا مع استمرار ظلال العزلة التي عاشتها المنطقة. لقد كان الأدباء، إذن، خُدامًا للنظام السائد، وذلك بشكل كان يُفقر الأبعاد الفنية والجمالية للأعمال الأدبية. غير أن ذلك لحسن الحظ، لم يدم طويلًا، حيث عرفت الستينيات، مثلًا، نوعًا من الانفتاح، تجلت علاماتُه في أعمال الترجمة وفي آثارها العميقة، حيث همت أعمال رامبو ومالارميه وبودلير وأدباء المرحلة الكبار. في حين لم يشمل هذا الوضع الدول الأخرى في المنطقة، حيث كانت تعتبر ترجمة نصوص الشعراء الفرنسيين، المتسمة حينها بنفحاتها الرمزية، تراجعًا عن الروح الثورية.
وتأسس الانفتاح الذي عرفته منطقتنا بعلامتين أساسيتين: ارتبطت العلامة الأولى بلجوء الشعراء إلى الفلكلور وإلى الثقافة الشعبية، بينما تمثلت العلامة الأخرى في حثهم عن هامش لتحقيق نوع من الاستمرار، حيث شكل مثلًا اكتشافُ غارسيا لوركا ماركيز محطة لها أكثر من دلالة ومؤشرًا على الانتماء إلى اللحظة الشعرية الأوربية القائمة حينها على البحث عن المجهول والغرائبي. وقد استمر هذا الاتجاه حتى الآن، ولكن على نحو مختلف بالطبع. وارتبط هذا التعايش بين العلامتين بالسيرورة التاريخية لتوزع الساكنة، حيث إن الأدباء المنحدرين من البادية ظلوا يحتفظون بمرجعيتهم الثقافية الشعبية. وذلك على الرغم من كل محاولات النظام الشيوعي التي كانت تستهدف تغيير هذا التوزع الذي كانت المناطق القروية تشغل، في إطاره، 70% من الساكنة إلى حدود السنوات الأولى لما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
التعدد اللغوي وجسور التلاقي
● ثمة علامة مركزية أخرى تحكم المشهد الثقافي والإبداعي المقدوني وأقصد بالضبط التعدد اللغوي. كيف تتدبر هذا التعدد؟
■ أفضل أن أجيبك انطلاقًا من تجربتي الشخصية. لقد ولدت بألبانيا وعشت ودرست بمقدونيا. ولذلك فأنا أكتب باللغتين الألبانية والمقدونية. وهو الوضع نفسه للألبانيين المقيمين في مقدونيا الذين يشكلون 30% من ساكني هذا البلد، وهو الأمر الذي لا ينطبق على المقدونيين. وتلك بالطبع صورة عن العلاقة الدائمة بين الأغلبية والأقليات، حيث تحجم الأولى عن تعلم لغة الثانية. وأرجو تجاوُز هذا الوضع على الرغم من الاختلاف البنيوي للغتين، من حيث إن الألبانية لا تنتمي إلى أية مجموعة لغوية، بخلاف المقدونية التي هي لغة سلافية.
على العموم، أعتقد أن هذا التعدد اللغوي يشكل، على الرغم من مشكلات التواصل التي يخلقها أحيانًا، عاملًا حافزًا لحركية ثقافية معينة، خصوصًا مع حضور نشاط الترجمة، التي احتفظت بوتيرتها حتى في لحظات أحداث الاصطدامات بين الألبانيين والمقدونيين.. أما أنا شخصيًّا، فلي معرفة عميقة باللغات السلافية الأخرى تمكنني من توظيف أسرارها الخفية داخل كتاباتي. وإذا كانت كل لغة تملك عتماتها الخاصة التي تستحيل ترجمتُها إلى لغة أخرى، فإنني أجد نفسي سعيدًا بامتلاكي هذه العتمات المضاعَفة، وهو الأمر الذي يتطلب مني جهدًا مستمرًّا ونفسًا طويلًا وحقيقيًّا.
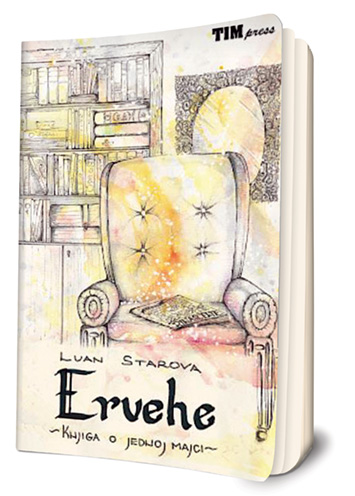 ● في نصوصك السردية يحضر الأب وغيره من أفراد العائلة كثيرًا. هل يشكل هذا الحضور تعويضًا عن غربتك المفترَضة؟
● في نصوصك السردية يحضر الأب وغيره من أفراد العائلة كثيرًا. هل يشكل هذا الحضور تعويضًا عن غربتك المفترَضة؟
■ أنا أنتمي لعائلة ألبانية مسلمة هاجرت إلى مقدونيا. وبذلك كانت العائلة لي وطنًا دائمًا، أبحث عن جذوره باستمرار. إنها أشبه بقرطاج التي استطاعت أن تقاوم خطر المحو. العائلة إذن تشكل لي العنصرَ الأساس داخل مسار حياتي، حيث أنشغلُ بالبحث عن هامش للتلاقي بين جيليها من الأسلاف والأبناء، وهو الأمر الذي يحضر في كتاباتي السردية خصوصًا، وذلك مع كثير من الحذر من السقوط في كتابة بورتريه تقريري للعائلة يمكن أن يكون على حساب أدبية الكتابة. لقد عشت خمسين سنة، والآن أنا أعيش جزءًا آخر من حياتي، وهو جزء أعدّه هدية من الله، ولذلك قررتُ أن أكرس ما تبقى من حياتي للبحث عن جذور عائلتي من خلال الكتابة وللإنصات لأصوات والديَّ الراحلين الخفية، حيث تمنحني الكتابة بذلك متعة قضاء لحظات رائعة معهما.
● أنت ذو أصول ألبانية. كيف استطاعتْ كِتابتُك أن تَنسُجَ أفُقَها الخاصَّ داخل المشهد الإبداعي المقدوني؟
■ هذا سؤال مهم. قد أبدو حسب تأويل ما كشخص خان أهله لكي يبحث عن مكان له بين الآخرين. وبالطبع أنا لست كذلك، كما أن ثمة تسامحًا بين الشعبين، الألباني والمقدوني، يمنحني هامشًا حقيقيًّا للحياة، وإن كان ذلك ليس يسيرًا وبديهيًّا خصوصًا في لحظات التوتر والاصطدام بين الشعبين. وخلال لحظات الضعف تلك يُبحَث عادة عن المجرمين وعن الخونة أو يُخلَقون إن اقتضى الحال. وعلى العموم، لقد اخترت الإبداع وطنًا لي، كما أن اللغة ليست ملكًا لشعب معين، ولكنها ملك للحياة، ولذلك فإن جذور اللغات تلتقي في مكان ما. لنأخذ مثلًا كلمة «mother»، نجد المفردة نفسها في لغات أخرى: «أم» بالعربية، «mère» بالفرنسية، «mutter» بالألمانية، «madre» بالإسبانية. تملك اللغة إذن أدراجًا تقود نحو الأبدي والقار، كما أنها تحتفظ بنوع من التضامن بين تجلياتها، حيث إن امتلاك لغتين أو ثلاث لغات يمكن أن يمنح بعدًا شعريًّا للغة المستعملة. وبالطبع، يظل تحقيق ذلك رهين أشياء أخرى.
توظيف الأسطورة ومقاومة البلاهة
● توظف عددٌ من أعمالك الأسطورة بشكل واضح. هل يشكل ذلك نزوعًا نحو محو آثار الواقعية التي طبعت أعمال العهد الشيوعي؟
■ أرى الأسطورة حلقة تتجمع في إطارها التجارب الإنسانية. وأعتقد أن توظيف الأسطورة يقتضي نوعًا من الحذر بغية تجنب مكايدها؛ لأنها أشبه بمتاهة يسهل الدخول إليها بينما يبدو الخروج منها عسيرًا ومستحيلًا في بعض الأحيان. وفيما يخصني، أشتغل في أعمالي السردية على التضحية والأساطير المرتبطة بها. يحضر ذلك مثلًا في عملي الروائي «زمن الماعز»، سواء بشكل واعٍ أو لا شعوري. ويعود جانب من ذلك إلى الحضور الدال للأسطورة داخل المرجعية الثقافية القديمة لمنطقة البلقان، حيث انبثقت هناك الأساطير الإنسانية الكبرى، كأساطير سيزيف وبروميثيو وأوديب. وبالطبع كنت حريصًا في روايتي على الأخذ في الحسبان تحولات سياق الأسطورة، وتغير الأسطورة نفسها التي صارت بعضُ تجلياتها في الوقت الراهن أقربَ إلى الكذب، تمامًا كما هو الأمر بالنسبة إلى الأساطير المرتبطة بهتلر وبموسوليني وببقية طغاة العالم. ويبقى الأدب هو الطريق الأفضل للانتقال بالإنسان إلى الأسطورة والعودة به منها بعيدًا من مزالقها الخفية.
 ● في عملك السردي «زمن الماعز» تحضر أيضًا روح الدعابة. وهو ما يتضح مثلًا من خلال اختيارك حيوان الماعز كبطل للرواية. هل تلك طريقتك في تدجين الواقع؟
● في عملك السردي «زمن الماعز» تحضر أيضًا روح الدعابة. وهو ما يتضح مثلًا من خلال اختيارك حيوان الماعز كبطل للرواية. هل تلك طريقتك في تدجين الواقع؟
■ لقد كانت مرحلة النظام الستاليني مرحلة مأساوية، وتساوق ذلك مع مرحلة طفولتي. ولذلك ارتبطت صورةُ المقاومة داخل مخيلتي الصغيرة بحيوان الماعز، وهو حيوان ظل يعيش بجانب الإنسان منذ القدم. وضدًّا لذلك، اختارَ النظام القضاء هذا الحيوان بهدف تغيير طرق عيش البدو. كان يمكن أن أكتب عن تراجيديا الدول الشيوعية بطريقة تأريخية وكرونولوجية، غير أن هدفي لم يكن هو الكتابة عن الألم وإنما عن البلاهة التي تخلق هذا الألم، وعن هؤلاء الذين أقدموا على قتل حيوانات الماعز مدفوعين بجرعة كبيرة من الجنون. ولذلك كنتُ مقتنعًا بأن الكتابة عن هذا الحدث ستكون أكثر دلالة بتوظيف روح الدعابة التي تستمد قوتها من فكاهة الشعب البليغة ببساطتها.
● تميلُ مجموعتك الشعرية «قرطاج» نحو الغرائبي. هل يتعلق الأمر برغبتك في تحقيق نوع من التصالح بين واقعية أعمالك السردية وغرائبية كتابتك الشعرية؟
■ بين الواقعي والخيالي ثمة طريق وعر يصعب معه البحث عن الممر الصحيح، غير أن الحياة والتجربة يمكنهما أن تقودانا إليه. لقد كانت قرطاج توحي لي بقدرة الإنسان على المقاومة. عشتُ بقرطاج طيلة أربع سنوات سفيرًا ليوغوسلافيا لدى الفلسطينيين. وكان لي اتصال متواصل، بحكم وظيفتي وبحكم الصداقة أيضًا، مع ياسر عرفات وفاروق قدومي وأبي إياد. كما كان بيتي يقع على بضعة أمتار من مقر إقامة أبي جهاد، حيث تعرض لعملية الاغتيال الدنيئة.
لقد عشتُ إذن داخل هذا السياق الذي أتحدث عنه للمرة الأولى؛ لأن تفاصيله أقوى من الكلام (يطلب مني خلال هذه اللحظة لوان ستاورفا، متأثرًا، سيجارة مؤكدًا أنها الأولى بعد سنوات من الانقطاع عن التدخين). عشتُ إذن هذا الحلم، وكانت لي ثمة علاقة بين التاريخ العريق لقرطاج ومقاومتها العميقة ووجود الفلسطينيين بتونس الذين كانت تربطني بهم علاقة تعاون كبيرة؛ لكوني سفيرًا لدى دولتهم التي لم تكن موجودة. كانت قرطاج نداء عميقًا للمقاومة. وكان يمكنها أن تكون فلسطين أو بلدي. غير أنني احتفظتُ بقرطاج الخاصة بي، تلك التي يقترب مصيرها من مصير عائلتي الصغيرة التي كانت مطاردة بخطر الفناء دائمًا. وتعاطفًا مع كل ذلك، كان ديواني «قرطاج» شكلًا من الاحتفاء بكل هذه التفاصيل التي تلتقي تراجيديا حياتي الخاصة.

سفر حرّ
● يبدو سفرك الشخصي ببعده التراجيدي امتدادًا لسفر عائلتك.
■ بالفعل. إنه سفر تمتد ظلاله إلى الجذور الأولى، متجاوزًا بذلك الحدود التي تشكل بالفعل تعبيرًا عن تصور ضيق للإنسان ولحريته.
● لسفرك أيضًا جانب آخر. أقصد نجاح أعمالك التي حصلت على أكثر من جائزة دولية؟
■ لم أبحث عن ذلك. ربما كان يهمني الحصول على الجوائز في مرحلة الشباب، غير أنني لم أعد أعير اهتمامًا للموضوع مع تقدم السن. وأستطيع أن أقول الآن: إن احتفائي بجائزة ما كان أشبه بخدعة تغريني بالفرح، بينما كان الحزن يجتاح أبطال رواياتي، وأعني خصوصًا حيوانات الماعز. تستطيع الجوائز أن تبعد كاتبًا ما عن طريقه، وهو ما حدث لأغلب الحاصلين على جائزة نوبل.
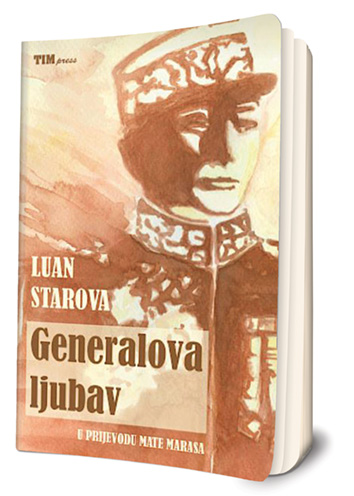 ● بخلاف هذا الاحتفاء يغيب اسمك عن العديد من الأنطولوجيات التي تقدم شعراء جيل السبعينيات المقدونيين.
● بخلاف هذا الاحتفاء يغيب اسمك عن العديد من الأنطولوجيات التي تقدم شعراء جيل السبعينيات المقدونيين.
■ أعُدّ نفسي شاعرًا عابرًا للأجيال. كما أن النقاد بمقدونيا يحجمون عن تصنيفي ضمن جيل معين، ويعود ذلك أساسًا لانتمائي الموزع بين وطنيين يجعل العاملُ السياسي الانتقالَ بينهما أمرًا عسيرًا. الأهم لي هو كتبي، أما الأنطولوجيات المخصصة للأجيال فهي تبقى أشبه بأدلة سياحية!
● أثرتَ أكثر من مرة علاقة السياسي بالشعري، وتبدو يائسًا من إمكانية وجود علاقة متكافئة بينهما.
■ ليس مطلَقًا. أنا أومن بالالتزام داخل العمل الأدبي. وهو التزام تجاه الإبداع وجماليته. وبالطبع، لا ينفي ذلك ضرورة الوعيَ السياسي للكاتب؛ لأنه يشتغل أساسًا على الكلمة، والكلمة خطيرة جدًّا؛ لأنها تستطيع أن تشعل حربًا ما.
● هل ما زالت الكتابة تملك هذه القوة داخل سياق العولمة الجديد؟
■ بالفعل، اللحظة الحالية هي لحظة تداول بامتياز، يستطيع في إطارها ما هو إلكتروني تقريبَ الناس وأيضًا خلق مسافات بينهم، لاستحالة تعويض الجنس البشري. وأعتقد أن العولمة، التي تتمظهر كبديل عن تراكم تجربة الإنسان، يمكن أن تدمره في لحظة واحدة؛ لأن منطق العولمة لا يؤمن بالاختلاف الإنساني. ثم ألا ترون أن العولمة هي أشبه بالمادية التي قامت عليها مرحلة الشيوعية، حيث كان لينين يدعو إلى وحدة عالمية قائمة على ما هو اقتصادي؟ العولمة تقوم على الفكرة نفسها، بالطبع مع احتفاظها باختلافاتها الخاصة. وأعتقد أن ما يشهده العالم الآن هو نتيجة هذه العولمة، حيث يعمل الأغنياء على خلق أيديولوجيتهم الخاصة القائمة على تدمير الآخر كوسيلة لاستمرارهم. إنهم يسعون إلى خلق صوت واحد يحكم العالم.

بواسطة حاوره حسن الوزاني - كاتب مغربي | يناير 1, 2022 | ثقافات
غاي بِينيت أحد أهم الأصوات الشعرية التي تطبع المشهد الشعري الأميركي المتسم بتعدديته المذهلة. وهي تعددية تعكسها تجربةُ بِينيت نفسها، حيث يبدو الشاعر منشغلًا بأكثر من جبهة إبداعية وفنية. فإضافة إلى ممارسته الشعرية، يدير غاي بِينيت مؤسسة لترويج الكتاب عن طريق الإنترنت، ويمارس الترجمة والتصميم الطباعي والموسيقا، كما يشرف على عدد كبير من المشروعات الأدبية والفنية. نشر غاي بِينيت، المولود سنة 1960م والحاصل على الدكتوراه في الأدب الفرنسي، مجموعة من الأعمال، من بينها مجاميعه الشعرية «هذا الكتاب»، و«الكلمات الأخيرة»، و«نظرات مشهورة»، و«100 نظرة شهيرة»، ودراسته «قصيدة العالمَين: الحوار الفرنسي الأميركي من خلال المجلات: 1985-2004» (2004) التي أنجزها باشتراك مع الباحثة الفرنسية بياتريس موسلي.
تميزت تجربة غاي بِينيت بالرغبة العميقة في الإنصات للآخر، وبالجرأة أيضًا في فهم علامات وجوده كشاعر أميركي، سواء المضيئة منها أو المعتمة؛ لذلك لا يتردد في الحديث عن الالتباسات التي تحيط بتاريخنا الإنساني المشترك، وفي التحذير من خطر تمثله على مقاس دولة واحدة.
هنا حوار معه:
● بدأتَ الكتابة في الخامسة عشرة من عمرك. بماذا احتفظتَ خلال هذا المشوار؟
■ احتفظتُ بشكل خاص بالخصال التي أحِبها لدى الناس والتي أتجرأ على الاعتقاد بأنني أتصف بها بدوري: الفضول الذي يشدني لكل ما هو غريب ومختلف، والتفتح والرغبة في التعلم، والحب الذي يربطني بالإبداع، سواء تعلق الأمر بالأدب أو الفنون التشكيلية أو الموسيقا.
● قضيتَ أكثر من عشرين سنة موسيقيًّا. هل تجد هذا الطريق الأفضل للوصول للكتابة؟
■ لم أقرر قطّ أن أصير كاتبًا ولم أكن أفكر في الأمر. لكنني بدأتُ، لسبب ما، الكتابة في سن الخامسة عشرة من عمري، وذلك في الوقت الذي كنتُ أدرس فيه الفن بالمدرسة. وبعد سنتين من ذلك، شرعتُ في دراسة الموسيقا. وكانت الكتابة، حينها لي، طريقةً للتعبير عن نفسي وللإبداع، تمامًا كما هو الأمر في الرسم والموسيقا. بل إنني كنتُ منشغلًا خلال وقت طويل بالموسيقا نفسِها، وانتهيتُ بالاشتغال موسيقيًّا طيلة عشرين سنة، كما أشرتَ. وخلال هذه المدة، استطعتُ أن أكتب نصوصًا، من دون أن أتخلّى عن نشاطي الفني الأول. وكان عليَّ أن أنتظر الثلاثينيات من عمري لكي أمارس الكتابة بشكل جدي؛ حيث إنها تشكل الآن جزءًا حقيقيًّا من حياتي اليومية. وأحيانًا أقول لنفسي: «عجبًا، لقد صرتَ كاتبًا!».
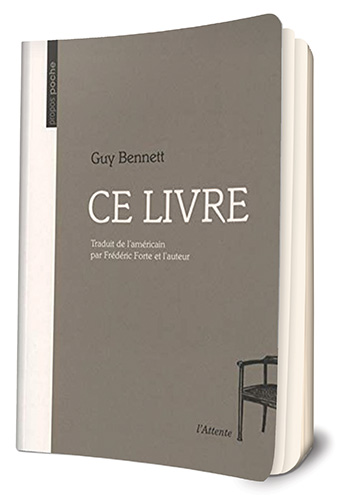 ● أنت شاعر ومترجم ومصور وناشر؛ كيف تستطيع تدبير كل هذه الانشغالات؟
● أنت شاعر ومترجم ومصور وناشر؛ كيف تستطيع تدبير كل هذه الانشغالات؟
■ الأمر سهل للغاية. والسر أنني أشتغلُ باستمرار ومن دون توقف. ويحدث أن أكون في خضم إنجاز مشروعات عدة في الوقت نفسه. فأنا الآن، على سبيل المثال، مقبل على إصدار كتيب جديد ضمن سلسلة المنشورات التي أديرها (Seeing Eye Books)، وأعدّ ملفًّا عن الشعر الأميركي خاصًّا بمجلة تصدر في كيبيك في كندا، كما أعد ملفًّا عن الشعر المغربي خاصًّا بمجلة أميركية أخرى، وأجمع نصوصًا لمجلة أتولى مسؤولية تحريرها، وأترجم أنطولوجيا للشعر الفرنسي، وأصحح مسودات ترجمة أخرى ستنشر قريبًا، وأكتب نصوصًا شعرية لمجلة مكسيكية أتعاون معها، وذلك إضافة، بالطبع، إلى عملي الذي أعيش منه، حيث أدرِّس بمدرسة للفنون.
● تكتب باللغتين الإنجليزية والفرنسية. كما أنك تترجم انطلاقًا من الفرنسية والروسية والإيطالية؛ ما الذي يمنحك إياه هذا السِّفْرُ اللغويّ؟
■ لقد منحني هذا السِّفْرُ، بالتأكيد، آفاقًا جديدة في الأدب، ولكن أيضًا في الحياة. وهذا هو الأهم لي. لقد تمكنتُ، بفضل هذا السِّفْرِ، من لقاء أشخاص من بلدان أخرى ومن التعرف إلى ثقافاتهم والإنصات لتجاربهم في الحياة، والتعرف أكثر إلى ذاتي وفهم دلالة وجودي داخل هذا العالم. وأعتقد أن معرفتي بلغات أخرى شكلت عنصرًا أساسًا في مسار تكويني، وفي نسج ملامح شخصيتي الراهنة.
القصيدة الصوتية
● تبدو منشغلًا بالتصميم، وفن الطباعة، والتجارب الصوتية؛ هل يشكل ذلك امتدادًا لتجربتك على مستوى الكتابة الشعرية والترجمة؟ ثم كيف تستطيع تدبير التوافق بين المكونين البصري والصوتي داخل تجربتك الشعرية؟
■ لا أعتقد أن انشدادي لفن الطباعة أو التجارب الصوتية يرتبط بعملي على مستوى الترجمة أو الكتابة الشعرية، بل أعدّهما مجالي اهتمام موازيين. والحقيقة أنني معجب كثيرًا بالقصيدة الصوتية، وقد ترجمتُ أعمال شعراء يشتغلون في هذا السياق. ومن بينهم خصوصًا غيوفان ساندري، وأرنست جاندلي، وبعض الشعراء المستقبليين الإيطاليين والروس كمارنيتي وإيليا زدانافيتش وغيرهما. وعلى الرغم من إعجابي بهذا النوع الشعري التجريبي فإنني مشدود، في إطار عملي الشعري، إلى البيت الشعري والقصيدة الغنائية القصيرة، والتركيبات الدلالية والنحوية الخاصة باللغة الإنجليزية، مع أنني أحاول دائمًا العمل على تعديلها.
 ● كنتَ قد أطلقتَ مشروع سلسلة قصائد جِناسية، خصوصًا من خلال عملك الشعري «إسقاطات ذاتية»؛ هل يتعلق الأمر بطريقتك في ممارسة اختلافك الشعري؟ ثم هل تؤمن بفاعلية «اللعب» الشعري؟
● كنتَ قد أطلقتَ مشروع سلسلة قصائد جِناسية، خصوصًا من خلال عملك الشعري «إسقاطات ذاتية»؛ هل يتعلق الأمر بطريقتك في ممارسة اختلافك الشعري؟ ثم هل تؤمن بفاعلية «اللعب» الشعري؟
■ أود أن أؤكد أن ما يهمني هو القصيدة وليس الطريقة التي تُكتب بها. فقصيدة سيئة، حتى إن كتبتْ بالاعتماد على طريقة جيدة، تبقى بالتأكيد قصيدةً سيئة. وإذا كنتُ أعترفُ أنني تأثرتُ، مدة طويلة، بالفن الذي يحقق إبداعيتَه من خلال اشتغاله الداخلي، فإن توظيف «اللعب» الأدبي في إطار نص ما لا ينفي، بالضرورة، جودتَه. وهو الأمر الذي يعكسه، على سبيل المثال، اعتمادُ النَّظم الشعري الغربي التقليدي على أساليب «اللعب» الأدبي المتجلي، خصوصًا في الوزن والتوزيع اللفظي والقافية وغيرها من الأشكال الثابتة التي لم تشكل قطّ حائلًا دون كتابة نصوص شعرية جيدة (أو سيئة أيضًا).
وفيما يخص طريقتي في تمثل القصيدة وكتابتها، فأنا أنطلق، في أغلب الأحيان، من فكرة شكلية ما، أو من إكراه معين له علاقة معينة بالموضوع الذي أريد تناوله، مُرتَئِيًا أنه من الممكن أن يتحقق اللقاء بين شكل القصيدة ومضمونها، بل أنْ يصير الأول موضوعًا للثاني، وهو الأمر الذي يَضمن قوةَ النص وتناسقه. وتمنحُ مجموعتي «إسقاطات ذاتية»، التي أشرتَ إليها سابقًا، إضافة إلى أغلبية أعمالي الشعرية، صورة حقيقية عن ذلك. ومن ثَمّ، لا تمثل هذه الوسائل لي عناصرَ مهمة فقط، ولكن عناصر ضرورية بشكل حاسم ونهائي. ولا يتعلق الأمر باختيار وضع معاكس للتيار، حيث إن اللعب الشكلي، كما قلتُ سابقًا، يشكل جزءًا من القصيدة الغربية التقليدية نفسها. وبناءً على ذلك، لا أنطلق أبدًا من أي موضوع قبلي، ولا من أية رسالة يُفترض توجيههُا إلى قارئ مفترض، وإنما أنتهي إلى بلورة الموضوع أو الرسالة؛ ذلك لأن القصيدة لي، هي مساحة شاسعة للاستكشاف، أما المُحَددات والأشكال التي تشكل أساسَ كتابتي فهي دليلي في رحلة الاستكشاف تلك. وما أجدهُ دائمًا في هذه الرحلة هو القصيدة نفسها.
● أنت أحد شعراء الجيل الجديد في الولايات المتحدة الأميركية؛ كيف تتمثل أهم علامات جيلك؟
■ الحقيقة أنه يصعب الحديث عن الأجيال الشعرية في الولايات المتحدة الأميركية أو تحديدها، وذلك بحكم الاختلاف والتنوع الكبيرين اللذين يطبعان الكتابة الشعرية هناك، بشكل يجعل من العسير تقويمها والتمييز بين مكوناتها.
● لنغيّر السؤال: ما العلامات المضيئة والمظلمة لوجودك كشاعر أميركي؟
■ إذا كنتَ تقصد مميزات وسلبيات هذا الوجود، فلا وجود للأولى. فصفة الشاعر لا تمنح، عندنا، أي وضع اعتباري يمكن أن يُقِرَّه من هم خارج العالم الضيق جدًّا للمجال الشعري، الذي لا يسكنه إلا الشعراءُ أنفسهم وقراؤهم وناشروهم المعدودون. كما لا أرى أي جانب سلبي في الوجود كشاعر في الولايات المتحدة الأميركية، باستثناء ممارسته لعمل لا دلالة له لدى 99% من مواطنيه.
الترجمة فعل إضاءة
● كنتَ تؤمن دائمًا بأن الترجمة «فعل إضاءة»؛ ما الذي تضيئه بالفعل؟
■ تحيل في سؤالك على ما صرحتُ به لمجلة «Double Change». ويعني ذلك أن عمليةَ الترجمة تفترضُ من صاحبها الاختيارَ بين بدائل معينة: الاكتفاء بالجانب الدلالي فقط، أو العمل على إعادة إنتاج سمات أخرى ترتبط بأسلوب النص وجانبه اللساني والمعجمي. وفي حالة القصيدة، يبدو الأمر أكثر تعقيدًا، حيث تتشعب الاختيارات: هل يجب الحفاظ على حضور الموسيقا في النص أو على غيابها؟ ما الذي يجبُ أن يفعله المترجم بالوزن أو القافية أو بالشكل الثابت في حال اعتماد النص على هذه المكونات؟ هل يجب على المترجم أن يستحضرَ الجانبَ البصريّ للنص وتوزيعَه الخَطّيّ وطولَ «الأبيات» ومستوى ارتباط معنى القافية في البيت بمعنى البيت الذي يليه؟ ثم هل على المترجم أن يستعمل بعض المحددات التي استعملَها الشاعر، حتى إذا كان ذلك يمكن أن يُبعِد الترجمة من المعنى الأصلي للقصيدة؟ ويؤدي تمثلُ واستحضارُ هذه التساؤلات إلى اهتمام المترجم بجوانب معينة داخل النص على حساب أخرى، بشكل تصيرُ معه الأولى أكثر وضوحًا وحضورًا داخل النص المترجَم. وبهذا المعنى، تتحدد الجوانب التي «تضيئها» الترجمة في تلك التي اختار المترجِم إعادة إنتاجها، عادًّا إيّاها الجوانبَ الأهم، بينما تصير بقيةُ جوانب النص الأصلي أقلّ حضورًا ووضوحًا، بل قد تغيب في النص المترجَم.
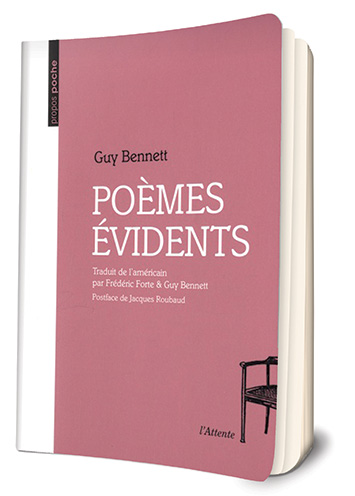 ● تعيش داخل فضاء ثقافي وسوسيو-اجتماعي يتجه باستمرار، نحو مَأْسَسة شاملة؛ هل تستطيع أن تحافظَ، في ظل ذلك، على شِحْنة العزلة والفوضى والجنون التي تقتضيها العملية الإبداعية والشعرية منها خصوصًا؟
● تعيش داخل فضاء ثقافي وسوسيو-اجتماعي يتجه باستمرار، نحو مَأْسَسة شاملة؛ هل تستطيع أن تحافظَ، في ظل ذلك، على شِحْنة العزلة والفوضى والجنون التي تقتضيها العملية الإبداعية والشعرية منها خصوصًا؟
■ حينما نستحضرُ مكانةَ الشعر داخل المجتمعات الحالية، وبخاصة المجتمع الأميركي، حيث يبدو وضعُ القصيدة خافتًا، يتبددُ خوفنا على عزلة القصيدة أو الشاعر. هناك شعراء يشعرون بالإحباط؛ لأنهم يتمنون أن يحظوا باهتمام العالم، وأن يعلم القراء بوجودهم، وأن يكون هناك اعتراف بالقيمة السوسيوثقافية لعملهم الإبداعي، وأن يكون هذا الاعتراف مرافقًا بدعم رسمي أو غيره يساعدهم على الحياة والكتابة والنشر. وفي مقابل هؤلاء، هناك شعراء آخرون يستمدّون إحساسَهم بالحرية من كون العالم يبدو غيرَ مكترث بوجودهم، ومن غياب مؤسسات تهتمّ بأعمالهم، ومن غياب أي دعم مادي أو غيره. ومن ثَمّ، يمارس هؤلاء عملهم الإبداعي بالطريقة التي تروقهم، وبإمكانياتهم الذاتية. أما أنا فلا أفكرُ كثيرًا في الأمر. أفعل ما أشاء، سواء تَعَلّقَ الأمر بالكتابة أو الترجمة أو النشر، لأنني أحب أن أقوم بذلك، ولا أنتظر أي شيء من أي أحد؛ ذلك لأنني أستمد قوتي من اهتمامي العميق بالإبداع الأدبي. وهي قوة لن تَمَسَّها بالتأكيد التحولات الاجتماعية التي أشرتَ إليها.
● تتقنُ اللغة الفرنسية وتكتب بها أحيانًا. وخلافًا لمنطق الجغرافيا، تبدو أقرب، ثقافيًّا واجتماعيًّا أيضًا، إلى المشهد الأدبي الباريسي أكثر منه إلى المشهد الإبداعي الفرانكفوني في الكيبيك القريب، جغرافيًّا، من الولايات المتحدة الأميركية؛ ألا تجد الأمر مفارقًا؟
■ بالتأكيد. الحياة تحفل أحيانًا بمفارقاتها الخاصة. أمّا هذه الحالة، فلا تبدو المفارقة عسيرة على التفسير؛ إذ تسهلُ إضاءة طبيعة علاقتي بفرنسا. فأنا، أولًا، أعددتُ دكتوراه في الأدب الفرنسي، وهو ما يعني أنني قضيتُ سنوات في دراسة فرنسا وثقافتها وتاريخها ومجتمعها. كما أنني درَّستُ اللغةَ والأدبَ الفرنسييْنِ في الجامعة عشرين سنة، وهي مدة طويلة بالتأكيد. وضمَّت الترجماتُ الأولى التي قمتُ بها النصوصَ الشعرية التي درَستها أو كنتُ أدرِّسها لطلبتي والتي كانت معبرًا لي للتعرف إلى عدد من الشعراء الفرنسيين. وأخيرًا، ونتيجة كل ذلك، انتهيتُ إلى الزواج بفرنسية؛ حيث نقضي، كل سنة، شهورًا في فرنسا، وهو الأمر الذي ساعدني على نسج علاقات وصداقات مع عدد من الشعراء الفرنسيين، وعلى إنجاز عدد من المشروعات الإبداعية بالاشتراك معهم. وللإشارة، كنت قد أنجزتُ مع زوجتي بياتريس موسلي كتابًا حول علاقات التبادل بين التجربتين الشعريتين الفرنسية والأميركية (قصيدة العالمين: الحوار الفرنسي الأميركي من خلال المجلات، 1850-2004).
أما ما يخص علاقتي بالتجربة الشعرية في الكيبيك، فقد انبثقتْ منذ مدة قصيرة فقط. ويرتبطُ ذلك، ربما، بوضع أعم، حيث إن الشعر الكيبيكيّ يظل غير معروف بشكل كبير في الولايات المتحدة الأميركية، أو على الأقل في الوسط الشعري الذي عشت فيه، على الرغم من ترجمة عدد من شعراء هذه التجربة. وتشكلُ الشاعرة الكيبيكية نيكول بروسا الاستثناء؛ إذ تحظى باهتمام كبير لدينا منذ سنوات. وقد كنتُ سعيدًا بالتعرف إليها، قبل ثلاث سنوات بمعرض الشعر في باريس. واقترحتُ عليها نشرَ نصّ ما لها ضمن السلسلة التي أديرها. وبالفعل، كتبتْ نيكول بروسا نصًّا خاصًّا بهذا المشروع تحت عنوان «Shadow-Soft et Soif»، عملتُ شخصيًّا على ترجمته. وهو ما شكل أحد الأعمال النادرة التي لم تُنشر قطّ بلغتها الأصلية التي كُتبتْ بها (باستثناء بعض مختارات النص التي نُشرت بالفرنسية في الكيبيك). ثم جمعتنا، في السنة التالية، قراءةٌ شعرية في باريس. وكان اللقاء مناسبة للتفكير في مشروع للتبادل الشعري بين الكيبيك والولايات المتحدة الأميركية. ويتعلق الأمر بإعداد ملف للشعر الأميركي سينشر بمجلة كيبيكية وآخر للشعر الأميركي بهدف نشره بمجلة أميركية، على أساس أن تُنَظَّمَ قراءاتٌ شعرية مشتركة بمناسبة إطلاق العمليْنِ. وعلى العموم، يشكل هذا المشروع وغيره مناسبة لي للتعرف إلى تجارب شعرية مجاورة لبلدي.
قريبًا من العالم العربي
● لديك صداقاتٌ مع مجموعة من الشعراء والكتاب العرب. كما أنك ترجمتَ عملين شعريين بالفرنسية للشاعرين المغربيين مصطفى النيسابوري (الاقتراب من الخلاء)، ومحمد خير الدين، وآخر للروائي الجزائري محمد ديب؛ هل تؤمن بإمكانية حوار شعري وثقافي مع العالم العربي في ظل شروط السياق الراهن؟

محمد ديب
■ الحقيقة أن معرفتي بالثقافة العربية تبقى، للأسف، محدودة جدًّا. ومعلوماتي حولها حصلتُ عليها، بالضبط، مُصادَفةً في خِضَمّ اكتشافاتي. وكالعادة، كان يقودني في ذلك فضولي الخاص. وأفترض أن لقائي الأول بالعالم العربي تم من خلال أغاني أم كلثوم التي استمعتُ إليها قبل أكثر من عشرين سنة. وإذا كان إحساسي بالموسيقا مرهفًا جدًّا، فإنني أجد الغناء العربي أحد أجمل أنواع الغناء في العالم. لقد أذهلني، بشكل كبير وعميق جدًّا، صوت أم كلثوم. ولم أكن قد استمعتُ، من قبلُ، إلى صوت آخر يوازيه. وكانت هذه الصدمة بالضبط وراء رغبتي في التعرف بشكل أكبر إلى هذه الموسيقا. ومنذ ذلك الحين، استطعتُ أن أطور معلوماتي حول هذه الموسيقا. وبالمناسبة، يروقني كثيرًا كل من محمد عبدالوهاب وأسمهان وفيروز ووردة، وأيضًا، الشاب خالد والمغنية الجزائرية الرميتي، ونجوى كرم كأصوات شابة أو ذات مزاج شاب كما هو الأمر للمغنية الرميتي. وأحتفظُ بالحب نفسه، سواء إلى الموسيقا العربية «العالمة» أو الكلاسيكية، كما يمثلها، على سبيل المثال، الراحل منير بشير، أو إلى الموسيقا الصوفية في امتداداتها العربية والإسلامية، خصوصًا من خلال تجربة التركي قدسي إرغونر.

محمد خير الدين
أمّا ما يخص علاقتي بالشعر والأدب العربييْنِ، فقد تكونتْ ملامحُها الأولى فيما بعد. وحيث إنني أجهل اللغة العربية، فقد قرأتُ على سبيل المثال، وبشكل يبقى محدودًا، أعمالًا مترجمة للشاعر المغربي مصطفى النيسابوري، وللكاتب الجزائري محمد ديب، وللكاتب التونسي عبدالوهاب المؤدب. وعلى العموم، أُومِنُ بشكل كبير، بأهمية الحوار وجَدْواه مع العالم العربي؛ ثقافيًّا كان أو غيره، خصوصًا معنا نحن الأميركان الذين نحتاجُ لتَذَكُّر حقيقة كون العالم لا ينتهي عند حدودنا، وكوننا نتقاسم الكوكب مع مليارات الأفراد الذين يختلفون عنا من حيث اللغة والثقافة والمعتقدات، ولكنهم يملكون الاحتياجات والرغبات نفسها وبخاصة الحقوق الأساسية نفسها؛ ذلك لأنهم ببساطة، كائنات بشرية مثلنا. ويبدو محزنًا أن يصير من الواجب التذكير بذلك.
كما يبدو مهمًّا أن نعيدَ تأمل، من قرب، علاقاتنا بالعالم العربي التي لم تبدأ، بالتأكيد، مع تحطيم البرجين، وأن نحاول فهم انعكاسات سياستنا الخارجية تجاه الشعوب العربية. كما يتوجب علينا، أيضًا، أن نعمل على تمثُّل، بشكل إيجابي وبعيد من النفاق، سياستنا في الشرق الأوسط، خصوصًا ما يهمّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لقد دأب الأميركيون، في المدة الأخيرة، على طرح سؤال أساسي: «لماذا يكرهنا الآخرون؟» وهو ما يبدو أمرًا مهمًّا. غير أن الإشكال يكمن في كونهم لم يكلفوا أنفسهم بالبحث عميقًا عن الجواب، وأحجموا عن الإنصات لمن يمكن أن يدُلّهم عليه.
● الإنصات لمن؟ للشعراء مثلًا؟ ما الذي يستطيع أن يفعله هؤلاء، بالمناسبة، لتصويب مسار تاريخ حافل بأحداثه المرعبة؛ أحداث 11 سبتمبر مثلًا؟
■ لا أعرف. وربما لا شيء. على الأقل، على مستوى ما يمكن أن يغير شيئًا ما داخل عالم السياسة والإستراتيجيات، حيث تبدو القصيدة عاجزة عن فعل شيء ذي أهمية. لكن، ربما، على مستوى أكثر تواضعًا وأكثر حميمية، قد تستطيعُ القصيدة، ومعها سفراؤها من الشعراء، نسج علاقات بين مواطني كل البلدان الذين يمتلكون رغبة الإنصات لجيرانهم والذين ينظرون بطريقة مغايرة للعالم وللحظة الراهنة التي نعيشها جميعًا بشكل يمكن أن يغني نظرتَنا، نحن، للأشياء. وأن تقررَ أنتَ، الشاعر المغربي، محاورةَ شاعرٍ أميركيّ لَخيرُ دليلٍ على قدرة ما أسميتَه أنتَ، في حديث سابقٍ بيننا، بالصداقة السرية للقصيدة، على التقريب بين الناس. ولو قُدر لذلك أن يتجاوز عالم الشعراء الضيق ليشمل عالم القراء الأقل ضيقًا، ولو قُدر لهؤلاء القراء أن يتقاسموا هذه الأفكار مع أقاربهم، ولو قُدر أيضًا لأقاربهم أن يتحدثوا عن هذه الأفكار مع أصدقائهم، فقد يكون من الممكن خلق جمهور يملك وعيًا أكبر بما يجري حوله، واقتناعًا أعمق بكوننا جميعًا سواسية. وهو ما يشكل، بالطبع، أمرًا أساسًا وحاسمًا.

 ■ بالفعل. مقدونيا هو اسم بلد عريق يوجد منذ قرون. وقد ورثَ الشعب السلافي، الذي حل في هذا البلد، كثيرًا من علاماته الثقافية، وانطفأتْ أخرى مع توالي السنين. وتُمثل مقدونيا الآن الجزء العاشر من يوغوسلافيا السابقة، وقد ارتبط ظهورُها من جديد بالانفجار الذي عرفته المنطقة وبانهيار الاتحاد السوفييتي والنظام الشيوعي. والحقيقة أنه إذا كانت يوغوسلافيا قد استطاعت أن تحقق تطورًا معينًا وأن تجمع حولها عددًا من الشعوب، فإن نظامها الشيوعي لم يكن يحمل حلولًا بعيدة المدى لمشكلات هذا التعدد. وقد ورثت مقدونيا جزءًا من هذا الماضي. إنها منطقة حافلة بسكونيتها الخاصة، التي تشكل أحيانًا، بشكل مفارق، منطقةَ قوة. وهي سكونية تكمن أهم علاماتها في استمرار ظلال الإمبراطورية العثمانية وظلال الأيديولوجيا والتاريخ. وذلك بشكل يجعل من مقدونيا أشبه بمتحف لمختلف الثقافات والحضارات واللغات والتجارب. حيث نجد مثلًا أن أغلب سكان مقدونيا ينحدرون من جذور سلافية، كما أن 30% منهم هم ألبانيون أو أتراك، ويشغل المسلمون 90% من هذه النسبة. وللأسف، عرفت المنطقة، بعد سنوات من التعايش، نزاعات مؤلمة بين المقدونيين والألبان، لم تلبث، لحسن الحظ، أن خمدت.
■ بالفعل. مقدونيا هو اسم بلد عريق يوجد منذ قرون. وقد ورثَ الشعب السلافي، الذي حل في هذا البلد، كثيرًا من علاماته الثقافية، وانطفأتْ أخرى مع توالي السنين. وتُمثل مقدونيا الآن الجزء العاشر من يوغوسلافيا السابقة، وقد ارتبط ظهورُها من جديد بالانفجار الذي عرفته المنطقة وبانهيار الاتحاد السوفييتي والنظام الشيوعي. والحقيقة أنه إذا كانت يوغوسلافيا قد استطاعت أن تحقق تطورًا معينًا وأن تجمع حولها عددًا من الشعوب، فإن نظامها الشيوعي لم يكن يحمل حلولًا بعيدة المدى لمشكلات هذا التعدد. وقد ورثت مقدونيا جزءًا من هذا الماضي. إنها منطقة حافلة بسكونيتها الخاصة، التي تشكل أحيانًا، بشكل مفارق، منطقةَ قوة. وهي سكونية تكمن أهم علاماتها في استمرار ظلال الإمبراطورية العثمانية وظلال الأيديولوجيا والتاريخ. وذلك بشكل يجعل من مقدونيا أشبه بمتحف لمختلف الثقافات والحضارات واللغات والتجارب. حيث نجد مثلًا أن أغلب سكان مقدونيا ينحدرون من جذور سلافية، كما أن 30% منهم هم ألبانيون أو أتراك، ويشغل المسلمون 90% من هذه النسبة. وللأسف، عرفت المنطقة، بعد سنوات من التعايش، نزاعات مؤلمة بين المقدونيين والألبان، لم تلبث، لحسن الحظ، أن خمدت.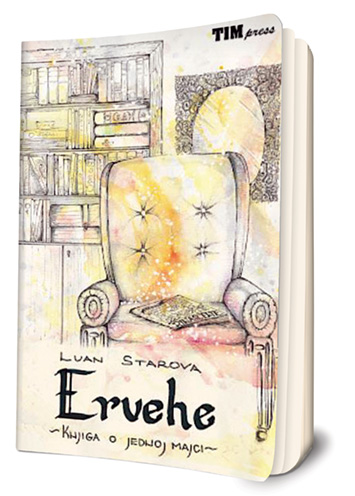 ● في نصوصك السردية يحضر الأب وغيره من أفراد العائلة كثيرًا. هل يشكل هذا الحضور تعويضًا عن غربتك المفترَضة؟
● في نصوصك السردية يحضر الأب وغيره من أفراد العائلة كثيرًا. هل يشكل هذا الحضور تعويضًا عن غربتك المفترَضة؟ ● في عملك السردي «زمن الماعز» تحضر أيضًا روح الدعابة. وهو ما يتضح مثلًا من خلال اختيارك حيوان الماعز كبطل للرواية. هل تلك طريقتك في تدجين الواقع؟
● في عملك السردي «زمن الماعز» تحضر أيضًا روح الدعابة. وهو ما يتضح مثلًا من خلال اختيارك حيوان الماعز كبطل للرواية. هل تلك طريقتك في تدجين الواقع؟
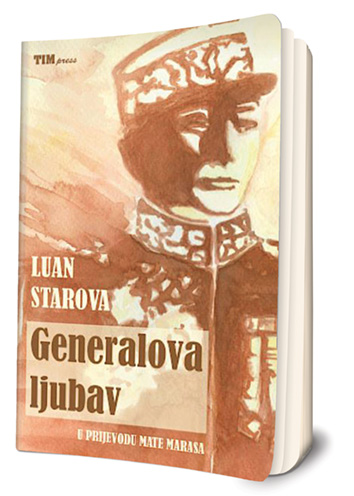 ● بخلاف هذا الاحتفاء يغيب اسمك عن العديد من الأنطولوجيات التي تقدم شعراء جيل السبعينيات المقدونيين.
● بخلاف هذا الاحتفاء يغيب اسمك عن العديد من الأنطولوجيات التي تقدم شعراء جيل السبعينيات المقدونيين.

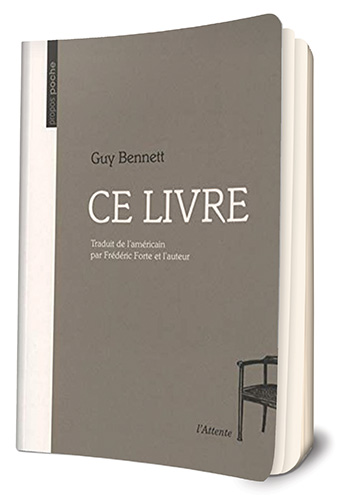 ●
● ●
●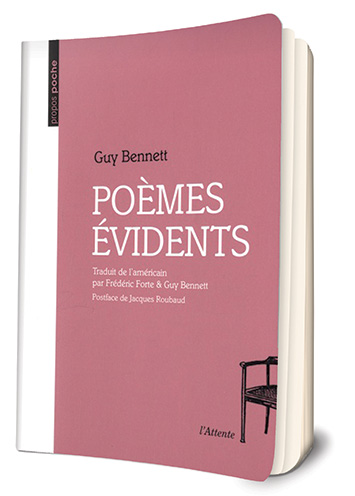 ●
●

