
بواسطة محمد الفخراني - كاتب مصري | نوفمبر 5, 2017 | نصوص
كان هناك صبيّ في قلبه قصة يريد أن يكتبها، وفي جيبه قلم صغير من البوص به بقايا حِبْر صُنِع من عصير الفاكهة. أراد الصبيّ أن يكتب قصته في شيء أكثر رِقَّة من لِحاء الأشجار، أو أيّ شيء من الأشياء التي كانوا يكتبون فيها مشاعرهم وأفكارهم في ذلك الوقت. لم يكن أيّ نوع من الأوراق قد ظهر في العالم بَعْد.
خرج الصبيّ، يبحث في الأماكن القريبة، ابتعد، دَخَلَ أماكن مرعبة لا يدخلها أحد، مشى في الغابات، ومسارات تحت الأرض، فتَّشَ في زوايا الليل والنهار، استوقفَ طيورًا وحيوانات مهاجرة وسألَها، لكنها ربما لم تعرف، أو لم تكن متأكدة أنها قادرة على مساعدته. وصلَ الصبيّ إلى أرض خالية، مُقَسَّمة إلى دوائر بعضها داخل بعض، انتقل من واحدة إلى أخرى حتى وصل إلى مركز أصغر دائرة، دار حول نفسه دورة واحدة، فبدأتِ الدوائر تدور، كأنه قام بتشغيلها بحركته تلك.
وصلَتْ الدوائر إلى سرعتها القصوى في لحظات، وصنَعَتْ دوامة هوائية أشبه بإعصار كبير حمل الصبيّ ورفعه عاليًا، دار به في أماكن كثيرة من العالم، لم يشعر الصبيّ بالخوف، إنما بالأمان واللعب، كان يضحك، ويرى تفاصيل كثيرة من العالم تدور معه: أشجار ملونة، أسماك، قوارب، آلات موسيقية، حيوانات، طيور، طافت به الدَّوَّامة الهوائية فوق مياه، عَبَرَتْ صحارى، صَعَدَتْ جبالًا، دخلَتْ ساحاتٍ تحت الأرض، طارت فوق السحاب، وهي تجمع للصبيّ كائنات جديدة تدور معه، ثم بدأتْ تهدأ تدريجيًّا، فتتلاشى الكائنات التي تحملها بداخلها، أو تطير بعيدًا، حتى لم يتبق غير الصبيّ.
وضَعَته الدوَّامة برفق على الأرض، ترنَّحَ قليلًا وأغلق عينيه، كان يضحك ضحكات قصيرة، وشعور خفيف بالدُّوار يدغدغه ويتسرَّب منه في الوقت نفسه، حتى هدأ كل شيء. كانت الأرض حول الصبيّ مُغَطَّاة بأوراق أشجار ملوَّنة، وتُظلُّه شجرة كبيرة، تبدو جديدة وقديمة في الوقت نفسه، أغصانها خضراء، وتتدلَّى منها خيوط رفيعة لها ألوان مختلفة، في نهاية كل خيط ثمرة واحدة، كأنها وردة كبيرة منغلقة على نفسها، ولها لون يختلف عن زميلاتها، تهتز الثمار قليلًا مع الهواء، ويصدر عنها صوت رقيق يُغوي بالتعامل معها، مدَّ الصبيُّ يده ولمسَ إحداها، فتفتَّحَتْ برفق مثل فراشة متعدِّدة الأجنحة، غير أنَّ الأجنحة كانت أوراقًا بحجم الكَفّ، ناعمة، مستطيلة، وتتوزَّع بشكل دائريّ حول نسغ أخضر كأنه محور لها.
أدركَ الصبيّ أنه وجد ما يبحث عنه، شعرَ برغبة في أن يكتب شيئًا، أخرجَ قلمه الصغير، كتب في أوراق الثمرة بتدفّق، حتى إنه لم ينتبه عندما انتهى حِبْر عصير الفاكهة من قلمه. في حياة أخرى لها، كان يمكن لهذه الشجرة أن تحصل على اسم «شجرة الورق»، إلا أن الصبيّ عندما نظر في الأوراق، ورغم كل ما كتبه، لم يجد غير كلمة واحدة هي «الكتابة»، فنظر إلى الشجرة، وأعطاها اسمها الذى ستُعرَف به في هذه الحياة «شجرة الكتابة».
في كل الحروب التي مرَّ بها العالم، أو مرَّت به، كانت كل الأشجار تحترق عدا «شجرة الكتابة»، وعندما يُصِرُّ أحدهم أو بعضهم على حرقها، ويجمعون لها كل أنواع النيران، ويخترعون لأجلها أجناسًا من الحرائق، فإن الشجرة تتحوَّل إلى فُتات ذهبيّ يتطاير في الهواء، وبينما يعتقدون أنهم قد أحرقوها، يتوزَّع فُتاتُها في أماكن كثيرة من العالم، وبمجرد أن يلامس الأرض تتحوَّل كل نُدفة منه إلى «شجرة الكتابة» جديدة.

بواسطة منتصر القفاش - كاتب مصري | نوفمبر 1, 2017 | سرد, نصوص
رأيته دائمًا جديرًا بأن يضم كنزًا، وليس مجرد أوراق قديمة، ينتظر أبي دائمًا الوقت المناسب لفرزها. هذا الصندوق الخشبي المغطاة زواياه الخارجية بشرائط نحاسية، وله بطانة من القطيفة الحمراء. ولا يمكن إغلاقه إلا بالضغط على غطائه بقوة عدة مرات.
كان أبي يسمح بفتحه في وجوده فقط. ويضع كتبًا كثيرة فوقه حتى تكون عقبة أمام من يخالف هذا الشرط. ومنذ خروجه إلى المعاش، صار يغضب كثيرًا إذا وجد الكتب مزحزحة عن مكانها أو تغير ترتيبها. ويثق في أن الصندوق فُتح في غيابه. لم يكن يوجه اتهامًا لشخص بعينه بل يلوم كل من في البيت: أنا وإخوتي وأمي، كلنا مسؤولون عن السماح لأحدنا بالعبث بالأوراق، ويعيد تذكيرنا بأهميتها فمن بينها عقد زواج أبيه من أمه، وشهادات ميلاد أخويه اللذين توفيا منذ سنوات، وعقد بيع البيت الذي قضى فيه طفولته، والأوراق التي كان يكتب فيها الشعر وهو صغير، ورسائل من أصدقاء قدامى لم نر أيًّا منهم، وإن كنا حفظنا أسماء معظمهم من كثرة حديثه عنهم، ويتمنى لو لم يتسبب في ضياع المفتاح وهو صغير.
أراد يومًا أن يرى زملاؤه في المدرسة هذا المفتاح الضخم، المحفورة فيه طيور منمنمة لكن ملامحها واضحة لمن يدقق فيها. وظل المفتاح يتنقل بين أيدي الزملاء المبهورين به حتى اختفى فجأة عن عين أبي، فتش كل الجيوب والحقائب كما حكى لكنه لم يعثر عليه. اشتكى للناظر فغضب لإحضاره المفتاح دون علم أسرته، وعاقبه بوقوفه ووجهه إلى الحائط حصتين كاملتين. ونصح جدي بحرمانه من المصروف لمدة شهر على الأقل، صارت أسبوعًا واحدًا، لم يكلمه فيه جدي الذي ظل يحس بفقدانه أفضل مكان لحفظ الأشياء الثمينة. ورفض أن يلمس الصندوق أي صانع مفاتيح، فكلهم لا يقدّرون قيمته وقد يكسرونه، ولا يستطيعون صنع نسخة مطابقة للمفتاح الأصلي. وصار يغير باستمرار الأماكن التي يخفي فيها خمس عملات ذهبية ومسدسًا وعدة رصاصات ورثها عن أبيه، وأحيانًا كان ينسى مكانها، فيظل يفتش عنها وهو يشتم كل من في البيت، ويسارع أبي بالخروج ولا يعود إلا بعد العثور عليها.
وكنت كلما فتحت الصندوق أمرر يدي ببطء على البطانة القطيفة، وأثق في إخفائها شيئًا ثمينًا لم ينتبه إليه أي أحد من قبل. وأتوقف عند مواضع أحس فيها بوجود شيء صلب تحتها. وأتخيله أحيانًا عملة ذهبية أو رصاصة أو نسخة أخرى للمفتاح.
وفي يوم قررت وضع حد لشكوكي المتزايدة، وفتحت بالمقص فتحة دقيقة في طرف البطانة، أقنعت نفسي بأنها غير ملحوظة، وأدخلت قلم رصاص قصر عن الوصول إلى أماكن أبعد. وسَّعت الفتحة قليلًا، وأدخلت مسطرة طويلة، استطاعت مسح مساحة أكبر دون الاصطدام بأي شيء صلب. دفعت المسطرة بأصابعي بقوة. فتمزقت حواف الفتحة، وسمعت صوت التمزق حادًّا كأنه خرق طبلة أذني، وسمعه كل أفراد أسرتي رغم عدم وجودهم في الشقة. رجعت أمي وأنا أعيد مجلدات الكتب فوق الصندوق. ونبهتني كعادتها بترتيبها كما كانت. لمحت المقص والقلم والمسطرة، وخشيت من أن أكون قد قصصت الأوراق القديمة أو كتبت فيها شيئًا. وقبل تماديها في تخيل ما يمكن أن يفعله أبي صارحتُها بما حدث. ظلت تحدق في التمزق صامتة. ثم أحضرت كيس أدوات الخياطة، وظلت تضاهي الدرجات المختلفة للخيوط الحمراء بلون البطانة، لم تجد الدرجة نفسها. نظرت في ساعة الحائط. وأمرتني بإغلاق الصندوق قبل عودة أبي. وخرجت مسرعة تلف على محلات الخردوات حتى عثرت على درجة اللون. تمنّت، وهي تهمس لي، لو كنت فعلت هذا قبل خروج أبي إلى المعاش. فلم يعد يغادر البيت كثيرًا، وأحيانًا لا يكمل مشوارًا لإحساسه بالألم في قدميه. وصارت أمي موزعة بين رفو التمزق بدقة والإسراع بإعادة كل شيء إلى مكانه ما إن تحس بصعوده السلم. وساهم إخوتي معي في إتمام هذه العملية سواء بتكرار الضغط على الغطاء حتى ينغلق، أو بترتيب الكتب فوقه أو بمسارعة أحدهم لتعطيل أبي عن الدخول.
لازمت أمي وهي ترفو، كانت تظل تحرك أصابعها في الهواء فوق الجزء الذي سترفوه، وتتحدث مع نفسها بصوت عالٍ عن أفضل جانب تمرر منه الإبرة، وعن الخطأ المحتمل لو سلك الخيط هذا الاتجاه أو ذاك، وضرورة أن يمتد مع خيوط النسيج ولا يتقاطع معها، وكثيرًا ما رأيتها سارحة في شاشة التلفزيون تحرك يدها كأنها ما زالت ترفو. وتبادلنا الابتسام حينما ظن أبي أنها تسبح على أصابعها فناولها سبحته حتى لا تخطئ في العدد. استغرقت عملية الرفو أسبوعًا، أكثرت فيه أمي من الدعاء بألَّا ينتبه أبي لما يحدث. وظل القلق ينتابنا جميعًا حينما يستغرق في حكي ذكريات يذكر فيها الصندوق أو الأوراق داخله ولو بشكل عابر. وأبدى سعادته بإنصاتنا له مهما طال حكيه، وعدم تذكيره بسماعنا هذه الحكايات من قبل. وكنت مثل إخوتي أنصت له مترقبًا انفجار غضبه، ومعاقبتنا جميعًا لتواطئنا عليه.
كررت أمي تحذيري من فتح الصندوق أو لمسه. والأفضل اعتباره غير موجود. وظلت فترة طويلة الشخص الوحيد الذي يفتحه في غياب أبي، لتتفرج الجارات على دقة رفوها، وتضحك حينما يفشلن في العثور على موضع الرفو، وتشرح لهن بالتفصيل الطريقة التي اتبعتها، وتحذرهن من ارتكاب أخطاء كادت تقع فيها كما لو أن لدى كل منهن صندوقًا تمزقت بطانته. وفجأة تتوقف عن الكلام، وتغلق الغطاء ضاغطة عليه عدة مرات، ونسارع كلنا ومعنا الجارة بمساعدتها، وإعادة الكتب كما كانت قبل أن يفتح أبي باب الشقة.

بواسطة سعيد الكفراوي - كاتب مصري | مارس 1, 2017 | قضايا
 لكل كاتب حسه بالأماكن، يصغي لحديثها وذكرياتها، ويستدعيها!! يسطر دون ارتعاش، قصصًا عنها، ويتخيل رؤى. وأنت تحاول، على قدر الطاقة تحقيق قيمة لما تراه، وتطرح من خلال السؤال تلو السؤال باحثًا عن صورة وذكرى، والإصغاء لصوت يجيء عابرًا السنين، وعن أناس كانوا هنا يومًا، ومضوا حيث وجه الكريم، فيما تثبّت الصور حركة مجتمع على مستويات عدة: الحوادث والثقافة والفنون وحياة الناس. والمقهى في تاريخ مصر المحروسة ذاكرة الحكايات، وشاهدًا على متغيرات الدنيا، وملاذًا لبعضهم عبر رفقة قد تطول من الشباب حتى الرحيل. والمقهى في كل تجلياته يمثل بعضًا من تاريخ الوطن الوجداني. أندهش وأنا أقلب صفحات من زمن مضى، وأتأمل جوهر المكان، وصفحات روّاده، ودوره المتميز في تكوين ذاكرة الوطن السياسية والاجتماعية والثقافية، والاحتفاظ في أحيان كثيرة بمجريات الأمور ولو من كل عام يوم!!
لكل كاتب حسه بالأماكن، يصغي لحديثها وذكرياتها، ويستدعيها!! يسطر دون ارتعاش، قصصًا عنها، ويتخيل رؤى. وأنت تحاول، على قدر الطاقة تحقيق قيمة لما تراه، وتطرح من خلال السؤال تلو السؤال باحثًا عن صورة وذكرى، والإصغاء لصوت يجيء عابرًا السنين، وعن أناس كانوا هنا يومًا، ومضوا حيث وجه الكريم، فيما تثبّت الصور حركة مجتمع على مستويات عدة: الحوادث والثقافة والفنون وحياة الناس. والمقهى في تاريخ مصر المحروسة ذاكرة الحكايات، وشاهدًا على متغيرات الدنيا، وملاذًا لبعضهم عبر رفقة قد تطول من الشباب حتى الرحيل. والمقهى في كل تجلياته يمثل بعضًا من تاريخ الوطن الوجداني. أندهش وأنا أقلب صفحات من زمن مضى، وأتأمل جوهر المكان، وصفحات روّاده، ودوره المتميز في تكوين ذاكرة الوطن السياسية والاجتماعية والثقافية، والاحتفاظ في أحيان كثيرة بمجريات الأمور ولو من كل عام يوم!!
لقد ظلت المقاهي في تاريخ مصر الاجتماعي أحد تجليات أحوال الوطن، وركنًا لثقافته، وورشة لتجريب الكتابة، والتعرف على الجديد، وتكوين الرأي، والمكان الأسمى لتبادل الحوار والأفكار، وممارسة لعبة السياسة، وأكثر الأماكن حرية للفضفضة، بل ظلت طوال تاريخه مختبرًا لعلائق القيم في المجتمع. وظلت المقاهي جزءًا من سياق تاريخي واجتماعي وسياسي وثقافي كان دائمًا ما يعطي المدينة حكاياتها وأساطيرها، ويغذي مشاعرها، ويفجر بداخلها السؤال.
ليس هذا قاصرًا عليها، ولا على بعض عواصم العرب، ولكن العلاقة تشمل العديد من عواصم العالم. مقهى «الفلور» في باريس تفجرت على كراسيه حركات أدبية وفنية، وشهد من حوادث السنين الكثير، وجلس على طاولاته سارتر، وسيمون دي بفوار، وألبير كامو، وأندريه مالرو، وفوكو، وأنجزت على طاولاته أهم المذاهب الفلسفية، وأفكار الحداثة، كما جلس زعماء؛ مثل: لينين، وتروتسكي، وسيزان، وبيكاسو، وفيكتور هوغو، وهيمنغواي، كل منهم له مقهاه الذي عشقه، وأنجز على كراسيه درة أعماله مستبدلين بذائقة الفن والكتابة ذائقة جديدة وحداثية. كيف أثرت المقاهي التي جلس عليها نجيب محفوظ في وعيه وذاكرته الإبداعية ليكتب ما كتب حتى انتهى الأمر بأحدهم في شهادة عنه، حيث قال: إنه لا يوجد مقهى في مدينة القاهرة لم يجلس عليه نجيب محفوظ.
تاريخ حافل
 ولمصر تاريخ حافل مع المقهى. يشهد عليها رفة النرد، وصوت أم كلثوم، والقعدة تحت تكعبية شجر في الظل الوارف تحت ليل رهيف. فمنذ عرفت مصر المقهى، في عام 1750م، منذ اكتشاف القهوة، حيث جمعت المسامرين والروّاد وفرق خيال الظل والشعراء الشعبيين وأهل السياسة، والمضروبين بالغرام، وفي مساحة مكانه أنشدت على الربابة السيرة الهلالية، والظاهرية، وحكايات الشطار والعيّاق، وحكايات من ألف ليلة وليلة، وفي بعض المقاهي غنت الجواري أعذب الشعر، وأجمل الأدوار، وفي موالد الأولياء أقيمت المقاهي على عجل في خلاء العاصمة، والمدن الريفية، في حضرة أسيادنا شيوخ الطرق، والمضروبين بالشفاعة، وعشاق النبي، والمقهى دائرة من نور ومسامرة.
ولمصر تاريخ حافل مع المقهى. يشهد عليها رفة النرد، وصوت أم كلثوم، والقعدة تحت تكعبية شجر في الظل الوارف تحت ليل رهيف. فمنذ عرفت مصر المقهى، في عام 1750م، منذ اكتشاف القهوة، حيث جمعت المسامرين والروّاد وفرق خيال الظل والشعراء الشعبيين وأهل السياسة، والمضروبين بالغرام، وفي مساحة مكانه أنشدت على الربابة السيرة الهلالية، والظاهرية، وحكايات الشطار والعيّاق، وحكايات من ألف ليلة وليلة، وفي بعض المقاهي غنت الجواري أعذب الشعر، وأجمل الأدوار، وفي موالد الأولياء أقيمت المقاهي على عجل في خلاء العاصمة، والمدن الريفية، في حضرة أسيادنا شيوخ الطرق، والمضروبين بالشفاعة، وعشاق النبي، والمقهى دائرة من نور ومسامرة.
وفي تاريخ مصر تميزت مقاهٍ، واشتهرت في بلاد الله، وحج إليها القاصي والداني، واحتلت في ذاكرة التاريخ مكانًا، ولها الفضل بما قدمته من خدمة، للمعارف من أدوار ثقافية وسياسية واجتماعية، عشت طرفًا منها، وشكلت بعضًا من الذاكرة، بالطرائف والحوادث.
قهوة «متاتيا» في ميدان إبراهيم باشا، في قلب القاهرة، تحيطها حديقة الأزبكية بروّادها من الأفاضل: شيوخ، وأفنديات، وأساتذة عائدون من بعثاتهم في بلاد الإفرنج، حيث كان يجلس الثائر السيد جمال الدين الأفغاني يوزّع السعوط بيمينه، ويشعل الثورة بشماله، وحوله يجلس الأفاضل الشيخ محمد عبده، وسعد زغلول، وعبدالله النديم، ومحرر المرأة قاسم أمين، ولحق بهم الشابان العقاد والمازني وغيرهما، متكلمين في الثورة، طارحين سؤال الاجتهاد في الدين، وحركة الاستنارة والتمدن، وحق الإنسان في التعليم والمشاركة السياسية، وعلاقته بما يجري في الدنيا من معرفة وعلوم، ويناقشون نتائج ما جرى للثورة العرابية، ممهدين الطريق لتبزغ شمس ثورة 1919م المصرية، فيما يصدرون جريدتهم الغراء «العروة الوثقى» التي تبنت أفكار الأفغاني ومحمد عبده في التغيير والاستقلال، وفي لحظات الصفاء ينطق صوت عبده الحامولي بالغناء فيمتد الليل حتى آخره.
قريبًا من مقهى «متاتيا» شرفة «الإنتركونتننتال» حيث تجلس فرقة «الأوبرا» الخديوية في انتظار تقديم موسمها الجديد على مسرحها. وبالقرب يقع كــــافــــيــــــه وحـــــديــــقــــــة «جروبي» حيث يجلس أمير الشعراء شوقي بك، وتلميذه الشاب محمد عبدالوهاب، المطرب الصاعد. وفي الجوار مقهى ركس وروّاده من فناني المسرح ينتظرون أن ينفتح شارع عماد الدين بالنور حتى يبدأ الشيخ سلامة حجازي وجورج أبيض ويوسف وهبي والريحاني وفاطمة رشدي وأمينة رزق والأخوان رياض وأعضاء الفرقة القومية أعمالهم المسرحية، ينتظرون على مقاهٍ تزدحم بالأقليات من كل جنس وملة، فتختلط اللغات واللهجات في مدينة تعيش تمدنها وغناها حيث تعقد الندوات الثقافية وتلقى الأشعار، وفي شارع عماد الدين تتجلى صورة شارع بيغال في فرنسا بأضوائه ومغانيه.
حوار حول القيمة

تعقد بالمقاهي ندوات الثقافة والأدب. بها تختلط تيارات السياسة، مع برامج الأحزاب، والشعار هو «الاستقلال التام أو الموت الزؤام». كان مقهى عبدالله بالجيزة يمثل طليعة للكتابة منذ الخمسينيات، ويؤمه رواده: عبدالقادر القط ورجاء النقاش وطيب الذكر الناقد أنور المعداوي والمحاور الساخر الذي لا ينسى محمود السعدني.
في وسط المدينة يقع مقهى «ركس» وقريبًا منه كازينو «صفية حلمي» الشهير وفيه يجلس نجيب محفوظ وشكري عياد وعبدالمحسن طه بدر وسليمان فياض والأديب الناشئ جمال الغيطاني. حوار حول القيمة، وحضور لمنجز الغائبين، والذاكرة معرفة بما قاله نيتشه: «نحن لا نتحرر إلا من خلال الذاكرة»، وفن الرواية تطل شمسه من خلال ما قاله الأديب الشاب نجيب محفوظ: «بأنها الشكل الذي يمثل شغف الإنسان الحديث بالحقائق وحنانه القديم للخيال». والقاهرة في حينها مدينة مزدهرة بتمدنها، واحتضانها لقضايا الفكر والمعرفة، مفتوحة الأبواب أمام المغضوب عليهم في بلادهم، وكنت طوال مشوارك ترى المغاربة والمشارقة، وأغرب الأجناس يحتلون كراسي مقاهيها، وأنا عرفت ورأيت الشاعر العراقي عبدالوهاب البياتي في مقهى «لابس»، والشاعر السوداني، شاعر إفريقيا محمد الفيتوري، والشاعر الفلسطيني معين بسيسو «على مقهى ريش» يرتل الشعر وسط أفراد جيله من الشعراء والفنانين. عشت ردحًا من زمان أجوب مقاهي المثقفين، وأبحث عنهم، بحثًا عن الألفة والمسامرة، والتعرف على مدارس الأدب وسمّاره، وكان مقهى «إيزافيتش» حيث تعرفت على الأبنودي وسيد حجاب وخليل كلفت وغيرهم، حتى ألقاني البحث إلى مقهى «ريش».
صحبني إليه أول مرة في عام 1966م الروائي جمال الغيطاني، وهناك التقيت أفراد هذا الجيل: عبدالحكيم قاسم وأمل دنقل ومحمد عفيفي مطر ويحيى الطاهر عبدالله وعمنا عبدالفتاح الجمل من فتح الأبواب أمام هؤلاء. التقيتهم في ندوة كان يقيمها نجيب محفوظ على المقهى. والمقهى هو مقهى «ريش» العتيد. أنشئ في عام 1908م في ميدان طلعت حرب، منتصف المدينة، أسسه رجل نمساوي من الأقليات التي كانت تزدحم بها مصر، ثم باعه ليوناني، الذي باعه لمصري طيب هو عبدالملاك أفندي خليل. لم يكن للمقهى صورته الحالية، وكانت تحيط به حديقة تطل على الميدان، وكانت به فرقة أوركسترالية، كما أن ثوار ثورة 19 كانوا يجلسون عليه، لقد غنت في حديقته الصغيرة «أم كلثوم» مرتدية العقال والغترة، وأنشدت في ذلك الوقت مدائحها الدينية وقصائدها الشعرية.
كان هذا المقهى تجسيدًا لخيال من جلس عليه من الفنانين، وتكونت على طاولاته كثير من مدارس الفنون والأدب، السوريالية المصرية عبر رمسيس يونان وجورج حنين، وكان المكان المختار لكتاب روز اليوسف، فزاره صلاح جاهين وجورج البهجوري وكامل زهيري والشاعران صلاح عبدالصبور وحجازي وغيرهما.
شاهد على زمن مضى
 مقهى «ريش» العتيد، بصوره من الفنانين والكتاب وأشيائه المعلقة على جدرانه يؤكد أنه كان شاهدًا على زمن ماض باذخ الغنى، وعلامة على مرحلة مرت بها الليبرالية المصرية. شهد هذا المقهى حوادث لا تنسى وقعت على طاولاته وأركانه معارك الشباب واختلافاتهم التي قال عنها يومًا نجيب محفوظ: «كانوا يتعاركون ويتصايحون ثم في اليوم التالي تراهم قادمين يتأبطون أذرعتهم». وعلى طاولات هذا المقهى كتبت البيانات والاحتجاجات ضد تجاوزات السلطة، منها ما أطلقنا عليه بيان توفيق الحكيم ضد السادات في أول حكمه. ومنه خرجت أول مسيرة يقودها يوسف إدريس حينما اغتالت إسرائيل غسان كنفاني، الكاتب والمناضل الفلسطيني، وسارت مسيرة الاحتجاج في شوارع وسط البلد في زمن كان قانون الطوارئ يمنع أي مسيرات. كان المكان بؤرة لمقاومة سياسة الانفتاح والتطبيع مع العدو، وصعود نجم الإسلام السياسي وجماعاته التي انتهى أمرها لممارسة الإرهاب فيما بعد.
مقهى «ريش» العتيد، بصوره من الفنانين والكتاب وأشيائه المعلقة على جدرانه يؤكد أنه كان شاهدًا على زمن ماض باذخ الغنى، وعلامة على مرحلة مرت بها الليبرالية المصرية. شهد هذا المقهى حوادث لا تنسى وقعت على طاولاته وأركانه معارك الشباب واختلافاتهم التي قال عنها يومًا نجيب محفوظ: «كانوا يتعاركون ويتصايحون ثم في اليوم التالي تراهم قادمين يتأبطون أذرعتهم». وعلى طاولات هذا المقهى كتبت البيانات والاحتجاجات ضد تجاوزات السلطة، منها ما أطلقنا عليه بيان توفيق الحكيم ضد السادات في أول حكمه. ومنه خرجت أول مسيرة يقودها يوسف إدريس حينما اغتالت إسرائيل غسان كنفاني، الكاتب والمناضل الفلسطيني، وسارت مسيرة الاحتجاج في شوارع وسط البلد في زمن كان قانون الطوارئ يمنع أي مسيرات. كان المكان بؤرة لمقاومة سياسة الانفتاح والتطبيع مع العدو، وصعود نجم الإسلام السياسي وجماعاته التي انتهى أمرها لممارسة الإرهاب فيما بعد.
أستعيد تاريخ المكان، زمنه وأيامه، بعد أن تغيرت الدنيا واختلف الزمان، وغابت رفقة الحلم: أمل دنقل ونجيب سرور ومحمد عفيفي مطر وإبراهيم أصلان وغيرهم، وعاد المقهى بعد صياغته لكنه مقهى آخر هجره روّاده، ورحل من صنعوا بهجته وتاريخه في الثقافة المصرية ومثلوا زمنًا ربما لن يعود!!

بواسطة محمود قرني - شاعر و كاتب مصري | مارس 1, 2017 | كتب
تعرض النقد، تحت وطأة الرغبة في العلمية والمعملية وتعزيز فكرة التخصص تحت أسر المدارس الشكلانية، إلى درجات مروعة من الاستغلاق والتعسف. وأظن أن كتاب «التمثل الثقافي» للناقد والأكاديمي الدكتور سامي سليمان أستاذ النقد الحديث بجامعة القاهرة، يفتح كوة هائلة في هذا الجدار، رغم أنه يعد واحدًا ممن عملوا بوعي على استخدام كثير من تقنيات النقد الشكلاني، وهي مرونة جديرة بالتأمل. كتاب «التمثل الثقافي وتلقي الأنواع الأدبية الحديثة» حسب عنوانه الفرعي يتناول تجربة النقد العربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد صدر قبل أشهر قليلة عن مكتبة الآداب بالقاهرة.
الإحيائيون الذين تناول الكتابُ مجهوداتهم الفذة لم يكونوا وحدهم من يصارع تراثًا تليدًا حاولوا الفكاك من أسره ونجحوا في ذلك، وبات بين أيدينا اليوم ثمرات ناضجة لجهودهم بينها كل الأشكال الإبداعية الوافدة على الثقافة القومية؛ مثل: الرواية، والمسرحية، والمقالة، والقصة، وفنون النثر عامة. أيضًا سامي سليمان هنا يصارع أمواجًا عاتية من التقاليد الجامعية البالية ومن درجات من الاستنامة إلى أشكال نقدية مستقرة سيكون العمل على مغايرتها عملًا صعبًا ويحتاج إلى جسارة من نوع خاص. فأدوات التطوير التي ساعدت الإحيائيين الأوائل كما يشير المؤلف، سواء كانت المطبعة أو الصحافة أو المؤسسات التعليمية والاجتماعية، تبدو الآن وهي تلعب أحطّ الأدوار ضد كل جادّ وكل جديد.
يرى الدكتور سليمان أن أطروحة الدكتور عبدالله الغذامي في عام 2000م حول النقد الثقافي كانت بداية حقيقية لانطلاق ما يسميه دراسات النسق الثقافي أو الأنساق الثقافية في الممارسة الأدبية بحيث أصبحت الممارسة النقدية تسعى إلى قراءة النص عبر بعديها الجمالي والثقافي. والحقيقة أن التأصيل العميق لهذا النسق يتعزز اليوم بشكل علمي شديد الدقة والتماسك في كتاب التمثل الثقافي، وظني أن أطروحة الدكتور الغذامي، بطبيعة الحال، متأثرة أشد التأثر بالمصطلح الغربي. فمصطلح الدراسات الثقافية صعد إلى السطح منذ سبعينيات القرن الماضي على ما يشير «آرثر إيزابرغر» وتحديدًا في مركز الدراسات الثقافية في جامعة برمنغهام. وقد تبدت قدرة الدراسات الثقافية المرنة والمتجددة عبر قدرتها على إعادة قراءة كثير من النظريات الاجتماعية والنقدية وإعادة توظيفها أيضًا؛ مثل: الماركسية والبنيوية والحركات الاجتماعية على نحو عام.
 هنا يقدم الدكتور سامي سليمان إجابته المدعومة بالفحص العلمي عن سؤال مركزي هو: كيف يمكن للغة الجمالية أن تجعل من النصوص الأدبية خطابًا ثقافيًّا متميزًا في ذاته ومتميزًا في علاقته بالثقافات الأخرى، وعبر هذا المفهوم تناول المؤلف العديد من الخطابات الثقافية التي يمكن أن تكون نتاجًا لإعادة النظر في مفردات مؤثرة؛ مثل: الثقافة الشعبية وخطابات الحياة اليومية والخطابات السائدة في وسائل الإعلام، وأظن أن النماذج التطبيقية التي قدمها المؤلف لا تقتصر قراءتها هنا على الرؤية النظرية وهي كثيرة ومتاحة بل على الجانب التطبيقي، وأظن أن إشاراته وتحليله الضافي لأسباب انتشار طبعات مختصرة ومحققة من ألف ليلة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يبدو إعادة اعتبار للقيمتين الأخلاقية والثقافية للثقافة الشعبية. توقف الدكتور سامي سليمان أمام مشروع الإحيائيين وعدّ حركة الإحياء ظاهرة مصرية شامية بامتياز، وعبر تحليل دقيق وضع الصراع الاجتماعي والسياسي في اعتباره، حيث يرى أن حركة الإحياء استندت إلى مقترحين أساسيين: أولهما الإحياء، وثانيهما التمدن. ولأن النقد الثقافي ممارسة وليس فرعًا من فروع نظريات المعرفة فقد عاد الدكتور سامي إلى تقديم قراءة جديدة في نظرية التلقي لا سيما لدى «هانز روبرت ياوس» و«فولفانغ إيزر» من واقع أن تلقي الأنواع الحديثة عمومًا في الثقافة العربية اعتمد على نظرية التلقي في جذرها الغربي وليس على ما ذهبت إليه القراءات البلاغية في النقد العربي القديم والوسيط. وهنا تجدر الإشارة إلى المحاولات المستمرة لسليمان لخلق معادلات مصطلحية ومفاهيمية لتعزيز النسق الثقافي الذي يخدم الثقافة القومية؛ ما يعزز بدوره فكرة التمثل الثقافي في الوجود، والقبول لدى القطاعات الواسعة من القراء الضمنيين الذين يستهدفهم.
هنا يقدم الدكتور سامي سليمان إجابته المدعومة بالفحص العلمي عن سؤال مركزي هو: كيف يمكن للغة الجمالية أن تجعل من النصوص الأدبية خطابًا ثقافيًّا متميزًا في ذاته ومتميزًا في علاقته بالثقافات الأخرى، وعبر هذا المفهوم تناول المؤلف العديد من الخطابات الثقافية التي يمكن أن تكون نتاجًا لإعادة النظر في مفردات مؤثرة؛ مثل: الثقافة الشعبية وخطابات الحياة اليومية والخطابات السائدة في وسائل الإعلام، وأظن أن النماذج التطبيقية التي قدمها المؤلف لا تقتصر قراءتها هنا على الرؤية النظرية وهي كثيرة ومتاحة بل على الجانب التطبيقي، وأظن أن إشاراته وتحليله الضافي لأسباب انتشار طبعات مختصرة ومحققة من ألف ليلة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يبدو إعادة اعتبار للقيمتين الأخلاقية والثقافية للثقافة الشعبية. توقف الدكتور سامي سليمان أمام مشروع الإحيائيين وعدّ حركة الإحياء ظاهرة مصرية شامية بامتياز، وعبر تحليل دقيق وضع الصراع الاجتماعي والسياسي في اعتباره، حيث يرى أن حركة الإحياء استندت إلى مقترحين أساسيين: أولهما الإحياء، وثانيهما التمدن. ولأن النقد الثقافي ممارسة وليس فرعًا من فروع نظريات المعرفة فقد عاد الدكتور سامي إلى تقديم قراءة جديدة في نظرية التلقي لا سيما لدى «هانز روبرت ياوس» و«فولفانغ إيزر» من واقع أن تلقي الأنواع الحديثة عمومًا في الثقافة العربية اعتمد على نظرية التلقي في جذرها الغربي وليس على ما ذهبت إليه القراءات البلاغية في النقد العربي القديم والوسيط. وهنا تجدر الإشارة إلى المحاولات المستمرة لسليمان لخلق معادلات مصطلحية ومفاهيمية لتعزيز النسق الثقافي الذي يخدم الثقافة القومية؛ ما يعزز بدوره فكرة التمثل الثقافي في الوجود، والقبول لدى القطاعات الواسعة من القراء الضمنيين الذين يستهدفهم.
في هذا السياق حرص ناقدنا على تقديم قراءة مقارنة ضافية حول فكرتي التمثل والتلاؤم عند جان بياجيه، ثم قدم قراءة لتفرقة بياجيه بين التمثل الثقافي والمعرفة من ناحية أن المعرفة ذات طبيعة تطورية وتاريخية، غير أنه يشير إلى أن بياجيه كان يقدم عبر تلك الدراسات المهمة رؤية لسيكولوجية الأطفال بينما حديثه يواجه أعمالًا إبداعية ناضجة لكتاب تجاوزوا الرشد.
كذلك يتوقف ناقدنا أمام آليات انتقال النظريات بين الثقافات موضحًا معضلات ذلك الانتقال وصعوباته، وأولها حاجة الثقافة الناقلة لما تنقل، وإدراك الجماعة الناقلة لأهمية ما تنقل وضرورته، وفي فصول لاحقة كشف أيضًا عن أشكال المقاومة التي تبديها الثقافة القومية في تكويناتها المحافظة ضد كل الأشكال الطليعية ذات النزعة التجديدية. ولأن المؤلف يقف باعتبار كبير أمام الثقافة القومية فقد توقف أمام ما قاله إدوارد سعيد حول نسبية النظريات المنقولة سواء في سياقات تولدها ونشأتها في الثقافة المصدرة أو الثقافة المستقبلة لا سيما إذا كانت تلك النظريات تنتقل إلى سياقات ثقافية ذات طابع شمولي. لكن سليمان لا يترك إدوارد سعيد قبل أن يبدي ملاحظة دقيقة حول قراءته لتلك الفكرة حيث إنه عندما حلل نظرية التشيؤ لدى جورج لوكاتش إنما فعل ذلك ضمن سياق ثقافي واحد وأيضًا مع مفكرين ضمن اتجاه فكري واحد هو الماركسية.
يرصد المؤلف أيضًا كيف تولدت الحاجة لدى المستعمرات القديمة في الشرق العربي للتجدد والأخذ عن الآخر، وباتت الأنواع الأدبية الحديثة تصارع السياقات البلاغية القديمة؛ كالخطابة والمقامة، وكذلك الشعر الغنائي الذي يمثل أعلى تعبيرات الرسوخ والقوة في الثقافة العربية، غير أن المؤلف يؤكد أن رعيل الإحيائيين التجديدين كانوا الأكثر إدراكًا لحتمية فكرة التمثل الثقافي، وكان ثمة ضرورة لنقل الأنواع الأدبية الجديدة كموضوعات لهذا التمثل، وهنا يقدم المؤلف تعريفًا دقيقًا لما يعنيه بفكرة التمثل الثقافي بوصفها «المسالك الذهنية التي يتخذها أو يعتمد عليها أبناء ثقافة ما في سعيهم للاستفادة من نتاج ثقافي قدمته حضارة أخرى» وهو في النهاية، كما يشير ما يُخضِع المفاهيم القارة في الثقافة القومية لعدد من التحولات بتعظيم مفاهيم جديدة وإقصاء مفاهيم أخرى وهو ما حدث بالفعل.
وكما يشير ناقدنا ويشير كتابه تستمد فكرة التمثل الثقافي أطرها العامة من الدراسات الثقافية التي تتخذ من البحث عن الأدوار الاجتماعية والسياسية منطلقًا عامًّا لها من منطلق أن علم الاجتماع والتاريخ والدراسات الأدبية تقدم مناهج ملائمة لفهم الثقافة، وقد منح هذا التعدد الفرصة للنقد كي يتناول موضوعات وقضايا كانت مستبعدة من الدراسات التقليدية، ولا ينسى المؤلف هنا أن يشير إلى أن إحدى مشكلات تلك الدراسة هو قلق المصطلح النقدي وتغاير مواقف بعض النقاد إزاء المفاهيم والقضايا التي كانت موضع اهتمامهم.
يثير المؤلف الدكتور سامي سليمان عددًا من الإشكاليات حول العقبات الثقافية التي قابلت جهد الإحيائيين واضطرارهم إلى الاتكاء على الموروث الشعري والنقدي العربيين كطريق إلى تحقيق جوهر الإحياء في سعي صادق ودؤوب للارتقاء بالتقاليد الجمالية والثقافية لنماذج قديمة، ويقدم لنا نموذجين على ذلك التحول عبر تجربتي أحمد فارس الشدياق وأحمد شوقي، ويتوقف أمام مقدمة ديوان الشدياق، وكيف أعلى من قيمة الإقبال على الأشكال الإبداعية المستحدثة لا سيما النثر، وكذلك ما فعل شوقي في نثره وكتاباته حول الانحياز لفكرة السرد حتى لو كانت داخل القالب الغنائي مثلما فعل مع قراءته لرائية أبي فراس «أراك عصي الدمع شيمتك الصبر». لقد تحول الشاعر، كما يقول سليمان، من كونه منتجًا لبلاغة قديمة ليتشكل وعي جديد لنموذج الشاعر الكاتب، ولم أفهم هنا لماذا وصف سليمان تجربة تحديث الكتابة لدى شوقي بأنها لم تؤت ثمارها، رغم أنه في الحقيقة قدم منجزًا إحيائيًّا نادرًا وفذًّا في الشعر وتحديدًا في الشعر الغنائي.
لكن المؤلف في النهاية يؤكد أن «الشدياق» و«شوقي» عززا فكرة الحاجة إلى تعديل مفهوم الفصاحة الموروث من التراث البلاغي، وهو الأمر الذي عزز عدة قيم توقف عندها المؤلف، من بينها أن الإحيائيين استطاعوا وضع الكتابة كمفهوم قبل الخطابة والشعر حيث وضعهما النقد المحافظ في المقدمة، وكذلك تعظيم قيمة الثقافة التدوينية على الثقافة الشفهية.

بواسطة أحمد أبو خنيجر - كاتب مصري | ديسمبر 27, 2016 | الملف

إدريس علي
في أواخر الثمانينيات من القرن المنصرم ظهرت مجموعة من التجليات الإبداعية، ذات الصوت المميز والمختلف عما هو سائد في حقل السرد المصري والعربي آنذاك، جاعلة من النوبة في جنوب مصر فضاءها السردي والتعبيري، منشغلة بهموم النوبة وأحلامها، وأزمة الهوية التي تمثل العصب الرئيس في ذلك المجتمع المنعزل، والقابع في الجنوب بعيدًا عن الاهتمام من العاصمة المركزية القاهرة، فجاءت كتابات: إبراهيم فهمي، ويحيى مختار، وإدريس علي، وحسن نور، وحجاج حسن أدول، متابعة لما كان استهله محمد خليل قاسم في روايته الرائدة في تاريخ السرد العربي: الشمندورة. التي نشرت في عام 1968م.
إذ بدت الرواية «الشمندورة» صرخة مبكرة لما حاق بأهل النوبة من غرق وتهجير وترك للوطن عقب تعلية الخزان الثانية في عام 1932م. ربما كانت تداعيات ذلك التهجير القسري الذي طال بعض القرى النوبية في ذلك الزمن البعيد مستمدة من حالة التهجير الثانية مع بناء السد العالي جنوب مدينة أسوان في عام 1964م. التي عاصرها وعايشها الكاتب، التي ستطول كل القرى النوبية؛ لكن كتابنا الجدد ربما كان بعضهم بدايات شبابه في زمن التهجير الثاني، وهو ما جعل توجهات الكتابة مختلفة، وإن لم تبتعد كثيًرا من الهم العام لأهالي النوبة.
أقلية عرقية
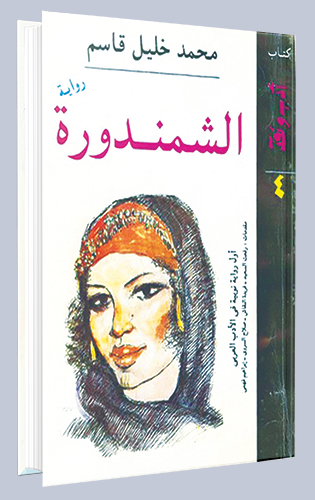 تمثل النوبة أقلية عرقية وثقافية داخل المجتمع المصري، وذلك من حيث منظومة القيم التي تتبناها الجماعة النوبية، ويبدو ذلك واضحًا وجليًّا في الملامح والسمات للشخصية النوبية من حيث اللون وامتلاك لغة خاصة، هي اللغة النوبية، وغير ذلك من المحددات؛ فجاءت واقعة التهجير، وغرق أراضي النوبة عند بناء السد العالي كنكبة حاقت بالمجتمع النوبي، لتصير تلك الواقعة هي النقطة المركزية التي تتمحور حولها أغلب الكتابات الأدبية التي أنتجها أبناء النوبة الذين أشرنا إليهم سابقًا، فواقعة الغرق وحلم العودة لذلك الفردوس المفقود، كما يراه أبناء النوبة، والحنين للبلاد البعيدة الضائعة تحت مياه بحيرة السد العالي ستكون أكثر النغمات ترددًا داخل لحن الكتابة النوبية، في محاولة جادة منها للتمسك بالهوية النوبية، ومقاومة الاندثار والذوبان داخل المجتمع المصري، وهو ما دفع بعضهم لاتهامات تصل للعنصرية ومترادفاتها المتعددة. وعلى رغم وجاهة القضية وجدارتها بالعرض والتحليل، وهو ما فعله أغلب الكتاب النوبيين، إلا أن إدريس علي وقف موقفًا مغايرًا من كل الكتابات التي اتخذت من النوبة مسرحًا لها، إذ بدت عينه تنظر إلى بنية هذا المجتمع المغلق، وترى معوقاته الداخلية، قبل أن يصب اللوم على الخارج الشمال، وهو ما جلب له كثيرًا من المصاعب والمتاعب، كما أنه هو السبب نفسه الذي جلب له الشهرة والذيوع، وترجمة أعماله الأدبية، ونيل الجوائز المرموقة عنها.
تمثل النوبة أقلية عرقية وثقافية داخل المجتمع المصري، وذلك من حيث منظومة القيم التي تتبناها الجماعة النوبية، ويبدو ذلك واضحًا وجليًّا في الملامح والسمات للشخصية النوبية من حيث اللون وامتلاك لغة خاصة، هي اللغة النوبية، وغير ذلك من المحددات؛ فجاءت واقعة التهجير، وغرق أراضي النوبة عند بناء السد العالي كنكبة حاقت بالمجتمع النوبي، لتصير تلك الواقعة هي النقطة المركزية التي تتمحور حولها أغلب الكتابات الأدبية التي أنتجها أبناء النوبة الذين أشرنا إليهم سابقًا، فواقعة الغرق وحلم العودة لذلك الفردوس المفقود، كما يراه أبناء النوبة، والحنين للبلاد البعيدة الضائعة تحت مياه بحيرة السد العالي ستكون أكثر النغمات ترددًا داخل لحن الكتابة النوبية، في محاولة جادة منها للتمسك بالهوية النوبية، ومقاومة الاندثار والذوبان داخل المجتمع المصري، وهو ما دفع بعضهم لاتهامات تصل للعنصرية ومترادفاتها المتعددة. وعلى رغم وجاهة القضية وجدارتها بالعرض والتحليل، وهو ما فعله أغلب الكتاب النوبيين، إلا أن إدريس علي وقف موقفًا مغايرًا من كل الكتابات التي اتخذت من النوبة مسرحًا لها، إذ بدت عينه تنظر إلى بنية هذا المجتمع المغلق، وترى معوقاته الداخلية، قبل أن يصب اللوم على الخارج الشمال، وهو ما جلب له كثيرًا من المصاعب والمتاعب، كما أنه هو السبب نفسه الذي جلب له الشهرة والذيوع، وترجمة أعماله الأدبية، ونيل الجوائز المرموقة عنها.
بدأ إدريس كتاباته القصصية بعيدًا من حقل النوبة قبل أن يتحول كلية للكتابة عنها، فكانت: المبعدون، وواحد ضد الجميع. تأمل العنوان، لتدرك ما هو قادم من أعمال، وما سيكون بمنزلة النغمة المحورية التي تقود اللحن، فقط تنويعات هنا وهناك، بشكل مختلف تأخذ قالبها لتصير عملًا جديدًا؛ إن فكرة الإبعاد والتهميش داخل نسق الحياة، لأي سبب، وجعلك هامشيًّا وغير مرغوب فيك في أغلب الأوقات، هو أن تقف وحدك، مع روحك وذاتك، ضد العوامل التي تعمل على إبعاد الإنسان وتهميشه، بدءًا من الأفكار العنصرية الأولى للقبيلة والجماعة، والأفكار الطبقية بكل تجلياتها، والنفي المتعمد داخل الوطن وخارجه، ضد القيم السلبية التي يجري التكريس لها، وجعل قانونها هو السائد، بكلمات أقل: أن تقف بعيدًا، خارج الصف، والسطر والطابور، فأنت تحديدًا مبعد ضد الجميع في الوقت نفسه.
استهل إدريس علي رواياته النوبية بالرواية الفاتنة «دنقلة» في عام 1994م، وبقدر ما جرّت عليه هذه الرواية من مشكلات وتهديدات عصبية بالقتل، لكنها أيضًا جاءت بالشهرة والجوائز والترجمة، وهو ما بدا نوعًا من التعويض النفسي والمعنوي، فآخر ما كان يبتغيه إدريس علي هو الفضائحية، لكنه كان يشير إلى مواطن الخلل، ويحث على التبصر بالأخطاء العنصرية لدى الجماعة، التي تتصور أنها نقية وخالية من العيوب، حتى إن وجدت هذه العيوب الراسخة في الطبيعة الإنسانية، فيجب عليه – هكذا تتصور القبيلة والجماعة – أن يقوم بسترها، وعدم التعرض لها، وهو ما كان يراه نوعًا من الهشاشة وعدم الفهم وقبول النقد الذاتي، بل الإصرار على بقاء حالة النقاء المزعومة، وعدم الاعتراف حتى لو بين الجماعة أنفسهم، بأنه يمكن معالجة الأخطاء عقب التعرف والإقرار بوجودها وعدم التنكر لها؛ ذلك ما سوف يكمله أيضًا في متتالياته النوبية: النوبي، واللعب فوق جبال النوبة، وتحت خط الفقر. في كل مرة يرفع الغطاء قليلًا عما هو مسكوت عنه ومتواطأ عليه، وجعله من الأسرار التي تخص الجماعة، وهو ما لا يرضاه إدريس علي، فهو لا يرى أنها جماعة مختلفة، فقط بسبب ظروف خاصة مرت بتجربة مختلفة، لكن حول الادعاءات العرقية والعصبية، فهو ضدها على طول الخط.
اللعب فوق جبال النوبة
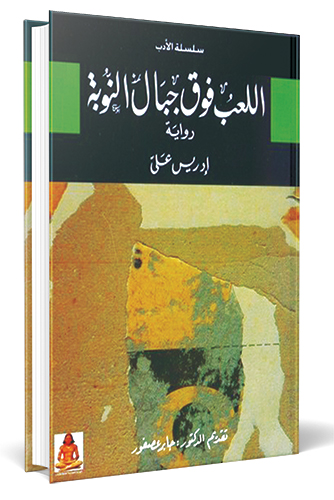 في رواية «اللعب فوق جبال النوبة» يعكس إدريس علي اللعبة الروائية، فغادة الشابة المولدة من أب نوبي وأم قاهرية يرسلها والدها إلى الجنوب، قريته النوبية القابعة في حضن الجبل متسربلة بعاداتها وتقاليدها القديمة، تلك القرية الهاجعة التي لا يحرك ركودها سوى مركب البوسطة كل أسبوعين، تصل غادة للقرية مبعدة من القاهرة ذات الأفق المفتوح والحياة السريعة وشديدة التبدل، يرسلها والدها كعقاب لها على حبها أحد شباب الحارة التي تقطنها أسرة ذلك النوبي الذي هاجر للشمال في حياته الباكرة بحثًا عن الرزق ولقمة العيش، وهناك تزوج من أم غادة، لكنه كنوبي أصيل سيرفض أن تتزوج ابنته من رجل ليس نوبيًّا، فالنوبية لا تتزوج إلا من نوبي، هكذا العادات، أما الرجل فيحق له أن يتزوج من غير النوبيات، وهو ما تراه غادة، ابنة المدينة، مجحفًا وتمييزًا ضدها، مجبرة تبعد للجنوب، لتقلب سكون القرية البعيدة والمنسية والمهملة رأسًا على عقب، وهو ما سوف يستفز حراس الجمود والتقاليد البالية، والويل كل الويل لمن يحاول أن يغير من تلك العادات أو يخترقها، ستكون حياته هي ثمن جرأته هذه، كما حدث مع غادة.
في رواية «اللعب فوق جبال النوبة» يعكس إدريس علي اللعبة الروائية، فغادة الشابة المولدة من أب نوبي وأم قاهرية يرسلها والدها إلى الجنوب، قريته النوبية القابعة في حضن الجبل متسربلة بعاداتها وتقاليدها القديمة، تلك القرية الهاجعة التي لا يحرك ركودها سوى مركب البوسطة كل أسبوعين، تصل غادة للقرية مبعدة من القاهرة ذات الأفق المفتوح والحياة السريعة وشديدة التبدل، يرسلها والدها كعقاب لها على حبها أحد شباب الحارة التي تقطنها أسرة ذلك النوبي الذي هاجر للشمال في حياته الباكرة بحثًا عن الرزق ولقمة العيش، وهناك تزوج من أم غادة، لكنه كنوبي أصيل سيرفض أن تتزوج ابنته من رجل ليس نوبيًّا، فالنوبية لا تتزوج إلا من نوبي، هكذا العادات، أما الرجل فيحق له أن يتزوج من غير النوبيات، وهو ما تراه غادة، ابنة المدينة، مجحفًا وتمييزًا ضدها، مجبرة تبعد للجنوب، لتقلب سكون القرية البعيدة والمنسية والمهملة رأسًا على عقب، وهو ما سوف يستفز حراس الجمود والتقاليد البالية، والويل كل الويل لمن يحاول أن يغير من تلك العادات أو يخترقها، ستكون حياته هي ثمن جرأته هذه، كما حدث مع غادة.
وإذا كان مبررًا بعض الشيء قبول تلك العنصرية التي يكاد يكون مفهوم مبرراتها والتي يعاني منها المجتمع النوبي، ونظرة الناس له وطريقة التعامل معه، لكن إدريس علي يضرب بعيدًا حيث العنصرية جزء أصيل من كيان الإنسان أيما كان لونه أو دينه ووعيه وثقافته؛ فالمجتمع الذي يعاني العنصرية الخارجية، هو في حقيقة الأمر أشد عنصرية، فنظرة القرية لغادة الجميلة هي في نظرهم «نصف بغلة»، ذلك أن أمها غير نوبية، ومن ثم وحسب هذا التصنيف تصبح أقل درجة منهم، ولا يحق لها أن تتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها غيرها، في الوقت نفسه لا يمكنها أن تتزوج بعيدًا من الحقل النوبي، وبطبيعة الحال لا يمكنها أن تمارس الحرية التي كانت تمارسها في المدينة، حقها في الاختيار والانتقاء للشخص الذي سيتزوج بها، الأدهى من كل هذا لو جهرت برأيها أو فعلها كما كانت تفعل ذلك في المكان الذي قدمت منه؛ يحسب لإدريس علي تلك اللغة البسيطة الدالة والموحية التي صاغ بها عالم الرواية من خلال عين الصبي الذي كأنه الكاتب في زمن بعيد في تلك القرية البعيدة والمهملة، وسوف تغرقها مياه بحيرة السد بعد مدة من الزمن.




 لكل كاتب حسه بالأماكن، يصغي لحديثها وذكرياتها، ويستدعيها!! يسطر دون ارتعاش، قصصًا عنها، ويتخيل رؤى. وأنت تحاول، على قدر الطاقة تحقيق قيمة لما تراه، وتطرح من خلال السؤال تلو السؤال باحثًا عن صورة وذكرى، والإصغاء لصوت يجيء عابرًا السنين، وعن أناس كانوا هنا يومًا، ومضوا حيث وجه الكريم، فيما تثبّت الصور حركة مجتمع على مستويات عدة: الحوادث والثقافة والفنون وحياة الناس. والمقهى في تاريخ مصر المحروسة ذاكرة الحكايات، وشاهدًا على متغيرات الدنيا، وملاذًا لبعضهم عبر رفقة قد تطول من الشباب حتى الرحيل. والمقهى في كل تجلياته يمثل بعضًا من تاريخ الوطن الوجداني. أندهش وأنا أقلب صفحات من زمن مضى، وأتأمل جوهر المكان، وصفحات روّاده، ودوره المتميز في تكوين ذاكرة الوطن السياسية والاجتماعية والثقافية، والاحتفاظ في أحيان كثيرة بمجريات الأمور ولو من كل عام يوم!!
لكل كاتب حسه بالأماكن، يصغي لحديثها وذكرياتها، ويستدعيها!! يسطر دون ارتعاش، قصصًا عنها، ويتخيل رؤى. وأنت تحاول، على قدر الطاقة تحقيق قيمة لما تراه، وتطرح من خلال السؤال تلو السؤال باحثًا عن صورة وذكرى، والإصغاء لصوت يجيء عابرًا السنين، وعن أناس كانوا هنا يومًا، ومضوا حيث وجه الكريم، فيما تثبّت الصور حركة مجتمع على مستويات عدة: الحوادث والثقافة والفنون وحياة الناس. والمقهى في تاريخ مصر المحروسة ذاكرة الحكايات، وشاهدًا على متغيرات الدنيا، وملاذًا لبعضهم عبر رفقة قد تطول من الشباب حتى الرحيل. والمقهى في كل تجلياته يمثل بعضًا من تاريخ الوطن الوجداني. أندهش وأنا أقلب صفحات من زمن مضى، وأتأمل جوهر المكان، وصفحات روّاده، ودوره المتميز في تكوين ذاكرة الوطن السياسية والاجتماعية والثقافية، والاحتفاظ في أحيان كثيرة بمجريات الأمور ولو من كل عام يوم!! ولمصر تاريخ حافل مع المقهى. يشهد عليها رفة النرد، وصوت أم كلثوم، والقعدة تحت تكعبية شجر في الظل الوارف تحت ليل رهيف. فمنذ عرفت مصر المقهى، في عام 1750م، منذ اكتشاف القهوة، حيث جمعت المسامرين والروّاد وفرق خيال الظل والشعراء الشعبيين وأهل السياسة، والمضروبين بالغرام، وفي مساحة مكانه أنشدت على الربابة السيرة الهلالية، والظاهرية، وحكايات الشطار والعيّاق، وحكايات من ألف ليلة وليلة، وفي بعض المقاهي غنت الجواري أعذب الشعر، وأجمل الأدوار، وفي موالد الأولياء أقيمت المقاهي على عجل في خلاء العاصمة، والمدن الريفية، في حضرة أسيادنا شيوخ الطرق، والمضروبين بالشفاعة، وعشاق النبي، والمقهى دائرة من نور ومسامرة.
ولمصر تاريخ حافل مع المقهى. يشهد عليها رفة النرد، وصوت أم كلثوم، والقعدة تحت تكعبية شجر في الظل الوارف تحت ليل رهيف. فمنذ عرفت مصر المقهى، في عام 1750م، منذ اكتشاف القهوة، حيث جمعت المسامرين والروّاد وفرق خيال الظل والشعراء الشعبيين وأهل السياسة، والمضروبين بالغرام، وفي مساحة مكانه أنشدت على الربابة السيرة الهلالية، والظاهرية، وحكايات الشطار والعيّاق، وحكايات من ألف ليلة وليلة، وفي بعض المقاهي غنت الجواري أعذب الشعر، وأجمل الأدوار، وفي موالد الأولياء أقيمت المقاهي على عجل في خلاء العاصمة، والمدن الريفية، في حضرة أسيادنا شيوخ الطرق، والمضروبين بالشفاعة، وعشاق النبي، والمقهى دائرة من نور ومسامرة.
 مقهى «ريش» العتيد، بصوره من الفنانين والكتاب وأشيائه المعلقة على جدرانه يؤكد أنه كان شاهدًا على زمن ماض باذخ الغنى، وعلامة على مرحلة مرت بها الليبرالية المصرية. شهد هذا المقهى حوادث لا تنسى وقعت على طاولاته وأركانه معارك الشباب واختلافاتهم التي قال عنها يومًا نجيب محفوظ: «كانوا يتعاركون ويتصايحون ثم في اليوم التالي تراهم قادمين يتأبطون أذرعتهم». وعلى طاولات هذا المقهى كتبت البيانات والاحتجاجات ضد تجاوزات السلطة، منها ما أطلقنا عليه بيان توفيق الحكيم ضد السادات في أول حكمه. ومنه خرجت أول مسيرة يقودها يوسف إدريس حينما اغتالت إسرائيل غسان كنفاني، الكاتب والمناضل الفلسطيني، وسارت مسيرة الاحتجاج في شوارع وسط البلد في زمن كان قانون الطوارئ يمنع أي مسيرات. كان المكان بؤرة لمقاومة سياسة الانفتاح والتطبيع مع العدو، وصعود نجم الإسلام السياسي وجماعاته التي انتهى أمرها لممارسة الإرهاب فيما بعد.
مقهى «ريش» العتيد، بصوره من الفنانين والكتاب وأشيائه المعلقة على جدرانه يؤكد أنه كان شاهدًا على زمن ماض باذخ الغنى، وعلامة على مرحلة مرت بها الليبرالية المصرية. شهد هذا المقهى حوادث لا تنسى وقعت على طاولاته وأركانه معارك الشباب واختلافاتهم التي قال عنها يومًا نجيب محفوظ: «كانوا يتعاركون ويتصايحون ثم في اليوم التالي تراهم قادمين يتأبطون أذرعتهم». وعلى طاولات هذا المقهى كتبت البيانات والاحتجاجات ضد تجاوزات السلطة، منها ما أطلقنا عليه بيان توفيق الحكيم ضد السادات في أول حكمه. ومنه خرجت أول مسيرة يقودها يوسف إدريس حينما اغتالت إسرائيل غسان كنفاني، الكاتب والمناضل الفلسطيني، وسارت مسيرة الاحتجاج في شوارع وسط البلد في زمن كان قانون الطوارئ يمنع أي مسيرات. كان المكان بؤرة لمقاومة سياسة الانفتاح والتطبيع مع العدو، وصعود نجم الإسلام السياسي وجماعاته التي انتهى أمرها لممارسة الإرهاب فيما بعد.
 هنا يقدم الدكتور سامي سليمان إجابته المدعومة بالفحص العلمي عن سؤال مركزي هو: كيف يمكن للغة الجمالية أن تجعل من النصوص الأدبية خطابًا ثقافيًّا متميزًا في ذاته ومتميزًا في علاقته بالثقافات الأخرى، وعبر هذا المفهوم تناول المؤلف العديد من الخطابات الثقافية التي يمكن أن تكون نتاجًا لإعادة النظر في مفردات مؤثرة؛ مثل: الثقافة الشعبية وخطابات الحياة اليومية والخطابات السائدة في وسائل الإعلام، وأظن أن النماذج التطبيقية التي قدمها المؤلف لا تقتصر قراءتها هنا على الرؤية النظرية وهي كثيرة ومتاحة بل على الجانب التطبيقي، وأظن أن إشاراته وتحليله الضافي لأسباب انتشار طبعات مختصرة ومحققة من ألف ليلة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يبدو إعادة اعتبار للقيمتين الأخلاقية والثقافية للثقافة الشعبية.
هنا يقدم الدكتور سامي سليمان إجابته المدعومة بالفحص العلمي عن سؤال مركزي هو: كيف يمكن للغة الجمالية أن تجعل من النصوص الأدبية خطابًا ثقافيًّا متميزًا في ذاته ومتميزًا في علاقته بالثقافات الأخرى، وعبر هذا المفهوم تناول المؤلف العديد من الخطابات الثقافية التي يمكن أن تكون نتاجًا لإعادة النظر في مفردات مؤثرة؛ مثل: الثقافة الشعبية وخطابات الحياة اليومية والخطابات السائدة في وسائل الإعلام، وأظن أن النماذج التطبيقية التي قدمها المؤلف لا تقتصر قراءتها هنا على الرؤية النظرية وهي كثيرة ومتاحة بل على الجانب التطبيقي، وأظن أن إشاراته وتحليله الضافي لأسباب انتشار طبعات مختصرة ومحققة من ألف ليلة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يبدو إعادة اعتبار للقيمتين الأخلاقية والثقافية للثقافة الشعبية.

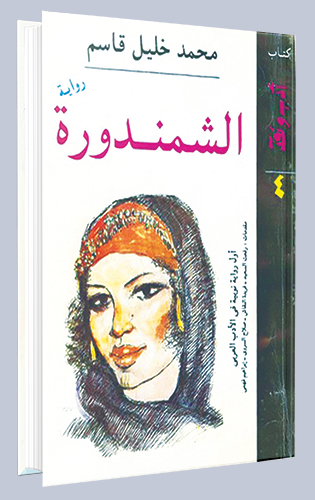 تمثل النوبة أقلية عرقية وثقافية داخل المجتمع المصري، وذلك من حيث منظومة القيم التي تتبناها الجماعة النوبية، ويبدو ذلك واضحًا وجليًّا في الملامح والسمات للشخصية النوبية من حيث اللون وامتلاك لغة خاصة، هي اللغة النوبية، وغير ذلك من المحددات؛ فجاءت واقعة التهجير، وغرق أراضي النوبة عند بناء السد العالي كنكبة حاقت بالمجتمع النوبي، لتصير تلك الواقعة هي النقطة المركزية التي تتمحور حولها أغلب الكتابات الأدبية التي أنتجها أبناء النوبة الذين أشرنا إليهم سابقًا، فواقعة الغرق وحلم العودة لذلك الفردوس المفقود، كما يراه أبناء النوبة، والحنين للبلاد البعيدة الضائعة تحت مياه بحيرة السد العالي ستكون أكثر النغمات ترددًا داخل لحن الكتابة النوبية، في محاولة جادة منها للتمسك بالهوية النوبية، ومقاومة الاندثار والذوبان داخل المجتمع المصري، وهو ما دفع بعضهم لاتهامات تصل للعنصرية ومترادفاتها المتعددة. وعلى رغم وجاهة القضية وجدارتها بالعرض والتحليل، وهو ما فعله أغلب الكتاب النوبيين، إلا أن إدريس علي وقف موقفًا مغايرًا من كل الكتابات التي اتخذت من النوبة مسرحًا لها، إذ بدت عينه تنظر إلى بنية هذا المجتمع المغلق، وترى معوقاته الداخلية، قبل أن يصب اللوم على الخارج الشمال، وهو ما جلب له كثيرًا من المصاعب والمتاعب، كما أنه هو السبب نفسه الذي جلب له الشهرة والذيوع، وترجمة أعماله الأدبية، ونيل الجوائز المرموقة عنها.
تمثل النوبة أقلية عرقية وثقافية داخل المجتمع المصري، وذلك من حيث منظومة القيم التي تتبناها الجماعة النوبية، ويبدو ذلك واضحًا وجليًّا في الملامح والسمات للشخصية النوبية من حيث اللون وامتلاك لغة خاصة، هي اللغة النوبية، وغير ذلك من المحددات؛ فجاءت واقعة التهجير، وغرق أراضي النوبة عند بناء السد العالي كنكبة حاقت بالمجتمع النوبي، لتصير تلك الواقعة هي النقطة المركزية التي تتمحور حولها أغلب الكتابات الأدبية التي أنتجها أبناء النوبة الذين أشرنا إليهم سابقًا، فواقعة الغرق وحلم العودة لذلك الفردوس المفقود، كما يراه أبناء النوبة، والحنين للبلاد البعيدة الضائعة تحت مياه بحيرة السد العالي ستكون أكثر النغمات ترددًا داخل لحن الكتابة النوبية، في محاولة جادة منها للتمسك بالهوية النوبية، ومقاومة الاندثار والذوبان داخل المجتمع المصري، وهو ما دفع بعضهم لاتهامات تصل للعنصرية ومترادفاتها المتعددة. وعلى رغم وجاهة القضية وجدارتها بالعرض والتحليل، وهو ما فعله أغلب الكتاب النوبيين، إلا أن إدريس علي وقف موقفًا مغايرًا من كل الكتابات التي اتخذت من النوبة مسرحًا لها، إذ بدت عينه تنظر إلى بنية هذا المجتمع المغلق، وترى معوقاته الداخلية، قبل أن يصب اللوم على الخارج الشمال، وهو ما جلب له كثيرًا من المصاعب والمتاعب، كما أنه هو السبب نفسه الذي جلب له الشهرة والذيوع، وترجمة أعماله الأدبية، ونيل الجوائز المرموقة عنها.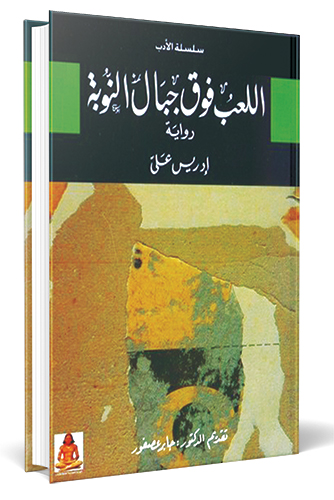 في رواية «اللعب فوق جبال النوبة» يعكس إدريس علي اللعبة الروائية، فغادة الشابة المولدة من أب نوبي وأم قاهرية يرسلها والدها إلى الجنوب، قريته النوبية القابعة في حضن الجبل متسربلة بعاداتها وتقاليدها القديمة، تلك القرية الهاجعة التي لا يحرك ركودها سوى مركب البوسطة كل أسبوعين، تصل غادة للقرية مبعدة من القاهرة ذات الأفق المفتوح والحياة السريعة وشديدة التبدل، يرسلها والدها كعقاب لها على حبها أحد شباب الحارة التي تقطنها أسرة ذلك النوبي الذي هاجر للشمال في حياته الباكرة بحثًا عن الرزق ولقمة العيش، وهناك تزوج من أم غادة، لكنه كنوبي أصيل سيرفض أن تتزوج ابنته من رجل ليس نوبيًّا، فالنوبية لا تتزوج إلا من نوبي، هكذا العادات، أما الرجل فيحق له أن يتزوج من غير النوبيات، وهو ما تراه غادة، ابنة المدينة، مجحفًا وتمييزًا ضدها، مجبرة تبعد للجنوب، لتقلب سكون القرية البعيدة والمنسية والمهملة رأسًا على عقب، وهو ما سوف يستفز حراس الجمود والتقاليد البالية، والويل كل الويل لمن يحاول أن يغير من تلك العادات أو يخترقها، ستكون حياته هي ثمن جرأته هذه، كما حدث مع غادة.
في رواية «اللعب فوق جبال النوبة» يعكس إدريس علي اللعبة الروائية، فغادة الشابة المولدة من أب نوبي وأم قاهرية يرسلها والدها إلى الجنوب، قريته النوبية القابعة في حضن الجبل متسربلة بعاداتها وتقاليدها القديمة، تلك القرية الهاجعة التي لا يحرك ركودها سوى مركب البوسطة كل أسبوعين، تصل غادة للقرية مبعدة من القاهرة ذات الأفق المفتوح والحياة السريعة وشديدة التبدل، يرسلها والدها كعقاب لها على حبها أحد شباب الحارة التي تقطنها أسرة ذلك النوبي الذي هاجر للشمال في حياته الباكرة بحثًا عن الرزق ولقمة العيش، وهناك تزوج من أم غادة، لكنه كنوبي أصيل سيرفض أن تتزوج ابنته من رجل ليس نوبيًّا، فالنوبية لا تتزوج إلا من نوبي، هكذا العادات، أما الرجل فيحق له أن يتزوج من غير النوبيات، وهو ما تراه غادة، ابنة المدينة، مجحفًا وتمييزًا ضدها، مجبرة تبعد للجنوب، لتقلب سكون القرية البعيدة والمنسية والمهملة رأسًا على عقب، وهو ما سوف يستفز حراس الجمود والتقاليد البالية، والويل كل الويل لمن يحاول أن يغير من تلك العادات أو يخترقها، ستكون حياته هي ثمن جرأته هذه، كما حدث مع غادة.