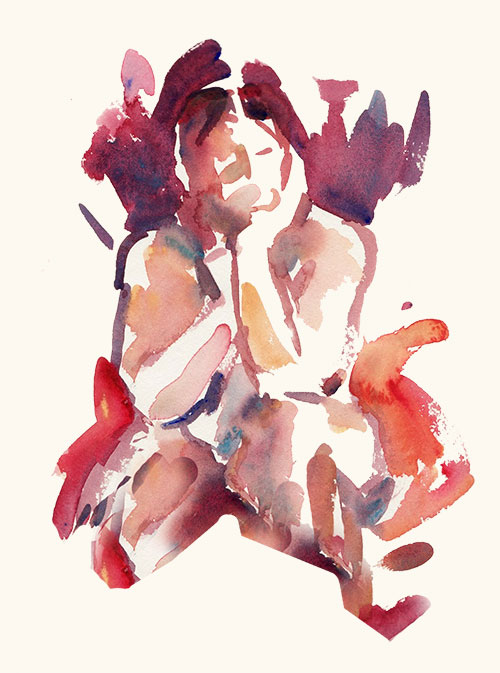موسيقيون شبان يجربون إيقاعات شرقية وغربية

نداء أبو علي
ما بين غياب مؤسساتي ورفض مجتمعي، يسقط الموسيقيون السعوديون في هوّة الاستنكار أو عدم التقدير؛ ما يفضي إلى إحباطات مستمرة، ومحاولات مستميتة تتطلب حفرًا بالأظافر في محاولة لإيجاد أي طريق نحو النجاح، من دون وجود ملامح تصلح لإعطاء أي قبس من الأمل بأن هناك مستقبلًا وتشجيعًا للفن والموسيقا. إنه بمثابة عزف في الظلام، أشبه بمن يصيح بأعلى صوته في فناء يرفض من بداخله الإنصات إلى أي صوت.
في كتاب المفكر والكاتب العراقي علي الشوك: «أسرار الموسيقا»، يقتبس مقولة جون بارو: «لقد وجدت حضارات بلا رياضيات، حضارات بلا رسم، حضارات حرمت من العجلة أو الكتابة، لكن لم توجد حضارة بلا موسيقا». وقد وجد علي الشوك أن الموسيقا ليست نتاج الطبيعة، بل هي من اجتراح الإنسان.
على الرغم من الضعف المؤسساتي في احتضان المواهب الموسيقية أو تعليم الموسيقا عبر المعاهد، يظهر قبس من الاهتمام، عبر جمعيات الثقافة والفنون، كتنظيم الجمعية في الرياض برامج تدريبية ودورات عن المقامات الموسيقية لأول مرة في عام 2012م، وذلك بعد خمس وعشرين سنة من حظر للموسيقا في الجمعية، يتم تعليم العزف على آلة العود والكمان، بهدف دعم المواهب الموسيقية.

بروفيسور أميركية توثق غناء الحجاز
الضعف المؤسساتي يمتد ليصل إلى الافتقار في توثيق ورصد الموسيقا وإبراز الموسيقيين، بدءًا بالتراث والموسيقا الشعبية بشكل أكاديمي دقيق، وانتهاء بالحقبة الحالية التي تكتنفها العشوائية؛ ما يضيع محاولات تتبع ودراسة التطور الموسيقي. في عام 2012م، قامت البروفيسور ليزا أركوفيتش المختصة بالتراث والموسيقا في جامعة بوسطن بزيارة لجمعية الثقافة والفنون بجدة لحضور فعالياتها، ومن ثم قامت بتوثيق للفلكلور الغنائي الحجازي؛ لوضعه في متحف للتراث العالمي في الولايات المتحدة الأميركية الذي يحوي أغلب التراث الإنساني الدولي.
وإذا كان محترفو الموسيقا في الآونة الأخيرة ماهرين في مواكبة العصر، سواء عبر استقاء تقنيات الموسيقا العالمية أو عبر استخدام أفضل الطرائق الإلكترونية للوصول إلى أكبر عدد من المتابعين، إلا أن ذلك لا ينفي حدوث تراجع وتدهور الذائقة للموسيقا، وغياب تلك المرحلة التي كان فيها استخدام الأغاني بالصور الشعرية الرفيعة المستوى. أصبحت الموسيقا تبحث عن استقطاب جماهيري كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يمكّن أي شخص، وإن لم يكن يمتلك إبداعًا موسيقيًّا فعليًّا- لأن يصدح بالغناء للآخرين، ويجد من يسمعه، بدءًا من الفضاء الإلكتروني أو اقتصارًا عليه.
لقد ظهرت محاولات فردية لسد الفجوة المؤسساتية؛ كإنشاء موقع إلكتروني لرابطة الموسيقيين السعوديين؛ لمناقشة المقامات الشرقية والغربية والسلالم الموسيقية، لضمّ الموسيقيين في السعودية والتثقيف الموسيقي، إلا أن الموقع لم يستمر من دون توضيح الأسباب باستثناء وجود خلل فني في قاعدة البيانات؛ الأمر الذي أدى بالجيل الجديد من محترفي الموسيقا إلى الدراسة على حسابهم الخاص خارج الوطن، وهذا امتداد لما قام به الموسيقيون في السابق، أو الغوص في عوالم الإنترنت، وتلقي الدروس عبر برامج كاليوتيوب، أو التواصل مع الآخرين وبث الموسيقا إلكترونيًّا. أصبح الغناء والعزف عبارة عن اجتهادات فردية، يبرز من خلالها عدد من المحترفين في وسط يتفاوت ما بين إنكار تام للموسيقا، أو غياب للذائقة الموسيقية. أما الطراز الموسيقي فشديد التباين وإن كان هناك ميل نحو الموسيقا الغربية ودمجها بالموسيقا المحلية.
فرق موسيقية تدعو إلى السلام
 في عام 2008م شهدنا تجربة فريدة لفرقة أطلقت على نفسها اسم «الفارابي» أسوة بالفيلسوف أبي نصر الفارابي الذي تضمنت رؤاه اعتقادًا بأن الإنسان استحدث الموسيقا تحقيقًا وإيفاء لفطرته التي تدعوه للتعبير عن أحواله وأن ينشد راحته. فرقة الفارابي التي نبعت من مدينة جدة جاءت نتيجة تجربة موسيقية ما بين مثنى عنبر وضياء عزوني، لتستخدم الموسيقا التجريبية مع اقتباس للأمثال والقصائد العربية القديمة لأبي نواس والمتنبي؛ لتمزج ما بين الموسيقا الشرقية والغربية. غناء هذه الفرقة بالفصحى يجعلك تستمع لأبيات من قصائد لأبي نواس مثلًا، فلا تتعجب من مثل: «سأعطيك الرضا، وأموت غمًّا / وأسكت لا أغمّك بالعتاب».
في عام 2008م شهدنا تجربة فريدة لفرقة أطلقت على نفسها اسم «الفارابي» أسوة بالفيلسوف أبي نصر الفارابي الذي تضمنت رؤاه اعتقادًا بأن الإنسان استحدث الموسيقا تحقيقًا وإيفاء لفطرته التي تدعوه للتعبير عن أحواله وأن ينشد راحته. فرقة الفارابي التي نبعت من مدينة جدة جاءت نتيجة تجربة موسيقية ما بين مثنى عنبر وضياء عزوني، لتستخدم الموسيقا التجريبية مع اقتباس للأمثال والقصائد العربية القديمة لأبي نواس والمتنبي؛ لتمزج ما بين الموسيقا الشرقية والغربية. غناء هذه الفرقة بالفصحى يجعلك تستمع لأبيات من قصائد لأبي نواس مثلًا، فلا تتعجب من مثل: «سأعطيك الرضا، وأموت غمًّا / وأسكت لا أغمّك بالعتاب».
في الوقت الذي تتناغم فيه الكلمات مع موسيقا تحوي مزيجًا غرائبيًّا من أوتار العود الكهربائي والغيتار الكلاسيكي والبيانو، وذلك دلالة على التأثر بالتجربة الغربية التي جاءت نتيجة دراسة مثنى في نيو أورلينز وضياء في ليفربول. يظهر ذلك التأثر بالتغريب في نماذج سعودية عديدة كقصي خضر، وهو مغنٍّ سعودي مختص بالراب والهيب هوب، ابتدأ طريقه الغنائي حين سافر لاستكمال دراسته في الولايات المتحدة الأميركية، وتمكن بدءًا من هناك واستكمالًا في مدينة جدة من افتتاح أستوديو، وإنشاء فرقة موسيقية، وإصدار ألبوم موسيقي، فيما يهدف في أغانيه التي تميل للراب إلى نشر السلام.
ومن التجارب الفريدة تجربة الشاب علاء وردي، وهو من أصول إيرانية، ترعرع ودرس في السعودية، ثم انتقل للدراسة الجامعية إلى الأردن ليتعلم التأليف والموسيقا. وقد حاز شعبية في العالمين العربي والتركي، وفي السعودية على وجه الخصوص؛ لاحترافه فن «الأكابيلا» الذي يستعيض فيه عن الآلات الموسيقية بالصوت، كما غرق في العالم الإلكتروني؛ لينشر الموسيقا التي قام بتأليفها وعزفها.
من جهة أخرى، يبزغ محترفون للموسيقا العصرية بدؤوا بتطويرها واحترافها بقالب مختلف؛ كتجربة المنتج والموزع الموسيقي ومنسق الأغاني السعودي عمر باسعد الذي بدأ العزف على الغيتار منذ سن الثانية عشرة، وأكمل دراسته حتى حاز شهادة البكالوريوس في الهندسة الصوتية، وهو يمزج ما بين الموسيقا العربية والغربية الحديثة بطراز «التكنو»، وتم ترشيحه لجائزة «إم تي في» ليعد أول منتج سعودي وعربي يرشح لهذه الجائزة.

فيما ظهرت فرق هواة تسعى لترويج معانٍ إنسانية كالسلام عبر الموسيقا، كفرقة «نغمة السلام» أو «بيس تون باند»، وقد شاركت في مهرجان الفرق المسرحية في الرياض العاصمة في أكتوبر 2015م. هذه الفرقة تجسد الغرق في بيئة لا تقدر مجال الموسيقا؛ إذ تطرَّق قائد الفرقة علي الشيحة في تصاريح عدة لوسائل الإعلام إلى صعوبة التمرس في مجال الموسيقا في ظل عدم وجود عدد كبير من الفعاليات والمهرجانات الثقافية المرتبطة بالموسيقا. وشددت الفرقة على أزمة غياب المعاهد الموسيقية، واضطرارهم لتعلم دروس الموسيقا من خلال الإنترنت واليوتيوب.
هناك أصوات بدأت تصدح بالغناء في الفضاء الخارجي لتصل إلى النجومية عالميًّا، إلا أن المحاولات تعد فردية وأحيانًا عشوائية؛ لذلك هي في حاجة إلى تقنين كبير، ودعم مؤسساتي وتعليمي لاحتضانها؛ ليتمكن المجتمع من التفريق ما بين الجيد والرديء من الموسيقا، وزيادة الوعي وإدراك فحوى الموسيقا المعبرة، والكلمات العميقة التي تعبر عن الهوية المحلية.