
بواسطة حازم صاغية - كاتب لبناني | سبتمبر 1, 2018 | مقالات
تُروى قصّة طريفة عن كيم إيل سونغ، جدّ الحاكم الحاليّ لكوريا الشماليّة كيم جونغ أون، والرجل الذي عاش مهووسًا بتعظيم نفسه وإسباغ الألقاب الفخيمة عليها. فقد استقبل «الزعيم المحبوب من أربعين مليون كوريّ» -حسب أحد ألقابه- وفدًا من صحافيّين لبنانيّين كان على رأسه النقيب الراحل ملحم كرم. ويبدو أنّ «كرم»، الذي كان ضليعًا في الشعر الجاهليّ ومفرداته الغريبة، أراد أن يتسلّى ويسلّي رفاق رحلته: هكذا كتب خطابًا يعجّ بالمصطلحات الجاهليّة المنقرضة ثمّ ألقاه في حضرة الزعيم كيم. لكنّ المترجم الكوريّ الواقف بين الزعيم والنقيب، الذي هو المترجم الرسميّ للأوّل، راح يترجم الخطاب إلى الكوريّة ترجمة فوريّة وسريعة، وهو ما أذهل «كرم» وباقي أعضاء الوفد.

كيم إيل سونغ
في مساء ذاك اليوم، وفي حفل أقيم لتكريم الضيوف اللبنانيّين، لمح ملحم كرم المترجم الكوريّ في طرف القاعة نفسها، فهرع نحوه كي يسأله عن البلد الذي درس العربيّة فيه. لكنّ المفاجأة بدت صاعقة، إذ تبيّن له أنّ المترجم لا يقرأ العربيّة ولا يكتبها، والأهمّ أنّه لا يفهم حرفًا واحدًا منها. فحين أمعن في الاستفهام، شرح له المترجم هذا الأمر الملغز: «إنّني منذ سنوات طويلة أترجم للزعيم من 17 لغة لا أجيد أيًّا منها. إنّني أقول له دائمًا الحقيقةَ، والحقيقةُ هي أنّه الأقوى والأذكى والأشجع والأجمل والأثقف والأحرص على مصالح شعبنا وأمّتنا. أمّا النصّ الذي يلقيه الآخرون وأتولّى ترجمته له فليس مهمًّا بالقياس إلى تلك الحقيقة الخالدة. على هذا النحو ينشرح وجه الزعيم وصدره فيما أمضي أنا في عملي خدمةً للأمّة الكوريّة وزعيمها».

أنور خوجا
مَن روى لي هذه القصّة بادلتُه قصّةً بقصّةٍ سبق لي أن قرأتها عن ألبانيا في ظلّ دكتاتورها الشيوعيّ الراحل أنور خوجا. فآنذاك لم يكن في ذاك البلد إلا جهاز تلفزيونيّ واحد هو الذي يملكه الزعيم خوجا نفسه. هكذا كان المذيع يوجّه كلامه مباشرة إليه كلّما ظهر على الشاشة: «مساء الخير، حضرة الزعيم الموقّر أنور خوجا. إنّ برامجنا اليوم تدور كلّها حول نضالك العنيد من أجل إسعاد ملايين الألبان وتعزيز السِّلْم العالميّ».
قصص كهذه، وهناك المئات منها، تُضحكنا بالتأكيد. لكنْ حين نتذكّر أنّ هؤلاء الأشخاص يحكمون بلدانًا ويتحكّمون بحياة وموت الملايين ينقلب الضحك إلى غصّة عميقة. ونحن نعلم كيف أنّ في وسع حاكم مستبدّ واحد أن يحجب بلدًا بكامله وكامل ملايينه. هكذا يقال مثلًا: «سوريا الأسد»، كما لو أنّ حافظ الأسد أو ابنه «بشّار» يختصران كلّ شيء فوق هذه الرقعة الجغرافيّة ذات المساحة التي تتجاوز الـ 185 ألف كيلومتر مربّع، كان يقطنها «قبل تهجير نصفهم» 23 مليونًا من البشر. الشيء نفسه يمكن قوله عن التاريخ، حيث يتحوّل الحاكم المستبدّ إلى عصارة لعشرات السنوات، وأحيانًا مئاتها. ذاك أنّ الحقب الزمنيّة التي سبقت كانت عاقرًا لا تنجب رجالًا ونساء يستحقّون الذكر! فالوجوه والرموز الذين حكموا قبل الانقلاب العسكريّ لم يولدوا أصلًا ولم يوجدوا قطّ!
لقد سبق لشارلي شابلن، عام 1940م، أن سخر في فيلمه الشهير «الدكتاتور العظيم»، من دكتاتوريّي ذاك الزمن، ولا سيّما منهم أدولف هتلر، أو أدينويد هِنكل كما أسماه. هكذا علّمنا كيف نسخر ممّن لا نملك في وجوههم إلا السخرية، وممّن يخافون من السخرية كما يخافون الطاعون. فهي تكسر الوقار والتراتُب والجدّيّة التي يُفترَض بالأتباع أن يعاملوا الزعيم بموجبها، كما تكسر تقديسه المزعوم والمفروض بقوة الخوف لتردّه شخصًا عاديًّا تثير أفعاله الضحك.

شارلي شابلن، في فلم «الدكتاتور العظيم»
والحقّ أنّ السخرية انبثقت من الاعتراض. فأوائل الكوميديّين السياسيّين نشطوا سرًّا خوفًا من انتقام الحاكم الجائر. وهم عبر منشورات ورسوم مطبوعة توزّع سرًّا، نبّهوا الجمهور الأوسع إلى مسألة الحرّيّة. ومعروفٌ، مثلًا، أنّ الثورة الأميركيّة تدين بأحد أسبابها للسخرية التي دفعت بعض «الوطنيّين» من طلاب الاستقلال لأن يرسموا ويكتبوا ما يثير الهزء بـ«الموالين» الذين حافظوا على ولائهم للإمبراطوريّة البريطانيّة، وصولًا إلى اجتذاب قطاعات أعرض من الرأي العام. لكنّ شارلي شابلن نفسه صرّح لاحقًا، وتحديدًا في 1960م، بأنّه ما كان ليصنع فلم «الدكتاتور العظيم» لو أنّه كان على بيّنة من أفعال هتلر الرهيبة. ففي 1940م كانت الحرب العالميّة الثانية في بداياتها، ولم تكن المحرقة قد نُفّذت بعد. ذاك أنّ المعرفة بضخامة الجريمة لا تترك أيّ مجال للضحك حتّى لو كان ضحكًا على دكتاتور تافه. أمّا بعض الذين وافقوا شابلن على رأيه فاعتبروا أنّ مَن نضحك عليه أو نسخر منه ينبغي أن يمتلك ولو حدًّا أدنى من الإنسانيّة، وإلا بات الضحك في غير مكانه.
وقصارى القول: إنّ هذا الصنف من الطغاة قد يحرمنا حتّى الضحك عليه في سرّنا، بينما نبادله الهديّة بهديّة أخرى مفادها أنّه لا يستحقّ أن نضحك عليه.

بواسطة حازم صاغية - كاتب لبناني | مارس 16, 2016 | كتاب الفيصل, مقالات
للأمكنة، كلّ الأمكنة، روائح. وليس جديدًا، لا في الحياة ولا في الأدب، أن نستذكر وجوهًا وحالات تمتّ إلى ماضينا البعيد، من خلال روائح نبّهتنا صدفٌ عابرة إلى أنّنا لا نزال نحملها فينا. لكنْ إذا كانت القرى والأرياف تزخر بروائح طبيعيّة يقول الأطبّاء: إنّها مفيدة للصدر وللتنفّس، وربّما لأعضاء أخرى في الجسد ولوظائف أخرى، فإنّ المدن تطالعنا بنوع آخر من الروائح. فهنا، تتجاور النفايات الملوّثة والتلويث الصناعيّ، بما فيه ذاك الصادر عن اهتلاك الآلات القديمة، لتضعنا أمام نتائج يصعب وصفها بالصحّيّة أو بالنفع.
مع ذلك، وعلى رغم هذه المنغّصات جميعًا، فأنا منحاز بقوّة إلى العيش في المدن. فالروائح الطيّبة في القرى لا تستطيع أن تحلّ محلّ البشر الذين يندر وجودهم هناك. أمّا الروائح السيّئة في المدن فلا تحجب عنّا حيويّة تلك المدن وحركة البشر والأفكار التي تضجّ بها. وانحيازي هذا إلى المدينة هو ما جعل صديقي حسن يتّهمني بأنّني أسعى إلى «خراب بيته»: فهو يملك منزلًا جميلًا في الريف، إلّا أنّ إلحاحي على ضرورة أن يتخلّص منه ويشتري بيتًا في المدينة، وحرصه على استمرار صداقتنا، جعلاه يبحث عن أيّ مُشترٍ، حتّى لو دفع له ما يقلّ عن سعر البيت العادل.
على أيّة حال، بالغتْ بيروت في امتحان قدرتي على التحمّل، كما لو أنّني «العاشق الوحيد» الذي رثتْ حالَه أغنية محمّد عبدالوهاب الشهيرة.
فأنا أقمت في شطري بيروت، الغربيّ والشرقيّ، اللذين اكتسبا تسميتهما هاتين إبّان «حرب السنتين» في أواسط السبعينات، فانطوى كلّ منهما على معنى طائفيّ ودلالة سياسيّة معيّنين. والإقامة في الشطرين معًا لا تنمّ فحسب عن حبّ صاحبها لبيروت، بل هي في نظر كثيرين تعبير عن وطنيّة متعالية على الهوى الطائفيّ الضيّق.
لكنّ ما حصل لي لا يشجّع مُحبّي المدن كما لا يشجّع مُحبّي الأوطان. ففي الأشرفيّة، الواقعة في الشرق، اخترت شقّة في الطابق الأوّل من البناية. ولسوء الحظّ اكتشفت بعد الانتقال إليها أنّ هناك مصبغة تقيم تحتها في الطابق الأرضيّ. وحين تقال كلمة «مصبغة»، في هذا السياق، لا يكون المقصود فعل التنظيف بل فعل التوسيخ. ذاك أنّ الروائح الكيماويّة التي كانت تنبعث منها كانت تتجاوز توسيخ بيتنا إلى توسيخ صدورنا. وهي معضلة دائمة لا يخفّفها تحوّل الطقس وتغيّراته: فإذا هبّ علينا الهواء هبّت هذه الروائح معه قويّةً عاصفةً، وإذا انحبس الهواء واضطررنا إلى فتح الأبواب كنّا كمن يفتح ذراعيه لملاقاة هذه الرائحة اللئيمة.
وكنت أقول: إنّ الروائح الكيماويّة أسوأ من الروائح الطبيعيّة، ليس فقط لأنّها أكثر إضرارًا بالصحّة، بل أيضًا لأنّها أصعب على التعقّل والفهم، فضلًا عن كونها غير مألوفة نهائيًّا. وأذكر ذات مرّة أنّني قرأت مقالًا لواحد من عتاة البيئويّين بهذا المعنى، مستخلصًا أنّ الرأسماليّة الصناعيّة لن يهدأ لها بال قبل أن تودي بنا جميعًا إلى التهلكة. وأحيانًا، وفي محاولة منّي للتحايل على مأساتي، كنت أقول لنفسي: هذا طبيعيّ، وأولئك البيئويّون المتطرّفون هم كمن يطالبنا بألّا نأكل كي لا نُضطرّ إلى دخول بيت الخلاء. لكنّني لا ألبث أن أتذكّر أنّ الأمور عندنا ليست على هذا النحو بتاتًا. فنحن في بلد كلبنان، إنّما نحصد التلوّث من دون أن نجني أفضال الصناعة، بحيث يقتصر أمر «تقدّمنا» على تنظيف بعض القمصان والسترات لزبائن المصبغة!
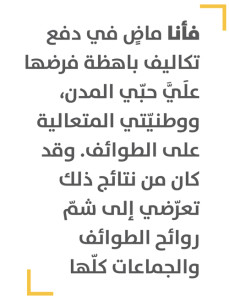 بيد أنّني حين انتقلت إلى منطقة الحمرا، في الشطر الغربيّ من العاصمة، بدأت، لسبب آخر، أعيد النظر بتلك الأفكار البالغة العداء للروائح الكيماويّة. فهنا وقعت على شقّة لطيفة في حيّ بالغ الحيويّة لا تبارحه الحركة ليلًا ولا نهارًا. فوق هذا، تحتلّ الشقّة الجديدة الطابق الخامس من البناية، نائيةً بنفسها عن الموبقات التي قد تأتي من الطريق العامّ وجلبته. وهي أيضًا شديدة التعرّض للضوء الذي يكاد ينفجر فيها انفجارًا؛ لأنّ فجوات عمرانيّة واسعة تحيط بها، وهذا ما تزداد ندرته في بيروت التي نكاد لا نرى سماءها؛ بسبب المباني الشاهقة المتكاثرة.
بيد أنّني حين انتقلت إلى منطقة الحمرا، في الشطر الغربيّ من العاصمة، بدأت، لسبب آخر، أعيد النظر بتلك الأفكار البالغة العداء للروائح الكيماويّة. فهنا وقعت على شقّة لطيفة في حيّ بالغ الحيويّة لا تبارحه الحركة ليلًا ولا نهارًا. فوق هذا، تحتلّ الشقّة الجديدة الطابق الخامس من البناية، نائيةً بنفسها عن الموبقات التي قد تأتي من الطريق العامّ وجلبته. وهي أيضًا شديدة التعرّض للضوء الذي يكاد ينفجر فيها انفجارًا؛ لأنّ فجوات عمرانيّة واسعة تحيط بها، وهذا ما تزداد ندرته في بيروت التي نكاد لا نرى سماءها؛ بسبب المباني الشاهقة المتكاثرة.
لكن المشكلة تكمن بالضبط هنا. فالطبيعة لا تمنحنا الشمس فحسب، بل تمنحنا أيضًا رائحة المجارير التي تهبّ علينا بين فينة وأخرى هبوبًا ساحقًا ماحقًا، وإن كان لا يدوم طويلًا. ولا بدّ أنّ الأمر الكريه هذا ناشىء عن فساد البنى التحتيّة التي لم تُجدّد بما يجعلها تواكب التحوّلات السكّانيّة وحاجاتها المتعاظمة. ولربّما زاد في تفاقم المشكلة ما عُرف به لبنان مؤخّرًا لجهة عجزه عن جمع نفاياته وتصريفها، أو إعادة تدويرها بشكل مفيد.
وكائنًا ما كان الدور الذي اضطلعت به المعالجات السياسيّة والاقتصاديّة السيّئة، يبقى أنّ روائح المجارير طبيعيّة جدًّا، وأكاد أقول: إنّها جزء لا يتجزأ من ثقافة شعب بعينه ومن تعاطيه مع مألوفاته وما هو حميم فيه. ولست هنا بحاجة إلى الاستشهاد بعلم النفس، خصوصًا علم نفس الأطفال ممّن لا يكتمون تعلّقهم بأسوأ ما تفرزه أجسادهم.
لكنْ لا هذا يحلّ المشكلة ولا ذاك. فأنا ماضٍ في دفع الأكلاف الباهظة التي رتّبها عليّ حبّي للمدن، ومعه وطنيّتي المتعالية على الطوائف. وقد كان من نتائج ذلك تعرّضي لشمّ روائح الطوائف والجماعات كلّها التي تقيم في المدينة، بالصناعيّ منها وما قبل الصناعيّ.
لهذا، ومن دون أن أقرّ علنًا بذلك، أضبط نفسي أحيانًا مُوافقًا صديقي الشابّ ماهرًا أفكاره. فماهر قرّر، قبل سنوات عدّة، أن يلوذ بالقرية، وأن يعتبرها حصنًا يعتصم به أمام زحف المدينة المتعاظم. فإذا ما اضطرّه ظرف بالغ الاستثنائيّة أن يفد إلى بيروت، عامل نفسه كأنّه أسير حرب لا يحظى بحرّيّته إلّا حين يقفل راجعًا إلى القرية.
والمؤكّد أنّ رئتي ماهر أنظف ألف مرّة من رئتيّ. لكنّني مُصرّ على ألّا أقول هذا الكلام، لا لحسن ولا لماهر، وأن أمضي متنقّلًا بين طوائف مدينتي وروائحها.






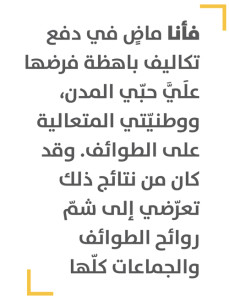 بيد أنّني حين انتقلت إلى منطقة الحمرا، في الشطر الغربيّ من العاصمة، بدأت، لسبب آخر، أعيد النظر بتلك الأفكار البالغة العداء للروائح الكيماويّة. فهنا وقعت على شقّة لطيفة في حيّ بالغ الحيويّة لا تبارحه الحركة ليلًا ولا نهارًا. فوق هذا، تحتلّ الشقّة الجديدة الطابق الخامس من البناية، نائيةً بنفسها عن الموبقات التي قد تأتي من الطريق العامّ وجلبته. وهي أيضًا شديدة التعرّض للضوء الذي يكاد ينفجر فيها انفجارًا؛ لأنّ فجوات عمرانيّة واسعة تحيط بها، وهذا ما تزداد ندرته في بيروت التي نكاد لا نرى سماءها؛ بسبب المباني الشاهقة المتكاثرة.
بيد أنّني حين انتقلت إلى منطقة الحمرا، في الشطر الغربيّ من العاصمة، بدأت، لسبب آخر، أعيد النظر بتلك الأفكار البالغة العداء للروائح الكيماويّة. فهنا وقعت على شقّة لطيفة في حيّ بالغ الحيويّة لا تبارحه الحركة ليلًا ولا نهارًا. فوق هذا، تحتلّ الشقّة الجديدة الطابق الخامس من البناية، نائيةً بنفسها عن الموبقات التي قد تأتي من الطريق العامّ وجلبته. وهي أيضًا شديدة التعرّض للضوء الذي يكاد ينفجر فيها انفجارًا؛ لأنّ فجوات عمرانيّة واسعة تحيط بها، وهذا ما تزداد ندرته في بيروت التي نكاد لا نرى سماءها؛ بسبب المباني الشاهقة المتكاثرة.