
«النجدي» لطالب الرفاعي.. بين التخييل والتاريخ
تنتمي رواية «النجدي» لطالب الرفاعي إلى طريقة جديدة في تناول الحدث التاريخي استنادًا إلى ممكنات التخييل السردي، لا إلى حقيقة سجلها التاريخ. وهي صيغة سردية تستمد عوالمها من وقائع تاريخية بشخصياتها وزمانها وفضائها من دون أن تُصنف مع ذلك ضمن التاريخ. إنها تُعيد إلى هذا التاريخ، عبر التخييل، بعضًا من «دفء الحياة» لا يمكن أن تكشف عنه سوى جزئيات وتفاصيل لا تندرج عادة ضمن اهتمامات المؤرخ. وهي بذلك تنزاح عن التاريخ؛ لأنها لا تلتزم بما دُوِّن فيه من وقائع، ولكنها لا تستطيع خلاصًا من زمنية محددة بمرجعية لا يمكن تجاهلها. فالنص لا يُخفي انتماءه إلى عوالم التخييل، كما يؤكد ذلك التحديد الجنسي في الغلاف: «رواية»، ولكنه وثيق الصلة أيضًا بحياة شخصية من الواقع تتمتع بوجود ضمن ساكنة معدودة، كما هو مثبت في السجلات المدنية الكويتية، ولها وجود في الذاكرة الوطنية كما يشير إلى ذلك أيضًا التاريخ الكويتي المعاصر الخاص بالتجارة البحرية ومغامرات صيد اللؤلؤ. فعلي بن ناصر النجدي كان من كبار النَّواخِذة في تاريخ الملاحة الكويتية، قبل أن تتنفس صحراء الكويت نفطًا، وتتراجع الرغبة عند أهله في ركوب السفن، وسيموت في حادث غرق مأساوي في البحر سنة 1979م، كما توقع هو نفسه، وكما تُؤكد ذلك الرواية في بداية الحلم «تعال»، وفي نهايتها حين يصرّح النجدي وهو يموت بتشبثه بالبحر: «مؤكد أنك تريدني… لن أفارق البحر».
هناك، في الظاهر على الأقل، نفس تأريخي صريح، كما يوهم بذلك الاسم، ولكن هذه الغاية لا تتحقق في الرواية إلا من خلال الانزياح عن التصنيف التاريخي الذي يكتفي بالمعنى الكلي في حياة الشخصية على حساب ما يمكن أن تقوله حياتها الفعلية. فلكي تستقيم «أنا» النجدي في الرواية، كان عليها أن تتخلص من «النحن» التي تحضر عبر مصفاتها تقلبات التاريخ الكويتي كله. ومن هذه الزاوية فقط، ستكون الرواية محاولة للمصالحة بين «الوهم السيري» وبين «يقين التاريخ»، مما يقتضي التخلص من الحكم القيمي العام، واستعادة مناطق في الذات تستعصي على الضبط، فهي موجودة في ما يفصل بين الحقيقة والتخييل؛ ومن خلال موقعها ذاك، فإنها تحتضن سلسلة من الوقائع التي لم تُرْو قط، أو رُويت على هامش الدفق الزمني المعتاد في حياة الفرد (النجدي) أو الجماعة (كل النواخذة).
فرصة النجدي الأخيرة
وقد تكون هذه الاستعادة هي فرصة النجدي الأخيرة لكي يكتب تاريخه الخاص بضمير «البوح» من دون وساطة محفل سردي آخر يختفي وراء ضمير غائب عادة ما يُسرب المعرفة خارج هوى الذات الفاعلة ورغباتها. فالذات، وبوابتها الرئيسة الأنا، هي سيل من الرغبات والميولات والإحباطات، وهي أيضًا أسيرة قدرها العقدي والثقافي أيضًا، لذلك لا يمكن أن تحيا إلا في السرد، فالحكاية هي الحارس الأمين للزمن، كما يقول ريكور. إن السرد فيها يُحيي ويُميت ما يشاء من الرجال والنساء. لقد حرمه التاريخ من ذكرياته فاستعادتها الرواية من خلال قصة في الحياة لا من خلال موقع في زمنية عابرة. انطلاقًا من هذه «الحاجات» السردية المضافة يمكن استيعاب حالات التراكب بين سرد يُؤرخ للحظة «واقعية» لا تحتفظ من فعل الفاعل سوى بمضمونه «الخام»، وهو ما يعود إلى علي النجدي النوخذة في التاريخ، وبين حكايات «مفصلة» تُبنى في الاستيهام التخييلي، وهي القصة التي ترويها «الأنا» في الرواية عن نفسها، أو ترويها لقارئ مفترض تُعد عوالم التخييل عنده أشد إقناعًا من حقيقة التاريخ، فهي مجموع الصفات التي لم يدونها المؤرخ أو لا تشكل عنده مصدرًا للحقيقة. فالنجدي «كيان صامت» في نصوص التاريخ، أما في الرواية فناطق في مجمل انفعالاته التي تشكل المادة الرئيسة للرواية، أو هي حياته الثانية كما هي في الخصوصية الفردية لا في عموم الحكم التاريخي. لذلك لا غاية منها سوى المتعة ذاتها، أي ما يمكن أن تقدمه حالات التشخيص التي يستعيد فيها القارئ جزءًا من ذاكرته، أو هي سبيله إلى فهم أفضل لتفاصيل حياته الخاصة. لم يعد النجدي، من خلال الرواية، جزءًا من ذاكرة الكويتيين وحدهم، لقد تسلل إلى ذاكرة كل القراء (ذاكرة الناطقين منهم بالعربية على الأقل). استنادًا إلى هذه «البياضات» وهي خاصية من خاصيات السرد التاريخي، بنى طالب الرفاعي عالم روايته. فهو لا يقدم صورة لشخصيات حقيقية استنادًا إلى سجل سيري محدود في الزمان والمكان، ولكنه لم يبتكرها من عدم أيضًا، كما هو الأمر في الرواية ذات الطابع التخييلي المحض، لقد منح المعروف مزيدًا من المعرفة هي ممكنات النجدي التي لم يُدرك وجودها سواه، أو لم يعيها هو نفسه، أو هي ما كان يود القيام به.
يتعلق الأمر بمجموع الوقائع التي تغطي ما يعود إلى سلوكه في حالات ضعفه وقوته وتأملاته وبكائه ونظرته إلى زوجته وأبنائه، وتعامله مع عماله. لقد ولد النجدي وعاد إلى الحياة من جديد في الرواية، لا من خلال سارد يحكي بطولات شخصية، بل من خلال سجل ذاتي مادته الرئيسة «الانفعال» الشخصي، وهي الخاصية الغائبة في نصوص التاريخ. لا يثق المؤرخون عادة في ما يُقال على هامش الواقعة، فهي عندهم كيان مبني وموجه لكي يُصبح مفهومًا يغطي مساحات تصف التحول أو التغير أو ترصد حالات حضارية في بدايتها أو في نهايتها.
وتلك هي الكوة التي تطل منها عين الروائي على ما لم تقله الموسوعات. إن الرواية ترصد «لحظات» في حياة النجدي، وهي اللحظات التي يقوم عليها البناء الروائي كله: لحظة نداء البحر ولحظة سقوط الطفل في البحر، وكل لحظات الإبحار والعودة ولحظات كثيرة أخرى في حياته. ولكن الرواية لا تبنى على وقائع، إنها تعيد صياغة ما تداوله الناس خارج النفس التخييلي. إن الرواية تمنح، من خلال التصوير الدقيق، السردي والوصفي، حركات وكلمات النوخذة وصحبه نفسًا بصريًّا تتعاقب فيها اللقطات والوضعات والمشاهد. إن الرواية تكتب بالكلمات، ولكنها تسرب إلى العين التي تقرأ ما يوازيها من الصور. أما في النص التاريخي فالأمر نقيض ذلك، إن الراوي فيه ينتشله من العالم البصري، فالواقعة عنده لا يمكن أن تستقيم إلا إذا استقرت في مفهوم تلخصه العبارة التالية: «مات في حادث مأساوي غرقًا في البحر».

طالب الرفاعي
لا تكتفي بوصف عابر
إن الرواية تلتقط من حالات التصوير هاته ما يختصره المؤرخ في مفاهيم كالشغف والشجاعة والحنكة في إدارة الفريق التقني وتصبه في الحياة. إنها لا تكتفي في جميع هذه الحالات، بوصف عابر لخاصية أو موقف، إنها تخلق سياقات وتنفخ فيها من سردها لكي تصبح قادرة على نشر الموصوف في كل سياقات التلقي الموازية. إن الرواية لا تسمي وتعين، كما هو الشأن مع التاريخ، إنها تقوم بالتصوير والتشخيص فقط، ومن خلال ذلك تتجاوز شرطها المحلي لكي تحتضن التطور والتحول والكبرياء الإنساني في كل مكان، إنها تُعمم المحلي وتمنحه بعدًا كونيًّا.
بعبارة أخرى، إن الروائي يُخَلِّص بطله من التاريخ ليعيده إلى الحياة، إنسانًا كريمًا سخيًّا شجاعًا عاشقًا، أي نوخذة، ولكنه يشبه جميع الناس أيضًا. فتفاصيل حياته لا نقرؤها في ما تقوله الموسوعات، فهذه تستهويها أحكام تجريدية تتداخل فيها نسخ الشجاعة والسخاء والعشق، إننا في الرواية نستخرجها مما يقوله فعل مشخص ضمن سياق إنساني مخصوص، يتعلق الأمر بلحظة تواصلية تضع النوخذة في علاقة مباشرة مع زوجته وأصدقائه وعماله. إن الشخصية تولد في تفاصيل السرد، لا في الحكم التصنيفي العام، فأن يكون المرء خيِّرًا شيء، وأن نبسط أمام الناس محكيات تروي خيره في كامل تجلياته فذاك شيء آخر. استنادًا إلى ذلك، هناك في النص هويتان تتصارعان أو تتكاملان: هوية الآنية المباشرة التي تحتفظ للنجدي بتاريخه الخاص خارج ما يتداوله الناس في الموسوعات والكتب، والهوية التي تحتضن أدواره الاجتماعية وديمومته في الزمن. وفي صيغة أخرى للقول، هناك هوية ثابتة في ذاكرة قارئ يعرف الكثير أو القليل عن النجدي (القارئ الكويتي على الأقل)، وذاكرة تُبنى في النص، ولا تستعير من الأولى سوى بنائها العام، وهي الهوية التي يستوعبها كل القراء ضمن قوانين التخييل وحده. إنها ليست نقيضًا للثانية، إنهما يتعايشان ضمن هوية كبرى هي الهوية السردية الجامعة بين التخييل والتاريخ الفعلي في حياة الفرد أو الأمة.
وستكون هذه الهوية شاملة لما ستكون عليه صورته في التاريخ (ما يمكن أن يتداوله الطلاب عن شخصيات شبيهة بالنجدي)، وما يُعاد بناؤه في السرد التخييلي (الاستمتاع بحكاية تروي قصة رجل عشق البحر، عشق الغرق فمات فيه). وعلى هذا الأساس، ستكون الهوية السردية وسيطًا أمثل بين الهويتين، فمن خلالها نتمكن من استعادة ممكنات الفرد كما اختزنها وجدانه. يتعلق الأمر بإخراج سردي للذات، ما كان ريكور يسميه تنظيم الوقائع الحياتية ضمن حبكة، ما نحكيه عن أنفسنا، وما تتضمنه القصة الكبيرة التي ننتمي إليها بحكم التاريخ أو الدين أو بحكم الانتماء الثقافي العام. وهي صيغة أخرى للقول، إن نجدي التاريخ ناقص بالضرورة، فهو وظيفة داخل النسيج الاجتماعي من حيث كونه تجسيدًا لأدوار جاهزة، وهو كذلك أيضًا من حيث إحالته على موقع في الذاكرة، إنه نوخذة، قد يكون أحسن من كل نواخذة الكويت أو شبيهًا ببعضهم، ولكنه سيصنف في نهاية الأمر ضمن النواخذة في التاريخ. إن قصته جاهزة في الذاكرة الجماعية من حيث إحالتها على تجربة شعب بأكمله مع البحر، وهي جاهزة أيضًا من حيث إحالتها على سجل مدني حقيقي يضبط الولادة والوظيفة وتاريخ الموت أيضًا. أما ما نقرؤه في الرواية فهو رسم لحياة أخرى نابعة من داخل «الأنا» وحدها، ما يمكن أن يكشف عن الكثير من تفاصيلها، وتلك قوة الرواية، لقد اختارت ضدًّا على التاريخ والتخييل ذاته ضميرًا يروي تفاصيل حياته ولحظات موته كما عاشها هو، لا مجرد «حادث غرق مأساوي» كما يقول التاريخ.
وهذا هو المضاف الحقيقي في العمل التخييلي، لقد مُنح النجدي «قناعًا» لكي يقول «الحقيقة كلها» بعيدًا من إكراهات المرجعية المباشرة في حياته. فـ«الأنا» الجديدة التي تُصرِّف الحدث وتستعيد الوقائع ليست إحالة على محفل في التاريخ، بل هي أداة مركزية في السرد، إنها أداة الكشف عن كل «ممكنات» الشخصية في الحياة، أو هي ما تبقى من حياة يهددها «التبسيط الزمني»، وقد يحرمها من كل شحنات الحميمية فيها (لقد صرح أومبِرتو إيكو بأنه يعرف كل شيء عن جوليان سوريل، ولكنه لا يعرف إلا الشيء القليل عن أبيه). إن الرواية، على هذا الأساس، تَبْسُط الحقيقة كلها أمام الناس، أو توهمهم بذلك على الأقل، فهي في جميع الحالات ليست استنساخًا لحياة جاهزة، إنما هي بديل عنها.

رحلة في ذهن عاشق للحياة
لذلك لن تكون الرحلة الأخيرة في الرواية عودة إلى «ماء صامت» أي فضاء للصيد وحده، بل هي رحلة في ذهن رجل عاشق للحياة، كما يريدها هو لا كما يمكن أن يعيشها كل النواخذة. لقد اختارت الرواية مفصلًا زمنيًّا مركزيًّا استطاع من خلاله الروائي «العبث» بزمنية خطية هي ما يرويه التاريخ، لكي يملأ الفراغات الممكنة بوقائع قد لا نعثر على أي شيء منها في ما يقوله هذا التاريخ ذاته، ولكنها تشكل النصيب الأكبر من الإبداع. فمن خلالها استطاع الروائي التحكم في السرد بالتوقف عن الحكي الحاضر لاستعادة تفصيل أو جزئية أو موقف هي جميعها لبنات في تبلور شخصية النجدي، الحقيقي والمتخيل. لقد مكنه الروائي من إسقاط كم زمني واستحضار آخر يستشرفه ضمن أفق ماض يعيشه القارئ في الرواية باعتباره فعلًا منجزًا.
وبذلك، فإن الرواية تتصرف في الزمنية لكي تخلق أكبر قدر من الدرامية: إنها توازي بين لحظة النداء الأول حين ينقاد الطفل وراء صوت غريب يأتيه من البحر الهادئ، وبين رحلة الموت حيث يُسْلم قياده لموج هادر سيبلعه: إنها لحظة رمزية توازي بين لحظات الخروج من جنة الأم حيث اللزوجة في منتهاها، والعودة إلى البحر حيث الماء الذي يطهر ويحتضن ويشد الفرد إلى الكلي في الطبيعة: إنها نداء الحياة ونداء الموت أو نداء الانصهار في الأصل، سديم أول لا شيء يحد الأفق الذي يحتضنه. إنها عودة إلى رحم الأم أو رحم الأرض أو البحر، العري الأصلي الذي منه جئنا وإليه نعود. وهذا هو الفاصل بين «أشباح» التاريخ، بتعبير أليكساندر دوما الأب، وبين «الكائنات الحية» في السرد التخييلي. بإمكاننا الإحاطة بكلية حياة إنسان ما من خلال الكيانات الأولى، فهي تشير إلى محطات تستعيد هوية سياسية أو دينية أو اجتماعية خالصة (وظائفنا في الدولة وانتماءاتنا العقدية وأدوارنا الاجتماعية كما يقوم بها كل الناس)، ولكننا نعيد امتلاك الحياة من خلال الثانية، فهي تتحدث عما يميز النوخذة علي النجدي من كل نواخذة الكويت. لقد تخلص بذلك من عباءة الرمز الوطني في التاريخ، لكي يتحول إلى تعبير عن الشرط الإنساني كله في الرواية. إنه ليس بطلًا خارقًا في السرد التخييلي، كما هو في التاريخ، إنه إنسان يتحدد جوهره في المقاومة والتحدي واحترام الخصم، فهو بذلك لا يختلف كثيرًا عن سانتياغو، العجوز عند همنغواي. لقد كان مثله وحيدًا شغوفًا بالبحر، قاوم العاصفة والبرد والموج الهادر، وسيكون شاهدًا على موته، لقد احتضن الماء الذي سيحتضنه إلى الأبد.


 التقدير التحليلي في الفن خلاف حكم التذوق الانطباعي، فالثاني انفعال خالص يقود إلى اللذة العرضية وحدها، أما الأول فيحاول ترجمة المتعة إلى مفاهيم تُجرد المشخص وتُجلي مضمونه، ذلك أن وجود التجربة لا يستقيم إلا إذا كانت قابلة للتعميم، وذاك شرط من شروط انتشار الذات فيما هو أبعد من ملكوتها الخاص. فقد يكون الانفعال فرديًّا دائمًا، ولكنه لن يستقيم إلا إذا استمد مضمونه من صيغ انفعالية مجردة يشترك فيها جميع الناس.
التقدير التحليلي في الفن خلاف حكم التذوق الانطباعي، فالثاني انفعال خالص يقود إلى اللذة العرضية وحدها، أما الأول فيحاول ترجمة المتعة إلى مفاهيم تُجرد المشخص وتُجلي مضمونه، ذلك أن وجود التجربة لا يستقيم إلا إذا كانت قابلة للتعميم، وذاك شرط من شروط انتشار الذات فيما هو أبعد من ملكوتها الخاص. فقد يكون الانفعال فرديًّا دائمًا، ولكنه لن يستقيم إلا إذا استمد مضمونه من صيغ انفعالية مجردة يشترك فيها جميع الناس.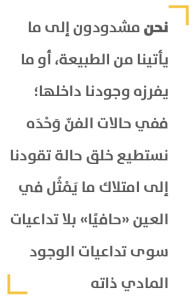 بعبارة أخرى، نستطيع من خلال الفن أن نعيد إلى النفس طاقتها الإبداعية الأولى كما يمكن أن تتحقق من خلال الحسي فيها. ففي البصري، وفي كل المنافذ الحسية أيضًا، نضع الذات في مقابل ما يأتيها من خارجها في استقلال عما يمكن أن تقوله اللغة أو توحي به. فالعين تذهب إلى موضوع نظرتها متحررة من كل أغطية الوجود سوى غطاء النظرة ذاتها.
بعبارة أخرى، نستطيع من خلال الفن أن نعيد إلى النفس طاقتها الإبداعية الأولى كما يمكن أن تتحقق من خلال الحسي فيها. ففي البصري، وفي كل المنافذ الحسية أيضًا، نضع الذات في مقابل ما يأتيها من خارجها في استقلال عما يمكن أن تقوله اللغة أو توحي به. فالعين تذهب إلى موضوع نظرتها متحررة من كل أغطية الوجود سوى غطاء النظرة ذاتها.