
بواسطة حسونة المصباحي - كاتب و روائي تونسي | سبتمبر 1, 2021 | مقالات
في الثاني من شهر يونيو من العام الحالي، فقدت الثقافة التونسية والعربية واحدًا من أعلامها، أعني بذلك المفكر والمؤرخ الكبير الدكتور هشام جعيط، الذي توفي عن سنّ تناهز 86 عامًا، أمضى الشطر الأكبر منها في التأليف في مجالات تتصل بالتاريخ الإسلامي، وبالحضارة العربية الإسلامية، وبماضي العرب وحاضرهم فكريًّا وثقافيًّا وسياسيًّا…
كان الدكتور هشام جعيط على فراش مرضه الأخير لما أصدر كتابًا بالفرنسية عن دار «سيراس» التونسية حمل عنوان: «معنى التفكير في التاريخ وفي الدين». وهو يحتوي على قسمين: حمل الأول عنوان: «قضايا التاريخ». أما القسم الثاني فحمل عنوان: «معنى التفكير في الدين». كما تضمن الكتاب مُلحقًا عن الديانات السماوية وتأثيراتها في الحضارات الإنسانية. ويهدف هذا الكتاب، بحسب مقدمة مؤلفه، إلى دراسة بعض الأسس المهمة للحضارات البشرية عبر التاريخ. ويركّز على قوتين فاعلتين هما، الهجرات البشرية والدين. كما يتطرق الكتاب إلى أسس أخرى مثل الدولة، والاقتصاد، والبنى الاجتماعية اعتمادًا على فلاسفة كبار عالجوا هذه القضايا، واهتموا بها اهتمامًا كبيرًا مثل: ابن خلدون، وهيغل، ودوركهايم، وبروديل، وماكس فايبر…
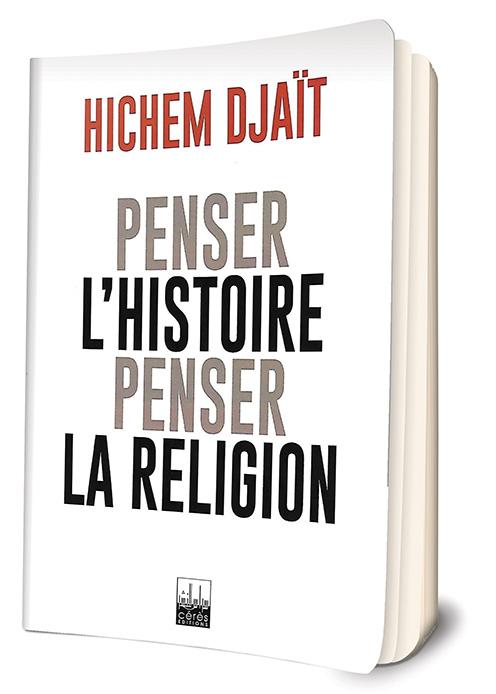 وفي المقدمة، يُضيف الدكتور هشام جعيط قائلًا: «مؤرخًا، اهتممت بالفلسفة في جميع تجلياتها، خصوصًا حين يكون لها ارتباط بالتاريخ. وبما أنني أنتمي إلى ثقافتين، الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية، فإنني سمحت لنفسي بالسباحة بينهما، مُخْتارًا أمثلتي من هنا ومن هناك». ويرى هشام جعيط أن الثقافتين المذكورتين لهما قواسم مشتركة، وصلات قوية عبر مختلف مراحل التاريخ، وهما تختلفان عن ثقافة الشرق الأدنى. مع ذلك هو سمح لنفسه بالبحث في مسائل تتصل بالثقافة في الهند، وفي الصين، ودراسة بعض جوانب الديانات الشائعة في هذين البلدين.
وفي المقدمة، يُضيف الدكتور هشام جعيط قائلًا: «مؤرخًا، اهتممت بالفلسفة في جميع تجلياتها، خصوصًا حين يكون لها ارتباط بالتاريخ. وبما أنني أنتمي إلى ثقافتين، الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية، فإنني سمحت لنفسي بالسباحة بينهما، مُخْتارًا أمثلتي من هنا ومن هناك». ويرى هشام جعيط أن الثقافتين المذكورتين لهما قواسم مشتركة، وصلات قوية عبر مختلف مراحل التاريخ، وهما تختلفان عن ثقافة الشرق الأدنى. مع ذلك هو سمح لنفسه بالبحث في مسائل تتصل بالثقافة في الهند، وفي الصين، ودراسة بعض جوانب الديانات الشائعة في هذين البلدين.
ويعتقد الدكتور هشام جعيط أن الهجرات لعبت دورًا مُهمًّا عبر التاريخ البشري؛ فقد كانت الجموع البشرية تنتقل من فضاء جغرافي إلى آخر حاملة معها لغات، وعادات وتقاليد وأديانًا ومعتقدات وأساطير وخرافات. وهذا ما حدث في منطقة الشرق الأوسط. كما أن الهجرات ساهمت في تكون ما أصبح يسمى بـ«الثقافة الهندو-أوروبية». كما ساهمت الغزوات الحربية في تأسيس ثقافات، ونشر لغات ومعتقدات. حدث ذلك خلال المدة التي خاض فيها ألكسندر المقدوني حروبًا من أجل ضم بلاد الشرق إلى اليونان ليكون هذا البلد مركز العالم الحضاري والثقافي والسياسي. كما حدث مع الغزو الإسباني لأميركا الجنوبية حيث فُرضت الديانة المسيحية ونُشرت اللغة الإسبانية بقوة السلاح. وبسبب ذلك ارتُكبت مجازر فظيعة مثل تلك التي حدثت في أميركا الشمالية بعد أن اكتشفها كريستوف كولومبس. كما تمكن العرب القادمون من الجزيرة العربية من نشر الإسلام واللغة العربية في العديد من المناطق البعيدة جدًّا من فضائهم الجغرافي.
ويرى الدكتور هشام جعيط أن العرب تمكنوا، بفضل الإسلام، من التحرر من التقاليد القبلية والعشائرية التي كانت سائدة ليؤسسوا إمبراطورية مترامية الأطراف على أنقاض إمبراطوريتين كبيرتين، هما الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. وفي البداية كانت الحروب هي الوسيلة لاكتساح فضاءات جغرافية جديدة، لكن شيئًا فشيئًا أصبحت اللغة العربية، التي هي لغة القرآن الكريم، الفاعلَ الأساسيّ في توسع رُقْعَة الحضارة العربية-الإسلامية.
وفي القسم الخاص بالدين، يُشيرُ الدكتور هشام جعيط إلى أن تجاربه وقراءاته لكبار الفلاسفة والمفكرين والمؤرخين أفضت به إلى أن الإنسان «مُتديّن بطبعة». ويعود ذلك إلى أن العالم الخارجي يُرْبكُه، ويُخيفه، ويثير فيه الحيرة والشك؛ لذا هو يجد في الدين ما يخفف عنه وطأة الحياة، ومتاعبها.
العلاقة بين الدين والحداثة
وبعد أن يستعرض الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي بسطت بها الديانات الكبيرة الثلاث؛ أي اليهودية، والمسيحية، والإسلام سلطتها على مساحات جغرافية شاسعة في القارات الخمس، يقدم لنا هشام جعيط قراءته الخاصة للعلاقة الملتبسة بين الدين والحداثة. وهو يرى أن الحداثة كانت أدبية في بداياتها؛ إذ ظهر شعراء وكتاب أرادوا القطيعة مع الكلاسيكية التي كانت في جلها محاكاةً وتقليدًا للآداب اليونانية والرومانية شعرًا ونثرًا. غير أن أولئك الشعراء والكتاب لم يكونوا يعلمون أن تلك القطيعة لم تكن تخصّ فقط أنماطًا من الكتابة، بل كانت تخصّ أيضًا أنماطًا من التفكير والحياة.
كما أنها تمثل أيضًا فاتحة لعصر جديد كانت فيه أوربا قد بدأت تخرج من العصر الوسيط، وأيضًا من عصر النهضة، لتدخل عصرًا جديدًا سيتميز بظهور الرأسمالية، وبرغبة بعض الدول الغربية في التمدّد والتوسع في إفريقيا وآسيا تحديدًا. وقد تميزت هذا الحقبة بظهور فلاسفة ومفكرين لم يترددوا في التصدي للكنيسة، وطُرق استعمالها للدين لقمع واضطهاد أهل القلم والفكر، ونصب المشانق لهم في الشوارع والساحات، وحرقهم وحرق كتبهم، مثلما حدث خلال المدة التي استفحلت فيها محاكم التفتيش.

إيمانويل كانط
ويرى هشام جعيط أن فلاسفة تلك الحقبة أمثال ديكارت، وسبينوزا، ولوك، وهيوم، وهوبز لم ينتقدوا الدين في مضامينه وأصوله، بل هم ركزوا على توجيه سهام نقدهم، العنيف أحيانًا، للكنيسة التي تلجأ إلى الدين لتشريع الاستبداد الديني والسياسي، وقمع الحريات الخاصة والعامة. ومع فلاسفة الأنوار الفرنسيين الكبار فولتير، وروسو، وديدرو، احتدّ النقد ضد الكنيسة، وضد أنظمة الحكم الملكية المتحالفة معها. وعلى الرغم من المضايقات المُجحفة التي تعرضوا لها، فإن أولئك الفلاسفة واصلوا معركتهم الفكرية بجرأة كبيرة لتكون أفكارهم وأطروحاتهم فتيلًا للثورة الفرنسية التي اندلعت عام 1789م.
ويشير الدكتور هشام جعيط إلى أن فلاسفة الأنوار في ألمانيا يختلفون عن نظرائهم في فرنسا، وبريطانيا؛ إذ إنهم لم يحشروا أنفسهم في المعارك السياسية، بل ركزوا على بلورة أطروحات فلسفية وفكرية جديدة تقطع مع الماضي، وتساعد النخب على مواجهة ما سوف تفرزه العصور الحديثة على جميع المستويات. وهذا ما فعله كانط (1727-1804م) في جميع مؤلفاته الفلسفية التي تزامن ظهروها مع الاكتشافات العلميّة الكبيرة خلال القرن الثامن عشر. وتقوم تلك المؤلفات على إعطاء القيمة العليا للإنسان الذي يتحتم عليه، بحسب الإمكانيات المتاحة له، منح معنى للعالم من وجهة نظر المعرفة، والأخلاق، والمصالح السياسية.
ويعتقد الدكتور هشام جعيط أن هيغل (1770-1831م) وسّع مجال الفلسفة، وفتح أبوابًا جديدة لم تُطرَق من قبل. وقد أتاحت له معارفه الموسوعية أن يُلقَّب بـ«أرسطو» عصره. فقد اهتم بالكيمياء وبعلم التنجيم، وبعلم النفس، وبالاقتصاد، وبالسياسة وبالفنون بجميع أنواعها. كما اهتم بالتاريخ اهتمامًا كبيرًا؛ لذا يمكن أن نقول: إن جميع الفلاسفة الذين اشتهروا في القرنين التاسع عشر والعشرين مثل ماركس، ونيتشه، وكيركوغارد، وكوجيف، وهايدغر، وغيرهم، استندوا إلى فلسفته، ومن وحيها بلوروا مفاهيم وأطروحات جديدة.
ويرى الدكتور هشام جعيط أن هيغل بلور أطروحاته الفلسفية من خلال ما تمليه عليه روح العالم. ويشير الدكتور جعيط إلى أن هيغل اهتم في سنوات شبابه بـ«العقيدة»، وبما سماه بـ«الدين الإيجابي» الذي يكون عمادًا للدولة التي تحكم «مجتمعًا واعيًا بوجوده التاريخي».
واضح أن الراحل الدكتور هشام جعيط أراد من كتابه الأخير هذا أن يجيب عن أسئلة كثيرة تشغل النخب العربية حول الحداثة، والدين وعلاقته بالسياسة، محاولًا أن يقدم تصوره لمجتمع جديد تتصالح فيه الحداثة مع الأصالة، ويتحول فيه الدين إلى «قوة إيجابية» دافعة للتقدم والرقي، ومحرضة على الحرية والديمقراطية، وكل القيم السياسية والفكرية والإنسانية التي تحتاجها المجتمعات العربية للخروج من المآزق والأزمات التي تتخبط فيها راهنًا.

بواسطة حسونة المصباحي - كاتب و روائي تونسي | مايو 1, 2018 | الملف
في بادية القيروان حيث ولدتُ ونشأت، لعبت كرة القدم بقدمين حافيتين مثل كل أبناء قريتي… وغالبًا ما تكون عطلة الصيف هي الأفضل لممارسة هذه اللعبة المثيرة والجميلة، وتنظيم مباريات بين أبناء جنوب قريتنا وشمالها. وتزداد هذه المباريات سخونة وحماسًا حين يحضرها رجال القرية الكبار لتشجيع الفريقين المتنافسيْن… وعندما انتقلتُ إلى العاصمة لمواصلة دراستي، حضرت مرة واحدة مباراة بين فريق النجم الساحلي، وفريق النادي الإفريقي، ثم قاطعت حضور المباريات نهائيًّا. وقد يعود ذلك إلى أني لا أتحمل ما يتخللها من عنف وصخب وكلام بذيء… ومنذ ذلك الوقت لم أعد أهتم بمباريات كرة القدم إلا عندما تترشح تونس لكأس إفريقيا، أو كأس العالم… كما أني كنت وما زلت حريصًا على متابعة مباريات كأس أوربا وكأس العالم بشغف كبير…
كنت في السابعة عشرة من عمري لما اكتشفت ألبير كامو من خلال رائعته «الغريب». ومن فرط إعجابي بتلك الرواية الصغيرة المكثفة، شرعت في البحث والتدقيق في سيرة صاحبها لأكتشف أنه كان مغرمًا بكُرة القدم. بل إنه مارَس هذه اللعبة باقتدار ضمن فريق جامعي. وكان حارس مرمى. وكان يخفي ممارسته لهذه اللعبة عن جدته العجوز التي كانت تعامله بقسوة، وتضربه حين يعود بحذاء مثقوب، أو ملطخ بالغبار والطين. ومع فريقه خاض كامو العديد من المباريات الساخنة. وأشدها سخونة تلك التي كانت تجرى بين فريقه وفريق وهران الذي ينتمي إليه إيمانويل روبليس. وسيكون هذا الأخير هو أيضًا كاتبًا مرموقًا فيما بعد.
معركة ضارية
وكان يحضر تلك المباريات جمهور غفير لتشجيع الفريقين. وبحسب روبليس، كان أبناء وهران يخوضون المباراة كأنهم يخوضون معركة ضارية؛ لأن فوزهم على فريق عاصمة البلاد يزيدهم فخرًا واعتزازًا بأنفسهم، ويضمن لهم العودة إلى مدينتهم متوّجين بالنصر والمجد. ولم ينقطع ألبير كامو عن ممارسة لعبته المفضلة إلا بعد أن علم أنه مصاب بداء السل. وكان آنذاك في السابعة عشرة من عمره. مع ذلك ظل مفتونًا بها، بل إنه اكتشف من خلالها مبادئ أخلاقية وفلسفية عميقة. وقد كتب في ذلك يقول: «لقد تعلمت أن الكرة لا تأتي أبدًا من الناحية التي ننتظر أن تأتي منها. وهذا ما أسعفني كثيرًا في حياتي، خصوصًا في المدن الكبيرة حيث الناس غالبًا ما يكونون غير مستقيمين».
كما تعلم كامو من كرة القدم الإقدام على المغامرة، وعلى مواجهة خصومه والمنافسين له بمعنويات مرتفعة، وبإصرار على كسب النصر. بل إنه يرى أن كل ما تعلمه من مبادئ أخلاقية، ومن الشعور بالمسؤولية يعود أساسًا إلى كرة القدم. وبعد إحرازه جائزة نوبل للآداب عام 1957م، اشترى ألبير كامو بيتًا في قرية بجنوب فرنسا. ووفاء للعبته المفضلة، كرة القدم، كان يعجبه أحيانًا أن يحضر المباراة التي تنتظم بين فتيان القرية. بل إنه أهدى أولئك الفتيان أزياء رياضية.
وقد فتنت كرة القدم كاتبين فرنسيين آخرين. فقد كتب الناقد والكاتب المسرحي جان جيرودو يقول: «الفريق يمنح الكرة إحدى عشرة حيلة، وأحد عشر خيالًا». ويرى أندريه مروّا أن مباراة جيدة لكرة القدم هي انعكاس للذكاء وهو في حالة حركة. بل قد يكون الذكاء مجسدًا من خلالها. وفي الثمانينيات من القرن الماضي، فتنت بأعمال الكاتب النمساوي بيتر هاندكه بعد أن قرأت روايته القصيرة المبهرة «الشقاء العادي» التي يروي فيها انتحار أمه. وبإعجاب قرأت رواية «قلق حارس المرمى لحظة ضربة الجزاء». بطل هذه الرواية القصيرة هي أيضًا يدعى جوزيف بلوخ. وهو حارس مرمى يطرد من فريقه بسبب هفوة ارتكبها. ومع بائعة تذاكر في إحدى دور السينما، يقضي ليلته، محاولًا التخلص من الهواجس التي كانت تعذبه. وفي الصباح يقوم بخنق بائعة التذاكر. ويبدو جوزيف بلوخ شبيهًا بمارسو بطل «الغريب» لألبير كامو. ومثله هو يقترف جريمة عبثية مدفوعًا برغبته في الخلاص من أزمته النفسية الحادة.
متعة تشبه كتابة قصيدة
وكان الشاعر الروسي إيفتشنكو مفتونًا بكرة القدم هو أيضًا. وكان يقول بأن المتعة التي يحصل عليها من خلال هذه اللعبة لا تختلف عن تلك التي يشعر بها وهو يكتب القصائد. وفي سنوات مراهقته كان يفرط في اللعب مع أبناء الحي في الفضاءات الفارغة، ويعود إلى البيت بحذاء ممزق، وبركبة أو قدم داميتين. وكان إيفتشنكو يرى أن الفرق الوحيد بين لاعب كرة القدم والشاعر هو أن الأول يحقق النجاح حالما تدخل الكرة الشباك. أما الثاني فإنه يتحتم عليه أن ينتظر طويلًا لكي يحصل على الشهرة.
وفي روايته «الورقة الصفراء»، كتب البريطاني نايك هومباي، مشجع فريق «الأرسنال»، يقول بأن حبه لكرة القدم يضاهي حبه للنساء. ولم يكن الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش يخفي حبه لكرة القدم. وبمتعة كان يتابع المباريات الكبيرة خصوصًا تلك التي تحصل بين الفرق المرشحة لكأس العالم. وخلال حصار بيروت في صيف عام 1982م، حرص محمود درويش على متابعة مباريات كأس العالم. وبينما كانت المدافع والطائرات تقصف المدينة على مدار النهار والليل، كان هو منشغلًا بالبحث عن بطارية تضمن له متابعة المباريات عند انقطاع الكهرباء. ولم يكن محمود درويش يخفي إعجابه الشديد ببعض نجوم كرة القدم مثل الإيطالي باولو روسي، والأرجنتيني دييغو مارادونا، والبرازيلي بيلي…
ويرى كتاب آخرون أن مباريات كأس العالم تعكس عوامل اجتماعية وثقافية لشعب من الشعوب. لذلك يسمي محبو كرة القدم لاعبي الفريق الهولندي «الأبقار الهولندية»، ولاعبي الفريق الإسباني «الثيران الإسبانية». ويتسنى لمحبي كرة القدم اكتشاف بلد بلا أي وزن سياسي أو اقتصادي أو ثقافي ما من خلال فريقه المشارك في مباريات كأس العالم. وهذا ما حدث مع الكاميرون، ومع دول إفريقية أخرى.
ولكرة القدم أبعاد سياسية أيضًا. لذلك يحرص الملوك والرؤساء على حضور المباريات التي تخوضها فرقهم الوطنية. وبعضهم يتحمس إلى درجة فقدان السيطرة على أنفسهمم فينتفضون واقفين عند تسجيل هدف، وقد يرقصون ويغنون… ورغم أنه فقد حفيدته فإن زعيم جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا حرص على متابعة كل مباريات كأس العالم التي دارت في بلاده عام 2010م.

بواسطة حسونة المصباحي - كاتب و روائي تونسي | مارس 1, 2017 | الملف

حسونة المصباحي
منذ ظهوره في بدايات القرن التاسع عشر، أثار القطار، أو «الحصان المحرّك بالبخار» إعجاب وفضول كبار الشعراء والكتاب في ألمانيا التي لم تكن قد توحدت بعد تحت راية بسمارك. وجميعهم عدّه إنجازًا هائلًا، قادرًا على أن يحقّق للبشر السعادة والرخاء، وصورة مشرقة للتقدم الصناعي والحضاري، و«ثورة تاريخيّة» فتحت بعض البلدان على بعضها، وسهّلت المبادلات التجارية على أوسع نطاق. قليل منهم فقط أظهروا نفورا منه، ورأوا فيه «ماردًا جبّارًا يهدّد حياتهم، وقيمهم، وتقاليدهم القديمة». وقد كتب أحدهم يقول: «غيّر القطار حياتنا، وغيّر الطبيعة من حولنا. كما غيّر وعينا بالزمان والمكان».

هاينريش هاينه: «القطار فصل جديد من فصول التاريخ الإنساني… وهو يقتل المكان فلا يتبقّى سوى الزمان»
وكان الشاعر هاينريش هاينه الذي أمضى شطرًا مديدًا من حياته مرتحلًا، ومسافرًا بين البلدان، من بين الذين اهتموا بـ«الثورة» التي أحدثها القطار في حياة المجتمعات في القرن التاسع عشر. وقد كتب يقول: «أثار تدشين خطّي القطار الحديدي هزّة أحسّ بها الجميع. أحد الخطّين يصل إلى مدينة «أورليان»، والآخر إلى مدينة «روّان» (مدينتان فرنسيّتان). وبينما يحملق العامة ببلاهة المخدرين في تلك القوى الضخمة المتحركة، ينتاب المفكرين رعب موحش يشعرون به دائمًا إزاء الجبار واللامعقول. وهم لا يدركون عواقبه، إنما يلمسون عدم قدرتهم على التنبّؤ به، أو السيطرة عليه. ما نلحظه هو أن وجودنا بأكمله يندفع، بل ينزلق إلى مجرى جديد، تترقّبنا فيه وضعيّة جديدة تحمل في طيّاتها السعادة، والشقاء في الوقت نفسه، ويجذبنا المجهول بسحره المخيف، ويغرينا ويرهبنا دفعة واحدة. وأكيد أن هذه الأحاسيس هي نفسها التي انتابت آباءنا عندما اكتُشفت القارة الأميركية، أو حين أعلن عن اكتشاف البارود، أو عندما توصّل الناس بفضل الطباعة إلى كتابة صفحات من الكتب السماوية».
ويضيف هاينريش هاينه أن القطار «فصل جديد من فصول التاريخ الإنساني». وهو «يقتل المكان فلا يتبقّى سوى الزمان». ومتخيّلًا التحولات التي سيحدثها القطار، فيكتب قائلًا: «يتهيّأ لي أنّ جبال العالم وغاباته تزحف كلّها نحو باريس. وها رائحة الزيزفون النابتة في ألمانيا تتسرّب إلى أنفي. وها أمواج البحر الشمالي تطرق بابي» (كتب هاينريش هاينه هذا وهو منفي في باريس).
حذر غوته
وثمة من يشير إلى أن شاعر ألمانيا الأكبر غوته سبق له أن تحدث عن القطار. حدث ذلك عام ١٨٢٥م. ويبدو أنه كان من بين الذين أبدوا نوعًا من الحذر إزاءه. فقد كتب يقول: «قطارات وسفن بخاريّة، ووسائل اتصال أخرى، يهدف جميعها إلى تسهيل التبادل، هذا هو الشغل الشاغل للمثقفين راهنًا. كلّ واحد منهم يبالغ ويغالي، وفي النهاية يظل أسيرًا للرداءة». أما لودفيك بورنه فلم يكن على اتفاق مع غوته. فقد أظهر تحمسًا للقطار؛ لأنه «سيكسر شوكة الطغيان، وستصبح الحروب من المستحيلات». كما أنه سيكون «محرِّكًا للتطورات الاجتماعية والسياسية». وفي رباعيته «طرق حديدية»، كتب الشاعر الرومانسي فون أرنيم أول قصيدة عن القطار في الشعر الألماني، التي تقول:
يفتح السيف الطريق للبعض
للبعض الآخر يفتحه المجراف
نترك آثارًا حديديّة في
الطريق الرديئة
ونمدّ جسورًا في تلك التي
تقطعها الأنهار
الإرادة الحديديّة تشقّ دائمًا
لنفسها طريقًا.
وفي قصيدة بعنوان: «الحصان البخاري»، كتب الشاعر ألبرت فون شاميسو يقول:
يا حصاني البخاري
أنت مثال للسرعة
وراءك تترك الزمن يعدو
وتسرح الآن متَّجهًا نحو الغرب
بينما بالأمس كنت قادمًا من الشرق
سرقت سرّ الزمن
أرغمته على أن يتراجع بين الأمس والأمس
أضْغطُ عليه يومًا بعد يوم
حتى أصل ذات يوم إلى يوم آدم.
إلّا أن الشاعر نيكولاس لينار يرى أن القطار قد يفسد حياة الناس. وهذا ما نستشفه من قصيدته التالية التي تعكس تشاؤمه:
في وسط الغابة الصغيرة الخضراء
مسرعة ومندفعة
تفترس القطارات ما حولها
ضيف بشع يحلّ عليك
ستسقط الأشجار يمينًا وشمالًا
أمام اندفاعها إلى الأمام
حتى جمالك الرائع
لا يمكن أن تحميه من حدّتها.
مع ظهور السيارة ثم الطائرة في مطلع القرن العشرين، أصبح القطار وسيلة عادية، ولم يعد يثير الحيرة والفضول والحماس مثلما كانت حاله خلال القرن التاسع عشر. وبعد نهاية الحرب الكونية الثانية، برزت تيّارت فكرية وأدبية تسخر من المنجزات التي حققّها التقدم الصناعي والعلمي في جميع المجالات. بل إن هذه المنجزات كانت ضالعة بشكل واضح وجليّ في كارثة الحرب الكونية التي قتلت الملايين من البشر، وخربت مدنًا، وأحرقت مساحات واسعة من الغابات ومن الأراضي الزراعية، ودمرت أمل الشعوب في الرخاء، وفي حياة أفضل.
وفي القطارات اعتاد الناس أن يروا كل يوم جرحى ومشوهين عائدين من جبهات القتال، و«توابيت داكنة». ومرة أخرى أثبتت الحرب الكونية الثانية أن التقدم الصناعي والتكنولوجي يفضي في الحقيقة إلى مزيد من الكوارث والأوجاع. وها هو الشعب الألماني الذي ظن أنه سيستعيد أمجاده القديمة بقيادة هتلر كان مشردًا في الشوارع، «يعيش فوق القضبان الحديدية، ويسكن المحطات والأرصفة، ويحاول من خلال آلاف المناقشات أن يبرهن على حقه في الوجود» بحسب هانس فِرنر ريشتر مؤسس «مجموعة ١٩٤٧» التي لعبت دورًا مهمًّا في تطوير الأدب الألماني بعد الحرب الكونية الثانية. وفي إحدى قصصه، يصف فولفغانغ بورشرت تلك المرحلة القاتمة من التاريخ الألماني المعاصر قائلًا: «مخلوقات رثة، كائنات أشبه بأشباح، لاجئون بلا وطن وبلا مأوى، منهم من أنقذ نفسه من الموت في آخر لحظة، ومنهم تاجر السوق السوداء منعدم الضمير. هؤلاء جميعًا يجمعهم أمل واحد: العودة إلى الديار».
ويصف ماكس فريش ما شاهده في محطة القطارات في فرانكفورت بعد الحرب قائلًا: «اللاجئون مضطجعون في كلّ مكان على سلالم محطة القطار. يخيّل للمرء أنهم لن يرفعوا أنظارهم حتى لو وقعت معجزة في وسط الساحة. إنهم يعلمون علم اليقين أنه لا شيء سيحدث. فلو قيل لهم: إن هناك بلادًا ما وراء القوقاز مستعدة لإيوائهم لجمعوا صناديقهم وبقايا أمتعتهم وارتحلوا دون أن يصدقوا كلمة واحدة مما سمعوه. حياتهم ليست حقيقية، بل انتظار من دون أمل».
القطار يصل في موعده
ويحضر القطار في «القطار يصل في موعده» لهاينريش بل الذي كان من أبرز رموز «مجموعة ١٩٤٧» والحائز على جائزة نوبل للآداب عام ١٩٧٠م. بطل هذه الرواية القصيرة جنديّ ألماني مأذون يركب القطار في عام ١٩٤٣م ليلتحق بالجبهة الروسية. فجأة تستبدّ به فكرة أنه لن يصل أبدًا، وأن تلك الرحلة هي رحلته الأخيرة، وأن القطار سينقله إلى قرية حيث ينتظره الموت. وفي القطار يواصل حياته العادية، يأكل وينام، ويلعب الورق مع أصدقائه الجنود. وهو يتذكر فصولًا من حياته، ووجوهًا من الماضي، ويحاول أيضًا أن يصلي. ويتقدم القطار في رحلته عبر ألمانيا ثم بولندا. وعندما يلتقي فتاة بولندية يتوهم أنه سيفلت من المصير الذي ينتظره، فيهرب معها في سيارة، إلّا أن السيارة يسحقها قطار، فتكون النهاية كما توقعها!
وفي أواخر الستينيات من القرن الماضي، أسّس هانس ماغنوس إنسنسبرغر، وهو أيضًا من أبرز وجوه «مجموعة 1947» مجلة «Kursbuch» (جدول القطارات) الشهيرة. وهو يعتقد أن هذا الجدول يثبت أن العمل الأدبي بات عديم الفائدة؛ لذا يجب أن يستبدل به الأخبار والتحقيقات الصحفية والمقالات: «لا تقرأ القصائد يا بني… عليك أن تقرأ جدول القطارات فهي أكثر دقة!».
المجد للقطار
قصيدة للشاعر الفرنسي فاليري لاربو

فاليري لاربو
امنحني صخبَكَ الكبير وسرعتك اللذيذة
وانزلاقك الليليّ عبر أوربا المغمورة بالضوء
آه يا قطار البذخ!
امنحني أيضًا تلك الموسيقا المُغمّة المدمدمة
في معابرك الجلديّة المذهّبة
بينما خلف الأبواب «المبرنقة» ذات المزاليج النحاسيّة الثقيلة
ينام أصحاب الملايين
أجتاز معابرك وأنا أعني
وأتبع عدوك باتجاه فيينا وبودابست
مازجًا صوتي بأصواتك المئة ألف
آه يا هارمونيكا زوغ!
أحسست لأول مرة بلذّة الحياة
في مقصورة من مقصورات قطار الشمال السريع
بين «فيربلان»، و«بسكاو»
كان القطار ينزلق عبر سهول
حيث يستند إلى جذوع أشجار ضخمة كما الهضاب،
رعاة يرتدون جلود خرفان قذرة
(كان الوقت خريفًا، وكانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحًا، وكانت المغنية الجميلة ذات العينين البنفسجيتين تغني في المقصورة المحاذية لمقصورتي)
أنت أيتها المرايا الكبيرة التي عبرك
رأيت سيبيريا وجبال سامنيوم وهي تمرّ
وأيضًا قشتالة الوعرة الخالية من الزهور
وبحر مرمرة تحت مطر دافئ.

بواسطة حسونة المصباحي - كاتب و روائي تونسي | نوفمبر 6, 2016 | ثقافات

حسّونة المصباحي
في الرابع والعشرين من شهر أغسطس (آب) 2016م، انطفأت روح الكاتب الفرنسي الكبير ميشال بيتور عن عمر يناهز 89 عامًا. وقد فاجأه الموت في بيته الخشبي في منطقة «سافوا العليا» السويسرية التي اختار الإقامة فيها بعد أن عمل سنوات طويلة في جامعة جينيف، شارحًا أعمال كتاب وشعراء كبار أحبهم، وبهم تأثر، من أمثال بلزاك، وفلوبير، وفيكتور هيغو، ورامبو، وآخرين. وقد اختار هذا البيت مع زوجته؛ لأنه لا يسمع من حوله غير صوت الريح، ورنين النواقيس، وهدير المياه المتدفقة من أعلى الجبال، وأغاني الطيور التي تكثر في الغابات بعد انجلاء الشتاء.
حتى الأيام الأخيرة من حياته المديدة، ظلّ ميشال بيتور دائب النشاط والعمل، محاطًا بالكتب، ومستمعًا إلى الموسيقا، ومستقبلًا أصدقاءه، وصحافيين يرغبون في التحاور معه حول أعماله المختلفة والمتعددة المشارب. وفي عام 2006م، قامت دار «لا ديفيرانس» بنشر هذه الأعمال التي تضم روايات، وأشعارًا، ودراسات أدبية وفلسفية ونقدية، ونصوصًا عن رحلات كثيرة عبر العالم، في 12 مجلدًا. وآخر كتاب أصدره ميشال بيتور كان عن الشاعر الفرنسي الشهير فيكتور هوغو. وبذلك يبلغ عدد الكتب التي ألفها ما يزيد على ألفي كتاب!
وقد ولد ميشال بيتور في شمال فرنسا في الثاني عشر من شهر سبتمبر (أيلول) 1926م. وفي سنوات شبابه، انتسب إلى جامعة السوربون؛ لدراسة الأدب الفرنسي. وبعد حصوله على شهادة مرموقة في هذا المجال، انصب اهتمامه على الفلسفة، فانصرف لدراستها بحماس فيّاض. وقد وجد في دروس ومحاضرات الفيلسوف الفرنسي الشهير غاستون باشلار ما زاده عشقًا للفلسفة التي ستظلّ حاضرة في أعماله وفي أفكاره وأطروحاته حتى النهاية.
دعوة من طه حسين
 وفي مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، انطلق ميشال بيتور إلى مصر بدعوة من وزارة المعارف التي كان يشرف عليها طه حسين لتدريس اللغة الفرنسية في معهد مدينة المنيا بمنطقة الصعيد. وستكون الأشهر الثمانية التي أمضاها هناك، غنيّة بالتجارب على جميع المستويات. وعلى رغم أن التلاميذ لم يظهروا رغبة كبيرة في تعلم لغة موليير، فإن ميشال بيتور وجد في أجواء مدينة القطن التي لا تزال عابقة بروائح التاريخ الفرعوني، ما حرضه على التعرف إلى أحوال الناس، وطبائعهم، وتقاليدهم وعاداتهم.
وفي مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، انطلق ميشال بيتور إلى مصر بدعوة من وزارة المعارف التي كان يشرف عليها طه حسين لتدريس اللغة الفرنسية في معهد مدينة المنيا بمنطقة الصعيد. وستكون الأشهر الثمانية التي أمضاها هناك، غنيّة بالتجارب على جميع المستويات. وعلى رغم أن التلاميذ لم يظهروا رغبة كبيرة في تعلم لغة موليير، فإن ميشال بيتور وجد في أجواء مدينة القطن التي لا تزال عابقة بروائح التاريخ الفرعوني، ما حرضه على التعرف إلى أحوال الناس، وطبائعهم، وتقاليدهم وعاداتهم.
وفي النص البديع الذي خصصه لتجربته المذكورة، والمنشور في كتابه «عبقيّة المكان»، يشير إلى أن أغلبية سكان المنيا مسلمون، غير أن عددًا قليلًا منهم كانوا يظهرون التعصب والتزمت، والتمسك بالقواعد الدينيّة الصارمة (…). وهناك أيضًا بضع كنائس قبطيّة، وعادة ما تشتعل المعارك حامية بين الأقباط الأرثوذكس، وهم الأغلبيّة، وبقية الفرق المسيحية الأخرى خصوصًا خلال الاحتفالات الدينية الكبيرة. وقد لحظ ميشال بيتور أن سكان المنيا يحتفظون ببعض التقاليد التي كانت سائدة في العهود الفرعونيّة. فعندما يقبل الربيع، يفضلون السهر خارج بيوتهم، مرتدين ثيابًا جديدة. وعلى الأبواب يعلقون باقات من الزهور، ومن الثوم. وتتعطر المدينة بروائح شذيّة تدلّ على السعادة، وعلى فرحة الحياة. وغالبًا ما يستغل التلاميذ الاحتفالات الشعبيّة التي تكثر في هذا الفصل، لكي يهجروا الدروس. وهم لا يفعلون ذلك للتمتع بمباهج الاحتفالات فقط، بل هربًا من خوض امتحانات آخر السنة الدراسية التي ترعبهم كثيرًا.
وفي مطلع الخمسينيات، أصدر ميشال بيتور كتابه الأول، وكان بعنوان: «ممرّ ميلانو». بعدها أمضى بضع سنوات في مدينة مانشستر البريطانية لتدريس الفلسفة في جامعتها. ومن أجواء هذه المدينة الصناعيّة التي يلفها الضباب الكثيف في النهار كما في الليل، استوحى موضوع روايته «جدول الأوقات». بطل هذه الرواية موظف فرنسيّ يدعى جاك ريفال، ينشغل بكتابة يومياته في مدينة «بلاستون» الخيالية، التي لا تختلف كثيرًا عن مانشستر. وهو يكثر من الحديث عن الزمن، حيث يبدو له أحيانًا أن الضجر الذي يقرض روحه وسط الضباب، يمنعه من أن يدرك معنى الماضي، ومعنى المستقبل. أمّا الحاضر فشبيه بكتلة متجمدة.
ويرى ميشال بيتور أنه من الخطأ أن ننظر خطيًّا إلى الزمن. وهذا ما أشار إليه القديس أغسطين في اعترافاته؛ فالماضي والمستقبل له ليسا لهما واقع في ذاتيهما. وهما لا يوجدان إلا في وعينا، وفي ذاكرتنا. لذلك يمكن القول: إن هناك حاضر الماضي، وحاضر الحاضر، وحاضر المستقبل.

الشهرة التي كان يطمح إليها
كان على ميشال بيتور أن ينتظر سنة 1957م لكي يحصل على الشهرة التي كان يطمح إليها. ففي تلك السنة أصدر روايته الثالثة وكانت بعنوان «التغيّر». وهي تصور رحلة ليلية في القطار بين باريس وروما، «عاصمة إمبراطورية العالم». والشخصية الرئيسة فيها رجل يرغب في أن يلتقي عشيقته. وأثناء الرحلة يسافر في الماضي، وفي الحاضر، وفي المستقبل. ومرة أخرى يظهر ميشال بيتور اهتمامًا بالزمن كما هي الحال في «جدول الأوقات». وقد حازت الرواية جائزة «رونودو» المرموقة. أمّا النقاد الطلائعيّون فقد استقبلوها بحفاوة كبيرة، وعدوها من أهم الأعمال التي تجسّد تيار ما سمي في ذلك الوقت بـ«الرواية الجديدة». وها هو ذا ميشال بيتور يحتل مكانة بارزة بين رموز هذا التيّار من أمثال ألان روب غرييه، وناتالي ساروت، وروبير بينجي، وكلود سيمون. وقد قال في هذا الشأن: «الرواية الجديدة كانت بالنسبة لي مدرسة النظر بامتياز، فلكي نصف الأشياء بشكل جيّد، علينا أن نتمعن فيها، وعليها نركّز انتباهنا. من هنا حضور النظر الثاقب في روايتي».
وفي الستينيات من القرن الماضي، سافر كثيرًا عبر العالم. فكان في أميركا الجنوبية. وكان في اليابان، وكان في الولايات المتحدة الأميركية. وقد سعى إلى كتابة رواية عن الفضاء الأميركي، هائل الاتساع. لذلك جمع كثيرًا من الوثائق التاريخية والأدبية وغيرها. وفي النهاية، جعل من كل ما جمعه، ومن كل ما عاشه من تجارب، كتابًا وصفيًّا للواقع الأميركي في جميع تجلياته. ومنذ ذلك الحين، انقطع ميشال بيتور عن كتابة الرواية لينشغل بكتابة أشعار، وتحقيقات، ودراسات فلسفية ونقدية، ونصوص مستوحاة من رحلاته عبر العالم. كما أنه أصبح يولي اهتمامًا كبيرًا للموسيقا التي علمته كيف «يصغي إلى رنين الكلمات» بحسب تعبيره.
في أحد الحوارات التي أجريت معه في نهايات حياته، قال ميشال بيتور: «لم تعد لي مشروعات كبيرة؛ فأنا أعيش الآن حالة وقف التنفيذ. والوقت يزداد ضيقًا يومًا بعد آخر، لذا عليّ أن أتعامل معه بشكل مختلف. ما زلت مواظبًا على الكتابة، لكني أكتب لأصدقائي، ولرسَّامين ومصوّرين يرغبون في التعاون معي».

بواسطة حسونة المصباحي - كاتب و روائي تونسي | أغسطس 30, 2016 | قضايا
ما يجمع أبناء بلدان المغرب العربي الثلاثة؛ أي المغرب والجزائر وتونس، أكثر ممّا يمكن أن يفرق بينهم. وفتنتهم بالشرق هي من بين ما يشتركون فيه وجدانيًّا ودينيًّا ومعرفيًّا وتاريخيًّا منذ أن انتشر الإسلام في ربوعهم. والمقدّس هو الفاعل الأساسيّ في هذه الفتنة. فقد أصبحت مكة المكرمة وجهتهم؛ منها جاء الإسلام، والقرآن الكريم، واللغة العربيّة التي فرضت وجودها في البلدان الثلاثة ابتداء من القرن التاسع، ماحية وجود اللغة اللاتينية التي كانت سائدة في العصور الرومانية، ومُقلّصة من نفوذ اللغة الأمازيغية: لغة البربر. وكان الحجّ إلى بيت الله الحرام الوسيلة المثلى لتعرف الشرق. فقد كان الحجاج المغاربة ملزمين بعبور ليبيا، ومصر، وجزء من بلاد الشام، والبحر الأحمر؛ لبلوغ الأماكن المقدسة. وكانت هذه الرحلة الشاقّة والطويلة، تسمح لهم باكتساب معرفة واسعة بعادات وتقاليد وتاريخ البلدان والمناطق التي يمرّون بها في غدوّهم ورواحهم. كما كانت تسمح لهم بالالتقاء برجال دين، وشخصيّات سياسيّة وأدبيّة، وتجار، ومغامرين.

ابن خلدون
وشيئًا فشيئًا لم يعد الحجّ وحده الباعث الوحيد للرحلة إلى الشرق. حدث ذلك عندما أصبح المغاربة يتطلعون إلى توسيع معارفهم في الفقه، وفي الأدب، وفي مجالات معرفيّة أخرى سواء في دمشق، أم في بغداد، أم في البصرة، أم في القاهرة، أم في حواضر أخرى. وكان طالب العلم المغربي يعود إلى القيروان، أو إلى تلمسان، أو إلى فاس، أو إلى مراكش؛ ليحظى بتقدير واحترام أهل السياسة، والدين، والأدب. فالشرق هو منبع المعارف الكبرى. ومن ينهل منه يصبح من المكرّمين المبجّلين. وكثيرون هم المغاربة الذين فتنهم الشرق ففضلوا أن يمضوا فيه ما تبقى لهم من العمر. ومحيي الدين بن عربي واحد من هؤلاء. فبعد أن ساح طويلًا في بلاد الأندلس، والمغرب، وتونس، رأى في منامه وهو في مراكش عرش الله، وملاكًا ينصحه بالتوجه إلى الشرق، فأخذ بالنصيحة من دون تردّد ليمضي الجزء الأكبر من حياته متنقلًا بين بلدان كثيرة.
وفي النهاية، استقر به المقام في دمشق ليموت ويدفن هناك. وكذا كان الأمر لعبد الرحمن بن خلدون الذي أمضى السنوات العشرين الأولى من حياته في تونس، مسقط رأسه، فلمّا هلك أهله بسبب الطاعون الجارف الذي ضرب البلاد، ذهب إلى فاس ليختلط فيها بأهل الفقه والأدب والسياسة. بل إنه تورط في مؤامرة سياسية، سجن بسببها لمدة عامين، اكتسب خلالهما تجربة مهمة سوف تفيده عندما يشرع في كتابة مقدمته الشهيرة. كما أنه عاش في بلاد الأندلس، في حماية وضيافة صديقه لسان الدين بن الخطيب، السياسي والشاعر اللامع. فلمّا كثرت السعايات الخبيثة بينهما، عاد من جديد إلى المغرب ليواجه تجارب ومحنًا أخرى، نجد ملامحها وعِبَرها في مقدمته.
وكان ابن خلدون في سنّ الأربعين عندما عاد إلى تونس آملًا أن يجد فيها ما يرضي طموحاته، إلا أن غريمه الإمام ابن عرفة شدّد عليه الحصار والمراقبة ليجبره أخيرًا على الرحيل إلى الشرق ليمضي ما تَبقّى له من العمر مُتنقّلًا بين الأماكن المقدسة، وبلاد الشام، ومصر حيث مات ودفن. ورحلة ابن بطوطة، وابن طنجة، دليل آخر على فتنة المغاربة بالشرق. من خلالها نتعرف حقبة مهمة من تاريخ بلدان كثيرة، فيها تكاثرت واشتدت الأزمات، والكوارث، والزلازل السياسيّة التي مَهّدت لسقوط العرب الحضاري.
سير مثقفين ومصلحين وسياسيين

عبدالعزيز الثعالبي

الحبيب بورقيبة
وفي العصور الحديثة، ظلّت فتنة المغاربة بالشرق مشعّة وملتهبة. وهذا ما تعكسه سير مثقفين ومصلحين وسياسيين. والتونسيّ الشيخ محمد بيرم (مولود عام 1840م) الذي كان من أنصار المصلح الكبير خير الدين باشا التونسي واحدًا من هؤلاء. فبعد أن طاف طويلًا في بلدان أوربيّة مختلفة للتداوي من مرض عضال أصيب به في طفولته، عاد إلى تونس ليناصر الأفكار الإصلاحيّة، المنوّرة للعقول، لكن الوزير الفاسد مصطفى بن إسماعيل الذي تآمر مع الفرنسيين لاحتلال تونس، شدّد عليه الخناق ليجبره في النهاية على الهجرة إلى إسطنبول، ثم إلى مصر التي وجد فيها خَيْرَ الملاذ؛ لذا فضّل الاستقرار فيها حتى وفاته في الثامن عشر من شهر ديسمبر عام 1889م.
والفتنة بالمشرق هي التي حرّضت الشيخ التونسي المصلح والزعيم السياسي الكبير عبدالعزيز الثعالبي على ترك تونس في مطلع العشرينيات من القرن الماضي ليمضي ما يزيد على 15 سنة متنقلًا بين بلاد الشرق، مدرّسًا في بغداد، وداعية إصلاحيًّا في مصر، وفي بلاد الشام، وفي اليمن، وفي الكويت، وأيضًا في الهند، وفي إندونيسيا. وكان حلمه خدمة العالم الإسلامي، ومساعدة العرب على النهوض من جديد، حتى الزعيم الحبيب بورقيبة العاشق لعدوّته فرنسا، ولشعرائها وفلاسفتها التنويريّين والعقلانيّين، لم يسلم من غواية فتنة الشرق. فبعد الحرب العالميّة الثانية، فرّ إلى مصر عبر ليبيا بعد أن بات متأكدًا من أن السلطات الفرنسيّة تسعى لاعتقاله. وفي القاهرة، التقى الزعماء المغاربة الذين كانوا قد بعثوا هناك مكتبًا للدفاع عن قضايا المغرب العربي من أمثال علالة الفاسي، وعبدالكريم الخطابي، والدكتور الحبيب ثامر، وغيرهم. ومن رحلته المشرقيّة تلك، استخلص بورقيبة أن جلّ زعماء تلك المنطقة يكثرون من الكلام، ولا يعيرون الفعل اهتمامًا كبيرًا. وكان الملك عبدالعزيز هو الزعيم الوحيد الذي لفت انتباهه؛ لذلك أشاد بخصاله البراغماتيّة.
وبسبب شعوره المبكر بالغربة في وطنه، شرع الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي في التطلع إلى الشرق ليتعرّف تجارب شعراء المهجر. وبهم سيتأثر، مُنْجذبًا إلى جبران خليل جبران خاصة. كما سيتأثر بأفكار طه حسين وبخاصة الواردة في كتابه: «في الشعر الجاهلي». وكان يلتهم كلّ ما يأتي من القاهرة، أو من بيروت ، من كتب ومجلات، مبديًا آراءه فيما ينشر من أفكار وأشعار ودراسات نقديّة. وهذا ما نتبيّنه من خلال رسائله إلى صديقه القيرواني محمد الحليوي الذي ساعده على الاطلاع على روح الحركة الرومنطيقية في أوربا. فلمّا ضاقت به الأحوال، وصدّت كلّ الأبواب أمامه، بعث الشابي بقصائده إلى مجلة «أبولو» ليتمّ الاحتفاء بها من جانب أسرة تحريرها.
لم أسلم من فتنة الشرق
وبالرغم من أنني أنتسب إلى جيل متشبّع بالثقافة الفرنسيّة، وبلغة موليير دَرَسْتُ التاريخ، والجغرافيا، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والفلسفة، وغيرها من المواد فإنني لم أسلم من فتنة الشرق. وكم كان يروق لي أن أجلس إلى صديقي الشاعر خالد النجار الذي سافر إلى القاهرة وبيروت ودمشق في سنّ العشرين ليحدثني عن الشعراء والكتاب والفنانين والمفكرين الذين التقاهم هناك. وبلهفة بالغة كنت أقتني المجلات القادمة من عواصم الشرق؛ مثل: «الآداب»، و«شعر»، و«مجلة المجلة»، وغيرها.
وقد سمح لي مؤتمر اتحاد الكتاب العرب الذي انعقد في تونس في ربيع عام 1973م، بتعرف شعراء وكتاب كنت أحلم برؤيتهم من أمثال: الطيب صالح، ومحمود درويش، ويوسف الصائغ، وعبدالوهاب البياتي، ويوسف السباعي، وغيرهم؛ لذلك انطلقت في خريف العام المذكور إلى الشرق عازمًا على العيش فيه سنوات طويلة. وبعد أن زرت طرابلس الغرب، ودمشق، وبغداد، وبيروت التي كانت ملامح الحرب الأهليّة بادية عليها، عدت إلى وطني وفي قلبي مرارة الخيبة. وهذا ما عبّرت عنه في روايتي «الآخرون»؛ إذ رويت تفصيلات رحلتي من بدايتها إلى نهايتها، التي كانت سلسلة من الخيبات والإحباطات.
واليوم، وقد انتفت الفتنة، أنظر إلى الشرق وهو يحترق، بقلب مفعم بالأسى والألم. ويزداد أساي وألمي اتساعًا حين أعاين حرائق الشرق الأيديولوجية والدينيّة التي بدأت تهدّد بلدان المغرب أيضًا.

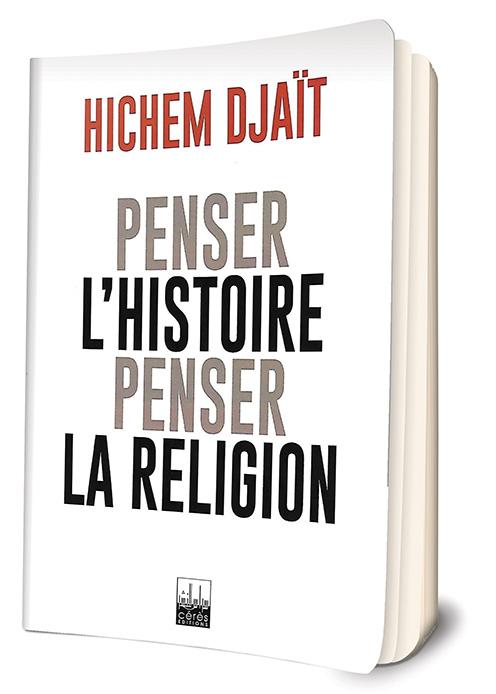 وفي المقدمة، يُضيف الدكتور هشام جعيط قائلًا: «مؤرخًا، اهتممت بالفلسفة في جميع تجلياتها، خصوصًا حين يكون لها ارتباط بالتاريخ. وبما أنني أنتمي إلى ثقافتين، الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية، فإنني سمحت لنفسي بالسباحة بينهما، مُخْتارًا أمثلتي من هنا ومن هناك». ويرى هشام جعيط أن الثقافتين المذكورتين لهما قواسم مشتركة، وصلات قوية عبر مختلف مراحل التاريخ، وهما تختلفان عن ثقافة الشرق الأدنى. مع ذلك هو سمح لنفسه بالبحث في مسائل تتصل بالثقافة في الهند، وفي الصين، ودراسة بعض جوانب الديانات الشائعة في هذين البلدين.
وفي المقدمة، يُضيف الدكتور هشام جعيط قائلًا: «مؤرخًا، اهتممت بالفلسفة في جميع تجلياتها، خصوصًا حين يكون لها ارتباط بالتاريخ. وبما أنني أنتمي إلى ثقافتين، الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية، فإنني سمحت لنفسي بالسباحة بينهما، مُخْتارًا أمثلتي من هنا ومن هناك». ويرى هشام جعيط أن الثقافتين المذكورتين لهما قواسم مشتركة، وصلات قوية عبر مختلف مراحل التاريخ، وهما تختلفان عن ثقافة الشرق الأدنى. مع ذلك هو سمح لنفسه بالبحث في مسائل تتصل بالثقافة في الهند، وفي الصين، ودراسة بعض جوانب الديانات الشائعة في هذين البلدين.








 وفي مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، انطلق ميشال بيتور إلى مصر بدعوة من وزارة المعارف التي كان يشرف عليها طه حسين لتدريس اللغة الفرنسية في معهد مدينة المنيا بمنطقة الصعيد. وستكون الأشهر الثمانية التي أمضاها هناك، غنيّة بالتجارب على جميع المستويات. وعلى رغم أن التلاميذ لم يظهروا رغبة كبيرة في تعلم لغة موليير، فإن ميشال بيتور وجد في أجواء مدينة القطن التي لا تزال عابقة بروائح التاريخ الفرعوني، ما حرضه على التعرف إلى أحوال الناس، وطبائعهم، وتقاليدهم وعاداتهم.
وفي مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، انطلق ميشال بيتور إلى مصر بدعوة من وزارة المعارف التي كان يشرف عليها طه حسين لتدريس اللغة الفرنسية في معهد مدينة المنيا بمنطقة الصعيد. وستكون الأشهر الثمانية التي أمضاها هناك، غنيّة بالتجارب على جميع المستويات. وعلى رغم أن التلاميذ لم يظهروا رغبة كبيرة في تعلم لغة موليير، فإن ميشال بيتور وجد في أجواء مدينة القطن التي لا تزال عابقة بروائح التاريخ الفرعوني، ما حرضه على التعرف إلى أحوال الناس، وطبائعهم، وتقاليدهم وعاداتهم.




