من المعروف عن الناقدة والباحثة والمترجمة سلمى الخضراء الجيوسي أنها تنجز معظم مشاريعها بجهود فردية، لكن ما تقدّمه هذه الباحثة والكاتبة والمترجمة يفوق في أثره ونتائجه ما تقدّمه مؤسَّسات حكومية وغير حكومية ضخمة تتوافر لديها الأموال والإمكانات وتُخَصَّص لها الميزانيات. والسرّ في ذلك أن الجيوسي تُقبل على مشاريعها بهمّة عالية، وتتولّاها برعايتها وإشرافها، وتكرّس لها وقتها وجهدها، مؤمنةً بقدرتها على إحداث الفرق وطبْع بصمة تخصّها وحدها دون سواها على جدار التاريخ.
والزائر إلى بيتها في العاصمة الأردنية عمّان، يعجب وهو يتأمّل ما يحلو لي أن أدعوه «خزانة الأسرار» التي قُسمت إلى عشرات الصناديق لتحتضن متعلَّقات المشاريع التي لم تنتَهِ (وربما لم تبدأ) بعد، ويشمل هذا الأفكارَ والخطاطاتِ والتصوراتِ الأولية والمحاورَ والاقتراحات.. وهذا واحدٌ من المؤشرات على الجدّية والمثابرة والإحساس بالمسؤولية، وهي الصفات التي تلازم شخصية سلمى الخضراء، وتجعلها «أيقونةً» في مجال العمل البحثي والثقافي المنطلق من رسالةٍ وطنية وقومية واضحة الملامح والأهداف.
ومن هذه الزاوية يمكن تفهّم الدوافع التي انطلقت منها وهي تؤسس في عام 1980م مشروعها الكبير «بروتا»، فقد كانت هناك حاجة ماسّة لوضع الكتاب العربي الجيد على رفوف المكتبة العالمية، وكان لا بد من سدّ الفراغ الناتج من غياب الثقافة العربية في المدوّنة الإنسانية. ثم جاء تأسيس «رابطة الشرق والغرب» للدراسات (1992م)، وهو مشروع أخذ على عاتقه إصدارَ عدد من الكتب النوعية المشتملة على دراسات حضارية، ومنها كتاب جامع عن حقوق الإنسان في الفكر العربي، وآخر عن القدس في التاريخ والتوراة، وثالث -كبير جدًّا- عن المدينة في العالم الإسلامي، ورابع عن الفن القصصي العربي في العصور الكلاسيكية.
هذه الحماسة للإنجاز وإطلاق المشاريع سمة لصيقة بشخصية سلمى الخضراء الجيوسي التي لا تفتأ تؤكد أنك إنْ قدمتَ أدبك وتراثك بشكل متقَن وذكي، فإن العالم مستعدّ له ومنفتح لك، مهما كانت محاولاتُ أعداءِ الثقافة العربية لردعه ولمنعك من تقديمه قوية.
وتقرّ الجيوسي أنّ ما يفتّ في عضدها، هو أنّ الرسالة الأساسية التي كرّست لها حياتها، لم تُصِبْ بـ«العدوى» إلّا عددًا قليلًا من المسؤولين العرب. لكن هذا لم يُثْنِها عن مقاومة الجهل الفادح بالعرب في الخارج، ونشر أرقى ما أنتجه العرب من أدب وإبداع في العالم، والتعريف بالإرث الروحي والمزايا الإنسانية لهم في القرون الوسطى.
ومما يَسِم تجربتها أيضًا، تنوّع اهتماماتها وتعدُّد اشتغالاتها، فمِن الشعر إلى النقد، ومن تأريخ الأدب إلى البحث والترجمة، ومن الإشراف على الأنطولوجيات الموسوعية إلى الغوص في التراث.
فقد أبدت هذه المبدعة اهتمامًا بالشعر في بداياتها، وأصدرت مجموعتها اليتيمة فيه «العودة من النبع الحالم» عام 1960م، ثم تحولت إلى النقد والبحث والترجمة بعد أن أجرت على الشعر «حكمًا جارحًا» على حد تعبيرها. فكانت إذا جاءتها القصيدة، لا تتردد في تأجيلها ريثما تنتهي من هذا ومن ذاك، ولأن لحظة الإبداع هشّة ولا تطيق التأجيل، فقد ضحّت سلمى الخضراء بما لا يُضَحّى به حتى تنجز ما يجب أن يُنجَز، بحسب ما تقول قبل أن تضيف: «لو كنت أعيش في زمن رخيٍّ أتمتع باستقرار الوطن جميعه وتقدمه المستمر، لما اخترت إلّا الإبداع تعبيرًا عن تجارب الحياة، ولكني أدرك أنه لن يقوم بنا إلا العمل المستمر للدفاع عن شرفنا المغتصَب وسمعتنا الحضارية وإنجازاتنا الزاهرة».
وفي النقد، استهواها التأريخ الأدبي أكثر من سواه، لهذا خصصت أطروحتَها للدكتوراه لتناول الشعر العربي الحديث منذ القرن التاسع عشر حتى عام 1970م مؤرّخةً كل ما حصل لهذا الشعر منذ عصر النهضة.
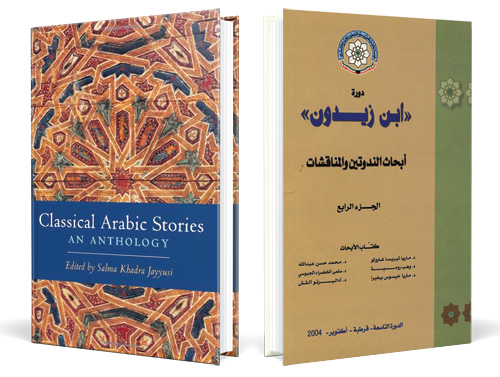 وفي مطلع الستينيات، ترجمت عددًا من الكتب عن الإنجليزية، منها كتاب لويز بوغان «إنجازات الشعر الأميركي في نصف قرن» (1960م)، وكتاب رالف بارتون باري «إنسانية الإنسان» (1961م)، والجزأين الأوَّلَين من «رباعيّة الإسكندرية» للورانس دريلم «جوستين» و«بالثازار» (1961/ 1962م)، و«هكذا خلقت جيني» لأرسكين كالدويل (1961م)، و«والت ويتمان» لريتشارد تشيس (1962م)، و«الشعر والتجربة» لآرشيبالد ماكليش (1962م).
وفي مطلع الستينيات، ترجمت عددًا من الكتب عن الإنجليزية، منها كتاب لويز بوغان «إنجازات الشعر الأميركي في نصف قرن» (1960م)، وكتاب رالف بارتون باري «إنسانية الإنسان» (1961م)، والجزأين الأوَّلَين من «رباعيّة الإسكندرية» للورانس دريلم «جوستين» و«بالثازار» (1961/ 1962م)، و«هكذا خلقت جيني» لأرسكين كالدويل (1961م)، و«والت ويتمان» لريتشارد تشيس (1962م)، و«الشعر والتجربة» لآرشيبالد ماكليش (1962م).
وفي عام 1977م نشرت دار بريل (لايدن)، وهي أعرق دور النشر الغربية لنشر الكتب عن الحضارات غير الغربية، كتابها «الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» في جزأين، وقد تُرجم هذا الكتاب إلى العربية، وصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت. وحررت الجيوسي أكثر من أربعين عملًا في إطار مشروع «بروتا»، ومن بين هذه الأعمال سبع موسوعات ضخمة للأدب العربي الحديث، هي: «الشعر العربي الحديث» (93 شاعرًا)، «أدب الجزيرة العربية» (95 شاعرًا وقاصًّا)، «الأدب الفلسطيني الحديث» (103 شعراء وكُتاب)، «المسرح العربي الحديث» (12 مسرحية، بالاشتراك مع روجر آلن)، «القصة العربية الحديثة» (187 إدخالًا)، ثم المسرحيات العربية القصيرة (20 مسرحية).
مُنحت سلمى وسام منظمة التحرير الفلسطينية عام (1990م)، والجائزة التكريمية التي يقدّمها اتحاد المرأة الفلسطينية في أميركا عام (1991م)، ووسام القدس عام (1999م)، ووسام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت عام (2002م)، وكرّمتها جمعية الخريجين العرب الأميركيين (1996م). كما نالت جائزة سلطان العويس للإنجاز الثقافي عام (2008م)، وجائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة، مناصفةً مع المستشرق الألماني هاندرتش هارتموت (2009م).
يشار إلى أن سلمى الخضراء أنهت تعليمها الثانوي في كلية شميت الألمانية بالقدس، ودرست الأدبين العربي والإنجليزي في الجامعة الأميركية ببيروت، ثم سافرت إلى لندن، حيث التحقت بجامعتها وحصلت منها على درجة الدكتوراه في الأدب العربي، وعملت أستاذة للأدب العربي في عدد من الجامعات العربية والأميركية، قبل أن تتفرّغ لمشروعها «بروتا».
هذا الحوار أجريتُه معها لـ«الفيصل»، وتطلب ذلك أن ألتقيها مرات عدة، في بيتها في عمّان، وفيه نقف على محطاتٍ مضيئة في رحلة التجربة، ونطلّ على رؤى هذه الباحثة التي تمثّل علامةً فارقة في المشهد الثقافي العربي، ونسمع منها عمّا يؤرقها ويشغل بالها، ونتعرف موقفَها من عددٍ من القضايا الملحّة والراهنة.
● خضتِ معركة حقيقية للتعريف بالأدب العربي، كيف تنظرين الآن إلى ما قمتِ به؟ وماذا تقولين للأجيال الجديدة التي هي أحوج ما تكون إلى قدوة أو نموذج؟
■ تبدأ المعركة منذ الطفولة: كيف ينشـأ الطفل وماذا يعرف عن تراثه ووضعه الحضاري في الحاضر والماضي. أنا نشأت في جوّ وطني حتى النخاع، فليس غريبًا أن أتبنّى ملءَ قسمٍ من فجوات التاريخ بما أنجزناه ما دمتُ قادرة على هذا. لا يمكنني أن أنسى تلك اللحظة التي غيّرت حياتي. كنت في أستوكهولم مع الشاعرين التونسيين المنصف الوهايبي ومحمد الغزّي مسافرين من بيت صديقتي العزيزة «سيغريدْ كالِهْ» في ريف العاصمة عبر أستوكهولم جنوبًا إلى «لونْدْ» لحضور مؤتمر عن الشعر العربي والسويدي الذي كان سينعقد في «لونْدْ» في جنوب السويد، وذهبنا بتدبير مسبق من رئيس مكتبة مؤسسة نوبل السيد «أوستن شوستراند» إلى زيارة هذه المكتبة الكبيرة التي كانت تجمع آلاف الكتب العالمية. فبعد أن تجولنا في المكتبة طلبتُ أن نرى الأرشيف العربي. وتردد «شوستراند» لحظتين ثم فتح لنا درجًا صغيرًا وأخرج منه أربعة كتب محدودة الحجم مترجَمة من العربية إلى الإنجليزية، وهذا كان كل ما عندهم من لغتنا. وسمعتُ صوتي يعلو بفزع للمنصف الذي كان واقفًا قربي: «تغيّرت حياتي يا منصف!». فقد صممت على أن أفعل كل ما بوسعي لتغيير هذا الوضع الشائن. وبدأ مشروع «بروتا» العمل على هذا في اليوم التالي. والحق أنه لم يُفشلني قط، وإن كان للذكورية أيّ تأثير فهو أن المساندات لم تأتِنا إلا بعد إنجاز مشروع نعمل عليه، فإذا أتممناه ونشرناه أعطونا المشروع التالي، وكان في وسعي أن نعمل على عـدة مشاريع معًا كما كنت أنوي، فالوضع حرج ويحتاج إلى بذل سخيّ للوقت والمال، ولكن الباذلين للمال لم يقتنعوا ولم يساندوا لنا إلا مشروعًا واحدًا بعد مشروع. ومع شكري الجزيل لهم لا بد من القول: إن تردّدهم في استغلال طاقتنا على عملٍ واسع قد قلّص مردودنا العملي كثيرًا رغم حاجة الثقافة العربية إلى إنجاز عـدة مشاريع دفعة واحدة.
أنا ما زلت أذكر، بقهرٍ وحرقـة، كيف نشأ جيلي الذي وُلـد بعد هجوم الاستعمار الغربي علينا بقليل، فقد كان يعرف عن تاريخ الإمبراطورية الإنجليزية أكثر بكثير مما يعرف عن تاريخ العرب الذين كانوا لعشرة قرون على الأقلّ في العصر الوسيط، أقوى الأمم غربي الهنـد وأعمقها حضارة وإبداعًا. اليـوم أصبحت المعرفة عن التراث العربي متاحة لطلبة العلم إلى حدّ مقبول، ولم يعد الجهل بها مقبــولًا.
في مواجهةٍ لي مع معلمة إنجليزية في سنوات الاستعمار الأخيرة في فلسطين، تظهر علائم المؤامرة علينا وذلك التلقين الذي كان يتلقّاه الموظفون الإنجليز في دوائرنا لإخضاعنا والبروز علينا آمرين متمردين. أنا تغلبتُ على هذا وأظهرتُ مكيدتهم، ولكن هذا التغلب لم يكن ميسورًا للكثيرين الذين تربّوا على الخوف من المستعمِرين ومحاولة إرضائهم.
● توصَف عمليات الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى، بأنها رهن المصادفة والارتجال. كيف يمكن إطلاق مشروع عربي جدّي يأخذ على عاتقه نقل ثقافتنا إلى العالم؟
■ ليس هذا أمرًا عسيرًا أبدًا. مشروعي مشروعٌ عربي جدّي كل الجـدّة وناجح كل النجاح، وقد أخذ على عاتقه نقل ثقافتنا إلى العـالـم، ولكن الذين ساندوه فعلوا ذلك بتدريجٍ ومحدودية، وبدل أن نُخرج ست أو سبع موسوعات في ١٨ شهرًا كما كنت مصممة وكما كنا قادرين، اضطررت إلى تقليص العمل ليتماشى مع توقيتهم. يبدو لي أن كل عمل دقيق منظم يعتبره معظم المسؤولين صعبًا غير ميسور. ما الذي كان يمنع المقتدرين العرب أن يساعدونا للقيام بمشروعنا الذي قدمته لهم عامرًا كاملًا لا ينقصه إلا المال، والمال طلبته منهم وأعطيتهم الخيار في إدارته هم بأنفسهم ولكنهم لم يؤمنوا بشيء ولا سيما بروح العمل نفسه وقيمته وضرورته. لم يبدُ ذلك مهمًّا أو لعلهم ظنوه غير ممكن، أي أنهم لم يدركوا لبابه الأساسيَّ ومقدرتنا عليه، وأظن أن ذلك كان يعـود ليس فقط إلى سوء التقدير لقيمته الإبداعية وفعاليته الأدبية والجمالية، بل أولًا لأن الشعور بتخلّفنا عن ركب الحضارة والإبداع كان منغرسًا في النفوس. ثم إن الذكورية دائمًا كامنة وترفع رأسها لتقليص دخول المرأة إلى العالم المتحرك ما استطاعت. مع كل هذا، إنّ ما قدمناه حتى الآن لم يكن محدودًا على الإطلاق.
● خلال مشروعك الثقافي لنقل عيون الأدب العربي إلى الإنجليزية، ركزتِ كثيرًا على إصدار الموسوعات الكبيرة. لماذا التركيز على الموسوعات؟
■ كنت أودّ إدخال أجمل ما عندنا من إبداع، وهذا قد لا ينجح إذا ركزتُ فقط على انتخاب عدد معين من كل بلد عربي، فقد يكون في بلدٍ ما مبدعٌ كبير هو الوحيد في بلده، ولذا فقد ركزت على انتخاب الأجود المتاح في العالم العربي جميعه دون الإعلان عن عدد المبدعين هنا أو هناك، قليلهم أو كثيرهم. الموسوعة العامة تتخطّى هذا النوع من الإعلان وتقدم أجمل المنتخبات باسم العرب جميعهم.
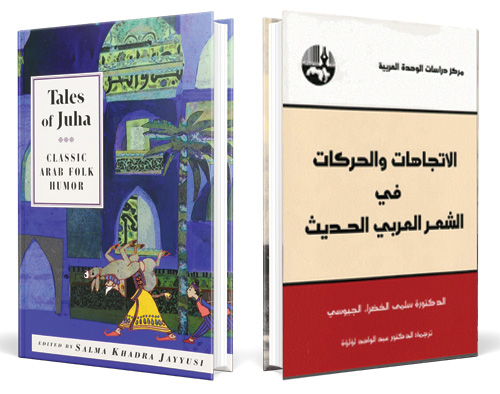 ● أخبرتِني خلال التحضيرات لهذا الحوار، أنّ السعودية دعمت زهاء عشرة مشاريع من مشاريعك. ما مدى اهتمام الحكومات والمؤسسات العربية بالمشاريع الثقافية، وكيف تقيّمين استجابتها؟
● أخبرتِني خلال التحضيرات لهذا الحوار، أنّ السعودية دعمت زهاء عشرة مشاريع من مشاريعك. ما مدى اهتمام الحكومات والمؤسسات العربية بالمشاريع الثقافية، وكيف تقيّمين استجابتها؟
■ للسعودية فضلٌ كبير على مسيرة مشروع الترجمة الأدبية عندنا، ويستحق القائمون على الثقافة وقتئذٍ شكرًا كثيرًا وأخـوّة لا توهَب إلا للعارفين بالعمل وصعوباته، أخـوّة الأذكياء غير الوارثين لمواقف تمنع مسيرةَ الحياة الفكرية وتطورها الطبيعي، وتحترم تفتُّحَ العقل البشري وقدراته، وتعترف بتآخيه وتوالده، مودّة أخويّة لا توهَب هبـاء، فهي قبل كل شيء إعلانٌ عن تزحزح الذكورية عن مكانها الراسخ، مودّة تقبل كلَّ إبداع أو إصلاح أصيل كائنًا صانعه مَن كــان؛ لأنه برهان على تقدُّم واسع في الفكر والروح، على تحديدٍ أكثر صلابة ونقاءٍ يؤاخي ولا يباعد، وكم أنا سعيـدة به.
ولكن لم يلقَ عملُنا ما يستحقّه من اهتمام وإكرام من جميع المسؤولين في مـراكز ثقافية عربية كثيرة أخـرى. لـو أن المؤازرة أتتنا من الجميع لكنّـا بنينا صرحًا عاليًا وأسّسنا وضعًا ثقافيًّا انقلابيًّا نحن في حاجة كبيـرة إليـه. إنّ تخيُّل هذا أو نتائجه في تقوية مكانة المرأة الإبداعية امتنع عليهم، لم يهبّوا لمناصرته والقراراتُ تعيش بين أيديهم.
لا يقوم أيّ عملٍ كبير دون إيمانٍ داخليّ بإمكان قيامه. وعلى هذا الإيمان بنيتُ مغامرتي ونجحت. لم أشعر دقيقة واحـدة أن نجاحي صعب. لم يخطر هذا في خيالي لحظة واحـدة. كنت أعمل بثقة غير مصطنعة وأسير به ببشْر وسعادة.
ما أريد تأكيده للمسؤولين عن الثقافة العربية وعن سمعتها في العالم، هو أن هذا الموضوع الغنيّ يستحق أن يكون على رأس قائمتهم، فعندنا الكثير الذي نستطيع تقديمه إلى العالم بلغات العالم. ولم نفشل قَطُّ في أيّ محاولة قمنا بها. بل على العكس، كسبنا سمعـة طيبة جـدًّا مبنية على إتقان العمل وشمولية المواضيع وتقديمها كجـزء مهم من العطاء العربي الإبداعي والفكري للعالم الواسع. فنحن –العرب- كنا من أوائل حمَلة هذا العطاء الأساسيين، ودراسة الثقافة في العصر الوسيط، ليس فقط في العالم العربي وما حوله، بل على امتداد المسافة من الهند إلى الأندلس، ستقودنا إلى هذه الحقيقة/ الاكتشاف.
وعودة إلى الحـاضر، وَضَعْنا تحت مشروع «بـروتـا» عشرة مجلدات، أغلبها مجلدات كبيـرة جدًّا من الأدب والفكر العربي مترجمة إلى الإنجليزية، وستة مجلدات دراسات بالإنجليزية عن الثقافـة والحضارة العـربية في لغـة إنجليزية إبداعية دقيقة، وهو إنجاز غيّرَ جذريًّا وضعَ الثقافة العربية في العالم. وبإمكان مَن يريد أن يجدها جميعها على شبكة الإنترنت. لا تتركوا هذا الأمر يدخل في قائمة المستحيلات عندكم، ما من مستحيل في العالم ينجح مرة ثم يفشل من تلقاء نفسه، لا يفشله إلا المسؤولون عنـه. إنّ إمكانية تكراره دليل على استعدادٍ له وحاجةٍ إليه. والإحجام عن ممارسته لا يعدو أن يكون ترددًا واجفًا هو بضاعة الغرباء عنه، بضاعة غير المختصّين. نحن نحتاج إلى شجاعة المؤمنين وعمق إيمانهم. ولكن لا إيمان بغير ممارسـة، ولا ممارسة بغير شجاعة، ولا شجاعة بغير ثـقةٍ بالذات وبكبرياء المغامرة مع المجهول المتاح. مع العلم أن مشروع الترجمة ليس مجهولًا أبدًا، وليس من مستعرب جادّ لم يَعرفه ولم يَستفـد منه.
مخطط غاية في اللؤم
● تقولين إنه لم يَحْمِكِ من القلق في شبابك إلا انتماؤك العربي ورؤياك للوطن الكبير وإمكاناته الشاسعة. لكن يبدو أن الرياح قادت السفينة إلى غير ما كنتِ أنت وأبناء جيلك تأملين. هل تعتقدين أن حلم الوحدة ما زال ممكنًا، ولماذا؟
■ نحن في صراع عميق مع مخططٍ غاية في اللؤم والبراعة، وقد خضع العرب له منذ زمن غير قليل. لقد لمست أنا شخصيًّا سوء تقدير الشبان العرب المتعلمين لإنجازات الثقافة العربية عبر القرون وتصديقهم لتراخينا، ذلك التراخي المزعوم، عن إغناء الإبداع الأدبي العالمي وهذا رغم أننا من أوائل بناة الثقافة الإبداعية في العالم. ولكن السؤال هنا هو: ما الذي يفعله وزراؤنا المسؤولون عن الثقافة العربية؟ ما بحثهم في هذا الأمر؟ ما اجتهادهم؟ ما مخططهم؟ هل يرضون أن يتركوا مخطط التغيير والانقلاب الذي نحتاج إليه كثيرًا دون جعله من أوائل متطلبات مخططهم الثقافي؟ كيف يرضون بالصمت عن معايير مجحفة ضدّنا ويتركونها تقرر سمعـة هذه الأمة ثقافيًّا؟ لم يعـد ممكنًا ترك المخطط الاستعماري ينمـو وينغرس عامًا بعد عام في العقول، فحتى جيل الستينيات في القرن الماضي كما أذكر، نشأ يظن أننا تخلفنا عن الإبداع تاريخيًّا. ولم يستغلّ أحدٌ من الرعاة القادرين على مواجهة هذه الافتراءات ضدنا، مركزَه ليحاول تغيير هذا الوضع. كيف حدث ويحدث هذا؟ إنه أمر جاد جدًّا.
● حركة الثقافة في العالم تتسارع على ما يبدو، نحو التبادل الثقافي المتكافئ. ما الذي ينبغي أن نفعله كعرب لتحقيق حضورنا المناسب الذي يعبّر عنا؟
■ نؤسِّس مركزَين رئيسيْنِ للثقافة؛ أولهما مركز يدْرس ما يَحْسُن تقديمه إلى العالم تحت مخطط مدروس، يعمل فيه أساتذة معتمدون؛ وثانيهما مركز يشرف على نقله عالميًّا عبر الترجمة. وللمركزين فروع متعددة، بحسب الحاجة. وتفصيلًا أكبر: نعيّن لذلك لجنـةً مرموقة من المثقفين المتخصصين منهم بالثقافة العربية قديمها وجديدها وعندهم أيضًا معرفة بالثقافة العالمية، على الأقل بإحدى لغات العالم الأولى. وذلك لانتخاب النصوص، واضعين لذلك شروطًا مدروسة قبل البـدء في أيّ عمل. ويتبع ذلك عملية الترجمة نفسها، وهذه مؤهلة عندنا في «بروتا»، ولا يمكن التنازل عن أيٍّ من شروطها. فالترجمة الجيدة تسير في أربعة مدرّجات هي: الترجمة الأولى، التدقيق المعنوي للترجمة، تحرير الترجمة (أي وضع العمل المترجم بدقة في لغةٍ وأسلوب يضمنان الأمرين معًا: معانيه وجمالياته)، والتدقيق الأخير الذي يعنى بالأمرين؛ المعنى والمبنى.
● لكِ حكاية مع الأديب خليل السكاكيني الذي اكتشف ميولكِ الأدبية. ما الذي حدث؟ وكيف كان رد فعلك وأنت –الطالبة- تلقين الإطراء من كاتب كبير؟
■ «الستّ ليّـا» معلمـة العربية كانت تشجعني كثيرًا وتقدّمني للمفتشين الذين يزورون المدرسة بين الفينة والفينة. وزار مدرستنا للتفتيش الأستاذ الكبير خليل السكاكيني الذي كان معروفًا أيضًا بوطنيته الفلسطينية، فقدمتني «الست ليّـا» وطلبت مني قراءة آخر مواضيع الإنشاء له، ففعلت، فسألني عن اسمي وعرف أني ابنة فلان، فأرسل تهنئته الحارة معي إلى والدي، ولمّا غادر صفَّنا مع معلمتنا هجمتْ زميلاتي عليّ وأوسعنني عناقًا فما تركنني حتى كان مريولي بلا جيوب ولا أزرار!
● نظرتِ إلى اعتقال أبيك من قِبَل الإنجليز غير مرة خلال حقبة الانتداب، على أنه واجب وطني لا غنى عنه للرجال. إلى أي مدى أثّرتْ فيك نضالات أبيك ومواقفه وعلاقته بك؟
■ أثّـرتْ في كثيـرًا. عيناه علَيّ حتى بعد رحيله المبكر عنا. لم يكن ينام إذا كان عنده تساؤل حول أمر وطني يحتاج إلى بحث. كان الوطن مقدسًا عنده ومعه تاريخ النضال العربي. وكانت أمي أكبر معين له تتحمل نتائج صراعه مع الاستعمار بحماسة وصبر واسع. أتذكّر كيف كان يستعين بي عندما يحتاج إلى بحث وتدقيق. كيف لي أن أنسى ليلةَ وصلتُ بعد غيابي ثلاث سنوات ونصف السنة في إيطاليا مع زوجي الدبلوماسي، فقابلني أبي مع الأولاد الثلاثة في باب مكتبه بدمشق حيث عرجتْ بنا سيارتنا لكي يرحّب بنا وأيضًا ليعطيني قائمة تحتاج سريعًا إلى بحثٍ بين أوراقه في البيت، فأمضيت أولى ليالي عودتي إلى الوطن بعد ذاك الغياب الطويل أعمل على هذا. على هذا الإرث الملتزم بالعمل البنّـاء بنيتُ ما قـدّمتُه بعد ذلك للثقافـة العربيـة:
«حلمٌ على ورقٍ أبدعتُه بيـدي
ولـم يضـنّ عليـه الحبرُ والورقُ
حلـمٌ على أرقٍ ألقمتُه جسـدي
ولم يَخُنّــي على عـدوانـــــِه الأرقُ
حلم ورثتُ رفيع الشأو دان له
صبـري الشحيح وقلبي ذلك النزِقُ».
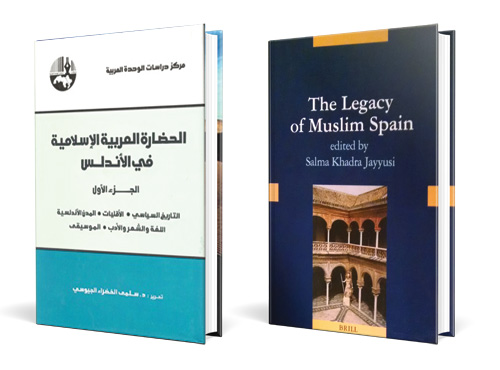 وأنت أستاذة أواسط الأربعينيات، نجحتِ في تشكيل رأيٍ عامّ ضد إدارة المدرسة التي تمثّل المستعمِر، وأشعلتِ فتيل إضرابٍ قامت به الطالبات. هل يمكنكِ استعادة تفاصيل ما جرى؟
وأنت أستاذة أواسط الأربعينيات، نجحتِ في تشكيل رأيٍ عامّ ضد إدارة المدرسة التي تمثّل المستعمِر، وأشعلتِ فتيل إضرابٍ قامت به الطالبات. هل يمكنكِ استعادة تفاصيل ما جرى؟
■ كان في عقد الأربعينيات أنْ حدث بيني وبين جماعة الإنجليز العاملين في مراكز التعليم والثقافة في فلسطين صدام كبير. كان ذلك قبل منتصف الأربعينيات، والإنجليز ما زالوا المسيطرين على جميع مرافق الحياة. وكنت بعد تخرجي في الجامعة الأميركية في بيروت قد عُينت أستاذة للعربية في كلية دار المعلمات في القدس، وهي مؤسسة دراسية متميزة تدْرس فيها، على حساب دائرة المعارف الفلسطينية، أذكى الطالبات الفلسطينيات القادمات من جميع أنحاء فلسطين بعد نجاحهن المتميز في مدارسهن.
كنت أدرّس الأدب العربي لثلاثة صفوف، وبيني وبين طالباتي صداقة ومودة لقرب السنّ والمشارب.
يوم الحادث كنتُ المراقبة في فترة الغداء، وتخلّف أحد الصفوف عن المجيء إلى الطعام. كان هذا يحدث أحيانًا لأسباب تتعلق بدراستهن، فإذا اضطرت أستاذة الصف إلى تأخير الصف عن موعد الغذاء كان عليها أن تُعلِم الأستاذةَ المراقبة ذلك النهارَ عن الأمر. غير أني لم أتلقَّ أيَّ خبر من أستاذتهن. فذهبت أستطلع الأمر ووجدتُ الطالبات ما زلن في المختبر يعملن مع أستاذة إنجليزية اسمها «مس مارش» كان من واجبها المنصوص عليه أن تخبرني عن تأخّـر ذلك الصف تحت نظارتها ولم تفعل. فلما فتحتُ باب المختبر استقبلتني بغضب شديد طالبةً مني أن أذهب وأغلق الباب. تكلمتْ بنبرة آمـرة وقحة لم أُطِقها، فأجبتها بصوت جاد بأنها أخَلّت بما هو متوقَّع منها، أي بإعلامي عن تأخُّر الصف عن الغداء، ثم ذهبتُ. ولكن لم تمضِ دقائق حتى تلقيت طلبًا من «مس هاكر» مديرة المعهد الإنجليزية أن أقابلها حالًا.
تبادلتُ النظر مع طالباتي، ثم ذهبت إلى مكتبي فأخذت منه جميع ما عندي من كتب وأوراق وأودعتها مع طالبة من الطالبات الخارجيات وذهبتُ إلى لقاء «مس هاكر». كانت «مس هاكر» تنتفض غضبًا وبادرتني تقول: «سمعت يـا مس خضرا بأنك تجـرّأتِ بالإجابة على مس مارش».
فأجبتها وقد تماسكتُ قدر ما استطعت قائلة: «لا يا مس هاكر، المس مارش هي التي تجرّأت علي»، فانفجرت تقول بضراوة وشدة: «يا مس خضرا. نحن نعرفك ونعرف أنك تهاجمين المستعمِر لطالباتنا. أخبريني الآن، هل تطيعين المستعمر يا مس خضرا؟»، وسمعتُ على أثر هذا مباشرةً رد فعل عالي الصوت من الطالبات المستمعات في ساحة المعهد. أجبتُها وقد تعمدتُ أن يكون صوتي أيضًا مسموعًا لهن: «من المحال يا مس هاكر أن أطيع المستعمر. ولكن هل أنتم مستعمرون في هذه الكلية؟ ظننت أنكن معلمات فقط». قلت هذا وخرجت إلى الطالبات اللواتي كنّ في حالة هياج لا يُكبح بسهولة. قلت: «اسمعن. هذا أمر خطير، وقد وقع الجماعة في خطأ كبير، فدعونا نتصرف بهدوء وكرامة. أنا ذاهبة إلى البيت الآن فأحْسِنّ التصرف وسنرى ما سيحدث». وخرجتُ، فسارت معي الطالبات الخارجيات حتى منزلي، وتابعن زيارتي في الأيام التالية وقد أضربن، هن والطالبات الداخليات، عن الحضور إلى صفوف الدراسة، وبقي الإضراب عن الدروس ما دمت أنا مضربةً إلى أن عاد أبي من أعماله في الجليل بعد أسبوع وسمع القصة من أمي.
بعد يومٍ من عودته طلب مني أن أذهب لمقابلة أعلى موظف عربي في دائرة المعارف الفلسطينية عندئذ، الدكتور أحمد سامح الخالدي. لم يُلقّنّي والدي كلمة واحدة لأرددها للدكتور الخالدي، بل تركني أتصرف بلغتي وأسلوبي. كنت أظن أن الدكتور الخالدي سيعاتبني على ما أوجدتُ في المعهد من اضطرابٍ وتوقف عن العمل ولكنه لم يفعل ذلك إطلاقًا، بل قال لي: «عودي يا ست سلمى إلى عملك غدًا». فعدت وعلمت أن «المس هاكر» طُلبت إلى دائرة المعارف وخرجت وعيناها محمرّتان من البكاء.
ألفة كبيرة للآخر
● كنت تقولين: إنك لا تشعرين بالغربة في أيّ مكان عربي. والآن، هل ما زال الشعورُ نفسُه لديك، أم تغيّرت الأحوال؟
■ الحقّ هو أنني لا أشعر بالغربة في أيّ مكان، فالعالم ملك جميع الناس، ولذا هو ملكي أيضًا، وبي ألفـة كبيـرة للآخر، لا أفرّق أبدًا، بل أذهب رأسًا إلى منازع التجربة الإنسانية المتبادلة. وقد نجح هذا كثيرًا معي في حياتي، وكنت أجيء أحيانًا إلى البيت ومعي وجوه جديدة أقدمها لأمي كأنها لازمتني دهرًا. كانت «أنيسة»، أمي، تفهمني وتعرف أني أدخل إلى حياة الآخر دون محاولة كشف ما لا يـودّ الآخر كشفه. عشت كل حياتي على هذا الشكل، لا أُحْجم ولا أقتحم، بل أهتدي إلى القاسم المشترك مع الآخر ونتحدّث. وكان الآخرون كثيرًا ما يكشفون لي ما في دواخلهم ثم يودّع بعضنا بعضًا دون عودة ولكني كنت أشعر أني كنت أغتني من هذا كثيرًا. أخبرني والدي أن أمه (جدتي سعـدى) كانت هكذا، وكم أشعر بأسف لأنها لم تعِش حتى أكبر وأتعرف على خصائصها.
ولكن من تجربتي هذه وجدتُ أن العرب هم أقل الناس استعدادًا لكشف ما في دواخلهم للآخرين.
● وثقَتْ دورُ النشر الغربية بمؤلفاتك وأعمالك، حتى إنها كانت تأخذ ما تنجزينه قبل أن تتفحّصه. هل يمكن القول: إنك وجدتِ التقدير الذي يليق بتجربتك في الغرب؟
■ وجدتُ المعاملةَ نفسها، وكان هذا مصدر طمأنينة لم تتغيّـر قط. لم أبحث يومًا عن ناشر، بل كان عملي مطلوبًا دون الإعلان عنه.
● هل تعتقدين أن ما قدمته للقارئ الغربي من أدبٍ عربي، أسهم في نقض فكرة مركزية الثقافة الغربية واستقلالها، وكذلك في تقويض الأفكار المشوهة والتصورات المُهينة عنا؟
■ كل إضافة جيـدة تأخذ مكانها، وفي وضعنا اليومَ، لا حدود لما يجب تقديمه للعالم لتغيير مكاننا الثقافي فيه. نحن نحتاج إلى التركيز على متابعة هذا طولًا وعرضًا حتى نؤكد دخوله إلى العالم. فعطاؤنا الإبداعي كان وما زال كبيرًا. نحن أبدعنا إدخالاتٍ سبّـاقةً جديدة للأدب أمثال المقامات وجنس الخبر وسواها، ولكننا قبلنا بنفينا من عالم الإبداع وكأننا لم ننجز شيئًا. لا يكفي لتغيير هذا الوضع ما قد يقدمه كاتبٌ أو أكثر مهما أعطى. نحن نتكلم عن ثقافة عالم عربي كبير عبر قرون عديدة يجب أن يُسرَد تاريخها الأدبي، لذا فالعمل الذي أردنا إنجازه كان يحتاج إلى مخطَّط مدروس ومموَّل بكرمٍ واهتمام، وإلى ناشرين عالميين ينشرونه بالإنجليزية وسواها من اللغات العالمية. نحن نجحنا في نشر ما أعددناه عند ناشرين معروفين لم يكن عندهم تردُّد للحظةٍ في أخـذ ما قدّمناه، وجلُّهم ناشرون كبار، أمثال مركز دراسات الوحـدة العربية في بيروت، ودار جامعة كولومبيا في نيويورك، ودار بريل للنشر في هولندا، وسواهم. وقد نشروا لنا كثيرًا، ولكن هذا الكثير كان أقل بكثير مما كنا قادرين على تزويدهم به لو أن وزارات الثقافة العربية رأت وآمنت وأعطت، مع أن براهين نجاح العمل كانت واضحة أمام أعينهم. ولكن أغلب هذه الوزارات لم تراجع شيئًا لنا أو تحاول التعرف على قيمته فنيًّا وعمليًّا. ولم تكلف أيّ وزارةٍ نفسَها عندما تخلّفت عن مساعدتنا حتى بكلمة اعتذار. هذا شيء مدهش للغايـة.
كنتُ قدمت للأمناء على الثقافة العربية مخطَّط مشروعٍ واسع درستُه بـدقة كبيرة وقلت لهم مستصرخةً اهتماهم أن يمكّنونا من القيام به ويديروا ماليته من عندهم بحسبما نتفق وإياهم ولم أعـد أسمع منهم.
لو أخذوا هذا المشروعَ لكان عندنا الآن مكتبة من الكتب نفخر بها، مترجَمة جميعها إلى عدد من اللغات العالمية بحسب مقاييسنا العالية التي اتبعناها بنجاح كبير. ولكني لم أعـد أسمع منهم. بذلنا لهم كل ما عندنا من اقتراحات ولم نعد نسمع شيئًا منهم.
ليس هذا مجرد مصادفـة، بل هو شاهدٌ عليهم للأجيال القادمة، شاهـدٌ مبيـن.
أدونيس ومهيار الديلمي

أدونيس
● رأيكِ في أدونيس مبنيٌّ على حادثة مرّ عليها عقود. وقد نقلتُ له ذات حوارٍ أجريتُه معه، قولَكِ: إنّ في مجموعته «أغاني مهيار» مشاركة مع مهيار الشاعر المغترب، وإنه لهذا السبب اختار هذا الاسم لها. وإنّ هناك من يَشتمّ رائحة «شعوبية» في اقتراحه هذا الاسم لمجموعته في البداية قبل أن يستبدل «مهيار» بـ«سريان». فكان ردُّه أنّ هناك أسماء أخرى مقترحة للمجموعة لا يعرف لماذا نسيتِها ولم تتذكري سوى هذا الاسم. وقال: إنك على ما يبدو مسكونة بفكرة مسبقة إلى درجة أنك ربطت بين «مهيار الدمشقي» و«مهيار الديلمي»، رغم أنه لا علاقة للأول بالثاني أكثر من تشابه الأسماء. وأخبرني أدونيس أنه صُدم بذلك، وبخاصة أنك تعرفينه، ولأنك شاعرة وناقدة يحترمها، ولو جاء هذا القول من شخص عادي لما قال شيئًا. لذلك كان ردّه عليك عنيفًا. وأكد كذلك أن من يقرأ ما كتبه شعرًا ونثرًا سيجد أنه خارج التصنيفات الشعوبية والعروبية القومية وغير القومية، وأن نتاجه كله يقوم على تهديم مثل هذه التصنيفات.
الآن؛ وبعد توضيح أدونيس، هل ما زلت متمسكة برأيك السابق عنه؟
■ متعِبٌ هذا السؤال، فالحقيقة التي يجب أن ندركها تغطي عددًا من الأجوبة: أولها أن الموضوع نفسه لم يعـد مهمًّا على الإطلاق بعد أن مضت سنوات عليه ونسيه الناس، ومن الحصافة تخطّيه. إنما من المهم أن نتذكر أنّ شعر أدونيس أهـم بكثير من شعر الديلمي، ولم يعد مهمًّا بالنسبة له أو لنا تذكُّر أيّ علاقة له مع الديلمي، سواء وُجدت أم لم توجَـد. إلا أنني لا أصدّق أن هذا كان يفوت أدونيس لحظةً واحدة، كما لا أصدّق أن إيراده شعرَ الديلمي جاء مصادفةً وعفوًا. هذه الإدخالات لا تجيء مصادفةً، ولكن بالنسبة لهذا الإدخال نفسه لا أجد أيّ أهمية في الوقوف أمامه وإضاعة الوقت، فشعر أدونيس شعرٌ باذخٌ قلَّ عديلُه. هذا السؤال يقودنا إلى حياتنا الأدبية في الخمسينيات والستينيات، أيْ إلى فترة التجريب واستقـراء قرارة النفس. كنا وقتئذٍ نهتم بهذه الأمور، ولكن القصائد تغربلت مع الزمن وأُسقط منها ما ليس مهمًّا، ولم يعد الصبر على نقاشٍ كهذا أمرًا ملزمًا أو مأنوسًا.
● كيف تنظرين إلى إسهام المرأة في المدونة الثقافية والفكرية والأدبية العربية؟ هل يمكن القول: إنه يوازي نظيره في دول الغرب مثلًا؟
■ لم يتوازَ إسهام المرأة في أيّ مكان من العالم بإسهام الرجل، ولعل وضع المرأة الطبيعي كربّة بيت وأمّ يؤخر مساواة إسهامها بإسهام بالرجل، ولكن لا بـد من القول: إن المرأة عندنا لم تواجه ما كان متوقَّعًا عند (البعض)، وهو إفشال مسعاها وتهميشها كليًّا، فهي لم تتهمّش عندنا كما كان متوقَّعًا. لا أستطيع أن أحكم على ما لا أعرف، فلا بـد أن ثمة نساء متعددات حُرمن -لأنهن نساء- من الاشتراك المباشر في العطاء الإبداعي، ولكن الأمر غير معلَن بحسب معرفتي، غير معلَن خجلًا، فمَن هو الرجل الذي يتعمّد مواجهةَ وضعٍ حسّاس جدًّا كهذا ويعترف بموقفه المانع الرادع لامـرأةٍ موهوبة، أختًا كانت أو ابنة أو زوجة، دخلت في عملية الإبداع ونشرت كتابتها. أظن أن هذا صعب جدًّا، ويظل -عندما يحدث- سرًّا عائليًّا قد يكشف نفسَه بعد سنين. أظن أن التدخل العائلي أحيانًا حرم عـددًا من الأديبات من البروز، كان هذا الحرمان شاهدًا على تعصُّب وتحكُّم كبيرَين لا حقّ لأي رجل بممارستهما. هذا القرن سيـرى بروز المرأة العربية المبدعة والمفكرة طولًا وعرضًا.
● أنتِ شاعرة أيضًا. وقد استمعتُ مؤخرًا إلى قصيدةٍ من نتاجك الأخير. هل تعتقدين أنك أنصفتِ تجربتك الشعرية وأعطيتِها ما تستحقّه من وقتٍ واهتمام؟
■ أعتقد أنني ظلمت نفسي وشعري، ولكني عندما اكتشفتُ سنةَ ١٩٨٠م فقرَ المكتبة العالمية بأدبنا، وكان فقرًا مخيفًا، استجبتُ لنداء الواجب الوطني والأدبي وقررت أن أحاول كلَّ ما أستطيعه لنقـل شيءٍ ذي قيمة من الثقافة العربية إلى اللغة الإنجليزية. وليس ما قدّمناه قليلًا. لقد غيّر وضع الثقافة العربية في العالم تغييرًا كبيرًا.
● هناك مَن يرى أن المرأة أبدعت في منطقة السرد أكثر من إبداعها في الشعر، وأنّ الأسماء النسائية المشهورة في عصرنا في كتابة القصيدة، لم تكن لَتنال الشهرةَ التي نالتها لولا دوافع أخرى عدا القصيدة، ففدوى طوقان شقيقة إبراهيم، ولكونها كذلك، حضرتْ في النقد والإعلام. ونازك الملائكة لولا ما قدّمته في مجال التنظير للقصيدة الحرة ولولا اهتماماتها النقدية لما حظيت قصيدتُها بما حظيتْ به. إلى أيّ مدى تتفقين مع هذا الرأي؟
■ الرجل أيضًا أبدع في مجال السرد أكثر من إبداعه في الشعر. أما الافتراض أنّ المرأة لا تنال الشهـرة الأدبية إلا خارج الإبداع، ففدوى لم تنَل الشهرةَ لأنها شقيقة إبراهيم، بل أيضًا لأنها كتبت شعرًا غير قليل كان جزءٌ منه شعرًا مقاومًا أشهرها كثيرًا في تلك اللحظة الأدبية، أما نازك الملائكة فقد كتبت شعرًا جيدًا بالأسلوب الحديث، ولا سيما في الخمسينيات عندما أبدعت لغةً شعرية انقلابية، وربما لا تتيح المساحةُ هنا إعطاءك ما يكفي من الأمثلة لإبداع نازك. على كلٍّ؛ هذا هجومٌ ذكوريّ على الشاعرات، ولا مكان له في النقاش الجـادّ.
إذا راجعنا حقبة الخمسينيات نستطيع أن نـدرك مدى إنجاز نازك الملائكة، و«أغنية حب للكلمات» مثلًا، وحدها تكفي للتعريف بمدى ما وصلت إليـه المحاولة الجديدة المبدعة التي قدمتها نازك للشعر العربي، ليس فقط ناقدةً، بل أيضًا شاعرةً، ولا سيما في معاملتها للّغة الشعرية. كانت نازك في خمسينيات القرن العشرين ملكة الشعر والنقد، لكنها سمحت للهجوم الذكوري الذي أحاط بها في مطلع الستينيات، وبالتحديد سنة ١٩٦٢م -يوم هاجم بعض النقاد كتابها «قضايا الشعر المعاصر»- أن يصدمها ويُقصيها عن متابعة مغامرتها مع اللغة الشعرية التي كانت مغامرةً جريئة ولافتة للنظـر كثيرًا. حتى الآن لا أستطيع أن أرى لماذا صمتت نازك أمام نقدٍ لا ديمومة له وغيّـرت مسارهـا.
● هل تجدين فرقًا بين «الناقد» و«الناقدة» في المدونة النقدية العربية؟
■ لا أتابع هذا المنحى بحثًا. الفروق النقدية تفشل إذا ركزت على هذا النوع من المقارنة في أيّ لغـة. نركّز فقط على قيمة الإدخالات الجديدة لا على جنْسِ مَن أدخلها.
● يسود العنفُ أرجاءَ الوطن العربي، ويغيب منطق الحكمة، برأيك كيف تصل شعوبنا إلى الطمأنينة؟
■ لا مجال هنا للحديث عن الطمأنينة. هذه ليست من مصطلحات هذه الفترة من حياتنا، فقد أصبحت غريبة عنا.
● كيف تلقيتِ نبأ إعلان الرئيس الأميركي ترامب القدسَ عاصمةً لإسرائيل؟ وكيف يمكن التعامل مع الأمر الواقع في هذا المجال؟
■ الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تُطلَب من مئات المتعلمين العرب ممن درسوا العلوم السياسية في جامعات العالم. لماذا لا يطْلعون علينا باقتراحات حلولٍ لا بـد منهـا. لعل أكثر المواقف شراسة وإيلامًا في المدة الأخيرة هي عندما فشل العرب في تقديم الاقتراحات الحيوية أيام «حسني مبارك» وقلبوا «الربيع العربي» إلى مأتم جديد.
● ما الذي تقرئينه هذه الفترة؟ وكيف ترتّبين أولويات القراءة لديك؟
■ أنا لا أقرأ في الرواية إلا في الليل؛ إلا إذا كنت أدرسها أيضًا وأكتب عنها. أما القراءة الفكرية والنقدية ففي النهار والليل بحسب رغبتي.
● هل من مشاريع تعملين عليها حاليًّا؟
■ عندي كتاب جاهز تقريبًا عن السرديات العربية القديمة كَتب لنا فيه عددٌ من أبرع المتخصصين في مواضيع السرد العربي عربًا ومستعربين، سيصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وقد يصدر أيضًا بالفرنسية. كما أنني تلقيت رواية مسلسلة بالإنجليزية عن الأندلس صدر منها حتى الآن ثلاثة أجزاء، وهي جميلة جدًّا، مفرحة في مطلعها في الجزء الأول، ثم يجيئها الحزن إذ تسقط تلك الحضارة الباهرة وتتحول إلى ذكرى. هذه تحتاج إلى ترجمة من الإنجليزية إلى لغتنا، وناهيك عن متعة قراءتها كرواية مبدعة، فهي تكشف للقارئ تاريخ مدة طويلة من تجربتنا تاريخيًّا مع العالم في الأندلس.
● أيّ أمنيةٍ لم تحققيها بعد، وتشعرين أنها ما زالت تلازمك؟
■ أن أكتب تاريخ الشعر العربي منذ الجاهلية، وقد سرتُ فيه مسافة ولكنه لم يتمّ بعـد.




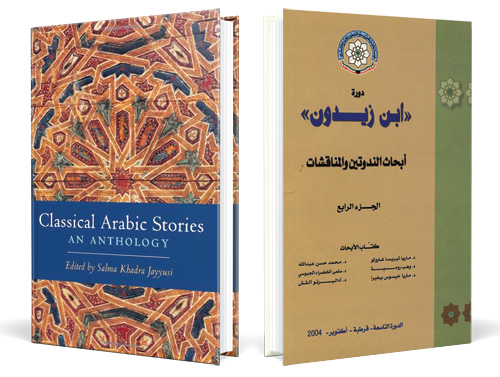 وفي مطلع الستينيات، ترجمت عددًا من الكتب عن الإنجليزية، منها كتاب لويز بوغان «إنجازات الشعر الأميركي في نصف قرن» (1960م)، وكتاب رالف بارتون باري «إنسانية الإنسان» (1961م)، والجزأين الأوَّلَين من «رباعيّة الإسكندرية» للورانس دريلم «جوستين» و«بالثازار» (1961/ 1962م)، و«هكذا خلقت جيني» لأرسكين كالدويل (1961م)، و«والت ويتمان» لريتشارد تشيس (1962م)، و«الشعر والتجربة» لآرشيبالد ماكليش (1962م).
وفي مطلع الستينيات، ترجمت عددًا من الكتب عن الإنجليزية، منها كتاب لويز بوغان «إنجازات الشعر الأميركي في نصف قرن» (1960م)، وكتاب رالف بارتون باري «إنسانية الإنسان» (1961م)، والجزأين الأوَّلَين من «رباعيّة الإسكندرية» للورانس دريلم «جوستين» و«بالثازار» (1961/ 1962م)، و«هكذا خلقت جيني» لأرسكين كالدويل (1961م)، و«والت ويتمان» لريتشارد تشيس (1962م)، و«الشعر والتجربة» لآرشيبالد ماكليش (1962م).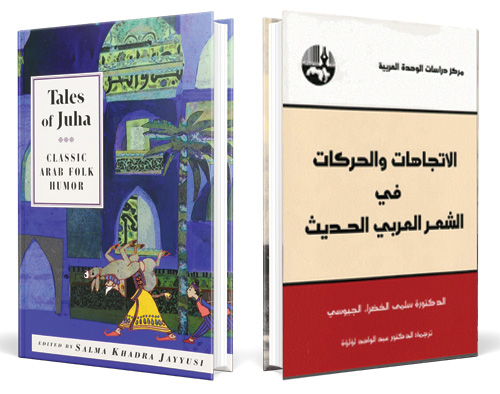 ● أخبرتِني خلال التحضيرات لهذا الحوار، أنّ السعودية دعمت زهاء عشرة مشاريع من مشاريعك. ما مدى اهتمام الحكومات والمؤسسات العربية بالمشاريع الثقافية، وكيف تقيّمين استجابتها؟
● أخبرتِني خلال التحضيرات لهذا الحوار، أنّ السعودية دعمت زهاء عشرة مشاريع من مشاريعك. ما مدى اهتمام الحكومات والمؤسسات العربية بالمشاريع الثقافية، وكيف تقيّمين استجابتها؟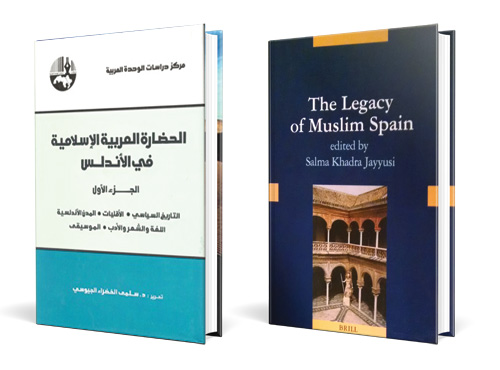 وأنت أستاذة أواسط الأربعينيات، نجحتِ في تشكيل رأيٍ عامّ ضد إدارة المدرسة التي تمثّل المستعمِر، وأشعلتِ فتيل إضرابٍ قامت به الطالبات. هل يمكنكِ استعادة تفاصيل ما جرى؟
وأنت أستاذة أواسط الأربعينيات، نجحتِ في تشكيل رأيٍ عامّ ضد إدارة المدرسة التي تمثّل المستعمِر، وأشعلتِ فتيل إضرابٍ قامت به الطالبات. هل يمكنكِ استعادة تفاصيل ما جرى؟









