
«افرح يا قلبي» لعلوية صبح.. جدلية الموسيقا والهوية
تدور أحداث رواية «افرح يا قلبي» للكاتبة اللبنانية علوية صبح حول تجاذبات الوطن والمنفى، وحول مفهومي المنفى الحقيقي والمنفى المجازي. يكتنف مصطلح (المنفى) عادة دلالة التهجير القسري للأفراد من قبل السلطة، وسواء أكانت تلك السلطة وطنية أم استعمارية، فموقعها الجغرافي قائم ومحدد، وهو جغرافيا الوطن، التي ستحدد جغرافيا أخرى هي المنفى، في حين يمكن استخدام مصطلح أوسع وهو (الدياسبورا) الذي يشمل المنفيين قسريًّا والمغادرين بطريقة شبه طوعية؛ بسبب ظروف عامة سلبية، كالحروب والكوارث الطبيعية والاستبداد، الذين شكلوا في مدة زمنية حالة جمعية. منهم من خرج بأوراق رسمية نظامية، ومنهم من خرج لاجئًا، أو بطريقة غير شرعية، والذين سيعاملون إداريًّا بطرائق مختلفة، فقد يطلق عليهم لفظ لاجئ، أو لفظ مهاجر، لكنهم سيشكلون الجماعة البشرية الفاعلة التي ستنتج آدابًا وفنونًا ومعارفَ وأعمالًا ستوسم بنتاج الدياسبورا، الذي سيقابله الإبداع والعمل في الوطن أو من الوطن، أو في الداخل، أو من الداخل .
تعد (الدياسبورا) التي تعني لغويًّا (الشتات) نزعة ما بعد كولونيالية، فضلًا عن أنها نزعة ما بعد حداثية أيضًا؛ إذ تنظر إلى القضايا القومية الكبرى من منظار محاولة التوفيق بين الصادق والعادل، وهي ليست مجرد إشارة بسيطة إلى حركة ثقافية عابرة للهويات، إنها صراع سياسي لتعريف المحلية، التي تخص مجتمعًا مميزًا، ضمن السياق التاريخي لمفهوم الإزاحة، والشتات، والاقتلاع من الجذور .
تشكل الدياسبورا الحالة الثقافية التي لا تذوب ولا تندمج في المنفى، فهي لا تشير إلى الفصل والانزياح والانقطاع، بل يفترض فيها عدم الانقطاع الكامل، فهي ضرب يجمع بين الانقطاع والارتباط ، ويمثل كتابها ومبدعوها العلاقة بين خصوصيتهم التي يغذيها الوطن وكونيتهم التي يغذيها المنفى، ولا سيما الميتروبولي؛ إذ «كان على المنفيين والمهاجرين واللاجئين والمغتربين المجتثين من أوطانهم أن يعملوا في محيط جديد، حيث يشكل الإبداع فضلًا عن الجديد الذي يمكن تبنيه فيما يعملونه، واحدة من التجارب التي لا تزال تنتظر مؤرخيها» .
التاريخ الفردي وتاريخ الجماعة
تعد الشخصية الرئيسة في النص (غسان) شخصية دياسبورية، فهو، بوصفه مبدعًا موسيقيًّا، نموذج روائي وجمالي يمثل ذلك التشظي بين الوطن والمنفى، لا ينقطع تمامًا عن الأول ولا يذوب تمامًا في الثاني، وفي ذلك تكمن إشكاليته الفردية التي تعبر عنها الرواية؛ إذ تتحول سرديته الفردية الخاصة إلى سردية الجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها، بدءًا من العائلة، إلى البلدة (دار العز) إلى الوطن (لبنان)، ومن ثم إلى سردية لكل بنية اجتماعية ثقافية ما بعد كولونيالية. تحدد تلك العلاقة الدرامية بين الوطن والمنفى حركة الشخصيات، التي تنطلق من فضاء صغير وهو قرية (دار العز) نحو فضاءات الميتروبول الواسعة في نيويورك وباريس، مرورًا بمحطات أخرى أصغر، مثل: برلين، وبيروت، وطرابلس، وقونيا، وبغداد، والقاهرة، حيث تتحرك الشخصيات أو تستعيد ذكرياتها، فتدفع حركة السرد قدمًا مع توالي الحكايات.
تختلط الأزمنة بالنسبة لتحديدات المكان الواضحة، ويعود ذلك إلى سيرورة الحروب؛ إذ تعيش أربعة أجيال من اللبنانيين حروبًا وثورات عديدة؛ بدءًا من نكبة فلسطين، مرورًا بالحرب الأهلية اللبنانية، فحرب العراق، إلى ثورة الأرز، وثورات الربيع العربي، ومع ذلك فليست الأحداث الكبرى هي التي تحدد التواريخ في النص، وإنما تحددها اللحظات الفارقة في حياة الشخصيات، مثل مقتل كل من (جمال) و (جورج) على يد الفصيل الديني المتشدد في الحرب الأهلية، ومثل دخول (عفيف) في اتجاه ديني متطرف، ومثل هجرة (غسان) إلى نيويورك بعد الحرب الأهلية، وهجرة أخيه (طارق) المصور إلى باريس بعد حرب العراق، وموت الأب (أبو جمال)، وحجاب (رُلى) وانتمائها إلى جماعة دينية متشددة.
مرجعيات نظرية
يكشف النص منذ عتباته الأولى في الإهداء عن النظرية التي كونته، أو عن الرؤية التي وراءه؛ حيث تفتتح الكاتبة نصها بمقتبسات من أقوال المفكر الفلسطيني الأميركي (إدوارد سعيد)، الذي يحضر كثيرًا في الحوارات بين (غسان) وزوجته الأميركية (كيرستن)، بوجوه شخصيته المتعددة: الأكاديمي، والمفكر في موضوعة الهوية والمنفى، والموسيقي صاحب الرؤية الطباقية، وأحد دعاة السلام عبر الفن والحوار، وستنص حوارات الزوجين على كتابيه (خارج المكان) وهو مذكراته الشهيرة، و(نظائر ومفارقات) الذي يضم حواره مع المايسترو الإسرائيلي (دانيال بارنبويم)، وستبدو شخصية (غسان) في معظم جوانبها صدى لشخصية (إدوارد سعيد) التي تشكلها تفاصيل مذكراته. تحضر بقوة أيضًا مقولات الكاتب اللبناني الفرنسي (أمين معلوف) في كتابه (الهويات القاتلة)، وإن كان اسمه قد غاب، فهو أشهر من ألّا يلفت نظر المتلقي إليه في كل مرة يشير النص فيها إلى عبارة الهوية والقتل، أو الهوية تقتل، أو الهوية القاتلة، فهي المقولة التي يلحّ عليها النص؛ ذلك أن أثر حروب الهوية في البلدان التي تتورط فيها لا ينتهي على مر الأجيال، وبذلك لن تتوقف أسئلة الهوية، مثلما لن يتوقف خطاب مقاومة الحرب، فكل لحظة لبناء الحياة فيما بعد الحرب هي لحظة مقاومة تحفظها الخطابات، وهذا ما فعلته (علوية صبح) منذ روايتها «مريم الحكايا».
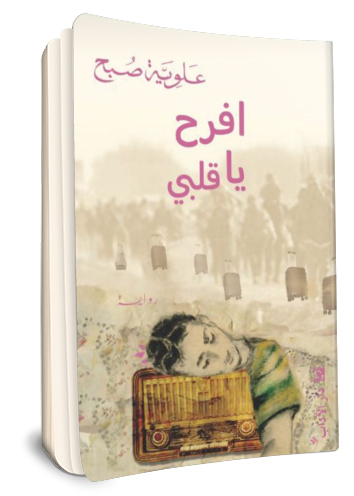 سمات الخطاب
سمات الخطاب
يقدم خطاب النص حالة الجماعة لحظة الحرب وبعدها، ويكشف عن القبيح الذي تنتجه فيشوه الفرد، والعائلة، والمجتمع، والذي لا فكاك منه في الحياة وفي الأدب على حد سواء. لا شك في أن خطاب الحرب الذرائعي مفعم بالمثل التي ستتوارثها الأجيال، ويمثل الأخ (عفيف) نموذجًا لذرائعية خطاب الحرب في النص؛ إذ سينتمي إلى جماعة دينية متطرفة خلال الحرب الأهلية، وسيقتل بسببه كل من أخيه (جمال) و(جورج) ابن أم جورج الجارة الحميمة، وحين نتتبع خط حياته مع الساردة إلى الخلف سيتبين لنا تسببه في مقتل (هبة) الصبية الحسناء ابنة صديق والده، حين أشاع بين أولاد البلدة في مراهقته عن علاقته الجسدية المدعاة بها، وراح يصف تفاصيل جسدها، فحذوا حذوه، وهو ما حدا بوالدها إلى أن يذبحها. سيواجه خطاب الحرب هذا بخطاب من وقائع، وصور، وأحداث، وحوارات، وموسيقا، وعلاقات حب يقاوم بها الموت، وحين تفشل هذه المقاومة سيتحول إلى خطاب المنفى الذي لن يستغني بأية حال عن مكوناته الثقافية، وقد تكون تلك الأخيرة تفاصيله مجتمعة كما في حالة (غسان)، فـ«الحرب هي خارج الثقافة، وضدها، أما المقاومة فهي في الثقافة، ومن أجلها أو معها» .
يتسم هذا الخطاب بأنثويته، على الرغم من تسنُّم (غسان) بؤرةَ السرد المركزية. ورث (غسان) الشغف بالموسيقا الشرقية من جده، وتابع دراستها في برلين، ثم اتخذ قراره بالقطيعة الثقافية معها في نيويورك، ليعود إليها مع ثورة الأرز. سنتعرف عبر (غسان) إلى شخصيات عديدة لكلٍّ حكايتها التي تبني النص وتحرك السرد، إلا أن تأنيث الخطاب يأتي من وجود الأم بوصفها الشخصية المحورية المقابلة لا لـ(غسان) فحسب وإنما للسارد أو الساردة كما أرجح، فهي الرحم الذي ولدت منه المصاير التراجيدية لأفراد العائلة جميعًا، ولمن حولهم أيضًا؛ إذ تطغى على النص حالتها الدرامية الناتجة من مواجهة قوتها بهشاشتها، عن ودفاعها عن وجودها الأنثوي، وعن أبنائها جميعًا الصالح منهم والطالح بلا تمييز، وعن موقعها التقليدي، وعن تضحياتها بكينونتها الأنثوية بقبولها بالعلاقة الملتبسة بين جهان خليلة الأب وزوجة الابن محمود فيما بعد، في مقابل التشبث بالجذور: «جلس أبوه وسط شلة من الجارات اللواتي يأتين عادة للسهرة في مثل هذا اليوم، وهن مرتديات قمصان النوم. يتحلقن حول الراديو، ويشربن الشاي في طقس خرافي، يبدين ]كذا[ فيه وكأنهن حريم أبيه، أمه تجلس إلى يساره، وجهان إلى يمينه» . تسيطر على النص أيضًا بلغتها الدرامية التي يتواجه فيها الاحتجاج مع الاستسلام، وهي تحكي حكاياتها الحزينة غالبًا: «يللي ما عندو بنات، بعيش بالغم!» .
المنفى المجازي
يصور النص العائلة بوصفها مصدر الشرور، ومحرك المصاير، ويفضح خطابه قيم هذه المؤسسة، والزيف الموجود في علاقاتها، ويصور الانقلاب عليها، والهرب منها. ويمكن أن تكون العائلة هنا أيقونة لمؤسسة أكبر تتمثل في الدولة، وهذا ما نسميه المنفى المجازي الذي سيدفع الأفراد نحو المنفى الحقيقي، فحسب فكتور هوغو: «للنفي وجود في خارج المنفى» .
أشار فكتور هوغو في مذكراته إلى قسوة المنفى: «ويمكن القول إجمالًا: إنه ليس ثمة نفي جميل» ، كما أشار إدوارد سعيد إلى ذلك كثيرًا، محيلًا إبداع الدياسبورا إلى شكل من أشكال مقاومة المنفى، فالمنفى عنده هو «الشرخ المرفوض الذي لا التئام له بين كائن بشري ومكانه الأصلي، بين الذات وموطنها الحقيقي، فلا يمكن البتة التغلب على ما يولده من شجن أساسي. وإذا ما كان صحيحًا أن الأدب والتاريخ يحفلان بحوادث بطولية ورومانسية مجيدة بل وظافرة حدثت في حياة النفي، إلا أن هذه الحوادث لا تعدو أن تكون جهودًا يقصد منها التغلب على أسى الغربة الشال، فمآثر المنفى لا يني يقوضها فقدان شيء خلفه المرء وراءه إلى الأبد» .
تخالف شخصيات الرواية رؤية كل من هوغو وإدوارد سعيد حول جحيم المنفى سواء أكان (غسان) أم طارق، أم سعيد صديق (غسان) الذي ينتمي إلى دولة عربية؛ وذلك لأن عذابات المنفى المجازي المتمثل في العائلة أو في الوطن، أكثر بكثير من عذابات المنفى الحقيقي؛ لذا سيواجَه المنفى المجازي بحِيَلٍ فنية عديدة، من مثل فضح الأعراف المدعاة، ونقد الانتهاكات الدينية والأخلاقية والتقاليد، والفرار من العائلة: «علمنا نيتشه ألا نشعر بالارتياح للتقاليد، وعلمنا فرويد أن نعد ألفة العائلة ذلك الوجه اللطيف المرسوم فوق غضبة قتل الآباء وغشيان المحارم» ، وسنجد ذلك الـ(تابو) في علاقة جهان الملتبسة والمحرمة بكل من الأب وابنه، كما سنجده في موقع جسد الأم المحروم، وعذاباتها النفسية المكتومة في هذه الثلاثية، وفي تناقضات عفيف وتحوله من بلطجي إلى متدين متطرف، وفي تخبطات جسد الأخ سليم بين الأنوثة والذكورة، وفي اكتشاف (غسان) للذة عبر جسد ابنة خالته الأربعينية الذي ظل يسبقه إلى كل امرأة يقاربها. سنجد جحيم المنفى المجازي أيضًا في ذكورية الأب وفي سطوته، وفي استسلام الأم، وفي القتل على الهوية، وفي قتل الأخ لأخيه، وفي الغطاء الديني للجشع، والظلم، والسلطة السياسية.
لعل تفاصيل جحيم المنفى المجازي تلك تجعل من المنفى الحقيقي جنة مطلوبة، بحيث لا تظهر عذابات المنفى التي أشار إليها إدوارد سعيد جلية في النص؛ لأن قوة المنفى المجازي أوسع سرديًّا، ولأن تفاصيله أقسى إنسانيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا؛ لذا لا بد من الهروب منه بأية طريقة، وما النوستالجيا إليه سوى حالة من المازوخية التي وقع فيها (غسان) لحظة موت أبيه. إن المنفى المجازي بسطوته العاطفية يشد (غسان) من (كيرستن)، ومن مانهاتن، نحو (رُلى)، ونحو دار العز، ونحو العائلة التي تتوارث أمراضها، وتطورها بناءً على السياق التاريخي الذي تطبعه الحروب المتوالية بطابعها.
فخاخ الهوية
استطاع (غسان) في لحظة وعي أن يصل إلى القطيعة العاطفية مع الوطن، وأن يقنع ذاته بأنه يمكن صناعة الهوية على قد الفرد وأهوائه: «وحده الفن جدير بأن يكون هوية» ، وأن الإبداع ليس رد فعل على حالة النفي كما أشار إدوارد سعيد، بل هو فعل بحد ذاته: فـ«الثقافة الغربية الحديثة هي في جزء كبير منها نتاج المنفيين والمهاجرين واللاجئين، والفكر الأكاديمي والنظري والجمالي في الولايات المتحدة، لم يصل إلى ما هو عليه اليوم إلا بفضل أولئك الذين هربوا من الفاشية والشيوعية وسوى ذلك من الأنظمة المجبولة على قمع الخارجين عليها وطردهم» . بقي (غسان) مؤمنًا بذلك إلى أن تأتي لحظة نكوصية يعود فيها إلى الوضع الذي وصف إدوارد سعيد به المنفى سابقًا حيث لا انقطاع ولا اندماج، وذلك بولادة ابنته آية، بعد زواجه من (رُلى)؛ إذ أعاد ذلك الارتباط علاقته الإشكالية مرة أخرى مع الوطن، وأيقظ فيه الجينات الثقافية التي اعتقد أنه استطاع تنحيتها: «فكر في أن (رُلى) تتحمله وصابرة على هجرانه لها، فلم يحرمها طفلًا يملأ عليها حياتها؟… ولكن حملها هذا سيربطه بها أكثر، كما سيربطه ببلاده، وهو الذي لم يفكر إلا بالقطيعة الكاملة معها… وجد نفسه في الشارع يبتسم، وغبطة مفاجئة تملؤه بعدما تخيل نفسه فجأة أبًا… سينجب من (رُلى) ما دامت (كيرستن) لا تنجب، فهو تزوجها في سن لم تعد تسمح لها بالإنجاب…» .
تواجه فخاخ الهوية في النص برؤيتين؛ إحداهما إقرارية تهكمية تطرحها الساردة، والأخرى تشكيكية تراجيدية يطرحها (غسان). يستعمل التهكم وسيلة فنية لكشف فصام الشخصية العربية من الحقبة الكولونيالية، حيث بدأ ازدواج الهويات الأيديولوجية بصورته المشوهة، الناتجة من جهل بالأنساق الثقافية وبمعطياتها، فيُتهكم على الرؤية السياسية للأفراد البسطاء، وعلى موقفهم من الانتماءات الأيديولوجية: «لكن الغريب أنه على الرغم من انتماء أبيه للناصرية نسبة إلى الرئيس جمال عبدالناصر الذي كان متيمًا به، كان يحن إلى زمن الأتراك حين يخبره جيرانه عن الجوامع الكثيرة والأسواق الشعبية والخانات وآثار عمرانية رائعة ما زالت حتى اليوم. وعلى الرغم من أن جارهم (أبو جورج) كان شيوعيًّا اكتشف (غسان) لاحقًا أنه انتمى إلى هذا الحزب لأن روسيا أرثوذوكسية» .
ينتقد التهكم المفاهيم الملتبسة عن الأيديولوجيا التي تطبعها الثقافة المحلية بطابعها، وتقود إلى حروب وثورات بدوافع مشوهة أحيانًا ونتائج مشوهة، يكون البسطاء والأنقياء وقودها وضحاياها غالبًا، إذ يتحدث (غسان) عن أخيه جمال الذي قُتل في الحرب: «ذهب إلى يسار الحياة، ليس لأنه ملحد، فهو يصلي ويصوم، لكن مظلومية الفقراء دفعته للاختيار… بلغ الشعور أقصاه في سن الثامنة عشرة حين كان ينزل إلى بيروت مرتين في الأسبوع متجهًا نحو الجامعة، وآلمته مشاهد بيوت الصفيح عند أطراف المدينة وضواحيها…» .
تتبدى الرؤية الأخرى في الأسئلة المؤلمة التي يطرحها (غسان) على طول السرد، والتي تصاغ بشكل تنظيري في منهاتن، حين ابتعد من ضغوطات العائلة، واحتاج المسافة الجمالية والفكرية لطرح الأسئلة الوجودية. ينبثق من هذه المونولوجات أسئلة الحقبة ما بعد الكولونيالية، وصياغات اللبناني الفرنسي أمين معلوف لها تحديدًا. لعل القضية الأخطر في نظر معلوف، التي جعلته يكتب كتابه (الهويات القاتلة) هو ما سماه (الشيء الذي في قرارة النفس): «هذا يعني أن لكل إنسانٍ قرارةَ نفسٍ، انتماءً واحدًا مهمًّا، هو حقيقته العميقة بشكل ما، جوهره، يتحدد عند الولادة، مرة إلى الأبد، ولا يتغير أبدًا، كما لو أن الباقي كل الباقي، أي مسيرته كرجل حر وقناعاته المكتسبة، وتفضيلاته، وحساسيته الخاصة، وميوله، وحياته كمحصلة، لا تهم في شيء» . يشرح في كتابه أن هذا اللون الواحد يقود إلى الإرهاب، وهو التكوين الذي شكل (عفيف) وانتهى به إلى التطرف حتى قتل أخاه: «هذا المفهوم الحصري والمتزمت والتبسيطي الذي يختزل الهوية كاملة إلى انتماء واحد ينادى به بغضب. هكذا يصنعون السفاحين» .
يدور حديث (غسان) مع عوده حول الثيمة ذاتها: «فجأة سمع صوته يقول «الهوية قيد»، ثم أردف ساخرًا ومقرعًا نفسه: لكنه قيد وجودي ضروري لطمأنينة الكائن، يحدد انتماءه إلى ثقافة ما، مكان ما، جغرافيا ما، وعالم ما، الهوية قيد وخلاص، حياة ومقتل. يا الله! كيف يمكن للكائن أن ينجو من هذا الفخ!» . يساعده في الوصول إلى يقين ما التجول في شوارع منهاتن، ومراقبة التعدد البشري الهائل: «أدرك أن البشر من كل الأجناس والبلدان يتساوون في الحزن أو الوحدة، حتى لو كانوا يجهلون بعضهم بعضًا، وفي هذا عدل ومساواة، لكن الشعور بالحرية هو ميزان العدل الأكبر. عندها أحسن بأن عليه ألا يحزن لأنه غريب، فالغربة خلاص لا مشكلة، والذي يكون غريبًا يكسب عالمه الخاص» . توصله المكابدات حول الهوية إلى قرارات قطعية تحرره من البيت، والعائلة، والوطن، والذكريات، لنكتشف فيما بعد أن مثل هذه القرارات انفعالية ومسيرة بردود أفعال غير حقيقية: «تابع سيره وهو يصرخ بأعلى صوته: أنا حر، بت حرًّا من كل ماضٍ. أقسم إني لن أعود إلى لبنان أبدًا، وإن مت سأوصي بدفني في نيويورك… ولم يكمل ما أراد قوله، فقد علق أول حرف منه في فمه» . يحدث في كل مرة أن يستثيره منبه هوياتي ما، فيعود إلى حالة عدم اليقين، وتعود الأسئلة المؤرقة حول تجاوز الذات الثقافية إلى أخرى، مثلما حدث عند لقائه فتاة عربية من مجموعة صديقه سعيد: «كرهها (غسان) ولم يعد يلتفت إليها. انتبه إلى نفسه مدركًا أنها لو كانت أميركية أو أجنبية لما اهتم لأمرها، وإنما لأنها عربية. لا يريد لأي منهن أن تكون حريتها فاسدة، وعلى هذا المستوى من التدني الأخلاقي. تفاجأ بإحساسه وموقفه منها، وقال لنفسه «أنا عربي»، ولم يكمل» .
يتحول الجسد أيضًا إلى ثيمة هوياتية، فتصير المتعة قابلة للتشريح الأنثروبولوجي الثقافي، ويأتي الوصل والقطع مع الهوية مع جدلية الجسدين؛ جسد كيرستن الغربي وجسد (رُلى) الشرقي، أي جسد يسحبه إلى المنفى الحقيقي، وآخر يشده إلى المنفى المجازي: «ليلة زواجه بـ(رُلى)، شعر أن هذا الجسد المستلقي معه في الفراش، كأنه يعرفه ولا يعرفه، جسم له رائحة نساء بلدته، وكأنه امتداد لجسمه… لماذا بقيت علاقته بجسم كيرستن يغلبها أحيانًا إحساس بالهزيمة، فيشعر بالضعف أمام جسدها، فيما يغلبه الإحساس تجاه جسم (رُلى) بأنه الأقوى؟… جسم كيرستن فرد مختلف وليس جماعة، وإن كانت له رائحة وبصمة أمريكية» ، ويقول أيضًا: «جسد كيرستن حر يستطيع أن ينفصل متى يشاء، هو لا ينتظره، بينما جسد (رُلى) يبقى في انتظار طويل…» .
تواجه فخاخ الهوية الراوية العليمة بحد ذاتها، فتعرض عن الإفصاح عن بعض الهويات الإشكالية أو المحظورة، أو تغفل وقائعيتها، فتتركنا لنختبر السياقات الثقافية واللغوية فنخمن جنسية (سعيد)، فيما تنجو بنفسها: «كان سعيد قد أتى إلى بيروت للدراسة في الجامعة الأميركية… بعد عودته إلى بلده، صودف جلوسه بين أصدقاء له ينتقدون بهمس رئيس نظام البعث الدكتاتوري والمستبد في بلده، كان بينهم واحد لم يعرفوا أنه مخبر…» . يفصح السرد عن مخاوف (سعيد) وأحلامه لكنه لا يفصح عن جنسيته، وعن النظام الذي يحكمه، وعلينا بوصفنا متلقين أن نعرف ما غيبه السرد، من السياق الذي يحيل إلى: شهريار، وألف ليلة وليلة، والبحث الأكاديمي فيها، والنظام الدكتاتوري، أو من المفردات مثل «ذبحتني» و«قتلتني».
تغفل الراوية العليمة أيضًا تسمية الفصائل المتطرفة في لبنان، مثل الفصيل الذي انتسب إليه (عفيف) مثلًا في الثمانينيات: «كانت البلدة آنذاك مع بداية الثمانينيات مثل الوطن كله، في حالة فوضى واهتراء… نجم أمراء يأفل ليصعد نجم أمراء آخرين مع انكفاء نجم التنظيمات القومية والوطنية، وصعود موجة الحركات المتشددة… الهلع ساد في البلدة ذلك اليوم بعدما وصلت أخبار شائعات من البلدة المجاورة تنبئ عن إعدام مسيحيين ومسلمين لم ينضووا ولم يرضخوا للحركة المتطرفة» ، أو الجماعة التي لحقت بها (رُلى) في الألفية الثالثة: «ولما فتح الباب وجدها ملفلفة بالسواد، لا يرى منها سوى بؤبؤي عينيها… كانت (رُلى) تستقبل التعازي بوفاة والدتها في بيتنا، وذات يوم جاءت نساء متعصبات ومتزمتات من البلدة لتعزيتها، لم تكن تعرفهن سابقًا، أظن أنهن من جمعية نسائية لتيار متطرف» .
يصرح النص، بخلاف ذلك الإغفال، بمواجهات الهويتين العربية والإسرائيلية، من خلال لقاء (غسان) الذي يحاكي هنا شخصية إدوارد سعيد بمجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، فيتنازعون على امتلاك الطعام بوصفه رمزًا للهوية، ولا تحدث مثل هذه اللقاءات، في الواقع خارج النص، بسهولة؛ إذ يتحفظ اللبنانيون والعرب عادة في بداية وصولهم إلى أميركا على مثل تلك اللقاءات، ولا سيما لو أعلن الطرف الآخر عن هويته، من غير أن يضع القناع الأميركي. يواجهنا النص بهوية ثالثة ذات أثر تراجيدي هي الهوية الجندرية، التي تمثلها شخصية الأخ سليم، فيضعنا أمام أسئلة الجسد، والسلوك، والرغبة، ولا نجد لها إجابة واضحة سوى اختفائه، وهذا الفخ الهوياتي يقع فيه كل فرد من أفراد العائلة، ويستجيب له بالألم والشفقة، أو بالشعور بالعار: «كان سليم ممسوسًا بالرقص الشرقي الذي لا يجيد سواه، يعوض به عن فشله المدرسي المتكرر، أو يستجيب له انسجامًا مع رغبة في النعومة تجعله أشبه بالبنات»؛ «على شعرة كان خلق بنت. وفي تلك الفترة من طفولته كان يحب أن يرتدي لون الزهر لأنه للبنات، لكنه لاحقًا كره النعومة وهذا اللون بعد أن تغيرت أهواء نفسه وجسده، وصار همه أن يجد نفسه كما يحلم. وفي مرحلة جذب الفتيات إليه تنفس أبوه الصعداء، لكن سليم بقي ضائعًا بسؤال: من أنا؟ ومن عليَّ أن أشبه وأكون مثله؟» .
مانيفستو للموسيقا الشرقية
تعادل ثيمة الموسيقا في النص ثيمة الهوية، وتصير المسبار الذي تُكتشف به كل من الذات والآخر. إن الموسيقا وإن كانت إحدى موتيفات الهوية مثلها مثل الطعام، واللباس، واللغة، تأخذ في النص بعدًا أعمق يجعلها الدال الرئيس على الهوية، وأداة التمييز بين الذات والآخر، ففي اللحظة التي قرر فيها (غسان) إحداث قطيعة مع الهوية الأولى، قطع عهدًا على نفسه بمقاطعة العود، بل الموسيقا الشرقية برمتها، والتفت إلى المنفى الحقيقي بموسيقاه الخاصة الغربية. لقد أعرض عن كل ما يشده إلى المنفى المجازي الذي ورث فيه المعرفة باللحن والعزف على العود من جده لوالده، وسمع فيه الأغاني القديمة من أمه، وأبيه، والجيران. ولد قرار القطيعة مع الموسيقا الشرقية لدى (غسان) إحساسًا بالهوية غير مسبوق أو متداول، جعله يشعر بحريته لأن هذا الإحساس مبتكر ومستحدث، وليس موروثًا أو مفروضًا، وعلى الرغم من أنه أعجب بمعرفة كيرستن بالفكر الصوفي وتقديرها له، لم يرتح لصدفة تعلقها بالموسيقا الشرقية التي جاء إلى أميركا للخلاص منها، وسوّغ لنفسه تقربه منها لطبيعتها الأميركية في التعامل مع جسدها، ولباسها، وظواهر محيطها الجمالية، وبأن هذا ما أذكى لديه الإحساس بالهوية، وليس السبب وراء إذكاء هذا الإحساس تعلقها بالموسيقا الشرقية: «يحدث أحيانًا أن يؤثر حدث سعيد أو حزين، او لقاء عارض على إحساسنا بالهوية اكثر من انتمائنا إلى موروث ألفي» .
يقدم النص مانيفستو حول الموسيقا والهوية، كما يقدم مسردًا بالموسيقا العربية والغناء العربي عبر مجموعة مختارة من الرموز: فريد الأطرش، وعبدالحليم، وشادية، وأم كلثوم، وغيرهم. يكتنف النص عروضًا تفصيلية للحن والمقام، فنبدأ بعنوان النص الذي يمثل عنوان أغنية لأم كلثوم أحبها (غسان)، وتعلقت بها بعد سنوات طويلة ابنته آية؛ لأنها مثلت بالنسبة لها هويتها المكتسبة من والدها، ودليلًا على ارتباطها به في غياب الأدلة الأخرى مثل العيش المشترك والرعاية اليومية. يربط النص آلة العود بإرث الجد، وبالمكان الأول (دار العز)؛ لذا سنلحظ مركزية هذه الآلة في السرد، بتاريخها، وشكلها، وصناعتها، وطريقة العزف عليها، لننتقل إلى تعرف (غسان) إلى الغناء الديني والموشحات في حلب حين زيارته لها مع جده، بالاتساق مع ألفته مع الترانيم الكنسية في كنيسة البلدة، والمكان الذي تمسك فيه بالصداقة مع الأصوات، فكانت الموسيقا العزاء والملجأ له من ضرب أبيه لأمه، لتصير فيما بعد الملجأ من تعقيدات الهوية وأوجاعها: «كانت نفسه دائمًا تنكسر في الكلام والصراخ في البيت، وتلتئم في الموسيقا والصمت» .
تصير الموسيقا لدى (غسان) ثيمة مركزية للمواجهات الهوياتية في النص، ويظهر ذلك عند انتقاله إلى المنفى الحقيقي حيث يتحول كل شيء إلى صراع على الهوية، وتبدو المرجعية النظرية للنص واضحة هنا وهي كتاب (نظائر ومفارقات/ استكشاف الموسيقا والمجتمع) وهو عبارة عن محاورات بين إدوارد سعيد وقائد الأوركسترا العالمي الإسرائيلي دانيال بارنبويم، لدرجة أن الأخير سيشار إليه في النص بوصفه المثال الأعلى لـ(غسان) في عزفه لـ(فاغنر)، الذي اختص (غسان) بموسيقاه في دراساته العليا. كان إدوارد سعيد قد خفف في (خارج المكان) عبء الهوية عن كاهل الموسيقا حين قال: «الموسيقا هي الموسيقا» ، كما أشار إلى أن «الشعور بالهوية مجموعة من التيارات، التيارات الجارية، أكثر منها بمكان محدد أو مجموعة ثوابت» ، كما أن دانيال بارنبويم نفسه عد عبارة: «أشعر أني في بيتي حيثما أعزف الموسيقا» عبارة مبتذلة لأن الشعور بالبيت أو بالهوية أعقد من ذلك، لكن النص بقي يربط بطريقة دوغمائية بين الموسيقا والهوية، عبر (غسان) الذي ربطهما أيضًا بطريقة مرضية، فبقيت الموسيقا مؤشرًا على حالة القطع والوصل بين المنفى المجازي والمنفى الحقيقي؛ لتنتهي القطيعة إلى صلح مع الذات عبر الموسيقا الشرقية، وذلك مع ثورة الأرز الأخيرة حيث عزف (غسان) أثناءها على آلة العود: «للمرأة الأولى شعر بثورة الوتر على الصمت والخوف» .



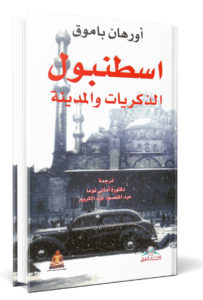 تظهر علاقة الكاتب مع المدينة العربيّة في الكتابات الروائيّة المتأخّرة أكثر نضجًا ممّا كانت عليه قبل تسعينيّات القرن العشرين، إنّها تقاطعات بين رؤية قومية أو وطنيّة تنتمي إلى الصفاء أو الذات، ورؤية كولونيالية تنتمي إلى الآخر، تلك التي تتسم بالموضوعية الظاهرية، على الرغم ممّا فيها أحيانًا من جهل، أو مبالغة، أو أيديولوجيا. توكّد تلك النصوص على التعددية الثقافيّة للمدينة في مجتمعات ما بعد الاستعمار، ممّا يشير إلى الرغبة في تدمير واحديّة النسق الاستعماريّ المسيطر، فالتعدّد هنا قوّة اجتماعيّة وثقافيّة، يدلّ على غنى حضاريّ تاريخيّ، تتمسّك به الكولونياليّات في صراعها مع القوّة المسيطرة، التي غالبًا ما تجيء من منطلق تفوّقها الأنثروبولوجيّ الثقافيّ، سواء كان دينيًّا أو عرقيًّا، فيظهر التأكيد على مدينية المدينة العربيّة بوصفه جزءًا من إستراتيجية تفكيكية للاستعمار.
تظهر علاقة الكاتب مع المدينة العربيّة في الكتابات الروائيّة المتأخّرة أكثر نضجًا ممّا كانت عليه قبل تسعينيّات القرن العشرين، إنّها تقاطعات بين رؤية قومية أو وطنيّة تنتمي إلى الصفاء أو الذات، ورؤية كولونيالية تنتمي إلى الآخر، تلك التي تتسم بالموضوعية الظاهرية، على الرغم ممّا فيها أحيانًا من جهل، أو مبالغة، أو أيديولوجيا. توكّد تلك النصوص على التعددية الثقافيّة للمدينة في مجتمعات ما بعد الاستعمار، ممّا يشير إلى الرغبة في تدمير واحديّة النسق الاستعماريّ المسيطر، فالتعدّد هنا قوّة اجتماعيّة وثقافيّة، يدلّ على غنى حضاريّ تاريخيّ، تتمسّك به الكولونياليّات في صراعها مع القوّة المسيطرة، التي غالبًا ما تجيء من منطلق تفوّقها الأنثروبولوجيّ الثقافيّ، سواء كان دينيًّا أو عرقيًّا، فيظهر التأكيد على مدينية المدينة العربيّة بوصفه جزءًا من إستراتيجية تفكيكية للاستعمار. 
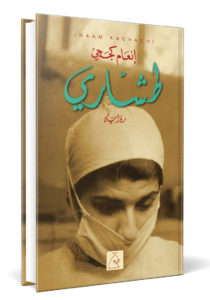 تتيح المدن الكوزموبوليتانيّة إمكانيّة اختيار الهويّة، التي تكون غنيّة ومتجددة، غير تلك الجامدة التي تفرض علينا بالمولد وبالقبيلة وبالدين: «أنا عدنيّ… لا أريد الانتماء سوى لهذه المدينة» (ستيمر بوينت)، وتفاصيل هذه الهويّة هي تفاصيل المدنيّة ذاتها: السينما، والمسرح، والبنايات الشاهقة، والمكتبات، والبنوك، والشركات، وقضايا الحداثة، من المنتديات، التي تناقش قضايا الدعوة إلى تحرير المرأة وإلغاء الحجاب، ولا نستثني أمراض المدينة والحرب والبحر، كالسلّ والتيفوئيد التي لا تكون في القرى والأماكن القصيّة غالبًا (ستيمر بوينت). تعيد إنعام كجه جي عبر علاقتها بالمدينة إنتاج كلّ من بغداد، والديوانيّة، والموصل في روايتها «طشّاري» (دار الجديد – بيروت)، هذه المدن المتفاوتة في حضورها التاريخيّ، تتساوى في المنفى الفرنسيّ، ويصبح معادلها الموضوعيّ مقبرة إلكترونيّة يصمّمها الحفيد ذو الهويّة المزدوجة (العراقية الفرنسيّة)، ويجمع فيها جثث الأقرباء التي تفرّقت بسبب نزيف الحروب. يتتبّع النصّ التاريخ السياسي والحزبي للعراق ودور النساء فيه، عن طريق الدكتورة وردية التي تحكي حياة أسرتها المسيحية، بالاتّساق مع تحوّلات المدن الثلاث، وحركة البشر، والكفاءات، والتعدّد الثقافيّ في فيلا الدكتور اللبناني فرنجيّة رئيس الصحة في الديوانية، وفي العلاقة مع أم يعقوب الصديقة اليهودية التي عقدت على مرآة سيارة الدكتورة ورديّة الجديدة في عام 1959م أم سبع عيون مربوطة بشريط فضي، ثمّ رحلت مع زوجها صاحب معمل الطابوق خوفًا من التنكيل باليهود في بغداد، فهاجروا إلى لندن، وبعدها إلى إسرائيل. (طشاري).
تتيح المدن الكوزموبوليتانيّة إمكانيّة اختيار الهويّة، التي تكون غنيّة ومتجددة، غير تلك الجامدة التي تفرض علينا بالمولد وبالقبيلة وبالدين: «أنا عدنيّ… لا أريد الانتماء سوى لهذه المدينة» (ستيمر بوينت)، وتفاصيل هذه الهويّة هي تفاصيل المدنيّة ذاتها: السينما، والمسرح، والبنايات الشاهقة، والمكتبات، والبنوك، والشركات، وقضايا الحداثة، من المنتديات، التي تناقش قضايا الدعوة إلى تحرير المرأة وإلغاء الحجاب، ولا نستثني أمراض المدينة والحرب والبحر، كالسلّ والتيفوئيد التي لا تكون في القرى والأماكن القصيّة غالبًا (ستيمر بوينت). تعيد إنعام كجه جي عبر علاقتها بالمدينة إنتاج كلّ من بغداد، والديوانيّة، والموصل في روايتها «طشّاري» (دار الجديد – بيروت)، هذه المدن المتفاوتة في حضورها التاريخيّ، تتساوى في المنفى الفرنسيّ، ويصبح معادلها الموضوعيّ مقبرة إلكترونيّة يصمّمها الحفيد ذو الهويّة المزدوجة (العراقية الفرنسيّة)، ويجمع فيها جثث الأقرباء التي تفرّقت بسبب نزيف الحروب. يتتبّع النصّ التاريخ السياسي والحزبي للعراق ودور النساء فيه، عن طريق الدكتورة وردية التي تحكي حياة أسرتها المسيحية، بالاتّساق مع تحوّلات المدن الثلاث، وحركة البشر، والكفاءات، والتعدّد الثقافيّ في فيلا الدكتور اللبناني فرنجيّة رئيس الصحة في الديوانية، وفي العلاقة مع أم يعقوب الصديقة اليهودية التي عقدت على مرآة سيارة الدكتورة ورديّة الجديدة في عام 1959م أم سبع عيون مربوطة بشريط فضي، ثمّ رحلت مع زوجها صاحب معمل الطابوق خوفًا من التنكيل باليهود في بغداد، فهاجروا إلى لندن، وبعدها إلى إسرائيل. (طشاري).
