
أُخوّة الباحث، تواضع العالم أندريه ميكيل (١٩٢٩-٢٠٢٢م)
لقيته صدفة ذات يوم من خريف ١٩٧٠م على رصيف شارع من شوارع الدائرة الخامسة عشر الباريسية، ولم أكن أدري يومها أننا نسكن جوار بعضنا. كان يسير وعلى وجهه مسحة من الكآبة، حاول محوها بسرعة حين لمحني. دخلنا في حديث عادي، سرعان ما قطعه ليخبرني أنه عائد من كنيسة الحي. ثم استدرك بعد ثوانٍ من الصمت أنه يتردد إليها للصلاة بعد وفاة ابنه منذ مدة. أحزنتني حالته، وهزّني أكثر تواضعه، وهو الأستاذ المرموق، في إبداء ضعفه أمام طالب أجنبي لم يلتقه إلا مرة واحدة قبل ما يقارب الشهر. نعم، استثارني ذلك الموقف بإنسانيته العفوية، حتى صار عندي بمثابة كلمة سر لم أبح بها قبل اليوم لأحد، وكأنها عقد خاص حميمي بيننا، ألجأ إليها حين أحاول فك أحجية هذا الإنسان.
ويتراءى لي اليوم، وأنا أكتب هذه السطور، أن علاقتي به اتسمت مذّاك بالاحترام الشديد مقرونًا بتعاطف كبير معه، لعله بلغ عندي حد العطف عليه، عطف الابن على أبيه إذ تُلمّ به النوائب. ولعلي بقيت أنظر إليه بتلك العين وهو في أوج مساره المهني، أستاذًا في الكوليج ده فرانس ومدبّرًا عامًّا له. ورحت ألبّي كل طلب يُوجّه إليَّ للاشتراك في حفلات تكريمية تقام على شرفه. وهل لك أن تغفل عن أب من طينته تدربتَ على يده وصادقته بإخلاص وإن على مسافة؟ ولعل هذه العلاقة لم تكن لتتخذ هذا المنحى، لولا لقاء جمعني به قبل أسابيع أتى على نحو خاص، جعلني أتساءل عن سر هذا الإنسان.
قيمه الرفيعة
كنت قادمًا من دمشق أبحث عن أستاذ يقبلني في حلقته الدراسية لإعداد ما كان يُسمّى وقتها بالميتريز. توجّهت إلى جامعة السوربون- باريس الثالثة، استهديت إلى قسم الدراسات العربية. ومع أني وجدت مكتب السكرتيرة مغلقًا، طرقت الباب وألححت. بعد دقائق خرج لي رجل في الأربعينيات، سألني بلطف وبشاشة عن حاجتي. قلت: أبحث عن مشرف لإعداد رسالة المتريز. فأجاب: السكرتيرة غائبة اليوم، هل أستطيع مساعدتك إن كنت على عجل؟ أدخلني إلى مكتبه وسمّى لي بعض المشرفين. فسألته عفويًّا ودون تحفظ عن رأيه بهم. نظر إليَّ وبعد ثوان أشار عليَّ بمقابلتهم شخصيًّا. ثم أضاف: لعلمك، أنا أيضًا أشرف على الدراسات الأدبية، ملمّحًا إلى أنه يشغل منصب المدير. أصابني الحرج من جهلي وقلّة لياقتي في التصرف، وقدّرت عاليًا رقيّ أخلاق هذا الإنسان إذ تجاوز عن سوء تصرّفي، وأدركت مدى تواضعه إذ قام بأعمال سكرتيرته المتغيبة ليوفّر المعلومات اللازمة لطالب وافد، وثمّنت احترامه لزملائه في القسم، وإن كان رئيسهم، إذ ذكرهم قبل أن يذكر نفسه.
استفهت عنه في اليوم التالي وإذا به الأستاذ الأشهر وقتها، أندريه ميكيل، مما زادني إعجابًا به. حظيت بإشرافه من الميتريز إلى دكتوراه الحلقة الثالثة عام ١٩٧٥م، ثم، بعد انتقاله إلى الكوليج ده فرانس، إلى دكتوراه الدولة، وكانت ما زالت قائمة آنذاك. مع الزمن تمكّنت العلاقة ما بيننا، فقدّر لي أن أستشف أكثر فأكثر القيم التي يهتدي بها. نعم، يتراءى لي الآن، بعد خمسين سنة من الألفة، أن هذه القيم هي أهمّ ما يمتاز به أندريه ميكيل عن أمثاله، حتى ممن لم يبلغ شأوه من العلم والتقدير، وهيهات أن توفّرها كثرة الشهادات الجامعية أو المناصب الرفيعة والأوسمة العالية الشأن.
نابغةً كان في الواقع أندريه ميكيل حتى قبل أن ينخرط في ميدان البحث. لمع ولمّا يبلغ الثامنة عشرة، حين تفوق في «المسابقة العامة»، وهي مسابقة يتقدّم إليها من بين الناجحين في البكالوريا من لمس من نفسه قدرة فائقة على معالجة موضوع من خارج البرامج الدراسية، تقترحه لجنة مختصة، ثم يُمنح بموجبها الطالب المتفوق في كل فرع جائزة غير مالية. وكان نصيب أستاذنا، بما أنه دخل المسابقة في فرع الجغرافيا، رحلة بحرية ما بين كورسيكا والمغرب العربي. بهذه العدّة تمكّن أندريه ميكيل (بعد سنتين تحضيريتين) من الانتساب إلى «المدرسة العليا للتربية»، ومنها تخرّج، على مدى عقود، كبار العلماء والفلاسفة في فرنسا. وفيها حصّل شهادة «التبريز، Agrégation»، أي أعلى شهادة تؤهّل للتدريس في الثانويات ثم في الجامعات، إذا ما اقترنت بشهادة دكتوراه. وجدير بالذكر أنه اختار فرعًا من أصعب الفروع، فرع قواعد اللغة الفرنسية، حيث رسّخ مقدرته اللغوية التي وظّفها في مؤلفاته الروائية.
خوّلته هذه المواهب الحصول سريعًا على منحة من المعهد الفرنسي في دمشق لإعداد أطروحة في الدراسات العربية، فكان أن فُتحت أمامه أبواب الجامعة، التي ما لبث أن تدرّج فيها إلى أعلى المناصب، إلى أن انتُخب عام ١٩٧٦م أستاذًا في الكوليج ده فرانس على «كرسي الآداب العربية الكلاسيكية»، وما لبث أن انتخبه زملاؤه ليشغل منصب رئيس إدارة الكوليج، قبل أن يعيدوا انتخابه لولاية ثانية دامت حتى عام ١٩٩٧م. وفي تلك الأثناء، عيّنه رئيس الجمهورية فرانسوا ميتيران مدير «المكتبة الوطنية العظمى»، ما بين عامي ١٩٨٤م و١٩٨٧م. في هذه المدة، نشر كتبه العلمية ومن أشهرها «الجغرافيا الإنسانية للعالم الإسلامي حتى أواسط القرن الحادي عشر، La géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du XI° siècle» (الواقع في ثلاثة أجزاء)، الذي شهره على المستوى العالمي. وتلقّى وافرًا من أعلى الأوسمة وحفلات التكريم.
موهبة فنية في الإبداع الأدبي
لم يقتصر إنتاج أستاذنا على البحوث العلمية، بل قام بترجمات قيّمة من التراث العربي. منها ترجمته (بمشاركة جمال الدين بن شيخ) لعمل جليل كان له تأثيره البالغ في الغرب منذ أن نُقلت بعض قصصه إلى الفرنسية ابتداءً من القرن الثاني عشر، هو كتاب «ألف ليلة وليلة». ومنها كذلك ترجمته لدواوين شعرية من عصر ما قبل الاسم مثل «ديوان مجنون ليلى»، الذي أوحى له بعمل روائي بعنوان «Layla ma raison»، أي «ليلى عقلي وهدف وجودي»، تلميحًا منه إلى جنون قيس بن الملوّح. ومن أهم ترجماته من الشعر الحديث ديوان بدر شاكر السياب. وإضافة إلى ذلك كله، مارس الفن الروائي على نحو خاص، وإليه ينتمي نصّه الوجداني الرائع، «الابن المنقطع، Le fils interrompu»، عن مرض ابنه ووفاته في سن الخامسة عشرة، وقد لاقى إقبالًا شديدًا وتُرجم إلى لغات كثيرة ومنها العربية بقلم طالبتي في السوربون، الدكتورة رشا صالح درويش.
كفاءات عالية وإنجازات بالغة الأهمية تشي بقدرته العقلية في البحث والتنظيم وبموهبته الفنية في الإبداع الأدبي. ولا شكّ أنه كان يُسرّ بها وبما تجرّ له من شهرة وتقدير، ولعلّه كان يسعى إليها، شأن كل إنسان، ولا ضير عليه. لا أُشيع سرًّا بقولي: إن أشد ما حز في قلبه -عدا وفاة ابنه- فشله المتكرر في الانتساب إلى الأكاديمية الفرنسية، أو مجمع اللغة الفرنسية الشهير، الذي أسسه الكاردينا ريشوليو في القرن السابع عشر لرعاية اللغة الفرنسية، ويُعد ذروة ما يسعى إليه أيّ كاتب فرنسي. فلا عجب والحالة هذه أن يغتم أستاذنا من كبوته هذه. وأستدرك قولي هذا بالتأكيد على أن أندريه ميكيل لم يقصر يومًا همه على النجاح. بل أُصر على عكس ذلك.

إنه من طينة أخرى لم يُجبل منها إلا قلة من الناس، لا يضعون جل مبتغاهم في تصدرهم العلماء والمبدعين وذوي النفوذ؛ إذ يعرفون أن العلم سلاح ذو حدين، يؤدي إلى الخير كما إلى الشر، وأن الشهرة آنية في الأحوال كافة وقد لا تُشبع إلا زهو «الأنا». هؤلاء لا يسعون إلى النبوغ إلا ليضعوه في خدمة الإنسان والمجتمع، وحسبهم ما يجنونه منه ما يضفي على حياتهم الخاصة مذاقها وألقها. فمقصد كل إنجاز هو ما يمنح الإنجاز قيمته الحقيقية، ملحه وسمته الإنسانية. وعندي أن أستاذنا من طينة لويس ماسينيون، سلفه في الكوليج ده فرانس على «كرسي الدراسات الإسلامية»، على اختلاف الطبع والسياق الثقافي بين عصريهما.
في دنيا العرب، وفي بغداد بالذات، تجلّت لماسينيون قيم الإسلام مُجسّدةً في سلوك بعض البغداديين الذين تفانوا لينقذوه من موت مُؤكد بعد أن اتهمه الوالي العثماني بالعمل لصالح دولة معادية، هي فرنسا. أُعجب بمروءتهم والتزامهم أخلاق الضيافة، مما لم يغفل يومًا في حياته عن الإشادة به. ذلكم الحدث جعله يستشفّ هدفًا جديرًا بأن يعطي معنى لحياته ويسلك إليه المسلك المناسب. أما الهدف فهو الاعتراف المتبادل ما بين المسيحية والإسلام، وفق مفاهيم عصره، حيث كان الغرب يطلق مصطلح إسلام أو العالم الإسلامي على المجتمعات كافة التي تدين أغلبيتها بالإسلام، مهما كانت أصولها الإثنية والدينية، لغاتها وثقافاتها، من دون أي اعتبار للانتماء القومي الذي مهّد لنهوض أوربا منذ قرون. وأما المسلك فتعريف الغرب، المفترض مسيحيًّا وإن كان واقعه يوحي بغير ذلك، على قيم الدين الإسلامي بالمعنى الحصري للكلمة، وإن كانت تلك القيم وثيقة الارتباط بالثقافات الشرقية عامة من سامية (إليها تنتمي الثقافة العربية) وآرامية وفرعونية وكلدانية وأخرى مما نشأ ما بين النهرين.
ولم يؤثر الخوض في أمور اللاهوت وعلم الكلام، بل التركيز على إبراز شخصيات دينية استثنائية (شأن الحلاج، الذي كرّس له مؤلفًا ضخمًا بعنوان «سيرة الحلاج وآلامه، La Passion d’al-Hallaj») وبخاصة الدفاع العملي عن حقوق العرب والمسلمين، فسعى آنذاك، أسوة بلورانس ومعه، إلى قيام مملكة عربية موحّدة، وعد بها الحلفاء الغربيون نخب المشرق العربي والجزيرة لقاء تحالفهم معًا ضد العثمانيين؛ وناضل في سبيل استقلال الجزائر وكرامة العمال المغاربة في فرنسا، كما دافع عن حقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. على منواله نهج أندريه ميكيل فتبنّى، كما عن فطرة، موقف «الأخوة» من العرب، حسب تعبير غابرييل مارتينيز غرو. ولا شك عندي أنه، لولا هذا الموقف العفوي المتميز، لما كان له هذا التأثير البالغ في زملائه وطلابه وكل من قاربه.
خياره الثقافي والإنساني
من منطلق التصوف أو من منطلق الأخوة، تلاقى ماسينيون وميكيل على الهدف والمقصد، أي: السعي لإعادة التواصل بين كتلتين بشريتين تمثّلان حضارتين متميزتين في تاريخ الإنسانية، تصادمتا على مدى قرون طويلة. ولكنهما اختلفا في سلوك الطريق المؤدي إليه. والواقع أنه ليس بين المسلكين تناقض ولا اختلاف، بل تكامل وائتلاف. يقول أندريه ميكيل في حديثه عن مساره، بعد تأكيده انتهاءَ صلاحيةِ مفهوم الاستشراق المرتبط بالرؤية الاستعمارية: «وأنا أُعِدُّ كتابي الأول المخصّص للأمثال في العصور الكلاسيكية [يقصد كتاب كليلة ودمنة، الذي ترجمه وعلّق عليه]، كنت أتجوّل في أنحاء سوريا ولبنان وجنوب تركيا. كما كنت أتلمّس أمرًا سيكون له تأثير جوهري على عملي فيما بعد، أي بدأت أُحسّ أنني مستعرب arabisant أكثر مني أخصائيًّا في الإسلام islamologue. أقصد أن الثقافة العربية، أيًّا كان مدى تشبّعها بالإسلام الذي نما في حضنها، هي أقدم منه وأرحب […] فإن كان الإسلام عربيًّا، إن جاز القول، فهيهات للثقافة العربية أن تُختزل كليًّا إلى الإسلام. ومن هنا اهتمامي بالجغرافيين القدامى».
من الواضح والحالة هذه أن خياره للمسلك الثقافي لم يرافقه أي موقف سلبي من الإسلام. ونحن نعرف أن أول ما استثار اهتمامه، عند أول لقاء له مع الحضارة العربية، هو نسخة فنية من القرآن الكريم يتقابل فيها النصان العربي والفرنسي؛ ركن الإسلام وجوهره متألقًا في ثوب الحضارة العربية خطًّا وزخرفة. تسنى له ذلك وهو في سن السابعة عشرة في أثناء رحلة من بين كورسيكا والمغرب العربي، كما ذكرنا سابقًا، مكافأةً له على تفوّقه في المسابقة العامة. لقاء مع عالم مجهول، يتصدّره كتابه الديني الخاص، حدّد إلى حد كبير مستقبله بأكمله، بما أن العربية أصبحت، حسب قوله السابق، ميدانه العلمي الأهم. فبقي القرآن الكريم موضع اهتمامه الخاص، بحيث نقل إلى الفرنسية سورة الواقعة مع تعليق مهم، وبقي الدين الإسلامي مرجعًا روحيًّا يسائله، كما حدث له حين فُجع بابنه، إذ يقول فيما بعد وفي سياق حديثه عن سجنه في القاهرة: «وأنا أجابه ذلك كله، لم أستطع الامتناع عن التناوب في مساءلة الإسلام، الذي كنت أخالطه باستمرار، والمسيحية التي أنتمي إليها». ومن المعروف أنه في مرحلة نضجه أعاد اكتشاف المسيحية بحيث أصبح الإنجيل المقدس يلازمه باستمرار، وكان من قبل قد تعرّف إلى الإسلام وأُخذ بموقفه الروحي، فتعانق الدينان في قلبه. ومن المفارقة أن تربّى في حضن عائلة شديدة البعد عن الدين عامة، فكيف عن الإسلام بصورة خاصة! مما يؤكّد صِدقَ موقفه من الإيمان ومن الإسلام بالذات.
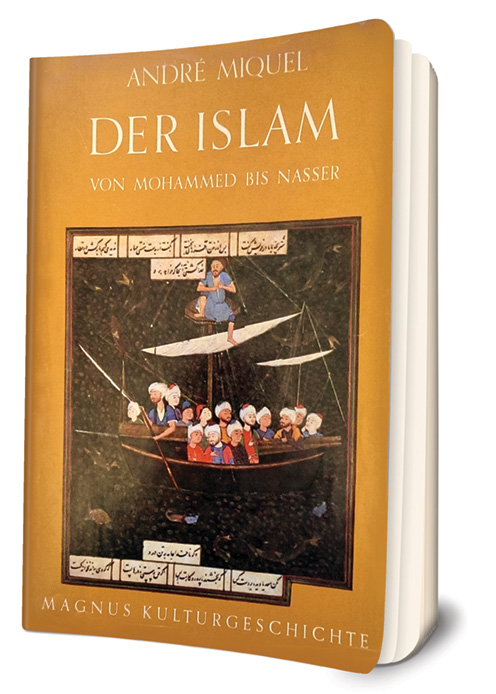 ولا بأس أن أُنوّه هنا بأن والديه كانا مدرسين في المدارس الابتدائية، التي اتخذتها الدولة الفرنسية في أوائل القرن العشرين حاضنة للفكر العلماني، فيها تتربى الأجيال الجديدة -بعد إعلان فصل الدين عن الدولة- على الالتزام بالعلمانية. وعهدت هذه المهمة إلى المدرسين الابتدائيين الذين كانوا بمنزلة إكليروس علماني في مواجهة الإكليروس المسيحي، حتى إنهم لُقّبوا بالمحاربين السود Les hussards noirs؛ بسبب ارتدائهم الثوب الأسود أسوةً بالكهنة المسيحيين. ولا ننسَ أن عائلته، إضافة إلى التزامها بالعلمانية، تنتمي إلى مجتمع كان لا يزال يشنُّ باستمرار حروبًا استعمارية ضد من جاورها من الشعوب العربية-الإسلامية، حتى ضد الدين الإسلامي نفسه. ذلك كله لم يحُل دون انفتاح أندريه ميكيل وهو في سن مبكرة على الإسلام. بل إن فطرة الانفتاح على الآخر، ولا سيما الآخر الغريب، هي التي تغلّبت عنده على كل عاطفة أخرى، وهي من دون شكّ إشارة وجدانية جلية إلى سلوكه بصدق وقناعة طريق الأخوّة، التي تقضي بالانفتاح على أيّ إنسان بما هو فيه إنسان، بغض النظر عن ثقافته ودينه ومنحاه الأيديولوجي.
ولا بأس أن أُنوّه هنا بأن والديه كانا مدرسين في المدارس الابتدائية، التي اتخذتها الدولة الفرنسية في أوائل القرن العشرين حاضنة للفكر العلماني، فيها تتربى الأجيال الجديدة -بعد إعلان فصل الدين عن الدولة- على الالتزام بالعلمانية. وعهدت هذه المهمة إلى المدرسين الابتدائيين الذين كانوا بمنزلة إكليروس علماني في مواجهة الإكليروس المسيحي، حتى إنهم لُقّبوا بالمحاربين السود Les hussards noirs؛ بسبب ارتدائهم الثوب الأسود أسوةً بالكهنة المسيحيين. ولا ننسَ أن عائلته، إضافة إلى التزامها بالعلمانية، تنتمي إلى مجتمع كان لا يزال يشنُّ باستمرار حروبًا استعمارية ضد من جاورها من الشعوب العربية-الإسلامية، حتى ضد الدين الإسلامي نفسه. ذلك كله لم يحُل دون انفتاح أندريه ميكيل وهو في سن مبكرة على الإسلام. بل إن فطرة الانفتاح على الآخر، ولا سيما الآخر الغريب، هي التي تغلّبت عنده على كل عاطفة أخرى، وهي من دون شكّ إشارة وجدانية جلية إلى سلوكه بصدق وقناعة طريق الأخوّة، التي تقضي بالانفتاح على أيّ إنسان بما هو فيه إنسان، بغض النظر عن ثقافته ودينه ومنحاه الأيديولوجي.
لقد توطّدت أواصر الأخوّة في قلبه مع المجتمع العربي إلى درجة أن محنة وجودية قاسية، أصابته أثناء وجوده في بلد عربي، لم تنجح في ثَنْيِهِ عن التزامه بالدفاع عن الحضارة العربية الوثيقة الارتباط بالإسلام. ففي عام ١٩٦١م، حين كان رئيسًا للبعثة الجامعية-الثقافية لدى السفارة الفرنسية في القاهرة، اتُّهم بالتجسس لصالح إسرائيل والنيل من أمن الدولة، تمامًا كما اتُّهم ماسينيون قبله في بغداد قبل نصف قرن. فسُجن وتعرّض للتعذيب وحُكم عليه بالإعدام، ثم أُطلق سراحه بعد سبعة أشهر في مارس/آذار ١٩٦٢م، بمناسبة توقيع اتفاقية إيفيان بين جبهة التحرير الجزائرية وحكومة الجنرال ديغول. صدمة نفسية هزّت كيانه من دون أن تنجح في تغيير نهج الأخوة الذي ارتآه تجاه الثقافة العربية وأهلها.
رسوخ نهج الأخوة
حين نطالع أعماله وندرك السبب الذي جعله يختارها هي خاصة، نتلمّس مدى رسوخ نهج الأخوة في قلبه وعقله على السواء. تعلّق ماسينيون بالحلاج بفعل ميله إلى التصوّف وتثمينه لمعنى الفداء. واختار ميكيل شخصياته المبدعة، انطلاقًا من اهتمامه بالجانب الحضاري، من حيث رؤية مؤلفها وقدرته على إضفاء معنى عما يعالجه. يرى الباحث المذكور سابقًا أن اهتمام ميكيل الخاص بالمقدسي، صاحب كتاب «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»، على سبيل المثال، لم يكن نابعًا بالدرجة الأولى من دقة معرفة المقدسي بواقع البلدان التي يصفها، بل من قدرته على خلق صورة ذات معنى عن هذا الواقع. ومن هذه الصورة راحت تتوالد سردية متكاملة، هي أقرب إلى عمل روائي ناجع، يرسم عالمًا بأكمله ويشير إلى معناه. ولا يتردد الناقد في إقامة مقارنة بين المقدسي وبين الروائي الفرنسي مرسيل بروست الذي يستحضر بلدة كومبريه من فنجان شاي وكعكة كان يغمسها فيه، صورة لخّصت عالمه آنذاك وطغت عليه. إنها، باختصار، تلك القدرة على استشفاف عالم داخلي متكامل انطلاقًا من تفاصيل واقعية في منتهى العادية، وهو ما يرقى بها إلى مستوى التخييل الإبداعي.
لا شك أن اهتمام ميكيل بالمقدسي لا يقل عنه أهمية تناوله لألف ليلة وليلة- وهو الكتاب الذي أثر إلى حد بعيد في المخيال الأوربي منذ القرن السابع عشر خاصة، فنقله إلى الفرنسية بمشاركة جمال الدين بن شيخ، ونشره في سلسلة La Pléïade وهي أشهر سلسلة أدبية في فرنسا. باختياره لهذا العمل العظيم، يعبّر ميكيل عن إعجابه بمخيال القاصّ الشعبي العادي، الذي يوازي إعجابه بالمقدسي ذي الثقافة المتوسطة، دون النخبة بدرجات. إن مخيال القاص الشعبي هذا يتناول القضايا الأساسية كافة في الحياة الإنسانية، ليعبّر عنها، كما تستوي في سياق ثقافته، بأسلوب طريف مبدع بعيد كل البعد من تزمّت أكثر الكتاب والفقهاء. ولعل من ميزاتها الأساسية أنها إبداع مشترك، أي في نهاية المطاف نابعة من مخيال أشخاص كثيرين من غير العلماء والنخبة، إن لم يكونوا من العامة. ولا أستبعد أن يكون إعجاب ميكيل بهذا القصص الشعبي مرتبطًا بحرصه على تراث بيئته الشعبية في منطقة جنوب فرنسا، المعروفة سابقا بـ L’Occitanie، موطن الشعراء الشعبيين الجوّالين، التروبادور، الذين اقتبسوا فنّهم من بعض أنماط الشعر العربي في الأندلس، وَفْق ما تعارَف عليه المؤرخون.
أما «كتاب الاعتبار» لأسامة بن منقذ -الذي نقله ميكيل إلى الفرنسية بعنوان «Oussama, un prince syrien face aux Croisés» (أسامة أمير سوري يواجه الصليبيين)- فمن نمط آخر. وانتقاء ميكيل له يشير إلى موقف إنساني آخر من أخلاق الفروسية، أو علاقة الفارس بخصمه في الحرب كما في السلم. أُعجب ميكيل بهذا الأمير الذي جمع بين الشجاعة في القتال وروح الفروسية في معاملته مع الغازي الصليبي. يقاتله بشراسة ويخالطه زمن السلم، عارف بمساوئه وقدرته على الغدر وغير غافل عن قيمه ومحاسنه. لا يصدر في علاقته به عن موقف أيديولوجي عقلاني، بل عن خبرة إنسانية تجعله يرى في خصمه إنسانًا متعدد الأبعاد، لا مخلوقًا تسيّره رغبة واحدة، هي في النهاية، التقيد بمواقف دينه دون أي تمحيص. فيُعجب ميكيل بإعجاب أسامة بهذا المحارب الصليبي الذي تُوفيت زوجته عن ابنة وحيدة كانت في مقتبل العمر، فلم ير ضيرًا في العناية بها عناية الأم، بحيث إنه راح يرافقها إلى الحمام ليغسل لها شعرها الطويل، غير مُصْغٍ لما تتطلبه منه عادات عصره وقومه بعدم الأخذ بتصرف النساء. كما يقدّر ميكيل تنبّه أسامة إلى أن الغزاة الصليبيين ليسوا سواسية في حسهم الإنساني، وأن كل فرد قادر على التطور والتكيّف مع بيئة أخرى. ذلك حين يخبر بتعرّضه لاعتداء من أحد الصليبيين وهو في الحمام العام. فينهض لنجدته صليبي آخر عرفه من كثرة تردده على الحمام، فيبادر ليكف عنه يد المهاجم ويعتذر لأسامة مشيرًا إلى أن هذا المعتدي غريب عن البلد، قادم من أوربا حديثًا وجاهل بتقاليدنا المحلية.
الدقة في قراءة النص
وأخيرًا لا آخرًا، لا بد من كلمة موجزة عن أخلاقه في ممارسته التدريس في مجال الأدب العربي، بما أنه شغل كرسي الأدب العربي في الكوليج ده فرانس، وأشرف على أطروحات كثيرين من الطلاب العرب. لقد تدرّب على يده أجيال من الطلاب والطالبات العرب، وأنا منهم. تعلموا منه الدقة في قراءة النص لاكتشاف شبكة المعاني التي تؤلف بين أجزائه، والبنية التي تنتظمه في سياقه الزماني والمكاني، وصولًا إلى القيم التي يحيل إليها، أيًّا كانت. كما أنه أمدّهم، إضافة إلى ذلك النمط التقليدي الصارم الذي نشأ عليه في النقد، بحب الاطلاع على المناهج الجديدة في تحليل النص، وما أكثرها آنذاك من بنيوية إلى تفكيكية إلى تحليلية نفسانية أو سوسيولوجية وغيرها… مما مارسها معهم دون أن يتقنها؛ لأنها حديثة العهد. أي نقل إليهم الانخراط في المعرفة من منابعها ليستكملوا بها فن النقد. فدفع بالعديد منا إلى تحصيل المزيد في الألسنية والسيميائية والفلسفية. وما كنا لننخرط في تلك الميادين، لولاه.
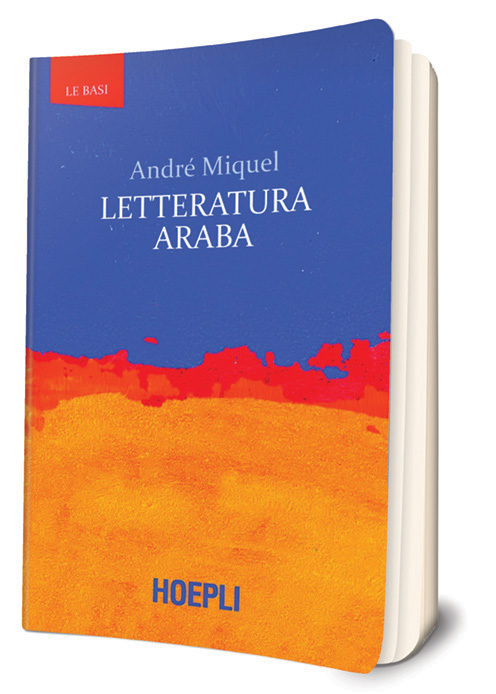 لا ريب أن المربّي الحقيقي هو من يدرّب طلابه على تجاوز علمه وكفاءته. وقد أقر ميكيل بصراحة في أكثر من مناسبة أنه ليس عالمًا في فن النقد، بل يرى نفسه أقرب إلى «السنكري»، bricoleur، يعتمد على ما يتوافر له من أدوات شتات تتآلف لإنارة النص، من دون أن ينسب إلى نفسه معرفة متكاملة في المناهج الحديثة. نتلمّس في هذا التصريح، غير المعتاد عند الأكاديميين، إلى تواضع العالِم الحقيقي الذي يعرف حدود علمه ويلتزمها. ويذهب إلى أبعد من ذلك فيقرّ أن عمله عن الجغرافيين العرب لا يمتّ إلى علم التاريخ بِصِلة، مع أن كتابه المذكور فتح أمام الجغرافيين آفاقًا رحبة أفاد منها مؤرخون كثر في العالم. ذلكم شأن العلماء الحقيقيين.
لا ريب أن المربّي الحقيقي هو من يدرّب طلابه على تجاوز علمه وكفاءته. وقد أقر ميكيل بصراحة في أكثر من مناسبة أنه ليس عالمًا في فن النقد، بل يرى نفسه أقرب إلى «السنكري»، bricoleur، يعتمد على ما يتوافر له من أدوات شتات تتآلف لإنارة النص، من دون أن ينسب إلى نفسه معرفة متكاملة في المناهج الحديثة. نتلمّس في هذا التصريح، غير المعتاد عند الأكاديميين، إلى تواضع العالِم الحقيقي الذي يعرف حدود علمه ويلتزمها. ويذهب إلى أبعد من ذلك فيقرّ أن عمله عن الجغرافيين العرب لا يمتّ إلى علم التاريخ بِصِلة، مع أن كتابه المذكور فتح أمام الجغرافيين آفاقًا رحبة أفاد منها مؤرخون كثر في العالم. ذلكم شأن العلماء الحقيقيين.
وبما أنه لا بد من اختتام هذه الشهادة الشخصية، فإني لم أجد أكثر تعبيرًا عن أخلاقية هذا الرجل المبنية على الأخوّة من نص قصير أستمده من إحدى خواطره الواردة في كتابه «أن تؤمن أو تحلم»، Croire ou rêver، حيث يقول:
«كم أكثَرْنا من الحديث النافل عن المحبة مُختزلةً إلى مجرد صدقة أو إلى مرادف بائس للأخوّة الحقيقية! لنعد مرة أخرى إلى الكلمة الأصلية carus، أي الله والقريب بوصفهما المآل الطبيعي لما نحمله من محبة. ويبقى علينا أن نتساءل: لماذا لا يُعرض علينا هذا الحب بوصفه مجرد حالة حياتية، بل على أنه فضيلة شأنها شأن الرجاء والإيمان؟ فالقول بالفضيلة دعوة إلى الجهد؛ أي، بمعنى آخر، أنْ لا حبّ نعيشه باكتمال في هذه الحياة الدنيا. وعليه أن نعوّض عن ذلك بأن نُحبّ، فلنُحبّ ولنُحبّ أيضًا وأيضًا وأزيد، وفق ما كان يقوله الأخ فانسان ده بول، بالرغم من أن ما هو عزيز على قلبنا يصبح أعزّ بما يفوق طاقتنا، بل بما يفوق كل ثمن؛ ومع أنّ أسمى محبة تحمل في طيّاتها دائمًا وأبدًا قدرًا من الأمل الخائب».
فهل من مزيد؟
باريس، أول فبراير/ شباط ٢٠٢٣م.

