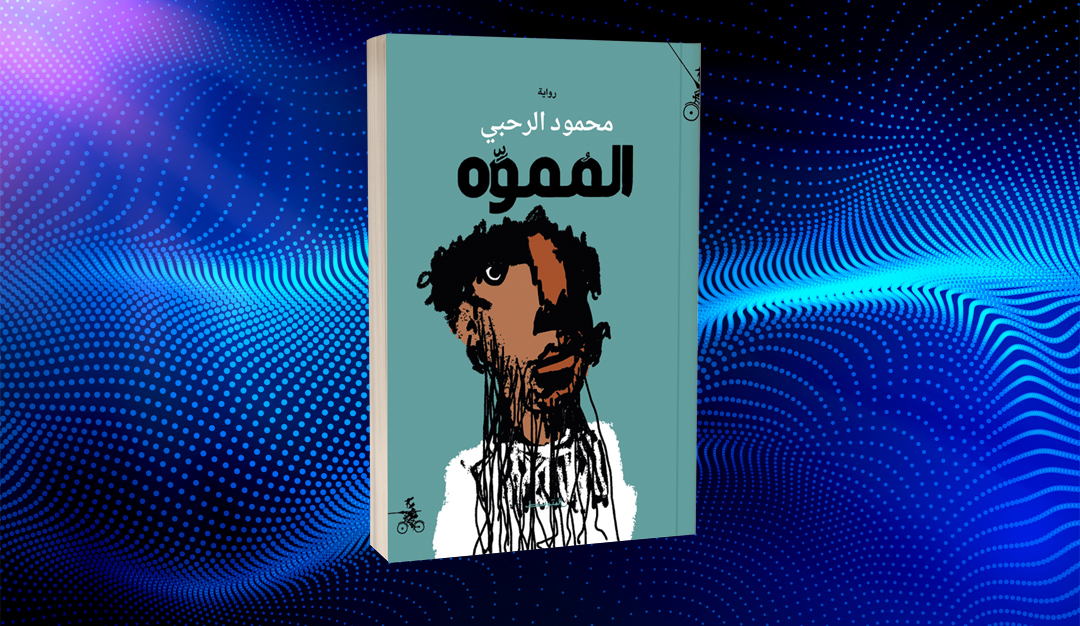
بواسطة محمد عبيدالله - ناقد وأكاديمي أردني | نوفمبر 1, 2023 | كتب
«المموّه» عنوان رواية قصيرة للكاتب العُماني محمود الرحبي. وعلى الرغم من نشرها تحت النوع (رواية) فإن طول الكتاب وطريقة كتابته وخصائصه الداخلية تتفق مع (النوفيلا) وطبائعها الفنية والسردية التي تقع في منطقة وسطى بين القصة القصيرة والرواية، وتمثل نوعًا أدبيًّا ثالثًا يختلف عن النوعين المجاورين. ولهذا النوع تاريخه الخاص، وله خصائص وأساليب فنية لافتة تعين الكاتب على عدم الإطالة في تقديم تجربة سردية تقتضي الكثافة ولا تحتمل الإطالة. ولذلك نشجّع الكتّاب والناشرين والقراء على الاعتراف بهذا النوع الأدبي وإشاعة تسميته وتصنيفه عربيًّا؛ ليأخذ مكانته التي يستحقها.
من أبرز علامات (النوفيلا) في هذا الكتاب أنه متوسط الحجم (نحو 55 صفحة) إلى جانب نظام التقسيم والتجزئة، فهو يتكون من (27 فصلًا) وهو ما يعني قِصر هذه الفصول. ويخلّف قصر الشريط السردي سمات داخلية تتطلب الكثافة والصياغة المحكمة، والابتعاد من أساليب التشعب والتوسع، لصالح بلاغة الحذف والإيحاء وتوسيع الفراغات القرائية. وهي سمات يلاحظها القارئ ويحمد معها حِرفة المؤلف ومقدرته في التكثيف والاجتزاء والاكتفاء بما هو ملائم لثيمة الكتاب من دون تفصيلات أو تشعبات؛ فكل شيء يبقى في حدود (النوفيلا) المكتوبة بتقنيات القصة القصيرة، بما فيها من قلّة الإسهاب وضبط مختلف العناصر بميزان سردي دقيق.
حياة مزدوجة
وأما عنوان الكتاب «المموِّه» فهو كلمة أو لفظة واحدة، بصيغة اسم الفاعل من الفعل (موّه) ومصدره (التمويه). وهذا الاسم هو مفتاح الكتاب وملتقى عناصره جميعًا؛ ذلك أن التمويه غدا عملًا للشخصية الرئيسة. وقد اكتفى المؤلّف بهذه التسمية ولم يمنحْه اسمًا خاصًّا، تاركًا المجال لصفته ولبلاغة وظيفته كي تحل محل اسمه. ومن ناحية الدلالة يُفهم التمويه على أنه ضرب من ضروب الحيلة والتضليل والإخفاء، ويتصل معناها اللغوي بِطَلْي المعادن بماء الذهب، فتتخذ ظاهرًا مخالفًا لجوهرها. ويبدو أن هذه الدلالة قد تحوّلت إلى ثيمة سردية اتجهت نيّة الكتاب إلى التعبير عنها في مستويات متعددة، فثنائية الظاهر والباطن وما تثيره وتسمح به من متعة الإظهار والإخفاء، وما تتيحه في أثناء ذلك من خيارات فنية ومن لعِب سردي كل ذلك يعد نسيجًا سرديًّا يتفق مع مطالب الرواية القصيرة ومع بنيتها التي تميل إلى تقديم أحدوثة كثيفة تخفي أكثر مما تظهر، وتدل بلغة الإيحاء أكثر مما تقول صراحة أو تفصيلًا.

محمود الرحبي
ويمكن ربط مبدأ (التمويه) وما يتخلله من تضليل وخداع بلون سردي قديم هو أدب الاحتيال الذي نجده في بعض أقاصيص الجاحظ وفي المقامات، ونحوها من سرديات واقعية لها بلاغتها في تحليل طبقات المجتمع، ولها وجهها المبهج من خلال لمحات السخرية والمفارقة المرتبطة بهذا الضرب من السرد. فبطل المقامات كثيرًا ما يقوم بدوره عبر (التمويه)؛ إذ يتظاهر في هيئة معينة بينما جوهره ومراده شيء آخر غير مظهره الخارجي. وعلى هذا الطريق سار محمود الرحبي ليقدم لنا صورة سردية جديدة تستأنف ذلك الضرب القديم؛ ليؤدي من خلاله دلالات واقعية تتصل بقراءة مجتمعاتنا المعاصرة، بما فيها أيضًا من ازدواجية الظاهر والباطن، والمُعلَن والمستتِر.
يروي (المموِّه) قصته بنفسه، فنحن إزاء سرد بضمير المتكلم يقدّم فيه الراوي تجربة شخصية، تلتبس بأسلوب السيرة الذاتية، مما يقرّبه من قارئه، ويجعل مشاهداته واكتشافاته أقرب إلى اعترافات بريئة مصدرها التجربة الذاتية التي تبعده من دراية السارد العليم، وتسمح له أن يتظاهر بشيء من البلَه وقلة الدراية، بل يتظاهر بالصدمة أحيانًا إزاء بعض ما يقابله في عالم الهامش المسكوت عنه في المحيط الذي يتاح له التجوال فيه.
وتقتضي وظيفة (التمويه) التي يحظى بها صاحبنا أن يعيش حياتين؛ حياة ظاهرة مع أمه وأسرته وجيرانه، وحياة أخرى باطنة، أقرب إلى حياة الليل التي يتطلبها عمله الجديد، مساعدًا ومموِّهًا مع (عثمان) رئيسه الجديد، الذي يقدّم معلومات محدودة عنه؛ ذلك أنه شخص غامض يمتهن أعمالًا مريبة تتطلب التمويه والغموض. أتاح هذا العمل السهل نسبيًّا للشاب أن يخرج على رتابة حياته، وكأنما أعجبه الدور فوافق على إطالة لحيته والتظاهر بمظهر يدل على ضرب من التدين الظاهري، وواظب إمعانًا في إتقان الدور على الذهاب فجرًا إلى المسجد، في هيئة أثارت ريبة أمه وبعض جيرانه خشية من تشدّده الديني. ويدخل السرد المتناوب بين هاتين الحياتين أو هذين الوجهين في إطار المفارقة وألوان من الازدواج، وهو ما يتطلب مهارات خاصة في مزيد من التمويه كيلا ينكشف أمره، فيتعلم ضروبًا من حيل الاحتجاج وكيفية الرد على الأسئلة الفضولية ليطمئن من حوله إلى عدم وجود شيء مخيف وراء هيئته غير المألوفة.
تفاصيل منتقاة
تقدم الرواية بأسلوب السرد المكثّف لمحات تغطي الخطين الأساسيين اللذين ألمحنا إليهما؛ الأول ما يتصل بعلاقته مع أمه وأسرته ومحيطه الاعتيادي. وقد نستشف من ذلك أن جوهر مأساته أنه شخصية أمومية، فهو آخر العنقود، فشل في الزواج والعمل، وبلغ سن الرابعة والثلاثين كولد مدلل، يحظى برعاية أمومية لا تخفى. يتحرك في هذه الحياة بين بيت أمه في مسقط، وقريتهم غير البعيدة حيث البيت القروي وزريبة الدواب التي لا بد من العناية بها وبالماشية المحبوسة فيها. وهناك زيارات الأقارب وبخاصة الخالات الثلاث، والأخت التي تصحب أمه أسبوعيًّا إلى القرية.
في هذه الطبقة تفاصيل منتقاة تضيء جانبًا من حياة المجتمع العماني الحديث، خصوصًا الطبقات الشعبية، بما فيها من تنوع ومن علاقات وصلات تقوم على مركزية الأم في الأسرة العربية، إلى جانب ما تومئ إليه الأحداث والتفاصيل من تداخل أنماط العيش القروي والمديني وتعايشها وتجاورها بصور متعددة في مجتمعاتنا العربية الراهنة، فضلًا عن بعض الإشارات الدالة على مشكلات الهوية والانتماء، مثل الإشارة إلى ضُرّة أصغر خالاته، فهي شابة عمانية إفريقية لا تعرف اللهجة وقد استعادت بعد زواجها انتماءها العماني، ولكن هويّتها مع ذلك بقيت مضطربة مشتتة، تنعكس على لغتها وتفاهمها مع الآخرين.

أما الوجه الآخر فيتصل بتجربة الراوي في التمويه، أي تجواله من بعد ظهر كل يوم حتى منتصف الليل بصحبة عثمان الذي يمكننا مجازًا أن نعدّه رئيسه وصاحب عمله الجديد. وهي رحلة يأخذه فيها إلى أحياء شعبية وإلى فنادق وحانات ومطاعم متعددة، داخل مسقط وخارجها في مدن مجاورة، بل ذهب مرة بالطائرة إلى ولاية بعيدة نسبيًّا. وكلها رحلات سريعة وقصيرة لا تخلو من المفاجأة والجدّة، ولا يعدم فيها التسلية على هامش عمل عثمان الذي لا يتدخل فيه، ولا يعرف عنه إلا ما يستنتجه عبر الملاحظة والاستنتاج، وكثيرًا ما يدفعه الفضول لطرح أسئلة ولكن رئيسه لا يجيبه ولا يشبع فضوله، ليظل العمل مموّهًا غامضًا. هذه هي دورة الحياة اليومية التي تتابعها الرواية من خلال ما يقدمه الراوي عن حياته وحياة الناس الذين يحيطون به، وخصوصًا أمّه في الحياة الظاهرة الاعتيادية، وعثمان في الحياة الباطنة الخفية.
ويمكن أن نرى في هذه (النوفيلا) الشائقة جانبًا من بلاغة المقايضة والتبادل؛ ذلك أن عثمان يقايض الراوي فيمنحه وظيفة مغرية، في ظاهرها، لا تحتاج منه صحوًا مبكرًا مثل وظيفته السابقة، ويعطيه راتبًا حسنًا، إلى جانب تغطية نفقاته وطعامه وشرابه، ويطلب منه مرافقته والتغطية عليه وجذب الأنظار وتشتيتها بعيدًا منه، وعدم طرح الأسئلة أو التدقيق في عمله. ويتميز الشاب المموه في القيام بدوره، ولا يلح في الأسئلة، ويعطي صاحبه التمويه المطلوب، مثلما يعطيه ويعطينا هذه الحكاية التي يكثف فيها إطلالته الخاطفة على المجتمع من أبوابه الخلفية، وشوارعه المعتمة الغامضة، كاشفًا عن بعض ظلال المسكوت عنه، إلى جانب انكشاف طبقات وثقافات ولغات متعددة في هذا الجزء المهمش من سكان المدينة والمقيمين فيها، وتبدو شخصية عثمان مفتاحًا من مفاتيح الهامش، وخبيرًا بزواياه وغوامضه، يتحرك بيسر ودهاء، ويتكلم ويفهم لغات عدة مما يتكلمه هؤلاء الذين جمعتهم أنماط العيش الهامشي.
تنتهي الرواية القصيرة نهاية مفتوحة باختفاء عثمان أو غيابه، وتذكّرنا أن البداية النشطة انطلقت في فصولها الأولى بظهوره المفاجئ، أما الراوي/ المموّه فيعبر عن شوقه لعثمان، وأنه يفتقد الجو السحري المحيط بتلك التجربة. وكأنه يدعو القارئ من طرف خفيّ إلى أن يستمتع هو الآخر بهذه اللمحات الشائقة التي حرص الراوي على تسجيلها من مشاهداته وتجاربه.

بواسطة محمد عبيدالله - ناقد وأكاديمي أردني | مارس 1, 2023 | جوائز, مقالات
في مناسبة نيل الدكتور عبدالفتاح كيليطو جائزة الملك فيصل العالمية لعام 2023م في فرع اللغة العربية والأدب/مجال السرد العربي القديم والنظريات الأدبية الحديثة، اعترافًا بجهوده الممتدة منذ عدة عقود في قراءة النثر والسرد القديم بعيون متأملة، تستهدي بالمناهج الجديدة، وتقدم أدبنا وتراثنا بأسلوب ممتع ومقروء يدرجه في اهتمامنا المعاصر، وفي ذلك صورة من صور تجديد التراث والتنبيه إلى ما فيه من كنوز وآثار دائمة الخضرة والحياة.
نتناول في هذه القراءة كتابه الموجز المعنون بــ«أبو العلاء المعري أو متاهات القول»(١) الذي يعد نموذجًا على مؤلفاته في السرد والنثر القديم، والنفاذ إلى الموروث من بوابة التفاصيل الصغيرة والظلال الهامشية. وإن نظرة خاطفة إلى بناء هذا الكتاب وعناوين فصوله ترينا اختلافه عن المؤلفات الأخرى المتعلقة بالتراث وأعلامه، فليس الجديد هنا هو المعري، وإنما طريقة قراءة الناقد له وطريقة الدخول إلى عالمه بمواربة ومن دون ادعاء بتقديم الكلمة النهائية. وإلى جانب صفحة «تقديم» و«كلمة ختامية» تدرّج كيليطو بين العناوين السبعة التالية: الفستق، منامات أبي العلاء، جنون الشك، رُبّان الحداثة، بين الجهر والسر، روايات، الكلب الأعمى. إنها عناوين أدبية سردية في عمومها، لا تدّعي شيئًا سوى تقديم رواية أو قصة «مفككة» ممتلئة بالفراغات التي تحتاج إلى ملء، ولكن ما العمل؟ لا شيء يتم، كأن النقصان والنسبية هما الأصل!
في الفصل الذي جعل عنوانه «الفستق» ربط المؤلف بين عمر الخيام والمعري من خلال بيت واحد، أخذه أو حوّره الخيام عن المعري، لم يركّز الناقد على الاختلاف بين وجهي: الزهد، واللذة، بل تساءل إن كان الخيام ابنًا روحيًّا للمعري؟ وعن مدى قبول المعري بهذه البنوّة؟ ولعل الناقد/ القارئ هو المعنيُّ بهذا السؤال وليس المعري؛ إذ رفض المعري أن يكون له أبناء بالمعنى الحقيقي والمجازي. ويرجح كيليطو رفض المعري للأبوة؛ لأنه «يكره أن يكون دائنًا أو مدينًا، والأبوة لا محالة تخلق دينًا في عنق الابن»(٢).
ومن هذه الفكرة ينتقل إلى فستق المعرة الذي استدعى ذكره وتأويله استعمال المعري له في إحدى هداياه وذكره في رسائله. كما سيرجع إلى ربط فكرة الدَّين في موقفه من والديه، ومن استمرار النسل والامتناع عن الزواج. يهمنا هنا إبراز انتقائية الناقد واختياره معاني النصوص التي تخدم تأويله. يذكر ما اشتهرت به معرة النعمان من الفستق الجيد، حسب روايات الرحالة والمؤرخين، ولكنه اعتمادًا على المعري يكتشف العكس: «ولكن المعري يؤكد العكس، فلقد بعث يومًا بشيء من الفستق إلى أحد معارفه، وأرفق هديته برسالة جاء فيها: (ولو أهديت إليه الأفق بثرياه، والربيع الزاهر برياه، لكان عندي أني قد قصّرت. وفي هذا البلد فستق رديء يسمى «غيظ الجيران»، ومعنى هذا الكلام أنه إذا كسر، ظن جيران السوء أنه ملآن، وهم لا يعلمون أنه فارغ. وقد وجهت شيئًا منه ليعبث به أتباعه)»(٣). ومثال على تساؤلات كيليطو وقراءته هذه الحكاية قوله: «إن المعري لم يكن ليجهل أن بلدته تنتج فستقًا جيدًا، فلماذا صدر عنه هذا القول المزيف؟ لماذا يقدم الملآن على أنه فارغ؟ وفضلًا عن ذلك لو كان الفستق رديئًا أكان سيسمح لنفسه بتوجيهه؟ إن ما يود تبليغه في الواقع هو أن مخاطبه لن يستدين بتسلمه للفستق، أي لن يكون ملزمًا بأن يهب له شيئًا مقابل ما توصل به… فكأن المعري يسعى إلى تقويض مبدأ الهبة الذي يسود العلاقة بين الناس، الهبة لا بد أن تقابلها هبة مماثلة أو مشابهة. ولكن أنى له ذلك؟ يود أن يلغي منطق الهبة والتبادل»(٤).
شطح الأسئلة
ووفق منطق القراءة الاعتيادية يمكننا أن نستنتج أن كيليطو قد ذهب بعيدًا وشطح بأسئلته، فمعرة النعمان اشتهرت حقًّا بفستقها حتى اليوم، ولكن كما هي الحال في البلدان التي تشتهر بسلعة ما فإنها تتوافر على أسوأ الأصناف وأجودها، فالوفرة تقترن بفرصة التفاوت، فليس كل فستق المعرة من الصنف الأجود، ويبنى على هذا أن المعري اختار نوعًا أو صنفًا رديئًا فارغًا سماه باسمه المتداول في البلدة: فستق غيظ الجيران، ولم ينفِ وجود الأصناف الجيدة، بل اختار النوع الفارغ ووجهه ليقوم بوظيفة الهدية الفارغة التي يقتصر دورها على إلهاء الخدم والصبيان والأعوان! هل يستهين كيليطو بهذه الوظيفة؟ ولذلك فليس ثمة تزييف في الخطاب؛ إذ كيف يرسل فستقًا جيدًا ويسميه رديئًا؟ هذا لا يستقيم! وإنما اختار الصنف الرديء الفارغ اختيارًا يتوافق مع الوظيفة التي يريد من الهدية أن تؤديها. ويمكن مع هذا التصويب في فهم النص أن نصل إلى النتيجة نفسها: تقويض فكرة الهدية والعبث بها، ضمن إلغاء أبي العلاء للاعتياد وللثقافة المتوارثة، ومن ذلك جملة الطقوس والعادات المكررة التي أعلن رفضها وجاهر بالخروج عليها دون مواربة.
 يعوّل كيليطو على مهارة القارئ وحصافته في التأويل والتقاط المضمر والمسكوت عنه، فما من مؤلف بريء، وإنما الكتابة مرتبطة أشد ارتباط بالارتياب، وربما تأكيدًا على هذا وتلويحًا به جعل «الارتياب»(٥) –في تقديمه- مبدأ يلحق بأعلام المؤلفين، وعرض وقائع سردية تتصل بمواقف شخصية من ذكرياته تتصل بارتياب المُتَلَقّين الأجانب بوجود الجاحظ والمعري، وكأنهما شخصيتان سرديتان لسنا على يقين من وجودهما التاريخي أو الفعلي. يترك كيليطو فجوة في نهاية المقدمة؛ إذ يسكت عند ارتياب المتلقين، ولا يحدّثنا عن ارتيابه هو، ولعل المعنى البعيد لهذا الارتياب ليس التشكيك في الوجود التاريخي، فقد وُجد الجاحظ ووُجد المعري، ولكن أية صورة من ذلك الوجود بين أيدينا؟ كل محاولة لقراءة المعري أو الجاحظ أو غيرهما هي صورة «متخيلة» ومحاولة لمحو الارتياب، ولكنها ويا للمفارقة، تضاعف من ذلك الارتياب بدلًا من إزالته.
يعوّل كيليطو على مهارة القارئ وحصافته في التأويل والتقاط المضمر والمسكوت عنه، فما من مؤلف بريء، وإنما الكتابة مرتبطة أشد ارتباط بالارتياب، وربما تأكيدًا على هذا وتلويحًا به جعل «الارتياب»(٥) –في تقديمه- مبدأ يلحق بأعلام المؤلفين، وعرض وقائع سردية تتصل بمواقف شخصية من ذكرياته تتصل بارتياب المُتَلَقّين الأجانب بوجود الجاحظ والمعري، وكأنهما شخصيتان سرديتان لسنا على يقين من وجودهما التاريخي أو الفعلي. يترك كيليطو فجوة في نهاية المقدمة؛ إذ يسكت عند ارتياب المتلقين، ولا يحدّثنا عن ارتيابه هو، ولعل المعنى البعيد لهذا الارتياب ليس التشكيك في الوجود التاريخي، فقد وُجد الجاحظ ووُجد المعري، ولكن أية صورة من ذلك الوجود بين أيدينا؟ كل محاولة لقراءة المعري أو الجاحظ أو غيرهما هي صورة «متخيلة» ومحاولة لمحو الارتياب، ولكنها ويا للمفارقة، تضاعف من ذلك الارتياب بدلًا من إزالته.
ويلتقط كيليطو تفاصيل جزئية من بعض الرسائل والحكايات الصغيرة، ويحاول تأويلها وتفكيكها كما يفعل في السرديات الصغرى، فهو في الأساس قارئ سرد، وربما لذلك أضفى على الكتاب كله روحًا سردية حتى في أسلوب كتابته، وطريقة عرض مادته، ويستخرج من باطنها خيطًا ما يفسر غموض المعري ويلقي ضوءًا جديدًا عليه. يتميز كيليطو بأسلوبه وطرقه في الربط أكثر مما يتميز بآرائه أو بالجديد فيما يكشفه. النص النقدي عنده أقرب إلى نص أدبي، فالناقد/ الباحث هنا «قارئ» مؤوّل، يحاول أن يفسر الحكايات والأخبار حتى الموضوعة منها تبدو ذات دلالة.
لا يكشف كيليطو عن منهجه بيسر، يتركه لتأويل القارئ وتسميته، إنه مثل بقية «التفكيكيين» لا يعد صنيعه «منهجًا»(٦) أو على الأقل يرفض أن يطلق عليه هذا المصطلح الذي ينتمي لعصر العقلانية، والفلسفة الكلية، لا يسمي هذا الصنيع أكثر من طريقة قراءة ومسار تأويل محتمل، ويتراجع البعد البحثي إلى درجة الصفر، ليحل مكانه البعد القرائي، ومن آيات ذلك أنه لا يشغل نفسه بتحقيق النصوص، أو بالرجوع إلى المصدر الأصلي، وأحيانًا يعتمد على المتداول منها دون توثيق.
متوائم مع نفسه
يخرج القارئ لهذا الكتاب بقراءة ممتعة، تشبه قراءة أثر أدبي مشوّق، لكنها قد لا تضيف كثيرًا إلى معرفته بالمعري؛ إذ إن تصعيد بعض الحكايات وتحريكها بأدوات سردية لا يضيف جديدًا إليها. كيليطو متوائم مع نفسه، لقد مارس «هوايته» القرائية في ملاحقة سلسلة من الحكايات الواردة في تراجم المعري وأخباره، وهي حكايات سهلة، ولدى المؤلف خبرة في تحليل الحكاية وظّفها في هذا الجانب، ولكن اللزوميات مثلًا لم ينل كبير اهتمام، والفصل الموضوع عنه ظل يدور في فلك المقدمة وبعض الأبيات بقصد الاستشهاد أكثر من التحليل، ولذلك نحسب أن هذه القراءة ظلت على عتبات عالم المعري، وتلصصت من نوافذ عزلته، ولكنها لم تكشف كثيرًا من مكونات عالمه الفكري الخصب والصعب.
القراءة التأويلية التفكيكية عند كيليطو قراءة سردية تطور قراءتنا للحكاية وللسرديات ولكنها لا تفتح أفقًا لقراءة شاعر فيلسوف، أدواتها تفكك وتقوّض أمورًا جزئية، ولكنها لا تتقدم أكثر من ذلك. إذن كتاب تفكيكي حول المعري ولكنه يدور في فلك حكاياته وأخباره أكثر من آثاره ومؤلفاته الصعبة. مع ذلك يحمد له ما يمكن أن يلتمس في منهجه من تدقيق ومن نفاذ من الزوايا المنسية والهامشية، ومن التعويل على دور القارئ نفسه في انتباهاته وذكائه، وفي حَفْز المتلقي ليغدو قارئًا أيضًا للمعري وللمادة نفسها، من دون أن نفرض عليه رأيًا محكمًا أو نهائيًّا، إنها قراءة حوارية لا تميل إلى الحسم، وقراءة أدبية تتفلت من جفاف البحوث وشعاراتها العلمية.
ينظر كيليطو للمعري بصفته «كاتبًا» يعي دور القارئ، ولذلك يعتني بما بين السطور، ويطالب بقراءة يقظة مرتابة: «هذا الإلحاح على أنه يخفي ما يعلم، قد يعود إلى كونه يخشى ألا يبصر القارئ ما يريد قوله حقًّا، أي ما لم يقله بصفة جلية صريحة، لهذا يحرص على لفت انتباهه، داعيًا إياه إلى نهج قراءة تكشف عما لم يكتبه، أو عما كتبه بين السطور. إنه في نهاية الأمر يطالب بقراءة حذرة يقظة مرتابة. لكن ألا تثير الكتابة بين السطور ظنون قارئ سيئ النية وميال إلى الإيذاء؟»(٧).
ويستطرد في الهامش موضحًا ما يقصده بهذا الضرب من «الكتابة»: «الكتابة بين السطور ليست بطبيعة الحال وقفًا على المعري… إنها على العموم تفترض تداول كتاب ما بين صنفين من القراء: قراء الصنف الأول لا يرون فيه إلا عرضًا موافقًا ومطابقًا للآراء الشائعة؛ أما قراء الصنف الثاني فِلمحون فيه شيئًا مختلفًا؛ لأن لهم طريقة في القراءة لا يمتلكها الآخرون. فهم مثلًا ينتبهون لتناقضات المؤلف ويتجنبون عزوها إلى نقص أو خلل في نمط استدلاله، خصوصًا عندما يشير المؤلف نفسه إلى احتمال وجودها كما فعل المعري في اللزوم»(٨). وهو يحيل إلى ليو شتراوس في «الاضطهاد وفن الكتابة» في إشارة دالة على مرجعياته البنيوية والتفكيكية. هذه المقاطع حول القراءة والكتابة والارتياب تذكر بمنهج كيليطو نفسه، وهو ينسى أو يتغافل أن المعري لا يكتب، وإنما يملي، وأنه ما عرف الكتابة قط لارتباطها بالبصر، أما ثقافة السمع، وآلية «الإملاء» في التأليف فنحسب أنها شيء مختلف كلية عن الكتابة، وينبغي اشتقاق معايير قرائية لتلائم هذه «الشفاهية» القدرية.
ومن الفقرات المتعلقة بعلو الاهتمام بالتأويل قول كيليطو: «تكمن المشكلة إذن في التأويل، في الطريقة التي قرئت بها اللزوميات. فالمعري يقصد شيئًا، وقُرّاؤه (أو فئة منهم) يصرون على رؤية شيء مخالف، فيعكسون الآية، فإذا بكتاباته تكتسي معنى لم يرده ولم يكن في حسبانه. هناك والحالة هذه سوء تفاهم فظيع، تغذّيه نية مبيتة للإساءة إلى المؤلف»(٩).
يحضر الناقد هنا في إهاب قارئ متمكّن، لكنه يقدّم قراءته بتواضع غير مفتعل، بعيدًا من لهجة التعالم التي شاعت في مصنفات المؤلفين، كتاب في أقل من مئة صفحة من القطع الصغير، بفصول موجزة بعناوين دالة، وهو لا يدعوك إلى تصديقه، بل يدعوك إلى مزيد من التأمل، وإلى التشكّك فيما يقول، ويترك لك حرية التأمل والتفكير. إنه –كما يقول واحد من أبرز قرائه- «لا يسعى إلى الكشف عن حقيقة المعري، فيما وراء التأويلات المتضاربة والآراء المتناقضة، ولا يهدف إلى القول الفصل في مسألة تديّن المعري.. بل يحاول أن يظهر لنا الشاعر في تناقضاته وصراعه بين الإفصاح والإضمار، والانكشاف والإخفاء»(١٠). مكتفيًا بلذة القراءة ووجوهها المتعددة، مستريحًا إلى حدّ من مقتضيات المنهج وإكراهاته المتعدّدة.
هوامش:
(١) عبدالفتاح كيليطو، أبو العلاء المعري أو متاهات القول، ط1، دار توبقال، الدار البيضاء- المغرب، 2000م.
(٢) المرجع نفسه، ص12.
(٣) المرجع نفسه، ص13.
(٤) المرجع نفسه، ص14.
(٥) للمؤلف كتاب صغير آخر عنوانه «الأدب والارتياب» فلفظة الارتياب أساسية في منهجه، أو طريقته القرائية.
(٦) انظر: سامي عبابنة، التفكيكية وقراءة الأدب العربي القديم، ع.كيليطو نموذجًا، في: دراسات (العلوم الإنسانية والاجتماعية)، الجامعة الأردنية، مج 42، ملحق 1، 2015م، ص1075، وما بعدها.
(٧) ع.كيليطو، أبو العلاء المعري أو متاهات القول، ص49.
(٨) كيليطو، المرجع نفسه، هامش ص49.
(٩) ع.كيليطو، المرجع نفسه، ص51.
(١٠) عبدالسلام بنعبد العالي، الأدب والميتافيزيقيا-دراسة في أعمال عبدالفتاح كيليطو، ط1، دار توبقال، الدار البيضاء-المغرب، 2009م، ص35.
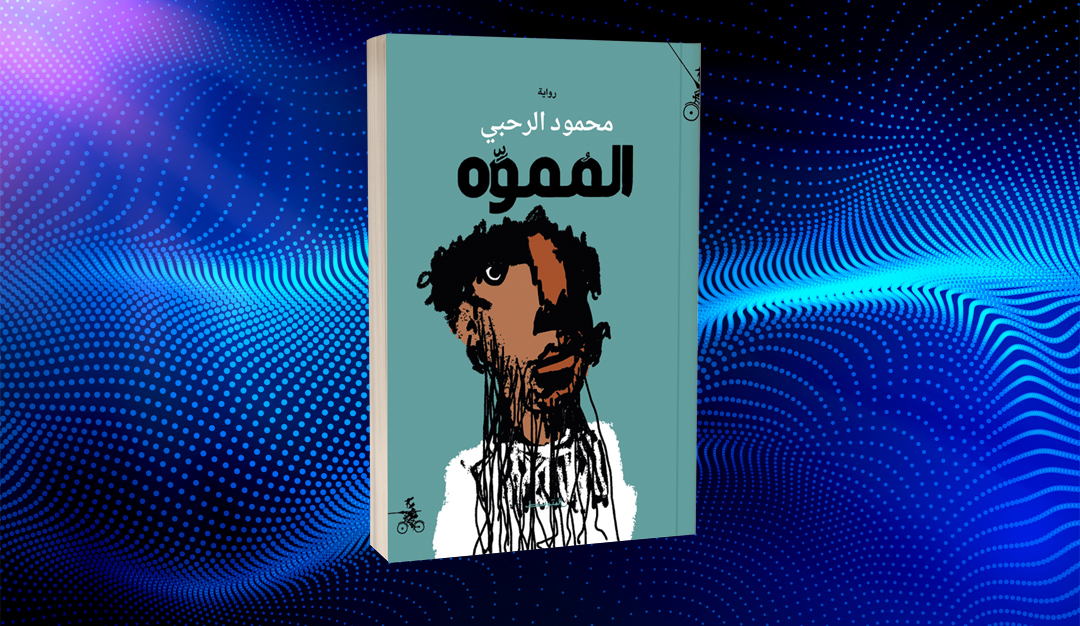




 يعوّل كيليطو على مهارة القارئ وحصافته في التأويل والتقاط المضمر والمسكوت عنه، فما من مؤلف بريء، وإنما الكتابة مرتبطة أشد ارتباط بالارتياب، وربما تأكيدًا على هذا وتلويحًا به جعل «الارتياب»(٥) –في تقديمه- مبدأ يلحق بأعلام المؤلفين، وعرض وقائع سردية تتصل بمواقف شخصية من ذكرياته تتصل بارتياب المُتَلَقّين الأجانب بوجود الجاحظ والمعري، وكأنهما شخصيتان سرديتان لسنا على يقين من وجودهما التاريخي أو الفعلي. يترك كيليطو فجوة في نهاية المقدمة؛ إذ يسكت عند ارتياب المتلقين، ولا يحدّثنا عن ارتيابه هو، ولعل المعنى البعيد لهذا الارتياب ليس التشكيك في الوجود التاريخي، فقد وُجد الجاحظ ووُجد المعري، ولكن أية صورة من ذلك الوجود بين أيدينا؟ كل محاولة لقراءة المعري أو الجاحظ أو غيرهما هي صورة «متخيلة» ومحاولة لمحو الارتياب، ولكنها ويا للمفارقة، تضاعف من ذلك الارتياب بدلًا من إزالته.
يعوّل كيليطو على مهارة القارئ وحصافته في التأويل والتقاط المضمر والمسكوت عنه، فما من مؤلف بريء، وإنما الكتابة مرتبطة أشد ارتباط بالارتياب، وربما تأكيدًا على هذا وتلويحًا به جعل «الارتياب»(٥) –في تقديمه- مبدأ يلحق بأعلام المؤلفين، وعرض وقائع سردية تتصل بمواقف شخصية من ذكرياته تتصل بارتياب المُتَلَقّين الأجانب بوجود الجاحظ والمعري، وكأنهما شخصيتان سرديتان لسنا على يقين من وجودهما التاريخي أو الفعلي. يترك كيليطو فجوة في نهاية المقدمة؛ إذ يسكت عند ارتياب المتلقين، ولا يحدّثنا عن ارتيابه هو، ولعل المعنى البعيد لهذا الارتياب ليس التشكيك في الوجود التاريخي، فقد وُجد الجاحظ ووُجد المعري، ولكن أية صورة من ذلك الوجود بين أيدينا؟ كل محاولة لقراءة المعري أو الجاحظ أو غيرهما هي صورة «متخيلة» ومحاولة لمحو الارتياب، ولكنها ويا للمفارقة، تضاعف من ذلك الارتياب بدلًا من إزالته.