
يوجين ثاكر أو في تشريح التشاؤم فلسفيًّا.. مقتطف من كتاب «تشاؤم كوسمي»
النشيد مفكرًا، هذا هو العنوان الذي يلح عليَّ كلما فكرت في كتاب «تشاؤم كوسمي» ليوجين ثاكر. إنه القصيدة بمفهوم أوسع، قد نجده في صلة لفظة الشعر بالإدراك العميق والوعي المتدبر، المعنى ذاته الذي تشير إليه عبارة «لا يشعرون» المطردة في النص القرآني. بعبارة أخرى، ينظم ثاكر نصًّا فلسفيًّا من طراز مخصوص، نصًّا يشبه في نحوه مادته التي يتفكر فيها ويلتحم بها. فيوجين هو الذي يذكرنا، في هذا المقتطف من الكتاب وفي سائر أقسامه الأخرى، أن التشاؤم ينبت في منزلة شائكة بين المزاج السيئ والفكرة السوداء أو الفكرة الحزينة ربما. من يدري؟ قد لا يجدر بالمرء أن يفصل الأفكار -مهما «كبرت» وأسندت إلى الفلسفة- عن الانفعالات والشعور. هذا تصور منبته لدى سبينوزا وأفقه لدى يوجين دون أن يكون قد صرح به إلا من حيث كونه سهم قراءة.
هل هو الكون أم الكوسموس؟ وكيف يمكن للتشاؤم أن يكون كوسميًّا؟ هل تتشاءم الكواكب البعيدة مثلًا؟ أم إن الثقوب السوداء عبارة عن ماليخوليا مبثوثة في مادة الكون؟ بالنسبة إلى شرح دلالة الاصطلاح «تشاؤم كوسمي»، فإن هذا ما يعمل على شرحه مؤلف الكتاب في هذا المقتطف أساسًا وفيما يليه؛ إذ يصله بمنزلتين أخريين من التشاؤم: أولهما أخلاقي («من الأفضل لو لم يولد المرء أصلًا»)، وثانيهما ميتافيزيقي («هذا أسوأ العوالم الممكنة»). أما فيما يخص سبب اختياري في ترجمة العنوان للفظة كوسموس، فذلك مرده أن المصطلح جارٍ على ألسن أهل الفلسفة العربية وأنه يعين مفهومًا مخصوصًا يعود إلى الفلسفة الإغريقية القديمة؛ إذ يكون الكوسموس الكون أو العالم منظمًا ومتناغمًا ومتناسقًا حيث كل عضو أو قسم يمتلك منزلةً محددةً بنظام و«موضعًا طبيعيًّا»، على حد عبارة أرسطو.
في هذا السياق، يشير ثاكر إلى بعض ممن يسميهم في موضع مغاير قديسي التشاؤم الآباء من قبيل شوبنهاور ونيتشه وسيوران. يشير إليهم لاعبًا بقراءته العميقة لمدوناتهم الفلسفية المتشعبة والمختلفة، التي يجد فيها نوعًا من الهدي. يقول مثلًا: «يتحرك منطق التشاؤم بين ثلاث أنماط من الرفض: قول -لا للأسوأ (رفض العالم-من-أجلنا، أو دموع شوبنهاور)؛ قول -نعم للأسوأ (رفض العالم-في-ذاته، أو ضحك نيتشه)؛ وقول -لا للـ من-أجلنا والـ في-ذاته (رفض مزدوجٌ، أو نوم سيوران). البكاء، الضحك، النوم- أي استجاباتٍ أخرى تكون مناسبةً لحياة موغلة في عدم مبالاتها؟».
لا ينظر يوجين ثاكر في هؤلاء الفلاسفة ومدوناتهم من باب الترف الفكري أو الاستعراض المتحذلق لمقالات وعقائد فكرية صارت بارزة في تاريخ الفلسفة الحديث(ة). إنه سالكٌ في شعاب قد سبقوه إليها، كلٌّ على طريقته وَفْقَ خصوصيته الفكرية والأسلوبية (من دون أن نكون ممن يقول بفصل تام بين الفكرة وأسلوبها). نحن إزاء شاعر، وباحث (في نظرية الميديا) ومفكر يقدم نفسه على نحو مباشر في «استقالة لا نهائية» بصفته «متشائمًا فيما يتعلق بكل شيء ما عدا التشاؤم». عودٌ على بدءٍ، إذن نحن إزاء شاعر يتفلسف أو فيلسوف ينشد يأسه من العالم والبشر والكوسموس. إنه، مثل آبائه المذكورين سلفًا، لا ينتمي إلا إلى مبالغاته القصوى. وضمن هذه المبالغات، تنجم تجربةٌ فريدةٌ في سياق الفلسفة الحديثة يمكن أن نسميها تجربة الفكر بصفته مغامرة كتابةٍ في الأساس.
المترجم
المقتطف الاستهلالي من كتاب «تشاؤم كوسمي»
ليس ثمة فلسفة تشاؤم. يوجد العكس فحسب.
إننا مدانون. التشاؤم هو وجه الفكر الليلي، ميلودراما عبث الدماغ وشعرٌ منقوشٌ في مقبرة الفلسفة. إن التشاؤم فشلٌ غنائي في التفكير الفلسفي، كل محاولة لبلوغ فكرٍ واضح ومتماسك تكون متجهمة ومغمورة بالبهجة الخفية لعبثها الخاص. إن التشاؤم الأقرب إلى الحجة الفلسفية هو العبارة الطريفة والوجيزة «لن نوفق أبدًا»، أو ببساطة «نحن مدانون». كل مجهود محكومٌ عليه سلفًا بالفشل، وكل مشروع لعدم الاكتمال. كل حياة محكومةٌ سلفًا بألا تعاش، وكل فكر بألا يتفكر فيه.
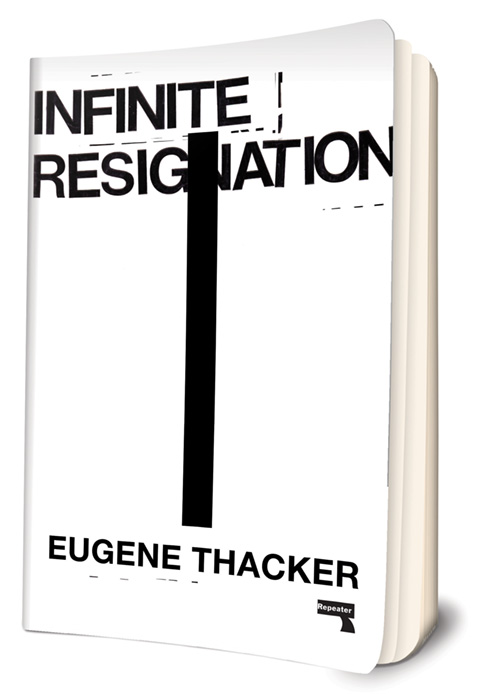 التشاؤم هو شكل الفلسفة الأدنى. ويحط من شأنه في معظم الأحيان ويقصى بصفته مجرد عرضٍ من أعراض موقف سيئ. لا أحد يحتاج إلى التشاؤم مطلقًا مثلما يحتاج المرء إلى التفاؤل؛ كي يلهم نفسه بلوغ القمم، ويرتقي بها، أو مثلما يحتاج المرء إلى النقد البناء أو النصيحة والملحوظات أو الكتب الحافزة أو يدٍ تربت على ظهره. لا أحد يحتاج إلى التشاؤم، على الرغم من أني أحب أن أتخيل إمكان عون تشاؤم ذاتي. لا أحد يحتاج إلى التشاؤم. ومع ذلك، الجميع -من دون استثناء- مضطر، في مرحلة ما من حياته، أن يواجهه. وإذا لم يكن ذلك بصفته فلسفةً، فبوصفه شكوى من الذات أو الآخرين، من محيط المرء أو حياته أو من حالة الأشياء أو العالم بعامة.
التشاؤم هو شكل الفلسفة الأدنى. ويحط من شأنه في معظم الأحيان ويقصى بصفته مجرد عرضٍ من أعراض موقف سيئ. لا أحد يحتاج إلى التشاؤم مطلقًا مثلما يحتاج المرء إلى التفاؤل؛ كي يلهم نفسه بلوغ القمم، ويرتقي بها، أو مثلما يحتاج المرء إلى النقد البناء أو النصيحة والملحوظات أو الكتب الحافزة أو يدٍ تربت على ظهره. لا أحد يحتاج إلى التشاؤم، على الرغم من أني أحب أن أتخيل إمكان عون تشاؤم ذاتي. لا أحد يحتاج إلى التشاؤم. ومع ذلك، الجميع -من دون استثناء- مضطر، في مرحلة ما من حياته، أن يواجهه. وإذا لم يكن ذلك بصفته فلسفةً، فبوصفه شكوى من الذات أو الآخرين، من محيط المرء أو حياته أو من حالة الأشياء أو العالم بعامة.
ليس ثمة ما يكفي للخلاص من التشاؤم، كما أنه ما من عزاء يكون جزاء له. وفي مجمل الأمر، التشاؤم سأمٌ من كل شيء آخر ومن نفسه كذلك. إن التشاؤم هو الصيغة الفلسفية لفك السحر عن العالم- فك السحر عن العالم بصفته إنشادًا، نشيدًا، مانترا(١)، صوتًا منعزلًا أحاديًّا وقد صير عديم المعنى بواسطة الامتداد الهائل والحميم المحيط به.
الرفض العظيم
ما زلنا مدانين. لا أحد يملك الوقت للتشاؤم. ففي نهاية المطاف، هناك بضع ساعاتٍ معدودةٍ في اليوم الواحد. ومهما يكن مزاجنا وسواءٌ أكنا سعداء أم حزانى، مندفعين أم منسحبين، فإننا نتعرف إلى التشاؤم ما إن نسمعه. عادةً ما يحمل المتشائم على أنه المتذمر المشير دومًا إلى الخلل من دون أن يوفر، ولو مرة واحدةً، أي حل ممكن. ولكن، في معظم الأحيان المتشائمون هم أكثر الفلاسفة هدوءًا؛ إذ يغرقون تنهداتهم في بلادة الاستياء. إن الصوت الطفيف الذي يصدره لا يسترعي انتباه أحد- «لقد سمعت كل هذا من قبل»، «قل لي شيئًا أجهله»؛ صوتٌ وسخطٌ لا يعنيان أي شيء. من خلال عرضه للمشكلات دون اقتراح حلولٍ، وطرحه الأسئلة دون تقديم أجوبةٍ عنها، والانسحاب إلى المسكن الكهفي المحكم للتذمر، يقترف التشاؤم الجريمة الأقل قابليةً للصفح من بين كل الجرائم الغربية؛ جريمة عدم التظاهر بحمل الأشياء محمل الجد. يفشل التشاؤم في النهوض بأكثر ركائز الفلسفة أساسيةً؛ إنها الـ«كما لو». فكر كما لو أن في ذلك نفعًا. تصرف كما لو أن عملك سوف يحدث فرقًا. تكلم كما لو أن هناك ما يمكن قوله. عش كما لو أنك لست -في واقع الأمر- معيشًا بواسطة نوع من اللاكيان المتمتم، مبهم وعكرٍ في الآن نفسه.
لو كان التشاؤم يملك ثقةً ذاتيةً أكبر وملكاتٍ اجتماعية أفضل، لكان قد حول فكه للسحر عن العالم إلى دينٍ، قد يسمي نفسه على الأرجح الرفض العظيم. ولكن ثمة نفيٌ في التشاؤم يرفض حتى هذا الرفض، وعيٌ بأن الأمر قد فشل منذ البدء، وأن تتويج كل ما هو كائنٌ هو أن كل شيء منذورٌ إلى لا شيء. يحاول التشاؤم قصارى جهده أن يقدم نفسه بواسطة النغمات المسترسلة والمنخفضة للقداس الجنائزي أو الصرير التكتوني للنشيد التيبتي(٢). ولكن تنسل منه غالبًا نغماتٌ متنافرةٌ تكون في الآن ذاته متذمرةً ومثيرة للشفقة. عادةً ما يتصدع صوته وتختزل كلماته الثقيلة فجأةً في مجرد كونها شظايا أصوات حلقية.
في نهاية المطاف، قد لا يكون الأمر سيئًا جدًّا. إذا كنا نتعرف إلى التشاؤم ما إن نصغي إليه؛ فذلك لأننا سمعناه جميعًا من قبل. ولم نكن في حاجة إلى سماعه في المقام الأول؛ إذ الحياة قاسيةٌ بما فيه الكفاية. ما تحتاجه في واقع الأمر تغييرٌ في الموقف، مرأًى جديدٌ، وتحولٌ في المنظور… أي كوب قهوة. إذا كنا لا نملك آذانًا للتشاؤم، فذلك لأنه يختزل دومًا في كونه شيئًا ما له قابلية التحول التي يكتسبها الصوت. إذا كان التشاؤم عرضةً للاستخفاف المطرد، فالسبب في ذلك أنه يحبط الجميع، مصممًا على أن يعدّ كل يوم يومًا سيئًا، حتى إذا لزم الأمر أن يقتصر على حقيقة كونه لم يصر إلى السوء بعد. بالنسبة إلى التشاؤم، العالم مفعمٌ بالاحتمالات السلبية، أي اصطدام مزاج سيئ بعالم متبلد الأحاسيس.
في واقع الأمر، يمثل التشاؤم نتيجةً لالتباس العالم بإقرارٍ يخص العالم. وهو كذلك التباسٌ يمنعه من الدخول الكلي إلى القاعات المقدسة للفلسفة. إذا كان التشاؤم في معظم الأحيان مرفوضًا؛ فذلك لأنه من المستحيل عادةً التفريق بين «مزاج سيئ» وطرحٍ فلسفي (ألا ينبت جميع الفلاسفة من مزاج سيئ؟). تقترح لفظة «التشاؤم»(٣) ذاتها وجود مدرسة أو تيار فكريين أو حتى طائفة ما. ولكن التشاؤم يملك دومًا عضويةً واحدة- أو اثنتين ربما. سيكون من المثالي طبعًا ألا يملك عضوية أي كان، مع ملاحظة وحيدة مخربشة وتعسر قراءتها، كان قد خلفها شخصٌ منسيٌّ منذ زمن بعيد. ولكن هذا يبدو غير واقعي، على الرغم من أنه بإمكان المرء دومًا أن يحافظ على الأمل.
تشريح التشاؤم
على الرغم من أنه قد يضع نفسه في هوامش الفلسفة، فيخضع التشاؤم للتحليل الفلسفي بقدر ما يخضع له أي شكل آخر للفكر. تمنح الغنائية المتعلقة بالفشل التشاؤم بنية الموسيقا. ما يمثله الزمن بالنسبة إلى موسيقا الأسى هو ذات ما يمثله العقل بالنسبة إلى فلسفة الأسوأ. إن مفتاحي التشاؤم الرئيسين هما التشاؤم الميتافيزيقي والأخلاقي، قطباه الموضوعي والذاتي؛ موقفٌ إزاء العالم وزعمٌ يتعلق بالعالم. أما التشاؤم الأخلاقي، فإنه من الأفضل لو لم يولد المرء أصلًا. أما التشاؤم الميتافيزيقي، فإن هذا هو أسوأ العوالم الممكنة. تكمن مشكلة التشاؤم الأخلاقي في أنانة(٤) الكائنات البشرية؛ أي العالم مصنوعًا وَفْقَ صورتنا، عالم -من-أجلنا. وأما التشاؤم الميتافيزيقي، فإن المشكلة تكمن في أنانة العالم، مموضعًا ومسقطًا بصفته عالمًا في ذاته. إن كلا التشاؤمين، الأخلاقي والميتافيزيقي، مخترقان فلسفيًّا؛ أما التشاؤم الأخلاقي، فبوساطة فشله في أن يجد موقعًا للإنساني ضمن سياقٍ لا إنساني أوسع، وأما التشاؤم الميتافيزيقي، فبوساطة فشله في التعرف إلى تواطئه في زعم الواقعية تحديدًا.
على هذا النحو، ينشئ التشاؤم موسيقاه الخاصة بالأسوأ. وهي بُغْضٌ إنسانيٌّ(٥) معممٌ دون الأنثروبوس. يتبلور التشاؤم حول هذا العبث. إنه «حب القدر» الخاص به، وقد صير في صيغة موسيقية.
ماليخوليا التشريح
ثمة منطقٌ يخص التشاؤم. وهو أساسي في ارتيابه من النسق الفلسفي. يقحم التشاؤم إقرارًا حول شرط ما. في التشاؤم، يجمل كل إقرارٍ في كونه إثباتًا أو نفيًا، تمامًا مثلما يجمل أي شرط في كونه الأفضل أو الأسوأ. مع شوبنهاور، ذلك المتشائم المفرط في تشاؤمه، المفكر الذي يتشابك بالنسبة إليه الفيلسوف والمتجهم على نحو مثالي، نرى قولًا نافيًا للأسوأ؛ إنه قول -لا يشتهي قول- نعم (من خلال الزهد، التصوف، السكينة) حتى لو كان هذا القول-نعم المخفي أفقًا يقع عند حدود الفهم. أما نيتشه، فإنه يعلن عن التشاؤم الديونيسي، وهو تشاؤم اقتدارٍ أو مرح. إنه قول-نعم للأسوأ، قول-نعم للعالم كما هو. ومع سيوران، يوجد كذلك تنويعٌ آخر غير مفيد ولكنه غنائي. إنه قول-لا للأسوأ بالإضافة إلى قول-لا لإمكان أي عالم آخر هنا أو هناك. ومع هؤلاء، يقترب المرء من التخلي المدروس عن التشاؤم نفسه. لكنه لا يبلغه أبدًا.
تشاؤم كوسمي
يشير كل من التشاؤم الأخلاقي والميتافيزيقي إلى نوع آخر من التشاؤم. إنه تشاؤم ليس ذاتيًّا ولا موضوعيًّا. وليس من-أجلنا ولا في-ذاته. بل هو تشاؤم العالم-من-دوننا. ويمكن لنا أن نسميه تشاؤمًا كوسميًّا… ولكن يبدو هذا مهيبًا جدًّا، متخمًا بالعجب وموغلًا في كونه مذاق المرارة الذي يخلفه الماوراء العظيم. تتعثر الكلمات. وكذا تفعل الأفكار. وعلى هذا النحو، نملك تشاؤمًا كوسميًّا. إنه تشاؤم يكون في البدء والختام تشاؤمًا متعلقًا بالكوسموس، متعلقًا بضرورة النظام وإمكانه. تتمثل خطوط التشاؤم الكوسمي العريضة في التصعيد أو التقليص الجذريين لوجهة النظر الإنسانية، الاتجاه اللابشري للفضاء العميق(٦) والزمن العميق، وكل هذا مظللٌ بمسلك مسدودٍ، أو افتقار إلى معنى أَوَّلِيّ، وهو استحالة الاعتبار على نحوٍ كافٍ وملائم دومًا لعلاقة المرء بالفكر -كل ما يتبقى من التشاؤم هو رغبات الانفعالات- جدالية، متبلدة، جامحة، منعزلة، مفعمة بالأسى وفاشلة في مباراة الشطرنج الهندسية، تلك التي تسمى الفلسفة. إنه خفقٌ يحاول التشاؤم أن يرتقي به إلى مصافّ شكل فني (رغم أن ما ينتج عن ذلك عادةً هو التهريج).
يقصر التشاؤم دوما دون أن يكون فلسفيًّا. ظهري يوجعني. ركبتاي تؤلمانني. أمس، لم أستطع النوم. إني متوتر. وأعتقد أنني مصابٌ في نهاية المطاف بِعِلّة ما. ينبذ التشاؤم كل الادعاءات حيال النظام- حيال نقاء التحليل وشرف النقد. لم نفكر حقًّا أن بإمكاننا اكتشاف الأمر. أليس كذلك؟ لقد كان ذلك تزجيةً للوقت فحسب، شيئًا ما يفعل، حركة جريئة تطرح قدمًا ملء هشاشتها، وفق القواعد التي كنا قد وافقنا على نسيان أننا صنعناها في المقام الأول. كل فكر يعين بلا فهمٍ غامض يسبقه وعبث يقوضه. أن يتكلم التشاؤم بأي صوت ممكن، فتلك هي الشهادة المغناة لهذا العبث وهذا اللافهم. اغتنم الفرصة. واخط إلى الخارج. اخسر نصيبًا من النوم. وقل: إنك قد حاولت…

نشيد العبث
يتخلل العبث التشاؤم. العبث في المقابل مختلفٌ عن الحتمية. وهو مختلفٌ كذلك عن الفشل البسيط (رغم أن الفشل لا يكون بسيطًا مطلقًا). إن الفشل كسرٌ في قلب العلاقات، صدعٌ بين السبب والنتيجة؛ صدعٌ يرأب على عجل بواسطة المحاولة، ومن ثم المحاولة مرة أخرى. في حالة الفشل، هناك نصيبٌ وافرٌ من اللوم يجب مواجهته؛ إنه ليس خطئي. إنها صعوبةٌ تقنية. إنه سوء تواصل. أما المتشائم، فيمثل الفشل سؤال «متى» وليس «إذا»- الفشل بصفته مبدأً ميتافيزيقيًّا. كل شيء يذوي وينتقل إلى ظلمةٍ أحلك من الليل، كل شيء من الانحدار الميلودرامي لحياة شخصٍ ما إلى اللحظات الخافقة المبتذلة التي تؤسس كل يوم. كل ما أنجز غير منجز؛ كل شيء قد قيل أو عرف منذورٌ إلى نسيان نجمي.
عندما يُصَعَّدُ على هذا النحو، يصبح الفشل حتميةً. إن الحتمية هي هرمسية السبب والنتيجة. في الحتمية، كل شيء تفعله، مهما يَكُنْ ما تفعلُه يَقُدْ دومًا إلى نهايةٍ محددة، وفي آخر المطاف إلى النهاية- رغم أن تلك النهاية، أو وسائل تحقق تلك النهاية، تظل غارقة في الغموض. لا شيء تفعله يحدث فرقًا؛ لأن كل ما تفعله يحدث فرقًا. ومن ثم، فإن آثار أفعالك محتجبةٌ عنك، حتى عندما تخدع نفسك بتفكيرك أنك ستنجح هذه المرة في التفوق على نظام الأشياء. من خلال اكتساب هدفٍ، التخطيط للآتي وتدبر الأشياء مليًّا نحاول، في بروميثيوسية(٧) يومية، أن نحول الحتمية إلى صالحنا، وأن نفوز بلمحةٍ من نظامٍ يبدو مدفونًا، أعمق فأعمق، في نسيج الكون.
ولكن الحتمية نفسها تملك دعتها الخاصة. قد تكون سلسلة السبب والنتيجة محتجبةً عنا. ولكن ذلك مرده الحصري أن الفوضى هي النظام الذي لسنا نراه بعد؛ إنه معقدٌ فحسب، موزعٌ ويقتضي رياضياتٍ معمقةً. تظل الحتمية متشبثةً بكفاية كل شيء يوجد… إذا تخلت الحتمية حتى عن هذه الفكرة، فإنها تصير عبثًا. ينشأ العبث من الاشتباه القاتم في أنه، خلف غطاء السببية الذي نسدله على العالم، ليس ثمة إلا اللامبالاة إزاء ما يوجد أو لا يوجد؛ مهما يكن ما تفعله، فإنه ما من نهايةٍ يفضي إليها في نهاية المطاف. إنها هوةٌ لا رجعة فيها بين الفكر والعالم. يحول العبث فعل التفكير إلى لعبة حاصل مجموعها صفر.
نشيد الأسوأ
في مركز التشاؤم pessimism، يقع لفظ pessimus، أي «الأسوأ». وهو لفظ نسبي بقدر ما هو مطلق. يتعلق الأسوأ بجملة السوء الممكن تحققها؛ إذ يكتنفه عبور الزمن أو تقلبات الحظ وانعطافاته. بالنسبة إلى المتشائم، «الأسوأ» هو النزوع إلى المعاناة التي تحبس على التدريج كل لحظة حية، إلى أن تخسف كليًّا وتندغم على نحو مثالي في الموت… الذي يتوقف، بالنسبة إلى المتشائم، عن كونه «الأسوأ».
إن التشاؤم مختومٌ بعدم إرادة تجاوز «الأسوأ». وذلك أمرٌ يسند على نحو جزئي فحسب إلى نقصٍ في الحافز. إن الأسوأ هو الأرضية التي تفسح المجال لكل ما هو كائن- يمكن للأشياء أن تصير أسوأ، ويمكن للأشياء أن تصير أحسن. يقتضي الأسوأ دومًا حكم قيمة، يكون مستندًا إلى أدلة شحيحة وتجربة قليلة. على هذا النحو، يكون خصم المتشائم الأعظم مذهبه الأخلاقي.
لعل هذا هو السبب في أن المتفائلين هم عادةً أكثر المتشائمين صرامةً- إنهم متفائلون قد نفدت خياراتهم. يبدو أننا مدانون جميعًا، آجلًا أم عاجلًا، بأن نصبح متشائمين على هذا النحو (تلك أكثر الأفكار إحباطًا…).
هوامش:
(١) المانترا هي تميمة مقدسة أو ابتهال مستخدم في ديانات من قبيل البوذية والهندوسية والسيخية.
(٢) نسبة إلى منطقة التبت.
(٣) يشير الكاتب إلى اللاحقة ism في مصطلح Pessimism الذي تقترن عادة بمصطلحاتٍ تعين الحركات والتيارات الفكرية أو الدينية أو السياسية. ونذكر مثلًا Stoicism التي يقابلها في العربية (من خلال اعتماد ياء النسبة مع التاء) الرواقية.
(٤) Solipsism : يترجم هذا المصطلح الفلسفي عربيًّا على أنحاء عدة تتفاوت في دقتها. وليس هذا مجال التفصيل في دقتها. ولكن من بينها الترجمة التي نتبناها. وهي الأنانة وكذلك الأنا-وحدية. ويمكن القول في نوع من الاختزال المشط: إن الأنانة مفهوم يعبر عن صيغة قصوى من المثالية؛ إذ ليس هناك، وفق هذا المفهوم أو النزعة الفكرية، من حقيقة في الوجود سوى حقيقة الذات المفكرة. ولهذا السبب، يتركب المصطلح لاتينيًّا من شقين، أولهما solus أي وحيد أو مفرد وipse التي تعني الذات أو عين الذات.
(٥) نزعةٌ فكرية عاطفية تتمثل في كراهية الجنس البشري أو سلوكه أو طبيعته عامة وبغضه وعدم الثقة فيه وازدرائه. تعود أصول المصطلح إلى الإغريقية. فتتكون من misos، أي كراهية وanthropos، أي إنسان.
(٦) أي الفضاء الخارجي البعيد من كوكب الأرض في مجرات قصية.
(٧) نسبة إلى بروميثيوس، وهو عملاق حارب في صف الآلهة الأولمبية ضد العمالقة في الحرب العظمى؛ شخصية أسطورية من الميثولوجيا الإغريقية اتسمت بالذكاء والحنكة وكانت محببة للبشر. أما بالنسبة إلى المصطلح، فهو مبتدعٌ حديثًا. وقد جرى تعميمه وإشهاره من قبل المنظر السياسي جون درايزك وصفًا لنزعة بيئية ترى في الأرض وما عليها موارد تحدد فائدتها بواسطة الحاجات البشرية ومصالح الإنسان، فيما تتخطى مشكلاتها بواسطة الإبداع الإنساني. وهي نزعةٌ مناقضة للفلسفة البيئية، أو ما صار يعرف منذ بعض الوقت بالإيكولوجيا العميقة.

