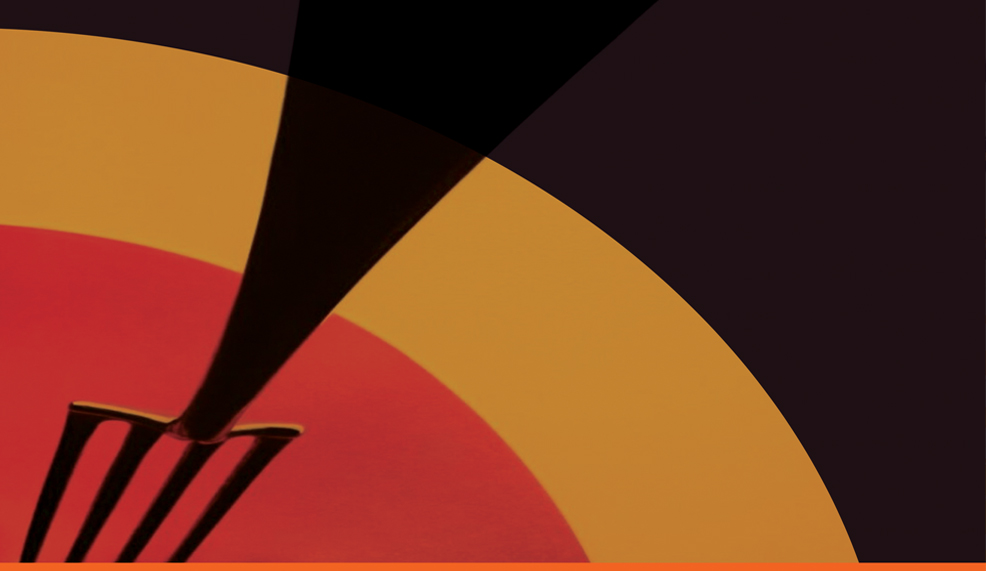
الترجمة والثقافة.. لماذا اتخذت دراسات الترجمة تحولًا ثقافيًّا؟
منذ زمن بعيد، في عام 1990م على وجه التحديد، ساهم معي أندريه ليفيفر في كتابة مقدمة لكتاب يحوي مجموعة من المقالات تحت عنوان: «الترجمة، التاريخ، والثقافة». أردنا أن نوجه الأنظار إلى التغيرات التي اعتقدنا أنها تزيد في ترسيخ الأبحاث المتعلقة بدراسات الترجمة، تلك التغيرات التي سجلت تحولًا بارزًا من هيمنة المداخل الشكلانية إلى مداخل أخرى تركز بشكل أكبر على عوامل النص الخارجية. وقلنا: إن أطروحة ممارسة الترجمة قد تقدمت بخطى حثيثة، وينبغي أن يكون التركيز عندئذ على مسائل أعم لها علاقة بالسياق والتاريخ والأعراف وليس مجرد تباحث معنى الأمانة في الترجمة، أو ما الذي يعنيه مصطلح «التكافؤ». لقد تغيرت نوعية الأسئلة التي كانت تثار حول الترجمة:
دائمًا ما كانت تطرح أسئلة من هذا القبيل في الماضي: «كيف تُعَلَّمُ الترجمة؟ وكيف تبحث؟» لقد كان أولئك الذين اعتبروا أنفسهم مترجمين غالبًا ما يزدرون أية محاولات لتعليم الترجمة، وأما الذين زعموا أنهم يدرِّسُون الترجمة فهم لم يمارسوها في الغالب؛ لذلك كان لا بد منهم أن يعودوا إلى أسلوب التقييم القديم بوضع نص مترجم قبالة نص آخر وتفحص كلا النصين في خواء شكلي. بيد أن الأسئلة تغيرت الآن، وأعيد تعريف الغاية من الدراسة؛ فالشيء الذي يدرس هو النص المتجذر في شبكته المتضمنة للعلامات الثقافية المصدرية والمستهدفة. (باسنيت وليفيفر، 1990م).
عندما كتبنا ذلك، كنا مدركين تمامًا لوجود صدع قائم بين مداخل الترجمة اللسانية والأدبية، وارتأينا أن نتحدى هاتين الصعوبتين من وجهة نظر ملحّة وإلزامية. في ثمانينيات القرن الماضي، كانت دراسات الترجمة تتطور بوصفها مبحثًا مستقلًّا، عن طريق استخدام منهجيات تعتمد على بحوث اللسانيات والأدب المقارن، وشعرنا حينها، إلى جانب العديد ممن كانوا يشتغلون في مجال الترجمة، بأن الوقت قد حان لتوظيف المزيد من أدوات التاريخ الثقافي والدراسات الثقافية. إذا ألقينا نظرة إلى الوراء، سنجد أن مقدمتنا تبدو ساذجة وبسيطة، فدراسات الترجمة تطورت بسرعة هائلة في التسعينيات، وهي تحتل الآن مكانة راسخة في الأكاديمية بحيث لم تعد هنالك حاجة لالتماس إعادة النظر في قضيتها. ولقد سعينا إلى تقديم بعض الأطروحات، ومنها أن الترجمة لها دور محوري في تشكيل النظم الأدبية، وأنها لا تتم على محور أفقي، وأن المترجم يشارك في مفاوضات ذات قوى معقدة (في توسطه بين الثقافات، إن جاز التعبير)، وأن الترجمة دائمًا ما تكون عبارة عن إعادة كتابة للأصل. وقد نوقشت موضوعات أبعد من ذلك بكثير من باحثين أمثال مايكل كرونين، وإدوين جنزلر، ولورنا هاردويك، وثيو هيرمانز، وتيجاسويني نيرانجانا، ودوغلاس روبنسون، وشيري سايمون، وهاريش تريبيدي، وإلسا فييرا، ولورنس فينوتي، وآخرين غيرهم. لقد أصبحت دراسات الترجمة موضوعًا أكاديميًّا مقبولًا، وانتشرت الكتب والمجلات المتخصصة وأطروحات الدكتوراه بسرعة أكبر مما يمكن لأي أحد قراءتها. وفي صميم جميع الأبحاث الجديدة والشائقة، أثيرت تساؤلات واسعة حول بحوث عدة مثل: الأيديولوجيا والأخلاقيات والثقافة.
في عام 1990م لم نكن بأية حال أول باحثين يناقشان مسألة التحول الثقافي. منذ زمن أبكر كان ثمة توجه لتوسيع هدف الدراسة بعيدًا من إطار النص المباشر، في أعمال جماعة «نظرية النظم المتعددة» المستلهمة من إيتامار إيفن زوهار، وجدعون توري، وجيمز هولمز. وقد قُدِّمتْ أطروحات مماثلة في ألمانيا وكندا والبرازيل وفرنسا والهند، وإن كان ذلك من وجهات نظر مغايرة؛ إذ شرع المترجمون وباحثو الترجمة بمهمة إعادة تعريف أهمية الترجمة في التاريخ الأدبي، واقتفاء أثر جينولوجيا الترجمة في سياقاتهم الثقافية الخاصة بهم، واستكشاف التداعيات الأيديولوجية للترجمة، وعلاقات القوى المتضمنة بوصفها نصًّا ينقل من سياق لغوي إلى سياق لغوي آخر.
وظيفة الترجمة
كانت نظرية النظم المتعددة تعنى أساسًا بالترجمة الأدبية، لكن باحثين آخرين ممن تضمنت أعمالهم موضوعات غير أدبية انتهجوا مسارات متوازية. تطورت «نظرية الغرض» في الترجمة، على سبيل المثال، على يد هانس فيرمر وكاترينا رايس وآخرين. وتنص نظرية الترجمة التي وضعها هانس فيرمر وكاترينا رايس إضافة إلى آخرين، على أن الغرض من الترجمة أو وظيفتها هما ما يحددان الإستراتيجيات التي ينبغي استخدامها. وعليه، فإن ذاتية المترجم تحظى بالأولية، كما أن الوظيفة التي تهدف الترجمة إلى تحقيقها في الثقافة المستهدفة، تمكن المترجم من اتخاذ خيارات محددة في أثناء عملية الترجمة. وهذا المنظور بعيد كل البعد من نظريات الترجمة التي تركز على الثقافة المصدرية، ويمكن أن يعبر عنها أيضًا بأنها تعكس تحولًا ثقافيًّا. في هذا الصدد يكتب إدوين جنزلر ملخصًا دراسات الترجمة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي:
«إن أبرز تحولين في التطورات التنظيرية لنظرية الترجمة على مدى عقدين هما (1) التحول من النظريات الموجهة للنص المصدري إلى النظريات الموجهة للنص المستهدف. والتحول إلى إدراج العوامل الثقافية إلى جانب العناصر اللغوية في نماذج التدريب على الترجمة. وكان أولئك المدافعون عن المناهج الوظيفية روادًا في كلا المجالين». (جنزلر، 2001: 70).
ما هو واضح الآن، عند مراجعة الوقائع الماضية، أن التحول الثقافي كان ظاهرة فكرية غزيرة، ولم يكن يحدث بأية حال في دراسات الترجمة فقط. ففي العلوم الإنسانية عامة، كانت الأسئلة الثقافية تكتسب أهمية متزايدة. شهدت اللسانيات كذلك تحولًا إلى الثقافة، مع تصاعد تحليل الخطاب، كما عبر دوغلاس روبنسون (2002م)، بالابتعاد من اللسانيات التقريرية إلى اللسانيات الأدائية. ويمكننا القول: إن تزايد الاهتمام بلسانيات المتون، تحت ريادة منى بيكر، هو مظهر آخر من مظاهر التحول إلى الثقافة في اللسانيات.

في الدراسات الأدبية، سيطرت المداخل الثقافية منذ زمن بعيد على زمام الأمور، بدءًا من المداخل الشكلانية إلى الدراسات النصية. وأما من مرحلة ما بعد البنيوية فصاعدًا، فإن الموجات العاصفة لمداخل الأدب الجديدة التي اجتاحت العقود الأخيرة من القرن العشرين، كانت بأجمعها تتسم ببعد ثقافي: كالنسوية، ونقد الدراسات الجندرية، والتفكيكية، ودراسات ما بعد الاستعمار، ونظرية الهجنة. اتخذت الدراسات الأدبية طرائق من الدراسات الثقافية، مشوشة الخطوط الفاصلة ما بين مجالات البحث التي كانت مميزة في السابق. خضع التاريخ أيضًا لتحول مشابه، مع إيلاء المزيد من التركيز على التاريخ الثقافي والاجتماعي، وتوسيع المجالات التي كانت هامشية في السابق مثل تاريخ الطب، وتاريخ الأسرة، وتاريخ العلوم. وأما الجغرافيا الثقافية فقد أدت إلى نشوء نهضة في الجغرافيا بوصفها مبحثًا. ومع تزايد نطاق هذه الدراسات، أعيدت تسمية أقسام اللغات الحديثة لتأكيد المدخل الثقافي. وأبانت الأقسام الكلاسيكية عن جيل جديد من الطلاب الذين كان جلّ اهتمامهم بالمبحث مأخوذًا بدراسة العلاقة بين الثقافات القديمة والمعاصرة.
وتشير لورنا هاردويك، الباحثة في اللغة اليونانية القديمة ومؤلفة لكتاب يتحدث عن الترجمة ما بين الثقافات، إلى أن فعل ترجمة الكلمات «ينطوي في حد ذاته على ترجمة أو نقل شتلة إلى الثقافة المستقبلة للإطار الثقافي الذي يجذَّرُ فيه نص قديم». (هاردويك، 2000: 22). وتسوق هاردويك حججًا واضحة المعالم لصالح الترجمة بوصفها أداة تغيير، وبذلك ينصب تركيزها على طلاب اللغات الكلاسيكية في الوقت الراهن. وتضيف بأن المهمة التي يواجهها مترجمو النصوص القديمة، أن يقدموا ترجمات تذهب لما وراء المعنى المباشر للنص وتسعى إلى الإفصاح بطريقة أو بأخرى (وتستخدم هاردويك استعارة «نقل الشتلات»، التي استوحتها من شيلي (2)، عن الإطار الثقافي الذي يجذَّرُ فيه ذلك النص. إضافة إلى أن الترجمة هي التي تمكن القراء المعاصرين من بناء الحضارات المفقودة. وهي البوابة التي يمكن من خلالها الولوج إلى الماضي.
أثر التحولات الثقافية في الترجمة
وبناءً عليه، يمكن أن يكون التحول الثقافي في دراسات الترجمة جزءًا من التحول الثقافي الذي كان يحدث في العلوم الإنسانية كافة في أواخر الثمانينيات والتسعينيات، وهذا أدى إلى تغيير بنية العديد من المباحث التقليدية. ففي دراسات الترجمة، مهدت نظرية تعدد النظم الطريق إلى التحول الثقافي آنذاك، مع أن جذورها تعود إلى الشكلانية، إلا أن القضايا التي أصبحت تحتل مكانة بارزة كانت تتعلق أساسًا بمسائل التاريخ الأدبي وحظوة النصوص المترجمة في الثقافة المستقبلة. وكمثال على الاتجاهات الموازية في دراسة الترجمة والأدب، فإننا لا يسعنا سوى أن نفكر في الطريقة التي يمكن أن تحور بها خرائط التاريخ الأدبي عندما ينظر إلى مرحلة ما من نقطة مرجعية بديلة.
شكك أنصار النظريات النسوية في هيمنة الكتاب الذكور على المعتمد الأدبي مما دفع بهم إلى إعادة تقييم الكيفية التي شيد بها ذلك المعتمد بصورة واقعية. وعليه، لو نظرنا بعين الاعتبار إلى القرن الثامن عشر من منظور الحركات ما بعد النسوية، فلن يغدو يهيمن عليه الكتاب الذكور، وإنما باعتباره الحقبة التي استهلت النساء فيه بتقديم مساهمات رئيسة في الحياة الفكرية. وإذا نظرنا بالطريقة ذاتها إلى القرن الخامس عشر من منظور دراسات الترجمة، في إنجلترا التي كانت بمنزلة أرض مقفرة، عدا قلة من المؤلفات المهمة التي كُتبت بعد وفاة شوسر عام 1400م، فإننا سنجد نشاطًا مكثفًا في ترجمة النصوص المقدسة والنصوص العلمانية. إن إعادة تقييم أنصار المرأة للقرن الثامن عشر من حيث إعادة النظر في المعتمد الأدبي وإعادة تقييم نتاج القرن الخامس عشر الأدبي ليس سوى مثالين على كيفية تغيير المعلومات الجديدة لمنظورنا التاريخي. وهكذا أصبح نتاج المرأة غير مرئي، شأنه في ذلك شأن تجاهل أهمية الترجمة. إن إعادة تقييم هاتين الحقبتين من التاريخ الأدبي تشتمل على إعادة التفكير في آرائنا المسبقة حول الأعمال الأدبية القيمة. في كلتا الحالتين، حدثت عملية موازية للتشكيك في المعايير المعمول بها، ويمكن عدّ هذه العملية تحولًا ثقافيًّا واضحًا.
كان محور نظرية تعدد النظم كما حدد معالمها إيفن زوهار هو الطعن في المعتمدات الأدبية الراسخة. وقد أبدى زوهار حجته بأن أي نموذج لنظام أدبي معين يحمل في طياته أدبًا مترجمًا؛ لأن الترجمة كانت في أحايين كثيرة القناة التي يمكن من خلالها الشروع في الابتكار والتغيير: «لا يمكن لأي محلل تاريخ أدبي أن يتجنب الاعتراف بحقيقة أهمية الترجمات ودورها في رصد التغيرات العبر زمنية أو اللحظية في أدب معين». (إيفن زوهار، 1978: 15). بعد أن أعرب عن رأيه في الأهمية الأساسية لدور الترجمات في النظام الأدبي، سعى إيفن زوهار بعد ذلك إلى تحديد الحالات التي قد تكتسب فيها الترجمات أهمية بالغة. وأوضح أن الآداب يتذبذب احتياجها للترجمات في أثناء تطورها. وبالتالي فإن نظامًا أدبيًّا راسخًا قد يترجم له بصورة أقل من نظام أدبي يخضع لتغيرات واضطرابات.
الترجمة وتطور الأدب
من شأن الآداب المتطورة حديثًا، وفقًا لنظرية إيفن زوهار، ترجمة المزيد من النصوص، وقد أثبت هذه الفرضية باحثو الترجمة مثل ماكورا (Macura، 1990) والمهتمين على سبيل المثال، بآداب شمال أو وسط أوربا. لقد دعمت الترجمة إلى حد كبير بعض الآداب، كالتشيكية أو الفنلندية، اللتين تطورتا في القرن التاسع عشر في سياق حركة الإحياء اللغوي والكفاح السياسي من أجل الحصول على استقلالهما الوطني. في المقابل، لدينا الصين كمثال؛ إذ لم يترجم لها لقرون عدة سوى النزر اليسير؛ لأن الكتاب الصينين لم يكونوا بحاجة إلى تأثيرات خارجية. أما اليوم فثمة طفرة في الترجمة هناك، مرتبطة بالتحديث والتغريب ودخول الصين في الاقتصاد العالمي.

