
بواسطة مشير باسيل عون - كاتب لبناني | سبتمبر 1, 2023 | مقالات
حين ينظر المرءُ فيما تصنعه العولمة الكونية بالمجتمعات الإنسانية المعاصرة، يتبين له مقدارُ السحر التوحيدي الذي تمارسه النماذجُ الإنتاجية المعدة للاستهلاك الفوري في جميع حقول الثقافة الإنسانية، سواءٌ في العلم والتقنية والصناعة النانوتكنولوجية المتطورة، أو في الأدب والفن والفلسفة وسائر العلوم الإنسانية. غير أن المفارقة المذهلة تتضح أمام أعيننا حين ندرك مبلغ الإصرار على الهوية الذاتية الجماعية، سواءٌ على مستوى الوعي القومي، أو على مستوى الوعي الديني، أو حتى على مستوى الوعي الأيديولوجي المرتبط بالمتحَدات الجماعية المبنية على المشتركات الفكرية والتقاربات الوجدانية والتواطؤات المنفعية.
العلم الوضعي والاختبار الوجداني
لا بد، في نظري، من الاستفسار عن وجهٍ من وجوه الإشكال الذي تستثيره هذه المفارقة، عنيتُ به قدرة المجتمعات على التوفيق بين ضرورة تأييد المكتسبات المعرفية التي تُفضي إليها العلوم الوضعية، وواجب الأمانة على خصوصية التعبير الذاتي عن الهوية الثقافية الجماعية. ينشأ الاستشكال المعرفي هذا من تعيين مقامَين: مقام العلم، ومقام التعبير الوجداني الجماعي في الأنظومة الثقافية الأرحب. ذلك أن الثقافة الإنسانية حصيلةُ الإنتاج المعرفي الأشمل في المجتمع الإنساني. لكل مجتمعٍ إنساني ثقافتُه التي تشتمل على تصوراته في الكون والطبيعة والحياة والزمان والعالم والوجود والمعية والتاريخ(١). من البديهي، والحال هذه، أن ينشأ في كل كتلةٍ حضاريةٍ تصورٌ معرفي خاص يُعنى بشرح المسائل الأساسية هذه.
تقارب العلوم وتباعد الثقافات
يبدو أن الحضارات القديمة كانت تمتلك تصوراتٍ «علميةً» متباينةً على غير تناقض، متدافعةً على غير إقصاء. بيد أن تطور الاحتكاكات الحضارية بين الأمم ساهم في مقارنة الخلاصات «العلمية» التي استخرجتها الشعوب في نطاق تصوراتها الثقافية الخاصة. ومع أن العلوم كانت، على وجه العموم، مختلفةً باختلاف البيئات الحاضنة وعناصر الاختبار المتوافرة في كل بيئة، إلا أنها ما لبثت أن توحدت شيئًا فشيئًا، فاستقر رأيُ علماء الرياضيات على تصورٍ علمي واحدٍ ناظمٍ. أما الاختلاف في علوم الطب، على سبيل المثال، فلم يَعد مرتبطًا بثقافة المجتمع، بل بصحة الفرضيات العلمية الناشطة في كل علمٍ طبي على حدة.
حين كان كِتَاب الشفاء يُدرس في جامعات فرنسا في العصور الوسيطة، لم يكن الاختلاف يتعلق بثقافة ابن سينا العربية الإسلامية، بل بصحة النظريات العلاجية التي كان يسوقها فيلسوف الإشراق هذا. أما اليوم فيمارس الصينيون في الصين الطب الصيني والطب الغربي، ويمارس الغربيون في المجتمعات الغربيةِ الطب الغربي والطب الصيني، مع أن فرضيات الطب الصيني تختلف عن فرضيات الطب الغربي. غير أن هذا الاختلاف علمي محضٌ لا يتجاوز حدودَ التقنيات العلاجية؛ لذلك لا أعتقد أن الاختلاف في التصور الطبي يُفضي بالصينيين والغربيين إلى تصوراتٍ علميةٍ متناقضةٍ في تعيين قوام البيولوجيا البشرية. جل الأمر أن الطب الصيني يراعي في بنية الإنسان البيولوجية تشابكًا لطيفًا بين النفسيات والبدنيات، بين الوجدانيات والجسديات، لا يوليه الطب الغربي، في معظم كلياته، مقامَ الصدارة. زدْ على ذلك أن الطب الغربي ليس واحدًا في تقنياته العلاجية؛ إذ يُؤْثِر بعضُهم العلاج الكيميائي الصناعي، في حين يختار بعضهم الآخر العلاجات الطبيعية الموازية.
توسعتُ في مثال العلوم الطبية لأبين أن الاختلاف بين الأمم لا يتجاوز مجرد التقنيات العلاجية، في حين أن الحضارتَين الصينية والغربية، على سبيل المثال، ما برحتا مختلفتَين في مسائلَ ميتافيزيائية وأنثروبولوجية خطيرة. آثرتُ التبسط في مسألة الطب؛ إذ إنها ترتبط بهوية الإنسان الجسدية-النفسية. أما سائر العلوم الطبيعية الوضعية الخالصة فتتناول حقولًا من المعرفة لا تتعلق بمقام الإنسان، كالفيزياء والكيمياء والرياضيات وما سوى ذلك. ومن ثم، تنفرد هذه العلوم بصفة التوافق والتناغم والتعاضد المعرفي. وعليه، حين يعاين المرءُ الاختلاف الناشط بين المقامَين، مقام العلوم ومقام التصورات الثقافية، لا بد له من أن يسأل: لماذا توحدت العلوم في تصورات الأمم، قديمِها وحديثِها، ولم تتوحد التصورات الثقافية المتعلقة باختبارات الوجدان الإنساني الفردي والجماعي؟ لماذا لم تُعطل وحدةُ العلومِ الأنظومات الثقافية المحلية؟
الخلفيات الفكرية الناظمة
لا شك أن هذا السؤال الفلسفي ينطوي على استفسارات فرعية شتى: إذا كان النموذج العلمي واحدًا، لماذا يبقى النموذج الثقافي مختلفًا؟ لا بد من تعريف النموذج الثقافي الذي يشتمل على تصورات الإنسان الحياتية وثوابته واقتناعاته وطرُق تفكيره وتذوقاته وإيثاراته واستحساناته. إذا اعترف الجميع بأن النار تولد النور والحرارة، وهذه حقيقةٌ فيزيائيةٌ، فلماذا يختلفون في بناء تصوراتهم الميتافيزيائية والأنثروبولوجية والقانونية؟ إذا كانت الحقائق الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والمعادلات الرياضية والمعلوماتية واحدة، فكيف يجوز لنا أن نَسُنَّ الشرائع المختلفة في تدبير حياة الناس داخل المدينة الإنسانية؟ هل يليق بنا أن نتفق في مسائل العلم ونختلف في قضايا الشرع الحياتي؟ إذا استطعنا أن نضطلع بمسؤولية إدارة الطبيعة والبيئة، على سبيل المثل، فكيف لا نستطيع أن نستخرج شِرْعةً قانونيةً كونيةً مشتركةً نستند إليها في تدبير معيتنا الإنسانية؟
من الاستفسارات الفرعية هذه نمضي إلى مساءلةٍ أشد تطلبًا تنظر في إمكان التوفيق بين وحدة العلوم وتنوع الخلفيات الثقافية التي تستند إليها هذه العلوم. بتعبير أوضح: هل يصح أن نعتمد العلوم المعاصرة ونُنتجها من غير أن نؤيد الخلفية الثقافية التي تستند إليها في بناء أنظومتها؟ قالها المفكرون العرب المعاصرون غيرَ مرة: كيف لنا أن نفصل المعرفة العلمية التقنية الغربية عن شروطها الثقافية التاريخية التي أنتجتها؟ أعرف أن تاريخ الفلسفة حافلٌ بالاجتهادات التي سعت إلى ضبط حركة المعرفة بوساطة مقولة النموذج العلمي الناظم (باراديغم)؛ لذلك انبرى غيرُ فيلسوفٍ يستخرج النماذج الهادية في كل عصرٍ من العصور.
منهجية النماذج المعرفية
سأكتفي بذكر اثنَين من الفلاسفة الذين وضعوا لكل عصرٍ معرفي نموذجَه الناظم. ارتأى هايدغر (1889- 1976م) أن تاريخ الفكر الإنساني منذ أفلاطون خاضعٌ لسلطة الميتافيزياء التي تتصور الكينونة في هيئة الكائن الأسمى، في حين أن الكينونة سر الأسرار وحركةُ الانكشاف والانحجاب التي لا يستطيع العقلُ الحسابُ أن يقبض عليها. في كل حقبةٍ ميتافيزيائيةٍ ينبسط تصورٌ كوني شاملٌ (Weltanschauung) يكشف لنا الهيئة التي يحلو للكينونة أن تتجلى عليها. ليس هذا التصور علمًا محضًا فحسب، بل طريقةٌ في التفكير والتقويم، ونهجٌ في تدبر الحياة، وبناءٌ معياري في القيَم السائدة. بعد أن يُخضع هايدغر التاريخ لتأويله الأنطولوجي الاستنقاذي، يستخرج خمسَ حقبٍ نموذجية تعاقبت على الحضارة الإنسانية: الحقبة الإغريقية، الحقبة المسيحية، الحقبة الحديثة، الحقبة التقنية الكونية، الحقبة المسائية الغروبية الأفولية التي نحيا اليوم وفقًا لأحكامها(٢).
كذلك عَصَرَ ميشيل فوكو (1926- 1984م) تاريخ الفكر الإنساني، فاستخرج من ثنايا اختماراته ثلاثة نماذج إبيستِمية معرفية تنضبط بمقتضى أحكامها ثلاثُ حِقَبٍ أساسيةٍ طبعت النشاط المعرفي: إبيستِمه عصر النهضة الذي ينتهي في منتصف القرن السابع عشر، وميزتُها التشابهُ والتماثلُ؛ إبيستِمه العصر الكلاسيكي الممتدة من منتصف القرن السابع عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر، وميزتُها التصورُ والنسقُ والهويةُ والاختلافُ وما ينجم عن هذا كله من خطاب المقولات؛ إبيستِمه الحداثة في الزمن الراهن، وميزتُها التاريخية أو المنهج التاريخي. من خصائص الحقول الإبيستِمولوجية الثلاثة هذه أنها تجعل المعارف والعلوم ممكنةً، وتضبط عمليات تصورها، وتُنظم إنتاجها بموجب شروط الحقيقة التي تتيح للناس أن يؤيدوا ما هو ممكنٌ معرفيًّا وما هو قابلٌ القولَ.
ذلك بأن الإبيستِمه تشتمل على شروط القول في كل حقبةٍ من حقَب الفكر الإنساني. ليست الإبيستِمه مجموع تصورات الكون، بحسب التعريف الذي ساقه ديلتاي (1833- 1911م)(٣)، بل مجموع الشروط الخلفية التي تتيح نشوء مثل هذه التصورات(٤). أما العلوم فانتابتها أطوارٌ من التحول جعلتها تنتقل من مبحثٍ إلى آخر. طرأ تحولٌ على علوم اللغة، فانتقلنا من قواعد النحو العام إلى فقه اللغة. وطرأ تحولٌ على علوم الحياة، فانتقلنا من التاريخ الطبيعي إلى البيولوجيا أو علوم الحياة. وطرأ تحولٌ على تحليل الثروات عند آدم سميث (1723- 1790م)، فانتقلنا منها إلى الاقتصاد السياسي عند ديڤيد ريكاردو (1772- 1823م). لا ضرورة إلى الإكثار من أمثلة تحقيب أطوار الفكر الإنساني. ما يعنيني في هذا السياق النظرُ في قدرة النموذج المعرفي (الإبيستِمه) على ضبط علوم الطبيعة وعلوم الإنسان، أي مبحث الكائنات الشيئية اللاواعية ومبحث الكائنات الإنسانية الواعية، في نسقٍ معرفي واحدٍ. إذا صح ذلك، فإن وحدة النموذج العلمي ينبغي أن تصاحبها، من حيث المبدأ، وحدةُ الوعي الثقافي الأرضي المسكوني العالمي الكوني الشامل. فهل يخضع الوجدان الفردي والجماعي لسلطة النموذج المعرفي المستند إلى المعطيات العلمية المتوافرة في كل عصر؟ بتعبير آخر: هل يمكن أن تحيا الشعوب في زمنٍ تاريخي واحدٍ وفي وعيٍ ثقافي مختلفٍ؟ وكيف يمكنها ذلك؟
الحياة العصية على الأخذ العقلاني الحساب
أعلم علمَ اليقين أن العلم لا يفكر، إذ يقتصر عملُه على تحليل بنية الكائنات الشيئية. غير أن العلم يهيمن على مدارك الوعي الإنساني هيمنةً كاملةً. فكيف يجوز لنا أن نستخدم الكمبيوتر ونخضع للعلاج الطبي النانوتكنولوجي، ونستدخل في أجسادنا أخطر ما أنتجته العلوم الطبية المعاصرة من غير أن يتأثر وعيُنا بالحمولة الثقافية التي تنطوي عليها الخلفية الفكرية الحديثة الناظمة؟ فإما أن منهجية النماذج العلمية خاطئةٌ؛ إذ إن الثقافات المحلية لا تخضع لسلطان الإبيستِمِه المعرفي، وإما أن هذه المنهجية صحيحةٌ، في حين أن المجتمعات التي ما زالت تُهمِل مقتضيات النموذج الحديث تحيا على قارعة التاريخ، وإما أن الحياة الإنسانية، بخلاف الطبيعة، تستعصي على الأخذ المعرفي الحساب، فتتجلى في هيئات ثقافية محلية لا تخضع لأي نموذجٍ معرفي توحيدي قاهرٍ.
حين أعلن هوسرل (1859- 1938م) أن العلوم الأُوربية تعاني أزمةً بنيويةً حادةً(٥)، كان في مقاصده الفلسفية أن يحرر الحياة من سطوة النموذج المعرفي. ذلك بأن عالم الحياة أو العالم الحي لا يخضع لشيئية التناول العلمي، ولو أنه يتصف بخصائص العلمية المقترنة بطبيعة الاختبار الحي الذي يقوم مقام المعطى القبْلي العام. ومن ثم، تنبثق ضمانة علمية الحياة من تقدم المعطى الحياتي على جميع ضروب التناول المعرفي، بحيث إن وعي الذات يخرج في قصديته الإنشائية إلى اختبار الحياة في تنوع تجلياتها. يبدو لي أن فصل هوسرل بين علم الأشياء الطبيعية وعلم الوعي الإنساني الحي يتيح لنا، في وجهٍ من الوجوه، أن نشرح أسباب الاختلاف في اختبارات الوعي الفردي والجماعي، وقد انعقد في هيئة الخصوصية الثقافية المقترنة بهويات الشعوب وهويات حضاراتها المختلفة.
تعليل مواضع التباين في الاختبارات الوجدانية
لست أقول بضرورة توحيد الاختبارات الوجدانية هذه، ولكني أحرض الجميع على التأمل في ضرورة توحيد شرائع الأرض حتى تستقيم المعية الإنسانية الكونية. لا بد لنا، في جميع الأحوال، من أن نُعيد النظر في العمارات الثقافية التي أنشأناها في حضاراتنا المختلفة؛ حتى نستخرج الخلفيات العلمية الضمنية التي لم نجرؤ حتى اليوم على تعرية فرضياتها وتهذيبها وتنقيحها. ما دام العِلمُ المعاصرُ واحدًا، وما دامت هوية الإنسان تخضع في قسط عظيم من بناءاتها الثقافية لخلاصات هذا العلم، فإن الاختلاف الحضاري المقبول ينبغي أن يقتصر على ما تستحسنه الأحاسيس الوجدانية السليمة من تقاليد اجتماعية، وأعراف مسلكية، واختبارات فنية، وإبداعات أدبية، وتذوقات صوفية، وشطحات غيبية ما ورائية. لا يجوز، في نظري، أن يتخطى الاختلاف هذه الحدود؛ إذ لا يصح أن نختلف في التشريع القانوني والإداري والسياسي والاقتصادي والبيئي الذي يضبط أحوال المعية الإنسانية في المدينة الحديثة الواحدة المتنوعة. ومن ثم، لا يجوز أن يشرع الناس في التقنيات والإداريات والسياسيات والاقتصاديات وعلوم البيئة تشريعًا يخالف ما انتهت إليه مُستندات شرعة حقوق الإنسان وخلاصاتُ العلوم الوضعية الموثوقة.
رصانة العقل وجَيَشَانُ الوِجْدان
أما الإجابة عن سؤال التعارض بين وحدة النموذج العلمي واختلاف الاختبار الثقافي، فيمكننا أن نعثر عليها في التمييز بين العقل والوِجدان. العقل غيرُ الوِجدان، يعقل الأشياء بحسب منطقٍ علمي حسابٍ. أما الوِجدان فيختبر الحياة اختبارًا شعوريًّا فؤاديًّا جَوَّانيًّا لا يملك الإنسانُ أن يقيم الحجة عليه. حين قال هايدغر: إن العِلم لا يفكر، أراد أن يحصر التفكير في إنتاج المعنى الحياتي الأشمل. لكل امرئٍ اختبارُه الوجودي الذي يُفضي به إلى مناصرة معنًى من المعاني. لذلك يحق للوجدان ما لا يحق للعقل؛ إذ إن الوجدان غني على شطحٍ حر، والعقل فقيرٌ على رصانةٍ مقتصدةٍ. أما الناسُ فتَضعهم طبيعتُهم أو وضعيتُهم البشرية أمام الاختيار بين الشطح والرصانة. بيد أن الشرط الوحيد الذي يجب صونُه في عملية الاختيار هذه يقتضي أن يخضع الشطحُ للخلاصات العلمية التي يخرج بها العقلُ. ذلك بأنه لا يجوز لنا أن نختبر من الحياة ما يُبطل فينا وفي الآخرين نعمة الحرية التي وهبنا إياها الوجودُ عينُه، وقد تجلى لكل واحدٍ منا في هيئة المنفسح الاختباري الأرحب.
هوامش:
(١) Cf. Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, Berlin, Springer Verlag, 1990.
(٢) Cf. Heidegger, Holzwege, GA 5, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1977, S. 336.
(٣) Cf. Dilthey, Weltanschauungslehre. Abhandlungen zur Philosophie der Philosophie, Bernhard Groethuysen (Hg.), Gesammelte Schriften 8, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, 1991.
(٤) Cf. Foucault, Dits et écrits (1954-1988), t. I (1954-1975), Paris, Gallimard, 2001, p. 1239.
(٥) Cf. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Elisabeth Ströker, Hamburg, Meiner Verlag, 2012.

بواسطة مشير باسيل عون - كاتب لبناني | مارس 1, 2022 | مقالات
أسهم الفيلسوف الفرنسي بول ريكور في إنشاء فِسارةٍ (بكسر الفاء) فلسفيةٍ استوعبت جميع النظريات التأويلية السابقة، واجتهدت في استثمار عناصرها البنائية الخصبة، فصهرتها في بوتقةٍ تصالحيةٍ ائتلافية. من خصائص هذه الفِسارة أنها لا تنبذ أي إسهام فِساري تأصيلي ولا تُقصي أي اجتهاد تأويلي ناجع، بل تستخرج الطاقات الاستيضاحية المفيدة من الأنظومات الفِسارية الفلسفية. ومن ثم، فإنها فِسارةٌ تجمع التيارَين المتعارضَين: التيار التأويلي المنهجي الاستقصائي الذي حمل لواءه شلايرماخِر (1768-1834م) وديلتاي (1833-1911م) وسواهما، والتيار التأويلي الأنطولوجي الوثوقي الذي نادى به هايدغر (1889-1976م) وغادَمر (1900-2002م) وغيرهما. ولكنها، في نهاية المطاف، تميل ميلًا أوضحَ إلى استخدام آليات التيار الأول؛ إذ تحشد كل مكتسبات العلوم الإنسانية في التحري عن أشكال بناء المعنى في النص.
النص طاقةٌ مشرعةٌ على الإيحاء
من جراء الإصرار على التوفيق بين الفِسارتَين الفلسفيتَين هاتَين، المنهجية الاستقصائية والأنطولوجية الوثوقية، أكب ريكور يتحرى عن مقام النص، وقد ساق له تعريفًا جديدًا استلّه من مكتسبات معارف علوم اللغة التحليلية وفلسفات الفعل التاريخي. في السبعينيات من القرن العشرين، أنشأ بحثًا مستفيضًا في مقام النص، رابطًا إياه بالفعل التاريخي. إذا كانت عبارة «الرمز يبعث على التفكير» شعار المرحلة الأولى من فِسارة ريكور الفلسفية، فإن مقصد «الإكثار من الشرح سبيلًا إلى الفهم الأفضل» غدا شعار المرحلة الثانية التي تُعنى باستجلاء طبيعة النص وهويته وبنائه. في أثناء هذه المرحلة، يفترض ريكور أن الجدلية التكاملية بين الشرح والفهم تُسهم في استيضاح مقام النص، وتُبين أيضًا طبيعة الفعل الذي يجعل المسلك أو التصرف الإنساني يتوسط النص والتاريخ.
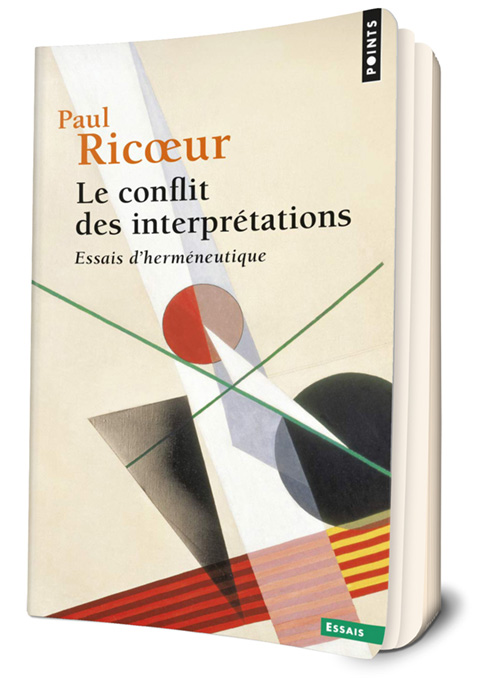 في هذا السياق، يذهب ريكور إلى أن النصوص تساعدنا في استجلاء حقائق الواقع. فالنص طاقةٌ جبارةٌ من التمدد الإيحائي الذي يجعل المعنى مشرع الآفاق؛ لذلك لا بد من توسيع مفهوم النص حتى يشمل كل ما يمكن فهمه من وقائع الحياة، فالكتابات نصوصٌ، والأفعال الإنسانية نصوصٌ، والأحداث التاريخية نصوصٌ. ومن ثم، ينبغي إعادة تعريف النص حتى يدل على الوحدة التعبيرية المبنية بناءً ذاتيًّا يحيل إحالةً مطردةً على مضامينها الخاصة. من جراء التعريف الجديد هذا، يكف ريكور عن تحديد الفِسارة استجلاءً لمعنى الرمز الذي ينطوي على بُعدٍ باطنٍ وبُعدٍ ظاهرٍ، ويَشرع في تحديدها اجتهادًا يعيد بناء حيوية النص الداخلية ويستثير فيه قدرتَه على افتتاح آفاقٍ جديدةٍ من المعاني تستوطن تصور العالم الذي يدفعني النص عينُه إلى الانخراط فيه انخراطَ التأول الوجودي الالتزامي.
في هذا السياق، يذهب ريكور إلى أن النصوص تساعدنا في استجلاء حقائق الواقع. فالنص طاقةٌ جبارةٌ من التمدد الإيحائي الذي يجعل المعنى مشرع الآفاق؛ لذلك لا بد من توسيع مفهوم النص حتى يشمل كل ما يمكن فهمه من وقائع الحياة، فالكتابات نصوصٌ، والأفعال الإنسانية نصوصٌ، والأحداث التاريخية نصوصٌ. ومن ثم، ينبغي إعادة تعريف النص حتى يدل على الوحدة التعبيرية المبنية بناءً ذاتيًّا يحيل إحالةً مطردةً على مضامينها الخاصة. من جراء التعريف الجديد هذا، يكف ريكور عن تحديد الفِسارة استجلاءً لمعنى الرمز الذي ينطوي على بُعدٍ باطنٍ وبُعدٍ ظاهرٍ، ويَشرع في تحديدها اجتهادًا يعيد بناء حيوية النص الداخلية ويستثير فيه قدرتَه على افتتاح آفاقٍ جديدةٍ من المعاني تستوطن تصور العالم الذي يدفعني النص عينُه إلى الانخراط فيه انخراطَ التأول الوجودي الالتزامي.
بما أن النص بناءٌ ذاتي تنعقد فيه صلاتٌ شتى من الترابط والتشابك والتعالق بين العناصر اللغوية المختلفة في الدلالة والإحالة، فإن التأويل الأنسب يستلزم اعتماد المنهجية التحليلية البنيوية التي تتناول النص في بنيته الذاتية الخاصة. قبل الشروع في الفهم، ينبغي الأمانة لمقتضيات الشرح الذي يتحرى عن طبيعة الصلات اللغوية المحتشدة داخل النص؛ ذلك بأن ريكور المتعمق في منهجيات التحليل اللغوي البنيوي يدرك أن اللغة شكلٌ أو صورةٌ أو بنيةٌ، قبل أن تكون جوهرًا أو مضمونًا أو معنًى.
ومن ثم، فإن التأويل ينبغي أن يترصد جميع إمكانيات انعقاد الصلات الجدلية بين العلامات اللغوية التي ينطوي عليها النص. قبل أن يُقدِم المتأولُ على استخراج المعنى واستدخاله في وعيه واستساغته وتحويله إلى معطًى وجودي مُلزم، ينبغي له أولًا أن يعاين كيفيات تكون النص وصوغه بناءً مستقلًّا نابضًا بالحراك الجدلي الداخلي الذاتي.
من الطبيعي، والحال هذه، أن يستعيد ريكور المباحث اللغوية التي اشتملت عليها أعمال الفيلسوف الفِساري شلايرماخِر الذي عرف النص مؤتلفًا يحتضن ضمةً من الأحكام النحوية والبناءات التعبيرية والارتباطات الإيحائية المطبقة تطبيقًا فرديًّا فذا يُبين عبقرية الكاتب. لا بد لكل نص أدبي أو فلسفي رفيع من أن يؤالف بين البُعدَين المتكاملَين هذَين: بُعد الخضوع لأحكام اللغة النحوية، وبُعد الائتمار بعبقرية الإبداع الذاتي.
ذلك بأن الخضوع النحوي وحده يُفضي إلى نص قاموسي عديم الروح، مسلوب الفرادة، في حين يُفضي الائتمار التفنني الذاتي إلى توليد نص مبهم، عاصٍ، مستحيل الإبلاغ. ومن ثم، فإن النص، في عرف شلايرماخر، كتلةٌ بنيويةٌ محكمةُ التركيب، تتألف من تواطؤ القوالب النحوية الجاهزة والأساليب التعبيرية الفردية العبقرية.
خصائص النص البنيوية في مقامه المستقل
استنادًا إلى مثل هذا التعريف، أخذ ريكور يستجلي طبيعة النص اللغوية، فعمد إلى تعريفٍ تحليلي يعاين في النص حدَثًا لغويًّا استثنائيًّا. خلافًا لما كانت تذهب إليه فِسارةُ الأنطولوجيا الوثوقية، ولا سيما عند غادَمر، أعلن ريكور أن النص ينبغي أن نتناوله أولًا تناولَ العلوم اللغوية السيميولوجية التي تحلل كيفيات البناء النصي، وطُرق استثمار العلامات الدلالية والإشارات الإحالية. في إثر هذا التناول، يمكن اللجوء إلى العلوم السيمانطيقية التي تتحرى عن طاقات المعنى المُنْغَلّة في مباني النص. إذا كان الأمر على هذا النحو، اضطر المتأولُ إلى إعادة تعريف النص قبل الشروع في تأوله.
حقيقة الأمر أن النص ينعقد على أربع خصائص أو سمات تجعل الكلام الناشط في أصل النص يتحول إلى حدَثٍ لغوي مستقل: المتكلم المخاطِب الذي ينشئ الكلام في الأصل، والمتلقي المخاطَب الذي يقتبل الكلام، ومضمون التخاطب أو معنى الكلام، والإحالة التي يشير إليها الكلامُ. يفترض الكلام مخاطِبًا يقول شيئًا ويبلغه مخاطَبًا في شأن أمرٍ من الأمور. ما إنْ ينتقل الكلام من حيز فكر المتكلم إلى نطاق الإبلاغ النصي حتى يتحول النص إلى كيانٍ ثقافي مستقل؛ ذلك بأن الكتابة النصية تنشئ النص إنشاءً خاضعًا لمسلمات المعرفة التواصلية في زمنٍ من الأزمان وسياقٍ من السياقات ومجتمعٍ من المجتمعات وثقافةٍ من الثقافات.
بفضل الإنشاء النصي هذا، يكتسب النص مقامًا مستقلًّا عن الحدث الكلامي الأصلي؛ إذ إن الكتابة تبين لنا، بحسب ريكور، أن حدَث الكلام الأصلي انقضى انقضاءً مبرمًا ولا قدرة لنا على استعادته. الأثر الوحيد الباقي من الكلام الأصلي ينعقد في البناء النصي. لذلك كان الإنشاء النصي مجبولًا على بعضٍ من الضعف والانعطاب؛ إذ إنه صورةٌ مستلةٌ من الأصل الغائب. وكل صورةٍ مفطورةٌ على قدرٍ مُربكٍ من الخيانة: «إن كل ما نكتبه وكل ما نُسجله إنما هو جوهر التفكر (noéma) في القول. إنه معنى حدث الكلام، لا الحدث بما هو حدثٌ». في النص لا يَبقى من الحدث الأصلي إلا معناه. أما جسدية الحدث أو ماديته التاريخية، فتزول زوالًا قاطعًا.
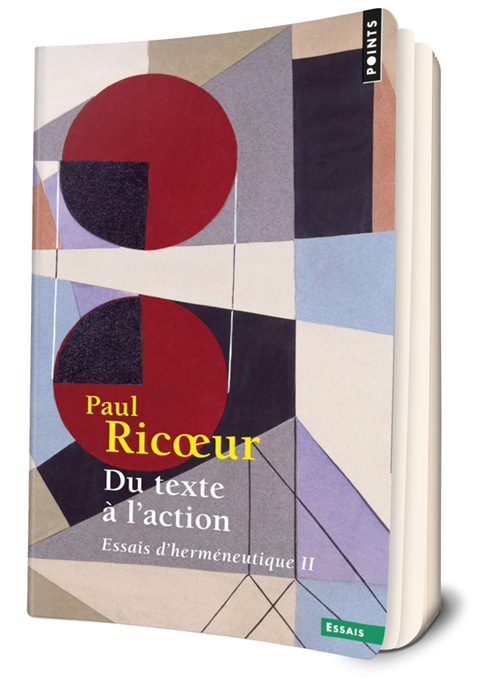 غير أن الإنشاء النصي يُسهل استقلالية الخطاب؛ إذ يُعتقه من الحدث الأصلي الذي احتضن نشأته الأولى. ومن ثم، فإن الكتابة تتسم بمفارقةٍ لصيقةٍ بها تمنحها فرادتها وخصوصيتها؛ ذلك بأن الضعف الظاهر اللصيق بالإنشاء النصي ينقلب إلى مسافة تحررية خلاصية تهبها كل قوتها الإبداعية. بفضل المسافة الانعتاقية هذه، يدرك المتأولُ أنه عاجزٌ عن استعادة الحدث الكلامي الأصلي، والانفراد به، والتماهي به، والتملك عليه، واستثماره استثمارًا ذاتيًّا منفعيًّا.
غير أن الإنشاء النصي يُسهل استقلالية الخطاب؛ إذ يُعتقه من الحدث الأصلي الذي احتضن نشأته الأولى. ومن ثم، فإن الكتابة تتسم بمفارقةٍ لصيقةٍ بها تمنحها فرادتها وخصوصيتها؛ ذلك بأن الضعف الظاهر اللصيق بالإنشاء النصي ينقلب إلى مسافة تحررية خلاصية تهبها كل قوتها الإبداعية. بفضل المسافة الانعتاقية هذه، يدرك المتأولُ أنه عاجزٌ عن استعادة الحدث الكلامي الأصلي، والانفراد به، والتماهي به، والتملك عليه، واستثماره استثمارًا ذاتيًّا منفعيًّا.
وعليه، يُصر ريكور على القول: إن الإنشاء النصي يُكسِب الكلام الأصلي استقلالًا مثلثَ الأبعاد، فيجعل النص مستقلًّا أولًا عن مقاصد المتكلم الأصلية، وثانيًا عن اقتبال الجمهور المخاطَب الأول، وثالثًا عن قرائن إنتاج الكلام المعرفية والاجتماعية والاقتصادية.
حين يتحول الكلام إلى نص مستقل، يصبح النص صاحبَ المبادرة، وحاضنَ المعنى، وباعث الإيحاء المتجدد. ما دام المتكلم حاضرًا، فإنه قادرٌ على استعادة الكلام وتغييره وتطويره أو نسخه وإبطاله. ما إنْ يغيب المتكلم ويتجسد كلامُه في نص منشور حتى يفقد كل سلطة على الخطاب. كذلك الأمر في شأن الجماعة الأصلية المخاطَبة التي اقتبلت للمرة الأولى كلامَ المخاطِب.
بغياب الجماعة، ينعتق الكلام الأصلي من كيفيات الاقتبال التي حددت في المقام الأول طُرقَ الإبلاغ. يصح الاستقلال عينه أيضًا في الخلفيات الإبيستِمولوجية التي تحكم إنتاج الكلام وتُقيد أحكام التعبير في القرائن الأصلية السائدة. بما أن الخلفيات الثقافية تتبدل بتبدل الأزمنة، فإن القرائن الأصلية الناظمة تسقط حين ينعتق النص من سلطة الكلام الأول وينعقد على استقلاليةٍ لصيقةٍ بطبيعة بنائه؛ لذلك يعلن ريكور أن الاستقلالية المثلثة الأضلاع هذه تُبطل كل الطموحات المعرفية التي استهلها دِيكارت (1596-1650م)، ومن بعده فيشته (1762-1814م) وهوسرل (1859-1938م)، حين اعتقدوا كلهم أن الذات المتكلمة تستطيع أن تعرف ذاتها معرفة شفافةً صافيةً مطلقة.
استقلال النص يستلزم تعاضد منهجيات التأويل
لا ريب في أن استقلالية النص تجعله قادرًا على افتعال المسافة الآمنة بينه وبين القارئ المتأول؛ لذلك يدعو ريكور النص عملًا قائمًا بحد ذاته يستنهض قدرات التأول على وجوهٍ شتى. أما الوظيفة التأويلية التي تضمنها المسافة الناشئة بين النص والقارئ، فإنها تتجلى في الاستقلالية التي يحرزها النص في اللحظة عينها التي فيها يُفرج القارئ عنه ويُخرجه من سلطانه وينشره. عندئذ يصبح النص قابلًا ضروبًا شتى من الاقتبال. لا بد، والحال هذه، من استثمار كل منهجيات العلوم الإنسانية التي تتحرى عن المتواري والمحجوب والمكتوم والمخنوق والمغيب في النص.
إنجاحًا لمثل العملية الاستقصائية هذه، لا يستنكف ريكور من الاعتماد على نظرية التفسير البنيوية والنفسية الفرويدية واللغوية الصوَرية التي تستل من النص وعودَ المعنى المُنغَلّة في مطاويه. ما إنْ يُنشر النص حتى يتحول إلى كتلةٍ من البناءات المعنوية التي تحتمل ألوانًا شتى من الاستدخال والاستساغة. غير أن ضروب التأول هذه لا تلائم بالضرورة مقاصدَ الكاتب الأصلية المضمرة، ولا قرائنَ التواصل الإبلاغي الأساسية، ولا استعداداتِ المخاطَبين الاقتبالية.
من فضائل استقلالية النص في فِسارة ريكور الفلسفية أن استثارة الجدة التأويلية لا تنحصر في منهجية واحدة، بل تستثمر مكتسبات جميع المنهجيات من غير أن تتقيد بالخلفيات الأيديولوجية الناظمة. مثال ذلك أن ريكور يستعين بالمنهجية التحليلية البنيوية، ولكنه لا يُغلق النص على ترابطاته الدلالية الضمنية فيحرمه من إمكانيات الانبعاث في وجدان القارئ؛ ذلك لأن البنيوية، في نظر ريكور، ليست مذهبًا في الوجود ومحضنًا للمعنى الحياتي، بل سبيلٌ من السبُل الكثيرة التي تساعد القارئ في إدراك كيفيات بناء النص الداخلية. لا تملك أي منهجية السلطانَ الاستبدادي المطلقَ الذي يدعي القدرة على الاستئثار بمعنى النص. ومن ثم، يجب على كل منهجية تأويلية أن تراعي أحكام فعل التأويل في حدّ ذاته، وتصون قابليات الانكشاف التي ينطوي عليها النص.
التأويل إنشاءٌ جديدٌ يحيي النص
وعليه، لا بد من الإعراض عن تحويل فعل التأويل إلى حالٍ وجدانيةٍ تمازجيةٍ ناشئةٍ من تلاقي العبقريتَين الفاعلتَين؛ أي عبقرية الكاتب وعبقرية القارئ المتأول: «أن يفهم المرء ذاتَه يعني أن يفهم ذاته أمام النص، وأن يقتبل منه شروطَ ذاتٍ أخرى غير الأنا التي أقبلت إلى القراءة. ما من ذاتيةٍ، سواءٌ كانت ذاتية المؤلف أو ذاتية القارئ، تقوم مقام الصدارة، أي مقامَ حضور الذات الأصلي أمام ذاتها». ومن ثم، فإن النص ينبغي أن يصون استقلاليته وقدرته على توليد قضيته الذاتية، أي قضية المعنى الذي ينطوي عليه، وقضية العالم الذي يبسطه أمام القارئ المتأول: «إن ما ينبغي أن نفهمه في سردٍ ليس أولًا المؤلف الذي يتكلم وراء النص، بل ما الذي يجري الكلام عليه، غرضُ النص (la chose du texte)، أي هذا الضرب من العالم الذي يَبسطه العملُ المكتوبُ، في وجهٍ من الوجوه، أمام النص».
معنى ذلك أن النص يرسم للقارئ عالمًا من المعاني المنكشفة التي تستنهض الوجدان المتأول حتى يأتي إليه ويسكن فيه ويعيد اكتشاف ذاتيته الخاصة بالاستناد إلى الإيحاءات البناءة المنبعثة من الجدليات الناشطة في تجاويف النص.
حقيقة الأمر أن النص لا يعترف بحدود الإغلاق والاختتام والانتهاء؛ إذ إنه لا يبرح على نشوءٍ مطرد، ينتقل من طورٍ إنشائي إلى آخر، حتى بعد غياب المؤلف أو انسحابه الطوعي في فعل النشر. يصر ريكور على اعتبار القراءة التأولية فعلَ مشاركةٍ سليمةٍ في تطوير بناء النص: «إن القراءة فعلٌ ملموسٌ يَكتمل فيه قدَرُ النص. إن الشرح والتأويل يتعارضان ويتوافقان، بما لا حد له، في صميم القراءة عينها». ذلك بأن القراءة فعلٌ إنشائي متأخرٌ يرافق الفعلَ الإنشائي الأول، ولو على وجوهٍ مختلفة. فالقراءة تأولٌ إغنائي يُثبت النص في مقام القدرة على الإلهام الاستنهاضي.
كل نص بَطلت مفاعيلُ قراءته لا يسقط في غياهب النسيان فحسب، بل تبَطل نصيتُه بطلانًا مطلقًا، أي يكف عن أن يكون نصًّا، أي عن استحقاق مقام النص. إذا كان الأمر على هذا النحو، فإن النص ينتعش في حضن الجماعة القارئة المتأولة، شأنه شأن النص الديني الذي تحييه الجماعة المؤمنة، أو النص الأيديولوجي الذي ترممه الطائفة المبايعة.
فحوى المقصود أن النص بطبيعته «منسلكٌ في جماعةٍ قارئةٍ تُنمي، في ظل بعض القرائن المؤاتية، هذا الضرب من المعيارية والقانونية الذي نعترف به في الأعمال العظمى، تلك التي لا تني أبدًا تخرج من سياقٍ قرائني لتعود فتنسلك في سياقٍ قرائني آخر في ظل الأحوال الثقافية الشديدة التنوع». يدين النص للجماعة ببقائه في قيد التداول وباطراد قابلياته الإلهامية؛ لا بل قلْ إن الجماعة القارئة تمنح النص وضعيتَه الإلزامية وتزوده صفةَ المرجعية القانونية، فتجعل الناس يستندون إليه في بحثهم عن معاني وجودهم التاريخي.
تدبر التباسات الذات المتأولة
تجدر الإشارة في هذا الموضع إلى أن الجماعة القارئة قد تختلف في تأول معاني النص. في هذه الحال، ينصحنا ريكور بالتروي والتصبر، ويحثنا على استجلاء التباسات الذات المتفكرة. فالأنا التي تروم أن تقرأ النص قراءة التأول الوجودي تعتصرها تشنجاتُ الوجدان المتكسر أو «الكوجيتو المنكسر»، على حد تعبير ريكور نفسه؛ ذلك أن الذات الإنسانية مبهمةُ القوام. السبب الأعمق أن كل فعل إرادي تستثيره الذات ينطوي حُكمًا على محجوبٍ لا إرادي يصيبه في صميم حركته.
حتى الإنسان الذي يدعي أن ذاته سيدةُ قرارها الحر غالبًا ما يختبر أن رغبته الدفينة غيرُ قراره المعلَن، وأن حركته المنجَزة غيرُ فكرته المنحجبة، وأن الضرورة القاهرة أقوى من الإرادة التي يخضع لها. وعليه، فإن الوجدان الإنساني محضنُ جميع ضروب التوريات والمعميات والتشويهات والتضليلات والارتداءات القناعية الحاجبة. لا بد، والحال هذه، من تأويلٍ جريءٍ يستلهم فلاسفة الشك (الفويرباخيون، النيتشويون، الماركسيون، الفرويديون، البنيويون، التفكيكيون) حتى ينزع القارئ عن المعنى كل التباساته الانحرافية.
من جراء تحليل الرغبة الإنسانية تحليلًا سِيمانطيقيًّا، تستطيع الفِسارة أن تتدبر الكيفيات المختلفة التي عليها تأتي الرغبة إلى اللغة وتدخل في نطاقها وتعتلن في مقولاتها. عوضًا عن محاولة الإمساك بالذات إمساكًا حدْسيًّا مَبنيًّا على الفرضية القائلة: إن الذات تستطيع أن تنكشف لنا انكشافًا شفافًا مباشرًا، ينبغي تأويل هذه الذات تأويلًا يتدبر جميع التعابير التي تتخذها رغبتُنا الخالصة في الوجود وفي الحياة وفي الانبساط المنعش.
والمعلوم أن هذه التعابير شديدةُ التعقيد البنائي والتشابك التنابذي والترجح التنازعي؛ إذ نرغب في الأمر في قرائن معينة، وفي نقيضه في قرائن أخرى. ومن ثم، ينصحنا ريكور بأن نُعرض في اجتهاداتنا التأويلية عن كل مطالب التأصيل القاطع الحاسم؛ إذ إن ذاتيتنا مجبولةٌ على الانعطاب الكياني والالتباس الوجداني.
بركة المعنى الفائض في صراع التأويلات
خلاصة القول أن النص، في جميع تجلياته الوجودية والثقافية، من ذاتٍ مُفصِحة وفعلٍ مُنبئٍ وصنعٍ مُبدعٍ وحدثٍ كاشفٍ وإنشاءٍ كتابي، لا يبيح لنا أن ندعي المعرفة المطلقة؛ لذلك لا بد من قبول صراع التأويلات الذي يرفضه فلاسفة اليقين، ومنهم على وجه التحديد أفلاطون ودِيكارت وهوسرل الذين يُصرون على إمكان المعرفة اليقينية القاطعة الجازمة الشافية. غير أن استحالة المعرفة المطلقة في تأويليات الوجود الإنساني وتعابيره الثقافية لا تعني أن الناس يجوز لهم أن يطلقوا الآراء على عواهنها، وأن يحكموا كيفما شاؤوا على الأمور الأساسية: «ثمة تأويلٌ حيث المعنى المتعدد. إن تعدد المعاني إنما يتجلى واقعًا بينًا في التأويل».
أفضل الأمثلة التي يسوقها ريكور على خصوبة الصراع التأويلي ما جاء به في شأن الاجتهاد القانوني الناشط في المحاكم؛ ذلك أن قرار المحكمة لا يوقف المباحثات القانونية والمراجعات النقدية الناشطة في المجلات المختصة بمسائل القانون، لا بل غالبًا ما يستثير حكمُ القضاء المتنازع عليه ضروبًا استثنائية من الاجتهاد التشريعي: «لا يأتي زمنٌ تُستنفد فيه إجراءاتُ الاستئناف إلا في المحكمة. ولكن ذلك يحصل بسببٍ من أن قرار القاضي تفرضه قوةُ السلطات العامة. لا مكانَ لمثل كلمة الفصل الأخيرة هذه في النقد الأدبي، ولا في العلوم الاجتماعية. أما إذا حصل ذلك، فإننا نُطلق عليه اسم العنف». ليس في التأويل أي فصلٍ للمقال وأي تهافت للرأي؛ إذ إن كل الاجتهادات صالحةٌ على قدر ما تصون مقام المعنى، وترعى انعطابية الذات، وتحرص على كرامة الكائنات التي يُفصح النص عن وجهٍ من وجوه اعتلانها. سلامة الأدلة وحسن الحجاج وإجماع الحكماء المنتمين إلى آفاق ثقافية متنوعة كلها معاييرُ صالحة تساعد المتأول في استجلاء مكانز النص. ومن ثم، فإن ريكور أسهم في تدبر مقام النص، مُعرضًا عن أحكام الفِسارة القديمة المبنية على فرضية التوافق الضروري بين النص ومقاصد القارئ. وحده النظرُ في بنيان النص يتيح للقارئ المتأول أن يستخرج المعنى على وجوهٍ جديدةٍ أخاذة.
هوامش:
(1) Paul Ricœur, Du texte à l’action. Essai d’herméneutique II, Paris, Seuil, 1986, p. 185.
(2) Ibid., p. 31.
(3) Ibid., p. 168.
(4) Ibid., p. 158.
(5) Paul Ricœur, Temps et récit. III. Le temps raconté, Paris, Seuil, 1985, p. 262.
(6) Paul Ricœur, Le conflit des interprétations. Essai d’herméneutique I, Paris, Seuil, 1969, p. 16-17.
(7) Paul Ricœur, Du texte à l’action, op. cit., p. 205.



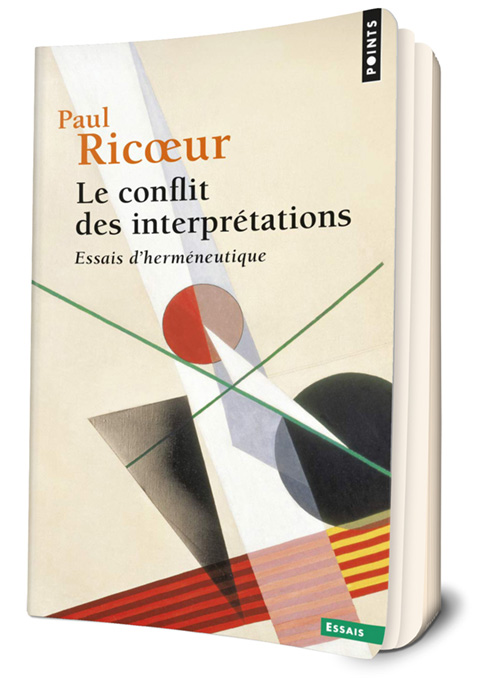 في هذا السياق، يذهب ريكور إلى أن النصوص تساعدنا في استجلاء حقائق الواقع. فالنص طاقةٌ جبارةٌ من التمدد الإيحائي الذي يجعل المعنى مشرع الآفاق؛ لذلك لا بد من توسيع مفهوم النص حتى يشمل كل ما يمكن فهمه من وقائع الحياة، فالكتابات نصوصٌ، والأفعال الإنسانية نصوصٌ، والأحداث التاريخية نصوصٌ. ومن ثم، ينبغي إعادة تعريف النص حتى يدل على الوحدة التعبيرية المبنية بناءً ذاتيًّا يحيل إحالةً مطردةً على مضامينها الخاصة. من جراء التعريف الجديد هذا، يكف ريكور عن تحديد الفِسارة استجلاءً لمعنى الرمز الذي ينطوي على بُعدٍ باطنٍ وبُعدٍ ظاهرٍ، ويَشرع في تحديدها اجتهادًا يعيد بناء حيوية النص الداخلية ويستثير فيه قدرتَه على افتتاح آفاقٍ جديدةٍ من المعاني تستوطن تصور العالم الذي يدفعني النص عينُه إلى الانخراط فيه انخراطَ التأول الوجودي الالتزامي.
في هذا السياق، يذهب ريكور إلى أن النصوص تساعدنا في استجلاء حقائق الواقع. فالنص طاقةٌ جبارةٌ من التمدد الإيحائي الذي يجعل المعنى مشرع الآفاق؛ لذلك لا بد من توسيع مفهوم النص حتى يشمل كل ما يمكن فهمه من وقائع الحياة، فالكتابات نصوصٌ، والأفعال الإنسانية نصوصٌ، والأحداث التاريخية نصوصٌ. ومن ثم، ينبغي إعادة تعريف النص حتى يدل على الوحدة التعبيرية المبنية بناءً ذاتيًّا يحيل إحالةً مطردةً على مضامينها الخاصة. من جراء التعريف الجديد هذا، يكف ريكور عن تحديد الفِسارة استجلاءً لمعنى الرمز الذي ينطوي على بُعدٍ باطنٍ وبُعدٍ ظاهرٍ، ويَشرع في تحديدها اجتهادًا يعيد بناء حيوية النص الداخلية ويستثير فيه قدرتَه على افتتاح آفاقٍ جديدةٍ من المعاني تستوطن تصور العالم الذي يدفعني النص عينُه إلى الانخراط فيه انخراطَ التأول الوجودي الالتزامي.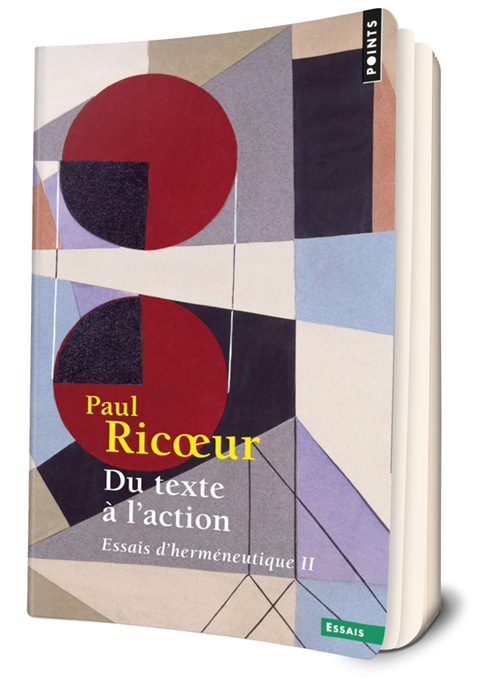 غير أن الإنشاء النصي يُسهل استقلالية الخطاب؛ إذ يُعتقه من الحدث الأصلي الذي احتضن نشأته الأولى. ومن ثم، فإن الكتابة تتسم بمفارقةٍ لصيقةٍ بها تمنحها فرادتها وخصوصيتها؛ ذلك بأن الضعف الظاهر اللصيق بالإنشاء النصي ينقلب إلى مسافة تحررية خلاصية تهبها كل قوتها الإبداعية. بفضل المسافة الانعتاقية هذه، يدرك المتأولُ أنه عاجزٌ عن استعادة الحدث الكلامي الأصلي، والانفراد به، والتماهي به، والتملك عليه، واستثماره استثمارًا ذاتيًّا منفعيًّا.
غير أن الإنشاء النصي يُسهل استقلالية الخطاب؛ إذ يُعتقه من الحدث الأصلي الذي احتضن نشأته الأولى. ومن ثم، فإن الكتابة تتسم بمفارقةٍ لصيقةٍ بها تمنحها فرادتها وخصوصيتها؛ ذلك بأن الضعف الظاهر اللصيق بالإنشاء النصي ينقلب إلى مسافة تحررية خلاصية تهبها كل قوتها الإبداعية. بفضل المسافة الانعتاقية هذه، يدرك المتأولُ أنه عاجزٌ عن استعادة الحدث الكلامي الأصلي، والانفراد به، والتماهي به، والتملك عليه، واستثماره استثمارًا ذاتيًّا منفعيًّا. 