
فتحي بن سلامة: العالم العربي والإسلامي يشهد اليوم نهضة حضارية غير مسبوقة
المفكر وأستاذ علم النفس فتحي بن سلامة، الذي درَّس علم النفس في جامعة «باريس ديدرو» على امتداد عشرات السنين، يعتقد أن تشخيص الوضع الصعب اليوم في المنطقة العربية الإسلامية لا يحجب الواقع الجديد، المتمثل في وجود مسار جدي للتحديث في المنطقة ومحاولات من أجل تحقيق نهضة حضارية حقيقية. صحيح، هناك صورة سلبية تروج اليوم عن المنطقة، فتبدو أمام العالم منبعًا للتخلف والإرهاب ويستغل أصحابها تحركات المتطرفين وغلاة الدين وتوظيفهم للشباب اليائس في أعمال إرهابية، باسم الإسلام والجهاد. وصحيح كذلك ما زال قسم من المسلمين متمزقًا بين الماضي والحاضر، والجدل لم يحسم حول قضايا عدة من بينها كيفية الاستفادة من ماضينا وتراثنا من دون أن يدفعنا ذلك إلى الانغلاق ورفض الاندماج في العصر. لكن ذلك لا يحجب الحقيقة وهو أن قطار التحديث قد انطلق وأن المسيرة لن تتوقف قريبًا. ذلك ما أكده لنا فتحي بن سلامة في حوار مع «الفيصل» الذي تناول أيضًا قضايا عدة تشغل الباحث، وعلى رأسها قضية مقاومة التطرف والإرهاب وبخاصة لدى شباب المنطقة، وكذلك لدى الشباب من أصول عربية وإسلامية في دول الغرب ومن بينها فرنسا حيث يقيم ويعمل.
وبحكم اختصاصه، في علم النفس، فإن المفكر فتحي بن سلامة يعتقد أن الدراسة النفسية لمشكل التطرف ضرورية لفهم الدوافع العميقة التي تجعل رجالًا ونساء كذلك، يقعون في فخ الحركات الإرهابية باسم الإسلام والجهادية، وخَصّص أبحاثًا عدة لهذا الموضوع وأنجز دراسات تحليلية، بالاعتماد على حالات ونماذج من الواقع مستعملًا للغرض، المناهج العلمية للتحليل النفسي.
الكاتب فتحي بن سلامة من مواليد جهة الساحل التونسي سنة 1951م، حاصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة الفرنسية عن أطروحته «تخييل الأصول في الإسلام» وله مجموعة مهمة من المؤلفات حول «أمراض الإسلام» أَكّد في أغلبها فكرةَ أن هناك فرقًا كبيرًا بين «الإسلام الواقعي» و«الإسلام المتخيل»، ونذكر من بينها: «الإسلام والتحليل النفسي» (2002م)، و«إعلان العصيان: استخدام المسلمين وغيرهم» (2005م)، و«الثورة المفاجئة، من تونس إلى العالم العربي: معنى الانتفاضة» (2011م)، و«حرب الذاتيات في الإسلام» (2014م)، و«المثالي والقسوة: الذاتية وسياسة التطرف» (2015م)، و«رغبة هوجاء في التضحية.. المسلم الأعلى» (2016م)، و«المرأة والجهاد، لماذا اخترن داعش؟» (2017م)، و«القفزة الملحمية، أو اللحاق بالجهاد» (2021م). وقد صدرت كلها بالفرنسية، وتُرجم بعضها إلى العربية. وتجربة فتحي بن سلامة في الجامعة الفرنسية ثرية، فتقلد مناصب رفيعة وتمكن من إحداث وحدات بحثية مهمة، أغلبها لها علاقة بموضوع اهتمامه، وهو فهم أسباب التطرف وعلاجه. ومؤلفاته من بين المراجع المهمة في فهم ظاهرة التطرف، لمعرفته الدقيقة بتاريخ المنطقة، ولاستفادته من المناهج الحديثة للعلوم الإنسانية التي فتحت آفاقًا واسعة أمام دارسي تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة العربية والإسلامية. وفيما يأتي نص الحوار:
● أي تشخيص يمكن وضعه اليوم لحالة الشعوب العربية والإسلامية؟
■ إن أي تشخيص حقيقي يجب أن يراعي الاختلافات بين الجهات والبلدان، وأن يأخذ في الحسبان المعطيات التاريخية الخاصة بكل بلد. لكن هناك قضايا وإشكاليات تجتمع فيها بلدان المنطقة العربية والإسلامية منذ الصدمة الحضارية التي تعرضت لها في القرن التاسع عشر وما زالت آثارها موجودة إلى اليوم. فالنقاش اليوم ما زال قائمًا والجدل ما زال مستمرًّا بين مَنْ يتشبث بالماضي متمسكًا بالعودة إلى الأصل والقديم، وبين من يتطلع إلى المستقبل ويطالب بالتحرر من ثقل الماضي ووطأته، لكنه يأخذ أبعادًا مختلفة من بلد إلى آخر. فقد أحدث شروخًا وتمزقات في بعض المناطق وأدى إلى حروب أهلية. عمومًا، إن النقاش حول علاقتنا بالماضي وبالتراث هو في قلب الجدل القائم حول مفهوم الهوية.
 صحيح أن صراعات الهوية موجودة في كامل أنحاء العالم بما في ذلك الغرب، رغم الثقة في أن مثل هذه المشكلات قد حسمت من خلال الانصهار في الحداثة، التي تعني البحث المستمر عن كل ما هو جديد. لكن الحداثة، وربما لمدة مؤقتة، تبدو في أزمة لأنها استنفدت إمكانياتها الإبداعية الثقافية والأخلاقية والسياسية. أما المنطقة العربية والإسلامية، فإن قضية الهوية تتخذ بعدًا دينيًّا متعصبًا، على أرضية علمانية هي في حكم الواقع. فالعالم الذي يعيش فيه المسلمون اليوم هو واقع علماني، بشكل واضح، لكنّ الكثيرين من بينهم لا يعترفون به على الرغم من أنهم يقبلون على منتجاته بنَهَمٍ. فهم ما زالوا يعتقدون أنه يمكن تأويله دينيًّا واستيعابه كما لو كانوا يملكون عصا سحريةً. وهو ما ينتج عنه إحساس بالمرارة الذي يقود بدوره إلى الشعور بخيبة الأمل، ثم يولد الضغينة، وكل ذلك تستغله الحركات المتطرفة.
صحيح أن صراعات الهوية موجودة في كامل أنحاء العالم بما في ذلك الغرب، رغم الثقة في أن مثل هذه المشكلات قد حسمت من خلال الانصهار في الحداثة، التي تعني البحث المستمر عن كل ما هو جديد. لكن الحداثة، وربما لمدة مؤقتة، تبدو في أزمة لأنها استنفدت إمكانياتها الإبداعية الثقافية والأخلاقية والسياسية. أما المنطقة العربية والإسلامية، فإن قضية الهوية تتخذ بعدًا دينيًّا متعصبًا، على أرضية علمانية هي في حكم الواقع. فالعالم الذي يعيش فيه المسلمون اليوم هو واقع علماني، بشكل واضح، لكنّ الكثيرين من بينهم لا يعترفون به على الرغم من أنهم يقبلون على منتجاته بنَهَمٍ. فهم ما زالوا يعتقدون أنه يمكن تأويله دينيًّا واستيعابه كما لو كانوا يملكون عصا سحريةً. وهو ما ينتج عنه إحساس بالمرارة الذي يقود بدوره إلى الشعور بخيبة الأمل، ثم يولد الضغينة، وكل ذلك تستغله الحركات المتطرفة.
لكن إذا ما تأملنا التطورات التي شهدتها هذه المنطقة من العالم، على الرغم من الكوارث التي عاشتها، فإننا نلحظ وجود تحولات كبيرة نهضت بالمنطقة. فالعالم الإسلامي، منذ النصف الثاني من القرن العشرين، على الرغم من الاحتلالات العسكرية والصراعات بين دول الجوار، والحروب الأهلية، والإرهاب، فإنه يشهد في هذه المرحلة نهضة حضارية أصِفُها شخصيًّا بأنها غير مسبوقة ولا يمكن وضع حد لمداها الذي يشمل جميع المجالات الحضارية: خروج النساء من سجنهن بالبيوت إلى الفضاء العام، ولو أنهن دفعن ثمن شعورهن بالذنب بارتداء الحجاب، وفي بعض البلدان حققت المرأة انعتاقها فعلًا، تطور مؤسسات المعرفة عبر إنشاء مئات الجامعات، زيادة نصيب الفرد من الدخل، وأحيانًا الثروة- صحيح أن هناك مداخيل كثيرة متأتية من النفط، لكنّ هناك كثيرًا من المبادلات التجارية، وإنتاج كثير من البضائع والعديد من الخدمات- توسيع الخدمات الصحية التي كانت سبب الانفجار الديمغرافي، ظهور نخبة من العلماء والكتاب والفنانين منتجين لمعارف جديدة، استحداث أنظمة قانونية جديدة حيث تختلط المراجع الدينية والعلمانية، غير أن القوانين العلمانية غالبًا ما تكون لها الغلبة في العديد من الحالات.

هذه إذن، ولو بعجالة، الوضعية الحقيقية للعالم الإسلامي التي يقع تغييبها، مقابل ترويج تلك الصورة الفظيعة التي تسبب فيها الإرهاب والأنظمة الفاسدة. لكن بالتأكيد إن النهضة الحضارية التي يشهدها العالم الإسلامي هي مسار طويل الأمد وبطيء ولا يشمل جميع الفئات، بل يترك كثيرين على الهامش ممن لا يستطيعون الانصهار في المسار لأسباب مادية أو ثقافية.
وفي الواقع تختلف نسبة الاندماج في النهضة الحضارية وفق الطبقات الاجتماعية. وصحيح أن نهضة العالم الإسلامي قائمة بشكل كبير على استعارات واسعة من الغرب لكن وجب الاعتراف كذلك -بعيدًا من أي تناظر كاريكاتيري- بأن النهضة الغربية ما كانت لتتحقق من دون الاستفادة من حضارات أخرى، من بينها الحضارة الإسلامية. وما أقوله في هذا المجال ليس من باب التفاؤل وإنما هو ملاحظة واقعية، حتى لو كنا ندرك أن الأمور لا تسير بالسرعة الكافية. في هذه الحالة علينا أن نتذكر من أين خرج العالم الإسلامي وكيف كانت وضعيته في القرن الماضي. أوربا في حد ذاتها شهدت خلال عصر النهضة العديد من الحروب الدينية والإرهاب، والدمار. فلا يمكن أن يحدث أي تغيير للحضارات من دون أن يثير ردود أفعال، لا نقول رافضة للتغيير، لأن ذلك يعدّ من أبسط الأشكال، إنما نقصد تلك الوضعية التي نريد فيها الشيء ولا نريده في الوقت نفسه، أي نريد التغيير ولا نريده في الوقت الذي نعيش فيه تغييرات كبرى. إن هذه الحالة أسوأ ما هو ممكن، يسود فيها التأرجح بين الرغبة في الشيء وعدم الرغبة فيه، وهي المنتشرة في منطقتنا. إنه مرض التناقض الذي يؤدي إلى الإصابة بالاضطراب العصبي كالانفصام والوسواس الذي يمكن أن نلحظ أنه في زيادة مذهلة في بلداننا. وهذا بدوره يؤدي إلى الإفراط في التديّن وفي مظاهره التي يسعى أصحابها من خلالها إلى مواجهة الإحساس بالذنب داخليًّا، أو ما يثيره فيهم الدعاة الذين يتقنون جيدًا اللعب بالآلام التي يعيشها أصحاب هذه الأمراض، من إحساس بالذنب.
المنهج العلمي والسرديات الأدبية
● أوضحت في كتابك «الإسلام والتحليل النفسي» أن المدونة الإسلامية هي أدب، وهي لا تختلف عنه إلا في أنه محاط بجهاز يُوهِم بأنه الأصل وأنه الحقيقة لا التخييل، هل التاريخ مبني على وهم؟ هل هي خاصية للمسلمين وحدهم أم هي خاصة بكل الأديان؟
■ يجب التمييز بين التاريخ الذي يكتبه المؤرخون بالاعتماد على المنهج العلمي، والسرديات التي تختلط فيها ذاكرة الأحداث بالأسطورة. وهذا ما قصدته في كتابي. فجزء مما ينسب للتاريخ الإسلامي ليس له قيمة تاريخية، بمعيار المنهج التاريخي. لكن علينا أن ننتبه إلى أن السرد الأدبي ليس بلا شيء. إنه مرآة تعكس جوهر مجموعة بشرية وروحها. كل حضارة وكل مجتمع لديه عالمه الخيالي والرمزي. الجماعات البشرية لديها أحلامها ولديها كوابيسها، وهي تصنع من خيباتها دراما وتحول انتصاراتها إلى ملاحم، حيث تكون المبالغة هي القاعدة. أما عالمنا اليوم فيتطلب التمييز بين الواقع والمرغوب فيه، وبطريقة أخرى يتطلب التمييز بين الخيال والأحداث الفعلية. لكن في منطقتنا العربية والإسلامية، ما زال ما هو غير تاريخي مهيمنًا على طريقة فهمنا للحاضر والماضي. والجزء الأكبر من تراثنا لم يمرّ بعد عبر غربال التاريخانية والنقد.
 ● تطلب في مؤلفاتك وفي محاضراتك من المسلمين أن يغيروا أنفسهم حتى يمكنهم أن يتحولوا إلى فاعلين؛ ما التغيير الذي يجب أن يقوموا به، وما التغيير الذي يمكن أن يحققوه في العالم؟
● تطلب في مؤلفاتك وفي محاضراتك من المسلمين أن يغيروا أنفسهم حتى يمكنهم أن يتحولوا إلى فاعلين؛ ما التغيير الذي يجب أن يقوموا به، وما التغيير الذي يمكن أن يحققوه في العالم؟
■ استلهمت ذلك من الآية القرآنية الجميلة: (إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ). وهي تعني أن التغيير لا يمكن أن يكون هبة من الله، إنه يأتي من مجهود داخلي للإنسان. يمكن أن نؤول ذلك على المستوى الروحاني، ويمكن أيضًا أن نؤوله على المستوى النفسي. فمن منظور التحليل النفسي، أقول: إنه يجب التمييز بين المخيل، الرمزي، والواقعي. فالمخيل يحيلنا إلى عالم المثال والحلم. أما الرمزي فهو يحيلنا إلى عالم اللغويات، مصدر كرامة الإنسان ووسيلته للتبادل مع أمثاله. أما الواقع فهو كل ما يتعلق بالموضوعية، بالحقيقة المجردة من كل عوامل ذاتية. وجميع هذه السجلات ضرورية لحياة الفرد والمجموعة، تجمعها روابط غير أنه لا بد من وضع حدود بينها حتى نقلل إمكانية الخلط بينها. ونحتاج في ذلك إلى عمل نقدي متمّعن وواضح وخلّاق. فالنقد هو من أهم العناصر في عملية التحديث. ولكن علينا أن نبدأ بنقد الذات، ونقد المجموعة التي ننتمي إليها قبل نقد الآخر.
● استخدام معايير وأدوات ومناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية في الدراسات الإسلامية فتح إمكانيات كبيرة أمام الباحثين؛ برأيك هل ساعدت هذه المناهج الناس على إعادة النظر في مسلماتها أم إنها زادت في عزل النخبة عن عامة الناس؟
■ المشكل هنا هو الهوة بين ما تنتجه النخبة ونشر المعرفة لدى الجميع. التقليص من هذه الهوة هي مسؤولية السياسات الثقافية والتعليم العمومي. فقد أشارت منظمة الألكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) في تقريرها الأخير إلى أن المنطقة العربية تضم مع بداية القرن الحادي والعشرين 70 مليون أُمّيّ، وهو ما يمثل النسبة الأعلى للأمية في العالم. ماذا فعلنا لكل هؤلاء الناس؟ كم من برنامج لرفع الأمية وضَعْنا؟ كم جامعة شعبية أسسنا؟ في المقابل تركنا الميدان لجحافل القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث باستمرار الرداءة وتنشر الجهل. وهو ما يزيد في حجم الهوة بين النخب وعامة الناس، ويشكل أرضية خصبة لانتشار الشعبوية بمختلف تمظهراتها وأشكالها.
سُبل الجهاد
● «الجهاد» من الموضوعات التي أوليتها أهمية في بحوثك، وخصصت كتابًا للمرأة والجهاد أكدت فيه أن المرأة تبحث عن الخلاص، بالانضمام إلى منظمة إرهابية مثل تنظيم داعش؛ لأنها تمنحها ذلك الوهم بالفوز؛ لأنها تزوجت بشخصية منذورة للموت أو لأنها أم لأولاد رجل منذور للموت. هل ماتت الفكرة مع فشل التنظيم ميدانيًّا، أم إنها ما زالت تمثل خطرًا لأنها تظل تعشش في العقول؟
■ أولًا، إن الجهاد قد تعرض إلى سحق رمزي مهم في بداية القرن العشرين. ابن رشد كان يميز بين أربعة أنواع من الجهاد: جهاد القلب؛ وهو جهاد النفس أي المعركة ضد النرجسية والأوهام، جهاد اللغة؛ الذي يعبر عنه من خلال البلاغة والقول الحسن، جهاد اليد؛ وهو البناء، وجهاد السيف؛ أي الحرب. وقد مكنت فكرة الجهاد ببعدها الديني في حقبة الكفاح ضد الاستعمار، واكتسبت مشروعيتها من الكفاح من أجل الخروج من القهر. وقد لُجِئَ إلى جهاد السيف كذلك، خلال التدخلات العسكرية الأجنبية. لكن الإسلام الراديكالي، بأشكاله الأكثر عنفًا، وظف الجهاد في الإرهاب وفي عمليات انتحارية، مستعملًا النزعة نحو التدمير الذاتي الموجودة لدى الأشخاص. كلمة «انتحار» خاطئة في هذه الحالة؛ لأن من ينتحر يقتل نفسه، لكن في هذه الحالات، المرشحين لتنفيذ هذه العمليات يريدون لا قتل أنفسهم فقط، إنما قتل الآخرين. إنهم يكرهون أنفسهم ويكرهون الحياة البشرية. وهكذا فإن مفهوم «الشهيد» قد وقع تحويل وجهته ليصبح تفضيلًا للموت على الحياة، وهو الأمر الذي لم يكن كذلك من قبلُ.
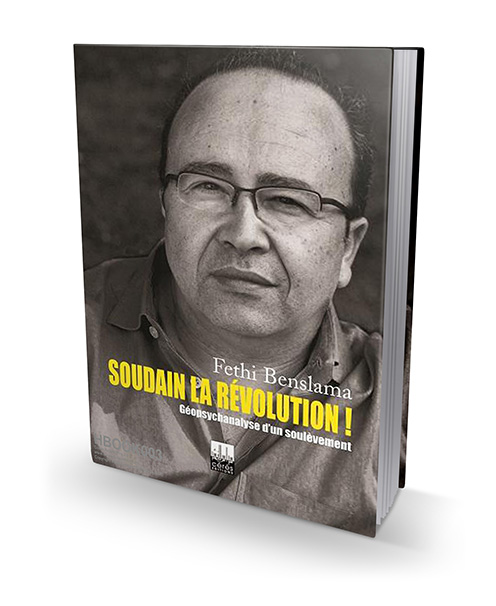 فالمجاهد يريد أن يقاوم حتى إن كلفه ذلك حياته، لكن الموت ليس هدفه. الرجال الذين استسلموا لنداء الموت هذا، ربطوا أنفسهم بقصة أصبحوا فيها أبطالًا مستشهدين. هناك أيضًا أقلية من النساء اللواتي يلبين النداء، ولكن من موقع مختلف. فالمرأة، في أغلب الأحيان، تريد أن تكون زوجة لجهادي لتحقق من خلال ذلك هدفين اثنين: أولا، تنجب أولادًا يضحون بأنفسهم من أجل الدولة الإسلامية المزعومة، وثانيًا، تلتحق بالجنة بفضل زوجها كمنذور للشهادة. فقد درسنا مع عالِم الأنثروبولوجيا فرهاد خسروخافار حالات عدة، وحاولنا فهم المحرك النفسي والاجتماعي الذي يحملهن على اختيار هذا المصير. نهاية داعش لا تعني نهاية الوهم الذكوري والأنثوي المرتبط بالجهاد الذي هو عبارة عن مادة مخدرة مهداة لمن يطلبها عندما تكون الظروف مناسبة.
فالمجاهد يريد أن يقاوم حتى إن كلفه ذلك حياته، لكن الموت ليس هدفه. الرجال الذين استسلموا لنداء الموت هذا، ربطوا أنفسهم بقصة أصبحوا فيها أبطالًا مستشهدين. هناك أيضًا أقلية من النساء اللواتي يلبين النداء، ولكن من موقع مختلف. فالمرأة، في أغلب الأحيان، تريد أن تكون زوجة لجهادي لتحقق من خلال ذلك هدفين اثنين: أولا، تنجب أولادًا يضحون بأنفسهم من أجل الدولة الإسلامية المزعومة، وثانيًا، تلتحق بالجنة بفضل زوجها كمنذور للشهادة. فقد درسنا مع عالِم الأنثروبولوجيا فرهاد خسروخافار حالات عدة، وحاولنا فهم المحرك النفسي والاجتماعي الذي يحملهن على اختيار هذا المصير. نهاية داعش لا تعني نهاية الوهم الذكوري والأنثوي المرتبط بالجهاد الذي هو عبارة عن مادة مخدرة مهداة لمن يطلبها عندما تكون الظروف مناسبة.
فالكلمات يمكن أن تتحول إلى مواد مخدرة قوية، وتوفر العرض المغري يجعلها مطلوبة تمامًا مثلما يخلق عرض الثلاجة الرغبة في اقتنائها في موجة الحرارة. دورنا كمثقفين ودور الحكام يتمثل اليوم في توضيح معاني الجهاد الأربعة وتوفير إمكانية الجهاد المدني بدل الجهاد الحربي. صحيح، إنه طموح كبير ولكن، لا خيار أمامنا. فعندما تشهد الحضارات تحولات كبرى، مثلما يحدث اليوم في العالم الإسلامي، مع الارتفاع الديمغرافي، فإن السيطرة على الغرائز تعاني إخفاقاتٍ عدةً، وبخاصة مع عدم تحقق الطموحات المشروعة. حينها يرتفع منسوب الإحباط الذي يدفع إلى حلول طوباوية مجنونة.
● بما أنك تعيش في أوربا وتحديدًا في فرنسا، هل ما يجري من نقاشات حول الإسلام في فرنسا، هو لأغراض سياسية ويوظف في حملات انتخابية أم إن هناك أزمة هوية حقيقية وأزمة ثقافية تعيشها فرنسا والغرب عمومًا؟
■ يجب ألا نغفل دائمًا أن أوربا متعددة مثل الإسلام. وبلد مثل فرنسا لا يمكن اختزاله في صوت واحد وفي موقف واحد في علاقته لا مع الإسلام -لأن ذلك عام جدًّا، ويمكن أن نضع فيه ما يخطر على البال- ولكن في العلاقة مع المسلمين. هناك واقع واضح لا يمكن تجاهله اليوم وهو يمثل رهانًا حقيقيًّا، هو أنه يوجد في فرنسا ما بين 6 و8 ملايين مسلم، أي ما يمثل 10% من إجمالي السكان، والمسلمون هم الأقلية الدينية الأولى في البلاد. في غضون نصف قرن، تغير المشهد البشري في هذا البلد بطريقة غير مسبوقة. وهو أمر لا بد من أخذه في الحسبان. المسلمون في فرنسا هم بدورهم ليسوا كتلة متجانسة. فهم ينتمون لبلدان أصلية مختلفة وعلاقتهم مع الدين مختلفة وينتمون لفئات مختلفة. فعلى سبيل المثال، نصف مسلمي فرنسا لا يمارسون الشعائر الدينية، وجزء منهم ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المتواضع أو الفقير (لا يمكن أن نحدد النسبة بالضبط لأن الإحصائيات المتعلقة بالانتماء الديني والعرقي ممنوعة في فرنسا)، ويعيشون في الضواحي الفرنسية في أوضاع صعبة اجتماعيًّا واقتصاديًّا.
في المقابل هناك مسلمون نجحوا في الاندماج وارتقوا السلم المهني وهم موجودون في مختلف المستويات الوظيفية، بما في ذلك أعلى الوظائف. هناك جزء من الفرنسيين يكنّون عداوة للمسلمين، وهي ليست موجهة من طرف الفئات المتواضعة فقط، إنما النخبة أيضًا. إنهم يمثلون تقريبًا 30% إذا ما استندنا إلى نتائج التصويت لفائدة الذين يعبرون صراحة عن كراهيتهم ورفضهم للمسلمين. وقد ساهمت العمليات الإرهابية فيما بين 2014 و2019م التي خلفت مئات القتلى والجرحى، في تقوية مشاعر الكراهية والخوف. ففرنسا هي أكثر البلدان الأوربية التي تأذّت من عمليات إرهابية باسم الإسلام. هناك أيضًا المظاهرات التي ينفذها منتمون للسلفية والإسلام الراديكالي، الذين يريدون تأكيد أنهم يمثلون الإسلام الحقيقي ويعلنون عن عدم اعترافهم بقوانين الجمهورية ويطالبون باتباع أحكام الشريعة. فما البلد الذي يقبل أن يرفض جزءٌ من سُكّانه قوانينَه؟ لا ننسى أن فرنسا دولة لائكية، وقوانينها لا تمنع اتباع الأديان وممارستها، لكن الدولة لا دِينَ لها، وتريد أن تبقى على الحياد. لأجل ذلك فإن القوانين تمنع إظهار الرموز الدينية في المدارس، وفي الإدارات. فقد شهدت فرنسا في تاريخها حروبًا دينية، وهي لا تريد أن يتدخل الدين في السياسة. الأمور إذن نسبية. فليس هناك عنصرية تمارسها الدولة ضد المسلمين. هناك فرنسيون يكرهون الإسلام ويخافون منه. وهناك مسلمون لديهم مشاعر معادية ضد البلد الذي يعيشون فيه؛ منهم من يحمل جنسية هذا البلد. انتقاد الدولة مسموح به في فرنسا وفي أوربا، لكن مشاعر الكراهية ومعاداة الوطن لا يمكن أن نجد لها أعذارًا.
ضرورة العودة إلى الواقع
● سبق أن وضعت وصفًا لحالة التونسيين، بعد أحداث 14 يناير 2011م وأنت التونسي الذي رحب كثيرًا بالثورة على الرغم من وصفك لها بالمفاجأة، وقلت: إنهم في وضعية تسمى «لا بسيكوز بوست أنسيرإكسويونال» وهو نوع من الهذيان بعد الثورة يتأتى من فقدان وقتي وجزئي للعلاقة بالواقع. كنت دعوت حينها إلى الرجوع إلى الواقع. هل حدثت العودة إلى الواقع، أم ما زالت الوضعية ذاتها؟
■ رحبت بالثورة التونسية، مثلي مثل أغلبية التونسيين. فقد جعلتنا نحلم بالحرية والعدالة والتقدم للجميع، حدث أن فكرنا أحيانًا بطريقة هذيانية. هي تجربة ثرية خاصة على مستوى الحريات السياسية والتعددية وحرية التعبير ومن خلال الدور البارز للمجتمع المدني الذي برهن عن إمكانيات كبيرة وعن وجود قوى خلاقة وقادرة على تعديل موازين القوى في البلاد. أعتقد أن المواطن التونسي يتمتع اليوم بأكبر قدر من الحرية في المنطقة العربية، فهو يمكن له أن يعبر عن رأيه من دون أن يخشى الملاحقات من أجل ذلك. وقد غنم التونسيون مكاسب سياسية مهمة، غير أن الفشل الاقتصادي كان هائلًا. فالنخبة السياسية التي تسلمت مقاليد السلطة ومن بينها حزب حركة النهضة الإسلامي، لم يتحملوا مسؤوليتهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ولم يحققوا العيش الكريم الذي كان من بين أهم الانتظارات من الثورة. بل على العكس، لقد حدث تراجع كبير.
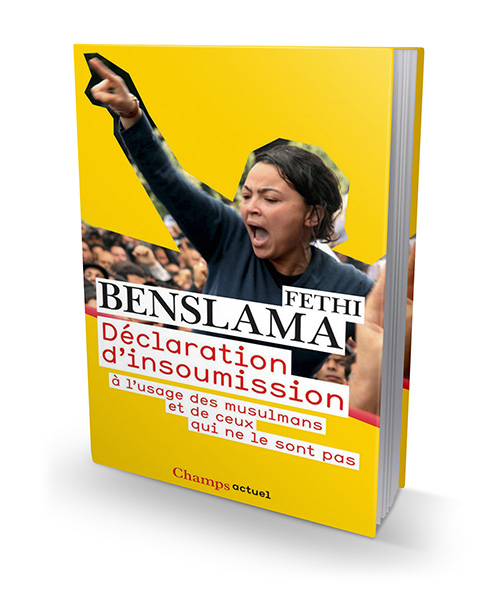 فالديمقراطية يجب أن تكون اجتماعية واقتصادية وليست سياسية فقط. فهذا الثالوث ضروري، ومن دون توافره تتحول الديمقراطية إلى آلية لاختيار مسؤولين عن طريق نظام اقتراع لتقاسم السلطة فحسب. يجب أن نعترف أنه بعد عشر سنوات، لا وجود لضلعين من أضلاع هذا الثالوث. بل شهدنا معارك حزبية وسياسية، تحرر أصحابها من التزاماتهم بتحقيق الانتظارات المشروعة للشعب التونسي. واليوم وجد التونسيون أنفسهم وبعد قرار 25 يوليو من هذه السنة (قام الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وتولى السلطة التنفيذية بنفسه وأعلن عن مرحلة استثنائية تمر بها البلاد مستندًا إلى الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول له اتخاذ تدابير خاصة في حال تعرض البلاد إلى خطر داهم)، مجبرين على العمل من أجل العثور على حلول تنقذ ديمقراطيتهم. سيكون الأمر صعبًا ومؤلمًا لكن ليس هناك خيارات أخرى أمامهم. وقد كان الرئيس قيس سعيد محقًّا عندما أعلن عن دخول البلاد في مرحلة استثنائية، لكن أعتقد أنه اتخذ سبيلًا خاطئًا بإصراره على أن يكون الوحيد صاحب القرار وأن يقوم وحده بالإصلاحات المطلوبة، فذلك لن يوصله إلى أي مكان. إنه مخطئ وسيجد نفسه مجبرًا على إصلاح خطئه. الشعب التونسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام من يرى نفسه المنقذ الوحيد أو النبيّ المخلِّص. فالصدق ونظافة الأيدي لدى المسؤول ضرورية، لكنها ليست كافية. والرئيس عليه عاجلًا أم آجلًا التعامل مع القوى الداخلية الفاعلة. المشكل أن البلاد بصدد تضييع وقت ثمين جدًّا.
فالديمقراطية يجب أن تكون اجتماعية واقتصادية وليست سياسية فقط. فهذا الثالوث ضروري، ومن دون توافره تتحول الديمقراطية إلى آلية لاختيار مسؤولين عن طريق نظام اقتراع لتقاسم السلطة فحسب. يجب أن نعترف أنه بعد عشر سنوات، لا وجود لضلعين من أضلاع هذا الثالوث. بل شهدنا معارك حزبية وسياسية، تحرر أصحابها من التزاماتهم بتحقيق الانتظارات المشروعة للشعب التونسي. واليوم وجد التونسيون أنفسهم وبعد قرار 25 يوليو من هذه السنة (قام الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وتولى السلطة التنفيذية بنفسه وأعلن عن مرحلة استثنائية تمر بها البلاد مستندًا إلى الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول له اتخاذ تدابير خاصة في حال تعرض البلاد إلى خطر داهم)، مجبرين على العمل من أجل العثور على حلول تنقذ ديمقراطيتهم. سيكون الأمر صعبًا ومؤلمًا لكن ليس هناك خيارات أخرى أمامهم. وقد كان الرئيس قيس سعيد محقًّا عندما أعلن عن دخول البلاد في مرحلة استثنائية، لكن أعتقد أنه اتخذ سبيلًا خاطئًا بإصراره على أن يكون الوحيد صاحب القرار وأن يقوم وحده بالإصلاحات المطلوبة، فذلك لن يوصله إلى أي مكان. إنه مخطئ وسيجد نفسه مجبرًا على إصلاح خطئه. الشعب التونسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام من يرى نفسه المنقذ الوحيد أو النبيّ المخلِّص. فالصدق ونظافة الأيدي لدى المسؤول ضرورية، لكنها ليست كافية. والرئيس عليه عاجلًا أم آجلًا التعامل مع القوى الداخلية الفاعلة. المشكل أن البلاد بصدد تضييع وقت ثمين جدًّا.
ضيق الهوية واتساع الوجود
● يرى المفكر هشام جعيط أن الإيمان بالهوية ورسوخها في التاريخ العميق لا يمكن أن يحصل من دون أن ندخل بجدية فيما أسماه بالتحديث والسيرورة العربية نحو المستقبل، وهو يشدد على أنه يؤمن بأهمية تحقيق التوازن بين الهوية الجماعية والدخول في التاريخ المعاصر، فإلى أي درجة يرى التحليل النفسي، الانتماء إلى مجموعة معينة مهمًّا؟
■ أُقدر كثيرًا عمل الأستاذ هشام جعيط مؤرخًا، فهو من أبرز المؤرخين في العالم العربي لكني لا أتفق معه على المستوى السياسي. فأنا مثلًا أرى أن مفهوم الهوية مفهوم سلبي وهو عبارة عن فخ مخيف في العالم العربي وفي كامل أنحاء العالم. فالهوية هي اختراع غربي وقع تحويله من المنطق إلى السياسة ولفائدة هيمنة الإمبراطوريات الأوربية في القرن التاسع عشر. في البداية كانت الهوية تستخدم في المسائل التعليمية بمعنى أن «الشيء هو نفسه»: الأليف هو الأليف أو الأليف يساوي الأليف.
لقد استخدم الغرب مفهوم الهوية لخدمة العنصرية، وللاستنقاص من الحضارات الأخرى. فالسلم الهرمي والتراتبية المفروضة على ثقافات الشعوب مصدرها الهوية التي ينطلق منها في تكوين هذا السلم التراتبي وفق الأفضلية الغربية. وقد ساهم مفهوم الهوية في خلق النظام البوليسي الحديث، (بطاقة هوية، صورة فوتوغرافية للهوية القضائية، بصمات الأصابع، الاعتماد على الحامض النووي لتحديد الهوية، وغيرها). باختزال، يتعلق الأمر بوصم فرد أو مجموعة (حصرها في مواصفات معينة) بغرض المراقبة. إن الهوية تندرج في إطار الخطاب الفوقي للسيد والمحكوم فيه.
ذكر ابن رشد أن المترجمين العرب عندما وجدوا أنفسهم أمام مصطلح الهوية من اللغة اليونانية «Authentes») مصطلح من اختراع الفيلسوف أرسطو اشتقه من كلمة «Autos» التي تعني الذات نفسها)، لم يجدوا في اللغة العربية جذرًا يمكنهم من ترجمته، فالتجؤوا لكلمة «هو» لتكوين كلمة «هوية»، ولكن «الهو» يعني الضمير الغائب والآخر. إذن في الواقع كلمة «هوية» تعني عكس ما تعنيه «Authentes»، أي الذات الأخرى وليس الذات نفسها. ولا ينبغي أن ننسى، أن «هو» يستخدم أيضًا للدلالة على الكائن كما أوضح ذلك اللغويÉmile Benveniste عندما نقول بالعربية «هويتي» نعني ذاتي كآخر، أي على أنها فرق في الوجود وليس تطابقًا يؤدي إلى الانغلاق الذاتي، مصدره خيال الكمال والتفوق والنرجسية حتى الانتحار في بعض الحالات.
وقد استعملت دول ما بعد الاستعمار في سياق عملية بناء الوطنية الحديثة مفهوم الهوية لمنع النقد وحرية التعبير، كما نجد هذا المفهوم يتكرر في جميع الخطابات الشمولية وأكثرهم خطورة خطاب الإسلاميين. ونشير في هذا الصدد إلى أن هذا الخطاب الهووي هو أكثرها محاكاة للغرب. إن خطاب الهوية يفتح أبوابًا كبيرة للقمع والإقصاء.
يجب رفض الهوية وخطابها، فنحن لسنا بحاجة للتعبير عن أنفسنا هكذا. فمفهوم الوجود أهم وأعمق. إنه لا يقبل الامتثال ولا يتحول إلى منطق بوليسي، ليس هناك معه سُلّم تراتبي بين وجود هذا وذاك. فكل وجود مهم. هناك وجود فردي، ووجود مشترك، ووجود سياسي ووجود خاص. إن وجودنا هو مصدر حياتنا التي تشعّ نحو اتجاهات عدة. ومن ذلك المصدر الفريد، كل وجود واحد ومتعدد.
مساءلة الربيع العربي
● سارع العالم بالترحيب بالربيع العربي، الذي عدّ فاتحة عهد جديدة أمام الشعوب العربية لتحقيق الانعتاق والتطور، ثم عُدّل الموقف وصرنا نتحدث عن تونس، التجربة الوحيدة، التي نجحت في تحقيق الانتقال الديمقراطي بطريقة سلمية، غير أن المسار توقف بعد إعلان الحالة الاستثنائية في البلاد (حركة 25 يوليو)؛ هل يمكن اليوم الحكم على ما يسمى بالربيع العربي؟ هل حان الوقت لذلك بعد أن كان جل الباحثين يرون أن الوقت لم يحن بعد لتقويم التجربة؟
■ إن كان هناك من شيء يمكن الإشارة إليه من وجهة نظري في الثورة التونسية، فهو أنها مثلت مرآة انعكست فيها صورة التونسيين. فما كان مخفيًّا ومغيبًا وممنوعًا، وصل إلى الإدراك والتمثل الجماعي. نحن إزاء عملية كشف من دون انقطاع تتم أمام أعيننا، من هذا الكشف انبعثت مرآة هائلة ذات أبعاد متعددة، احتلّت الفضاء العام من كل جهة. ومن خلال هذه المرآة تمكن التونسيون من الانخراط في الحياة السياسية ومن تأسيس تجربتهم الخاصة في هذا المجال، حيث أصبح كل واحد منهم بإمكانه أن يشارك في المشهد السياسي بكل حرية. لقد اكتشفوا بالحجة أن الدين لا يمكن أن يحل المشكلات السياسية والاقتصادية لأي مجموعة بشرية.
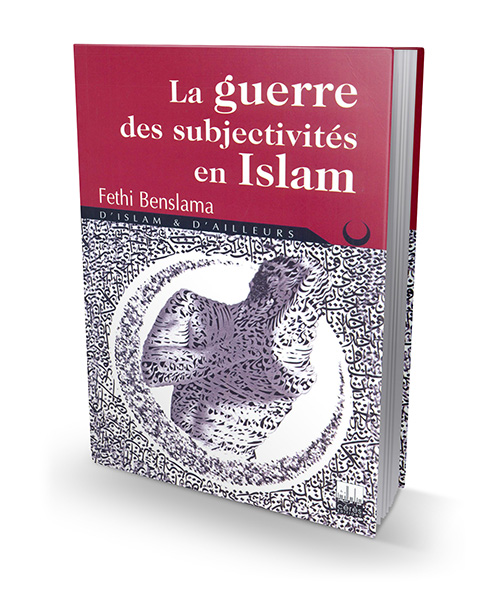 لقد أعلنت الثورة التونسية نهاية وهم الإسلام السياسي. لكن نهاية الوهم لا تكفي. فقد أشار الفيلسوف نيتشه إلى أن رفع الستار عن الواقع صعب التحمل. يلزمنا وقت كافٍ لقبوله ولتأويله تأويلًا صحيحًا. من وجهة نظري، إن الجماهير التي انتفضت في تونس ثم في مصر وفي مناطق أخرى، حركت مسار الحرية الذي ظل معطلًا لمدة نصف قرن من الزمن. وسيتواصل المسار بعد الوقفة الحالية. لقد مكنت هذه الانتفاضات من ظهور إبداع سياسي جديد سيبقى في الساحة لسنوات أخرى وقد مكنت بالخصوص من فتح المجال أمام تكوين تجربة الحرية بالمعنى الحقيقي للكلمة. من هذا المنطلق، نلحظ أنه لم يطل الوقت كثيرًا، حتى أُزِيحَ الستار عن الإسلام السياسي بطريقة واضحة، عن طابعه الوهمي وقد لاقى رفضًا واسعًا في المناطق التي وصل فيها إلى الحكم. إن الانتفاضات يمكن أن تتكرر ويمكن أن تعود بأشكال أخرى ويمكن أن تتخذ شكل إصلاحات يقوم بها حكام أذكياء. فقلب كل شيء ليس دائمًا الحل الوحيد الممكن.
لقد أعلنت الثورة التونسية نهاية وهم الإسلام السياسي. لكن نهاية الوهم لا تكفي. فقد أشار الفيلسوف نيتشه إلى أن رفع الستار عن الواقع صعب التحمل. يلزمنا وقت كافٍ لقبوله ولتأويله تأويلًا صحيحًا. من وجهة نظري، إن الجماهير التي انتفضت في تونس ثم في مصر وفي مناطق أخرى، حركت مسار الحرية الذي ظل معطلًا لمدة نصف قرن من الزمن. وسيتواصل المسار بعد الوقفة الحالية. لقد مكنت هذه الانتفاضات من ظهور إبداع سياسي جديد سيبقى في الساحة لسنوات أخرى وقد مكنت بالخصوص من فتح المجال أمام تكوين تجربة الحرية بالمعنى الحقيقي للكلمة. من هذا المنطلق، نلحظ أنه لم يطل الوقت كثيرًا، حتى أُزِيحَ الستار عن الإسلام السياسي بطريقة واضحة، عن طابعه الوهمي وقد لاقى رفضًا واسعًا في المناطق التي وصل فيها إلى الحكم. إن الانتفاضات يمكن أن تتكرر ويمكن أن تعود بأشكال أخرى ويمكن أن تتخذ شكل إصلاحات يقوم بها حكام أذكياء. فقلب كل شيء ليس دائمًا الحل الوحيد الممكن.
● المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية موجودة في كل المجالات العلمية والمهنية، حتى إنه أصبح لتونس ولأول مرة في تاريخها رئيسة للحكومة، ومع ذلك ما زالت المرأة تعاني العنفَ وما زال مطلب المساواة -حتى في دول ترى أنها قد حررت المرأة- بعيد المنال؛ هل يمكن أن نجزم بأن العلاقة مع المرأة في مجتمعاتنا ستبقى مرضًا أزليًّا تعانيه؟
■ إن تحرر المرأة كما هو الشأن لكل عمليات التحرر لا تتم دفعة واحدة. فهي معركة طويلة الأمد وما يحدث اليوم في الحركة النسوية في الغرب يؤكد ذلك. فقد ظهرت موجة جديدة تقف بالخصوص ضد العنف الذي تعانيه النساء. أما العالم العربي، فإن خروج المرأة من حبسها بالبيت تطور مهم، من دون شك. لكن ما زال ما هو مسجون في اللاوعي، وأقصد تلك المخاوف والمعتقدات الناجمة عن القمع الذي عاشته النساء لقرون، والذي ترك آثارًا عميقة وقوية. علينا القيام بعمل كبير لتجفيف المستنقع النفسي في هذا المجال. لكن هذا العمل لن يتم من دون مشاركة الرجال؛ لأن انعتاق المرأة جزء لا يتجزأ من انعتاقهم الشخصي.
● كيف تصف تجربة التدريس في الجامعات الفرنسية لأستاذ من أصول تونسية، وحامل لشهادات عليا من الجامعات الفرنسية؟
 ■ كانت تجربة جميلة في الحياة والعمل، تمكنت من خلالها من الوصول إلى مناصب عليا في الجامعة عامة، وفي اختصاصي العلمي خاصة. كنت أستاذًا جامعيًّا، وعميدًا لقسم دراسات التحليل النفسي لعشرة أعوام، وهو القسم الجامعي المختص في التحليل النفسي الأكثر أهمية في العالم. إضافة إلى ذلك، بعثت ثلاثة هياكل في الجامعة. أحدثتُ سنة 2011م «معهد الإنسانيات والعلوم»؛ يتعاون فيه باحثون في العلوم الإنسانية وفي علوم الطبيعة. وأحدثتُ سنة 2017م «مركز البحوث حول التطرف وطريقة علاجه» ثم قبل مغادرتي للتقاعد، جمعت ضمن وحدة تعليم وبحث كل من علم التحليل النفسي والعلوم الاجتماعية وتاريخ الفلسفة والعلوم. وكل هذا لم يحل دون مواصلة أبحاثي ونشر ما لا يقل عن 15 كتابًا ترجمتها إلى لغات عدة، وقد تُرجِمَ كثير منها إلى اللغة العربية، إضافة إلى نحو 200 مقال نُشر في مجلات.
■ كانت تجربة جميلة في الحياة والعمل، تمكنت من خلالها من الوصول إلى مناصب عليا في الجامعة عامة، وفي اختصاصي العلمي خاصة. كنت أستاذًا جامعيًّا، وعميدًا لقسم دراسات التحليل النفسي لعشرة أعوام، وهو القسم الجامعي المختص في التحليل النفسي الأكثر أهمية في العالم. إضافة إلى ذلك، بعثت ثلاثة هياكل في الجامعة. أحدثتُ سنة 2011م «معهد الإنسانيات والعلوم»؛ يتعاون فيه باحثون في العلوم الإنسانية وفي علوم الطبيعة. وأحدثتُ سنة 2017م «مركز البحوث حول التطرف وطريقة علاجه» ثم قبل مغادرتي للتقاعد، جمعت ضمن وحدة تعليم وبحث كل من علم التحليل النفسي والعلوم الاجتماعية وتاريخ الفلسفة والعلوم. وكل هذا لم يحل دون مواصلة أبحاثي ونشر ما لا يقل عن 15 كتابًا ترجمتها إلى لغات عدة، وقد تُرجِمَ كثير منها إلى اللغة العربية، إضافة إلى نحو 200 مقال نُشر في مجلات.
هناك عدد من الزملاء العرب حصلوا على فرصة مماثلة للعمل في جامعات أوربية وأميركية. وأقدر كثيرًا زملائي في الجامعات العربية الذين يواجهون صعوبات أكبر في عملهم وأقر بالفضل بالخصوص لمن تولوا ترجمة كتبي، ومن بينهم شقيقتي رجاء بن سلامة الأستاذة الجامعية والمحللة النفسية، وهي حاليًّا المديرة العامة للمكتبة الوطنية التونسية. وقد ترجمتْ كتابي «الإسلام والتحليل النفسي» ترجمة رائعةً. أنا أكتب بالفرنسية ولكن كلما قرأت جملة من كتاباتي تحولت إلى اللغة العربية، التي أمارسها باستمرار، أشعر أني أُولَد من جديد.

