
حوار الأحياء والموتى.. الإنسان العربي والموت
من منظور الفلسفة الأبيقورية، يبقى الموت، شيئًا لا يستحق الاهتمام، ولا ينبغي أن نُعيره أيّ أهمية، فنحن إن كنّا في وضع الحياة، فهو لا يعنينا، كأصحاب حركة ونشاط، وإن كنا في وضع الموت، فهو أيضًا لا يعنينا، لأننا سنكون غير موجودين أصلا. أما بالنسبة لحضارتنا العربية فيبقى الموت شيئًا بالغ الأهمية، ومثار تفاعلات لا تنتهي، حيث يصير للموت والميت مكانٌ هو الأهم، ويصير حيز الفعل، المنسوب للأموات، الأكثر تأثيرًا وفاعلية، وهذا ما تؤكده أعداد الأضرحة المتوزعة على جغرافيا العالم الإسلامي، وما تُرسّخه من جهة أخرى أعداد الزائرين لهذه المراقد وأعداد المرتبطين بها، وكذا عدد كتب المناقب والطبقات المخلدة لسِيَرِ من ماتوا.
الموت مجالًا للمباهاة
في وسط أتقن الاحتفاء بالموتى، والإعلاء من شأنهم، تبقى الكتابة عن المقابر والأضرحة أمرًا عاديًّا جدًّا، بل ضروريًّا، فالموت يبقى تتمة لمسار وليس نهاية سيرة، ولا حظرًا لها، إلى درجة أن جنازة الميت بَقيت مناسبة للمباهاة والتباري بين الميت وبقية زملائه الموتى، أو بينه وبين من تركهم خلفه من أصحاب المذاهب المخالفة، حيث يؤثَر عن الإمام أحمد متوعدًا بعض الطوائف التي كانت حملت له العداء قوله: «بيننا وبينكم يومُ الجنائز»؛ لتكون الجنازة لا، كما قد يُعتقد، إغلاقًا تامًّا لحساب الميت الدنيوي، ولا طيًّا لدفتر حساباته الشخصية، وسدًّا لسجل خصوماته السابقة التي لم تُحلّ بعد مع غرمائه الدنيويين، والتي لم يُقضَ فيها بقول فصل، وإنما هي استمرار لحياته الأولى ومعاركها العنيدة التي لم تُحسم بعد، فـالشخص الميت إما أن يعامل كحثالة أو كرمز، كما يؤكد كونديرا.
 في الأزمنة العربية الوسيطة صار الموت وسيلة إقناع وأداة إثبات للذات، كما هو وسيلة لقهر الآخر وإسكاته نهائيًّا في النزاعات الفكرية، وهنا يورد صاحب نفحات الأُنس قصة دخول فريد الدين العطار طريق الصوفية، فبينما كان في دكّانه، إذ أقبل عليه درويشٌ، وطلب منه «شيئًا لله»، فلم يعطِه، فقال له الدرويش: «كيف ستكون ميتتُك أيها الخواجة؟»، فأجابه فريد الدين: «مثلما تموت أنت». فقال الدرويش: «وهل يمكنك أنْ تموتَ كما أموت؟»، فوضع الدرويش يديه تحت رأسه، ثم فاضت روحه. فأغلق العطار باب دكانه، ونحا نحو أهل الطريقة. ويورد صاحب كتاب المقابر والمشاهد أن أحد موتى كتابه كان يكتب، فوقع القلم من يده، فاستند إلى حائط وقال: «والله إن كان الموت لهذا فهو طيب»، فمات من فوره. بل إن التباري في الموت قد يستمر حتى بعد الموت، فالصراع الخفي الذي كان بين صوفي كبير هو بشر الحافي وفقيه كبير هو أحمد بن حنبل يمتد إلى المقبرة، فعوض أن يبقى اسم بشر بن الحارث الحافي اسمًا للمقبرة التي دُفن بها، يُزاح ويعوض باسم نِدِّه أحمد بن حنبل؛ فور دفن الأخير فيها، يقول علي بن أنجب: «وكان يقال مقبرة بشر الحافي إلى أن توفي أبو عبدالله أحمد ابن حنبل (…) ودفن بها، فنُسبت إليه، واشتهرت به، فهي تُسمى الآن مقبرة أحمد».
في الأزمنة العربية الوسيطة صار الموت وسيلة إقناع وأداة إثبات للذات، كما هو وسيلة لقهر الآخر وإسكاته نهائيًّا في النزاعات الفكرية، وهنا يورد صاحب نفحات الأُنس قصة دخول فريد الدين العطار طريق الصوفية، فبينما كان في دكّانه، إذ أقبل عليه درويشٌ، وطلب منه «شيئًا لله»، فلم يعطِه، فقال له الدرويش: «كيف ستكون ميتتُك أيها الخواجة؟»، فأجابه فريد الدين: «مثلما تموت أنت». فقال الدرويش: «وهل يمكنك أنْ تموتَ كما أموت؟»، فوضع الدرويش يديه تحت رأسه، ثم فاضت روحه. فأغلق العطار باب دكانه، ونحا نحو أهل الطريقة. ويورد صاحب كتاب المقابر والمشاهد أن أحد موتى كتابه كان يكتب، فوقع القلم من يده، فاستند إلى حائط وقال: «والله إن كان الموت لهذا فهو طيب»، فمات من فوره. بل إن التباري في الموت قد يستمر حتى بعد الموت، فالصراع الخفي الذي كان بين صوفي كبير هو بشر الحافي وفقيه كبير هو أحمد بن حنبل يمتد إلى المقبرة، فعوض أن يبقى اسم بشر بن الحارث الحافي اسمًا للمقبرة التي دُفن بها، يُزاح ويعوض باسم نِدِّه أحمد بن حنبل؛ فور دفن الأخير فيها، يقول علي بن أنجب: «وكان يقال مقبرة بشر الحافي إلى أن توفي أبو عبدالله أحمد ابن حنبل (…) ودفن بها، فنُسبت إليه، واشتهرت به، فهي تُسمى الآن مقبرة أحمد».
وقد صار الموت محل نكاية وانتقام من جثة الميت ومن قبره، فالقاضي عياض الذي لم ينس الصوفية خرجاته ضد أبي حامد القاسية والمجحفة، لم يكن باستطاعة المتَصوّف إلا أن يساهم بدوره في الإساءة للقاضي عياض، بتنشيط مخيلته من خلال حبك قصص ستُتَداوَل حتى دونما قرائن ولا تَحَرّ تاريخيّ تسيء للقاضي عياض، فقُطِّع أبو الفضل إربًا، ودُفن في مكان مجهول بمراكش، بلا صلاة ولا غسل، وأُقطِعت منطقة دفنه للنصارى، فبنوا جوار قبره كنيسة، في أقصى مشاهد التمثيل بالمخالف قَسْوَةً. غير أنه بعد مدة طويلة سيتعامى الصوفي عن ذكرى الإساءة، ليعيد له الاعتبار، ويبالغ في تعظيمه بعدما بُولِغ في الإساءة له، حتى إنه لما قَدم أحد مشايخ التصوف المغربي وهو أبو علي اليوسي لزيارة ضريح عياض اعترضه جيران ضريح القاضي، ليُحدّد لهم حَرَم الضريح، فقال لهم اليوسي: «المغْرِب كله حَرمٌ لأبي الفضل».
هكذا إذن، ينتقل الموت بضحاياه إلى أن يصيروا برمزية غير عادية، يقاس على إثرها حُب الناس للميت، وتوهب له كارزمية أخرى تنضاف إلى الهيبة التي قد يكون حازها وهو حيّ، ففي جنازة أبي محمد الهسكوري (ت: 710هـ)؛ ولما خرج الناس بنعشه ازدحم عليه أهل القيروان حتى صار النعش في أكف مشيّعيه، وأحمد الدقاق (ت: 748هـ) ازدحم الناس على قبره، وقطعوا الحصير الذي حمل عليه تبرّكًا به، ليرجع كل رجل بقشة منه، وفي جنازة يوسف بن عمر الأنفاسي، (ت: 761هـ) حُمل وسط النهار من بيته، ولم يبلغ قبره من كثرة الازدحام إلا قرب غروب الشمس. وقد يُنتقل بأمر الجنازة العادية إلى محلّ للقتال، ويصير جثمان الميت محل نِزال بين من يعدون أنفسهم الأحق به، فهذا أبو محمد الهزرجي حينما مات، همّت القبائل التنافس عليه، فكُلُّ قبيلة، تقول: «إنما ندفنه عندنا».
وفي ذات السياق حينما مات غلام الخلال، وكان من أعيان الحنابلة وزهادهم، اختلف أهل بغداد في موضع دفنه، فقال بعضهم: «ندفنه في مقابر الإمام أحمد». وقال الباقون: «بل يُدفن عندنا هنا»، حتى إنهم جرّدوا لأجل حسم الأمر السيوف، وثارت الفتنة. فأمر الإمام بأن يُدفن في موضع مقابل لدار الخلافة، لم يكن قد دُفن فيه أحد، فصار موضع دفنه مقبرة يقصدها الناس طلبًا لمجاورة غلام الخلال. وفي الوقت نفسه قد يحرم مفسر كبير كالطبري من أن يدفن في مقابر المسلمين، الشيء الذي دفع أصحابه لأن يدفنوه في صحن داره برحبة يعقوب ببغداد، مِمَّا لم ينه الناس أن يصلوا على قبره ليلًا ونهارًا شهورًا عدة.
حينما تصير المقابر مدنًا
لم تبق المقابر التي انزوى إليها الموتى في مأمن؛ للارتياح من جلبة العالم ومعاركه المذهبية، حيث صارت الأكثر جلبة والأكثر ضجيجًا، وكما كان للأحياء مدنٌ يسكنونها وأسواق تُروَّج فيها بضائعهم وتُتَداول فيها أموالهم، فقد استحدثت للأموات مدنٌ وأسواق تُنافس مدن من لا يزالون على قيد الحياة، تعجّ هي الأخرى بالمال والبضائع، وهذا ما قد يكون اضطر ماسينيون لأن يسمي أحد أهم مقابر القاهرة مدينة(١)، لِمَا امتازت به من شروط تؤهلها لأن تكون مدينة حقيقية، فمقبرة القرافة التي ألف عنها ماسينيون كتابًا كاملًا، يروي المقريزي أنها كانت لها شُرطة وعَسس ونُظّار، والإقامة فيها كانت مقننة بهدف دفن الموتى، وحراسة الأضرحة، والاهتمام بنظافتها، وبناء المقابر الجديدة، وإقامة طقوس الموت والدفن، ورعاية بعض الفقراء وعابري السبيل والمتصوفة، وبعضهم سماها حديقة(٢)، فهي ليست مكانًا دائمًا للحزن والوحشة، وإنما هي مكان فوق العادة للسياحة والتأمل، بل للكتابة أيضًا(٣)، كما هي مكان جيد للقراءة والمطالعة حيث نجد في كتاب المقابر والمشاهد أكثر من ثلاث مكتبات ضخمة قد وُقِفت على مقابر وأضرحة بغداد، يستفيد منها الزائرون، وعلى كل منها ناظر وحَرس.
وقد تصل العمارة والكِبَر بالمدافن العربية في الزمن الوسيط إلى درجة تحتاج معها إلى دليل وهو ما دفع كُلًّا من موفق الدين أبي الحرم مكي (ت: 615هـ) إلى كتابة مرشد الزوار إلى قبور الأبرار وابن الزيات (ت: 814 هـ) إلى تأليف الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة لتتكاثر أدبيات زيارة المدافن وتتناسل، ليكون الأمر شبيهًا بكتبٍ في الإرشاد السياحي، يُحَدّد فيه يوم الزيارة وساعة الانطلاق وما يجب عمله وما يتوجب تركه. في محاولة لتنظيم طقوس الاحتفاء بالأموات، فصار كل يوم رهينًا بزيارة ضريح أو مقبرة، ففي مصر جُعل يوم الإثنين للسيد الحسين، ويوم الثلاثاء والسبت للسيدة نفيسة، ويوم الخميس والجمعة للقرافة لزيارة الشافعي.
في المقابر والمدافن انتقل الميت شيئًا فشيئًا من «مشغول بنفسه» إلى موضوع للاشتغال، يَشغل الآخرين، ويحظى باهتمامهم؛ ليصير هذا المنتزع من باقَة الباقين على قيد الحياة، موضوع احتفاء وإحياء مستمر، فهو إن كان المـــوت المخبأ الــذي يلجـــأ إليــه الكــائن كما لو يــلجـأ إلــى قلــعة جبــل، كما يؤكد هايدغر، للاختباء عن الآخرين وقطع الصلة معهم، غير أن الأحياء يَحُولُون دون الهناءة التي يرجونها، ويحوِّلون الهدأة إلى جَلبة، فتبدأ الأمور بشكل بسيط عند حدود تلاوة القرآن عند رأس الفقيد، لإيناس وحشته في سفره الجديد، وبعدها إحياء أيام يقضيها الأحياء بجانبه، حتى إنها كانت تستغرق عند قبر بعضهم شهرًا كاملًا؛ لتتحول المقابر شيئا فشيئًا إلى مكان يتجاوز أسواق الأحياء رواجًا وجلبة، وليَقلب الأموات المعادلة.

صار من عادات البغداديين مثلًا، وأعرافهم التي دأبوا عليها عند قبر أحمد بن حنبل إحياء ليلة النصف من شعبان، فكانت توقد عند قبره مئة من الشمع. ويُحصي أحدهم في بعض الليالي أنه قد دخل إلى إحدى مقابر بغداد نيّف وأربعون ألف شمعة، وكانت الجموع الغفيرة من أهل بغداد يقصدون إحدى مقابر المدينة في كل يوم أربعاء بالزيارة والتعظيم، فالميت لم يعد يعتقد أن ليس له من الأمر شيء، بل صارت له يدٌ خفية تُحرك الأمور من وراء أستار، يقول الرحالة الحضيكي مثلًا عن أبي العباس السبتي وضريحه بمقبرة باب تاغزوت: «كان رضي الله عنه يحب المساكين، ويجري عليهم حيًّا وميتًا. ترى الناس رجالًا ونساءً، صغارًا وكبارًا، عاكفين على قبره بلا عدد، ورزقهم يأتيهم من كل ناحية في رخاء وغلاء، والناس في القحط يموتون جوعًا، والضعفاء والأرامل والعُميُ على قبره يأكلون ويشربون من رزق الله تعالى، وذلك بركة الشيخ، والمشاهدة تغني «وليس الخبر كالعيان»»(٤).
إن الميت/ الولي بوصفه حارسًا غيورًا على كل من لاذ به؛ يستحق حقًّا أن يكون قبره آية معمارية تليق بالمهام التي لا يُفلح غيره في إنجازها، من سقوط المطر إلى إطعام الفقير والجائع المقتر، وعند زوايا ضريحه يجد الفرد والجماعة من اليائسين من يواسي الكُلوم، ومن يُنَفِّسُ عن استياءاتهم ويجبر كُسُورهم، فالولي حتى وهو ميت، يقوم بعملية سطو على الوظائف الموكلة بالأحياء، فالولي وأصدقاؤه الآخرون هم من يحكمون وهم من يُصرّفون أمور الناس، يقول الشيخ زروق (ت: 899 هـ): «من لهم التصرف في المغرب بعد وفاتهم، ثلاثة: الشيخ أبو العباس السبتي (ت: 601 هـ)، وعبدالسلام بن مشيش (ت: 625 هـ)، وأبو يعزى (ت: 572 هـ)»(٥)، أي أن الأولياء هم العاصم والمأمن وقت الشدائد وزمن الكوارث، يقول ابن أنجب عن مقبرة باب حرب: «وقد دفن بهذه المقبرة من كبار العلماء، ومشاهير الفضلاء، وأعيان الزهاد والنبلاء، من يُستنزل ببركتهم ممتنع القطر، ويدفع بقصدهم كارث الأمر»(٦).
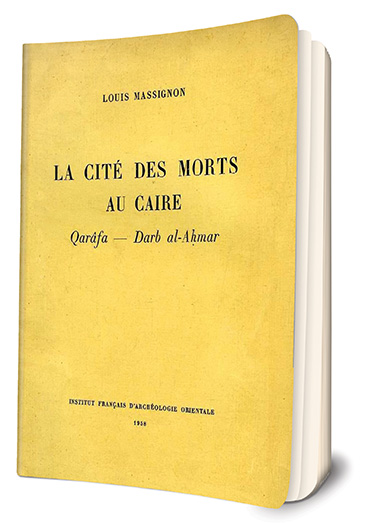 تشييد العمران والإفراط فيه حد البذخ، يصير شيئًا عاديًّا، بل ضروريًّا في الأبنية التي تحوي جثامين الموتى، وبشكل هو الأكثر دهاءً يمسخون فكرة غيابه ليجعلوها حضورًا غير عادي بالمرة، يتغلغل وجوده داخل جماعتهم، وبشكل هو الأكثر مهابة حتى من الأحياء أنفسهم، يُبالغون في تقديره وتوقيره، بجعل بنائه الذي يسكنه آية في التشييد والتزاويق. المقابر كانت عند الإنسان العربي تشبه تمامًا البَانثيون (Panthéon) عند اليونان، أو مدافن عظماء الأمة عند أيّ فرنسي، فالأعلام من أهل العلم والزهد بالكثرة مما لا يمكن حصره في المقبرة الواحدة؛ لهذا يكثر عند أصحاب الطبقات والتراجم في ختام القول عن إحدى المقابر: «وقد دُفن بها خلق كثير من الفقهاء والصالحين والأولياء الزاهدين»، أو القول عن أحد الأضرحة: «وبالقرب منه وحوله قبور جماعة من أئمة الدين، وعلماء المسلمين، والعباد الصالحين» أو قوله: «وقد دفن بها كبار العلماء وأرباب الصلاح والزهادة والمجاهدة والعبادة الجمّ الغفير، والعلم الكثير».
تشييد العمران والإفراط فيه حد البذخ، يصير شيئًا عاديًّا، بل ضروريًّا في الأبنية التي تحوي جثامين الموتى، وبشكل هو الأكثر دهاءً يمسخون فكرة غيابه ليجعلوها حضورًا غير عادي بالمرة، يتغلغل وجوده داخل جماعتهم، وبشكل هو الأكثر مهابة حتى من الأحياء أنفسهم، يُبالغون في تقديره وتوقيره، بجعل بنائه الذي يسكنه آية في التشييد والتزاويق. المقابر كانت عند الإنسان العربي تشبه تمامًا البَانثيون (Panthéon) عند اليونان، أو مدافن عظماء الأمة عند أيّ فرنسي، فالأعلام من أهل العلم والزهد بالكثرة مما لا يمكن حصره في المقبرة الواحدة؛ لهذا يكثر عند أصحاب الطبقات والتراجم في ختام القول عن إحدى المقابر: «وقد دُفن بها خلق كثير من الفقهاء والصالحين والأولياء الزاهدين»، أو القول عن أحد الأضرحة: «وبالقرب منه وحوله قبور جماعة من أئمة الدين، وعلماء المسلمين، والعباد الصالحين» أو قوله: «وقد دفن بها كبار العلماء وأرباب الصلاح والزهادة والمجاهدة والعبادة الجمّ الغفير، والعلم الكثير».
على سبيل الختم
لم يكن الموت حدثًا بسيطًا وعاديًّا، قد يأتي على روح الواحد منا وعلى جسده، ليُختتم به برنامج حياةٍ ومسار عيش، كما هي الولادة، إعلانٌ عن بدايته. إن الموت بقدر ما هو رغبة فيزيقية أو حتى ميتافيزيقية لإجراء الفناء في الجسد البشري، فإنه يتحول لدى القريبين من الميت إلى محاولة مضادة لأجل ترميم هذا الخراب، بخلق نوع من الاتزان الذي أمسى مفتقدًا مع حالة الموت، وتعويض حالة اللاحضور بأفعال يتداخل فيها الجمالي بالعقائدي، ليتحول الموت بما هو نهاية وحدث طبيعي عادي جدًّا إلى بداية وحدث ثقافي غير عادي بالمرة والمطلق، والالتفاف عليه ليتحول من مصدر قلق واضطراب إلى منبع بركة ونِعم لا تنتهي، بل مكمن طَمأنة من الأموات أنفسهم لمن هم على قيد الحياة، والمجد لله الحي الذي لا يفنى ولا يموت.
هوامش:
(١) Louis Massignon, La cité des morts au Caire: Qarâfa, Darb al-Aḥmar, Institut français d’archéologie orientale, 1958.
(٢) سمير أيت أمغار، حديقة الأموات، بحث في تاريخ مقبرة الأشراف السعديين بمراكش، مراكش: منشورات آفاق، 2017م.
(٣) ففي المقبرة ألّف أبو الفرج بن الجوزي كتابه: تقريب الطريق الأبعد في فضل مقبرة أحمد، وفي المقبرة عثر خيري شلبي على المكان الأنسب للكتابة، وهو المقبرة ذاتها.
(٤) محمد بن أحمد الحضيكي، الرحلة الحجازية، ص 67.
(٥) التعارجي، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، ج: 1، ص 308.
(٦) علي بن أنجب، المقابر والمشاهد، ص 48.

