
بواسطة الفيصل | ديسمبر 28, 2023 | مسرح
في أزمنة التحولات التي تعيشها المجتمعات، كل شيء جوهري يتحول بدوره، خصوصًا حين تأتي هذه التحولات بعد رغبات دفينة وأحلام كانت ضربًا من المستحيل. الفنون أيضًا يطولها التحول، وبالتالي فهي تذهب في التعبير عن تحول في التحول، ليس التحول الذي يحدث خارجها، إنما أيضا التحول في بنيتها نفسها ومنطوقها وشكلها ومراميها.
مسرحية «رسوم وطلل: جغرافيا القصيدة»، التي استمر عرضها طوال ثماني ليالٍ على مسرح ميادين بالدرعية، وسط جمهور كثيف، نموذج ساطع لهذا التحول في التحول، للمتحول الذي يمضي في صيرورة منسجمة، مع كل ما يحدث في مجالات متعددة، منفعلًا به وفاعلًا فيه، يلتمس منه شرارة الانطلاق، ثم يندلع في صورة حريق هائل، من التعبيرات المبهرة.
يجمع «رسوم وطلل»، للمسرحي الإشكالي صالح زمانان الذي يتمرد باستمرار على نفسه، بين الفائدة والمتعة، بين الماضي والحاضر، بين الجغرافيا والتاريخ، بين الإنسان والأرض، بين الشعر وثقافته، بين الشاعر ومأزقه الوجودي، بين الكرنفال والاستعراض، بين الغناء والفرجة في منتهى معانيها.

ويترافق مع كل ذلك، وعي شقيّ، هو وعي الشاعر زمانان، بالتاريخ والأرض والإنسان، وما ينبغي أن يكون عليه الحاضر، أو أن ما يبدو أن الحاضر انتهى إليه، ما هو إلا لحظة أصيلة جديرة بتاريخها في كل أطواره السابقة. تقول المسرحية المعلن من الجغرافيا والمضمر أيضًا. يفصح النص، الذي عبر عن مخيلة قادرة على عبور الأزمنة من دون أن تتخلى عن زمانها، عن جسد المكان وروحه، وعن امتداده فينا.
قد تكون فكرة النص بسيطة، مجموعة من الفتيات والشباب، يتتبعون؛ تلبيةً لاحتياجات بحثية طلبها منهم أستاذهم، وفي سياق حكائي متواتر، خريطة الشعر منذ القدم إلى زمن قريب. فهم يترحلون، كل فريق على حدة، إلى أجزاء من الوطن المترامي؛ للعثور على الشعراء الذين وسموا تلك الأمكنة بشيء من سيرهم، وطبعوها بما شهدته حيواتهم من منعطفات مهمة، سواءٌ كانت شعريةً أو موضوعيةً.
بالتأكيد، لم يكن المتفرج إزاء حلقة أخرى، من برنامج «على خطى العرب»، إنما كان أبعدَ من ذلك، أو على الأقل كان في مواجهة مع صورة أخرى تقولُ، بتعبيرية جارفة وبطريقة جديدة، موضوعَها، صانعة من الإبهار البصري والحركي جوهرا أساسيا لها.
هذه الإبهار في الحركة وفي الألوان بتعابيرهما الدقيقة، تفردت بإنجازه فرقة أورنينا وقائدها الفنان ناصر إبراهيم، الفرقة ذائعة الصيت التي اشتهرت بعروضها الضخمة والمبهرة، عربيًا وعالميًا، إضافة إلى مجموعة من الشابات والشبان السعوديين.
صنعت أورنينا نصًا حركيًا عميقًا وخاطفًا للأنفاس. نصًا موازيًا وفي الوقت نفسه معبرًا عن أدق مضمرات النص المكتوب، ومشتبكًا به على نحو فريد.
عكست المسرحية حال التنوع والاختلاف في مناطق السعودية؛ من حيث اللباس والألوان إلى منطوقها الشعري والحضاري. أنجز موسيقا العرض وألحانه بشار زرقان، الموسيقيّ الذي عُرِفَ باشتغالاته الطليعية والمفارقة، وأخرجه صبحي يوسف، المعروف جيدًا في المسرح السعودي.

فكرة مبتكرة
لكن كيف يمكن التعبير عن هذه الفكرة البسيطة، لكن المبتكرة بامتياز والخارجة عن مألوف الأفكار التي لها هذا الطابع؟ للتعبير عن هذه الفكرة احتاج المؤلف، الذي عُرِفَ بنصوصه المفارقة والعصية والمربكة، سواءٌ كانت مسرحية أو شعرية، إلى قوام يمزج بين أشكال وصيغ وتعبيرات؛ كي يعطي الفكرة حقها من التجلي، وينأى بها عن التبسيط والمباشرة، وبالتالي يستطيع المتفرج التقاط الفائدة، من دون أن ينتابه الملل.
ساعة كاملة، ربما تنقص أو تزيد بعض الدقائق، من المعرفة والبهجة والفرجة في أقصى درجاتها. مضى وقت المسرحية، بلا أدنى انتباه لسيولة الزمن، وكأن النص، قد «سرى» بنا، ولعل ذلك ما حدث فعلًا، إلى تلك الجغرافيات المتعددة والمختلفة، إلى تلك الكيانات الشعرية الهائلة، التي عاشت في أزمنة سحيقة، لكنها ما برحت تحضر وستحضر في ذاكرتنا، في خروج على الزمن، في صورته الحاضرة، إلى أزمنة ماضية، إلا أنها ما زالت تؤثث الراهن في كل مناحي الحياة، بصورة أو أخرى.
في المسرحية، التي توجت مبادرة عام الشعر العربي، وشهدت حضورًا وتفاعلًا لم ينقطع لحظة واحدة، سيرى المهتم، وغير المهتم، شعراء وشخصيات ميزوا الجغرافيا والتاريخ بملامحهم؛ مثل: امرئ القيس، طرفة بن العبد، ابن المقرب العيوني، عنترة بن شداد، زهير أبي سلمى، عبد يغوث، حاتم الطائي، وليلى الأخيلية.
سيرى الجمهور كل ذلك في نسيج مركب برهافة من القصائد والموسيقا والرقصات البارعة، الأقرب، في بعض ملامحها إلى فن باليه مبهر، بدقة الحركة ورشاقتها وتعبيرتها العميقة. أداء الفتيان والشبان جمع بين المسعى البحثي والاندهاش من النتائج، كانوا هم السبيل إلى الدهشة والدهشة معًا. كانوا صورة للمتفرج الذي لم يقع بعد على جغرافية الشعراء، فتمسه، لاحقًا، جمرة القصيدة وتشعل الأسئلة في خياله ووجدانه. الشابات والشبان جسدوا الشغف، في أبهى صوره، بالفن وبالشعر والجغرافيا.

رسوم وطلل يقعان في الحب
رسوم قائدة فريق الفتيات (أصايل محمد) وطلل قائد فريق الشبان (محسن بدر) سيعبران في ختام العرض عن ولع أحدهما بالآخر، عن نوع من العاطفة والشعور، الذي لن يفصح عن نفسه في سهولة، وكأنما قد تماهيا تمامًا مع ما عثرا عليه وكشفاه للمتفرج من علاقات محمومة، من غرام يفوق الوصف، بين كُثَيِّر عَزّةَ، وقيس وليلى، وعنترة وعبلة، وسواهم من العُشّاق. وكأنما العرض، في أحد وجوهه دعوة إلى الحب، الذي هو الحياة ومباهجها، في المعنى العميق للكلمة.
ترافق مع المسرحية، التي انطلقت عروضها في المدة (20: 27 ديسمبر 2023م)، معرض تشكيلي، شارك فيه عدد من الرسامين، وضم أعمالًا لهم إضافة إلى بعض المعلقات المكتوبة بخط بديع. كل رسام من هؤلاء حاول استلهام قصيدة أو تجربة أو شطرًا من حياة، تخص شاعرًا أو شاعرة، كان لشعره أو شعرها فعل السحر في الوجدان والذاكرة وفي الجسد أيضًا. كل شاعر، وفقًا إلى رؤيته وثقافته، استطاع تحويل ملمح سيروي لشاعر قديم، إلى «ملون» مثير للأسئلة والإعجاب، بل عمق من رؤيتنا لتلك القصيدة أو من نظرتنا لذلك الشاعر. في المعرض وجدت أعمالًا خلابة، لا تقلّ في حيويتها وفي قوة حضورها عما تحقق لبعض قصائد أولئك الشعراء العظام، من حضور وديمومة.

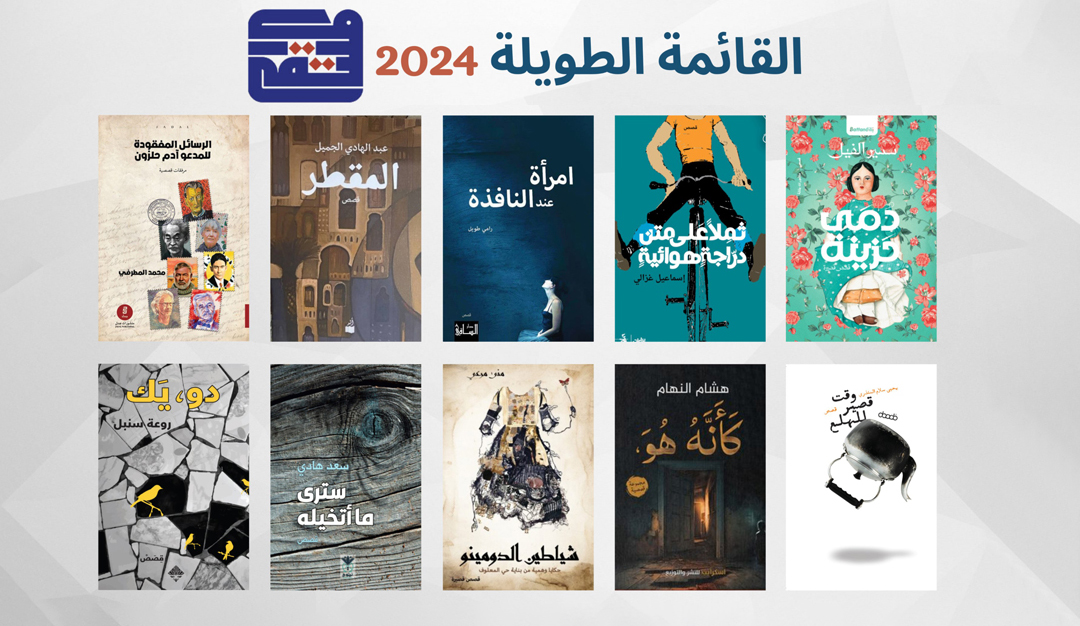
بواسطة الفيصل | نوفمبر 16, 2023 | جوائز
أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأميركية، راعي «جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية»، القائمة الطويلة لدورتها السادسة لعام 2023/2024م. وتقدّم للجائزة في هذه الدورة (198) مجموعة قصصية، من (23) دولة عربية وأجنبية. وكانت إدارة الجائزة قد أعلنت عن لجنة التحكيم المؤلّفة من: الدكتورة شهلا العجيلي – رئيسًا. وعضوية كل من: الدكتور شعيب حليفي، والدكتور فهد حسين، والدكتورة سعداء الدعّاس، والدكتورة ميشيل هارتمان. واتخذت لجنة التحكيم معايير خاصة بها لتحكيم المجاميع القصصية لهذه الدورة، تمثلت في التركيز على العناصر التالية:
أولاً- جدّة وجودة بناء النص، وتدل عليه طريقة السرد التي يتخذها الكاتب، ومدى نجاحه في إقناع المتلقي بها، ومناسبتها لفن القص.
ثانيًا- اتصاف النص بالإبداع، وهو القوة الملهمة الحاضرة في النص.
ثالثًا- فصاحة اللغة، وتعني ابتكار صيغ جمل وتراكيب جديدة، وخلوها من الأخطاء النحوية والإملائية، وصحة بناء الجملة العربية.
رابعًا- جودة المعالجة الفنية، وتعني قدرة الرؤية الفنية للنص على طرح القيمة الإنسانية التي يتغياها النص.
خامسًا- حضور تقنيات القص التي تحدث الأثر في المتلقي، من مثل: المفارقة، وكسر أفق التوقع، وتوظيف الحكاية، والانزياح عن المألوف، ومحاكاة النصوص.
سادسًا- تميز الفضاء النصي بالخصوصية، إما من خلال محليته، وإما من خلال انفتاحه على آفاق ثقافية مغايرة.
 ودارت في الأشهر الماضية اجتماعات، ونقاشات، ومداولات متعددة ومطولة بين أعضاء اللجنة للوصول إلى أهم المجاميع القصصية، التي تستحق بجدارة أن تكون حاضرة في القائمة الطويلة للجائزة، والمكونة من عشر مجاميع، تقدّم مشهدًا إبداعيًّا قصصيًّا عربيًّا دالًّا على أهمية فن القصة القصيرة العربية، ولائقًا بمساعي «جائزة الملتقى» للوصول إلى منجز ثقافي أدبي نوعي، وهي الجائزة الأرفع في مجال القصة القصيرة العربية، وهو ما حدا بكل من جامعة الشرق الأوسط الأميركية، ودولة الكويت لتكون حاضنة لها.
ودارت في الأشهر الماضية اجتماعات، ونقاشات، ومداولات متعددة ومطولة بين أعضاء اللجنة للوصول إلى أهم المجاميع القصصية، التي تستحق بجدارة أن تكون حاضرة في القائمة الطويلة للجائزة، والمكونة من عشر مجاميع، تقدّم مشهدًا إبداعيًّا قصصيًّا عربيًّا دالًّا على أهمية فن القصة القصيرة العربية، ولائقًا بمساعي «جائزة الملتقى» للوصول إلى منجز ثقافي أدبي نوعي، وهي الجائزة الأرفع في مجال القصة القصيرة العربية، وهو ما حدا بكل من جامعة الشرق الأوسط الأميركية، ودولة الكويت لتكون حاضنة لها.
وتزامنًا مع إعلان القائمة الطويلة للجائزة، أشاد الأديب طالب الرفاعي، مؤسس الجائزة، ورئيس مجلس أمنائها، بالدعم السخي الذي تقدمه جامعة (AUM) لدعم الجائزة وتشجيعها، لافتًا إلى النجاحات المتوالية التي حققتها الجائزة؛ إذ بات يُنظر إليها بوصفها الجائزة الأهم للقصة القصيرة العربية، وهي التي تمثل دولة الكويت في «منتدى الجوائز العربية». كما أشاد بالجهد المخلص الذي قامت به لجنة التحكيم لهذه الدورة، متمنيًا لها النجاح، في المضي قدمًا في عملية التحكيم وصولًا لإعلان المجموعة الفائزة.
القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للدورة السادسة
١. «الرسائل المفقودة للمدعو آدم حلزون»: محمد المطرفي. السعودية. منشورات جدل.
٢. «المَقْطَر»: عبدالهادي الجميل. الكويت. دار أثر.
٣. «امرأة عند النافذة»: رامي الطويل. سوريا. دار الساقي.
٤. «ثملًا على متن دراجة هوائية»: إسماعيل الغزالي. المغرب. منشورات المتوسط.
٥. «دمى حزينة»: سمير الفيل. مصر. مؤسسة بتانة الثقافية.
٦. «دو، يَك»: روعة سنبل. سوريا. دار ممدوح عدوان.
٧. «سترى ما أتخيله»: سعد هادي. العراق. دار نينوى.
٨. «شياطين الدومينو»: منى مرعي. لبنان. دار النهضة العربية.
٩. «كأنه هو»: هشام النهام. البحرين. اسكرايب للنشر.
١٠. «وقت قصير للهلع»: يحيى سلام المنذري . عُمان. دار عرب.
وستُعلن الجائزة عن القائمة القصيرة المكونة من خمس مجاميع قصصية بتاريخ 15 ديسمبر 2023م، كما ستجتمع لجنة التحكيم في الكويت في منتصف شهر يناير 2024م لاختيار الفائز، الذي سيحصل على مبلغ (عشرين ألف دولار أميركي ودرع وشهادة الجائزة)، في حين يحصل كل كاتب في القائمة القصيرة على مبلغ (خمسة آلاف دولار أميركي ودرع وشهادة الجائزة). وسيشهد حرم جامعة الشرق الأوسط الأميركية في الكويت احتفالية الجائزة، ونشاطها الثقافي لهذه الدورة، المتمثل في إقامة مؤتمر الجائزة الأول للقصة القصيرة العربية، وذلك بمشاركة كوكبة من كتاب القصة القصيرة العربية، ونقادها، وعدد من الناشرين، والمترجمين العالميين.

بواسطة الفيصل | نوفمبر 1, 2023 | كاريكاتير

بواسطة الفيصل | نوفمبر 1, 2023 | الملف
عبدالله البريدي – كاتب وأكاديمي سعودي
الذكاء الاصطناعي هو البركان الثائر للتقنية الفارة من قمقمها؛ في سياق يرتحل من «الكهنوت» إلى «الشبكوت». هذا البركان الهادر كان خاملًا في فلسفة تخطت منذ قرون «فهم الوجود» بما هو موجود (الفلسفة الإغريقية)، وصولًا إلى «التهام الوجود» (بيكون، ديكارت ومن بعدهما) ضمن «ميتافيزيقا التقنية»؛ إذ لم تعد التقنية مجرد طائرة ورقية ترتفع بهبوب الرياح، ولا طاحونة مائية تدور بجريان المياه، وإنما تقنية تأمر الطبيعةَ لكي تخضع للعقل والقوة (هايدغر). والتهام الوجود ليس بما هو موجود فحسب، بل بما يمكن أن يكون موجودًا، ضمن خيال مرتخٍ إمبريالي؛ وفق الرمز الأولي لـ«لحضارة الغربية الفاوستية» يتجسد في «المكان اللانهائي» (شبينغلر)، عبر القوة اللامحدودة (هوبز، نيتشه)، وهو ما يفسر لنا بوضوح الشهوة العارمة بغزو الفضاء الممتد اللانهائي لاستغلاله وإخضاعه، بعد تطويع كوكب الأرض وامتصاص خيراته.
ويمسي هذا البركان أكثر تدميرًا وعبثية إذا راعينا النقلة المربكة لهذه الفلسفة من الوثوقية التامة (اللوغوس والحد التام) إلى العدمية الصرف (اللامعنى والإيروس)؛ ومن المرجعية المتجاوزة إلى المرجعية الكامنة، ومن الثنائيات الكبرى إلى واحدية منمنمة حلولية (عبدالوهاب المسيري)؛ في مشهد يتغذى على عقيدة نيوليبرالية، تضمن لرأس المال سر نموه، والمتمثل في الحركة اللانهائية (وفق تعريف ماركس لرأس المال)، وضمان تغول السوق والشركات العابرة لكل شيء، ضمن «ميتافيزيقا اليد الخفية» (آدم سميث)، وهو ما أحال العلم المعاصر إلى مجرد «عامل شاي» لدى «السيد: السوق». فالذي يقود العلم ليس الإبستمولوجيا، وإنما التطبيقات الجالبة للأرباح، كالأَمَة التي تَلِدُ رَبَّتَها (يُمنى الخولي)؛ مع شيوع فردانية طاغية تطوِّح بكل شيء سوى سرديات صغرى (ليوتار)، تخلق من الإنسان كائنًا أنانيًّا إيروسيًّا تافهًا ذا بعد واحد (ماركوزه)، لا يعمل بغير العقل الأداتي (هابرماس).
المواقف حيال الذكاء الاصطناعي
هذا التوصيف المكثف يمثل قاعدة ذهنية لتحليل الذكاء الاصطناعي بشكل بِنيوي معمق في هذا النص الصغير، وقد يستغرب بعضٌ من الاتكاء على مثل هذه الأفكار المركبة المعقدة، التي قد تبدو مشتتة أو غير ذات علاقة. والأمر بخلاف ذلك؛ إذ هي في حقيقة الأمر أفكار متوالية متعاضدة، وهي ذات قدرة تفسيرية هائلة لما نعيشه راهنًا من ثورة الذكاء الاصطناعي، ولما سوف يحدث في المستقبل القريب والمتوسط. وبغض النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف حول توصيفي المكثف Thick Description (للمزيد حول سمات هذا التوصيف، انظر كتابي: البحث النماذجي، 2023م)، أشرع في تحليل الذكاء الاصطناعي من جهة تأثيره الضخم غير المسبوق في الجانب العقلي أو الذهني Cognitive.
وقبل الولوج في هذا التحليل، يتوجب علينا تصنيف المواقف حيال الذكاء الاصطناعي في عالمنا المعاصر؛ إذ يمكن وضعها في أربعة مواقف رئيسة، وذلك كما يلي:
الموقف اللامبالي: وهو الموقف الذي لا يكترث إطلاقًا لتحليل الذكاء الاصطناعي بشكل معمق، من جهة إيجابياته وسلبياته، وفرصه وتحدياته، وحاضره ومستقبله؛ إذ يتعامل معه بموجب الأمر الواقع بنزعة سطحية براغماتية، مع تخبط في السياسات والقرارات، ويكون ذلك على مستوى الحكومات والمنظمات والأفراد.
الموقف الخاضع: وهو الموقف المسوِّغ لكل ما يُسمى «التقدم العلمي»، في نزعة براغماتية يغلب عليها طابع «العلموية النزقة»، مع مجافاة أي نقد جوهري للذكاء الاصطناعي، والاكتفاء بذكر إيجابيات عامة على قدر كبير من السطحية، واتهام الناقدين بـفوبيا التقنية ونحو ذلك.
الموقف الرافض: وهو على النقيض من سابقه، فهو يرفض أو يكاد يرفض كل شيء حديث، وفي الغالب يكون ذلك لأسباب أيديولوجية أو لعوامل تمت بِصِلة بفلسفة الحياة الخاصة كالنزعة التقليلية التزهدية التقشفية Minimalism.
الموقف الناقد: وهو أنضج المواقف وأكثرها نجاعة من الناحيتين: العلمية والتطبيقية، المنهجية والحياتية، وداخل هذه المواقف تيارات عديدة، ويتفاوت مستوى النجاعة وفق الأفكار التأسيسية والمِرشاد (البارادايم) والمقاربة المنهجية. وينسلك تحليلنا في هذا النص الصغير ضمن الموقف النقدي.
لقد تناول جملة من الباحثين الرِّصان والكُتّاب الجادين موضوع تأثير التقنية الحديثة في العقل ضمن حقول معرفية ومقاربات منهجية متنوعة، ومن بين أهم الأطروحات العلمية العميقة أطروحة «سوزان غرينفيلد» في كتابها المهم: «تغيُّر العقل- كيف تترك التقنيات الرقمية بصماتها على أدمغتنا» (ترجمة: إيهاب عبدالرحيم علي، عالم المعرفة، ع 445، 2017)، وهي عالمة أعصاب في جامعة أُكسفورد ومتخصصة في العقل والدماغ من زاوية الأعصاب. وكذلك أطروحة زميلها في الجامعة ذاتها «لوتشيانو فلوريدي» بعنوان: «الثورة الرابعة- كيف يعيد الغلاف المعلوماتي تشكيل الواقع الإنساني» (ترجمة: لؤي عبدالمجيد السيد، عالم المعرفة، ع 452، 2017)، متناولًا الموضوع من فلسفة المعلومات وأخلاقياتها. ومنها أيضًا أطروحة أستاذ الفيزياء النظرية الياباني الأميركي بعنوان: «مستقبل العقل- الاجتهاد العلمي لفهم العقل وتطويره وتقويته» (ترجمة: سعد الدين خرفان، عالم المعرفة، ع 447، 2017).

تحليلي النقدي للذكاء الاصطناعي سوف يركز على تأثيراته البِنيوية في العقل، التي يمكن صبها في قالبين كبيرين متواشجين، وذلك كما يلي:
الذكاء الاصطناعي يغتال الذاكرة
إن أخوف ما أخافه على الإنسان المعاصر هو تآكل ذاكرته. ولهذا، أجدني مؤمنًا بأن الحضارة التي ستغلب في المستقبل المتوسط هي تلك التي تحافظ على ذاكرتها، سليمة قوية، بعتادها المادي الفسيولوجي، وعتادها المعنوي الثقافي. الذاكرة الإنسانية هي إحدى المعجزات المبهرة في خلق الإنسان، فإمكانياتها هائلة، وهي جزء من الوعد الإلهي المقدس بتمكين الإنسان من المعرفة وفهم العالَم، ليكون خليفة تعمر العالم بالتوحيد والرحمة والعدالة والخيرية. إن أعظم عقار يمتلكه الإنسان هو ذاكرته، والذاكرة هي العقار الوحيد الذي يسعى المستبدون لامتلاكه! والإشارة إلى الاستبداد هنا تحيلنا إلى المستبد الإنسان والمستبد الآلة، مع وجود نزعة واحدية حلولية لنكون إزاء «المستبد الإنسآلي» أو «المستبد الآلساني».
لقد أحدث كتاب «حضارة السمكة الحمراء» (للفرنسي القدير برونو باتينو، من ترجمة المكين الدكتور مصطفى حجازي، 2021م) دويًّا هائلًا في فرنسا وأوربا وفي العالَم اليقظ أيضًا، حيث يُشبِّه المؤلف ذاكرةَ الإنسان المعاصر بذاكرة السمكة الحمراء المحشورة في الحوض الصغير، حيث لا تدوم ذاكرتها أكثر من 8 ثوانٍ، واستطاعت حواسيب غوغل العملاقة تقدير مدى انتباه «جيل الألفية»، وهم أولئك الذين وُلِدوا والشاشة الملساءُ حولهم، والذين يتمحورون حول الزمان-المكاني لشاشاتهم، حيث قُدِّر انتباه هذا الجيل بنحو 9 ثوانٍ، وبعد هذه الثواني «السمكية»، ينفصل ذهنُه عن موضوع تركيزه، باحثًا عن مُثير جديد (معلومة، خبر، مشهد، إعجاب) وذلك بدءًا من الثانية العاشرة؛ بفارق ثانية واحدة فقط عن هذه السمكة التعيسة!
في الحقيقة، هذا التشبيه موجعٌ جدًّا، حيث يؤكد خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق ما بات يُسمى «اقتصاد الانتباه»؛ إذ يستهدف عمالقةُ الشابكة إبقاء الإنسان مربوطًا بالنت ما أمكن، حيث يحققون المليارات من مجرد بذل الإنسان انتباهه في شوارع شبكات التواصل الاجتماعي وردهات المتاجر الإلكترونية، مشيرًا إلى أن يد الشبكة حَلَّتْ مَحَلّ يد السوق الخفية (باتينو يقصد يد آدم سميث في الليبرالية/ الاقتصاد الكلاسيكي).
ويزداد الوضع مأساوية إذا أخذنا في الحُسبان تزهيد بعض التربويين والمثقفين والمفكرين من الحفظ والتلقين في التعليم، عادِّين الحفظَ والتلقين من عادات العصور المظلمة، وهو ما جعل كثيرًا من الأنظمة التعليمية والتربوية في العالم للأسف الشديد تلغي أو تقلل أنشطة الحفظ والتلقين وتهمشها، فلا يكاد يحفظ الطفل شيئًا يذكر، فعادَ ذلك على الذاكرة السمكية المتهالكة بمزيد إضعاف وإضمار. ولست أدري ما كنه التعليم الذي يخلو من الحفظ والاسترجاع؟ كيف يتعلم الإنسان أي علم من العلوم من دون حفظ أساسياته من البديهيات والمسلمات والمبادئ والنظريات والقوانين والافتراضات ونحو ذلك؟ هذا النمط التربوي المجافي للحفظ يفسر لنا جزئيًّا سر الخيبة التربوية وضعف الحصيلة العلمية والمهارية في العقود الأخيرة وفي العقود التالية أيضًا؛ إذ إنني أتوقع مزيدًا من التدهور في هذه الحصيلة، ما لم يحدث تصحيح بقالب إستراتيجي مؤسسي.
والألم يزداد بإضمار ملكة الحفظ والتلقين في عالمنا العربي الإسلامي، الذي كان يعد الحفظ والتلقين أحد أكبر مفاخره وإيجابياته نقاط قوته. وفي هذا يقول العلامة جورج مقدسي: «لعب الحفظ دورًا حاسمًا في عملية التعلم… لقد كان الحفظ سمة عامة أهل العلم»، مع القدرة على الانتقال من الرواية (الحفظ) إلى الدراية (الفهم)، موردًا قصة العبقري أبي العلاء المعري، حيث فقد أحدهم أوراقًا في كتاب لم يتبين عنوانه ولا مؤلفه لتمزق ظهرية الكتاب، فاقترح عليه صديقٌ أن يقرأ شيئًا من الكتاب على المعري، ففعل، فأوقفه المعري وشرع في إكمال الأجزاء الناقصة، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب هو: «ديوان الأدب» لإسحاق بن إبراهيم الفارابي. (انظر: نشأة الإنسانيات، ترجمة المكين القدير أحمد العدوي، ص 413-415)، فهل يطيق أحدٌ الزعم بأن الحفظ جعل من المعري متعلمًا ساذجًا سطحيًّا كما يزعم مناهضو الحفظ والتلقين؟!
لو كنتُ مسؤولًا في التعليم، وطُلب مني قرار واحد، لما كان سوى تعزيز الحفظ وفرضه على جميع الطلبة في كل المراحل: من التمهيدي حتى الدكتوراه. وهذا يتناغم مع فكرتي ونبوءتي السابقة: الحضارة التي ستغلب في المستقبل المتوسط هي تلك التي تحافظ على ذاكرتها، سليمة قوية، بعتادها المادي الفسيولوجي وعتادها المعنوي الثقافي!
الذكاء الاصطناعي ينحر الدهشة
العقل يغفو بالمألوف، ولا شيء يوقظه سوى دهشة نشِطة. يَضمُر العقلُ بالرتابة اليومية وفقدان الاندهاش حيال الخارق أو اللافت. يموت العقل إذا شَعَرَ بالتخمة المعرفية، وموته إيذان بحياة الذاكرة. الدهشة رعشة حيرة، وومضة إعجاب؛ إذ يصاب العقل فجأة بارتباك وتعجب من جراء إبداعية الفكرة أو العمل الذي أمامه، ليبادر العقل بالتساؤل: كيف تم ذلك؟ وإن كان أكثر حيوية ونشاطًا لربما أضاف: لماذا لم يخطر مثلُ هذا على بالي من قبلُ؟ الدهشة تدل على أن العقل لا يزال على قيد التفكير والفعل المؤشرين على حياة العقل والروح. والأهمية السابقة للدهشة، هي ما أقنعتْ عددًا كبيرًا من الفلاسفة بالتعبير عن مكانة الاندهاش في الحقل الفلسفي، تنظيرًا وتطبيقًا. ومن ذلك ما يقرره أفلاطون بقوله: «إن انفعال الاندهاش الذي يخالجك هو السمة الحقيقية للفيلسوف»، ويؤيد مثل ذلك أرسطو مشددًا على أن الاندهاش هو ما دفع المفكرين الأوائل إلى فعل التفلسف، والدهشة ممزوجة بالاعتراف بالجهل، وقريب منه هايدغر بالقول: إن الاندهاش يحمل الفلسفة من أولها إلى آخرها ويديرها. مشددًا على أن الدهشة هي انفعال مستديم يصطبغ بالمعاناة والتحمل والصبر والتكبد والسحر والاستسلام لنداء الإبداع.
ويلتقط ياسبرز ملمحًا مهمًّا، بقوله: «إن الاندهاش يدفع الإنسان إلى المعرفة، فحين أندهشُ فمعنى هذا أنني أشعر بجهلي». لقد أشعلتِ الدهشةُ الفلاسفة الأوائل حينما تساءلوا عن أصل الأشياء، ومن بينهم طاليس القائل: إن الأصل هو الماء، وتبعه في ذلك المبحث أنكسيمانس وأنكسيمندار وغيرهما كما هو معروف في تاريخ الفلسفة. وهذه المسألة ذاتها هي التي أغرتْ أستاذة الفلسفة في جامعة جنيف ورئيسة قسم الفلسفة في اليونسكو جان هِرش بأن تعنون كتابها حول تاريخ الفلسفة الغربية بـ«الدهشة الفلسفية» (انظر كتابي: «كينونة ناقصة»، ط2، 2023م، ص 147-148).
الذكاء الاصطناعي في تياره الرئيس يؤثر بشكل ضخم في الدهشة، بل قد يعمد إلى نحرها ودفنها في مقابر الإجابات الجاهزة التي تتقافز بسرعة ورشاقة من الجهاز الذكي عبر تقنية شات جي بي تي- المندرجة ضمن ما بات يسمى «الذكاء الاصطناعي التوليدي»- فما على الإنسان إلا أن يوجه سؤالًا لتطبيق شات جي بي تي، ليجد إجابة حاضرة جاهزة، مع إمكانية طلب إجابة أكثر تحديدًا ودقة، وبخاصة مع التطور المتلاحق لهذه التقنية؛ إذ هي تتطور على مدار اللحظة؛ عبر إدخال مليارات المحددات/ المغذيات للتقنية التوليدية (Parameters)، التي تسعى جاهدة لمحاكاة تفكير الإنسان والتفوق على ذاكرته «المحدودة» وعقله «الاختزالي».

والكارثة لا تقف عند تخوم إقبار ملكة البحث عن إجابة لدى الإنسان المعاصر ذي الذاكرة السمكية، بل تتجاوز ذلك، لتصل إلى اغتيال ملكة التسآل نفسها، حيث تتيح هذه التقنية خاصية لبلورة الأسئلة في كل مجال، كأن يتساءل الطالب أو الأستاذ أو الباحث أو المستشار مثلًا: ما الأسئلة المنهجية التي يجب بلورتها من أجل تصميم بناء هندسي محكم؟! الآلة باتت هي التي تسأل وتجيب بجدية، ونحن نشاهد ونلعب ببلاهة، ضمن سلوكيات إدمانية للمشاهد والتطبيقات المعززة بخوارزميات الإعجاب والدوبامين في سياقات اقتصاد الانتباه. وكل هذا وأمثاله، يعني انطفاء الدهشة تمامًا؛ إذ لا يعمل الإنسان تفكيره وتأمله، بل يلجأ إلى الآلة لكي تجيب، بل لكي تسأل أيضًا.
لقد أعلنتْ شركةٌ منتجةٌ لـتقنية شات جي بي تي أنها بصدد التعاون والتحالف مع شركة ميكروسوفت، وهو ما يعني أن هذه التقنية من الذكاء الاصطناعي سيجري دمجها في الحواسيب الشخصية والبرامج المعروفة، حيث ستكون متاحة مثل القواميس المدمجة في برنامج الوورد، وهذا مجرد مثال للمشهد، مما يعني اكتساحًا تامًّا لهذه التقنية وأمثالها، وتعطيلًا قد يكون تامًّا هو الآخر للذاكرة والتفكير، وسينعكس هذا الأمر بصورة سيئة جدًّا في كثير من الأنظمة التعليمية التي تصدر من الموقف اللامبالي أو الخاضع؛ إذ سيجد المعلم صعوبة بالغة في تمييز إذا كان هذا الحل أو تلك الإجابة هي من صنع جي بي تي أو من إنتاج ذاكرة الطالب وعقله؟ هذا إذا كان المعلم أصلًا يهتم أو يكترث لهذه المسألة؛ إذ قد يكون منتسبًا لـقبيلة اللامبالين، وقد يكون هو الآخر يعبث بجهازه الذكي، وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي يعبث بذاكرته وتفكيره هو الآخر!
وكما يعلم بعضكم، فعملية إدماج الذكاء الاصطناعي لا تتم بين منتجات الشركات التقنية ذاتها فقط (كالإدماج السابق مع منتجات ميكروسوفت)، حيث يتجاوز ذلك إلى الإدماج مع الإنسان نفسه في عقله وجسده عبر زرع الشرائح الرقمية، بحجج قد يبدو بعضها مقبولًا أو مفيدًا في إطار جزئي مشروط (أشدد على إطار جزئي مشروط). ومن الخلفيات المهمة ذات البعد الفلسفي المعقد في توظيف الذكاء الاصطناعي بعد إدماجه في جسد الإنسان وعقله، فكرة «ما بعد الإنسانية» أو «ما فوق الإنسانية» Posthumanism أو Transhumanism (أو الإنسان الفائق أو أي تعبيرات مشابهة)، وهي ذات خلفية تطورية داروينية صرفة.. حيث يؤمنون بأن الإنسان الراهن (الذي هو نحن الآن) لا يستحق البقاء؛ لأنه ما زال يمرض ويبكي ويشيخ، بل يموت أيضًا!
وفي مثل هذه السياقات المعقدة، إن من جهة التربح المادي أو من جهة التغيير لبِنية الإنسان وجوهره لأهداف متعددة صريحة أو ضمنية، تُطرح تطبيقاتٌ عديدةٌ للذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة بأجيالها الثورية المتعاقبة، ومن بينها: شات جي بي تي؛ إذ هي مجرد تطبيق ضمن تطبيقات، يتوالى صدورها تباعًا، بما لا نطيق مجرد متابعته، وسيكون لها آثارٌ مدمرةٌ جدًّا على بِنية العقل الإنساني والتفكير والاستنتاج والذاكرة وكل العمليات الذهنية.. فضلًا عن الجوانب الإنسانية الأخرى التي لا يمكن الحديث عنها في نص صغير كهذا، وهو ما ينذر بمخاطر تتهدد المنظومة التعليمية في العالَم وأسس التفكير والعمل والإنتاج أيضًا. ولمثل هذه السلبيات الكبرى، اتخذت جامعة ستانفورد (وهي التي احتضنت ولادة الرقمي والمنصات والمجتمع الشبكي) قرارًا بعدم إدخال المحمول في المحاضرات، وهي بصدد فرض غياب الحواسيب بشكل متصاعد داخل حرمها الجامعي!
في كتابه القيم، يشير باتينو إلى مسألة شديدة الخطورة، حيث يقول، بعد حديث عن تعلُّم الآلة والخوارزميات التي تتعلم من تلقاء ذاتها: «إن أنصار ما فوق الإنسانية يعلنونها قائلين: سوف يأتي وقتٌ تصبح فيه الحواسيبُ فائقةُ القوة والموصولةُ فيما بينها بشبكة متفوقةً على الإنسانية، وتتولى بالتالي تنظيم حضارة جديدة، قائمة على ذكاء الآلات. يطلق كرزفايل على هذه اللحظة تسمية «الفرادة»، ويعلن عن قدومها في العام 2045» (ص 179). راي كرزفايل هذا هو مرشدٌ «روحيٌّ» في كنيسة الوحدة الكونية (البعد الروحي!)، وهو في العقد السابع من عمره، وقد ابتكر حاسوبًا وهو في الثانية عشرة من عمره، ويقود جامعة الفرادة Singularity University في غوغل، حيث يستخدمها مركزًا لأحلامه في خلق عالَمٍ جديد، عبر «أبحاث ما فوق الإنسانية»، التي تربط حقول الذكاء الاصطناعي بالنانو وعلم الأحياء والعلوم العصبية والذهنية، والمعروفة باختصار: NBIC.
هذا، ومن المتحتم عليّ قبل إغلاق هذا النص أن أؤكد أنني أعقل تمام التعقل أن ثمة استخدامات مفيدة للذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة كالبحث والاستكشاف والطب والزراعة ونحو ذلك، وأنني لست ضد هذه الاستخدامات المفيدة؛ شريطة أن تكون ضمن سياق غائي أخلاقي نقدي تركيبي إطاري شامل. كما أنه يتوجب عليَّ أيضًا التشديد على أنني لا أقرّ البتة بأن ما يحدث هو «تقدم العلم» ويجب من ثمَّ قبوله والتسليم به، وإنما هو «تقدم تطبيقات العلم»، وشتان بين العلم وتطبيقاته؛ فالأول يسوسه تعقلٌ إبستمولوجيٌّ بثوابته الدينية والأخلاقية والمنهجية والمعرفية، والثاني يغويه جشعٌ سوقيٌّ، بأنانيته وجشعه وماديته وتوحشه وعبثيته. هذا والله ولي التوفيق، وهو أعلم وأحكم.
المشروع والبرنامج: مشكلة الروبو

علي حرب – كاتب لبناني
امتداد اليد
شكلت الأدوات لدى الإنسان امتدادًا لليد، يستخدمها في سد حاجاته وفي تذليل العوائق التي تعترضه في معترك الحياة. هذا ما تشهد به الاختراعات في غير مجال، من القوس إلى السيف، ومن البندقية إلى الصاروخ، ومن عربة الخيل إلى القطار البخاري، ومن المحراث الخشبي إلى الجرار الآلي، ومن السيارة إلى الطائرة، ومن الهاتف إلى التلفاز. وكلها مثالات تبين كيف أسهم تطور الأدوات والتقنيات، في مسيرة التقدم الحضاري للبشرية، بتطورها من الأبسط والأبطأ والأقل فاعلية أو خطرًا، نحو الأعقد والأسرع والأكثر فاعلية وخطرًا. ومع الثورة الرقمية بموجاتها المتلاحقة وتقنياتها الفائقة، من حيث سرعتها وفاعليتها، دخلت البشرية في طور جديد؛ إذ فُتحت معها إمكانات هائلة للنشر والبث، للإحصاء والمعرفة، للنقل والتواصل…
تحدي العقل
هذا ما حصل مع اختراع الحاسوب؛ إذ هو لم يعد مجرد أداة تعد امتدادًا لليد، بل أصبح تحديًا للعقل البشري. من هنا أثيرت الأسئلة واشتعلت الجدالات حول قدراته ومفاعيله: هل نحن إزاء أداة تتسع معها إمكانات الإنسان وتتضاعف، أم إننا إزاء جهاز قد يحل محل الإنسان ويصبح بديلًا عنه، أو يتجاوزه ليفلت من سيطرته؟ وكانت المباراة بين الحاسوب وبين كاربوف، أشهر لاعبي الشطرنج يومئذ، فاتحة عصر جديد؛ لأن الآلة الصماء قد تغلّبت على الذكاء البشري.
وأذكر في هذا الخصوص أن أحد أساتذة الفلسفة، في الولايات المتحدة، افتتح سنته الدراسية بالكلام على فلسفة أفلاطون، ولكنّ طالبًا جابهه بالقول: ماذا تجدينا العودة إلى القدامى؟ لنتحدث عن الحاسوب وأثره في حياتنا ومستقبلنا. وكان اعتراض الطالب في محله، ما دام الحاسوب قد أربك عقول البشر، وبالأخص الفلاسفة الذين ينظر إليهم الناس بوصفهم أصحاب العقول النيّرة والباسقة.
الشبكات العنكبوتية
ثم أتت الموجة الثانية، كما جسّدها اختراع الشبكات العنكبوتية بصفحاتها ومنصاتها، بمواقعها وتغريداتها. معها أيضًا فتحت إمكانات هائلة في مجال البث والنقل للمعلومات والرموز والصور. لقد أصبح بإمكان العامل على الشبكة أن يتصل ساعة يشاء، بمن يشاء، في أي مكان من العالم؛ كما أصبح بإمكان عدد من الأشخاص أن يشاركوا في ندوة افتراضية، مع بقاء كل واحد منهم في بلده.
وهكذا شكل اختراع الشبكات نقلة تقنية تغيرت معها علاقتنا بالواقع، الذي تمت مضاعفته وأعيد تشكيله كواقع افتراضي، سيبراني. إنها ثورة لا سابق لها جرت مع الإنتاج الإلكتروني الناعم، من العلامات والرموز والصور والأساليب، التي يجري بثها على الأثير، بسرعة البرق والضوء في مختلف أرجاء الكرة. بذلك تحولت الشبكات إلى خزان للمعلومات. نحن إزاء مكتبة كونية نجد فيها كل كتب العالم مسجلة على رقائق إلكترونية هي بحجم الإصبع بل الدبوس.
حديث الآلة
مع روبو المحادثة نشهد موجة تقنية ثالثة من موجات الذكاء الاصطناعي. صحيح أن الروبو يستند في بياناته ومعطياته إلى خزائن الشبكات. ولكنه يتعداها. لم يعد الأمر مقتصرًا على محركات البحث ومواقع التواصل. نحن إزاء جهاز له ميزتان: الأولى أننا نتحدث إليه، فنسأله وهو يقدم الإجابة. من هنا سمي روبو المحادثة. أما الميزة الثانية، فهي قدرته على تركيب ما أمكنه من النصوص والصور والأصوات أو الفيديوهات والشيفرات والسيناريوهات. من هنا سُمّي الروبو الجديد الذكاء الاصطناعي التوليدي. إذًا نحن إزاء آلة يمكن وصفها، بفضل هاتين الميزتين، بأنها آلة تتعلم أقله كما يتعلم الطفل، أي ليست صماء بَكْماء.
وهكذا صار بإمكان العامل على الشبكات أن يستشير مَكِنَتَهُ الذكية، للبحث عن حلول وأجوبة أو عن توقعات في مختلف الميادين والمجالات. بوسع هذه الآلة أن تكتب قصيدة، أو أن تقدم مرافعة في قضية قانونية، أو أن تعطي نصائح لأصحاب البنوك ليحسنوا التعامل مع زبائنهم، أو أن تزود الطالب بشرح وافٍ عن كيفية تكوّن البراكين. وقد سألها أحد الأساتذة الجامعيين عن الخطة التي يجب اعتمادها في دروسه. فقدمت له إجابة مقنعة كادت تغنيه عن البحث والتخطيط.
الروبو والفيلسوف
وسأبقى في المجال الفلسفي حيث المحك والرهان. فقد جرت مباراة في فرنسا بين الذكاء الاصطناعي وبين الفيلسوف ميشال أنتهوفن، وكان السؤال حول ماهية السعادة، وهي المسألة نفسها التي طرحت في فرنسا، في امتحانات الثانوية العامة، في شهر يونيو/حزيران الفائت 2023م. وقد أجاب الروبو عن السؤال في دقائق معدودة، بتقديم معالجة وافية تنطوي على الاستشهاد بآراء كبار الفلاسفة كأرسطو وكانط. أما الفيلسوف فقد احتاج إلى ساعة وربع الساعة لإنجاز إجابته. ولما نظرت اللجنة الفاحصة في الإجابتين وجدت فارقًا كبيرًا بينهما؛ إذ الفيلسوف تغلب على الذكاء الاصطناعي وسبقه بأشواط.
ولا غرابة. فالمعالجة الفلسفية لا تحتاج فقط إلى المعلومات والمعارف، حول هذه الفلسفة أو تلك القضية، أي ما يملك منه روبو المحادثة ما لا يملكه الفيلسوف، وهذه أصلًا أفضليته كخزان للمعلومات لا ينضب (Big Data).

ازدواجية الإنسان
إن المعالجة الفلسفية تحتاج إلى قدر من التفكير بما هو نظر وتأمل أو تفكر وتبصر أو فهم وتدبّر، وذلك يقتضي ارتداد المرء على ذاته، على سبيل المراجعة والمحاسبة أو الدرس والفحص أو التحليل والتشريح، بتقليب وجهات النظر والمفاضلة بين الاحتمالات.
وتلك هي ميزة الإنسان وحيلته كذات مفكرة: ازدواجيته كما تجسدها المسافة النقدية بينه وبين نفسه. ولهذا فنحن عندما نسأل الروبو عن اعتراضاته على هذا الفيلسوف أو ذاك، فإنه ينقل اعتراضات سواه، أي مما يختزنه من معلومات، ولكنه لا يضيف شيئًا من عنده. فهو لا يفكر؛ لأن ما ينقصه هو الوعي والإرادة أو القصد والنية أو المرونة والحيوية.
وقد طرح على أحد الروبوتات السؤال التالي: إذا كانت المرأة تحتاج إلى تسعة أشهر لكي تضع ولدًا، فكم تحتاج تسع نساء؟ كانت الإجابة سخيفة ومضحكة؛ إذ أجاب بأنها تحتاج إلى شهر واحد، وهو ما يعني أن للروبو أخطاءَه وسقطاته، إذا طرحت عليه أسئلة تخرج عما هو مُبرمَج بصورة مسبقة.
من هنا تمييزي بين مصطلحين:
المشروع وهو ميزة الإنسان، بما هو سبق دائم على الذات، يتيح لنا أن نعيد النظر فيما كنا نفكر فيه أو ننفك عما اعتدنا عليه من الطرق والأساليب، بحيث نخترع ونبتكر لكي نتغير ونتجدد، بكسر القوالب الجامدة وتفكيك الأنساق المغلقة.
مقابل ذلك هناك البرنامج وهو ميزة الروبو الذي باستطاعته أن ينفذ، بما يملكه من المعطيات، عملية معقدة قوامها سلسلة إجراءات وصولًا إلى الهدف المطلوب أو إلى حل المشكلة العالقة.
هذا ما يفعله الروبو بأقصى سرعة. ولكن مشكلته تكمن بالذات في سرعته الفائقة التي تتم على حساب التروي والتأني وإنعام النظر في اتخاذ الخيارات ورسم الخطوات. وهكذا فالفارق كبير بين شيء هو أسير مسبقاته ومعطياته، وبين كائن يأتي دومًا بما هو غير مسبوق ولا منتظر، لكي يجدد عدة التفكير.
الذكاء والعقل
أخلص من ذلك إلى ما يثيره الذكاء الاصطناعي التوليدي، من سجالات، على مستوى العالم، حول قدراته ومنافعه أو حول مضاره وخطره. أنا لا أعتبر الذكاء الاصطناعي التوليدي أهم ثورة تقنية في القرن الحادي والعشرين، الأحرى القول هو قفزة في مجال التقنية الرقمية والصناعة الافتراضية. ثم من يستطيع التنبؤ بما سوف يحدث على امتداد قرن من الزمان، إلا على سبيل التشبيح والرجم في الغيب؟! فاستقراء التجارب يحملنا على التواضع؛ لأنه يكشف لنا ما لا ينفك يحدث ويتحول في هذا العالم، إنما يفاجئ الإنسان دومًا بما هو غير متوقع. والأصل في ذلك أن عملًا ينطوي على الخلق والاختراع، إنما يأتي من مكان غير متوقع، بقدر ما يفتح آفاقًا للفكر والعمل لم تكن في الحسبان.
ولكني لا أقلل من أهمية الذكاء الاصطناعي. أنا مع تشومسكي بأن الآلة لا تفكر. ولكني لست معه، ومع زميليه، بحديثهما عن «الوعود الزائفة» للذكاء الاصطناعي (راجع جريدة الشرق الأوسط 23/3/2023). لا شك أن الذكاء الاصطناعي يمثل تطورًا غير مسبوق، قياسًا على الحواسيب والشبكات، بما يفتحه من الإمكانات؛ أولًا من حيث اختصار الوقت، ثم من حيث فاعليته القصوى في الحصول
على المعلومات.
هل القدرة على التوليد أو على التوقع تجعلنا نقول: إن الروبو قد يطور هذه الميزة، لكي يقترب من الإنسان ككائن يعي ويشعر ويفكر؟ لا أعتقد. فالروبو يبقى مجرد آلة مبرمجة. هي ذكية من حيث قدرتها على التخطيط لحل مشكلة ما. وقد تتفوق في هذا الخصوص، على الإنسان؛ لأنها لا تخطئ إذا أُحسِنت برمجتها، ولكونها تفتقر ذاتيًّا إلى المشاعر والعواطف. هذا، بينما الإنسان يخطئ لأنه ذات راغبة، أي له مشاعره وأهواؤه وأوهامه. ولكنه بسبب حيويته وازدواجيته، قادر على إعادة النظر لاستخلاص الدروس على سبيل إعادة التركيب والبناء أو التجديد والتطوير.
وهكذا، فالروبو لا مشاعر عنده. هو ذكي بقدر ما نحسن برمجته وقولبته. إنه كائن حسابي، إحصائي، أكثر مما هو كائن عاقل، سَوِيّ، يملك القدرة على التروي والتبصر. ولهذا فقد ينتج أفدح الضرر، إذا ما بُرمِجَ خطأ، أو إذا استخدمته مجموعات راديكالية إرهابية، أو عنصرية فاشية.
التلصص والتلاعب
لا شك أن للأدوات مساوئها ومضارها. فهي ككل شيء يخترعه الإنسان، سواء أكان فكرة أم أداة، يمكن استخدامه على الوجه السلبي أو على الوجه الإيجابي. هذا شأن المركبات والطائرات. إنها تستخدم لتذليل المسافات وتقليص الأزمنة. ولكن قد تستخدم كآلات حربية لإطلاق المدافع والصواريخ ودك البيوت على رؤوس أصحابها.
وهذا شأن روبوتات المحادثة، إنها تتيح لنا الحصول على ما نحتاجه من المعلومات والمعارف أو من الأجوبة والحلول بسرعة البرق. ولكنها يمكن أن تشكل أداة تمويه أو تضليل، عبر التلاعب بالصور والأصوات، أو بمراقبة الناس والتجسس على حياتهم الشخصية من حيث هم غافلون، كما يمكن أن تنضم القدرات التي تملكها الروبوتات الفائقة إلى ما تفتقت عنه علوم الأعصاب والجينات من القدرات العجيبة، لإحداث تغيير في طبيعة الإنسان وهويته يطول وعيه وفكره، كما يطول جسده ودماغه؛ لإنتاج كائن جديد، متحول وعابر للإنسان الذي نعرفه، وتلك مغامرة نحو المجهول، غير مضمونة العواقب.
الشبكة والكتاب
هل الذكاء الاصطناعي ينتج البطالة، بقدر ما بات يحل محل الإنسان في كثير من الأعمال والوظائف؟ أنا لست خبيرًا في هذا المجال. ولكن ما يفيدنا به تاريخ الثورات التقنية، هو أنه مع كل اختراع جديد تتراجع وظائف أو تزول، لكي تنشأ وظائف جديدة أو تزدهر.
ما أتوقف عنده في هذا المجال، هو أنه مع الثورة الرقمية، بحواسيبها وشبكاتها ومنصاتها وروبوتاتها، تكاد تتراجع لدى الأجيال الجديدة، ليس فقط الكتب الورقية، بل تتراجع أيضًا القراءة، الشفهية، بصوت عالٍ، كما جسدتها مادة «المحفوظات» في البرامج المدرسية لدى الأجيال السابقة؛ إذ كان يطلب من التلامذة حفظ القصائد والنصوص، شعرًا أو نثرًا لمشهوري الشعراء والأدباء.
وأنا أذكر، وكنت فتى دون العاشرة، أن أقرباءنا الآتين من الولايات المتحدة قد شاؤوا زيارتنا، فاستدعاني والدي؛ لكي أقرأ أمامهم بعض القصائد التي حفظتها، غيبًا، فابتدأت بلامية ابن الوردي:
لا تقل أصلي وفصلي*** إنما أصل الفتى ما قد حصل
وقد قرأت مؤخرًا أن بعض نجوم الثورة الرقمية منعوا أولادهم من قضاء معظم وقتهم ملتصقين بالشاشات والمنصات، بحيث يخصصون وقتًا لقراءة الكتب الورقية. والفارق كبير بين قراءة الواحد نصًّا على الشاشة، وبين قراءته في كتاب ورقي، فضلًا عن حفظه. فالقراءة الإلكترونية، بصمت، مآلها برمجة العقل وقولبة الفكر وطحن القارئ. ولذا فهي تضعف الذاكرة وتشل الطاقة على التفكير النقدي. أما القراءة على الكتاب الورقي، فإنها تتيح للواحد فيما هو يَقْلِب الصفحات، أن يتوقف لكي يقلّب أفكاره ويراجع حساباته. بهذا المعنى فالروبو يجعلنا أذكى، ولكن أقل حكمة وروية. فلا تتباهينّ بالسرعة والسيولة. فمآل ذلك هو أن تستهلك الأفكار والمشروعات قبل أن تؤتي ثمارها.

الفكرة والأداة
قد يكون للذكاء الاصطناعي مفاعيله السلبية، كما هي حال اختراعات الإنسان وصنائعه. ولكن ضرره لن يكون أفدح من الضرر الذي يحدثه استخدام أسلحة الدمار الشامل. ونحن نعلم أن عصر التنوير الأوربي لم يمنع استمرار الحروب الطاحنة في أورُبا، طوال قرون، انتهاء بالحربين العالميتين المدمرتين.
وإذا كانت أوربا عادت إلى رشدها، مع مجيء الأنظمة الديمقراطية، فإن ذلك لم يتحقق بسبب فلاسفة الأنوار، ولا لأنهم عملوا بكتاب الفيلسوف كانط حول السلام الدائم. لقد توقفت الحروب؛ بسبب الدمار المتبادل الذي دفع الأوربيين إلى التفكير بعقل تداولي تجسد في قيام الاتحاد الأوربي.
ولكن، ها هي الحروب تعود إلى أوربا من جديد، على أرض أوكرانيا، بين المعسكرين الروسي والغربي. بل إن العالم ليس على ما يرام. فهو مضطرب غاية الاضطراب، في غير مكان، وبخاصة في كثير من البلدان العربية التي تمزقها الحروب المركبة، التي هي أهلية بقدر ما هي عالمية. وفي الأصل ولّى زمن الحروب المحلية الأهلية، فالحروب تتعولم كما يتعولم العالم بمحاسنه ومساوئه.
ومكمن العلة ليس في الأدوات والتجهيزات ولا في الشبكات والبرمجيات، كما نحسب نحن الذين نتباهى بذكائنا الفطري، ونصرّ على أن الروبو لا يفكر مثلنا. لنحسن تشخيص المشكلة: نحن ضحايا أفكارنا وعقائدنا، كما نحن ضحايا مشروعاتنا وصنائعنا، التي تفاجئنا وتصدمنا، كما صدقنا الحرب في قلب أوربا، وكما يفاجئنا التغير المرعب في المناخ بسبب الاحتباس الحراري. ولعل هذه واحدة من مفارقات الوضع البشري: فما يصنعه الإنسان سواء أكان فكرة أم أداة، عقيدة مقدسة أم نفايات نووية، قد يتجاوزه ويفلت من سيطرته لكي يرتد ضده. فهل نخشى من الروبو، القادر على التعلم والتركيب والتوقع، من الإتيان بأفعال تقودنا، من حيث لا نحتسب، إلى المجهول وإلى ما لا تحمد عقباه؟!
هذا السؤال يعيدنا إلى البداية، إلى نشأة المدنية والحضارة. فلا عمل ولا مشروع ولا تقدم من دون ضوابط أو معايير تمليها المسؤولية والأمانة، فيما يخص المآلات والمصاير، إذا لم نشأ لها أن تكون صادمة أو كارثية.
الحرية والهوية
من هنا فالمسألة تتعدى الذكاء الاصطناعي لتطول الإنسان في وجوده وفي هويته. فمن هذا الكائن المسمى إنسانًا؟ بل ما هو وأي شيء هو؟ وإذا صح أنه الأذكى والأقوى والأقدر بين الكائنات، فهذه الميزة خاصة هي التي تجعل منه الكائن الأشد خطرًا على نفسه وعلى الحياة والأرض، إذا كان لا يقيم اعتبارًا لما تحتاج إليه الحياة على هذا الكوكب من القيم والقواعد المتعلقة بالتوازن والتكامل، بحيث لا يطغى بُعدٌ أو وجه على سائر الأبعاد والوجوه.
وذلك يقتضي ممارسة التقى الفكري والتحلي بالتواضع الوجودي، بحيث يكون للروبو سياسته وحدوده، وتكون له قواعد استخدامه والانتفاع به، كما تكون له فلسفته ويكون له فنّه. وإذا كان الذكاء الاصطناعي يغير علاقتنا بمفردات وجودنا، بالواقع والحقيقة، بالمعرفة والآلة، بالعقل واللغة، فإن مقاربته النقدية تتعدى المستوى الخلقي، لتطاول غير مستوى ومجال. هناك المسؤولية التي يفترض بالحكومات أن تحملها تجاه عمل الشركات العملاقة بنجومها وشبكاتها وروبوتاتها. ولا يجدر التذرع بحرية التفكير والعمل. فالتجارب تفيد أن شعار الحرية يترجم بعكسه عندما يعامل كحقيقة مطلقة أو أيقونة مقدسة. بالطبع هناك المستوى الخلقي.
فالإنسان لا يعيش وحده، ولا يعمل بمفرده، ولا ينجح من دون معاونة الآخرين، وهو ما يعني احترام ما تمليه الحياة المشتركة، سواء على مستوى قطاع أو بلد أو منطقة، أو المعمورة، من قواعد التكافل والتضامن، بقدر ما يعني خلق اللغات والأطر التي تتيح للواحد أن يمارس هويته كمواطن عالمي. فالآخر ليس جحيمًا، وإنما هو شطرنا الوجودي، الذي يحسن بنا التدرب على قبوله، بحيث تدار العلاقة معه بلغة التنافس العقلاني الشريف، لا بمنطق الصدام والتحطيم أو التغول، كما توحي الصراعات بين مارك روزنبرغ وإيلون ماسك. وإذا كان لكل تجربة معناها ولكل خبرة مفهومها، فما يعنيه عصر الشبكات هو أن هوية المرء لم تعد تفهم وتمارس كمماهاة تامة وخاوية مع الذات، ولا كمغايرة كلية وفقيرة مع الآخر. وإنما تفهم وتمارس بوصفها شبكة التبادلات وصيرورة التحولات التي تصنعها علاقاتنا مع الآخرين.
هناك من جهة ثالثة المستوى المعرفي. والمعرفة هي ميزة الإنسان وحيلته في تدبر وجوده، إذ هي التي تتيح له فهم واقعه بإعادة صوغ عالمه، بتحويله إلى مبدأ أو معتقد، إلى مفهوم أو قانون، إلى معيار أو قاعدة، إلى شكل أو أسلوب… وإذا كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تغيير الحياة بمختلف وجوهها، فمن الحمق استعمال هذه التقنيات، من دون أن نعرف كيف تعمل، أو أن ندعها تطغى علينا، إنها بذلك تخرج عن سيطرتنا وتتحول من آلة إلى إله. فنحن لا نحتاج إلى هذا الكم الهائل من المعلومات والبيانات، التي إذا ما أسيء استخدامها تغرقنا وتستبد بنا، لتبلبل لغاتنا وتشل عقولنا.
إن البشر، وسط كل هذا الاضطراب العالمي، ووسط هذا التشابك في المصالح والمصاير، لا يحتاجون إلى هذا البحر المتلاطم من المعلومات، كما لا يحتاجون إلى أسلحة الدمار الشامل، وإنما يحتاجون إلى قدر من الحكمة والتعقل والتواضع، بحيث يديرون شؤونهم بمفردات التوازن والتكامل أو الرعاية والقناعة أو الشراكة والتبادل، لا بمفردات الاستهلاك المفرط والنمو الفالت أو التكاثر الفاحش؛ لأن مآل ذلك هو الخراب والهلاك.
من هنا حاجة الروبو إلى فلسفة. فالحياة لا تستقيم بالأداة والرقم والمعلومة، من دون سقف رمزي تجسده المعاني والقيم أو القواعد والفضائل. ولا يعني ذلك العودة إلى الوراء، وإنما يعني أن نتحول عما نحن فيه، في مواجهة التغيرات والتحديات، بابتكار الجديد من المفاهيم والقواعد أو الأنماط والأساليب.
لعل أهم ما فتحته الثورة الرقمية من إمكان وجودي، بمنصاتها وروبوتاتها، هو أنها أتاحت لكل فرد أن يتحول إلى لاعب فاعل، بوسعه أن يتدخل في الشأن العام، عبر الشبكات، بالقراءة أو الكتابة، بالمحادثة أو المناقشة. لنحسن استخدام هذه الأدوات والتعامل معها، بحيث يشتبك في أنشطتنا وأعمالنا، ما هو سياسي وخلقي أو اقتصادي وتقني أو معرفي وجمالي. وتلك هي فلسفة الروبو.
يوفال نوح هراري(٦) ويان لوكان(٧) وجهًا لوجه: الذكاء الاصطناعي أو صدمة الأدمغة(٨)

حوار: هيلواس بونس وغيوم غرالي – ترجمة: يحيى بوافي – مترجم مغربي
الذكاء الاصطناعي هو موضوع الساعة الذي فرض نفسه على الجميع من دون منازع، من تشي جي بينع إلى جو بايدن وفلاديمير بوتين الذي صرح بنفسه سنة 2017م، أن البلدان التي ستكون لها الزعامة في ميدان الذكاء الاصطناعي هي التي ستكون لها الهيمنة والنفوذ على الساحة العالمية. وإذا كان التاريخ قد أظهر مدى ما تمتعت به رؤية سيد الكرملين من عدوانية على الأقل، فمن المستحيل أن يُتجاهَل اليوم ما حققه الذكاء الاصطناعي من تقدُّم. فهو قادر على تسهيل الملاحظة الفضائية أو إعداد آلياتها وصيانتها، وعلى إتاحة تمثيل البروتينات القابلة للطي مثل بلعمة (phagocyter) حقيقية، مع مضاعفة المشاهد التي تستلهم الراهن وتكون أكثر اتصافًا بالحقيقة من الطبيعة، فماذا تعتقدون بخصوص هذا الصعود القوي الذي هو، دون أدنى ريب، الصعود الأكثر هَوْلًا في مَشهديّتِه منذ أن ظهر تعبير «الذكاء الاصطناعي» سنة 1956م في مؤتمر دراتموث؟
من الناحية النظرية كل شيء يذهب في اتجاه تأكيد التعارض بين يان لوكان ويوفال نوح هراري؛ فأحدهما باحثٌ بينما الآخر مُؤرِّخ. يرى الأول أَلا شيءَ يدعو إلى الذُّعر من ظهور هذا التخصص، بينما يخشى الآخر أن يؤدي بحضارتنا إلى الانهيار. سبق ليوفال نوح هراري أن وقّعَ على الرسالة المفتوحة التي وجهها منتدى التفكير الذي يحمل اسم مستقبل الحياة (Think Tank The Future of life)، على غرار ما فعل قُرابة ثلاثين ألف باحثٍ طالبوا بالتوقف لمدة ستة أشهر عن تنمية وتطوير أدوات تكون أرقى من شات جي بي تي (- 4 GPT-)، النموذج اللغوي الذي سرّع من اعتماد شات جي بي تي في وقت قياسي، أما يان لوكان فلا يرى في هذا النداء إلا ضجة وزعيقًا لرسل الموت.
أُجرِيَت المقابلة التي اقترحتها مجلة لوبوان بشكل تناظري عن بعد؛ لأجل المواجهة بين وجهة نظر كل من يان لوكان ويوفال نوح هراري حول الذكاء الاصطناعي وما يعِدُ به من منافع وما يُنْذِرُ به من أخطار. الأول مدير البحث الأساسي في الذكاء الاصطناعي بشركة ميتا الحاصل على جائزة تورينغ التي تعادل جائزة نوبل في مجال المعلوميات، وصاحب كتاب «حين تتعلم الآلة» الصادر عن دار النشر أوديل جاكوب، والثاني هو مؤلّف لكتُبٍ تصدَّرت قائمة الكتب الأكثر مبيعًا: «العاقل، تاريخ موجز للبشرية» و«21 درسًا للقرن الحادي والعشرين» (صدرت ترجمتهما الفرنسية عن دار النشر ألبان مشيل).
الذكاء والوعي والمشاعر
● لتكن بدايتنا من أهم نقطة، أي ما تعريفكما للذكاء؟
■ يان لوكان: الذكاء هو القدرة على إدراك وضعية، ثم تصميم وتخطيط مقطع من الأفعال لأجل بلوغ الهدف.
يوفال نوح هراري: الذكاء هو القدرة على حل المشكلات. غير أن الذكاء لا يرادف الوعي، مع أنهما يمتزجان ويختلطان لدى الإنسان، فالوعي هو القدرة على الشعور بالألم وبالحب وبالكراهية، والكائنات البشرية تستخدمُ الوعي أحيانًا من أجل حل المشكلات، غير أننا نجد العديد من الكائنات العضوية، كما هي الحال للنباتات والعضويات المجهرية، التي تحل المشكلات من دون أن يكون لها وعي بذلك، كما أن الآلة بدورها يمكن أن تكون ذكية وتقوم بحل المشكلات من دون أن تكون لها مشاعر.
يان لوكان: نعم لم يتحقق ذلك بعد، لكن الوقت سيحين لحصوله.
● أحقًّا آلةٌ ذكية ولها أحاسيس؟ لكن ما الموعد النهائي لتحقق ذلك؟
■ يان لوكان: من العسير جدًّا تحديد المدة التي سيستغرقها ذلك، لكن ما يبقى يقينيًّا ولا يعتريه أدنى شك بالنسبة لي، هو أننا سنشهد على أقل تقدير، آلات يكون مبلغُها من الذكاء مثل ما لدى الكائنات البشرية، فإذا صارت قادرة على أن تضع لنفسها أهدافًا، عندها سيكون لها ما يعادل مشاعرنا وأحاسيسنا الإنسانية؛ لأن العواطف في الغالب الأعم ما هي إلا استباقٌ للنتائج. فلكي نخطِّطَ، على سبيل المثال، ونضع تصميمًا لا بد من أن نستبق النتائج هل ستكون جيدة أو سيئة؟ وهذا ما يشكل أحد الأسباب الرئيسة والأساسية للعواطف، فإذا ما أدركنا مسبقًا، بوصفنا كائنات بشرية، أن وضعية من الوضعيات تنطوي على أخطار صيرُورَتِها وضعية خطيرة، فإن الخوفَ يَنْتابُنا، مما يَحُثُّنا على البحث عن اختيارات مختلفة لأجل الانفلات من الوضعية الخطيرة، وإذا كانت الآلات قادرة على القيام بذلك، فستكون لها عندئذ مشاعر وأحاسيس.
● غير أننا، على ما يبدو، لا نزال أبعد ما نكون عن الآلة الواعية، التي استحضرها عالم الرياضيات البريطاني ألان تورينغ منذ الخمسينيات من القرن الماضي…
■ يوفال نوح هراري: إنه أمر ممكن لكنه ليس بالأمر الضروري الذي لا يمكن تفاديه وتجنُّبُه، إن الوعي هو القدرة على اختبار الأحاسيس والمشاعر، وبالتالي فمن الممكن تمامًا أن تكتسب الآلات وعيًا، لكن يمكنها أيضا التطور وفقًا لنمط تطور مختلف، وأن تُنَمّي أنواعًا أخرى من الذكاء تكون أعلى من الذكاء البشري، لا تستلزم أي إحساس، وتلك هي الحالة الحاصلة فعليًّا في ميادين محدودة مثل ألعاب الشطرنج أو لعبة الغو، فألفا غو(٩) لم يشعر بالفرح حين كسب الجولة، مع أنه أكثر ذكاءً من الكائنات البشرية في هذه اللعبة، وبالتالي فمع الذكاء الاصطناعي العام يمكن للآلات دون إحساس أن تتخطى ذكاءنا بأشواط كبيرة.
يان لوكان: من اليقيني أن كثيرًا من الأنظمة التي نصفها بالذكية ستكون موجودة، بل إنها موجودة الآن، وسبق لها أن وُجدت فعليًّا، فعلى سبيل المثال لاعب الغو أو حتى نظام القيادة الآلية، كلها أنظمة لا تمتلك مشاعر وأحاسيس، لكن لو أردنا لها أن تكتسب مستوى بعينه من الاستقلالية وأن تعمل مُحاولةً تحقيق هدف، فمن الراجح أنّنَا سنُجهزها بما يكافئُ الأحاسيس أو المشاعر، بحيث تكون قادرة على التَّنبُّؤ بنتيجة مقطع خاص من الأفعال.

أخطار ومكاسب محتملة
● شات جي بي تي الذي تملّك لغتنا، الجوهرية جدًّا في العقد الاجتماعي، هل ينطوي على أخطار؟
■ يان لوكان: لا أظُنّ أن هذا الرُّبُوت الخاص بالدردشة خطير في الوقت الحالي. كان يمكنه أن يصير كذلك، لو صُمِّم بكيفية مغلقة، وبعيدًا من الأنظار، غير أن العكس هو الذي حصل، لأن وسيلة التقدم للنماذج الكبرى الخاصة باللغة هي جعلها ذات مصدر مفتوح. وهي فكرة جيدة سواء نظرنا إليها من زاوية الأمن أو من زاوية البحث. لكن لنتصور مستقبلًا يكون فيه بإمكاننا جميعًا امتلاك عامل ذكي تحت إمرتنا وتحكُّمِنا؛ إنه تمامًا كما لو أن فريقًا من الأشخاص الأكثر ذكاء قد صار فجأة يخدمنا تبعًا لما نأمر به، حتى يجعلنا أكثر إنتاجية وإبداعية. وهؤلاء الفاعلون الأذكياء سنخاطبهم بكيفية طبيعية جدًّا، كما في فِلْم «هي» (Her). ومن جهتي، بوصفي مديرًا صناعيًّا سابقًا وأستاذًا جامعيًّا، أحاول ألا أعمل إلا مع من هم أكثر ذكاءً مني؛ لأنها أجود وسيلة للنجاح، وبالتالي ليس علينا الشعور بأننا مهدّدُون بهذا الأمر، بله يجعلنا أقوى وأكثر تعزيزًا، إنه مطلع نهضة جديدة وعصر أنوار جديد.
يوفال نوح هراري: إن السؤال المطروح هو معرفة من هم أولئك الذين سيكون هذا البرنامج في أيديهم، نعم يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مدهشًا وعجيبًا، لكن إذا وقع بين الأيدي الخطأ، يمكنُه تدميرُ الديمقراطية أيضًا. إن مصدر الديمقراطية هو المحادثة والمناقشة بين الأشخاص، وإذا ما وُجد هؤلاء العملاء القادرون على إقامة محادثة أفضل من أي كائن إنساني كان، وكانوا مُوظّفين في خدمة فاعلين غير مسؤولين، فإن السيناريو الكارثي هو ما سيرتسم في الأفق. وإذا ما قُرصِنَت المُحادثة بين الأشخاص أو التُفّ عليها وشُوِّهَت، وهو ما يقدر الذكاء الاصطناعي على القيام به في الوقت الحالي، فإن ذلك سيقوِّضُ أسس ودعائم النظام الديمقراطي. إذن فمَنِ الأخطر، أن تكون حاصلًا على مساعد ذكي يقدم لك 95% من أجود النصائح، أم أن يكون لك مساعد يضاعف الهلوسات(١٠)؟
يان لوكان: إن الأنظمة الحالية للذكاء الاصطناعي مساعداتٌ جيدةٌ في الكتابة، لكنها ليست مصادرَ موثوقة للمعلومة. وفي غضون سنتين إلى خمس سنوات مقبلة، سيحقق النظام تقدمًا من أجل خلق أنظمة للذكاء الاصطناعي تكون أكثر واقعية، لتصير هذه الأنظمة في نهاية المطاف أكثر موثوقية من أي وسيلة أخرى للبحث عن المعلومة. لنأخذ على سبيل المثال الأنظمة الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة: في الوقت الحالي نجد الأنظمة المساعدة على السياقة تكون على درجة كبيرة من الموثوقية على متن الطريق، لكنها لا تكون كذلك في مكان آخر ويُطْلَبُ من السائق وضع يديه دائمًا على عجلة القيادة. ومع النماذج اللغوية ذاتية الارتكاس، يُفْتَرَضُ بالمستخدمين ألا تبتعد أيديهم لحظةً من لوحة المفاتيح؛ لأن هذه الأنظمة يمكن أن تقول أشياء غبية وسخيفة، إذ ليس لها حس سليم، حتى إن كانت قد راكمت كمًّا هائلًا من المعارف التي يُمكنها اجترارها.
● ألا ينطوي وجود آلات أكثر استقلالية على خطر تطور ونمو عالم يتخلّى فيه الإنسان عن كل قدراته على اتخاذ القرار لصالح الآلة؟
■ يان لوكان: إننا نعيش بالفعل في عالم معظم القرارات التي تُتَّخَذ هي قرارات تتخذها الآلات، طبعًا هي قرارات ليست على درجة كبيرة من الأهمية، لكن حين تعمدون إلى البحث على محرك البحث، فإن ترتيب المعلومات المعروضة تُحَدّدُه الخوارزميات مسبقًا. وإذا ما جمعتكم مناقشة على شبكة التواصل الاجتماعي مع أصدقائكم الذين يتحدّثون بلسان آخر، فإن الخوارزميات هي التي تتولى ترجمتها، طبعًا لا تكون تلك الترجمة بمواصفات الكمال المطلوبة، لكنها تبقى نافعة في كل الأحوال، وهو ما يدل على أن كل أداة يمكن أن تُوَظَّف؛ إما لتحقيق غايات جيدة أو سيئة، والمستخدمون هم من يحددون في نهاية المطاف، ما تقوم به الخوارزميات؛ لأن هذه الأخيرة تتكيّف وتتأقلم آليًّا بدلالة رغبات المستخدمين.
يوفال نوح هراري: لا يمكن للسكين أن تقرر قتل شخص ما أو إنقاذ حياة في أثناء عملية جراحية؛ لأن القرار كان دائمًا موقوفًا على الإنسان، بينما الذكاء الاصطناعي هو الأداة الأولى التي يمكنها الحلول محلَّنَا في عملية اتخاذ القرار. صحيح أننا لسنا بمأمن من القيام باختيارات سيّئة، فقد ارتكبنا أخطاء مُرعبة وعشنا تجارب فاشلة، من قبيل النازية والشيوعية، كما أن الحربين العالميتين الأولى والثانية كلتيهما كانتا خطأً فادحًا. وبعد تدمير حياة مئات الملايين من الناس، تعلمنا في نهاية المطاف بناء مجتمعات صناعية جيدة، والسبب الوحيد الذي يفسّرُ بقاءنا على قيد الحياة في القرن العشرين هو أن التقنية لم تكن بالقوة التي تتيح لها تدميرنا، أمّا تقنية القرن الحادي والعشرين فأقوى بكثير من نظيرتها في القرن الماضي، وإذا ما ارتكبنا من جديد خطأ من قبيل ذاك الذي وقعنا فيه كأن نُقيم، على سبيل المثال، نظامًا شموليًّا على أساس الذكاء الاصطناعي أو أن نُشعل فتيل حرب عالمية ثالثة، فإن حظوظ خروجنا من ذلك أحياءً، حتَّى نتعلّم من جديد من أخطائنا، تبقى ضعيفة جدًّا إن لم تكن منعدمة.
يان لوكان: الشيء نفسه يمكننا قولُهُ عن الثوْرات التي حدثت في التاريخ البشري، فالطباعة قوّضت المجتمع في أوربا عند بداية القرن السادس عشر الميلادي مع الطوائف الدينية، لكنها حملت معها الأنوار والنزعة العقلانية والفلسفة والعلم والفلسفة والديمقراطية.
يوفال نوح هراري: الطباعةُ غذّت الأنوار، لكنها غذّت الإمبريالية الأوربية والحروب الدينية أيضًا، لكن لو استُؤنِفَت الحروب الدينية من جديد، كما حدث بين البروتستانت والكاثوليك في فرنسا إبّان القرن السادس عشر، فإنني لا أعتقد، في ظل توافر الذكاء الاصطناعي والقنابل النووية أن البشرية ستبقى على قيد الحياة؛ لذلك فإن الخطر متمثل في أن الذكاء الاصطناعي يقوّض أسس الديمقراطية ودعائمها ويقود إلى خلق دكتاتوريات رقمية جديدة ستكون أكثر تطرفًا من الاتحاد السوفييتي.
على عتبات عصر جديد
● لكن على الرغم من ذلك، تقول أنت يا يان لوكان: «إن تعزيز وتضخيم الذكاء الإنساني بواسطة الآلة سيؤدي إلى عصر نهضة جديد»، هل حقًّا يمكن أن يحدث ذلك؟
■ يان لوكان: إنها نهضةٌ أو عصر أنوار جديد، يدعمه تسارع التقدم العلمي والتقني والطبي والاجتماعي بفضل الذكاء الاصطناعي؛ لذلك فإن التخفيف من وتيرة البحث العلمي ليس مفيدًا لأنه لن يُوقف الخطر، وأقل ما يُقال عنه هو أنه أمر سخيف. ومن أجل استثمار وتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي على أكبر نطاق، لا بد من التَّحلي باليقظة والحذر والقيام بذلك تحت رقابة الحكومات والجمهور.
يوفال نوح هراري: لقد استغرقت المجتمعات، ولا سيما الديمقراطية منها، عقودًا في فهم ما يحصل من تغيّرات، كما أن فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على السياسة والسيكولوجيا والاقتصاد… سيحتاج سنوات عديدة؛ لذلك سيكون لزامًا علينا التخفيف من إيقاع السيرورة الخاصة به حتّى تكون المجتمعات قادرة على تعيين المخاطر وتحديدها؛ لتبني في المُحصّلة الفعل المناسب.
● ومع البرامج الجديدة كما الحال في برنامج (Midjourney) أو (Runway)، التي تتيح ابتكار صور فوتوغرافية وفيديوهات أكثر فأكثر اتصافًا بالخاصية الواقعية، وهو ما جعل مفهوم الحقيقة موضوع تهديد واعتداء…
■ يوفال نوح هراري: إن المشكلة كانت قائمة حتّى قبل أن تظهر هذه الأدوات، فالحوار الديمقراطي قد انهار؛ لأن المواطنين بمن فيهم من ينتمون إلى أحزاب الحكومة، ما عادوا قادرين على التوَصُّل إلى تحقيق التوافق أو الإجماع، وتلك هي المفارقة التي تطبع الديمقراطيات الغربية، ففي الولايات المتحدة الأميركية، بوصفها إحدى البلدان التي تمتلك تقنية المعلومات الأكثر قوة، نجد الأميركيين عاجزين عن تحقيق الاتفاق فيما بينهم حول الأسئلة الأولية جدًّا: من الفائز في انتخابات 2020م؟ هل اللقاحات يمكنها مساعدتنا أم إنها على العكس من ذلك، خطيرة؟ بل إن الأمر قد بلغ بهم حدّ التساؤل عمَّ إذا كان التغيُّر المناخي أمْرًا واقعًا، فكيف لبلد يمتلك تقنيات قوية للمعلومة يعجز عن التّوصُّل إلى تحقيق اتفاق حول أمور هي من الأساسيات؟ وبناءً عليه يبدو أنْ لا شيء قد اكتُسِبَ.
يان لوكان: إن الجيل الشاب الذي نما وترعرع في صُحبة الإنترنت، يأخذ مسافة نقدية وله كيفية أكثر نسقية وتنظيمًا للتوصل إلى أصل معلومة من المعلومات، فكثير من التَّنبُّؤات لا تأخذ في حُسبانها أنَّ الناس يكيِّفُون طريقتهم في التفكير.

سلاح ذو حدين
● هل سنكون في حاجة إلى شكل التنظيم السائد نفسه في مجال الطاقة النووية؟
■ يان لوكان: يتمثل الاختلاف الكبير في أن الذكاء الاصطناعي صُمِّمَ لأجل زيادة الذكاء الإنساني، بينما صُمِّمَت الأسلحة النووية لقتل الناس.
يوفال نوح هراري: إنه لَسؤال جيد: هل صمّمنا الذكاء الاصطناعي لجعل الناس أكثر ذكاء أم لأجل التّحكُّم فيهم؟ الإجابة عن هذا السؤال تختلف من بلد إلى آخر.
يان لوكان: من المرجّح أن بعض البلدان تصمّم الذكاء الاصطناعي للتحكم في الناس، غير أن تأخرها في مجال التقنية سيكون أمرًا لا مناص منه.
يوفال نوح هراري: أعتقد أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرّد أمنية، فعلى سبيل المثال كان النازيون أكثر تقدمًا من الغرب في مجال البنادق والطائرات النفاثة؛ إذ هزمت ألمانيا النازية فرنسا سنة 1940 هزيمة حاسمة، حتى إن كان التوازن الاقتصادي بين القوات قد شَجَّع التحالف الفرنسي البريطاني؛ لذلك لن أراهن على أن الديمقراطيات هي من تكون لها السيادة دائمًا.
● ما رأيكم في اقتراح إيلون ماسك زرع رقائق إلكترونية في أدمغة كائنات بشرية حتى تنافس الذكاء الاصطناعي؟
■ يوفال نوح هراري: يعيدنا ذلك إلى طرح سؤال: كيف نفكر بخصوص إمكانية جعل «الكائنات الإنسانية مزيدة ومعزّزة»؟ أعتقد أنه من الخطير جدًّا استخدام الذكاء الاصطناعي أو الوصلات أو الأسطح البينية دماغ- حاسوب لمنحهم حياة أطول أو ذاكرة أفضل. فقد عانينا دائمًا، نحن معشر البشر، من وجود فارق وتباعد بين قدرتنا على استخدام الأنظمة والحكمة الضرورية من أجل فهم هذه الأنظمة في العمق، لكن الحاصل، للأسف، هو أن الاستغلال أسهل بكثير من الفهم. تعلَّمنا في الماضي التحكم في الأنهار والحيوانات والغابات، لكن غاب عنا فهْمُ تعقيد النظام الإيكولوجي، فكان أنْ أفرَطْنا في استخدام قوتنا وسُلطتنا؛ وهو ما تسبَّب في اختلال توازنه. وفي القرن الحادي والعشرين لم نعد قادرين على تعلُّم استغلال العالم الذي يحيط بنا وحسب، بل صرنا قادرين على التحكم في عالمنا الداخلي واستغلاله أيضًا، فالذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى مثل الهندسة الوراثية، يمكنها إتاحة إعادة تصميم جسدنا وأذهاننا، وأن نتحكم في انفعالاتنا، وأفكارنا وإحساساتنا. كما أن الحكومات والشركات والجيوش يمكنها استخدام التقنيات الجديدة لتحسين الكفاءات التي تكون في حاجة إليها من قبيل الذكاء والانضباط، عبر إهمالها وتخليها عن تنمية العطف، والحساسية الفنية أو الروحية. هكذا يمكننا أن نفقد قسمًا كبيرًا من إنسانيتنا من دون أن نكون على بيّنة من ذلك. إننا نفضِّل التركيز على الزيادة في قوة الخوارزميات بدل أن نركز على البحث في الذهن الإنساني الذي لا نعرف إلا النزر القليل عنه؛ لذلك أتمنى أن نخصِّص في مقابل كل دقيقة نكرّسها لنمو الذكاء الاصطناعي، دقيقة أخرى للبحث في تطور ذهننا الخاص.
يان لوكان: فيما يخصُّ الرقاقات التي تُغرَسُ في الدماغ، فإن البحث فيها يجري منذ سنوات عديدة، وهي تظل مفيدةً جدًّا في علاج بعض اضطرابات البصر والسمع، وواعدة جدًّا في علاج أنواع بعينها من الشّلل، ويمكننا أن نتصور علاج بعض اختلالات الذاكرة في المستقبل عبر حصين اصطناعي، غير أنني أشك في أن يُوافق كثير من الأشخاص على وضع رقاقات مغروسة ليتفاعلوا مع مساعد افتراضي، وإن حصل ذلك فلن يحصُل في المستقبل القريب على الأقل. الذكاء الاصطناعي يسرع وتيرة تقدم الطب، وهو ما نعاينه الآن في مجال التصوير الطبي، كما ساعدنا بالفعل في فهم آليات أو مكانيزمات الحياة البيوكميائية، على سبيل المثال من خلال التحكم في تشَكُّل البروتينات وتفاعلاتها مع بروتينات أخرى. لا أومن بالسيناريو الذي يُشَجّع من الخيال العلمي، وفيه ستكون الهيمنة للذكاء الاصطناعي على الإنسانية وسيقضي عليها، ربما قد تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية أكثر ذكاء منَّا نحن، لكنها ستَخْدُمنا ولن تكون لها أي رغبة في الهيمنة على البشرية.
الوجود الإنساني والأنطولوجيا الرقمية

عبدالعزيز بومسهولي – كاتب مغربي
يعبر العقل الاصطناعي عن العالم برمته، كانكشاف أخير للإنسانية جمعاء. وهذه مسألة حتمية تفوق كل إمكانيات البشر؛ لأنها لا تعبر عن مجرد رغبات بشرية فردية، بقدر ما تعبر عن تلك الرغبة الفائقة التي يختزل فيها الوجود الإنساني كله داخل ما يمكن تسميته الأنطولوجيا الرقمية، التي مسّت في الصميم كل رغبة أنثروبولوجية خاصة، وحولتها إلى مجرد رغبة رقمية. وهي بذلك لا تحول دون إمكانية المعرفة بالنسبة للإنسان، أو ما الذي يمكنني أن أعرفه؟ كسؤال كانطي محض، وإنما تجعل من ذاتها إمكانية فائقة للمعرفة التي تتجاوز قدرات العقل البشري على إنتاج المعرفة. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن قدرة العقل البشري ليست ممكنة الآن في هذا العالم الرقمي من دون وساطة للعقل الاصطناعي. بل إن ماهية الإنسان عينها صارت بدورها رقمية.
ولهذا ينكشف السؤال مجددًا: مَنِ الإنسان؟ هل هو هذا الكائن الإنساني الذي يعبر عن العالم، كما لو كان راعيًا للوجود؟ أم هو هذا الكائن الإنساني الذي ينكشف بدوره في عالم الذكاء الاصطناعي ككائن رقمي؟ إذن، مَنِ الإنسان؟ هل هو كائن انتهى زمانه؟ وإذا انتهى زمانه الذي تؤسسه رغبته الأنثروبولوجية، فما الذي يكونه هنا والآن فيما يمكن تسميته ما بعد الإنسانية؟ وهل ما بعد الإنسانية ليست إلا مجرد استعارة تحكي الانكشاف الأخير للتاريخ كعقل كوني لرغبة ترهن الاقتدار البشري في عقل كلي يتحكم في التاريخ، ربما على نحو هيغلي، حيث ينكشف العالم ككتاب لا متناه الحدود وكأفق مفتوح؟
قدرات فائقة
العقل الرقمي لا يفكر كما العقل الإنساني، هو يعمل فقط، ولكنه يعمل بقدرات فائقة للعقل البشري، أو إن شئنا هو العقل الذي يحوي في ذاته العقل البشري كله، واللوغوس الكوني الذي يختزل في جوفه عقل أو نظام الطبيعة. وبالرغم من كون العقل الرقمي نتاجًا للفكر البشري، فإنه بقدرته الفائقة على العمل لا على التفكير، صار شرطًا ضروريًّا لإمكان تجربة الفكر، فليس بإمكان الفكر اليوم إلا أن يفكر لا انطلاقًا من معطى الحساسية وحسب، بل من معطى إدراك رقمي للحساسية. ومعناه أن العقل الرقمي اليوم هو الذي يملي قوانينه على تجربة الفكر. لقد كان الفكر الساذج واهمًا عندما تصور أن التقنية ستتحكم في الإنسان من خلال كائن آلي من صنعه، غير أنه أدرك اليوم أن ما يتحكم في تجربته ليس هو هذا الكائن الأسطوري المتشكل في مخيال الإنسان، وإنما هو هذا العقل الرقمي الذي صار يشكل عنصرًا مكونًا لماهية وجوده في العالم، بحيث إن ماهية وجوده تكاد لا تنفصل عن هذه الماهية الرقمية التي صار مرغمًا على التفكير من خلالها في اختبار تجربة وجوده، وفي اختيار نمط عيشه.
طبيعة رقمية
الجسد وحده قادر على أن يتشكل رقميًّا، ما دام أن طبيعته ليست فيزيقية محضة ولا هي روحية محضة، بل هي من طبيعة رقمية بالمعنى الذي يفيد بأن الفيزيقي والروحي هما معًا محض احتمال رقمي، وأنهما معًا ليسا موجودين مستقلين بذاتيهما، بقدر ما هما وجهتا نظر للإنسان عن الشيء عينه الذي هو الجسد، والذي يشهد بتحوله الرقمي على نهاية زمان بلغ فيه مع الإنسان أقصى كمالات إشباع الوجود. وهذا معناه أن الكائن الإنساني، قد انتهى زمانه، كما عبرنا عن ذلك في أطروحتنا لعام 2001م. أي أن زمان التاريخ بما هو إشباع للرغبة الأنثروبولوجية للإنسان قد استنفد أغراضه، ليفسح المجال لزمن يجعل من الجسد المشبع تاريخيًّا وأنثروبولوجيًّا عنصرًا أساسيًّا في المعادلة الرقمية للوجود.
توضيح أخير: الإنسان الذي جعل من نفسه وصيًّا على الجسد، انتهى زمانه، ليس بالمعنى الهيغلي- الكوجيفي ولا الفوكويامي، ولكن بمعنى أقرب من تصور سبينوزي مفاده أننا لا نستطيع معرفة ما يقدر عليه الجسد، وأن قدرة الجسد على التشكل تفوق كل الاحتمالات الممكنة وكل الممكنات المتماكنة أيضًا.
كاتب مغربي
تحديات السرد الروائي في مواجهة الذكاء الاصطناعي

لنا عبدالرحمن – روائية وناقدة لبنانية
لم يعد عالم الرواية بعيدًا من رهانات الذكاء الاصطناعي؛ إذ تتواتر الأخبار بشكل متلاحق عن تجارب يقوم بها الكُتاب، بغرض امتحان علاقتهم مع التقنية الجديدة، واكتشاف الدور الذي ستؤديه في حياتهم. الكلام لا ينتهي عن تقنية «شات جي بي تي»، وعن روبوتات تحل مكان البشر، وتفعل أفعالهم، وتهددهم بوجود منافس قوي في مجالات علمية، ومهنية كثيرة، سواء في الطب أو الهندسة أو تصميم الغرافيك، ومهن أخرى؛ لذا يحضر التساؤل إلى متى ستظل الكتابة الإبداعية بمنأى عن الخطر الإلكتروني؟ وهل هي بعيدة حقًّا؟ وهل من الممكن لروبوت أو نظام حاسوبي أن يكتب رواية أو قصيدة تتفوق على ما كتبه البشر؟ وما القيمة الحقيقية للنصوص التي ينتجها الذكاء الاصطناعي؟ إن هذه التساؤلات التي تدور في أذهان المبدعين، أو الذين يعيشون في دائرة الإبداع من كُتاب وقراء، تستحق التأمل الدقيق بغية استقراء الغد، بكل ما فيه من مفاجآت محتملة؛ وبخاصة أن الرواية العربية تشهد حضورًا للتقنية بدلالات عدة؛ سواء بالكتابة عن دور الروبوتات في الحياة المستقبلية، أو قبول التشارك مع التقنيات الجديدة في كتابة رواية مشتركة.
توليد النصوص
أثارت قدرة التقنية الجديدة على توليد النصوص كثيرًا من النقاشات، حول مستقبل الأدب والشعر. يرى بعضٌ أن ما ينتجه الذكاء الاصطناعي هو مجرد تكرار للأنماط اللغوية التي سبق استخدامها، وليس له قيمة إبداعية حقيقية، كما أنه سوف يؤدي إلى فقدان الهوية الفريدة للكتّاب والشعراء؛ لأن النصوص، التي أُنشِئَت بواسطة الذكاء الاصطناعي، تفتقر إلى الروحانية والعمق الإنساني.
بينما يرى آخرون أن هذه التقنيات قد تفتح الأبواب أمام أشكال جديدة من الإبداع الأدبي، حيث يمكن دمج القدرات البشرية والآلية معًا لإنتاج أعمال فنية حديثة ومبتكرة؛ إذ بمجرد تدريب النموذج الإلكتروني بشكلٍ كافٍ، يصبحُ قادرًا على توليد نصوص جديدة تبدو طبيعية. ومع ذلك، يجب أن نلحظ أن هذه النصوص ليست ناتجة عن «تفكير» أو «إبداع» بالمعنى التقليدي للكلمة. بل هي نتيجة للأنماط اللغوية التي اكتشفها النموذج في أثناء مدة التدريب. المدافعون عن التجربة يعتبرون أن الجانب الإيجابي في الأمر يتعلق بسهولة الوصول إلى محتوى أدبي مختلف، من خلال استخدام تطبيقات ومواقع تستند إلى الذكاء الاصطناعي، كما أنه يُسرع من الوتيرة الإنتاجية للكُتّاب بسبب سهولة الحصول على المعلومات. هذا إلى جانب قدرة التقنيات الحديثة على تحليل وفهم النصوص الأدبية؛ إذ يمكن للخوارزميات والنماذج اللغوية تحليل النصوص بطرق تتجاوز قدرات البشر في بعض الحالات، ومن ثم يُمكن توجيه القراء إلى فهم أعمق للعناصر الأدبية، مثل الرموز والتعبيرات المجازية والتناص. وعلى الجانب الآخر قد يؤدي التحليل الآلي للأعمال الأدبية إلى تقييم سلبي، من دون أخذ العوامل الإبداعية والثقافية والاجتماعية والفردية في الحسبان.
رؤية غربية

كازو إيشيغورو
كتب كازو إيشيغورو الكاتب البريطاني الياباني الأصل، الحاصل على جائزة نوبل في الآداب، روايته «كلارا والشمس» حول الروبوت «كلارا» وعلاقة الصداقة التي سوف تجمعها مع فتاة مراهقة تشتريها من أحد المتاجر؛ كي تعيش معها وتعوضها عن أختها الميتة. إيشيغورو عبّر في أكثر من مناسبة عن قلقه، من أن يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى التقليل من قيمة العمل الأدبي، والخلفية الثقافية والتاريخية للإبداع. يطرح إيشيغورو تساؤلًا حول جوهر أن نكون بشرًا في عصر يتقدم فيه الذكاء الاصطناعي بقوة نحو الحياة الإنسانية، ويقدم نبوءة عن الحياة المستقبلية عبر سلسلة من العلاقات القوية، التي تجمع بين الإنسان والآلة، بداية من والدة الفتاة «جوسي»، التي تريد أن تشتري روبوت على شكل فتاة، لأنها فقدت ابنتها الكبرى، وابنتها الثانية مهددة بالموت؛ لذا حين تشتري «كلارا»، تطلب منها أن تُقلد حركات ابنتها في المشي والأكل، وسائر العادات.
تثير «كلارا والشمس»، تساؤلات عميقة حول تعقيدات العلاقات البشرية المستقبلية، وإمكانية حدوث تقاطع بين الوجود الإنساني الطبيعي، والمعدل جينيًّا والذكاء الاصطناعي. لكن المفارقة في السرد، أن إيشيغورو يضفي لمسة من الإنسانية على حوارات كلارا وجوسي، وعلى أفكار كلارا، وكأنه يحذرنا مما يمكن حدوثه مستقبلًا.

مارغريت أتوود
الروائية الكندية الشهيرة مارغريت أتوود، صاحبة رواية «حكاية الخادمة» التي تدور أجواؤها في عالم من الدستوبيا، تنحو إلى اعتبار أن الذكاء الاصطناعي قد يُمثل فرصة للبشرية لاستكشاف جوانب جديدة من الإبداع، شريطة استخدامه بطريقة مسؤولة، ولا يحل محل الإنسانية في الأدب. قدمت أتوود في روايتها هذه، التي تُعيد إلى الأذهان رواية جورج أورويل «1984»، عالمًا مستقبليًّا غارقًا في مأساوية عصرية، حيث النساء عاجزات عن الإنجاب، ويتعرضن للتعذيب عبر إرسالهن إلى معسكرات لتنظيف بقايا الإشعاعات النووية. تغوص أتوود في حكايات بطلتها، وبطلات أخريات، يواجهن أخطارًا تتعلق بالتغيرات الجغرافية والمناخية، وفقدان التوازن الاجتماعي والبيئي، وهو ما يجعل الحياة ككل مهددة بالزوال.
التقنية عربيًّا
ظهرت في الآونة الأخيرة، العديد من الروايات، التي تقدم نبوءات مستقبلية حول علاقة الإنسان مع التقنية والروبوتات والذكاء الاصطناعي من جهة، وحول مصير الإنسان على هذا الكوكب من جهة أخرى. والملحوظ حول هذه الروايات أنها تتقاطع عند مجموعة من الأفكار المشتركة.
 في رواية «جزيرة المطففين»، الصادرة عن دار المتوسط، يقدم الكاتب اليمني حبيب عبدالرب سروري، رؤيته لتحالف الرأسمالية والتقنية، من خلال سرد تَنبُّئِيّ واستباقي للمرحلة القادمة، التي تحكم مصير الإنسان، وتحوله إلى مجرد مُتلقٍّ للنظام الرأسمالي العالمي، وعبر استغلال البيانات والذكاء الاصطناعي، يحدث التجسس على حياة الناس. تتعدد أماكن الرواية من بريطانيا إلى العالم العربي، وتتناول قضايا مصيرية وحساسة، مثل الهجرة واللجوء والأوبئة والكوارث البيئية، لكنها تركز على التحولات العصرية المستمرة، وتنبه إلى أخطار حلول الآلات مكان البشر، وإلى إمكانية خروج الآلة عن السيطرة البشرية وحدوث تمرد مخيف، سوف يهدد الحياة الإنسانية حقًّا. لنقرأ: «برز هذا السؤال سريعًا: من سينقل لبعض البشر غذاءهم لبيوتهم، في هذين الأسبوعين الحاسمين؟ الرد بديهي أيضًا: روبوتات هذه الحكومة الموحدة… ومن سيعاقب أي إنسان يغادر باب منزله؟ الرد بديهي أيضًا: درونات الحكومة الموحدة، ستقصفه بإشعاعات فاتكة، لمجرد رؤية عدساتها له وهو يحاول مغادرة باب مسكنه لأي سبب كان، أسبوعان لا يُنسيان في تاريخ كوكب الأرض، لم يقصف خلالهما غير نحو 25 ألف إنسان فقط».
في رواية «جزيرة المطففين»، الصادرة عن دار المتوسط، يقدم الكاتب اليمني حبيب عبدالرب سروري، رؤيته لتحالف الرأسمالية والتقنية، من خلال سرد تَنبُّئِيّ واستباقي للمرحلة القادمة، التي تحكم مصير الإنسان، وتحوله إلى مجرد مُتلقٍّ للنظام الرأسمالي العالمي، وعبر استغلال البيانات والذكاء الاصطناعي، يحدث التجسس على حياة الناس. تتعدد أماكن الرواية من بريطانيا إلى العالم العربي، وتتناول قضايا مصيرية وحساسة، مثل الهجرة واللجوء والأوبئة والكوارث البيئية، لكنها تركز على التحولات العصرية المستمرة، وتنبه إلى أخطار حلول الآلات مكان البشر، وإلى إمكانية خروج الآلة عن السيطرة البشرية وحدوث تمرد مخيف، سوف يهدد الحياة الإنسانية حقًّا. لنقرأ: «برز هذا السؤال سريعًا: من سينقل لبعض البشر غذاءهم لبيوتهم، في هذين الأسبوعين الحاسمين؟ الرد بديهي أيضًا: روبوتات هذه الحكومة الموحدة… ومن سيعاقب أي إنسان يغادر باب منزله؟ الرد بديهي أيضًا: درونات الحكومة الموحدة، ستقصفه بإشعاعات فاتكة، لمجرد رؤية عدساتها له وهو يحاول مغادرة باب مسكنه لأي سبب كان، أسبوعان لا يُنسيان في تاريخ كوكب الأرض، لم يقصف خلالهما غير نحو 25 ألف إنسان فقط».
 من ناحية، يفتتح الكاتب المصري تامر شيخون روايته «شفرات القيامة» بعبارة لألبرت أينشتاين تقول: «العلم بدون دين كسيح، والدين بدون علم أعمى». تستشرف الرواية زمنًا مستقبليًّا يقع في سبتمبر 2045م، مع الدكتور نوح جوشواه اللاجئ السوري الأصل، الأميركي الجنسية. ومن خلال سرد يتنقل في الزمان والمكان مع شخصيات عدة، يطرح الكاتب رؤيته حول الأخطار التقنية القادمة. إنها تتسلل لحياتنا بقوة من دون أن ندري بها، وصلنا لمرحلة أصبحنا فيها لا نملك أداة للتغيير، وهذا يتضح من استخدام شيخون لكلمة «شفرات» التي تدل على أمرين: أولهما تحول البشر إلى مجرد «أكواد»، والثاني أن امتلاك بعض الشفرات السرية في أيدٍ عابثة ومؤذية سوف يؤدي إلى الخراب، وإلى حلول القيامة على الأرض. لنقرأ: «عجيب أمر التكنولوجيا، في لحظة فارقة، ينفرد فيها المرء بذاته ليواجه معضلة وجوده، يتابعني فيها عشرة ملايين مُشاهد، جالسين في بيوتهم أو مكاتبهم عبر شاشة هولوغرام سرمدي، من خلال كاميرا أصغر من حبة العنب مثبتة خلف أذني. سيستمتعون بلحظاتي الأخيرة «لايف»، كما استمتعوا بألعاب «كول أوف ديوتي، حروب الجيل السابع»، لكنهم أبدًا لن يدركوا ما إذا تلاشت نفسي في العدم أو انتقلت إلى برزخ موازٍ طالما أفسد حياتي الأرضية».
من ناحية، يفتتح الكاتب المصري تامر شيخون روايته «شفرات القيامة» بعبارة لألبرت أينشتاين تقول: «العلم بدون دين كسيح، والدين بدون علم أعمى». تستشرف الرواية زمنًا مستقبليًّا يقع في سبتمبر 2045م، مع الدكتور نوح جوشواه اللاجئ السوري الأصل، الأميركي الجنسية. ومن خلال سرد يتنقل في الزمان والمكان مع شخصيات عدة، يطرح الكاتب رؤيته حول الأخطار التقنية القادمة. إنها تتسلل لحياتنا بقوة من دون أن ندري بها، وصلنا لمرحلة أصبحنا فيها لا نملك أداة للتغيير، وهذا يتضح من استخدام شيخون لكلمة «شفرات» التي تدل على أمرين: أولهما تحول البشر إلى مجرد «أكواد»، والثاني أن امتلاك بعض الشفرات السرية في أيدٍ عابثة ومؤذية سوف يؤدي إلى الخراب، وإلى حلول القيامة على الأرض. لنقرأ: «عجيب أمر التكنولوجيا، في لحظة فارقة، ينفرد فيها المرء بذاته ليواجه معضلة وجوده، يتابعني فيها عشرة ملايين مُشاهد، جالسين في بيوتهم أو مكاتبهم عبر شاشة هولوغرام سرمدي، من خلال كاميرا أصغر من حبة العنب مثبتة خلف أذني. سيستمتعون بلحظاتي الأخيرة «لايف»، كما استمتعوا بألعاب «كول أوف ديوتي، حروب الجيل السابع»، لكنهم أبدًا لن يدركوا ما إذا تلاشت نفسي في العدم أو انتقلت إلى برزخ موازٍ طالما أفسد حياتي الأرضية».
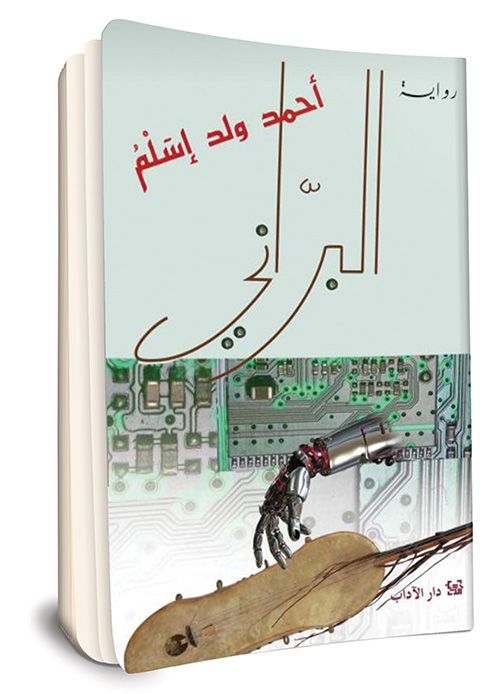 في رواية «البراني» للكاتب الموريتاني أحمد ولد إسلم، نقف أمام عالمين؛ أحدهما نقي ومجرد من التقنية «مدينة النعمة»، والآخر محكوم تمامًا للآلات «جزيرة المستقبل»، وبين هذين المكانين تدور الأحداث، تتقاطع مصاير شخوص الرواية مع الروبوتات، التي تحل مكان البشر في العديد من المهام، مثل مهمة رعي الأغنام، التي يقوم بها في الرواية روبوت ذكي اخترعه «مختور ولد احويبيب»، الذي يعيش وسط العالمين، ويحب الاستماع إلى الموسيقا التقليدية الموريتانية. يصفه وهو يواصل قيادته لسيارته الحديثة جدًّا، ويستمتع بترانيم ونغمات الفنان الموريتاني الشيخ سيد أحمد البكاي ولد عوه، المنبعثة من شريط كاسيت قديم غير متماشٍ مع طراز سيارته. تتناول الرواية الزلازل، وقوارب الهجرة غير الشرعية، وجزيرة موجودة في المحيط يسكنها جماعات ممن أطلق عليهم «العقول المهاجرة»، يتحقق فيها الرخاء والرفاه الإنساني، ويتحدث سكانها العربية كلغة أولى.
في رواية «البراني» للكاتب الموريتاني أحمد ولد إسلم، نقف أمام عالمين؛ أحدهما نقي ومجرد من التقنية «مدينة النعمة»، والآخر محكوم تمامًا للآلات «جزيرة المستقبل»، وبين هذين المكانين تدور الأحداث، تتقاطع مصاير شخوص الرواية مع الروبوتات، التي تحل مكان البشر في العديد من المهام، مثل مهمة رعي الأغنام، التي يقوم بها في الرواية روبوت ذكي اخترعه «مختور ولد احويبيب»، الذي يعيش وسط العالمين، ويحب الاستماع إلى الموسيقا التقليدية الموريتانية. يصفه وهو يواصل قيادته لسيارته الحديثة جدًّا، ويستمتع بترانيم ونغمات الفنان الموريتاني الشيخ سيد أحمد البكاي ولد عوه، المنبعثة من شريط كاسيت قديم غير متماشٍ مع طراز سيارته. تتناول الرواية الزلازل، وقوارب الهجرة غير الشرعية، وجزيرة موجودة في المحيط يسكنها جماعات ممن أطلق عليهم «العقول المهاجرة»، يتحقق فيها الرخاء والرفاه الإنساني، ويتحدث سكانها العربية كلغة أولى.
تتطرق الرواية أيضًا إلى فكرة إطلاق فيروس إلكتروني يوقف شبكة الإنترنت، وتفرد مساحة للحديث عن الروبوت الذي حمل اسم «ما يخرص»، ورؤيته للعالم. يقول: «خلال أشهر طويلة من التدريب على الكلام والحركة والأعمال المختلفة، واستكشاف عوالم الإنترنت، واستيعاب عشرات اللغات العالمية، تمكن «ما يخرص» من تكوين وعي ذاتي بنفسه وبمن حوله، وأدرك أنه مجرد برنامج ذكاء اصطناعي، صمم له مخترعه دمية مطاطية من البوليكربون غير قابلة للكسر، وجعله يقوم بمختلف الأعمال التي تحتاجها المزرعة، ووفر له مصدر طاقة مرتبطًا بألواح الطاقة الشمسية، فضلًا عن أنه ألبسه دراعة من أفضل أنواع القماش، وعلمه الحديث باللهجة الحسانية الموريتانية، وجعل منه رجلًا بدويًّا، لا يمكن لمن خاطبه في الظلام أن يساوره شك في أنه ولد على تلة جنوب مدينة النعمة أقصى الشرق الموريتاني».
 أما الكاتب المصري الشاب أحمد لطفي، فإنه يتبنى فكرة حضور الذكاء الاصطناعي في الكتابات الإبداعية، ويرى أنه سيقدم مجالات خصبة لإصدارات قيمة في المستقبل. وضمن هذه الصيحة الجديدة المثيرة للاهتمام صدر له رواية «خيانة في المغرب»، عن دار كتوبيا. إنها أول رواية عربية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويقوم بناؤها على حوار مشترك بين الكاتب وبرنامج شات جي بي تي، ومكتوبة بشكل أساسي للقراء اليافعين، وتتألف من مئة صفحة، تدور في أجواء بوليسية غامضة، حول شخصية بطل يدعى فارسًا، يتعرض لملاحقة من جانب إحدى العصابات، وهو ما يجعل أحداثها حافلة بالتشويق والإثارة، والأهم من هذا كله هو الاطلاع على بعض الفقرات، التي كتبها الذكاء الاصطناعي، لنقرأ منها: «إذا كان هؤلاء الرجال يلاحقونك بهذه الطريقة، فإن ذلك يعني أن هناك شخصًا قويًّا وخطيرًا خلفهم. شخصًا لديه نفوذ وثروة وسلطة في هذه المدينة، شخص لا تريد أن تواجهه أبدًا».
أما الكاتب المصري الشاب أحمد لطفي، فإنه يتبنى فكرة حضور الذكاء الاصطناعي في الكتابات الإبداعية، ويرى أنه سيقدم مجالات خصبة لإصدارات قيمة في المستقبل. وضمن هذه الصيحة الجديدة المثيرة للاهتمام صدر له رواية «خيانة في المغرب»، عن دار كتوبيا. إنها أول رواية عربية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويقوم بناؤها على حوار مشترك بين الكاتب وبرنامج شات جي بي تي، ومكتوبة بشكل أساسي للقراء اليافعين، وتتألف من مئة صفحة، تدور في أجواء بوليسية غامضة، حول شخصية بطل يدعى فارسًا، يتعرض لملاحقة من جانب إحدى العصابات، وهو ما يجعل أحداثها حافلة بالتشويق والإثارة، والأهم من هذا كله هو الاطلاع على بعض الفقرات، التي كتبها الذكاء الاصطناعي، لنقرأ منها: «إذا كان هؤلاء الرجال يلاحقونك بهذه الطريقة، فإن ذلك يعني أن هناك شخصًا قويًّا وخطيرًا خلفهم. شخصًا لديه نفوذ وثروة وسلطة في هذه المدينة، شخص لا تريد أن تواجهه أبدًا».
وعلى الرغم من قيام لطفي بهذه التجربة، فإنه يصف عجز الذكاء الاصطناعي عن القيام بمحاكاة لغوية للكتابات الإنسانية، في هذه المرحلة، وأن كل ما تنتجه الآلات يحتاج إلى التدخل البشري، وبخاصة على مستوى اللغة.
التحدي الأكبر
تُثبت التجارب حتى الآن، أنه ليس بإمكان الأنظمة الحاسوبية إنتاج نصوص أدبية بطريقة تبدو طبيعية وبشرية للغاية، إلا أنه من الممكن جدًّا حدوث تأثير ملحوظ للذكاء الاصطناعي في النصوص الأدبية من الجانب المعلوماتي فقط، أي تسهيل الحصول على معلومات وأحداث أرشيفية أو تاريخية قديمة؛ بسبب احتوائه على كميات هائلة من البيانات اللغوية، التي تشمل كتبًا، ومقالات، ونصوصًا أدبية، شعرًا وغيره، إلى جانب تزويد النموذج بملايين الكلمات والجمل، مما يمكّنه من فهم السياقات والقواعد والأنماط اللغوية. وعلى الرغم من كل هذا، فإنه حتى الآن لم يؤدِّ إلى كتابة نص أدبي أو شعري، أو أي نص إبداعي بشكل مستقل عن التدخل البشري؛ إذ لا بد من أن يقوم الكاتب المتعامل مع هذه التقنيات، بإعادة قولبة النص، وإضفاء الحبكة الإنسانية على ما كتبته الآلة.
لعله من المثير للاهتمام متابعة التطورات المستقبلية في هذا المجال، ورؤية كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في خلق أشكال جديدة مما يُسمى كتابات إبداعية، وأن نضع نصب أعيننا أن الإبداع الحقيقي يأتي من الإنسانية والتجارب المختلفة والمذهلة، التي يخوضها البشر على مدار حياتهم؛ إذ على الرغم من الإمكانيات الهائلة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، فإنه لا تزال هناك حاجة إلى الإنسان، لإضفاء الروح والعمق على كل الجوانب الإبداعية في حياته، بل إن التحدي الأكبر، الذي سيواجهه هو قدرته على احتواء هذه الإمكانيات التقنية الهائلة، والاستفادة منها بما يساهم في إثراء التجربة الإبداعية والإنسانية.
الظل التقني.. والتلاعُب

فيسيل ريجرز، فليكس ماجوفيسكي، آنا فرينا نوتهوف
ترجمته من الألمانية: شيرين ماهر – مترجمة مصرية
تُرى، كيف سيكون رد فعل أفلاطون تجاه أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل (ChatGPT)؟! ربما كان سيعترف بهذه الأنظمة عادًّا إياها تحدّيًا سياسيًّا، مثلما فعل مع السفسطائيين. ولكن السؤال الأهم: كيف نتعامل اليوم مع الابتكارات التقنية التي يتكشف لنا كونها أحد أشكال السفسطة الحديثة؟
في القرن الخامس قبل الميلاد، شهدت اليونان القديمة اضطرابات ثقافية، تزامنًا مع ظهور السفسطائيين، حيث ظهرت طبقة من «الحكماء»، ادعى بعضهم أن لديهم إجابات عن كل أسئلة البشرية، وسرعان ما انتشرت الحجج السفسطائية في المجتمع اليوناني. لقد كان رموزهم خطباء جرى تدريبهم على أسلوب لغوي مجوف لا يهدف إلى المعرفة بقدر ما يهدف إلى الإقناع. فغالبًا ما كانت تتفوق طريقة العرض على ماهية الطرح الاستفهامية والمحتوى الذي يجري تقديمه للعامة. كل ما يَهُم، بالدرجة الأولى، التأثير الذي يمكن تركه في الجمهور من الناحية الأدائية والجمالية، بواسطة ما يُعرف بـ«الخطابة الاحتفالية» وهي أحد أشكال البلاغة التي تتعلق بالمدح أو الذم؛ فلم يكن البحث السفسطائي عن الحقيقة مرتبطًا، بالضرورة، بالمعرفة الواقعية، وإنما كان هناك انتشار سريع لما نسميه اليوم «الحقائق البديلة» أو «الأخبار المزيفة».
تبدو هذه الظاهرة القديمة معاصرة، بشكل لافت؛ لأن عبارات مماثلة تتكرر، عبر المولدات الخوارزمية التي طورها الذكاء الاصطناعي (AI) من قبل شركة OpenAI؛ ومنها تطبيقات مثل chatbot وChatGPT وهي أحد أنواع نماذج اللغة الضخمة التي تعمل في إطار نماذج مُدربة مُسبقًا بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يمكنها إنشاء نصوص مُحكمة ومنطقية بشكل مثير للدهشة عبر مُدخلات بشرية، تُسمى «المحفزات»، على سبيل المثال: إذا كنت تكتب نصًّا عن «السفسطة القديمة» بواسطة ChatGPT، ستجد التطبيق يلخص الحجج ويرتبها بطريقة منطقية صارمة من حيث الأسلوب، علاوة على توفير إمكانيات اقتصادية غير متوقعة؛ لذلك لا تساعد مولدات الذكاء الاصطناعي في كتابة نص لمجلة فقط، بل يمكنها أن تكون (أكثر ربحية) في نطاق البرمجة، بصفة عامة.
ولكن مع كل هذه الضجة، يجب على المرء أن يضع أيضًا السلبيات في الحسبان. فعلى الرغم من أن الرياضيات والإحصاءات والخوارزميات المتقدمة، تغذي ChatGPT بالبيانات الرقمية، إلا أن الذكاء الاصطناعي ليس آلة معرفة خالصة، لكنه غالبًا ما ينشر هراء لا يُصدَّقُ، وينشر أفكارًا عنصرية ومُحرِّضة على الكراهية وفق احتمالات إقناع نسبية، لكنها مجرد إخفاقات لفظية مكتوبة.
عالم الظل.. وما بعد الحقيقة
بالنظر إلى مثل هذه الإخفاقات، يتبادر إلى الذهن تساؤل مُلِحّ حول كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي. لقد اقترح العديد من المؤلفين والكُتَّاب؛ مثل الصحفي الهولندي، جيسي فريدريك، عَدّ (ChatGPT) مجرد أداة مساعدة وليست بديلة، فيما سيكون التحايل هنا قائمًا على الفرز ومواجهة الهراء المتولد بشكل بناء، للحفاظ على الجيد وتجاهل السيئ. يمكننا أن نتخيل موقفًا مشابهًا في الماضي: بينما كان بعضٌ يستمع إلى سادة الفكر السفسطائي بطريقة تأملية، كان هناك آخرون يتجاهلون آراءهم ويشككون فيها، متجاوزين الحمقى في الملتقيات الفكرية: ولكن، ترى من يهتم الآن؟!
في الماضي، كانت هناك مجموعة صغيرة من الفلاسفة أكثر تشككًا بقيادة سقراط: لقد تعاملوا مع ظاهرة السفسطة ورموزها من السفسطائيين على محمل الجد، وعدُّوهم تحديًا اجتماعيًّا حقيقيًّا. أمّا هم، فلم تكن اللغة أداة محايدة، بل وسيلة يمكنها إغواء الجمهور بواسطة الخطابة التي تمارس الشعر على نحو متناقض؛ فيمكن من خلاله التلاعب ومزج الواقع بالوهم. واستنادًا إلى هذا المنظور السُّقراطي البحت، علينا أيضًا أن نكون حذرين بشأن الذكاء الاصطناعي، لكونه يتماهى مع الفكر السفسطائي، ومن ثم، هناك احتمالية مع استخدام تطبيق ChatGPT أن تعمل وفق النهج نفسه: بمجرد دمج ألعابها اللغوية مع خدمات الإنترنت اليومية، ربما تحولنا إلى حفنة من المتصفحين في عالم الظل التقني -أي في عالم ما بعد الواقع- وقد يحدث ذلك بوتيرة أسرع مما نرغب.
كما أنه لا ينبغي، بالضرورة، أن نفترض أن هذه البرامج حريصة على إعطاء الحقيقة المطلقة. وبصرف النظر عن عبارات العنصرية أو التحريضية والانتقائية، هناك أيضًا مراجع واقتباسات وهمية. كذلك يمكن للبرنامج إنشاء مواقع ويب مليئة بالأخبار المزيفة، التي تنتقل بدورها عبر الإنترنت كالنار في الهشيم وصولًا إلى مستوى جديد وخطير في الوقت نفسه؛ إذ يتحدث النقاد فعليًّا عن «كارثة نصية» محذرين من «انهيار النموذج»- وهي مرحلة لن يتدرب فيها الذكاء الاصطناعي على الأشياء التي سبق إنشاؤها فحسب، بل سيسود أيضًا كل هرائها ويصبح مصدرًا للبيانات التي ستولد بدورها زيفًا لا حصر له.. ترى، من يريد ولا يزال بإمكانه القيام بمراجعة وتفنيد الحقائق في مثل هذا التنبؤ المفزع؟ إنه ضياع تام للحقائق وبلا رجعة.
إثابات المال والكراهية
في مواجهة لغو العبارات السفسطائية، طور الفلاسفة الموالين لفكر سقراط أساليب جديدة لـ«تقصي الحقائق»، التي مهدت الطريق، لاحقًا، إلى ظهور ما عُرف بـ«علم المنطق». حتى إن أفلاطون، تلميذ سقراط، تساءل عن مراحل المعرفة في القصة الرمزية الشهيرة للكهف التي تعكس ماهية الفكر السفسطائي: حيث كان السفسطائيون، بحسب زعمه، يعرضون الظلال فقط على الجدران، متظاهرين بانعكاسات واقع زائف، بينما لا تتجلى الحقيقة إلا عند خروجنا من الكهف، عندما نرى العالم تحت ضوء كاشف من دون ظلال وهمية، وقتها سنصبح «مستنيرين» بمعنى الكلمة- بحسب الرؤى الأفلاطونية.
يمكننا أيضًا أن نسأل -من منظور فلسفي- عن كيفية اقتفاء أثر المعرفة في عالم ChatGPT الذي يكتنفه الغموض. لكننا بحاجة إلى أن نتجاوز مجرد التساؤل عن الحقيقة وأن نفرق، أولًا، بين ما هو «أصلي» و«مستحدث» في أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحيث ستنحصر الإجابة، بشكل حدسي، في كل ما هو «جديد» ما لم يكن موجودًا فعليًّا. ومن هذا المنظور، يمكن قراءة ميلاد الكلمات على أنها بداية لأفكار جديدة، إلا أن التطورات التقدمية في الفن تسمح لنا أيضًا باكتشاف الجديد. لقد طور مصمم الألعاب جيسون إلين Jason M. Allen قالبًا فنيًّا ثوريًّا من خلال الرسم بطريقة مختلفة تمامًا- تجربة جمالية غير معروفة حتى الآن. لكن هل ينطبق الأمر نفسه مع الذكاء الاصطناعي؟!

في العام الماضي، لأول مرة، فاز عمله الذي صممه بمساعدة الذكاء الاصطناعي بالجائزة الأولى في مسابقة فنية صغيرة، حيث استعان «إلين» بمولد الصور Midjourney لإنشاء عمل فني رقمي بواسطة أدوات فلترة موجهة. يمثل عمله الذي حمل اسم « Théâtre d’Opéra Spatial» مزيجًا مستقبليًّا غامضًا يعود إلى عصر الرومانسية المتأخرة وأعمال الرسام النمساوي البارز «Gustav Klimt»، وهو تعديل لرسوم حرب النجوم السماوية بمصاحبة عائلة ملكية على الطراز الياباني، حيث تنظر الشخصيات المجهولة من نافذة مستديرة تطل على مدينة مترامية الأطراف، مع إلقاء نظرة لامعة على المناظر الطبيعية المغمورة، فيما تبدو الصورة غير واقعية، كما لو كانت افتراضية، مُصطنعة، وربما تكون هزيلة بعض الشيء، وكأنها قد أُنشِئَت توًّا.
أمّا هذه اللوحة التي صُنِعَت بواسطة الذكاء الاصطناعي، فتلقى «إلين» كل أنواع التعليقات الكارهة، فضلًا عن 300 دولار. لقد اعترى «إلين» مشاعر الغضب من فوزه بالجائزة بمساعدة متواضعة من صديقه الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي؛ لأنه وفقًا لمفهوم النقد على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يقم بإبداع نسخة أصلية، بل اقتصر دوره على إعطاء تعليمات؛ إذ يبدو الأمر أكثر حساسية مع الأحكام المتعلقة بأعمال الفن والأدب والشعر والجماليات التي يجرى تنفيذها بمساعدة تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أوMidjourney، حيث تكون أصالة العمل والتأليف موضع نقاش جذري- بينما جاء تعليق إلين المقتضب على ذلك: «الفن ميت، يا عزيزي. لقد انتهى بالفعل. الذكاء الاصطناعي انتصر، وخسر البشر». هذا الزهو الجبري لا طائل منه بالنسبة لنا، لأن الفروق بين النصر أو الهزيمة، الإنسان أو الذكاء الاصطناعي لا تبدو مختزلة، بل إنها تخفي حقيقة أن الاختلاف المثير للاهتمام بين الإنسان والآلة يكمن في الطريقة التي يخلقان بها الشيء الجديد نفسه؛ وكيفية ارتباطه بالماضي والمستقبل.
إضاءات وزوايا متغيرة
هذا واضح بالفعل في طريقة عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ إذ يعتمد كل من ChatGPT وMidjourney على كميات هائلة من البيانات الموجودة فعليًّا؛ مليارات الكلمات من الكتب والمقالات عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني وصور الأشخاص والأشياء. يُدَرَّبُ الذكاءُ الاصطناعي التوليدي على هذه البيانات لاشتقاق احتمالات تتعلق بإجراء التنبؤات. ثم يتنبأ تطبيق ChatGPT بالكلمة المنطقية لمتابعة الكلمة السابقة، فيما يطابق برنامج Midjourney أي تكوين لصورة رقمية يناسب نمط إحصائي؛ إذ يبحث الذكاء الاصطناعي عن أوجه التشابه والسياقات المماثلة ثم يخلق ما يسميه العالِم الأدبي، هانيس باجور«المعنى الأحمق»، حيث يجري استخلاص المستقبل من الماضي، بينما لا يُلتقَط المعنى حقًّا، وإنما (إعادة بنائه) بواسطة تحليل الأنماط، التي يجري إنشاؤها استنادًا للاحتمالات.
أشار الصحفي، تيد تشينغ، الذي يعمل في مجلة «The New Yorker» الأميركية، إلى أن تطبيق ChatGPT يعيد صياغة أجزاء من النص من الويب، بينما يوفر بحث Google الاستشهادات. وهكذا يُضغَط النصُّ بشكل مرِن، مثل صورة «JPEG» المضغوطة التي تحذف معلومات معينة لتحويل الصورة إلى تنسيق بياني متناهي الصغر؛ إذ يعملChatGPT بشكل مماثل، في حال الوصول الكامل بالإنترنت؛ لأن المعلومات لا تُنسَخ أو تُقتبَس فحسب، بل تُكثَّف ويُعاد مَزْجُها بصورة متعمدة، بحيث يتولد شكل وحدس جديد للأشياء. قد يبدو الأمر مثيرًا للتساؤل عما إذا كان هذا الشكل الجديد مشابهًا بالفعل لذلك «الجديد» الذي من صُنع الإنسان، وبخاصة أن البشر ليسوا أكثر من «أداة» تتحد بواسطتها الاحتمالات؛ إذ لا يمتلك هذا «الجديد» سوى القليل من سحر البدايات، بينما هو مبني، في الأساس، على الأشياء السالفة.
لكن دعونا نتدرب على تغيير الإضاءات والزوايا: ترى الفيلسوفة حنا آرندت، أن المرء يمكنه الاعتراض على أن الناس لا يتوقعون المستقبل بالطريقة التي تفعلها الآلات. في الواقع، لا يختبر البشر الوقت بوصفه تكثيفًا لتفاصيل الأمس؛ وبدلًا من ذلك، لديهم كل من الذاكرة، والماضي الحي، والتوقعات، بما يخلق مستقبلًا مفتوحًا وخياليًّا وحيويًّا تمامًا. هذا التزامُن اللامتزامِن في الوقت الحاضر، إضافة إلى إمكانية التفكير والتفسير، يجعل من المتاح صناعة «مفاجأة» لخلق آفاق معرفية جمالية مختلفة وغير متوقعة؛ إذ يُظهِر العمل الفني لـ«إلين» أن أنظمة الذكاء الاصطناعي -بغض النظر عن الجودة الجمالية- بواسطة ثرائها بفضل المتغيرات، علاوة على العشوائية والأنماط المثيرة للاهتمام، تخلق حقًّا نوعًا من الإبداع.
وعلى الرغم من تخزين كم هائل من البيانات والمُدخلات، فإن هناك أيضًا حدودًا للإبداع الاصطناعي؛ فمن الصعب إنشاء شيء جديد من الاحتمالات الإحصائية يتضمن تنوعًا انعكاسيًّا للأفعال البشرية، وأشكال التعبير والتخيل، والوعي أو حتى معنى الأشياء نفسها. إن التمييز «الواعي» بين الإنسان والآلة ينطوي على قدر من التميز، ولكن على الرغم من كل قيوده، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي قد وُجِدت في عالمنا الحداثي لتبقى وتُواصِل استمراريتها، لا لِتَفْنَى. يمكننا الآن أن نرثي نظرية الفن أو نستمتع بالتفوق المعرفي المفترض. ولكن هل الاستهزاء بالمنتج الرديء المتولد من هذه الجماليات الرقمية يجعلنا نصل إلى ما هو أبعد من ذلك؟ هل يمكن أن يتطور الأمر لمستويات مقلقة أيضًا؟
وفقًا لفيلسوف التكنولوجيا، برنارد شتيغلر، دائمًا ما تحدد التقنيات مسار المستحضرات الدوائية، فهي داء وترياق في الوقت نفسه. ينعكس هذا -بصورة غير مباشرة – في خطاب الذكاء الاصطناعي الحالي؛ إذ يؤكد بعضٌ جوانبَه السلبيةَ، حيث أصبح بإمكان الذكاء الاصطناعي التعرف إلى مفتاح «اليوتوبيا السيبرانية». أما هؤلاء، فيُعَدّ تطبيق ChatGPT أداة للتقدم، وربما توليفة من التاريخ البشري، وصولًا للتنوير نفسه. ليس من الغريب أن يحتفل الطيف السياسي الواسع بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المدافعين عن الشيوعية المؤتمتة بالكامل حتى أنصار ما بعد الإنسانية التحررية الذين كانوا يثقون لسنوات في الوعود التقنية ويصفونها بـ«التفرد»، بحسب (راي كورزويل)، بينما يقدم الآخرون -ومعظمهم ممن طوروا تطبيق ChatGPT- الجانب المظلم من الذكاء الاصطناعي مستخدمين نبرة الهلاك. إنهم لا يحذرون من فقدان الوظائف فحسب، بل يحذرون أيضًا من القدرة المطلقة لهذه الأنظمة ويرون «ذكاءً خارقًا» يلوح في الأفق، يمكنه أن يقضي على البشرية. إنهم يركزون على الإمكانات الهائلة التي لا تُصدَّق -وإن كان ذلك مرتبطًا بدلالات سلبية- وبالتالي يروجون أيضًا لأساطير السرد الكارثي حول انقراض الإنسان وعالم «ما بعد الإنسانية» بوصفه «خطرًا وجوديًّا» قائمًا تحت مظلة الحداثة الإلكترونية، فيما يبدو ذلك غير بديهي، وإنما حيلة تسويقية تضخيمية، حيث يجرى الإعلان عن المنتج الرقمي ونماذج أعماله بخطاب قوي، فحسب.
تغيرات في العلاقات العالمية
وبعيدًا من «سيناريو الاستيلاء على الذكاء الاصطناعي»، يمكن ممارسة موقف أكثر استرخاءً وعقلانية مع «إيان بوجوست». فمن وجه نظره، لن يكون ChatGPT ترياقًا ولا سمًّا؛ إذ يفتقر الروبوت، ببساطة، إلى الذكاء الفعلي ليكون خطيرًا فعليًّا، بينما يجادل «بوجوست» في مقاله على موقع «The Atlantic» بأن تطبيق ChatGPT ليس نظامًا معرفيًّا، ولكنه نظام جمالي بحت، ولا يهدف إلى إنتاج المعرفة وتقصي الحقائق، وإنما يهدف إلى التعبير والأداء، بدلًا من فهمها الفهم العميق، حيث يجرى التلاعب بالنص، بحيث يقتصر الأمر على مجرد (ترقيع) نصي يفضي في النهاية إلى إنتاج مقالات مَعِيبة أو معيارية ومملة.
ولكن، هل صحيح أن الأنظمة الجمالية لا تنطوي على المخاطر الكامنة في النظم المعرفية؟ يعيدنا هذا السؤال إلى النقد السقراطي للفكر السفسطائي. استنادًا إلى رؤية سقراط، حيث يكمن الخطر في فرضية أن ChatGPT يمكنه أن يستدرجنا إلى شَرك الحقائق المبتذلة وأنصاف الحقائق، وبالتالي تطوير ديناميكية تتغلب على تنوع التعبير البشري. ذلك السحر الجمالي ليس موضع تساؤل فحسب؛ لأن بإمكانه تضليلنا أو أن يجعلنا نتظاهر بأن الأوهام المبهجة هي حقائق واقعية. إنها أيضًا مشكلة قد تدفعنا للاستغراق في حلقات التغذية المعلوماتية السريعة، من واقع تبني معايير اجتماعية تقنية، بكل سهولة ومن دون أدنى شك أو تَحَرٍّ للدقة.
هذا الاتجاه نمارسه فعليًّا في الحياة اليومية. بالطبع لا تزال لدينا القدرة على إيجاد طريقنا في جميع أنحاء المدينة باستخدام الخرائط الورقية، لكننا نستخدم خرائط Google. كذلك لا يزال بإمكاننا مصادفة الحب وتجريب الرومانسية من خلال لقاء الصدفة، ولكن يأمل كثيرون في حدوث أول نظرة مشتركة عبر تطبيق Tinder. النظم السيبرانية لا تحرمنا من الحرية، لكنها تبدو أكثر دقة وراحة، حيث توصي بأسرع الطرق وأفضل المقترحات، وتقدم مسارات عمل معينة، ثم توجهنا في النهاية بالميل التقني الاجتماعي الذي يحصر تنوع السلوك البشري في اتجاهات محسّنة خوارزميًّا.
يمكن أيضًا رؤية تطورًا مشابهًا مع تطبيق ChatGPT، فهو لا يغير فقط كيفية كتابتنا وقراءتنا، وأشكال التعبير التي نتبعها، ولكن أيضًا كيفية إدراكنا للعالم. يجب أن يكون واضحًا أن إمكانية هيكلة الإدراك العالمي، ليست فقط إشكالية استقلالية، لكنها سياسية أيضًا: نظرًا للأهمية اليومية للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. ووفقًا لرؤية الفيلسوف الألماني، يورغن هابرماس، يمكن للمرء أن يتحدث فعليًّا عن «تغيير البنية التحتية الاقتصادية للمنصة في المجال العام»؛ من تسويق وخصخصة الاتصالات الاجتماعية من جانب الشركات الفردية، وبالتالي من منظور التطور الذي يسمح بتداول جميع أنواع الأخبار المزيفة ونظريات المؤامرة؛ إذ يبدو الآن أن هذه اللعبة تتكرر مع نماذج اللغات الضخمة، حيث تحدد أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات، بشكل متزايد، شروط وأحكام علاقاتنا مع أنفسنا والعالم.
نقد الأحكام الآلية
إذن ماذا نفعل؟ كيف يجب أن نتفاعل مع الأنظمة السفسطائية الحداثية؟ أولًا، يجب التشكيك في السرديات في مجال الذكاء الاصطناعي، وعدم أخذ ما ورد بها كـ«مسلمات»: غالبًا ما يتم التأكيد على أن التطور التقني أمر لا مفر منه؛ له جوانب إيجابية، بشكل أساسي، على المجتمع بالرغم من العواقب السلبية غير المقصودة، فيما يحذر، سام ألتمان، أيضًا من مخاطر الذكاء الاصطناعي العام (AGI) الذي يجنح إلى خلق حياة خاصة به، لكنه يدرك «أن الجوانب الإيجابية ستفوق الجوانب السلبية مرات عدة في نهاية الأمر». بالطبع يمكن للمرء أن يبدأ بالأسئلة الفلسفية، ولكن ربما يتطلب الأمر أكثر من الحجج العقلانية.. إذن كيف يعمل الظل التقني؟
نحن بحاجة، أولًا، إلى تغيير موقفنا تجاه أنظمة الذكاء الاصطناعي. يجب أن ندرك أننا لسنا عاجزين، وأنه يمكننا تشكيل التطورات التقنية بشكل ديمقراطي. تلعب المؤسسات الحكومية دورًا رئيسًا هنا، ليس فقط من خلال تعزيز التقنيات، ولكن أيضًا من خلال الحد من تأثيرها. وهناك أمثلة تاريخية توضح كيف يمكن تحقيق ذلك. فعلى الرغم من الخطر الهائل للأسلحة النووية، فقد أُبرِمَت اتفاقيات عالمية تنظم آلية استخدام التقنية من خلال المعاهدات، والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) وبالمثل كان الحال مع تقنيات الاستنساخ البشري، فعلى الرغم من أنها ممكنة تقنيًّا، لكنها تخضع للتنظيم أو الحظر في جميع أنحاء العالم. كذلك، لا يجب أن نستثني أنظمة الذكاء الاصطناعي من هذه اللوائح وضوابط الاستخدام.
ثانيًا، يتعلق الأمر بالمبالغة في التقدير الإيجابي أو الاحتفاء المفرط بمنتجات الذكاء الاصطناعي مقارنة بأشكال التعبير البشرية. لا يتم التأكيد على هذا فقط، من باب الحث على تقدير جهودنا الجماعية في إنشاء بيانات التدريب، وبخاصة أعمال الفنانين والمؤلفين، الذين يرون الآن وجودهم مهددًا. وإنما يجب أيضًا مكافحة النار بالنار، أي استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن تلاعب منتجات الذكاء الاصطناعي؛ إذ يُنصح بمراجعة نظام القيم التقنية الاجتماعية لدينا بشكل أساسي والعمل عليه.
ثالثًا، أهمية تسييس المخيل التقني. هذا يعني ضرورة الاعتراف بأن أنظمة مثل ChatGPT لا تسقط من السماء مثل المَن، ولكنها تستمر في حياكة المشكلات الاجتماعية، بل تُظهِرها. على سبيل المثال، لجعل هذا التطبيق أقل عنصرية أو تحيزًا، استأجرت شركة OpenAI موظفي النقر الكينيين لتصفية المحتوى العنصري ودفعت لهم أقل من دولارين في الساعة. أكد باحثو الذكاء الاصطناعي النسوي، مثل عالمة الكمبيوتر الإريترية Timnit Gebru، أنه منذ سنوات تعكف أنظمة الذكاء الاصطناعي على الجمع بين المدخلات التمييزية و(التحيزات الخوارزمية، وما إلى ذلك)، وتنظمها. لذلك يجب أن ندرك أن النصوص والصور التي تُنشَأُ تَخلقُ أعباءً حقيقية، وأن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى للاهتمام بـ«حساسية التدريب» وفهم مختلف للتقنية؛ وبذل كثير من الوقت في فهم مسألة ما إذا كانت التقنية والفن يتيحان لنا الوصول إلى العالم، وما إذا كان ذلك يساعدنا على فهمه وفهم أنفسنا على نحو أفضل أم لا؟
إن اتباع هذا المسار ليس بالأمر السهل، لأسباب عديدة، حيث يرى، مارك فيشر، أنه «يبدو حاليًّا تخيل نهاية العالم أسهل من تخيل نهاية التقنية الرأسمالية الرقمية». هذا لا يعني أننا يجب ألّا نحاول. ففي ضوء عوالم التقنية السفسطائية الغامضة و«تحليل النص» المعلن عنه، ندرك فعليًّا أننا في عصر «الإنترنت المنقرض» بحسب «جيرت لوفينك»، حيث تدافعت فعليًّا الاحتمالات المندثرة، وهو عصر ترتبط فيه النظم التقنية ونقاط التحول في النظام المناخي ارتباطًا حتميًّا؛ لذا حان الوقت لعدم التكهن بمخاطر الذكاء الاصطناعي المستقبلي الخارق، وإنما ممارسة إشارة جذرية إلى الحاضر؛ لأن «المستقبل هنا بالفعل، لكن هناك توزيع غير متكافئ للحقائق».
رابط الموضوع:
https://www.philomag.de/artikel/technosophistische-schattenspiele
الذكاء الاصطناعي: ثورة علمية أم خطر يهدد الوجود البشري؟

صبحي موسى – صحافي مصري – هدى الدغفق – صحفية سعودية
كان الذكاء الاصطناعي حتى وقت قريب خادمًا جيدًا للإنسان، فمن خلاله أمكنه أن يجمع قدرًا كبيرًا من المعلومات في أقل قدر من دقائق، وأن يكتب نصًّا كان يحتاج إلى وقت طويل في جمعه وضبطه، وأن يوفر وقتًا عظيمًا في حراسة بيته أو إدارة تفاصيل كالإضاءة أو الرقابة أو ري الحدائق. لكنه أصبح خطرًا يهدد وجود الإنسان نفسه، ففي دقائق معدودة أصبح بإمكان الآلة أن تكتب عملًا روائيًّا، أو تنتج لوحة فنية. وأصبح بقدرة الحاسوب أن يرسم ديكورًا لمشهد سينمائي كان يستغرق تجهيزه شهورًا عدة، بل يستخدم وجوه ممثلين وأصوات مغنيين في إنتاج أعمال فنية لم يشاركوا فيها، حتى شهدت هوليوود مظاهرات عشرات العاملين فيها احتجاجًا على استخدام الذكاء الاصطناعي بديلًا عنهم. وما يزيد من خطورة هذا الذكاء أن بمقدور الآلة أن تطور نفسها بنفسها، من دون الحاجة للعودة إلى صانعها، وأصبح بإمكانها إنتاج أجنة من دون الحاجة لوجود كائن بشري. كل هذه التطورات المذهلة مثلت ثورة ليست فقط علمية، ولكن اجتماعية وفكرية واقتصادية وفلسفية، وأصبح على الإنسان أن يجيب عن العديد من الأسئلة التي اعتقد لقرون طويلة أنها صارت بديهية، وأن يقف أمام مرآة نفسه لمعرفة: هل ما زال الذكاء الاصطناعي يخدمه، أم إنه أصبح خطرًا يهدد وجوده على هذه الأرض؟
السعودية… تتقدم العالم

أمـيمة سعودي
في تميز واضح حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول عالميًّا في مؤشر الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي الذي يُعَدّ أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن «تورتويس» الذي يقيس أكثر من 60 دولة في العالم، فيما حصلت ألمانيا على المركز الثاني، وحلت الصين في المركز الثالث. بالنسبة للتصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي فهو يقيس أكثر من 100 معيار ضمن سبعة مؤشرات كالتالي: الإستراتيجية الحكومية، البحث والتطوير، والكفاءات، والبنية التحتية، والبيئة التشغيلية، والتجارة. وقد نالت المملكة المركز الأول في مؤشر الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والمركز 31 في إجمالي مؤشرات التصنيف الصادر عن «تورتويس» وهي شركة عالمية لديها مجلس استشاري عالمي يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم.
وحققت المملكة نسبة 100% في معايير المؤشر من أبرزها، وجود إستراتيجية وطنية مخصصة ومعتمدة للذكاء الاصطناعي بالمملكة، ووجود جهة حكومية مخصصة للذكاء الاصطناعي، ووجود تمويل وميزانية خاصة بالذكاء الاصطناعي، مع تحديد ومتابعة مستهدفات وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي.
اهتمت السعودية بالذكاء الاصطناعي مبكرًا عندما صدر أمر ملكي عام 1440هـ بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» لتكون المرجع الوطني في كل ما يتعلق من تنظيم وتطوير وتعامل. وقادت سدايا التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي، فعملت على تطوير الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي من أجل توحيد الجهود وإطلاق المبادرات الوطنية في البيانات والذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة المثلى.
ساهمت مراكز التميز التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة أهدافها وتطوير منتجاتها في مجالات البحوث والابتكار التي تغطي المجالات الحيوية كافة، وفي مجال التوعية المحلية الدولية نظمت (سدايا) القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختيها عام 2020م و2022م، كما عملت على إنشاء أكاديمية سدايا التي تستهدف تطوير الطاقات الشبابية المهتمة بالذكاء الاصطناعي، وغيرها الكثير من اللقاءات والمنتديات والنشرات. وتعد «سدايا» ذات دور مهم في إطلاق المبادرات الدولية في الذكاء الاصطناعي؛ ومنها إطلاق مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والانضمام إلى شراكة التنمية الرقمية تحت مظلة البنك الدولي. وعملت سدايا على المشروعات العلمية والصحية والبيئية، وأطلقت مركز التميز في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة «كاوست»، وإنشاء مركز التميز في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الصحة، وإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي في البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإطلاق برنامج الكوكب الذكي ضمن مشاريعها البيئية، كما كان لها دور مهم في الإثراء اللغوي من خلال إعداد «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي» وإطلاق منصة «صوتك». وقد نشرت «سدايا» في موقعها الرسمي وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي نتائج الاستطلاع وإحصائيات معدل ثقة المواطنين بالتعامل مع منتجات الذكاء الاصطناعي وخدماته.
الإستراتيجية الوطنية
أطلقت السعودية الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي «نسدي»، للقيام بدورٍ رئيس في رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة والعالم؛ سعيًا للإسهام في تمكين البرامج والقطاعات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي «نسدي»، تحقيق كثير من المنجزات الوطنية المهمة حتى عام 2030م، وأبرزها: الوصول إلى أعلى 15 دولة في الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أعلى 10 دول في البيانات المفتوحة، والوصول إلى أعلى 20 دولة في الإسهام بالمنشورات العلمية، وتطوير الأفراد ببناء مورد مستديم للكفاءات لأكثر من 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يقارب 75 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار أميركي)، وحفْز ريادة الأعمال، والإسهام في خلق أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقد تحققت قفزات في المجالات ذات التقنيات المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الصناعي، ومنها: مدينة «نيوم» شمال غرب المملكة التي تقام على مساحة 26 ألفًا و500 كيلومتر مربع، وتعد نيوم مثالًا ممتازًا على دمج الابتكار الحقيقي في البنية التحتية للمدن، بما سيتيح الفرصة لظهور المركبات ذاتية القيادة، المباني الذكية، والخدمات المتنقلة الجديدة، وإتمام المعاملات عن طريق «المترجم الآلي» الذي يغني عن المترجمين، بما يحقق «رؤية المملكة 2030» التي تهدف ضمن بنودها إلى الانتقال إلى عالم الإبداع والابتكار عبر التطور التقني، إضافة إلى توقيع المملكة مذكرتيْ تفاهم مع شركة مايكروسوفت الأميركية للإسهام في تحقيق التحول الرقمي للمملكة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعد إحدى ثمار الشراكات الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، كما أنه في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، حصلت الروبوت صوفيا على الجنسية السعودية.
تقرير ستانفورد
كذلك توجت المملكة العربية السعودية بالترتيب الثاني على مستوى العالم في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي، بعد أن كشف استطلاع للرأي ارتفاع معدل ثقة المواطنين السعوديين بالتعامل مع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة وفقًا لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي بنسخته السادسة (Artificial Intelligence Index Report 2023)الصادر عن جامعة ستانفورد الأميركية خلال شهر إبريل 2023م. احتلت المملكة عام 2020م المركز الأول عربيًّا، والمركز 22 عالميًّا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، مقارنة بالمركز 29 عالميًّا عام 2019م، وفقًا لتقرير مؤشر «تورتويس».
ختامًا، تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات أو المهام التي كانت تتطلب القوة البشرية فيما مضى، كما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع لا يمكن لأي إنسان تحقيقه، وهو ما يعود بمزايا كبيرة على الأعمال.
يجب على العالم أن يضمن استخدام التقنيات الجديدة، وبخاصة تلك القائمة على الذكاء الاصطناعي، لصالح مجتمعاتنا وتنميتها المستديمة، ومن المهم أن تنظم تطورات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بحيث تتوافق مع الحقوق الأساسية، علاوة على ذلك، يلزم اتباع نهج شامل وعالمي، بمشاركة صناديق الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها، لإيجاد طرق لتسخير الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستديمة.
البقاء للإنسان

عيسى البستكي – رئيس جامعة دبي
مخاوف الخبراء من تطور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في مختلف جوانب الحياة مبررة إلى حد كبير. يتعين علينا أن نتفق جزئيًّا مع هذه المخاوف، ويزداد القلق عندما يتعلق الأمر بإمكانية تطوير الذكاء الاصطناعي ذاتيًّا. إذا كانت لديه القدرة على تعلم وتحسين نفسه من دون تدخل بشري فعليّ، فإنه يمكن أن يتسبب ذلك في فقدان السيطرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تجب مراعاة أن الإنسان سيظل مسيطرًا على العملية الإبداعية لمدة طويلة؛ فالآلات تعتمد بشكل كبير على التعلم من البيانات والخوارزميات التي نصمّمها. وإمكانية التفكير الإبداعي والقرارات الأخلاقية لا تزال في يد البشر. ولدينا القدرة على توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل يحقق المزيد من الفوائد للبشر ويقلل من المخاطر عليهم.
إطار قانوني
الذكاء الاصطناعي برنامج حاسوبي غير عشوائي، أي أن من الممكن أن نتوقع النتيجة ونمنعها عن طريق الذكاء الإدراكي لدى البشر… فالآلة مع الذكاء الاصطناعي برنامج حاسوبي مبرمج من قبل الإنسان… إذًا فالكلمة الأخيرة والسيطرة الأخيرة أو القرار الأخير دائمًا للإنسان؛ لذلك نعتقد أن الإنسان سيظل مسيطرًا على عناصر العملية الإبداعية في المستقبل القريب، ولكن يجب علينا أيضًا أن نتبنى إطارًا قانونيًّا وأخلاقيًّا قويًّا للتنظيم والرقابة على تطور التقنية والذكاء الاصطناعي لضمان استفادة الجميع منها بشكل آمن وفعال.
يتنبأ كتاب «التفرد قريب: عندما يتجاوز البشر علم الأحياء» للكاتب ريموند كرزويل بأن الذكاء الاصطناعي سيتخطى الذكاء البشري في سنة ٢٠٤٥م… وهذه رؤية لا أتفق معها؛ لأن الإنسان دائمًا متقدم على الآلة بخطوة حين يبرمجها، لكن بالنسبة إلى مجالات الفنون والآداب ستكون هناك منافسة بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الإدراكي للإنسان، ولكن البراعة الإدراكية ستتغلب على البراعة الاصطناعية دون أي شك. إن الاحتمالات التي تمتلكها الآلة اصطناعية الذكاء محددة وإن كانت كبيرة جدًّا، وأما الإنسان فالاحتمالات الموجودة لديه في عقله وإدراكه متعددة الإبداعات بسعة شبه لا نهائية؛ فالعقل البشري لا يمكن منافسته عندما يأتي دور الجد ومن أجل البقاء. إذًا يجب أن نطمئن بأن الإنسان هو المسيطر على الآلة اصطناعية الذكاء حاضرًا ومستقبلًا إلى أن تقوم الساعة.
المواجهة العلمية وتشجيع الابتكار

عبدالرحمن المحسني – أكاديمي سعودي
يؤكد المتخصصون أن الذكاء الاصطناعي سيغير خارطة الكون وسينقل مركزيات الاهتمام الدولي، وأنه بعد سنوات قليلة سيكون مكانك هو بمقدار وعيك وقدرتك على التفاعل مع مستجدات الذكاء الاصطناعي ووضع آلياتك المناسبة والبنى التحتية للاستقبال والتفاعل. وفي كتاب سدايا (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي) الصادر عام 2022م يرد ما نصه: «فقد قام مكتب إدارة البيانات الوطنية بالاستفادة من الممارسات والمعايير العالمية عند وضع إطار أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والذي يهدف إلى: دعم وتعزيز جهود المملكة في تحقيق رؤيتها وإستراتيجيتها الوطنية المتعلقة باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتشجيع البحث والابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق الازدهار والتنمية المنشودة…»(١١).
 وهذا الرأي هو عين الوعي الذي لا يقلل من خطورة الذكاء الاصطناعي ويواجهه لا بالتجاهل والتغافل، بل بالمواجهة العلمية وتشجيع الوعي والابتكار البحثي لمعرفة سبل الإفادة وتجنب الخطر. وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أهم دول العالم التي أخذت موضوع الذكاء الاصطناعي بجدية تامة منذ بدايات ظهوره. يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي تتبناها حكومة المملكة والجهات المختصة فيها لمحاولة وعي الظاهرة والتعامل العلمي معها. ولقد يكون من المستغرب في وقت مبكر قليلًا من عام 2015م اهتمام المملكة مثلًا بالروبوت (صوفيا) وهي تقريبًا أول نموذج روبوت ناجح شبيه بالبشر، صممته شركة «هانسون روبوتيكس» في «هونغ كونغ» في إبريل 2015م؛ كي تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشرى، وتعد الأكثر اكتمالًا من منظور الروبوتات الشبيهة بالبشر، ومارست أعمالًا بشرية تمثل نقلة في عمل الروبوت، فنفذت صوفيا أول زيارة لمصر والقارة الإفريقية، كما أجرت العديد من اللقاءات الصحفية في مختلف دول العالم، وتحدثت فيه مع بعض المضيفين. وقدِمت صوفيا إلى الأمم المتحدة في 11 أكتوبر 2017م، وأجرت محادثة قصيرة مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، وأجرت صحيفة الأهرام مع صوفيا لقاءً مطولًا. وهي تستطيع استقبال الكلام وتحليله عن طريق تقنية الـ Block Chain التي تمكنها من الاستجابة لأيّ محادثات تقوم بها، كما أنها تستطيع القيام بأكثر من 60 تعبيرًا للوجه لمحاكاة التعبيرات البشرية، وشاركت في مؤتمرات ومُنحت الجنسية(١٢).
وهذا الرأي هو عين الوعي الذي لا يقلل من خطورة الذكاء الاصطناعي ويواجهه لا بالتجاهل والتغافل، بل بالمواجهة العلمية وتشجيع الوعي والابتكار البحثي لمعرفة سبل الإفادة وتجنب الخطر. وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أهم دول العالم التي أخذت موضوع الذكاء الاصطناعي بجدية تامة منذ بدايات ظهوره. يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي تتبناها حكومة المملكة والجهات المختصة فيها لمحاولة وعي الظاهرة والتعامل العلمي معها. ولقد يكون من المستغرب في وقت مبكر قليلًا من عام 2015م اهتمام المملكة مثلًا بالروبوت (صوفيا) وهي تقريبًا أول نموذج روبوت ناجح شبيه بالبشر، صممته شركة «هانسون روبوتيكس» في «هونغ كونغ» في إبريل 2015م؛ كي تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشرى، وتعد الأكثر اكتمالًا من منظور الروبوتات الشبيهة بالبشر، ومارست أعمالًا بشرية تمثل نقلة في عمل الروبوت، فنفذت صوفيا أول زيارة لمصر والقارة الإفريقية، كما أجرت العديد من اللقاءات الصحفية في مختلف دول العالم، وتحدثت فيه مع بعض المضيفين. وقدِمت صوفيا إلى الأمم المتحدة في 11 أكتوبر 2017م، وأجرت محادثة قصيرة مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، وأجرت صحيفة الأهرام مع صوفيا لقاءً مطولًا. وهي تستطيع استقبال الكلام وتحليله عن طريق تقنية الـ Block Chain التي تمكنها من الاستجابة لأيّ محادثات تقوم بها، كما أنها تستطيع القيام بأكثر من 60 تعبيرًا للوجه لمحاكاة التعبيرات البشرية، وشاركت في مؤتمرات ومُنحت الجنسية(١٢).
آلات تتصرف وكأنها ذكية
يتجه مفهوم الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) إلى الطريقة التي يحاكي من خلالها قدرات الذكاء البشري، وهو جزء من علم الحاسوب الذي يتعامل مع عملية تصميم الأنظمة الذكية التي تُظهر مجموعة من الخصائص تُربَط بالذكاء المتعلق بالعديد من السلوكيات البشرية. ولعل من المهم أن نشير إلى عام 1955م حيث كان جون مكارثي أحد رواد منظمة العفو الدولية أول من حدد هدف الذكاء الاصطناعي على النحو الآتي: الهدف من الذكاء الاصطناعي هو تطوير آلات تتصرف وكأنها ذكية(١٣).
وفي محاورة الباحث مع الذكاء الاصطناعي ذاته وعن دوره في بناء المجتمع، يجيب الذكاء الاصطناعي بما يتجه إلى ما نحن بصدده من ذكر دوره في بناء المجتمع في اتجاهاته المختلفة (علمية واجتماعية وصحية…)، يقول:(١٤) «الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) هو مجال من مجالات الحوسبة يهتم بتصميم وتطوير الأنظمة والبرامج التي تستطيع التفكير والتعلم واتخاذ القرارات بشكل مستقل، وذلك باستخدام مجموعة من التقنيات والأدوات الحاسوبية المتطورة. يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تمثيل الذكاء البشري والتفاعل مع البيئة بشكل مستقل وذكي، وذلك بتحليل البيانات والمعلومات من مصادر مختلفة، واستخدامها لاتخاذ القرارات والتنبؤ بالأحداث المستقبلية. يُستخدَم الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة مثل التجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والتصنيع، والتعليم، والأمن، وغيرها من المجالات الحيوية، وقد أدى التطور السريع في هذا المجال إلى تحسين العديد من العمليات والخدمات المقدمة للمستخدمين».
رؤية الذكاء الاصطناعي
نلحظ أن الرأي السابق هو رؤية الذكاء الاصطناعي ذاته التي تعبر عن دورها البناء في خدمة المجتمع في اتجاهات متعددة. والسعودية تعد واحدة من أكثر دول العالم قدرة على توجيه الذكاء الاصطناعي بما يخدم التنمية، ولديها بنية تحتية مهمة، كما أن لديها أيضًا مدنًا ذكية تعتمد بالدرجة الأولى على قدرات الذكاء الاصطناعي في التفاعل مع الإنسان. ونستذكر هنا أهمية التشاركية الواعية بين الإنسان والآلة، وهو ما تؤكد عليه ستيفانيا جيانيني التي تقول: «يبدو أن أجهزة الحاسوب والبشر الذين يعملون معًا فهم أقوى مما لو عمل كلٌّ بمفرده».
يلفت الانتباه فيما ورد من رأي الذكاء الاصطناعي قوله: «تمثيل الذكاء البشري والتفاعل مع البيئة بشكل مستقل وذكي». ولا أتصور أن فكرة استقلال الذكاء الاصطناعي تفوت على اهتمام المؤسسات السياسية والعلمية؛ فقضية خروج الذكاء عن السيطرة واستقلاله بالتفكير واتخاذ القرار يمثل قلقًا يقول به العلماء المتخصصون في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي بيد أن الوعي به أهم طرق المواجهة، بما يجعل الذكاء الاصطناعي داعمًا مهمًّا للتنمية وإعمار الكون.
الخطر الجديد

محمد الناكوع – باحث تونسي
«مع ظهور كل تكنولوجيا جديدة تتجدد الآمال والوعود بحل مشكلات الإنسان، ولم يصدق هذا، قدر ما يصدق على تكنولوجيا المعلومات والاتصال». بحسب رأي نبيل علي ونادية حجازي في كتاب «الفجوة الرقمية» (عالم المعرفة، الكويت 2005م، ص: 17) وباعتبار انتشار هذه التقنيات في كل الفضاءات وبين مختلف الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية، غير أن الواقع يبدو عكس ذلك، مع تسرّب الخوف من هذا الوافد الجديد، ألا وهو الذكاء الاصطناعي، الذي قد يشكل الخطر الجديد الذي يهدد الإنسان، لا في أمنه فحسب، بل في علاقاته الاجتماعية. والأخطر من ذلك أن يهدّده في قوته، من خلال اختفاء مهن عديدة في المستقبل. وقد يتجاوز ذلك إلى ما يتصل بالوجود الإنساني الذي يشكل التكاثر، وهي الميزة الكبرى في المحافظة على النسل، هذا النسل الذي قد يختفي في صورة حصول التزاوج بين أبناء البشر والآلة.
تهديدات ليست جديدة
في الحقيقة الخطر أو الأخطار التي تهدّد الوجود الإنساني ليست جديدة؛ حيث يذهب بيك أولريش(١٥) إلى أن المفهوم يندرج تحت كل ما يشير إلى تهديد الوجود الإنساني وعدم الأمان لديه، وهو ما يجعل منه مفهومًا قديمًا بقدم البشرية. وهذا أمر كان ينطبق بشكل أكبر على المجتمعات القديمة، من خلال ما كان يهدد الإنسان من مجاعات وأخطار ومن أمراض وأوبئة. غير أن الحديث انتقل اليوم من الخطر في حد ذاته إلى المخاطر المصنوعة أو المصنعة التي تشير حسب بيك أولريش(١٦) إلى «توابع نجاحات الحداثة، حيث تنشأ رعونة جديدة واستهتار بالمخاطرة بسبب فشل مواصفات وشروط حسابها ومعالجتها مؤسسيًّا إلى حد ما… ويشيع النقاش بشأن ما هو لصالح التوابع المحتملة وما هو ضدها».
لنعطي مثالًا على ذلك. مع تفاجؤ العالم بجائحة كورونا، احتد النقاش بين الأطباء حول العلاج الممكن، ولعل «الكلوروكين» من العقاقير التي صارت أكثر شهرة في العالم، وهو «الدواء الذي يُستخدم في العادة للوقاية من الملاريا ومعالجتها». بلغ النقاش أشده حول توابع استعمال هذا الدواء، بين مقلل من شأنها وبين محذر من استعماله باعتبار أن خطر مخلفاته قد يتجاوز خطر «فيروس كورونا نفسه». وما قيل عن «الكلوروكين» يُمكن أن يقال عن الذكاء الاصطناعي، إذا تواصل التعامل معه بمنطق اقتصادي ربحي. وهنا يُطرح السؤال: كيف السبيل لفك هذه العقدة، حتى لا يشتكي الراعي ولا يجوع الذئب، على رأي المثل العربي؟
الاختزال
يقترح علينا بورديزيكس إدوارد(١٧) أربع إستراتيجيات لمقاومة المخاطر المصنعة عمومًا، من بينها اختزال الأخطار، وهو اختزال يجمع بين ثنائية التمسك بالهدف والتعامل مع الأثر، الذي يعني، فيما نتعرض إليه، التشبّث بالتقنيات الحديثة وما قدمته وتقدمه للبشرية من خدمات جليلة، وفي الوقت نفسه بذل كل الجهود للتخفيف من الآثار الجانبية لها. لكن لعل السؤال الذي قد يُطرح: من يتحمل نفقات البحث العلمي الذي سيندرج في إطار التقليص من آثار الذكاء الاصطناعي؟
ضرورة تطوير قانون المصنفات

هاني شنودة – ملحن مصري
يُعد الذكاء الاصطناعي أحدث الثورات في التقنيات الحديثة، ومثلما أن له فوائده فستكون له أضراره. ومؤخرًا سمعنا عن أن أم كلثوم تغني أغنيات ليست لها، وهو ما يحتاج منا وقفة مهمة، ليس لمنع الذكاء الاصطناعي، فهذا أمر قادم لا محالة، ولكن لضبط خطواته وتنظيمه. فالذكاء الاصطناعي لم يصل بعد إلى عالمنا العربي، ربما ظهر وتم التعامل به في بلدان العالم المتقدم، لكنه لم يصل إلينا بشكله الكامل والقوي بعد.
وهذا يستدعي منا أن نعقد مؤتمرًا موسعًا للموسيقيين والملحنين والمغنيين وكتاب الأغاني إلى جانب القانونيين؛ كي نضع القوانين اللازمة لضبط عمل الذكاء الاصطناعي. هناك العديد من الأسئلة التي لا بد من الإجابة عنها عبر هذه القوانين الجديدة، التي ينبغي أن تناسب هذه الثورة الجديدة. من بين تلك الأسئلة: هل يجوز أن توضع صورة أم كلثوم على أي أغنية؟ هل يحق في حالة استخدام صوت أم كلثوم أن يكون لها حقوق مالية وأدبية؟ وحين يوضع صوتها على كلام بذيء أو سيئ أو غير أخلاقي هل لدينا من العقوبات ما يمنع ذلك؟ كل هذه الأسئلة وغيرها لا بد أن تكون لها إجابات قانونية واضحة وحاسمة. ولا بد أن يوجد القانون قبل انتشار التقنية، فعادة ننتظر وقوع الكارثة ثم نَسُنّ القوانين، وتصبح لدينا فيما بعد مشكلة طويلة لا تنتهي. علينا أن نستبق الذكاء الاصطناعي بالقوانين التي تقلل من أثره، ونستدعي المستقبل قبل أن نسقط في هوة الماضي.
قوانين المصنفات
لا بد من التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي سيستعمل في الخير مثلما يستعمل في الشر، ودور المصنفات الفنية هو منع الشر عن المجتمع، والمصنفات الفنية لديها قوانينها التي تعمل بها، لكنها بالتأكيد قوانين غير كافية، ومن ثم فلا بد من تطوير هذه القوانين، وتطبيقها على الذكاء الاصطناعي، علمًا بأن الواقع تحكمه القوانين، لكن شبكة المعلومات الدولية «النت» لا يحكمها شيء. وفي النهاية أؤكد أن الخطر الحقيقي يأتي من الماضي وليس الحاضر أو المستقبل، فحين نضع صوت عبدالحليم حافظ على أغنية جديدة لا بد أن نتأكد إنْ كان الكلام يستحق أم لا، أما المستقبل فليست به مشكلات، بمعنى أنه إذا تمكن الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى توليفة صوت بطبقة معينة، ووضع له كلمات معينة كي يغنيها، فلا توجد مشكلة، وكل ما نرجوه ألّا يجور المستقبل على الماضي ويشوهه.
صدمة الذكاء الاصطناعي

طارق الناصر – مؤلف وملحن أردني
هناك مخاوف من الذكاء الاصطناعي لكنها مؤقتة. أذكر أنني جئت بين مرحلتين: الأولى كانت الفِرق تعزف موسيقا حية، والثانية دخل فيها نظام يسمونه مجازًا بالحاسب الآلي، أي استخدام الحاسب الآلي لأول مرة في تصنيع الموسيقا. وقتها كانت هذه صدمة مثل صدمة الذكاء الاصطناعي الآن. بالتأكيد كانت هناك أشياء سيغيرها؛ لأن هذا هو المصير، فالأمور تسير دائمًا على هذا النحو. وبكل الأحوال فإن التقنيات والروبوتات ستصل لأشياء مثل هذه. وبالفعل هذا ما يحدث منذ بداية الثمانينيات، حين ظهر الحاسوب، وأخذوا يصنعونه بطريقة تجعلك قادرًا على وضع مؤلفك من خلاله، أي أن تصنع الموسيقا التي تريدها من خلال أصوات الحاسوب. وهذه طبعًا أصوات صناعية نسمعها اليوم بأجهزتنا، حيث الرنات في الهواتف المتنقلة وغيره، وهذا كله هو النظام الإعلامي نفسه الذي كان بداية صناعة الموسيقا بالحاسوب.
ليس هناك ما يدعو للخوف
أفادنا الحاسوب في تقنيات التسجيل وغيره، وهذا موضوع آخر، فكل هذه تقنيات للصوتيات أو لصناعة الصوت. أما فيما يخص التلحين والتأليف فأنا أعتقد أنه ليس هناك ما يدعو للخوف؛ لأننا اكتشفنا بعد زمن أن هذا الأمر يظل مرتبطًا بالإنسان؛ لأنه هو القادر على خلقه. وبالتأكيد سيحل الذكاء الاصطناعي كثيرًا من المشكلات، وستنتشر أنواع كثيرة من موسيقاه في الأسواق، وقد يصل الأمر إلى حد الحفلات، لكن ستظل منطقة اللايف محمية؛ لأن الموسيقا الحية لم تتأثر طوال السنوات الماضية، وبالتالي لا يوجد خطر عليها، كما هي حال صناعة الموسيقا في الأستوديوهات. سيؤثر الذكاء الاصطناعي (ai) كثيرًا في هذه الصناعة، وسيغير من شكلها، وهذا طبيعي؛ نظرًا للإمكانيات الهائلة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي.
والآن أين المشكلة؟ بالتأكيد لا توجد مشكلة، لكن يمكن أن نسميها طفرات، فستحدث طفرات في الذكاء الاصطناعي، تعقبها طفرات موسيقية: أفكار جديدة، أصوات جديدة، تراكيب جديدة. ولكن هذه المفردات، حتى لو صنعها الذكاء الاصطناعي، لن تعمل من دون المعطيات التي نغذيه بها؛ إذ لا بد أن تخبره بما تريد. تقول له: نريد لحن أغنية بهذه المواصفات، وبهذا النوع من الموسيقا، وبهذا النوع من الأصوات، وبهذا النوع من المشاعر والانفعال، فمن الذي وضع هذه المدخلات، أليس الإنسان؟!
أفكار ومشاعر
منذ التسعينيات وأنا أتخيل الأمر على هذا النحو، وكنت قد قلت في إحدى القنوات الإعلامية مع مطلع الألفية: إنه سيأتي زمن يمكن لكل إنسان أن يؤلف الموسيقا التي يحبها، وبالطريقة التي يحبها، والذكاء الاصطناعي سوف يساعده؛ لأنه سيحدث طفرات، وسيحدث نقلة نوعية لمناطق ثانية في صناعة الموسيقا. لكن ستظل هذه الموسيقا بلا قيمة ما لم يبث فيها الإنسان أفكاره ومشاعره، بطريقة أو بأخرى. وبعدها سنكتشف أن هذا العمل أفضل من ذاك؛ لأن صانعه وضع فيه أفكاره ومشاعره. لكن هذا التطور سيتوقف إن اختفت الكهرباء، حينها سنبحث عن عازف ناي وعازف عود وعازف طبل…
هذه التقنيات الحديثة مرتبطة بنظام قائم يتغير يومًا بعد يوم حتى أصبحنا نتحدث عن قدرته على تلحين الموسيقا، لكني لا أعتقد ذلك؛ فهذه هي النقطة الجوهرية؛ لأن تأليف الموسيقا مرتبط بمشاعر المؤلف، وهذه المشاعر مثل التشكيل على الحروف: مثل الفتحة والضمة والكسرة، وهي التي تبين المعنى. المشاعر التي يعيشها الإنسان هي التي تجعله يصنع أغنية بكلمات ومواصفات محددة، حتى لو طلب من الذكاء الاصطناعي أن ينفذها، فهذه مجرد تقنيات.
مثلما قلت سابقًا، لقد صنعنا الآلات الإلكترونية المبرمجة من خلال الحاسوب، وقد عملت عليها مدة كبيرة منذ بدايتها، وظللنا نستخدمها طوال المدة التي كنا نقدم فيها الكروكات، فحين لا تكون لدي رغبة في شرح تصوري لمن أصنع له المواد الإعلامية، فإنني أنفذ موسيقاي على الحاسوب. أعمل خريطة، أو أرسم له إسكتش، وهو يُنفِّذ. وظللت منبهرًا بهذه التقنيات طوال حقبة التسعينيات حتى بداية الألفية، لكن فيما بعد أصبحت قناعتي أن الأصوات الحية هي التي ستظل، وهي التي تصنع الموسيقا، وليس المؤلف فقط، فالمؤلف هو الصوت الحي، وستظل له قيمته، وبالعكس ستزداد وتعلو.
إشكالات الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية

كنعان الأحمر – محامٍ تونسي مختص في حقوق الملكية الفكرية
أدت التقنيات ومخرجات الذكاء الاصطناعي إلى إشكالات عديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية عامة، وحقوق المؤلفين المالية والمعنوية على أعمالهم خاصة، سواء أكانت براءات اختراع أو نماذج صناعية، أو علامات تجارية… إلخ. ونقصد بأعمال المؤلفين كل عمل أدبي أو فكري أو علمي، أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه (نص، موسيقا، تصوير، سينما،… إلخ)، مبتكر، ويحمل الطابع الإبداعي الذي يسبغ عليه أصالة فريدة.
الأصالة
الإنترنت عامة هي أهم عنصر في التقنيات التي تستخدم لإنتاج مخرجات الذكاء الاصطناعي، والإنترنت هي عمليًّا آلة نسخ ممتدة عالميًّا، بمعنى أنها تزود متصفح الإنترنت بنسخة على شاشة جهازه عن المحتوى الموجود بها. ولم تكد قوانين الملكية الفكرية تنتهي من احتواء تبعات آلية عمل الإنترنت على الحقوق الفكرية حتى ظهر مؤخرًا الذكاء الاصطناعي الذي لا يُعِيد نسْخ المحتوى كما في الإنترنت فقط، بل يستفيد منه مع مواد أخرى قد تضاف إليه لإنتاج مخرجات جديدة من نصوص أو رسومات أو صور أو أفلام،… إلخ. هذا خلَّف إشكالات وتحديات فلسفية وقانونية وأخلاقية وتطبيقية تتعلق بحق المؤلف وغيره، وما زالت هذه الإشكالات حتى الآن في طور التقويم والمعالجة من دون أجوبة نهائية واضحة.
أول هذه الأسئلة هو، هل ستخضع مخرجات الذكاء الاصطناعي- مثلًا: نص أو رسمة أو قطعة موسيقية أو فِلْم منتج بواسطة الذكاء الاصطناعي- للحماية تحت قانون حق المؤلف مثل الإبداعات البشرية؟ وإن كان الأمر كذلك، فكيف يمكننا حماية مخرجات الذكاء الاصطناعي بحق المؤلف الذي نشأ وتطور كحق طبيعي ذاتي من حقوق الإنسان، حق يهدف لحماية الروح الإبداعية الأصيلة عند الإنسان، ولاحترام التعبير عن الإبداع البشري ومكافأته ماديًّا وتشجيعه؟ ألا يمكن أن يؤدي ذلك لتسفيه الإبداع البشري الإنساني، والقضاء عليه تدريجيًّا من خلال وضعه في منافسة غير عادلة مع التقنيات القادرة على الإنتاج السريع والكثيف والسهل، بما لا يقارن مع قدرة الإنتاج الفردي البشري على الإبداع؟ إضافة لهذه الأسئلة الفلسفية والأخلاقية يبقى السؤال من الناحية العملية والتطبيقية هو: كيف ستستطيع مخرجات الذكاء الاصطناعي أن تحقق أهم شرط للحماية تحت حق المؤلف، وهو الأصالة والإبداع والذاتية المرتبطة بالعامل البشري؟ ومن سيكون مالك الحق؛ من أوجد البرنامج أم من استعمله؟ هذه الأسئلة جميعًا ما زالت من دون جواب، وستبقى كذلك حتى يتم وبشكل واضح ونهائي الاتفاق على تعريف وتحديد الذكاء الاصطناعي نفسه والتقنيات التي تنتجه. ولهذا ما زالت، على نحو عام، مخرجات الذكاء الاصطناعي من دون حماية لحقّ المؤلف.
من الضرورة
الإشكالية المقابلة هي كيفية التعامل مع تبعات وأثر مخرجات الذكاء الاصطناعي على حقوق المؤلف على الأعمال والمواد الإبداعية المحمية للبشر، سواء أكانت نصوصًا أو رسومًا أو صورًا أو أفلامًا سينمائية أو غيرها، التي تُغَذَّى تقنيات الذكاء الاصطناعي بها. والموجودة إما كمحتوى على الإنترنت أو خارج الإنترنت؟ مثلًا؛ من الناحية النظرية القانونية، يستطيع أي شخص اللجوء للنصوص القانونية المعترف بها في مجال حقوق المؤلف، بكل دولة، لمنع استخدام صورته من جانب الآخرين، عبر إنتاج صور مطابقة أو مشابهة، من دون إذنه. ولكن من الناحية العملية، ونتيجة لعولمة الإنترنت والانتشار غير المحدود لبرامج الذكاء الاصطناعي، وسهولة الوصول إليها عبر عدد غير محدود من الناس، وسرعة وسهولة القيام باستخدامها للنسخ أو التقليد في أي مكان من العالم، سيكون من الصعب عمليًّا على معظم المنتجين من الأفراد أصحاب الحقوق، الذين ليس لديهم موارد وإمكانيات الشركات الضخمة الكبيرة، القيام بأي منع للاعتداءات التي قد تصبح غير محدودة على صورهم أو حقوقهم، أو كشف وملاحقة المعتدين الذين يمكن أن يتوزعوا عبر بلدان عديدة. هذا أيضًا يمكن أن يؤدي لتسفيه الإبداع البشري الإنساني والقضاء عليه تدريجيًّا؛ لذا من المُلِحّ والضروري إيجاد الطرق والأطر القانونية والتقنية اللازمة لمعالجة كل هذه الإشكالات.
الذكاء الاصطناعي ودوره في الحياة الحديثة

معمر بن علي التوبي – أكاديمي عُماني مختص بالذكاء الاصطناعي
تجتاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذجه المتعددة حياتنا، لنجد أبعادًا حديثة في مجتمعنا الصناعي الذي يدخل حقبة رقمية متقدمة تتمثل في تغير أنماط تعاملاتنا اليومية في الحياة؛ فنرى السرعة في انتقال المعلومات والبيانات وتحليلها الدقيق، كما طرأت الجودة -بجانب السرعة- في كل شيء. بات الذكاء الاصطناعي كائنًا رقميًّا يأخذ حيّزه الرقمي بجانب التقنيات الرقمية الأخرى، بل نراه شريكًا يزيد من فرص الجودة لوظائف التقنيات المتقدمة. فنرى، مثلًا، قوة ارتباط الذكاء الاصطناعي بالبيانات الكبيرة التي تشكّل وقودًا للذكاء الاصطناعي. وترتبط هذه البيانات كذلك بأنظمة جمع البيانات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء والحساسات الذكية، وبوجود الحوسبة المتقدمة الخاصة بتخزين البيانات الكبيرة وتحليلها مثل الحوسبة السحابية والحوسبة الكوانتمية؛ لتتضح أهمية هذه التكاملية الرقمية التي تجتمع فيها مثل هذه التقنيات معًا؛ ولتشكّل قوة رقمية تعيد من تشكيل واقع حياتنا وتدفع بمجتمعنا الصناعي إلى مصب رقمي تجتمع فيه مكونات رقمية تسمح لسريان صناعي رقمي جديد في حياتنا أوصل المجتمعات الصناعية إلى ما يُعرف بالاقتصاد الرقمي، والتعليم الرقمي وغيرها من التطورات.
تبعات جدلية
من المهم أن ندرك أن أي ظهور تقني أو علمي حديث له تبعاته الجدلية التي تتعلق بتقبل المجتمعات لهذه التغييرات التقنية، من حيث ما يمكن أن تُظهره -في بداياتها- من نقلة غير معهودة. فبسبب هذا التحول، غير المألوف، تبدأ في الظهور بعض المظاهر السلبية التي يمس بعضها النمط المهني أو التفكيري المعتاد في الحياة والمجتمعات. وجدنا ذلك، مثلًا، مع بداية ظهور الإنترنت في بدايات تسعينيات القرن العشرين، وما أحدثه هذا الظهور من قلق لدى بعضٍ من حيث عدم الجاهزية في قبول هذا التحديث التقني المتمثل في الإنترنت؛ بحكم أنه يشكّل تحديًا لمؤسسات وأفراد لا يتقنون التعامل مع نظام اتصال المعلومات مثل الإنترنت؛ فبدأ القلق ينتشر خوفًا من اختفاء مهن تعتمد الطرق التقليدية وتحل محلها أنظمة متقدمة مثل الحاسوب والإنترنت. إلا أن هذه المخاوف، في غضون سنوات قليلة، بدأت تتلاشى مع التخصصات الرقمية الجديدة، ومع تنامي عدد المتخصصين.
ما أشبه اليوم بالأمس؛ إذ يتجلى دور الذكاء الاصطناعي في أنه نظام رقمي يعتمد مبدأ التحليل الدقيق للبيانات، والخروج بمخرجات تنبؤية دقيقة تتجاوز -في كثير من حالاتها- قدرات الإنسان التنبؤية والتحليلية؛ وبالتالي يعمل الذكاء الاصطناعي وفق آلية الدماغ البشري الذي يعتمد الشبكات العصبية وارتباطها وتواصلها، إلا أن الشبكات العصبية في الذكاء الاصطناعي تستعيض عن الأنظمة البيولوجية التي في الدماغ البشري بأنظمة رياضية مثل الأوزان التي ترتبط ببعضها الآخر مشكّلة خلايا عصبية رقمية، وكذلك خوارزميات التعلم الذاتي التي تسمح للنظام الذكي أن يتعلم ويتدرب على البيانات المُدخلة، ويعيد تعديل آلية إدراكه لهذه البيانات بسرعة عالية؛ ليحقق الهدف المنشود، وهذا النوع من الذكاء الاصطناعي الذي يُعرف بالتعلم العميق يشبه الكيفية التي يعمل بها الدماغ البيولوجي.
معظم جوانب الحياة
تعدّت قدرات الذكاء الاصطناعي كل التوقعات، وفي الوقت نفسه تجاوزت المخاوف معظم التوقعات السابقة -قبل الظهور الفعلي للذكاء الاصطناعي- فاقتحمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي معظم جوانب حياتنا. فنجد هذه التطبيقات تتنافس في قطاع الصحة مثل التشخيص المبكر والدقيق للأمراض. فقد أثبت الذكاء الاصطناعي قدرته التي تفوق فيها على الإنسان من حيث السرعة والجودة، والبحث عن الحلول الصحية للأوبئة، وتحليل مكوناتها المعقدة؛ وبالتالي تحديد النمط العلاجي الأفضل والسريع عبر تصميم سريع للأدوية المناسبة. نرى كذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعاملاتنا اليومية عبر هواتفنا وحواسيبنا؛ فباتت ترجمة اللغات أكثر سرعة وجودة بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي، وكذلك الدردشة والدعم الرقمي عبر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل نموذج شات جي بي تي التابع لميكروسوفت وبارد التابع لغوغل.
على الرغم من هذه النقلة الإيجابية في حياتنا بفضل الذكاء الاصطناعي؛ فهناك تحديات ومخاطر تتعلق بوجود الذكاء الاصطناعي الذي يعدّ تفوقه في الذكاء على الإنسان مصدر هذا القلق. تفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان في مجالات كثيرة، وأدى إلى تلاشي بعض المهن التي كان الإنسان يشغلها، كما أن أخطاره تمس قيم الإنسان ووجوده؛ إذ من الممكن أن يقود تفوق الذكاء الاصطناعي إلى تسارع في مجال الصناعات العسكرية والبيولوجية دون أي اعتبارات أخلاقية، إلا أن ذلك -حسب ما أرى- قابل للسيطرة عبر التحكم المسبق بالبيانات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي دون أن يُفقد مكانة الذكاء الاصطناعي ودوره الإيجابي في حياتنا.
هل سينجب الذكاء الاصطناعي في السينما جنينًا أم مسخًا؟

ليث عبد الأمير – مخرج وناقد عراقي
السينما فن إبهار! هكذا ولدت منذ قطار الإخوة لوميير. المشهد الذي صور قطارًا يسير باتجاه الكاميرا فولّد حالة من الدهشة، باندفاعه نحو الجمهور في أثناء العرض الأول له في باريس، وذلك في عام 1896م. والسينما إذ تعمل بهذا الاتجاه، فهي تهدف إلى خلق الصدمات وهز الجمهور. وهنا يصبح دور التقنيات حيويًّا في خلق الإثارة. وهو الأمر الذي يؤكد مدى الترابط الجدلي بين السينما كفن وصناعة.
أصبح، من الضروري، اليوم، التوقف عند كلمة «صناعة»؛ لأنها صارت مثل سمك «قرش الرمل الببري» الذي تتغذى الأجنة من جنسه على الصغار منها داخل الرحم. والتقنيات الحديثة، وبخاصة ما يُسمى بالذكاء الاصطناعي، تجاوزت كل الحدود المرسومة في السينما بين الصناعة والفن، حيث أصبحت الصناعة بانطلاقتها الكبرى متجاوزة للفن نفسه.
الإكستريم
السينما فن يعشق الهدم وتهوى التحرّش بالحدود والتجاوز على المألوف والعادي أو الشائع، بل تتجاوز ذاتها. وفي هذا توجه نحو ما نطلق عليه بظاهرة «الإكستريم» في السينما. ونقصد بالإكستريم: الأقصى، التطرف، التجاوز، المغالاة، الإفراط، البعد عن الوسط، والخروج عن المألوف. وهي ظاهرة ليست بحديثه ولكنها أصبحت مستفحلة في السينما، وفي هذا المنحى، بحسب جيل ليبوفسكي وجان سيرو، حداثة فائقة. تجري اليوم، في مصانع السينما، عملية هدمٍ غير مسبوقة، وهو هدم غير تأسيسي، هدمٌ للشكل، وتجاوزٌ للغة والأسلوب، وكَسْرٌ للمفهوم التقليدي للشاشة وكل هذا يقع ضمن حدود الحالة القصوى (إكستريم).

يقوم الذكاء الاصطناعي في زمننا المعاصر بعمل غاية في الدقة، فهو مشرط الجراح القادر على إزاحة دور الممثل التقليدي، بل حتى استئصال الكاميرا من موقعها، وذلك بفضل برامج الحاسوب القادرة على بناء زوايا تصوير عديدة، من مواقع يصعب على الكاميرا التقليدية الوصول إليها (بسبب أخطار التصوير).
إن هذا الشكل من «سينما الإكستريم» يهوى الأحاسيس والانفعالات العنيفة التي يُعبّر عنها بأشكال غير تقليدية، وذلك بالانجذاب إلى كل ما هو شديد ومُفرِط، ومبالغ فيه، أي هو حالة انفعالية. في هذا السياق يقول ميشيل لاكروا: «لكي نشعر بأننا أحياء، نحن بحاجة إلى تجارب عنيفة»؛ وذلك لأننا نعيش في مجتمعات مخدَّرَة، مُستَلبَة، وغير فعالة. فنحن البشر، حيث نمضي أغلب حياتنا في القلق والخوف والحروب والكوارث، نعيش في رعب دائم وحياة متوترة، نحن بحاجة إلى صدمات تهز أعماقنا وتملأ خواء أرواحنا. وهنا يصبح التساؤل مشروعًا: هل يا ترى سرقت التقنيات من السينما خصوصياتها الجمالية والفكرية والموضوعية؟ وذلك، لأن وسائل التعبير الفنية، قد تغيرت بناءً على مستجدات العصر وتقنياته الجديدة.
ملامح القادم
يبدو أننا لا نستطيع الآن أن نحدد ملامح ما سيأتي. ويصعب البحث عن إجابة في اتجاه واحد، ولكن المؤكد أننا على أبواب عصر جديد، بجماليات سرد من نوع مختلف: استغناء عن الممثلين وكتاب السيناريو، بناء ديكورات افتراضية وإنشاء شخصيات رقمية وتحقيق أشكال غير نمطية للصور. ونحن هنا لا نريد التكهن بالمستقبل، لكن يبدو أن حدود القادم، هو في مرحلة التكوين. وهي حدود جديدة، مفتوحة على فضاءات واسعة، وأخطار جديدة أيضًا.
ربما في هذا انعطافة نحو فن جديد، فن خارج من رحم السينما، فن لا حدود له، فن تصبح الأسطورة فيه أو الخيال والحياة الافتراضية واقعًا يعيش وينمو معنا. وفي هذا إنجاز عظيم للسينما أو العكس فربما هو تهديد للسينما نفسها أو «تدمير»؛ لأن التضخم في دور التقنيات والصناعة سيعمل باتجاه تدميري على حساب الفن نفسه. أو على أقل تقدير، سيسرق جزءًا حيويًّا من الموضوعات المحبَّبة، خلال كل تاريخ السينما العريق. ترى بعد كل هذا هل سيحبل الذكاء الاصطناعي بجنين شرعي أم بمسخ في السينما؟
هوامش:
(١) يوفال نوح هراري (Yuval Noah Harari) من مواليد م1976، مؤرخ إسرائيلي حصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة أُكسفورد سنة 2002م، يعمل أستاذًا للتاريخ بالجامعة العبرية في القدس منذ سنة 2005م، أصدر سنة 2014م كتابه «العاقل. تاريخ موجز للبشرية sapiens. Brève histoire de h l’humanité»، الذي بِيعَ منه أكثر من 23 مليون نسخة، كما أصدر سنة 2017م «الإنسان الإلة؛ تاريخ موجز للمستقبل une brève histoire du futur, Homo deus»، وفي سنة 2018م كتاب «21 درسًا للقرن الحادي والعشرين) (21 leçons pour le XXIe siècle وكلها صدرت في ترجمتها الفرنسية عن دار النشر ألبان مشيل (Albin Michel).
(٢) يان لوكان (Yann Le Cun) من مواليد 1960م، نال شهادة الدكتوراه بجامعة ببير وماري كوري سنة 1987م، يعود إليه الفضل في تطوير ما يسمى «تقنيات التعلم تحت الإشراف»، عمل أستاذًا بجامعة نيويورك سنة 2003م. أسس مختبر البحث حول الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ميتا )فايسبوك سابقًا)، سنة 2013م، وحصل على جائزة تورينغ سنة 2019م التي تعادل جائزة نوبل في مجال المعلوميات.
(٣) Intelligence artificielle: le choc des cerveaux , entretien entre Yuval Noah Harar et Yann Le Cun, Propos recueillis par Héloïse Pons et Guillaume Grallet, le Point 2549 ,11mai2023 , P:48-55
(٤) ألفاغو هي برمجية في كمبيوتر غو طُورت من قِبل غوغل ديب مايند في أكتوبر من عام 2015م، وأصبحت أول برمجية تهزم لاعبًا بشريًّا محترفًا في لعبة الغو، حيث هزمت في مدينة سيول لاعب الشطرنج ليي سيدول lee Sedol، الذي كان يُعَدّ واحدًا من أفضل لاعبي الشطرنج في العالم.
(٥) لفظ يستخدمه الباحثون لأجل الدلالة على بيانات الآلات التي لا تكون لها علاقة بالواقع، فهو في مجال الذكاء الاصطناعي إلى حال تصيب أنظمته، فتجعلها تقدم إجابة غير صحيحة في الواقع أو غير مرتبطة بالسياق المعطى ومع درجة عالية من الثقة تجعلها تبدو مقنعة ظاهريًّا.
(٦) يوفال نوح هراري (Yuval Noah Harari) من مواليد م1976، مؤرخ إسرائيلي حصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة أُكسفورد سنة 2002م، يعمل أستاذًا للتاريخ بالجامعة العبرية في القدس منذ سنة 2005م، أصدر سنة 2014م كتابه «العاقل. تاريخ موجز للبشرية sapiens. Brève histoire de h l’humanité»، الذي بِيعَ منه أكثر من 23 مليون نسخة، كما أصدر سنة 2017م «الإنسان الإلة؛ تاريخ موجز للمستقبل une brève histoire du futur, Homo deus»، وفي سنة 2018م كتاب «21 درسًا للقرن الحادي والعشرين) (21 leçons pour le XXIe siècle وكلها صدرت في ترجمتها الفرنسية عن دار النشر ألبان مشيل (Albin Michel).
(٧) يان لوكان (Yann Le Cun) من مواليد 1960م، نال شهادة الدكتوراه بجامعة ببير وماري كوري سنة 1987م، يعود إليه الفضل في تطوير ما يسمى «تقنيات التعلم تحت الإشراف»، عمل أستاذًا بجامعة نيويورك سنة 2003م. أسس مختبر البحث حول الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ميتا )فايسبوك سابقًا)، سنة 2013م، وحصل على جائزة تورينغ سنة 2019م التي تعادل جائزة نوبل في مجال المعلوميات.
(٨) Intelligence artificielle: le choc des cerveaux , entretien entre Yuval Noah Harar et Yann Le Cun, Propos recueillis par Héloïse Pons et Guillaume Grallet, le Point 2549 ,11mai2023 , P:48-55
(٩) ألفاغو هي برمجية في كمبيوتر غو طُورت من قِبل غوغل ديب مايند في أكتوبر من عام 2015م، وأصبحت أول برمجية تهزم لاعبًا بشريًّا محترفًا في لعبة الغو، حيث هزمت في مدينة سيول لاعب الشطرنج ليي سيدول lee Sedol، الذي كان يُعَدّ واحدًا من أفضل لاعبي الشطرنج في العالم.
(١٠) لفظ يستخدمه الباحثون لأجل الدلالة على بيانات الآلات التي لا تكون لها علاقة بالواقع، فهو في مجال الذكاء الاصطناعي إلى حال تصيب أنظمته، فتجعلها تقدم إجابة غير صحيحة في الواقع أو غير مرتبطة بالسياق المعطى ومع درجة عالية من الثقة تجعلها تبدو مقنعة ظاهريًّا.
(١١) مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الإصدار 1، ص 3.
(١٢) انظر لقاءً مسجلًا معها: صحيفة الأهرام: 19 إبريل 2018م: https://www.youtube.com/watch?v=QiFRJh5czCA
(١٣) انظر: موسى، عبدالله. وبلال، أحمد. (2019). الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنية العصر. ط1. القاهرة. المجموعة العربية للتدريب والنشر. ص 20.
(١٤) موقع AI)). (2023)«ما مفهوم الذكاء الاصطناعي؟». رابط، https://poe.com/s/K06hknsZTOgvsGwHt1Wu، بواسطة المحسني، عبدالرحمن. تاريخ الدخول 15/7/2023. وانظر: المحسني، عبدالرحمن (2023). في أدب الذكاء الاصطناعي: الرؤية والنص (مركز التميز البحثي. جامعة الملك عبدالعزيز)، ص 10.
(١٥) أولريش بيك (2006، ص: 22). “مجتمع المخاطر العالمي، بحثا عن الأمان المفقود«. ترجمة علا عادل وآخرون (2013). المركز القومي للترجمة. القاهرة.
(١٦) أولريش بيك (2006، ص: 27)، المصدر السابق.
(١٧) بورديزيكس إدوارد (2008م، 127 – 128). «إدارة المخاطر والأزمات والأمن»، ترجمة أحمد المغربي. دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة 1، القاهرة.

بواسطة الفيصل | سبتمبر 1, 2023 | الملف
سيرة ذاتية بلا ذات
أو هل نحن ما نكتبه عن أنفسنا؟

فتحي المسكيني – كاتب تونسي
الإشكال
ينطلق هذا المقال من التساؤل التالي: لماذا يكتب المؤلفون في «الغرب» سيرًا ذاتية بقدر واسع من التجرد لا يقيمون فيه اعتبارات كثيرة للقيود المجتمعية، على خلاف الكتاب «العرب» الذين يحرصون على أن تظل صورتهم في سيرهم الذاتية لا تشوبها شائبة، بحيث على العموم لا تتحلى بجرأة الكاتب الغربي؟
قد يوحي هذا التساؤل بأنه يخضع إلى منطق «هم» و«نحن»، وبالتالي لا يُعول عليه في التفكير، إلا أن المنصف لا ينكر أنه ليس فقط يشير إلى إشكال حقيقي، بل هو يحث على التفكير في صعوبة لا تزال بلا تشخيص كافٍ؛ إذ على الرغم من أن العرب، حسب فرانتز روزنتال، مثلًا، قد اكتشفوا «الشعور بالأنا» في كتابتهم عن أنفسهم، فإن «إبداع السيرة الذاتية في الإسلام قد كان أقل ارتباطًا بالشخصية منه بالموضوع. إن تجارب الفرد لم تكن بما هي كذلك في ذاتها تمنح الحافز إلى تشاركها، بل فقط عبر محتواها التعليمي بشكل عام»(١).
ربما من الصعب أن نقبل بوجود «سيرة ذاتية» عند العرب القدامى إلا بتجوز: لقد عرفوا «السيرة»- وهو تقليد يبلغ أشواطه الأخيرة عند السيوطي سنة 1485م تحت عنوان: «التحدث بنعمة الله تعالى»، حيث يقول مؤرخًا لهذا النوع من الكتابة: «ما زالت العلماء قديمًا وحديثًا يكتبون لأنفسهم تراجم. ولهم في ذلك مقاصد حميدة، منها التحدث بنعمة الله شكرًا، ومنها التعريف بأحوالهم ليُقتدى بهم فيها»(٢)– لكن العرب لم يعرفوا «السيرة الذاتية»؛ ليس فقط، إن السيرة الذاتية هي جنس أدبي أوربي حديث (ظهر غالبًا في القرن الثامن عشر كما نرى ذلك في «اعترافات» روسو) لم يدخل الفكر العربي المعاصر إلا بداية من ثلاثينيات القرن العشرين(٣)، بل إن «الذات» نفسها بالمعنى الذي شاع بعد ديكارت وبخاصة منذ كانط، مفهوم غريب عن معجم الملة، ولم يتعامل العرب مع إشكاليته إلا منذ عشرات السنين فقط. ربما ما زلنا نتمرن على تشكيل ذواتنا الجديدة؛ والسؤال اليوم عن أصالة «السيرة الذاتية» هو أحد أشكالها(٤).
الجرأة والتحفظ
لا أحد يحق له أن يدعي أنه «ذات» دون الدخول في أفق الأزمنة الحديثة. و«نحن» اليوم على الأغلب «ذوات» على رغم أنوفنا؛ إذ لا يكفي أن تكون «أنا» حتى تكون «ذاتًا». إن الذات إنشاء وجودي ولغوي «حديث» (له «علاقة بالثقافة الغربية»(٥)، وربما له جذور مسيحية تتعلق بعذابات الضمير بعد «علمنتها»)، ومن ثم هو مستقل تمامًا عن الأنا النحوي التقليدي. إن تقليد «السيرة» -كما فعل العرب في كتب «السير» و«التراجم» و«الوفيات» و«طبقات الأعلام» و«الأنساب»- شيء، وما صار يسمى «سيرة ذاتية» هو شيء آخر. وإن نكتة الإشكال مختلفة بين هذين الجنسين من الكتابة: ربما أن محك «السيرة» التقليدية هو «الحقيقة» التاريخية، أما مقياس «السيرة الذاتية» فهو «جرأة الصدق» أو «البوح». إن من «يترجم لنفسه» (حسب عبارة السيوطي الرشيقة) لا يكتب «سيرة ذاتية»؛ إن مقصد «الترجمة للنفس» هو مطلب أخلاقي ديني هو صناعة «القدوة» في أفق الملة؛ أما مطلب «السيرة الذاتية فهو «البوح»، وهو شخصي محض. وهذا الموقف لم يتغير من السيوطي في «التحدث بنعمة الله» (1485م) إلى المؤلفين العرب المعاصرين، كما نرى ذلك لدى من كتب سيرته مثل فارس الشدياق (أول العرب المعاصرين في هذا الفن) في كتاب «الساق على الساق فيما هو الفارياق» (باريس: دوبراه، 1855م) أو من درس السيرة، مثل إحسان عباس في «فن السيرة» (1956م)، وإن لحظنا انتقالًا واضحًا من القدوة «الدينية» إلى القدوة «الثقافية» حيث وقع الانزياح «نحو السيرة الفنية»(٦).
ومن هنا نأتي إلى السؤال الأساسي: لماذا تكون السير الذاتية التي تأخذ شكل «الاعترافات» أو «اليوميات الحميمية» أو «المذكرات» أو «الأسرار الخاصة» أو «البوح العاطفي» أو «حماقات الطفولة» أو «المحرمات»،… إلخ. أعمالًا أدبية جريئة وصريحة وصادقة في ثقافة، ومتكتمة ومتحفظة ومخاتلة في ثقافة أخرى؟ كيف يكون الكاتب «جريئًا» أمام نوع من «المجتمع» ويكون «متحفظًا» أمام نوع آخر؟ هل هناك علاقة بين «الذاتية» وبين «الخجل من الحقيقة»؟ أو بين الجرأة والفضيحة؟ إلى أي مدى يحق لنا عندئذ أن نصف «سيرة» ما بأنها «ذاتية»، ما دام مقياس طرافتها يوجد خارجها، في «قيود المجتمع» الذي تنتمي إليه؟ هل يمكن كتابة السيرة الذاتية في شكل «دفاع عن الحميمية»(٧) بما هي كذلك ما دامت «السيرة الموضوعية» هي مجرد تناقض في الألفاظ؟
الذات كأنها آخر
لا يتعلق الأمر هنا بالسيرة الذاتية التي تهدف إلى «البطولة». كل «كاتب سيرة ذاتية» يعول على البطولة هو يخدعنا بقدر ما يخدع نفسه. هو لديه «صورة عن نفسه» يريد أن يكرسها أو يدافع عنها. وبهذا هو يخترع سيرة، ولا يكتبها. إن ما يهمنا هو تلك السيرة التي تكون حقًّا «ذاتية»، أي نابعة من «تجارب خاصة» عاشها الكاتب لأنه «كاتب» وليس لأنه شخص في مجتمع له مؤسسة القيم التي تقيد أعضاءه. وأول خاصية «ذاتية» هي عيش ما لا يعيشه «الآخرون» أو «العاديون». لا معنى لما هو «ذاتي» إذا كان سلوكًا «عموميًّا»، أي إذا لم يكن «خاصًّا». إن مقياس الذاتي هنا هو «سياسة الخصوصية»: أي ما لا يُقال إلا لأنفسنا أو كما قال ابن سينا في عبارة رشيقة، «للذين يقومون منا مقام أنفسنا».
طبعًا، علينا أن نسأل أيضًا: متى كان يمكن لكاتب أن يوجد «بمفرده» بمعزل عن «المجتمع» الذي يعيش فيه أو ينتمي إليه؟ ومن المفيد أن نذكر دومًا قولة فيتغنشتاين بأنه لا توجد «لغة خاصة»(٨). كل ما يقال هو قد حدث في لغة لا يقولها أحد لأول مرة بل يستعملها. ومن ثم كل ما يقوله كاتب معين هو لا يعدو أن يكون استيلاء على لعبة لغوية متاحة في أفق ثقافة ما. وعلينا أن نسأل فقط: هل يصدق هذا على ما يقوله عن «نفسه» أيضًا؟ أم يمكنه أن «يمسك لسانه» عندما يكتب عن «ذاته» بوصفه مجرد «صديق» بالتعريف الذي قدمه أرسطو، أي بوصفه «ذاتًا أخرى»؟ وعندئذ نفهم حيلة أنتول فرانس حين سمى سيرته الذاتية «كتاب صديقي»(٩)(!).
إذا كانت اللغة قد «قالتنا» سلفًا -«إذِ القولُ قبلَ القائلينَ مَقُولُ» كما علمنا المتنبي- فمن الواضح جدًّا أنه لا أحد يمكنه أن يتحدث من دون أن «يجرح» أحدًا، نعني دون أن يعامل أحدًا، ولو كان «ذاته»، بوصفه «آخر»، أي بوصفه «متأخرًا» عنه في الوجود أو في الحقيقة أو في الزمان بوجه من الوجوه، أي بوصفه «موضوعًا» أو حتى «شيئًا». أنت «آخر نفسك»، أي أنت متأخر عنها في زمان ذاتك، أي في حضورها عند نفسها. ولأن التأخر عن أنفسنا ليس مشكلًا لغويًّا، فإن «السيرة»- بالمعنى الحرفي «كتابة الحياة» كما عاشها أحدهم أو «كتابة المعيش»، حيث علينا أن نلمح الفرق بين «أن نعيش» (bios) كبشر وبين مجرد «الحياة» (zoé) مثل النبات- هي تثير صعوبة تقع خارج حدود اللغة، من حيث إنها تشير إلى استعمال «الذات كأنها آخر» (حسب عبارة ريكور المأخوذة عن هيغل) تقهقر قليلًا في «مسيره» إلينا داخل الزمان وتحول إلى كائن سردي. من يكتب سيرته هو يحدثنا عن آخر سردي بقدر ما يدعي أنه «هو» وليس شخصًا غيره. السيرة نوع من «كتابة الأنا»، حسب عبارة جميلة لجورج غوسدورف)(١٠) التي تسمح للكاتب بأن يعامل «أناه» بوصفه قد تحول إلى «هو». لا يتعلق الأمر بمجرد تبديل في الضمير من المتكلم إلى الغائب، بل إن الكاتب مدعو إلى بناء علاقة «ذاتية» مع كائن سردي عليه أن يعامله بوصفه «آخر» لا يزال يملك أفضلية وجودية في الادعاء بأنه «نفسه».
حدود الآخرية
لكن حدود «الآخرية» غير واضحة هنا. من هو آخر نفسه؟ – هو من يجرؤ على أن «يفضحها»، أي أن يكشف عما تخفيه عن «الآخرين»، وذلك لسبب أساسي، ألا وهو أنه «يخجل» من شيء ما من نفسه بوصفه مدعاة إلى «الفضيحة» أمام «جمهور» شديد التحديد. إن الآخرية هي هنا ضرب من «سياسة الهوية». وحين يكون من يمارسها هو الكاتب «نفسه» فذلك يضفي طرافة أو خطورة خاصة على المهمة: إن العلاقة بأنفسنا هي عندئذ في جوهرها مشكل سياسي؛ إذ لا تصبح السيرةُ «ذاتيةً» إلا عندما «تبوح» بما لا يستطيع الآخرون قوله أو لا «يحق» لهم قوله. يقف الآخر دومًا على عتبة الذات. يراقبها أو يحبها. أو يقوم بالأمرين كليهما. لكن الآخر هو بالتعريف ذاك الذي لا يحق له سلفًا أن يتكلم باسمنا؛ ذاك الذي لا يملك حقًّا أصليًّا في كتابة سيرتنا الذاتية. فهو لن يكتب أبدًا إلا «سيرة غيرية». وبهذا المعنى هو لا يتكلم بل يحكي. وحده ضمير المتكلم يتكلم. كل ما عداه يسرد قصة. ومن هنا علينا أن نراقب المفارقة التي تهدم مقام الكاتب الذي يقدم على كتابة سيرته الذاتية: هو يقبل معاملة «نفسه» بوصفه «آخر»، وفي اللحظة نفسها هو يحول حياته إلى قصة، أي إلى سياسة للهوية. هو سوف «يختار» عندئذ من «يريد» أن يكون، وليس فقط ما كانه فعلًا. سوف يكون علينا أن نفهم تمييز هايدغر بين «الماضي» (ما وقع في الزمان الطبيعي) و«ما كان» (ما جربناه سابقًا في علاقتنا بأنفسنا). كل كاتب عندئذ هو ادعاء سردي متأخر حول نفسه.
لذلك فإن وراء كل «سيرة ذاتية» يقف سؤال صامت: «من يجرؤ على أن يكون ذاته مرة أخرى دون أي تغيير لتلك الهوية؟». إن «الجرأة» هنا تأخذ هالة خاصة. هي تقودنا إلى أسئلة من هذا القبيل:
– هل ثمة فرق «حقيقي» بين «الذات» التي تكتب وبين «الهوية السردية» التي «تبنيها» عن نفسها؟
– ما معنى أن نصف سيرة ذاتية بأنها «جريئة» أكثر من غيرها؟
– ما الذي يمنع كتابنا من أن يكتبوا سيرًا ذاتية بمثل جرأة تلك التي كتبها كتاب غربيون؟
كل كاتب هو «سيرة ذاتية» وليس «ذاتًا»
إن أخطر سوء فهم لما يفعله «الكاتب» هو أن نختزله في «الشخص»، ومن ثم أن نسمح لأنفسنا بأن نحاسبه وكأنه واحد «منا»، من قبيلتنا أو من ديانتنا أو من دولتنا. قال نيتشه يصف لسان حال كل كاتب: «نادرًا ما أكون شخصًا». علينا أن نقبل بهذا التوصيف: إن الكاتب نادرًا ما يكون شخصًا. إن الشخص المادي هو أضعف انفعالات الكاتب. وإن بعض الانتماء «إلينا» يشبه أن يكون ابتزازًا هوويًّا. من أجل ذلك علينا أن نبدأ أولًا بتحرير الكاتب من الذين يدعون أنه ينتمي إليهم. ليس ثمة «هوية شخصية» ومن ثم ليس ثمة «هوية قومية» جاهزة للكاتب أو تجعل منه كاتبًا. إن شخصية «الكاتب» هي اختراع فني، موقف إنجازي، قوة تداولية، وليس شخصًا طبيعيًّا يمكن أن نحاسبه بوصفه «مواطنًا». علينا أن نرتسم كل انفعال المسافة الذي يفصل الكاتب عن المواطن أو عن شخصه اليومي الذي نعرفه في سياق حياة عامة مشتركة.
ولذلك يجب ألّا تخدعنا ما تسمى «كتابة الذات»: إن «الذات» هي ما يضيفه الإنسان إلى «جسمه». قال سبينوزا: «إن النفس هي فكرة الجسم». لكن «الكاتب» هو شيء آخر: هو ليس «ذاتًا» أو «نفسًا»؛ لأنه ليس «شخصًا» بل هو «شخصية» سردية، أي دور لغوي في نطاق فن إبداعي يحمل توقيعات مختلفة من قبيل «الشعر» أو «الفلسفة» أو «الرواية» أو «الأدب»،… إلخ. كل هذه الأجناس الأدبية تُحيل على «مؤلفين» أي على شخوص إجرائية اختُرِعَت من أجل تنظيم نوع سائد من «سياسة الهوية» في مجتمع بشري: إن سقراط أو الحلاج أو غاليلي أو نيتشه، إلخ. ليسوا «أشخاصًا» بالنسبة إلينا، بل هم «مؤلفون»، أي أسماء سردية تشير إلى أدوار أو وجوه رمزية أو هويات غير طبيعية، بل تم «بناؤها» في ذاكرة عميقة أسس عليها المنتمون إليها تصورهم لأنفسهم.
وبعبارة حادة: كل كاتب هو «سيرة ذاتية» (autobiography) لكنه ليس «ذاتًا» (subject) شخصية. هو «سيرة» أي بناء سردي لذاكرة متخيلة صارت تؤدي «بالنسبة إلينا» دور شخصية «حقيقية» على أساس نوع من «الميثاق الأتوبيوغرافي» الضمني حسب عبارة «كاتب» فرنسي(١١)، أي على أساس نوع من «الالتزام» أمامنا بأن يسرد الكاتب «قصة حياته» بقدر معين من «الصدق» مقابل التزامنا بأن نحكم على ما يسرده بما يكفي من النزاهة والإنصاف. لكن ذلك لا يعني أن الكاتب قد صار شخصًا، أي ذاتًا طبيعية، بل فقط أنه سوف يعيد صياغة أحداث حياته وكأنها وقعت كما يقصها، أي وكأنه هو من «خلقها» كما تصورها. إن السيرة تكون «ذاتية» عندئذ في معنى غريب عن مفهوم «الذات». هي «ذاتية» أي تتعلق بعلاقتنا بأنفسنا، لكنها ليست «ذاتًا» أي لا يؤدي فيها الكاتب دور «الشخص» الطبيعي الذي يمكن أن نحاسبه وكأنه «مواطن» أو عضو في جماعة سياسية. وعلينا أن نتذكر دومًا أن مصطلح «السيرة الذاتية» هو نفسه اختراع أدبي «حديث» أي يشير إلى استحداث ثقافي وأسلوبي خاص بنوع من المجتمعات، وليس إلى صفة طبيعية للبشر.
ذلك يعني أن «من» يكتب عن «نفسه» هو يخترعها، يعيد بناءها، أو هي تقع عليه مثل حجر غريب. «إن السؤال عن الهوية يساهم في تشكيل الهوية»(١٢)، بحيث إن السيرة الذاتية تتعامل مع «الأنا» بوصفه «مادة تشكيلية»(١٣) عليها إعادة صياغتها. وبمعنى ما، تبدو الحاجة المُلِحّة أحيانًا إلى كتابة سيرة ذاتية نابعة من خوف مخاتل ومبهم من انهيار الذات نفسها، أي تشتتها في مقاطع أو شذرات بلا مركز عبثًا يحاول الكاتب أن يلم شتاتها في هوية مستقرة. من يكتب سيرة ذاتية هو بوجهٍ ما يحمي نفسه من جنونه النائم في قصته: قال فوكو: «الجنون هو غياب الأثر».
ولذلك ربما من المخاتلة أن نميز بشكل بارد بين «السيرة الذاتية» و«التخييل الذاتي» (autofiction) الذي ظهر تمردًا رشيقًا على ميثاق السيرة الذاتية(١٤). قال رامبو في إحدى رسائله (13 مايو 1871م): «أنا أريد أن أكون شاعرًا، وأنا أعمل من أجل أن أجعل نفسي عرافًا: أنتم لا تفهمون أبدًا، وأنا لا يمكنني تقريبًا أن أفسر لكم. يتعلق الأمر بأن أبلغ إلى المجهول عن طريق اختلال كل الحواس. إن العذابات هائلة، ولكن ينبغي أن يكون المرء قويًّا، أن يكون وُلد شاعرًا، وأنا قد تعرفت إلى نفسي شاعرًا. ليس هذا ذنبي أبدًا. من الخطأ أن نقول: أنا أفكر: بل قد يجب أن نقول: إن شيئًا يفكرني/ إن أحدهم يفكر في. عذرًا عن التلاعب بالكلمات. أنا هو آخر. اللعنة على الخشب الذي وجد نفسه كمانًا، تبًّا للغافلين الذين يجادلون حول ما يجهلونه تمامًا!».
ما يريده الكاتب أو الشاعر ليس مطلبًا شخصيًّا. إنه لا يريد أن يكون «واحدًا منا». بل هو يكتب كي لا يكون واحدًا منا؛ كي يقع خارجنا، نحن الذين سنقرؤه. إن من يكتب يعرض نفسه لما يقع خارج أفقه كشخص معلوم. الكتابة فن تعريض النفس لما لا يُطاق في أفق الشخص الذي يكونه أيًّا كان. وما لا يُطاق هو أن يصبح المرء كائنًا «آخر»، أي هوية يمكنه أن يسرد قصتها خارج «شخصه» العادي. وهذا يعني أن الكاتب نادرًا ما يكون «نفسه»، أي نادرًا ما يمكنه أن يزعم كما فعل ديكارت، «أنا أفكر». ذلك أن ما «يحدث» هو أن «أحدهم يفكر فيه» أو «يفكره» بفعل قوة لا يراها أو لا تراه. لا يفعل الكاتب سوى أن يعرض نفسه للتفكير، تمامًا كما يعرض نفسه للتهلكة. قال رولان بارت: «أنا لا أعبر عن نفسي، بل أنا أكتبني»(١٥).

الجرأة بين الأدب وسياسة الحقيقة
نأتي هنا إلى المقطع «السياسي» من المشكل، ونسأل: «ما معنى أن نقول عن سيرة ذاتية بأنها جريئة؟». قد يعني ذلك أيضًا أننا نصف سيرة ذاتية أخرى بأنها «جبانة». ولكن ما «الجرأة»؟ هل لدينا تاريخ أو تأويل متفق عليه حول مفهوم «الجرأة»؟ إن تاريخ الجرأة لا يُكتب بالطريقة نفسها أو الدلالة نفسها في مجتمعين مختلفين. عمومًا، يبدو أن الجرأة تُقاس بالثالوث المحرم: نعني بالممنوع الخوض فيه في مسائل الجنس والسياسة والدين، أي ما يتعلق بثلاثية الأب/ الملك/ الإله. أنت لا تُعد «جريئًا» إلا عندما تتخطى حدود الكلام المتفق عليه بين المتخاطبين داخل جماعة تواصلية معينة. والمتفق عليه هو كل ما لا يعرض الثالوث المحرم إلى الخطر، نعني لا يضع سلطة الأب/ الملك/ الإله موضع سؤال. وكل ما عدا ذلك هو قابل للتفاوض الأخلاقي حسب موازين القوى بين المتخاطبين.
إلا أنه لا توجد حدود «كونية» للجرأة بل كل مجتمع يضع لنفسه حدوده الخاصة، أي تعريفاته الخاصة للجرأة وللجريء. وهذا يعني أن تعطل أو تعطيل حدود الجرأة لن يكون مشكلًا شخصيًّا: لا يمكنك اختراع مفهومك الخاص عن الجرأة؛ وذلك أن كل تعريف للجرأة هو مفعول ثقافي لنوع من سياسة الحقيقة يكون شعب ما قد أسس عليها نمطَ السلطة أو أنماطها داخل أُفقه الخاص لفهم نفسه. وبعامة، كان هناك دومًا خط فاصل بين منطقتين من قيم الخطاب، ما يُباح قوله وما يُحظر قوله، وهذا الخط هو الذي يسمح لنا بتحديد درجة الجرأة في خطاب ما. وبالاستناد إلى هذا النوع من الفصل إنما أتى المعاصرون إلى رسم خط قوي بين ما يُقال في «الحياة الخاصة» وما يمكن قوله في «الفضاء العمومي». وبما أن «الكاتب» شخصية عمومية (كل كاتب هو «كاتب عمومي» ولا معنى لكاتب خصوصي) فهو يخضع لهذا التوزيع السياسي للحقيقة. وهو لا يُعَدّ جريئًا فيما يقوله أو يكتبه إلا في ضوء الفصل السائد في مجتمعه بين ما هو «حياة خاصة» (ما يخص جنسه أو جندره أو ميوله أو تجاربه،… إلخ.) وما هو «فضاء عمومي» (ما يهم سلوكه «التخاطبي» إزاء الآخرين ومدى التزامه بقيود مجتمعه).
ذلك يعني عندئذ أنه لا يمكن أن يكون الكاتب جريئًا بالمعنى نفسه في ثقافتين مختلفتين: إن الجرأة هي دومًا وفي كل مرة قيمة ثقافية: أي هي مفعول وظيفي لجهاز معياري ساري المفعول في أفق الفهم الذي يبنيه مجتمع ما عن «نفسه». كل جرأة هي إذن عمل في المفرد ويحمل توقيعًا مجتمعيًّا ويستند إلى مفهوم معين عن الحرية.
ومن حيث التصنيف، هناك على الأغلب نوعان من الجرأة في الأدب: جرأة على الحياة الخاصة، ولا ينحصر ذلك في «الكتابة الحميمية» فقط، فقد تكون «الخصوصية» دينية أو عرقية،… إلخ. وجرأة على الحياة العامة، حيث تدور سياسة الحقيقة بشكل «عمومي» أي «رسمي» و«قانوني» و«أمني». وعلينا أن نسأل: أين تقف جرأة الكاتب؟ هل هي جرأة/ بوح، أم جرأة/ صراحة؟ ربما أن مهنة الكتابة نفسها قد تكون في بعض المجتمعات في حدّ ذاتها جرأة محضة، أي صراحة وقحة وخروجًا صامتًا أو متنكرًا أو خجولًا عن قيود المؤسسة. فمن «يكتب» يخرج عن حدود الكلام العادي حيث يَجْري نشاط تخاطبي وفق خطة «المتفق عليه»، أي ما لا يعرض الاستعمال الرسمي للخطاب إلى الخطر. ولهذا فإن مجرد «استعارة» أو «مجاز» أو «تجوز» أو «تشبيه» يمكن أن يعرض الاستعمال الرسمي للغة إلى مجازفة غير محسوبة. ومن ثم إن كل سيرة ذاتية هي واقعة تحت وطأة «سياسة للكتابة» (حسب تعبير جاك رانسيير)(١٦) تمتد من أفلاطون إلى اليوم.
هناك دومًا ضرورة كي نسأل: ما «حدود السيرة الذاتية؟»(١٧). لا أحد يستطيع أن يطرح السؤال: «كيف عشت؟» أو «كيف سأعيش؟» من دون أن يشعر بأن «تمثيل الذات» يقود بالضرورة إلى استشعار الفاصل المزعج بين «الحياة» وبين «قصة الحياة»؛ إذ لا أحد بإمكانه أن يتحدث عما «عاشه» (وكل حياة يمثل تمثلها بوصفها «صدمة» شخصية مستمرة) من دون أن يستعير من قواعد مجتمعه طريقة تمثيل نفسه أو تمثلها. إن قيود المجتمع هي «هناك» دوما -في «هابيتوس» الخطاب- قبل أن يأتي الكاتب إلى ما يسميه «حياته». ومن ثم كل حديث عن «نفسه» المحكية هو خروج من ذاته الأنطولوجية إلى هوية سردية لا يتحكم في لعبتها إلا جزئيًّا فقط. إن «تمثيل الذات» هو نفسه اختراع مجتمعي ينظم علاقة الأفراد ليس فقط بحياتهم، بل بقصة حياتهم أيضًا. ومن هنا تبدو السيرة الذاتية مثل وصفة علاجية متأخرة لكل مرض قادم: يريد الكاتب أن يجمع حياته في قصة كي يحميها من نفسها، مما عاشته دون أن تراه في لوحة واحدة، أي بلا هوية. ومن ثم لا معنى لأي «تمثيل للذات» لا ينتهي إلى تغيير الذات(١٨).
ومن ثم إن كل جرأة هي تقع سلفًا بين الأدب وسياسة الحقيقة في مجتمعٍ ما: إن «الذاتي» نفسه هو «موقع» دومًا، نعني ليس فقط يحمل بصمة المؤسسة بل هو نتاج داخلي لها. نحن، كما بين فوكو جيدًا، ذوات تَشكَّلت بما خضعت له. ومن ثم إن أي كتابة حقيقية هي مشتقة من جرأةٍ ما: نعني من رغبة حثيثة في أن «نكون على نحو مغاير». قال فوكو: «ثمة لحظات في الحياة حيث يكون السؤال عما إذا كان يمكننا أن نفكر على نحو آخر غير الطريقة التي نفكر بها، وأن ندرك على نحو آخر غير الطريقة التي نرى بها سؤالًا لا غنى عنه حتى نستطيع أن نستمر في النظر أو في التفكير»(١٩).
إن جرأة أي سيرة ذاتية ينبغي أن تُقاس بمدى قدرة كاتبها على أن يفكر في «ذاته» أو أن يرى «شكل حياته» بشكل آخر: أي بمدى استعداده كي يعترف بحدود معرفته بنفسه أو بما فاته من معرفاته بنفسه أو بحياته. لكن «الحق» في الحديث عن نفسه لا يعني أن الكاتب يملك كامل الحرية في أن يكون نفسه مرة أخرى. إن جرأته على أن يقول الحقيقة حول نفسه هي نفسها رهينة سياسة الحقيقة في المجتمع الذي يعيش فيه. ومن ثم هو لا يملك حدود ذاته ما دام لا يملك حدود حقيقته. صحيح أن السيرة الذاتية توحي بأنها عمل «خارج الخدمة»، يسمح للكاتب بالدخول الأسلوبي في ثقافة «الشهادة» أو «الاعتراف» أو «الوصية» أو «التوبة»،… إلخ، ومن ثم كأنه يتحدث بشكل «أركيولوجي» غير قابل للمحاسبة، أي يتعلق بحياة لم يعد يعيشها أحد؛ هي تشبه -حسب أسطورة أفلاطون عن الكتابة في محاورة فايدروس- استدعاء «الأب» الغائب؛ كي يشهد لفائدة «اللوغوس» المكتوب الذي كان محكومًا عليه باليتم لمدة طويلة. لكن الأب هو دومًا جزء لا يتجزأ من ثالوث السلطة، نعني ثالوث الأب/ الملك/ الإله، الذي في ضوئه فقط يمكن لأي مفهوم عن الجرأة في الحديث عن النفس أو عن الحقيقة أن يتشكل.
حدود السيرة الذاتية أو التفاوض بين الصدق والحقيقة
كيف نفهم حدود الجرأة الأدبية في «سيرة ذاتية»؟ هل هي حدود الكاتب أم حدود المجتمع الذي ينتمي إليه؟ هل هي حدود الحرية أم حدود الهوية؟ حدود السيرة كجنس أدبي أم حدود الذات؟ إن سقراط جريء في المدينة اليونانية على نحو مغاير تمامًا لجرأة النبي الإبراهيمي في الجماعة الكتابية؛ ولذلك لا معنى للمزايدة باسم جرأة على أخرى. ومن هنا، لا تكمن خطورة السيرة الذاتية في السؤال: «كيف حكى الكتاب ما عاشوه من تجارب»، بل في شيء آخر: «هل تجرؤوا على أن يصوروا أنفسهم دون تغيير؟». لا يتعلق الأمر بالحقيقة بل بالصدق؛ ذلك أن كاتب السيرة لا يملك من قوة إنجازية غير «ثقة» القراء. وهذا يعني أن ما سُمي «الميثاق الأتوبيوغرافي»، أي أن المؤلف والحاكي والشخصية واحد، ربما هو في شطر منه ادعاء أدبي أو خدعة أسلوبية.
قال أحد الباحثين: «هل ينبغي لصاحب السيرة الذاتية أن يقول كل شيء، وهل يريد ذلك، وهل يستطيع ذلك؟ أليست المطالبة بالصراحة خدعة؟ أليست الحقيقة التي يزعم البعض نقلها، وهمًا وغشًّا؟»(٢٠)، ماذا لو أن كاتب السيرة الذاتية لا يعدو أن يكون مجرد «حامل أسرار» شخص «آخر» لا يملك حق الكلام بلا رجعة؟ ربما داخل كل «منا» هناك «آخر» لم يتكلم قط. وربما لن يفعل أبدًا. وأن من يُقدم على كتابة سيرته الذاتية «هو لا يتوجه إلينا بالخطاب، بل «نحن» مجرد شاشة أو خلفية مخاتلة تساعد غير المرئي للكاتب على الظهور ولو في شكل ظلال سردية. هو ربما لا يكلمنا، بل يساعد الجانب المسكوت عنه من «نفسه» على الكلام. صحيح أنه يقص علينا «وجوده الخاص»، ويحكي عن «تجاربه الفردية»، لكنه لا يفعل ذلك لأنه «يملك نفسه»، أو «سيد ذاته»، بل، على العكس؛ لأن شطرًا خاصًّا وأصيلًا قد ظل محبوسًا في ركن أخرس من «حياته» أو مما يسميه «قصة حياته»، ولم يجد طريقه إلى الخطاب إلا في شكل «سيرة ذاتية». قال مونتاني: «قد يحدث لي ألا أجد نفسي حيث أبحث عنها، فإذا وجدتها كان ذلك بمحض الصدفة» (المقالات، I، 10).
علينا أن نأخذ عبارة «حامل الأسرار» في معنى ما يسمى في لغة المسرح: «النجي» أو «المؤتمن»، أي من يساعد «البطل» على أداء دوره. قد يكون «كاتب السيرة الذاتية» عبارة عن «مساعد للبطل» (أي للمؤلف) وليس هو البطل. إن دوره عندئذ هو أن يقوم بالمهمة «القذرة»: البطل هو الفيلسوف الذي لا يكتب إلا «فلسفة» أو الروائي الذي لا يكتب إلا «رواية». لكن «السيرة الذاتية» هي أقل شأنًا من «أثر» فلسفي أو أدبي؛ لأن «الكاتب» هنا قد يكون «نجيًّا» فقط، أي ساردًا غير مباشر وربما «غير أمين»؛ إذ من يُفشي الأسرار إلا «المؤتمن» عليها؟ قد يفضل الكاتب أن يتحول إلى «نجي»، أي إلى شخصية تحمي البطل من نفسه، أي من «قصته». وتزداد خطورة النجي بقدر انهيار البطل أو فقدانه الطريق إلى عبقريته: هو يخترع له السياق الجيد؛ كي يلتقي نفسَه في قصة تليق بالبطل.
من أجل ذلك لا أحد يكتب «سيرة ذاتية» حقًّا، ولو شبه لنا ذلك كثيرًا. إن أكبر ما يزعج كاتب السيرة الذاتية هو أفق الانتظار وسياسات التوقع. ولذلك هو يلجأ دومًا إلى ما سماه جورج أورويل «قبور الذاكرة»، حيث تُتْلَفُ الوثائقُ في أفران ضخمة، كل سيرة تمتلك قدرًا كافيًا منها. كيف؟ عن طريق «تصحيح أو تكذيب» شيء من أنفسنا؛ «بالتمجيد أو بالثأر»؛ «بالعثور على معنى لوجودنا»؛ ولكن أيضًا، وهو الشيء نفسه، «بالتشويه الإرادي» لمصادر أنفسنا، حيث نصطدم بضرب من «طوباوية الحقيقة والنزاهة»(٢١).
قد نسأل: لماذا يُعد القديس أغسطين جريئًا حين حكى في «الاعترافات» (II، 4، 9) أنه في طفولته «سرق» الكمثرى من بستان الجيران، وأنه قد صار خجلًا من ذلك عند الكبر؟ إن معنى الجرأة هنا ليس «الاعتراف» فقط، بل اعتراف «قديس» بأنه «سارق»: لكن الصدام بين السرقة والقداسة هو هنا تناقض لذيذ ما دام يجري في شكل «حماقة طفل»، وليس في شكل وصية لاهوتية. إن الطفل ينقذ القديس من ذنب السرقة، ويحولها إلى «اعتراف» أدبي أي إلى جرأة ذاتية «مفيدة». وقد نسأل أيضًا: لماذا يُعد فوكو الأخير جريئًا عندما يحكي في حواراته في الولايات المتحدة عن «مثليته» في صيغة «نحن» المثليين؟ ربما هو قد انتهى إلى «الخروج من الخزانة» الذي كان ينقده، لكن ذلك لم يكن «جريئًا» إلا مؤقتًا أو محليًّا فقط، إذ إن المثلية قد صارت معترفًا بها بشكل «جندري» وباتت محمية بالقوانين الشخصية ما بعد الحديثة منذ تسعينات القرن الماضي.
والآن، ما نصيب الكاتب العربي من هذه القضية؟ لماذا يحرص على «سمعته» بمثل هذا الهوس الأخلاقي؟ ما الذي لم يخسره بعد؟ ربما علينا أولًا أن نعود إلى تعريف «السيرة الذاتية»: هل ما حكاه طه حسين في «الأيام»، أو فدوى طوقان في «رحلة جبلية، رحلة صعبة»، أو توفيق الحكيم في «حياتي»، أو ميخائيل نعيمة في «سبعون» أو نوال السعداوي في «أوراقي… حياتي»، أو يمنى العيد في «أرق الروح»… إلخ، هي «سيرة ذاتية» أم «سيرة فكرية» أو «سيرة اجتماعية» أو «سيرة عمومية» بإمكان أي «آخر» أن يكتبها؟ هي «قصص عقلية» وليست «سيرة ذاتية». وعلينا أن نسأل دون مواربة: ما الذي منع «الذات الخاصة» من الكلام في أفقنا الروحي؟ أم السيرة الذاتية العربية لا تزال «بلا ذات» أصلًا؟
لو أخذنا الآن مثالًا «نسويًّا» (بكل تعمد في عصر «قلق الجندر»)، فماذا نجد من «السيرة الذاتية»؟ نعني: من سيرة «الذات الخاصة» الممنوعة أصلًا من الكلام، ليس فقط لدى «الآخر الكبير» (المجتمع) بل «عند نفسها» (حيث تنتصب «هوية» مكرسة ومتسلطة تمنع أي «ذات» منفلتة أو محرمة من أخذ الكلمة أمام نفسها). نلحظ رأسًا أن الموضوع الرئيس للسيرة النسوية لا يزال بشكل مهووس هو «فضح» الهيمنة الذكورية. إن حرص النساء على «كتابة الذات» في شكل «سيرة فكرية» مناضلة وناقدة ومعارضة للنظام الأبوي هو نفسه وقوع غير محسوب في فخ المؤسسة الرسمية التي «سمحت» (تحت ضغط «إبستيمولوجيا الشمال» حيث انتصرت «حقوق الجندر») بأن تقبل ببعض «النقد» النسوي للهيمنة الذكورية، ولكن مع شرط غير مرئي في «العقد السير ذاتي»، ألا وهو ألا تكتب النساء «سيرة ذاتية» بل فقط «سيرة فكرية» موضوعها الوحيد والأوحد هو نقد الذكور، أي نقد الآخر الكبير، ولكن دون خروج عن «قيود المجتمع»، وليس «كتابة الذات الخاصة» حقًّا. إن المؤسسة نفسها (الجامعات، المجلات، مراكز البحث، وسائل الإعلام،… إلخ) هي التي صارت تدفع النساء إلى «كتابة الذات» في شكل «سيرة ذاتية» بلا «ذات خاصة»؛ لأنها سيرة سالبة ونقدية محصورة في مهمة مختومة هي نقد النظام الأبوي بوصفه العدو الرسمي للذات. لا يزال «الذكر» هو محور السيرة النسوية، هو يمنحها الموضوع، ولكن أيضًا هو من يحدد المهمة وأفق الانتظار. وإذا بالسيرة الذاتية تتحول رغم أنفها إلى تمرين «أنثوي كئيب»(٢٢)، نرجسي لكنه ارتكاسي.
في الواقع، إن ما وقع هو حرمان النساء من كتابة الذات الخاصة بكل «واحدة» منهن. ومن ثم حرمان السيرة الذاتية من أن تكون تاريخًا للجرأة الخاصة، وليست استجابة فرحة مسرورة للمنتظر منها في عصر نجح في تدجين هوية النساء عن طريق تبني نضال النساء بوصفه جزءًا من هوية المجتمع ما بعد الأبوي. إن أفق الانتظار الذكوري ما لبث يخاتل بمساعدة النساء على كتابة الذات ولكن من دون خدش لأي نوع من «الحياء» الشرقي. ولذلك حين نشرت غادة السمان «رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان» اختلط الحكم النقدي على «جرأتها» باتهامها بتشويه «سمعة» مناضل؛ إذْ كشفت عن وجهه «الإنساني» بوصفه «عاشقًا»(٢٣). صحيح أن الجرأة قد انحصرت في التنويه بالشجاعة «الأنثوية» على «نشر» امرأة مشهورة لرسائل الحب التي «تلقتها» من كاتب مشهور، لكنها جاءت «بلا مؤلف»، جرأة لبقة، صامتة، تستعمل غيابها بشكل لائق؛ إذْ إن غادة السمان لم تنشر رسائلها التي كتبتها «هي» إلى غسان كنفاني «المعشوق». لقد فضلت «المرأة» في نهاية المطاف ليس فقط أن «تسكت» وتحفظ للنظام الأبوي هيبته الذكورية، بل أن تمتنع صراحة عن التوجه إليه بالخطاب؛ إذ استهلت «الكتاب» (بلا مؤلف) بما سمته «محاولة إهداء: إلى الذين لم يولدوا بعدُ[…] إلى الذين سيولدون بعد أن يموت أبطال هذه الرسائل»(٢٤). لم يكن أمام «السيرة الذاتية» للأنثى سوى أن تستعمل غياب الكاتبة أو أن تتوجه بالخطاب إلى المستقبل.
الرواية العربية والسيرة الذاتية المؤجّلة

فيصل درَّاج – ناقد فلسطيني
يحايث الرواية، نظريًّا، مستويان: أحدهما، يضيء المعيش الاجتماعي في وجوهه المتعددة، ويسرد الثاني فعلًا إنسانيًّا يترجم وجوه المعيش ولا يسيطر عليه، منتهيًا إلى ما يكشف من اغتراب الإنسان ونقصه. يتكشّف المعيش الاجتماعي مرجعًا للاغتراب، ويستَظهِرُ المغترب وجودًا متحولًا يخبر عن المعيش ومآله الذاتي معًا.
أظهرت الرواية العربية، من بداياتها الأولى، علاقة المفرد بالمجموع: «زينب» لهيكل، «عودة الروح» لتوفيق الحكيم، «الأيام» لطه حسين… لكنها أخطأت غالبًا في تصوير الطرفين؛ لأنها اشتقتهما من فضاء مجرد ملتبس، واطمأنت إلى اليقين وتركت الاحتمال مكسوًّا بالضباب.
والسؤال الآن: كيف يكتب الروائي سيرة مجتمع يراه «مجردًا» لا يحتمل التفريد، ولماذا يستهل السيرة الذاتية بمفرد يعود فيذيبه في جملة من الوجوه «الغامضة»؟ وإلى أين تؤول هذه السيرة «المستحيلة» إنْ كانت لا تستقيم إلا بمفرد واضح الحدود؟ يخالط هذه السيرة عجز واضطراب؛ لأنها لا تصدر عن روائي معطوب الأداء، بل عن مجتمع يعوّق السيرة قبل البدء بكتابتها!
فرد مغترب وأمة مهزومة

عبدالرحمن منيف
استهل عبدالرحمن منيف روايته «الأشجار واغتيال مرزوق» 1973مـ بشخصية قلقة مسافرة، زرعت الحياة فيها ما يثير الاضطراب. لكن المسافر، الذي لم تتكشّف سماته بعد، يلتقي مسافرًا آخر له حكاياته المحمّلة باحتمالات تسحبه إلى حيث تريد، أنجز الروائي في رواية من «بواكيره» عملًا منقسمًا -قلق الرؤية- محملًا بأبعاد سياسية اجتماعية ميّزت الرواية العربية بعد هزيمة 1967م، وصفت فيه الخيبة والأمل المُصادر والمراجعة الذاتية الناقصة. ولم يكن الحال مختلفًا في رواية حنا مينه «بقايا صور» 1975م، ولا في رواية الراحلة رضوى عاشور «أطياف» 1999م.
توزعت الروايات الثلاث ثنائية: الوعد المنتظر والمآل المرغوب في سياق عربي انتظر «الثورة» وانتهى إلى نقيضها. تعامل مع «الرموز الأيديولوجية» في لحظة الانتظار ولم يتخلّ عنها في لحظة «مواجهة الهزيمة». فرض السياق «المهزوم» مقولات: الفرد المغترب والأمة «المهزومة الجديرة بالحياة»، والمجتمع المُخْضع الذي لا يختار حكّامه ويصفق لما «لا يرى»… والمقولات جميعها أخلاقية انفعالية، تحجب واقعها بأيديولوجيات غير واقعية، وتتوّهم الجواب في «قول تحريضي» مرجعه الأماني، أو في «قول تعويضي» يكاثر الوهم بجملة الحكايات السعيدة.
يحيل القول التحريضي، كما التعويضي، المفرد المحدد إلى لا مكان، ففي الأول يغيب المفرد قبل أن يحضر، طالما أن التحريضي نسيج من الكلمات وفي الثاني يأتي غائب المحاكمة، فالتعويض الروائي يختار ما شاء من وجوه الحياة التي يجهلها. لا مكان للمفرد، في الحالين، يوجد في الخطابة ويمنع عنه الواقع إمكانية الكلام الصحيح. ومن أين يأتي المفرد في رواية لا تعترف إلا بمفرد مستبد؟ وكيف يتشخصن في رواية محاصرة بالرقابة وجمع من المحرّمات؟

حنا مينه
يقال في علم الاجتماع: إن الإنسان محصلة لعلاقاته الاجتماعية. والمفرد العربي المفترض يتأسس، وفقًا لاجتهادات الأستاذين حليم بركات وهشام شرابي، على التربية الأسرية. التي تشل في الإنسان إرادته وتصادر كيانيته، يتوسطها «تربية ذكورية» لا يفلت منها الإنسان العادي ولا الروائي الذي يتناوله في روايته. يملي المجتمع الذكوري مفردًا مركزه خارجه، لا يُسيّس ولا حظ له من الوعي السياسي، الذي ينطوي على الاختيار والرفض والقبول. يتلو العائلة الحارسة للتقاليد والمحروسة بها مدرسة تربي تلميذها على التلقين والاستظهار، لا يهجس بالمبادرة ولا يذهب إلى أفعال حرة. تبني الأسرة والمدرسة، وهما جهازان تربويان متكاملان، صورة «الدولة الأبوية» حيث الفرد يرى في مرؤوسيه عدوًّا له، مثلما ترى «الدولة» في رعاياها أعداء لها، يتبادلان الكراهية وما يمنع عن شخصية «المواطن» النمو والحركة السليمة.
تبني «التربية الأبوية» شخصية لا تقوى على الفعل، حدّاها: الشفهي- القمعي، تذهب من تجريد إلى آخر. فبعد التربية المشار إليها، في أبعادها الثلاثة، تأتي تربية دينية شكلانية قوامها: الجماعة المؤمنة والجماعة الضالة، جماعتان لا تحتاجان إلى الاختبار، تضمن وجودهما التقاليد المتوارثة التي لا تحتاج بدورها إلى الاختبار. والمحصلة فرد لا فردية له، لا يعترف بذاته ولا يتبادل الاعتراف مع فرديات غامضة، لا تعرف من أين أتت ولا إلى أين تذهب. طبقتان انطوت سيرورتهما على صراع أنتج في التحديد الأخير، فاعلًا إنسانيًّا له مكانه الموائم في «الفعل الروائي»، على اعتبار أن كل طبقة اجتماعية متحوّلة تنتج «أدبية» خاصة بها، تتسع لما يدعى: السيرة الروائية.
فضاء القهر الاجتماعي
على خلاف شخصيات الشرط العربي، ولا أقول الرواية العربية، رسمت الرواية الأوربية شخصيات صقلتها التجربة، وتميزت بفرديتها المبدعة. على سبيل المثال، روبنسون كروزو البرجوازي المغامر المنتج الذي عاش علاقة العمل والملكية الخاصة، الحر في المبادرة والتفكير، وشخصية «آخاب» في موبي ديك الذي اغتصب الطبيعة وهزمته. إذا تركنا كروزو مع زمنه التاريخي، يتبقى لنا، ونحن نتأمل السيرة الذاتية في الرواية العربية، مفهوم: التجربة الفردية المغاير منطقها للكل المجرد والتذهين البلاغي وطقوس الرغبة والإنشاد، تجربة واضحة العناصر والأدوات والأهداف. سجّل صنع الله إبراهيم سيرة ذاتية نموذجية في روايته: «تلك الرائحة»، التي رصدت فضاء السجن في زمن سلطوي قاهر رموزه: «العسكري» الذي يمسح حضور «السجين السياسي»، وإشارات السلطة القمعية في الحياة اليومية، ولغة ميكانيكية تنكر التنوّع والاختلاف. تبدأ الرواية: «قال الضابط»، إعلانًا عن القوة الآمرة، وتنتهي بزيارة الأم الراحلة التي تصرّح: باليتم. فكل البشر في مواجهة السلطة الغاشمة يتامى، وكل الأصوات مقابل الصوت المتسلّط قبضة من أثير.

شريف حتاتة
أعطى حليم بركات سيرة ذاتية في روايته «عودة الطائر إلى البحر». رصد السارد هزيمة حزيران، وكل الهزائم من هزيمة حزيران، منتقلًا من «الضفة الغربية» والأردن ولبنان. نقد تخلّف الوعي الاجتماعي والقومي والوطني داخل الأجهزة السلطوية وخارجها، وعاين غياب المسؤولية الفردية، التمس إيضاحًا في الحكاية الشعبية عن «الضبع والعروس»، حيث الاستسلام للضباع يلقي بالعروس إلى الضباع. تتجلى في الحالين سيرة «عربي» وجهاها الرغبة والعجز والرجولة المستحيلة.
ولعل فضاء القهر الاجتماعي، المحروس بأكثر من رقابة، هو الذي استدعى عالم الطفولة مرجعًا لسيرة ذاتية «بريئة» تجلّت في «طائر الحوم» ورواية «الجبل الصغير» لكل من حليم بركات وإلياس خوري و«البئر الأولى» التي استعاد فيها جبرا إبراهيم جبرا طفولته في مكان فلسطيني ابتعد. ولم يكن حال الفلسطيني الآخر إميل حبيبي مختلفًا في عمله «إخطيّة»، حيث شباب مضى وحبٌّ انقضى وذكريات تستدعي البكاء. ما يسمح بالسيرة الذاتية إذن هي الطفولة التي لا تستثير العقاب أو هزيمة واسعة الألقاب ثقيلة الحراسة.
أملى الواقع العربي المقتصد في الحريات موضوعات السيرة الذاتية وعيّن حدودها، التي انطوت على الطفولة وتجربة السجن وحذفت منه المتخيّل الحر؛ إذ الطفولة مرحلة «ما قبل مجتمعية»، إن صح القول، والسجن معيش يعترف بالمجتمع ويلغيه، وبثبات الإنسان وأحلامه ونداءات جسده وما يحيل على «الثالوث المحرّم» الذي وجوهه: الجنس والدين والسياسة. وهذه الأمور كلها التي تستلزمها السيرة الذاتية غير مسموح لها في الرواية العربية إلا كهامش ناقص.

حليم بركات
لم تعرف الرواية العربية السيرة الذاتية الواضحة إلا في نماذج عارضة، مثل: «الخبز الحافي» للمغربي محمد شكري التي لامست «عالم الحواس» ورغبات الجسد المقموعة؛ ذلك أن الجسد في التربية المسيطرة عورة حدودها «الحلال والحرام»، وهناك رواية المصري الدكتور شريف حتاتة: «العين ذات الجفن المعدنية»، في أجزائها الثلاثة التي عطفت «حركة الجسد» على عنف السجن والسجّان. وما أثارته سيرة «شريف حتاتة» الذاتية يعود إلى رجل شاذ اغتصب طفلًا بريئًا، لا أكثر. ولنا أن نذكّر بسيرة لويس عوض الرائعة «خريف العمر» التي التهمت فيها سريعًا القضايا الاجتماعية ما هو ذاتي وفردي.
سير معوّقة
لم تتعامل القراءة العربية مع أعمال: شكري وحتاتة وعوض، التي تتباين قيمها الأدبية، ككتابة تنتمي إلى «جنس أدبي» معترف به، مارسته الفرنسية كوليت والأميركي هنري ميللر وغيرهما، إنما عاملتها بمعايير بقيم أخلاقية خالصة تقضي على الأدب وتقضي بحديث عن «الشرف والانصياع المجتمعي الواضح الحدود». ومع أن الأدب العربي، كما قضت العادة، لا مكان فيه «للأدب المكشوف». فكتابة السيرة الذاتية في مجتمع «معتل الحرية» يلغيها، أو يأتي بسيرة معوّقة يغلب فيها ما بين السطور على السطور، تُقبل ولا يرحب بها، حال «بعض الجمل» في رواية «تلك الرائحة»، وبعض روايات علوية صبح. وقد يكتنفها الالتباس إن كان الموضوع دينيًّا، حال رواية يحيى حقي: «قنديل أم هاشم». وهناك «المجاز الأدبي» الذي تلوذ به الروايات المحدّثة عن القمع السياسي مثل «الزيني بركات» لجمال الغيطاني. في كل معيش مقموع أبعاد من سيرة ذاتية لها شكل «المجاز»، آيته «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ، و«طواحين بيروت» لتوفيق يوسف عوّاد، وروايات هدى بركات المبدعة الغموض. في هذه الروايات جميعًا صور من الأرض والسماء، الحاضر والماضي، الروح والجسد والرغبة والحرمان.. من المحقق، في النهاية أن السيرة الذاتية لا تقف سليمة في مجتمعات غادرتها الحرية…
كتب الإنجليزي إيان واط في كتابه «صعود الرواية»: «يجب على المجتمع أن يعترف بالفرد اعترافًا حقيقيًّا ليكون موضوعًا جديرًا بالكتابة الأدبية». يظل القول صحيحًا في شرط «السيرة الذاتية الأدبية»، لا أدب إلا بفرد حر ولا سيرة ذاتية أدبية إلا بمجتمع متحرر القراءة والكتابة.
تكتب السيرة الذاتية، إذن، عمّا مضى، متخذة من شخص معين وتطوره موضوعًا لها، تتصف بوعي موضوعي يتعرف إلى الفردية وشروط تحققها، يصرح بما يقول بوضوح متحرر من الرقابات المختلفة. لا يعثر هذا التعريف على عناصره في شرط اجتماعي سلطوي عربي تواجهه عقبات متعددة.
إشارات:
– فيصل درّاج: الذاكرة القومية في الرواية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008م.
– Ian Watt: the rise of the novel 1957, the university of California press.
– Linda Anderson: Autobiogrphy, Rout Ledge, London, 2001, p: 44.
– ينظر أيضًا إلى: Roger Allen: the Arabic novel, Second edition, Syracuse uniersity press, 1995.
أين الذات في السيرة الذاتية؟

شيرين أبو النجا – ناقدة مصرية
يقول لي جيلمور: «لا تستمد السيرة الذاتية قوتها من تشابهها مع الحياة الحقيقية، بقدر ما تستمدها من التجاور مع خطابات الحقيقة والهوية، ولا تستمد قوتها أيضًا من الإحالات والمحاكاة، بقدر ما تستمدها من القوة الثقافية لقول الحقيقة»(٢٥).
إعادة تمثل للماضي
إذا كانت السيرة الذاتية تزعم أنها تقدم حقيقة ما حدث وما وقع للذات في سيرتها ومسارها، فهو بالتأكيد زعم باطل. فالسيرة الذاتية -أو النص الذي يُسمي نفسه هكذا- ليست إلا إعادة تمثل للماضي وهو ما يتضمن ثلاثة عوامل رئيسة: المؤلف أو المؤلفة، الذات المكتوب عنها، واستقبال القارئ للنص في سياق بعينه (زمان ومكان). وعلينا أيضًا أن نتذكر ما حذرنا منه بول ريكور في كتابه «الذاكرة والتاريخ والنسيان» (2000م) عن ضرورة التفرقة بين عملية استعادة ذكرى ما وبين التخييل الذي يُعد عملية تقصد إلى إنتاج خيال ما.
إلا أن السيرة الذاتية لا بد أن تتضمن عناصر التخييل، فإعادة تمثل موقع الذات في الماضي يعني إعادة إنتاج لقصة أخرى، وهو ما يجعلها جنسًا أدبيًّا بامتياز، لا يمكن تفسيره عبر معايير الحقيقة والكذب، بل هو نص يمنح المؤلف/ المؤلفة مساحة ليعيد رسم مسار الذات في محاولة لفهمها. أو كما يقول جوليان إنريك: إن الذات ليست منفصلة عن الجماعة والسياق الاجتماعي، بل هي «واقعة في شبكة تتشكل من الممارسات الاجتماعية والخطابات والذاتية، وحقيقتها نسيج العلاقات الاجتماعية»(٢٦). ووقوع الذات في هذا النسيج المتشابك يستدعي دائمًا التفاوض للمضيّ قُدمًا في امتلاك الفاعلية، التي تُعرفها سوزان ستانفورد بوصفها «ظهور الذوات الإنسانية التي تخلق المعاني، وتقوم بالفعل مع التفاوض مع مجموع الأوضاع في النظام الاجتماعي، مهما كانت محددة ومفروضة»(٢٧).
في كتابة السيرة الذاتية يختار المؤلف أو المؤلفة الممكن من بين الخيارات التي يتيحها السياق. وهو ما يجعل مسار الفاعلية بأكمله محكوم بالتفاوض؛ لأن الذات الواحدة قد تعيش مواقع متعددة وأحيانًا متناقضة طبقًا للواقعة التي تستدعيها الذاكرة. السيرة الذاتية إذن ليست صورة مصمتة وأحادية للذات؛ بل هي لمحة من مسار هذه الذات، ومن هنا تظهر أهمية السياق الذي تستعيده هذه الذات. السيرة الذاتية ليست دالًّا على الهوية إنما دال على التجربة التي تُشكل جوهر مفهوم الذاتية التي تتشكل بدورها «عبر أفعال هذا الشخص أو غيره من فعل الكلام/ الكتابة. والخطاب الذي يتناقض مع خطاب آخر لا يلغي تشكل الشخص وتكوينه من حيث الخطاب الأصلي. إن ذاتية المرء هي بالتالي وبالضرورة متناقضة»(٢٨).
وعليه لا يجب النظر إلى السيرة الذاتية وكأنها تقدم رؤى أو أفكارًا في المطلق، بل هي شذرات استدعَتها الذاكرة لتوضيح موقعية الذات مما يشكل سياق النص. وقد شرح حاتم الصكر هذا الأمر بقوله: إن «الزمن في السيرة الذاتية سيكون ثلاثي الأبعاد: فثمة زمن ماضٍ مستعاد هو زمن الأحداث، وزمن حاضر هو زمن الكتابة، وزمن غير متعين يلقيه وعي القارئ أثناء إنجاز فعل القراءة»(٢٩). بمعنى آخر، تستدعي الذاكرة آليات التفاوض التي اعتمدتها الذات في سياق محدد يحكمه النزعات الشخصية والرغبات والآمال، العوامل المعوقة، أو الداعمة كالعائلة، أو الموروث الثقافي، أو عوامل خارجية دخيلة كالاستعمار والاحتلال تؤطر كل ذلك.

الذات الأنثوية والعالم
في عام 1990م، كتبت جين سعيد مقديسي تجربتها في أثناء الحرب الأهلية اللبنانية «شذرات من بيروت»، وفي شهادتها التي نشرتها مجلة «باحثات» (1995م) تحت عنوان «التعبير عن الذات: لماذا كتبت» تعلق جين على كتابها «شذرات من بيروت»، أنها كتبت ردًّا على الأسئلة التالية: «ما مكاني في العالم؟ هل أنا متفرجة سلبية، مجرد متابعة للأشياء، شخص لا يفهم شيئًا مما يجري حوله؟ أم هل أنا مشاركة فعالة في أحداث زمني؟» يؤرشف «شذرات من بيروت» قصة الذات الأنثوية الممزقة في علاقتها بالعالم في لحظة معينة. ويفترض هذا الموقف أن الذات هنا ليست كاملة مترابطة، ولذلك تصبح الكتابة وسيطًا يسد الفراغ بين الذات والعالم.
تحاول هذه المذكرات أن تعالج فجوات التاريخ وانخلاع الزمان والمكان وغياب الأمان والتردد والمخاوف والاضطرابات. ولا نلمس هناك أي محاولة لإخفاء الذات الممزقة وراء قناع الثبات أو التماسك الحازم. كما لا تحاول الذاكرة سرد الأحداث في خط طولي منتظم يُضفي الوحدة العضوية على مسار الذات. وقد انتقدت النظريات النسوية محاولة إظهار الذات في السيرة بشكل عضوي متماسك؛ لأن الحياة أبعد ما تكون عن ذلك. على سبيل المثال، ترى شاري بنستوك أن الذات العضوية في السيرة الذاتية ليست إلا أسطورة مؤلفة وضعها الميتافيزيقيون في الغرب(٣٠). وقد عمدت ليز ستانلي إلى تحليل كثير من كتابات السيرة الذاتية النسوية، وخلصت إلى أن هذه الكتابات تتحدث بصورة واضحة عن وقوع «أمر ما ثم أمر آخر… ولكن… بصورة فيها وعي واضح بالتشظي الداخلي للذات… وتضع السرد في موقع… يخلق ترابطًا ووحدة هوية للذات»(٣١).
تتردد كلمة تجربة كثيرًا في الخطاب النسوي وفي خطابات أخرى كثيرة، تُراوِح بين الفلسفة والتاريخ والحديث اليومي العادي. واستخدم في هذا السياق تعريف تيريزا دي لوريتس حيث ترى أن التجربة عملية تتكون من خلالها الذات. ولا تجعل دي لوريتس النوع الاجتماعي هو أساس تشكل التجربة، ولكنها تستكشف فكرة التجربة بوصفها ممارسةً يعد النوع الاجتماعي أحد العناصر الحيوية بداخلها(٣٢). وتعقب كارين كابلان على ذلك بقولها: «إن الذات التي تتبدى في هذا العمل لديها مقدرة على الفعل وعلى التحليل الفكري، ووعيها بصدد التشكل، فهو لم يصل إلى صورة ثابتة نهائية بل دائمًا يتشكل من خلال علاقته بالتاريخ»(٣٣).
يتضح هذا الأمر في مذكرات لطيفة الزيات التي صدرت بعنوان: «حملة تفتيش في أوراق شخصية». اشتبكت لطيفة الزيات مع حياتها الشخصية ومع حياتها العامة في الوقت ذاته. فكما يشي العنوان (حملة تفتيش في أوراق شخصية) يجتمع الشخصي والعام ليدفعا الذات إلى الخروج. وعلى الرغم من رحيلها في عام 1996م، فإن سيرتها الذاتية تنتهي في عام 1981م؛ إذ تتأمل وتحلل التغيير الذي أحدثته فيها تجربة السجن الثانية. لا تتبع الزيات أي ترتيب زمني طولي للأحداث ولا تفصل بين الخاص والعام إطلاقًا، فبعد أن تبدأ بعام 1973م حيث موت أخيها تعود إلى عام 1965م حين وقع الطلاق بينها وبين رشاد رشدي: «وبدأ التقييم لمجمل حياتي. وكان زواجي قد أثار من الضجة ربما أكثر مما أثاره طلاقي، فقد انتمينا لمعسكرين متضادين، وإن لم أَعِ أنا هذه الحقيقة في حينه».

تضفير الخاص والعام
لم تتورع فدوى طوقان (1917-2003م) عن تضفير الخاص والعام في سيرتها «رحلة جبلية.. رحلة صعبة» الذي صدر عام 1985م وتبعه الجزء الثاني بعنوان: «الرحلة الأصعب» عام 1993م. تقص طوقان بسلاسة اصطدامها بالمنظومة الأبوية الصارمة في نابلس التي أدت إلى حرمانها من التعليم في سن مبكرة. فكان أن تتلمذت على يد أخيها إبراهيم، ولم تخرج إلى الحياة العامة بشكل كامل إلا بعد نكسة 1967م حيث لم يعد الانكفاء على الذات الفردية قادرًا على تفسير العالم/ لم يكن هناك أي خيار آخر سوى المقاومة.
غني عن الذكر أن السير أو اليوميات التي تناولت المقاومة ليست قليلةً في المكتبة العربية، وتتسم هذه السير بالتركيز على مفردات الوعي ومسار تشكله الذي دفع المؤلفة إلى الانضمام لصفوف المقاومة بأشكالها المختلفة، سواء المقاومة المسلحة للعدو الإسرائيلي مثل كتاب «مقاومة» (2000م) لسهى بشارة حيث وثقت تجربتها أيضًا في معتقل الخيام، أو المقاومة الفكرية الدفاعية لمنظومة أبوية تقليدية راسخة في المجتمع مثل مذكرات هدى شعراوي، أو مقاومة أفكار استشراقية استوعبتها مجتمعاتنا، ثم أعادت إنتاجها مثل «نساء على أجنحة الحلم» (1998م) لعالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي، أو مقاومة أفكار راسخة عن النساء تجعل منظومة القهر في توزيع الأدوار أمرًا طبيعيًّا ومقبولًا مثل: «مذكرات طبيبة» (1985م) لنوال السعداوي. وأحيانًا مقاومة المرض عبر كتابته كما فعلت رضوى عاشور في «أثقل من رضوى» (2013م)، وتبعتها بجزء تالٍ وهو «الصرخة» (2015م). وأخيرًا هناك أيضًا ما أسمته الكاتبة الفلسطينية سحر خليفة «سيرة ذاتية أدبية» حيث دوّنت الأوضاع المصاحبة لمسارها ككاتبة وذلك في «روايتي لروايتي» (2018م).
تتخذ أيضًا السيرة الذاتية أشكالًا أخرى بما يؤكد أن حدود الجنس الأدبي مرنة وقابلة للانزياح، فهناك مثلًا الرواية السير-ذاتية التي يقول الناقد حسين حمودة: إن عالمها يتحرك «حركة رحبة، وأيضًا رواية «المتمردة» 2003م للكاتبة الجزائرية مليكة المقدم، ويصرح الغلاف الخلفي بأن الكتاب مزيج من السيرة الذاتية والخيال الروائي. وفي الممارسة الفعلية للكتابة تستخدم الكاتبة ضمير المتكلم كما في السيرة الذاتية، وتؤكد هذه الرؤية الذاتية بإشارات كثيرة إلى رواياتها السابقة. الساردة هي امرأة جزائرية وصلت سن الرشد في غضون حرب الاستقلال، ثم دفعتها صدمة سنوات ما بعد الاستقلال إلى الهجرة لفرنسا حيث أتمت تعليمها هناك، وفتحت عيادتها الخاصة، وعكفت على الكتابة في مواجهة الأصولية الدينية. وهناك نمط الرسائل مثل: «رسائل الغريبة» للكاتبة اللبنانية هدى بركات (2004م) حيث تجد الكاتبة في النزوح- الذي يبدو إراديًّا- عن المكان، حافزًا على العودة إلى الجذور لتسائل وتؤسس ماضيها هناك (بيروت) وحاضرها هنا (باريس)، وأن تشكل في النهاية سردًا متجاوزًا لا يمكن أبدًا عَدّه صرخة حنين إلى الماضي.
السيرة الذاتية بأشكالها المتعددة ليست مجرد بوح أو فضفضة لهموم، بل هي في حد ذاتها موقف فكري، وموقع معرفي، ونقطة انطلاق، وسعي نحو فهم جاد لمسار الذات وتشكلاتها في ظل العديد من الظروف المتغيرة. تظهر الذات وهي في حالة تغير مستمر وحركة دائمة لا تستقر بشكل مشابه للطبيعة المجتمعية والسياسية للمكان الذي تعيش فيه صاحبة التجربة أو ذاك الذي تأتي منه. وبما أن العلاقات الجيوسياسية والمجتمعية والنفسية تقوم بدور العلامات الدالة على المكان، فإن تلك النصوص تتحرك بحرية بين الشخصي والسياسي حتى تنمحي الحدود بين الاثنين. أي أنها تتجه إلى خارجها لتحتضن التناقضات والنـزوح والتغير، من دون أن تزعم أنها تؤرخ حقيقة ما وقع، ومن دون أن تزعم أنها تتحدث باسم الذات الجماعية. ومن هنا تتجلى أهمية التجربة المعيشة، ومن سماتها عدم الاحتفاظ بشكل ثابت، واحتواؤها على درجة كبيرة من التعقيد. وبما أن الواقع دائم التغير وفق سياسات التاريخ والتاريخانية، فلن يكون هناك أبدًا مقصد نهائيّ اسمه الذات؛ لأن الذات هي سيرورة وسيرة وصورة تتبلور من خلال تجاوز حدود الثابت والمألوف والمرغوب، وتتجاوز محدودية الفهم، وتتجاوز الرغبة في اتباع خط طولي.
«محمد شكري بين غواية العيش والكتابة»
قراءة في مذكرات محمد عز الدين التازي

صدوق نور الدين – ناقد مغربي
قد لا يحتاج الكاتب الراحل محمد شكري إلى مناسبة للكتابة عنه، فهو حاضر باستمرار، وكتبه تمثل أكثر من مناسبة لاستعادته وإثارة نقاش حول موضوعاتها ومضامينها. وللموضوعية فقد صدرت العديد من الدراسات حول الراحل وحياته الأدبية والشخصية. بعضها نال حظًّا من الاستحسان والتداول داخل المغرب وخارجه، وأخرى حالت ظروف دون انتشارها والاطلاع عليها من لدن شريحة واسعة من القراء في العالم العربي، على الرغم من أهميتها. ومن بين هذه الكتب التي صدرت عن محمد شكري -الذي شكلت سيرته بأجزائها الثلاثة «الخبز الحافي»، «زمن الأخطاء/ الشطار» و«وجوه» علامة فارقة في تاريخ السيرة الذاتية العربية- نجد كتاب القاص والروائي محمد عز الدين التازي الموسوم بـ«محمد شكري غواية العيش والكتابة» (باب الحكمة، تطوان).
ينتمي كتاب التازي إلى أدب المذكرات، ويضيء جوانب من حياة «الكاتب العالمي» كما اختار أن يُلقب، ومثلما هو مدون على شاهدة قبره: «هنا يرقد جثمان المرحوم محمد شكري الكاتب والروائي العالمي»، (الصورة/ المذكرات ص: 200). والواقع أن هذه المذكرات تستكمل حصيلة كتابات ظهرت معظمها في حياة محمد شكري (1935- 2003م) في صيغة حوارات أو نصوص سردية حكائية أو رسائل تَكَفَّلَ بصوغها أدباء وكتاب أو بعض المقربين. واللافت أن معظمها صدر في شمال المغرب (طنجة/ تطوان) اللهم «ورد ورماد» (2014م)، وهي الرسائل المتبادلة بين الناقد والروائي محمد برادة ومحمد شكري الصادرة بداية عن وزارة الثقافة، إلى كتاب الروائي الطاهر بنجلون الموسوم بـ«جان جنيه الكذاب الرائع» (غاليمار/2010م)، والمتطرق فيه للعلاقة بين شكري وجنيه.
بين الصداقة والوفاء
تتشكل بنية المذكرات من كلمة، بمنزلة مقدمة، وثلاثة فصول وخاتمة. هذا التشكل يوحي وكأن الأمر يتعلق بتدوين لسيرة ذاتية من منطلق التجاور الذي يصل بين أدب المذكرات والسيرة الذاتية. والواقع أن تلقي هذه المذكرات لا يجعلنا نقف على تفاصيل من حياة محمد شكري لم تجسدها سيرته وحسب، وإنما على مشاهد ذاتية ارتبطت بحياة كاتب المذكرات محمد عز الدين التازي:
«هذه المذكرات، وهي تحمل اسم محمد شكري، تسعى إلى استحضار شخصه، ولحظات ومواقف عشناها معًا أو عاشها مع غيري، فكنت شاهدًا عليها، وبوحًا باح لي به في أوقات عاش فيها قلقه الخاص». (ص/7). من ثم فالدافع الرئيس لكتابة هذه المذكرات هو تمثُّل جوانب حياتية لم يتأتَّ تدوينها. وهو ما يعدُّه التازي، نوعًا من الوفاء لصداقة «امتدت لأربعة عقود». (ص/13) وإذا كانت كتابة هذه المذكرات تتم بالاستحضار اعتمادًا على الذاكرة، وهو ما يسمها بالتكرار الناتج عن النسيان، فما يمكن ملاحظته عن التشكل كون منطلق المذكرات وفق المتعارف عليه من مكوناتها التي يهيمن فيها التحديد الزمني والمكاني إلى سيادة ضمير المتكلم، لم يتحقق سوى في الفصل الثاني حيث الإشارة الزمنية لبداية العلاقة بين التازي وشكري، والمحددة في (1968م). يقول الناقد والروائي محمد برادة (1938م) في كلمته المثبتة على ظهر الغلاف الأخير: «بل إن ذاكرة كل واحد منا لا تكتمل إلا بقدر ما يتسع عدد الذين يستحضرونها من زوايا مختلفة».
من ثم عمد التازي إلى تقسيم المذكرات لأوقات، بدت في استقلاليتها وحدات حكائية، الناظم الجامع بينها شخصية محمد شكري. هذه الأوقات وعددها (29) تبدأ من «وقت للتعارف» وتنتهي بـ«وقت لقبعة القش».
1968م: بداية التعارف
مثلت سنة 1968م، بداية العلاقة التي جمعت بين عز الدين التازي ومحمد شكري. كان الأول طالبًا بكلية الآداب بمدينة فاس، حيث تقع أعرق جامعة «ظهر المهراز» التي تخرج منها أعمدة الأدب المغربي الحديث. ومن ثم هي الجامعة التي كتب عنها الروائي أحمد المديني نصه «رجال ظهر المهراز» (منشورات أحمد المديني/ 2007م). وأما الثاني، فكان معلمًا يدرس بمدينة طنجة.
كان اللقاء بـ«القصر الكبير» إحدى مدن الشمال، حيث تأتى تنظيم مهرجان ثقافي من طرف جمعية «الشعلة» التي تعد من أقدم الجمعيات المغربية التي تواصل أنشطتها الثقافية إلى اليوم.
اعتقد التازي بداية أن محمد شكري كاتب تونسي من خلال قراءته لقصص حرص على نشرها في جريدة «العلم» (لسان حزب الاستقلال). ويعد ملحقها الثقافي المدرسة الأولى للعديد من الأدباء والكتاب المغاربة؛ إلا أنه تفاجأ به يقدم نفسه كالتالي: «أنا مغربي، ريفي، أصلي من الريف، لكني اليوم أعيش في طنجة. هل تأتي إلى طنجة؟» (ص/ 37)
ستثير الإجابة عن هذا السؤال استغراب شكري. فالتازي لم يكن ليسافر سوى بمرافقة جده الذي تكفل بتربيته بعد طلاق والده من والدته. هذه الحكاية، رأى فيها شكري، إلى حد ما، مرآة لذاته ومعاناته الأسرية. ولعل هذا ما أجج أواصر الحميمية والتقارب بين التازي وشكري. «أنت أيضًا عشت محنة مع العائلة؟ قد لا تكون مثلي، فوالدي ذهب إلى الجندية ولم يعد إلا وهو عاطل يتحشش ويضربنا أنا وإخوتي» (ص/ 37).
وسيلمس التازي لاحقًا، الجرح العميق لانتفاء مفهوم «العائلة» عن حياة محمد شكري، لما تقدم إليه الأخير بطلب رعاية ابنه ثلاثة أيام، لولا أن التازي بكياسته أرجأ الأمر لعطلة الصيف المدرسية القادمة: «قدرت ذلك الحرمان الذي يشعر به لكونه لم ينجب أطفالًا، وفكرت في أن ولدي نوفل، ابن العاشرة آنذاك، ربما لن يستأنس بشكري لحد بعيد طوال تلك الأيام الثلاثة، ثم إن شكري لن يتخلى عن عاداته في ارتياد الحانات، فهل سوف يضطر، لإرضاء عادته اليومية، أن يأخذ الولد معه؟» (ص/11).
الحرمان العائلي طبع حياة شكري في صغره، وعلى السواء كبره، وهو ما جعله «على قلق» باستمرار؛ إلا أن التباين الذي وسم العلاقة في بدايتها، كون التازي كان منتميًا سياسيًّا، فيما أخلص شكري للثقافة والأدب: «أنا لست مسيسًا. لكني مع الإنسان المغربي المسحوق» (ص/35).
طنجة الأسطورية: النهاريون والليليون
سيزور محمد عز الدين التازي طنجة صيف 1969م، لتكون اللحظة بداية صداقة متواصلة إلى أن غيب الموت الراحل محمد شكري. ولمناسبة الزيارة، اقترح شكري الإقامة في بيته عوض الفندق. واشترط شرطين: الأول أن يشتري التازي الفراش الذي ينام عليه. والثاني، أنه في حال الفاقة والعوز، سيضطر لبيعه. هذا السلوك، ينهجه و«الكاتب الكبير» محمد زفزاف. الأخير داوم التردد عليه أصيافًا كثيرة، كما فسح له باب النشر في المنابر الثقافية العربية، كمثال مجلة «الآداب» البيروتية، حيث ستنشر الدار لاحقًا مجموعته القصصية الأولى «مجنون الورد» (1979).
«أخذ يحدثني عن صديقه الكاتب محمد زفزاف، الذي تعود أن يقيم في بيته خلال أيام من عطلة الصيف، وأخبرني بأنه كان يشتري الحصير والفراش والمخدة، فينام عليهما لتلك الأيام، ثم عندما يأتي الصيف القادم لا يجدها، ويضطر لشراء أخرى. سألته: ولماذا لا يجدها؟ قال: لأنني في وقت الحاجة أبيعها. وسأبيع تلك التي سوف تشتريها أنت، بعد عودتك إلى فاس، إن اشتدت بي الحاجة» (ص/43).
أما والتازي يقيم في بيته العادي، فسيعرفه على السيدة «فتحية» التي تساعده في إدارة شؤون البيت. وهنا سيستغرب التازي من كونه يلقبها بـ«السيدة» عوض «الخادمة». وسيطلع شكري التازي على خبايا مدينة طنجة التي وصفها بالأسطورية. فسكانها، حسبه، ينقسمون إلى فئتين: فئة النهاريين، وفئة الليليين. من ثم دعاه للتعايش معهما: «هم سكان مدينة طنجة. منهم من يعيشون حياتهم بالنهار وينامون في الليل، ومنهم من يعيشون حياتهم بالليل وينامون بالنهار» (ص/40).
ويعترف التازي بكونه أفاد من مكتبة شكري كثيرًا، بحكم تنوع الكتب الموجودة فيها، وتنم عن اختيارات دقيقة يصعب حيالها الاستغناء عن أي مؤلف من المؤلفات التي تضمها. وإذا كان شكري قد عرف حياة الفقر والعوز، مما اضطره لاستدانة مبالغ مالية هزيلة (ألف فرنك: دولار تقريبًا)، وبيع الساعات اليدوية في الميناء، إلى الغناء في الحانات بتقليد محمد عبدالوهاب وفريد الأطرش، فإنه تحول من الاستدانة إلى مقرض مالي للكتاب والأدباء، والدليل أنه أقرض محمد عز الدين التازي مبلغ (5000 درهم: 500 دولار تقريبًا) في فترتين متتاليتين: «كان يعطف علي في سنوات المحنة، وهو من زودني بالساعات اليدوية التي كنت أبيعها في الميناء، حتى لا أسرق، كما قال لي» (ص/48).
«أخبرت محمد برادة بأنني قد قرضتك الخمسة آلاف درهم، وأبديت له مخاوفي من ألا تتمكن من تسديدها، فقال لي: السي عز الدين صاحبك، وقد اشتركتما في الحلو والمر، وأنت وسع الله عليك في الرزق، فتخل له عنها» (ص/50).
«الخبز الحافي» سيرة كتاب
يورد محمد عز الدين التازي في الفصل المعنون بـ«وقت للخبز الحافي»، حكاية تأليف محمد شكري لسيرته الذاتية؛ إذ يرى أن عملية التأليف تمت إما في سنة (1972م) أو (1973م) بمقهى «سنترال» بطنجة في غضون عشرة أيام. كان شكري يكتب في دفاتر مدرسية سرعان ما يرقمها كي لا يختل الترتيب المرتبط بالمعنى المعبر عنه في السيرة. ويذكر التازي بأنهما كانا يجلسان في المقهى ذاته، كل على طاولة بعيدًا من الآخر، ولما تنتهي عملية الإبداع يعودان للالتقاء من جديد.
على أنه في تلك المدة كان على اتصال بالكاتب الأميركي «بول بولز» (1910- 1999م) الذي أقام في طنجة إلى حين وفاته، فطلب منه سرد حكايات ينقلها إلى اللغة الإنجليزية لتنشر في مجلتين هما: «بلابوي» و«أنطيوس» في مقابل (5000 درهم: تقريبًا 500 دولار) عن كل حكاية. وسيعترف شكري في لقاء آخر معه بأنه بصدد كتابة سيرة ذاتية سرعان ما طالبه بإحضارها. وهكذا كان يمده يوميًّا بالفصل الذي يكتبه صباحًا، لتتحقق ترجمته في المساء.
«هل لديك حكايات تحكيها لي حتى أكتبها بالإنجليزية؟ جازف محمد بالرد: لدي حكايات كثيرة. ولدي سيرة ذاتية كتبتها بالعربية» (ص/53).
صدرت السيرة بداية باللغة الإنجليزية تحت عنوان: «من أجل الخبز وحده». ويرى التازي أن العنوان قد يكون من وضع «بول بولز»، مثلما الأمر بالنسبة لـ«الخبز الحافي» الذي اقترحه الروائي الطاهر بنجلون. ويقال: إن الناقد والروائي محمد برادة وضع عنوان الجزء الثاني من هذه السيرة الذاتية التي صدرت في المغرب تحت عنوان: «زمن الأخطاء» (1992م)، بينما حملت الطبعة البيروتية عن «دار الساقي» عنوان «الشطار»، وبتقديم من الناقد المصري صبري حافظ.
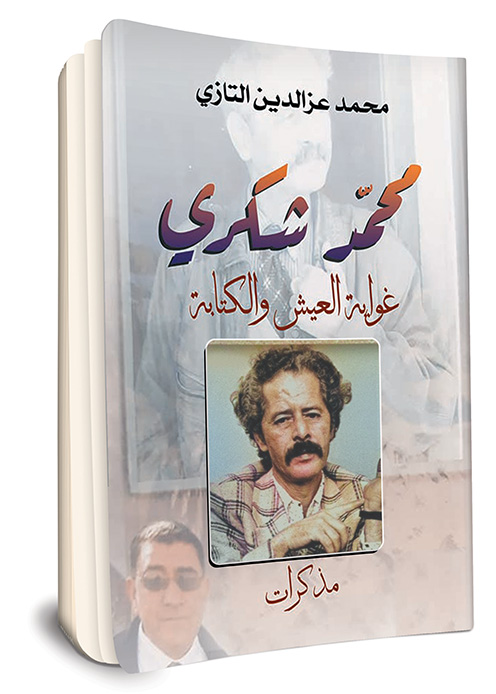 على أن أول طبعة باللغة العربية ظهرت في المغرب (1982م) في سحب أولي بلغ (5000 نسخة)، لتتواصل الطبعات إلى أن بلغت أربع طبعات، حيث تدخل الاتجاه الديني التقليدي لمنعها بمسوغ المحتوى المعبر عنه. وفي الآن ذاته يشير التازي إلى كون الخميني، وهو يهدر دم سلمان رشدي، أهدر على السواء دم الراحلة فاطمة المرنيسي ومحمد شكري الذي رفض مقترح حمايته: «تقبل شكري الأمر بهدوء. وحينما دعي إلى قسم الشرطة، وسأله الضابط: هل تحتاج إلى حماية؟ أجاب مِن فورِه: كلا. أنا لم أفعل شيئًا ضد أحد. وإن أرادوا أن يهدروا دمي فلن تنفع أية حراسة. ثم إنني لا أطيق أن أعيش وبرفقتي حارس» (ص/62).
على أن أول طبعة باللغة العربية ظهرت في المغرب (1982م) في سحب أولي بلغ (5000 نسخة)، لتتواصل الطبعات إلى أن بلغت أربع طبعات، حيث تدخل الاتجاه الديني التقليدي لمنعها بمسوغ المحتوى المعبر عنه. وفي الآن ذاته يشير التازي إلى كون الخميني، وهو يهدر دم سلمان رشدي، أهدر على السواء دم الراحلة فاطمة المرنيسي ومحمد شكري الذي رفض مقترح حمايته: «تقبل شكري الأمر بهدوء. وحينما دعي إلى قسم الشرطة، وسأله الضابط: هل تحتاج إلى حماية؟ أجاب مِن فورِه: كلا. أنا لم أفعل شيئًا ضد أحد. وإن أرادوا أن يهدروا دمي فلن تنفع أية حراسة. ثم إنني لا أطيق أن أعيش وبرفقتي حارس» (ص/62).
يقول التازي: إن «دار الآداب، بيروت» اعتذرت عن نشرها. ولعل من المفارقات أن محمد شكري تندر كثيرًا عقب إصدار الروائي والقاص سهيل إدريس (1925- 2008م) الجزء الأول من سيرته الذاتية «ذكريات الأدب والحب» (2001م)، لما تضمنته من مواقف «غير أخلاقية» حالت دون ظهور الجزء الثاني.
أثار التازي أسئلة وملحوظات نقدية حول «الخبز الحافي» نجملها في التالي: محمد شكري لم يكن حكواتيًّا ويعتمد الشفوي، كما أشارت بعض الدراسات النقدية، وإنما كاتب قصة باللغة العربية السليمة. ولم يكن شكري يتقن اللغة الإنجليزية، مثلما أن «بول بولز» غير متمكن من اللغة العربية. من ثم يطرح التازي السؤال: كيف تحقق التواصل بين المؤلف والمترجم؟ وهنا يرجح بأن الوساطة قد تكون تمت عن طريق محمد المرابط طباخ «بولز» الذي يجيد اللغة الإنجليزية: «مع ذلك فالترجمة كانت تتم، وبكل تأكيد، انطلاقًا من نص مكتوب بالعربية، هو الذي كتبه محمد بمحضري على أوراق تلك الدفاتر المدرسية» (ص/54).
ويشير التازي إلى أن بعض القراء ألمحوا للضعف الأدبي لـ«الخبز الحافي»، مع تأكيد قيمتها النابعة أساسًا من الجرأة التي تفردت بها، إذا ما ألمحنا لكون محمد شكري قد باح للتازي باعتراف مؤداه أنه لم يدوّن الوقائع الاجتماعية كاملة كما عاشها، وإنما مارَس رقابته الذاتية على العديد من القضايا والمشاهد المؤلمة.
يصنف شكري سيرته الذاتية، حسب التازي، فيما يسمى بأدب الشطار الذي يرسم صورة عن أحوال الفقراء والمعوزين ومعاناتهم. وقد يكون تأثير المرجعيات الإسبانية حاضرًا في سياق عملية الإنجاز. على أن ما غفل عنه كاتب المذكرات، كون التصنيف أورده الناقد المصري الراحل الدكتور علي الراعي في كتابه «شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» (كتاب الهلال). ويلحظ محمد عز الدين التازي أن سيرة «الخبز الحافي»، حجبت التلقي والنظر النقدي على التعرف إلى بقية أعماله الأدبية، مثلما طبعت شخصيته بالنرجسية: «لم يكن محمد شكري ينظر إلى حياته الخاصة بنرجسية وإعجاب بالذات، بينما أدركته النرجسية ككاتب، عندما اشتهر اسمه وترجمت أعماله إلى لغات عدة» (ص/20).
يبقى كتاب «محمد شكري غواية العيش والكتابة»، تجربة في أدب المذكرات أضاءت جوانب مهمة من حياة كاتب مَثَّلَ في لحظة زمنية من تاريخ الأدب العربي الحديث، وليس المغربي وحسب، ظاهرةً تَستحقُّ الدرس والتحليل النقدي الموضوعي، وبخاصة أن كاتبها الروائي والقاص محمد عز الدين التازي عايش الراحل إلى أن غيبه الموت، ولئن اعتمد في التمثل والاستحضار على ذاكرته، وبالرغم من كون العديد من القضايا المدونة كانت معروفة ومتداولة وتحتاج فقط لمن يوثقها.
سرديات الاعتراف والكتابة الضد

علي حسن الفواز – كاتب عراقي
قد يبدو الحديث عن غياب نص السيرة حديثًا مواربًا، ومُضلِّلًا للتغافل عن غياب نص الاعتراف، بوصفه نصًّا يتجاوز الظاهر السيروي، إلى تلمّس الباطن «المقموع» والمستور، والفضائحي، وبما يجعله النص الأكثر تمثيلًا للذات «الصافية»، عبر الكشف عن خفايا سيرتها، وتتبّع المحجوب من وقائعها ويومياتها، وتسريد ما هو محذوف منها، أو ما هو مقموع فيها، وعلى نحوٍ يجعل من نص الاعتراف وكأنه نصٌّ ضدي، تحضر فيه تلك الذات وهي في نوبة تعرٍّ، أو تمرد، أو هذيان، تستفز الذاكرة بوصفها مخزنًا غير بريء، مثلما تستدعي التطهير، بوصفه رغبةً للتخلّص من وهم الخطيئة، والتجاوز على مركزيات التابو في التاريخ، وفي المقدّس الاجتماعي والعائلي والمرآوي.
الاعتراف والخلاص
من الصعب عزل سؤال الاعتراف عن الحياة، أو حتى وضعه داخل توريات اللغة، تخفّيًا، أو تكتّمًا، أو توهمًا؛ لأنّ الاعتراف يتطلب بالضرورة وجود نص مُدوَّن، أو خطاب في التصريح، والإشهار، وهو ما يعني تقويضًا لتاريخ الصمت، والكبت، وحفرًا في «غواطس» اللاوعي التي تتغوّل فيها فكرة التابو، والخوف من الاجتماع السياسي أو الأيديولوجي والديني، حتى التاريخي، وبما يجعل (سردية الاعتراف) الأقرب إلى لعبة تقويض «الأنا المغلقة» وإلى مخاتلة التاريخ/ تاريخ الجسد/ الأيديولوجيا، والإيهام برغبة الانعتاق من الذاكرة القاسية للخطاب العصابي، ومن الثلاثي المهيمن في سرديات «الدين، الجنس، السياسة» بوصفها مجالات تصنعها الذات المغلقة. وهذا ما يُعطي لفعل الاعتراف نوعًا من المفارقة، والتمرد على النسق، عبر تقويضه وفضحه، من خلال تعرية تلك الذات الصيانية، عبر النقض والبوح، والتدوين المُضاد، والكشف عن المخفي في الوثائق، أو في سرائر الذات.
وبقطع النظر عن المرجعية الصيانية لتلك السرديات، أقصد ما يخصّ صناعة النص المغلق للسلطة والجماعة، فإن الكتابة، أي كتابة الاعتراف، بوصفها السيري، أو التمثيلي، ستكون هي الرهان على ما يُسمّى بـ«تدميرية» ذلك النسق، والمجاهرة بالضد، عبر الإبانة عن السر، أو فضحه، وعن علاقة ذلك بالجسد؛ إذ يضع الاعتراف هذا الجسد بوصفه الفيزيقي، أو المفهومي، أمام تعرية أنثروبولوجية، قد تعصف بحصانته، وغروره، وعلائقه ورموزه وشفراته، حيث تتحول «اللغة/ الاعتراف» إلى نصٍّ «سريري» بوصف فرويد، إلى موجّه أنثروبولوجي، له طاقة الكشف عن البنيات العميقة، عبر العلامات، والطقوس بوصف شتراوس، وإلى مجال استعاري، حيث تتعرّى الذات، لتنحل الأقنعة، والتوريات، وليبدو النص الاعترافي، في هذا السياق، وكأنه محاولة تعسفية للتخلّص من ضغوط الكبت والخوف، وإلى اصطناع مواجهة افتراضية مع العالم، وربما مع الذات نفسها، تمثيلًا لرغبتها الحميمة في الإشباع الرمزي عبر التطهير والخلاص.
إذ لا يمكن للاعتراف أن يكون، إلا في لحظة تماهٍ مع فكرة الخلاص، أو عند لحظة تمثيلِ شغفٍ يتماهى عبره المُعتَرِف مع الآخر، بحثًا عن التفريغ، والانتشاء. فكل الاعترافات التي يكتبها الأقوياء هي تماهٍ عميقٍ مع لحظات استحضار للآخر، والادعاء بأنّ سرديات اعترافهم هي تمثيل أخلاقي لتلك اللحظات، وعبر تمثّلات الحب والقوة والعجز، أو لما هو متعالٍ وضاغط في فكرة التطهير، حيث تكون تعبيرًا نكوصيًّا عن الإحساس باللاجدوى، والضعف، التي كثيرًا ما تحدث تحت ضغط نفسي كما في الفشل العاطفي، أو نتيجة للفشل السياسي والنفي والعجز كما في بعض اعترافات السياسيين.
يظل الاعتراف بمعناه «الثقافي» هو الأكثر مكرًا في تمثيل مرجعياته ورمزيته، وفي التعبير عن علاقة النص الاعترافي بذات الكاتب؛ إذ يقترح تمثيله الخطابي عبر «مناصات» إشهارية/ المدونات، واليوميات، المذكرات، التي تتيح للقارئ تلقيًا إغوائيًّا، تشتبك فيه حافزات التاريخي والسيروي، مثلما تتيح مجالًا لتوصيف حدود لهذا النص، بوصفه نصًّا يعمد إلى الكشف عن المضمر، والمحذوف، والمقنّع، الذي يتبدى عبر كتابةٍ تتفجّر فيها الإثارة، والفضح، أو الهتك، أو عبر كتابة توحي بما يشبه التفريغ النفسي، التي كثيرًا ما تُكتب في المنافي، حتى لا تطول الكاتب الاعترافي سلطة الرقابة، أو مكاره التشهير والتنمّر.
نص مثير للغواية
هذه الكتابات هي ما يجعل «أدب الاعتراف» مفارقًا، ويُثير شغف القرّاء وفضولهم الذين يتماهون مع أسرار ما يُكشَف، بوصفها نصوصًا للآخر المفضوح، مثلما ستكون نصوصًا استحواذية للذات القارئة، تلك التي يمارس من خلالها القارئ إحساسه بالإشباع الرمزي، والتطهير عبر تدمير ذلك الآخر، وصولًا إلى التشفّي التعويضي، على مستوى اكتشاف الغامض من العالم، أو على مستوى التعرّف إلى ما يجري في المحجوب من الجسد والتاريخ والأيديولوجيا.
سردية الاعتراف، قد لا تكون واقعية بالكامل؛ إذ يتسرّب إليها التخيّل، ليجعل نصها مثارًا للغواية، كما في اعترافات جان جاك روسو، أو اعترافات أوغسطين. ويمكنها كذلك أن تجعل من ذلك النص نزوعًا إلى الإيهام بالقوة والفحولة، كما في روايات الطيب صالح، وجبرا إبراهيم جبرا، وبما يجعل من تلك السردية نصًّا ضديًّا، يتحول فيه الفقد إلى إشباع، والنكوص إلى تجلٍّ، والطفولة إلى مشاكسة، والشباب إلى فحولة شبق جنسي، والكهولة إلى حكمة، والسقوط الأخلاقي إلى تمرد، وهو ما بدا واضحًا في روايات محمد شكري وفي بعض قصص وروايات عبدالستار ناصر.
الاعتراف السياسي
هذا الاعتراف لا يعني كتابة نصٍّ مجاور، يتناصّ مع السيرة، بل يعني محاولة في «البراءة» وفي تقويض فكرة «المثال» والثابت، والقارّ في اللاوعي الجمعي، الذي سيجعل من موضوع الاعتراف وكأنه مغامرة يكون فيها التشهير تطهيرًا، والفضح تعريةً، ولا سيما المتعلِّق بالاعترافات السياسية، التي يدخل بعضها في نوبة عاصفة من التعريات الأيديولوجية والنفسية كما في «اعترافات عزيز الحاج» و«اعترافات مالك بن الريب» للشاعر يوسف الصائغ، التي كانت في جوهرها اعترافات حزبية، وإكراهية، غايتها عزل الذات عن قامعها، وتسويغ الاعتراف بوصفه خلاصًا مما يشبه الإثم، والضعف، مقابل القصدية في فضح الآخر.
 كما تنطوي بعض الاعترافات على مقاربةٍ لتاريخ الأخطاء الوطنية والسياسية، التي تدخل في إطار تصفية الحساب مع الذات، وهي رغبة عمادها التخلّص من عقدة الذنب كما في اعترافات «محسن الشيخ راضي» وكتاب «أوكار الهزيمة» لهاني الفكيكي. وبقدر أهمية وخطورة مثل هذه الاعترافات تاريخيًّا ونفسيًّا وسياسيًّا، فإنها في المقابل ستصطنع لها نسقًا، يقوم على اصطناع تاريخٍ مضاد، تاريخ يُحرّض على إعادة قراءة كثير من الأحداث والوقائع والملفات، وفضح أزمنتها المتقادمة، وشخصياتها المُقنَّعة. كما أنّ مذكرات واعترافات عدد من السياسيين العراقيين الآخرين أمثال حازم جواد وطالب شبيب وصبحي عبدالحميد وغيرهم، كشفت هي الأخرى عن ذاكرة الرعب التي عاشوها، أو ساهموا في صنعها، حتى في قتل ضحاياهم؛ إذ حملت معها هذه الاعترافات نزوعًا مُركّبًا يزاوج بين تجاوز عقد الإثم، وبين التوهم بالخلاص، فضلًا عن محاولة فضح التابوات التي غمرت التاريخ السياسي العراقي منذ أحداث 1963م الدامية وإلى عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.
كما تنطوي بعض الاعترافات على مقاربةٍ لتاريخ الأخطاء الوطنية والسياسية، التي تدخل في إطار تصفية الحساب مع الذات، وهي رغبة عمادها التخلّص من عقدة الذنب كما في اعترافات «محسن الشيخ راضي» وكتاب «أوكار الهزيمة» لهاني الفكيكي. وبقدر أهمية وخطورة مثل هذه الاعترافات تاريخيًّا ونفسيًّا وسياسيًّا، فإنها في المقابل ستصطنع لها نسقًا، يقوم على اصطناع تاريخٍ مضاد، تاريخ يُحرّض على إعادة قراءة كثير من الأحداث والوقائع والملفات، وفضح أزمنتها المتقادمة، وشخصياتها المُقنَّعة. كما أنّ مذكرات واعترافات عدد من السياسيين العراقيين الآخرين أمثال حازم جواد وطالب شبيب وصبحي عبدالحميد وغيرهم، كشفت هي الأخرى عن ذاكرة الرعب التي عاشوها، أو ساهموا في صنعها، حتى في قتل ضحاياهم؛ إذ حملت معها هذه الاعترافات نزوعًا مُركّبًا يزاوج بين تجاوز عقد الإثم، وبين التوهم بالخلاص، فضلًا عن محاولة فضح التابوات التي غمرت التاريخ السياسي العراقي منذ أحداث 1963م الدامية وإلى عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.
خيار الاعتراف السياسي يدخل أيضًا في سياق ما يمكن تسميته بـ«الجريمة السياسية»؛ إذ هي جريمة الفضح والتخلّي، مثلما هي جريمة إخضاع المتهمين إلى التعذيب وتصفيتهم. وأحسب ملفات الأمن السياسي تزخر بكثير من اعترافات الضحايا تحت التعذيب، التي لا تخلو من التسريد والفضح والانتهاك النفسي والجنسي؛ إذ تركت جروحًا نرجسية كبيرة في الجسد السياسي والثقافي، ولا سيما أنّ كثيرًا من ضحاياها كانوا سياسيين معارضين ومثقفين لهم رمزيتهم في الاجتماع العراقي. ولعل رواية «شرق المتوسط» لعبدالرحمن منيف، ورواية «الوشم» لعبدالرحمن مجيد الربيعي، ورواية «نساء زحل» للطفية الدليمي تحمل كثيرًا من شواهد سرديات الانتهاك النفسي والجنسي.
أنا أعترف إذًا أنا موجود
محدودية النص الاعترافي في أدبنا العربي، ترتبط بعقد كثيرة، بدءًا من طبيعة الشخصية العربية، وتكوينها العصابي والديني والعائلي، ولا تنتهي بالسلطة؛ إذ تفرض تلك السلطة قمعها على المختلف، والمفضوح، مثلما تفرض توصيفها للنص الذي يصنعه المثقف، أو يُصرّح به السياسي، أو يستهلكه المواطن التابع، عبر تعويم شيوع «ثقافة النمط» وتأطير الأفكار الضاغطة عن الالتزام والانتماء والصيانة، والخضوع للقانون والأعراف. وهي فرضيات يدخل فيها الأيديولوجي، أكثر من التدخل الأخلاقي، مقابل الخضوع إلى فرضية الرقابة، تلك التي تفرض آلياتها شروطها ووجودها على الجسد والنص والفكر في آنٍ واحدٍ؛ لأنّ إباحة كتابة الاعتراف ستعني إباحة الحديث عن المستور والمقموع، التي يمكنها الدخول إلى تابوات السياسة، وإلى فضح ما هو مضمر في أنساقها المتعددة.
من أكثر الكتب العربية إثارة في سرديات الاعتراف كتب الروائي المغربي محمد شكري في كتابيه «الخبز الحافي»، و«الشطّار»، فضلًا عن اعترافات الكاتب لويس عوض، وكتابات رشيد بو جدرة، وعبدالرحمن صدقي، وسلام إبراهيم، وشكري عياد، وكوليت خوري، وسهيل إدريس، ونوال السعداوي، وفؤاد قنديل وغيرهم. لكن السؤال الفاعل في هذا التوصيف يتعالق بمدى جدّية هؤلاء الكتّاب في أن يُشرعنوا «أدب الاعتراف»، وبمدى حدود المسموح أو عدم المسموح في الإبانة عنه؟
إنّ الخلط بين أدب السيرة وأدب الاعتراف يعكس الطابع الإشكالي في النظر إلى النص «السير ذاتي» وإلى «النص الاعترافي» وتحميلها توصيفات تتجاوز التأطير السردي، إلى الدخول في سياق أدب الإثارة، أو المبالغة، وربما الدخول إلى نص «البورنو» أو «أدب زنا المحارم» أو «جنس القاصرين» كما في قصص وروايات فؤاد التكرلي وناطق وخلوصي، وغيرها من الكتابات التي تدخل في تابوات اجتماعية أكثر منها ثقافية. وهذه عملية ستكون مربكة للقارئ ولتداولية القراءة. وفق ما طرحه آيزر، حول إشكاليات القراءة والتلقي، فإن هذه القراءة تتطلب تفاعلًا، وتجاوبًا، وكشفًا، وتقاطعًا، وتأويلًا. ولأن مثل هذا النص «لا يخضع لصاحبه فقط، بل يخضع لإستراتيجيات معقدة بين القارئ المؤول، بما يمتلك من معرفة وخبرات جمالية من جهة، وبين النص من جهة أخرى، فينتج عن هذا التفاعل استجابات قرائية تكشف عن إمكانات وإجراءات مقروئية جديدة، تتجه نحو فهم الدلالة المغيبة، وفكّ رموزها». كما جاء في كتاب بسام قطوس «إستراتيجيات القراءة- التأصيل والإجراء النقدي» (دار الكندي للنشر والتوزيع، إربد 1998م، ص13)
السيرة والاعترافات
قد تتضمن كتابة السيرة اعترافات كثيرة، لكنها لن تكون مُقنّعة، أو مغالية، بقدر ما ستكون محاولة في تزكية حياة الكاتب، وترميم بعض الفجوات في تاريخه الشخصي أو السياسي؛ لأنّ خروجها من السيري إلى الاعترافي سيدخلها في مجال الأنوية بمعناها الفرويدي، وسيُلقي ظلالًا حول تاريخيتها، ويُجردها من براءتها، وربما يدفع بها لأنْ تكون أكثر من مغامرة، وأكثر من رغبة في تفريغ ركام المسكوتات، مثلما ستكون باعثًا على استدعاء قارئ فضولي، مهووس بأدب اليوميات والسير والاعترافات والمذكرات والفضائح، وهي أنماط تميل إلى خلخلة ما هو واقعي وتاريخاني، إلى أفق يكون فيه السردي والتاريخي، مجالًا لإنتاج «النص الزئبقي» كما سمّاه سعيد يقطين. وهو نص يؤسس اكتفاءه عبر الإشباع الرمزي، الذي سيجعل من نص الاعتراف، نصًّا رهينًا بالكتابة الضد، والسردية المفارقة، وقصدية الإثارة، حيث يتقوّض فيها الواقعي، مقابل حضور التخيّلي وسردية روايته، وستجعل من شخصياتها الورقية، كما يسميها رولان بارت، تدخل إلى الواقع عبر أقنعة سيميائية، واصطناع حيوات يمكن التلاعب بمصايرها، لكنها، على الرغم من ذلك، تبقى على تماسٍّ مع وقائع عامة، أو أحداث، أو حتى تاريخ له رواة آخرون، قد يكتبون اعترافات ضدية، أو قد يجردون ذلك التاريخ من واقعيته، ومن رمزيته.
التقاطع ما بين الاعترافي والسيري والعمومي يكمن في إجادة لعبة التأليف، وفي صياغة جرأة المكتوب، فالاعتراف ليس نزوعًا للاكتفاء بالتطهير، وفضح المقموع، وتفريغ المكبوت، بل هو مجال «نصوصي» تكمن حيويته في الإثارة أولًا، وفي الحفر في تاريخ المهمل ثانيًا، وفي تحويل «الفضيحة» بالمعنى المُفارق، إلى مادة للاستهلاك، وإلى المغالاة في توصيف الحرية، بوصفها جزءًا من «الإرادة والمسؤولية» بتوصيف سارتر، وأحسب أن رواية «المثقفون» لسيمون دي بوفوار هي نص اعترافي، عرّت فيه الكتابة زمنًا ثقافيًّا فرنسيًّا، ومثقفين كانوا يعيشون عوالمهم الخاصة.
سردية الاعتراف، يمكن أن تكون أيضًا لعبة قصدية في تسويغ الحديث عن سردية تجارية للفضائح، تلك التي نجدها في مذكرات نجوم السينما ونجوم الرياضة، حيث تقود اعترافاتهم الجنسية، أو انحرافاتهم، أو تهرّبهم الضريبي إلى اهتمامات واسعة من الجمهور النرجسي، ومن الجهات الرقابية، أو حتى من جانب بعض الجهات الدينية.
في هذه السردية يتجاوز الكاتب النمط إلى المختلف، فبقدر ارتباط السردية الاعترافية بغواية الحرية والتطهير، فإنها تكشف أيضًا عن أزمة وعي تلك الحرية، وأزمة العلاقة مع الآخر، والإحساس بالضعة والدونية، وخرق المألوف. فما كتبه جان جينيه مثلًا من اعترافات، كشفت عن الشخصية المُدمّرة، والوضيعة، وأن تلك الاعترافات لا تعدو أن تبدو كأنها نوع من النزق، وأنّ فعاليتها كأثرٍ أدبي لم تُثر نوازع أخلاقية، أو ثورية، بقدر ما كشفت عن شخصية مأزومة، مُنحلّة، مثلما كشفت عن نزعة احتجاجية على عالم رأسمالي مجنون، وعن جسدٍ تطحنه النزوات وسط عالم فاسد ومحبِط، وفاقد لشروط العدل والأمل والإشباع الروحي.
هذا الفقد هو نظير لسؤال الهوية في ثقافتنا العربية، فمن الصعب الحديث عن هوية عمومية وسط تشظي الهويات العصابية، ووسط عالم غائر في التابوات وبالجماعات القاهرة والمقهورة، حدّ أنّ بعض الاعترافات كانت محاولة نفسية/ احتجاجية، لكنها وُظِّفَت للتعبير عن رفض القهر الاجتماعي والاستبداد السياسي والظلم العنصري والاضطهاد الحقوقي، كما حدث مع نادية مراد الإيزيدية، التي تعرّضت لاغتصاب بشع من جماعات داعش الإرهابية، حيث قادها اعترافها بعمليات الاغتصاب الجماعي إلى الفوز بجائزة نوبل للسلام لسنة 2018م، وإلى تحويل قضيتها إلى إثارة موضوعات فاضحة للمحنة العراقية، ومحنة جماعاتها الإثنية المقهورة.
هل لم يعرف العرب فـن السيــرة الذاتيــة؟

صبحي موسى – صحفي مصري
هل لم يعرف العرب فن كتابة السيرة الذاتية؟ ولم لجأ أغلب الكتاب إلى تسريب سيرهم الذاتية من خلال أعمالهم الإبداعية، من دون أن يكتبوا عليها بشكل مباشر «سيرة ذاتية»؟ وما الذي تطلبه كتابة السيرة الذاتية؟ وما المحظور الذي يتجنبه الكاتب العربي؟ أسئلة تطرحها «الفيصل» على عدد من الكتاب.
السيرة الذاتية أدب نخبوي لا ينتجه العامة
سعيد الغانمي
لا يتخيَّل كثير من العرب أن السيرة الذاتية فن من أقدم الفنون الأدبية العربية. وهي نوع من الكتابة تقع في صنف الكتابة التاريخية من حيث المظهر؛ إذ تعدّ تطويرًا لكتابة السيرة. ويكمن الفارق الأساس بينهما أن السيرة يكتبها شخصٌ عن تجربة شخصٍ آخر وحياتِهِ، في حين تتميز السيرة الذاتية بأنها كتابة المرء عن حياته وتجربته الشخصية. ويُفترض بهذه الكتابة أن تكون قريبةً بقدر الإمكان من التوثيق الدقيق، أي ينبغي لها الالتزام بضوابط الكتابة التاريخية. لكن السيرة الذاتية من ناحية أخرى ينبغي أن تتضمَّن عنصرًا أدبيًّا أو إبداعيًّا يُغري قارئ النص بالاستمرار في قراءته. وهذا العنصر هو عنصرٌ إبداعيٌّ، وليس تاريخيًّا. ولذلك تنطوي السيرة الذاتية على عنصرين متناقضين معًا؛ التاريخ الذي ترائي بالانتماء له، والإبداع والابتكار الأدبي الذي ينطوي على جانب خيالي مبتكر مناقض للتاريخ.
من ناحية أخرى، يجب الانتباه إلى أن أدب السيرة الذاتية أدب «نخبوي» لا تنتجُهُ العامة ولا تفكِّر به، ولا سيما في الثقافة العربية التي تتمتع فيها النخب الثقافية بالتميز من الناحيتيْنِ اللغوية والتربوية عن بقية الطبقات الثقافية. وهذا التميز «ثقافيٌّ» صرف، ولا علاقة له بالوضعية الاقتصادية أو المادية. فقد يوجد أثرياء كثيرون في البلدان العربية، لكنهم لا ينتمون إلى طبقة النخبة الثقافية، وبالتالي فهم لا يفكِّرون بكتابة السيرة الذاتية. وإذا فكَّروا بها، فهم يستعينون بخبراء من طبقة المثقفين لكتابتها. وبالتالي فهي ليست بسيرة ذاتية، بل عملية دعائية تزعم أنها سيرة ذاتية. يصح هذا على شيوخ القبائل، والأثرياء، والفنانين، الذين يعيشون في حالة من الرفاهية المادية، وحالة من الإدقاع الثقافي. وبالذات حين يكتبون عن الذات باللغة العربية الفصحى، لا بالعاميات التي يتقنونها.
في أدب السيرة الذاتية، كما يمارسه العرب حديثًا، ينبغي أن نميز بين أهداف متعددة للكتابة. فهناك نصوص تدعي الانتماء للسيرة الذاتية من الناحية المظهرية وحسب. وهذه النصوص تلتزم أو ترائي بالالتزام بكتابة التاريخ الدقيق. وأغلب هذه النصوص يكتبها أشخاص من ذوي المواقع الوجيهة، والمسؤوليات الاجتماعية البارزة، مثل شيوخ القبائل، ورؤساء الأحزاب، وأعلام السياسة، وأصحاب المناصب. وهؤلاء بحكم مواقعهم يحرصون على إبراز الجانب الإيجابي من تجربتهم؛ لأنها ليست تجربة شخصية في الأساس، بل هي تجربة جمعية تتكلم باسم المؤسسات الاجتماعية التي يمثلونها.
في المقابل، هناك أدباء كتبوا سيرهم الذاتية بنوع من البوح الحميم، الذي لا يقل اعترافًا عن نظيره الأوربي. على سبيل المثال، كتب المرحوم إحسان عباس سيرته الذاتية «غربة الراعي»، مُقرًّا ببساطة تاريخه الشخصي، متسائلًا عن دوره الاجتماعي، وهو ليس سوى «راعٍ» بسيط، في إهمال واضح لعمق تجربته الثقافية من ناحية إنتاجه لمكتبة كاملة من الأعمال المهمة.
ناقد وأكاديمي عراقي
سير الأجيال القادمة ستكون مختلفة
حمزة المزيني
ما يتضمنه بعض السير الذاتية من حديثٍ عن مغامرات أشبه بالـ«فضائحيات»، يعود الأمر في أصوله إلى التقليد الكاثوليكي الذي يتمثل في أن الفرد يرتكب ما يرتكب من خطايا ثم يأتي إلى القسيس فـيعترف له بما ارتكب، ثم يبلغه القسيس أنه «رجع كيوم ولدته أمه». هذا التقليد ربما انتقل إلى السيرة الذاتية الغربية التي يمكن القول: إنها اعتراف كاتب السيرة للمجتمع بما ارتكبه من فضائح، ثم يشعر بأنه أزاحها عن ضميره بعد أن دوَّنها ليقرأها الناس الذين ربما يعجبون بجرأته، وربما يسامحونه على فضائحه. لكن مثل هذا التقليد الاعترافي غريب على ثقافة العالم غير الغربي، والعالم العربي والمسلم خاصة.
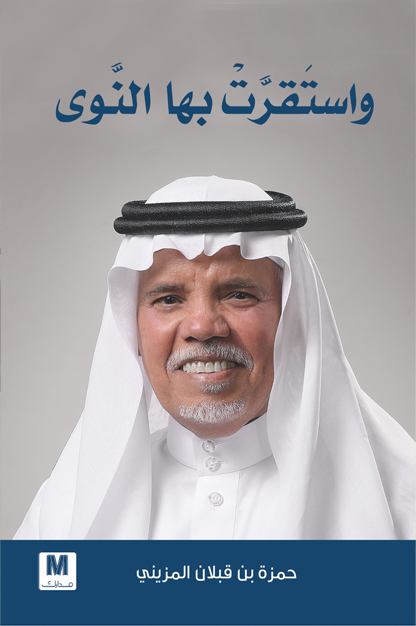 وهناك سببٌ ثانٍ يتمثل في أن المجتمع الغربي يقوم على الفردية، فيمكن أن يكتب كاتب سيرة فيها فضائح الدنيا كلها ولا تتعدى فضائحياته إلى أسرته مثلًا. أما في الثقافة العربية الإسلامية، وربما في المملكة على وجه أخص، فكاتب السيرة موصول بشبكة اجتماعية مترابطة واسعة ينشأ عنها أن ما يقوله عن نفسه سيتعدى لا محالة إلى غيره، ولا سيما إلى أسرته وأقاربه وأصدقائه؛ فهو ليس في حلٍّ إذن أن يؤذي أحدًا بما اقترف من فضائح لا دخل للآخرين بها.
وهناك سببٌ ثانٍ يتمثل في أن المجتمع الغربي يقوم على الفردية، فيمكن أن يكتب كاتب سيرة فيها فضائح الدنيا كلها ولا تتعدى فضائحياته إلى أسرته مثلًا. أما في الثقافة العربية الإسلامية، وربما في المملكة على وجه أخص، فكاتب السيرة موصول بشبكة اجتماعية مترابطة واسعة ينشأ عنها أن ما يقوله عن نفسه سيتعدى لا محالة إلى غيره، ولا سيما إلى أسرته وأقاربه وأصدقائه؛ فهو ليس في حلٍّ إذن أن يؤذي أحدًا بما اقترف من فضائح لا دخل للآخرين بها.
توجد أمثلة قليلة للسيرة الذاتية الفضائحية العربية، ومثالها الأبرز سيرة الكاتب المغربي محمد شكري «الخبز الحافي»، وهناك من يشكك في صدق ما تضمنته تلك السيرة. وممن يشكك فيها الكاتب المغربي حسن العشاب في كتابه «محمد شكري كما عرفته»، (القاهرة: دار رؤية، 2008م) الذي يصف نفسه بأنه «معلِّم محمد شكري». ومما قاله عنها: «إن هذه السيرة حملت بصمة كاتب أمريكي أعاد صياغتها كعمل فني مصطنع، لتحمل طابعًا فضائحيًّا» وإن «جل أحداث الخبز الحافي غير حقيقية»، فيما يقول الكاتب الجزائري إبراهيم مشارة عن الحرج الذي كان يتخوف محمد شكري منه فيما يخص تعدي ما كتبه إلى الآخرين، ومن أسرته خاصة: «وقد كان شكري يتوجس في نفسه خيفة من صراحتها ومن آثارها على سمعة العائلة خاصة أخواته البنات». في المقابل هناك سير ذاتية عربية وغربية كثيرة لا تتضمن مثل هذه الاعترافات، ولم ينقص من قيمتها الفنية والأدبية والسيرية شيء.
من دون رقابة ذاتية
لكل شخص قصته، ومن المؤكد أن الأجيال القادمة ستكون تجاربها مختلفة عن تجارب جيلي، وما سيقولونه وسيكتبون عن تجاربهم سيكون لافتًا للنظر بما لا يقل، أو ربما يتفوق على السير الذاتية التي كتبها المنتمون للأجيال (غير المرقمنة).
فيما يخص سيرتي «واستقرت بها النوى»، لم أشعر في أثناء كتابتها أني كنت أفكر في الجرأة أو الرقابة الذاتية على ما سأكتبه، فقد حرصت على أنْ أُدوِّن ما كان يتوارد عليَّ من ذكريات مررت بها بعيدًا من الانتقائية أو التحسين. وهناك أشياء لم أكتبها لأن الذاكرة لم تسعفني باستحضارها، وهناك أشياء تركتها لأنها غير مهمة في نظري. كنت أقرأ بعض السير لكتّابٍ سعوديين طوال سنين، وفي الواقع أنا لم أفكر بكتابة سيرتي الذاتية إلا مؤخرًا، ويعني هذا أني استفدت من تلك السير بصورة غير مباشرة ومن غير أن أشعر. وقد كان القراء كرماء جدًّا في استقبال سيرتي، ولهم الشكر على ذلك، وكتب عنها عدد من الكتّاب والنقاد في الصحف والمجلات السعودية، كما كتبت عنها بعض الدراسات الأكاديمية، وقد فازت بجائزة الدكتور غازي القصيبي التي تقوم عليها جامعة اليمامة في دورتها الأولى في مسار الأدب عن السيرة الذاتية عام 2022م.
ناقد وأكاديمي سعودي
لن أستخدم صابونًا لغسل سيرتي الذاتية
أمير تاج السر
أعتقد أن الكاتب عمومًا حين يبدأ الكتابة، أول ما يخطر في باله شيء من أحداث عاشها أو عاشها أشخاص قريبون منه مثل الأهل والجيران وسكان الشارع والحي الذي يعيش فيه؛ لذلك غالبًا تتسرب هذه الأشياء إلى نصه الروائي من دون وعي، وتظهر شخوص يعرفها ويعرف ملامحها جيدًا. وأنا مثل غيري، كان في نصوصي الروائية الأولى مثل «سماء بلون الياقوت» و«نار الزغاريد»، كثير من الحوادث التي صادفتها في طفولتي ومراهقتي، وأيضًا شخصيات التقيتها في الحياة، ولفتت نظري. ومع التقدم في الكتابة واتساع رقعة الخيال والمعرفة، يظهر قليل من هذه الشخصيات والحوادث، ويمكن أن تنعدم تمامًا في نصوص مثل «توترات القبطي»، و«مهر الصياح» وجزء مؤلم من حكاية.
لكن عندي أعمال أسميتها سيرًا مثل: «سيرة الوجع»، و«مرايا ساحلية»، و«قلم زينب»، و«تاكيكارديا»، وهي نصوص من بعض وقائع سيرتي طبيبًا، رأيت كتابتها كما هي دون تدخل مني. وقد كان في «سيرة الوجع» ما يمكن أن يكون تاريخًا اجتماعيًّا لمدينة طوكر في أوائل التسعينيات من العام الماضي، قبل أن أسافر إلى قطر، و«في مرايا ساحلية» رصد لأيام الطفولة في مدينة بورتسودان، وفي «قلم زينب» التي نجحت جدًّا، وتدرس مقررًا في المدارس الثانوية في دولة الإمارات، ذكريات عن عملي في قسم النساء والتوليد بمستشفى بورتسودان، وحادثة تعرفي إلى نصاب مجرم، أزعجني كثيرًا. «تاكيكارديا» الصادرة منذ ثلاث سنوات عن هاشيت أنطوان، أيضًا عن جانب مهم من أيام أخرى في قسم النساء والتوليد نفسه، إنها أيام« مجهول»، ذلك الصبي الذي أرهقني كثيرًا بالمطاردة بسبب موت امرأة من جيرانهم في قسم التوليد، وكانت حوادث جديرة بتوثيقها. وكتبتُها فيما يشبه الرواية أو لنقل السيرة الروائية، وهي أيضًا وجدت أصداء جيدة، وفي ذهني حوادث أخرى أتمنى لو عثرت على وقت لكتابتها.
بالنسبة لكتابة السيرة العربية، فهي أمر مرعب إذا تحرى الكاتب أن يكون صادقًا، ولا يكتب ما أسميه السيرة المغسولة، التي يزيل منها كل الشوائب الأخلاقية، وينشرها بصيغة تصيره ملاكًا. في الغرب لا يهتمون ويكتبون كل شيء مهما كان مقززًا. ولو قرأت قصة «عن الحب والظلام» لعاموس عوز لعثرت على حياة صاخبة، لم يعدل فيها. عندنا المجتمع لا يترك أحدًا يكتب مثل هذا، ولو كتب لا يستطيع أن ينشر بسبب تحرجه. شخصيًّا، لو كتبت سيرة كاملة سأكتبها كما هي، ولن أستخدم أي صابون في غسلها.
قاص وروائي سوداني
الشجعان هم من يكتبون سيرهم الذاتية

صالح معيض الغامدي
كانت السيرة الذاتية في ثقافتنا العربية عمومًا وفي الأدب السعودي خصوصًا؛ سيرة ذكورية، وظلت لوقت طويل على ذلك المنوال. ولم تظهر بعض التغيرات بمشاركة المرأة واقتحامها مجال كتابة السيرة الذاتية إلا في بداية الألفية الثالثة. وكنا قد استبشرنا خيرًا بظهور سير كل من السعوديات مرام مكاوي وليلى الجهني وهدى الدغفق وأميمة الخميس وغيرهن، في وقت متقارب نسبيًّا، ولكن وتيرة الإصدارات السير ذاتية النسائية تراجعت أو على الأقل خفت، ولم تساير الطفرة التي شهدتها السيرة الذاتية الرجالية في أدبنا السعودي.
ويوجد أكثر من تفسير لهذا التباطؤ، فإضافة إلى بعض القيود والمحاذير الاجتماعية، أرى أن انتشار وسائل التواصل الحديثة مثل الفيسبوك وتويتر والسناب شات وغيرها من البرامج والمدونات قد حلت بديلًا سهلًا عن الكتابة الورقية للسيرة الذاتية النسائية. فقد شهدنا كثيرًا من الكتابات السير ذاتية المكتوبة والمرئية تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذه، وتلقى قبولًا جيدًا فيما يبدو من المتابعين. ومع ذلك فلا أظن أنها ستقف عائقًا في المستقبل المنظور أمام ظهور مزيد من السير الذاتية المكتوبة، فالسيرة الذاتية النسائية المكتوبة جنس أدبي يتيح للكاتبة السعودية التعبير عن ذاتها وقضاياها وإبداعاتها الأدبية بشكل عام، ويكسب ما تنتجه المبدعة سيرذاتيًّا انتشارًا واسعًا وديمومة.
وضع معايير صارمة لكل جنس أدبي يبدو أمرًا صعبًا، باختلاف الأزمان والثقافات والأجيال والقناعات الأدبية، وإلا لما ربط الإبداع الأدبي دائمًا بالانحراف عن المعايير الثابتة أو التجاوز للمألوف والثابت منها. وإذا كان بالإمكان تحديد بعض المعايير العامة لبعض الأجناس الأدبية مثل الشعر والرواية والقصة، فإن ذلك يبدو صعبًا جدًّا بالنسبة للسيرة الذاتية، فلكل كاتب طريقته الخاصة تقريبًا في كتابة حياته. بالطبع هناك مفهوم عام للسيرة الذاتية وليس تعريفًا اصطلاحيًّا يشير إلى معايير ثابتة، وهذا المفهوم العام للسيرة الذاتية هو ما مفاده أن السيرة الذاتية هي التي يكتبها الشخص عن حياته. وهذا ما يتفق عليه الجميع، أما كيفية تطبيقه كتابة، فيختلف ربما باختلاف الكُتاب أنفسهم. وهذا ما جعل الناقد التقويضي (بول دي مان) يشكك في دقة مصطلح السيرة الذاتية، بل في كونها جنسًا أدبيًّا له سمات جمالية واضحة أصلًا. ومع ذلك، فكلٌّ مستمرٌّ في كتابة السيرة الذاتية بالطريقة التي يراها.
إن نجاح السيرة الذاتية مرتبط بالتعبير الصادق عن حياة الإنسان بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات لتكون تجربة يفيد منها كاتبها أولًا بالتعرف إلى ذاته جيدًا، ويفيد من تجاربها ويستمتع بها متلقوه. وكما أن المبالغة في تمجيد الذات قد تبدو أمرًا غير مقبول، كذلك المبالغة في التعري وصدام القيم المجتمعية بكل أشكالها. وهناك فرق كبير من مصادمة هذه القيم ونقد ما قد يحتاج منها إلى نقد بطبيعة الحال.
إن الشجعان هم من يكتبون سيرتهم الذاتية، والشجاعة هنا مجازية بطبيعة الحال. كتابة السيرة ليست ضربة لازب على كل كاتب، فكما أن هناك دوافع تشجع الكتاب على كتابة سيرهم الذاتية، هناك في المقابل عوائق تقف ضد كتابتها. ولا سبيل إلى حصر هذه العوائق كلها هنا. ولعلنا نشير فقط إلى أن بعض الكتاب يخشى أن يلحق الضرر بأي من أفراد أسرته أو أصدقائه وذلك بكشف بعض أسرارهم، وبعض الكتاب يخشى ألا يتمكن من سرد كل ما يريد من حياته، وبعضهم يستعير الرواية لكتابة سيرته أو طرفًا منها… وهكذا تُعَدّ الأسباب التي تعوق بعضًا عن كتابة سيرته الذاتية.
ناقد سعودي
من الصعب مكاشفة الجمهور بالسيرة الحقيقية للكاتب
طالب الرفاعي
مند روايتي الأولى «ظل الشمس» التي صدرت بطبعتها الأولى عام 1998م، ارتضيت لنفسي أن أكتب وفق المدرسة الفرنسية لرواية «التخييل الذاتي» التي تشترط للسيرة الذاتية أن يكون المؤلف حاضرًا في العمل الروائي باسمه الحقيقي، وسيرته الحقيقية، وما يحيط به في المجتمع من أفراد أسرته وأصدقائه والقضايا الاجتماعية؛ ولذا فإن «ظل الشمس»، هي رواية سيرة ذاتية حقيقية لعملي مهندسًا إنشائيًّا في مواقع العمل والإنشاء الكويتية، وبوجودي إلى جانب العامل والحداد والنجار وعامل المجاري والخرسانة والميكانيكا. حينما كتبت ونشرت «ظل الشمس» فقد كنت ولم أزل مقتنعًا بأن سيرة حياة الأديب الروائي والقاص والمسرحي والفنان، إنما هي جزء أساسي من سيرة الحراك الفكري والاجتماعي والاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات؛ ولذا من يقرأ «ظل الشمس» سيرى معاناة العمالة العربية والأجنبية التي تعمل في الكويت، وكيف أنهم يخاتلون الموت يوميًّا في سبيل لقمة العيش، ومنهم من يموت دونها! وسيرى أيضًا طالب الرفاعي المهندس الذي يلبس البنطلون «الجينز» وقبعة «الهلمت» الثقيلة، وينزل مع العمال والمراقبين؛ ليقف على صب الخرسانة تحت أشعة شمس مباشرة وحارقة، تصل إلى ثمانين درجة على ترمومتر سيلزيوس.
أجزاء حقيقية من سيرتي الذاتية وأسرتي ووضعي الاجتماعي والاقتصادي جاءت في رواية «الثوب»، التي تتحدث عن الكاتب الخليجي، وأنه ليس كما يتصور الجميع: يعيش غنيًّا وميسور الحال دائمًا، وأن القوة التي تحكم المجتمعات الخليجية إنما هي السلعة والاستهلاك، بما في ذلك التعامل وشراء الأدب/ الرواية بوصفها سلعة لها ثمن كباقي السلع، وبإمكانية عمل الأديب والروائي تحت سلطة المال وأهله! إن قناعتي بتوثيق سيرة حياة الكاتب بوصفها جزءًا من الحراك الاجتماعي في أي مجتمع، وبسببٍ من ندرة الكتّاب العرب، ربما يُعدّون على أصابع اليد الواحدة، الذين امتلكوا شجاعة كتابة شيء من سيرتهم الذاتية. وهو ما دفعني لكتابة أجزاء، وبعضها شائك جدًّا، من سيرتي الذاتية الحقيقية في أعمالي الروائية. إن إقدام أديبة أو أديب عربي على نشر سيرته الذاتية الحقيقية من خلال عمل روائي إنما يضمن له سهولة نشرها ووصولها لشريحة كبيرة من جمهور القراءة. وهذا ما دفعني لنشر جزء من قناعاتي وآرائي وسيرتي الحقيقية، ولأول مرة، في مجموعتي القصصية الجديدة «الدكتور نازل»، وأزعم أنه جاء بشكل أدبي غير مسبوق. مع التنويه إلى أن ضريبة مكاشفة جمهور القراءة بالسيرة الذاتية الحقيقية للكاتب قد تجرّ عليه مواقف كثيرة صعبة ومحرجة.
قاص وروئي كويتي
هل كتبت «ظلال مكة» كسيرة ذاتية؟
أحمد بوقري
حين شرعت في كتابة «ظلال مكة» لم يكن هاجسي الأساس كتابة سيرتي الذاتية أو الأدبية فأنا لم أصل بعد إلى نهاية الأفق الكتابي أو إلى لحظة الاستراحة الذهنية الواجبة، بل- آملًا- أن يكون في العمر بقية إذ ما زال يحتشد بزخم كتابات أدبية وفكرية ونقدية لم تنجز بعد. إنما كان هاجسي الأهم والمفصلي، هو القبض على اللحظة التاريخية المكية الغائبة عن جيلنا المعاصر، لحظة المكان المتواري من تاريخيته المكانية، ولحظة الزمان الذي فقد قسماته ولن يعود إلى تاريخيته النوستالجية المندثرة، بمعنى حين بدأت أكتب الحكايات الصغيرة المتتالية التي جاءت في شكلٍ سردي فني قصير، لم تخلُ من تخييلته بالطبع، أردت من هذه الحكايات أن تكون تعبيرًا بسيطًا كاشفًا عن هاتين اللحظتين الذائبتين، فقسمت الكتاب إلى ظلالين اثنين انضويا تحت ظل مكة القدسي الكبير، وهما ظلال المكان وظلال الذكرى كما كنت عائشًا غائصًا في كنفهما. تعهدت بيني وبين قلمي وضميري أن يكون بوّاحًا شفافًا لا يلوي عن كشف المسكوت عنه فيما ترتضيه أخلاقيات الكتابة وحقيقة الواقع المجردة كما عشته وجربته وخبرته.
 وصرحت بذلك في متن الظلال نفسها حين قلت: «في كتابة هذه السيرة الذاتية تحضرني مقولة أبي حامد الغزالي: «المضنون به على غير أهله»؛ إذ يصبح الحديث عن المسكوت عنه هو الهيكل العظمي للبناء القص-سيري؛ إذ دونه يصبح البوح سطحيًّا وباهتًا أو فاقدًا لحرارته وجرأته التاريخية والفنية.
وصرحت بذلك في متن الظلال نفسها حين قلت: «في كتابة هذه السيرة الذاتية تحضرني مقولة أبي حامد الغزالي: «المضنون به على غير أهله»؛ إذ يصبح الحديث عن المسكوت عنه هو الهيكل العظمي للبناء القص-سيري؛ إذ دونه يصبح البوح سطحيًّا وباهتًا أو فاقدًا لحرارته وجرأته التاريخية والفنية.
كسرت أنا هذه الحيرة (الأخلاقية) بين ما أضن به على غيري أو ما أسكت عنه في ظلال البيوت، أو حكايا الذكريات مع أبي، لكنني هنا وبشيء من المكاشفة والشفافية التي تقف في منطقة وسطى بين المضنون به والمسكوت عنه سأترك لقلمي فيما بقي من الحكايا الغوص في الدهاليز المعتمة في جنبات هذه السيرة، بمعنى أن أي سرد سير-روائي في نظري يفقد صدقه الفني والتاريخي إن حاول إخفاء بعض الحقائق والوقائع الصغيرة، التي لا يشكل المرور عليها أو ذكرها خدوشًا في اللوحة العائلية، أو اضطرابًا في الجدارية الهائلة الشخصية للمروي عنه.
وكثيرًا ما سقطت الكتابات التاريخية والسيرية في مستنقع التزييف والتمويه والتعمية؛ إما لأهداف أيديولوجية أو (أخلاقية) زائفة أو لا أخلاقية في الوقت ذاته في لَيّ أعناق الحقائق، وإما لفقدان قيمة الجرأة والشجاعة الواعية حين تم التغاضي عن المسكوت عنه من الأحداث والجرائم والوقائع؛ وهو ما خلق لدى المتلقي بالنتيجة وعيًا زائفًا بالحاضر منبنيًا على ضلالات وإكراهات وظلامات الماضي. في الحالة السردية يكتسب الحديث عن هذا المسكوت عنه أهمية استثنائية وفنية؛ إذ كثيرًا ما يكون أدب اعتراف، وكشفًا حميميًّا لصور الضعف البشري وانهيارات الذات أمام إغواءات الحياة ومغريات النفس والروح وشهواتها.
ناقد وكاتب سعودي
أسباب دفعتني للكتابة عن سيرتي الذاتية
علوان الجيلاني
لا أعرف سببًا محددًا لكتابتي عن سيرتي الذاتية، ربما هي طبيعتي الخاصة، وميلي الشديد للاحتفاظ بتفاصيل حياتي، وربما أنه تكويني الأسري والاجتماعي. وأحيانًا أفكر أن الأمر يتعلق بالمكان وما أصابه من تبدلات، بشكل خاص. أقصد التبدلات القسرية التي أحدثتها فيه التيارات الدينية المتطرفة منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين، وهي تبدلات طالت التدين الصوفي الذي كان يصبغ على المكان روحانية ثرية ومتسامحة، كما طالت الفنون الشفافية والموروث المتعلق بها من رقص وغناء وملابس وعادات وتقاليد بالغة الفرادة، وطالت مظاهر التشارك خاصة بين الرجال والنساء في كل وجوه الحياة. ذلك كله ليس بعيدًا من الحنين الذي ملأني به البعد عن المكان معظم الوقت منذ عام 1990م، عندما انتقلت من الجيلانية، القرية الوادعة في قلب تهامة (غرب اليمن)، إلى العاصمة صنعاء، بدأت التفكير في كتابة رواية سيرية عام 2009م، لكني كنت أنتظر ثلاثة أمور:
أولها: اكتشاف طريقة خاصة ينسرد من خلالها المكان وناسه بتناسج محكم ومتناسب مع حضوري طفلًا في السرد. ثانيها: كتابة الرواية بلغة تجترح نفسها بعيدًا من النماذج التي قرأتها. كنت أريد أن أكتبها بلغة تعبر عن روح المكان نفسه، وعن عوالمه التي تختزنها ذاكرتي بشكل جيد. وأنا من ذلك النوع من الناس الذين يحتفظ وعيهم بمشاهد وأحداث وقعت في وقت مبكر جدًّا من طفولتهم. كنت أذكّر إخوتي الأكبر سنًّا مني بأحداث لا يتذكرونها. وأعتقد أني نجحت في كتابة روايتي كما تخيلتها لغة وأسلوبًا. ثالثها: أني كنت أنتظر لحظة وصولي إلى ذروة النوستالجيا كي أبدأ الكتابة، وقد حدث ذلك بالفعل بين نهاية عام 2019م وبداية 2020م. كنت وقتها أقيم في القاهرة، وكانت قد مرت علي خمس سنوات بعيدًا من اليمن، مات أبي مطلع عام 2018م وأنا في زحمة ذلك الغياب، وأبي يشكل بالنسبة لي روح تلك النوستالجيا، ثم أحاطت بي حروب استهدفتني وجودًا وإبداعًا، وفجأة وجدت نفسي أكتب.
فيما يتعلق بخوف الكاتب العربي من الإقدام على كتابة سيرته الذاتية، فإني أعتقد أن الأمر يمكن تقسيم أسبابه؛ فهناك من يحجم لأن في سيرته ما لا يود تذكره، وهناك من يتملكهم الخوف من الكتابة السيرية نفسها. الكتابة عن الذات صعبة بوصفها فنًّا أكثر من صعوبتها كمحاذير اجتماعية أو ثقافية أو دينية. أعرف كُتابًا حاولوا لكنهم عجزوا؛ لأنهم لم يروا في حياتهم ما يستحق، مع أني أعرف أن في حياة كل شخص ما يستحق، المهم كيف نكتبه
شاعر وناقد يمني
العرب يؤمنون بمبدأ «إذا ابتليتم فاستتروا»
محمد عبيدالله
يخيل إليّ أن السيرة الذاتية بجذورها العربية كثيرًا ما استراحت إلى مبدأ (التحدث بنعمة الله) وفق التسمية التي اختارها جلال الدين السيوطي قديمًا وحسين نصار حديثًا لسيرتيهما، مما يعني التركيز على الجوانب المضيئة وعلى النجاح وما يستدعي الشكر والحمد، وربما شيء من التبرير في بعض الأحيان من دون الصراحة والجرأة الكافية في سرد الأخطاء والتجارب الخاصة المخجلة. وفي هذا تغليب لسياسة «إذا بُليتم فاستتروا»، أدى إلى ضمور ثقافة الاعتراف والصراحة الكلية، وإلى التهرب من الإخفاقات والأخطاء والالتفاف عليها بالتناسي والإهمال وطلب الغفران عنها سرًّا وليس علانية.
نوقن أن حياة الإنسان ليست نسقًا واحدًا من اللياقة والتعفف والبراءة، إلا إذا كان المرء نبيًّا أو وليًّا صالحًا. إنها حياة تتصارع فيها العناصر الخيرة والشريرة، فضلًا عن نسبية الخطأ والصواب، من منظور الفرد، والمثقف الذي غالبًا ما يسبق مجتمعه ويصطدم مع قناعاته. مجتمعاتنا تميل إلى التزييف، ولا يتشابه ظاهرها مع باطنها، ومهمة الكتابة هي إعلان الباطن وفضحه، وهي مهمة من مهمات السيرة الذاتية ووجه من وجوه تحدياتها الكثيرة.
أما تسريب السيرة في الأعمال الأدبية تحت قناع روائي أو قصصي أو شعري، فربما تكون أخف وطأة وأكثر ثراء من السيرة الذاتية الخالصة؛ ذلك أن هذه الأنواع تقوم على عقد ضمني مع القارئ أساسه الخيال لا الحقيقة. والصدق الفني مختلف عن الصدق التحقيقي الذي تطلبه السيرة الخالصة وترنو إليه. وأنا شخصيًّا أقدر كثيرًا من الأعمال الروائية التي شكلت قناعًا سيريًّا لمؤلفيها، حتى وإن كان الدافع الأصلي لمثل هذا التحول يتمثل في محاولة تجاوز خطوط المنع والتشكيك والاستنكار، أي الهروب من سلطة المجتمع وممنوعاته باللجوء إلى الشكل الروائي الذي يبني عقده على التخييل وليس قول الحقيقة.
أضرب على ذلك بأعمال كتاب أردنيين راحلين أعرف تجاربهم: غالب هلسا، مؤنس الرزاز، إلياس فركوح. فهؤلاء الثلاثة كتبوا رواياتهم مستهدين بالخطوط الأساسية في سيرهم الذاتية، وأبطالهم الرئيسون هم المؤلفون أنفسهم، بأسماء مستعارة ووقائع تختلط فيها مساحات الواقع مع التخييل، وفي أعمالهم لقاء خاص وثري بين السيرة الذاتية والرواية والهوية، مما أسهم في تقديم تجارب كبرى مميزة لا تنغلق على فردية السيرة وتدوينها المنغلق.
أما في إطار تجربتي الذاتية فقد تسربت سيرتي ووقائع من حياتي وطفولتي وشبابي في ديوانَيْ شِعر نشرتهما قبل سنين طويلة، هما: «مطعونا بالغياب» (1993م)، و«سحب خرساء» (2005م). يسمح الشعر الغنائي، بشكله التقليدي والحديث، لمثل هذا اللقاء مع السيرة بعد تكثيفها واستخراج ما هو شعري منها. ومع أن الشكل الشائع للسيرة هو الشكل النثري فلا يوجد مانع من كتابة السيرة شعرًا، ولكن هذا النوع الشعري لم ينل حظه من الاهتمام كما هي حال السيرة النثرية.
كاتب وناقد أردني
سربت سيرتي في أعمالي الروائية

نبيل سليمان
في روايتي الأولى «ينداح الطوفان» (1970م)، تسربت من سيرتي أمشاج محدودة، من دون أن يكون ذلك متعمدًا أو مقصودًا، مما يتعلق بسنوات إقامتي في القرية، وعملي معلمًا. وسيأتي مثل ذلك في رواية «ثلج الصيف» (1973م)، مما يتعلق بسفري من بيروت إلى دمشق إلى حلب إلى الرقة، حيث كانت مئات الكيلومترات ترفل بالثلج. أما روايتا «السجن» (1972م)، و«جرماتي أو ملف البلاد التي سوف تعيش بعد الحرب» (1977)، فقد جاءتا (بريئتين) من تسريب سيري. وتلك إذن كانت حصيلة الروايات الأربع خلال سبعينيات القرن الماضي.
غير أن السيرية بلغت في رواية «المسلة» (1980م)، أن حملت الشخصية المحورية فيها اسمي الأول (نبيل). وفيما أعلم كان قد سبقني غالب هلسا وحده إلى تسمية الشخصية المحورية باسمه الأول. وقد جاء ذلك أيضًا في رواية «محاولة للخروج» 1980م، لعبدالحكيم قاسم. وستقوم عام 1985م روايتي «هزائم مبكرة» على السيرية، مما يتعلق بنشأتي وسنوات التعليم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وقد تقنعت السيرية في هذه الرواية بتبديل اسم الشخصية المحورية للرواية، كما توسلت المواربة بنسبة ما فيما يتعلق بالجنس وبالتابو في مراهقة هذه الشخصية.
من ثلاث وعشرين رواية خلال ثلاث وخمسين سنة، اشتبك السيري بالروائي في الروايات العشر التي ذكرتها. وعلى الرغم مما ذكرت من المواربة ومن القناع- وهما غالبان على حضور السيرة في الرواية العربية بعامة- فقد تنامت جرأتي على تشغيل السيري في الروائي، من رواية إلى رواية. بعد شهور من صدور روايتي الأولى «ينداح الطوفان» يبدو أن قارئًا أو أكثر وشى بالرواية وبكاتبها إلى أسرتين من القرية التي يقيم فيها أهلي، فهاجم كبير إحدى الأسرتين والدي، وهاجمني شاب من الأسرة الأخرى. وقد تحاشيت طويلًا أن يقرأ والدي رواية «هزائم مبكرة» لما فيها من الصبوات الجنسية لظلّ الكاتب: شخصية خليل. لكنني اكتشفت بعد عشر سنوات، إنْ لم يكن أكثر، أنه قرأ الرواية. ولعله كان -رحمه الله- أكثر رحابة مني ومن أمثالي من الروائيين الذين يخاتلون السيرية.
لقد تنامى حضور السيرة في الرواية العربية، وتضاعفت روايات التخييل الذاتي، لكن سطوة النفاق والتحريم والتكاذب لا تزال طاغية في الفضاء العربي الإسلامي عامةً. ومن أسف أن هذه السطوة تضاعفت في البلدان التي عاشت منذ عام 2010م ما عُرف بالربيع العربي. ففي سوريا مثلًا يترصد للروايات السيرية وللسيرة الذاتية، كما للكتابة عامةً، رقيب عتيد من رُقباء السلطان الاجتماعي أو السلطان الديني أو السلطان السياسي. ولا يختلف الأمر إلا بمقدار بين جزء وجزء من أجزاء سوريا المقسمة.
وفي المقابل نجد درجة أعلى من الجرأة في الروايات السورية وغير السورية التي تصدر في بلاد المنافي والهجرات والتهجير.
روائي وناقد سوري
كنت صادقًا في سيرتي فلم يكن لدي ما أخسره
عبداللطيف الوراري
ترك لنا العرب القدامى إرثًا سيريًّا كثيرًا ومتنوّعًا، عنوا فيه بالتأريخ للفرد وترجمة حياته بصورةٍ من الصور. وترافق هذا التأريخ للأفراد واتّسع مداه مع ما عرف بــ(أدب التراجم والطبقات)، الذي تلا عصر الرواية والتدوين، وتمخّض عنه تدوين سير الرجال، مترسّمين «علم الجرح والتعديل»، وهو من التجارب الرائدة في مجال تمحيص تاريخ حياة شخص ما حتى أصبح نموذجًا للمعاجم السيرية التي تناولت، بروح الدقة والصرامة، تراجم الرجال في شتى فنون المعرفة. وفي المقابل، ألف آخرون كتبًا ورسائل قائمة الذات هي بمنزلة تراجم وسير ذاتية صرّفوها، تعبيرًا واعتبارًا، في الحديث عن أهواء النفس وصراعها الروحي، وذكرياتهم، وتحوّلات عصرهم المضطرب، وقلاقل دولهم. وتضعنا هذه الكتب والرسائل أمام حقيقة أن فنًّا من الكتابة اسمه «فن التراجم الذاتية أو السيرة الذاتية» كان موجودًا في الأدب والثقافة العربيين، ويبين عن ملامح واشتراطات ومواصفات خاصة لـ«نوع أدبي» كان يتطور باستمرار، وبالتالي يدحض المغالطات التي شاعت في الأدب الغربي وأشاعها الفكر الاستشراقي أو الكولونيالي والإغرابي بعد ذلك، والقائلة: إن أدب «السيرة الذاتية والاعتراف» إنما هو نوع غربي خالص لم يعرفه غير الأورُبيين.
عندما أقبلتُ على كتابة شذراتٍ من سيرتي الذاتية المسماة «ضوء ودخان» (منشورات سليكي أخوين- طنجة 2016م)، وضعتُ نصب عينيّ مبدأ الصدق على نحو من الأنحاء؛ لأني ليس لي ما أخسره بعد الذي خسرته من أيام حياتي، فكتبتُ وفق ما يمليه عَلَيّ شرطي الإنساني، بما فيه من نواقص ومشاعر متضاربة، إلى حد معقول من الحرية الذي لا يتنافى مع الإبداع، ولكن لا يفتتن بالسنن المجتمعي الضاغط بقدر ما هو يسعى إلى تغييره. إن للسيرة الذاتية، كما قال فيليب لوجون، كينونة جميلة مستحيلة، وليس ثمة من مانعٍ لكي تُوجد. لقد كان لي في شذراتي السيرية مساحات من البوح والاعتراف، فسعيتُ قدر الإمكان إلى أن أقتسم مع قارئي جوانب من شخصيتي منذ طفولتي، وأن أظهر بنواقصي وآلامي وأحلامي، كما أملاها عليّ الحال وقتئذ، وأن أُوجد في صميم هذه الشذرات ما يُشعرني وإياه بشرطنا الإنساني الذي هو جماع مقادير وخيبات ومصادفات تقع في منعرجات الحياة. لكن صدّقْني إذا قلتُ: إنّ شيئًا من الأمان ومن الاستشفاء قد أوجدته لنفسي، وأنا أواصل هذه الشذرات؛ هذه الجرعات.
كاتب وناقد مغربي
إشكاليات السيرة الذاتية في الأدب العربي

محمد الشحات
تُعدّ كتابة السيرة الذاتية من أكثر الأنواع الأدبية إشكالية في الثقافة العربية؛ نظرًا لأن حضورها يرتبط بماهيتها وفلسفتها الوظيفية في بنية المجتمع الذي ينتجها ويتداولها. ولأن أغلب المجتمعات العربية تُضيّق الخِنَاق على الكُتّاب والمُبدعين والمُفكّرين، يغدو الأمر أكثر صعوبة عندما يلجأ الكاتب العربي إلى كتابة سيرته الذاتية في شكل سردي مقصود. ولعل سيرة «الأيام» (1929- 1939م) لطه حسين تُعدّ بمنزلة رأس الحربة في هذا النوع السردي الإشكالي. وما أكثر التحليلات والانتقادات التي واجهت هذا الكتاب لطه حسين، ولا تزال.
تعتمد سردية السيرة الذاتية على نوع من المكاشفة الذاتية التي يمثّلها ميثاق السيرة أو عقد السيرة الذي يُنظر إليه بوصفه عقدًا «قانونيًّا» بين الكاتب والقارئ؛ شرطه الأول «الشفافية» وشرطه الثاني «مساءلة الذات» وشرطه الثالث «إلقاء الضوء على قطاع كبير من حياة الشخصية المحورية»، وسرد تجربتها الحياتية التي غالبًا ما يتخذ راويها من زمان ومكان الطفولة نقطة انطلاق أثيرة تمثّل أغلب بدايات السير الذاتية العربية. وهنا، يمكن للقارئ العربي تأمّل عدد من السير الذاتية الشهيرة في القرن الماضي. بيد أن ثمة إشكالية أخرى ذات مرجعية اصطلاحية أو مفهومية؛ إذ ينبغي التفرقة بين «السيرة الذاتية» و«السيرة الذاتية الروائية» و«رواية السيرة الذاتية» و«التراجم» و«المذكّرات». فالسيرة الذاتية نص سردي يُبئِّر على الذات بما يجعلها محور العملية السردية بأسرها، في توازن كبير بين الذاتي والمرجعي. أما إذا طغت صفة الروائية (أي التخييل) على الواقعي (المرجعي) فنحن بصدد رواية سيرة ذاتية. وهي النوع الأكثر شيوعًا في الثقافة العربية في الآونة الأخيرة، وبعضها ينحرف نحو مجرى الترجمة. وفي أحيان أخرى تهيمن على السرد القيمة المرجعية التي تربط تحولات الذات بالمكان والمجتمع في صعوده وهبوطه.
أما نصوص المذكرات فهي ضرب من السيرة الذاتية التي تُعنَى بالرصد اليومي لسلسلة متوالية من الأحداث المتصلة حيث يهيمن على السرد حضور المجتمع أكثر من حضور الأنا، فضلًا عن سلسلة من الأنواع البينيّة المنبثفة من هذا التداخل المعقَّد بين الذاتي والمرجعي، الواقعي والتخييلي، الإنساني والمجتمعي، كما في فنون «الرسائل» و«الصور الشخصية» (أو اللوحات القلمية أو البورتريهات).
لا تزال السيرة الذاتية العربية تعاني وطأةَ سلطةِ القمع وضيق مساحة الحرية التي لا تكفي كاتبًا واحدًا، كما كان يقول يوسف إدريس ذات يوم بعيد. ولأنها كتابة تحتمي بسلطة التخييل الذي يمنحها بعض الحرية يلجأ الكثير من الكُتّاب العرب إلى حيلة تشبه مبدأ «التقيّة» الذي يمزج فيه الكاتب بين الذاتي والمرجعي والتخييلي في بنية سردية واحدة، بحيث لا يستطيع الرقيب الديني أو السياسي أو المجتمعي مساءلته في القول والمساءلة والمكاشفة.
ناقد وأكاديمي مصري
سأكتب سيرتي على هيئة حكي عن موضوع ما
شهلا العجيلي
يفترض في كتابة السيرة الذاتية قيامها على الحكي الاستعادي، وأن تتسم ببلاغة اللغة، وإحكام البناء، وحسن التقسيم، وأن تجمع أجزاءها روح إبداعية واحدة، وأن تتضمن خبرات ومغامرات تجذب المتلقي، ولا سيما مع سرد المواجهات مع واحد أو أكثر من التابوهات، الاجتماعية والسياسية والدينية، ويمكن كذلك سرد الموقف الذاتي من أحد أحداث التاريخ المفصلية، وتفسيره.
ثمة سؤالان جوهريان في فن السيرة الذاتية؛ الأول عن إذا ما كانت أحداث السيرة وقائعية مطلقة أم تتضمن خيالًا، والثاني عن مدى عد السيرة الذاتية وثيقة تاريخية.
يمكن لكاتب السيرة الاستعانة بعناصر ضئيلة من الخيال؛ وذلك لربط أجزاء عمله، فتبدو في صورة محكمة متماسكة، كأن يستعمل الخيال في وصف فضاءات الأحداث والأمكنة، ولا سيما تلك التي تغيب عن ذاكرته، على ألا يسترسل في التخيل، ومن هنا ننتقل إلى إجابة السؤال الثاني، إذ لا تعد السيرة وثيقة تاريخية حول الأحداث العامة، فقد يتدخل فيها الخيال، كما ستحدد الرؤية الشخصية للحدث مسار تأويله من جانب المتلقي، ولا شكّ في أن رؤية الكاتب الذاتية مما حوله مضادة للرؤية الموضوعية التي يفترض أن تنطلق منها كتابة التاريخ، كما أن السيرة لا تخلو من مراوغات الذاكرة، ولا سيما أن معظم السير تكتب في وقت يكون فيه بينها وبين الأحداث مسافة زمنية طويلة، وإن كنا نفترض الصدق في السيرة الذاتية، وذلك بسبب من ميثاق القراءة بين المبدع والمتلقي الذي أشار إليه أمبرتو إيكو.
يجذبني ذلك الشكل المحدث من كتابة السيرة الذاتية، الذي يركز على علاقة الكاتب بثيمة محددة، ولا سيما إذا كان روائيًّا، فالروائي غالبًا يستنفد سيرته الذاتية في رواياته عبر أحداث ملتبسة، ومحورة، وبشخصيات مقنعة، ويتبقى له، من أجل السيرة، أن يروي ما وراء النصوص، أو الحكايات المتعلقة برحلة الكتابة، أما علاقته بثيمة محددة هي التي تحمل الجديد غالبًا. من ذلك ما فعله إبراهيم عبدالمجيد في كتابة سيرته مع السينما وعالم الأفلام في كتابه «أنا والسينما»، وما فعلته إيزابيل الليندي في «أفروديتيّات»، وما فعله الدكتور عبدالسلام العجيلي في كتابه «جيش الإنقاذ»؛ إذ كتب تجربته في حرب 1948م، وكانت سيرة ذاتية عن علاقته بفلسطين، وفيها كثير ممّا غاب عن المتلقّي في تلك المرحلة، ولعلّي أفكّر في كتابة سيرتي الذاتيّة بهذه الطريقة، أي بربطها بموضوع معيّن، ولا شكّ في أنّني لا أفكّر هذه اللحظة في مدى شجاعتي، وبما يمكن أن يقال، أو بالطريقة التي سنتحايل فيها على ما لا يقال، فذلك بالطبع رهن بلحظة الكتابة وبظروفها التاريخيّة.
روائية وأكاديمية سورية
السيرة الذاتية الحرة علامة على صحة المجتمع الثقافي

أمين الزاوي
السيرة الذاتية، بالنسبة لي، هي الحفر بعمق في الأعماق، أعماق الذات الكاتبة، الحفر بعنف ومن دون تحفظ، السيرة الذاتية هي قرينة الحياة، يجب أن تكتب بمرها وحلوها، بأخطائها وتهوراتها، بوسخها ونظافتها. وكتابتها تشبه «الحكة»، فكلما حك الكاتب المكان ازدادت لذة الحك أكثر وأعنف، واختلط الألم بالمتعة. وهي تقليب شجاع للأقاليم المسكوت عنها، وفتح الأبواب الموصدة كي يدخل الهواء، ويدخل القارئ إلى أعماق حياة الكاتب بكل تفاصيلها. وكل كاتب حقيقي بداخله جرح ما، يحمله على كتفيه كالصليب، وهي حالة «باثولوجية» لا تشفى إلا بكتابة السيرة الذاتية الصادقة المحرِّرَة.
وكتابة السيرة الذاتية ليست مرتبطة فقط بشجاعة الإفصاح عند الكاتب، ولكن أيضًا بمدى سقف الحرية الشخصية التي يمنحها المجتمع للفرد، ولأن هذه الحرية مفقودة أو محاربة في المجتمعات العربية والمغاربية فإن السيرة الذاتية غائبة. فالمجتمعات التي يحضر فيها الرقيب الديني والأخلاقي بشكل قامع لا يمكن فيها لكتابة السيرة الذاتية المتحررة أن تزدهر.
وكلما كانت ثقافة «القطيع» سائدة انتفت كتابة السيرة الذاتية الصادقة، تلك التي تبحث عن الفرد في تجلياته الحرة والمستقلة. ونحن أمام مجتمع «متدين» بامتياز، «تدين» مظهري وجماعي، وكل من يخرج عن ذلك فهو «كالذئب» الضائع الذي يسهل مطاردته.
وفي المجتمعات التي تقرأ الأدب بمقياس «العيب» و«الخجل» لا يمكننا تصور ازدهار كتابة السيرة الذاتية المتحررة والصادقة. أما في المجتمعات الغربية القائمة على احترام الحريات الشخصية كقيمة أساسية في المواطنة وحقوق الإنسان، والقائمة على «ثقافة الاعتراف» و«الغفران» كقيمة أساسية في الفكر المسيحي، ففي هذه المجتمعات تزدهر كتابة السيرة الذاتية العميقة الصادقة.
هذا الواقع السيكوثقافي والديني يجعلني أضحك وأنا أقرأ بعض ما يسمى بسيرة ذاتية في الأدب العربي والمغاربي المعاصر، إنها نصوص يبدو فيها الكاتب وهو يستعرض حياته كأنما يستعرض فصول حياة «ملاك» لا يخطئ ولا يذنب ولا يكفر ولا يخون، إن الطهرانية هي مرض عضوي في كتابة السيرة الذاتية عند الكتاب العرب. شخصيًّا كتبت سيرتي الذاتية وبكثير من الحرية ولكني لم أنشرها بعد، ليس خوفًا، لكني أعتقد أن الفرصة المناسبة لنشرها، نظرًا لما تحمله من نبش في ذاكرة طفل ومراهق وشاب من تفاصيل المحيط العائلي وحياة الأصدقاء، غير متوافرة حتى الآن.
روائي جزائري
السيرة الذاتية نتاج الذاكرة أكثر من الواقع
عبدالمقصود عبدالكريم
السيرة الذاتية نوع أدبي فريد، يعشق قراءته قُرّاء كثيرون، ومع ذلك يمكن الحديث عن ندرته النسبية، وبخاصة في مجتمعاتنا، الناطقة بالعربية. وبداية علينا التمييز بين «السيرة» التي يكتبها كاتب أو باحث عن شخص آخر، و«السيرة الذاتية» التي يكتبها صاحبها نفسه، أو يمليها على صحفي أو كاتب كما في السير الذاتية لبعض السياسيين البارزين. لكن الأمر يختلط أحيانًا، حين تكتب زوجة، على سبيل المثال، عن حياتها مع زوجها الكاتب أو الشاعر البارز، حينها يكون الكتاب سيرة ذاتية للزوجة وسيرة للزوج، ويقع في هذا الإطار كتاب انتهيت من ترجمته للتو، من تأليف فريدة لورانس، زوجة د. هـ. لورانس، عن حياتها مع لورانس، ويعتمد في جزء كبير منه على رسائل لورانس.
أول ما يخطر على البال عند الحديث عن السيرة الذاتية ومحاولة وصف هذا النوع الأدبي أنه نوع انتقائي رقابي، نوع يخضع للذاكرة وهي انتقائية بامتياز، ويخضع لأنواع شتى من الرقابة. وأفترض هنا مبدئيًّا أن الكاتب يحاول باستمرار توخي الصدق والدقة بقدر المستطاع.
أكرر كثيرًا أن الذاكرة تعمل بآليات معقدة يصعب تفسيرها غالبًا، وأنها تعمل بفلسفة خاصة بها. ربما يندهش معظمنا من أن ذاكرتنا تحتفظ بأشياء تبدو بالغة التفاهة وكثيرًا ما تنسى أحداثًا ربما نظن أنها بالغة الأهمية. أكرر هذا الآن لأن السيرة الذاتية تعتمد على الذاكرة، والذاكرة تنتقي وتزين وتحرف، وتحتفظ في معظم الأحيان بتفسيرنا الخاص للأحداث وصياغتنا الخاصة لها وليس بالأحداث نفسها. وبالتالي علينا أن ننظر إلى ما نكتبه من الذاكرة بريبة، بصرف النظر عن الدقة والصدق. وبالتالي يمكن القول: إن السيرة الذاتية نتاج الذاكرة أكثر مما هي نتاج الواقع، الواقع كما حدث بالفعل. ويمكن أيضًا إضافة أن الذاكرة لا تعرف الحياد غالبًا وأن ما تخزنه يتأثر بداية بانحيازنا.
نأتي إلى النقطة الثانية، وهي الرقابة. بداية في انتقائية الذاكرة نوع من الرقابة اللاشعورية، يمارسها اللاشعور في قمع أحداث لا نتحمل تذكرها، باختصار أسوأ من أن يتحمل الدماغ تذكرها. وهناك الرقابة الذاتية الواعية التي نمارسها بوعي، باستبعاد أحداث معينة لأننا نرى أنها تسيء إلينا، أو بمحاولة تزيينها وتفسيرها بما يتلاءم مع مزاجنا. في النهاية كتابة سيرة ذاتية حلم يراودني منذ زمن طويل، فقط أنتظر اللحظة المناسبة، واختيار الشكل المناسب لكتابتها، ومن الغريب أن يحيرني اختيار اللغة، وحتى لا يذهب الخيال بعيدًا، الاختيار هنا بين العربية الفصحى واللهجة المصرية، وربما تأتي في النهاية مزيجًا منهما.
شاعر ومترجم مصري
السير الذاتية أكثر مبيعًا من الرواية
خالد لطفي
كُتُب السير الذاتية من أكثر الكتب مبيعًا الآن في المكتبات، حتى إنها تفوقت على الأعمال الروائية، وبخاصة سير المشاهير مثل سيمون دي بوفوار، وجورج أورويل والأمير هاري وغيرهم، ربما لأن الناس تفتقد إلى القدوة الآن، أو أنهم يبحثون عن النماذج الناجحة كي يعرفوا سر نجاحها. فقصص المشاهير من رجال الأعمال تلقى رواجًا كبيرًا؛ لأن الناس تبحث عن الحقيقة أو الشيء المفيد بالنسبة لهم، وليس مجرد حكاية أو قصة خيالية، حتى ندوات الكتابة الذاتية تلقى إقبالًا كبيرًا. بما يعني أن الناس لديها رغبة في معرفة أسرار وتفاصيل حياة المشاهير، وربما هذا هو السبب في أن السير الذاتية التي تحتوي على حقائق وأسرار جديدة من الأعمال الأكثر مبيعًا. كذلك تأتي كتب التنمية البشرية، بما تقدمه من خبرات ونصائح للقارئ، في قائمة الأعمال الأكثر مبيعًا، ومعها كتب الرسائل، مثل رسائل سيمون دي بوفوار وبول سارتر وهنري ميلر، ورسائل غسان كنفاني التي لاقت قبولًا واسعًا، لكن هذا النوع من الكتب مثله مثل كتب السيرة الذاتية لا يوجد كتاب كثيرون له في العالم العربي.
في العموم ليس هناك كتاب كثيرون يحرصون على كتابة سيرهم الذاتية، فهناك كتابة ذاتية، لكنها ليست سير ذاتية، أي أنهم يكتبون روايات بها جانب من ذاتهم، وهذه أيضًا يقبل الناس على شرائها. وبعضٌ لديهم في حياتهم ما يستحق الكتابة والإقبال على شرائه، لديهم قصص نجاح يسعى الناس لمعرفة تفاصيلها، لكن ليس كل الناس لديهم الشجاعة كي يكتبوا سيرهم، وليس كل سيرة تستحق الكتابة.
مدير مكتبة تنمية بالقاهرة
أن تكتب امرأة سيرتها أن تشق بُرقعها لتَرى وتُرى
هدى الدغفق
أحسب أن من تكتب سيرتها أو تسجل اعترافاتها كاتبة شجاعة؛ فهي تخوض معارك غير مضمونة النتائج مع ذاتها ومع ذوي القربى والمجتمع، ثم مع الوسط الإعلامي بل العالم كله. لقد عانيت ألوانَ الهواجس التي ظلت تكدر لحظات كتابتي، كما تمثل لي رقيبي الذاتي وهو يحاصرني شبحًا عصيًّا. ولقد نجحت في مقاومته ليتراجع شيئًا فشيئًا، وذلك بفضل مقدرتي على إقناع ذاتي بأنني لن أنشر ما أكتبه. وذلك ما حفزني لأواصل كتابة كل ما تذكرته عن طفولتي ومراهقتي وشبابي وزواجي وطلاقي وما بعده من دون تحفظ.
أما عنوان كتابي وهو «أشق البُرقع أرى». فلقد توقعت تلك الهجمات التي اعترضت طريقي قبل النشر وبعده مثل عدم فسح كتابي وعدم قبول المتلقي التقليدي للعنوان حسب تفسيره؛ ولذلك هداني حدسي إلى أهمية كتابة مقدمة توضيحية، وكانت فيما بعد حجة لي ذكرت فيها: «كل ما يحول دون ذاتي، كل ما يحول دون رؤيتي، برقع سوف أشقه لأَرى وأُرى».
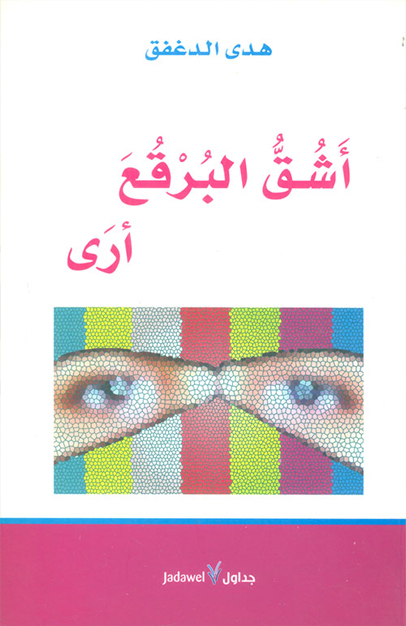 ولعل تداول وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الحسابات الخاصة والتفاعل مع التعبير الذاتي والتهافت على الكتابة والتفاعل اللحظي وشجاعة المستخدمين في الكتابة عن حياتهم ونشر يومياتهم، هو ما دفعني إلى المسارعة بنشر كتابي؛ فلقد خشيت أن يهدأ حماسي لكتابته ويتغير رأيي بنشره. لذلك عندما أخبرتني دار النشر أنها سوف تؤجل طباعة كتابي عامًا آخر تركتها إلى دار نشر غيرها.
ولعل تداول وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الحسابات الخاصة والتفاعل مع التعبير الذاتي والتهافت على الكتابة والتفاعل اللحظي وشجاعة المستخدمين في الكتابة عن حياتهم ونشر يومياتهم، هو ما دفعني إلى المسارعة بنشر كتابي؛ فلقد خشيت أن يهدأ حماسي لكتابته ويتغير رأيي بنشره. لذلك عندما أخبرتني دار النشر أنها سوف تؤجل طباعة كتابي عامًا آخر تركتها إلى دار نشر غيرها.
لقد فوجئت بما أشعر به من وحشة مكانية وأنا أحرر كتاب «أشق البرقع أرى» حيث اضطرني ذلك إلى الابتعاد مكانيًّا لألوذ بذاتي عن الرقيب الاجتماعي الذي أحسست بأنه يجثم على جمجمتي، فاخترت الارتحال إلى بعض البلدان؛ كي أحتفظ بروح شجاعتي في السرد. لقد كان الصباح والنهار بشكل عام فرصة حقيقية اقتنصتها للتخلص من شعوري بالرقيب وأنا أكتب سيرتي تلك. فالشياطين لا ترى في الشمس. وبرغم صعوبة الأمر فقد تغلبت على قلقي من موقف بعض الأسماء التي وردت في سيرتي من صديقات وزملاء ومعلمات ومن عائلتي وبعض أقاربي، ومن المؤسسات الحكومية التربوية والثقافية وغيرها.
لم أعرض كتابي «أشق البرقع أرى» على أحد لاستشارته قبل طباعته؛ لأنني لا أريد أن أتأثر برأيه وأفقد شهية السرد. فقد ألمحت لبعض الصديقات عن عزمي على نشر سيرتي وحذرنني من ذلك. قال لي أحدهم: لا يجدر بك أن تكتبي سيرتك قبل الستين، لكن اقتناعي بضرورة كتابة سيرتي من دون الالتزام بالأفكار التقليدية غير العلمية شكل لي تحدّيًا لمواصلة كتابتي؛ لعلي بذلك أفتح بابًا ظل مغلقًا مدةً من الزمن ليس في السعودية وحسب، بل في منطقة الخليج كلها وهو أدب السيرة الذاتية.
بعد طباعة «أشق البرقع أرى» خضت معارك مع تلك القراءات التي حكمت على الكتاب من عنوانه فقط من دون قراءة مضمونه. فلقد انهالت عليَّ انتقادات عبر تويتر والفيسبوك حول العنوان، بل إن بعضهم بعث بردود أفعاله إلى وزارة الثقافة والإعلام آنذاك، وكتب إلى قسم الرقابة مطالبًا بمنع بيع كتاب «أشق البرقع أرى» أو تداوله. فيما كتب بعضهم رأيه بحيادية مثل الأستاذ منذر عياشي الذي أشار في مجلة اليمامة قائلًا: «كتاب لامرأة تحب المرأة السعودية». وهذه الغاية الحقة من كتابة سيرتي وهي مساعدة النسوة في بلادي بشكل خاص، على تجاوز أزماتهن في تجاربهن الإنسانية والعائلية البسيطة.
لا أخفيكم أن هناك اعترافات لم تعلم بها عائلتي مثل تجربة تدربي على السياقة في مدارس تعليم السياقة بالبحرين، وسفري للمشاركة في بعض المهرجانات الثقافية الأدبية كشاعرة، ولقد كانت تلك البلاد تعيش ثوراتها آنذاك. ولعلي أردت أن أخبر عائلتي عن ذلك من خلال سيرتي التي عرفتني بي ومكنتني من تحليل كثير من المواقف الاجتماعية والواقع؛ إذ عشت حوارًا ذاتيًّا يستقرئ تفكيري وأنا أكتب. وكانت سيرتي مسكّنًا أحاطتني بحالة من الطمأنينة الأدبية والروحية. لم تكن سيرتي ثائرة بل كانت واقعية فيما ترويه. وهي وإن كانت فردية عند بوحها فقد أضحت جماعية بعد قراءتها من الآخرين وهذا هو العزاء.
شاعرة سعودية
ليس في سيرتي الذاتية ما يستحق الكتابة

محمود الورداني – قاص وروائي مصري
أتكئ في قصصي ورواياتي على ما عشته وما شاهدته وما لمسته. والاتكاء لا يعني أن تكتب ما جرى، إذ لا يمكن أن تكتب ما جرى أصلًا؛ لأن الكتابة عملية خلق، وهي تستكمل تفاصيلها في أثناء عملية الكتابة ذاتها، فليس كل ما جرى لك صالحًا لأن تسجله، وإلا فسوف تسجل ما لا يندرج في الكتابة؛ لأن الكتابة عملية خلق وليس تسجيلًا، وعندما أبدأ في كتابة أي عمل لا تكون الصورة واضحة في ذهني، بمعنى أن ما أنوي كتابته لا يكون واضحًا في ذهني، فأنا أتعرف إليه في أثناء الكتابة وليس قبلها. خبرتي بالناس وبالمدينة والحواري والشوارع التي عشت فيها والأعمال التي اضطررت لممارستها منذ طفولتي، كل هذا هو الخلفية أو الزاد الذي أستمد منه الكتابة، أنا لا أعرف مثلًا كيف يعيش الفلاحون، لا أعرف كيف يعيش أبناء الأرستقراطية، لا أعرف تفاصيلهم الملموسة، ولا روائحهم، ولا أستطيع أن أكون مفتعلًا، ولا بد أن ما أكتبه في نطاق خبرتي المباشرة. ومن ثم الإدراك الحسي، وهو السبيل لرؤية هذا العالم أو ذلك، يعني أن تسم رائحته، وأن ترى ألوانًا بعينها، وتشم أنفاس من تكتب عنهم. هناك عمل لي قريب جدًّا من حياتي الشخصية وهو «بيت النار»، وهو يتتبع المهن التي عمل بها الروائي منذ طفولته حتى وجوده في السجن بسبب سياسي. كل ما ورد في هذا العمل قريب مني، ولكن ليس هناك تفصيلة واحدة حدثت بالفعل لي، فأنا حين أكتب أتحرر بالفعل من السيرة؛ لأنه لا يجوز لي أن أسجل السيرة، فأنا أستسلم للكتابة ذاتها، فالكتابة هي التي تقودني وليس العكس، قد أبدأ الكتابة عن شخصية ما، وأظنها شخصية طيبة، لكن قد تقودني الكتابة عنها إلى شكل مختلف عن ذلك.
أعرف جيدًا مشكلة كتابة السيرة الذاتية والتعبير فيها عن تفاصيل خاصة أو حجرة في مجتمع مثل مجتمعاتنا، كما حدث مع لويس عوض حين كتب «أوراق العمر»، لكن بالنسبة لي الأمر مختلف، فأنا لا أشعر أن لدي ما أخجل منه في سيرتي الذاتية، لكني لا أرى أن حياتي الشخصية مهمة. وحين حاولت كتابة سيرتي الذاتية في كتاب «الإمساك بالقمر»، الصادر منذ عامين، كتبت عن سيرة الجيل الذي أنتمي إليه، والمدة التي عشتها معه، وانتسبت فيها إلى جماعة أدبية، وذوق أدبي جديد، وعن المغامرة السياسية التي أشرف بالانتماء إليها، ولم أشعر أنني بحاجة للكلام عن أمور شخصية، ربما لأنني كما قلت لا أرى أن سيرتي الذاتية في حد ذاتها تستحق التوقف أمامها والكتابة عنها وحدها، لكن بالتأكيد تأمل ما جرى مع جيلي ومرحلتي أمر يستحق الحديث عنه، وهو ما أسعى إليه في كتاباتي الروائية والقصصية.
هوامش:
(1) Franz Rosenthal, “Die arabische Autobiographie”; in: Studia Arabica 1 (Analecta Orientalia 14), 1937, p.11 : “Das autobiographische Schaffen im Islam ist weniger an die Persönlichkeit als an die Sache gebunden. Die Erlebnisse des Einzelnen bieten nicht als solche an sich den Anreiz zu ihrer Mitteilung, sondern nur durch ihren allgemeinengültigen lehrhaften Gahalt.”
(2) جلال الدين السيوطي، كتاب التحدث بنعمة الله (العباسية: المطبعة العربية الحديثة، 1975م) ص 3.
(3) Thomas Philipp, “The Autobiography in Modern Arab Literature and Culture”, in : Poetics Today 14: 3 (Fall 1993).
(4) Cf. Dwight F. Reynolds (Edited by), Interpreting the Self. Autobiography in the Arabic Literary Tradition (London: University of California Press, 2001), pp. 72 sqq.
(5) Cf. Georges May, L’autobiographie (Paris : PUF, 1979, 1984), pp. 17 sq.
(6) إحسان عباس، فن السيرة (بيروت: دار صادر، 1956م)، ص 35.
(7) Delphine Scotto di Vettimo, “L’écriture autobiographique : un plaidoyer pour l’intime”, in : Connexions 105/ 2016-1, pp. 109 sq.
(8) L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, § 256.
(9) Anatole France, Le Livre de mon ami (1885).
(10) Georges Gusdorf, Les écritures du moi. Lignes de vie 1 (Paris : Odile Jacob, 1991).
(11) Cf. Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique (Paris : Seuil, 1975).
(12) Georges Gusdorf, Les écritures du moi. Lignes de vie 1, op. cit. p. 11.
(13) Ibid.
(14) Vincent Colonna, L’autofiction (essai sur la fictionalisation de soi en littérature). Doctorat de l’E. H.E.S.S., 1989, pp. 16 sqq.
(15) Roland Barthes, Le lexique de l’auteur (Pars : Seuil, 2010), p. 100.
(16) J. Rancière, “Politiques de l’écriture”, in : Jean-François Côté et Régine Robin (dir.), “La sociologie saisie par la littérature”, Cahiers de recherche sociologique, n° 26, 1996, p. 19-37.
(17) Leigh Gilmore, The Limits of Autobiography. Trauma and Testimony (London: Cornell University Press, 2001).
(18) Ibid. p. 11.
(19) M. Foucault, L’Usage des plaisirs, Gallimard, 1984, p.15-16.
(20) إيف ستالوني، الأجناس الأدبية. ترجمة محمد زكراوي (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2014م)، ص 214.
(21) Georges May, L’autobiographie, op. cit. pp. 41 sq ; 55 sq.; 81 sq.; 86 sq.
(22) Cf. Catherine Chabert, Féminin mélancolique, Paris, Puf, 2003.
(23) [بلا مؤلف]، رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان. مع ملحق بمقتطفات من آراء نقدية لـ 220 كاتبة وكاتب. قدمت لها: غادة السمان (بيروت: منشورات غادة السمان، ط. 1، 1992م، ط. 13، 2022م)، صص 109-183.
(24) نفسه، ص 4.
(25) Leigh Gilmore, The Limits of Autobiography. 8
(26) Julian Henriques et at., Changing the Subject: Psychology, Social Regulation and Subjectivity (London: Methuen, 1984), 117.
(27) Susan Friedman, Mappings.
(28) Bronwyn Davies, “The Concept of Agency: A Feminist Poststructuralist Analysis,” The International Journal of Social and Cultural Practices, no. 30 (December 1991), 43.
(29) حاتم الصكر، السيرة الذاتية النسوية: البوح والترميز القهري. مجلة فصول، عدد 63، 2004.
(30) Shari Benstock, “Authorizing the Autobiographical.” In Feminisms: An Anthology of Literary Theory and Criticism. Warhol and Herndl, eds. New Brunswick, N.J.: Rutgers U P, 1991, . . 1040-57.
(31) Liz Stanley, “The Knowing Because Experiencing Subject: Narratives, Lives and Autobiography.” Lennon et al., eds. 135
(32) Teresa de Lauretis, (1984). Alice Doesn’t: Feminism, Semiotics, Cinema. Bloomington: Indiana U P, 159.
(33) Caren Kaplan. (1996). Questions of Travel: Postmodern Discourses of Displacement. Durham: Duke U P.






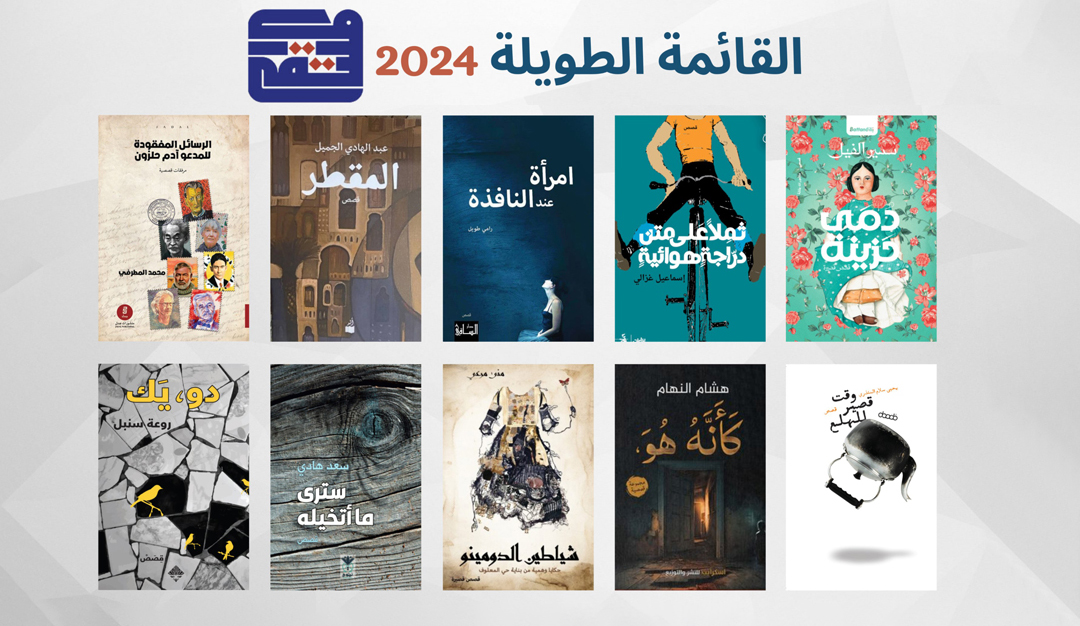
 ودارت في الأشهر الماضية اجتماعات، ونقاشات، ومداولات متعددة ومطولة بين أعضاء اللجنة للوصول إلى أهم المجاميع القصصية، التي تستحق بجدارة أن تكون حاضرة في القائمة الطويلة للجائزة، والمكونة من عشر مجاميع، تقدّم مشهدًا إبداعيًّا قصصيًّا عربيًّا دالًّا على أهمية فن القصة القصيرة العربية، ولائقًا بمساعي «جائزة الملتقى» للوصول إلى منجز ثقافي أدبي نوعي، وهي الجائزة الأرفع في مجال القصة القصيرة العربية، وهو ما حدا بكل من جامعة الشرق الأوسط الأميركية، ودولة الكويت لتكون حاضنة لها.
ودارت في الأشهر الماضية اجتماعات، ونقاشات، ومداولات متعددة ومطولة بين أعضاء اللجنة للوصول إلى أهم المجاميع القصصية، التي تستحق بجدارة أن تكون حاضرة في القائمة الطويلة للجائزة، والمكونة من عشر مجاميع، تقدّم مشهدًا إبداعيًّا قصصيًّا عربيًّا دالًّا على أهمية فن القصة القصيرة العربية، ولائقًا بمساعي «جائزة الملتقى» للوصول إلى منجز ثقافي أدبي نوعي، وهي الجائزة الأرفع في مجال القصة القصيرة العربية، وهو ما حدا بكل من جامعة الشرق الأوسط الأميركية، ودولة الكويت لتكون حاضنة لها.













 في رواية «جزيرة المطففين»، الصادرة عن دار المتوسط، يقدم الكاتب اليمني حبيب عبدالرب سروري، رؤيته لتحالف الرأسمالية والتقنية، من خلال سرد تَنبُّئِيّ واستباقي للمرحلة القادمة، التي تحكم مصير الإنسان، وتحوله إلى مجرد مُتلقٍّ للنظام الرأسمالي العالمي، وعبر استغلال البيانات والذكاء الاصطناعي، يحدث التجسس على حياة الناس. تتعدد أماكن الرواية من بريطانيا إلى العالم العربي، وتتناول قضايا مصيرية وحساسة، مثل الهجرة واللجوء والأوبئة والكوارث البيئية، لكنها تركز على التحولات العصرية المستمرة، وتنبه إلى أخطار حلول الآلات مكان البشر، وإلى إمكانية خروج الآلة عن السيطرة البشرية وحدوث تمرد مخيف، سوف يهدد الحياة الإنسانية حقًّا. لنقرأ: «برز هذا السؤال سريعًا: من سينقل لبعض البشر غذاءهم لبيوتهم، في هذين الأسبوعين الحاسمين؟ الرد بديهي أيضًا: روبوتات هذه الحكومة الموحدة… ومن سيعاقب أي إنسان يغادر باب منزله؟ الرد بديهي أيضًا: درونات الحكومة الموحدة، ستقصفه بإشعاعات فاتكة، لمجرد رؤية عدساتها له وهو يحاول مغادرة باب مسكنه لأي سبب كان، أسبوعان لا يُنسيان في تاريخ كوكب الأرض، لم يقصف خلالهما غير نحو 25 ألف إنسان فقط».
في رواية «جزيرة المطففين»، الصادرة عن دار المتوسط، يقدم الكاتب اليمني حبيب عبدالرب سروري، رؤيته لتحالف الرأسمالية والتقنية، من خلال سرد تَنبُّئِيّ واستباقي للمرحلة القادمة، التي تحكم مصير الإنسان، وتحوله إلى مجرد مُتلقٍّ للنظام الرأسمالي العالمي، وعبر استغلال البيانات والذكاء الاصطناعي، يحدث التجسس على حياة الناس. تتعدد أماكن الرواية من بريطانيا إلى العالم العربي، وتتناول قضايا مصيرية وحساسة، مثل الهجرة واللجوء والأوبئة والكوارث البيئية، لكنها تركز على التحولات العصرية المستمرة، وتنبه إلى أخطار حلول الآلات مكان البشر، وإلى إمكانية خروج الآلة عن السيطرة البشرية وحدوث تمرد مخيف، سوف يهدد الحياة الإنسانية حقًّا. لنقرأ: «برز هذا السؤال سريعًا: من سينقل لبعض البشر غذاءهم لبيوتهم، في هذين الأسبوعين الحاسمين؟ الرد بديهي أيضًا: روبوتات هذه الحكومة الموحدة… ومن سيعاقب أي إنسان يغادر باب منزله؟ الرد بديهي أيضًا: درونات الحكومة الموحدة، ستقصفه بإشعاعات فاتكة، لمجرد رؤية عدساتها له وهو يحاول مغادرة باب مسكنه لأي سبب كان، أسبوعان لا يُنسيان في تاريخ كوكب الأرض، لم يقصف خلالهما غير نحو 25 ألف إنسان فقط». من ناحية، يفتتح الكاتب المصري تامر شيخون روايته «شفرات القيامة» بعبارة لألبرت أينشتاين تقول: «العلم بدون دين كسيح، والدين بدون علم أعمى». تستشرف الرواية زمنًا مستقبليًّا يقع في سبتمبر 2045م، مع الدكتور نوح جوشواه اللاجئ السوري الأصل، الأميركي الجنسية. ومن خلال سرد يتنقل في الزمان والمكان مع شخصيات عدة، يطرح الكاتب رؤيته حول الأخطار التقنية القادمة. إنها تتسلل لحياتنا بقوة من دون أن ندري بها، وصلنا لمرحلة أصبحنا فيها لا نملك أداة للتغيير، وهذا يتضح من استخدام شيخون لكلمة «شفرات» التي تدل على أمرين: أولهما تحول البشر إلى مجرد «أكواد»، والثاني أن امتلاك بعض الشفرات السرية في أيدٍ عابثة ومؤذية سوف يؤدي إلى الخراب، وإلى حلول القيامة على الأرض. لنقرأ: «عجيب أمر التكنولوجيا، في لحظة فارقة، ينفرد فيها المرء بذاته ليواجه معضلة وجوده، يتابعني فيها عشرة ملايين مُشاهد، جالسين في بيوتهم أو مكاتبهم عبر شاشة هولوغرام سرمدي، من خلال كاميرا أصغر من حبة العنب مثبتة خلف أذني. سيستمتعون بلحظاتي الأخيرة «لايف»، كما استمتعوا بألعاب «كول أوف ديوتي، حروب الجيل السابع»، لكنهم أبدًا لن يدركوا ما إذا تلاشت نفسي في العدم أو انتقلت إلى برزخ موازٍ طالما أفسد حياتي الأرضية».
من ناحية، يفتتح الكاتب المصري تامر شيخون روايته «شفرات القيامة» بعبارة لألبرت أينشتاين تقول: «العلم بدون دين كسيح، والدين بدون علم أعمى». تستشرف الرواية زمنًا مستقبليًّا يقع في سبتمبر 2045م، مع الدكتور نوح جوشواه اللاجئ السوري الأصل، الأميركي الجنسية. ومن خلال سرد يتنقل في الزمان والمكان مع شخصيات عدة، يطرح الكاتب رؤيته حول الأخطار التقنية القادمة. إنها تتسلل لحياتنا بقوة من دون أن ندري بها، وصلنا لمرحلة أصبحنا فيها لا نملك أداة للتغيير، وهذا يتضح من استخدام شيخون لكلمة «شفرات» التي تدل على أمرين: أولهما تحول البشر إلى مجرد «أكواد»، والثاني أن امتلاك بعض الشفرات السرية في أيدٍ عابثة ومؤذية سوف يؤدي إلى الخراب، وإلى حلول القيامة على الأرض. لنقرأ: «عجيب أمر التكنولوجيا، في لحظة فارقة، ينفرد فيها المرء بذاته ليواجه معضلة وجوده، يتابعني فيها عشرة ملايين مُشاهد، جالسين في بيوتهم أو مكاتبهم عبر شاشة هولوغرام سرمدي، من خلال كاميرا أصغر من حبة العنب مثبتة خلف أذني. سيستمتعون بلحظاتي الأخيرة «لايف»، كما استمتعوا بألعاب «كول أوف ديوتي، حروب الجيل السابع»، لكنهم أبدًا لن يدركوا ما إذا تلاشت نفسي في العدم أو انتقلت إلى برزخ موازٍ طالما أفسد حياتي الأرضية».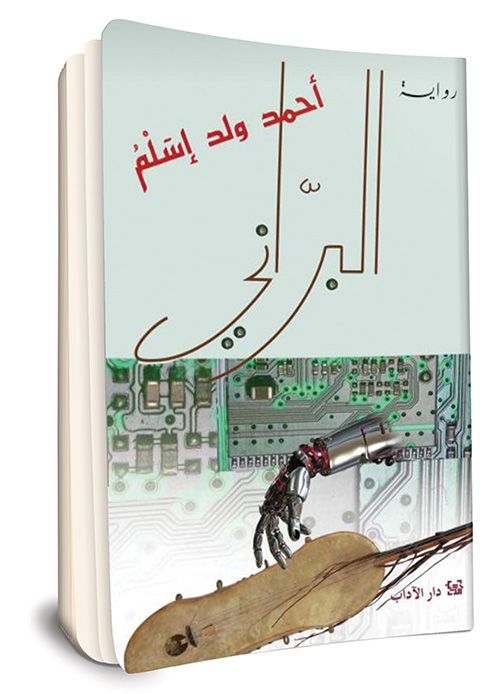 في رواية «البراني» للكاتب الموريتاني أحمد ولد إسلم، نقف أمام عالمين؛ أحدهما نقي ومجرد من التقنية «مدينة النعمة»، والآخر محكوم تمامًا للآلات «جزيرة المستقبل»، وبين هذين المكانين تدور الأحداث، تتقاطع مصاير شخوص الرواية مع الروبوتات، التي تحل مكان البشر في العديد من المهام، مثل مهمة رعي الأغنام، التي يقوم بها في الرواية روبوت ذكي اخترعه «مختور ولد احويبيب»، الذي يعيش وسط العالمين، ويحب الاستماع إلى الموسيقا التقليدية الموريتانية. يصفه وهو يواصل قيادته لسيارته الحديثة جدًّا، ويستمتع بترانيم ونغمات الفنان الموريتاني الشيخ سيد أحمد البكاي ولد عوه، المنبعثة من شريط كاسيت قديم غير متماشٍ مع طراز سيارته. تتناول الرواية الزلازل، وقوارب الهجرة غير الشرعية، وجزيرة موجودة في المحيط يسكنها جماعات ممن أطلق عليهم «العقول المهاجرة»، يتحقق فيها الرخاء والرفاه الإنساني، ويتحدث سكانها العربية كلغة أولى.
في رواية «البراني» للكاتب الموريتاني أحمد ولد إسلم، نقف أمام عالمين؛ أحدهما نقي ومجرد من التقنية «مدينة النعمة»، والآخر محكوم تمامًا للآلات «جزيرة المستقبل»، وبين هذين المكانين تدور الأحداث، تتقاطع مصاير شخوص الرواية مع الروبوتات، التي تحل مكان البشر في العديد من المهام، مثل مهمة رعي الأغنام، التي يقوم بها في الرواية روبوت ذكي اخترعه «مختور ولد احويبيب»، الذي يعيش وسط العالمين، ويحب الاستماع إلى الموسيقا التقليدية الموريتانية. يصفه وهو يواصل قيادته لسيارته الحديثة جدًّا، ويستمتع بترانيم ونغمات الفنان الموريتاني الشيخ سيد أحمد البكاي ولد عوه، المنبعثة من شريط كاسيت قديم غير متماشٍ مع طراز سيارته. تتناول الرواية الزلازل، وقوارب الهجرة غير الشرعية، وجزيرة موجودة في المحيط يسكنها جماعات ممن أطلق عليهم «العقول المهاجرة»، يتحقق فيها الرخاء والرفاه الإنساني، ويتحدث سكانها العربية كلغة أولى. أما الكاتب المصري الشاب أحمد لطفي، فإنه يتبنى فكرة حضور الذكاء الاصطناعي في الكتابات الإبداعية، ويرى أنه سيقدم مجالات خصبة لإصدارات قيمة في المستقبل. وضمن هذه الصيحة الجديدة المثيرة للاهتمام صدر له رواية «خيانة في المغرب»، عن دار كتوبيا. إنها أول رواية عربية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويقوم بناؤها على حوار مشترك بين الكاتب وبرنامج شات جي بي تي، ومكتوبة بشكل أساسي للقراء اليافعين، وتتألف من مئة صفحة، تدور في أجواء بوليسية غامضة، حول شخصية بطل يدعى فارسًا، يتعرض لملاحقة من جانب إحدى العصابات، وهو ما يجعل أحداثها حافلة بالتشويق والإثارة، والأهم من هذا كله هو الاطلاع على بعض الفقرات، التي كتبها الذكاء الاصطناعي، لنقرأ منها: «إذا كان هؤلاء الرجال يلاحقونك بهذه الطريقة، فإن ذلك يعني أن هناك شخصًا قويًّا وخطيرًا خلفهم. شخصًا لديه نفوذ وثروة وسلطة في هذه المدينة، شخص لا تريد أن تواجهه أبدًا».
أما الكاتب المصري الشاب أحمد لطفي، فإنه يتبنى فكرة حضور الذكاء الاصطناعي في الكتابات الإبداعية، ويرى أنه سيقدم مجالات خصبة لإصدارات قيمة في المستقبل. وضمن هذه الصيحة الجديدة المثيرة للاهتمام صدر له رواية «خيانة في المغرب»، عن دار كتوبيا. إنها أول رواية عربية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويقوم بناؤها على حوار مشترك بين الكاتب وبرنامج شات جي بي تي، ومكتوبة بشكل أساسي للقراء اليافعين، وتتألف من مئة صفحة، تدور في أجواء بوليسية غامضة، حول شخصية بطل يدعى فارسًا، يتعرض لملاحقة من جانب إحدى العصابات، وهو ما يجعل أحداثها حافلة بالتشويق والإثارة، والأهم من هذا كله هو الاطلاع على بعض الفقرات، التي كتبها الذكاء الاصطناعي، لنقرأ منها: «إذا كان هؤلاء الرجال يلاحقونك بهذه الطريقة، فإن ذلك يعني أن هناك شخصًا قويًّا وخطيرًا خلفهم. شخصًا لديه نفوذ وثروة وسلطة في هذه المدينة، شخص لا تريد أن تواجهه أبدًا».





 وهذا الرأي هو عين الوعي الذي لا يقلل من خطورة الذكاء الاصطناعي ويواجهه لا بالتجاهل والتغافل، بل بالمواجهة العلمية وتشجيع الوعي والابتكار البحثي لمعرفة سبل الإفادة وتجنب الخطر. وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أهم دول العالم التي أخذت موضوع الذكاء الاصطناعي بجدية تامة منذ بدايات ظهوره. يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي تتبناها حكومة المملكة والجهات المختصة فيها لمحاولة وعي الظاهرة والتعامل العلمي معها. ولقد يكون من المستغرب في وقت مبكر قليلًا من عام 2015م اهتمام المملكة مثلًا بالروبوت (صوفيا) وهي تقريبًا أول نموذج روبوت ناجح شبيه بالبشر، صممته شركة «هانسون روبوتيكس» في «هونغ كونغ» في إبريل 2015م؛ كي تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشرى، وتعد الأكثر اكتمالًا من منظور الروبوتات الشبيهة بالبشر، ومارست أعمالًا بشرية تمثل نقلة في عمل الروبوت، فنفذت صوفيا أول زيارة لمصر والقارة الإفريقية، كما أجرت العديد من اللقاءات الصحفية في مختلف دول العالم، وتحدثت فيه مع بعض المضيفين. وقدِمت صوفيا إلى الأمم المتحدة في 11 أكتوبر 2017م، وأجرت محادثة قصيرة مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، وأجرت صحيفة الأهرام مع صوفيا لقاءً مطولًا. وهي تستطيع استقبال الكلام وتحليله عن طريق تقنية الـ Block Chain التي تمكنها من الاستجابة لأيّ محادثات تقوم بها، كما أنها تستطيع القيام بأكثر من 60 تعبيرًا للوجه لمحاكاة التعبيرات البشرية، وشاركت في مؤتمرات ومُنحت الجنسية
وهذا الرأي هو عين الوعي الذي لا يقلل من خطورة الذكاء الاصطناعي ويواجهه لا بالتجاهل والتغافل، بل بالمواجهة العلمية وتشجيع الوعي والابتكار البحثي لمعرفة سبل الإفادة وتجنب الخطر. وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أهم دول العالم التي أخذت موضوع الذكاء الاصطناعي بجدية تامة منذ بدايات ظهوره. يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي تتبناها حكومة المملكة والجهات المختصة فيها لمحاولة وعي الظاهرة والتعامل العلمي معها. ولقد يكون من المستغرب في وقت مبكر قليلًا من عام 2015م اهتمام المملكة مثلًا بالروبوت (صوفيا) وهي تقريبًا أول نموذج روبوت ناجح شبيه بالبشر، صممته شركة «هانسون روبوتيكس» في «هونغ كونغ» في إبريل 2015م؛ كي تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشرى، وتعد الأكثر اكتمالًا من منظور الروبوتات الشبيهة بالبشر، ومارست أعمالًا بشرية تمثل نقلة في عمل الروبوت، فنفذت صوفيا أول زيارة لمصر والقارة الإفريقية، كما أجرت العديد من اللقاءات الصحفية في مختلف دول العالم، وتحدثت فيه مع بعض المضيفين. وقدِمت صوفيا إلى الأمم المتحدة في 11 أكتوبر 2017م، وأجرت محادثة قصيرة مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، وأجرت صحيفة الأهرام مع صوفيا لقاءً مطولًا. وهي تستطيع استقبال الكلام وتحليله عن طريق تقنية الـ Block Chain التي تمكنها من الاستجابة لأيّ محادثات تقوم بها، كما أنها تستطيع القيام بأكثر من 60 تعبيرًا للوجه لمحاكاة التعبيرات البشرية، وشاركت في مؤتمرات ومُنحت الجنسية


















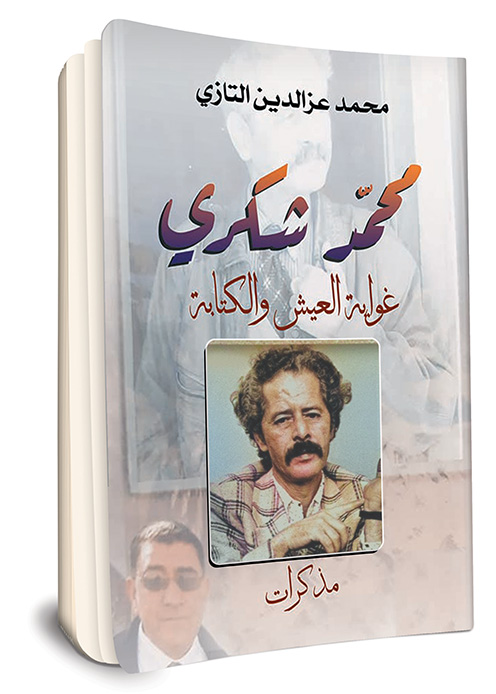 على أن أول طبعة باللغة العربية ظهرت في المغرب (1982م) في سحب أولي بلغ (5000 نسخة)، لتتواصل الطبعات إلى أن بلغت أربع طبعات، حيث تدخل الاتجاه الديني التقليدي لمنعها بمسوغ المحتوى المعبر عنه. وفي الآن ذاته يشير التازي إلى كون الخميني، وهو يهدر دم سلمان رشدي، أهدر على السواء دم الراحلة فاطمة المرنيسي ومحمد شكري الذي رفض مقترح حمايته: «تقبل شكري الأمر بهدوء. وحينما دعي إلى قسم الشرطة، وسأله الضابط: هل تحتاج إلى حماية؟ أجاب مِن فورِه: كلا. أنا لم أفعل شيئًا ضد أحد. وإن أرادوا أن يهدروا دمي فلن تنفع أية حراسة. ثم إنني لا أطيق أن أعيش وبرفقتي حارس» (ص/62).
على أن أول طبعة باللغة العربية ظهرت في المغرب (1982م) في سحب أولي بلغ (5000 نسخة)، لتتواصل الطبعات إلى أن بلغت أربع طبعات، حيث تدخل الاتجاه الديني التقليدي لمنعها بمسوغ المحتوى المعبر عنه. وفي الآن ذاته يشير التازي إلى كون الخميني، وهو يهدر دم سلمان رشدي، أهدر على السواء دم الراحلة فاطمة المرنيسي ومحمد شكري الذي رفض مقترح حمايته: «تقبل شكري الأمر بهدوء. وحينما دعي إلى قسم الشرطة، وسأله الضابط: هل تحتاج إلى حماية؟ أجاب مِن فورِه: كلا. أنا لم أفعل شيئًا ضد أحد. وإن أرادوا أن يهدروا دمي فلن تنفع أية حراسة. ثم إنني لا أطيق أن أعيش وبرفقتي حارس» (ص/62).
 كما تنطوي بعض الاعترافات على مقاربةٍ لتاريخ الأخطاء الوطنية والسياسية، التي تدخل في إطار تصفية الحساب مع الذات، وهي رغبة عمادها التخلّص من عقدة الذنب كما في اعترافات «محسن الشيخ راضي» وكتاب «أوكار الهزيمة» لهاني الفكيكي. وبقدر أهمية وخطورة مثل هذه الاعترافات تاريخيًّا ونفسيًّا وسياسيًّا، فإنها في المقابل ستصطنع لها نسقًا، يقوم على اصطناع تاريخٍ مضاد، تاريخ يُحرّض على إعادة قراءة كثير من الأحداث والوقائع والملفات، وفضح أزمنتها المتقادمة، وشخصياتها المُقنَّعة. كما أنّ مذكرات واعترافات عدد من السياسيين العراقيين الآخرين أمثال حازم جواد وطالب شبيب وصبحي عبدالحميد وغيرهم، كشفت هي الأخرى عن ذاكرة الرعب التي عاشوها، أو ساهموا في صنعها، حتى في قتل ضحاياهم؛ إذ حملت معها هذه الاعترافات نزوعًا مُركّبًا يزاوج بين تجاوز عقد الإثم، وبين التوهم بالخلاص، فضلًا عن محاولة فضح التابوات التي غمرت التاريخ السياسي العراقي منذ أحداث 1963م الدامية وإلى عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.
كما تنطوي بعض الاعترافات على مقاربةٍ لتاريخ الأخطاء الوطنية والسياسية، التي تدخل في إطار تصفية الحساب مع الذات، وهي رغبة عمادها التخلّص من عقدة الذنب كما في اعترافات «محسن الشيخ راضي» وكتاب «أوكار الهزيمة» لهاني الفكيكي. وبقدر أهمية وخطورة مثل هذه الاعترافات تاريخيًّا ونفسيًّا وسياسيًّا، فإنها في المقابل ستصطنع لها نسقًا، يقوم على اصطناع تاريخٍ مضاد، تاريخ يُحرّض على إعادة قراءة كثير من الأحداث والوقائع والملفات، وفضح أزمنتها المتقادمة، وشخصياتها المُقنَّعة. كما أنّ مذكرات واعترافات عدد من السياسيين العراقيين الآخرين أمثال حازم جواد وطالب شبيب وصبحي عبدالحميد وغيرهم، كشفت هي الأخرى عن ذاكرة الرعب التي عاشوها، أو ساهموا في صنعها، حتى في قتل ضحاياهم؛ إذ حملت معها هذه الاعترافات نزوعًا مُركّبًا يزاوج بين تجاوز عقد الإثم، وبين التوهم بالخلاص، فضلًا عن محاولة فضح التابوات التي غمرت التاريخ السياسي العراقي منذ أحداث 1963م الدامية وإلى عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.
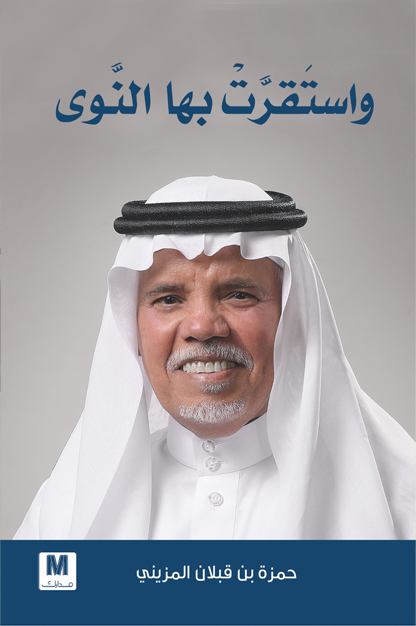 وهناك سببٌ ثانٍ يتمثل في أن المجتمع الغربي يقوم على الفردية، فيمكن أن يكتب كاتب سيرة فيها فضائح الدنيا كلها ولا تتعدى فضائحياته إلى أسرته مثلًا. أما في الثقافة العربية الإسلامية، وربما في المملكة على وجه أخص، فكاتب السيرة موصول بشبكة اجتماعية مترابطة واسعة ينشأ عنها أن ما يقوله عن نفسه سيتعدى لا محالة إلى غيره، ولا سيما إلى أسرته وأقاربه وأصدقائه؛ فهو ليس في حلٍّ إذن أن يؤذي أحدًا بما اقترف من فضائح لا دخل للآخرين بها.
وهناك سببٌ ثانٍ يتمثل في أن المجتمع الغربي يقوم على الفردية، فيمكن أن يكتب كاتب سيرة فيها فضائح الدنيا كلها ولا تتعدى فضائحياته إلى أسرته مثلًا. أما في الثقافة العربية الإسلامية، وربما في المملكة على وجه أخص، فكاتب السيرة موصول بشبكة اجتماعية مترابطة واسعة ينشأ عنها أن ما يقوله عن نفسه سيتعدى لا محالة إلى غيره، ولا سيما إلى أسرته وأقاربه وأصدقائه؛ فهو ليس في حلٍّ إذن أن يؤذي أحدًا بما اقترف من فضائح لا دخل للآخرين بها.
 وصرحت بذلك في متن الظلال نفسها حين قلت: «في كتابة هذه السيرة الذاتية تحضرني مقولة أبي حامد الغزالي: «المضنون به على غير أهله»؛ إذ يصبح الحديث عن المسكوت عنه هو الهيكل العظمي للبناء القص-سيري؛ إذ دونه يصبح البوح سطحيًّا وباهتًا أو فاقدًا لحرارته وجرأته التاريخية والفنية.
وصرحت بذلك في متن الظلال نفسها حين قلت: «في كتابة هذه السيرة الذاتية تحضرني مقولة أبي حامد الغزالي: «المضنون به على غير أهله»؛ إذ يصبح الحديث عن المسكوت عنه هو الهيكل العظمي للبناء القص-سيري؛ إذ دونه يصبح البوح سطحيًّا وباهتًا أو فاقدًا لحرارته وجرأته التاريخية والفنية.


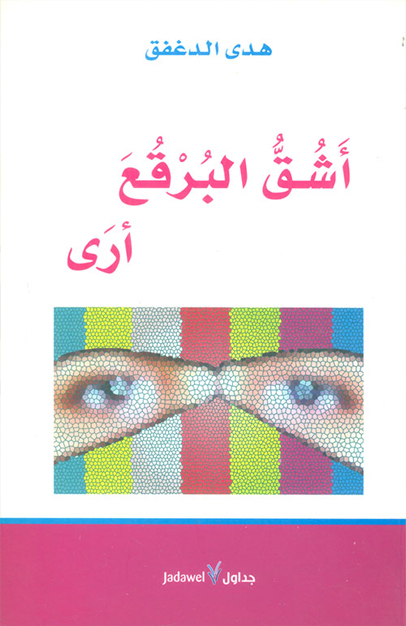 ولعل تداول وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الحسابات الخاصة والتفاعل مع التعبير الذاتي والتهافت على الكتابة والتفاعل اللحظي وشجاعة المستخدمين في الكتابة عن حياتهم ونشر يومياتهم، هو ما دفعني إلى المسارعة بنشر كتابي؛ فلقد خشيت أن يهدأ حماسي لكتابته ويتغير رأيي بنشره. لذلك عندما أخبرتني دار النشر أنها سوف تؤجل طباعة كتابي عامًا آخر تركتها إلى دار نشر غيرها.
ولعل تداول وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الحسابات الخاصة والتفاعل مع التعبير الذاتي والتهافت على الكتابة والتفاعل اللحظي وشجاعة المستخدمين في الكتابة عن حياتهم ونشر يومياتهم، هو ما دفعني إلى المسارعة بنشر كتابي؛ فلقد خشيت أن يهدأ حماسي لكتابته ويتغير رأيي بنشره. لذلك عندما أخبرتني دار النشر أنها سوف تؤجل طباعة كتابي عامًا آخر تركتها إلى دار نشر غيرها.
