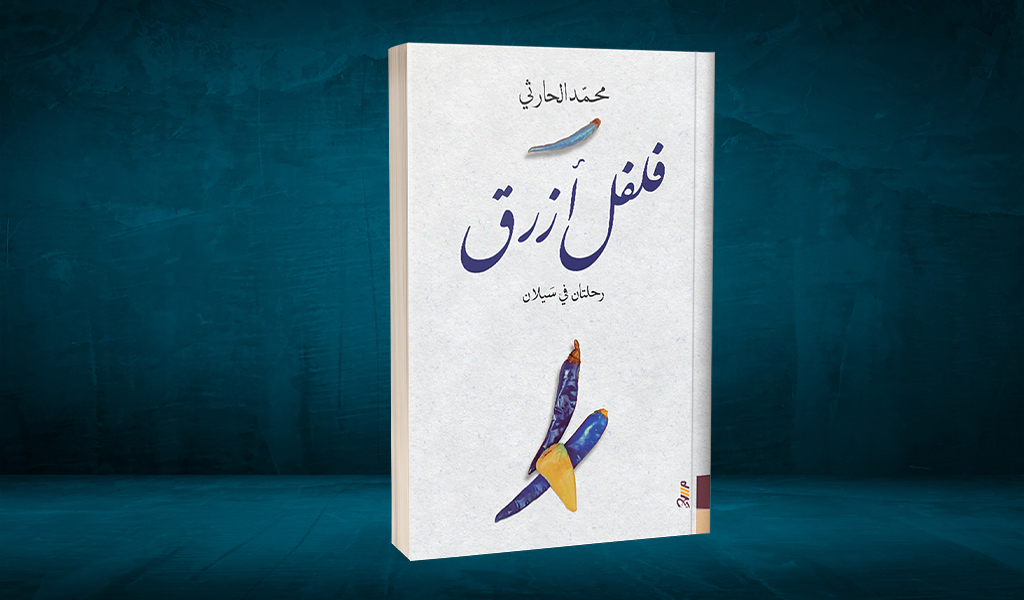بواسطة حمود سعود - كاتب عماني | مارس 1, 2024 | نصوص
• ماذا ترى خلف الباب؟
– باب آخر.
• وخلف الباب الآخر؟
– بيت.
• ماذا في داخل البيت؟
– شجرة كبيرة.
• وماذا خلفها؟
– جبل بعيد.
• ماذا فوق الجبل؟
– قلعة متهدمة.
• هل نزل المحاربون من الجبل؟
– لا أرى محاربين.
• هل تركوا بنادقهم في زوادة التاريخ؟
– لا أرى شيئًا.
• وماذا خلف القلعة؟
– مدفع منسي.
• وماذا بعده؟
– هناك يتوقف الزمن، وربما أنني لا أرى شيئًا. أو أن رؤيتي إلى الأشياء لا تصل إلى البعيد.
• لكنني لم أسألك عن المشهد كاملًا، سألتك ماذا خلف الباب؟
– أنت سحبتني إلى فخ الأسئلة.
• وهل تعتبر الأسئلة فخًّا في لعبة الحكاية والمشهد؟
– وهل تبحث أنت عن مشهد ما، لكي تُغذّي به مخيلتك المتشظية؟
دعنا من كل هذا، لنعد ترتيب الأشياء، برغم أنني لا أرى الأشياء بوضوح وصفاء، أو لا أرى الأشياء بتاتًا؛ أو لا تعجبني الأشياء المرتبة والمصفوفة بعناية، ولكي أكون دقيقًا، فأنا وحيد هنا، أجلس بالقرب من المحراب. أشعر بالضوء يأتيني من الجهة المقابلة، لسنوات طويلة كنتُ أفكّرُ في الضوء، أدرك ببصيرتي بأنه قادم من الشرق، وأحببتُ أن أسألك. وبما أنك تذهب إلى المدرسة؛ فإنك تعرف الجهات جيدًا، ولكنني غير متأكد، هل تعرف الطريق جيدًا؟
• الطريق إلى أين يا جدي؟
– دعنا الآن من أسئلتك وطريقك. لنبدأ بترتيب الأشياء مرة أخرى، ونشق طريقًا مختلفًا إلى تفاصيل المشهد.
الجدار الذي أسندُ عليه ظهري، هو الجدار الغربي للمسجد الصغير الذي بنيته، في عام 1979م، لم تكن هناك جدران، كان المكان مفتوحًا كأرواحنا الصغيرة، والفضاء واسعًا، لا تحده سوى الجبال، ربما كانت خيامًا وعرشانًا من سعف النخيل، لم تصل الكهرباء بعد، أنا وأولادي كُنا نصلي هنا، تناثرت الأشياء، ركض الزمن بطفولة الأولاد، بعضهم سافر، وبعضهم الآخر ذهب إلى الحرب، ولم يعد، كبرت الجدران صارت بيوتًا، وأصبحت للبيوت أسوارًا وأسرارًا، وأغلقت نوافذ الطفولة مبكرًا، أصبح لي غرفة تحيط بها مزرعة صغيرة من جهة الجنوب، امتدت الكهرباء، شعرت بدوران المروحة في 1989م، ولكنني لم أبصر ضوء المصابيح. أيها الطفل، العميان هامش منسي في صفحة المبصرين المسرعين، والأعمى عكاز تُرك في الظلمة.
• ولكن يا جدي ما دخل الجدار بالباب، وفخ الأسئلة؟
– لكي تدرك بدايات الأشياء، يجب عليك أن تصنع ذاكرة وتاريخًا للأشياء.
لنعيد ترتيب المشهد مرة أخرى.
• ماذا أمامك الآن؟
– باب أبيض مفتوح.
• ماذا خلفه؟
– باب حديدي أخضر آخر.
• وماذا خلف الباب الحديدي؟
– بيت أبيض، يقف بالقرب منه صهريج ماء أزرق.
• ماذا ترى في جدار البيت الأبيض؟
– خط أسود، ينزل من المزراب إلى أسفل، وفي نهاية الخط تقف دراجة هوائية لطفل.
– لا عليك، فذلك حزن عميق، في ذلك البيت، حزن يحفر في أرواح أهله وأكبادهم.
• وماذا يدريك أنت أيها الأعمى؟
– العميان أكثر بصيرة منك أيها الطفل، ومن ثم قلت لك، دعك من الأسئلة، ودعنا نرمم الحكاية، فطين التعجل يفسد لذة الكلام.
– وهل علينا أن نغزر سهام الأسئلة في جسد الحكاية الهشة؟ من ثم ليس هناك ما تسرده، أنت فقط ترمم تفاصيل مشهد ضبابي، لا تراه في ذاكرتك، تحاول أن تمسك بجذور الأسئلة لتصنع حكايات هشة ومبعثرة.
– أيها الطفل، الأسئلة أعمدة تمسك سقف الحكاية، وجذور الكلام، أنت تبصر الأشياء أمامك، وأنا أخمّرُ تاريخ الأشياء في ذاكرتي. فلا حكاية من دون تاريخ، ولا تاريخ من دون بصيرة، ولا بصيرة دون ألم، وحدهم العميان والنساء والمجانين من يستطيعون القبض على الحكايات وجذورها وأنفاسها.
– يا جدي أنت تبصر الأشياء ببصيرة العميان، وأنا أحرّكها أعجنها بخيال الأطفال، دع سقف الكلام يطير، لا تحبسه في خيام الذاكرة. الذاكرة تفسد فرح الحكاية.
لنعد مرة أخرى، إلى البيت، وتحديدًا، إلى الجدار. ماذا ترى في الجدار؟
• خط أسود نازل من الأعلى؟
– لا فرق، إن كان الخط نازلًا من الأعلى، أو صاعدًا من الأسفل، فذلك كله يدل على حزن الجدار والبيت، فإذا كان نازلًا فهو حزن ينخر جذور البيت، وأما إذا كان صاعدًا، فالحزن ممتد إلى فضاءات البيت وأزمنته.
• هل تحزن الجدران، يا جدي؟
– كل الأشياء لها فرحها وحزنها، ولكن تحتاج من ينصت لها. يتأمل وجع الأشياء دون تعجل أو تطفل عليها، ودون تسوّل، فالأشياء تفتح ذاكراتها وعاطفتها وجنونها لمن يحسن صداقتها ولملاطفتها، ولمن يتقن قراءة ظلالها. الأشياء يا بني كقلوب الأمهات، أو كطيبة الجدات الذاهبات إلى الموت.
• وكيف تدرك يا جدي حزن الأشياء؛ وأنت لا ترى شيئًا؟ وكيف تتقن قراءة الظلال، وأنت لا تبصر الأشجار والأشياء.
– صحيح أنني لا أرى، ولكنني أشعر بها، حتى الزمن الذي لا تشعر به أنت، أنا أشعر بحزنه، وبفرحه الشفيف في الفجر، وبصمت الأشياء في منتصف الليل.
• وكيف تشعر به يا جدي؟
– لا تسأل أيها الطفل أعمى كيف يخترق عمق الأشياء بروحه، فداخل كل أعمى بصيرة لا يدركها المبصرون. أيها الطفل، لا تسأل الجبال عن شموخها وعزلتها، ولا تسأل الأرامل عن حزنهنّ، ولا تسأل الطيور عن فرحهنّ في الربيع، فكل الأشياء تبوح بجوهرها من دون السؤال.
– ولماذا تقول: إن الجدار في البيت الأبيض حزين؟ ربما يكون كحل فرح في عين الجدار.
– كلما رأيت أيها الطفل سواد في بياض الجدران، فتذكر حزن أهل ذلك البيت.
– للبيوت حزنها وفرحها يا جدي، الفرح يختلط بحزن عابر أو دائم.
– ماذا يفعل الصهريج الأزرق بالقرب من البيت؟ هل شعروا بالعطش؟ هل جفّتِ البئر التي حفرتها في بداية السبعينيات؟
• وهل تعتقد أيها الأعمى بأن كل سيارة زرقاء تبيع الماء أن أهل ذلك البيت حاصرهم العطش؟ أنت تتوهم الأشياء، ولا ترمم الحكاية؟ جعلت من الخط الأسود في الجدار الأبيض حزنًا مقيمًا في أكباد أهل ذلك البيت؟ وأن صهريج ماء أزرق يقف جانب البيت، يشير على عطش أهل ذلك البيت؟ ماذا لو كانت سيارة عابرة توقفت بالصدفة في هذه اللحظات قرب البيت؟ وما دخل توقف سيارة زرقاء ببئر حفرتها أو تخيلته أنت قبل نصف قرن.
– لا عليك، الأطفال عجولون دائمًا، وضجرون وعاجزون عن فهم جوهر الأشياء. ربما ستفهم لعبة الاحتمالات في الحكاية. لا تمضي في لعبة الحكاية من دون حبال الاحتمالات، لكيلا تسقط في حفر اليقين، وأفخاخ الواقعية.
– لا أفهم ما تقوله، أيها الأعمى. لكنني أرى صهريج ماء بالقرب من الجدار الأبيض.
– دع الصهريج يقف وحده، ثمة أغراض يتركها عادة سائق الصهريج عند الزجاج الأمامي.
• هل تستطيع أن تذهب، وتأتي بها؟
– ما جدوى تلك الأغراض، في الحكاية التي تريد أن ترممها في ذاكرتك. أو لعبة تريد أن تكملها في ملعب مخيلتك.
– أيها الطفل، الحكايات تحتاج دائمًا إلى جذور، وإلى التفاصيل الصغيرة والهامشية. التفاصيل هي ملح الحكايات، بدونها لا تستطيع تذوق طعم الحكاية.
في اللحظة التي خرج الطفل من الباب، إلى صهريج الماء، سقطت دمعة لم تصل إلى ملابس الأعمى، توغلت في لحيته البيضاء. امتدت يد الأعمى الذي يسند ظهره على الجدار إلى لحيته، شعر بشيء رطب، اختفت الدمعة في بياض الزمن وعتمة الذكريات.
في لحظة اختفاء الطفل، مرت ذكريات كثيرًا في ذاكرة الرجل، الذي يعرف الأشياء والأمكنة التي سأل عنها الطفل، دروب ورحلات ومجاعات وجبال وحكايات وسنوات عجاف وجفاف مرت بحياة الأعمى، وحروب وقبائل تناحرت، وقبل أن يمتد زمن التذكر طويلًا وبعيدًا. عاد الطفل وفي يده دفتر أزرق، وأوراق مبعثرة. جلس بالقرب من الأعمى.
فتح الطفل الدفتر الأزرق، سقطت بعض الأوراق القديمة، فواتير كهرباء، تدحرج قلم أزرق من الدفتر. سمع الأعمى صوت انفتاح الدفتر.
قرأ الطفل، بعض الأسماء، التي لا يعرفها، وأمام الأسماء أرقام.
ناصر بن عبدالله 15 ريالًا. سالم بن محمد 20 ريالًا. بيت أولاد الشرقي 10.
مطعم الملباري 10.
ضجر الأعمى من الأرقام، وقال للطفل، قلّب الدفتر، فبائعو الماء يدسون أسرارهم في دفاترهم؛ قبل أن تغرق في ماء النسيان.
ظل الطفل يقلب الدفتر الأزرق، يرى أسماء وأرقامًا. في منتصف الدفتر، رأى رسالة مكتوبة بحروف غير منظمة وخط مرتبك، حاول أن يتهجى الكلمات، الجد صامت، يسمع صوت حروف وهمسات الطفل، وهو يحاول نطق الكلمات.
«أبي وأمي العزيزان، أريد أن أرسل لكما، هذه الرسالة، وأنا الذي لم أكتب في حياتي أي رسالة، حتى عندما طلب منّا أستاذ اللغة العربية كتابة رسالة إلى صديق، كتبت رسالة عن الصداقة، فغضب الأستاذ، وعاقبني بكتابة الدرس خمس مرات. لم أكتب رسالة حب، أو رسالة وداع، أو رسالة للحكومة لأطلب أي شيء. فأنا لا أحب أن أطلب من الحكومة أي شيء، والحكومة تحب من يطلبها، لذا لم أكتب أي رسالة في حياتي.
هذه الرسالة أكتبها، وأنا أقف على الشارع -والشوارع تُوصل الناس إلى جهاتهم وبيوتهم- وقد اشتعل بداخلي الفقد والشوق لكما، أقف هنا على طرف الشارع، حتى لا يرى أطفالي دموعي، أفتقدكما كثيرًا، أفتقد صوت أمي في الفجر، أفتقد أبي في صلاة الفجر، وقهوة صباحاته. لا أدري ما جدوى الحياة بعدكما. كل شيء أصبح رماديًّا بعدكما، فقدكم ثقب أرواحنا.
كل الأشياء ذبلت بعدكما، حتى شجرة البيت، لا روح لها بعدكما، أشتاق لكما كثيرًا».
أخفى الجد الأعمى دموعه، تلعثم الطفل، لم يدرك سبب دموع الجد، وما علاقته بالرسالة، وبسائق صهريج الماء، الصمت دثر المكان، تأمل الطفل الدموع الساقطة على لحية الجد البيضاء. لا يدري سبب هذه الدموع، هل كانت إحدى الشخصيات يقرب له، الأم، الأب، سائق الصهريج، خاف أن يسأله، ويزيد من تدفق دموعه، فكر بأن يسأله عن الأبواب المفتوحة نحو البيت الأبيض.
• لماذا كل هذه الأبواب مفتوحة نحو البيت الأبيض؟
* * *
• لماذا الباب الثاني لونه أخضر؟
* * *
• هل رممت كل الحكاية يا جدي؟
– مسّد الجد لحيته، شعر برطوبتها، وقال: الحكايات لا يرممها الحزن، ولا الفقد، بل يكسرها يمزق حبالها، والأبواب تُفتح أيها الطفل لترى سهام الزمن كيف تنهش الأشياء، أما اخضرار الباب ليخفف عنك وحشية الإسمنت.
* * *
الرجل الذي كان يبكي في الصهريج الأزرق، دخل إلى المسجد، أقام للصلاة، وقف الجد وبجانبه الطفل، خلف الرجل الذي كتب رسالته.
ظلال الحكاية
• الشجرة الواقفة في السفح، أنصتت بحزن لحديث الطفل والأعمى، لكنها لم تدرك كل الحكاية، وعندما رأت دموع الجد، أوجعها حزنه؛ لأنها تعرف الجد منذ طفولتها، تراه في الدروب في الفجر، تسمع حكاياته على مواقد الشتاءات الباردة. ولكي ترمم شجرة السفح حكاية الأعمى والطفل، سألت الشجرة الكبيرة في وسط البيت، الذي سأل عنه الجد الطفل. أيتها الشجرة الحارسة لحزن البيت وفرحه، لماذا بكى الجد بكل هذه الحرقة، وكأنه طفل؟
– أيتها البعيدة، حارسة الفجر، وصديقة الظهيرات، لكل بيت سره وجرحه، أنتِ تعرفين الجد أكثر مني؛ لأنك رأيته طفلًا، وأنا ابنة هذا البيت الإسمنتي، وأدرك ما حلَّ بالرجل الذي يصلي الآن بالجد والطفل. والبشر هم أطفال أمام الموت، مهما كبروا وشاخوا. فقد والديه، في يوم واحد، يشعر الآن بأنه فقد كل شيء، كل أحلامه يرى أمه تناديه، أبيضّتْ عيناه من الحزن.
وقبل أن يسجد الرجل سجدته الأخيرة صمتت شجرة البيت.
خرج الرجل الذي كتب الرسالة، وحمل دفتره الأزرق دون أن يسأل من جلبه إلى هنا.
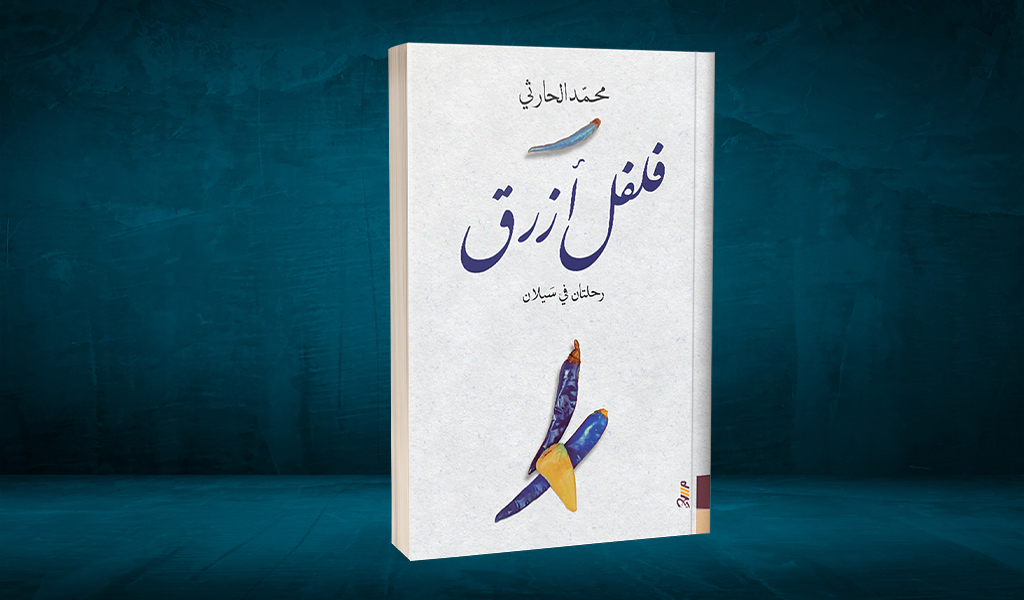
بواسطة حمود سعود - كاتب عماني | يوليو 1, 2021 | كتب
في «فلفل أزرق»، كتاب الترحال الثالث للشاعر والكاتب الراحل محمد الحارثي يذهب بنا إلى جهة أخرى من جهات الأرض، من بلاد تشبه كثيرًا قصائده المكتنزة بالدهشة، وعلى الرغم من قربها من أجواء الرحلة الثانية «محيط كتمندو» التي تسبق هذا الكتاب (مكانيًّا/ وزمنيًّا)، فإن الحارثي لا يتوانى عن إدهاش القارئ وإرباكه جماليًّا، ليس فقط باكتشاف أمكنة جديدة والنحت في عوالمها، بل يحاول أن يُغيّر ويجدد في أساليب سرده، وأن يشركَ البشر والأمكنة والتاريخ والأطعمة والمخيلة بحسّه النقدي والرمزي في سرده للرحلة.
ما بين «محيط كتمندو» و«فلفل أزرق» (الذي صدر بعد رحيل الحارثي) توقف الكاتب مع ناقته العمياء قليلًا، لتبحر به وبنا في نصوصه الشعرية (التي مزجها بالسرد وروائح الأمكنة)، وربما حمل عليها بعض أجواء وشذرات نصوص الرحلة الأخيرة، ونثر بعضها في ديوانه الأخير. مثلما نجد كذلك واضحًا وجليًّا في قصيدتين من قصائد الديوان «رحلات صناديق الشاي والقرنفل بين سيلان وزنجبار»، و«إنجلترا الصغيرة».
عتبات النص: صدر الكتاب عام 2020م عن دار مسعى، (بعد رحيل كاتبه بعامين) وقد صمم الغلاف الناشر والشاعر محمد النبهان. وربما يتساءل القارئ عن وجود قرون الفلفل باللون الأزرق في غلاف الكتاب، وهل نجد لهذا الفلفل ما يربطه بالرحلة، أي علاقة أو لنقل أي دلالة بين العنوان وقرون الفلفل وبين أجواء الرحلة؟ ومن الملحوظ أنها ثلاثة قرون: فلفل بلون أزرق، وواحد بلون أصفر، وترك قرنًا آخر أزرق في ظهر الكتاب ليودع به القارئ والرحلة والعمر.
وقبل البحث عن زرقة الفلفل، ودلالة العتبة، سيستقبل القارئ عنوانًا فرعيًّا في فهرس الرحلة بعنوان: «فلفل أزرق على ورقة موز خضراء»، وعند بحثك في داخل الرحلة عن الفلفل وزرقته ستجد هذه الفقرة التي يمتدح بها الحارثي، بل يتغزل بالفلفل في ص248.
«ماذا بعد؟ قرون هائلة الحجم من الفلفل مقرمشة بعد شيّها على شعلة هادئة؛ لتكتسب صبغتها الزرقاء اللموع. الصبغة التي تميزها وهي تسيل على طبقة اخضرارها الداكن بعد تحوّلها للونها الأزرق المستحيل، لدرجة أن الزرقة المحيطية العميقة جعلتني -كما فعلت في ترينكومالي- من تلك الزرقة النادرة. الزرقة الحرّاقة قليلًا، الزرقة التي لا يدرك رائحتها -دعك من طعمها- سوى نخبة ذوّاقة يعتمدون على كافة حواسهم الخمس حين يتذوقونها لحظة انكسارها هشة بين أسنانهم…».
هذه الفقرة تكشف مدى تعلق الحارثي بالفلفل ومحبته له، وليس أي فلفل، الفلفل الأزرق على ورقة موز خضراء، هل هذه رمزية مبطنة عن الرحلة؟ فسرنديب أو سريلانكا محاطة بزرقة البحر، وهي جزيرة خضراء وهل أشعل الكاتب حواسه الخمس (أو الست في تخمين بعض الأمور) في تذوق طعم الرحلة وتفاصيلها؟ دعنا من الرمزية ودلالة الفلفل الأزرق، لنقرأ هذه الفقرة الصغيرة التي يكشف فيها المؤلف عشقه وهيامه بالفلفل الأزرق. «كنت أشبه بسكران في حانة شعبية؛ فالزرقة بعمقها اللامتناهي في قرن فلفل مُشبع بخلفية ظلاله الخضراء، مثلما هو اخضرار ورقة الموز اليانعة يتلألأ بقوة اخضراره لأسكر بالفعل».
تكشف لنا السطور السابقة (وكذلك سطور أخرى في الكتاب) مدى محبة الكاتب للفلفل، وتغزله به، ومزج هذه الزرقة باخضرار ورقة الموز، «كنت أشم وأتلمس تفاصيل زرقته اللامعة وهي تنبثق من بوتقة اخضرارها الداكن…» ص248. وسنجد كذلك في الصفحة الخامسة والستين هذا المقطع: «أدهشني طعم الفلفل المقرمش؛ لأنه غير حرّاق، لذعته متوسطة ومعبرة عن لونه الأزرق الغريب بعد شيّه. قال ماركوس: هذا نوع خاص من الفلفل الأحمر يُقطف قبل نضجه ويترك في الشمس عدة أيام ليكتسب لونه الأزرق. وهو غير حرّاق، يصبح طعمه لذيذًا حين يُشوى ويُقدم ساخنًا. قلتُ له: لم أذق فلفلًا كهذا الذي يُعطي الطعام نكهة بديعة بلذعته الخفيفة المُستطابة».
وإلى آخر صفحة من الرحلة، وبل في آخر فقرة لا ينسى الحارثي تذكير القارئ وتوديعه بالفلفل الأزرق ولذعته الخفيفة تحت اللسان -وبكل تأكيد لتكتمل حفلة اللون- يكون على ورقة موز خضراء. حتى لو نسي القارئ طعم الفلفل في لسانه في الفقرة الأخيرة، سيذكره القرن الفلفلي الأزرق الأخير في الغلاف الأخير من الكتاب.
ربما من خلال هذا المقطع (والمقاطع السابقة) نستطيع أن نخمّن، لماذا اختار الكاتب هذا العنوان مع قرون الفلفل (التي اختارها الناشر ربما). فهذه الرحلة لها طعم خاص بالنسبة للحارثي، تأتي بعد تجارب كثيرة في ترحاله في جهات الأرض، وتراكم معرفي في كتابة أدب الرحلات. فهذه الرحلة كتبها باستمتاع وبتلذذ، ونجد ذلك في الجوانب التي كتب عنها وفيها عن سرديب.
أسفل العنوان، هناك عنوان فرعي (رحلتان إلى سيلان)، حيث إن الكاتب قام برحلتين إلى سيلان، ومن خلالهما قسّم كتابه إلى فصلين؛ الرحلة الأولى سمّاها «دمعة الهند»، فيما سمّى الرحلة الثانية: طاولة الكتابة تُنحت من شجرة فاكهة الخبز. وتحت كل من الرحلتين هناك عناوين فرعية، هي بمنزلة محطات وتأملات في زمن وأمكنة الرحلة. وقبل الدخول إلى الرحلتين هناك مقدمة صغيرة كتبتها ابنة أخت الكاتب الدكتورة جوخة الحارثي بعنوان: «إشارات الحياة»، أشارتْ فيها لظروف كتابة الكتاب ونشره.
يُهدي الحارثي كتابه إلى الكاتب والروائي سليمان المعمري: «إلى رجل بالكاد أعرفه، لكنه يعرفني جيدًا/في مَراقي الكلمات ومثالبها../سليمان المعمري الذي أهدى سيبويه زرقة شاشة مُقمرة/ ولوحة مفاتيح حصّادة لحقول الأبجدية». ويأتي هذا الإهداء بعدما راجع ونقّح المعمري ثلاث مخطوطات كتب سابقة للحارثي. وقبل الدخول إلى متن الرحلة يضع المؤلف عتبة صغيرة (بمنزلة وداعية للرحلة ومحبة لها) بعنوان: « تمائم ترحال»؛ وهي عبارة عن أربعة أبيات شعرية من الشعر العربي القديم لكل من أبي تمام وأبي فراس الحمداني وديك الجن والبحتري، ومقولتين لمونتسكيو وديكارت. وهذه التمائم لحفظه من الحسد والعين، لكن في مجملها تحرِّض الكاتب والقارئ على الترحال والاغتراب وعدم الكسل. تمائم اختارها الحارثي بعناية فائقة، ليشعرَ المتلقي بغبطة الكاتب بالسفر والترحال والاغتراب والاقتراب من سكان الجزر.
وفي العتبة الأخيرة للكتاب، يضع الناشر جزءًا من كلمة الدكتورة جوخة الحارثي من إشارات الحياة. قال محمد الحارثي لأصدقائه: «أريد من قلبي المريض أن يمهلني حتى أتّم كتابيّ الأخيرين». قلب الشاعر أمهله لكي يذهب بقارئه إلى نصوص شعرية حملتها ناقة عمياء، لكن هذا القلب خذله للمرة الأخيرة وحرمه من تذوق الفلفل الأزرق (بلذعته الخفيفة) فتركه يتيمًا في أفواه القراء.
الهوامش جذور المتن
يعتني محمد الحارثي بالهامش في هذه الرحلة (كما في «محيط كتمندو») ولا يهمل هوامشه، بل يجعلها جذورًا تحفظ المتن من رياح المباشرة، وتحفظ الفكرة من السطحية، فنجده هنا يُعلّق في الهامش، ويتجلى في التعمق في نهر الهوامش في هذه الرحلة. ولا يرضى أو يكتفي بالمعلومة الجاهزة؛ بل يبحث في مخيلته أو في محركات البحث، أو يسأل رفيقه في الرحلة عن دلالة اسم مكان لكي يبحث عن جذره اللغوي أو التاريخي، أو في الكتب ليجعل حبل السرد متماسكًا. وإذا لم يجد ما يقنعه يحاول خلق رابط سردي للمعلومة، مثلما فعل في الصفحة 183؛ لكي يربط اسم مدينة بنتوتة، يقول الحارثي في الهامش: «راق لي تسميتها بنطوطة (أو ابن بطوطة)، فقد عبر الرحّالة المغربي الشهير جزيرة سرنديب، فهل جاء اسمها تحريفًا لاسمه؟ بحثت كثيرًا، لكنني لم أوفق لإجابة شافية، وكنت أفكر بزيارتها، لكنها الآن مجرد منتجع فخم يزخر بفنادق الخمس نجوم التي يرتادها الأثرياء. على الرغم من أن الحارثي بحث عن سبب التسمية ولم يوفّق في ذلك، فلم يستسلم، فذهب إلى مخيلته الشعرية والتاريخية وربط اسم مدينة بنتوتة باسم الرحالة ابن بطوطة. ويكرر فعل ذلك في بحث عن معنى بحيرة الحليب، ويكتبُ هامشًا لذلك في ص77.
وعلى ذكر كلمة سرنديب يضع الحارثي هامشًا عن تاريخ تسمية البلاد بهذا الاسم وتغيّره، الهامش الموجود في الصفحة 21 وضّح تغير اسم البلاد عند الرومان والعرب والإنجليز والبرتغاليين وبعد الاستقلال. يتلذذ المؤلف بالهامش ويطيل فيه، يتعمق به، ينحته، يدس فيه معلومة أو نقدًا مبطنًا أو سخرية لاذعة، يتحيّن الفرصة في محطات الرحلة ليكتب هامشًا عن مشهد أو قلعة أو معلومة تاريخية أو عن رفيقه في الرحلة أو مرشده السياحي. أو تستفزّه كلمة دعس، فيضع لها هامشًا طويلًا.
* * *
نجد هذا الهامش في ص 43 «القرم أو الشورى جنس من النباتات الشاطئية تعتاش على المياه المالحة، ويوجد منها عدة أنواع، تكثر على الشواطئ جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج العربي. شاطئ مرتفعات القرم (حيث يقطن أثرياء مسقط) تسمى بسبب وجود غابة من أشجار القرم ما زالت موجودة لحسن الحظ، ولم يختطفها التوسع العمراني الجائر على حساب البيئة».
ومن الهوامش التي يتجلى فيها خيال الشاعر ونحته في ذاكرته وعاطفته ما نجده في ص241؛ يضع الحارثي هامشًا عن محطة أومانثا وهو في طريقه لزيارة منطقة الشمال، عقر دار حركة التمرد السابقة نمور التاميل. «ربما كان عليّ الاعتراف هنا بأن ما حدث في تلك المحطة كان شعورًا غريبًا لازدواج إيحائه بين الوطن/ والحب ومعكوسهما في مرآة الترحال؛ لأن اسم المحطة وإحالة اسمها إلى عُمان (وفق تحريفي!) مضافًا إلى آيسكريم لثغة ثاء (قد تكون تلك الفتاة) قد تأتأ بها لسانها لاستدراج ما لن يربط أحدهما بالآخر، عدا تلك القُبلة التي أرسلتها في الهواء ليرسل يائسًا عاشق اللحظة مثيلتها قبل انطلاق القطار، مصادفات سفر عاطفية يبقى رونقها وبهاؤها أسير اللحظة علّ الذكريات تحاول استجلابها في زمن آخر».
من خلال هذا الهامش يصنع لنا الكاتب مشهدًا سرديًّا سينمائيًّا، بدأت شرارته عندما ربطتْ مخيلة الشاعر اسم المحطة أومانثا باسم وطنه عُمان، وبذكاء فني ولغوي، أضاف الكاتب فكرة لثغة الثاء في لسان فتاة المحطة التي أرسلت له قبلة عابرة، ليضيف الثاء لعمان وتصبح أومانثا في ذهن القارئ، فخلق الشاعر/ الكاتب من هذا المشهد هامشًا جماليًّا. امرأة وشاعر وقطار وقُبلة وحنين إلى وطن. ما أُريد أن أقوله في جانب الهوامش في رحلة الحارثي (طبعًا تحتاج لدراسة أعمق من ملحوظاتي الانطباعية): إن الهامش معه لا يقل أهمية ومتعة من المتن، يحرض الكاتب على البحث عن المعلومة أو المشهد أو تاريخ الأمكنة، ليجعل من الرحلة وتفاصيلها أعمق وأكثر دهشة، وأكثر رسوخًا في ذاكرة المتلقي، نجده مثلًا في ص 89 يكتب هامشين: الأول عن عُرابي وثورته، وكيف وصل إلى المنفى في سرنديب، (حيث زار المؤلف المنزل الذي عاش عُرابي ورفاقه فيه) من خلال الهامش يتعرف القارئ إلى لمحة سريعة ووافية عن ثورة عُرابي، وفي الهامش الثاني يكتب عن أشجار المانغو، وكيف وصلت إلى مصر بفضل عُرابي، وأنواع المانغو في مصر. وصار الحارثي يشتري المانجو المصري محبًّا لعُرابي وثورته ومنفاه.
هامش محمد الحارثي مكتوب بحرفية وعمق، وبحث، وأحيانًا يظل الهامش عالقًا في ذاكرة القارئ. سأضيف أيضًا أن هوامش كتاب «فلفل أزرق» لم تكن ترفًا، أو شيئًا فائضًا عن النص، بل هي جزءٌ مهمٌّ منه، هوامش تشبه المسامير التي تمسك بخيمة السرد والرحلة. وهي ليست سهلة، بل يشعر القارئ بأن المعلومات التي حوتْها كُتِبَتْ بجهد وبحث كبيرين. يحاول الحارثي أن ينوّع في الهوامش لا يجعلها جامدة وميتة المعنى، يُراوِح بين الهامش الذاتي المتخيل، والهوامش التاريخية، والهوامش ذات الحس النقدي، وكذلك حس السخرية حاضر في هذه الهوامش.
عين الشاعر وحسّ المتأمل
ربما يتساءل القارئ: ما الذي يُميّز سرد الحارثي من الآخرين ممن كتبوا في أدب الرحلة؟ هل ينقل الكاتب المشهد مثلما يراه؟ هل يختار بلاد الرحلة بعناية؟ يقرأ عنها؟ هل يهمل طرق نقل المَشاهد؟ هل يركز على جانب واحد من البلاد التي يزورها أم إنه يحاول أن يغطي جوانبها المتعددة؟ لعلنا من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة سندخل تدريجيًّا إلى متن الرحلة، ليس لنعرف مدن ومطاعم وفنادق وعملة سريلانكا أو سرنديب، بل لنتوغل في حياة شعب وثقافة مكان وتضاريسه وتاريخ الجزيرة التي سمّاها الحارثي «دمعة الهند».

محمد الحارثي
يقول في ص270: «دائمًا أحب الطرق الفرعية الموصلة إلى قاعة الحياة في مزرعة، حي شعبي حيث تكثر به المقاهي التي تلتقي فيها بالبسطاء الحقيقيّين؛ لأنك عبر التواصل والنقاش معهم تستطيع معرفة الكثير من خفايا البلاد التي تتحاشى ذكرها كتب الأدلة السياحية». وهذا ما نجده في هذه الرحلة، حيث يخلق الكاتب حوارات مع الشخصيات التي يلتقيها، مع سائق السيارة أو صاحب الفندق، أو جارته في النزل، أو صاحب المطعم، أو مع سائحة تدرس الأدب العربي، أو يذهب إلى فنان تشكيلي إنجليزي يعيش في سرنديب ليسجل معه تاريخه في الجزيرة. أو يطلب من سائق التُّكْتُك أن ينحرف قليلًا ليجلس مع «شيّاب» في أقصى الشمال السريلانكي، أو مع صيّاد يبحث عن رزقه. يُنوع وسائل المواصلات؛ يركب القارب، وسيارة الأجرة، والقطار السريع، والقطار البطيء. كل هذا التنوع هدفه المغامرة واكتشاف المكان وتفاصيله.
يعتني محمد الحارثي بالتفاصيل الصغيرة (وبتفاصيل التفاصيل أحيانًا) فيخبرك بسعر وجبة في مطعم شعبي، ليس كذلك فحسب، بل يخبرك بمكونات الوجبة، وما الذي يضاف إلى وجبتك مجانًا؟ وطقوس الجلوس في مطعم شعبي في سوق الخضار. سنجد هذا الشرح في ص247، 248: «ورقة موز خضراء يانعة تُفرش على المائدة بعد أن يوضع إبريق من الماء البارد مع كأسين، ليأتي سُقاة الطعام: يوضع الأرز وسط ورقة الموز، ثم يأتي نادل آخر لديه صينية بها خمسة أو سبعة مكونات يسكبها بمغرفته على ورقة الموز لتحيط بكدسة الرز: عدس، باميا، بطاطا، بنجر، جوز هند مبشور في الليمون مع فلفل غير حرّاق، باذنجان مقلي مقرمش، جزر أحمر (نعم، أحمر وليس أصفر) مطبوخ في بهارات لاذعة قليلًا لكنها تعطيه نكهة لم أتوقع أنها ستطغى على حلاوة الجزر».
عينه المتأملة المتدربة على التفاصيل، لن تتركك هائمًا وعائمًا في شوارع وفنادق ضخمة، بل عين السارد للرحلة ستقود يد وعين القارئ/ السائح إلى مدن وقرى ومتاحف ومصانع الشاي ومزارع البقر، وحدائق الأشجار، ومطاعم شعبية، وقلاع تركها المستعمر الهولندي والبرتغالي والإنجليزي. ستدخل معه إلى معابد هندوسية وبوذية ومساجد وكنائس. وستعرف أسماء الأشجار والحيوانات والأسماك. (مع كل هذا التجوال ستصله رسالة نصية في هاتفه من ملك البلاد يبارك له عيد الفطر). وعندما يتوغل في الأمكنة، سيحدثك عن لغات الجزيرة وعن الديانات، وعن التعايش بين الأقليات، والتسامح، والتزاوج بين الأديان بكل حرية وأريحية. وسيذكر لك تاريخ الحرب الأهلية، وكيف حسم الجيش الباكستاني الحرب عام 2008م.
«أزعم أنني كنت ولا زلتُ مولعًا باستقصاء طبيعة المكان الذي أزوره وكائناته. ومراقبة الطيور والحيوانات جزء من اهتماماتي، وأيضًا تأمل سكان البلاد في سلوكهم اليومي حيال بيئتهم، وما أعطته الطبيعة لهم، أو حيال السياح وما يمكن لهم أن يستفيدوا منه إن عرفوا كيف يستثمرون إمكانيات المكان الذي يعيشون فيه». ص222.
القارئ لهذه الرحلة يجد هذا القول صحيحًا؛ لأن الكاتب تجده يتأمل البشر ويخبرك بالفارق في التعامل بين أهل الشمال والجنوب (السنهاليين والتاميليين). لدرجة حرصه على التفاصيل، سيضع لك جدولًا لحروف اللغة التاميلية، وكيف وصلت هذه اللغة من جنوب الهند، ونسب وجود الأديان في هذه الجزيرة.
عين الشاعر المتدربة جيدًا على التفاصيل وعلى رصد المشاهد اليومية، جعلت من هذا الكتاب الترحالي وثيقة ثقافية ومعرفية عن شعب وبلاد، فلم يكتفِ محمد الحارثي بزيارة معظم مدن سرنديب والغوص في دروبها وأسواقها، بل بحث عن أسماء المثقفين السريلانكيين من أصول غربية، ودوّن مجال اشتغالاتهم الفنية وبعض أعمالهم. دخل كذلك للمتاحف ليستكشف تاريخ البلاد، كما دخل المكتبات ليروي شغفه الجمالي بالرحلة. فقد قاده شغفه بالتفاصيل إلى أن يلتقي جورج بيفن الفنان البريطاني الذي يعيش منذ عقود في سريلانكا، وأجرى معه حوارًا وسبر تجربته، وشاهد لوحاته.
لا يكتفي المؤلف طوال الكتاب بنقل المشاهد والمعلومات والحوارات، من دون تحليل وفحص ونقد ومقارنة، بوساطة لغة شفافة يتقنها الحارثي جيدًا، حتى الشاب اليمني (الهارب من اليمن؛ بسبب تغيير ديانته) لم يتركه الكاتب من دون نقد، لهذا التحول الذي جعله يسخر من كل شيء يمت بديانته السابقة، ونجد ذلك في هامش كتبه في الصفحة 214، حين شعر الكاتب بتجاهل الشاب اليمني: «تجاهل جوزيف تعليقي بخصوص الطاقية العمانية؛ لأنه منسلخ روحيًّا فيما يخص ديانته التي نشأ عليها».
ونجد هذا الحس النقدي للأشياء والظواهر والعادات واضحًا في كثير من محطات الرحلة، وليس بالضرورة النقد بمعنى إظهار الجانب السلبي، أحيانًا يكون من باب المقارنة، مثلًا في المقارنة بين نمط طعام سكان جزيرة سريلانكا وسكان الخليج العربي الذين يلتهمون اللحوم بشكل مبالغ فيه. وبعض الملحوظات التي يلحظها، يَعْمِد إلى تحليلها، (مثلًا الفارق بين الأسعار للدخول للأماكن السياحية للسائح والمواطن).
ومن الجوانب اللافتة في هذه الرحلة (كما في تجربة محمد الحارثي ككل) الاعتناء جيدًا بلغة السرد، ليس فقط الاعتناء بها وجعلها سلسة فاتنة، بل كذلك النحت فيها، والتشبيهات التي يستخدمها في سرده للأحداث، من الأمثلة على ذلك (ثدي اللغة الحلوب، أشياخ القبيلة، نفطويه، بممحاة عجلاته). هذا اللغة التي نحتها الحارثي لم تكن متكلّفة أو مبالَغًا في صياغتها، بل جاءت سلسة متماسكة، دعّمها بتشبيهات وصياغات، وأحيانًا يسافر بخياله إلى شخصيات أحبها كهمنغواي وفان جوخ.
وإذا كان الحس النقدي موجودًا فهذا لا يجعل الكاتب ينسى أو يتناسى حسه الفكاهي، الذي ينثره على فصول الرحلة، مثلما فعل مع مرشده السياحي ماركوس الذي سمّاه مرقص، والذي رسم لنا بخياله صورة بأن زوجته تراقبه.
يمكن القول: إن هذا الكتاب الترحالي، يعدُّ نموذجًا لأدب الرحلة العميق، أدب الرحلة الذي يغوص في التفاصيل، الذي يقدم الجمال والدهشة بلغة سردية شفافة. من الجيد كذلك أن يُترجم هذا الكتاب إلى اللغات الحيّة الأخرى لقيمته الأدبية والمعرفية، وأن يُدرّس في مساقات كليات الآداب العمانية على أقل تقدير.