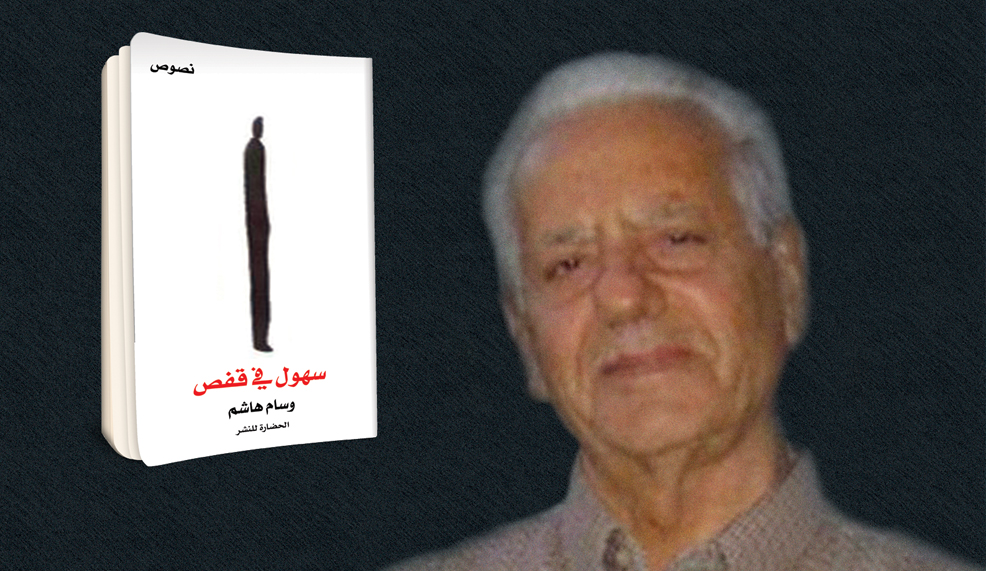بواسطة وسام هاشم - شاعر عراقي | مايو 1, 2022 | نصوص
جدتي
في صباي كنت أرسم
شخوصًا أحرصُ على أن أجمعهم مع الفرح في صندوق لكنهم سرعان ما يهربون،
أرسم معهم قططًا كاملة مكتملة لكنها لا تموء بل تبكي.
في حي يسمونه «سومر» رسمت قاربًا صغيرًا، وحين استيقظت صباح اليوم التالي وجدت الحي وقد تحول إلى هور، وقاربي تقوده امرأة بعباءة سوداء نادتني من بعيد وكانت جدتي.
وحين رسمت، في صباي، أصدقائي غرق بعضهم في ماء قليل، وآخرون ماتوا على الرمل،
أحدهم خدش عفنه بدينار، وآخر دفن شعره في قبر.
في صباي كل من رسمتهم هلعين.
– لا أريد أن أرسم بعد الآن..
قلت لنفسي هذا، يوم حلمت بكِ منذ صباي وحتى الساعة.
علبة نسيان
الساعة الآن الخامسة ونصف الحلم،
الثلج يجهز نفسه هنا.
لكني وأنا أفتح عيني ويدي تمتد لعلبة السجائر أتدفأ بكِ وأنت هناك
ليهبط الثلج مثل مظليين بيض من طائرات كثيفة.
أنا دافئ بكِ ويحرسني إخوتي الحقول
قبضة يدك وهي تقطر حزنًا ونعناعًا على ما تبقى من حياتي،
قبضة يدي تعصر ذكريات رجل مرَّ من تحت كل غيوم الأرض واهتدى للمطر الأخير في عنقك.
أنا الرجل الذي يحب كثيرًا فكرة الطيور،
يشتري مع علبة سجائره كل يوم علبة نسيان،
يغفو على أغنية ولا يصحو عليها.
تتناسل أحلامه حتى إنه يجد عشبكِ في فراشه.
رجل في الآخر أحمق لكنه طيب باعتراف كل الفراشات الحزينة التي مرت بنوافذه.
تَعَلَّمَ من صفعة الشرطي ومن قبله حبيبته أن الحياة واسعة، وأنكِ ستنتظرينه على حافة شارع ما في مدينة.
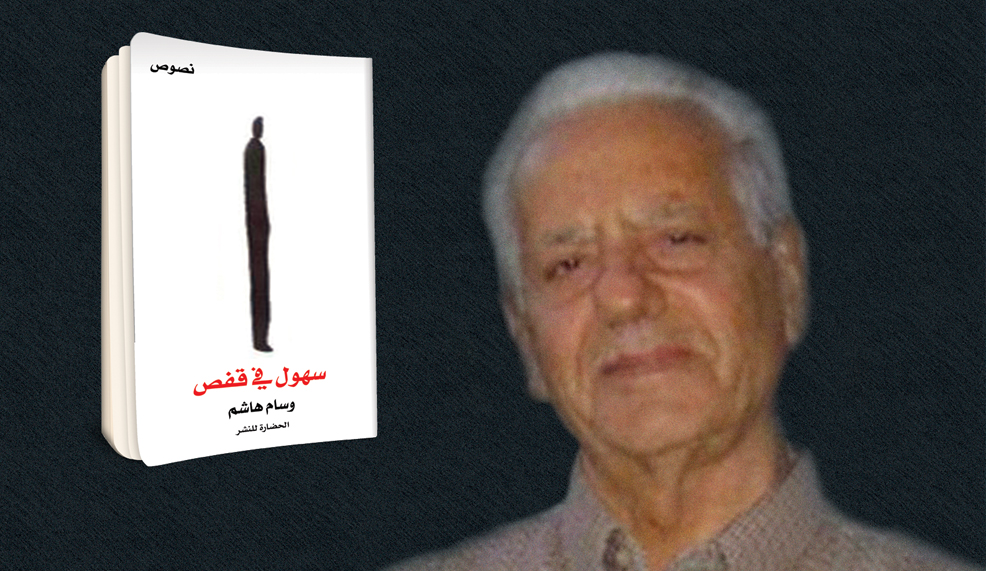
بواسطة وسام هاشم - شاعر عراقي | مارس 1, 2021 | مقالات
لم أعد أتذكر إن كان نهارًا صيفيًّا أم في شتاء بغداد، لا فرق، وصلني خبر أن طراد الكبيسي دخل مَنزله منزعجًا وفي يدهِ مُغلفٌ فيه كتاب لشاب نزق يعتقد أن بإمكانه وببساطة أن يرسل ديوانه المُعَد للطبع مع رسالة مقتضبة تقول: إنه تم الاتفاق على أن يُطبع الكتاب بمقدمة (دراسة) لأحد النقاد الثلاثة المختارين بينهم طراد الكبيسي. أية هفوة أن تُقدِّمَ نصوصك لناقد صعب وحريص وحادّ ذي لغة جافة أقرب للرسمية! كما يصفه كاظم الحجاج في معرض رثائه له «كان ناقدًا، مثل القضاة، لا يجامل ولا يحابي».
في صباح اليوم التالي اتصل بي أحد من أفراد عائلته قائلًا: إن الكبيسي نهض صباحًا مبتهجًا بديوان يعتقد أنه الأكثر دهشة والذي سيكون له شأنه الخاص في الشعرية العراقية، بعد قضاء ليلته كاملة مع «سهول في قفص» المخطوطة المطبوعة بطابعة كاظم غيلان الأولفيتي، هذا ما قاله لي محدِّثي على الهاتف، وأبلغني أنه تَرَكَهُ وهو مشغول في كتابة مُقَدمتِه عن الديوان. زمننا حينها في بداية التسعينيات الذي كنا فيه نأكل ونشربُ وندخنُ الشعر، مع زقنبوت الحصار في أول أعوامه. كان من الممكن ألَّا ينام أحدنا، نحن المهووسين بوهم أن الشعر يقولنا حتى وإن لم يقل ما نريدهُ.
هل قلت لا أتذكر إن كان صيفًا أم شتاءً بغداديًّا؟ الآن أتذكره صباحًا مشمسًا بالتمام والكمال، وقد وصلتني بعد أيام الدراسة مرفقة بالنصوص وهي تتحدث عني مُختفيًا مُتَخفّيًا في ذاتي. وأنا أقرأ السطور والصفحات كنت أقول لنفسي: يا ويلي، ماذا فعلت؟ ألم تَكفِني مغامرة النصوص ليضاف لها دراسة ناقد فذ وبعين ثاقبة تضيء ما حاولت إخفاءه عن عمد أو عن خوف؟
لكنه الهوس الذي أبتليتُ به في خوض مغامرتي الكبرى، بينما أمضي إلى ما لا أعرف عاقبته، أو كنت في العمق أعرف تمامًا. قلت ليكن ما يكون رغم أني بداخلي تمنّيت لو أني كنت قد اخترت إحدى الدراستين للناقدين اللذين اقتُرِحَا مع الكبيسي.
في أول أيام هروبي، قال لي شاعر كبير في عمان: كيف نجوت بعد نشر هذه النصوص؟ لقد أخرجت حتى طراد الكبيسي من تأنيه وحذره المعروف. كان يعرفه جيدًا وقد كتب عنه أيضًا. كيف لـ«سهول في قفص» أن تُخرج ناقدًا متأنيًا وحذرًا عن صمته؟ أقولها لنفسي كل مرة أقرأ فيها المقدمة حتى ساعة رحيل الكبيسي في ديسمبر الماضي، متذكرًا غرابة أنه ربما الناقد الوحيد الذي جمعتني به مناسبات معدودة قليلة، بحكم ابتعاده من المهرجانات وبحكم خجلي كتلميذ له ولغيره، واختياري القائم لحد الآن بالابتعاد من النقاد.
كان آخر لقاء به في مهرجان جرش الأردني في النصف الثاني من عقد التسعينيات، عابرًا يتخلله اتزان الكبيسي ووقاره وهدوء العارف وازدياد ارتباك الفتى الهارب. وإلى الآن أنا نادم، فلم أشكره بما يليق به وبدراسته التي أضعها للقراء هنا:
وسام هاشم «المخفي في ذاته»
طراد الكبيسي
كيف تكون القصيدة تأريخ الشاعر الشخصي، ويكون الشاعر، على نحو ما تأريخًا؟
كيف تكون هي طريقة الخلاص أو التطهر من نيوراستانينا العالم؟ لقد كان الشعر يقال، ويفهم، ويكتب أيضًا، تحت جملة هواجس، طغى منها عليه لقرون طويلة: «الوظيفة» أو «الغرض». ولكن منذ بداية هذا القرن برز الاتجاه نحو ما يمكن إدراجه تحت «إستراتيجية التسمية»، حيث تكون الكلمة أبرز مشاغل الشاعر الإستراتيجية. فالشعر –كما يقول هايدغر- هو التسمية التأسيسية للكائن ولماهيَّة الأشياء جميعًا، عبر تمثلها للوجود فيسيولوجيًّا وميتافيزيقيًّا. وحسب المبدأ المعروف: أن لكل شيء اسمه وما لا اسم له لا وجود له.. فأن تمنح الأشياء اسمًا، يعني أن تدعوها لأن توجد. وحيث إن الشعر اليوم، في جميع أنحاء العالم، يواجهُ لغاتِ موضوعة.
فهو يستخدم اللغة الأصلية. أي أنه لا يستخدم اللغة كأنها قَبْليَّة، بل على أنها بِدْئيَّة، وفي هذه الحالة، لا بد من أن يكون بِدْئيًّا من جهتين:
الأولى- العودة بالكلمة «اللغة» إلى حالتها الأصلية «بِدْئيَّة» من حيث إنها -أصلًا- لغةٌ شعريَّة. ففي كل لغة، حتى اللغة اليومية التي يتخاطب بها الناس، قوة شعرية خفيَّة، وعلى الشاعر إظهارها.
الثانية- الدهشة تجاه الأشياء، أو الغرائبيَّة. ونعني بها أن يعيد الشعرُ الأشياءَ إلى بداءتها، أو يُظهرها كما لو أنها ترى لأول مرَّة. أو كما لو أن الشاعر ذلك الطفل الذي يُقْذَفُ به إلى العالم، وعليه أن يتعرّف إلى الأشياء، عاريةً من جميع المحمولات والمُسميات التي منحها لها الناس من خلال تأريخهم، أو تأريخها، الطويل. حيث يقوم الشاعر بتسميتها. أي منحها وجودًا. كأن تكون الشجرة، ليست الشجرةُ بل رأسًا منكوشًا، أو امرأة تطرح ثمرها خارج رَحِمها، مكشوفًا أمام الناس! ومن هنا، وكما قال هايدغر أيضًا: إن جوهر الصورة الشعرية هو أن تجعلنا نرى شيئًا ما، مرئيًّا أم غير مرئي، غريبًا. ونعني بالغرابة: الدهشة، أو ما يُطلق عليه، أحيانًا، «المقدس» الذي عادة هو «المخفيُّ في ذاته».
هذا «المدخل» ضروري لهذا «الشاعر-الطفل» الذي بدا مندهشًا بالعالم والأشياء. وكأنه يراها لأول مرَّة. لذا فهو «يلهو») بها، «ويُعيد» ترتيبها بلغة مُتقطعة تجرَّدت من كل محمولاتها الموضوعية، لتكتسب وتَمْنَح، في الوقت نفسه، الأشياءَ أسماءً جديدة لا تخلو من غرائبية. وبعبارة أخرى: إن العالم والأشياء لدى وسام هاشم تولد وتوجد بفعلٍ وإحساسٍ ذاتي فاجع… هذه الحرب ليست هي «حربنا» التي عرفناها، ولا هي الحرب التي تكلَّم عنها هيرقليطس، بل هي «حربة» هو أَولدَها وأوجدها بذاتيَّة خالصة، بل بـ«لذة أدبية» تشبه لذَّة فنان يرسم وجه امرأة قبيحة.
وفق هذا، سأقول لوسام هاشم، كما تمنَّى أوكتافيو باث على ناقدهِ، ما هي «اللذَّة الأدبية» التي تمنحها قراءةُ مجموعته هذه، سأحتكم أولًا إلى التقاليد. فقد كان الشاعر منذ القِدم، يثير لدى الناس، أعمق المُتع. ولهذا اتخذوا من الشعر، شكلًا لقصصهم وأساطيرهم وملاحمهم وصلواتهم وأدعيتهم وتعاويذهم وأغانيهم ومُلْحة المجالس. وإذا كان بعضٌ منّا –أو كلُّنا- فَقَدَ هذا الإحساس بـ«متعة» الشعر، فَلِضُعْف صلتنا بالتقاليد والتراث من جهة، ولأن تَعقُّد الحياة وكثرة المرارات المُنغّصة لروح المرح للإنسان المعاصر، أفقدَته أو أَضعفَت لديه، حِسَّ الابتهاج بفرص الحياة. ومن الخصائص التي تجعل الشعر ممتعًا، أنه يتبدّى لبعضٍ أشبه باللعب. فالشاعر يلعب بالموجودات: يهدمها ويعيد بناءَها. بل إنه لا يتورع أن يجعل من ذاتِه، مركز الموجودات هذه، منجذبًا إليها أو منجذبة إليه، وكأنه قطب الكون المغناطيسي في ذاته، أو كأنه رَسُّ الكينونةِ.
ولا عجب، فالشاعر أول من كلّم الآلهة والتقط إشاراتها، وتكلم بكلامها. ولما كانت الآلهة تتكلم بالإشارات، فقد جاء الكلام الشعري: تأويليًّا، أو «حمّال أوجه» وذا طبيعة نبوئيَّة.
وسأحتكم، ثانيًا إلى ذلك الشاعر الصيني الحكيم الذي يجلس على قمة الهرم الكوني يرقب العالم ويحاول أن يأسره في بوصة من الورق! وأقصد هنا أن تفكر وتشعر على نحو عميق، وأن تجعل القارئ، يشعر ويفكر في الكون على نحو أشمل وأعمق. أي أن تكون له هو الآخر اكتشافاته وتخييلاته، وهو ما يبعث البهجة في نفسه. وربما الغرور، من جهة كونه إحساسًا بالتعالي، وتحقق الذات المتعالية.
فما الذي يجعل الإغريق (اليونان اليوم) مولعين بإلياذة وأوديسة هوميروس، والعراقيين بملحمة جلجامش، والطليان بكوميديا دانتي، والعرب بالمعلقات السبع، والإنجليز بشكسبير، والهنود بالمهابهارتا… إلخ رغم أنهم اليوم لا يعيشون شيئًا من تلك العوالم التي جسَّدتها هذه الأعمال؟!
لا شك، ليست هي براعة التقنيات اللغوية والأسلوبية والنغمية والتشخيصية فحسب، بل الأسئلة التي تطرحها حول «الحقيقة الإنسانية». والمحمولات التي تبثّها، والمشاعر التي تعمّقها حول الكون والإنسان والأشياء، لا تزال مطلوبة بوصفها تنتمي إلى «جذوريَّة» الشعر الذي هو «فلسفة» ما قبل الفلسفة! فليس الشعر، ولا «شباب الشعر» إذن، في اجتراح الصياغات اللغوية والنغمية فحسب، بل في «التجربة المسنة». أي الأكثر حكمة، والأعمق رؤية، والأبعد رؤية، والأغنى عاطفةً وحسًّا. وتلك، في رأينا، هي إحدى أو أهم ركائز أن يظل الشعر ممكنًا وضروريًّا.
في مجموعة وسام هاشم «سهول في قفص» نلتقي، أولًا، مع مهنة أو مهمة الشاعر الصيني لوتشي. فوسام هاشم الذي شاء أن يفيض على حياته ويحجرها في «قفص» الشكل النثري، لم يبتعد كثيرا من رؤية العالَم «نصًّا نثريًّا» مأساويًّا من الصعوبة ضبطه. وبالتالي لا بد من مواجهته بما يمكن أن ندعوه بـ«النص الفاجع».
النص: الدهشة والفخ معًا، وبخاصة حينما يجد المرء نفسه (وسام هاشم وجيله): «يهرولون بأحلامهم في قفص»! أولئك هم «أطفال» الحرب، الذين شبوا ووجدوا شبابهم «مجازًا» من «مجازات» لغة الحرب وأسلحتها ومُخلّفاتها الاجتماعية والسريّة، فهم بذلك أشبه باللامرئي: «قبضتُه من ريح وأصابعُه هواء وأقدامه خرافة». فأيّ كائن هو الذي عمره: «كيس نفايات»! وسنواته خداع! وكينونته «امِّحاء»!
إن عبارة هاملت: «نكون أو لا نكون» والكوجيتو الديكارتي: «أُفكر، إذن، أنا موجود»، وفعل الحرية السارتري: «الآخرون هم الجحيم» كلها تلتقي وتتفاعل عند وسام هاشم لتصبح «نمحي فنكون… أكون فأَمَّحي». إن فكرة «الامحاء» قد تكون «فكرة ملائكية!» طهورية وكأنها فكرة جحيمية، ولا إنسانية في الوقت نفسه؛ لأنها نبذ للآخر، من جهة، وإقصاء للذات من جهة أخرى: «جعلتَني زجاجًا فلم تَرني» ولكن علينا، مع ذلك، أن نفهم أنه من جيل لم يرَ الدنيا إلا من خلال الحرب: «على شرفة الحرب نُعلّق أعمارنا مثل حبل غسيل» (الحرب إمْحاء) للحقيقة الإنسانية. والحرب عادة.
سواء من خلال: «إلى الموت.. عادة سِرْ!» أو من خلال التعوّد على الاختفاء من الرَّصْدِ. حيث يصبح الاختفاء عادة مُتضخمة، يتضخَّمُ المُختفون معًا حدّ التفسخ فيصبحون: «هائلون من شدة اختفائنا».
فتختلط الرؤية وتصبح الأشياء هي الأخرى متضخمة، أو ليست ما هي عليه: «للحقيقة عجيزة أخرى»، و«للمودة كراهية كالتحية»، و«للكراهية أسنانًا بيضاءَ» و«منفًى للعقل في البرتقالة»… إلخ.
وهذا ما ينعكس بدوره على لغة وسام هاشم، وهي لغة تقترب جدًّا من الكلام المحكيّ في مفرداته وإيقاعه وصوره وأسلوبيَّته حيث المفارقة (السخرية) وتقطيع العبارات، وكثرة الانتقالات من صورة أو فكرة إلى أخرى دونما رابط أو تمهيد، أو اللجوء إلى النظام المقطعي حيث كل مقطع يشكل زاويةَ نظر إلى المشكلة، أو حزمةَ ضوءٍ تكشفها.
حسنًا… وأخيرًا، أقول: إن «سهول في قفص»: ذاكرة حرب متشظية في ذاكرة فردٍ. ومجاز في ذاكراتٍ تلمُّها ذاكرة.
وسام هاشم، إنها أوجاعك بقدر ما هي أوجاعنا، لكنك من دوننا صرخت: «أكلتك الحربُ.. الثعالبُ قادمة»!