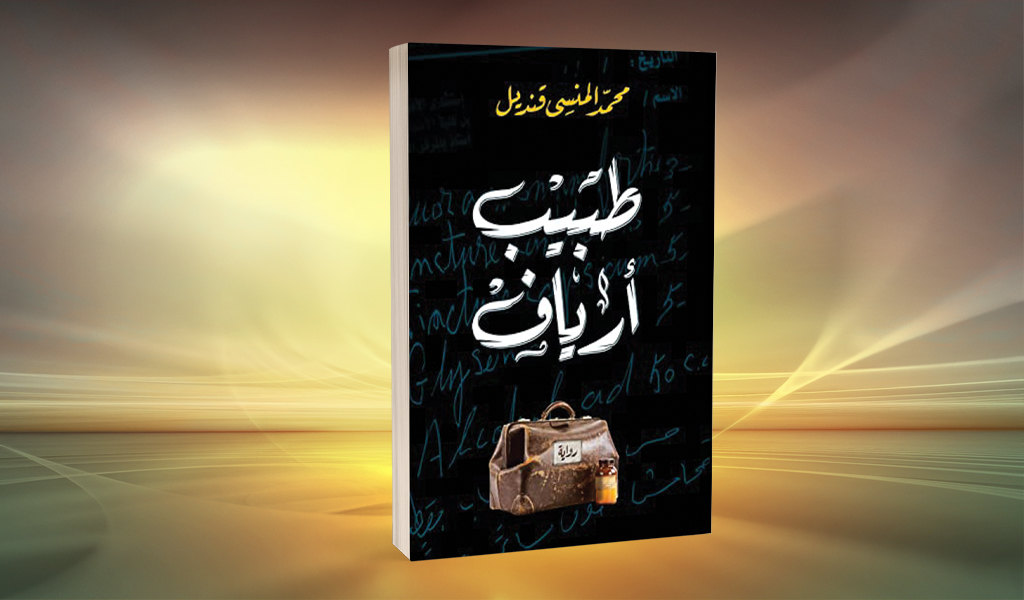بواسطة لنا عبدالرحمن - ناقدة وروائية لبنانية | يوليو 1, 2022 | كتب

عبدالله آل عياف
يقوم استقراء البنية الدلالية في رواية «حفرة إلى السماء»- (دار رشم السعودية ومسكلياني تونس)، للكاتب السعودي عبدالله آل عياف- على تحليل المعنى الذي يطرحه المضمون الحكائي وتعيين التناظرات والتعارضات المتعددة التي يقدمها في معانيه المحورية؛ حيث هناك محور جوهري ترتكز إليه بنية الرواية ككل، يؤدي فيه المكان دورًا رئيسًا، إنه قرية (مجهرة)، حيث تجتمع الأضداد والمفارقات عبر شخصيات أهلها. يصفها أحد شخوص الرواية قائلًا: «لكل قرية مجنونها إلا مجهرة، كلها مجانين». فهل ينطبق هذا الوصف حقًّا على أهالي مجهرة؟
تبدو القصص والأساطير ساكنة في تلك القرية، كما تسكن عادةً الحكايات السحرية في القرى البعيدة من المدن، تلك الموصولة مع العالم الخارجي بجماعة من الرائحين والغادين إليها، حاملين الحكايا عما وراء البحر والنهر والمدن البعيدة التي تسكنها النساء الفاتنات. وبدا غياب التمثيل الكياني المضاد لمدينة بعينها في مقابل مجهرة، أن جعل الصراع الدائر يتكثف في النص مكانيًّا داخل القرية، وبين أهلها، فبين الأزقة، والأبواب، مع الأصوات والروائح تختبئ الحكايات، وكأن الأفراح والأتراح في مجهرة لا تعدو إلا أن تكون دخانًا ممتدًّا يمزج بين الحقيقة والسراب.
بنية النص الروائي، مضمونًا
اختار الكاتب أن يفتتح روايته، التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» 2021م، مع لعبة سردية مشوقة. تبدأ الرواية مع الفصل الأول «مغادرة ووصول» بجملة: «أمام رجال مجهرة، وآخرين قدموا من القرى المجاورة، كان على تيماء أن تختار: إما أن تتعرى هي أو أن يتعرى والدها الشيخ الكبير». يتابع القارئ تيماء، التي تحمل صفات نفسية تختلف عن سائر نساء البلدة، «تنظر إلى السماء دائمًا»، ولا تنكسر أمام أحد، ويظل السؤال حاضرًا: ما الذي أجبرها على التعري؟ مشهد غامض لا يتكشف مغزاه كله إلا عند وصول القارئ للصفحة «120»؛ إذ تعتمد الرواية على التقطيع السردي ضمن الفصل الواحد، إلى جانب لعبة المرايا المستخدمة مع الشخصيات كلها، فتعكس كل شخصية حكايتها وحكايات أخرى تتقاطع معها كاشفة رؤيتها للمكان والزمان والشخوص.
يتجلى التناقض المبثوث منذ الصفحة الأولى في ثنائية الولادة والموت، وفي توظيف هذه الثنائية بتحولها إلى عملة واحدة بوجهين. موت الجد سالم ودفنه، وولادة حفيده غيث في مقبرته، يمثلان الحدث الأكثر عمقًا ومحورية في النص؛ لأننا سوف نجد له انعكاسات أخرى في حياة الأبطال جميعهم في علائقهم المختلفة مع الواقع وفيما بينهم. وليس لنا إلا أن نضع أي شخصية ضمن هذا التوزيع الأولي الدال على هذه الثنائية، ثم تفنيد ماهية دورها في الحكاية لنجد لها تناظرًا واضحًا مع المعطى الرئيس. لو أخذنا مثلًا نموذجيًّا على ما نسوقه فإنه كفيل بالكشف عن هذا التناظر الدلالي:
تيماء: ينفتح النص مع تيماء ابنة الشيخ سالم، التي تعود من زيارة صديقتها سوير لتجد والدها ميتًا والرجال يقومون بدفنه، تندفع تيماء إلى المقبرة هاجمة على كفن والدها، فتداهمها آلام الولادة فتضع ابنها غيث على تراب القبر.
سوير: وإن كانت تمثل عنصر الحياة والاستقرار عبر البيت وإنجاب الأبناء، فإن زوجها «فرج»، في ميله إلى الرحيل والتنقل، ثم نهايتهما معًا على قارعة الطريق، يعطي ذلك الشكل الحاد لحضور الموت، الذي يوقفه وجود فاطمة ابنة سوير في عهدة تيماء، ورمزية استمرارها في الحياة، بل منحها دورًا محوريًّا في السرد.
حمود: ترسم تجربة حمود مع معاناة الانتقال، مخاض التحول والولادة من جديد، يغادر مجهرة نحو البحار، يصير البدوي النوخذة، تشكل هذه التجربة بكل ما فيها مرحلة ثانية من اختيارات الأبطال للمراوحة في المغادرة والعودة (الولادة والموت)، دون اكتمال التجربة لسبب أو لآخر، يضطر حمود، طافي، أن يرجع لمجهرة طوعًا، ويموت فيها.
غيث ابن تيماء: يمكن عدّه المجسّد الواقعي لصراع الموت والحياة، ليس بسبب ولادته في المقبرة فقط، ولا لأنه أوشك على الغرق وهو غلام، بل لأنه ظل مسكونًا بالموت والمجهول والأسئلة المعلقة بلا إجابات، تمنى امتهان العمل داخل القبور، يتبسط في قربه منها ولا يشعر بالخوف، كما لو أنه ألفها منذ لحظة ميلاده على أرضها.
هكذا يمكننا أخذ أي شخصية في النص، وتحليل بنيتها الحكائية ووظيفتها ضمن المعطى الدلالي الرئيس، حيث يمكن فهم مواقعها وتصرفاتها وتحولاتها في إطار الهيكل الكلي للرواية.
مرايا السرد
 تكونت الرواية من اثني عشر فصلًا، وفي كل فصل عنوان يشير إلى مضمونه، حسب الشخصيات الرئيسة التي يمنحها الكاتب حق سرد حكاياتها؛ إذ يرتكز النص على وصل بؤرة السرد بالشخصيات، وهو ما جعل من كل شخصية تُشكل مُكملًا أساسيًّا لسرد الأخرى. هذا بالتوازي مع استخدام لعبة الإيهام السردي في تأجيل كشف محورية بعض الشخصيات ودلالاتها (حمود، فاطمة، غيث)؛ إذ يمثل حمود الشخص المتمرد على كل قوانين مجهرة، مغادرًا نحو العالم البعيد، ماضيًا بين البر والبحر بحثًا عن ذاته، أما فاطمة ابنة سوير فيتكشف في الفصل الأخير أنها من تقوم بعملية السرد والكتابة عن مجهرة التي تغيرت كثيرًا وأصبحت مدينة يُقيم فيها خليط من العمال الأجانب. أما غيث فقد أراد الكاتب عبره تقديم نموذج الصبي المختلف عن أقرانه، الذي يطرح أسئلة مغايرة مثل: «أين يذهب الدخان؟ هل للشيطان وجه مثلنا؟ ما لون الماء؟ كم عدد النجوم؟».
تكونت الرواية من اثني عشر فصلًا، وفي كل فصل عنوان يشير إلى مضمونه، حسب الشخصيات الرئيسة التي يمنحها الكاتب حق سرد حكاياتها؛ إذ يرتكز النص على وصل بؤرة السرد بالشخصيات، وهو ما جعل من كل شخصية تُشكل مُكملًا أساسيًّا لسرد الأخرى. هذا بالتوازي مع استخدام لعبة الإيهام السردي في تأجيل كشف محورية بعض الشخصيات ودلالاتها (حمود، فاطمة، غيث)؛ إذ يمثل حمود الشخص المتمرد على كل قوانين مجهرة، مغادرًا نحو العالم البعيد، ماضيًا بين البر والبحر بحثًا عن ذاته، أما فاطمة ابنة سوير فيتكشف في الفصل الأخير أنها من تقوم بعملية السرد والكتابة عن مجهرة التي تغيرت كثيرًا وأصبحت مدينة يُقيم فيها خليط من العمال الأجانب. أما غيث فقد أراد الكاتب عبره تقديم نموذج الصبي المختلف عن أقرانه، الذي يطرح أسئلة مغايرة مثل: «أين يذهب الدخان؟ هل للشيطان وجه مثلنا؟ ما لون الماء؟ كم عدد النجوم؟».
في المقابل ثمة شخصيات نمطية مثل (الشيخ عيسى)، الذي يجسد الشيخ النموذجي الذي يعالج أهل القرية بالطب العربي القديم عبر الأعشاب والكي والأدعية والتمائم. وعلى الرغم من سلوكه الذي يوحي بالعدل وميله لإنصاف الضعفاء إلا أنه في اللحظات الحاسمة يعود لانحيازاته القبلية والشخصية، وهذا يتجلى حين يرفض أن يمنح غيثًا السلطة على المقبرة لأنه لا ينتمي لآل صميح. يقول: «ما راح أكون الرجل اللي طلعت في وقته المقبرة والقيام على أمورها من آل صميح وراحت لآل جبر». ص 194.
الطبيعة الكونية
تحضر العناصر الكونية الأربعة (الماء، النار، التراب، الهواء)، وتتجسد تأثيراتها في حكايات سكان مجهرة، ويكون لها البطولة في قبضها على مجريات الحياة، أو في وضع ختم النهاية لحيوات الشخوص. إن طبيعة النفس الإنسانية تتداخل مع الطبيعة الكونية وفي حال تناغمها يحل التوازن في مَعِيش الإنسان، فيما يؤدي اختلالها إلى شتى ضروب الأهواء والانهيارات.
يضع الكاتب وجوهًا متناقضة بعضها مقابل بعض في تحدٍّ سافر للحقيقة الغائبة، التي تظل مبهمة وغامضة، مثلًا: إذا كان الأستاذ ظافر، المدرس الغريب الذي يحل بالقرية يمثل صوت العقل الحاض على العلم والمعرفة، فإن احتراقه وموته بنيران باغتته وهو يصبغ غرفة المكتبة، يعبر عن تلقي العقل لهزيمة واضحة بشكل عبثي جدًّا. وتظل شخصية ظافر محاطة بالغموض منذ البداية حتى النهاية، حتى حين يُبَلَّغ والده بموته، لا يأخذ جثة ابنه المحترق، بل يطلب منهم دفنه في مجهرة. فهل كان ظافر يتلقى العقاب على فعلة ما؟ هل كان منبوذًا لإيمانه بالعقل؟ لتحريضه على العلم، أم لأسباب أخرى لم تتبدَّ جهرًا؟
أما البحر ورمزية الماء، فيوجد لحضوره تمثلات عدة، بدءًا من الصلة بين القرية والساحل الذي يجتذب أبناءها، فيغويهم بنسائه الفاتنات، كما حدث مع «فرج»، أو أنه يجذبهم إليه ويحولهم إلى نوخذة (حمود)، الذي غاب عن قريته لأكثر من خمسين عيدًا. وحين عاد إليها، وفي لحظة وصوله، يتقاطع مصيره مع الصبي (غيث) الذي أراد تعلم السباحة فألقى بنفسه إلى ماء النباعة، الذي جذبه عميقًا، وكاد يغرق لولا أن أنقذه حمود الملقب بطافي لأنه نجا من كل أهوال البحار. وللمفارقة نكتشف أن طافي كان نزوله للماء ذاك هو الأول في حياته، فلا هو وصل إلى قاع البحر كما قيل عنه، ولا أمسكته الجنية من كعب قدميه كما شاعت الحكايا. طافي عاش حياته كلها على ظهر السفينة، لم يبلل ثوبه بالماء، وهنا تكمن المفارقة. لنقرأ: «وحده النوخذة الجيد لا يحتاج إلى تعلم السباحة. هل ستصدق أيها الصبي العجيب أن أول نزولٍ لي تحت الماء كان بسببك!» ص227.
تبدو مقولة: «من التراب وإليه نعود»، متجسدة في انفتاح الرواية مع الفصل الأول «مغادرة ووصول». وإذا كان البشر جميعًا أتوا إلى الحياة من طريق واحد هو رحم الأم، فإن لحظة القدوم تلك تختلف في موضعها من شخص لآخر. أراد آل عياف لضم الحياة بالموت في اختياره أن يولد الصبي غيث على تراب مقبرة جده سالم، مفارقة عجيبة أخرى سوف تظل تسم حياته كلها، فلا انجذابه للماء، ولا رغبته في السفر بعيدًا نزع من داخله ارتباطه بالمقبرة، وإحصاءه عدد القبور فيها، وتآخيه مع أمواتها وقبورها وحنوه عليهم.
الحضور النسوي
يمثل الحضور النسوي في الرواية، تجربة وعي جديد، وولادة جديدة، حيث تبدأ الأحداث مع تيماء، وتنتهي مع فاطمة ابنة سوير. ويحمل هذا الحضور في طياته اضطراب العلاقة مع الآخر (الرجل). يتجلى هذا بداية مع شخصية تيماء وارتباك علاقتها مع غيث ابنها؛ إذ على الرغم من كونه ابنها الوحيد، فإن صِلَتها به تظل مشوبة بسوء الفهم الذي يصل إلى الشك بجوهر الحب بينهما. لكن قوة الحضور النسوي عند تيماء تتمثل في انتهاء مهنتها في الحياكة، لتحل مكانها زراعة النخل في أرضها «مبروكة»، ومنح كل نخلة اسم شخصية في النص، وفي صراعها مع رجال القرية؛ كي تتمكن من الحصول على الماء، بعد أن حبسوا الماء عن أرضها. ارتباك العلاقة مع الآخر في حياة تيماء يتمثل أيضًا مع زوجها الذي يكاد يغيب حضوره، بعد أن اختار الرحيل عن القرية، أيضًا في اشتباك مشاعرها المتناقضة نحو الشيخ عيسى.
لعل في اختيار الكاتب وضع النهاية على لسان فاطمة إشارة للدور الحيوي الذي لعبته المرأة في استكمال الدورات الحياتية في تشكل الوعي. وإن كانت الراوية (فاطمة) تتقدم في هذا الموقف لتحيل القارئ إلى أحد خيارين: إما أن يعُدّ نفسه متلقيًا وحسب، أو عنصرًا فاعلًا ومتخيلًا لما جرى في مجهرة، وفي كل القرى الأخرى التي مسّتها الحضارة مسًّا كبيرًا فأعادت تشكيل بنيتها. إذ يكفي أن نقرأ في الصفحات الأخيرة من الرواية قول فاطمة: «تعلمت من أمي أن الأحزان تتوالى، ومن أبي أن الفرح ينتصر أخيرًا، ومن تيماء ألا أنحني أمام أحد أو لشيء… سمعت أن مجهرة تغيرت كثيرًا بعدي… كل شيء تغير إلا نخلتي، وعندما تعطي مجهرة لنخلتي اسمًا آخر سترحل ذكراي أنا أيضًا. ووحدها مجهرة ستبقى؛ لأنها تنسى».

بواسطة لنا عبدالرحمن - ناقدة وروائية لبنانية | مايو 1, 2021 | كتب
تمضي الكاتبة اللبنانية علوية صبح في روايتها الجديدة «أن تعشق الحياة» في المسار ذاته الذي اختطته في سابق رواياتها: «مريم الحكايا»، و«دنيا» و«اسمه الغرام»، بحيث لا يجد القارئ مشقة في تتبع الحكايات والأشخاص الذين يلتئم ماضيهم بحاضرهم في بوتقة واحدة، في مكاشفات إنسانية مؤثرة في قدرتها على تعرية الذات الداخلية، ومواجهتها بمواطن ألمها ولذتها، صراعها وسكونها، ذروة قوتها ولحظات انهيارها، ولا تبدو هذه المواجهات مجدولة ضمن ثنائيات مباشرة، بل تُصاغ ضمن النسيج الكلي للرواية، الذي يمضي بالحفر عميقًا منذ السطور الأولى.
بداية من العنوان «أن تعشق الحياة» (دار الآداب– بيروت)، ومقارنته مع العناوين السابقة، نجد دلالة كاشفة لعناوين روايات صبح المعنية بالحياة، والكتابة، والحب، والجسد. ضمن هذه الحقائق تطرح الكاتبة أسئلتها الوجودية، وتقدم رؤيتها للحياة. وإن كانت في النص الذي بين أيدينا «أن تعشق الحياة» ترتحل في تحليق حر -عبر تجربة المرض- نحو جوهر التساؤل الفعلي عن العلاقة مع الجسد، بحيث يبدو أنه العلة والمعلول، وكيف لا؟! والجسد البشري ككل هو الحضور المجسد للإنسان؛ إذ من غير جسد يغيب الوجود.
* * *
هناك ثيمات تشكل جوهر هذا النص، وتتقاطع مع كتابات صبح السابقة، وإن بدت هنا نبرة الألم النافذ للعمق أكثر حضورًا ووطأة على مدار الصفحات، بحيث لا تكاد تخلو صفحة من الحديث عن آلام الجسد وصراعاته. تحضر أزمة الجسد منذ الصفحات الأولى، مع البطلة «بسمة»، إنها راقصة باليه يخونها جسدها، تنفلت أعصابه عن سيطرتها، وتتمرد على الخضوع لإرادتها، فيصاب هذا الجسد بمرض يحار به الأطباء، يورث عطبًا في حركتها، لكنه لا يُعجز الروح عن الحب.
هكذا تمضي الحياة في مسارين، كلاهما مناقض للآخر: المرض والحب. وكأن هذا التجاور هنا غاية القصد منه هو تحرير فكرة الحب في جوهرها من ارتباطها بالجسد، يقول الحبيب البعيد لبسمة: «من قال إن الرجل لا يحب امرأة مريضة؟» هذا السؤال المطروح في صيغة حسم لوجود العشق، يُمثل انتصارًا للذات وللروح ولكل المفاهيم المعنوية على حساب الجسد، بعبارة أدق، تنتصر الكاتبة على مدار الرواية لفكرة أن رغباتنا الداخلية، وعشقنا للحياة ووجود الشغف، هي مقومات انتصارنا على جسد ضعيف، سقيم، متهالك، بحيث تصل في ختام المطاف إلى حقيقة تكاد تقول: إن الحب الافتراضي الذي تعيشه مع حبيب بعيد، ربما يكون الحب الحقيقي والأوحد.
معمار الرواية
اختارت الكاتبة معمارًا سرديًّا بسيطًا وواضحًا، في الاعتماد على تقنية الرواية- الرسالة. المكان هو مدينة بيروت، أما الزمان فنجد فيه إشارات للسنوات التي تلت الربيع العربي، ثم قيام الحروب واشتعالها في أكثر من بلد عربي، مما يزيد انعكاس حالة مأساوية على البطلة الساردة بسمة.
بدأت الرواية التي تتكون من اثنين وعشرين فصلًا، على شكل رسالة تكتبها بسمة إلى حبيب اليوسفي، الرجل الذي أحبته ضمن العالم الافتراضي، وتبادلت معه الرسائل الإلكترونية والواتساب، ومحادثات السكايبي. إنه حب عصري لا ينفصل عن الوجود التقني المعاصر، بل يؤكد أهميته في النجاة بالروح، من أن يصيبها التلف بسبب المرض؛ إذ تؤدي الحياة الافتراضية هنا إلى وجود واقع مشرق يبث الأمل من خلال الرسائل التي تتلقاها بسمة.
في المقابل إن كيان بسمة الواقعي المرادف للحب هو حقيقتها كراقصة باليه، الرقص يمثل وسيلتها التعبيرية الأهم للتواصل مع الحياة. هكذا يتمثل حضور الرقص في عدِّه أحد الوجوه الأساسية للجسد، ليس لبسمة فقط، بل لأكثر من بطل داخل النص. مثلًا: ينتقد والد بسمة أمها لأنها لا تتقن الرقص، ويكشف عن هذا علانية، موصيًا ابنته بأن تحب الرقص، وعلى الرغم من أن نموذج الأب لا يبدو فعالًا في الرواية أو مؤثرًا في حياة ابنته العملية، فإن البطلة بسمة تجد دعمًا من خالها الذي عاد من البرازيل وشجعها على تعلم الباليه وهي صغيرة، خالها القادم من بلاد السامبا يشجعها على الرقص والقراءة. من هنا تبدو اللحظة المفرقية، والتحول الأهم في حياتها.
النص المكتوب في صيغة المخاطب على شكل رسالة طويلة، تحكي من خلاله بسمة في سرد مسترسل، كل ماضيها، طفولتها، مراهقتها، شبابها، قصتها مع حبيبها الأول أحمد، ثم حكايتها مع يوسف الأستاذ الجامعي الذي يرسم ويكتب الشعر، وترتبط معه بقصة حب عنيفة لا تلبث أن تنتهي، رغم كل ما كان بينهما من تناغم وتقاطعات فكرية حول الفن والحياة. يكرر يوسف في لوحاته رسم حقيبة السفر، وحين تسأله بسمة عن السبب تكون إجابته بأن الحقيبة كناية عن الذين غادروا لبنان، لكن الحقيبة أيضًا ترمز إلى عدم قدرة يوسف على البقاء طويلًا في علاقة مستمرة، هو أيضًا يحس بحاجته للرحيل والمضي بعيدًا من المرأة التي سكن إليها.

علوية صبح
هوية الأنوثة
تشتبك دلالات الوجود الأنثوي في الرواية، مع حضورات شتى لآلام جارحة ومعذبة، ومهلكة للذات، هذا أيضًا يمكن تتبعه في روايات صبح السابقة، لا يمكن عدّ كتابة علوية صبح ضمن تصنيف الكتابات النسوية، فالأبطال جميعًا يسري عليهم نوع من القهر المحطم للروح، لكن عذابات النساء ترتبط بشكل وثيق بالعلاقة مع الجسد، ثم تتمظهر في انقلاب الضحية إلى وحش مجروح. بعيدًا من شخصية البطلة الساردة بسمة، يمكننا رؤية هذا في شخصية الأم، التي تجبر الأب في لحظة من غياب الإنسانية على تناول برازه، ثم تفعل بالمثل. تكشف الأم لبسمة هذه الحقيقة بعد انتحار الأب، تعيش الأم حياتها في حرمان وفقر ومعاناة تكتمل مع بتر ساق زوجها واضطرارها إلى خدمته، وثقل هذا على نفسها، في لحظة ما تخونها ذاتها تمامًا وتنفجر في مواجهة زوجها ونفسها، ثم بعد رحيل الزوج تستمر في عقاب نفسها وحرمانها من مسرات الحياة ومتعها، ويصير شغلها الشاغل زيارة قبر زوجها والبقاء بجانبه، وكأنها بهذا البقاء تُكفر عن خطيئتها في حقه.
تعاني أنيسةُ صديقة البطلة التي تعمل على كتابة روايتها الأولى، اضطرابًا في علاقتها مع زوجها الذي يضربها خلال علاقتهما الزوجية لدرجة أن تصاب بالشلل، لنقرأ: «وعندما أصيبت بالشلل، تنهدت بأسى، وقالت لي: تصوري يا بسمة أنه ينام معي بالقوة، غير آبه لحالتي الصحية». تصف بسمة علاقتها مع فكرة الوجود الأنثوي قائلة: «لا أدري لم أنا متأكدة من شيء وحيد هو أنني لست مخلوقة من ضلع رجل، إنما من أضلع أمي وجداتي». «أحببت جسدي الحر، الذي راح يحلق منفلتًا من أي قيد… عندما ينطق الجسد تتوقف لغات العالم لتصغي إليه، الرقص فعل إنساني وجمالي محض وبامتياز».
الذاكرة، الحرب، الأحلام
لم تسلم ذاكرة بسمة من الحروب الطويلة التي عاشها لبنان، ولا من وقائع ما تشاهده من أحداث الربيع العربي، وهو ما يجعلها تواجه أكثر من معركة، خارجية وداخلية. جسدها المهزوم الذي خانها في سحبها إلى دائرة مظلمة ظلت تقاومها على مدار الرواية، ثم هناك الحروب التي يضج بها العالم وتصل لأسماعها عبر نشرات الأخبار فتزيد من عذاباتها. تتمظهر هذه الآلام في معظم الفصول، وتتخذ شكل مراقبة للذاكرة وللأحلام، وللحاضر أيضًا. لنقرأ: «تصور أي صراع، بل أي حرب أقيمها مع ذاكرتي، وكم أتعذب؟ كأن حرب جسدي علي لا تكفيني». «هل خيبتي بيوسف الآن جزء لا ينفصل عن خيبتي بانكسار أحلام الربيع العربي؟». «يا لبشاعة الحروب والفقدان! كم يُمرضان ويفعلان بالجسد».
تبدو هذه العبارة موجزة لحالة بسمة على مدار الرواية. وإذا كان الإنسان منذ وجوده على سطح الأرض وهو يحاول مواجهة العدو الأول له وهو المرض، فإن بسمة في حربها على مرضها وإصرارها على النهوض بذاتها للقيام بعرض مسرحي جديد تتشبث بالأمل وتنتصر للحياة، تقول: «أقاوم وأعد نفسي وجسدي بأنني سأشفى حتمًا، وأن الحياة ستحتضنني مثلما أحتضنها».
يتكرر أيضًا حضور الأحلام في النص، وتقدم الكاتبة من خلالها صورة واضحة للحالة الداخلية التي يرفض العقل الواعي الاعتراف بها، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمشكلات الفرد وحياته الحقيقية. وهنا تأتي أهمية الحلم في القيام بالتأويل الذي يتم من خلاله الاسترشاد نحو ما ينبغي تغييره. تتداخل هنا فكرة الحلم مع فكرة الشغف، والعودة للحياة والرقص. تقول: «أنا عاشقة للحياة مثل أنيسة تمامًا، عاشقة للفن. ولكن، أنا الآن مريضة… أريد أن أشفى من كل شيء، من كل ما يمرضني ويؤلمني». أيضًا «هل أنا مسؤولة عن مرضي؟ هل قاصصت نفسي فقاصصني جسدي، كيف لي ألا أتابع ما يجري والبلاد بلادي، والدم وصل إلى غرفتي». «انهار جسدي، ولم أعد أقوى على الرقص، وفقدت الرغبة في كل شيء. والحرب التي طالت لسنوات هزمت أحلامي بالتغيير… على ماذا أتعكز؟ على جسد يتهاوى؟ أم على أحلام تنهار؟».
وهناك أيضًا حلم الحب الغائب، الذي فقدته الساردة أكثر من مرة، بداية من الحبيب الأول أحمد الذي تصفه بأنه لم يكن من نسل آدم وحواء، بل «من نسل الضوء والأنهار النقية»، أحمد يهديها كتابًا لابن عربي ويطلب منها أن تعيش حياتها، وأن تحب من جديد، لكن الموت يغيب أحمد ويترك في داخلها فوهة من الحزن، تجعل حضوره في ذاكرتها يتكرر في الحلم. ومع فقد الراوية للأب، ثم للحبيب أحمد تبدأ خلايا المرض تعشش في جسدها، وتتشكل في مرض حار الأطباء في توصيفه.
تشكل الشخصيات الجانبية أيضًا، رسمًا يتمم ظهوره تفصيلات الثيمات الرئيسة للرواية، بحيث تبدو التركيبات النفسية لهؤلاء الأشخاص محاكاة تجد انعكاسها في مرآة بسمة. أمينة، الصديقة التي تؤمن بظهور الأشباح، وطاقة العين والحسد، أنيسة وهي الأقرب لبسمة، تعاني في زواجها، ثم تنهي هذه المعاناة بتأليف روايتها الأولى، نزار صديق يوسف الذي فقد إيمانه بالنضال، وأصيب برهاب البرد الأبدي.
تبدو اللغة في «أن تعشق الحياة» سلسة، منسابة، وغير مفتعلة، لغة تأملية تُضيء عتمة الداخل، بحثًا عن شعاع ضوء نفاذ يتجلى حضوره مع اختيار الكاتبة أن تنتصر بطلتها للحياة، بحيث تتبنى الرواية فكرة جوهرية ترتبط بعدد من نظريات العلاج الحديثة التي تؤكد قدرة «التشافي الذاتي» على إبراء الجسد من علله وأسقامه. تختار بسمة عنوان «رقصة الشفاء» لعملها الاستعراضي، وتقدمه في عرض مسرحي جديد يجعلها تشعر أنها أقرب إلى ديار القمر، «امرأة مبرأة من أي علة، وبلا حاجة لأي سؤال».
تعاني أنيسةُ صديقة البطلة التي تعمل على كتابة روايتها الأولى، اضطرابًا في علاقتها مع زوجها الذي يضربها خلال علاقتهما الزوجية لدرجة أن تصاب بالشلل، لنقرأ: «وعندما أصيبت بالشلل، تنهدت بأسى، وقالت لي: تصوري يا بسمة أنه ينام معي بالقوة، غير آبه لحالتي الصحية». تصف بسمة علاقتها مع فكرة الوجود الأنثوي قائلة: «لا أدري لم أنا متأكدة من شيء وحيد هو أنني لست مخلوقة من ضلع رجل، إنما من أضلع أمي وجداتي». «أحببت جسدي الحر، الذي راح يحلق منفلتًا من أي قيد… عندما ينطق الجسد تتوقف لغات العالم لتصغي إليه، الرقص فعل إنساني وجمالي محض وبامتياز».
الذاكرة، الحرب، الأحلام
لم تسلم ذاكرة بسمة من الحروب الطويلة التي عاشها لبنان، ولا من وقائع ما تشاهده من أحداث الربيع العربي، وهو ما يجعلها تواجه أكثر من معركة، خارجية وداخلية. جسدها المهزوم الذي خانها في سحبها إلى دائرة مظلمة ظلت تقاومها على مدار الرواية، ثم هناك الحروب التي يضج بها العالم وتصل لأسماعها عبر نشرات الأخبار فتزيد من عذاباتها. تتمظهر هذه الآلام في معظم الفصول، وتتخذ شكل مراقبة للذاكرة وللأحلام، وللحاضر أيضًا. لنقرأ: «تصور أي صراع، بل أي حرب أقيمها مع ذاكرتي، وكم أتعذب؟ كأن حرب جسدي علي لا تكفيني». «هل خيبتي بيوسف الآن جزء لا ينفصل عن خيبتي بانكسار أحلام الربيع العربي؟». «يا لبشاعة الحروب والفقدان! كم يُمرضان ويفعلان بالجسد».
تبدو هذه العبارة موجزة لحالة بسمة على مدار الرواية. وإذا كان الإنسان منذ وجوده على سطح الأرض وهو يحاول مواجهة العدو الأول له وهو المرض، فإن بسمة في حربها على مرضها وإصرارها على النهوض بذاتها للقيام بعرض مسرحي جديد تتشبث بالأمل وتنتصر للحياة، تقول: «أقاوم وأعد نفسي وجسدي بأنني سأشفى حتمًا، وأن الحياة ستحتضنني مثلما أحتضنها».
يتكرر أيضًا حضور الأحلام في النص، وتقدم الكاتبة من خلالها صورة واضحة للحالة الداخلية التي يرفض العقل الواعي الاعتراف بها، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمشكلات الفرد وحياته الحقيقية. وهنا تأتي أهمية الحلم في القيام بالتأويل الذي يتم من خلاله الاسترشاد نحو ما ينبغي تغييره. تتداخل هنا فكرة الحلم مع فكرة الشغف، والعودة للحياة والرقص. تقول: «أنا عاشقة للحياة مثل أنيسة تمامًا، عاشقة للفن. ولكن، أنا الآن مريضة… أريد أن أشفى من كل شيء، من كل ما يمرضني ويؤلمني». أيضًا «هل أنا مسؤولة عن مرضي؟ هل قاصصت نفسي فقاصصني جسدي، كيف لي ألا أتابع ما يجري والبلاد بلادي، والدم وصل إلى غرفتي». «انهار جسدي، ولم أعد أقوى على الرقص، وفقدت الرغبة في كل شيء. والحرب التي طالت لسنوات هزمت أحلامي بالتغيير… على ماذا أتعكز؟ على جسد يتهاوى؟ أم على أحلام تنهار؟».
وهناك أيضًا حلم الحب الغائب، الذي فقدته الساردة أكثر من مرة، بداية من الحبيب الأول أحمد الذي تصفه بأنه لم يكن من نسل آدم وحواء، بل «من نسل الضوء والأنهار النقية»، أحمد يهديها كتابًا لابن عربي ويطلب منها أن تعيش حياتها، وأن تحب من جديد، لكن الموت يغيب أحمد ويترك في داخلها فوهة من الحزن، تجعل حضوره في ذاكرتها يتكرر في الحلم. ومع فقد الراوية للأب، ثم للحبيب أحمد تبدأ خلايا المرض تعشش في جسدها، وتتشكل في مرض حار الأطباء في توصيفه.
تشكل الشخصيات الجانبية أيضًا، رسمًا يتمم ظهوره تفصيلات الثيمات الرئيسة للرواية، بحيث تبدو التركيبات النفسية لهؤلاء الأشخاص محاكاة تجد انعكاسها في مرآة بسمة. أمينة، الصديقة التي تؤمن بظهور الأشباح، وطاقة العين والحسد، أنيسة وهي الأقرب لبسمة، تعاني في زواجها، ثم تنهي هذه المعاناة بتأليف روايتها الأولى، نزار صديق يوسف الذي فقد إيمانه بالنضال، وأصيب برهاب البرد الأبدي.
تبدو اللغة في «أن تعشق الحياة» سلسة، منسابة، وغير مفتعلة، لغة تأملية تُضيء عتمة الداخل، بحثًا عن شعاع ضوء نفاذ يتجلى حضوره مع اختيار الكاتبة أن تنتصر بطلتها للحياة، بحيث تتبنى الرواية فكرة جوهرية ترتبط بعدد من نظريات العلاج الحديثة التي تؤكد قدرة «التشافي الذاتي» على إبراء الجسد من علله وأسقامه. تختار بسمة عنوان «رقصة الشفاء» لعملها الاستعراضي، وتقدمه في عرض مسرحي جديد يجعلها تشعر أنها أقرب إلى ديار القمر، «امرأة مبرأة من أي علة، وبلا حاجة لأي سؤال».
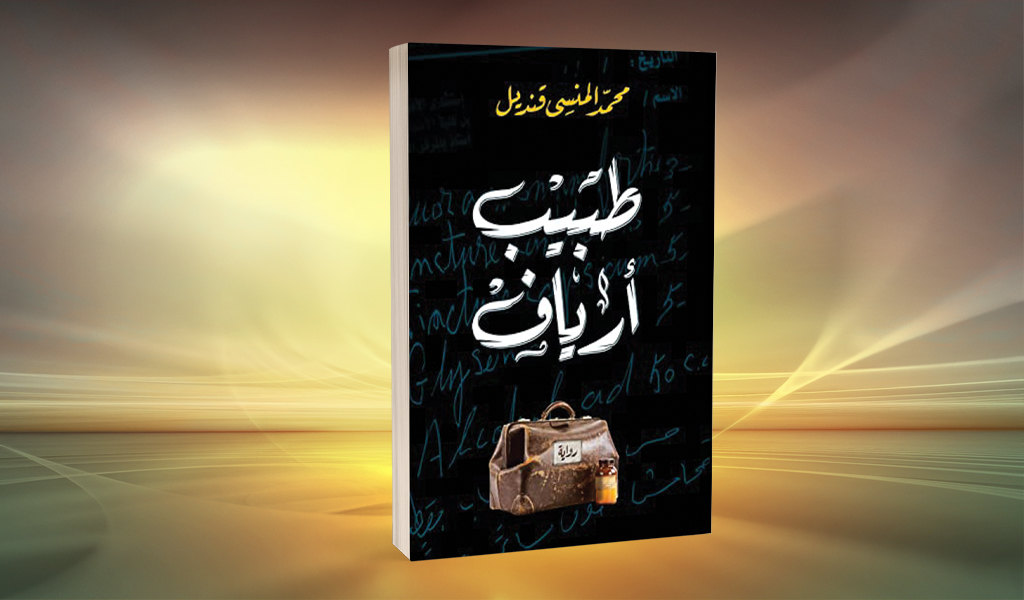
بواسطة لنا عبدالرحمن - ناقدة وروائية لبنانية | يناير 1, 2021 | كتب
يتشكل العالم الروائي في معظم روايات محمد المنسي قنديل من موقف وجودي متأزم يتعرض له البطل الراوي الذي يدلف القارئ إلى عالمه، عبر حكاية أساسية تنفتح مثل فوهة صغيرة، ثم تتسع وتتمدد رقعة أحداثها لتطغى على واقعه كله. هذا ما يمكن ملاحظته في رواية «قمر على سمرقند» مع بطله «علي» الذي يرتحل من عالمه الساكن في القاهرة ليبحث في مدينة «سمرقند» عن أسرار قديمة محجوبة عنه، يخوض غمار رحلة عصيبة بحثًا عن صديق لوالده كي يكشف له الماضي. إن ثيمة «الرحلة» ومعالمها المجبولة على غموض المجهول والانتظار والتيه، والواقع العشوائي لمحطات السفر بما فيها من سائقين ومسافرين ومارّة عابرين، يُمثل محورًا لانطلاق الرواية، هكذا يكون على البطل «علي»- وهو الاسم الدائم لأبطال قنديل في معظم رواياته- أن يخوض صراعات ومفاوضات بديهية للوصول إلى غايته. رحلة «علي» إلى سمرقند يمضيها مع «نور الله» السائق الغامض الذي يتقن العربية.
أما رحلة «علي» في «طبيب أرياف» (دار الشروق- القاهرة) من القاهرة إلى الصعيد لا تقلّ ألمًا واغترابًا عنها من رحلة سمرقند، حيث يمثل هذا الارتحال في روايات صاحب «انكسار الروح» خلخلة للثوابت، بل زوالًا لواقع ما وانشطاره إلى ما قبل وما بعد، ثمة عالم متروك، وآخر يمضي البطل نحوه في مسار يختلط فيه الاختيار والإجبار. يعود صاحب «أنا عشقت» من التاريخ الذي خاض غماره في «كتيبة سوداء» ليغوص في عمق الصعيد المصري، كما فعل في نصه «يوم غائم في البر الغربي».
في رواية «طبيب أرياف» لم يختر الدكتور «علي» رحلته طوعًا، بل فُرضت عليه قسرًا في قرار استبعاده أو نفيه من القاهرة، بعد خروجه من المعتقل. وانطلاقًا من اللحظة التي يقف فيها داخل محطة الأتوبيس ليبحث عن وسيلة تنقله إلى القرية التي يجب عليه الوصول إليها، سوف يتغير عالمه وينسحب الماضي من تحت أقدامه، ويحلّ واقع جديد مغاير يحمل بصمات المعاناة والشقاء الموسومة بها معظم التجارب المشابهة.

محمد المنسي قنديل
دلالة العنوان والغلاف
العنوان في الرواية «عتبة» لدخول النص، يمكن القول: إن المنسي قنديل واجه تحدّيًا كبيرًا في «طبيب أرياف» التي يستدعي عنوانها رواية توفيق الحكيم «يوميات نائب في الأرياف»، حيث التناص في العنوان ومفهوم الارتحال المكاني الإلزامي من المدينة للريف والتسلل إلى ما بينهما من هوة متسعة. أما غلاف الرواية التي نتناولها، والدلالة البصرية له في احتلال اللون الأسود مساحة كبرى، مع وجود حقيبة أدوية في أسفل الغلاف، واختيار اللون الأبيض لإبراز التناقض بين الأرضية السوداء والعنوان، فإن القارئ يتمكن بعد انتهائه من الرواية من إدراك السبب لحضور هذا السواد في الأرضية التي تُعبر عن محاكاة سافرة للواقع العبثي الظالم الذي لا يحتاج لأي فانتازيا كي تُظهر مدى سوداويته.
يتكون المعمار الروائي في «طبيب أرياف» من اثني عشر فصلًا، ويمضي السرد بالضمير الأول على لسان البطل الطبيب «علي»، فالأحداث كلها يرويها عن مرحلة من حياته أمضاها داخل وحدة صحية في قرية نائية، وهناك يواجه العبث مجسمًا في مجموعة من المفارقات الغريبة للطبيب، لكنها تُعبر عن قانون المكان وآلية سيره، فهو محكوم منذ العصر الفرعوني للحكام والكهنة والتجار، هذا المفهوم العتيق في التاريخ ما زال يسري واقعًا حيًّا يتمثل في سيرورة الأحداث التي لم يتمكن «علي» من التصدي لها، بل إنه يضطر للاستسلام لقانون اللعبة. ومنذ الصفحات الأولى من الرواية يُلامس القارئ إحساسًا بالتورط مع مصير البطل الذاهب مُكرهًا إلى المجهول.
ليست فقط ثيمة الرحلة الحاضرة بقوة في كتابة المنسي قنديل، بل الأبطال الغارقون في حالة من الضبابية والعجز ورغم ذلك يواصلون المضيّ في مسارهم، محاولين بجهد متعثر الانتصار لأحلامهم. عند وصول الطبيب ليلًا للوحدة الصحية العائمة في الظلام تستقبله مجموعة من الفئران حين يقوده مساعده في الوحدة «بسطويسي» إلى غرفته في الدور العلوي، مع وعد بتنظيف الغرفة وطرد الفئران في الصباح. انطلاقًا من هذا الحدث الواقعي ظاهرًا، الرمزي ضمنًا تتعاقب سلسلة من المفارقات الغريبة بالتزامن مع حضور شخصيات ومغادرتها مسرح الحدث، كي يكتمل تشكيل الإطار العام للمشهد؛ هذا ينطبق على مجمل الشخصيات الثانوية، إذ على هامشيتها فإنها تبني أمام عين القارئ حجرًا رئيسًا لإدراك المكان والأشخاص، هذا ينطبق مثلًا على شخصية «الصقر» و«العمدة وزوجته» و«أبينوب» و«دسوقي» وغيرهم من الشخصيات.
الحضور النسوي
يرتبط حضور المرأة داخل الرواية عند البطل «علي» بحالة توسل السعادة عبر التقاء روحي وجسدي مرتجى، وهذا يحضر بشكل واضح في علاقته مع الممرضة «فرح»، أيضًا في المونولوج الداخلي لعلاقته مع حبيبته السابقة «فاتن». واجه علي فشل العلاقة مع «فاتن» بسبب السجن والاعتقال الذي تعرض له وأدى إلى وصوله للصعيد، في المقابل تواجه فاتن تحقيقات ومطاردات من رجال الشرطة عن علاقتها مع علي، وهو ما يؤدي بها إلى اتخاذ قرار إنهاء العلاقة والارتباط برجل آخر. إذن يُخفق علي في قصة حبه بسبب السياسة أيضًا، ويعود إلى وحدته وخوائه العاطفي والجسدي.
أما فرح، الممرضة الشابة المتزوجة التي تعمل معه في الوحدة الصحية، فإن تورطه في الدخول معها في قصة حب تؤدي إلى حملها بجنين منه، تبدو العلاقة معها إشكالية منذ البداية؛ بسبب وجود تقاطعات اجتماعية ونفسية محكومة بها ضمنًا، ثم اختيار الكاتب تقديم كل صراعات وتناقضات المرأة عبر شخصها، مع ضرورة الإشارة عند الكلام عن شخصية فرح لوجود «وعي فطري» عندها يبدو في بعض العبارات أعلى من مستوى شخصيتها كأن تقول واصفة حال القرية: «الموت في بلدتنا سهل، نحن نموت لأسباب تافهة؛ لذا فإنقاذ روح من الموت عندنا هو فعلًا معجزة حقيقية». هذه الجملة تُطلقها فرح رغم أنها لم تغادر بلدتها قط، وحين ذهبت لدراسة التمريض قصدت بلدة مجاورة، لم تطأ قدماها القاهرة أو أي مدينة أخرى، بل إنها تعرف أن حياتها كلها سوف تمضي في بلدتها النائية كي تحيا وتموت فيها، لكن على الرغم من ذلك وفي أكثر من موضع تبدو فرح مثل العارفة لكثير من حقائق الحياة. في مقابل ذلك يبدو «الوعي» المسيطر على شخصية الجازية الغجرية متوافقًا مع تشكيل المنطق الواقعي في البناء الفني لشخصيتها ضمن كل أبعادها لامرأة غجرية رحالة، وساردة لسيرة «الهلالي» في ليالي الغجر.
الدلالات الفنية
ثمة بعد تخييلي في «طبيب أرياف» لا بد من التوقف عنده، حيث تقوم عليه الحبكة الفنية المتخيلة. على الرغم من أن روايات المنسي قنديل تعتمد على محاكاة جلية للواقع، فإن تفكيك الأحداث والتفاصيل التي ينتقيها من جوهر الحياة الخصب والحافل هو ما يشكل الميزة الرئيسة في رواياته، حيث تضفير الحكاية بالمخيلة، والحس الباطني للأبطال، واختياراتهم التي تعكس ميلًا إلى التحدي من ناحية، وإلى انكسار عميق من ناحية أخرى يشكل النسيج الحي للنص.
العالم الروائي المقدم في «طبيب أرياف» هو صعيد مصر، بلدة نائية جمعت في بنيانها كل أنواع القسوة الإنسانية التي من الممكن أن تسحق الفرد في بوتقتها، صراعات السلطة والدين والثأر والانتقام ورقابة المجتمع وسحقه للفرد جاثمة بقوة، لكن وسط هذا كله كيف يمكن التفكير في الحب، في الجنس، في الغناء، في الترانيم، والأناشيد والحكايات. تحضر هذه الأبعاد في معظمها عبر تقاطعات البطل السارد مع الشخصيات النسوية في العمل.
هذه اللحظات المقتطعة من الزمن، بل في معظم لحظات التواصل الإنساني في النص بين البطل السارد علي ومعظم الأبطال رجالًا ونساءً تميل إلى الصدق، تحديدًا في المحاولة المستمرة للمواءمة ما بين داخل الذات وخارجها. ومن خلال ما يرومه البطل من إحداث تآلف بين ذاته والعالم، فإننا نراه لا يستنكف الكشف عما ينتابه من لحظات ضعف وسقوط. يحمل الضعف الإنساني في هذا النص جماليات عالية؛ لأنها تخلو من الافتعال والادعاء والزيف. الأوقات التي ينكسر فيها البطل ويقف عاجزًا أمام السلطة المطلقة للمجتمع كثيرة في النص، وعاكسة بدقة لانهزامات الذات وجروحها ومرارتها، حين تختار الصواب وتعجز عن القيام بيقينها الخاص، الأمثلة على ذلك في علاقته مع الجازية، المرأة الغجرية التي تتعرض للاغتصاب من رجال الشرطة ومحاولته علاجها ومساندتها بكل الطرق، هناك أيضًا تفاعله مع قصة السيدة جليلة المرأة الأرملة المسلمة وتورطها مع أبينوب الخياط المسيحي، لكن تبدو قصته مع فرح بكل ما فيها من تناقض تتويجًا للصراع الإنساني بين الحب والرغبة في الامتلاك، وربما قليل من الشر أيضًا. لا تبدو الذات منزهة عن الخطايا في «طبيب أرياف» بل إن الكاتب كان حريصًا على تبيان الصراعات النفسية وتعريتها وتقديمها بمنظور مجرد يعكس دلالاته المستقلة عن الأحكام المسبقة.
بدأت الرواية بصراع الرحلة والمنفى الإلزامي، ثم تشعبت إلى صراعات أخرى، وانتهت في تشابك حزين لمصاير الأبطال المفجعة، كأن هذه الفجيعة هي الثمن الفادح لاختياراتهم المناقضة للمجتمع، كما هو الحال مع شخصية جليلة، أيضًا فرح وزوجها. في المقابل هناك تأكيد رسوخ السلطة بكل أشكالها وانكسار «الأنا»، مهما حاولت التمرد وتحقيق مرادها. في مقابل رحلة الطبيب إلى الصعيد التي افتتح بها الرواية، هناك رحلة النكوص التي يقوم بها في الصحراء مع مأمور الشرطة وعساكره والجازية، رحلة مواجهة الموت واكتشاف مدى الهوان الذي يرزح تحته البشر، لنقرأ: «يشير للعساكر الموجودين في العربة الكبيرة، يهبطون وهم يحملون أكفانًا بيضاء ناصعة مثل الرمل الذي نقف عليه، كانوا يعرفون منذ البداية أنها رحلة للموتى».
انزياح الزمان والمكان
يبدو الزمن سائلًا في «طبيب أرياف»، غير محدد بدقة، الإشارة إلى زمن السبعينيات في بداية الرواية، ثم الانتقال إلى ذكر حادثة اغتيال الرئيس السادات التي وقعت في السادس من أكتوبر عام 1981م، والتوقف أمام حدث الانتخابات الصورية التي أدت إلى قدوم الرئيس حسني مبارك، سبَّبَ تشويشًا للقارئ في تساؤله عن المدة الزمنية التي أمضاها الطبيب في الصعيد، رغم أن الإشارات الزمنية وسياق الأحداث توحي كما لو أنها عدة أشهر، لا سنوات.
في مقابل هذا، تبدو الإشارات إلى الأماكن، وكما في معظم روايات المنسي قنديل، مؤثرة وحاضرة بقوة في كل التفاصيل الصغرى والكبرى، بداية من وصف القرية وبيوتها ونوع المعمار المتجاور الذي يسكن فيه أهالي البلدة، ثم وصف غرفته في الوحدة الصحية، أيضًا وصف غرفة الفندق الذي نزل فيه ليلتين في البلدة المجاورة، الحديث عن الشوارع ومحطات السفر وما تعج به من صخب. إن براعة قنديل في الوصف الجغرافي الدقيق والحيوي يمكن عَدّه من الركائز الأسلوبية المهمة في سرده، وهذا ينطبق على مجمل أعماله الروائية، حيث يتمكن القارئ من المشاركة في تخيل الأماكن التي يتحدث عنها، بل إن قدرته السلسة على تصوير المكان وربطه بأسلوب فعّال مع الحدث الرئيس وتحركات الأبطال يُسهم في تدعيم سياق «الرواية-الحكاية» في بنائها القائم على التصاعد والتشويق من البداية إلى النهاية.


 تكونت الرواية من اثني عشر فصلًا، وفي كل فصل عنوان يشير إلى مضمونه، حسب الشخصيات الرئيسة التي يمنحها الكاتب حق سرد حكاياتها؛ إذ يرتكز النص على وصل بؤرة السرد بالشخصيات، وهو ما جعل من كل شخصية تُشكل مُكملًا أساسيًّا لسرد الأخرى. هذا بالتوازي مع استخدام لعبة الإيهام السردي في تأجيل كشف محورية بعض الشخصيات ودلالاتها (حمود، فاطمة، غيث)؛ إذ يمثل حمود الشخص المتمرد على كل قوانين مجهرة، مغادرًا نحو العالم البعيد، ماضيًا بين البر والبحر بحثًا عن ذاته، أما فاطمة ابنة سوير فيتكشف في الفصل الأخير أنها من تقوم بعملية السرد والكتابة عن مجهرة التي تغيرت كثيرًا وأصبحت مدينة يُقيم فيها خليط من العمال الأجانب. أما غيث فقد أراد الكاتب عبره تقديم نموذج الصبي المختلف عن أقرانه، الذي يطرح أسئلة مغايرة مثل: «أين يذهب الدخان؟ هل للشيطان وجه مثلنا؟ ما لون الماء؟ كم عدد النجوم؟».
تكونت الرواية من اثني عشر فصلًا، وفي كل فصل عنوان يشير إلى مضمونه، حسب الشخصيات الرئيسة التي يمنحها الكاتب حق سرد حكاياتها؛ إذ يرتكز النص على وصل بؤرة السرد بالشخصيات، وهو ما جعل من كل شخصية تُشكل مُكملًا أساسيًّا لسرد الأخرى. هذا بالتوازي مع استخدام لعبة الإيهام السردي في تأجيل كشف محورية بعض الشخصيات ودلالاتها (حمود، فاطمة، غيث)؛ إذ يمثل حمود الشخص المتمرد على كل قوانين مجهرة، مغادرًا نحو العالم البعيد، ماضيًا بين البر والبحر بحثًا عن ذاته، أما فاطمة ابنة سوير فيتكشف في الفصل الأخير أنها من تقوم بعملية السرد والكتابة عن مجهرة التي تغيرت كثيرًا وأصبحت مدينة يُقيم فيها خليط من العمال الأجانب. أما غيث فقد أراد الكاتب عبره تقديم نموذج الصبي المختلف عن أقرانه، الذي يطرح أسئلة مغايرة مثل: «أين يذهب الدخان؟ هل للشيطان وجه مثلنا؟ ما لون الماء؟ كم عدد النجوم؟».