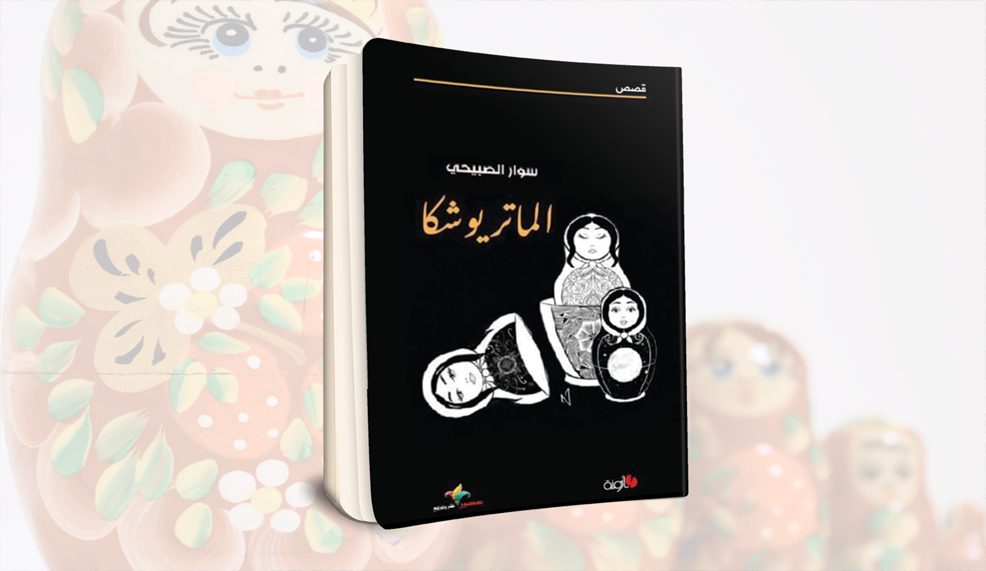بواسطة يوسف ضمرة - كاتب أردني | يناير 1, 2024 | مقالات
لماذا سُمّي موت البطل أو جنونه أو هزيمته في التراجيديا الإغريقية والشكسبيرية سقوطًا؟ هل هذا يعني أن التراجيديا تخضع لتعريف أرسطو مثلًا، وهو القائل: إن أبطال التراجيديا هم الملوك والأمراء والأرستقراطيون والنبلاء وما إلى ذلك؟ وهل يعني السقوط التراجيدي إذًا مأساة انحدار كائن فوقي إلى درجة مساواته بالناس العاديين، وبأقدارهم التي نراها كل يوم، كلازمة حياتية ضرورية؟ وهل ثمة تراجيديا من دون بطل تراجيدي؟ وهل هذا البطل فرد بالضرورة، أو ربما يكون جماعة ما؟
ليس من السهل أن نحيط بهذا الموضوع، بعد أن كُتبت فيه عشرات، أو مئات المؤلفات، من دون أن يكون هنالك اتفاق واضح على التفاصيل.
وفي أي حال، فإن مقولة أرسطو، التي حدد فيها البطل التراجيدي، لم تعد قائمة في الدراما الحديثة. ويعزو أكثر من ناقد هذا التحول إلى التحولات البنيوية التي أصابت المجتمعات الحديثة، حيث لم يعد الملك أكثر من رمز للدولة، ولم تعد الدكتاتورية تمتلك أي حق في احتكارها السلطة بأمر الله، كما كان الوضع أيام الإغريق. ولكن المبادئ العامة في التراجيديا لم تتغير، وإن طرأ على تفسيرها بعض الاختلافات والتباينات. فتداعت مقولة: إن الشرير لا يكون بطلًا تراجيديًّا. وهي مقولة كانت مثار شك منذ البداية، حيث لا يمكن اعتبار شخصية مثل (آخيل) مليئة بالخير، وهو ما ينطبق أيضًا على (آغاممنون) و(ميديا) و(باريس) و(مكبث) و (آنا كارينينا) و(إيما بوفاري) وآخرين.
بمعنى آخر، إن الجوهر الأخلاقي للشخصية ليس معيارًا للبطل التراجيدي، بمقدار ما لمعايير أخرى أهمية كبرى في تكوين هذا البطل، وأهمها: السقوط المأساوي، في دويّه المرعب في النفس. ومدى انغماس المشاعر الإنسانية في هذا السقوط، والتأثير الجمعي الذي يمارسه علينا، كالتفكير في مصايرنا وحاضرنا وآثامنا وحماقاتنا.
البطل التراجيدي في الكتابة العربية
لقد عرف الغرب هذا الفن منذ الإغريق، وطوروه، بحيث لم يعد للآلهة ذلك الدور الذي كانت تلعبه من قبل، نظرًا للقطيعة المعرفية التي عرفتها أوربا بين الدين والدولة، ونظرًا إلى تطور العلوم والاكتشافات والاختراعات البشرية المرعبة، وهو الأمر الذي أدى إلى التقليل من تأثير الغيبيات في الحياة والناس.
أما العرب، فقد عرفوا هذا النوع عبر التاريخ، لا من خلال الكتابة الدرامية. ولكن الكتاب العرب لم يلتفتوا إلى هذا السقوط التراجيدي المدوي في التاريخ العربي، وإلا لكانت لدينا العديد من الأعمال الدرامية التراجيدية، ولربما فاقت في تأثيرها ما كتبه العديد من رموز الإغريق والغرب عمومًا. إن مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء، يشكل سقوطًا تراجيديًّا مذهلًا في دويه وتأثيره وتفاعله مع المشاعر الإنسانية عبر التاريخ. كما يشكل مقتل عبدالله بن الزبير، وصلبه على جدار الكعبة سقوطًا تراجيديًّا مدوّيًا آخر. والأمثال كثيرة، لا نستثني منها سقوط البرامكة، الذي ربما يتفق إلى حد كبير مع تعريف أرسطو سالف الذكر. ولا ننسى مقتل حمزة في أُحد، والآثار التي خلّفها.
وما يهمنا الآن، هو البحث عن البطل التراجيدي في الكتابة العربية المعاصرة، بوصف هذه الكتابة حديثة نسبيًّا، إذا ما استثنينا البطل التراجيدي في الشعر العربي، بدءًا من طرفة بن العبد، وصولًا إلى مالك بن الريب وابن زريق البغدادي، من دون أن ننسى دويّ السقوط في شعر الصعاليك العرب. ثمة خلط أحيانًا بين الميلودراما والتراجيديا، وهو ناجم عن إشاعة مناخ عام من الحزن والأسى في الميلودراما، وهو الأمر الذي يشير إلى تقاربها مع التراجيديا في عدد من تعريفاتها وتمظهراتها الوافرة. ولكن الفارق الجوهري الذي ينبغي لنا الالتفات إليه، هو أن الميلودراما لا تنطوي على ذاك الدويّ الهائل الذي تنطوي عليه التراجيديا. كما أن الميلودراما لا تنتهي عادة بسقوط تراجيدي، بل على العكس من ذلك، فهي تعمل على انقشاع مناخ الحزن والأسى الذي أشاعته في البداية. بينما التراجيديا تقوم بما هو مختلف تمامًا.
فقصة الحب بين روميو وجولييت مثلًا، كانت تسير في شكل طبيعي، وربما كان ممكنًا انتهاءُ هذه التراجيديا على نحو آخر، فتنتفي عنها صفة التراجيديا التي نعرفها. أي أن التراجيديا تسير في العادة -ظاهريًّا- في شكل طبيعي، وربما لا يعكر صفو مسارها سوى حدث عابر أو مفاجئ يؤدي إلى هذا السقوط التراجيدي. إن تدخُّلَ إلهةٍ في إفشاء السر المتعلق بوتر (آخيل) غير المعمد في ماء النهر المقدس، هو الذي يغير المسار الذي لم نكن نتوقعه. وكذلك الحال في وشاية (ياغو) التي جاءت في شكل عابر، وكان يمكن أن تُعالَج لولا أن الوقت لم يسعف (عطيل) أو زوجة (ياغو)!
بالكاد نعثر على التراجيديا
وإذا استدرنا إلى الأدب العربي المعاصر، فإننا بالكاد نعثر على التراجيديا أصلًا، وهي الحاضن الرئيس للبطل التراجيدي. لقد حاول عبدالرحمن الشرقاوي في مسرحية «الحسين ثائرًا وشهيدًا»، لكنه لم يقم إلا بتوثيق تاريخي ممسرح. أي أنه لم ينطلق من الواقعة أو الشخصية كي يبني بناءً آخر جديدًا، كما فعل كُتّاب الإغريق مثلًا، الذين انتقوا شخصيات عدة من ملاحمهم وأساطيرهم، وقاموا بتأليف تراجيديات تخص هذه الشخصيات في شكل مغاير عما ورد، أو في شكل لم يكن موجودًا في الأصل، إلى الحد الذي جعل المؤرخين والباحثين يعيدون النظر مثلًا في أسطورة (بروميثيوس) إثر ما كتبه (آسخيلوس) عنه. كما تمكن عدد من هؤلاء، وعلى رأسهم (آسخيلوس) و(يوروبيديس) و(سوفوكليس)، بتتبع ذاتي/ إبداعي لمصاير بعض شخصيات الإلياذة مثلًا، وهو ما فعله الكاتب المتميز جمال أبو حمدان في مسرحية «الخيط» التي تابع فيها حياة (عوليس) و(بينيلوب) في شيخوختهما، من دون محاولة بناء تراجيدي في النص، اللهم سوى إشاعة مناخ تراجيدي عام!
وإذا كانت ثمة ملامح تراجيدية في الأدب العربي المعاصر، فإننا نعثر على شيء منها في الكتابة الروائية تحديدًا. وهذا ليس استثناءً عربيًّا، بعد أن انتهت الأشكال الملحمية الأولى، والمأساة اليونانية والتراجيديا الشكسبيرية، وبعد أن اختفت الأساطير في أشكالها الأولى من حياة العالم كله، وإن ظلت مظاهر الأسطورة قائمة في العالم الحديث في أشكال مختلفة، كما أشار (مارسيا إلياد) أكثر من مرة.
أي أن الرواية هي التي ورثت هذا الإرث كله، وكان عليها أن تتفاعل مع المجتمع البورجوازي الجديد، والارتقاء بقيمة الفرد، والمواطنة، والقانون، بعد أن كان الفرد كل شخص في الجماعة.. أي بعد أن كان صورة عن الآخرين، الطبقة والشريحة والمرتبة والمجتمع كله في المجتمع القبلي والشمولي. وليست مصادفة أو اعتباطًا ألا يكتب الأديب في الغرب قصة قصيرة أو رواية إلا باسم واضح، بينما لا نزال هنا نكتفي بالضمير (المتكلم والغائب والمخاطب)، وهو ما يحتاج إلى كتابة مستقلة.

بواسطة يوسف ضمرة - كاتب أردني | يوليو 1, 2023 | مقالات
لو سألنا كاتبًا مئة مرة عن دوافع الكتابة لديه، لحصلنا على مئة إجابة مختلفة؛ ذلك أن الأفكار في هذا السياق ليست منظمة وواضحة تمامًا؛ إنها تغير تراتبيتها من حين لآخر. ولكن الثابت هو أن القراءة عمل ممتع في المقام الرئيس. أما أسباب المتعة فهي كامنة في النص نفسه، وهي كثيرة إلى حد لا يمكن حصرها.
لماذا أبدأ بهذه الفقرة النظرية؟ لأنني ببساطة وصلت إلى إجابة محددة واحدة عن السؤال أعلاه، فيما لو طرح عليّ مئة مرة. والإجابة واضحة لا تحتاج تأويلًا أو تفسيرًا، وهي «لا أعرف»! بل يمكنني القول: إن عدم المعرفة يشكل أحد الدوافع الأساسية للكتابة؛ أي أن الكاتب في هذه الحال إنما يكتب مقتحمًا المجهول لمعرفة السري والغامض في نفسه وفي الحياة.
الكتابة رحلة اكتشاف
لقد أمضيت ما ينيف على نصف قرن في كتابة القصة القصيرة، وفي كل مرحلة كنت أظن أنني عثرت على ما أردته منذ البداية؛ لأكتشف بعد هذه التجربة الطويلة أنني لا أعرف ما الذي أريده تمامًا. في البدايات كنت مؤمنًا كسواي من زملائي أن للكتابة وظيفة لا تقل عن وظيفة الجندي والعامل، وأن الكتابة التي لا تبرز وظيفتها الاجتماعية والسياسية هي مجرد خطوط لا قيمة لها. وقد قادني هذا الأمر في البدايات إلى ارتكاب مجازر أدبية أو قصصية على وجه الخصوص. كان الأمر أشبه ما يكون بوضع العربة أمام الحصان. كانت الوظيفة جاهزة ومحكمة قبل كتابة النص، وكان عليّ أن أطوع مفردات هذا النص؛ لكي تؤدي مجتمعة الوظيفة المحددة. كان هذا هو أردأ أشكال الكتابة على الإطلاق، وقد مارسته بكل أسف. لكنني أزعم أن في داخلي، حتى في تلك المرحلة، كان ثمة شيء ينفر مما أرتكبه. كنت على استحياء أكتب بين حين وآخر قصة مختلفة، مفارقة للنمطي الذي كان سائدًا، ولكني حينها كنت أشبه ما أكون بصبي يقفز إلى بستان ويقطف ثمرة مختلفة عن الثمار التي اعتاد الصبية قطفها.
حين أسأل نفسي الآن عما فعلته خلال هذه التجربة، ولماذا؟ وكيف؟ ربما أجد القليل من الإجابات. فقد أدركت أن الثقافة السائدة تلعب دورًا رئيسًا في توجيه الكاتب مهما كان متمردًا. كما أدركت أن التغيرات الاجتماعية تلعب دورًا آخر. فالكتابة مثل العادات الاجتماعية التي تتغير بحسب متغيرات متحركة. فأنت اليوم لا تستطيع القيام بزيارة شخص ما لم تكن هاتفته واتفقت معه على التفاصيل، بينما في السابق كنت تعبر أميالًا لرؤية أحدهم وأنت تدرك أنك ربما لا تجده، كما أنك لا تعرف أحواله مطلقًا.
لقد نشرت ثلاث عشرة مجموعة قصصية، وشاركت في عشرات الندوات والملتقيات القصصية، وقرأت عشرات الكتب النقدية التي تتناول قصصًا بالدرس، أو تحاول تأسيس نظريات في فن القصة. ربما أكون تأثرت بهذا كله؛ الأسئلة التي كنت أتلقاها والملحوظات والقراءات النقدية لقصصي وقصص سواي، إضافة إلى نظريات تتناول فن القصة والسرد والعناصر المكونة له كالشخوص والحكايات والتكنيك. ولكنني في العقد الأخير الذي أصدرت فيه ثلاث مجموعات قصصية، وجدت نفسي حرًّا تمامًا. لم يعد ثمة إحساس بأي شكل من أشكال القيود التي حفرت في لحمي طوال عقود. وأستطيع القول الآن: إنني وصلت إلى ما كنت أبحث عنه منذ البدايات وقد كان غامضًا.
إنني لا أنصح كاتبًا مبتدئًا بأي شيء، ففي داخل كل كاتب جاد قبطان يتعلم تدريجيًّا إلى أن يصبح خبيرًا وشجاعًا ومتمرسًا.
عن الإنسان في هذه الحياة
كل ما كان يلزمني هو الجرأة والمغامرة، سواء أكان في الأفكار أم في التكنيك القصصي. لقد قلدت آخرين ولكني وجدت دائمًا أنني صدى للصوت لا صوتًا خاصًّا. التزمت ببعض التنظيرات واكتشفت أن الأمور ليست على تلك الدرجة من السهولة، بمقدار ما هي شكل ساذج من أشكال الاحتيال الفني. سأوجز فأقول: إن الأفكار تقود نفسها في نصوصنا، سواء أطلت بملامحها كلها أم ببعض منها. وأرى أن أهم ما يمكن الوقوف عنده مسألتان اثنتان: الحكاية والتكنيك!
عندما نقول الحكاية فإننا أمام أس القصة؛ أمام العنصر الرئيس الذي لا غنى عنه مهما تغير التكنيك الفني وتبدل، ومهما كانت الموضوعات والأفكار مختلفة ومتباينة. أي أنه لا قصة بلا حكاية. والحكاية تتشكل من وقائع وشخوص. فنحن لا نكتب عن أعماق المحيطات بالأرقام، ولا عن إحداثيات رياضية. نحن نكتب عن الإنسان في هذه الحياة. والكتابة عن الإنسان تشمل كل ما يخص هذا الإنسان من حكايا ووقائع وأفكار ومتغيرات وسلوكيات. كل ما علينا أن نفعله هو أن نجعل هذه الحكايات مقبولة وممتعة بالنسبة للقارئ، على الرغم من قساوتها في أغلب الأحيان. ولكي نفعل ذلك علينا أن نمتلك الشجاعة الكافية لارتياد آفاق فنية غير مألوفة؛ لركوب أمواج التكنيك المغاير والمختلف. فالمفارقة وحدها لا تصنع قصة، والتكثيف وحده كذلك.
والحكاية التي هي أس القصة، لا تتوقف عند الوقائع والأحداث، ولا ينبغي لها أن تكون مجرد حكمة تقليدية كما قرأنا قديمًا. نحن نتحدث عن خيال إنساني جامح لا حدود له ولا نهايات، وهذا الخيال يقود عناصر الحكاية ضمن نسق مجدول من الأفكار والتصورات الغامضة والواضحة. وفي النهاية علينا ألا نكتب إلا كل ما هو جديد ومغاير ومختلف. هذا يعني أننا مطالبون برؤية الحياة من زاوية مغايرة للسائد والنمطي والمألوف. ولكي نفعل ذلك، أرى أن التكنيك الفني يعد الركيزة الأساسية في هذا السياق.
أعرف أن بدايات القصص مهمة، ونهاياتها كذلك. ولكني أعرف أكثر أن كل ما يرد في القصة ينبغي له أن يكون ضروريًّا وضروريًّا جدًّا، وأن كل ما هو ليس كذلك ينبغي لنا التخلص منه. وأستطيع الجزم هنا أنني كنت حريصًا جدًّا على الابتعاد من الثرثرة القصصية والإنشاء.
أما المسألة الأخرى هنا فهي ما يتعلق باللغة. لقد شاعت في السبعينيات مقولة اللغة الشعرية في السرد، وقد رأيت لاحقًا أن هذا تحديدًا قد ساهم في إضعاف فن القصة، حيث الفرق كبير بين اللغة الشعرية واللغة السردية. فاللغة الشعرية تعتمد الانزياح اللغوي، بينما السرد يحتاج لغة بلا انزياحات، لغة مباشرة ولكنها مسبوكة بعناية فائقة، بحيث تنشر حولها مناخات شاعرية.
لقد كتب الكثيرون سردًا غرائبيًّا؛ سورياليًّا وفانتازيًّا ورمزيًّا بمعادل موضوعي وغير موضوعي. لكنني وجدت أن الفارق بين ما هو واقعي في الحياة، وما هو فانتازي ليس كبيرًا كما كنت أظن. إن كثيرًا من الوقائع التي تحدث يوميًّا ربما تكون أقرب إلى ما يمكن تسميته بالفانتازي من الواقعي. ولذلك، وجدت أن هذا التلاقح بين الواقعي والفانتازي ربما ينتج عملًا جديدًا لم أكتبه من قبل، وربما ظهر في مجموعاتي الثلاث الأخيرة، وبالتحديد في «فالس الغراب» التي منذ انتهائي منها قبل سنتين، لا أزال ألتقط أنفاسي وأعد نفسي لكتابة جديدة مغايرة، آمل أن تشكل إضافة نوعية تستحق التأمل.

بواسطة يوسف ضمرة - كاتب أردني | يوليو 1, 2022 | مقالات
بدءًا يستوقفنا التوصيف «الغرائبية» الذي يبدو في أحيان كثيرة مخاتلًا إلى حد كبير. ونقول مخاتلًا لأنه يحيلنا إلى أكثر من لون سردي، وهو الأمر الذي يجعلنا نخلط بين هذه الألوان من دون مسوغات متماسكة. فالرمزية مثلًا ليست غرائبية، ولكنها قد تتحول إلى غرائبية إذا استخدم الكاتب موتيفات الغرائبية نفسها في عمل رمزي. بناءً عليه يتعين علينا أن نحاول تحديد مفهوم قريب إلى الدقة لكلمة «غرائبي» قبل الحديث في المعتاد والمألوف.
تبدو كلمة غرائبي مشتقة من غرائب، وهي جمع غريب وغريبة. والغريب هو كل من ينزل بقوم يختلف عنهم في العرق والعقيدة واللغة. حتى لو أتقن بعض خصائصهم فإنه سيظل غريبًا. ولكن كلمة غريب اتسعت مع تطور الفكر الإنساني والفلسفة، فصار لدينا الغريب اللامنتمي والغريب الذي يعيش غريبًا في مجتمعه على الرغم من كونه ينتمي للعقيدة واللغة والهوية المجتمعية ذاتها.
فغريب كامو لم يكن في أعماقه يتوافر على شرط إنساني عرفته البشرية منذ وجدت على الأرض. ولذلك كان عنوان الرواية موفقًا جدًّا ولا بديل عنه. إنه شخص له شكل بشري لكنه مفرغ من القيم البشرية التي تحميها العاطفة الإنسانية، وهو ما يمكن وصفه بالعدمي.
ولكن السؤال المُلحّ هنا هو: لماذا يجنح بعض الكتاب إلى هذا اللون من الكتابة؟
بداية يمكن القول: إننا لا نستطيع تحديد إجابة قاطعة أو جازمة لهذا السؤال، ولكننا ربما نكون قادرين على الاقتراب من إجابة تبدو مقبولة أو لها ما يسندها إلى حد ما.
إن أول عامل يتوافر عليه السرد الغرائبي هو الخيال. وهو هنا خيال ليس عاديًّا أو مألوفًا أو متعارفًا عليه. إنه خيال يكاد يكون مبتَكرًا إلى حد كبير، متطرفًا بالقياس إلى الخيال النمطي أو المعتاد والمألوف، القائم على أحلام اليقظة والأمنيات والأحلام. أي أنه لا يستند إلى منطق بشري معتاد. فعلى سبيل المثال، فإن القتل في الحروب أمر طبيعي، حيث الجنود يقتتلون بناءً على أوامر قادتهم السياسيين والعسكريين، ولا يفرقون بين من هو طيب وشرير، ولا توجد خصومات شخصية بين الطرفين تدعو جنديًّا في جهة ما يزهق روح جندي في الجهة المقابلة. إن هذا يبدو مقبولًا وإن كنا لا نحبذ حدوثه إلا عند الضرورة القصوى. لكن القتل الشخصي أمر مختلف، فهو نتيجة خلاف ما بين شخصين، يبدأ من شتيمة ولا ينتهي بالسرقة والاغتصاب. أما أن يقتل المرء شخصًا آخر لمجرد أن عينه زرقاء وتشبه عين النسر كما حدث عند إدغار آلان بو، فهذا هو الغرائبي عينه!
ليس كل مخالف للسائد غرائبيًّا
بهذه المعاني نطرق الباب الأول لمفهوم الغرائبية في الأدب عمومًا والسرد خصوصًا؛ ذلك أنه ليس كل مخالف للسائد والمألوف يعد غرائبيًّا في الأدب. وعلى سبيل المثال فقد خرج علينا شعراء عرب بقصيدة التفعيلة وابتعدوا من البحور المعروفة، ولم يقل أحد: إن شعرهم الجديد «شعر التفعيلة» كان غرائبيًّا. وكذلك الحال مع قصيدة النثر ومع القصة القصيرة جدًّا، ومع القصة الومضة، ومع اللارواية أو رواية الضد في الغرب.
إن قتل الرجل العجوز عند إدغار آلان بو بسبب عينه الزرقاء، ذات الغشاء، التي تشبه عين النسر، لا تبرره عصبية القاتل التي يسوقها منذ البداية. ولكننا هنا نصل إلى عامل آخر من أسباب الجنوح، ونعني به غموض النفس البشرية. فالإنسان ليس واضحًا تمامًا كما نظن؛ إنه مضطر للتأقلم والتكيف مع القوانين البشرية والعادات الاجتماعية؛ لأن غير ذلك يعني العصيان والتمرد، وهما أمران يستحق صاحبهما العقوبة أيًّا كانت درجتها ونسبتها.
هذا الغموض البشري لا يُعبَّر عنه موضوعيًّا، فكان الأدب والسرد بالتحديد ميدانًا واسعًا لهذا التعبير وغيره. ولكن السؤال الآخر اللاحق في هذه الحال هو: ما الغرض من الكتابة الغرائبية؟
غاية الغرائبية
حين نفكر في الغرائبية في النص، نكتشف، بعد الصدمة الأولى للتلقي، أن مثل هذه الأفكار تصبح مقبولة لدينا بعد أن كانت عند الصدمة الأولى أفكارًا متطرفة وغير مألوفة.
كل ما تفعله الكتابة الغرائبية هو أنها تواجه الصعب في حياة الإنسان، وتخوض معركة شرسة ضد الغامض والسري في النفس البشرية، وتحاول العثور على معنى كل ما قد يستعصي على الرؤية والفكر، وتقرر الكشف عن أعمق ما في الذاكرة والخيال من نتوءات يعرف الإنسان بوجودها ولكنه لا يفهمها ولا يستطيع تفسير وجودها.
يبدأ إدغار آلان بو قصته «القلب الواشي» -لها ترجمات عدة بالطبع- بإخبارنا أنه شخص عصبي، ولكنه يدرك أن هذا الأمر وحده ليس كافيًا لما سيقدم عليه، فيخبر مخاطبه الآخر أنه من الصعب أن يصدق هذا؛ ولذلك يعود إلى إخباره كيف تبلورت المسألة في داخله. هذا فقط كل ما يورده آلان بو في سياق إخبار صديقه كيف قام بقتل رجل لا يبغضه ولا يوجد بينهما أي خلاف على الإطلاق. إنها عينه الزرقاء التي تشبه عين النسر!
يا إلهي! لا يتقبل الإنسان مثل هذا الإخبار بالطبع، ولكن التأني قليلًا يجعلنا نفكر في الأمر على الأقل، ونتساءل: ألا يوجد شيء مريب هنا؟ ألا يوجد ما أخفاه القاتل؟ ألا يمكن أن يكون لدى القاتل أسباب يجهلها هو نفسه؟ وهنا نتوقف قليلًا. هل توجد لدينا بوصفنا بشرًا مبررات وأسباب للقيام بخطوات غير مقبولة من الآخرين؟ ربما. هل يستطيع الإنسان أن يفسر لنفسه لماذا انعطف يمينًا أو يسارًا ذات يوم؟ هل كان يدرك أنه سيتعرض لحالة سطو فأخبرته نفسه أن يسلك الطريق الآخر لينجو؟ هل يمكن للقتل أن يكون درءًا للموت عن النفس من دون أن نعلم؟
الكتابة الغرائبية هي تلك الكتابة التي تجنح إلى هذا كله؛ إلى الغريب والغامض والسري واللامعقول بالنسبة للبشر. إنها كتابة تفتح لنا الباب للولوج إلى عوالم تبدو غريبة عنا، وغير معتادين عليها. إن شخصين مثل فلاديمير وإستراجون في مسرحية «في انتظار غودو» لصموئيل بيكيت، ليسا غبيين أو مشردين أو جاهلين.
لقد سمعا نداء خفيًّا في داخلهما جعلهما واثقين إلى حد كبير من مجيء غودو الذي لا يجيء. والسؤال هو: مَنْ غودو الذي ينتظرانه؟ والجواب سيكون مخاتلًا هنا؛ لأن علينا كمتلقين ومشاهدين أن نضع أنفسنا مع فلاديمير وإستراجون لكي نحاول أن نجيب. هل غودو هو الخلاص البشري؟ أهي الإجابات عن أسئلتنا الوجودية التي لا تتوقف؟ هذا جائز، ولكنه ليس كافيًا لأن جاك دريدا علمنا مقولة مهمة تسمى «الإرجاء والاختلاف» وهو ما يعني أننا كلما عثرنا على إجابة ما، سوف نعثر لاحقًا على إجابة مغايرة.
ختامًا نقول: إن الغرائبية أحد أهم الأشكال التعبيرية في الكتابة، وتتأتى أهميتها من كونها تركب المغامرة، وتلجأ إلى الغامض والسري في النفس البشرية، ولا يعنيها النمطي والمعتاد والسائد في الحياة. إنها ببساطة الامتحان الأصعب الذي يقرر الإنسان التصدي له لكي يعرف ويفهم بعض ما لم يفهمه عبر التاريخ البشري.
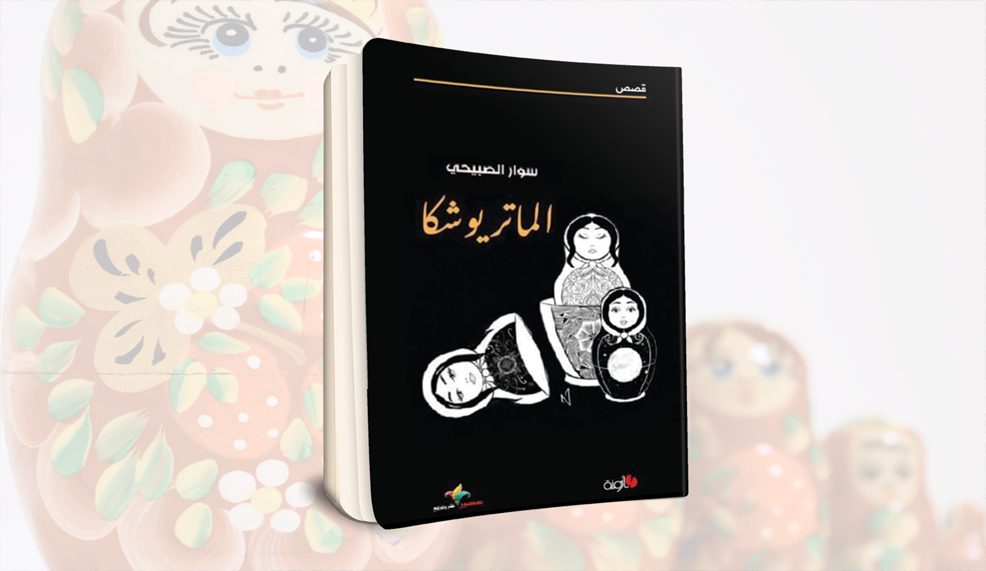
بواسطة يوسف ضمرة - كاتب أردني | يناير 1, 2022 | مقالات
هذه هي المجموعة القصصية الأولى للكاتبة سوار الصبيحي، حتى إنني لم أقرأ لها من قبل قصة واحدة في صحيفة أو مجلة. والماتريوشكا دمية روسية ما إن تفتحها حتى تجد لعبة تشبهها أصغر حجمًا، وهكذا! تلجأ سوار الصبيحي إلى كل ما يلزمها لتبني لنا عالمًا سريًّا أو غامضًا أو مكشوفًا لكثيرين منا، ولكنا لا ننتبه إليه في مشوارنا الحياتي، أو نداريه أو نغطيه خوفًا على أنفسنا من المعرفة. كل ما تقوم به سوار الصبيحي هو الكشف عن هذا الغامض والسري والمكشوف، وهو ما يعني تعريتنا أو مواجهتنا بمرآة ترينا أعماقنا لا ملامحنا الخارجية وحسب.

سوار الصبيحي
تختار الكاتبة نماذجها التي نعرفها ونلتقيها ونمر بها ونصادفها دائمًا في حياتنا، ولكننا لا نعرف ما يدور في أعماقها وفي مشوارها؛ بل يمكن القول بثقة عالية: إن هذه الشخوص ذاتها لا تعرف حقيقة ما يدور في أعماقها من أسئلة ورضا وطموح وأمل ووحشة وخوف وغير ذلك. نحن أمام شخوص نكاد نعرفها لأنها قريبة جدًّا منا، بل نشعر بها تتحرك في دواخلنا كما لو أنها جزء منا.
هذه التجربة التي تنقلها لنا الكاتبة من خلال صورة فنية مكثفة، هي التي تضعنا مباشرة أمام أنفسنا، ونبدأ في أثناء القراءة بطرح الأسئلة التي تتداعى بلا توقف: عمن تتحدث الكاتبة في هذه القصص؟ من هؤلاء الناس؟ هل ثمة مشكلات وقضايا وأفكار كهذه موجودة خارجنا من دون أن نعرف؟ وهل كنا كذلك طوال مشوارنا عبر السنين من دون أن ننتبه؟ هل سرقتنا الحياة من وجودنا إلى هذا الحد، كما يحدث مع الموظف في قصة «المنبه»؟ هل كانت خياراتنا ملتبسة كما في قصة «إشارات منتظرة»؟ هل تتوزع رغباتنا وأفكارنا، وتتشتت بحيث يكون أحدنا مشكلًا من ذوات عدة من دون أن يدرك، كما في قصة «الماتريوشكا»؟
تحيلنا هذه القصص إلى الدوافع التي تقف خلف الكتابة نفسها، ونعود إلى السؤال الأبدي: «لماذا نكتب»؟ هل حقًّا نعبر عن قضايا عامة، أم نحن نبوح ببعض ما نتلمسه أحيانًا في أعماقنا من قلق وأسئلة تنبثق عند كل منعطف في الحياة؟ هل كان فلوبير يعبر عن قضية عامة عبر شخصية إيما بوفاري وهي تركل حياة مستقرة وتركض خلف حياة صاخبة ومغايرة؟ أليست المرأة هنا في قصة «إشارات منتظرة» صورة من صور إيما بوفاري، حتى لو لم تفعل ما فعلته إيما نفسه؟ إنها تحمل في داخلها ذلك الرفض نفسه لاستقرار يبدو أليفا وربما يشكل طموحًا قبل الوصول إليه، لكنها تنفجر في لحظة عشوائية ربما، لكي تعبر لزوجها عما في داخلها تجاهه وتجاه هذه الحياة التي تعيشها. إنها تنتقد بقسوة خيارها الأول القائم بالموافقة على الزواج من هذا الرجل، ثم توغل في الكشف عما أخفته في أعماقها من رفض لكل ما يقترن به. ألم تقل آنا مثل هذا الكلام لزوجها أليكسي كارينين حين علم بارتباطها حبًّا برجل آخر؟ ما الذي سيحصل عليه الموظف المتفاني في وظيفته حد الإفراط ونسيان كل ما عداها؟ ألم يصل المحترم عند نجيب محفوظ إلى مقعد مدير المؤسسة بعد أن نسي حياته بكل تفاصيلها؟ بلى، فقد حصل على الترقية وهو يستلقي على فراش الموت!
حدث عابر
تحتاج الكاتبة هنا إلى حدث عابر أو واقعة عادية مما نمرّ بها كل يوم، لكي تشكل هذه الواقعة قطرة الماء الأخيرة التي تجعل الكأس تفيض. هكذا تتمكن من استخدام مفردات الحياة اليومية التي لا تشكل في حد ذاتها أمرًا لافتًا. فما اللافت في قراءة الجارة لفنجان قهوة امرأة؟ إنه حدث يجري كل يوم وفي كل مكان ومع شخوص حقيقيين، ولكن الكاتبة تتمكن من استخدامه صاعقًا لتفجير أعماق شخص يعيش حياته كابتًا مشاعره الحقيقية بلا سبب سوى مجاراة المجتمع وعاداته وتقاليده.
وبمقدار ما نفاجأ بالتفاصيل العادية التي تتمكن الكاتبة من تنسيقها واستخدامها، فإننا لا نستطيع تهميش التقنية الفنية التي تجيد توظيفها، ولعل أبرز ما تعتمده الكاتبة هنا هي المفارقة التي يتحدث عنها الكثيرون. إنها السمة الأبرز في هذه القصص؛ فبينما تلجأ قارئة الفنجان للاعتراف للمرأة أن الفنجان لم يكن فنجانها، ونتوقع نحن منحنى آخر للوقائع والأفكار بالنسبة للمرأة التي تبدو كأنها انزلقت في مصارحتها للزوج بمكنونات نفسها، فإننا على العكس تمامًا «وهي مفارقة ثانية» نكتشف أن المرأة كانت تعرف أن الفنجان ليس لها. إنها ضربة معلم إن جاز التعبير، حيث تشكل قراءة الفنجان «الخطأ» مبررًا وهميًّا للمرأة ليس إلا.
إن عزيزة لا تفعل شيئًا حين تأتي إلى البلدة كل يوم سبت؛ إنها فقط تقرأ الكف للنسوة وتمنحهن الأمل في تغيير المستقبل الذي يبدو لهن راكدًا ومعروفًا تمامًا قبل عزيزة.. إنه مستقبل قائم على بنية الحاضر الذي يعشنه بكل ما فيه من روتين وسطوة ذكورية، وكدر يومي في العائلات وبين الأزواج. كل ما يغير مشاعر النسوة هو هذا الأمل الذي تمثله عزيزة، لا بقراءتها الكف فقط، وإنما بشكلها ولباسها وأصباغ وجهها كغجرية نمطية. وهو ما يهدئ الرجال أنفسهم كذلك، وخصوصًا حين يعيشون هدوءًا مميزًا في هذا اليوم. ولذلك فإن اختفاءها يشكل صدمة للجميع في البلدة؛ لقد اختفى الأمل واختفت الفرحة التي يثيرها رنين الأساور والأقراط وبريق الأصباغ.
وبالعودة إلى المفارقة، فإننا نلمح هنا مفارقة في عنان القصة الذي هو «خطوة عزيزة» وهي جملة معروفة في اللهجة المصرية تنطوي على ترحيب بالقادم، وهو ما ينطبق على القصة هنا. كما أن العنوان يمكن أن يُقرأ هكذا «خطوة -البنت- عزيزة. هل تعود البلدة مثلما كانت؟ نشعر أن المرارة تكبر، ونتلمس بعض المخاوف عند الرجال. هل أدركوا أن عزيزة عرفت بعض أسرارهم كما حدث مع أهل بلدة يوسف إدريس في قصته «الشيخ شيخة»؟
خطوط حياتنا
ما الذي تريه لنا هذه المرايا؟ قراءة الكف وفنجان القهوة؟ إنها خطوط حياتنا التي نعيشها ولا ننتبه لتفاصيلها. إنها أفكارنا التي كلما أطلت برأسها في يومياتنا نقوم بطمسها بأي فعل نمطي لكي نستمر في حيواتنا من دون تلك الزوابع التي قد تثيرها الأجوبة. أحيانًا نخفي وأحيانًا نقمع تلك الأفكار. وأحيانًا تخدعنا الملامح الخارجية فنتخذ قراراتنا بناءً على هذا الخداع. لقد ظلت الأخت الكبرى تواظب على مراقبة الجار واهتمامه بنبتة دون غيرها في باحة منزله كما هي الحال في قصة «في الظل». وقد يصح أن نتساءل في النهاية عن ماهية من هم في الظل؛ هل هم في الظل حقًّا كما نظن ونعتقد، أم إن المظهر الخارجي كان مخاتلًا فخدعنا؟ هل الأخت الكبرى في الظل طالما كان اهتمام الأم منصبًّا على الأخت الصغرى؟ لقد اكتشفت أن اهتمام الجار بالنبتة التي ظنتها أثيرة لديه، يعود لحاجتها إلى رعايته أكثر من سواها من نباتاته، وبخاصة تلك الكبيرة والعتيقة التي لا تحتاج إلى كل هذه العناية؛ لأنها كبرت وضربت جذورها في الأرض عميقًا ولم تعد بحاجة إلى رعايته كتلك النبتة الجديدة التي تتعبه وتأخذ كثيرًا من وقته للحفاظ عليها.
ثمة كثير من الأفكار التي تبرز بعد قراءة هذه القصص، ولكن ما هو أكثر أهمية من ذلك، هو قدرة الكاتبة على تطويع الوقائع العادية لتصوغ منها بنية فنية حية، قادرة على إثارتنا ولفت انتباهنا لما هو تحت القشرة الخارجية لنمط الحياة اليومية التي نحياها، ونخشى على أنفسنا من منعطفات حادة قد تكون زلقة أو تودي بنا إلى مسارات مغايرة نحتاج وقتًا طويلًا للتأقلم معها، وإقناع أنفسنا والآخرين بها.

بواسطة يوسف ضمرة - كاتب أردني | مايو 1, 2021 | كتب
تبتعد سلمى الخضراء الجيوسي والشاعر شوقي عبدالأمير من أسرار الشعر التي يبحث عنها الشعراء في العادة. يتناولان موضوعات تتعلق بالشعر وبغيره. علي العامري، في كتابه «رقيم الحبر: شعراء يتحدثون عن الطفولة والحب والمنفى» (الدار الأهلية للنشر)، يدرك أن كلًّا من سلمى الخضراء الجيوسي وشوقي عبدالأمير لم يتركا بصمات بارزة في مسيرة الشعر العربي، لكن كلًّا منهما انهمك في مشروعات ثقافية عربية على تماسّ مباشر بالشعر، وهذا ما جعل العامري يوجه بوصلته نحو تلك المشروعات الثقافية «بروتا» و«شرق. غرب» لسلمى الخضراء الجيوسي، و«كتاب في جريدة» لشوقي عبدالأمير بالتعاون مع اليونيسكو وباشتراك أكثر من مئة صحيفة عربية.
ولذلك لم يكن مستغربًا أن ينصب الحوار ويتمحور حول هذه المشروعات؛ والأهداف والبدايات والعوائق والتطور والأثر والمآزق اللاحقة كتوقف كثير من الصحف، والقراءة في الإنترنت مباشرة من دون الحصول على ورق وتكديسه، والمعاناة أحيانًا في التخلص منه، لكن الجيوسي الشاعرة وعبدالأمير الشاعر لم يغردا خارج السرب فيما يتعلق بالشعر، حيث كابد الاثنان ما كابده بقية الشعراء في الكتاب، وبخاصة المنافي والتشرد والغربة والمعاناة التي يتسبب فيها الحنين إلى الوطن أينما ذهب المرء وحيثما استقر.
لكن المشكلات الأكثر تعقيدًا تتعين في حوارات الشعراء الخمسة الآخرين «عبدالوهاب البياتي، ومحمد القيسي، وعز الدين المناصرة، والمالطية ماريا غريك غانادو، والفلسطينية جذرًا ناتالي حنظل». تشي الحوارات بأهمية قيم معينة للشعر، ومن أهمها الطفولة والمنفى والهوية، وهي قيم تبدو القاسم المشترك الأعظم في هذا الكتاب. وإذا ما قلنا الهوية فإن اللغة تبرز كملمح رئيس من ملامح هذه الهوية، وهو ما نلمسه ونشعر به في آراء الشاعرتين المالطية ماريا غريك غانادو، والفلسطينية الأنتيلية الأميركية نتالي حنظل التلحمية قبل مئة عام.
يبرز الفقد كأحد العناصر أو العوامل الأساسية، ولا نحب ترداد ما قاله السابقون في هذا الشأن من قبل، وهو أن المرأة تعني الأم/ الحبيبة/ الأرض/ الوطن. فحمدة والدة الشاعر محمد القيسي التي أرضعته في فلسطين وحملته على كتفها وفي حضنها عبر حدود وجغرافيات عدة، تظل هي المرأة الإنسان الذي قاسى وعانى وذاق مرارة المنافي وقسوة الحنين إلى الديار أكثر من الشاعر نفسه. لكنها في بؤسها ومراراتها وندبها اليومي تنقل الوطن إلى ابنها من دون أن يقصد أحدهما ذلك. يقول القيسي: إنه كان عاقًّا لأمه، لكنه حين وجد نفسه بعد أكثر من خمسين عامًا مجردًا من تلك «اللطميات» وخطوط المنافي على وجه أمه، أدرك فداحة الخسارة التي أصابته.
كسر الحنين
لكن المنفى لشاعر مثل عز الدين المناصرة شكل حالًا مختلفة، فقد اكتشف أنه لكي يظل فلسطينيًّا، كان عليه أن يكسر الحنين في داخله. وهو حين يخاطب عنب الخليل في ديوانه الذي يحمل عنوان «يا عنب الخليل» لا يناديه كمنفيّ، وإنما كإنسان يعيش مأساة الاحتلال، وهو ما ينطبق على الجغرافيا في شعره؛ إنها بمنزلة توكيد الارتباط بالشعب وبالوطن، فهو ينادي عنب «الخليل» ويكتب الخروج من «البحر الميت» الذي يذكره صغيرًا مع أهل قريته الذاهبين لإحضار الملح بعد أن تتبخر المياه عن الصخور. ويكتب «قمر جرش كان حزينًا» وهو هنا يشير إلى أحد أهم مواقع المقاومة الفلسطينية قبل ترحيلها إلى لبنان وسوريا. ثم يعود إلى «كنعان» وأرض كنعان في «كنعانياذا» ليؤكد ارتباطه الجذري بفلسطين، وليؤكد ثانية أنها ليست أرضًا موعودة لأحد سوى الكنعانيين، حيث سرق الاحتلال منذ نشأته المفردات الكنعانية من رقص وغناء وملابس وطعام، بوصفها إرثًا يهوديًّا.
لقد لعبت الطفولة عند الشعراء المحاوَرين دورًا أساسيًّا في تشكيل التجارب الشعرية وصقلها. وهي غالبًا هنا مقترنة بالمنفى، كما هي الحال مع الشعراء عبدالوهاب البياتي وعز الدين المناصرة ومحمد القيسي. فهؤلاء جميعًا اقتُلِعُوا من أوطانهم بعد طفولة منقوصة، وخبروا المنافي بكل وحشتها وبعدها الفيزيائي عن الوطن. والملحوظة التي لا تكاد تذكر من قبل الشعراء أنفسهم، هي أنهم أُجبِروا على مغادرة الوطن؛ ليقاسوا حياة لا تقلّ قساوةً عن الاحتلال الأجنبي حينًا، والاحتلال المحليّ حينًا آخر.

علي العامري
فالشعر ليس مرغوبًا من جانب السلطة الحاكمة؛ لأنه يستثير المشاعر الإنسانية في مواجهة الاحتلالات المختلفة والدكتاتوريات المشابهة. وهو ما جعل الاحتلال الإسرائيلي يسجن العديد من الشعراء كمحمود درويش ويطرد آخرين. وهو ما فعلته بعض السلطات العربية الحاكمة في كثير من أقطارها. وعلى الرغم من الحريات التي تمتع بها بعض المنفيين من الشعراء، فإن الحرية تظل هنا منقوصة، تمامًا كما يكون الوطن حاضرًا ولكن بلا حرية؛ إنهما توأمان من الصعب الفصل بينهما أو التمييز أو التوكؤ على أحدهما؛ لأن الاختلال مصير حتمي.
ترتبط الطفولة ارتباطًا وثيقًا بالتملك، وهو الأمر الذي لم يشر إليه الشعراء. فحين كان البياتي يلعب على ضفاف دجلة، ويلقي بالزوارق الورقية في الماء، كان يشعر في أعماقه أن النهر والضفاف والزوارق الورقية له، وما يعزز هذا الشعور هو قدرته وتمكنه من ممارسة الفعل نفسه وقتما شاء، ومن دون قمع فوقي. وعليه يكون المنفى محتفظًا في داخله بملكيات كبيرة تخصه تمامًا. فدجلة في المنفى لا يعود مجرد نهر في بغداد، بل ملكية خاصة فقدها البياتي. والحال تنطبق على المناصرة الذي فقد عنب الخليل خاصته، حيث كان الصغير يدخل أي كرم ويتناول أي عنقود من دون حواجز، وعليه يصبح في المنفى فاقدًا ملكًا شخصيًّا كالطفل الذي فقد ألعابه، أو شاهد من يمزقها واحتفظ بالمشهد حتى آخر عمره.
تظل في الحوارات شاعرتان على الحدود العربية والغربية جغرافيًّا وثقافيًّا. فمالطا جغرافيًّا تنتمي إلى الشواطئ العربية؛ أقصد الحدود الثقافية واللغوية. ومن المعروف أن مالطا جاءها العرب من صقلية، وجاؤوا معهم باللغة العربية والعادات والتراث كالغناء والرقص. ثم جاء البريطانيون وجعلوا اللغة الإنجليزية هي الرسمية. ثم استقلت مالطا، والتحقت بعد عشر سنوات بالاتحاد الأوربي.
وجدت الشاعرة ماريا غريك غانادو نفسها أمام ثلاث لغات أساسية، هي العربية والإنجليزية والإيطالية، من دون أن ننسى بقايا اللغة المالطية المحلية التي كانت سائرة إلى الانقراض. وبمقدار ما قد يشكل هذا التنوع ثراء ثقافيًّا، فإنه يقلص من خصوصية الجزيرة وأرخبيلها. فكل شخص في الكون يعتز بلغته ويعدّها جزءًا منه في مواجهة الآخر، وملمحًا من ملامح هويته، وهذا ما عانته الشاعرة المالطية ماريا غريك غانادو، التي تكتب بالإنجليزية، وتحكي المالطية العامية، وتعرف العربية والإيطالية. تضاف إلى هذا كله معاناتها من مرض «الاضطراب ثنائي القطب» المتعلق باختلال المزاج.
وهي تخبرنا أن الشعر ساعدها كثيرًا في مواجهة هذا المرض المزمن الذي يؤدي إلى اضطراب الشخصية وأعراض أخرى كالبارانويا والفصام. لقد أخذت مالطا تستقر تدريجيًّا، وربما ساعدها وجودها في الاتحاد الأوربي على ذلك، ولم يعد الشعر معيبًا للنساء المتزوجات مثلها كما كان من قبل، وأظنه إرثًا عربيًّا إلى حد كبير.
جرح المنفى
أما شاعرتنا الثانية المولودة والمقيمة على الحدود ثقافيًّا وجغرافيًّا، فلها جذور تمتد عبر الأرض البعيدة والمتعاكسة. لقد ولدت في هاييتي، وتحديدًا في جزيرة «هيسبانيالو» الجبلية في أرخبيل الأنتيل، التي تجمع على أرضها توأمين بلغتين مختلفتين، هما هاييتي والدومينيكان. نشأت بين الحدود، وتشكلت سيرتها في الأرخبيل الكاريبي وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والوطن العربي وعموم آسيا والشرق. وعلى الرغم من أنها لم تعرف فلسطين طفلة أو شابة، فإنها لا تنسى أن أجدادها هجروا بيت لحم الفلسطينية في عشرينيات القرن الماضي، وهي تعرف وتتابع مآسي شعبها، وتعدّ نفسها شخصًا منفيًّا تسبب له المنفى في جرح لا يتوقف عن النزف. تكتب بالإنجليزية، وقد اختيرت إحدى قصائدها ضمن مشروع الشعر المتحرك، حيث تعلق بعض القصائد في عربات المترو، ويقرؤها يوميًّا قرابة سبعين مليون شخص. تقول نتالي: إنها كانت تضطر للمزج بين أكثر من لغة للتعبير عن نفسها، وتظل شاخصة إلى أرض آبائها فلسطين، حيث ذهبت إلى بيت لحم والقدس، وشعرت بالرباط القوي الخفي الذي لا يزال قائمًا بينها وبين تلك الثقافة والهوية.
أخيرًا كنت أود لو نشر الشاعر علي العامري مؤلف الكتاب قصائد ولو قليلة لهاتين الشاعرتين، حتى يتمكن القارئ من الاطلاع على معاناتهما شعريًّا، ومدى تأثير الولادة والإقامة في الحدود وعليها. لكنه في النهاية كتاب ثريّ بكثير من المواقف والآراء، وقد اضطررنا إلى القفز على بعضها بسبب المساحة، خصوصًا ما يتعلق بنقد الشعر وقصيدة النثر التي لا اختلاف كبيرًا يُذكر حولها، باستثناء التسمية عند الشاعرين محمد القيسي وعز الدين المناصرة اللذين يُعَدّان من شعراء قصيدة النثر، رغم ارتباطهما الوثيق بقصيدة التفعيلة وبالغنائية الشعرية.