
بواسطة حاوره: أحمد فرحات - شاعر وكاتب لبناني | سبتمبر 1, 2023 | حوار
يكتسب هذا الحوار أهميته من أهمية المُتحاوَر معه، ومكانته في الثقافة العربية/ الإسلامية في الهند اليوم، وكذلك من نشاطه في مضمار خدمة اللغة العربية وتراثها في الهند وعموم شبه القارة الهندية. إنه البروفيسور مجيب الرحمن، الرئيس السابق لـ«مركز الدراسات العربية والإفريقية» في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، وأستاذ الأدب واللغة العربية في الجامعة نفسها حاليًّا. والرجل صاحب مؤلفات وترجمات وأبحاث كثيرة تدور في فضاء لغة الضاد وتعزيزها في بلاده، وفي عموم أرجاء الوطن العربي. ولقد أنجز في السنوات الماضية ترجمات مهمة لبعض روائع الأدب الهندي باللغتين الأردو والهندية إلى العربية، منها رواية «نهر النار» لكاتبتها قرة العين حيدر، ورواية «الوشاح المدنس» للكاتب الشهير فانيشوار ناث رينو. كما نقل كتبًا فكرية ونقدية عدة منها: «مواطن الحداثة» لديبيش شاركرابورتي، و«فكرة الهند» لسونيل خيلناني«، و«السير في الطريق السريع» لرام بوكساني… إلخ.
ويعمل حاليًّا على ترجمة بعض الروايات العربية إلى اللغة الأردية، منها رواية «ديوان الإسبرطي» للجزائري عبدالوهاب عيساوي، ورواية «حانة الست» للمصري محمد بركة، ورواية «رقصة الجديلة والنهر» للمصرية وفاء عبدالرازق… في هذا الحوار معه، تحدث البروفيسور مجيب الرحمن عن أزمة تعلم اللغة العربية وتعليمها في الهند، وعن تقصير أهلها في الوطن العربي، وداخل الهند، وبخاصة أن العربية «كانت في أوائل القرون الوسطى لغة الكلام والكتابة لجميع المسلمين المثقفين على اختلاف قومياتهم، من الهند إلى المحيط الأطلسي»، بحسب المستشرق الإنجليزي الكبير رينولد نيكلسون (1868 – 1945م).
كما تحدث البروفيسور مجيب الرحمن عن أن هناك أكثر من 55 ألف مخطوطة عربية في الهند لم تُحقق وتنشر حتى الآن، وهذا شأن علمي وحضاري عربي وهندي وإنساني غير مقبول أن يظل هكذا محجوبًا عنه أو طي الإهمال والنسيان.
إلى نص الحوار:
● لنتحدث عن أحوال اللغة العربية في الهند اليوم، خصوصًا جهة دوافع الإقبال على تعلمها من الأجيال الهندية الجديدة؟ وإلى أي حد تخطى تعلمها تقاليد اندراجه في إطار التعليم الديني الإسلامي أو بدفع منه، ليصير على خط تعلم اللغات الأجنبية الأساسية لذاتها في البلاد؟
■ لا يزال الإقبال على تعلم العربية في الهند مرتبطًا بالتراث الثقافي الغني لهذه اللغة في البلاد من جهة، وبدفعٍ من الاعتبارات الدينية الإسلامية الراسخة من جهة أخرى. فالهند تزخر بعدد هائل من مؤسسات التعليم الديني التي يُطلق عليها اسم «المدارس»؛ وقد تجاوز عددها الثلاثين ألف مدرسة، اختار بعضها لنفسه اسم «الجامعة»، على غرار «جامعة دار العلوم بديوبند»، وهي أكبر مؤسسة للتعليم الديني في الهند؛ إذ تحتضن أكثر من خمسة آلاف طالب، و«الجامعة السلفية في بنارس»، و«جامعة الفلاح» في مدينة «أعظم جراه»، وغيرها. وتهتم جميعها بتعليم لغة الضاد لأبناء المسلمين الهنود، ذكورًا وإناثًا، وذلك على الرغم من افتقارها إلى المناهج الحديثة الخاصة بتعليم اللغات. جاء في تقرير «لجنة ساشار» التي عينتها الحكومة الهندية لدراسة أوضاع المسلمين عمومًا في البلاد، والصادر في عام 2006م، أن 4% من أبناء المسلمين، والبالغ عددهم في الهند نحو 200 مليون نسمة، يتلقون العلم في المدارس الدينية، ويتخرجون فيها بشهادات عليا معترف بها أكاديميًّا ورسميًّا، مثل شهادة «العالمية» وشهادة «الفضيلة»، وبعد التخرج يشتغل الطلبة، إما معلمين في الكتاتيب والمدارس، أو أئمة في المساجد، وبعضهم الآخر ينتقل إلى دول الخليج العربي للعمل في التجارة أو في وظائف شتى متاحة.
وثمة خريجون من المدارس الدينية إياها، يتجهون إلى الجامعات الحكومية الهندية للتخصص في اللغة العربية والأدب العربي، وكذلك في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.. وبالعكس، ويحصلون فيها على شهادات تتدرج من البكالوريوس إلى الماجستير فالدكتوراه. ويقدر عدد الجامعات الحكومية التي توفر تعليمًا منتظمًا ومستديمًا للغة العربية في الهند، نحو أربعين جامعة. وباستثناء جامعة جواهر لال نهرو في نيو دلهي، التي تحتضن قسمًا كبيرًا للغة العربية فيها تحت اسم «مركز الدراسات العربية والإفريقية»، ليس ثمة جامعات هندية أخرى يسير تعليم لغة الضاد فيها وفق خط موازٍ لتعليم لغات أجنبية عدة كالفرنسية والألمانية والصينية والروسية واليابانية والإسبانية وغيرها.
من جهة أخرى، توفر بعض الجامعات في الهند دورات مسائية قصيرة للمهنيين الراغبين في تعلم العربية، وذلك لأغراض العمل المتصلة بالمهن التي اختاروها، تمامًا كما نجد في قسم اللغة العربية في «الجامعة الملية الإسلامية».. وهي في المناسبة جامعة عريقة تأسست قبل استقلال الهند في عام 1920م، وشاركت في تأسيسها شخصيات فكرية وسياسية هندية كبيرة من طراز: أبو الكلام آزاد وذاكر حسين ومحمد علي جوهر وغيرهم.
باختصار، لا يسير تعليم اللغة العربية في الجامعات الحكومية الهندية وفق الخط السائد لتعليم اللغات الأجنبية الأخرى في البلاد.
عوائق تعليم اللغة العربية
● ما الذي يحول دون تعزيز وتطوير أساليب تعليم لغة الضاد في الهند اليوم؟ وعلى من تقع المسؤولية الجوهرية في ذلك، سواء داخل الهند نفسها أم خارجها؟
■ ثمة عوامل عدة، داخلية وخارجية، تحول دون تعزيز وتطوير أساليب تعليم اللغة العربية في الهند، أهمها أن مناهج التعليم في معظم المدارس الدينية قد عفا عليها الزمن، ولم تخضع بالتالي للتعديلات اللازمة التي من شأنها أن تتواءم وتطورات بيداغوجيا التعليم الحديثة؛ فاللغة بوصفها وسيلة تعبير وتواصل مع الآخرين، يجب تعلمها وتعليمها لتفي بهذا الغرض وتؤهل حاملها ليكون مرنًا، ومواكبًا لتحولات الزمن والاجتماع ومتغيرات العلم والثقافة، من دون المس طبعًا بالهوية الدينية ورسالتها ومعانيها. وهذا ما تفتقده مدارسنا الدينية (ما خلا استثناءات قليلة منها) التي تنظر إلى لغة الضاد بوصفها حاضنة للعلوم الإسلامية فقط، بمعزل عن اعتمادها لغة تعبير وتواصل مع الآخر، نطقًا وكتابةً. ثم إن أغلبية مؤسسات التعليم الديني في الهند تفتقر إلى الوسائل العلمية والتقنية المساعدة لعملية التعليم المتحركة ذاتها. وعليه يجب تزويدها بالمساعدات المادية المطلوبة لتحل مشكلاتها على هذا الصعيد.
أما الجامعات والمعاهد الحكومية، فيتمثل ضعف تعليم العربية فيها بوجوه عدة، من أهمها أن مدرسي اللغة العربية خاصتها، لا يحصلون على فرص التدريب أو التأهيل المهني كالتي هي في معاهد تعليم العربية لغير الناطقين بها، فتبقى مهاراتهم اللغوية ضعيفة ومتراجعة. ثم إن الأغلبية الساحقة من أساتذة اللغة العربية الهنود، لم يسبق لهم، مع الأسف، أن زاروا بلدًا عربيًّا واحدًا في حياتهم، عكس المعلمين الهنود للغات الأجنبية كالفرنسية والألمانية والصينية… إلخ، الذين يحصلون على دعوات دورية من البلدان الأجنبية التي يدرسون لغاتها في بلادهم، فيقضون هناك أوقاتًا معينة يزورون خلالها الجامعات والمدارس، ويقفون على أحوال التعليم المتطور فيهما. كما ينخرطون بين الناس في الأسواق العامة والمطاعم والمقاهي والمتاجر وخلاف ذلك، فيتحدثون إليهم بلغاتهم، ويعيشون تقاليدهم وثقافاتهم على أرض الواقع، فيكتسبون بذلك معارف جديدة تؤهلهم لتطوير مهاراتهم، وإغناء فنيات التدريس لديهم، بحيث ينعكس ذلك إيجابًا على الطلاب ومجمل العملية التربوية، بهذه الكيفية أو تلك.
والأمر المؤسف الذي يجب التنبيه إليه، وبالتالي السعي لسد ثغرته، يتعلق بمعضلة المنح الدراسية، التي هي غائبة بالكامل عن الذين يدرسون لغة الضاد في الجامعات والمعاهد الهندية، والتقصير هنا يشمل مسؤولية الجهات المعنية بالشأن التربوي داخل الهند نفسها، وخارجها أيضًا، وبالتحديد في الدول العربية الغنية والقادرة. يُضاف إلى ذلك، قلة الاهتمام بإبرام اتفاقيات تعاون ثقافي بين الجامعات الهندية من جهة، ونظيراتها العربية من جهة أخرى. حتى لو حدث أن جرى اتفاق ما بين طرفين أكاديميين معنيين هنا، فإن التقاعس عن التنفيذ يكون سيد الموقف من الجانبين. وفي كثير من الأحيان -وأنا هنا أتكلم على الجانب الهندي- يكون ضعف المستوى اللغوي العربي لدى الطالب الهندي، ليس عائدًا إليه، بقدر ما هو عائد إلى رداءة مستوى التعليم المدرسي والجامعي الذي يتلقاه في بلده. وهذه حقيقة قائمة في معظم الجامعات التي تقع في الولايات الهندية النائية، باستثناء ولاية كيرالا التي تتمتع بروابط ممتازة مع دول الخليج العربي، وتفتخر بما لديها من جسور ثقافة عربية تاريخية وعريقة.
مهما يكن من أمر، وعلى الرغم من التحديات الجسام التي يواجهها واقع تعليم اللغة العربية في الهند، فإنه يمكننا القول بفخر، ودونما أي ارتباك: إن مستوى تعليم اللغة العربية في الهند، لا يزال أرفع من غيره في بلدان إسلامية عديدة تقع في جنوب شرق آسيا، وشرق آسيا، مثل: باكستان وبنغلاديش وإندونيسيا. ولعمري إن مرد ذلك عائد إلى تلكم التقاليد الأصيلة والمتناوبة في تعليم اللغة العربية في الهند (على الرغم من نقدنا لها) التي ما زالت المدارس الدينية الإسلامية تحافظ عليها، وتضحي في سبيلها بكل ما أوتيت من طاقات. هكذا فهي هنا بمنزلة حصن حصين للثقافة العربية والإسلامية في الهند.
المجمع العلمي العربي- الهندي
● ماذا عن الجمعيات والهيئات التي تضطلع بأحوال اللغة العربية في الهند، وخصوصًا المجامع اللغوية منها، كالمجمع العلمي العربي- الهندي الذي أسسه مختار الدين أحمد، رئيس قسم اللغة العربية في جامعة عليكره في عام 1976م. هل تقوم هذه المجامع بأدوارها العلمية كما ينبغي؟ أم إنها نهضت نتيجة لطفرة حماسية معينة ثم تراجعت ظاهرتها وخبت؟
■ للأسف الشديد فإن المجمع العربي- الهندي الذي كان معقدًا للآمال في بداية عهده، لم يستطع أن يواصل مسيرته على الدرب الذي أراده له مؤسسه، بل إن قسم اللغة العربية في جامعة عليكرة الإسلامية العريق، الذي كان يضم كوكبة من كبار علماء اللغة العربية في الهند سابقًا، مثل العلامة عبدالعزيز الميمني ومختار الدين آرزو وغيرهما، قد بات باهتًا وأثرًا من الماضي. نعم، لقد تراجعت فعالية المجمع حتى درجة الصفر، لكن كلنا أمل الآن، من أن زميلنا الفاضل البروفيسور محمد ثناء الله الندوي سيعمل على تنشيط المجمع من جديد، ويعيده إلى مجده السابق، خصوصًا بعدما تولى ريادة الأمور فيه مؤخرًا، فللرجل روابط وعلاقات واسعة مع المثقفين في العالم العربي، وهو حيوي ونشط جدًّا.. يكفي أنه يوصف، وعن جدارة، بأنه علامة الهند الشاب في العصر الحاضر.
من جانب آخر، تراجع أيضًا دور المؤسسات الأخرى المعنية بتعزيز الثقافة العربية في الهند، سواء على صعيد التأليف أم الترجمة أم التحقيق، مثل مؤسسة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد (1882م) التي قدمت إسهامات بارزة في تحقيق التراث ونشره، وهذا التراجع يعود إلى التدهور الشامل في وضع المسلمين في الهند، وتقلص الدعم المالي لمؤسساتهم. إذن، الجمعيات والهيئات التي اضطلعت في الماضي بأحوال اللغة العربية، تراجعت أنشطتها اليوم وخبت بسبب الترهل الذي أصاب جسد الأمة الإسلامية في عموم بلاد الهند.

اللغات واشتراطات سوق العمل
● من الذي يناصب اللغة العربية العداء في الهند؟ وما الهدف من سياساته المناوئة تلك على المديين القريب والبعيد؟ وهل للعربية من يحميها في ذلك البلد الكبير والمهم في آسيا؟
■ ليس ثمة من يناصب اللغة العربية العداء في الهند، فالحكومة تقدم دعمها للغة الضاد، كما تقدمه للغات الأجنبية المركزية الأخرى. إننا نعيش الآن عصرًا يتوقف فيه تقدم كل شيء أو تأخره على مدى أفضليته في سوق العمل. ولذلك فليست اللغة كنظام معرفي متكامل، هي وحدها التي تمر بوضع صعب، وإنما معها كذلك الدراسات الإنسانية والاجتماعية واللغوية والأدبية التي قد لا تكون لها صلة مباشرة بسوق العمل؛ فهي أيضًا تواجه أزمة وجودية بفعل ضغوطات واشتراطات الرأسمالية الجديدة، وتخلي الدولة بالتدريج عن مسؤولياتها وواجباتها، وترك قطاع التعليم تحت رحمة الرأسمال الجديد. وهذا ما يحدث فعليًّا، حتى في الدول الأوربية، ومنها إنجلترا مثلًا.
إذًا، يتعين على القائمين على تعليم العربية في الهند من أساتذة وخبراء تربية أن يبذلوا جهودًا أكبر مما سبق، خصوصًا جهة الاعتماد على المناهج المعاصرة والتقنيات الحديثة أو المستجدة في تعليم اللغة العربية. هناك عشاق بالملايين للغة الضاد في الهند. وأنا قلت مرة في ندوة أقيمت العام الماضي احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية: «العربية تجري في دمائنا وعروقنا، حبنا لها أصيل وضارب في جذور ثقافتنا العريقة. العربية هويتنا وإن كنا عجمًا، ونحن من سيحمي العربية ويصونها ويرفع من شأنها على الدوام في بلادنا».
● قمتم بتأليف كتيب خاص بتعليم اللغة العربية للمبتدئين، وذلك بالتعاون مع جامعة أنديرا غاندي المفتوحة في نيودلهي.. كيف تقيم تجربة مثل هذا الكتيب واستلهامه على أرض واقع التعليم في الهند، وهل أتت هذه التجربة أُكُلها يا ترى، وبخاصة أنها دخلت دائرة تعليم العربية عن بعد؟
■ كانت هذه تجربة رائعة وفريدة فعلًا. لقد قطع القسم العربي في جامعة أنديرا غاندي المفتوحة شوطًا لا بأس به في تعليم العربية عن بعد، وحققت «دورة الدبلوم في العربية عن بعد» نجاحًا كبيرًا، وهو الأمر الذي جعل الجامعة تطلق مؤخرًا «دورة الماجستير عن بعد». وتفيد المعلومات أن أكثر من ألف طالب سجلوا في هذه الدورة، وقد يرتفع العدد إلى أضعافه لاحقًا. ويشرف على القسم العربي في جامعة أنديرا غاندي الدكتور محمد سليم، وهو أكاديمي شاب نابه جدًّا ومتحمس جدًّا، وإليه يعود الفضل في تنشيط هذا القسم العربي في الجامعة المذكورة وتعميم نفعه.
55 ألف مخطوطة عربية
● تحدثتم أكثر من مرة عن أن هناك تراثًا علميًّا وثقافيًّا عربيًّا في الهند غير مُظهرٍ حتى الآن. أشرتم مثلًا إلى أنه لا تزال هناك نحو خمسين ألف مخطوطة عربية تنتظر التحقيق العلمي فيها، ثم نشرها. حدثْنا عن هذا الأمر؟ وهل أنتم متفائلون بأن هذا الكنز المعرفي سيعرف طريقه إلى النور قريبًا خدمة للثقافتين الهندية والعربية على السواء؟
■ نعم، ثمة كنز ثقافي وعلمي عربي غير مُظهر حتى الآن، ونقصد هنا تلكم المخطوطات العربية المنتشرة في مختلف المكتبات والمتاحف الهندية، ويقدر عددها بنحو خمسة وخمسين ألف مخطوطة عربية، مثل مكتبة دائرة المعارف العثمانية في حيدرآباد، التي حقّقت ونشرت عددًا كبيرًا من المخطوطات المهمة. والمكتبة السعيدية في حيدرآباد أيضًا، وتحتوي بدورها على مجموعة مخطوطات نادرة يعود تاريخ بعضها إلى القرن الأول الهجري، وعلى رأسها مخطوط «تاريخ دمشق» لابن عساكر، و«التبيان لتفسير القرآن» لأبي جعفر الطوسي، و«تحفة الغريب» للدماميني.
ومن جهته، يحتوي «متحف سالار جونغ» في حيدر آباد على بعض أنفَسِ المخطوطات العربية (2620 مخطوطة)، وكذلك مكتبة «خدا بخش» الشرقية العامة في مدينة بتنه (أقل بقليل من 9000 مخطوطة عربية) ومكتبات جامعات دلهي، وتتصدرها مكتبة الجامعة الملية الإسلامية، ومكتبة جامعة «همدرد»، ومكتبة «مولانا أزاد» في جامعة عليكرة الإسلامية، ومكتبة دار العلوم في ديوبند، ومكتبة «دار العلوم» لندوة العلماء في لكهنؤ، ومكتبة «الجمعية الآسيوية في كلكتا» التي أسسها الإنجليز. والحقيقة أن الجزء الأكبر من هذه المخطوطات العربية ما زال ينتظر الفهرسة والتحقيق العلمي، ثم النشر. وعليه، فإن الواجب العلمي والديني يملي على العرب والمسلمين الاهتمام بهذه الثروة المعرفية القيمة، كيف لا وهي نتاج عقول آبائنا وأجدادنا عندما كانوا يمتلكون زمام أمور العلم والحضارة؟
العلاقات الثقافية الهندية العربية
● ثمة كتب مهمة وتاريخية اضطلع بها مؤلفون هنود مرموقون، تناولوا خلالها علاقات الهند ببلاد العرب، مثل كتاب «العلاقات العربية- الهندية» للعالم سيد سليمان الندوي، وكتاب «الصلات ببن الهند والبلاد العربية» لمحمد إسماعيل الندوي، وكتاب «الأصول الهندية للتراث العربي- الإسلامي العلمي والأدبي» للبروفيسور عبدالعلي.. وغيرها من كتب ثقافية وحضارية مماثلة.. كيف تقيم شخصيًّا مثل هذه الكتب؟ وأي صدى لها كان داخل بلاد الهند نفسها وعلى المستوى العربي؟
■ نعم، تُعد هذه الكتب التي ذكرتها من المراجع الأولى والمهمة جدًّا لدراسة العلاقات التاريخية والحضارية بين الهند والعالم العربي. وثمة دراسات أخرى مـتخصصة ظهرت في بعض الجامعات الهندية، كجامعة جواهر لال نهرو، والجامعة الملية الإسلامية، مركّزة، هذه المرة، على دراسة العلاقات الاقتصادية والتجارية والإستراتيجية بين الجانبين، نظرًا لعمقها التبادلي بينهما وتراكم هذا العمق بحكم الدوافع الاقتصادية نفسها، وكون منطقة الخليج العربي تحتضن أكثر من ثمانية ملايين هندي يعملون هناك؛ وبحكم أيضًا أن المنطقة تشكل مصدرًا أساسيًّا للنفط والطاقة بالنسبة إلى الهند. وقد سعى كل من الجانبين، وتبعًا لذلك، إلى رفع مستوى العلاقات بينهما إلى درجة الشراكة الإستراتيجية، تمامًا كما هو حاصل الآن بين الإمارات والسعودية من جهة، والهند من جهة أخرى مقابلة.
● وماذا عن الكتب أو المؤلفات الهندية الجديدة ذات الصلة بالعالم العربي اليوم؟ هل هي موجودة أصلًا أم انتفت ظاهرتها إلى غير ما رجعة؟
■ كما سبق وذكرت لك، هناك أقسام مختصة في بعض الجامعات الهندية لدراسات غرب آسيا، وهي جامعة جواهر لال نهرو في دلهي، والجامعة الملية الإسلامية، وجامعة عليكرة وغيرها. واهتم الباحثون فيها بدراسة جوانب متعددة من العلاقات بين الهند والعالم العربي، ولا سيما منطقة الخليج وامتدادًا إلى مصر ووادي النيل هذه المرة. ومن العلماء البارزين الذين قدموا كتبًا مميزة في هذا الميدان، البروفيسور آفتاب كمال باشا؛ فقد ألف أكثر من عشرين كتابًا من بينها: «مصر في عالم متغير»، و«الهند وغرب آسيا»، و«الهند وعمان»، و«الخليج المعاصر»، و«المشاركة السياسية في دول الخليج العربي». وهناك أيضًا الكاتب تلميذ أحمد، وله مؤلفات عديدة قي الفضاء نفسه، منها: «الإصلاح في العالم العربي» (2005م)، و«التحدي الإسلامي في غرب آسيا» (2010م)، و«غرب آسيا في خضم الحرب» (2021م) وغيرها.
ولا بد من الإشارة إلى الكاتب بنسي دهار برادهان، وله دراسات مهمة عن القضية الفلسطينية من أهمها: «الدبلوماسية المكوكية والقضية الفلسطينية»، و«الديناميات المتغيرة لسياسة الهند نحو غرب آسيا» وغيرهما. ومن الكُتاب أيضًا الأستاذ أم. أتش. إلياس، المختص بالشؤون الثقافية في دول الخليج العربي، وصاحب عدد لا بأس به من المؤلفات في الموضوع. وهناك أيضًا أنيس الرحمن، المختص بدراسات الهجرة والدياسبورة الهندية في بلدان الخليج، وله خمسة مؤلفات، وما يزيد على 50 دراسة مستفيضة في موضوع تخصصه، وكتابه: «هجرة العمال الهنود إلى الخليج: تحليل اجتماعي واقتصادي» يُعَدّ من المراجع الأولية والأساسية في دراسات الدياسبورة الهندية في الخليج العربي.
ولا بد أن نشير إلى الكاتب محمد أزهر من جامعة عليكرة الإسلامية، المختص بشؤون الطاقة والمالية العامة والعلاقات الاقتصادية بين الهند وغرب آسيا، وكتابه المعنون بـ«اقتصادات الخليج المعاصرة والعلاقات بين الهند والخليج» يُعَدّ مرجعًا مهمًّا لدراسة العلاقات الاقتصادية المعاصرة بين الجانبين العربي والهندي. إذًا، فالمؤلفات الهندية الجديدة حول العالم العربي توالت وتتوالى باستمرار، وخصوصًا منها تلك التي تصدر باللغة الإنجليزية عن الجامعات الهندية الآنف ذكرها.

من العربية إلى الهندية.. والعكس
● هل هناك أدب هندي معاصر أو حديث باللغة العربية اليوم؟ وهل من يشجع على مثل هذه الظاهرة أو الحراك الإبداعي؟
■ إن كنتم تقصدون بالأدب الهندي المعاصر باللغة العربية الأجناسَ الأدبيةَ الحديثةَ كالقصة والرواية والمسرحية والشعر الحديث، فلأكن صريحًا معك، هذه الأجناس الأدبية مفتقدة في المشهد الأدبي الهندي عمومًا، وقد يكون سبب ذلك أن الإبداع يقتضي من المبدع أن يمتلك مقدرة لغوية طبيعية كمثل الناطق الأصلي بها. أما التأليف العلمي، فذاك شأن آخر، وإن لم ينتبه إليه كثيرًا علماؤنا. وعلى أي حال، فلقد بدأ المشهد يتغير رويدًا.. رويدًا منذ أن نشر الكاتب الشاب حامد رضا روايته «أحلام ضائعة» في القاهرة العام الماضي، وأقبل عدد من الكتاب الشباب على كتابة القصص القصيرة، ونشروا مجموعات قصصية في القاهرة، وفاز بعضهم بجوائز في مسابقات أدبية حول القصة القصيرة أقيمت في السنوات الأخيرة في العالم العربي.
على مستوى آخر، كانت مجلة «قطوف الهند» الإلكترونية الفصلية المُحكمة (التي أترأس إدارة تحريرها) قد أجرت في العام الماضي مسابقة حول القصة القصيرة لطلبة الجامعات الهندية بمناسبة الاحتفاء بـ«اليوم العالمي للغة العربية»، متلقية خمسين مشاركة للمنافسة، ونشرت القصص الفائزة في المسابقة في العدد الأخير من المجلة، وهي ظاهرة تبشر بالخير على مستوى الحراك الإبداعي المكتوب بالعربية في الهند. أما حضور الهند في الشعر العربي التقليدي، ولا سيما في موضوعات كالمديح النبوي والغزل، فلا بأس به، ولكنه لم ينل الاهتمام المطلوب من جانب أغلبية القُرّاء المعنيين بالكتابة الإبداعية الحديثة.
● وكيف تتجلى الكتابات الفكرية والأدبية والثقافية الهندية بالعربية في بلادكم الغنية بالطاقات والإبداعات على اختلافها؟
■ المؤلفات الهندية باللغة العربية تكاد تنحصر في موضوعات دينية إسلامية، كالتفسير، والحديث، والفقه، والتاريخ الإسلامي، والترجمة، والسيرة، وقليل جدًّا منها يتعلق بالأدب. وهنا لا بد من أن ننوه ببعض مؤلفات الشيخ أبي الحسن الندوي الذي ألّف مئات الكتب بلغة الضاد في موضوعات إسلامية وأدبية أيضًا، فكتبه: «إذا هبت ريح الإيمان»، و«الطريق إلى المدينة»، والقراءة الراشدة (للأطفال)، و«مختارات من أدب العرب»، يمكن أن نعدها كتبًا أدبية ذات نكهة إسلامية. وبعد وفاته في عام 1999م، لم يظهر كاتب هندي يداني قامته في مستوى التأليف باللغة العربية، وإن كان هناك من ألفوا كتبًا في موضوعات تتعلق بالثقافة الإسلامية في شتى المدارس الدينية وأساتذة الأقسام العربية في الجامعات الهندية.
من الشعراء الهنود المعاصرين تذكر أسماء كل من: الشيخ عبدالله السلمي، صاحب دواوين شعرية عدة، ومحمد ضياء الدين الفيضي، والشاعر الشاب صبغة الله الهدوي، والأستاذ عبدالله الأماني الفيضي، والشيخ أنور عبد الله الفضفري، وكلهم من ولاية كيرالا الهندية، وهم ينظمون قصائد رائعة باللغة العربية. وبخصوص الصحافة العربية العلمية في الهند، فهي مزدهرة جدًّا، وتعكسها عشرات الدوريات والمجلات الصادرة عن كبرى المدارس الدينية، وأقسام اللغة العربية في الجامعات الهندية التي تنشر وبشكل دوري كثيرًا من البحوث العلمية.
الترجمة بين اللغتين الهندية والعربية
● المعروف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتضن أكبر جالية هندية من حيث العدد بين الجاليات الهندية المتوزعة بين سائر دول مجلس التعاون الخليجي.. والسؤال الآن: ألا يفترض أن يكون لهذا الأمر تأثيره الطاغي في أُولِي الأمر في الهند.. على الأقل لجهة عملهم على عدم السماح بالإضرار بمسيرة تعليم لغة الضاد في بلادهم، وتعزيز المثاقفة العربية- الهندية، ومنحها الأولوية على ما عداها من أولويات؟
■ ثمة علاقات وروابط راسخة تربط الهند بالعالم العربي؛ والحكومة الحالية برئاسة السيد ناريندرا مودي عزَّزت هذه العلاقات أكثر فأكثر، حتى ارتقت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وهناك استثمارات عربية خليجية بمليارات الدولارات في الهند.. والعكس صحيح أيضًا، ولكن طبيعة هذه العلاقات تجارية واقتصادية. أما حجم التبادل الثقافي بين الجانبين فضعيف جدًّا، مقارنة بحجم التبادل التجاري والاقتصادي؛ ولذلك من الأهمية بمكان تفعيل التبادل الثقافي بين الهند والعالم العربي من خلال ترجمة الآداب الهندية إلى اللغة العربية.. وبالعكس، وتبادل زيارات المفكرين والمثقفين والطلبة، واعتماد مشروعات علمية وثقافية مشتركة ونحو ذلك مما يصب في مجمله في مصلحة المثاقفة العربية- الهندية.
● لنتكلم أخيرًا عن ترجماتك فيما خص اللغة العربية وآدابها في الهند، وغيرها من الأمور ذات الصلة؟
■ أنجزتُ في السنوات المتوسطة الماضية ترجمات لبعض روائع الأدب الهندي باللغتين الأردو والهندي إلى اللغة العربية، منها رواية «نهر النار» (بالأردو) للروائية قرة العين حيدر (حائزة على أعلى جائزة أدبية في الهند عن روايتها «جيان بيت»)، ورواية «الوشاح المدنس» (عن الهندية) للكاتب الشهير فانيشوار ناث رينو؛ إضافة إلى ترجمات لبعض الكتب العلمية والسِّيَرية إلى العربية منها «مواطن الحداثة» لديبيش شاكرابارتي، و«فكرة الهند» لسونيل خيلناني، و«السير في الطريق السريع» لرام بوكساني. وترجمت بعض القصص الهندية إلى العربية لهيئة الكتاب الوطنية الهندية.
أما حاليًّا فأشتغل على نقل بعض الأعمال الروائية العربية إلى اللغة الأردية، مثل رواية «الديوان الإسبرطي» للجزائري عبدالوهاب عيساوي (جائزة البوكر العربية- 2020م)، ورواية «حانة الست» للمصري محمد بركة، و«رقصة الجديلة والنهر» للمصرية وفاء عبدالرزاق. كما أعكف أيضًا على تأليف كتاب حول فن الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.. وبالعكس، وكتاب خاص بالنظريات الأدبية والنقدية الحديثة (باللغة العربية) للطلبة الهنود. كما أشتغل على كتاب يتناول، وبالمقارنة، الموضوعات الاجتماعية في عالم الروايتين: العربية والأردية. وأعمل كذلك على إعداد كتاب حول الجذور الهندية لدراسات ما بعد الاستعمار.. وسيصدر بعض هذه الكتب قريبًا جدًّا إن شاء الله.

بواسطة حاوره: أحمد فرحات - شاعر وكاتب لبناني | نوفمبر 1, 2020 | حوار
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وفي سبيل تكريس نفسها قوة عظمى على الساحة الدولية، سعت روسيا في «إستراتيجيتها الأوراسية» المستمرة منذ سنوات، إلى استخدام كل ما لديها من عناصر قوة، ابتداءً من موقعها الإستراتيجي الذي يغطي جزءًا من أوربا وقسمًا كبيرًا من آسيا، وكذلك امتلاكها لثروات طائلة، وقوة عسكرية جبارة، ونفوذ سياسي متعاظم، وطاقات علمية كبيرة، وتراث حضاري، وحضور طاغٍ على الساحة السوفييتية السابقة، من أجل بناء هيكلية تكاملية أوراسية بمشاركة دول أخرى آسيوية من الدرجة الأولى.
وروسيا الأوراسية كما يفهمها أهلها، ليست مجرد دولة مترامية على قارتين، بل إنها في نظرهم عبارة عن ملتقى للدروس والعبر التاريخية، التي أسهمت في تذليل التناقضات وعدم الاستقرار والتي شهدتها هذه المنطقة عبر التاريخ، وتتجسد فيها (أي روسيا) إنجازات الشعوب والقوميات والإثنيات التي تقطن أرجاء المجال الأوراسي. وهذا ما يفسر ظهور النظرية الأوراسية في روسيا في أعمال مفكرين روس في القرنين الماضيين من أمثال سافيتسكي وتروبتسكوي وألكسييف وكراسافين وغيرهم.
هكذا، وانطلاقًا من إسهام روسيا في الحضارة العالمية، والأوراسية، عبر ألف عام من تطورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمعرفي، يمكن القول: إن قيام التكتل الاقتصادي والسياسي الأوراسي المستجدّ، لن يكون مجرد استجابة للتحديات العولمية الراهنة، بل هو في الدرجة الأولى امتداد لمسار تاريخي وحضاري عميق الجذور؛ فالأيديولوجية الأوراسية بالنسبة إلى روسيا، هي الفرصة الوحيدة للاستمرار والارتقاء إلى مصافّ الدول العظمى.
حول «العقيدة الأوراسية» في روسيا اليوم، وموقع «البوتينية» فيها، ودعم الكنيسة الأرثوذكسية لمنطلقاتها.. فضلًا عن حضور الثقافة الأنغلوساكسونية في بلاد بوشكين، ونظرة المثقفين الروس لمثقفينا العرب، كان لنا هذا الحوار مع الدكتور محمد دياب، المفكر والمتخصص اللبناني في الشؤون الإستراتيجية الروسية بمراياها المختلفة: السياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية.
وكان لا بد في الحوار مع الدكتور دياب أن يتطرق إلى تفجير بيروت الذي هز العالم كله، وأثار ردود أفعال دولية ساخطة.
والدكتور دياب أكاديمي سابق في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية. وله مؤلفات عدة من أبرزها: «نهاية العصر السعيد»، و«أزمة النموذج النيوليبرالي للرأسمالية»، و«التجارة الدولية في عصر العولمة»، ويُعِدّ هذه الأيام كتابًا هو الأول من نوعه على مستوى الثقافتين العربية والروسية، وسيحمل «كما أخبرنا» عنوان: «فلسطين في الثقافة الروسية». وسيهديه المؤلف إلى «إيرينا سميليا نسكايا» المؤرخة والمستعربة الروسية الكبيرة.
فيما يأتي تفاصيل الحوار:
● لنتحدث عن مفهومك للعقيدة الإستراتيجية الأوراسية لروسيا.. كيف تقرأ معادلاتها في الداخل الروسي وعلى مستوى الإقليم والعالم؟
■ قبل الحديث عن «العقيدة الإستراتيجية الأوراسية» لا بد من التوقف بإيجاز عند مفهومي «أوراسيا» و«الأوراسية». من المعروف أن علم الجيوبوليتيك، الذي أرسى أسسه الألماني فريدريك راتسيل وطوَّره الإنجليزي السير هيلفورد ماكيندر والأميركيان ألفريد ماهان ونيقولاس سبايكمان وآخرون، يفترض وجود كيانين أو قطبين جيوبوليتيكيين أساسيين، هما: قوى البَرّ (أوراسيا) وقوى البحر (الأطلسية). وثمة تناقض أساسي بين هذين القطبين، وهو تناقض لا يقوم على أساس طبقي، وإنما على أساس مفهوم «المدى» الجغراسي.
قطب البَر يتمثل فيما يسمى «قلب العالم»، الذي يمتد في رحاب القارة الآسيوية وبعض أوربا، على جزء كبير مما تمثله روسيا اليوم، وأجزاء أخرى من آسيا جنوبًا وشرقًا. وفي المقابل، فإن قوى البحر تقع في المناطق الساحلية، أو الطرفية التي تتمحور حول منطقة الأطلسي (كانت زعامتها تتمثل في الإمبراطورية البريطانية سابقًا، قبل أن ينتقل مركز الثقل إلى الولايات المتحدة اليوم). بين هذين القطبين الأساسيين يدور صراع يرتبط بالجوانب الحضارية والتكنولوجية والإستراتيجية والاقتصادية والثقافية. ويمسّ هذا الصراع حتمًا مسألة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة خاصة. وتقول صيغة ماكيندر الكلاسيكية: «إن من يسيطر على أوراسيا (قلب العالم) يسيطر على العالم». ويمكن السيطرة بطريقتين مختلفتين، وفقًا لتوازن القوى العام بين «قوى البَرّ» و«قوى البحر».
 تفترض الطريقة الأولى، أو ما يسمى الطريقة القارية، أن يسود الحافز الآتي من الداخل، من قلب القارة، سواء أكان إمبراطورية روسية أم كيانًا أوراسيًّا أشمل أم تحالفًا قاريًّا يشمل دولًا مركزية مثل: روسيا والصين والهند وإيران وغيرها، أو غير ذلك. فمهمة قطب البر تتمثل في توسيع نفوذه قدر الإمكان نحو المناطق التي تغطي القارة الأوراسية كلها والمناطق المحاذية لها وإقامة التكامل الإستراتيجي فيما بينها؛ ونحن نرى إرهاصات قيام مثل هذا التحالف أو التكامل اليوم.
تفترض الطريقة الأولى، أو ما يسمى الطريقة القارية، أن يسود الحافز الآتي من الداخل، من قلب القارة، سواء أكان إمبراطورية روسية أم كيانًا أوراسيًّا أشمل أم تحالفًا قاريًّا يشمل دولًا مركزية مثل: روسيا والصين والهند وإيران وغيرها، أو غير ذلك. فمهمة قطب البر تتمثل في توسيع نفوذه قدر الإمكان نحو المناطق التي تغطي القارة الأوراسية كلها والمناطق المحاذية لها وإقامة التكامل الإستراتيجي فيما بينها؛ ونحن نرى إرهاصات قيام مثل هذا التحالف أو التكامل اليوم.
أما النموذج الآخر للسيطرة على أوراسيا والمناطق المحاذية لها، وبالطبع على موارد الطاقة فيها، فهو نموذج السيطرة من الخارج، من جهة قوى البحر. هذا النموذج (الأطلسي) الرامي للهيمنة على المنطقة الإستراتيجية نفسها، يفترض السيطرة الخارجية على ما يسمى «المناطق الساحلية» التي تفصل «قلب العالم» عن البحار الدافئة. يرتبط هذا النموذج تاريخيًّا بالقوة الأنغلوساكسونية: الإمبراطورية البريطانية سابقًا، ثم الولايات المتحدة الأميركية التي انتقلت إليها تدريجًا زعامة القطب الأطلسي، التي تتحكم بمصاير العالم اليوم. ويقوم هذا النموذج على ربط «المناطق الساحلية» بمركز القوة الأطلسية، وبسط السيطرة عبر البحار والمحيطات بواسطة الأساطيل الحربية وحاملات الطائرات والشركات العابرة للقوميات والحدود، ونقل مصادر الطاقة عبر الناقلات العملاقة.
ما الذي تمثله «المناطق الساحلية» التي تمتد من المدى الأوربي، مرورًا بالشرق الأوسط، وصولًا إلى الشرق الأقصى والمحيط الهادئ؟ خلافًا لصيغة ماكيندر التي رأت أن أوراسيا هي «قلب العالم»، وأن من يسيطر عليها، فهو يسيطر على العالم، رأى عالم الجيوبوليتيك الأميركي سبايكمان أن «المناطق الساحلية» هي المفتاح للهيمنة على العالم، فيقول: «إن من يهيمن على المناطق الساحلية يهيمن على أوراسيا، ومن يهيمن على أوراسيا فإنه يتحكم في مصاير العالم».
استنادًا إلى ما تقدم يمكن مقاربة «العقيدة الإستراتيجية الأوراسية». وإذا فهمنا الإستراتيجية على أنها عبارة عن تنسيق وتوجيه كل موارد الدولة من أجل تحقيق أهدافها العليا، يمكن القول: إن القوة العسكرية هي إحدى الوسائل لإضعاف إرادة الخصم فقط، ومن ثَمّ التفوق عليه، ويجب أن تقترن بكل أنواع الضغوطات الاقتصادية والتجارية والمالية والسياسية والدبلوماسية، وإبرام التحالفات مع دول أخرى تتقاطع معها مصالحها. فنرى أن روسيا تسعى في إستراتيجيتها الأوراسية إلى استخدام كل ما لديها من عناصر قوة، ابتداءً من موقعها الإستراتيجي الذي يغطي جزءًا من أوربا وقسمًا كبيرًا من آسيا، وكذلك امتلاكها لثروات طائلة وقوة عسكرية جبارة ونفوذ سياسي ودبلوماسي، ولطاقة علمية كبيرة وتراث حضاري وحضور قوي على المساحة السوفييتية السابقة، من أجل بناء هيكلية تكاملية أوراسية بمشاركة دول أخرى، آسيوية بالدرجة الأولى.
وللعقيدة الإستراتيجية الأوراسية التي تسير على نهجها روسيا أبعاد ثلاثة: جيوسياسي، وأمني، واقتصادي. وهي اتجاهات متداخلة ومتشابكة. في البعد الجيوسياسي، تسعى روسيا إلى إعادة ترميم وتوطيد علاقاتها المتشعبة مع الجمهوريات السوفييتية السابقة واستعادتها إلى «الحضن» الروسي، مستفيدة من الروابط الشديدة والمتنوعة، اقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، التي ربطت هذه الجمهوريات بالمركز الروسي طيلة العصرين الإمبراطوري والسوفييتي، ومن خيبة أمل بعضها من نتائج توجهها نحو الغرب عقب تفكك الاتحاد السوفييتي، واقتناعها بأن الحضن الروسي أكثر «دفئًا» وفائدة.
وتذهب روسيا أبعد في توجهها الجيوسياسي، فتعمل على نسج علاقات وُدٍّ وتفاهم وتعاون مع دول مختلفة في القارة الآسيوية والشرقين الأوسط والأدنى (مع تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى وباكستان والهند…إلخ)، على الرغم من التناقضات، الحادة أحيانًا، وتضارب المصالح التي تشوب العلاقات بين بعضها بعضًا أحيانًا.
وفي البعد الأمني، تعمل روسيا على تعزيز قواها العسكرية ومواجهة التحديات الإستراتيجية التي يشكلها تقدم حلف الناتو شرقًا وصولًا إلى «باحتها الخلفية» في أوكرانيا وجورجيا والبحر الأسود (فكان إقدامها على ضمّ شبه جزيرة القرم وتدخلها الفاعل في منطقة الدونباس في شرق أوكرانيا بمنزلة خطوات جوابية ذات بعد إستراتيجي بهدف حماية أمنها القومي). وفي إطار البعد الأمني الإستراتيجي يندرج تدخلها المباشر في سوريا وغير المباشر في ليبيا ومناطق أخرى، وهي تضع ذلك ضمن مهمة مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، فهي ترى أن هناك يقع خط الدفاع الأول عن أمنها الإستراتيجي.
وعلى المستوى الاقتصادي، تعمل روسيا على بناء هياكل تكاملية أوراسية من ضمنها منظمة شانغهاي للتعاون الأوراسي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتعاون المكثّف مع اثنين من أعضاء مجموعة بريكس الآسيويين هما الصين والهند، والعمل المشترك مع الصين في إنجاز مشروع «حزام واحد طريق واحد»، الذي تسعى الصين من خلاله إلى إحياء تقاليد «طريق الحرير العظيم» في ظل أوضاع العالم المعاصر.
وتشهد هذه المنظمات والبنى التحالفية جهودًا لصوغ أهداف ومهمات وخطط سير ومؤسسات، ووضع آليات لتحقيق الاتفاقيات ولتعزيز مواقع الدول الأعضاء ولتعزيز نفوذها في العمليات السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. إن موقع روسيا في وسط القارة الأوراسية، وهي التي تَعُدّ نفسها صلة الوصل الجامعة بين حضارتي الغرب والشرق، حدَّد لها دور المؤسس والمحرك لعملية التكامل ضمن الاتحاد الأوراسي الإستراتيجي. فروسيا، كما يفهمها الأوراسيون الروس، ليست مجرد دولة على قارتين، بل إنها في نظرهم، عبارة عن ملتقى للدروس والعبر التاريخية التي أسهمت في تذليل التناقضات وعدم الاستقرار التي شهدتها هذه المنطقة عبر التاريخ، وتتجسد فيها (أي في روسيا) إنجازات الشعوب والقوميات والإثنيات التي تقطن أرجاء المجال الأوراسي. وهذا ما يفسر ظهور النظرية الأوراسية في روسيا في أعمال مفكرين روس في القرنين الماضيين من أمثال سافيتسكي وتروبتسكوي وألكسييف وكراسافين وغيرهم.
انطلاقًا من إسهام روسيا في الحضارة العالمية والأوراسية عبر ألف عام من تطورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمعرفي، يمكن القول: إن قيام التكتل الاقتصادي والسياسي الأوراسي لن يكون مجرد استجابة للتحديات العولمية الراهنة، بل هو بالدرجة الأولى امتداد لمسار تاريخي وحضاري عميق الجذور؛ فالأيديولوجية الأوراسية تمثل لروسيا الفرصة الوحيدة للاستمرار وللارتقاء إلى مصافّ الدولة العظمى.
● روسيا دولة تعددية بامتياز، ومع ذلك فالقومية الروسية، لغة وتاريخًا وهوية ثقافية، تطغى على ما عداها من قوميات في الدولة الواحدة. ما السبب يا ترى؟ وكيف تقرأ مستقبل روسيا مع تعددية كهذه؟
■ صحيح، روسيا دولة متعددة القوميات والإثنيات واللغات والأديان. فهي تضم عشرات الشعوب والأقليات القومية والإثنيات التي يتمتع معظمها بحكم ذاتي في إطار جمهوريات وكيانات شبه دولية. غير أنها تخضع كلها لسلطة مركزية قوية، تُعَدّ ضرورية للحفاظ على وحدة ولحمة هذه الدولة التعددية الكبيرة الشاسعة والمترامية الأطراف. كان هذا الوضع قائمًا في العصر الإمبراطوري ثم السوفييتي، ولا يزال قائمًا في العصر الراهن، ولا نعتقد أنه قد يتغيّر في المستقبل؛ لأن تغيره يعني زوال روسيا كدولة عظمى.
إن ما ميز التوسع الجغرافي للدولة الروسية، الذي بدأ منذ القرن السابع عشر هو أنه لم يكن توسعًا استعماريًّا بالمعنى التقليدي، على غرار الاستعمار الإنجليزي أو الفرنسي أو البرتغالي أو الإسباني وما رافقه من محاولات تدمير للمجتمعات الخاضعة ونزع لهويتها القومية والحضارية، بل كان توسعًا حضاريًّا «ناعمًا»، إذا جاز التعبير. فنقل الروس إلى المناطق والشعوب الأخرى التي استحوذوا عليها لغتهم وحضارتهم وإلى حدٍّ ما بعضَ عاداتهم، واندمجوا مع هذه الشعوب وتفاعلوا معها، ونهلوا من ثقافاتها حتى من لغاتها. فنجد في اللغة الروسية الكثير من الكلمات والمصطلحات والتعابير المأخوذة من لغات الشعوب التي تعايشوا معها. كما نرى ملامح هذه التأثيرات في كتابات الشعراء والكتاب الروس العظام من بوشكين إلى ميخائيل ليرمنتوف إلى ليو تولستوي وإيفان بونين وغيرهم.
ومن جهة أخرى، لعبت القومية الروسية واللغة الروسية دور العنصر الجامع لهذه القوميات والشعوب في بوتقة واحدة أنجبت ما يمكن تسميته «الحضارة الروسية الجامعة». لقد سعت السلطة المركزية في روسيا، في كل العصور، للحفاظ على هويات ولغات الشعوب والقوميات حتى الإثنيات الصغيرة المنضوية تحت جناحها، وحرصت على تعليم هذه اللغات إلزاميًّا لأبنائها إلى جانب اللغة الروسية، فلم تُفقد لغة واحدة من هذه اللغات. وقد أنجبت هذه الثقافة الروسية الجامعة أدباء ومفكرين وعلماء وفنانين كبارًا من أمثال جنكيز إيتماتوف ورسول حمزاتوف وآخرين كثر، كتبوا بلغاتهم الأم وباللغة الروسية، وفنانين كبار من أمثال مُسلم موغاموايف مغني روسيا الأكبر في القرن العشرين. كما أن سياسيين كبارًا تَبَوَّءُوا مناصب قيادية في الدولة، منهم ستالين نفسه (الجورجي)، وميكويان (الأرمني)، وخروشوف (الأوكراني)، وعلييف (الأذري) وغيرهم.
ما أود قوله: إن الهوية الروسية الجامعة لم تقضِ على الهويات القومية والإثنية، على الرغم من أن العنصر الروسي كان هو الجامع والموحّد للجميع تحت راية الحضارة الروسية الجامعة والمتعددة الهويات. لقد حافظت الحضارة الروسية على تعدديتها ضمن الوحدة.
فيلسوف العقيدة الأوراسية
● ألكسندر دوغين هو فيلسوف العقيدة الأوراسية ومنظرها المركزي، ومع ذلك يظهر الرئيس بوتين كأنه هو المبتعِث الإستراتيجي لها، ودائمًا من موقع أنها تشكّل بديلًا للاتحاد السوفييتي السابق ومحاولة لتجميع قواه المتشظيّة من جديد.. ما تعليقك؟
■ بالفعل، ألكسندر دوغين هو اليوم فيلسوف العقيدة الأوراسية، والممثل الأول للتيار الأوراسي الذي يرى أن المعضلة الرئيسة التي نجمت عنها التحديات الوجودية التي تواجهها روسيا اليوم، تتمثل في فقدانها الكثير من عناصر قوتها ومراكز نفوذها ومصالحها الحيوية وتكمن في تخليها عن دورها الطبيعي الذي رسمه لها موقعها الجيوسياسي المحوري على مساحة المجال الأوراسي الرابط بين آسيا وأوربا.
والجدير بالذكر أن دوغين ليس أول من تناول الفكرة الأوراسية وكتب عنها من المفكرين الروس. فقد سبقه إلى طرحها في عشرينيات القرن الماضي مفكرون روس كبار من أمثال: نيقولاي تروبتسكوي، وبيوتر سافيتسكي، وليف تموميليف، وكراسافين وغيرهم. وتتلخص الفكرة المركزية للاتجاه الأوراسي في الفكر السياسي الروسي في عدِّ روسيا قارة بذاتها، هي «أوراسيا» المترامية على أجزاء واسعة من أوربا وآسيا. ومن ثَمّ، فإن روسيا هي في آنٍ واحد دولة أوربية وآسيوية، يقع القسم الأكبر من أراضيها وثرواتها في آسيا، بل إن عمقها الإستراتيجي، والاقتصادي والعسكري، يمتدّ في رحاب هذه القارة. وهي لم تتحول دولة عظمى لها ثقلها ودورها الفاعل على الصعيد الدولي إلا بعدما نجحت في القرون الماضية في الخروج من قوقعتها في جزئها الأوربي، وتمددت جنوبًا نحو القوقاز كخطوة على طريق تحقيقها حلمها الدائم في الوصول إلى المياه الدافئة، وشرقًا عبر سيبيريا، وصولًا إلى الشرق الأقصى وشواطئ المحيط الهادئ. انطلاقًا من ذلك يرى دوغين أن على روسيا القيام بدورها الذي حدده لها موقعها الجغرافي وإمكاناتها وتاريخها. ويرى دوغين أن للشعب الروسي دورًا محوريًّا وقياديًّا في مجموعة الشعوب والقوميات التي تقطن روسيا. ونراه، في محاولته صوغ المبادئ الفلسفية للمشروع الأوراسي الذي يدعو إليه، يدمج الأوراسية بالروسية، بمعنى أن أوراسيا هي روسيا، وروسيا هي أوراسيا. ولذا اتهمه بعضٌ، سواء من المفكرين الليبراليين الروس أم من الغربيين، بالشوفينية القومية.
يمثل دوغين تيارًا روسيًّا مواجهًا للتيار ذي الهوى الغربي. ولكنه ليس الممثل الوحيد له، وهو في الواقع مفكر وكاتب غزير الإنتاج يسعى إلى طرح رؤيته لمستقبل روسيا ولدورها التاريخي المفترض القيام به، بيد أنه لا يشكل قوة سياسية ذات نفوذ ولا يضطلع بدور سياسي يُذكر في روسيا. وهو، إذ يرى في بوتين رجلًا وطنيًّا ومنقذًا لروسيا، حقق إنجازات كبيرة لا يمكن نكرانها تضعه في مصافّ رجالات روسيا العظام عبر التاريخ، إلا أنه في رأيه حقق أقصى ما يمكن تحقيقه، وصار عليه ترك الساحة لغيره كي يكمل المسيرة. فهو يقول: «الحاضر مِلك لبوتين، ولكن المستقبل ليس مِلك يديه»، بمعنى أنه حقق ما ينبغي تحقيقه في هذه المرحلة، وينبغي أن يأتي من يكمل المسيرة من بعده.
لقد كان بوتين رجل المرحلة الراهنة، ولكنه ليس رجل المرحلة المقبلة. هذا هو، باختصار، رأي دوغين في بوتين. وربما من المفيد هنا اقتباس ما قاله دوغين في معرض تقويمه وانتقاده لمقولة فلاديسلاف سوركوف حول ما وصفه ﺒ«البوتينية». كتب دوغين: «لقد قدم بوتين قسطًا هائلًا في تقدم روسيا، ولا يجوز التشكيك في إسهاماته في هذا المجال أو التقليل منها. إنه منقذ روسيا وبطلها. وأنا أرى أنه أنجز مهمته في هذا المجال. لقد حقق بوتين كل ما يمكن تحقيقه واستنفد نفسه بالكامل، ولم يعد في وسعه سوى الحفاظ على الوضع القائم. لذلك الآن، وبعدما أنجز مهمته، ينبغي السير قدمًا. وهذه الخطوة إلى الأمام لا يمكن لبوتين نفسه، ولا لأحد من فريقه بالطبع، القيام بها. لأن بوتين اعتاد على هذا الوضع. من هنا يمكن القول: إن بوتين يملك، بالطبع، الحاضر كاملًا، ولكن المستقبل ليس مِلك يديه. لا بد في المستقبل من إعادة النظر في كل عناصر النظام القائم».
 ويرى دوغين أن الوضع الراهن في روسيا سوف يتطور على نحو غير متوقع. فهو إما سيشهد تحسنًا وتطورات إيجابية جديدة، وإما ضِدّ ذلك قد يشهد تردّيًا ملحوظًا وحادًّا. ويقول: «سيبني المستقبل شخص آخر. لا نعرف من سيكون. قد يكون أفضل من بوتين بكثير، يمكن تعليق آمال مجتمعنا عليه. وقد يكون أسوأ بكثير؛ لأن بوتين لم يتمكن من إنجاز بعض الأمور بصورة نهائية؛ لذلك قد نشهد نكوصًا وعودة إلى التسعينيات. هنا تكمن خصوصية الوضع الذي نعيشه اليوم». لعل دوغين يشير هنا إلى أن بوتين لم يتمكن من إنجاز بناء هيكلية للسلطة تضمن ظهور البديل الكُفْء القادر على استكمال المسيرة. وربما تكون التعديلات الدستورية المقترحة اليوم تهدف إلى سد هذه الثغرة وتجنُّب الوقوع فيما يحذر منه.
ويرى دوغين أن الوضع الراهن في روسيا سوف يتطور على نحو غير متوقع. فهو إما سيشهد تحسنًا وتطورات إيجابية جديدة، وإما ضِدّ ذلك قد يشهد تردّيًا ملحوظًا وحادًّا. ويقول: «سيبني المستقبل شخص آخر. لا نعرف من سيكون. قد يكون أفضل من بوتين بكثير، يمكن تعليق آمال مجتمعنا عليه. وقد يكون أسوأ بكثير؛ لأن بوتين لم يتمكن من إنجاز بعض الأمور بصورة نهائية؛ لذلك قد نشهد نكوصًا وعودة إلى التسعينيات. هنا تكمن خصوصية الوضع الذي نعيشه اليوم». لعل دوغين يشير هنا إلى أن بوتين لم يتمكن من إنجاز بناء هيكلية للسلطة تضمن ظهور البديل الكُفْء القادر على استكمال المسيرة. وربما تكون التعديلات الدستورية المقترحة اليوم تهدف إلى سد هذه الثغرة وتجنُّب الوقوع فيما يحذر منه.
ويضيف دوغين: «لا يملك بوتين رؤية للمستقبل. فإذا كان يرى أن ما لدينا مثاليٌّ وكافٍ الآن، فهو مخطئ. هذا هو جوهر اللحظة السياسية الراهنة. لقد فعل بوتين كل ما في وسعه لتصحيح كوارث التسعينيات، وفي حال لم يغيّر المسار اليوم قد نعود مجددًا إلى الكارثة. لا بد من تحولات حقيقية، وهذه التحولات ينبغي أن يقوم بها شخص آخر يعتمد على الشعب. أما إذا سرنا وفق منطق فلاديسلاف سوركوف فسوف نسقط في التسعينيات». ويتحدث دوغين عن علاقة الشعب بالنخبة السياسية، فيقول: «إن الولاء للرئيس هو ما يردع الشعب عن الهجوم القاسي على هذه النخبة. فهذه النخبة معادية للشعب. إن الولاء للرئيس والموقف الإيجابي منه، هو ما يردع الشعب عن الهجوم على هذه النخبة الفاشلة والفاسدة، الموالية للغرب والكارهة لكل ما هو روسي».
● ما دمتم ذكرتم اسم فلاديسلاف سوركوف، فهل نملك أن تحدثونا عنه بوصفه شخصية روسية محورية أطلقت ظاهرة «البوتينية» كنهج سياسي كاريزمي عالمي فعّال، يمثله طبعًا الرئيس بوتين نفسه. كما يقال: إن سوركوف هو صاحب فكرة «الديمقراطية السيادية»، وهو محدث الاقتصاد الروسي.. ماذا تقول؟
■ قد يكون من المبالغة وصف فلاديسلاف سوركوف بأنه شخصية روسية محورية، أو أنه أحد صنّاع السياسة الروسية ومساعد سياسي أول لبوتين. إنه في الواقع واحد من اثني عشر مساعدًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كان مساعدًا للرئيس في الشؤون الأوكرانية ابتداءً من عام 2013م، أي في الحقبة العصيبة التي شهدت احتدام الأزمة الأوكرانية وانخراط روسيا السياسي والعسكري في أتون تلك الأزمة، في محاولة منها لمجابهة تداعيات انتقال «الشقيق» الأقرب إلى المعسكر المعادي، وهي تداعيات سياسية وديمغرافية واقتصادية، وجيوإستراتيجية بالدرجة الأولى. ولا شك في أنه كان لسوركوف، السياسي الشاب النشيط والطموح، دور فعال في رسم السياسة الروسية على «الجبهة» الأوكرانية. والجدير بالذكر، أنه أعفي منذ مدة وجيزة من مهماته كمسؤول عن الملف الأوكراني، الذي وضع في عهدة نائب رئيس الحكومة سابقًا ونائب رئيس مكتب الإدارة الرئاسية حاليًّا دميتري كوزاك. وهو أمر له دلالته بصورة خاصة ومؤشر على تحول محتمل في مقاربة موسكو للعلاقات بين البلدين، باتجاه تغليب الحوار مع إدارة الرئيس الأوكراني الحالي فولودمير زيلينسكي؛ لذا قد يكون من الأصح القول عن سوركوف: إنه رجل المهمّات الصعبة وشخصية سياسية بارزة، ولكنه في الواقع منفذ لسياسة الرئيس، وليس صانعًا لهذه السياسة. وبالطبع، لا يمكن القول: إنه محدِّث للاقتصاد الروسي، فهو ليس رجل اقتصاد وبعيد كل البعد من ملف السياسة الاقتصادية، فلهذه السياسة أربابها في روسيا. علمًا أن سوركوف أُعفِيَ في 19 شباط/ فبراير الماضي من مهماته كمستشار للرئيس.
من جهة أخرى، يمكن القول بكل ثقة بأن سوركوف يطمح إلى أن يكون «مُنظِّرًا» للعهد البوتيني، وواضع الأساس أو «التأطير النظري» لما اتفق على تسميته «البوتينية». فتوالت كتاباته التي يحاول فيها وضع الأسس النظرية والسياسية لهذه الفكرة.
تناول سوركوف موضوعة «البوتينية» في مقالة نشرها في شهر فبراير 2019م في صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا «الصحيفة المستقلة»، وكانت بعنوان: «دولة بوتين طويلة الأمد». وصف سوركوف في هذه المقالة «البوتينية» بأنها أيديولوجيا المستقبل، وأكد أن من الضروري جدًّا لروسيا وضع توصيف أو تشريح لنظام حكم فلاديمير بوتين. فيقول: «من الضروري أن نعي، أن نفهم، وأن نقدم وصفًا لنظام الحكم البوتيني، وعمومًا لمجمل أفكار البوتينية ومعاييرها، بوصفها أيديولوجيا للمستقبل». ويضيف أن النظام السياسي الذي نشأ في عهد بوتين ما هو إلا نظام سياسي شامل لجعل الحياة أفضل (يستخدم المصطلح الإنجليزي، وإن بأحرف روسية). ويقول: «إن دراسة البوتينية، بوصفها أيديولوجيا فاعلة للحياة اليومية، بكل تحديثاتها الاجتماعية وتناقضاتها المثمرة، ما هي إلا بداية مفيدة جدًّا؛ لأن البوتينية تمثل لايف هايك سياسي شامل وطريقة جيدة لممارسة الحكم».
وفي شرحه لإنجازات البوتينية يقول: «لقد أُوقِفَ تفكُّك الدولة الروسية وبدأت عملية إعادة البناء. وعادت روسيا إلى وضعها الطبيعي الممكن والوحيد بوصفها دولة عظمى وحيزًا شاسعًا متعاظمًا جامعًا للشعوب (المقصود الشعوب والقوميات المنضوية في إطار الاتحاد الروسي – م.د.). هذا الدور الكبير الذي رسمه التاريخ العالمي لروسيا لا يخوّلها مغادرة مسرح هذه التاريخ ولا الاكتفاء بلعب دور الكومبارس فيه». وفي تقويمه لدور بوتين في التاريخ الروسي، فإنه يضعه في مصافّ عظماء بناة الدولة الروسية عبر العصور. فيقول: «الدولة الروسية تواصل خطاها، إنها اليوم دولة من طراز جديد لا مثيل له». ويحدد سوركوف أربعة نماذج أساسية للدولة شهدتها روسيا عبر تاريخها كله: دولة إيفان الثالث (إمارة موسكو الكبرى التي تحولت إلى دولة عموم روسيا في القرن الخامس عشر – القرن السابع عشر)؛ دولة بطرس الأكبر (الإمبراطورية الروسية في القرن الثامن عشر- القرن التاسع عشر)؛ دولة لينين (الاتحاد السوفييتي، في القرن العشرين)؛ دولة بوتين (القرن الحادي والعشرون).
ويواصل سوركوف تشريح النظام النظام البوتيني فيقول بأن الجهد السياسي الداخلي العالي الوتيرة الذي تعيشه روسيا باستمرار والمرتبط بضرورة الحفاظ على مساحاتها الهائلة المترامية الأطراف وضرورة الإمساك بزمام الأمور فيه (وهذا يفترض وجود سلطة مركزية قوية جدًّا)، والاضطرار لخوض غمار صراع جيوسياسي دائم، تجعل من وظائف الدولة العسكرية- البوليسية ذات أهمية بالغة وحاسمة. وروسيا لا تُخفي هذه الوظائف، بل تعمل على إبرازها وجعلها مرئية. ويخلص سوركوف من ذلك إلى القول: «لذا، لا وجود للدولة العميقة في روسيا، بل هي ظاهرة للعيان. أما الشعب فهو العميق عندنا. وهو، على الرغم من أنه يشارك في الأنشطة (المقصود: في الحياة السياسية)، فإنه لا يظهر على سطح الأحداث، بل يعيش حياته الأخرى العميقة، ويبقى خارج نطاق الاستفتاءات السوسيولوجية، وبعيدًا من تأثيرات التحريض والتخويف وغير ذلك من وسائل التأثير.
إن فهم ما يريده هذا الشعب غالبًا ما يأتي مفاجئًا ومتأخرًا. إن هذا الشعب العميق، بحجمه الهائل وطاقته العظيمة، يصنع قوة حضارية لا تُقهر، توحد الأمة وتضغط على النخبة لتنزلها من عليائهاـ تلك النخبة التي تحاول، من حين لآخر، التحليق في الفضاء الكوسموبوليتي والذوبان فيه». ويخلص سوركوف إلى القول: «إن براعة الاستماع إلى الشعب وفهمه ومعرفة رغباته وإدراك عمقه، والعمل تبعًا لذلك – تلك هي الفضيلة الرئيسة والفريدة من نوعها التي تتسم بها دولة بوتين. ولذلك، فإنها دولة فعالة وطويلة الأمد. إن نموذج الدولة الروسية الحديثة يبدأ بالثقة، وعلى الثقة يقوم. وهنا يكمن اختلافه الجذري عن النموذج الغربي».
حظيت أفكار سوركوف هذه بدعم أوساط واسعة في المجتمع السياسي والفكري الروسي، ولكنها تعرضت في المقابل لانتقادات العديد من المفكرين والباحثين السياسيين الذين رأوا فيها عوارض عبادة الفرد والجنوح لإضفاء صفات مثالية على الرئيس الروسي وعلى النظام السياسي الذي أقامه في روسيا. فألكسندر دوغين، مثلًا، رأى أن أفكار سوركوف ما هي إلا تعبير عن رأي النخبة السياسية المحيطة ببوتين. فيقول في هذا الصدد: «نحن هنا أمام رغبة جامحة للحفاظ على الوضع الراهن، وجعله أمرًا واقعًا غير قابل للتغيير. ما يريده سوركوف هو الآتي: «إن بوتين باقٍ إلى الأبد»، حتى بعد غيابه ستبقى البوتينية قائمة. يحدث هذا الأمر عندنا عندما تصل الدولة إلى نهايتها، عندما تصبح منفصلة عن الواقع. في هذه الحال تعلن أنها باقية إلى الأبد. وهذا ما يذكرنا بالأباطرة الصينيين…».
أما «الديمقراطية السياديّة»، فلم يكن سوركوف مَنِ ابتكَرَ هذا المصطلحَ. لقد كان جان جاك روسو هو أول من استخدمه في القرن الثامن عشر، وذلك لتوصيف الديمقراطية السويسرية حينذاك. وفي القرن التاسع عشر استُخدم مصطلح «الديمقراطية السيادية» في إنجلترا بمعنى «الديمقراطية» عمومًا. وفي القرن العشرين استُخدم هذا المصطلح في الفكر السياسي الأميركي للدلالة على السلطة المحلية في الولاية التي تعتمد القوانين على مستوى الولاية، خلافًا للسلطة الفيدرالية. وحاليًّا يُستخدم مصطلح «الديمقراطية السيادية» في روسيا للإشارة إلى أن الدولة الروسية لا تخضع لمراكز سلطة كبرى خارجية، كما هي الحال في بلدان أخرى.
أما سوركوف فيستخدم هذا المصطلح بمعنى أن الديمقراطية الروسية، على النقيض من الديمقراطية الغربية التي تعكس الانتخابات فيها صراع المصالح، تعبر عن الوحدة بين السلطة والشعب. وعمومًا، لم يكن سوروكوف أول من استخدم مصطلح «الديمقراطية السيادية» في روسيا، بل سبقه إليها الكاتب السياسي فيتالي ترتياكوف في مقالة بعنوان: «الديمقراطية السيادية» نشرت في إبريل 2005م، جاء فيها: «انتقلت روسيا طوعًا من النظام السوفييتي إلى نمط جديد من التطور، نمط بناء مجتمع ودولة ديمقراطية، حرة (سيادية) وعادلة… الديمقراطية السيادية (والعادلة) في روسيا- تلك هي الصياغة اللغوية والجوهرية لفلسفة بوتين السياسية…».
● أي دور ثقافي و«أيديولوجي ديني» يمكن أن تلعبه الكنيسة الأرثوذكسية في تدعيم وحدة روسيا من جهة، ودعم المسار التنظيري والعملي للعقيدة الأوراسية من جهة ثانية؟
■ لا نعتقد أن الكنيسة الأرثوذكسية يمكن أن تلعب دورًا ما تنظيريًّا أو عمليًّا في إطار العقيدة الأوراسية. فمقاربة الكنيسة لتاريخ روسيا وواقعها الراهن ومستقبلها تختلف كليًّا عن المقاربة الأوراسية، كما يفهمها دعاتها بوصفها عقيدة جامعة لمناطق وشعوب تنتمي إلى منابع قومية ودينية مختلفة تلتقي وتتوحد ضمن البوتقة الأوراسية الواحدة مع دور ريادي لروسيا فيها.
مقاربة الكنيسة الأرثوذكسية تختلف كليًّا. فمنذ سقوط القسطنطينيَّة سادت على المستوى الرسمي (في العهد الإمبراطوري) والكنسي في روسيا الفكرة التي تقول: إن الكنيسة الأرثوذكسيَّة الروسيَّة هي الحافظة الوحيدة والحقيقية للتقوى المسيحيَّة، وأن موسكو هي «روما الثالثة»، وريثة روما الأولى وروما الثانية (القسطنطينيَّة) التي عاقبها الرب على ارتدادها عن الإيمان القويم بسقوطها في أيدي «الكفار». وبما يتلاءم مع هذه الفكرة توجه الدعم المالي والسياسي لنشاط الكنيسة الأرثوذكسيَّة التبشيري ضمن الحدود الروسية وفي الخارج.
تتحدث الكنيسة عن هوية روسيا الأرثوذكسية، وترى أن هذه الهوية تشكلت مع سقوط الإمبراطورية البيزنطية. فسقوط «روما الشرقية» فرض إلحاح قيام المملكة الأرثوذكسية في شمال أوربا (روسيا). لقد تكونت «الهوية الروسية» وترسخت، على حد قول الفيلسوف الروسي بانارين، بالدرجة الأولى بفضل المُثل الأرثوذكسية للمملكة المقدسة، القائمة على الحقيقة العليا والتضحية في سبيل الدين الحق، وليس على أساس الشعور القبلي أو العزة الإمبراطورية، أي أنها هوية فوق قومية، فوق إثنية. ونشأت روسيا، وفق هذه النظرة، في الأساس كدولة أرثوذكسية، كرسالة إلهية، فثمة تطابق في الخصوصية الروسية بين الهويتين الإثنية والدينية: الروس كأرثوذكس، والأرثوذكس كروس. ومن ثَمّ، نلاحظ هنا تغييبًا كاملًا لكل المكونات الأخرى القومية – الإثنية والدينية، وتعارضًا تامًّا مع الفكرة الأوراسية.
هذا من الناحية النظرية. أما في الممارسة السياسية، إذ تدرك الهيئات الكنسية العليا طبيعة روسيا بوصفها دولة متعددة القوميات والانتماءات الدينية، فإنها تسعى لكي تكون سياستها، على المستوى الرسمي على الأقل، منسقة مع سياسة الدولة ومنسجمة مع أهدافها التوحيدية في الداخل وتوجهاتها السياسية والإستراتيجية على الصعيد الدولي. وهي تلتقي بذلك دعاةَ الاتجاه الأوراسي في نهج توطيد قوة روسيا ومنعتها وحضورها على الساحة الدولية.
التحديات المواجهة للعقيدة الأوراسية
● ما أبرز تحديات العقيدة الأوراسية، وهل تراها قادرة على تجاوز هذه التحديات، وفي الطليعة بينها توسّع حلف شمال الأطلسي في أوربا الشرقية وانتشار الدرع الصاروخية الأميركية، علاوة على الاختراق الأوكراني المعروف؟
■ تواجه روسيا والعقيدة الأوراسية تحديات كبيرة إستراتيجية وجيوسياسية واقتصادية وأمنية. التحدي الأكبر كان تفكك الاتحاد السوفييتي، ومن ثم انسلاخ جمهوريات ومناطق شاسعة عن روسيا كانت على مدى قرون جزءًا من الإمبراطورية الروسية، وشكلت ما يمكن تسميته الحزام أو المدى الجيوسياسي والإستراتيجي الحيوي العازل للمخاطر الخارجية بالنسبة إلى روسيا. وتفاقمت خطورة هذا التحدي مع توجه بعض هذه الجمهوريات غربًا؛ بحثًا عن الدعميْنِ الاقتصادي والسياسي، وذلك مع وصول قوى سياسية معادية لروسيا على رأس هذه الجمهوريات.
أدى هذا الانزياح غربًا إلى تمدد النفوذ الغربي الأطلسي، الأميركي بالدرجة الأولى، السياسي والاقتصادي والعسكري، إلى حدود روسيا، إلى باحتها الخلفية وعقر دارها، خصوصًا بعد سقوط أوكرانيا في الحضن الغربي كُليًّا، بعدما سبقتها إلى ذلك جورجيا، ومولدافيا نسبيًّا. لقد أسهم ضعف روسيا وتخلخل مواطن القوة لديها في تسعينيات القرن الماضي في انفكاك هذه الجمهوريات عنها وتطويقها بالنفوذ الغربي. وبعد وصول بوتين إلى السلطة ونجاحه في تذليل الكثير من مخلفات التسعينيات، واستعادة روسيا جزءًا من قوتها ومكانتها على الساحة الدولية، بدأت بعض هذه الجمهوريات، خصوصًا في آسيا الوسطى، خُطَى العودة إلى الكنف الروسي. بيد أن الخطر الأكبر يبقى على «الجبهة» الأوكرانية.
إن ما نشهده اليوم من تحركات سياسية وعسكرية روسية نشطة على أكثر من اتجاه، وفي أكثر من منطقة (أشرنا إليها بشيء من التفصيل في الإجابة عن السؤال الأول)، تندرج في إطار السعي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها.
التحدي الآخر يبقى على «الجبهة» الاقتصادية. فعلى الرغم من تعزز دور روسيا السياسي ومكانتها على الصعيد الدولي، وتصاعد قوتها العسكرية، تبقى نقطة الضعف الخطيرة لديها في المجال الاقتصادي. فالاقتصاد الروسي لم يرقَ حتى الآن إلى المستوى الذي يتيح لروسيا لعب دور يتناسب مع ما تطمح إليه، على المستويين الأوراسي والعالمي. لقد وضعت الحكومة الجديدة التي عيّنها بوتين مؤخرًا، والتي تتألف بصورة أساسية من مجموعة من الوزراء الشباب والاختصاصيين، خطة طموحة تهدف إلى إجراء إصلاحات جذرية في الاقتصاد الروسي والارتقاء به إلى مستوى الاقتصادات المتطورة في العالمي ليحتل مكانه بين الاقتصادات الخمسة الأولى في العالم. وتعول القيادة الروسية على نجاح هذه الخطة الاقتصادية؛ لأن نجاحها يعني نجاح روسيا في وضع عقيدتها الإستراتيجية الأوراسية موضع التنفيذ. بحيث تكتمل هذه العقيدة بأضلعها الثلاث: الجيوسياسي والعسكري والاقتصادي.
● كيف هو حضور الثقافة الغربية، الأميركية منها والأوربية، في روسيا اليوم؟ هل لا يزال قويًّا؟ وما تعليقك على مثقفين روس (لا يستهان بعددهم) ما زالوا يرون أن مستقبل روسيا هو في التوجّه غربًا؟
■ لا ننكر أن تأثير الثقافة الغربية جلي ومتزايد في الأوساط الاجتماعية والسياسية والفكرية والفنية والإعلامية، بل على مستوى الإنسان العادي في روسيا اليوم. خصوصًا مع انتشار وترسّخ نمط الاستهلاك النيوليبرالي. وعندما نقول الاستهلاك لا نقصد استهلاك السلع المادية والخدمات فقط، بل نعني بالدرجة الأولى الثقافة الاستهلاكية السطحية في المجتمع الروسي. وهذه صفة غريبة عن الإنسان الروسي المعروف عنه تقليديًّا أنه يتمتع بمستوى راقٍ من الثقافة والتعليم وبوعي سياسي عالٍ، وبأنه من أكثر الشعوب إقبالًا على القراءة. لقد نجحت موجة الاستهلاك والتسطيح في إلحاق ضرر كبير بهذه الخصوصية التي كانت سمة مميزة للمجتمع الروسي.
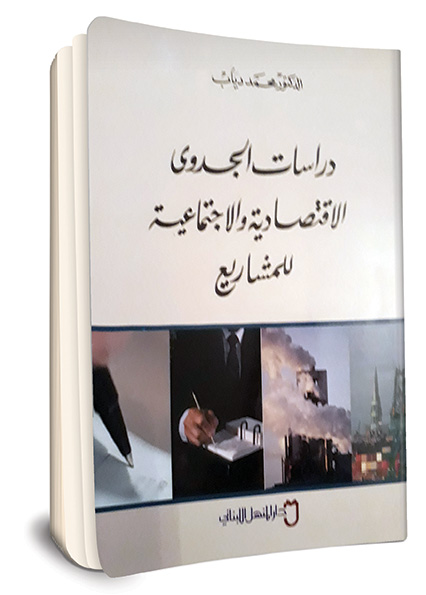 وثمة اليوم تيار لا يستهان به في أوساط المثقفين الروس، هو امتداد لتقاليد قديمة، يرى أن مستقبل روسيا يرتبط بتوجهها غربًا. يعزز دعاة هذه الرأي حضورهم على الساحة الروسية، الذي يبدو طاغيًا في الظاهر، على الرغم من أنه ليس كذلك في الواقع، من خلال سيطرتهم على وسائل الإعلام المملوكة في أغلبها من قوى ومجموعات ذات هوى غربي. ولهذا التيار قوة وتأثير كبيران في الوسط الفني والأدبي إلى حد ما. أصحاب هذا التيار، الذي يمكن تسميته التيار النيوليبرالي الغربي الهوى، يعدُّون روسيا جزءًا من الحضارة الغربية (بدأ هذه التيار مع بطرس الأكبر)، تكونت ثقافتها وتعززت في قلب الثقافة الغربية وتكاملت معها، ولا مستقبل لها إلا في سياق الحداثة الغربية.
وثمة اليوم تيار لا يستهان به في أوساط المثقفين الروس، هو امتداد لتقاليد قديمة، يرى أن مستقبل روسيا يرتبط بتوجهها غربًا. يعزز دعاة هذه الرأي حضورهم على الساحة الروسية، الذي يبدو طاغيًا في الظاهر، على الرغم من أنه ليس كذلك في الواقع، من خلال سيطرتهم على وسائل الإعلام المملوكة في أغلبها من قوى ومجموعات ذات هوى غربي. ولهذا التيار قوة وتأثير كبيران في الوسط الفني والأدبي إلى حد ما. أصحاب هذا التيار، الذي يمكن تسميته التيار النيوليبرالي الغربي الهوى، يعدُّون روسيا جزءًا من الحضارة الغربية (بدأ هذه التيار مع بطرس الأكبر)، تكونت ثقافتها وتعززت في قلب الثقافة الغربية وتكاملت معها، ولا مستقبل لها إلا في سياق الحداثة الغربية.
ثمة تيارات وقوى واسعة على الساحة الثقافية الروسية تواجه التيار الغربي ونفوذه. منها التيار الأوراسي والتيار السلافي- الأرثوذكسي اللذان أتينا على ذكرهما في الإجابة عن أسئلة أخرى. ومنها أيضًا ما يسمى «جماعة الأرض»، وهي تيار أدبي واتجاه في الفكر الاجتماعي والفلسفي، انتشر في روسيا في ستينيات القرن التاسع عشر، وظهر له مؤيدون كثر في البيئة الثقافية الروسية في الآونة الأخيرة. مبادئ هذه الجماعة تقوم على «الفكرة الروسية» التي تجسد الإيمان ﺒ«الأصالة الروسية» التي تتلخص في الرسالة الخاصة للشعب الروسي، المتمثلة في إنقاذ البشرية جمعاء. وينادي أصحاب هذا التيار بفكرة التقارب بين «المجتمع المتعلم» والشعب، على أساس «التربة» الشعبية أو الوطنية والعُرَى الدينية- الأخلاقية. ورغم قربهم الفكري من «التيار السلافي»، حاول دعاة هذا التيار سلوك خطّ وسطي، «محايد» إلى حد ما بين «التيار السلافي» الذي ينقض التوجه الغربي بالكامل، و«التيار الغربي» الذي لا يرى مستقبلًا لروسيا إلا في التصاقها بالغرب وبالثقافة الغربية. من أبرز ممثلي هذا التيار في القرن العشرين، الأدباء سولجينيتيسن، راسبوتين، بيلوف، شوكشين وغيرهم.
● بعد أفول النظرية الماركسية – اللينينية وما انشق عنها من تجليات أدبية وفنية وثقافية متشعبة سابقًا، أي تأثير ثقافي روسي متجدد يمكن أن يشكل «قوة ناعمة» تخترق ثقافات البلدان والقارات هذه الأيام؟ باختصار، أي براديغم ثقافي روسي يمكن «تسويقه» في زمن العولمة وتحولاتها؟
■ عمليات العولمة الشاملة لم تبدأ اليوم، ولكن سرعتها تدفع للتفكير في مصير الثقافات التقليدية، الثقافات الوطنية للشعوب المختلفة، ببقائها أو احتمال زوالها. ثقافة العولمة تعبر عن حضارة السوق المعولمة، حيث يسود منطق الاستهلاك، فيتحول كل شيء إلى سلعة؛ الأدب سلعة، الفن سلعة، العلم سلعة… إلخ. في ظل هذه «الثقافة» تمحى الفوارق بين الثقافات وتظهر ثقافة واحدة، تبلور «ثقافة معولمة» تتسم بسمات تستفيد منها القوى المسيطرة على العمليات الاقتصادية والسياسية والإعلامية، فتحتكر نتاجات هذه الثقافة، بما يؤدي إلى تشكّل نمط محدد من الوعي الثقافي يخلق ما يمكن تسميته «الإنسان الكوسموبوليتي» المشبع بهذه الثقافة. ويحدث ما يشبه «الاختراق الثقافي» للمجتمعات التقليدية، يهدد منظومة القيم الأصيلة ويشكل نوعًا من الازدواجية الثقافية التي تجتمع فيها تناقضات الأصالة والمعاصرة، وهو ما يؤدي إلى تهميش الثقافة الوطنية، أو تغيير ملامحها وصولًا إلى اضمحلالها.
هل بإمكان الثقافة الروسية الصمود تحت ضغط عمليات العولمة المتسارعة هذه، والحفاظ على أصالتها وغناها وقوتها الروحية التي تميزت بها؟ هل بإمكانها تحقيق ذلك مع استيعاب و«هضم» التيارات والتحولات الآتية من الخارج، وجعلها تتأقلم وتتلاءم مع روحها وأسلوبها وقيمها الإنسانية؟ أم محكوم عليها فقدان روحها والتحول إلى شيءٍ ما هجين لا رُوحَ له ولا طعم ولا رائحة، ولا خصائص تميزه من مكونات الثقافة المعولمة الأخرى؟ نستطيع القول بثقة: إن الثقافة الروسية قادرة على تجاوز هذا «القدر». هذه الثقافة التي ترتكز إلى تراث بوشكين ودوستويفسكي وتولستوي وغوركي وشولوخوف وغيرهم من عمالقة الفكر والأدب والشعر والفن الروس ومكملي خطاهم من المعاصرين، لديها القوة الداخلية الكفيلة بمواصلة الإبداع والتجدد بما يتلاءم مع متطلبات وظروف المرحلة الراهنة من التطور العالمي.
إن السمة المميزة التي اتسمت بها الثقافة الروسية هي الجمع بين الأصالة الوطنية والطابع الشمولي، بل العالمي أيضًا. وهي تستمد هذه الخصوصية من انتماء روسيا إلى الغرب والشرق في آنٍ واحد، ومن تعددية المنابع الفكرية والثقافية والحضارية للشعوب المنصهرة في البوتقة الروسية الجامعة، مع الحفاظ على الأصالة الوطنية لكل مكون من مكونات هذا الشعب الروسي العظيم.
ونشير في هذا السياق إلى أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن تنشأ في كنف هذه الثقافة مدرسة الاستشراق العريقة التي أنجبت علماء كبارًا، أغنوا المكتبة الروسية والمكتبة العربية بكنوز معرفية ثمينة. إن ما يميز الثقافة الروسية أيضًا، هو إنسانيتها وانفتاحها على الثقافات الأخرى وتفاعلها معها، انطلاقًا من القوة الأخلاقية لهذه الثقافة التي كان الأدب والفن الروسي، ولا يزال، معبرًا عنها وحاملًا، بل ناقلًا لقيمها. فالتلاقح والتفاعل مع الثقافات الأخرى، من دون فقدان الأصالة والشخصية الوطنية، هو مصدر غنى لثقافة كل شعب وللثقافة العالمية عمومًا (والثقافة العالمية تختلف عن الثقافة المعولمة التي تخنق الثقافات الوطنية وتقضي عليها. الثقافة العالمية التعددية هي مجموع الثقافات الوطنية الأصيلة لمجموع الشعوب والقوميات). التعددية ضمن الوحدة، هنا تكمن رسالة الثقافة الروسية.
● كيف ينظر المثقفون الروس إلى العالم العربي اليوم، ثقافيًّا وفكرو- سياسيًّا بالمعنى الإستراتيجي؟ هل المفكرون أو المثقفون العرب المعاصرون حاضرون أصلًا في مركزية اهتمام المثقفين الروس؟
■ اهتمام المثقفين الروس بالعالم العربي قديم، وقد تكونت صورة هذا العالم في جزء أساسي منها تحت تأثير الكتاب المقدس، عندما بدأ الأدباء الرومانسيون الروس يتوافدون إلى المشرق العربي، حاملين معهم تصورات جاهزة عن أهله وعاداتهم مستمدة من الأفكار الاستشراقية، الغربية بصورة أساسية. وبرزت تأثيرات الثقافة العربية في بعض أشعار شعراء كبار كبوشكين وليرمنتوف وكتابات أدباء من أمثال غوغول وبونين وديرجافين وغيرهم. ولاحقًا، حضرت القضايا العربية والمسائل الثقافية العربية بقوة في الساحة الثقافية والإعلامية الروسية وفي أعمال وإسهامات مستعربين كبار، وعلى رأسهم أغناتي (أغناطيوس) كراتشوفسكي، وفي أنشطة مراكز ومعاهد الاستشراق والاستعراب العريقة في روسيا، وفي الترجمات العديدة لأعمال المؤلفين العرب، من أدباء وشعراء ومفكرين عمومًا، إلى اللغة الروسية.
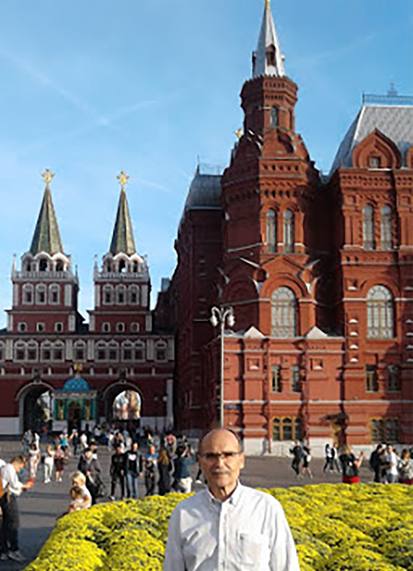 مع انهيار الاتحاد السوفييتي، عاشت روسيا حالة من التردي والضياع خلال أكثر من عقد من الزمن، أصابت الجسم الثقافي الروسي بشظاياها، وتركت تداعيات جانبية سلبية تمثلت في انحسار مؤقت في حركة الاستشراق والاستعراب، ناجم عن النقص في التمويل بالدرجة الأولى، وترافق ذلك مع إقفال القسم العربي في وكالة نوفوستي وفي «دار التقدم» للنشر، اللذين كانا يعملان على ترجمة ونشر الكثير من أعمال الأدباء والشعراء والمفكرين العرب إلى الروسية وإيصالها إلى القارئ الروسي، وعلى إصدار ترجمات كثيرة لنتاجات ثقافية روسية إلى اللغة العربية ومخصصة للبلدان العربية. أدى ذلك كله إلى تراجع في اهتمام المجتمع الثقافي الروسي بالثقافة العربية والمثقفين العرب. ولا ينبغي أن ننكر أيضًا أن حالة العالم العربي المتردية وطغيان التطرف فيه اليوم أَسهَمَا في تراجع الاهتمام به وبثقافته.
مع انهيار الاتحاد السوفييتي، عاشت روسيا حالة من التردي والضياع خلال أكثر من عقد من الزمن، أصابت الجسم الثقافي الروسي بشظاياها، وتركت تداعيات جانبية سلبية تمثلت في انحسار مؤقت في حركة الاستشراق والاستعراب، ناجم عن النقص في التمويل بالدرجة الأولى، وترافق ذلك مع إقفال القسم العربي في وكالة نوفوستي وفي «دار التقدم» للنشر، اللذين كانا يعملان على ترجمة ونشر الكثير من أعمال الأدباء والشعراء والمفكرين العرب إلى الروسية وإيصالها إلى القارئ الروسي، وعلى إصدار ترجمات كثيرة لنتاجات ثقافية روسية إلى اللغة العربية ومخصصة للبلدان العربية. أدى ذلك كله إلى تراجع في اهتمام المجتمع الثقافي الروسي بالثقافة العربية والمثقفين العرب. ولا ينبغي أن ننكر أيضًا أن حالة العالم العربي المتردية وطغيان التطرف فيه اليوم أَسهَمَا في تراجع الاهتمام به وبثقافته.
مع عودة الاستقرار إلى روسيا والتقدم الذي تشهده على مختلف المستويات والصُّعُد، انتعشت مجددًا العلاقات الثقافية الروسية– العربية، وإن لم تصل إلى سابق عهدها بعد. فعلى الرغم من أن حركة الترجمة من العربية إلى الروسية لا تزال ضعيفة، وإمكانية نشر النتاجات الأدبية والفكرية العربية باللغة الروسية محدودة، فإن انتعاش هذه العلاقات تجلى في اللقاءات والمؤتمرات المشتركة التي تعقد من حين إلى آخر في روسيا أو في هذا البلد العربي أو ذاك، ويشارك فيها مفكرون ومثقفون روس وعرب. من هذه اللقاءات: اللقاء الذي عقد في القاهرة عام 1999م تحت عنوان: «روسيا والعالم العربي… العمل المشترك لبناء عالم متعدد الأقطاب»، ومؤتمر «حوار الثقافات: تجربة روسيا والمشرق العربي» في طرابلس لبنان عام 2001م)، و«الحوار العربي الروسي في القرن الحادي والعشرين» الذي نظم برعاية معهد الاستشراق في أكاديمية العلوم الروسية والمنظمة العربية لمسائل التعليم والثقافة والعلوم في مصر، وعقد بدورتين في تونس عام 2003م، وقازان عام 2005م، ومؤتمر «التقاليد الثقافية في مصر والشرق: من العهود القديمة إلى عصر العولمة» الذي عقد عام 2008م في القاهرة برعاية معهد الاستشراق في أكاديمية العلوم الروسية والجامعة الروسية– المصرية.
على الرغم من هذه المؤتمرات واللقاءات الحوارية التي جرت وتجري في السنوات التي تلتها، وبعضها بمبادرات من المراكز الثقافية الروسية في بعض البلدان العربية ومن جمعيات خريجي الجامعات الروسية العرب، فإن اهتمام المجتمع الثقافي الروسي بالعالم العربي وبالثقافة العربية، بحسب رأيي الشخصي، لا يزال ضعيفًا نسبيًّا، ولم يَعُدْ إلى المستويات التي كان عليها في العصر السوفييتي.
انفجار بيروت حوَّل لبنان إلى ساحة مكشوفة للصراعات الإستراتيجية الدائرة في الإقليم
لننتقل إلى ما حدث في أغسطس الماضي، وأعني انفجار مرفأ بيروت، ما قراءتك للانفجار الزلزالي «الأبوكاليبسي» الضخم الذي أطاح بمرفأ بيروت وما هي في رأيكم، تداعياته المحلية والإقليمية والدولية؟
– كانت الكارثة التي أصابت بيروت ومرفأها وناسها وعمرانها بمنزلة فاجعة إنسانية واقتصادية وسياسية بكل المعايير والمقاييس، وتركت وستترك تداعيات خطيرة بعيدة المدى على لبنان وشعبه ومستقبله دولةً وكيانًا، وعلى موقعه ودوره على مستوى الإقليم، تداعيات ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وجيوسياسية.
وبصرف النظر عما إذا كانت الكارثة نتيجة إهمال وسوء إدارة وانعدام مسؤولية وفساد يرتقي إلى مستوى الجريمة الموصوفة، أو أن ثمة قوى داخلية أو خارجية استغلت واقع وجود قنبلة موقوتة بهذا الحجم التدميري في قلب العاصمة اللبنانية لارتكاب هذا العمل الإجرامي خِدمةً لأجندات محددة؛ فإن الثابت أن ما وقع هو وليد تلك المنظومة السياسية الغارقة في الفساد التي تكوَّنت وتجذَّرت وتشبَّثت بمقاليد السلطة منذ قيام لبنان دولةً مستقلةً. وقد بات واضحًا كالشمس أن الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية المتناسلة والمتفاقمة، التي كان تفجير المرفأ ذروتها الدامية، تكشف عُرْيَ وعَجْزَ وعدم أهلية النظام السياسي- الاقتصادي القائم في لبنان، وتفرض حتمية تغييره.
في التداعيات الاقتصادية: لقد اضطلع مرفأ بيروت بدور محوري في الاقتصاد اللبناني بوصفه المرفأ الرئيس، حيث كان يؤمِّن ما يقارب 82% من حركة الاستيراد والتصدير في البلاد، و89% من مجمل عمليات نقل الحاويات، ويؤمن لخزينة الدولة دخلًا سنويًّا قدره 270 مليون دولار، ويؤدي دورًا كبيرًا في حركة الترانزيت إقليميًّا. ومن ثَمّ، فإن توقف المرفأ، ولو لمدة قصيرة، ستنجم عنه خسائر لا تعوض للاقتصاد اللبناني المتهالك أساسًا. ومن جهة أخرى، من المعروف أن مرفأ بيروت لعب، تاريخيًّا، دورًا بالغ الأهمية في الاقتصاد الإقليمي، وكان بمنزلة بوابة ﻟ«الداخل العربي» على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط. وكانت توضع الخطط الطموحة لتعزيز هذا الدور من خلال تطوير المرفأ نفسه وكذلك شبكة المواصلات التي تربطه بالبلدان العربية. ومن الواضح أن ما حدث يوجّه ضربة قاصمة لكل هذه الطموحات، ويُخرِج مرفأ بيروت من المنافسة الشديدة الدائرة بين مرافئ شرقي البحر المتوسط، لمدة قد تطول، وهو ما قد يفقده هذا الدور بصورة شبه نهائية. كل ذلك يدفع إلى الظن بأن تدمير مرفأ بيروت قد يكون الهدف منه استكمال تطويق لبنان، ويمكن وضع ذلك في سياق حسابات جيوسياسية وإستراتيجية في إطار ما يسمى «حرب المرافئ» في هذا الجزء من العالم.
في التداعيات السياسية والجيوسياسية: لقد استثارت الكارثة التي حلَّت ببيروت موجة تعاطف شعبية وسياسية وإعلامية عارمة على المستويين العربي والدولي، لم يشهد لبنان لها مثيلًا، حتى في أحلك مراحل الحرب الأهلية. وكان هذا التعاطف صادقًا أمام هول الكارثة، ولا سيما على المستوى الشعبي، وإلى حد كبير على المستويين الرسمي والإعلامي. فقد سارعت دول شقيقة وصديقة لمدّ يد العون للبنان في محنته، ولا شك لدينا في صدق عاطفتها واندفاعتها المشكورة. بيد أن الدول، خصوصًا الكبرى منها، ليست جمعيات خيرية، ولكل واحدة منها مصالحها وأهدافها وتحالفاتها وتطلعاتها لتوظيف ما حدث في إطار الصراع الدائر على مواقع النفوذ في المنطقة، خصوصًا في ضوء الأصوات والدعوات التي تصاعدت في لبنان في الأشهر الأخيرة والداعية إلى التوجه شرقًا، أو بالأحرى فتح كل الخيارات، سواء أكانت شرقية أم غربية، للخروج من أزماته المالية والاقتصادية المتفاقمة وإيجاد الحلول لها.
لقد أدَّت الكارثة إلى استجلاب التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان (أو بالأحرى تزايدها، وهي الحاضرة أصلًا في الواقع اللبناني منذ إن وجد لبنان)، وإلى تقاطر كبار المسؤولين والمبعوثين من دول، بعضها كبرى، لزيارة لبنان والتقاء مسؤولِيهِ وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني، بل نزول بعضهم إلى الشارع والاستماع إلى شكاوى الناس العاديين ومطالبهم. وأدت أيضًا إلى تزاحم السفن والبوارج الحربية الأجنبية أمام الشواطئ اللبنانية بحجة تقديم المساعدة في إزالة آثار الانفجار.
وإذا كانت موجة التعاطف قد أسهمت، نسبيًّا، في فك الطوق الاقتصادي والمالي والسياسي المفروض على لبنان منذ قرابة العام، فإن ما حدث أدى عمليًّا إلى تحول لبنان إلى ساحة، مكشوفة هذه المرة، للصراعات الإستراتيجية الدائرة في الإقليم، التي قد تسهم نتائجها في إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة. ومن الأكيد أنه سيحدث تسابق وتنافس بين دول عدة للفوز بعقود إعادة بناء المرفأ، وربما تشغيله، وبشروط قد تضع هذا المرفق الحيوي والبالغ الأهمية محليًّا وإقليميًّا، في قبضة الجهة التي ستفوز بالعقد، مع ما يترتب على ذلك من هيمنة على الاقتصاد اللبناني، بحكم الدور الذي يلعبه المرفأ في هذا الاقتصاد.
ومن الواضح أن الطبقة السياسية التي تمسك بزمام السلطة في البلاد منذ ثلاثة عقود، قد أظهرت الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة التي تعصف بالبلاد في السنوات الأخيرة، ثم كارثة المرفأ، مدى فسادها وعدم أهليتها. إن هذا الطبقة السياسية ستكون عاجزة عن الوقوف في وجه التدخلات الخارجية وحماية الوطن من أتون الصراعات الدولية، مع ما سينجم عن ذلك من فقدان لبنان لأمنه واستقراره وحرية قراره، ولاستقلاله في نهاية المطاف.





 تفترض الطريقة الأولى، أو ما يسمى الطريقة القارية، أن يسود الحافز الآتي من الداخل، من قلب القارة، سواء أكان إمبراطورية روسية أم كيانًا أوراسيًّا أشمل أم تحالفًا قاريًّا يشمل دولًا مركزية مثل: روسيا والصين والهند وإيران وغيرها، أو غير ذلك. فمهمة قطب البر تتمثل في توسيع نفوذه قدر الإمكان نحو المناطق التي تغطي القارة الأوراسية كلها والمناطق المحاذية لها وإقامة التكامل الإستراتيجي فيما بينها؛ ونحن نرى إرهاصات قيام مثل هذا التحالف أو التكامل اليوم.
تفترض الطريقة الأولى، أو ما يسمى الطريقة القارية، أن يسود الحافز الآتي من الداخل، من قلب القارة، سواء أكان إمبراطورية روسية أم كيانًا أوراسيًّا أشمل أم تحالفًا قاريًّا يشمل دولًا مركزية مثل: روسيا والصين والهند وإيران وغيرها، أو غير ذلك. فمهمة قطب البر تتمثل في توسيع نفوذه قدر الإمكان نحو المناطق التي تغطي القارة الأوراسية كلها والمناطق المحاذية لها وإقامة التكامل الإستراتيجي فيما بينها؛ ونحن نرى إرهاصات قيام مثل هذا التحالف أو التكامل اليوم. ويرى دوغين أن الوضع الراهن في روسيا سوف يتطور على نحو غير متوقع. فهو إما سيشهد تحسنًا وتطورات إيجابية جديدة، وإما ضِدّ ذلك قد يشهد تردّيًا ملحوظًا وحادًّا. ويقول: «سيبني المستقبل شخص آخر. لا نعرف من سيكون. قد يكون أفضل من بوتين بكثير، يمكن تعليق آمال مجتمعنا عليه. وقد يكون أسوأ بكثير؛ لأن بوتين لم يتمكن من إنجاز بعض الأمور بصورة نهائية؛ لذلك قد نشهد نكوصًا وعودة إلى التسعينيات. هنا تكمن خصوصية الوضع الذي نعيشه اليوم». لعل دوغين يشير هنا إلى أن بوتين لم يتمكن من إنجاز بناء هيكلية للسلطة تضمن ظهور البديل الكُفْء القادر على استكمال المسيرة. وربما تكون التعديلات الدستورية المقترحة اليوم تهدف إلى سد هذه الثغرة وتجنُّب الوقوع فيما يحذر منه.
ويرى دوغين أن الوضع الراهن في روسيا سوف يتطور على نحو غير متوقع. فهو إما سيشهد تحسنًا وتطورات إيجابية جديدة، وإما ضِدّ ذلك قد يشهد تردّيًا ملحوظًا وحادًّا. ويقول: «سيبني المستقبل شخص آخر. لا نعرف من سيكون. قد يكون أفضل من بوتين بكثير، يمكن تعليق آمال مجتمعنا عليه. وقد يكون أسوأ بكثير؛ لأن بوتين لم يتمكن من إنجاز بعض الأمور بصورة نهائية؛ لذلك قد نشهد نكوصًا وعودة إلى التسعينيات. هنا تكمن خصوصية الوضع الذي نعيشه اليوم». لعل دوغين يشير هنا إلى أن بوتين لم يتمكن من إنجاز بناء هيكلية للسلطة تضمن ظهور البديل الكُفْء القادر على استكمال المسيرة. وربما تكون التعديلات الدستورية المقترحة اليوم تهدف إلى سد هذه الثغرة وتجنُّب الوقوع فيما يحذر منه.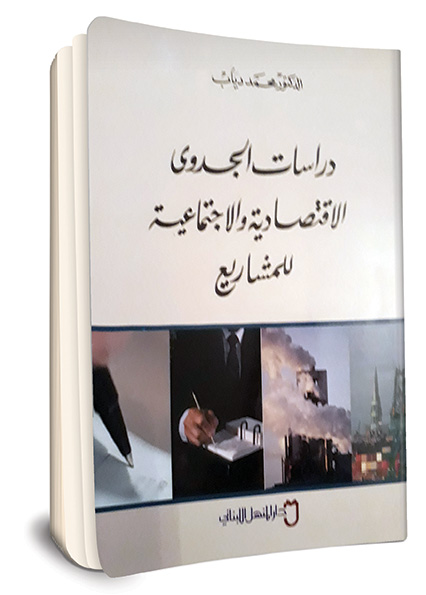 وثمة اليوم تيار لا يستهان به في أوساط المثقفين الروس، هو امتداد لتقاليد قديمة، يرى أن مستقبل روسيا يرتبط بتوجهها غربًا. يعزز دعاة هذه الرأي حضورهم على الساحة الروسية، الذي يبدو طاغيًا في الظاهر، على الرغم من أنه ليس كذلك في الواقع، من خلال سيطرتهم على وسائل الإعلام المملوكة في أغلبها من قوى ومجموعات ذات هوى غربي. ولهذا التيار قوة وتأثير كبيران في الوسط الفني والأدبي إلى حد ما. أصحاب هذا التيار، الذي يمكن تسميته التيار النيوليبرالي الغربي الهوى، يعدُّون روسيا جزءًا من الحضارة الغربية (بدأ هذه التيار مع بطرس الأكبر)، تكونت ثقافتها وتعززت في قلب الثقافة الغربية وتكاملت معها، ولا مستقبل لها إلا في سياق الحداثة الغربية.
وثمة اليوم تيار لا يستهان به في أوساط المثقفين الروس، هو امتداد لتقاليد قديمة، يرى أن مستقبل روسيا يرتبط بتوجهها غربًا. يعزز دعاة هذه الرأي حضورهم على الساحة الروسية، الذي يبدو طاغيًا في الظاهر، على الرغم من أنه ليس كذلك في الواقع، من خلال سيطرتهم على وسائل الإعلام المملوكة في أغلبها من قوى ومجموعات ذات هوى غربي. ولهذا التيار قوة وتأثير كبيران في الوسط الفني والأدبي إلى حد ما. أصحاب هذا التيار، الذي يمكن تسميته التيار النيوليبرالي الغربي الهوى، يعدُّون روسيا جزءًا من الحضارة الغربية (بدأ هذه التيار مع بطرس الأكبر)، تكونت ثقافتها وتعززت في قلب الثقافة الغربية وتكاملت معها، ولا مستقبل لها إلا في سياق الحداثة الغربية.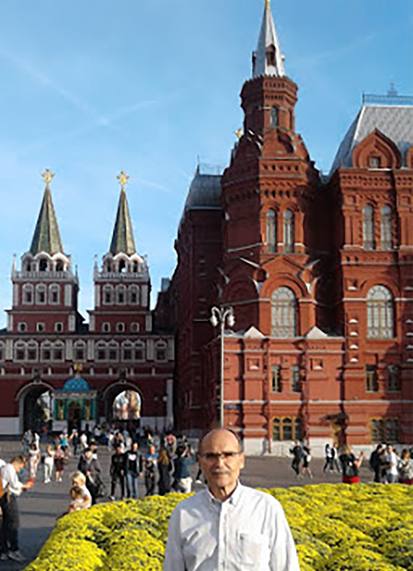 مع انهيار الاتحاد السوفييتي، عاشت روسيا حالة من التردي والضياع خلال أكثر من عقد من الزمن، أصابت الجسم الثقافي الروسي بشظاياها، وتركت تداعيات جانبية سلبية تمثلت في انحسار مؤقت في حركة الاستشراق والاستعراب، ناجم عن النقص في التمويل بالدرجة الأولى، وترافق ذلك مع إقفال القسم العربي في وكالة نوفوستي وفي «دار التقدم» للنشر، اللذين كانا يعملان على ترجمة ونشر الكثير من أعمال الأدباء والشعراء والمفكرين العرب إلى الروسية وإيصالها إلى القارئ الروسي، وعلى إصدار ترجمات كثيرة لنتاجات ثقافية روسية إلى اللغة العربية ومخصصة للبلدان العربية. أدى ذلك كله إلى تراجع في اهتمام المجتمع الثقافي الروسي بالثقافة العربية والمثقفين العرب. ولا ينبغي أن ننكر أيضًا أن حالة العالم العربي المتردية وطغيان التطرف فيه اليوم أَسهَمَا في تراجع الاهتمام به وبثقافته.
مع انهيار الاتحاد السوفييتي، عاشت روسيا حالة من التردي والضياع خلال أكثر من عقد من الزمن، أصابت الجسم الثقافي الروسي بشظاياها، وتركت تداعيات جانبية سلبية تمثلت في انحسار مؤقت في حركة الاستشراق والاستعراب، ناجم عن النقص في التمويل بالدرجة الأولى، وترافق ذلك مع إقفال القسم العربي في وكالة نوفوستي وفي «دار التقدم» للنشر، اللذين كانا يعملان على ترجمة ونشر الكثير من أعمال الأدباء والشعراء والمفكرين العرب إلى الروسية وإيصالها إلى القارئ الروسي، وعلى إصدار ترجمات كثيرة لنتاجات ثقافية روسية إلى اللغة العربية ومخصصة للبلدان العربية. أدى ذلك كله إلى تراجع في اهتمام المجتمع الثقافي الروسي بالثقافة العربية والمثقفين العرب. ولا ينبغي أن ننكر أيضًا أن حالة العالم العربي المتردية وطغيان التطرف فيه اليوم أَسهَمَا في تراجع الاهتمام به وبثقافته.