
بواسطة سوسن جميل حسن - كاتبة سورية | سبتمبر 1, 2022 | مقالات
في مجموعته الشعرية الصادرة من الهيئة المصرية العامة للكتاب 2022م، بعنوان «مَوَجان»، يمارس الشاعر شربل داغر الحفر في طبقات ذاكرته الشخصية، وزمنه في تقدّمه، متابعًا تحوّلات الجسد، مع تحوّلات المدينة، متمشّيًا في «شوارع القصيدة»، يلتقط المعاني قبل أوان قطافها، كعناقيد الحصرم في الدالية «يلسع فيما يلمع في إفاقة الأصابع على ما لا تحسن الإتيان به». وفي القسم الأخير «قصيدة: نافذة ومرآة»، من ثمانية نصوص، بين شعرية وأخرى يصنّفها الشاعر أنها تقع في برزخ بين الشعر والخاطرة، فيها حفر بماضيه الكتابي وتكوّنه الإبداعي، وتفكّر في كتابته، يقابل فيه حالته الكتابية بلفظ معجمي استخدمه في كتابه ترانزيت «كِينة»، يشير إلى «شرط الإنسان في وجوده»، فأحياه من خلال «قوّته الكامنة». هذا التعيّن في الموقع، أساس في التفلسف، عند هايدغر وقبله، كما يقول، وهذا ما دفعه في شعره لأن يجعل من اللحظة وجودًا في مكان ما.
في شوارع القصيدة
في حوار صحفي يقول عن شعره: «له مسالك خافية تتعدّاني، وإن تشملني في نهاية القصيدة، فالقصيدة قد تنطلق من لحظة ما، من لفظ أحيانًا، فأجدني أتبعها فيما أتخيّر ميلانًا ما، سواء للجملة أو لتدافع القصيدة». لربّما يمكن مقابلة العنوان «مَوَجان» بهذا التعريف، فالموج يعني من ضمن معانيه «المَيْل» والمَوَجان يمكن مقابلته بـ«مَيَلان»، ففي قصيدته «تمشيت بعد ظهر القصيدة»، تحيل جملة «بعد الظهر» إلى الإغفاءة الطافية، بما يمكن أن نسمّيه «مَوَجان» بين اليقظة والنوم، أما الزمن فهو القصيدة، وكأن الشاعر يضبط زمنه عليها، فيتمشّى في شوارعها لتبسطَ أمامه الجدران وتستدعي مخيلته تلاعب الصور بهذا التوتر «بين الطلب على الشيء، والتردّد في فتح مهاوي الغياب». هذا التدفق الرقراق مثل نهر بين البداية والمشتهى، تحمله مفردات الحركة والتنقّل: يعود، تمشّيتُ، ينبسط، يتقدّم، مسرّع، إبطاء، السائر، الخطوة، وصول، اندفاعة… تتوالف لتصنع ذلك المَوَجان.

شربل داغر
لشغفه باللغة مساحة واسعة في قصائده: «كان يلهو باللغة، بل بتمدّد فيها ويقوم، بثقة الليّن، والطري، والعنيف، والمتراقص، والمتدافع، من حركات الإقبال عليها، في عجينتها، في خبزها الوهّاج»، ويناديها بشغف وحميميّة: «أيتها اللغة، يا رفيقة قيلولتي من دون نوم… دعيني أكُنْ حيث تكونين». وهو في علاقته العاطفية معها، تراه يلاعب الألفاظ: «يتطاير في المدى المشدود بيني وبينها رذاذٌ مثل (فقش) الموج». فكيف يكون للموج فقشٌ، والفقش يكون لغلاف هشّ يتهشّم بنقرة فيسيل ما بداخله، بينما الموج مفتوح على الفراغ بلا حدود؟ لكنها تبدو صورة جميلة، معبّرة، مبتكرة.
تراه في ضجيج الحياة ككائن في عزلته، غارق في تفاصيل عناصرها، «تراني من دوني في الدبيب لما يجمعني بغيري، من دون أن أكون أي واحدٍ منهم». بينما في قصيدة «ما قاله القميص لحبل الغسيل»، يؤكّد بالالتباس نفسه، بين الأنثى واللغة، ما يموج في داخله من موسيقاها وقوارير عطرها، وليس كما غيره «يزن الكلمات في موازينها»؛ لذلك يرمي نصيحته: «لا تفحصْ، لا تتفقّدْ، القميص شرب من مائها، وحبل القصيدة طويل».
وهو في المَوَجان بين «الحين والحنين» و«هنا والآن»، يرسم العالم كما هو افتراض من حيث تحقّقه، ففي قصيدة «وجدوا، في الركام، أسنانًا حليبية» ينظر إلى ما لحق في المدينة بعد انفجار المرفأ، وكأنه الطفل الذي كان عندما سقطت أسنانه اللبنية، بينما «أسناني الخلّبية، تقضم بإفراط، إذ تتمرّن، في خفّة القراءة، على تناول الحروف مثل ثمار فوق أغصان السطور». فهذا الدمار أتى على ذاكرة الطفولة أيضًا، وأمّا ما لا يطمره الركام فهو: «يستلقي، يغفو، من دون قلق، في امتدادات الكلام الممتد بين العين واللسان، في انتظارات القصيدة». هي جذوة الحياة تتوهج إذ تلامسها نسائم القصيدة لتنهض من جديد غير آبهة بهواء ملوّث، فالصبي «يدرج في القصيدة من غير كمّامة أو مجاز»، القصيدة التي تحمل بصمتها الفريدة، لا تشبه غير نفسها، في بياض القلب الذي يغوص إليه «أبيض قلبي لا حبر له، ولا بحر لقافيته… له نثر يتشعّب في تهدّجات الصوت، أبيض قلبي يفتح سطوره لسواد بيروت».
جمالية الاحتمالات
تتكرّر كلمة الحظّ في قصائده، مثلما لو أنّه يؤكّد اكتناز المعاني وأوجه الحياة في الشعر، في احتمالية تشكّلها وتكوينها وسورياليّتها، «فيتدبّر خيطانًا قوية لطائرة ورقية: يعلو بها ويشد على خيطانها كمن بات أكيدًا في مشاغلة الحظ». هذا التكرار يحيلنا أيضًا إلى مَوَجان آخر، عدم اليقين «دعني أضرب موعدًا مع الحظ، وأقامر فيما لا يعود لي»، كما مفردة لعلّ، بتكرارها في جمل وقصائد عديدة، فتلقينا في تلك المساحة الضبابية نموج بين المأمول والمستحيل، «لعلّنا في وجهَيِ استعارة يرتعشان… من دون أن يبرحا مكانيهما»، الاستعارة التي تتكرّر في النصوص أيضًا.
في القسم الذي يحمل عنوان: «وداد عن بعد»، يمكن للبعد أن يحيل الخيال، مرفوعًا على خيمة اللغة، إلى فنّان يمدّ أسرّة الشهوة بما تحتاج من شراشف المتع لتبدو مواقعة القصيدة ظلَّ مواقعة الحبيبة، بكل ذاك السموّ والرفعة في لقاء الجسد بالجسد، «أوّل شجرة تصادفينها في الطريق بعد خروجك الصباحي: المسيها… هي يدي، أكتب أحيانًا لأنني أشتهيكِ». في قصائد هذا القسم نرى انزياحات مخاتلة، محبوكة بشغف القصيدة واشتهاء اللغة، وجمالية الاحتمال، كما في قصيدة «لعلّي في الرنين»، التي نكاد نسمع فيها صوت الكمنجات تئنّ بالرغبة، أو في قصيدة «كتابها مفتوح»، وفيها يرمينا الشاعر، كعادته، في ذلك الالتباس المثير بين الأنثى والقصيدة، فترى اجتماع الحسيّة العالية مع التسامي النبيل في الصور التي يشكّلها، «النازل أو الطالع، بين الثديين، صاريةٌ لشراع، ينشر ما يغوص في لججه، يتخاصر مع الهواء ويراقص الموج، في فقشه الفوّار».
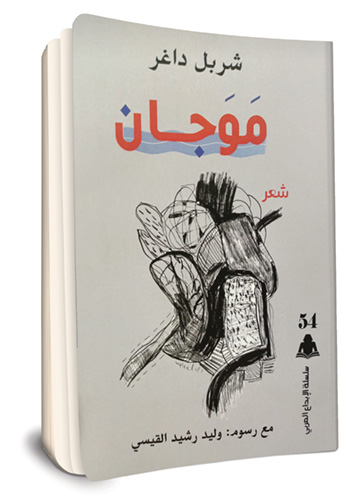 الموسيقا تشغل نصوصه وتتصاعد ألحان خفيّة من إيقاعها، مع صور يتضافر بعضها مع بعض لتشكّل نصوصًا سردية، وهو ما يستدعي السيناريو السينمائي، كما في معظم نصوص القسم الأول «أيها الموت، يا جاري الأليف»، إذ تبدو اللقطات الشعرية كما لو كانت لقطات كاميرا، يشبكها خيط خفي موغل في عمق النصوص، وما يغلب في شعره اللقطات الخارجية، التي تنظر إلى العالم من خلال عدسته الداخلية، فقصيدة «قبل الموت بقليل» نصّ يفتح في مقدمته على المشهدية السينمائية، على الحركة، ترصدها كاميرا خلف عدستها مصوّر يسبر غور النصّ، ليفضي هذا المشهد إلى أسئلة الوجود الفلسفية، الحياة/ الموت. «ليس للموت ما يعد به، ليس له غير ما يستردّه من ديون الحياة المستحقة».
الموسيقا تشغل نصوصه وتتصاعد ألحان خفيّة من إيقاعها، مع صور يتضافر بعضها مع بعض لتشكّل نصوصًا سردية، وهو ما يستدعي السيناريو السينمائي، كما في معظم نصوص القسم الأول «أيها الموت، يا جاري الأليف»، إذ تبدو اللقطات الشعرية كما لو كانت لقطات كاميرا، يشبكها خيط خفي موغل في عمق النصوص، وما يغلب في شعره اللقطات الخارجية، التي تنظر إلى العالم من خلال عدسته الداخلية، فقصيدة «قبل الموت بقليل» نصّ يفتح في مقدمته على المشهدية السينمائية، على الحركة، ترصدها كاميرا خلف عدستها مصوّر يسبر غور النصّ، ليفضي هذا المشهد إلى أسئلة الوجود الفلسفية، الحياة/ الموت. «ليس للموت ما يعد به، ليس له غير ما يستردّه من ديون الحياة المستحقة».
كذلك المسرح، كما في «عبور الكلام» و«لو تجلس، لا سأمشي»، النص الحواري بين الذات الكاتبة والآخر فيها «هو»، يذكّرنا بروايته «وصيّة هابيل».
نصوص شعريّة «تموج» في فضاء القصيدة، عامرة بألفاظ الحركة والصوت، وعناصر الطبيعة والصور من دون حضور لمفردات اللون، ربما لذلك قدّم الفنّان «وليد قيسي» رسومه بالأسود، بقلم الفحم، فبدت كما لو أنها صدى القصائد، كخطوطٍ تتشكّل في عتمة الأحلام، تبدو مثل خربشات طفل يمسك قلمه الرصاص أول ما يستيقظ ويبدأ برسم أحلامه ورؤاه، وأحيانًا كوابيسه ومخاوفه، من يستطيع أن يرسم أحلام طفل غير فنّان مشى في شوارع القصيدة، يتعقّب الشاعر من دون أن يراه، يلتقط ما يتساقط منه في مراتع الطفولة إذ يزورها في التذكّر ويزورها في القصيدة؟

بواسطة سوسن جميل حسن - كاتبة سورية | يناير 1, 2022 | مقالات
قد يعترض بعضٌ على التفكير فيما يمكن أن تكون عليه المدن التي دمّرتها الحرب في سوريا، أو الأحياء التي تهدّمت، بدعوى أن الوقت الآن للإنسان والبحث عن حلّ سريع لمعاناته التي أتت على حياته ومستقبل أبنائه. من حيث المبدأ يبدو هذا القول في مكانه أمام هول الكارثة والمستوى غير المسبوق أو الموصوف لما وصل إليه الشعب السوري بكل فئاته وشرائحه، سواء في الداخل السوري أم في بلدان اللجوء، في مناطق النظام أم المعارضة. لكن أليس التفكير في المستقبل ووضع تصوّرات له أو لما يمكن أن يكون عليه وما يجب أيضًا يعدّ عملية استباقية من حيث الضرورة؟ التفكير في حلول ووضع خطط وبدائل مسبقًا يُنجي من الانزلاق إلى الحلول السريعة التي لا تكاد تطبق على الأرض حتى تتفجّر عيوبها ونواقصها وتتحوّل من حلول إلى مشكلات تلقي بعبء ثقيل وتستنفد طاقات وتهدر موارد من أجل ترميمها أو إعادة صياغتها بما يلائم الوضع الجديد.
التفكير في المدن وهندستها وعمرانها أمر ضروري وحيوي، فهي ليست أبنية ومجمعات كتلية فقط، بل هي بمنزلة حضن يحتوي الحياة اليومية والأنشطة الاجتماعية في المدينة، وتدوّن نشاطها الثقافي والتاريخي، فالعمران بمفهومه الواسع وميدانه الرحب على علاقة انعكاسية مع التجمعات الحضرية أو المدن، يعكس كل منهما الآخر ويؤثر فيه، وعندما يمر أحدهما في أزمة لا بد أن يتأثر الآخر، أما أزمة مدننا وحواضرنا الاجتماعية فليست ابنة الحرب فقط، إنها معاناة تمتد عقودًا إلى الوراء، إن لم يكن قرونًا، الدليل الدامغ ما تحتفظ به الذاكرة البصرية والصور والأفلام والوثائق المؤرشفة عن تلك المدن التي كانت تخسر ملامحها بالتدريج وتستحيل إلى مدن مترهّلة بأرواح مأزومة.
معظم المدن العريقة تمتلك هوية خاصة يلمسها الغريب بمجرد دخولها، ثم يتعرف إليها في أثناء الإقامة فيها، يستكشف ما هو خلف صورتها من ملامح شخصيتها وروحها وثقافتها، ومعظمها تغزوك في الإطلالة الأولى بشعور ما، غالبًا ما يكون دقيقًا، فحتى المدن قد تعشقها من النظرة الأولى، باريس مثلًا في أول لقاء بصري معها تشعر أنك أمام غانية فاتنة، تبهرك بجمال مستبد وتجذبك إليها، لكنك تشعر أنها بسطت أمامك كل شيء في اللقاء الأول، بينما برلين مدينة تشعر في لقائك الأول معها بحضن دافئ وطمأنينة وهناء، وعليك أنت أن تذهب إلى مكامن أسرارها وتكتشف ما هو خلف هذا الشعور الدافئ، هي مدينة لا تبذل مفاتنها، بل تجيد الغواية واستدراج زائرها إلى مكامن أسرارها. لكن في الحالتين لكل من هاتين المدينتين هويتها الخاصة، كمدن كثيرة في العالم.
ليس غائبًا عن البال أن المجتمعات تنتج من جملة ما تنتج، المعنى، المعنى بما يعني من دور في ضبط الحياة ونظم إيقاعها، وهذا يتعلق بالمعطيات المتوافرة والثقافة المؤثرة في حياة الناس، بحمولتها المعرفية المبنية على أسس متباينة من دينية ودنيوية، وما تفرز من أنماط فلسفية ومنظومات أخلاقية وقيمية، وسياسية أيضًا، ولكل جماعة طريقتها في تسويق معانيها وتكريسها في حياة أتباعها. وإذا كنا نتحدث عن أنظمة سياسية شمولية استبدادية حكمت الشعوب لمدة زمنية ما، فإن الحرب كشفت أن هذه الأنظمة الشمولية لم تفلح في صهر شرائح المجتمع وفئاته في بوتقة واحدة، مع الإقرار بأنها استطاعت، أو ربما كانت التركيبة الفكرية والثقافية مساعدة لها، تمكين التفكير النمطي وتقليص المبادرة والقدرة على الإبداع والابتكار.
في أوربا، ومنذ عصر الأنوار ثم الثورة الصناعية ازدهرت الأفكار والابتكارات، وتميزت الحياة الثقافية بنشاط وازدهار عظيمين كان لهما الدور البارز والكبير في وصول شعوبها ومجتمعاتها على هذا المستوى من التقدم والاستقرار، بغض النظر عن الأزمة الحالية، وأزمة الثقافة في عصر العولمة والرقمنة، التي أخمّن أنها، أي الأزمة، ستنفرج وتتفتق عن حلول لأغلب المشكلات؛ لأن القاعدة المتبعة هي فسح المجال للإبداع والابتكار.
تخطيط المدن والأيديولوجيا المهيمنة

فالتر غروبيوس
إذا ما توافرت الإرادة السياسية فإن الرؤى المستقبلية لتخطيط المدن تتبع للأيديولوجيا المهيمنة للنظام السياسي وعلاقته بالمجتمع، ولدينا مثال هنا هو مدينة برلين وتأثير الأيديولوجيا النازية في تخطيطها والنمط المعماري لها، إذ إن باوهاوس كانت نموذجًا لرؤية مستقبلية مختلفة حُوصِرَت وطُورِد مؤسسيها حتى اضطروا للهجرة خارج ألمانيا، ولقد مرّ قرن وزيادة على بدعة أثّرت في حياة البشرية من حيث العمران، أو العيش في التجمعات الحضرية، ليس فقط العمران ككتل مرصودة للسكن واحتواء الأنشطة البشرية، بل تصميمها من أجل أن تناسب الحياة العصرية وتتناغم معها، كما تقدّم رؤية أو تصوّرًا للمستقبل، غير غافلة عن الفنون كمنتج بشري رفيع، إنها مدرسة باوهاوس.
ففي عام 1919م أنشأ المعماري والمصمم فالتر غروبيوس معهدًا لتأهيل المعماريين والفنانين والمصممين في مدينة فايمر الألمانية، الْتحقَ به العديد من الشخصيات المهمة والشهيرة والمؤثرة في الحياة، منهم يوهانس إيتن الكاتب والرسام السويسري التعبيري، والرسام الأميركي الألماني ليونيل فينينغر، والنحات الألماني جيرهارد ماركس، لقد كان لدى غروبيوس رأي مفاده أن الهدف الأساسي للفنون التشكيلية كافة هو البناء، وعلى المعماريين والنحاتين والرسامين العودة إلى الحرفة؛ إذ ليس هناك فارق أساسي بين الفنان والحرفي، فالفنان ما هو إلا صيرورة مكثفة للحرفي. لقد صارت باوهاوس اليوم منارة يستهدي بنورها العديد من الشركات كشركة إيكيا السويدية، فهي ليست للمعمار الخارجي فقط بل تهتم بالعمران الداخلي للمساكن والبيوت وأماكن العمل أيضًا، وتتابع تغير الحياة لتواكبه، بل لتضع رؤية مستقبلية أيضًا.
لكن كان التوجه لدى النازية مختلفًا، كما جاء في مقالة بحثية للباحث ضرغام مزهر كريم العبيدي له بعنوان: أثر السياسة على فكر العمارة. إذ تكاملت العمارة النازية مع فكر الحزب النازي في خططه وأهدافه القومية التي ترمي إلى إبداع وابتكار (إحياء روحي ثقافي) لألمانيا، مستوحيًا أفكاره وتوجيهاته من خلال إعجابه الشديد بالإمبراطورية الرومانية بوصفها الإمبراطورية الآرية الأقدم، مضافًا إلى ذلك استلابه لصالح فكرة الخلود والأبدية. فامتد تأثير هذا الحلم ليشمل المدن والقرى لتكون صورة خاصة ومعبرة عن المجتمع الألماني، وسعت إلى تحقيق مبادئ أساسية في العمارة، منها المنصة المسرحية التي تعدّ ملمحًا مميزًا لأغلبية الأبنية التابعة لتلك الحقبة بما توافر من ظروف النشاطات العامة والاحتفالات القومية والمهرجانات، كما يقول الباحث في بحثه، ومنها أيضًا الموعظة؛ إذ كان هتلر يرى أن في العمارة منهجًا لتوصيل رسائل. من النماذج الدالة بشدة التي يعود تاريخها إلى تلك الحقبة قاعة الشعب بقبتها الضخمة، ومبنى المستشارية، وغيرها كثير.

ملاحظة فارقة
في النتيجة يمكن استخلاص فكرة تنمّ عن ملاحظة فارقة، فالدكتاتوريات الغربية استطاعت أن تنجز مشروعات وتبني دولًا وتؤسس مدنها وتعمّرها وتمنحها هوية تروق لها وتخدمها، فتركت تلك الأوابد التي تدل عليها، أما أنظمتنا الدكتاتورية فاعتلت عرش السلطة والنفوذ وتركت الفساد يتفشى في أركان الدولة والمجتمع، وأدخلت الحياة بكل مناحيها في حالة استنقاع، وتركت للفساد أن يزحف ويقضي على بقايا الهويات القديمة المتشكلة عبر التاريخ. لا يمكن ألا يكون لكل أمة أو دولة أو شعب هويته الثقافية والعمرانية، ولقد مر على سوريا تاريخيًّا العديد من الغزوات والحملات العسكرية والاستيطان، وكلها تركت بصماتها، إلا أن النواة الأساسية للمدن كانت على النمط الإغريقي، السوق الذي يشكل المركز الحيوي للمدينة وحوله تنشأ الأحياء السكنية والمقرات الأخرى. ثم جاء الاحتلال العثماني وترك بصماته على المدن السورية، من شكل البيوت إلى الأسواق الشعبية إلى التكايا والمساجد وغيرها، حتى الاستعمار الفرنسي الذي كان بقاؤه محدودًا قياسًا بالعثماني إلا أنه ترك بصماته أيضًا نراها في كل المدن السورية، أما ما حصل بعدها، وبعد الجلاء وابتلاء سوريا بأنظمة عسكرية وانقلابات عديدة، فقد تجمدت الحركة العمرانية، ولحقتها مرحلة الخراب. صار التعدي على التاريخ والأبنية والمنشآت القديمة يجري على الملأ لصالح المتنفذين والمستفيدين من حالة الفساد التي كانت تتعاظم، واكب ذلك زحف الريف المنهك والمفقر والمهمل إلى المدن وبناء العشوائيات أمام أعين الحكومة، في الوقت الذي كانت فيه المدن تتوسع بحكم الضرورة السكانية بشكل فوضوي من دون أية دراسة خبيرة أو اهتمام مسؤول، فراحت مدننا تتحوّل شيئًا فشيئًا إلى كتل من الفوضى والبشاعة، تنظيم وتنفيذ من دون أي غاية ترتجى أو أيديولوجيا مهتمة.
لا أحكي عن التنفيذ السيئ الذي يتحالف فيه الفساد والرشوة والاستهتار وانعدام المحاسبة، بل أحكي أيضًا عن الرؤية الضيقة والتصوّر القاصر والدراسة الفقيرة والإستراتيجية الممسوخة لأي مشروع، فالشوارع تُشَقّ من دون يُوضَع في الحسبان ازدياد الكثافة السكانية وعدد السيارات، ومن دون بنى خدمية، ومن دون ساحات ومواقف للسيارات، العقد المرورية تصبح وحدها أزمة بعد شهور من تدشينها للعمل، الأبنية السكنية لا تحمل أي هوية أو قيمة جمالية، كل بيت أو شقة في بناء يلوّن شرفته أو واجهته كما يريد، وكل مالك له أن يعدّل كما يحلو له، ومداخل الأبنية كارثية، وليس هناك مرافق عامة للساكنين، هي كتل إسمنتية تنهض بطريقة أو بأخرى، المهم أن تدفع الرسوم وأن تغض الطرف ضابطة البناء، مدن تكابد وتختنق وتهصر أرواح ساكنيها في هذه الفضاءات القاتلة من القبح والبشاعة والحصر. هذا في الأحياء النظامية والمرخّصة، أما العشوائيات فحديث آخر. شكل المدينة، وأمراضها التي تمكنت منها في العقود الأخيرة، وتحولها إلى أماكن إقامة شاقة لأفراد الشعب كان سببًا من أسباب الاحتقان في تقديري، وإذا كان الحديث عن الغضب الشعبي ليس حديثه هنا، فإن الواقع الدامغ على الانهيارات المتلاحقة التي جاءت الحرب وأتت على الباقي من المدن لتزيدها يفرض أن يكون هناك خطة ما أو تصور ما للمستقبل.
لا ينقص السوريين قدرات إبداعية ومؤهلات تساعدهم في الابتكار، فبأي ملعب يجب إلقاء الكرة؟ هل يمكن فصل هذا الهدف عن بقية الأهداف المُلحّة للشعب؟ لا يكفي التفكير في تغيير النظام لأن الثورات ترنو إلى قلب الواقع رأسًا على عقب، الثورة تتحقق كل يوم، بل يجب أن تتحقق، إنها صيرورة من الأفعال الدائمة، وليس من الحكمة طرح حلول لأي مشكلة على المستوى الذي بدأت عليه، إن عشر سنوات من الحرب والدمار كفيلة بخلق وعي جديد، وتطلّع إلى مستقبل تتوجه الأنظار والاهتمامات والانشغالات فيه إلى إعادة ترتيب كل شيء وفق رؤية تتماشى مع العصر ومفتوحة على المستقبل، وهذا يتنافى مع تجميد الحالة في شكل وحيد لا يمكن تسميته بغير صراع على السلطة من دون أي برنامج. هل يتشكل ائتلاف للمبدعين من معماريين ومهندسين وفنانين وحرفيين ومخططين واجتماعيين وحتى أدباء وفلاسفة بين السوريين، بدلًا من ائتلاف قوى الثورة الذي لم يقدّم إلا المساهمة في انزلاق البلاد إلى هذه الهاوية؟ ألن يكون أسلم وأجدى وأنبل من أجل مستقبل سوريا والسوريين؟ أسئلة في البال.

بواسطة سوسن جميل حسن - كاتبة سورية | مارس 1, 2021 | مقالات
كنّا صغارًا نختلق دائمًا ما يسلّينا ويفرحنا بروح جماعية عالية ولهفة دائمة التوهج إلى اللعب، كان لدينا مساحة كبيرة للحلم ولم نكن نملك أجهزة فائقة الذكاء أو ذكية، حتى التلفزيون الذي دخل حياتنا ولم يغتصب أحلامنا دفعة واحدة، كان كسحر انسلّ من كيس ساحر في الغيب وتربّع في أفضل مكان في البيوت ليأسر قلوب الكبار والصغار، ننتظره بلهفة عندما كان البث على دفعتين بالأبيض والأسود.
كان كثير من الألعاب التي نلعبها على علاقة مع الكرسي، لعبة «كرسي كراسي» مثلًا التي كانت تقوم فيها فتاتان، يعني أربع أيدٍ تتشابك وتقبض كلّ يدٍ على ساعد اليد الأخرى لتشكّل الأيادي الأربع مربّعًا يشبه مقعد الكرسي، ثم نُجلس واحدة من المجموعة عليها ونرفعها وندور بها ونحن نغني لها كرسي كراسي عمّي جراسي جاب الطرحة حطّا ع راسي.. إلخ، وسط هرج ومرح يلقينا في موجة فرح عارمة. أمّا لعبة الكراسي الموسيقية فكنّا نلعبها وكأنها صُممت لأجلنا ولم نكن نعرف أنها عالمية ويوجد أطفال آخرون في بقاع الأرض المترامية يلعبونها، إلّا متأخرين، وكان الحماس يتملّكنا جميعًا لنفوز بالكرسي وسط تزاحم ومنافسة حامييْن.
وأمّا اللعبة الأكثر صرامة وجدّية، وكانت تتسلّل رهبتها إلينا معزّزة الخوف الذي كانت أسرنا تباشر زرعه في نفوسنا باكرًا لتشاركها المدرسة فيما بعد تلك الرسالة القيّمة من أجل تربيتنا وتأهيلنا لنكون طيّعين مستقبلًا، ثم الشارع والجامعة والوظيفة وغيرها، فكانت لعبة كرسي الاعتراف، لم نكن قد سمعنا بفِلْم كرسي الاعتراف ليوسف وهبي، ولم تكن قد تكونت لدينا خبرة السينما بعد، كذلك لم تكن رواية كرسي الاعتراف للسعودي عبدالله الشاوي قد ظهرت، كنّا نُجلس الواحد/ة منّا إلى كرسي ونصنع جوًّا يليق بمهابة الموقف ونجعل الجالس/ة على الكرسي يعترف أو تعترف بكل الارتكابات، ولم تكن تنقصنا الحيل الطفولية الماكرة لأن نوجّه تفكير المتهم مسبقًا بالنسبة لنا إلى الساحة التي نريد، كان بعض منّا يبكي وهو يعترف بتلك الخطايا الصغيرة التي ارتكبها، ككذبة بيضاء مثلًا، ثم نعاود الكرّة على البقية فلا يبقى بيننا من على رأسه/ا خيمة أو غطاء إذ نصبح مكشوفين بعضنا أمام بعض، حتى تلك اللعبة التي يصدر فيها فرد من بيننا الأوامر، وكنّا نسمّيها قال المعلّم، كانت تتطلّب أن يجلس الموكل إليه مهمة إصدار الأوامر أن يجلس على كرسي ثم يصدر أوامره الاستبدادية علينا بطريقة عكسية.
كان الانطباع الذي ترسّخ في وجداني منذ ذلك الحين أن الكرسي شيء فردي، أو بمعنى آخر لا يمكن لاثنين أن يجلسا عليه، بالرغم من أننا فعلناها صغارًا عندما كانت الأمكنة أقل من عدد الموجودين، وجلسنا في أحضان ذوينا أيضًا إنما على كرسي واحد فقط، لكنه في الوقت ذاته هو شأن شخصي وفردي في ظرف مؤقت مرصود لوقت اللعب فقط، فما إن تنتهي اللعبة حتى يعود الكرسي إلى شأنه كموضوع عام، لنا جميعًا حق استخدامه بالتشارك مع البقية.
كان في بيتنا كراسيّ، كغيري من رفيقات الطفولة، معظمها من الخيزران، وعندما دخلت المدرسة كان كرسيّ المعلمة في الصف من الخيزران وكان له مهابة في نفوسنا فلا نجرؤ على الاقتراب منه حتى قبل دخول المعلمة، وكان يلفتني أن كل تلك الكراسي من الخيزران التي رأيتها في تلك الفترة تتوزع على ثلاثة أشكال؛ مقعد مشغول بطريقة جميلة تمنحه شكل الدانتيل المخرم ومسند للظهر يميز كل نموذج من غيره. لم يكن في بيتنا حينها غرفة طعام متكاملة، كان لدينا طاولة وحولها كراسيّ من الخيزران، وإذ تدلّل أمي الكراسيّ أو الضيوف الذين سيجلسون عليها كانت تضع عليها طراريح قطنية في البداية ثم تحوّلت إلى إسفنجية.
لكن ما كان يبهجني أكثر هي الكراسي التي أسرع للجلوس عليها بمجرّد وصولنا إلى الضيعة لزيارة جدّتي وجدّي، أوّل من كنت ألمح بمجرد اقترابنا من بيتهما هو جدّي الجالس أمام البيت على مصطبة واسعة فوق كرسيّ منها، كرسيّ من القش المجدول على مقعدها، ومسندها عبارة عن عوارض خشبية بين قائمتين تتماديان إلى الأسفل لتشكّلا خلفية الكرسيّ. كنت مغرمة بهذه الكراسيّ، وبتلك التي تبدو كبناتها، الكراسيّ المنخفضة بلا مسند مصنوعة من القش أيضًا.
رهبة وحيرة
صار أمر الكرسي يشغلني بعد أن كان في محيطي الصغير يومها له شكلان فقط شائعان في المدينة، في البيوت وفي المقاهي والمطاعم وفي المدارس وكل الأمكنة، كرسيّ الخيزران وكرسيّ القش، مما تطلب وجود حرفة تقوم على إصلاح العيوب التي يحدثها الزمن، فلطالما أحضرت الكراسيّ المعطوبة إلى الحِرفيّ ليشدّها، هكذا كانوا يقولون «يشدّ الكراسي» أو ليلف عليها حبال القش بدلًا من التالف منها، لكنّ أمر الكرسيّ حيّرني وولّد رهبة في نفسي في المرّة الأولى التي سمعت فيها آية الكرسي، وقد كان اسمها يتردّد أمامي كثيرًا على ألسنة الكبار، عندما يكون الشخص مصابًا بالرعبة تحديدًا، يقولون له: اقرأ آية الكرسي، وعندما تلتها المعلمة علينا في المدرسة الابتدائية انتابتني رجفة وكبر السؤال في رأسي الطفولي، بالأخص عندما تلت ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾، فأعجز عن تصوّر شكل الكرسيّ الذي يتسع السماوات والأرض، لم يكن عقلي الطفولي يستوعب معنى المجاز حينها، لكن صورة غامضة ترتسم في خَلَدِي تأخذ شكل كرسيّ عملاق لا أستطيع تلمّس حدوده لكنني جالسة عليه مع المخلوقات كلّها فيتحوّل الشعور بالرهبة إلى نوع من الاطمئنان الملتبس مثل يقين عليّ الإيمان به كمسلمة لا تقبل السؤال.
كبرت وصار الكرسيّ يتغير، وصارت أشكاله تتعدّد، وصرت أسمع توصيفات متنوعة له، كرسيّ المكتب، كرسيّ دوّار، كرسيّ سفرة، كرسيّ البلكون، كرسيّ أطفال، … إلخ. وصرت ألتفت إلى هذه الأنماط من الكراسيّ التي تتغيّر من شكل إلى آخر ومن مادة إلى أخرى، لم يعد الخشب وحده مرصودًا للكراسي، صار هناك الحديد والكروم وكثير من اللدائن يتحالف معها الجلد أو المخمل أو بعض أنواع القماش الفاخر، ومنها تلك المطعّمة بالصدف المشغولة بأيدي مَهَرة الشام وحرفيّيها الفنانين، لكن أكثر ما كان يستفزني تلك البلاستيكية التي غزت حياتنا وتمادت على بيئتنا، ولم يعد الأمر يتطلّب الانتظار بعد أن يوصّى النجار على تفصيلها إلى أن يأتي دور المشتري، صارت الكراسيّ تعرض في صالات متخصصة بالأثاث الجاهز، منها ما هو مخصّص للمكاتب ومنها للبيوت ومنها للمتنزهات أو الحدائق والشواطئ، صار كل شيء معروضًا بغزارة مربكة، وصرنا أسرى النموذج الذي يصمّمه المتخصصون ويطرحون علينا قيمًا جماليّة تحاصر خيالنا ولم نعد قادرين على ابتكار نماذجنا الخاصة، في كل شيء.
قبل أن أتحرّر من موضوع الكرسيّ كوسيلة استعمالية، أثار مخيّلتي كرسيّ غوّار الطوشة الذي كان يعرض في أواخر ستينيات القرن الماضي، بلهاثه الدائم خلف الكرسيّ الذي يحوي في مقعده المنجّد الكنز الذي خبأته فيه جدّته، لم أكن قد سمعت برواية «الكراسيّ الاثنا عشر» للكاتبين السوفييتيَّيْنِ إيلف وبتروف حينها، لكن الكرسيّ في المسلسل أثار اهتمامي وأنا الطفلة حينها، فأخذت أرسم أشكالًا للكرسيّ على أوراق دفاتري، لأكتشف أن كرسيّ الخيزران وكرسيّ القش وحدهما يتكرّران في رسوماتي، مثلما لو كانا النموذج الأمثل بأبسط حالاته وبكامل طاقته الجمالية الكامنة.
بقي للكرسيّ مكانة خاصة في نفسي، لم أتخلّص من رسمه بأشكال ترنو إلى مرحلة الطفولة حتى وأنا بعمر التقاعد، بعدما أمضيت ما يقارب الثلاثين عامًا في مهنة الطب، بدّلت خلالها أشكالًا عديدة من الكراسي، ونلت ما نلت بسبب جلوسي لأوقات طويلة من آلام في عمودي الفقري، وأنا التي كانت تنصح مرضاها باختيار الكراسيّ المناسبة والوضعيات المناسبة وتجزئة أوقات الجلوس الطويلة باستراحات متكرّرة من أجل حماية الجسد، إلى أن صرت مُسَمَّرة أمام جهاز اللابتوب مستعبدة من قبله لأجل الكتابة، وإلى أن وصلت مع العالم إلى عصر كورونا فصارت معظم الأشغال تنجز عن بعد، وصار الكرسيّ أمرًا أكثر من جبّار.
لكن الكرسيّ تعدّد كثيرًا في بالي، ولم يعد ذلك الشيء المكوّن من مقعد ومسند، ليس لأنه صار اختصاصًا قائمًا بذاته تسخّر له الأدمغة المبتكرة والمخيّلات الخلّاقة وصار يمكن أن يكون أكثر من أربعة أرجل، مقعد ومسند للظهر بكثير، مثلما صرّح مسؤول في معرض «الكراسيّ والتصميم» في بيناكوثيك دير مودرن في ميونيخ ذات مرّة فقط. بل لأنه صار هناك كراسيّ مجازية، لكل واحد سطوته، ولم يعد الكرسيّ وسيلة للجلوس فقط. أخذت المفردات تتكرّر وتتعدّد أمام وعيي كلّما كبرت وزادت اهتماماتي واتسعت النوافذ التي أطلّ منها على العالم أو يقتحمني العالم من خلالها، وراح الكرسيّ يحتلّني من جديد إنما بأسئلة أخرى. كرسيّ الطالب، كرسيّ الأستاذ، كرسيّ البابوية، الكرسيّ الرسولي، الكرسيّ الرئاسي، وغيرها. لكن أكثر ما أثار فضولي وتفاعل في نفسي كان الكرسيّ الكهربائي، الكرسيّ الألماني، وكرسيّ الرئاسة.
الكرسيّ والعنف
لا أعرف بالضبط تاريخ الكرسيّ ومنذ كم من الزمن دخل حياتنا كوسيلة للجلوس، لكنني قرأت ذات مرّة أن الكرسيّ الألماني، الوسيلة الشائعة في تعذيب المعتقلين السياسيين خاصة في الأنظمة القمعية التي لا تعترف بوجود صوت معارض وحيد، تعود جذوره إلى القرون الوسطى، يمكن قبول هذا الافتراض انطلاقًا من التاريخ البشري المترع بالعنف والخيال الذي لا تحدّه حدود في ابتكار أساليب التعذيب والتوحش. من شهادات المعتقلين الذين وثقوا تجربتهم في المعتقلات، وبعض الأعمال الأدبية التي قامت على هذه الثيمات أو القصص، يمكن وصف الكرسيّ الألماني بأنه أداة تعذيب تقوم على تقييد الشخص بوثاق محكم من يديه وقدميه إلى الكرسيّ المتحرك الذي بحركته يجعل الجسد يتمدّد إلى أقصى درجة تسمح بها مرونته ثم المتابعة بالعكس حتى «تُقرف» رقبته أو تتكسّر فقراته، يا لهول وفظاعة التوحّش. ربّما يستحقّ أن يكون كتاب للكاتب السوري أحمد العمر يحمل اسمه «كرسيّ ألماني» عنوانًا.
أمّا الكرسيّ الكهربائي، حيث يُقيّد المعتقل إلى كرسيّ ويُمرّر في جسده تيار كهربائي مدروس التوتّر بشكل يبقى المعذَّب معه قادرًا على الإحساس بالألم، أو يُستخدم في الإعدام، فيستدعي اسمه إلى وعيي فِلْم «The Green Mile»، للممثل البارع توم هانكس، حيث مشهد الإعدام لرجل أسود بريء بواسطة الكرسيّ الكهربائي وهو يطلب عدم تغطية وجهه كي يستقبل موته مفتوح العينين، ما زال يثير في داخلي خليطًا من المشاعر الحارقة المربكة كلّما تذكّرته وكأنه يحدث أمام عيني ويقبض على روحي في اللحظة.
لكن الكرسيّ الرئاسي بقي لغزًا بالنسبة لي، لم أستطع تكوين صورة له أحمّلها ما تستطيع رفعه من معانٍ لها علاقة بالرئاسة، لم تكن الصورة منسجمة في مخيلتي مع الشكل الأوّلي الذي أحتفظ به في ذاكرتي وبين رموز وعيي للكرسي، فكيف يكون للرئيس، أيّ رئيس، كرسيّ يخصّه؟ وبِمَ يفرق هذا الكرسيّ عن كراسينا، نحن الناس العاديين؟ ومن أي مادة يصنع هذا الكرسيّ الذي يمتلك أحيانًا سطوة ومهابة تختصر كل ما تعني الرئاسة من دلالات مفهومية؟
لم أكن أقتنع أن الكرسيّ يمكن أن يكون ملكًا شخصيًّا إلّا إذا كان صاحبه قد اشتراه لنفسه من ماله وليستخدمه كما يحلو له في خدمة نزعاته ورغباته الذاتية المنفصلة عن الآخرين، لكن كرسيّ الرئاسة أمر مختلف؛ فيه من الغواية والجاذبية ما يكفي لأن تجري أنهار من الدماء في سبيله، وأن يكون محطّ أنظار أطراف صراعات تدور حوله مثلما صوّرته رواية «كرسيّ الرئاسة» للروائي المكسيكي كارلوس فوينتس كحدث مستقبلي يتنافس الساسة ويتآمرون فيها للوصول إلى كرسيّ الرئاسة، وأن يكون الطريق إليه مكلفًا، وقد يؤدي إلى إشعال حروب ودمار أوطان، وأنه يمكن أن يتحوّل إلى إرث يتوارثه الأبناء عن الآباء.
لكن هذا الكرسيّ الذي يتبوّأ قمة الهرم القيادي في أي دولة، له مزايا مغايرة في الدول التي قطعت شعوبها أشواطًا في تكريس مفاهيم تبنى عليها الدول الحديثة والمجتمعات المستقرة، كرسيّ لا يُفتح إليه الطريق إلّا بانتخابات يتمسك بها الشعب كحق من حقوقه، ويسعى منطلقًا من واجب الدفاع عن هذا الحق وعن مستقبل بلاده وأبنائه إلى انتخاب من يراه مناسبًا أو جديرًا للجلوس على هذا الكرسيّ من أجل التفرغ لقيادة الدولة لصالح الشعب. في الدول الحديثة والأنظمة الديمقراطية لا مكان للتأبيد على كرسيّ، القول الحكم هو أصوات الشعب، والقائد المنتمي إلى شعبه الذي يعدّ منصبه وظيفة عليا يؤديها، يتنحى عندما يشعر أن الكرسيّ صار ينوء تحته، أو أنه لم يعد قادرًا على الجلوس لمدة أطول فيتنحى ويفسح لغيره المجال والزمن القادم، وها هي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نموذج يُقتدَى أمام أعين العالم؛ المرأة التي قادت بلادها لأربع ولايات متتالية وكانت سياستها ناجحة ومؤثرة، تقرّر أن تنهض عن كرسيّ الرئاسة في العام القادم عندما ستنتهي ولايتها الأخيرة، وقد قدّمت أقصى ما لديها، أنغيلا ميركل التي سيذكرها التاريخ بأنها مرّت بهذا الكرسيّ فأزهرت بلادها في ولايتها.

بواسطة سوسن جميل حسن - كاتبة سورية | نوفمبر 1, 2019 | مقالات
إن المتغيرات السريعة والدراماتيكية التي ألمت بالمدن العربية في سنوات الحروب التي طالت دولًا عدة، وبخاصة بلدان ما سُمِّيَ بالربيع العربي، ومنها سوريا على وجه الخصوص، يطرح على الطاولة سؤال الرواية والمدينة من جديد، ويلحّ على استنطاق الواقع المدمر بما يمكن أن تكون عليه العلاقة الجدلية بين المدينة والرواية.
إذا كان عصر النهضة العربية قد نجمت عنه ولادة الرواية عن المدن التي تحولت نحو التحديث وأثرت في الوعي الذي انقسم مستويين متقابلين؛ الوعي القديم بثوابته التقليدية، والوعي الجديد المفتوح على التحديث ومتحولاته، فإن العصر الحالي بما يمور من حروب وعنف وتدمير طال البنيان والمجتمع وكل منظومات الحياة، وأحدث انقطاعًا في التدفق الزمني للمدن، بل يمكن القول: إن هذا التدفق كان قد تعرض إلى عوائق في العقود الماضية التي تلت عصر النهضة الواعد أدت إلى تباطؤ جريان الزمن، نجم عنه استنقاع لم تكن المدن بمنأى عنه، المدن بفضائها الإنساني وما يستتبعه من نشاط وإنتاج وَسَمَا تلك المرحلةَ.
لو وضعنا الزمنين، زمن النهضة العربية وزمننا الحالي، بعضهما مقابل بعض لوجدنا أن هناك خطًّا بيانيًّا يسير متعاكسًا بالرغم مما أنجزت البشرية من تقدم سريع وإنجازات في القرن المنصرم كان أعظمها الثورة الرقمية التي وسمت النصف الثاني منه، وصار العالم يعيش ضمنها اليوم. كذلك التحولات الكبيرة اللاحقة للحرب العالمية الثانية ومنها أن شعوبًا عديدة استفادت من تجاربها ونهضت من تحت ركامها وبنت دولها التي تعدُّ اليوم من الدول القوية الراسخة، كألمانيا واليابان. وأسهمتا في رفد الحركة الأدبية في الرواية وغيرها من الأجناس بأعمال تدلُّ على التجديد المستمر المترافق بحركة نقدية جادة.
التغيرات الحداثية التي طالت المدن العربية كان لها علاقات جدلية مع أقطاب التنوير حينها، علاقات نجمت عنها أنشطة ثقافية عدَّة واكبت الحداثة التي كانت بدأت تضع بصماتها على المدن كنشوء الصحف أو الجرائد وتوسعها وإرهاصات الرواية العربية، ومساهمات الجرائد حينها في إشهار هذا النوع الأدبي وتقديمه إلى جمهور متلهف للجديد، مقابل جمهور آخر يخشى من التحديث ويتمسك بالثوابت التقليدية في وجه المتغيرات. كذلك المقاهي الثقافية التي باتت اليوم جزءًا من سردية تاريخية لتلك المدن، واكبت هذه المتغيرات التطور العمراني الذي كان يرنو إلى بناء المدن الحديثة ذات الوظيفة الاجتماعية مع التمسك بالقيمة الجمالية وإعطاء فن العمارة وهندسة المدن الأولوية، دعم هذه الإنجازات وجود أنظمة حكم اهتمت بمدنها، حتى لو كان الدافع النرجسية والشعور العارم بالملكية، من خلالها كان الحكام يتطلعون إلى أن يباهوا الأمم الأخرى بها.
لا يمكن الاقتداء بتلك التجارب الريادية اليوم، فمشاكلنا تختلف جذريًّا عن تلك الحقبة، وتغيرات المدينة ارتبطت بجريان الزمن، والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على غير ما هي عليه اليوم. فميلاد المدينة الحديثة في ذلك الزمان واكبه نمو واكتمال الوعي المديني مرتبطًا بالطبقة الوسطى التي صارت في عصرنا الحالي آيلة إلى التلاشي بعد الفرز الصاعق الذي أحدثته الحرب، وقبلها عقود الفساد الحكومي والاجتماعي في طبقات المجتمع؛ إذ ظهرت طبقة من أصحاب الأموال منبتّة من الفراغ القيمي والفكري احتكرت قطاع المال والأعمال من دون أن يكون لديها مشروع وطني، لتأتي الحرب وتقضي على ما بقي من أطلال الطبقة الوسطى وتعيد الفرز والتصنيف من جديد، ويصبح تجار الحرب هم المرشحين مستقبلًا لتسلُّم الاقتصاد وإعادة الإعمار وامتلاك مصير المجال العام، مع الأخذ في الحسبان مدى افتقارهم للمعرفة والعلم والقيم.
بما أن المدينة وعاء سياسي وثقافي وإبداعي لتعدد الأجناس والأعراق والطبقات والمعتقدات والثقافات وأنواع الإبداع المختلفة، فإنها تخلق وعيًا مدينيًّا ينجم عنه تغيير العلاقات الثقافية وأدوات إنتاج المعرفة، وهذا ما يسم عصر النهضة، لكن ذلك العالم الصاعد الذي رمزت إليه المدن المتحولة كان قد انهار في مرحلة لاحقة ولم يعد يقوى على الصعود بعد أن دَوَّتِ الهزائم في فضاء المنطقة العربية، وبخاصة بعد هزيمة حزيران 1967م، وما نجم عنه من أدب سُمِّي بأدب النكسة أو أدب الهزيمة، تلك الهزيمة التي أسست لمرحلة جديدة في ظل أنظمة عسكرية شمولية كانت قد صادَرَت الحريات منذ وصولها إلى الحكم وقبل النكسة، واستمرت هذه الممارسات مواكبة نمو المدن الورمي الفوضوي وازدياد العشوائيات حول مدن النهضة السابقة كسوار من الفقر والبؤس والجهل.
لقد كانت الرواية أكثر وأسرع الأجناس الأدبية إلى تلقف الزلازل التي عصفت بالمنطقة، وبخاصة الزلزال السوري منذ بدايته أو بالأحرى منذ تفشي العنف وتحول حركات الانتفاضة الشعبية نحو العسكرة واشتعال الحرب وانهيار المجتمع بطريقة دراماتيكية، وكانت القضايا التي طرحتها غالبية الروايات هي العنف والتشريد واللجوء والقمع والطائفية ومظاهر أَسْلَمة المجتمع والنزعات العنصرية، حتى يمكن القول: إن بطل الروايات الأكبر كان العنف، وإن بعض الروايات تأثرت بسِمَة العصر «الصورة والمشهدية»، فكانت كما لو أنها كاميرا تجول في الأماكن، وبعضها كأنها وثيقة تدون الأحداث، وقسم منها مثلما لو كانت صراعًا عقائديًّا أو أيديولوجيًّا يجري بين شخوص الرواية، منها ما رسم بانوراما توثيقية شملت معظم المدن السورية في المرحلة الأولى من الحراك عندما كانت المظاهرات تعم المدن أيام الجُمَعِ. وبعضها رسم للمدن التي غادرها صورًا من الذاكرة مغمسة بالحنين والنوستالجيا في مقابل صور اليوم التي يشاهدها على الشاشات أو يسمعها من أفواه الذين طفروا في تغريبتهم.
تنوعت مصاير المدن السورية، بين مدمَّرة أو مهجورة أو تحت سيطرة نفوذ أجنبي أو فصائل لها طرق إدارتها الحياة. وما بقي تحت سيطرة النظام الحاكم لكنها تعرض لتغيير في هويته لا يمكن وصفه بشكل نهائي لأن التخلق على هامش الحرب ما زال مستمرًّا وفق أخلاقها. لكن يمكن القول: إن مصير المدن بأفضل حالاتها صورة واقعية لديستوبيا تفوق الخيال.
لكن الحديث عن المدن الموعودة، المدن التي تنتظر على حدود دمارها ونزيف أرواح من غادروها حيتان المال المتلهفة لتكويم الأرباح من وراء بنائها، المدن التي سوف توضع لها مخططات وفق ثقافة الجهات المستثمرة وتوجهاتها، ولن يكون للهوية السورية مكان فيها، الهوية التي انشطرت وتعددت وضاقت مساحتها، صارت هويات مناطقية أو تنتمي إلى مرحلة ما قبل الدولة في بعض أجزائها، كيف سيكون شكل المدينة الجديدة، أو المدن الجديدة؟ وأي فضاء ستمنح للوعي المديني ووعي الذات والخصوصية؟ في سوريا أثناء الحرب أحدث الزلزال هوة سحيقة العمق بين الحاضر الذي كانت عليه المدن والمستقبل المتوقع، هناك انقطاع للزمن. ليست الصدمة صدمة الحداثة التي كانت محرضًا للوعي المديني في عصر النهضة المذكور، لكنها صدمة وجودية هزت الوعي وخلخلت أركانه، فالمدن الموعودة المنتظرة، لا لتنهض من تحت ركامها كما عنقاء أسطورية، بل تنتظر انتظار العاجز عن مصيره مثل جريح يتكوم فوق ركامه لتمتد أية يد إليه ولن يمتلك ترف الاختيار، هذه المدن التي يفترض أن لها سكانًا سيعودون إليها بعد إعمارها، هي التي ستصنع الصدمة الثانية، ومعظمها لجأ ساكنوها إما إلى دول الجوار حيث تلقفتهم حياة اللجوء القاسية بشرط مهين لإنسانيتهم، ولد جيل في تلك المنافي المنافية للظرف الإنساني، جيل بدأ يكبر ويشكل رموز وعيه بعيدًا من العصر، بلا مدارس بلا طفولة بلا أمان بلا عناية صحية بلا ألعاب بلا حكايات غير حكايات الموت والدمار والضغينة والثأرية، هذا الجيل الذي ستمنُّ عليه نهايات الحروب وثمار طاولات التفاوض بعدها بعودة إلى مأوى وإلى مدن وأحياء عليه أن يرسم فيها فضاءه الخاص، لن يمنح ترف أن يمارس حلمه وخياله في تصميم بيئته، بيته شارعه الحي الذي يعيش فيه، الأسواق، الساحات، الميادين، المتاجر، دور السينما، المسارح، دور العبادة، أماكن الترفيه، أماكن التسلية؛ كل هذا سيهبط عليه من فوق، من إرادة المال والاستثمار والربح، من أموال تجارة الحروب التي كان ضحيتها وثمنها الباهظ.
أي وعي مديني وأي علاقة بين الساكن الجديد في أرضه القديمة عائدًا من تغريبته القاسية إلى أطلال أزيلت أنقاضها وارتفعت مكانها أبنية أخرى وأحياء وشوارع أخرى، وجيران آخرون؟ ما الفضاء الإنساني المتوقع أن يتشكل فوق جمرات مطمورة تحت رماد النفوس التي التهمتها حرائق الحرب، وأي مجتمع ينتظر أن يتخلَّق بعدما خلخلت الحرب بنيانه المهتز أساسًا وهتكت نسيجه المهلهل؟ كيف ستنشأ العلاقات في مدن تتشكل بطريقة قسرية بعيدًا من جريان الزمن وعلى صدى انفجاراته التي صدّعت الوعي والذاكرة؟
سيكون لهذه المدن تاريخها الجديد يستبطن تاريخًا أعمق، بل سيكون لكل مدينة سورية تاريخ مختلف سيبدأ من جديد، مثلما سيكون لكل منها روايتها، لن تكون هناك رواية سورية واحدة، ستكون روايات، لكن السؤال الأكثر إبهامًا وغموضًا سؤال العلاقة بين المدينة والرواية.


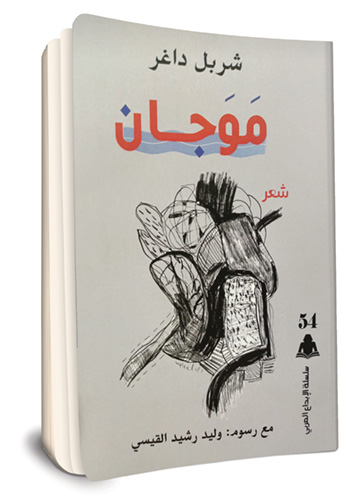 الموسيقا تشغل نصوصه وتتصاعد ألحان خفيّة من إيقاعها، مع صور يتضافر بعضها مع بعض لتشكّل نصوصًا سردية، وهو ما يستدعي السيناريو السينمائي، كما في معظم نصوص القسم الأول «أيها الموت، يا جاري الأليف»، إذ تبدو اللقطات الشعرية كما لو كانت لقطات كاميرا، يشبكها خيط خفي موغل في عمق النصوص، وما يغلب في شعره اللقطات الخارجية، التي تنظر إلى العالم من خلال عدسته الداخلية، فقصيدة «قبل الموت بقليل» نصّ يفتح في مقدمته على المشهدية السينمائية، على الحركة، ترصدها كاميرا خلف عدستها مصوّر يسبر غور النصّ، ليفضي هذا المشهد إلى أسئلة الوجود الفلسفية، الحياة/ الموت. «ليس للموت ما يعد به، ليس له غير ما يستردّه من ديون الحياة المستحقة».
الموسيقا تشغل نصوصه وتتصاعد ألحان خفيّة من إيقاعها، مع صور يتضافر بعضها مع بعض لتشكّل نصوصًا سردية، وهو ما يستدعي السيناريو السينمائي، كما في معظم نصوص القسم الأول «أيها الموت، يا جاري الأليف»، إذ تبدو اللقطات الشعرية كما لو كانت لقطات كاميرا، يشبكها خيط خفي موغل في عمق النصوص، وما يغلب في شعره اللقطات الخارجية، التي تنظر إلى العالم من خلال عدسته الداخلية، فقصيدة «قبل الموت بقليل» نصّ يفتح في مقدمته على المشهدية السينمائية، على الحركة، ترصدها كاميرا خلف عدستها مصوّر يسبر غور النصّ، ليفضي هذا المشهد إلى أسئلة الوجود الفلسفية، الحياة/ الموت. «ليس للموت ما يعد به، ليس له غير ما يستردّه من ديون الحياة المستحقة».





