
بواسطة عبدالسلام بن عبدالعالي - كاتب مغربي | يناير 1, 2024 | بورتريه
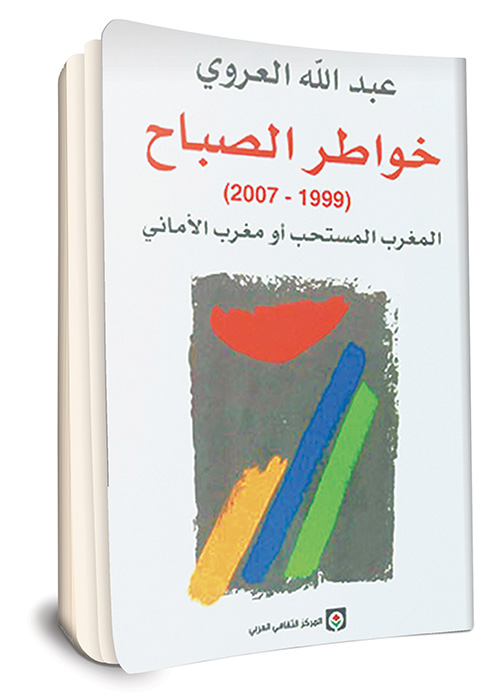 نستطيع أن نقول: إن البورتريه الذي رسمه عبدالله العروي للفنان البلجيكي ر. ماغريت في الجزء الأول من كتابه «خواطر الصباح»، هو، إلى حد ما، «بورتريه ذاتي». نقرأ في هذا الكتاب: «روني ماغريت: لم أتأثر بألوان فنان مثلما تأثرت بأعماله التي تمزج الحلم والعقل. لوحاته، ملصقاته في الواقع، تمثل أحلام رجل رصين متعقل طلق الرومانسية بعد، أو قبل، أن يعرفها. أثر فيَّ لأنه أبعد ما يكون عن ميلنا الغريزي إلى دغدغة العواطف. لا أتصوره يضحك أو يبكي، قد يمزح وهو مقطب». يحكي ابن أخي العروي، الكاتب فؤاد، في إحدى مقابلاته التلفزيونية، أنهما التقيا مرة في معرض باريس، وأنه عندما قدم عمه لناشره الفرنسي مازحًا، علق عبدالله العروي قائلًا: «هذا هو الوحيد في عائلتنا الذي يمزح، أنا يتعذر علي ذلك، وحتى إن مزحت فمقطبًا».
نستطيع أن نقول: إن البورتريه الذي رسمه عبدالله العروي للفنان البلجيكي ر. ماغريت في الجزء الأول من كتابه «خواطر الصباح»، هو، إلى حد ما، «بورتريه ذاتي». نقرأ في هذا الكتاب: «روني ماغريت: لم أتأثر بألوان فنان مثلما تأثرت بأعماله التي تمزج الحلم والعقل. لوحاته، ملصقاته في الواقع، تمثل أحلام رجل رصين متعقل طلق الرومانسية بعد، أو قبل، أن يعرفها. أثر فيَّ لأنه أبعد ما يكون عن ميلنا الغريزي إلى دغدغة العواطف. لا أتصوره يضحك أو يبكي، قد يمزح وهو مقطب». يحكي ابن أخي العروي، الكاتب فؤاد، في إحدى مقابلاته التلفزيونية، أنهما التقيا مرة في معرض باريس، وأنه عندما قدم عمه لناشره الفرنسي مازحًا، علق عبدالله العروي قائلًا: «هذا هو الوحيد في عائلتنا الذي يمزح، أنا يتعذر علي ذلك، وحتى إن مزحت فمقطبًا».
من الطرائف التي حكاها فؤاد العروي في هذه المقابلة أنه غالبًا ما يشعر، عند مجالسة عمه أنه يصبح أكثر ذكاء. فكأنما تدفعه تلك المجالسة، هو الكاتب الحائز على كثير من الجوائز الغربية وأهمها غونكور، وخريج مدرسة القناطر والطرق الباريسية، إلى أن «يدفع» بذكائه لمتابعة أحاديث عمه. لعلنا محتاجون، نحن كذلك، إلى شيء من هذا لمحاولة رسم بورتريه مفكرنا الكبير.
لا يمكن أن نرسم بورتريه العروي (1933-) بمتابعة علاقاته الاجتماعية، أو بحشره في سياق الفكر العربي المعاصر، وتحديد مواقفه ومكانته بين أقطاب هذا الفكر. ذلك أن المعروف عنه هو انعزاله، وكونه لا يحشر نفسَه مباشرة ضمن علاقات وسياقات. فعلى الرغم من أنه يقول: إنه يمارس النقد الأيديولوجي، فإن ما يميز كتاباته هو صمته فيها عما يجري بالقرب منه، وتفضيله محاورة البعيد على مجادلة القريب. لا يعني ذلك مطلقًا أنه لا يهتم بقضايا الساحة العربية ولا ينخرط فيها، كل ما في الأمر أنه، حتى عندما يود وصف تلك الساحة وتحليل ما يروج فيها، يكتفي ببناء نماذج ثقافية مثل «الشيخ» و«رجل التقنية» أو «رجل السياسة»، من غير أن يمثل لتلك النماذج بالأشخاص الأحياء الذين قد يكونون من ورائها. فما يهمه هو «اجتماعيات الثقافة» وليس «اجتماعيات المثقفين».
في التاريخانية
نستطيع أن نقول: إن السؤال الذي ما فتئ هذا المفكر يطرحه بأشكال متباينة، ومنذ الستينيات من القرن الماضي هو: كيف يستوعب الفكر العربي مكاسب العقل الحديث؟ وقد مهّد لإجابته عن هذا السؤال في كتابه الأول الأساس «الأيديولوجية العربية المعاصرة»، بأن فضَح النظرات الأيديولوجية التي نهجها المفكرون العرب على اختلاف مناحيهم للإجابة عن هذا السؤال، فرأى أن الطريق الوحيد لتجاوز هذا القلب الأيديولوجي، وتجنب الانتقائية والسلفية هو نهج سبيل التاريخانية بكل مقوماتها، أي: الإيمان بـ«صيرورة الحقيقة، وإيجابية الحدث التاريخي، وتسلسل الأحداث، ثم مسؤولية الأفراد عنها». لا بد إذًا من التسليم أولًا أن التطور التاريخي يخضع لقوانين لا يحيد عنها، وأنه يتجه وجهة واحدة لا تختلف من جنس لآخر، مما يمكن كل ثقافة من أن تتفتح على هذه الوجهة، ويسمح للمثقف والسياسي بأن يقوما بدورهما الإيجابي.
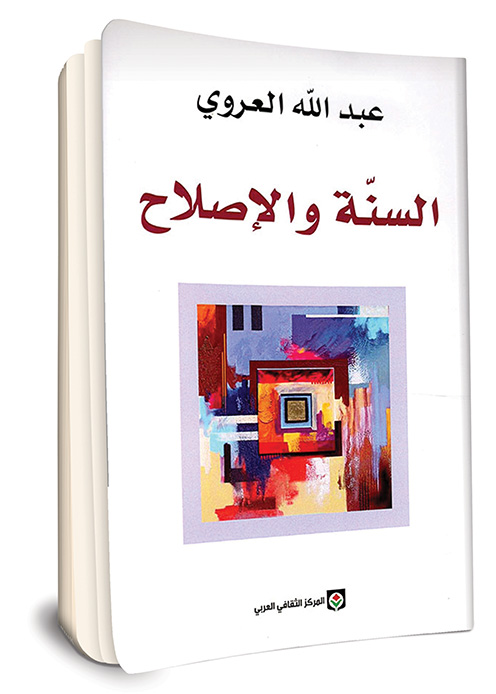 في كتاب «السنة والإصلاح» نستشف معنى للتاريخانية أكثر تركيزًا. فهي إيمان بقوة الزمن، إيمان بأن «الوقوف على البدايات يكشف حتمًا الدوافع والغايات»، إيمان بأن السابق يحدد اللاحق، إيمان بالتسلسل الزمني. (نقرأ في ص 28 من هذا الكتاب: «فالإلغاء التعسفي للتسلسل الزمني يدعو حتمًا إلى معاداة التاريخانية وتحويلها إلى نظرية عامة يسهل تفنيدها»). ثم إن التاريخانية إيمان بقوة الحدث. فالحدث هو الذي «يميز ما هو نيو، وما هو بوست».
في كتاب «السنة والإصلاح» نستشف معنى للتاريخانية أكثر تركيزًا. فهي إيمان بقوة الزمن، إيمان بأن «الوقوف على البدايات يكشف حتمًا الدوافع والغايات»، إيمان بأن السابق يحدد اللاحق، إيمان بالتسلسل الزمني. (نقرأ في ص 28 من هذا الكتاب: «فالإلغاء التعسفي للتسلسل الزمني يدعو حتمًا إلى معاداة التاريخانية وتحويلها إلى نظرية عامة يسهل تفنيدها»). ثم إن التاريخانية إيمان بقوة الحدث. فالحدث هو الذي «يميز ما هو نيو، وما هو بوست».
يميز العروي مع بنيديتو كروتشي، بين التاريخية l’historisme، التي تفسر كل حدث بشروط نشأته، وبين التاريخانية l’historicisme، أي التاريخية من الدرجة الثانية نوعًا ما، التي ترى بأنه في التاريخ الذي يصنعه البشر، وفي مستويات الفعالية جميعِها، لا وجود لمبدأ نظام وتوجه ممكن، إلا داخل التجربة التاريخية ذاتها. فالتاريخ ينظم نفسه بنفسه، وهو في الوقت ذاته تعالٍ ومحايثة. يكون محايَثَة طالما تجلى كفعالية واعية للإنسان، وهذا هو مستوى التاريخية، ويكون تعاليًا عندما يفرض نفسه كنظام ومثالٍ يُحتذى تحت طائلة الفشل، وهذا مستوى التاريخانية. التاريخانية مفهوم يستعمله إنسان العمل، والمنظر السياسي. عندما يؤلف ماكيافيلي «تواريخ فلورنسية»، فهو في نطاق التاريخية، أما عندما يكتب «الأمير» فهو تاريخاني.
وفي الحالتين كلتيهما، ليس من السهل الانفلات من التاريخ. فـ«وحدَه التاريخ، مثل المختبر في علوم الطبيعة، يمكن من الفصل بين الآراء المتعلقة بالإنسان ومصيره. بالإمكان دومًا تصور إمكانيات أخرى غير التي تمت بالفعل، إلا أن هذا يبقى مجال الفن». عند الوصول إلى هذه النقطة، يمكن للمرء إما أن ينكر البعد التاريخي، أو يُهمله، فيخوض في الفلسفة، وإما أن يعيَه بوضوح وينتهيَ بأن يتكيف معه مُخاطرًا بالتعرض لتهمة الانهزامية.
الأطروحة التي يعتمدها العروي إذًا هي أن كل مثقف عربي، إذا ما وعى، حق الوعي، الوضع الذي يعيشه، هو أيديولوجي عن طواعية وطيب خاطر، وبما هو كذلك، فإنه يسقط بالضرورة تحت نير التاريخ المشترك، ويكون فكره جدليًّا بالضرورة، وهذا الجدل يكشف له أن أفقه هو التاريخانية، بما هي استعادة واعية وإرادية، لكونها ضرورية، استعادة لفترة تاريخية سبقت معرفتُها، كما سبق تحليلُها والحكمُ عليها. هذه التاريخانية ذات المنحى العملي تجرّ من يعتنقها نحو أخلاق نفعية وفلسفة وضعانية. وهذه قد تؤدي إلى عدم الثقة في أي مشروع يرمي إلى استعادة الميتافيزيقا أو تجديد الأنطولوجيا. بهذا المعنى، ستغدو الفلسفة نوعًا من العمل الترفيهي. إلا أن التاريخانية، إذا اقتصرت على مجالها، لا يمكن تفنيدها؛ لأنها تعبر عن واقع مجرب. والأخبار تشهد دون انقطاع أنه من دونها، لا يمكن تصور نظرية للعمل السياسي.
يعتبر العروي النظرية فقط مرحلة في عملية الفهم، الهدف منها توضيح المفهومات قبل العودة إلى الواقع المشاهد. لحظة النظرية هي بالضبط الكشف عن هذه القدرة على الانسلاخ عن المؤثرات الموروثة والمفروضة، وعلى الرغم من ذلك فهي ليست سياسة، ولا يمكن أن تكون مصدر سياسة؛ إذ «السياسة ممارسة ليس إلا، وما قد يستنتج عن النظرية من سلوك ليس سياسة».
في التحديث
التاريخانية إذًا هي السبيل الوحيد للانفتاح على أبواب التحديث ما دامت هي وحدها الكفيلة بأن تجعلنا نميز بين الخصوصية والأصالة. فالأولى حركية متطورة، والثانية سكونية متحجرة ملتفتة إلى الماضي. الأصالة تصورٌ وهمي يجعلنا نعتقد أن التراث ما زال يغذي تفكيرنا الحالي. هذا في حين أن الرباط الذي يشدنا إليه «قد انقطع نهائيًّا، وفي جميع الميادين، وإن الاستمرار الثقافي الذي يخدعنا لأننا ما زلنا نقرأ المؤلفين القدامى ونؤلف فيهم إنما هو سراب… إنه أصبح حسًّا رومانسيًّا منذ أزمان متباعدة». ما يتبقى لنا إذًا هو «طي الصفحة، أي القطيعة المنهجية».
في القطيعة
يريد العروي أن ينفصل توًّا عن التراث، لا عن هذا التيار أو ذاك، وإنما عن الذهنية العامة التي تسوده والتي تخالف كل المخالفة الذهنية الحديثة. إلا أننا لن نتمكن، في نظره، من الوقوف على مفارقات هذه الذهنية العامة التي تسود التراث ما لم ننظر إليه من منظور مقومات الفكر الحديث. لو اكتفينا بإنجازاتنا الثقافية لاستحال أن نصل بمحض الاستنباط إلى المفهومات التي تقوم عليها الحداثة الفكرية. «فالدور التاريخي الغربي الممتد من عصر النهضة إلى الثورة الصناعية هو المرجع الوحيد للمفهومات التي تشيد على ضوئها السياسات الثورية الرامية إلى إخراج البلاد غير الأورُبية من أوضاع وسطوية مترهلة إلى أوضاع صناعية حديثة».
سيعمل العروي في كتبه المتأخرة على محاورة التراث، بل نقده و«الاهتمام بالتقليد» على حد تعبيره. فربما سيتبين أن الانفصال عن التراث ليس عملية تلقائية. كما أنه ليس خصامًا وإنما تملكًا وإحياء. نقد التراث هنا حكم على التراث انطلاقًا من مفاهيم غير نابعة من صلبه، فنحن لسنا بصدد وصف تقريري، وإنما أمام موقف انتقادي معياري. هذه المعيارية تطبع سلسلة كتب المفهومات التي نشرها العروي كلها. فهذه المفهومات لا تطابق المجتمعات العربية مطابقة كاملة؛ «إذ إننا لو انطلقنا من المجتمعات العربية وحدها، من إنجازاتها الثقافية الماضية والحاضرة لاستحال أن نصل بمحض الاستنباط إلى كمال المفهوم». يستحيل أن نجد الآن عند الغزالي مفهوم الأدلوجة، أو عند ابن عربي مفهوم الحرية، أو عند ابن خلدون مفهوم التاريخ، أو عند الشاطبي مفهوم الدولة، أو عند ابن رشد مفهوم العقل. ينظر العروي إلى التراث، كما يقول، من «منظور مكتسبات الفلسفة الغربية الحديثة»، أي من موقع ذاك الذي أدرك تلك المفهومات مكتملة فجاء لينتقد.
قد يقال: إن العروي قد عاد في بعض مؤلفاته المتأخرة للوقوع فيما عَابَهُ على المفكرين العرب في كتابه «الأيديولوجية العربية المعاصرة»، إلا أنه ينبهنا إلى أنه يميز في الفكر الحديث بين مقومات الفكر الحديث وبين أيديولوجية الغرب. فالمنهج ليس هو الأيديولوجية. المنهج نوع من التفكير على أساسه تتكون أيديولوجية: «الأيديولوجية هي التي تتشبث بها الطبقة، أما المنهج فقد أصبح قاعدة مشتركة لكل التيارات الفكرية العصرية».

في نقد العقل العربي-الإسلامي
لهذا التمييز في نطاق الفكر الغربي ما يقابله في الفكر العربي-الإسلامي. هنا أيضًا يميز العروي بين الموقف الكلامي والمذهب أو المنهج ثم الذهنية. الموقف يشير إلى نوعية التعامل مع النصوص وتناول الأسئلة والوقوف عند الأجوبة. أما الذهنية فهي تتعدى علم الكلام لتغدو إبيستمي ثقافة بكاملها؛ ذلك أن الأصل الذي انبنت عليه العلوم الإسلامية بأكملها هو أن العلم واحد لا يتبعض ولا يتفاضل ولا يتحول. وهذا الأصل تقرر في علم الكلام ومنه انتقل إلى العلوم الأخرى؛ لذا فـ«الذهنية الكلامية» عامة يخضع لها الفيلسوف والباطني والفقيه والمتصوف، ولا تقتصر على علم الكلام. ومن أهم مميزاتها أنها لا تكتفي بتحديد العقل بالمعقول، بل تجعل الثاني سابقًا على الأول. وهذا المعقول السابق على العقل الذي يحل فيه ولا يتولد عنه هو «العلم» بالمعنى المطلق. هذا المعقول يُعرف باسم خاص في كل مذهب وهو يسمى الخبر، أو الحكمة، أو السنة، أو التقليد، أو سر الإمام، أو الكشف. هذا المعقول مستقل لا يتوقف على طريقة تحصيله. فليس طلب العلم والحالة هذه بحثًا وتقصيًا. كما أن العقل الفردي ليس منبع المعقولات، ولا مصدر المعارف. متى تهيأ العقل الفردي حل فيه العلم بصورة مكتملة مباغتة نهائية.
وما يقال عن تدرج لعقول الفلاسفة لا ينبغي أن يفهم على أنه درجات من وعي العقل بنفسه، وإنما هي «شخوص على مستوى واحد من الوجود في الكون». ليس المنطق والحالة هذه أداة ومنهجًا وقواعد لبلوغ العلم اليقين؛ ذلك أن العلم اليقين سابق على العملية المنطقية. لا فرق هنا بين الوجود وما يقال عنه وما يتوصل به إلى معرفته. والعقل مرآة ينعكس عليها الحق المطلق. إن حضور المنطق الأرسطي عند أنصاره المسلمين وعند خصومه لا يدل، في نظر العروي، على أن الثقافة الإسلامية ثقافة عقل. فالعقل الذي تحتفل به مفهوم ملتصق بها ومفارق لما يعرف بالاسم نفسه في المجتمع المعاصر. سِمَتُهُ الأساسيةُ أنه عقل المطلق أي عقل المجردات، عقل الحدود والأسماء، وهو وعاء لعلم مطلق. لقد فهم المنطق بطريقة جعلت ذهن المسلم لا يلتفت إلى الطبيعة. وإن اختار المسلك الاستقرائي فليطبقه على نصوص وأقوال، لا على أعراض وأحوال طبيعية.
قد يرد بعضٌ على هذا بأن ما يقوله العروي هنا لا يصدق على مفكري الثقافة العربية الإسلامية جميعهم، وهو لا يصدق، بصفة خاصة، على ابن خلدون الذي اشتهر بنقده لعقل الفلاسفة. يعترف العروي بأن العقل عند صاحب «المقدمة» لا يورَث ولا يُكتشف، وإنما يُكتسب بالتجربة المتجددة؛ فهو دومًا عقل مشخص، محدد ومحدود بظروف الممارسة، إلا أن هذا التشخيص بالضبط هو الذي سيحد في نظر العروي، من منظور صاحبه إلى العقل. فبرغم أنه أعرض عن علم الكلام، وتوخى تأسيس علم الواقعات، ومع أنه توصل إلى مفهوم العقل التجريبي المرتبط بالصنائع، إلا أنه وقف في المجال الذي ابتدعه حيث وقف غيره في ميدان الكلام. فهو لم يتصور أن يصبح العقل التجريبي عقل إنشاء وإنجاز؛ لذا فقد حصر المرئيات في المتحقق، ومنع نظريًّا الانفتاح على التجارب الوهمية الكاشفة عن المحتمل. وبعبارة واحدة فقد حرم نفسه من خوض تجربة الممكن الموضوعي التي هي تجربة الفن التي تفتح العقل على آفاق الممكنات. وبهذا فقد جعل العقل محاصرًا: «قانون تفكيره هو التوقيف والحصر في كل المجالات: في السياسة، في العلم، في التعبير… موضوع العلم الحق، العلم اليقيني عنده هو الواقعات، أي الحاصل المحقق بالفعل، وأما المقدر المتوهم المحتمل فهو وهم. والوهم لا يُحد فلا يعلم». بهذا يتنافى علم الواقعات مع التوقعات وحساب الاحتمال؛ «إذ علم ما يستقبل هو من الغيب الذي لا يتم إلا بالكشف».
هذا الانسداد هو ما يجعل صاحب المقدمة عاجزًا عن إقامة منطق حقيقي للفعل؛ ذلك أن الفعل لا يكون فعلًا إلا إذا كان تجرؤًا على أمر غير محقق. إن علم العمران الخلدوني علم طبيعي، علم ما هو محقق وليس علمًا إنسانيًّا ناتجًا عن الإبداع والإقدام. لقد طبق ابن خلدون على الواقعات منطق الطبائع بالمعنى الكلامي فسد الطريق في وجه عقل العمل البشري، وبالتالي عقل الطبيعة كما فهمها الفكر الحديث، مجال تجارب الإنسان المتجددة. لقد أبدل ابن خلدون العقل التجريدي بالعقل التجريبي، فكان مجددًا في ذلك؛ إلا أنه لم يستطع أن يطور هذا العقل الثاني إلى عقل يعم كل أوجه الممارسة بما فيها من انفتاح ومخاطرة واعتبار الممكنات نسيجًا للوقائع ذاتها.
المثقف بين السياسة والسياسي
هناك وعي حاد عند العروي بأهمية دور المثقف في المجتمعات العربية المعاصرة؛ «لأن عمله اليومي هو بالضبط نقض الظاهر»، ولأن اسمه وشهرته تُستغلان «للتأثير على الرأي العام»، ولأنه مجبر على أن يثبت أنه أدرك «سن الرشد»، خصوصًا أمام المستشرقين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم الأوْلى بالحديث عن مجتمعاتنا، بل التحدث باسمها، وهم يتعجبون اليوم ويتساءلون: «كيف حصل أن يسأل اليوم العرب عن مستقبل ثقافتهم؟».
كتب العروي في إحدى خواطره: «التاريخ بلا سياسة أبكم، والسياسة بلا تاريخ عمياء». أنا «أنقب على الماضي القريب لأفهم الماضي البعيد، وكذلك الراهن». إن من يأمل ويتطلع إلى المستقبل، لا بد أن يتجاوز التخصص، «قد يقرر حقيقة. لكن السياسي ملزم بافتراض إمكانية». لا يعني هذا أن المثقف العروي مشارك فعال في الحياة السياسية، ولا هو منخرط في اليومي السياسي. إنه لا ينضوي في حزب بعينه، ولا يتخذ موقفًا سياسيًّا مقابل آخر، وإنما هو محلل مهووس بالسياسي، وهو ينتمي، كما يقول، «إلى فكرة لا إلى حزب»: لا أستطيع أن أقول مثل ماء العينين: أنا مخاوي، أي أخ لكل شيخ زاوية. لا يرضيهم الانتماء إلى فكرة، إلى حركة، إلى مشروع، المطلوب هو التعلق بأهداب رجل، أن تعلن الولاء لشخص بعينه؛ لذا فإن حضور السياسة عنده لا يتم إلا من خلال همّ ثقافي.
في المدة من 1988م إلى 1999م، أي حتى رحيل الملك الحسن الثاني (وهي المدة التي يغطيها الجزء الثالث من مذكراته)، كان العروي قد تقلد مهمة رسمية، وكُلِّف بشرح قضية الصحراء واستكمال وحدة التراب الوطني لدى بعض رؤساء الدول العربية والأوربية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الاضطلاع بهذه المهمة لم يجعله يغرق في السياسة ويتخلى عن عين المحلل الناقد. ويمكننا أن نجزم بأنه لم يكن، حتى في هذه المدة، مشاركًا فعالًا في الحياة السياسية، مع ما تجر إليه من اتخاذ مواقف، وتعيين مواقع، وخلق «عداوات»، والخوض في جدالات، وكل ما يترتب عن الانخراط الفعلي في اليومي السياسي. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظل محللًا مهووسًا بالسياسي، ظل «أستاذ تاريخ»، يلحظ ويسجل «كما يفعل المؤرخون القدامى»، لكنه ليس مؤرخًا لوقائع وأحداث، وإنما هو محلل مهتم بالسياسي، متابع للتطورات الدولية والعربية، حامل لهموم بلاده وقضاياها المصيرية.
لكنه، كما قلنا، يحلل «من بعيد»، يتحاشى الغرق في السياسة أو إصدار الأحكام، أو الميل لكفة ضد أخرى. فحينما يعقد، على سبيل المثال، مقارنة بين قطبين سياسيين مهمين لعبا أدوارًا كبيرة في الحياة السياسية المغربية غداة الاستقلال، بل ربما قبله، يكتفي بوصف «موضوعي» بارد، ويعمل جاهدًا على الوقوف «عن بعد». كتب مقارنًا بين الزعيم اليساري عبدالرحيم بوعبيد، وبين رضا كديرة: «أقارن بين الرجلين؛ لأنهما وُلِدَا في السنة نفسها (1922م)،
ومارسا المهنة نفسها (المحاماة)، وتأثرا على المستوى نفسه بالثقافة الفرنسية. ثم كان بينهما تشابه ملحوظ في البنية والملامح سوى السحنة… لو كان المغرب في مستوى إسبانيا، لو عاش مثلها تجربة ديمقراطية أصيلة لكُنّا رأينا الرجلين يتواجهان تحت قبة البرلمان كما تواجه في الكورتيس فيلبه غونزاليس وأدولفو سوارس؛ الأول باسم الديمقراطية الشعبية، والثاني باسم الليبرالية الديمقراطية. لو حصل ذلك -وكان واردًا في وقت ما- لَتَرَبَّى المغرب، والنخبة الشابة بخاصة، على تقاليد النقاش الحر المسؤول، ولَدَخَلَت البلاد فعلًا عهد الرشد السياسي. لكن مُنع كلاهما
من تحقيق أهدافه».
لا يعني هذا مطلقًا أن العروي لا يكترث لقضايا بلده. الضدُّ ربما هو الصحيح. فهو يحملها معه حتى عندما يكون خارج الوطن، وهو لا ينفك يقارن ويتذكر ويتحسر: «يبدو أن ما كنت أشعر به من إرهاق لا يعدو أن يكون تضايقًا من جو المغرب الخانق، من انسداد الأفق أمام الجميع، صغارًا وكبارًا. غيرنا يترقب، ويأمل: المتدين الكشف، العالم السبق، الفنان الإنجاز، السياسي الفوز. أما نحن فإننا نسبح في الفضاء، نعد الأيام، ونسمي الشهور». وقضايانا الكبرى لا تفتأ تطرح ولا تفتأ تتعقد وتتشابك: «نبحث، ونتيه في البحث، عن أسباب الركود والتخلف.. السبب واضح: الدولة تعلم الناس الكسل والخمول… بحث عن أدنى فرصة لإنشاء عيد جديد.. نتساءل ونتيه مجددًا في التأويلات، عن عدم تجذر الديمقراطية عندنا… فلننظر في الوضع العائلي، علاقة الأب والابن، الزوج والزوجة، ربة البيت والخادم».

العروي والفلسفة
نقرأ في كتاب «السنة والإصلاح»: «لا أرى نفسي فيلسوفًا، من يستطيع اليوم أن يقول: إنه فيلسوف؟ ولا أرى نفسي متكلمًا ولا حتى مؤرخًا همه الوحيد استحضار الواقعة كما وقعت في زمن معين ومكان محدد. لم أرفع أبدًا راية الفلسفة ولا الدين ولا التاريخ، بل رفعت راية التاريخانية في وقت لم يعد أحد يقبل إضافة اسمه إلى هذه المدرسة الفكرية لكثرة ما فُندت وسُفهت».
منذ كتاباته الأولى والعروي ينبهنا إلى أنه لا يقصد بانتسابه إلى التاريخانية انضواء ضمن تيار فلسفي وجد منشأه في الفكر الأوربي. فليس المقصود بالانتساب إلى التاريخانية عنده اتخاذ موقف فلسفي يجد أسسه عند فلسفات بعينها.
عيب الفلسفة الميتافيزيقية هو أنها ترى أن التاريخ مفتوح على الدوام، من غير أن تدرك أنها بذلك تعمل على نفيه. ونفي التاريخ، هو عدم رؤية الواقع والجدل واللامساواة والصراع والتبعية، وأولوية المجتمع وعدم أهمية الفرد مؤقتًا ربما، ومجمل القول، هو التصريحُ بعدم فاعلية السياسة والانزواء في البيت بعيدًا من صخب البشر. أليس هذا هو المعنى الذي اتخذه لفظ الحكمة على الدوام؟ وما معنى محبة الحكمة (التفلسف) إن لم تكن اتخاذ هذا الموقف؟
على هذا النحو تبدأ الفلسفة: فهي تتحدث عن نسيان الوجود، في حقيقة الأمر إنه نسيان التاريخ. التاريخ يُخضع والفلسفة تُحرر، هذا ما تَعِدنا به الحكمة، ونحن نميل بطبيعة الحال إلى تصديقِه. كلٌّ منا، شاعرًا بمرارة وخيبةِ أمل، يتمنى لو كان مكانَ الحكيم، سعيدًا في عزلته.
لكن، لو أن تجارب أخرى قد عُرفت، لو اضطر المرء إلى القيام باختيارات أخرى، ألن يكون هناك ميْل إلى القول، على العكس من ذلك، إن التاريخ يحرر وإن الفلسفة تُخضع. تبدو هذه الأطروحة أقل وضوحًا، إلا أنه، بعد تفكير، يمكن تبريرها بسهولة. فأيهما أقرب إلى الإخضاع؟ وأي سجن أشد إحكامًا من منظومة سبينوزا أو كانط؟ ما الذي يتبقى قوله والتفكير فيه أو تخيله إذا انطلقنا من مبادئ أحدِهما أو الآخر؟
العروي والنقد الأيديولوجي
لكي تقوم الفلسفة بدور، ينبغي عليها، والحالة هذه، أن تتحول إلى انتقاد للأيديولوجيا: «ودور منتقد الأيديولوجيا، وهو دور الملاحظة والتقويم، هو أن يعرض المنهجيْنِ معًا ويوضحهما؛ منهجَ الباحثين الذين يكتفون بالرغبة في فهم ما كان (التاريخية أو التاريخانية من الدرجة الأولى)، ومنهجَ رجال العمل الذين قرروا التحرر من الماضي (التاريخانية من الدرجة الثانية)».
ما يجعلنا نحكم بأن هذا الفكر أيديولوجيًّا هو حركة التاريخ، فـ«هناك مجرى للتاريخ لأن هذا يُدرَك كحلبة صراع تتواجه فيها مشروعات متضاربة. ليس هناك حَكَم لتعيين الغالب، هناك فقط تشكل جديد للواقع، ونتيجة مؤقتة، واضحة للجميع، تجعل أحد الخصمين يستعيد مشروع الآخر لمعاودة المباراة سواء في الميدان نفسه أو خارجه، ضد الخصم ذاته أو ضد آخر».
يتعلق الأمر إذن بتاريخ آخر، يتجدد عبر استعاداته المتواصلة، على عكس التاريخ السابق الذي كان يُستأنف كي لا يتبدل، وهذا ما يحدد العصر الجديد. من هذا الإدراك لمعنى التاريخ واتجاهه تتولد الأيديولوجية التي هي الشكلُ الجديد للفكر، كل ما هناك أن ما يرمي إليه الفكرُ لم يعد هو هو.
هكذا يربط ذنب السمكة برأسها، وتتشابك المفهومات الأساسية عند العروي، فيستخلص المفهوم المنطلق، مفهوم الأيديولوجية، من مفهوم التاريخ، ليعطي محتوى جديدًا لمفهوم العقل. ومن ثمة، يحددُ هذا الأخير بشكل مختلف، الفردَ والحرية والمجتمع الذي ينوي الفرد العيش فيه.
على هذا النهج سلك صاحب «الوطنية المغربية»، فهو لم يخض في أطروحته في دراسة تاريخية أو اجتماعية حول نشأة الأمة المغربية وهيكلها، وإنما سعى إلى تحليل الخطاب الذي كان الوطنيون المغاربة يبررون به أقوالهم وأعمالهم؛ لذا يؤكد: «أخذتُ الوطنية المغربية كمستوى من مستويات المفهوم العام للأيديولوجية». وهكذا فقد ظل العروي وفيًّا لنقد الأيديولوجية، ونقد الواقع الثقافي لعالمنا العربي، ماضيًا وحاضرًا، حتى وإن كان نقده قد تم دائمًا «عن بعد».
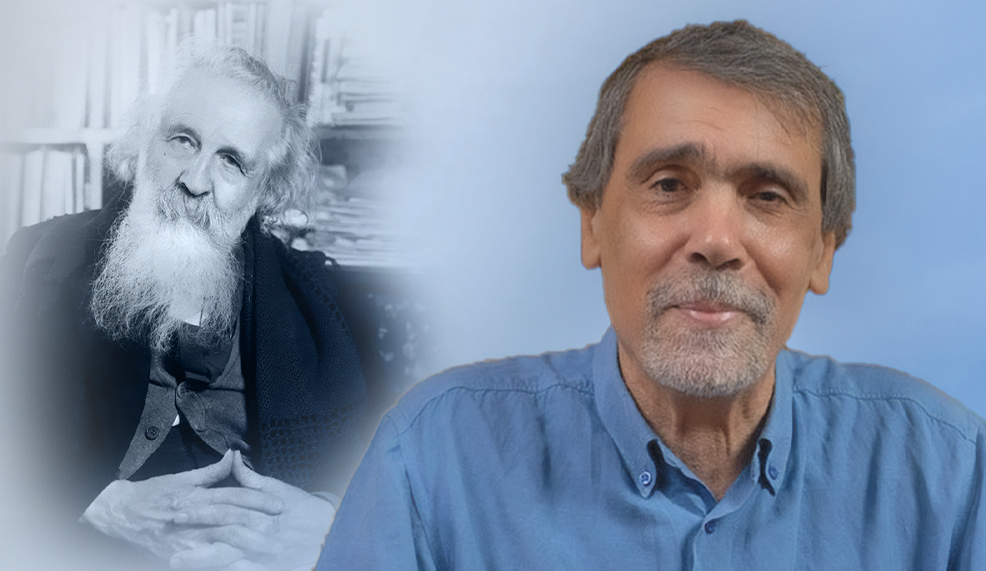
بواسطة عبدالسلام بن عبدالعالي - كاتب مغربي | يوليو 1, 2021 | مقالات
المصادرة الأساس التي ينطلق منها عبدالفتاح كيليطو في كتابه الأخير: «في جو من الندم الفكري» (منشورات المتوسط، إيطاليا) هي أن المرء يبحث عما هو في متناوله. المعرفة الأولية ليست معرفة أولى. الأَوّلِيّ يُعثَر عليه في نهاية مسار. والبداهة ليست مُعطًى أول، وإنما هي في نهاية تحليل. لا عجب أن تتكرر في الكتاب بمجموعه عبارة كافكا، التي يُعزّها كيليطو أيما إعزاز، حتى إنه وضعها عنوانًا لأحد كتبه: «ما نبحث عنه يوجد قربنا».
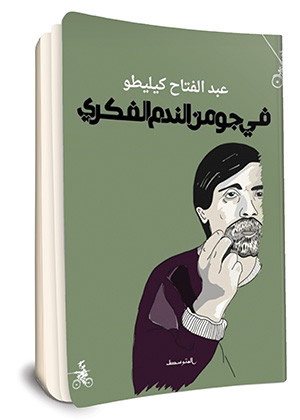 يستلهم كيليطو إبيستمولوجيا البداهة هذه من الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار. نتبين ذلك بمجرد أن نفتح الكتاب الذي يُستهل في عتبته بهذه العبارة المأخوذة من كتاب «تكوين الفكر العلمي» حيث يقول باشلار: «إذا ما تحررنا من ماضي الأخطاء، فإننا نلفي الحقيقة في جو من الندم الفكري. والواقع أننا نعرف ضد معرفة سابقة، وبالقضاء على معارف سيئة البناء، وتخطي ما يعرقل، في الفكر ذاته، عملية التفكير».
يستلهم كيليطو إبيستمولوجيا البداهة هذه من الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار. نتبين ذلك بمجرد أن نفتح الكتاب الذي يُستهل في عتبته بهذه العبارة المأخوذة من كتاب «تكوين الفكر العلمي» حيث يقول باشلار: «إذا ما تحررنا من ماضي الأخطاء، فإننا نلفي الحقيقة في جو من الندم الفكري. والواقع أننا نعرف ضد معرفة سابقة، وبالقضاء على معارف سيئة البناء، وتخطي ما يعرقل، في الفكر ذاته، عملية التفكير».
ليس الندم المقصود هنا ندمًا أخلاقيًّا، ليس ندمًا على تصرفات وأفعال. كما أنه ليس ندمًا عَرَضيًّا، وإنما هو من صميم المعرفة، بل هو من صميم الفكر بما هو كذلك. فالأمر لا يتعلق بتدارك زلات يقع فيها الإنسان عَرَضًا، ومن حين لآخر، وإنما ببنية الفكر كفكر. الفكر ينطوي على ما من شأنه أن يجره نحو الخطأ. هناك، كما يقول باشلار: «في الفكر ذاته ما يعرقل عملية التفكير».
لسنا هنا أمام إبيستمولوجيا ديكارتية تنطلق من حقائق أُولَى وتضطر لأن تفترض افتراضًا شيطانيًّا ماكرًا يخدع الفكر. نحن، على العكس من ذلك، أمام إبيستمولوجيا لا ديكارتية تفترض أن الفكر يخادع نفسه من غير حاجة إلى افتراض شيطان ماكر. تقوم هذه الإبيستمولوجيا على مصادرة أساس وهي أنه «في البدء كان الخطأ». هنا تغدو كل معرفة تقويمًا لاعوجاج وتصحيحًا لأخطاء.
الكتابة نشأة مستأنفة
كل تفكير هو «تخطي ما يعرقل في الفكر ذاته عملية التفكير». ستصبح الكتابة، والحالة هذه «نشأة مستأنفة» بعبارة ابن خلدون. نقرأ في الكتاب: «الخطأ ليس شيئًا يحدث أو لا يحدث، إنه على العكس المكون الأساس للكتابة، معدنها وطبعها. أن تكتب معناه أن تخطئ. الكتابة هي دومًا إعادة النظر».
يعبر كيليطو عن ذلك تعبيرًا «حديثًا» فيقول: إن النص ما يفتأ «يُعالج»: «المرض والحالة هذه هو الأصل، والعافية مجرد فرع، مجرد خطأ. هكذا تبدو كتاباتي عندما أعيد قراءتها، نصوص مريضة يتعين علاجها، مع يقيني أن العلاج لا نهاية له. هنا ربما ندرك تعريفًا للنص الأدبي. إنه ما لا يفتأ يُعالَج، بكل معاني الكلمة».
بهذا المعنى، فإن الكاتب ينظر دومًا إلى ما سبق أن كتبه على أن فيه دومًا شيئًا لا يستقيم. فيه دومًا إغفال أو تضييع فرصة سنحت، أو حتى عدم انتباه إلى أمور كان من شأنها أن تبدو جلية واضحة. فعلى سبيل المثال، بعد أن أكد كيليطو غير ما مرة أن لا أحد ينام في «الليالي» نبهته إحدى الدارسات إلى تسرعه: «كنت خارج الرباط حين توصلت برسالة من أستاذة تُدَرس «أنبئوني بالرؤيا»، كتبت تعلمني أنها قلقة لأن الترجمة الفرنسية لـِ«ألف ليلة» – وكانت تشير على وجه التحديد إلى ترجمة أنطوان غالان التي نُشرت في بداية القرن الثامن عشر– جاء فيها أن الشخوص الثلاثة ينامون جزءًا من الليل. ارتبكت وطلبت منها أن تبعث لي الفقرات التي تثبت ذلك، وعند توصلي بها لم يبق وجه للشك أو الإنكار، فتملكني غيظ شديد من نفسي ولمتها على التسرع وإلقاء الكلام على عواهنه والولع بالغرابة إلى درجة أنني نسبت إلى النص ما لم يقُله».
من جملة الاستدراكات التي يوليها كيليطو أهميةً في كتابه هذا، تلك التي تتعلق بأحد عناوين كتبه، وهو كتاب «بحبر خفي» حيث يكتب: «تبين لي ذات يوم وعلى حين بغتة أنه يمكن أن يُقرأ بحَبر خفي، والحَبر كما نعرف هو المتبحّر في العلوم، ولا غرو أن تتم الإحالة على البحر بصدده. يكفي تبديل شكل حرف ليختلف معنى العنوان، بل معنى الكتاب بكامله. لم أكن واعيًا بذلك، كنت غافلًا تمامًا عن الحَبر، وعن البَحر، لكن اللغة لا محالة واعية ودائمًا بالمرصاد، تنتظر الفرصة والوقت المناسب للإفصاح عن المعنى المستتر».
يشبه كيليطو وضع الكاتب وهو لا يرى ما هو قريب منه بذلك الشخص الذي يبحث، كل صباح، عن مفتاح بيته، إلا أنه غالبًا ما يتبين أخيرًا أنه في جيبه: «قد يكون من المناسب في هذا السياق التذكير بحادث كثيرًا ما يحصل: في الصباح وأنت على وشك الخروج، وقد تأخرت، تهرع إلى الباب، ولكن أين هو المفتاح؟ تبحث عنه في كل مكان، تسأل من يكون برفقتك، تغضب، وأخيرًا تدرك أنه في جيبك. فقدانك المفتاح، وقضاؤك وقتًا طويلًا تبحث عنه، بينما هو في متناولك… غير أنك لن تهتدي إليه إلا بعد بحث محموم يستغرق وقتًا قصيرًا أو طويلًا».
لا تخفى هنا أهمية استعارة «المفتاح» هذه بوصفه أداةً لفتح الأبواب وفك الألغاز وتأويل النصوص، إلا أن المرء، بكل أسف، قد لا يعثر على المفاتيح إلا بعد فوات الأوان. هذا ما حصل لصاحب «الندم الفكري» فيما يتعلق بالكتابة عن رواية غوستاڤ فلوبير، «التربية العاطفية»: «التزمت ذات يوم بالكتابة عنها في مؤلف جماعي ذي شأن كان سيصدر بالإيطالية، عن الرواية في بعدها العالمي، غير أنني ترددت معتقدًا أنني لست جديرًا بالقيام بهذا العمل، وفي النهاية تخليت عنه. تأسف الباحث الإيطالي المشرف على المشروع وقال، إني تذكرت جيدًا، إنه كان يترقب أن أقدم مقاربة خاصة للرواية. كلام يثلج الصدر، أن يكون ما تقول، ما كان يمكن أن تقول، ما لم تقل، فريدًا من نوعه. تبين لي فيما بعد ما قد يكون المقصود، أنني سأمنح مسحة، لنقل عربية، للرواية، نغمة مستطرفة مميزة، شيئًا لا يمكن أن يأتي به إلا قادم من ثقافة مختلفة، غير أوربية، من لغة الضاد… ولما سمعت قول الأستاذ تملكني شيء من الندم على ترددي وإحجامي، وإلى اليوم أحِنّ إلى هذا العمل الفريد النادر الذي لم أنجزه وليست لي أدنى فكرة عن مضمونه ومحتواه».
الكتابة ندم متواصل على ما فات أن كُتب، وعلى ما لم يُكتب بعد.

بواسطة عبدالسلام بن عبدالعالي - كاتب مغربي | يناير 1, 2021 | الملف
على هذا السؤال «الوقح»، نعلم أن هايدغر كان قد ردّ بجواب أكثر «وقاحة» في محاضراته التي جمعت في كتاب «ما هذا الذي نسميه تفكيرًا؟» حيث أكد: «العلم لا يفكّر». وقد علّق على ذلك بقوله: «إن هذه العبارة: “العلم لا يفكر”، التي خلّفت كثيرًا من الضجيج إثر نطقي بها، تعني أن العلم لا يشتغل في إطار الفلسفة، إلا أنه، ومن غير أن يعلم، ينْشدّ إلى ذلك الإطار. فعلى سبيل المثال: إن الفيزياء تشتغل على المكان والزمان والحركة. إلا أن العلم، بما هو كذلك، لا يمكنه أن يحدّد ما الحركة، وما المكان، وما الزمان».
العلم إذًا لا يفكّر، بل إنه لا يمكن أن يفكّر في هذا الاتجاه باستخدام وسائله. لا يمكنني على سبيل المثال أن أقول ما الفيزياء باتّباع مناهج الفيزياء. ماهية الفيزياء لا يمكنني أن أفكّر فيها إلا عن طريق سؤال فلسفي. ليست العبارة: «العلم لا يفكر» عتابًا ومؤاخذة، وإنما هي مجرد إثبات وتحديد للبنية الداخلية للعلم: من خصائص ماهية العلم أنه يتوقف على ما تفكر فيه الفلسفة من جهة، وأنه من جهة أخرى، يتناسى ذلك ويُهمل ما يستدعي أن يكون محط تفكير (1959, p26 PUF, Qu’appelle-t-on penser?, ).
لا يسمح المقام بأن نستعرض هنا كل «الضجيج» الذي أعقب جواب هايدغر عن السؤال: «هل العلم يفكر؟» وننقل مدى الاستياء الذي عبّر عنه أهل العلم أنفسهم إزاءه. ويكفي أن نشير إلى نوع من سوء الفهم والتفاهم الذي حام حول تأويل ذلك الجواب. فقد ذهب بعضهم إلى اتهام الفيلسوف الألماني بالطعن في العقل العلمي واعتناقه نوعًا من اللاعقلانية، خصوصًا بعد أن كتب في «رسالة في النزعة الإنسانية»: «أن الإبداع الشعري أكثر صدقًا من الاستكشاف المنهجي للكائن». والحال أن قصد صاحب «ما هذا الذي يُسمَّى تفكيرًا؟» كان مجرد التمييز بين العقل والفكر، ذلك التمييز الذي تَعزّز عنده بعد ما سُمّي بنقطة التحول التي أعقبت سنة 1932م، والذي يميز بمقتضاه من جهة، بين الفكر المفكّر الذي هو سمة الفلسفة التأملية، ومن جهة أخرى، العقل الذي ينكشف من خلاله النشاط العقلي للعلوم والعقلانية العلمية، والذي يظل منحصرًا في المجال الحسابي للإجراءات الصورية والمجردة للمنطق والرياضيات والعلوم المضبوطة. كأن الفيلسوف الألماني «يعيب» على العلم كونه يأخذ على كاهله البحث عن شيء يتخذه موضوعًا له من غير أن يضعه بما هو كذلك موضع سؤال.
هل نفهم من ذلك أن الأمر لا يتعلّق فحسب إلا بالتأكيد على أهمية فلسفة العلوم، والدعوة إلى محاولة التحديد الفلسفي لموضوعات العلوم ومناهجها، والتساؤل عن كيفية بلوغها لحقائقها ومدى يقين تلك الحقائق؟ مجمل القول، هل يتعلق الأمر فحسب بإثبات أهمية البحث الإبستمولوجي ووعي العلوم بذاتها؟
نعلم أن كثيرًا من محاضرات هايدغر تتعرض لهذه القضايا الإبستمولوجية. فقد أدلى بدلوه غير ما مرة في النقاشات الإبستمولوجية التي كانت تثيرها التحوّلات العلمية الكبرى التي عرفها الثلث الأول من القرن السابق. ويكفي أن نشير هنا إلى الجدالات التي دارت حول النتائج الفلسفية للفيزياء النسبية وميكانيكا الكمّ. وعلى الرغم من ذلك، فإن صاحب «كانط ومسألة الميتافيزيقا» لا يكتفي بالإشارة إلى هذا البعد الإبستمولوجي عندما يقرّر أن «العلم لا يفكر»، وإنما يرى أن مهمة الفكر، ليست فحسب أن يطرح قضايا إبستمولوجية، وإنما أن يذهب أبعد من مناهج العلوم، كي يبرز المسلمات الأساس لتلك المناهج، بل وللفاعلية العلمية ذاتها فيخضعها للمساءلة
على هذا النحو ينبغي، في نظرنا، أن نفهم الأهمية الكبرى التي يوليها هايدغر لمسألة التقنية. فما طرقه لتلك المسألة، وتخصيصه لها بمحاضرة أصبحت نصًّا كلاسيكيًّا في الموضوع، إلا محاولة للتفكير فيما لم يفكر فيه العلم. أو لنقل إنها محاولة للتفكير في التقنو- علم، وإعادة النظر في العلاقة التي تربط العلم بالتقنية. ذلك أن فلاسفة العلم اعتادوا ألا ينظروا إلى التقنية إلا كمجرّد تطبيق للنظريات العلمية. فهي ليست في نظرهم إلا العلم المطبَّق. أكاد أجزم بأن «فيلسوف التقنية» قد عمل على قلب هذه العلاقة، فجعل العلم مفعول التقنية، وبيّن أن مشاغل العلم واهتماماته وقضاياه تجد أصولها خارج العلم، وبالضبط في التطور التقني.
المعرفة العلمية وسيطرة التقنية
بل إن هايدغر قد ذهب في محاضرته «في مسألة التقنية»، إلى القول إن الفيزياء الحديثة ليست فيزياء تجريبية لأنها تطبق على الطبيعة آلات من أجل فحصها. بل العكس، فلأن الفيزياء، مسبقًا وكنظرية، تجبر الطبيعة كي تظهر مركبًا من القوى قابلًا للحساب الرياضي، أمكن للتجريب أن يمحصها. فالتقنو-علم لا يطبق على طبيعة محايدة ما ارتآه، وإنما يكون، ومنذ البداية، أمام موضوع من صنع التقنية. بل إن المعرفة العلمية ذاتها طاقة ورصيد معلومات تكون تحت الإمرة، فتخضع للسيطرة التقنية.
ذلك أن التقنية تنغرس في البعد الأنطولوجي للكائن، فهي نمط تجليه. إنها الكيفية التي يختفي فيها الوجود ليظهر كمستودع. وعندما يقول هايدغر إن التقنية هي كذلك، فهو يقصد أنها تحدد مفهومنا عن المكان والزمان، وأنها تغيّر أنماط عيشنا وأسلوب تفكيرنا، وتؤثّر في فنوننا وآدابنا، وتغيّر أذواقنا وأهواءنا، وتنظّم إداراتنا ودواليبنا، فتحدد العلم وتشرط مناهجه وموضوعاته. بل إنها قد تعمل ضد العقلنة ذاتها.

يورغن هابرماس
فعلى رغم وهم التحكم في الطبيعة وفي الإنسان، الذي ما تنفك التقنية تنشره، وعلى رغم وهم الضبط والعقلنة والتنظيم الذي ما يفتأ العلم يرسّخها، فإنهما (التقنية والعلم)، سرعان ما يدفعان الإنسان نحو تشكيل مدخرات هائلة من الطاقة تنفلت من كل عقلنة، ونحو نهَم الاستهلاك الذي لا تحدّه حدود، فيجران العقل إلى أن يعمل ضد كل تعقل، بل إنهما قد يعملان في النهاية ضد الإنسان ذاته.
ذلك هو التغيير الكبير الذي حدث في المجتمع العلمي خلال القرن الماضي حيث أصبح مجتمعًا تقنو-علميًّا، وحيث غدا التقنو-علم يتحدد في المقام الأول من خلال أساليبه، حيث تسود الأدوات التقنية المتقدمة وأهدافها التي هي إنتاج تقنيات جديدة تكون دائمًا أكثر كفاءة، وأكثر سرعة، وأكثر قوة، وأكثر دوامًا. ففي وسط البحث العلمي اليوم، معظم ما هو محط رغبة في البحث والتقصي هو تقني بشكل حصري تقريبًا. يترتب عن ذلك أن البحث العلمي الذي قد يستفيد من التمويلات هو الذي يقود بأسرع ما يمكن إلى تقنية تكون مفيدة، ولكن، قبل كل شيء، مربحة على المدى القصير. والنتيجة هي هيمنة عقيدة الفعالية على جميع مستويات النشاط البشري، تلك العقيدة التي تطبع أصغر ألياف الثقافة والفكر السياسي، مما يجعل من التقنو-علم الأيديولوجية الأساس لجميع المجتمعات الصناعية.
هذا الزواج بين التقنية والرأسمال جعل العلم يخرج عن سيطرة العلماء ليحيد عن مراميه التقليدية التي كان أبو الفلسفة الحديثة قد عبّر عنها في القسم السادس من مقاله في المنهج عندما جعل هدف العلم هو «أن يجعلنا سادة على الطبيعة ممتلكين لها». لم يعد التقنو-علم يكتفي إذًا بأن يوفر الأدوات البسيطة التي توسع النشاط البدني والفكري للجسم والعقل، وتضع الإنسان أمام أفق جديد من الاحتمالات التي لا تشمل سوى إشباع احتياجاته، وتحقيق رغباته وطموحاته الشخصية والاجتماعية والسياسية، وإنما صار يذهب أيضًا إلى حد التغيير الجذري لنمط وجوده الاجتماعي، بل وحتى البيئي والبيولوجي.
هذا ما يعبّر عنه اليوم بالثورة البيوتقنية التي يأمل بعض المتحمسين لها أن تمكننا من أن نغدو «أصل المستقبل» على حدّ قول أحدهم، فتروض جيناتنا وتختار مكوناتنا الحيوية، وتزيد في أعمارنا، بل وتخلق أنواعًا أخرى من الكائنات الحية.
يعود الترويج الكبير لمصطلح «التقنو-علم» الى جيلبر هوتوا الذي استخدمه على نطاق واسع في كتاباته عن التقنية والاتصال وأخلاقيات علم الأحياء منذ سبعينيات القرن الماضي. ووفقًا لهُوتْوا، ليس للتقنو-علم تعريف أحادي الجانب، لذا فهو يكتفي بأن يؤكد على طابعه المؤطر للثقافة، نقرأ في كتابه «التقنو-علم والحكمة؟»: «غالبًا ما يسير هذا المفهوم عن التقنو-علم الموضوع تحت علامة القوة، غالبًا ما يسير جنبًا إلى جنب مع فكرة استقلالية التقنية ومع عدم أخلاقيتها. استقلالية التقنية تعني أن الناس لا حول لهم اتجاه التطور التقني، فهم يخدمونه ويعملون على تحقيق ما هو ممكن علميًّا. ومن جانبه، فإن الإلزام التقني يتطلب القيام بكل ما هو ممكن تقنيًّا: من تجارب واختراعات واكتشافات واستكشافات وإعادة بناء، إلخ. Gilbert HOTTOIS, Technoscience et sagesse ?, Nantes, Pleins Feux, 2002, p. 22.)
لذا فإذا ما تُرك التقنو-علم يعمل كما يحلو له، ويُحدد أهدافه ووسائله وحدوده بدلالة الحصول على أكثر ما يمكن من الفعالية، من غير تدخل أخلاقي أو سياسي أو فلسفي، فإنه سينزّل المتطلبات الإنسانية والاجتماعية في المرتبة الثانية ولن يوليها اهتمامًا، أو أنه قد يتجاهلها بكل بساطة. بعبارة أخرى، عندما لا يتم تأطير الفاعلية العلمية من خلال الاهتمام الأخلاقي، فإن التقنية تغدو علمًا لا أخلاقيًّا، ولا تعود تقاس إلا بمدى ما تجنيه من أرباح.
تحول غريب
ومع ذلك فلا شيء كان ينذر عند قيام أول المعارف العلمية منذ بضعة آلاف من السنين بأن العلم سيواجه يومًا ما مخاطر التعارض مع مصالح البشر. والواقع أنه حصل تحوّل غريب فقط عندما اقترنت إمكانيات المنافذ التقنية الناشئة عن الاكتشافات العلمية بالطاقة المتولدة عن تقنية العصر الصناعي. ولم يعد تقدم العلم «التأملي» يولد مجرد تقنية متفرعة، بل إن العلم نفسه هو الذي أصبح يُوجَّه ويُموَّل من أجل الحصول على تقنيات جديدة. إن الحاجة إلى الفرص التقنية السريعة هي ما غدا يوجّه البحث العلمي الآن بشكل شبه حصري. ففي معظم البلدان، يعمل المجتمع العلمي من خلال نظام مِنَح وتمويلات صادرة عن المنظمات الحكومية، وهذه المنظمات تخضع لسياسات قصيرة المدى للمسؤولين المنتخبين الذين يأملون في إعادة انتخابهم، وبالتالي يخضعون بشكل أساس لقوانين السوق الاقتصادية.
على العلم إذًا أن يعود إلى التفكير، وإلى التفكير في نفسه أولًا وقبل كل شيء. لا نقصد هنا بطبيعة الحال الاكتفاء بالدعوة إلى تعميق الدراسات الإبستمولوجية، ولا حتى فتحها على نوع من «سوسيولوجيا المعرفة العلمية»، وإنما الذهاب أبعد من ذلك للتفكير فيما لا يفكر فيه العلم، وفتح الفعالية العلمية على السؤال الفلسفي، بله طرح البعد الأخلاقي للتقنو-علم موضع سؤال وإقامة نوع من «أخلاقيات العلم»: أخلاقيات العلوم الحيوية، وأخلاقيات البيئة، وأخلاقيات تقنية المعلومات.
تجند كثير من الفلاسفة المعاصرين لاتخاذ موقف نقدي إزاء هذا الانفلات للتقنو-علم، والدعوة إلى تأسيس هذه الأخلاقيات بمختلف فروعها. ويكفي أن نتذكر المواقف المتشددة التي أبداها بعض منهم إزاء مسألة استنساخ الكائنات الحية، وقضايا تحسين النسل والإنجاب الصناعي، والقتل الرحيم، والهندسة الوراثية، والأغذية والكائنات المعدلة جينيًّا، والخلايا الجذعية، والإجهاض، وعمليات تغيير الجنس وحمل الأجنة البشرية في الأرحام الاصطناعية أو الحيوانية، إضافة إلى الأدوية ذات التأثير النفسي لتعديل السلوك والانتباه والذاكرة والإدراك.
وما ينبغي التنبيه إليه بهذا الصدد أننا لا يمكن أن نجزم بأن أنصار الحداثة يتحمسون لتطور التقنو-علم، وأن المناهضين لها يبدون موقفًا محافظًا إزاء ذلك التطور. فإن كان بعض هؤلاء المتحفظين من التطور الهائل للعلم وتطبيقاته يبدي في الوقت ذاته موقفًا سلبيًّا إزاء الحداثة كهانس يوناس (صاحب مبدأ المسؤولية الذي يؤكد بمقتضاه مسؤولية الإنسان عن مصير نوعه في الحاضر وأفقه المستقبلي، مستبدلًا مفهوم السيادة على الطبيعة الديكارتي-البيكوني)، فإن آخرين، مثل الفيلسوف هابرماس، يبدون كثيرًا من التحفظ إزاء بعض مغامرات العلوم الحيوية حتى وإن كانوا يتحمسون للفكر الحداثي في الوقت ذاته (لا ننسى أن هابرماس هو صاحب عبارة «الحداثة مشروع لم يكتمل بعد»).
ردود فعل

مارتن هايدغر
غير أن ما ينبغي الإلحاح عليه هو أن ردود الفعل تلك قد اتخذت في كثير من الأحيان بعدًا جماعيًّا ومؤسسيًّا ويكفي أن نذكّر بتواريخ بعض البيانات والدعوات التي صدرت عن بعض الهيئات والمؤتمرات كمدونة نورمبرغ لتنظيم التجارب الطبية (1947م)، وبيان راسل-آينشتاين (1955م) الذي يعدّ أول اعتراف رسمي بالمسؤولية الجماعية للعلماء تجاه المجتمع. ومؤتمر بوغواش للعلوم والشؤون العالمية (1957م) لتجنب اندلاع نهاية العالم النووية، من خلال الجمع بين العلماء من الغرب والشرق. ومؤتمر أسيلومار لمواجهة مخاطر التقدم في التلاعب الجيني (1975م)، من غير أن ننسى ظهور الحركات البيئية المنتقدة للتقدم العشوائي ابتداء من نهاية الستينيات من القرن الماضي.
وقريبًا منا ينبغي أن نشير إلى قوانين أخلاقيات البيولوجيا (2004،2011. 2018م: الاجتماع العام لأخلاقيات علم الأحياء، مراجعة القانون)، وقانون «الجمهورية الرقمية» الذي ظهر في فرنسا (2016م، بعد التشاور العام)، وتقرير فيلاني الذي يرمي إلى «إعطاء معنى للذكاء الاصطناعي» (مارس2018م).
أدى هذا التراكم إلى الوعي بضرورة تسريع دمج الأخلاق في العلم بمختلف مجالاته، إلى حدّ أن نموذج العلم المنفصل عن المجتمع غدا غير مقبول. وقد أدى ذلك إلى ظهور نماذج جديدة لإنتاج المعرفة العلمية، من خلال دمج غير المتخصصين في الإنتاج العلمي إقحامًا لمختلف الآراء بما فيها غير المتخصصة ومساهمة في فتح الأوساط العلمية على المجتمع بكل مكوناته. لا يعني ذلك على الإطلاق سعيًا نحو فرملة البحث العلمي وقمعًا للفضول المعرفي لدى الإنسان.
هذا ما عبر عنه الفيلسوف جيلبر هوتوا، الذي سبق أن أشرنا إليه، بقوله: «يجب أن نفعل كل ما يمكن فعله، فلا نترك تجربة ولا معالجة مخبرية طالتها أيادينا وعقولنا إلا أجريناها، ولا طريقًا تبدّت أمامنا إلا استكشفناها، ولا بابًا انفتحت إلا ولجناها، ولا سبيلًا من سبل استغلال إمكانيات الكائن – مادة أو حياة أو فكرًا – تراءت لنا إلا اتّبعناها».
إلا أننا لا ينبغي أن ننسى أن تقييد شروط البحث العلمي جزء من العقلنة العلمية وضبط لمسارها. فإن كان ينبغي علينا معرفة كل ما تجب معرفته، فإن كل ما يصبح ممكنًا تقنيًّا لا يجب السماح به بالضرورة.

بواسطة عبدالسلام بن عبدالعالي - كاتب مغربي | يوليو 1, 2020 | مقالات
يقدم لنا هذا الكتاب حوارات مع نخبة منتقاة من المفكرين العرب. فهو يشكل، بمعنى ما، زبدة الفكر العربي، ويبلور أهم القضايا التي تشغله، ومجمل الصعوبات التي يواجهها، ونبذة عن التطلعات التي يرمي إليها.
وقبل أن نحاول عرض أهم القضايا الفكرية التي تشغل أذهان مفكرينا، والتي يمكن أن نستخلصها من هذه الحوارات معهم، لنتوقف أولا عند السمات التي تكاد تصدق عليهم جميعا، والتي يمكن أن نقول إنها طبعت الفكر العربي في مجمله.
ينتمي معظم هؤلاء المفكرين إلى الجيل الذي ولد أواسط النصف الأول من القرن الماضي، ذلك الجيل الذي واكب حركات التحرر من ربقة الاحتلال الأجنبي بمختلف أشكاله، كما واجه التخلف بكل أبعاده فكان عليه إرساء الحداثة في مختلف تجلياتها، وهو يواجه اليوم أخبث أشكال الوثوقية وقد اتخذت صورة عنف مادي مجسد. إننا إذاً أمام رعيل من المفكرين الأكاديميين الذين ارتبطت لديهم الثقافة والفكر بالنضال من أجل التحرر والتحديث والديمقراطية.
لا عجب إذًا أن يكون الطابع العام لهذا الفكر هو تجذره، لا أقول في السياسة، وإنما في السياسي Le politique . لذا فهو لم ينم بعيدًا من معمعة النضال، ولم يقتصر على تأملات نظرية في استقلال عن كل ممارسة. من هنا طابعه غير الأكاديمي الصرف. بهذا المعنى فإننا نستطيع أن نقول: إن مفكرينا قد انتزعوا الثقافة انتزاعًا، ولم تقدم إليهم المعارف على طبق من ذهب. لعل ذلك ما جعل أغلبهم لا يعرف التخصص المعرفي بمعناه الأكاديمي؛ إذ إنهم كانوا مجبرين على تعدد الانشغالات، وتنوع المصادر، وتشتت الاهتمام، وتعدد اللغات. فلن نستطيع أن نقول إن هذا متخصص في الاقتصاد، وذاك في الأدب والآخر في التاريخ، إلخ…بل إننا نجدهم مرغمين على الانفتاح على مشاغل وقضايا تتجاوز مجال تخصصاتهم، ليس تطاولًا منهم، وإنما ضرورة يفرضها واقع حالهم الذي ينيطهم بمهام أقوى من طاقتهم في أغلب الأحيان.
سنلمس هذا، بطبيعة الحال في مجمل القضايا التي يعرضون لها، والتي تبلورها هذه الحوارات، تلك القضايا التي تلتحم بالواقع العربي وتنمو في كنفه. صحيح أن هناك اختلافًا من مفكر لآخر، فهناك موضوعات تشغل بال هذا، ولا يعيرها الآخر أيّ اهتمام. إلا أن هناك ما يمكن أن نطلق عليه قواسم مشتركة، وقضايا عامة شكلت الخلفية النظرية، والانشغال الأساس عند معظم مفكرينا، حتى وإن لم تكن بدرجة الوعي نفسها عند كل واحد منهم.
لعل القضية الأولى التي يبدو أنها تشغل بال مثقفينا، والمتحاور معهم هنا على الخصوص، هي مسألة الإسلام السياسي، وما يتمخض عنها من قضايا نظرية كعلاقة الأخلاق بالدين ومسألة تأويل النص الديني، ومسألة الإصلاح، وقضايا الوثوقية والعنف.
القضية الثانية التي تكاد تحضر في جميع هذه الحوارات هي مسألة تحديث المجتمعات العربية، وما يتفرع عنها من قضايا، كمسألة العلمانية وقضايا بناء الدولة الحديثة.
القضية الكبرى الثالثة التي نلمس بقوة حضورها في هذه الحوارات هي مسألة النخب الثقافية وما يتفرع عنها من قضايا كدور المثقف في مجتمعاتنا، وعلاقة المفكر بالمثقف، ودور الأيديولوجية ووضعية الفلسفة في العالم العربي.
مسألة الإسلام السياسي
يلاحظ المفكر السوري برهان غليون أن ما يحدث في مجتمعاتنا من عودة إلى الدِّين هو نتيجة السياسات الثقافية والقواعد التي اعتمدت، في عالمنا العربي، في التعامل مع الفرد على مستوى الأسرة والعشيرة والدولة والمجتمع. فعوضًا من أن يكون الدِّين أحد الموارد المثرية للشخصية العربية فإن عقلية المحافظة والخوف قد حولته من الحرية إلى سياج يمنع الفرد من تمثُّل القيم الجديدة، والتطلع إلى الآفاق المبتكرة. وما تكرار عمليات الاعتداء، المادي والرمزي، التي تتم باسم الدين في مجتمعاتنا إلا انعكاس لرُوح الانتقام التي تعبِّر عن التخبُّط واليأس الذي يطبع حياة الأفراد، والشباب منهم على الخصوص، أكثر مما تعكس رؤية لأيّ مشروع طويل المدى. لا عجب إذاً أن يتم ما نشاهده من أشكال العنف باسم الدين، فنحن هنا إزاء«ردود أفعال مخفقة لأُناس مخفقين يغطّون على إخفاقهم باستعراض أقصى ما يمكن من العنف والقوة والعدوان على الأبرياء».

برهان غليون
فبدلًا من أن يتخذ الفرد في العالم العربي طريق المعارضة والاحتجاج على أوضاعه المجحفة، واقتراح بدائل سياسية، أو إصلاحات، والعمل على تطبيقها؛ فإنه يميل إلى جميع أشكال الفوضى وقلب النظام، وتقويض أسسه المعنوية، أي تجريده من الشرعية، لا لإقامة نظام جديد مكانه، وإنما لخرق كل نظام. فـ«ليس لصعود المدّ الإسلاميّ منذ أربعة عقود سوى مُحرِّك واحد هو نزع الشرعية عن النُّظُم السياسية القائمة على أمل إقامة نُظُم أخرى مكانها أكثر تطابقًا مع ما يُعتقد أنه أقرب إلى العدالة مثلما تعرفها بعض الأوساط المشايخية”». وهكذا فلم يَعُدِ الدِّين يجمع أحدًا، حتى داخِل المذهب الواحد. وسرعان ما نجد أنفسنا أمام صراعات داخل صفوف الحركات الإسلامية السياسية ذاتها.
في هذا الاتجاه، يرى حسن حنفي أن عيبنا، نحن العرب، هو أننا نريد الانتقال من الدين إلى الثورة من دون تحويل الدين إلى فكر، ثم ننقل الفكر إلى الواقع. «وهذا ما حدث مع الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده، ومع دعاة التيار العلمي مثل فرح أنطون وشبلي شميل وإسماعيل مظهر الذي قضى حياته يدافع عن دارون». نحن نريد أن نقفز على المراحل، لكن هذا يمثل السبب الرئيس في أننا كلما ننهض نقع ثم نقوم فنقع، سواء أكان من يقوم بذلك الشعب أم النخبة العسكرية.
على هذا النحو يرى فهمي جدعان أن الإسلام السياسيّ «هو محض أيديولوجيا تمتح من الميكافيليّة والخداع ونشدان المنفعة الخالصة والسيطرة»، وهو يرى أن العقدة الأساسيّة، العقدة البنيويّة في مشكل الحركات الإسلاميّة السياسيّة تكمن في المنهج الذي يحكم فهم أصحابها للمعطيات الدينيّة أو للمعطيات التاريخيّة ذات العلاقة بأصول دينيّة. يقوم هذا المنهج عند هذه الحركات، في نظره، على كونها ذات نزعة «ذريّة»، بمعنى أنها «تجتزئ بالنّصوص المفردة وبالوقائع الجزئية، وتقوم بعملية تجريد وتعميم يخترقان ويتجاوزان المكان والزمان والتاريخ، ولا تلتفت إلى الوجوه العلائقيّة التي تربط بين الجزئي وبين الكلي، أو بين «الذريّ» وبين « الشموليّ». فنحن لسنا بإزاء «نزعة» بقدر ما نحن بإزاء وقائع تفرض «العنف»، لكنه العنف المتبادل الذي يفرضه الصراع.
يرجع علي حرب هذا الصراع إلى المنظومات العقائدية والأنساق الفقهية التي تضيِّق ما اتسع وتقطع ما اتصل. «فهي التي أسّست للانشقاق والعداوة، سواء داخل الإسلام أم بين المسلمين وسواهم، بقدر ما اشتغل أئمّتها بلغة التكفير والردّة، أو بعقلية الكره والحقد، أو بمنطق الإقصاء والنفي المتبادل. والحصيلة هي كل هذه البحار من الدماء، وكل هذا الخراب المادي والمعنوي، كما تصنعه الحروب الأهلية الطاحنة أو الأعمال الإرهابية الوحشية على يد الجهاديين من أهل الخلافة أو المجاهدين من أتباع الولاية».
إلى هذا الموقف نفسه تذهب الباحثة التونسية ناجية الوريمي التي ترى «أن الأزمة التي نعيشها اليوم، ليست متأتية من الدين، بل هي في جانب منها راجعة لتمثّله تمثّلًا محدودًا ومنغلقًا: لا تزال تيّارات عديدة تقحمه في الصراعات السياسيّة، وبه يبرّر المتشدّدون رفض التجديد والإبداع وباسمه يصادرون الحريّات، وتحت مسمّاه يرفضون التعدّد والاختلاف، وبتعلّة الدفاع عنه يدّعي المتطرّفون أنّ العنف الذي يمارسونه عنف شرعيّ».
أما المفكر علي فخرو فيبحث عن أسباب العنف الذي تنساق إليه بعض الحركات الدينية المتطرفة في الظروف الاجتماعية والنظم السياسية التي تعيش المجتمعات العربية في كنفها. فتراجع الأفكار القومية والأفكار الليبرالية خلّف نوعا من الفراغ في الحياة السياسية العربية، هذا الفراغ ملأه الإسلام السياسي. ذلك : «أن بناء الدولة العربية على أسس حديثة لم يتم حتى الآن؛ ما دفع بالإنسان العربي إلى التوجه إلى القبيلة أو المذهب»، ومن ثمة إلى العنف.
بعض المفكرين ممن تم الحوار معهم يبحثون عن أسباب التطرف والعنف خارج المجتمعات العربية، وبعيدًا عن الدين وتأويله، بل حتى عن السياسة ونظمها. فخليل أحمد خليل يؤكد أنه فضلًا عن العنف الكامن داخل المنظومة الدينية نفسها، «فإن صراع الغرب الأميركي مع الشيوعية بعد إسقاط الاتحاد السوفييتي ولد عند الغرب خوفًا من نهوض العالم الإسلامي كقوة إمبراطورية؛ «لأن الإسلام هو إمبراطوري بطبعه فأدخلوا وحوش التطرف إليه».
أما الطيب تيزيني فيذهب بعيدًا في هذا المضمار ويرى «أن داعشًا ظاهرة عالمية بقدر الإفقار والإذلال واللاكرامة التي يعيشونها في بلدانهم، هؤلاء قتلة لكنهم أيضًا ضحايا، قد يكون بعضهم الآخر مجرمين، فهم لا يملكون شيئًا، القاتل الذي أنتج داعشًا هو الغرب، وتبعه الشرق الأعلى. داعش نتيجة الغرب الاستعماري المتجبر والشرق الذي أصبح مقلدًا للغرب يحاول أن يفعل ما يفعله. لقد نشأ داعش عالميًّا لكن في النية الخفية غير المرئية، لذلك التخلص من داعش يعني أن تبني عالـمًا جديدًا».
في انتظار بناء هذا العالم الجديد يقترح بعض مفكرينا الاهتمام أولًا وقبل كل شيء، بالمحيط الداخلي والوسط الاجتماعي والظروف السياسية التي يعيش في كنفها الفرد العربي. وهكذا فعالم الاقتصاد جلال أمين لا يرى في الإصلاح الديني حلًّا لظواهر التطرف وأشكال العنف المتولدة عنه، إذ لا مفر من تحويل الظروف المحيطة به. يقول:«إن المتكلمين حول تجديد الفكر الديني لديهم تعالٍ وغرور أكثر مما يلزم. فلا أحد يجدد في الخطاب الديني أو غير الديني، لا أحد. أنت إذا كنت لا تحبذ طبيعة الفكر السائد انظر إلى الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أنتجت هذا الفكر وغيرت فيه أو حاولت تغييره». في النطاق نفسه يرى علي فخرو أن التحديث السياسي هو الكفيل بأن يجعل المواطن يطمئن إلى المؤسسات التي تحميه. يقول: «الذين يسكنون في دولة ما إذا هم شعروا بأن الدولة تحميهم من خلال القوانين والدساتير والتوزيع العادل للثروة والمساواة وتكافؤ الفرص، لن يحتاجوا إلى ارتباطاتهم الفرعية لتحميهم؛ لأن الدولة تحميهم. عندما يشعر الفرد بأن الدولة لا تحميه وأن ليس هناك مواطنة متساوية، ولا تكافؤ فرص، فإلى أين يتوجه؟ هو وحده لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، يلجأ إلى انتماءاته الفرعية: الانتماء القبلي، والمذهبي، والديني».
المفكر عبدالمجيد الشرفي يفسر التشبث بالتأويلات التقليدية برده إلى نظرية المصالح، فهو يرى «أن التشبث بالتأويل التقليدي للنصوص القرآنية إنما يعكس مصالح فئات اجتماعية محافظة». لذا فهو يقوم ضد كل التأويلات التقليدية ويفتح باب الاجتهاد على مصراعيه: «ليست هناك نصوص غير قابلة للتأويل، هناك مقولات نسمعها بكثرة ونقرؤها في الأدبيات الإسلامية مثل المعلوم من الدين بالضرورة. وليس هناك شيء معلوم من الدين بالضرورة وإنما هناك ما هو معلوم من الدين بحكم الثقافة والتكوين والقيم إلخ. وليس هناك شيء ثابت في الدين باستثناء نواة صلبة وهي التوحيد والإيمان بنبوة محمد ما عدا ذلك فإنه نسبي وليس ثابتًا».
إلا أن بعض مفكرينا يذهب إلى نوع من اليأس من كل إصلاح سواء أكان تغييرًا لواقع معيش، أو إعادة نظر في تأويل النص الديني، مثل فهمي جدعان الذي يؤكد أن المشكل في الإسلام السنيّ على وجه الخصوص هو أنّ «النواة القاعديّة» العقدية فيه لم تستجب لجهود الإصلاح التي بدأت منذ محمد عبده، وأنّ «الرؤية الاتباعية» صلبة لا تتقبّل «الاجتهادات» الجديدة، ولا تطيق مقاربة «الرؤية الإسلاميّة» التقليدية مقاربة إبداعيّة.
تحديث المجتمعات العربية

علي فخرو
كتب علي فخرو: «حين تتحدث مع من يدعون إلى الحداثة ويريدونها، تجد أنّ الحداثة بالنسبة لهم هي الحداثة الغربية، في حين أنها حداثة للغرب، أنت يجب أن تبني حداثتك، انظر مثلًا إلى الصين أو اليابان فهم يبنون حداثتهم، لديهم أشياء مختلفة عن الغرب، هذا لا ينطبق علينا مع الأسف الشديد، فقد ابتلينا بشيئين، بالسّلفي الذي يعتقد أن الحداثة هي ما فعله الآباء والأجداد، السلف الصالح، وبأولئك الذين يريدون أن يغربونا بالقضاء على ذاتنا، على إبداعنا، يدفعون بنا لبناء ما لا يصلح لنا، المطلوب هو حداثة عربية، تأخذ من الثقافة الإسلامية، فالإسلام هو جزء لا يتجزأ من ثقافتنا ولا يمكن القفز فوقه لأن الملايين من العرب يؤمنون بذلك».
هذا التحديث من الداخل الذي ينفي كل إسقاط لحداثة مستوردة تراه الباحثة التونسية ناجية الوريمي في تخلص الفكر العربي من القيود التي تكبّله، ومن دائرة الممنوع التفكير فيه، فإذا ما قام الفكر العربي بذلك، فإنه سينفتح على الحداثة ويستوعب مبادئ التنوير، فيصبح قادرًا على الإضافة إليها وإثرائها. لا يعني ذلك بالضرورة انفصالًا عن التراث والقطع مع الماضي، وإنما تشريح هذا الماضي ذاته حتّى يفصل فيه بين الإنسانيّ الدائم والقابل للتطوير، والظرفيّ العابر الذي ينتصب حجر عثرة في طريق التقدّم. فلا حداثة تجبّ التراث، ولا تجديد على أرضيّة منفصلة.
هذا ما يسميه المؤرخ التونسي هشام جعيط الرسوخ في التاريخ. يقول: «اعتبرت باكرًا أن الإيمان بالهوية ورسوخها في التاريخ العميق لا يمكن أن يحصل بدون أن ندخل بجدية فيما أسميته بالتحديث والسيرورة العربية نحو المستقبل. فأنا أومن بأهمية تحقيق التوازن بين الهوية الجماعية والدخول في التاريخ المعاصر». لا انخراط في الحداثة إذاً من غير احتفاظ بالخصوصية: «الحداثة عندي مرتبطة بالهوية، والهوية ما زالت تقوم بدورها الإستراتيجي في مقاومة الهيمنة الإمبريالية التي أخذت شكل الهيمنة الاقتصادية، وما دعوتي للغرب بالكف عن التدخل في شؤون العرب والمسلمين إلا انطلاق من اعتقادي في ضرورة التمسك بخصوصياتنا، وبالعناصر الأساسية التي انبنت عليها هويتنا وحضارتنا». لكن الهوية لا ينبغي أن تبقى دائمًا نبشًا في التاريخ ولا انغماسًا في التراث وتمترسًا وراء الدين واللغة. إنها لا تقوم كذلك على الذاكرة فحسب، بل تعني بناء الذات والمستقبل، واحتكاك الهويات الفردية، وانفتاحها على الأخلاقيات التي تقرّب بين البشر وتبني القيم، التي تفتح آفاقًا أمام الإنسان، وتعطي لحياته معنى، وتجعل منها قيمة عالية.
هذا التعلق بالهوية والخصوصية طرح على مفكرينا قضية الموقف من الدين، خصوصا وأن البعض رفعه ورقة ضد كل تحديث مدعيا أن لا مكان للعلمانية في حياتنا الاجتماعية. هذا ما يوضحه المفكر المغربي محمد سبيلا الذي يرى أن من الأشياء التي استثمرت في دينامية مقاومة أشكال التحديث والتطور هو إعطاء تصور سلبي للعلمانية، والذهاب إلى أن العلمانية ضد الدين، وأنها إلحاد وكفر الأمر الذي ولّد ما يسميه فهمي جدعان «رهاب العلمانية»!
لذا يستخلص سبيلا:«قيل وكتب الكثير حول العلمانية في هذا الإطار، وهذا له ارتباط بالمقاومة وتشويه المفاهيم لجعلها غير مستساغة لدى الجمهور». يميز سبيلا ين نوعين من العلمانية: فهناك العلمانية الراديكالية التي ظهرت بعد الثورة الفرنسية في مرحلة معينة، التي تقول: إن الدين تأخر وإن الدين ينتمي إلى مراحل تجاوزها التطور، وهي مرحلة غيبية ميتافيزيقية، ويجب إبعاده عن السلطة ويجب حماية المجتمع من هذا التصور، فهذا هو الحد الأقصى للعلمانية الراديكالية، ولكن هناك العلمانية العادية التي تقول: إنه يتعين الفصل بين الدين والسلطة، وليس إبعاد الدين كثقافة من ثقافات المجتمع، ولكن هي فقط تتحدث عن الجانب السياسي، بحيث إن استعمال الدين في الصراع السياسي هو مسألة فيها الكثير من الإجحاف، فيتعين أن يتطور المجتمع تلقائيًّا عبر صراعات اقتصادية وأيديولوجية في غياب استغلال الدين في السياسة. «الخلاصة في قضية العلمانية أن مضمونها في التجربة الأوربية سواء الثورية أو العادية، تبين أن تطوير المجتمع تطويرًا إيجابيًّا يتطلب الفصل بين الدين والسياسة بمعنى تدبير الشؤون العامة وشؤون الحكم وأن السلطة يجب أن تكون محايدة، فهذه هي الخلاصة التاريخية للشعوب بخصوص التجربة الأوربية الكونية.»
يتبنى فهمي جدعان التمييز ذاته، فهناك المفهوم الفرنسي للعلمانيّة، أعني «علمانيّة الفصل» المناهضة لكل دعوى أو رؤية دينيّة، إلا أن هناك مفهوما آخر وهي «علمانية الحياد». يقول: «فيما يتعلق بنا نحن، وبدين الإسلام، اليوم، نلاحظ أنّ الدين، يُوجَّه إلى صيغة أيديولوجية سياسيّة راديكاليّة، تضاد التصوّر الذي أتمثّله أنا شخصيًّا لهذا الدين بما هو منظومة اعتقاديّة، أي إيمانيّة، ذات ماهيّة إنسانيّة، وأخلاقيّة، وحضاريّة، وجماليّة، تتوافق مع «علمانيّة الحياد» لا مع «علمانيّة الفصل». أي مع «دولة مدنيّة» تصون الدين من التعدّيات والإساءات، وتحفظ لأهله الحريّة والكرامة والعدل التي هي قيم مشتركة بين الدين وبين الدولة الإنسانيّة العادلة. إنّ الغائيّة الأساسيّة لهذا الدين تكمن في مبدأ (العدالة)، وإنه «حيثما ظهرت أمارات العدل فثمّ شرعُ الله»، وأضيف أنّ القيم العليا الإنسانية كامنة في «الأصول البذريّة» والنصوص «المُحكَمة» لهذه القيم في (النصّ الدينيّ) الذي هو عندي ذو ماهيّة إنسانيّة أخلاقيّة أولًا وآخرًا، وأنّ فهم جميع النّصوص ينبغي أن يوجّه هذه الوجهة استنادًا إلى مبدأَيِ المُحكم والمؤوّل».
لا يرى هشام جعيط جدوى في هذا النقاش القائم حول مفهوم العلمانية على اعتبار أنها وضع قائم، يقول: «فيما يخصنا كعرب ومسلمين، فإننا قبل أن ندخل في الحداثة (دخلنا في الحداثة في الخمسينيات من القرن الماضي) كنا مستعمرين، وكان الدين يسيطر على البلدان الإسلامية كلها تقريبًا، وفي جميع أشكال حياتها. ثم ماذا نعني بإلغاء الدين؟ هل هو فصل الدين عن السياسة أم فصله عن الاقتصاد؟ والإجابة على ذلك أن هذا الفصل هو اليوم أمر واقع تقريبًا حتى في بلداننا. ومثلما أرى أنه لا داعي لفكرة بعث ميثاق لحقوق الإنسان المسلم، وكانت قد بادرت بها بعض الدول الإسلامية؛ لأني أعتقد أن المسلم ليس كائنًا مختلفًا، وأن مواثيق الأمم المتحدة عامة تسري على الناس جميعهم، فإني لا أرى كذلك ضرورة أو أهمية لظهور مثل هذا التيار الداعي لإلغاء عنصر الدين؛ لأن الدين موجود ومتغلغل داخل غالبية الفئات الاجتماعية، أما الفصل بين الدين والسياسة، وبين الدين والاقتصاد فهو كما سبق وذكرت قد أصبح أمرًا واقعًا.»
مسألة النخب الثقافية

حسن حنفي
بينما يرى حسن حنفي أننا في العالم العربي «لم نجرب حتى الآن النخبة الثقافية، كما حدث في الثورة الفرنسية». فإن المفكر التونسي الطاهر لبيب يرى أن مفهوم النخبة انبنى في مراحل سابقة كمراحل التحرير الوطني وبناء الدولة الوطنية أو في مراحل نضالية كتلك التي عرفتها الستينيات وبعض السبعينيات في أغلب البلدان العربيّة. في تلك المراحل أسند المثقف إلى نفسه أو أُسندت إليه أدوار كانت مرتبطة بأحلام جماعية وبمشاريع وبدائل مجتمعية لم تعد قائمة اليوم. لذا يستخلص المفكر التونسي أن هذه الأدوار التي كان المثقف في العالم العربي قد أنيط بها، والتي على أساسها كان المثقف عنصرا أساسيا في تزكية النخبة، قد انتهت. لذا فإن مفهوم النخبة نفسه أصبح غير ذي معنى، بل استُغنِي عنه.
يتفق برهان غليون مع المفكر التونسي في هذه النقطة، فهو يعتبر مثله أن النخب الثقافية قد لعبت دورا إيجابيا في بداية التحرر من الاستعمار، وأنها استطاعت بالفعل أن تربح النزاع مع سلطات الوصاية الأجنبية، وتبني دولًا وطنية خاصة بها. وكانت هذه اللحظة من اللحظات التاريخية المهمة والمضيئة والحاسمة في تاريخ العرب الحديث. لكنه يعقب: « ما إن استتب الأمر لهذه النُّخَب حتى بدأت مسارًا معاكسًا، وهو إعادة الشعوب إلى الحظيرة، وإجبارها على التخلِّي عن مكتسباتها. منذ الاستقلال كان هَمُّ النُّظُم الحاكمة هو تجريد شعوبها من آمالها وتطلعاتها في المشاركة والتحوُّل إلى رجال أحرار قادرين على المساهمة في تقرير مصير مجتمعاتهم. باستثناء مرحلة سيطرت عليها الشعبوية؛ أي: مخاطبة الشعب المهمَّش مع الإبقاء على تهميشه، وهي ما نُسمِّيه المرحلة القومية؛ إذ اصطبغ تاريخ هذه الشعوب بالديكتاتورية الدموية وحكم القهر والعنف.»
يؤكد هشام جعيط هذا التراجع لدور المثقف العربي. ذلك أن أطرافا تتمتع بقدرة كبيرة على التأثير في الجموع على غرار القيادات السياسية والحزبية قد حلت محله. هذا ما يذهب إليه الطاهر لبيب أيضا. فهو يرجع تدهور دور النخب إلى التحولات الكبرى التي عرفها عالم اليوم: «فالعلاقة التي تعوّدنا على رصدها وتحليلها بين الثقافة والواقع قد تفكّكت أو تميّعت، خصوصًا مع انتشار ثقافة معولمة من الصعب ربطها بمكوّنات البنية الاجتماعية المحليّة. إن الكثير مما كان يعدّ ثقافة النخبة أصبح من قبل بادئ الرأي الذي تتناقله وسائل الاتصال الحديثة. لهذا يستخلص المفكر التونسي قائلا: «إذا أردنا المحافظة على حد أدنى من التصنيف فليكن بين المثقف والمفكر. كل الناس مثقفون بطريقة أو بأخرى، ولكن ليسوا كلهم مفكرين».
يعتمد فهمي جدعان هذه المقابلة بين المفكر والمثقف الداعية: وهو يعتقد أنّ المثقف يحتاج، كي يفهم الواقع ويحلّله ويوجهه، إلى المفكر وأدواته العلميّة والفلسفيّة المنضبطة والضابطة؛ لأنّ التعويل يكون على «قول» المفكر، لا على «رغبة» المثقف.يقول: «المثقف يحتاج حاجة ماسّة إلى المفكر وأدواته العلميّة والفلسفيّة المنضبطة والضابطة. وفي أمر فهم الواقع وتحليله وتوجيهه ينبغي، في رأيي، التعويل على «قول» المفكر، لا على «رغبة» المثقف. و«القول» يُحيل إلى العقل والعلم، و«الرغبة» تُحيل إلى الظنّ والشهوة».
* * *
تلك أبرز النقاط التي دارت حولها هذه الحوارات. لا يمكننا أن نختم هذا التقديم الموجز من غير أن نشير إلى الموضوعات التي غابت عنها. ولعل ما يلفت الانتباه عند الاطلاع عليها، هو عدم إشارة أي واحد من مفكرينا إلى الدور الذي يمكن للفن أن يلعبه في نهضة المجتمعات العربية. صحيح أن بعض المتحاورين أشاروا إلى اهتماماتهم الأدبية والروائية على الخصوص، إلا أن الظاهر هو أنهم لا يعولون كثيرا على الفن بجميع أشكاله سبيلا إلى نهضة الشعوب، وتفتح قدرات الأفراد، وتربية أحاسيسهم والارتقاء بأذواقهم وانفتاحهم على القيم السامية.

بواسطة عبدالسلام بن عبدالعالي - كاتب مغربي | سبتمبر 1, 2019 | مقالات
لو أننا حدّدنا الفلسفة على أنّها فن إطلاق العنان للأفكار العامة المتناقضة فيما بينها بصدد أيّ موضوع من الموضوعات، فإننا نستطيع أن نؤكد أنها قديمة قدم العالم، وأن التفكير الفلسفي وجد منذ وجد البشر الذين ينطقون ويتكلمون، أما إذا لم تكن الفلسفة مجرد ممارسة للتفكير، أما إذا كانت، كما يقول هيغل، طريقة خاصة جدًّا في التفكير، فإن الأمور ستتخذ منحى آخر.
نتجه نحو هذا المنحى إن أولينا اهتمامنا إلى اللفظ «فلسفة» الذي يقول عنه هايدغر: إنه يتكلم يوناني. لفظ «فلسفة» في جميع اللغات نقل حرفي عن اللغة اليونانية. الفلسفة تسمى في جميع اللغات «فلسفة» كما يلاحظ بوفري. يصدق هذا على لغتنا العربية، لكن أيضًا على اللغة الإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية والروسية بل حتى الصينية. جميع اللغات تنقل اللفظ اليوناني وتنقلنا، نحن المتقصّين لأصول الفكر الفلسفي، إلى يونان حيث ازدهرت أشكال جديدة من التنظيم السياسي سمحت للنظام الطبيعي أن ينفصل عن الوظيفة السياسية، كما مكّنت التفكير من أن يتخلص من الطابع الأسطوري الذي كان يروي حكاية تعطي حلًّا لسؤال لم يوضع؛ كي يعرض نفسه في صيغة أسئلة أصبح الجدال حولها مفتوحًا وفي الساحة العمومية.
ليس من قبيل المصادفة إذن أن ينفصل الفكر الفلسفي عن الفكر الأسطوري عند الإغريق نتيجة لذلك الشكل الخاص من المؤسسات السياسية الذي يُدعى «مدينة» والذي يحقق على مستوى الأشكال الاجتماعية، الفصل بين الطبيعة والمجتمع، وهو الفصل نفسه الذي تفترضه ممارسة التفكير العقلاني على مستوى الأشكال الذهنية. مع ظهور «المدينة» انفصل البوليس عن الكوسموس، انفصل التنظيم السياسي عن النظام الكوني، وظهر كمؤسسة بشرية تخضع لبحث دائب وجدال متواصل، فأخذت مجموعة بشرية ترى أن شؤونها العامة لا يمكن أن يُتخذ فيها قرار إلا بعد جدال عام يواجه أفكارًا متناقضة فيما بينها، يساهم فيه الجميع وتتعارض فيه الخطابات المدعَّمة بالبراهين والحجج.
يشكل مفهوم الجدال والمحاجّة التي تقبل باختلاف الآراء وتضاربها شرطًا أساسيًّا لكل تفكير فلسفي. فلا فلسفة إلّا إذا سلّمنا أن جميع الأسئلة والقضايا يمكن أن تكون موضع جدال مفتوح. نقضي على التفكير الفلسفي لحظة إيقاف ذلك الجدال باسم عامل يَخرج عن آلية الجدال ذاتها، واسم سلطة ليست هي سلطة العقل. حتى سلطة العقل هذه لا ينبغي أن نفترضها محكمة عليا وشيئًا متعاليًا بعيدًا من عملية الجدال يُملى عليها القواعد ويُبين لها الطريق. إنها، على العكس من ذلك، محايثة لذلك الجدال متصلة به. بل إنها لا تنمو إلا في ثناياه، ولا وجود لها خارجَه، وهي ليست في نهاية الأمر، إلا تلك التقنيات الذهنية التي تختص بها ميادين معينة للتجربة والمعرفة. معنى ذلك أن العقل ليس مبادئ تُملَى وقواعد تُطبّق، إنما حياة تمارس، وتقنيات تُنظم وفقها الأفعال والأقوال، والتجارب والمعارف؛ كي تجد هذه كلُّها التعبير عنها في لغة ملائمة تكون موضع عمليات ذهنية خاضعة لقواعد تتحكم في لعبتها. إذا سمحنا إذن لعوامل خارجية بأن تتدخل في هذه «اللعبة» حِدْنا عن التفكير الفلسفي، وقضينا على العقل وخنقنا العقلانية. معنى ذلك أن سمة الانفتاح وعدم الانغلاق – الانفتاح على المستقبل وعلى الآخر- شرط أساس، لا لاستمرار التفكير الفلسفي وانتعاشه فحسب، إنما لميلاده ونشأته.
خاصية مستحيلة التحقق
هناك خاصية مزدوجة للفكر الفلسفي إذن، وهي (خاصية) قد تبدو متعارضة الأطراف مستحيلة التحقق: فهو يفترض ذاتًا نختلف معها ونجادلها، إلا أننا ننفتح عليها ونتفاهم معها في الوقت ذاته. فلا تعني العقلانية مطلقًا الإجماع حول رأي واحد إنما تتعارض مع ذلك الإجماع. لكنها لا تعني كذلك عدم التفاهم المطلق. أكاد أقول: إنه إن كان هناك تفاهم منشود هنا فلا وسيلة إليه إلا الانطلاق من سوء التفاهم ذاته، وإن كان هناك إجماع فلا طريق إليه إلا الجدال الذي يقبل بتعدد الآراء واختلافها وتضاربها. وهكذا سيغدو «الاختلاف رحمة»، وتغدو العقلانية طريقًا مفتوحًا على المستقبل، متفتحًا على الآخر، وتصبح حياة تُغزى وتكتسح، وتجربة تُغذّى وتُرعى، ونضالًا متواصلًا ودربًا لا نهاية له.
طبيعي، والحالة هذه، أن يعرف مجال المعقولية تحولات بتجدد المقاومات التي تقوم أمام العقل أثناء فعاليته. فالعوائق التي يواجهها العقل لا تظل هي هي. نعلم أن تلك المقاومات اكتست أسماء متنوعة حسب الحقب وحسب الفلاسفة وحسب المجالات، فاتخذت اسم العوائق الإبيستمولوجية تارة، واتخذت اسم الفكر الأسطوري تارة أخرى، كما ضُمّت تحت اسم الأيديولوجية في غالب الأحيان. لا يسمح لنا الوقت هنا بأن نخوض في عرض تاريخي لتلك العوائق. ويكفي أن نتوقف عند ما يعنينا، فنتساءل عن العوائق التي يواجهها التفكير الفلسفي اليوم؟ وماذا يستطيع حيالها؟
عندما نتكلم عن عوائق متجددة فلا يعني ذلك بالضرورة أن العوائق التقليدية مضت وامّحت: لا يعني أن المعرفة غدت تتم في جو من المسالمة والهدنة، كما لا يعني أن عالمنا غدا متحررًا من كل طابع أسطوري، وهو لا يعني بالأولى أنه عالم بلا أيديولوجية كما يقال. قد تكون كل هذه العوائق لا تزال حية فاعلة، إلا أنها لم تعمل إلا على تغيير حُلَّتها. لا شك أن هذا يصدق أكثر ما يصدق على العوائق الأيديولوجية التي يظهر أنها غدت تعمل في عالمنا على غير النحو الذي عملت به حتى الآن. عندما كانت الستينيات من القرن الماضي تقابل بين «العلم والأيديولوجية»، أو بين «الحقيقة والأيديولوجية»، فإنها كانت ترى أن الآلية الأيديولوجية تتمثل أساسًا في كونها أداة لخلق الأوهام وتغليف الحقائق دفاعًا عن المصالح.
ليس في إمكاننا اليوم، بطبيعة الحال، أن نقابل بين التفكير الفلسفي والأيديولوجية إذا اقتصرنا على هاته المعاني عن الآلية الأيديولوجية. ذلك أن هاته الآلية لم تعد اليوم تتمثل في الدفاع عن المصالح، لا يمكننا أن ندرك الآليات التي تعمل وفقها الأيديولوجية إن نحن بقينا تحت قهر «نظرية المصالح»، ولا حتى نظرية الاستلاب. ذلك أن هذه الآلية أصبحت تلعب دورًا مهمًّا من حيث هي إعادة إنتاج لعلائق الإنتاج، وكونها الأسمنت الموحّد للمجتمع، المغلّف لتناقضاته، المقنّع للاختلافات فيه، الباثّ لنوع من الرأي الأوحد الذي يكبل التفكير ويقتل الاختلاف ويخنق كل روح نقدية. إنها الآلية التي تجعل التناقض انسجامًا، والاختلاف تطابقًا، والتعدد وحدة. الأيديولوجية لا تقتصر على الدفاع عن مصالح، ولا على القلب والتغليف، ولا حتى على خلق الأوهام، وإنما تذهب حتى تغليف التناقضات وقهر الاختلافات لخلق الوحدة والقضاء على التعدد.
على هذا النحو فالآلية الأيديولوجية آلية فعّالة. إنها ليست مرآة عاكسة منفعلة، تعكس الواقع الاجتماعي وما يتفاعل فيه، وإنما هي عامل محدّد، وفعالية نشطة، ومقاومة مستميتة. الأيديولوجية قدرة جبّارة على التلوُّن والتقنّع، وقدرة خارقة على التلوين والتقنيع وخلق الأوهام، إلا أنها لا تكتفي بتشويه الأفكار وقلب الحقائق، ووظيفتها ليست وظيفة إبيستمولوجية ما دامت آلية لخلق التطابق وقهر الاختلافات. لو نحن استعملنا الأيديولوجية بهذا المعنى لغدا من المتعذر علينا الحديث عن موتها كما يتداول اليوم، ما دامت آلية أساسية، لا أقول لخلق الواقع، وإنما لخلق «ما يعمل كواقع» على حد تعبير فوكو.
فهذه الآلية تتمثل اليوم في جعل الواقع مفعولَ ما يُصوّر به وما يقال عنه. المنطق المتحكّم هنا منطق غريب يمزج بين الحلم والواقع، ويخلق الواقع الذي يتنبأ به فينبئ عنه. هذا المنطق هو المتحكم في آليات الإعلان والدعاية حيث تغدو الأيديولوجية هي ما يجعل الأشياء حقيقة بمجرد التأكيد الدائم على أنها كذلك. إنها لبّ لا واقعية الواقع، لبّ «سريالية الواقع». هو إذًا واقع يفقد شيئًا من الواقعية، واقع يتلبس الوهم ويتحوّل إلى سينما. لا عجب إذًا أن تغدو الشاشة اليوم صورة عن الواقع إن لم تكن هي الواقع ذاته في مباشرته وحيويته وحياته. مع ما يتمخض عن ذلك من تحوّل لمفهوم الحدث نفسه حيث تغدو الأحداث الجسام وقائع مشتتة يجترها الإعلام كي يحشرنا في الراهن ويغرقنا فيه.
توتاليتارية الإعلام
قد يؤخذ علينا هذا الانزلاق من الحديث عن التفكير الفلسفي إلى الحديث عن الأيديولوجية فالإعلام. إلا أننا نرد بالسؤال: هل يمكننا اليوم أن نتحدث عن التفكير الفلسفي، وعن العقل وإمكاناته من دون هذا الربط، ومن غير الحديث عن الآلية الأيديولوجية وما تمثله وسائط الاتصال كمعوقات لذلك الفكر؟ ألا تشكل تلك الوسائط غذاءنا اليومي إلى حدّ أن بإمكاننا أن نتكلم اليوم عن توتاليتارية الإعلام، شريطة أن نرى أن التوتاليتارية هي كذلك تعمل في عالمنا على غير النحو الذي عملت به ربما إلى حد الآن. فليس وراءها اليوم نازيٌّ مُتشنِّج ولا شيوعيٌّ متعصِّب، إنما وراءها الإعلام بما يولِّده من أفراد فقدوا القدرة على إدراك حقيقة التجربة الفعلية، أفراد لم يعد في إمكانهم أن يستشعروا حقيقة العالم الواقعي، ولا معنى ما يتم فيه، وغدوا عاجزين عن تحديد صحة الخطابات، بل إنهم صاروا فاقدين لأدوات تمحيصها، وأصبحوا مستعدين لأن يتقبلوا أيّ خطاب حول العالم. إنهم أفرادٌ فقدوا كل معيارية، فقدوا القدرة على التفرقة والتمييز، القدرة على التفكير.
فقدان هذه القدرة، أو ما يطلق عليه البعض «الدوخة الأيديولوجية»، أليس هو ما أصبح يولّد هذا الهروب إلى الأمام الذي يطبع النزعات الأصولية والذي يجعل جيلًا بكامله يشعر أن العقل لم يعد يقوى على شيء، وأن لا حيلة له أمام العوائق مهما كانت: قديمها وجديدها؟ أليس هو ما يوجد وراء الفكر الوثوقي الذي لم يعد مجرد فكر نظري يتقبل الآراء بعيدًا من كل روح انتقادية، إنما غدا موقفًا أخلاقيًّا- سياسيًّا بالأساس، بل موقفًا شديد العنف، يتجلى عنفه، لا بما يصدر عنه من أقوال، بل بما ينطوي عليه من آلية موحدة ترفض كل تعدد للآراء واختلاف للمواقف، وكل تردّد بين شك ويقين. وهو الأمر الذي يدفعه إلى أن يُدخل كل الأمور في دائرته فيجبرها على الخضوع لمنطقه، مع ما يقتضيه ذلك من آلية إكراهية. وقد سبق لنيتشه أن بيّن أنّ كل آلية موحدة، لا تكون كذلك إلا بما هي تنظيم وإكراه وإقحام، وإلا بما هي مقاومة فوضى الكثرة، وسَنّ منطق الهيمنة والإخضاع والقهر.
هذه الآلية هي التي تمنع الوثوقي من أن يقبل بتعدّد الآراء، وبالأحرى اختلافها. لكن، قبل أن يرفض الوثوقي الاختلاف مع غيره، يبدأ أولًا بالامتناع عن الاختلاف مع نفسه، أو، على الأصح، بالخضوع لاستحالة الاختلاف مع الذات. قبل أن يسدّ الوثوقي الأبواب على الغير، يسدّها على نفسه، و قبل أن يمارس عنفه على الآخرين، يرزح هو نفسه تحت ضغط البداهة وعنفها. فالوثوقي لا يُخضع فكره للمنطق، بل إنه يخضع كل شيء لمنطقه هو. من هنا ذلك الادّعاء بالإحاطة بكل شاذة وفاذة؛ إذ إن أيّ تحفظ أو تردّد من شأنه أن يحطّ من مكانته ويضعف سلطته وهيبته. من هنا الطابع الكلياني للوثوقية وتوتاليتاريتها.
ذلك أن هناك ارتباطًا وثيق الصلة بين الكلي Total والكلياني Totalitaire، بين الرّغبة في الإحاطة بكل شيء، وبين التفرّد بالرأي والتوتاليتارية، وهو ارتباط يتجاوز المستوى اللفظي. ذلك أن التوتاليتاري يتسم بمنطق الحصر والنظرة الكلية، التي تدّعي أن لا شيء يفلت من إحاطتها. من هنا ابتعاده التامّ من كل تحفظ وتردّد، وحسمه المتسرع في كل ما من شأنه أن يفصح عن نقص وعجز، نظرًا لما يترتب عن ذلك، ليس من إظهار لضعف نظري فحسب، وإنما من تنقيص من صاحب الرأي ومسّ بهيبته وسلطته. فالنقص هنا أيضًا لا يتوقف عند المعرفة والنَّظر، إنما يطول الهيبة والسّلطة. إنه ليس مجرَّد جهل بأمور، إنما هو علامة على قصور وعجز وضعف؛ لذلك فإن ما يميّز الفكر الوثوقي هو قدرته الخارقة على الإفتاء في جميع النوازل مهما كانت طبيعتها ودرجة تعقيدها. فهو لا يرى في كل شكّ أو تردّد إلا علامة عجز، ولن ينظر إلى الخطأ إلا على أنه خطيئة.
ليس الفكر الوثوقي الدوغمائي الذي يسبح في البديهيات واليقين، عنيفًا بما يتولد عنه من مفعولات، وما يتمخض عنه من نتائج، إنما بما هو ينشدّ، أو يُشدّ إليه على الأصَّح، وما يعتقده طبيعيًّا بَدَهيًّا مُسَلَّمًا به. فكأن العنف هنا عنف بنيوي. وقد سبق لرولان بارت أن بيَّن أن البداهة عنف، و«أن العنف الحقّ هو أن تقول: طبيعي أن نعتقد هذا الاعتقاد، هذا أمر بدهي».
كان ديكارت، أبو الفلسفة الحديثة، قد حدَّد البداهة بربطها بمفهوم الوحدة والبساطة، مثلما ربط الشكّ بالتعدّد والتركيب. فالذهن لا يشك ويحار إلا إذا تعددت أمامه المسالك وتعقدت الدُّروب. الشكّ حيرة واختيار وحرية، أما البداهة فجبر وقهر واستعباد. إن كان أمامك مسلك واحد، فإنك لا تملك إلا أن تأخذه، أو لنقل بالأولى إن المسلك هو الذي يأخذك فتنقاد نحوه متوهمًا أنك تملك الحقيقة، ناسيًا أنك مملوك لها، خاضع لقهرها، معرَّض لعنفها.
على هذا النحو فإن الوثوقية عنف وقمع بما هي بداهات تسدّ أبواب الشك وتوصد سبل النقد فتسجن صاحبها داخل «كلّ موَحَّد» وتحول بينه وبين أن يتنفس هواء الحرية. لذا فهي ترتبط بالتشنج وأحادية الرأي وما يتولد عنها من قمع للآراء المخالفة، وعدم اعتراف بالرأي الآخر، برأي آخر، الأمر الذي قد يؤدي بها إلى عدم الاقتصار على العنف الرمزي، لكن هذا العنف لن يكون في جميع الأحوال إلا امتدادًا لعنف بنيوي.
لا يمكن للفكر أن يتحرّر من الوثوقية إلا عندما تنفتح أمامه الأبواب، وتتعدد السّبل، وتتعقد المسالك. آنئذ، إن كانت هناك بداهة، فهي لا يمكن أن تكون إلا عند نهاية مسار، وإن كان هناك وصول إلى حقيقة، فلا يمكن أن تكون إلا تعديلًا مفتوحًا لرأي، وتصحيحًا لأخطاء بحيث لا تُدرك، كما قال باشلار، «إلا في جوّ من النّدم الفكريّ». هنا وهنا فقط يتحدد الفكر كتراجع وانعكاس réflexion، ويغدو الفكر مرادفًا للنقد. وهنا يغدو التفكير فلسفيًّا بحق فيعيد للعقل ثقته بنفسه، ويفتح الباب لمشروعية السؤال، ويصبح مقاومة للبلاهة وكل أشكال اللافكر التي نتغذى عليها ونتشربها يوميًّا، والتي يعمل مجتمع الفرجة على تكريسها في أدمغتنا وترسيخها في تصرفاتنا ساعيًّا لأن يقنعنا بأنها فكر بل كل الفكر، كي يجعلنا نحيا طبق ما تجري عليه الأمور وعلى شاكلتها. وغني عن التذكير بأن هذا التغلغل في اليومي يتطلب عدم اقتصار فعل التفلسف على المنابر الأكاديمية، وزحزحته عن مواقعه المعهودة، وموضوعاته المستهلكة بهدف بلورة فكر- مضاد يحدث شروخًا في عالم ينحو نحو التنميط و«التبلّه».

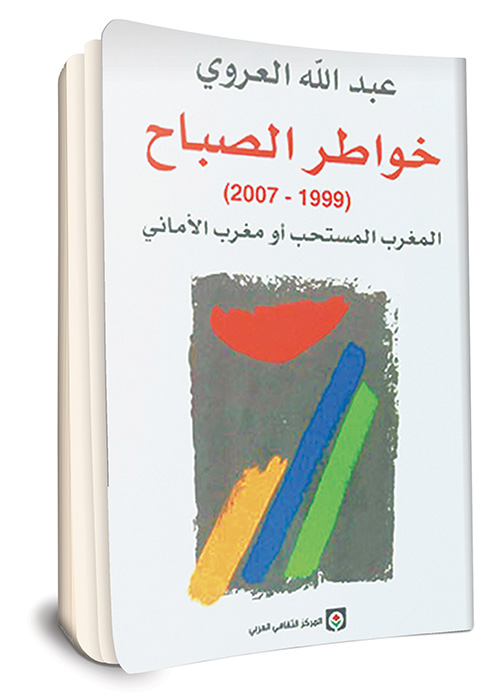 نستطيع أن نقول: إن البورتريه الذي رسمه عبدالله العروي للفنان البلجيكي ر. ماغريت في الجزء الأول من كتابه «خواطر الصباح»، هو، إلى حد ما، «بورتريه ذاتي». نقرأ في هذا الكتاب: «روني ماغريت: لم أتأثر بألوان فنان مثلما تأثرت بأعماله التي تمزج الحلم والعقل. لوحاته، ملصقاته في الواقع، تمثل أحلام رجل رصين متعقل طلق الرومانسية بعد، أو قبل، أن يعرفها. أثر فيَّ لأنه أبعد ما يكون عن ميلنا الغريزي إلى دغدغة العواطف. لا أتصوره يضحك أو يبكي، قد يمزح وهو مقطب». يحكي ابن أخي العروي، الكاتب فؤاد، في إحدى مقابلاته التلفزيونية، أنهما التقيا مرة في معرض باريس، وأنه عندما قدم عمه لناشره الفرنسي مازحًا، علق عبدالله العروي قائلًا: «هذا هو الوحيد في عائلتنا الذي يمزح، أنا يتعذر علي ذلك، وحتى إن مزحت فمقطبًا».
نستطيع أن نقول: إن البورتريه الذي رسمه عبدالله العروي للفنان البلجيكي ر. ماغريت في الجزء الأول من كتابه «خواطر الصباح»، هو، إلى حد ما، «بورتريه ذاتي». نقرأ في هذا الكتاب: «روني ماغريت: لم أتأثر بألوان فنان مثلما تأثرت بأعماله التي تمزج الحلم والعقل. لوحاته، ملصقاته في الواقع، تمثل أحلام رجل رصين متعقل طلق الرومانسية بعد، أو قبل، أن يعرفها. أثر فيَّ لأنه أبعد ما يكون عن ميلنا الغريزي إلى دغدغة العواطف. لا أتصوره يضحك أو يبكي، قد يمزح وهو مقطب». يحكي ابن أخي العروي، الكاتب فؤاد، في إحدى مقابلاته التلفزيونية، أنهما التقيا مرة في معرض باريس، وأنه عندما قدم عمه لناشره الفرنسي مازحًا، علق عبدالله العروي قائلًا: «هذا هو الوحيد في عائلتنا الذي يمزح، أنا يتعذر علي ذلك، وحتى إن مزحت فمقطبًا».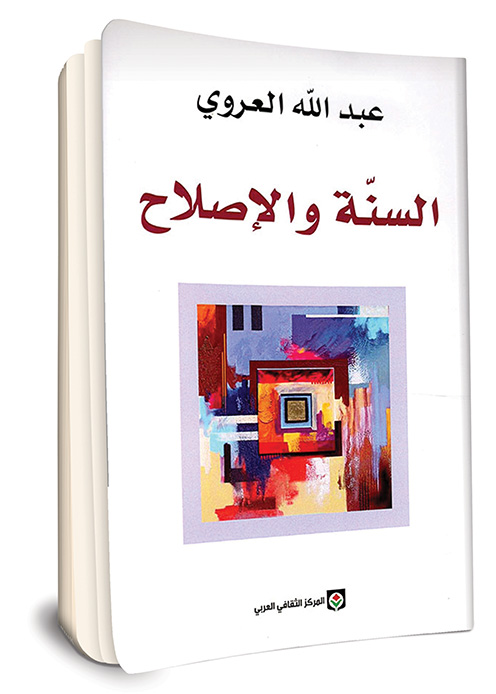 في كتاب «السنة والإصلاح» نستشف معنى للتاريخانية أكثر تركيزًا. فهي إيمان بقوة الزمن، إيمان بأن «الوقوف على البدايات يكشف حتمًا الدوافع والغايات»، إيمان بأن السابق يحدد اللاحق، إيمان بالتسلسل الزمني. (نقرأ في ص 28 من هذا الكتاب: «فالإلغاء التعسفي للتسلسل الزمني يدعو حتمًا إلى معاداة التاريخانية وتحويلها إلى نظرية عامة يسهل تفنيدها»). ثم إن التاريخانية إيمان بقوة الحدث. فالحدث هو الذي «يميز ما هو نيو، وما هو بوست».
في كتاب «السنة والإصلاح» نستشف معنى للتاريخانية أكثر تركيزًا. فهي إيمان بقوة الزمن، إيمان بأن «الوقوف على البدايات يكشف حتمًا الدوافع والغايات»، إيمان بأن السابق يحدد اللاحق، إيمان بالتسلسل الزمني. (نقرأ في ص 28 من هذا الكتاب: «فالإلغاء التعسفي للتسلسل الزمني يدعو حتمًا إلى معاداة التاريخانية وتحويلها إلى نظرية عامة يسهل تفنيدها»). ثم إن التاريخانية إيمان بقوة الحدث. فالحدث هو الذي «يميز ما هو نيو، وما هو بوست».


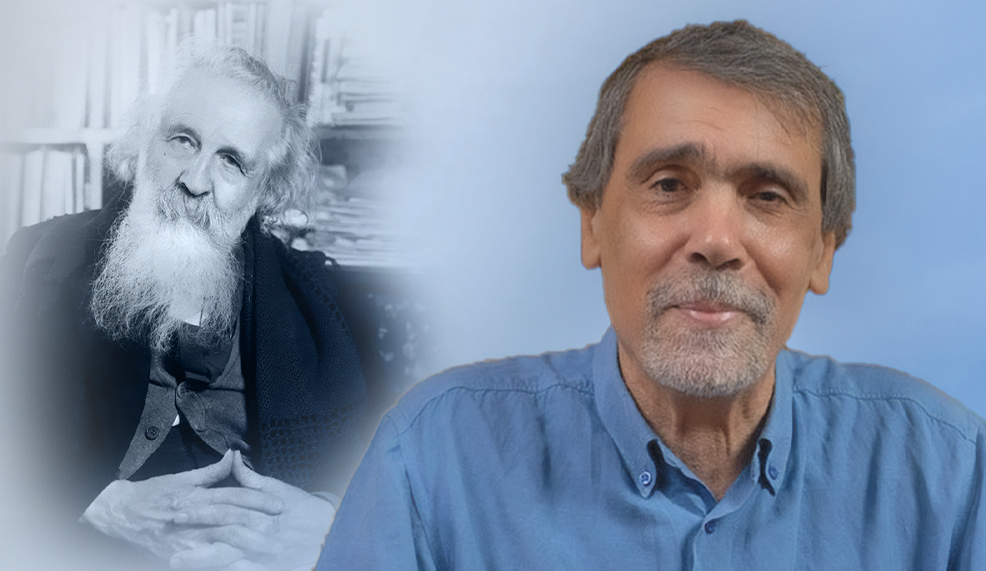
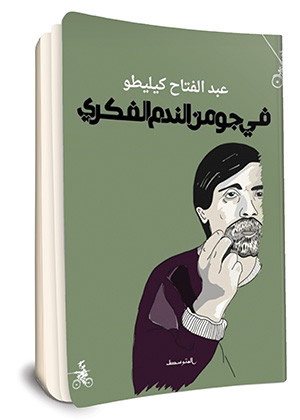 يستلهم كيليطو إبيستمولوجيا البداهة هذه من الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار. نتبين ذلك بمجرد أن نفتح الكتاب الذي يُستهل في عتبته بهذه العبارة المأخوذة من كتاب «تكوين الفكر العلمي» حيث يقول باشلار: «إذا ما تحررنا من ماضي الأخطاء، فإننا نلفي الحقيقة في جو من الندم الفكري. والواقع أننا نعرف ضد معرفة سابقة، وبالقضاء على معارف سيئة البناء، وتخطي ما يعرقل، في الفكر ذاته، عملية التفكير».
يستلهم كيليطو إبيستمولوجيا البداهة هذه من الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار. نتبين ذلك بمجرد أن نفتح الكتاب الذي يُستهل في عتبته بهذه العبارة المأخوذة من كتاب «تكوين الفكر العلمي» حيث يقول باشلار: «إذا ما تحررنا من ماضي الأخطاء، فإننا نلفي الحقيقة في جو من الندم الفكري. والواقع أننا نعرف ضد معرفة سابقة، وبالقضاء على معارف سيئة البناء، وتخطي ما يعرقل، في الفكر ذاته، عملية التفكير».







