
بواسطة الفيصل | أغسطس 31, 2017 | تحقيقات
لم يكن المسرح العربي يعرف في زمن ما معنى «أزمة» مثلما يعرفها الآن، على الرغم من كثرة ترديد المسرحيين لهذه الكلمة. فعلى مدار تاريخه منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى وقتنا الراهن والمشتغلون في مجال المسرح يتحدثون عن وجود أزمة في المسرح، ربما تمثلت في قلة النفقات، وربما في ندرة خشبات العرض، أو حتى تفتت الفرق الكبرى ورحيل النجوم والمؤسسين. لكن طيلة الوقت كان ثمة ورق جديد لكتاب جدد، وجمهور كبير يقبل على هذا الفن الذي يمكنه أن يستوعب مختلف الفنون الأخرى، بدءًا من الغناء والموسيقا والرقص إلى الإلقاء والتأليف والوعظ والإلهاء والتثوير، حتى إنه في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي كان هو الفن الجماهيري الأول. واستطاع منافسة السينما والتلفزيون لسنوات طويلة، حتى إن مسرحية «الزعيم» لعادل إمام ظلت تعرض لأكثر من عشر سنوات على المسرح، وما زالت أعمال سعد الله ونوس ومحمد الماغوط ومحمود دياب وعلي سالم والرحبانية وغيرهم قادرة على إمتاع الناس حتى الآن، لكن السنوات الأخيرة كشفت أن المسرح العربي خرج من المنافسة، ولم يعد قادرًا على إمتاع الجماهير أو جذبهم، وأن تجارب مثل مسرح مصر أو غيرها لم تقدم إلا مزيدًا من التسطيح، وأن فن البسطاء لم يعد قادرًا على التعبير عن همومهم أو ثوراتهم أو مخاوفهم، فهل يعيش المسرح العربي الآن في أزمة، وما أسبابها؟ وكيف يمكن الخروج منها؟
زياد عيتاني: الإعلام يتعامل مع المسرح بطريقة خاطئة
الصعوبات التي تواجه العاملين بالمسرح أولها الإعلام الذي غيّب عن الناس الثقافة العامة، ونعني بالثقافة العامة أن نقدم مسرحًا قائمًا على الروايات الكلاسيكية الشهيرة، أو الأعمال التي يقال عنها: إنها نخبوية، وهي في حقيقة الأمر غير ذلك، فما معنى أن يعطي الإعلام انطباعًا عن المسرح أنه أمر ثقافي كبير وخاص بالمثقفين أو نخبة معينة من الناس، ألم يكن ما قدمه محمد الماغوط مع دريد لحام ثقافة شعبية؟!، ألم يلامسا كثيرًا من الأمور المهمة في عالمنا العربي؟ الشيء نفسه فعله لينين الراملي مع محمد صبحي. فلماذا الترويج للمسرح كأن إيقاعه بطيء ونخبوي، ولا يمكنه أن يجاري ما هو سائد بالسوق؟ هل ما هو سائد بالسوق هو كل ما نملك؟ لا أظن. من المؤسف أن الإعلام تعامل مع المسرح بطريقة خاطئة، فالمسرح أبو الفنون، ولا بد أن يمنح الحيز الأول، فلماذا تغيبت الأعمال الروائية عن الدراما التلفزيونية، ما زلنا نتذكر التلفزيون المصري وهو يقدم أعمالًا لتشيخوف، من بينها سهرة تلفزيونية مدتها ساعة بعنون: «الرهان»، قام ببطولتها يحيى الفخراني، هل كانت نخبوية؟ لا لم تكن نخبوية، فقد كتبت بأسلوب عصري سريع يناسب الشباب، وهكذا يمكننا أن نمثل كثيرًا من الأعمال العالمية المهمة، لكن الإعلام لا يساعد.
 الأمر الثاني هو الإنتاج الذي يسعى للربح السريع دائمًا، فيطالب المسرحيين بشيء أقرب إلى ما يسمى بـ«اللايت»، على أساس أنك لا تستطيع أن تقدم للعالم غير اللايت، بالطبع لا، فأنا قدمت ثلاث مسرحيات، إحداهن بلبنان، لبنان الذي تعداده أربعة ملايين نسمة، استمرت لمدة ثلاث سنوات، حضرها 45 ألفًا، وهي نسبة كبيرة، كانت المسرحية بعنوان: «طريق جديد» وهي مقاربة تاريخية كوميدية لعدة نقاط في عالمنا العربي، فماذا كان دور المنتج، المنتجون يفضلون دائمًا الربح السريع، يفضلون ما يعرف بـ«الكوميدي لايتس»، وهو ما أثر في مفهوم المسرح الشعبي.
الأمر الثاني هو الإنتاج الذي يسعى للربح السريع دائمًا، فيطالب المسرحيين بشيء أقرب إلى ما يسمى بـ«اللايت»، على أساس أنك لا تستطيع أن تقدم للعالم غير اللايت، بالطبع لا، فأنا قدمت ثلاث مسرحيات، إحداهن بلبنان، لبنان الذي تعداده أربعة ملايين نسمة، استمرت لمدة ثلاث سنوات، حضرها 45 ألفًا، وهي نسبة كبيرة، كانت المسرحية بعنوان: «طريق جديد» وهي مقاربة تاريخية كوميدية لعدة نقاط في عالمنا العربي، فماذا كان دور المنتج، المنتجون يفضلون دائمًا الربح السريع، يفضلون ما يعرف بـ«الكوميدي لايتس»، وهو ما أثر في مفهوم المسرح الشعبي.
يمكن للنهوض أن يحدث من خلال ثلاثة محاور أساسية: أولها هو الإعلام، وثانيها هو السلطة أو الدولة التي لا بد أن تضع المسرح ضمن مناهج التلاميذ في المدارس والطلاب في الجامعات، وتشركهم أكثر في الثقافة المسرحية المفقودة، فيجب أن ندعم كل البرامج الثقافية، فالثقافة ليست ذلك المفهوم النخبوي، لكنها كل شيء في حياتنا، تاريخنا، حضارتنا، كل شيء، نحن يمكننا أن نتناول أي شيء في حدود 120 كلمة على تويتر، فهل نستطيع عمل ذلك من خلال المسرح؟ بالطبع يمكننا أن نصنع كثيرًا، فقط أعطوا المسرح المجال المناسب، وليس بطريقة البحث عن نجم كبير كي نصنع له عملًا مسرحيًّا، هذا النهوض لا بد أن يتعاون فيه كل من الإعلام والسلطة والمسرحيين أنفسهم، أما أن يُترك المسرحيون وحدهم فذلك أمر صعب، والمسرحيون كما يقال يعيشون من اللحم الحي، لكن هذا طريق صعب ولا بد أن نسلكه حتى يستمر هذا الفن، فهذا الفن بناه مسرحيون كبار بداية من جورج أبيض إلى نجيب الريحاني إلى فؤاد المهندس، ودريد لحام، ومحمد الماغوط بالشام، وجابر مهموش بالإمارات واجباعي بتونس والرحبانية بلبنان؛ لذلك لا بد أن يستمر لأنه جزء مهم وأساس في حضارتنا العربية.
كاتب وممثل مسرحي لبناني
ناصر ونوس: الحكومات رفعت الدعم عن المسرح
منذ ولادة المسرح العربي أواخر القرن التاسع عشر وهو يمر بمراحل متأزمة، يزدهر سنوات تطول أحيانًا وتقصر أحيانًا أخرى، ثم تأتي مرحلة الهبوط، تطول أيضًا أو تقصر. وآخر مراحل ازدهار المسرح العربي كانت في أواخر عقد الثمانينيات، ثم بدأ نجمه يأفل من جديد. إلى أن وصلنا إلى الوضع الحالي، حيث يمر بأسوأ مراحله –باعتقادي- منذ تأسيسه. وأسباب أزمة المسرح العربي كثيرة، أولها عزوف الحكومات العربية عن دعم المسرح، طالما أن هذا المسرح يتناول قضايا تعدّها هذه الحكومات خطيرة عليها. وهنا نأتي إلى النقطة المهمة وهي أن المسرح لا يمكن أن ينتعش إلا في ظل الحالة الديمقراطية وتوافر المناخ لحرية التعبير.
ومن يراجع تاريخ المسرح العالمي والعربي والحقب التي ازدهر فيها يدرك ذلك. ففي الستينيات والسبعينيات ازدهر المسرح قياسًا بالوقت الحالي؛ لأن القبضة الأمنية للأنظمة الحاكمة لم تكن بعد قد أحكمت سيطرتها على قطاعات المجتمع كافة، ومنها القطاعان الفني والثقافي، كما هو حاصل الآن. ما زال هناك فسحة للتعبير عن الرأي، وطرح القضايا الكبيرة منها والصغيرة، من دون هذا التدخل الفج في تفاصيل العملية الإبداعية. كان ثمة هامش لحرية التحرك بمعزل عن الرقابة المشددة على كل كلمة تقال كما هو الوضع الحالي. ومع إدراك هذه الأنظمة أن المسرح قد يهدد وجودها، ولو بشكل غير مباشر، بدأت برفع الدعم عنه، مثلما امتنعت عن إقامة المعاهد المسرحية التي ترفد الحركة المسرحية بأجيال جديدة. كما امتنعت عن تشكيل الفرق المسرحية الجديدة التي تلبي حاجات المجتمع الثقافية والفنية المتنامية، وحولت المهرجانات المسرحية إلى استعراضات إعلامية تهدف إلى تحسين سمعة الدولة أو النظام القائم.
ومع امتناع الدولة عن تقديم الدعم للمسرح، وصلنا إلى مرحلة نعاني فيها شحّ الكوادر المسرحية، من كُتاب ومخرجين وفنيين، بل ممثلين يعملون في المسرح. ومن ثم فإن الخروج من هذه الأزمة يجري بتأهيل كوادر جديدة، وتكوين فرق مسرحية جديدة في جميع المدن والبلدات حتى القرى، وإقامة المهرجانات على المستوى المحلي والعربي، وهو ما يعزز روح المنافسة ومن ثم التطوير المستمر. يجب علينا ألّا ننتظر الحكومات حتى تقدم الدعم للمسرح من تلقاء ذاتها، إنما علينا السعي الحثيث لتحقيق طموحاتنا المسرحية من خلال مطالبتها بالدعم المطلوب. وينبغي لنا ألّا نكتفي بالمصادر الحكومية لمثل هذا الدعم، بل يجب البحث عن مصادر التمويل الخاص، من خلال إقامة شركات إنتاج محلية، تنتج العروض الم
سرحية مثلما تقوم شركات الإنتاج السينمائي بإنتاج الأفلام.
كاتب ومترجم وناقد مسرحي سوري
سعيد حجاج: ليس هناك أزمة في المسرح
من تاريخ قراءتي للمسرح وأنا أسمع أن هناك أزمة في المسرح، على مر العقود والأزمان ثمة أصوات تتحدث عن وجود أزمة في المسرح سواء المصري أو العربي، وعن نفسي لا أرى هذه الأزمة، لكني أرى الدنيا تطور، وكل مسرح يشبه عصره، لكن أزمتنا نحن أن الدنيا تتطور ونحن نرى المسرح بعيون الستينيات، نتعامل معه طيلة العقود التي تلت الستينيات من منظور هذه الحقبة، والحقيقة أن الستينيات كان بها إستراتيجية وتوجه، لكن بعد رحيل الرئيس عبد الناصر لم تعد هناك إستراتيجية ولا توجه، من ثم ظهرت فكرة أزمة المسرح. الواقع يقول: إن الأزمة الحقيقية تكمن في علاقة الناس الآن بالمسرح، فالميديا أخذت اهتمام الناس إليها، وتركت المسرح يعاني ضعف الاقبال وقلة الجمهور، وهو ما يشعر الناس بأن ثمة أزمة، متناسين الفارق الزمني والتقني والإعلامي بين الستينيات والآن. كانت السينما في الستينيات هي المنافس الوحيد، أما الآن فهناك السينما والدراما التلفزيونية وبرامج التوك شو وغيرها، وكل هذا خصم من رصيد المسرح في اهتمام الناس.
كاتب مسرحي مصري
وليد داغستاني: الأولوية لمسرح المدرسة
يشكو المسرح العربي اليوم من معضلات شتى تعيق الفنان وتحدّ من قدراته الإبداعية في ظل غياب تصور واضح لدور المسرح في المجتمع. وقد يعود ذلك إلى جهل أغلبية الحكومات العربية بقيمة المسرح، ومن ثم فإن ما يُرصد له من ميزانيات محتشمة تفرضه ضرورة دبلوماسية للظهور أمام الدول المتقدمة بمظهر التحضر، ولهذا فقد آن الأوان للتفكير جديًّا في تأهيل المسرحيين للاضطلاع بدورهم الحساس، من خلال التكوين والدعم، وإعطاء أولوية مطلقة لمسرح المدرسة والجامعة، وإشعار الناس بقيمة هذا الفن. ويظل أيضًا القطاع الخاص مسؤولًا بشكل مباشر عن نوعية ما يقدمه من أعمال مسرحية عادة ما تكون ذات طابع تجاري. ولذلك فإن الفنانين عليهم حث الدولة على سن قوانين تحمي مهن الفنون الدرامية، وتشجع النقابات على الوقوف إلى جانب حقوق المسرحي في العيش الكريم وتكافؤ الفرص.
مخرج وممثل مسرحي تونسي
محمد أبو العلا السلاموني: سوء الإدارة وراء أزمة المسرح
 المسرح بشكل عام في حالة أزمة كغيره من مؤسسات المجتمع العربي الراهن، نظرًا لما تمر به البلدان العربية جميعًا من ظروف عاصفة في أعقاب الربيع العربي، هذه الظروف التي أضعفت كل شيء بما في ذلك المسرح العربي، فقد شملت الفوضى كل شيء، وعمّ الدمار في كثير من بلدان المنطقة، وارتعد الجميع من تلك الموجة الشريرة للجماعات المتشددة في مختلف بلدان العالم العربي. والمسرح من المفترض أنه إحدى الأذرع المهمة التي ينبغي لها مواجهة قوى الإرهاب، هذا إذا فكر المسؤولون عن المسرح بشكل إيجابي في كيفية مواجهة الإرهاب، فهي قضية ثقافية بامتياز، والمسرح في قلب العملية الثقافية، فالفكر لا يواجَه إلا بالفكر، أما اعتماد مواجهة العنف بالعنف، فذلك سيؤدي إلى دمار شامل، يمكننا معالجة القضية من جذورها بتغيير الفكر الحافز على الإرهاب، لكن المشكلة تكمن في سوء الإدارة، وفي ظني أنها هي أساس أزمة المسرح الراهنة. فالعشوائية والشللية سيطرتا على هذا القطاع بشكل واضح، وليس هناك مسؤول لديه رؤية أو إستراتيجية واضحة للتعامل مع الإرهاب من خلال المسرح، ولا حتى للمسرح بشكل عام في هذه المرحلة، ففي الستينيات كان مدير المسرح لديه خطة وبرنامج وأفكار واضحة، وحين يتوقف عمل لظرف ما كان يسرع بالاتصال بالكتاب كي يقدموا له عملًا يسد الفراغ الذي تركه العمل الذي توقف، الآن الأمور كلها تسير بالمصادفة والهوى، ومن ثم فلا أحد يعرف ما الذي ينبغي عمله ولا ما الضرورة، مشكلة المسرح بالدرجة الأولى هي مشكلة سوء إدارة، وانعدام خيال، وهيمنة شللية، وانعدام الرؤية الإستراتيجية لما ينبغي عمله.
المسرح بشكل عام في حالة أزمة كغيره من مؤسسات المجتمع العربي الراهن، نظرًا لما تمر به البلدان العربية جميعًا من ظروف عاصفة في أعقاب الربيع العربي، هذه الظروف التي أضعفت كل شيء بما في ذلك المسرح العربي، فقد شملت الفوضى كل شيء، وعمّ الدمار في كثير من بلدان المنطقة، وارتعد الجميع من تلك الموجة الشريرة للجماعات المتشددة في مختلف بلدان العالم العربي. والمسرح من المفترض أنه إحدى الأذرع المهمة التي ينبغي لها مواجهة قوى الإرهاب، هذا إذا فكر المسؤولون عن المسرح بشكل إيجابي في كيفية مواجهة الإرهاب، فهي قضية ثقافية بامتياز، والمسرح في قلب العملية الثقافية، فالفكر لا يواجَه إلا بالفكر، أما اعتماد مواجهة العنف بالعنف، فذلك سيؤدي إلى دمار شامل، يمكننا معالجة القضية من جذورها بتغيير الفكر الحافز على الإرهاب، لكن المشكلة تكمن في سوء الإدارة، وفي ظني أنها هي أساس أزمة المسرح الراهنة. فالعشوائية والشللية سيطرتا على هذا القطاع بشكل واضح، وليس هناك مسؤول لديه رؤية أو إستراتيجية واضحة للتعامل مع الإرهاب من خلال المسرح، ولا حتى للمسرح بشكل عام في هذه المرحلة، ففي الستينيات كان مدير المسرح لديه خطة وبرنامج وأفكار واضحة، وحين يتوقف عمل لظرف ما كان يسرع بالاتصال بالكتاب كي يقدموا له عملًا يسد الفراغ الذي تركه العمل الذي توقف، الآن الأمور كلها تسير بالمصادفة والهوى، ومن ثم فلا أحد يعرف ما الذي ينبغي عمله ولا ما الضرورة، مشكلة المسرح بالدرجة الأولى هي مشكلة سوء إدارة، وانعدام خيال، وهيمنة شللية، وانعدام الرؤية الإستراتيجية لما ينبغي عمله.
كاتب مسرح ودراما تلفزيونية مصري
محمد المنجي بن إبراهيم: بين أحكام المتغيّرات وفضاءات الحرية
العلاقات ضمن الحياة المسرحية في تونس، وكذلك حسب اطلاعي، في كامل الوطن العربي يشوبها التأرجح والمدّ والجزر بين مجموعات تنادي بالحداثة والتجديد على الأصعدة الفكرية والفنّية وكيفيات الإنتاج والتقديم، وشؤون التوزيع والترويج، ومجموعات أخرى متشبّثة بنمطية مسرحية تدرّ الربحَ الوفير من دون عناء أو شقاء التفكير. وهناك شقّ آخر يمسك بوسط العصا، ويسعى إلى أن يكون لمسرحه وجود ولو متواضع، فيُقْدِمُ على أنماط مسرحية ذات طابع تقليدي من حيث الاختيار ومجهود إنجاز العرض سواء فيما يتعلّق بالكتابة المسرحية أو الأطر الفنية للإعداد والتقديم.
وفي هذا الشأن يكمن فسيفساء المسرح العربي، وقطاعاته المحترفة، والهواة، والمسارح الجامعية والمدرسية، وذلك ضمن علاقات مضطربة وفي أجواء لا تخلو من مطبّات هوائية غير مريحة. خلاصة هذا المعنى أن المضايقات السلطوية لحرّيات التعبير هي أجهزة قمعية تحدّ من انتشار المقترحات الفنّية الجريئة، وأنّ التسيّب والفوضى والتعاطي الاعتباطي للنشاط المسرحي يُدخل المسرح في متاهات متداخلة كخيوط العنكبوت يصعب الخروج منها، وأنّ أشكال التطرّف السياسية أو الدينية أو الاجتماعية تجذب كلّ المحاولات التقدمية إلى الخلف وإلى الأسفل، وأن الحرّيات المزعومة بمفهوم :«اصنع ما شئت» و«العالم صغير» و«لا حاجة لهوية»… وغيرها هي عوامل لا تضمن استقرار الذات، وتُهمل التعريف بالشخصية، ولا تُعير اهتمامًا باحترام الهوية، بل هي عوامل تُؤدّي إلى التيه والغربة، وإلى ضروب العدمية بانعدام الكيان، ومن ثم فعلى كل فنان مسرحي اختار عن طواعية واقتناع أن يجعل من حياته المهنية والمجتمعية خدمة للتعبير المسرحي بمكوّنات وأدوات تسمح له لا أن يضاهي كبار القوم المتقدّم فقط إنّما بالتنافس المشروع معهم، وذلك بأن يعتمد على هويته وبَصماته المحلية، وثراء ثقافته ومراجعه التراثية والتاريخية، وبُعد النظر الحداثي والمعاصر، ولا يكون في التفرقة والتشتّت والضغينة والأحقاد، ولا في الصراعات الداخلية والخارجية ورمي الآخرين بالحجارة ونعتهم بالتخلّف واللا-اعتبار، فالكبير يبقى صغيرًا أمام شسوع المعرفة، والفنان يبقى متواضعًا أمام عظمة الإبداع.
ناقد ومخرج مسرحي تونسي
سميحة أيوب: المسرح تحول اسكتشات هزلية فقيرة وأحيانًا مهينة

سميحة أيوب
الحالة العامة في جميع البلاد هي سبب اضطراب المسرح، ولا يمكننا أن نتحدث عن مسرح حقيقي ومزدهر في ظل ظروف غير مستقرة، فأغلب البلدان في العالم العربي تعاني عدم استقرار واضح، وأغلب البلدان غير مستقرة ماديًّا أو سياسيًّا، وهذا ترك تأثيره في المسرح في العالم العربي كله، ولا نملك الآن إلا المبدعين أنفسهم، سواء الكتاب أو الممثلون أو المخرجون أو العاملون في الإضاءة والملابس والديكور وغيرها، لا نملك سوى البشر، وهم العنصر الوحيد الذي يمكن الرهان عليه، فلا الأدوات والميزانيات ولا الإمكانيات متوافرة، وكي يتوافر ذلك كله لا بد من توافر حالة من التوازن. وفي ظل الأحوال السياسية التي تجوب العالم العربي الآن فمن الصعب الرهان على شيء، فالعالم العربي منذ سنوات وهو يعيش حالة من الاضطراب السياسي، والمسرح هو عمل ثقافي وسياسي أيضًا، واضطراب الحالة السياسية يقضي باضطراب أحوال المسرح بشكل واضح، ومن ثم فإننا لا نملك إلا مطالبة المبدعين أنفسهم بالتمسك بعملهم، وكل منهم يقدم عمله على أكمل وجه؛ كي لا يخسر الجميع، المسرحيون أنفسهم قبل الجمهور والمجتمع كله. ولا يمكن عد كل ما ينتج الآن عملًا مسرحيًّا حقيقيًّا، فالمسرح أمر حضاري جدًّا، لكن هناك تجارب تقدم الآن مسيئة إلى الذوق والفن، ألفاظ خارجة، واسكتشات بذيئة، ورغبة في إهانة الممثلين بعضهم بعضًا كي يضحك الجمهور. هذا ليس مسرحًا، ولا ثقافة ولا قيمًا، المسرح فعل حضاري يجب الحفاظ عليه، ولا يجب الاستسلام لموجات الانحطاط التي توالت على المسارح العربية في الأوقات الأخيرة، وهذا لا يعني أن المسرح العربي كله ضعيف، لكن الرغبة في إرضاء الجمهور وإضحاكه حولت المسرح إلى اسكتشات هزلية فقيرة وأحيانًا مهينة.
عبدالعزيز السماعيل: أزمة وجودية في الصراع بين قيم المدنية، والقيم المتطرفة

عبدالعزيز السماعيل
أعتقد أن المسرح بوصفه فنًّا وحدثًا اجتماعيًّا ثقافيًّا جادًّا حيًّا ومباشرًا، أو هذا ما يجب أن يكون عليه أصلًا، قادر على المساهمة بفاعلية في مواجهة كل أشكال الأزمات والقضايا التي تهم المجتمع العربي الآن، ومن ضمنها تعزيز قيم التسامح والمحبة والمواطنة والمشاركة والحوار… إلخ، من قيم حضارية وإنسانية عالية هي أصلًا من صميم فضائل الدين الإسلامي الحنيف، في مقابل كشف الزيف والتضليل الذي يدعيه دعاة الغلو والتطرف والانغلاق باسم الإسلام، إلا أن المسرح العربي ذاته واقع في أزمته الخاصة والمزمنة منذ سنوات طويلة؛ بسبب ضعف الدعم وغياب التخطيط الإستراتيجي للثقافة عمومًا ومن ضمنها المسرح، إضافة إلى العنصر الأهم وهو تشديد سلطة الرقيب التي تعوق دوره في تناول القضايا المهمة في المجتمع بشكل واضح وصريح، وقد ضاعف الآن الانفتاح الكامل على العولمة وقيم السوق والاستهلاك الرأسمالي من أزمة المسرح العربي ليس فقط في الوطن العربي بل في العالم أيضًا، ولأن ما يعنينا هو المسرح في واقعنا العربي تحديدًا، يمكن ملاحظة أحد مظاهر تلك الأزمة في انقسام المهتمين بالمسرح أنفسهم تيارين مختلفين.
فالذي لا يستطيع مجاراة عروض السوق الاستهلاكية للترفيه والتسلية انسحب إلى العزلة، أو إلى تغليب الشكل المسرحي وألوان السينوغرافيا بدعوى التجريب الغارق في الترميز والدلالات اللغوية المنفلت من أي موضوع أو مضمون جاد له قيمة فكرية مهمة في المجتمع، في حين بقي المسرحي الجاد المؤمن بدور المسرح وأهميته يصارع من أجل توفير احتياجاته المسرحية الملحّة، أملًا في أن يجد له مكانة اجتماعية مرموقة يتمناها منذ زمن بعيد ولا يستطيع الحصول عليها إلا مع النخبة المسرحية في عروض المسابقات والمهرجانات أحيانًا.
إن المجتمع الذي يدعم وهم الخصوصية والمحافظة على التقاليد، رغم انفتاحه المفرط على أنماط السوق وقيم الاستهلاك الرأسمالي المادي، لن يبحث عن قيمة حقيقية للفنون، ولا عن مسرح جاد وحقيقي يناقش قضاياه وهمومه الاجتماعية الحقيقية، ومن ضمنها قضايا التطرف والغلو والإرهاب، بل عن مسرح استهلاكي مُسلٍّ ساخر من مشاكل الناس والأشكال النمطية للشخصيات الشاذة فيه، مثل: الأسود والسمين والأعور والقصير والطويل… إلخ من موضوعات سطحية فجة تستجدي إضحاك المشاهدين وتسليتهم بأي شيء، ومن أي شيء غريب أو عجيب في سلوكه أو هيئته.
ومن ثم فإن القيم التي تسطح المسرح وتتعامل معه كعلبة غازية فارغة سوف ترمى بعد الانتهاء منها، سوف تنتج قيمًا لصالحها، سطحية وتافهة أيضًا، لكنها عميقة ومؤثرة في نفوس الناس وتسطيح تفكيرهم، ومن ضمنها تدمير قيمة المسرح، حين يتحول إلى منصة تهريج ليس إلا.
إن ازمة المسرح العربي كانت ولا تزال أزمة في العمق، أزمة وجودية في الصراع بين قيم الثقافة والتحضر والمدنية، والقيم الدينية المتطرفة والعادات والتقاليد المحافظة، على الرغم من مظاهر التمدن والمعاصرة الشكلية في المدن وحياة الناس.
مسرحي سعودي

بواسطة الفيصل | أغسطس 31, 2017 | تشكيل, فنون
ترى الفنانة السعودية منال الضويان الفن نوعًا من الحوار المتطور، وتؤكد في حوار لـ«الفيصل» أن القول بالحضور الواضح للفنانة السعودية «مُسَيَّس». وتشدد على الحاجة إلى نقد الذات سعيًا للتطور. الضويان في تجربتها المتنوعة تستعمل الرمز البسيط من أجل التعبير عن قضية كبيرة، بدأت مشوارها الفني من خلال التصوير الفوتوغرافي، ثم طوَّرت هذا الفن إلى ما يعرف بفن الـ installation وصممت أفكارًا فنية ثلاثية الأبعاد كبيرة الحجم تحتلّ مساحات تعبر عن الفكرة بأشكال متعددة. وقد شاركت الضويان في معارض دولية واقتنى عدد من المتاحف العالمية أعمالها مثل: المتحف البريطاني، ومتحف لا كونتي، والمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث وغيرها. وثَّقت منال الضويان مجموعات اجتماعية مثل: «رجال ونساء النفط في المملكة العربية السعودية» في مشروع فني حمل عنوانًا: «إذا نسيتك فلا تنساني»، وفي مشروعها «صدمة» تناولت تأثير وسائل الإعلام في ممارسة المحو المتعمد للهويات. إلى نص الحوار:
بدأتِ عملك مبرمجة نظم معلوماتية بناء على تخصصك في البكالوريوس بعلوم الحاسوب، ثم حصلت على درجة الماجستير في تحليل النظم وتصميمها، إذن، كيف تبلور اهتمامك بالفن والتصوير؟
– منذ الطفولة وأنا أرسم وكنت مهووسة بالتصوير، وقد عدت من الجامعة وأنا في سن صغيرة أحمل بمعيتي ثلاثة عشر صندوقًا مليئة بالصور. كانت رغبتي في دراسة الفن قديمة، لكن كانت دراسة الفن آنذاك في المنطقة غير متاحة، ولم تكن هناك أية حركة فنية على الرغم من وجود فنانين، ومع ذلك قررت دراسة الماجستير في تحليل النظم المعلوماتية نهارًا، أما في المساء فقد كنت أدرس فن الطباعة وأحصل على كورسات في جامعات فنية في لندن. عندما عدت من الدراسة التحقت بأرامكو. أول معرض لي أقيم في شمال إسبانيا، ثم صار الفن شغلي الشاغل، وبعد خمس سنوات من هذا التغيير في حياتي تركت عملي، وتفرغت للفن وتخصصت فيه.
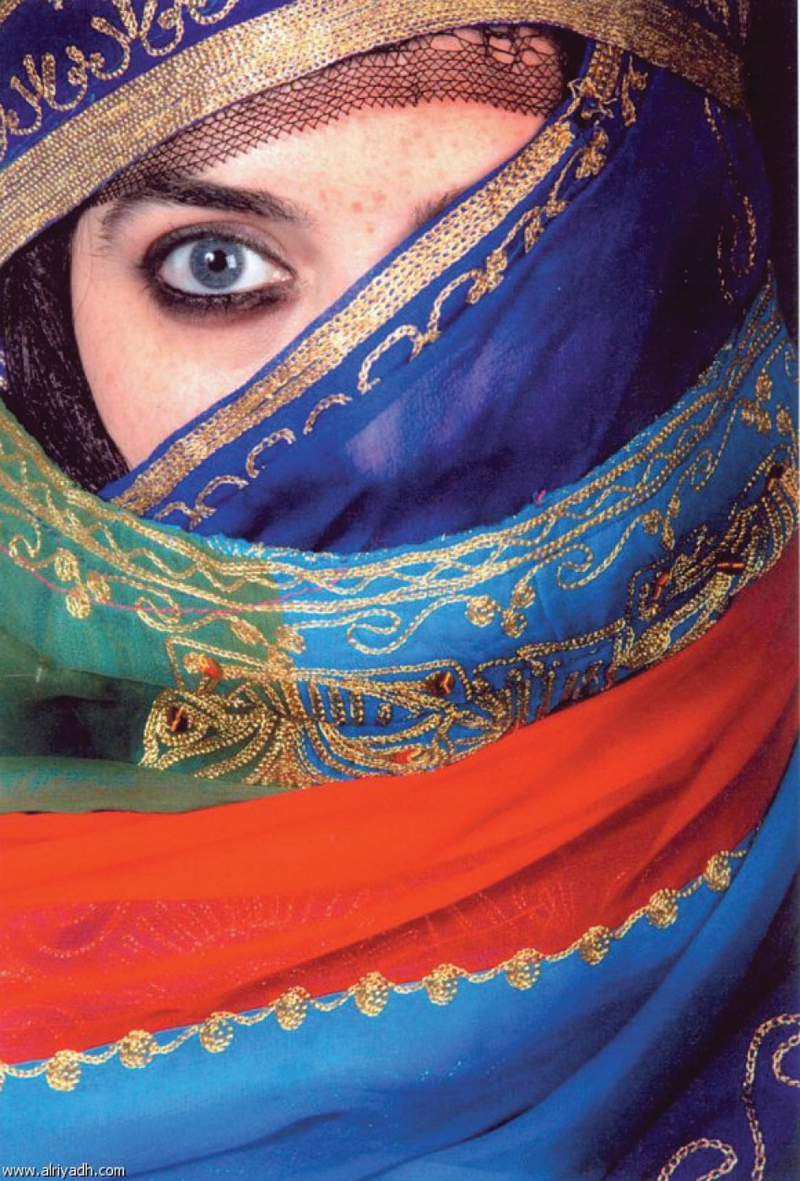 وثَّقتِ مجموعات اجتماعية، مثل «رجال ونساء النفط في السعودية» في مشروعك الفني «إذا نسيتك فلا تنساني»، وتناولتِ تأثير وسائل الإعلام في نشر محو متعمد للهويات في مشروع «صدمة»؛ هل تعتقدين أن رسالة الإعلام العربي كانت سلبية تجاه قضايا مجتمعه وبخاصة المرأة؟
وثَّقتِ مجموعات اجتماعية، مثل «رجال ونساء النفط في السعودية» في مشروعك الفني «إذا نسيتك فلا تنساني»، وتناولتِ تأثير وسائل الإعلام في نشر محو متعمد للهويات في مشروع «صدمة»؛ هل تعتقدين أن رسالة الإعلام العربي كانت سلبية تجاه قضايا مجتمعه وبخاصة المرأة؟
– بالنسبة لي أحاول الابتعاد من علاج المشكلة، وأعتقد أن دور الفن جعل المشاهد ينظر إلى مشهد أو قضية أو صورة بطريقة مختلفة، فإذا اعتادت عيناك على النظر إلى المشهد من اليمين فأنا أجعلك تنظر إليه من اليسار، وهذه الحالة في تغيير الرؤية من شأنها أن تنتشل المتلقي من الخمول وربما تجعله يغير من طريقة طرحه الأسئلة. وأما الإعلام العربي فلن أعلِّق على موقفه، لكن سأحيل إلى خطورة تكرار الصورة في الإعلام بما لها من قوة، فتكرارها في الصحافة خمسًا وعشرين عامًا في حوادث سيارات المعلِّمات مثلًا أعده خطرًا أو نوعًا من تثبيت قصة وإهمال القصص الأخرى، فنشر صور سيارات مدمرة من دون أي جثث أو توضيح أسماء النساء اللائي توفين في هذه الحوادث هو نمط من المحو للإنسان الذي ذهبت روحه. وأعلم أن النية هي الحفاظ على الخصوصية لكن التكرار بهذا الشكل محو لإنسانية النساء اللائي ذهبت أرواحهن سدى في تلك الحوادث من دون فجيعة من المجتمع الذي ينتمين إليه. فمسؤولية الإعلام تقحمه في مثلبة التكرار التي تدخل حس أفراده في نوع من الخمول والغفوة. وأحاول معالجة هذه القضية في مشروعي «حالة من الاختفاء». ولقد جمعت صورًا من تلك الحوادث عن النساء نُشرت خلال ثلاثة أعوام في جريدة واحدة، ووجدت أنهم لا يقومون بنشر صور جديدة عن تلك الحوادث بل يستعملون الصور ذاتها، ولقد استعملت في بضعة شهور، تقدر بأربعة أشهر، الصور ذاتها ثماني مرات، وهي صور تشمل عددًا وفيرًا من النسوة، ولا تنشر صورة امرأة بمفردها، مخفيات الشكل والوجه والتكوين، الأمر الذي يشعر معه المرء بأن المرأة ليس لها تكوين وليس لها شكل محدد. لذلك أحاول في أعمالي التأكيد على أن المجموعات الكبيرة تساعد على محو هوية الشخص وفردانيته، وهذا شكل من التجاهل لذات المرأة وهويتها.
تضمَّن بعض مشاريعك الفنية تساؤلًا عن: ماذا يحدث لذاكرة لا يوجد لها قصة؟ وربما اضطررتِ إلى استخدام أرشيف صورك الشخصية لإعادة نشر قصتك من خلال ذكريات شخص آخر لبناء اتصال متخيَّل. كيف استطعتِ تكوين هذا التصور القصصي والإنساني وتجميعه وتضمينه من خلال أرشيف من الصور؟ وما الذي دفعك إلى الاستعانة بأرشيفك الشخصي لهذه الغاية الفنية البحتة؟
– منذ مدة وأعمالي تعالج قضية الذاكرة وبخاصة أن والدي كان متأثرًا بسبب مرض الزهايمر أواخر سبع سنوات من عمره قبيل وفاته. وبصفتي شابة وجدتْ والدها لا يتذكر اسمها ولا وجهها ولا يتذكر ما حوله، كانت تجربة صعبة جدًّا، ولقد عالجت هذه التجربة من خلال عملي في الفن. فكثير من أعمالي تدور حول والدي وتجربته مع هذا المرض، ففي هذا المشروع الذي سميته «أنا هل أنسى؟». كنت في عمر اثني عشر عامًا أعطاني والدي صندوقًا فيه ثلاث مئة نيغاتيف، وكنت ألعب بها وأتسلى وأضع عليها تكوينات، وصنفتها في صور عن الماء، وأخرى عن الجبال، وصور في أوربا وأميركا وهكذا، لكنني حينما كبرت وبعد وفاة والدي نظرت إلى تلك الصور بنظرة مختلفة لأن جميع من فيها توفي والأماكن الموجودة في تلك الصور ليس لها قصة، فبدأت أطرح فكرة: ماذا يحدث للذاكرة أو للقصة حينما لا تكون لها ذاكرة؟ ولقد أخذت صوري إلى فلوريدا في مكان إقامة فنية في جزيرة كابتيفا التي تتبع الفنان روشان بيرغ فاونديشن، وهذا الفنان معروف في أميركا، ولقد كنت أول عربية تشارك في تلك الإقامة الفنية، وبدأت إنتاج أعمال وأفكر في أن تلك الصور إذا فقدت قصتها وذاكرتها فسوف أصنع لها ذاكرة وقصة وتاريخًا هي قصتي، وبتلك التجربة أكون قد بعثت فيها روحًا جديدة برؤية وفكر جديدين وأحييتها، وهذه تجربتي التي قمت فيها بإحياء الذاكرة بعد المحو.
 استمددتِ إلهامك في مجموعة «أنا» من الخطاب الذي ألقاه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز يوم تولّيه العرش، ودعا فيه يومها السعوديّين كلّهم ليتعاونوا على بناء وطننا. كما شدّد على أهمية مشاركة المرأة. وفي الصور الفوتوغرافية من مجموعة «أنا» نساء صورتهن وهن يرتدين تفاصيل توحي بوظائف عدة، ما الذي دفعك إلى إعداد هذه المجموعة؟
استمددتِ إلهامك في مجموعة «أنا» من الخطاب الذي ألقاه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز يوم تولّيه العرش، ودعا فيه يومها السعوديّين كلّهم ليتعاونوا على بناء وطننا. كما شدّد على أهمية مشاركة المرأة. وفي الصور الفوتوغرافية من مجموعة «أنا» نساء صورتهن وهن يرتدين تفاصيل توحي بوظائف عدة، ما الذي دفعك إلى إعداد هذه المجموعة؟
– كان للملك عبدالله -يرحمه الله- خلال حكمه خطابات عدة وأهمها عند توليه الحكم، والثاني لما عيّن المرأة في مجلس الشورى. وتحدث عن النساء البارزات وتأثير النساء في حياته، وتكلم عن أم سلمة وبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكوني موظفة في أرامكو آنذاك كنت محاطة بنساء ناجحات في مجالات عملهن، وحين ألقى الملك عبدالله ذلك الخطاب وغيره جرى حوار شديد في المجتمع السعودي وعلى مستوى إعلامي كذلك، عن الوظائف التي يمكن للمرأة شغرها، وقيل يومها: إن المرأة ستعمل في الوظائف المناسبة لطبيعتها بصفتها امرأة، وكنت أتساءل بحيرة: ما الذي يناسب طبيعة المرأة من الوظائف؟ ومن سيحدد ما الذي يتناسب وطبيعتها؟ ومن خلال طرح هذين السؤالين على نفسي انطلقت بعمل هو من أوائل أعمالي في هذا المجال قبل ثلاثة عشر عامًا. فلقد طلبت من عدد من النساء اللائي يعملن أن يحضرن إلى الأستوديو الخاص بي لتصويرهن بزي المهن التي يعملن فيها: أنا معلمة، أنا مهندسة بترول، أنا كاتبة، أنا سفيرة في الأمم المتحدة، وما إلى ذلك. فكان لكل صورة نقاش وحوار لأنني عددتُ ذلك العمل عملًا تشاركيًّا.
تميز عملك «في الهوا سوا» ببساطته التعبيرية الفنية، فهو عبارة عن سرب من الحمام الأبيض بعدد 200 حمامة معلَّقة بحبال شفافة ملاصقة لسقف يحدّ من حريتها. وعبر بعمق عن رسالته المجتمعية الرافضة للحد من حرية حركة المرأة السعودية والقيود المفروضة عليها. ترى أين تكمن مسؤولية الفن في المجتمع؟ وكيف يمكن للفنان إنشاء حوار اجتماعيّ صحّيّ على الصعيدين المحلّيّ والعالميّ؟
– أعدّ الفن نوعًا من الحوار، وأعتقد أن النقد الذاتي مهمّ في كل المجتمعات، ولا بد أن ننتقد أنفسنا كمجتمع لنتطور بدل التقبل على مضض أو الابتعاد وترك المساحة للعابثين في الأرض فسادًا، فقضية الحمام تلامس قضية الولاية على المرأة وأنا بصفتي فنانة أستخدم رمزًا بسيطًا ليعبِّر عن قضية كبيرة، ففي عملي «الصدمة» وفلم «لم يكن لدي أجنحة» كان الطرح يناقش قضية السياقة ومسؤولية المجتمع في الحفاظ على سلامة المرأة، و«في الهوا سوا» تكلمت عن الولاية وخطورة ظلم المرأة على المجتمع برمته.
الملاحظ أنه على الرغم من الوضع الذي تعيشه المرأة السعودية في مجتمعها فإن الفنانات السعوديات حاضرات وبقوة في ساحة الفن السعودي المعاصر؛ في رأيك ما الذي يدفع الفنانة السعودية إلى تجاوز إحباط الداخل من خلال الفن الذي يحمل رسالة التغيير؟
– نعم هناك حضور واضح للفنانة السعودية لكنني أعتقد أن هذا الكلام مُسَيَّس من ناحية دفعنا إلى القول بأن المرأة بصفتها فنانة لم تظلم أو أخذت حقها من الانتشار والوجود. أنا أعتقد أن الحركة الفنية في السعودية فيها توازن بين الرجل والمرأة غير موجود في أي مجال آخر في التجربة الاجتماعية السعودية، ولذلك تبرز المرأة التي تكاد تكون أثرًا مختفيًا فيغير ذلك من المجالات الأخرى، فهما في حال مساواة تقريبًا؛ إذ إن مجال الفن خاص جدًّا يتكلم عن قصة الفنان الخاصة والحوار يحترم الرأي الآخر. أما الإحباط للفنانة والفنان فهو يأتي من عدم القدرة على إنتاج الفن أو عدم القدرة على التعبير.
عرضتِ بعض أعمالك بشكل دائم في مجموعات المتحف البريطاني، والمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، ومؤسسة عبداللطيف جميل، ومؤسسة دلفينا في لندن، وهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، ومؤسسة الناظور في ألمانيا ومؤسسة بارجيل في الشارقة؛ فهل لك أعمال معروضة في السعودية؟
– عرضت كثيرًا من أعمالي في السعودية منها صالة أثر وكان اسم المعرض «رحلة الانتماء». وشاركت في مهرجان جدة الفني قبل أربع سنوات. وفي كل عام يختار المنسقون لي عملًا للمشاركة به، ولقد شاركت هذا العام بعملي «الصدمة» في المتحف الوطني بالرياض، وفي معرض بالسفارة الفرنسية، وفي أرامكو أقمت معرضين. وفي البحرين كثير من السعوديين يحضرون هناك لتلقي أعمالي، بل إن أغلب من يقتني أعمالي سعوديون، وكثير منها في البيوت السعودية. ومن المتاحف التي أتواصل معها في المنطقة متحف الدوحة، والمتاحف الموجودة في أبو ظبي، ومتحف البرجيل في الشارقة، وكذلك متحف بالأردن.

بواسطة الفيصل | أغسطس 31, 2017 | فنون

فرقة المصريين وهاني شنودة
يعدّ واحدة من الظواهر الفنية التي عرفتها مصر منذ مطلع السبعينيات حتى الآن، وُلد عام 1943م بمدينة طنطا في وسط الدلتا، وتخرج عام 1966م من معهد الكونسرفتوار، أدخل على الموسيقا المصرية توزيع الألحان، واعتمد الأدوات الموسيقية الكهربائية، نال كثيرًا من الهجوم، وقدم كثيرًا من النجوم في مقدمتهم محمد منير وعمرو دياب الذي التقاه في حفلة ببورسعيد، فنصحه بنزول القاهرة وتعلم الموسيقا، وقدم له ألبومه الأول «يا طريق». هو الموسيقار هاني شنودة صاحب فرقة المصريين التي قدمت تراثا مهمًّا للموسيقا المصرية والعربية (بحبك لا. ماشية السنيورة. حرية. كتير. بنات كتير. أبدًا من جديد، حظ العدالة)، لحَّن الموسيقا التصويرية لأكثر من خمسين عملًا سينمائيًّا، من بينها: (اللومنجي، ونسيت أني امرأة، ومصيدة الذئاب تعالب وأرانب، وصعيدي في الجيش، وصراع الحسناوات، ومسجل خطر، والعذراء والعقرب، وصديقي الوفي، والمشبوه، والمطربون في الأرض).
«الفيصل» التقته وحاورته حول الموسيقا والفن وقضايا أخرى:
● ما الذي حققته فرقة المصريين للموسيقا العربية وللغناء في مصر؟
■ فرقة المصريين غيرت «المزيكا» في مصر ودول أخرى كثيرة، وحين تذهب إلى أي فرح تجد الناس يغنون أغانيها، وهذا يعني نجاحها وتحققها وارتباط الناس بها، فضلًا عن أنه لم يكن في الموسيقا المصرية هارموني أو باص غيتار أو كونتر بوينت. «المصريين» هي التي أدخلت العلوم الموسيقية، لم يكن هناك توزيع أو هارموني في الكورال، فالجزء الذي يجيء فيه ربع تون كان يُترَك بلا توزيع. وفي «المصريين» عملنا أول شريط كاسيت لمحمد منير، وعملنا له الموسيقا التي ما زال يغني وفقًا لإيقاعاتها حتى الآن.
● هاني شنودة من أكثر الموسيقيين الذين احتكوا وتعاملوا مع كتاب وشعراء، فما الذي جعلك قريبًا من الوسط الثقافي هكذا؟
■ أول شيء أنا مدين بكل ما أنا فيه لأستاذ اللغة العربية في مدرستي الإعدادية الذي علمني موضوعات الإنشاء، مؤكدًا أن كل موضوع له مقدمة ثم قمة ثم تذييل، سواء ببيت شعر أو آية قرآنية، كان يكلمنا في كل شيء، وعن كل شيء، فأثار خيالنا وأرواحنا نحو كل ما هو جديد، إضافة إلى ذلك فأنا من بيت جمع بين الثقافة والفن، فوالدي كان صيدلانيًّا لكن كانت لديه مكتبة كبيرة، وكان محبًّا للقراءة والاطلاع، وأمي كانت تجيد العزف على العود، ومن ثم فقد نشأت في بيت جمع بين الثقافة والفن.
نجيب محفوظ وحليم

نجيب محفوظ
● ما الذي غيرك لتنتقل من الأغاني الغربية إلى الأغاني المصرية؟
■ كنا فرقة غربي، نغني أغاني غربية تتميز بالإيقاعات السريعة والمدد القصيرة، وكنا نقدم موسيقانا في المنتزه بالإسكندرية، وكان يجيئنا نحو ثلاثة آلاف شاب وفتاة يرقصون على موسيقانا وأغنياتنا، فجاءنا نجيب محفوظ لإجراء حوار معنا لـ«آخر ساعة» أو «المصور»، وكان ذلك قبل أن يحصل على نوبل بسنوات طويلة، فقال لي: «أنتم عاملين زوبعة في فنجان، أنتم ما بتعملوش أغاني عربي ليه؟»، فقلت له: إن الأغنية العربية تأخذ وقت ثلاثة أو أربعة أغاني مما نغنيه، كما أنها تبدأ بتانغو وتنتهي بمقسوم «على واحدة ونص»، والشباب يرون أنه من العيب الرقص على إيقاعات شرقية، وظللت أسترسل في ملاحظاتي على الأغنية العربية، فقال لي: «لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام». وبدا على ملامحي أنني لم أستوعب ما قال، فأوضح قائلًا: «اللي أنت مؤمن أنه صح اعمله»، ومشى نجيب، لكن البذرة التي بذرها في رأسي لم تمشِ، ظلت باقية، وأثّرت فيّ حين طلبني عبدالحليم حافظ وقال لي: «عايزك تعملي فرقة صغيرة»، وكان عبدالحليم يعمل مع الفرقة الماسية، وهي فرقة كبيرة وشهيرة، فوافقت وأحضرت درامز، وبيست بلارمر، لكن عبدالحليم عاد وقال لي: إن قائد الفرقة الماسية وهو الموسيقار الشهير أحمد فؤاد حسن غاضب، ويردد أن عبدالحليم سيترك الماسية وسينضم إلى فرقة صغيرة، واقترح علي أن نضم ثلاثة عازفين من الماسية إلى فرقتنا، فانضم إلينا عازف الغيتار هاني مهنى، وعازف الأوكرديون مختار السيد، وحسين نور «رق». وبدأنا البروفات، فعملنا حفلة في نادي الجزيرة، كان الجزء الأول بقيادة أحمد فؤاد حسن، والجزء الثاني منها بفرقتي، وبعد الحفلة قال لي عبدالحليم: «إحنا لاقينا نفسنا؛ لأن حجز الأوتيلات هيبقى أقل، وحجز الطيران هيبقى أقل». وحين فكرت في الكلام علمت أن عبدالحليم فهم ما يفهمه كثيرون، فهو بما لديه من قدرة على الاستبصار علم أن المستقبل للآلات العالمية الجديدة، سواء البيست غيتار أو غيره، وبخاصة حين رأى هذا العدد من الشباب الذين يرقصون على الهارموني والعلوم الموسيقية الجديدة التي مكنتنا من تفجير طاقاتهم، حينها قلت: إنه حان الوقت كي أكوِّن فرقة خاصة.
ولما جاءني عبدالرحيم منصور قائلًا: إن عنده مغنيًا شابًّا صوته مميز لكن حظه يعانده، وإنه يريده أن يغني معي، كان هذا الشاب هو محمد منير الذي وزعت له ألبومه الأول، ولحَّنت له فيه أربع أغنيات، وفي أثناء تسجيلنا شريط منير وجدت أن من يلعب الدرامز والغيتار لديهما صوت جيد، فأضفت إليهما إيمان يونس أخت الممثلة إسعاد يونس، وكوَّنت منهم فرقة المصريين، وكان النجاح حليفنا في كثير من الأغاني، وعملنا لمنير شريطه الأول والثاني، ولنجاة «باعشق البحر»، ولعدوية «زحمة يا دنيا زحمة»، وآخرين من بينهم: فايزة أحمد، وعلي الحجار، ومحمد الحلو، لكن بالأسلوب الجديد.
هجوم كاسح

نجاة الصغيرة
● اتُّهمت بأنك أدخلت الموسيقا الغربية إلى الغناء المصري؟
■ هوجمنا هجومًا لا أستطيع وصفه، سواء من الصحافة أو التلفزيون أو غيرهما، لكن «بيني وبينك» أمام النجاح الكاسح يهون أي هجوم، فضلًا عن أن الكاسيت أعطى هامشًا كبيرًا من الحرية في السماع، فقبله كان ذوق لجنة الإذاعة المصرية هو الذي يتحكم في ذوق الناس، ثم جاء الكاسيت الذي خلق الحرية، فكل من لديه (135 قرشًا) يستطيع أن يشتري ما يحب، فلما شعروا أن السجادة تنسحب من تحت أقدامهم توقفوا عن مهاجمتنا. في هذا الوقت قدمنا ألبومات «بنات كتير» و«بتتولد» لمحمد منير، وغيرهما، الآن تقلصت مساحة الحرية، وعاد كل شيء إلى ما كان عليه، فأنت تسمع ما هو متاح على اليوتيوب، فللأسف السوشيال ميديا ضيقت حرية السماع، ربما تكون وسعت الحرية في إبداء الرأي أو غيره، لكن في الأغنية الأمر مختلف، فالأغنية كلفتها مثلًا نحو مئة ألف جنيه، ثم تُصوَّر بنحو مئة ألف أخرى، ثم تعرضها على اليوتيوب من دون مقابل، ومن ثم فلا أحد سيقدم على إهدار نحو مئتي ألف جنيه في أغنية كي يسمعها الناس على اليوتيوب، فعدنا من جديد إلى ذوق لجنة الإذاعة.
● ما الاتجاهات السائدة في الموسيقا بمصر الآن؟
■ الطاغي الآن هو أغاني المهرجانات، وأنا لست ضدها، لكني سأقول لك قبل أن تسأل: نحن في الموسيقا ليس لدينا نوت مؤدبة أو «قبيحة»، مؤمنة أو كافرة، لكن هناك توليفة من الإيقاعات، أما الكلام فله طريقتان، وكلمات أغاني المهرجانات «لمؤخذة سيئة ورديئة»، ولو كانوا عرضوها على المصنفات الفنية وسمحت لهم بغنائها فلا بد من جزاء الموظف الذي وافق عليها، أما إن كانوا غنوها من دون تصريح من المصنفات التي عليها أن تعطي تصريحًا لكل ما ينشر: رواية أو ديوان شعري أو أغنية، ومن ينشر شيئًا بلا تصريح منها يواجه عقوبات كبيرة، وإذا كانوا غنوها من دون تصريح ولم تقم المصنفات بمحاسبتهم فهناك مشكلة وتساؤل كبير.
● هل يدين هاني شنودة بالفضل لعصر شريط الكاسيت؟
■ أدين بالفضل لعنادي، فقد كنت أعرف أن هذا هو الاتجاه الصحيح؛ لأن بلدي والبلاد المجاورة تأخرت، وأنا ابن هرمس، أنا مولود مميز، ولا أستطيع أن أكون أقل من أجدادي الذين عملوا بالعلم، وأن أقول: إن الموهبة وحدها تكفي.
● ماذا تقول للموسيقيين الشباب؟
■ أسمع موسيقا تصويرية في المسلسلات، مستوى الصوت بها أعلى وأفضل مما كان متاحًا في الماضي لدينا، وهي موسيقا جميلة، لكن ينقصها الشخصية، ففي الماضي لو أخذت موسيقا فلم «شمس الزناتي» ووضعتها لفلم «المشبوه» فإنك لا تستطيع، ولا تستطيع أن تضع موسيقا أي منهما لفلم «لا عزاء للسيدات» أو العكس، لكن الآن يمكنك أن تضع موسيقا أي مسلسل لمسلسل آخر من دون أن تشعر بأدني خلل، ففكرة الشخصية في موسيقا المسلسلات وغيرها لم تعد موجودة، رغم أنها موسيقا حلوة، وأصحابها موسيقيون محترفون وموهوبون. ومن ناحية الأغنية فأريد أن أقول: إن الناس يرحِّبون بالأغنية الرومانسية والدينية والفكاهية، حتى أغنية الكلام الفارغ أو التي بلا رسالة كـ«يلا حالًا بالًا حيُّوا أبو الفصاد»، المهم أن تكون أغنية وليس إساءة للناس.

بواسطة شاكر لعيبي - شاعر و باحث عراقي | أغسطس 31, 2017 | كتاب الفيصل المرفق مع العدد


بواسطة الفيصل | أغسطس 29, 2017 | قضايا
يتطلع الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي إلى مجموعة من المبادرات في خدمة اللغة العربية، من خلال إستراتيجيات تنظر إلى الشباب بوصفهم جزءًا رئيسًا من الحل وليسوا جزءًا من المشكلة، وتوظيف خبراتهم وطاقاتهم لخدمة اللغة العربية.
الوشمي يلفت في حوار مع «الفيصل» إلى أن الرهان على حركة تعليم العربية مهم ويجب أن يتوافر من أجله الأفراد والمؤسسات، وأن يتداخل فيه شرائح متنوعة، مشددًا على أن اللغة صانعة الإبداع، وأن الإنسان لا يفكر إلا باللغة، وأن اللغة التي لا يتحدثها الأطفال هي لغة تسير إلى الموت. إلى نص الحوار:
● ماذا قدم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية حتى الآن؟
■ يتأسس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية على مبادئ عامة أهمها أنه يجتهد في أن تكون اللغة العربية مسؤولية الجميع، وليست مسؤولية فرد أو مؤسسة، وتبعًا لذلك يطلق برامجه في مختلف المجالات، ويجتهد في أن يعمل مع الشركاء، وأن يفعِّل أدوارهم في خدمة اللغة العربية، بحيث لا يُظن أن العربية مسؤولية قسم النسخ والتحرير فقط! إنما هي رؤية وهوية، ويمكن أن نقول: إن أبرز مجالات العمل في المدة الماضية تركزت على:
أولًا: تأسيس وإطلاق مجموعة كبيرة من البحوث التي تعالج قضايا لغوية دقيقة يزيد عددها على ٤٠٠ مشروع علمي شارك فيها عدد كبير من المختصين.
ثانيًا: إطلاق برامج تبحث أحوال اللغة العربية في العالم؛ لأننا نتكلم عن اللغة ولا نملك إحصاءات دقيقة عنها، وتبعًا لذلك أطلقت قواعد البيانات (أكثر من ثلاث قواعد موجودة في موقع المركز) إضافة إلى مشروع اللغة العربية في العالم وسلسلة الأدلة.
ثالثًا: العمل على عقد الشراكات النوعية مع مختلف الجهات ذات الحضور الدولي من المنظمات وغيرها.
رابعًا: تأسيس ورعاية برامج لغوية متنوعة في آسيا وإفريقيا وأوربا من خلال شهر اللغة العربية في الصين وفي الهند وفي تركيا، وتأسيس معامل مثل: معمل اللغة العربية في جامعة إسطنبول، ودعم أقسام اللغة العربية، وإطلاق المنح في السنغال وأوغندا وجيبوتي، ودعم المكتبات في البلاد غير العربية، وغير ذلك.
خامسًا: العمل على تهيئة المؤسسات المتنوعة في بلادنا الغالية على إيجاد مسار رئيس لخدمة اللغة العربية ضمن أعمالها منطلقين من الرؤية الأولى حول مسؤولية الجميع في خدمة اللغة العربية.
● إلامَ يتطلع المركز؟
■ نتطلع إلى مجموعة من المبادرات في خدمة اللغة العربية إستراتيجيًّا، وأتمنى أن تتحقق قريبًا، ولا أعتقد أنها صعبة المنال، وطمعًا في التركيز فإني أشير إلى ثلاثة مسارات منها:
أولًا: التنسيق: نحن نلحظ من خلال الاستقراء العام وجود جهود لغوية متنوعة في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية وفي البلاد العربية، لكنها جهود متفرقة، ونتأسف حين نجد مشروعًا واحدًا في بلادنا تتنازعه عدة جهات وكلها تستهدف خدمة اللغة العربية، ولذلك نطالب بأن يكون هناك تنسيق نوعيّ بين الجهات المعنية باللغة العربية، والأفكار في المشروعات التي تخدم اللغة العربية، وأن تتولى المؤسسات العامة أو المرجعية مثل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية إطلاق مبادرات للتعريف بالجهود المتنوعة.
ثانيًا: مكانة الشباب: يجب أن ننظر إلى الشباب بوصفهم جزءًا رئيسًا من الحل وليسوا جزءًا من المشكلة، وأن نوظف خبراتهم وطاقاتهم لخدمة اللغة العربية، ويمكنني أن أشير إلى أن تعريبًا واحدًا لأحد تطبيقات الهاتف الذكي قام به شاب يعادل جهدًا متنوعًا يقوم به بعض الأقسام أو الجهات اللغوية.

إحدى فعاليات المركز
ثالثًا: نحن في زمن تُشكلنا فيه التقنية، ويجب علينا جميعًا أن نكثف حضور المؤسسات اللغوية والمبادرات اللغوية في هذا المجال بهدف أن نصل إلى الصيغة الأنسب.
● ما آلية العمل داخل المركز؟
■ يقوم المركز بتحقيق أهدافه المنصوص عليها في تنظيمه الصادر من مجلس الوزراء، في سياق خطط تتكامل مع عمل الجهات المتنوعة، فيوجد في بلادنا أكثر من ستين قسمًا للغة العربية مع كثير من الجهات المعنية باللغة العربية أو بثقافتها، والمركز قد وضع خطة تكاملية للعمل مع الجهات المتنوعة في المملكة. وتردنا طلبات لتعليم العربية للناطقين بها، لكن المركز لا يقوم بهذا العمل بشكل مباشر، إنما يتيح ذلك لشركائه في المعاهد وفي الجامعات السعودية كيلا لا تتكرر الجهود، على حين تصدى المركز لعمل لقاءات التنسيق والشراكة بين الجهات والأقسام اللغوية لأول مرة ورشَد هذا اللقاء حتى انعقد منه أربعة لقاءات بحثت فيها المشروعات المشتركة، وما إلى ذلك.
● ما رأيكم في مجامع اللغة العربية بشكل عام؟ وما التحديات التي تعترضها؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
■ مجامع اللغة العربية في البلاد العربية تقوم بوظيفة مهمة في خدمة اللغة العربية؛ ولئن كانت مرتبطة بالجانب القطري إذ تمثل دولها بشكل رئيس؛ فإننا يجب أن نشير إلى أنها تقوم بجهد نوعي في مجال المعاجم والتصحيح اللغوي وغير ذلك، وهي تواجه تحديات عدة؛ أهمها الصورة النمطية التي حوصرت المجامع بها من خلال النظر إلى أنها ثانوية، وأنها تترك الجوانب الرئيسة، علمًا بأن أنظمتها التي سنّتها لها الجهات التنظيمية في دولها هي التي حصرتها ضمن أُطر محددة، ولعل من أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات:
أولًا: أن يهيأ لهذه المجامع إطار العمل الدولي وليس العمل القُطْري فحسب.
ثانيًا: استحداث أنظمة لدخول الشباب والنساء فيها من المتخصصين والمتخصصات.
ثالثًا: إلزام هذه المجامع بأن يكون لها شق تقني مماثل لشقها الواقعي؛ لأن الحياة تتجه نحو هذا الاتجاه، ويجب أن تكون جميع الخدمات التي تقدمها موجودة على الشبكة.
● كيف ترون الوضع الذي تعيشه اللغة العربية الفصحى مع أجيالها من الطلبة والمعلمين وغيرهم؟
■ هذا السؤال يحتاج إلى لقاءات حوارية متنوعة ودراسات دقيقة للوصول إلى صيغة من صيغ الإجابة، وهو مما تفتقده لغتنا، ولذلك نعمل الآن على مشروع «مؤشر اللغة العربية»، ويتعين هنا الإشارة إلى أن الرهان على حركة تعليم العربية هو رهان مهم، ويجب أن يتوافر من أجله الأفراد والمؤسسات، وأن تتداخل فيه شرائح متنوعة منهم المختصون باللغة، ومنهم المختصون بالتربية، ومنهم المعنيون في قطاعات التنمية والحضارة بشكل عام؛ إذ إن تعليم العربية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام المتنوعة هو نافذة مهمة لكي نصنع جيلًا يعتز بلغته، وينظر إليها بوصفها تقع في المنزلة العليا من اهتماماته، فاللغة صانعة الإبداع، والإنسان لا يفكر إلا باللغة، واللغة التي لا يتحدثها الأطفال هي اللغة التي تسير إلى الموت.

 الأمر الثاني هو الإنتاج الذي يسعى للربح السريع دائمًا، فيطالب المسرحيين بشيء أقرب إلى ما يسمى بـ«اللايت»، على أساس أنك لا تستطيع أن تقدم للعالم غير اللايت، بالطبع لا، فأنا قدمت ثلاث مسرحيات، إحداهن بلبنان، لبنان الذي تعداده أربعة ملايين نسمة، استمرت لمدة ثلاث سنوات، حضرها 45 ألفًا، وهي نسبة كبيرة، كانت المسرحية بعنوان: «طريق جديد» وهي مقاربة تاريخية كوميدية لعدة نقاط في عالمنا العربي، فماذا كان دور المنتج، المنتجون يفضلون دائمًا الربح السريع، يفضلون ما يعرف بـ«الكوميدي لايتس»، وهو ما أثر في مفهوم المسرح الشعبي.
الأمر الثاني هو الإنتاج الذي يسعى للربح السريع دائمًا، فيطالب المسرحيين بشيء أقرب إلى ما يسمى بـ«اللايت»، على أساس أنك لا تستطيع أن تقدم للعالم غير اللايت، بالطبع لا، فأنا قدمت ثلاث مسرحيات، إحداهن بلبنان، لبنان الذي تعداده أربعة ملايين نسمة، استمرت لمدة ثلاث سنوات، حضرها 45 ألفًا، وهي نسبة كبيرة، كانت المسرحية بعنوان: «طريق جديد» وهي مقاربة تاريخية كوميدية لعدة نقاط في عالمنا العربي، فماذا كان دور المنتج، المنتجون يفضلون دائمًا الربح السريع، يفضلون ما يعرف بـ«الكوميدي لايتس»، وهو ما أثر في مفهوم المسرح الشعبي. المسرح بشكل عام في حالة أزمة كغيره من مؤسسات المجتمع العربي الراهن، نظرًا لما تمر به البلدان العربية جميعًا من ظروف عاصفة في أعقاب الربيع العربي، هذه الظروف التي أضعفت كل شيء بما في ذلك المسرح العربي، فقد شملت الفوضى كل شيء، وعمّ الدمار في كثير من بلدان المنطقة، وارتعد الجميع من تلك الموجة الشريرة للجماعات المتشددة في مختلف بلدان العالم العربي. والمسرح من المفترض أنه إحدى الأذرع المهمة التي ينبغي لها مواجهة قوى الإرهاب، هذا إذا فكر المسؤولون عن المسرح بشكل إيجابي في كيفية مواجهة الإرهاب، فهي قضية ثقافية بامتياز، والمسرح في قلب العملية الثقافية، فالفكر لا يواجَه إلا بالفكر، أما اعتماد مواجهة العنف بالعنف، فذلك سيؤدي إلى دمار شامل، يمكننا معالجة القضية من جذورها بتغيير الفكر الحافز على الإرهاب، لكن المشكلة تكمن في سوء الإدارة، وفي ظني أنها هي أساس أزمة المسرح الراهنة. فالعشوائية والشللية سيطرتا على هذا القطاع بشكل واضح، وليس هناك مسؤول لديه رؤية أو إستراتيجية واضحة للتعامل مع الإرهاب من خلال المسرح، ولا حتى للمسرح بشكل عام في هذه المرحلة، ففي الستينيات كان مدير المسرح لديه خطة وبرنامج وأفكار واضحة، وحين يتوقف عمل لظرف ما كان يسرع بالاتصال بالكتاب كي يقدموا له عملًا يسد الفراغ الذي تركه العمل الذي توقف، الآن الأمور كلها تسير بالمصادفة والهوى، ومن ثم فلا أحد يعرف ما الذي ينبغي عمله ولا ما الضرورة، مشكلة المسرح بالدرجة الأولى هي مشكلة سوء إدارة، وانعدام خيال، وهيمنة شللية، وانعدام الرؤية الإستراتيجية لما ينبغي عمله.
المسرح بشكل عام في حالة أزمة كغيره من مؤسسات المجتمع العربي الراهن، نظرًا لما تمر به البلدان العربية جميعًا من ظروف عاصفة في أعقاب الربيع العربي، هذه الظروف التي أضعفت كل شيء بما في ذلك المسرح العربي، فقد شملت الفوضى كل شيء، وعمّ الدمار في كثير من بلدان المنطقة، وارتعد الجميع من تلك الموجة الشريرة للجماعات المتشددة في مختلف بلدان العالم العربي. والمسرح من المفترض أنه إحدى الأذرع المهمة التي ينبغي لها مواجهة قوى الإرهاب، هذا إذا فكر المسؤولون عن المسرح بشكل إيجابي في كيفية مواجهة الإرهاب، فهي قضية ثقافية بامتياز، والمسرح في قلب العملية الثقافية، فالفكر لا يواجَه إلا بالفكر، أما اعتماد مواجهة العنف بالعنف، فذلك سيؤدي إلى دمار شامل، يمكننا معالجة القضية من جذورها بتغيير الفكر الحافز على الإرهاب، لكن المشكلة تكمن في سوء الإدارة، وفي ظني أنها هي أساس أزمة المسرح الراهنة. فالعشوائية والشللية سيطرتا على هذا القطاع بشكل واضح، وليس هناك مسؤول لديه رؤية أو إستراتيجية واضحة للتعامل مع الإرهاب من خلال المسرح، ولا حتى للمسرح بشكل عام في هذه المرحلة، ففي الستينيات كان مدير المسرح لديه خطة وبرنامج وأفكار واضحة، وحين يتوقف عمل لظرف ما كان يسرع بالاتصال بالكتاب كي يقدموا له عملًا يسد الفراغ الذي تركه العمل الذي توقف، الآن الأمور كلها تسير بالمصادفة والهوى، ومن ثم فلا أحد يعرف ما الذي ينبغي عمله ولا ما الضرورة، مشكلة المسرح بالدرجة الأولى هي مشكلة سوء إدارة، وانعدام خيال، وهيمنة شللية، وانعدام الرؤية الإستراتيجية لما ينبغي عمله.



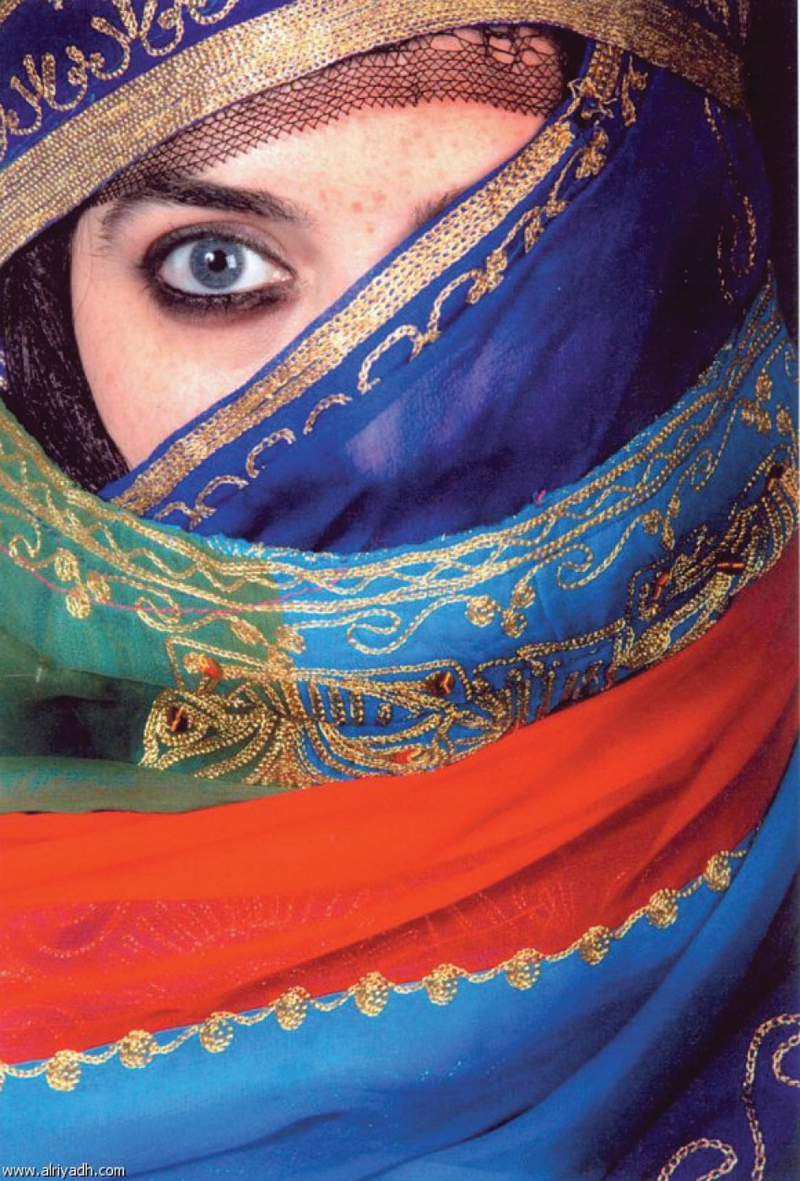 وثَّقتِ مجموعات اجتماعية، مثل «رجال ونساء النفط في السعودية» في مشروعك الفني «إذا نسيتك فلا تنساني»، وتناولتِ تأثير وسائل الإعلام في نشر محو متعمد للهويات في مشروع «صدمة»؛ هل تعتقدين أن رسالة الإعلام العربي كانت سلبية تجاه قضايا مجتمعه وبخاصة المرأة؟
وثَّقتِ مجموعات اجتماعية، مثل «رجال ونساء النفط في السعودية» في مشروعك الفني «إذا نسيتك فلا تنساني»، وتناولتِ تأثير وسائل الإعلام في نشر محو متعمد للهويات في مشروع «صدمة»؛ هل تعتقدين أن رسالة الإعلام العربي كانت سلبية تجاه قضايا مجتمعه وبخاصة المرأة؟ استمددتِ إلهامك في مجموعة «أنا» من الخطاب الذي ألقاه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز يوم تولّيه العرش، ودعا فيه يومها السعوديّين كلّهم ليتعاونوا على بناء وطننا. كما شدّد على أهمية مشاركة المرأة. وفي الصور الفوتوغرافية من مجموعة «أنا» نساء صورتهن وهن يرتدين تفاصيل توحي بوظائف عدة، ما الذي دفعك إلى إعداد هذه المجموعة؟
استمددتِ إلهامك في مجموعة «أنا» من الخطاب الذي ألقاه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز يوم تولّيه العرش، ودعا فيه يومها السعوديّين كلّهم ليتعاونوا على بناء وطننا. كما شدّد على أهمية مشاركة المرأة. وفي الصور الفوتوغرافية من مجموعة «أنا» نساء صورتهن وهن يرتدين تفاصيل توحي بوظائف عدة، ما الذي دفعك إلى إعداد هذه المجموعة؟







