
بواسطة صبحي موسي - صحافي مصري | مايو 1, 2019 | الملف
هل يمكن تصور أدب أو إبداع من دون فلسفة ينهض عليها؟ يوجد ما يشبه الخصام بين الذهنية العربية والفلسفة، شواهده حرق الكتب لفلاسفة مثل ابن رشد وسواه، إضافة إلى ما عاناه بعض الفلاسفة من متاعب مع الذهنية العربية في تلك الأزمنة. فكيف يرى المثقفون الآن هذه الذهنية، وما تأثير غياب الفلسفة في الإبداع العربي؟
عدد من المثقفين والمثقفات تحدثوا لـ«الفيصل» عن الفلسفة والعقل العربي، وأيضًا عن علاقة الفلسفة بالأدب.
عقل عربي مغرم بصناعة الأصنام
يذهب أستاذ الفلسفة في جامعة الزقازيق المصرية الدكتور حسن حماد إلى أن العقل العربي بطبيعته عقل نصي، ومعظم اجتهاداته وإبداعاته تدور حول النص، حتى من قبل نزول الوحي. ويقول: «إننا لا نعرف فلاسفة في الثقافة العربية، حتى الذين نتغنى بأمجادهم مثل الخوارزمي والفارابي والحسن بن الهيثم، معظمهم لم يكن من العرب. وقد ازدهرت الحضارة الإسلامية في القرنين الرابع والخامس الهجري، وأدى تفتُّت الإمبراطورية الإسلامية إلى اضمحلال هذه الحضارة، ثم ظهرت في صورة عسكرية تمامًا مع الدولة العثمانية، وكل إنجازها هو فتوحات وليس إبداعًا فكريًّا. لقد هيمنَ التفكير الأصولي السني على معظم التاريخ الإسلامي، وتم إقصاء الفكر الفلسفي والمعتزلي من المشهد، فأصبحت الفرقة الناجية هي فرقة أهل السنة والجماعة، وأُحرقت كتب ابن رشد، وقُتل السهروردي والحلاج وغيرهما». ويمضي الدكتور حماد يقول: «خلاصة القول أن الذهنية العربية كانت ولم تزل تدور في فلك النص؛ لذا غابت السرديات العلمية والفلسفية والجمالية إلى جانب حضور السرديات المقدسة الكبرى، تلك التي أصبحت تقود الحياة اليومية والفكرية والسياسية لدى كل طبقات المجتمع، وما زلنا نفكر في السياسة بمنطق القبيلة، وفي العلم بمنطق اللاهوت، وما يشغلنا ليلَ نهارَ هو كيف نوفِّق بين العلم والدين، والفلسفة والدين، والفن والدين، فالعقلية النصية هي العقلية الإقصائية التي أنتجت العقليات الإرهابية في نهاية المنحنى».
ويذكر أن الحضارة الغربية «مرت بمرحلة مخاض بدأت من القرن 16، وارتبطت بظهور طبقة جديدة هي الطبقة البرجوازية، وارتبطت بنهضة علمية تمثلت في أبحاث جاليليو وكوبلر وغيرهما، ثم رينيه ديكارت وفرانسيس بيكون، وكذلك ظهرت البروتستانتية وهي حركة احتجاج وثورة ضد سلطة الكنيسة، وهو ما أدى إلى خلخلة الصورة الجامدة لأوربا في هذا العصر، ثم جاء عصر التنوير ليكمل المسيرة، والتنوير معناه أن العقل هو القوة التي تسيِّر مقادير الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، وفي القرن الـ20 ظهرت ثورات ضد العقل في إنجازات الفلسفة والفن كالدادية والسوريالية والتكعيبية والوجودية والفلسفات العدمية، هذا التيار الذي تمخضت عنه ما بعد الحداثة المتجسدة في ميشيل فوكو وجاك دريدا وغيرهما، ورغم أن العقل الأوربي يعيد ويراجع صياغة أطروحاته بصورة دائمة إلا أنه لم يزل عقلًا خصبًا ونابضًا بالحياة؛ لأن من طبيعة العقل النقدي نقد الواقع والذات، أما العقل العربي فهو عقل نرجسي منكفئ على ذاته، يجترّ ماضيه وذكرياته، وليس لديه رؤية تجاه المستقبل، فرؤيته تأتي من الماضي، ومن لحظة مثالية أو عصر ذهبي وهمي، وهو عصر الخلافة الإسلامية، ناسيًا أن ثلاثة من الخلفاء الراشدين قُتلوا. هذا العقل غير قادر على مراجعة نفسه، ومغرم بإعادة صناعة الأصنام سواء تمثلت في النصوص أو الفقهاء أو التاريخ».
أدب مطعم بالفلسفة
من ناحيته، ينفي الكاتب الكردي السوري هوشنك أوسى غياب الفلسفة عن حياة المجتمع، ويشير إلى أنه بموت الفلسفة تموت المجتمعات، «ذلك أن السؤال هو روح الفلسفة، وإن خلت الفلسفة من الأسئلة تحوّلت إلى دين يتعامل مع الأمور والأحداث والتحوّلات الاجتماعيّة – الاقتصاديّة – السياسيّة بيقينيّات ومطلقات وحتميّات، معطوفًا عليها الغيبيّات. وعليه، الفلسفة عقل المجتمع، والإبداع رُوحه. وتكمن جدليّة وديناميّات تطوّر المجتمعات في ثنائيّة العقل والروح. وما يجمع العقل والروح هو السؤال. فللعقل أسئلته التي ربما تتعارض أحيانًا مع أسئلة الروح. والعكس صحيح».
ويقول هوشنك: إنه من الممكن الحديث عن تراجع الفلسفة في الحياة العامّة العربيّة والشرق أوسطيّة، «ولكن لا يمكن الحديث عن الغياب بشكل مطلق للفلسفة، رغم الترسانة الخرسانية الهائلة التي يتمتّع بها الاستبداد والفساد في العالم العربي. فمن طبائع الاستبداد السعي الدؤوب نحو تغييب الفلسفة من حيوات الناس، بهدف اغتيال الفلسفة، وشلّ العقل الفردي والمجتمعي. لكن الفلسفة تقاوم، سواء بشكل مجرّد، أو عبر الفنون والآداب، فما زال هناك شِعر، ينطوي على أفكار ورؤى فلسفيّة، حتّى لو كان على نطاق ضيّق. وما زالت هناك رواية وقصّة تنحوان منحى الفلسفة في حَفْز الأسئلة وقلق المعرفة، ومعاودة إنتاج أسئلة الوجود والحياة والحريّة لدى الأفراد والمجتمعات، حتى لو كان ذلك في نطاق ضيّق. صحيح أن المجتمعات العربية، بفعل الاستبداد وعدم ملاحقة التطوّرات الكونيّة على صعيد التعليم والعلوم وإنتاج المعرفة، أصبحت مجتمعات استهلاكيّة، وهو ما انعكس على الآداب والفنون. ولكن الصحيح أيضًا أن النثر الفلسفي أو الأدب المطعَّم بالفلسفة، ما زال يمارس فعل المقاومة، مقاومة الانحطاط والاستبداد وقيم ومفرزات المجتمع الاستهلاكي».
وعن حضور الفلسفة في الأدب العربي يوضح أوسى أن من الطبيعي أن يكون هناك تراجع في القيمة الأدبيّة أو ندرة الأعمال الأدبيّة ذات العمق والمنحى الفلسفي، مع هذه الوفرة الكبيرة من صدور الأعمال الأدبيّة والجوائز المخصصة لها في العالم العربي، «وليس بالضرورة أن يكون الكاتب/ة فيلسوفًا حتّى يحقُّ له طرح بعض الأفكار والأسئلة الفلسفيّة في أعماله. كذلك العمل الأدبي، ليس بالضرورة أن يكون مغاليًا أو موغلًا في متاهات الفلسفة؛ ذلك أن قارئ الأدب ينتظر من الأديب أدبًا، وليس سلسلة من البحوث والدراسات الفلسفيّة، فحضور الفلسفة في الرواية ولو بنسبة 20 إلى 25 بالمئة، يكفي لأن يخوّل لنا تسميتها رواية فلسفيّة. وما يزيد على ذلك، ربما يشكّل عبئًا على الرواية».
النص يصدر عن رؤية وفكر
الكاتب والناقد الأكاديمي اللبناني الدكتور عبدالمجيد زراقط يرى أن الأدب يصدر عن رؤية فكرية، وأن النص الأدبي يتشكل من منظور هذه الرؤية، وهو ما يعني، في رأيه، أن الفكر مكون أساس من مكونات أي نص أدبي. ويقول: «ما يختلف به نص عن نص آخر هو نوعية هذا الفكر وموقعه في بنية النص ودوره في إنتاج فاعليته الجمالية الدلالية، وإذا أردنا أن نطبق هذا على نماذج روائية فإننا نجد أن «الأجنحة المتكسرة» لجبران خليل جبران تصدر عن رؤية فكرية مفادها أن الشرائع البشرية السائدة تكسر أجنحة الإنسان، وخصوصًا أجنحة الحب، ونجد أن رواية «العائد» لخليل تقي الدين، وروايات «لقاء» و«مذكرات الأرقش» و« مرداد» لميخائيل نعيمة تصدر عن رؤية فلسفية تقول بوحدة الوجود والحلولية وتناسخ الأرواح والتقمُّص، وأن رواية ليلى بعلبكي «أنا أحيا» وروايات سهيل إدريس «الحي اللاتيني» و«الخندق الغميق» و«أصابعنا التي تحترق« تأثرت برؤى الفلسفة الوجودية».
تراجع البعد الفلسفي
ويوضح الناقد الأكاديمي الجزائري الدكتور وحيد بن بوعزيز أن الذهنية العربية على غرار ما كتبه المعري وجلاه المتنبي في أشعاره، كانت تنحو تجاه العقل الفلسفي على الرغم من العداء الموجود لكل ما هو فلسفي. ويلفت إلى أن الشاعر محمد إقبال حاول «إضفاء طابع ذهني على أشعاره، كما حاول توفيق الحكيم كذلك كتابة الكثير من المسرحيات الفلسفية، ولعل أشهرها «أوديب ملكًا»، ونجد في المغرب العربي بداية اتجاه في الرواية يتكئ على الرواية الفلسفية، نضرب على سبيل المثال رواية «حدث أبو هريرة قال» للمسعدي، ورواية «الغريق» لعبدالله العروي، ورواية «العلامة» و«ذلك الأندلسي» لبن سالم حميش. في المغرب حاول الأدباء دومًا تغليف نصوصهم بطابع فلسفي خاص، من غوته ونيتشه وريلكه إلى أمبرتو إيكو وميلان كونديرا. ويعود تراجع البعد الفلسفي في النصوص العربية إلى عقدة من الفلسفة في الثقافة العربية، وإلى تراجع الطابع الفكري بسبب الأيديولوجيا العولمية التي ترفض كل إعمال للعقل فعلًا. لقد كان للفيلسوف الإيطالي جياني فاتيمو على حق حينما قرر أن عمق الأيديولوجيا العولمية هو تبليد وتسفيه للعالم، فما أحوجَنا اليوم إلى نصوص تخترق عتمة الماضي وعتمة المستقبل».
كره الفلسفة بديهيًّا
ويتهم أستاذ الفلسفة في أكاديمية الفنون المصرية الدكتور حسن يوسف الذهنية العربية، بأنها تكره الفلسفة بالبديهة؛ «لأن الفلسفة تعني استعمال العقل، والذهنية العربية لم تتعود على استعمال العقل، وجانب كبير من تاريخنا الفكري قائم على التلقي وإراحة العقل من أجل تمرير كل ما تريد السلطات تمريره، أما إعمال العقل والتحليل والاستنتاج فإنه يعني إيقاظ الوعي، وهذا غير مطلوب، والذهنية الإسلامية لا تحب أن تستخدم التفكير العقلاني، ومن ثم فإنها تقوم بعملية توفيقية أو حسبما أحب أن أسميها عملية تلفيقية، أما ابن سينا والكندي والفارابي وغيرهم فهم ليسوا عربًا أصلًا، وكثير من المفكرين في التاريخ العربي كان عقلهم منشغلًا بالعملية التوفيقية أكثر من الانتماء الكامل للفكر الفلسفي أو العقلاني». ويشير يوسف إلى ابن رشد: يظل «العلامة الأبرز في مسار الفكر العربي الفلسفي، ورغم ذلك فقد رد عليه الغزالي، وهو ليس عربيًّا أيضًا، بكتاب سمّاه «تهافت الفلاسفة»، فرد عليه ابن رشد بكتاب «تهافت التهافت»، ومن ثم فلم يكن ابن رشد مقبولًا من المجتمع الفكري في الجماعة العربية، ولم تكن أي محاولة لإيقاظ العقل مرغوب فيها، ومن يدافع عن ذلك فأغلبهم غير صادق، وبنية الذهن العربي الإسلامي غير راغبة في العقل الفلسفي، وليس لديها القدرة على تقبل الآخر ولا تصوراته عن الكون والعالم، ومن ثم لا تؤمن إلا بما لديها ولا تفكر خارج حدوده، وقد ترك ذلك تأثيره على الإبداع العربي. فالإبداع بشكل عام ضعيف؛ لأن الذات غير محررة، ومقولبة في أطر عادات وتقاليد دينية واجتماعية متشددة، ودائمًا محاطة بأطر، ومن ثم فالأفق الثقافي ليس به إبداع، فقط هناك التأثر ببعض الأطروحات الخارجية ومسايرتها، أما الإبداع الحقيقي الخالص فغير موجود بسبب الخوف من التصادم مع من يحاربون الإبداع في كل رؤاهم».
لا إبداع بلا فلسفة
الشاعرة والروائية الإماراتية ميسون صقر تدافع عن وجود الفلسفة في الإبداع. وتوضح أن الفلسفة هي رؤية للعالم وعمق للواقع والكتابة، وأنها تفيد فكرتنا عند كتابة النص؛ لأن محاولة رؤيته من منطق غير فلسفي، أي أدبي فقط، كما تذكر، تقلل من قيمته.
وتقول ميسون صقر: «الفلسفة تساعدنا على ترتيب الأفكار والرؤى بشكل عام، وليس في الفكرة الداخلية فقط. ومن دونها تصبح أفكارنا مشتتةً وبدائيةً وغير واضحة، وغير منسقة في أنساق وملفات أساسية. كما أن الفلسفة تقدم رؤى عميقة للواقع السياسي والثقافي والأدبي، وتحولها إلى وجود له هيكل واضح، بينما الإبداع هو لغة لا بد أن توضع في إناء، فإذا امتزجت بالفلسفة عمقها هذا الشكل الأخير. والثقافة تُبنَى على مجمل الأفكار الحداثية في الأدب والسياسة والتكنولوجيا، والفلسفة تبحث في تفكيك كل هذا، وإعادة صياغته من جديد، فهي تفكير واعٍ منسق». وتذكر صقر أنه منذ بداية العالم حتى الآن «هناك تطور للأفكار الفلسفية، وهناك تداخل بين الفكر الثقافي والأنثروبولوجي والديني واليوتوبي، والفلسفة تربط كل هذه الحقول ببعضها، بينما الإبداع هو الذي يخلق السيولة التي تساعدنا على الانتقال من حقل إلى آخر بوعي ومرونة شديدة، ولا يوجد إبداع من دون فلسفة، وأي مبدع لا يتعاطى الفلسفة كفكر ومنهج لتخيل العالم فإنه لا يقدم ابداعًا، ولكن مجرد لغة لا معنى لها».

بواسطة صبحي موسي - صحافي مصري | مارس 3, 2019 | الملف
الجامعة ليست مجرد شهادة علمية في حياة من يدخلها، لكنها قنطرة العبور من نعومة الصبا إلى صخب الحياة وجمالها، ففيها تتشكل الأفكار، وتعرف الأقدام خطواتها على الطريق، فتتخذ المسارات وتتحدد الرؤى. لا يدرك من لم يدخل الجامعة سنوات الاكتمال، بدءًا من الجلوس في المدرَّج الواسع الطويل العالي، والإنصات لكلمات عالم جليل عجوز عصرته السنون، وصولا إلى الجلوس في الكافيتريا بانتظار صديقة غائبة، أو المشاركة في فرق الكشّافة والأنشطة المتنوعة، والأُسَر الثقافية ومجلاتها على الحائط، أو الصراع من أجل الدخول في اتحاد الطلاب، أو المشاركة في مسابقات الغناء والشعر والترفيه.
في الجامعة مذاق أول قصيدة لشاعر، وأول قصة لكاتب، وأول اكتشاف لأفكار اليمين واليسار، أو تنازع الجماعات على تجنيدك، وأنت تتحسس أقدامك الخطى، لتعرف من هؤلاء ومن هؤلاء، فتظل تعرف وتكتشف حتى تكتمل سنوات تعليمك وإدراكك، وتظل طيلة العمر تنتشي بذكريات أيام الجامعة عن أول فتاة عرفتها، وأول أستاذ التقيتَه، وأول تيار انتميتَ إليه، وأول جماعة دخلتَها وخرجتَ منها سالمًا، وتتذكر المواقف والأماكن والأحداث، وتتذكر التفاصيل واليوميات، وتعيش لسنوات طويلة موقنًا أن ذهنك ما كان ليكتمل وعيه من دون المرور من تحت قبة الجامعة، فتحلم أن تعود إلى سنواتها من جديد، ربما لتغير التخصص، وربما لتعدِّل النتائج، أو تلتقي مَنْ أخذتهم منك السنون وأمواج الحياة، لكنك في كل موقف تتذكر فيه الجامعة ستشعر بنوع من الحنين واستحضار أيام تتمنى أن تعود، فماذا يقول الكُتاب لـ«الفيصل» عن أيامهم في الجامعة؟

أمير تاج السر
مرحلة غنية جدًّا
يقول الكاتب السوداني أمير تاج السر: إن مرحلة دراسته في مصر كانت غنية جدًّا، وإنه يعدها المرحلة التي تكون فيها كشاعر أولًا ثم ككاتب ثانيًا، «كنت أقرأ المجلات التي كانت تصدر في ذلك الحين وبعضها مستمر في الصدور حتى الآن. مجلات مثل: القاهرة، وإبداع، والأقلام والطليعة العراقيتين، وغير ذلك. أيضًا كنت أحصل على زادي من الكتب في كل المجالات من رواية وشعر ونقد، وأذكر أنني اقتنيت كتبًا في عروض الشعر، وأتقنتُ عن طريقها كتابة قصيدتي المُفعَّلة. كنت أعشق الكتابة في بحر المتقارب والمتدارك، واكتشفت لاحقًا أن الشعر التفعيلي في معظمه، كان يركض في هذه البحور». تعرف تاج السر في حياته الجامعية إلى المثقفين المصريين، وبدأت علاقته بهم في البدء خجولة، حيث التقى مثقفي مدينة طنطا، لكنها اتسعت بعد ذلك لتشمل معظم الأسماء التي كانت موجودة على الساحة في تلك الأيام، «وكان من حسن حظي أن عبدالحكيم قاسم كان حيًّا في تلك الفترة، وارتبطتُ بصداقة جيدة معه، وتعلمت كيف أكتب رواية بناءً على مشورته».
لا تعد مرحلة الجامعة هي مرحلة النبوغ الأدبي، رغم أنها مرحلة التأسيس الحقيقي، وربما يمارس الكاتب فنه سواء القصة أو الشعر من دون أن يعرف الكثيرون ذلك عنه، يقول تاج السر: «كان وجودي في الجامعة، أعني داخل الجامعة ومحيطها، وجودًا علميًّا فقط، كنت أدرس الطب ولي زملاء كثيرون لم يكونوا يعرفون أنني شاعر أو كاتب، وبالرغم من أن الراحل أحمد خالد توفيق كان معنا، إلا أنه لم يكن يمارس الأدب داخل الجامعة، وكانت معرفتي به سطحية جدًّا، معرفة زمالة فقط. وقبل أن أتخرج بأشهر، استطعت إنجاز روايتي الأولى «كرمكول» التي قدمتني للوسط الأدبي كاتبًا، مضى في الطريق الطويل بعد ذلك».

جيهان عمر
جو البهجة والتجريب
أما الشاعرة المصرية جيهان عمر، فلم تكن تعلم أن التحاقها بالجامعة، سيكون له أي أثر آخر سوى الالتحاق بقسم الفلسفة الذي تمنت الدراسة به، «لكنني بالتحاقي بكلية الآداب فوجئت بعدد كبير من كاتبي القصة والشعر والمسرح.. بعضهم من المعروفين الآن بجيل التسعينيات. كانت الأوراق متاحة للجميع، فمن كتب قصيدة جديدة يحملها في جيب الجاكيت؛ إذ إن الأصدقاء هم الجمهور الوحيد. ومن نُشرت له قصة قصيرة في مكان ما فستجد المجلة نفسها في يده، كانت الفرحة بالنشر الورقي كبيرة. أما اطلاع أصدقائك على ما تكتب فهو غاية المنتهى. كنت تجد نصوصًا مميزة كأنها لأديب كبير، كما كنت تجد المقلدين تمامًا كما يحدث في كل وقت. ولكن جو البهجة بالجديد والتجريب الذي كان يحدث من دون أن تعي تمامًا ما تفعله بالنص، هو المتعة التي ما زلنا نذكر حلاوتها. تبادل الكتب أيضًا وقراءتها بسرعة لكي تمر على قارئ آخر أو استعارتها من مكتبة الجامعة، كان أهم ما يميز تلك الفترة».
كيف بدأت جيهان الكتابة في الجامعة؟ تقول: «كنت أكتب لنفسي. أخبئ كل ما أكتب عنهم وأكتفي بسماع جديدهم. كنت أشعر كأنني كمن يكشف رُوحَه أمام الغرباء لو قرأتُ لهم ما أكتب. ثم سيطرتْ عليَّ فكرة أخرى. كيف سيميز القارئ نصًّا بين هذا الكم من الإنتاج الغزير. أما في العام الرابع فبدأت أقرأ لصديق أو اثنين من حافظي الأسرار. وحينما كان الشاعر هشام قشطة يعد عددًا عن قصيدة النثر في مصر.. أصرّ الصديق الذي استأمنته على سري على نشر القصائد القصيرة التي قرأها في هذا العدد، وكانت هذه هي أول تجربة نشر لي في عام 1997م، ثم اختار مترجم ألمانيّ نصيْنِ من المجلة كان النصان هما قصائدي مع قصائد كاتب آخر لنشرها في جريدة ألمانية، هنا فقط اقتنعت بأن هناك قارئًا يستطيع أن يقرأ لي أو ينحاز ذوقه لنصوصي، ورغم هذا الشعور الإيجابي إلا أنني أصدرت ديواني الأول عن دار شرقيات بعدها بسنوات عدة. أيضًا على استحياء من دون ضجة وبخوف كبير من أن تبيت كلماتي بعيدة عني، وحيدة على أرفف المكتبات الباردة».
مَدِين كثيرًا للحياة الجامعية
ويختزل الشاعر والكاتب الليبي عبدالباسط أبو بكر محمد مرحلة الدراسة الجامعية في نقطتين أساسيتين: هما الانفصال الأول عن المنزل وارتباطاته. ويرى أن لهذه النقطة دورًا كبيرًا في تأسيس الكثير من الآراء والأفكار وبلورة فهم للحياة بعيدًا من مظلة الأُسرة الراعية. أما النقطة الثانية فهي كثرة القراءة وتنوع الأفكار، وبخاصة أنه درس في جامعة بعيدة من المنزل ملحقة بسكن داخلي لإقامة طلبة الضواحي. ويضيف عبدالباسط: «كانت مرحلة الدراسة الجامعية نقطة تأسيس في حياتي بشكلٍ عام، ونقطة لتكوين رصيدي المعرفي بشكلٍ خاص، وبالتالي حجر الأساس الذي اعتمدت عليه لكتابة أول نصوصي الشعرية عام 1996م».
كان أعظم إنجاز لعبدالباسط بوصفه طالبًا جامعيًّا مهتمًّا بالقراءة، أن يجد مكتبة الجامعة الممتلئة بالكثير من الكتب، ويجد متسعًا من الوقت نهاية الأسبوع ليقرأ، «في الجامعة تعرفت على تجارب السيَّاب وعبدالصبور والبياتي وأبو ريشة والجواهري وأمل دنقل. وكانت العتبة الأولى لقراءة كتب التاريخ التي كنت مهووسًا بها، وفي المقابل وخلال السنوات الأولى، كانت حالة الكتابة تتشكلُ في أول نصٍّ قصصي كتبته من صميم التجربة، وكانت شخوصه حيةً تتنفسُ وتتقافزُ عبر أروقة الحرم الجامعي، وعندما عرضته على الأصدقاء للقراءة كانت أصداء القراءات كثيرة جدًّا إلى درجة أن صديقي عبدالله بو صالح كتب عنه أول دراسة نقدية متكاملة».
أثر الجامعة كان عميقًا في حياة عبدالباسط؛ «منحتني الحياة الجامعية فُرصًا عدة؛ الفرصة الأولى: هي القدرة على نقاش الأفكار الصغيرة والكبيرة، وأنا أنظرُ الآن إلى تلك الفترة بشخوصها وإنجازاتها، وأيضًا حماقاتها، بوقارٍ كبير. والفرصة الثانية: هي القدرة على التأمل كجزئيةٍ مُكملة لحالة القراءة والنقاش، حيث كان السكن الداخلي للطلبة في حضن الجبل الأخضر، موفرًا أجواء تساعد على إتمام هذه الجزئية. والفرصة الثالثة: هي رصيد معرفي وحياتي لكتب وقراءات وشخوص وتجارب كثيرة، شكلت لي رصيدًا مهمًّا تستدعيه الذاكرة في سياقات التجربة الإبداعية المختلفة. أنا ككاتب مَدِين كثيرًا للحياة الجامعية بتفاصيلها الكثيرة والمتنوعة؛ لأنها منحتني كمًّا من التجارب اللازمة في تلك الفترة العمرية، بل ساهمت في رسم مساقات الحياة والأصدقاء والكتابة بالطبع!».

عبدالباسط أبو بكر محمد
فضلت صحبة نفسي
كانت الكاتبة الإماراتية مريم الساعدي في أيام الجامعة شخصًا حالمًا، رافضًا وغاضبًا، وهو ما جعلها تمضي وقتها في المكتبة تقرأ الروايات من دون أن تنضم لأي جماعة أو جمعية، «ثقافة الأحكام الجاهزة أصابتني بالسقم، فلجأت للعزلة وصادقت الكتب وشخصيات الروايات. صادقت جين آير الفتاة الطيبة البائسة التي أحبت السيد روتشستر القاسي في مظهره، لكنها أدركت قلبه الطيب في رواية شارلوت برونتي المليئة بالإشراقات الاجتماعية. صادقتُ السيد آشلي الأرستقراطي الطيب الذي تحبه البطلة سكارليت أوهارا دون أن يبادلها الحب في الرواية الرومانسية التاريخية «ذهب مع الريح» لمارغريت ميتشل. و«الأمير الصغير» في رواية أنطوان دو سانت أوكزبري كان صديقي الحكيم عطر البراءة الذي أتنفس في طُهر أفكاره براءة الحياة. عشتُ أيامًا طويلة مع أبطال «الحرب والسلام» لتولستوي، وعانيت الصراع النفسي مع راسكولنيكوف بطل «الجريمة والعقاب» لدوستويفسكي، وهكذا ظللتُ بين المحاضرات والمكتبة.
لكن ماذا عن الرومانسية في الواقع، ماذا عن الزملاء والزميلات؛ تقول مريم: إنها كانت أحيانًا ما ترضخ لضغط بعض الزميلات فتستمع لقصصهن عن الحب. كل منهن كانت لديها قصة حب ما، وكلها كانت قصصًا تنتهي بغدر الرجل، فتعيش الفتاة دور المكلومة فترة من الزمن حتى تنتقل لقصة الأخرى. وتؤكد الساعدي لنفسها أنها أيضًا تؤمن بالحب، ولكن كما صورته الروايات؛ «أما قصص زميلاتها فقد بدت خيالية ولا علاقة لها بالواقع. في أحيانٍ أخرى كنت أجد نفسي في دوائر زميلات في النقيض الآخر، رفضن كل أشكال الحياة العصرية، وتشبثن بالوعظ من عذاب الآخرة كوسيلة حياة. كان هذا كل ما يشغلهن، لا حديث عن الحياة إلا كذنب لن نتطهر منه سوى بالموت، لذلك فضّلتُ دومًا صحبة نفسي».

مريم الساعدي
كانت مريم تحب الذهاب إلى المحاضرات، وتحب النقاش وطرح الأفكار والأسئلة، لكن لم يكن كل الأساتذة يرحِّبون بذلك، والطالبات لم يكنَّ مهتماتٍ سوى بالشهادة في النهاية. الغالبية كُنَّ يرغبْنَ في الفراغ من المحاضرات والذهاب للبيت، «عندما يصبح همّ الإنسان حال خروجه من البيت هو العودة إلى البيت، يعني أن لا شيء ذا قيمة يحصل كثيرًا في الخارج». لكن كيف بدأت علاقة مريم الساعدي بالكتابة؟ «أحيانًا كلمة صغيرة يقولها أستاذ لطالبته تشكل فرقًا. كنت أُحب درس الكتابة الإبداعية، طلب منا الأستاذ كتابة اليوميات، وكنت أشعر بالسعادة لتعليقاته على يومياتي، قال في إحداها: «أرى هنا كاتبة تتشكل بوعي وحكمة.. سيكون لها شأن». كان هذا منذ زمن طويل، لا أعرف إن أصبح لي شأن كما تنبأ الأستاذ حينها. جرفتني قوالب المجتمع الجاهزة أيضًا، سقطتُ في الفخ بحثًا عن حيوية حياة لم أعشها أيام التلمذة. لكن عزائي أنني لم أكتب يومًا إلا ما صدّقتُه، على قلّته».
سنوات القسوة وتغير ملابس الطلاب والطالبات
الروائي والأكاديمي المصري الدكتور زين عبدالهادي يرى أن أعوام ١٩٧٥م و١٩٧٩م التي كانت سنوات دراسته في قسم المكتبات والوثائق بكلية الآداب في جامعة القاهرة، كانت سنوات شديدة القسوة، ليس عليه وحده لكن على المجتمع المصري كله، «كان وعيي قد تشكل مع هزيمة ١٩٦٧م، وخرجنا جميعًا مشردين بين مدن مصر بعد أن تركنا مدن القناة. كثيرون منا فقدوا أحلامهم، وكثيرون لم يستطيعوا العودة، وكنا منهم. كان تشكيل وعيي السياسي وارتباطي بالأدب واهتمامي بالعلم هم محاور حياتي كلها في تلك الفترة، التي ميزها صعود التيار الديني الجهادي، والصراع بينه وبين اليسار الشيوعي والاشتراكي والتحرري. رأيت تغير ملابس الطلاب والطالبات ليحل الجلباب محل القميص والبنطلون. وتحل العباءة محل المايكرو جيب. وتدخل الجنازير والهراوات والقبضات الحديدية داخل الجامعات، وتبدأ المعارك اليومية بين التيارين. كانت مجلات الحائط وسيلة لأنفسنا. نفكر في رواياتنا الأولى. يدخل أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام مدرج ٧٨ بآداب القاهرة لنستمع إليهما للمرة الأولى، نستمع إلى تغريدات نجم وعُودِ الشيخ إمام وصوتِه القويِّ ونغني معهما: «مصر يا امَّه يا بهيةْ.. يا امّ طرحةْ وجلابيةْ.. الزمن شاب وانتي شابةْ.. هو رايح وانتي جايةْ…» وتبدأ الحروب بيننا وبين قوات الأمن المركزي ويقبض على كثير منا ونزور الأقسام والمعتقلات ونشاهد التعذيب ونمر عليه».

زين عبدالهادي
ويمضي الدكتور زين يقول: «كان ذلك بعد سنوات من قيام السادات بثورة التصحيح، وإغلاقه للمعتقلات وإنهاء التعذيب في مصر، ولكن هيهات. إنه قدر المصريين وحكامهم، وتلك العلاقة الملتبسة عبر التاريخ الحديث والمعاصر. تبدأ القصة مع «انتفاضة الحرامية» كما سمَّاها السادات عام ١٩٧٧م، ليتم اعتقال المئات من طلاب الجامعات مرة أخرى وثالثة وعاشرة، ويستمر المشهد العبثي لنهاية التاريخ. وكان ذلك محور أول رواية أكتبها ولم تنشر، كانت بداية علاقتي بجيل سبقنا، منهم: مجيد نجم، ونعيم صبري، ويوسف إدريس، وإبراهيم عبدالمجيد وغيرهم. وعلى المستوى العلمي زلزل ألفين توفلر وزوجته كل أفكاري عن العلم، بعد أن بدأت أتابع أعمالهما؛ «تحول السلطة»، و«الموجة الثالثة»، مُبشِّريْنِ بحضارة جديدة تتعلق بالتكنولوجيا والاتصالات لم تعرفها الإنسانية من قبل، عرفتهما ونحن نحارب دائمًا في الاتجاه الخاطئ».

بواسطة صبحي موسي - صحافي مصري | نوفمبر 1, 2018 | تحقيقات
في أربعينيات القرن الماضي كانت توجد جماعات أبولو والديوان والخبز والحرية وغيرها، وفي خمسينيات وستينيات القرن ظهرت جماعة شِعْر التي تمحورت حول مجلة شعر البيروتية المناصرة للتيارات الشعرية الجديدة، وفي السبعينيات ظهرت في مصر جماعتا أصوات وإضاءة اللتان تنافستا في ضم الأدباء الجدد في مواجهة شعراء القصيدة الكلاسيكية، فضلا عن رفضها للتعامل مع المؤسسة وعدّ مَن يسعى لذلك خائنًا لاستقلال المثقف. لكن مع الوقت تغيرت الأحوال، وتفننت الدول في استقطاب المثقفين المناوئين لها في أروقة مؤسساتها الرسمية، وسرعان ما جعلتْ لكل طريقة شيخًا لا يمكن الحصول على الجوائز أو السفر إلى المؤتمرات أو المشاركة في الندوات من دونه، فانفضت الجماعات القديمة التي كانت تمارس ضغطها على المؤسسة الرسمية لضبط إيقاع عملها، إلى جماعات جديدة تسعى للضغط على الدول أو المؤسسات الرسمية لاستيعابها في تشكيلات لجانها ومِنَحها وجوائزها وسفرياتها.
زاد الأمر صعوبة بعد أن أضعفت ثورات الربيع العربي قبضة المؤسسات، وجعلت المسؤولين يسعون لاسترضاء الجماهير واحتواء غضبهم، وهو ما جعل الواقع الثقافي، في رأي بعض المثقفين، أشبه بميليشيات تجوب الشوارع، كل مجموعة لها مقر معروف سواء مقهى ثقافي أو دار نشر أو حتى صالون في منزل، ولكل جماعة أب روحي عادةً ما يكون شاعرًا أو ناقدًا كبيرًا، ورئيس فعلي يستمد قوته من كونه موظفًا كبيرًا في مؤسسة ثقافية، أو مسؤولًا في جريدة كبرى، أو مجلة قوية، أو صاحب دار نشر حققت قدرًا من شهرة. هذه الجماعات أصبحت بديلًا للجماعات القديمة، لكن أدوارها تغيرت من ضبط إيقاع المؤسسات الرسمية إلى ابتزازها لأجل مصالح شخصية للأعضاء، كالنشر والترجمة والحصول على الجوائز والمشاركة في المؤتمرات والسفر إلى الخارج والتحكيم في المسابقات. فكيف يرى المثقفون أنفسُهم هذا التحولَ وأسبابه؟
ناصر الظفيري: موظفو الدولة وأشباههم

ناصر الظفيري
الحياة الثقافية بالتأكيد ككل حياة مشابهة تخضع للمؤسسة الرسمية أو شبه الرسمية. لا توجد اليوم جمعيات ثقافية غير ربحية في الوطن العربي. السلطة في العالم العربي هي التي تقوم بالصرف على هذه المؤسسات وإن أطلقت عليها تسميات بعيدة عنها، ولكنها بالتأكيد تتبناها ماديًّا وإعلاميًّا، ومتى توقفت المؤسسة الرسمية عن الصرف عليها ستموت فورًا. العاملون في هذه المؤسسات هم موظفو دولة يخضعون لسياستها ويتبنون آراءها وأفكارها وبالتالي لن يتقبلوا أي عمل لا ينسجم مع هذه الأفكار السياسية للدولة. هذه هي الجماعات الضاغطة، التي غالبًا لا نعرف الأيدي التي تحرك جيش الموظفين أو حتى لجان التحكيم. في الجوائز العربية لا أعتقد أن اللجان مثلًا تقرأ جميع الأعمال ولكنها تخضع لدور النشر التي أيضًا ترتبط بمصالح مع المؤسسة الرسمية. تستطيع أن تكتشف هذا من تكرار الأسماء المدعوة للمهرجانات الثقافية. في الكويت مثلًا أتذكر أن كل أمسية شعرية للمجلس الوطني يتكرر اسم شاعرين أو ثلاثة. وفي كل ندوة تتكرر أسماء الباحثين أنفسهم، هذه الأسماء محفوظة في درج السكرتير يقدمها للمدير الذي غالبًا لا علاقة له أدبيًّا أو ثقافيًّا بالمناخ الثقافي العربي. وكل ما عليه اعتماد أسماء اللائحة من دون عناء. لا أستطيع أن أتهم البعض ولكني أسمع الشائعات التي تتحدث عن مناصفة الجوائز الأدبية مع الفائزين، وأستبعد ذلك الاتهام. أما ما يتعلق بالشللية الثقافية فهي موجودة ونعيشها كل يوم في حياتنا الثقافية. هناك مشكلة العاصمة والإقليم والحاضرة والأطراف، هناك النزعة العنصرية وسياسة الإقصاء والتجاهل لأي عمل يأتي من خارج الشلة المسيطرة على الوضع الثقافي. هذه السيطرة تأتي كما ذكرنا من طبيعة علاقة المثقف بالمؤسسة وقربه من أصحاب القرار فيها. الكثير من المثقفين وخصوصًا في الخليج يبذل من ماله ليحقق انتشارًا أو لترجمة عمل من أعماله، والبعض يستغل نفوذه ومكانته الوظيفية لإدخال عمله في لوائح الجوائز وهو واللجنة يعلمان أن عمله لا يستحق.
روائي كويتي.
أحمد قران: مؤسسات بلا فاعلية

أحمد قران
مؤسسات المجتمع المدني هي أهم وسائل الضغط الاجتماعي في أي دولة، من بين تلك المؤسسات ما يرتبط بالثقافة كالمراكز الثقافية والأندية الأدبية وجمعيات الفنون والمجالس الثقافية والمنتديات، شريطة أن تكون لها استقلالية عن الحكومات حتى تستطيع ممارسة دورها بحرية ومن دون إملاءات من المسؤول الرسمي، فإن لم تكن كذلك -أعني أن تكون مستقلة- فلن تستطيع ممارسة دورها المتمثل في الضغط الثقافي من أجل تغيير السائد وإحداث تحديثات وتجديدات في البنية الثقافية والاجتماعية.
هناك مؤسسات ثقافية أغلبها حكومي، وبالتالي لا تستطيع ممارسة ضغط ثقافي حقيقي من أجل التغيير إلا بالقدر المسموح لها به، أما المؤسسات والمنتديات الخاصة فهي قليلة، ولا تستطيع الخروج عن ذلك الإطار، كي لا تُلغَى، وبالتالي يعمل أصحابها وفق منظومة العمل الرسمي. الإشكالية التي تواجه الثقافة العربية تكمن في عدم إيمان الحكومات بدور الثقافة كقوة ناعمة تستطيع خدمة الحكومة والوطن وتحسين الصورة الذهنية عنهما ونقل تراث وحضارة وثقافة البلد إلى الآخر، وإن حرية الإبداع هي المنهج الذي يجب أن تتخذه المؤسسات الثقافية إذا ما أرادت أن يكون لها تأثير ثقافي ومجتمعي.
شاعر وأكاديمي سعودي.
محمد جعفر: جماعات بلا ألق

محمد جعفر
يمكنني أن أقول: إن المثقف المعرب في الجزائر لم يعرف فكرة النضال الثقافي. فجُلُّ المظاهر الثقافية عندنا منذ الاستعمار كان طابعها دينيًّا واتخذت من فكرة الإصلاح منطلقًا لها. هذا مع تبسيط للقضايا الجوهرية، والقفز عليها بدل حلها جذريًّا. وكنموذج لذلك موقف المثقف الإصلاحي من الثورة. وأما الفعل التنويري والثوري فقد مارسه المثقفون المفرنسون. وإن كنا اليوم نشهد شبه موات يشمل الفئتين معًا. ولعل ذلك يرجع لأسباب عديدة أهمها: الارتهان لمؤسسات الدولة. فالجمعيات والنوادي الثقافية يقوم على أغلبها طفيليون عديمو الموهبة، لا هدف لهم غير منافعهم الشخصية. وهي مجرد تابع لوزارة الثقافة. أضف إلى ذلك خلو الساحة من مؤسسات ثقافية مستقلة من حيث التموين، كذلك لا أثر لمجلات وجرائد تُعنَى بالثقافة. وهذه العناصر هي التي يتبلور فيها أي معطى ثقافي. كما تكون هي واجهته والموجِّه له.
وفي ظل هذا الوضع المخزي يلجأ أغلب المثقفين اليوم إلى مواقع التواصل. وهي رغم سلبياتها العظيمة يمكنها أن تكون عنصرًا حاسمًا في التثوير لقدرتها على الاستقطاب والحشد. ولقد لعبت دورًا حاسمًا في تلك الهَبَّة التي قام بها المثقفون للتضامن مع الروائي رشيد بوجدرة. ثم إن هذه الهبّة التي جاءت عفوية تحوي نواة تنظيم فاعل ومؤثر، هذا إذا ما توافرت النيّات والتأطير المطلوب. وإن كنت أتصور أنه لا ازدهار للشأن الثقافي في الجزائر ما لم يَقُدْه المفرنسون. فهي الفئة الوحيدة التي تخَرَّج منها مناضلون حقيقيون رافضون لكل أشكال العسف. وما على المثقف المعرب إلا واحد من خيارين: إما أن يخوض نضاله تحت لواء المفرنسين، أو يثبت جدارته وهذا بتخلِّيه عن حالة الجبن التي يرتهن لها ويرفض كل أشكال التدجين. وهو الخيار شبه المستحيل في ضوء ما يتوافر من معطيات.
كاتب جزائري.
راضية الشهايبي: تركيبات وهمية
في غياب مشروع ثقافي واضح الرؤى والمنهجية، وفي ظل ما تشهده المؤسسات الثقافية من فقر وتفقير وتقتير وتنقيص في ميزانياتها، ونتيجة لما يتعرض له المثقف العربي من تهميش وتقليل من قيمته ومن دوره في بناء المجتمعات، وأمام ما تلقاه

راضية الشهايبي
الثقافة من تنكُّر من جُلِّ وسائل الإعلام بأنواعها؛ برزت مجموعات أو جمعيات ثقافية في أغلبها تكاد تكون تركيبة وهمية يشرف عليها دخلاء لا علاقة لهم بالثقافة لتحقيق أغراض شتى والحصول على تمويلات وتبرعات. فتدور مناسباتها من دون برمجة مسبقة ومن دون أهداف دقيقة وبانفصال عما يدور حولها، وبانقطاع عن باقي مؤسسات الدولة. وتستمر تلك المجموعات في التجارة بالثقافة من دون فعل ثقافي حقيقي ومن دون رقابة صارمة ومتواصلة من طرف المؤسسات الثقافية، وهو ما جعل المثقف الحقيقي يتوارى في فردانيته ويتمادى في عزلته، وذلك في غياب تام لجماعات ثقافية منظمة لها طرائقها في استثمار هذه الطاقات الثقافية بما يعود بالتأثير الإيجابي في بناء الشخصية العربية وتطويرها نحو الأفضل.
يحتاج عالمنا العربي أكثر من أي وقت مضى إلى جماعات ثقافية واعية بما تمر به الشعوب من اختلال نفسي واقتصادي وثقافي، وعاقدة العزم على الضغط بشتى السبل على الحكومات؛ كي تدعمها وتنخرط معها في شراكة حقيقية لوضع إستراتيجيات يمكن تحقيقها على أرض الواقع، وعلى الحكومات أن تشرك هذه الجماعات في صنع القرار الثقافي؛ إذ يمكنها تقديم الكثير من خلال طرح نقد حقيقي للواقع وإعطاء البدائل واقتراح السبل، ولا سبيل للنجاة إلا بجماعات ثقافية حقيقية تتكون من خيرة مثقفي كل بلد، وأن تكون منظمة ومهيكلة على أسس قانونية وإدارية، ولها مشاريعها على المَدَيَيْنِ القصير والطويل، وتعمل على نشر الثقافة والانفتاح على المؤسسات التعليمية، وإشراك الشباب في الثقافي الجماعي.
شاعرة تونسية.
علي عطا: مصالح شخصية

علي عطا
هل توجد في مصر جماعات ضغط ثقافية فيما يتعلق بالضغط من أجل الصالح العام؟ ونعم أيضًا فيما يخص الابتزاز لأغراض شخصية أو شِلَليَّة. لكن هذا التحديد ليس جامعًا مانعًا، بما أن السائد هو اختلاط الحابل بالنابل في ظل غيوم كثيفة تكتنف الجو العام في مصر منذ 25 يناير 2011م حتى الآن. ومع ذلك، ألاحظ أن الضغط من أجل بلوغ مصالح شخصية هو الغالب، وهو يُراوِح بين النعومة والفظاظة، ويمارسه بعض أصحاب دُور النشر، ومنهم مثلًا واحد وجدناه ضمن رؤوس اعتصام وزارة الثقافة الشهير في منتصف 2013م، فبمجرد أن لاحت بوادر نهاية حكم الإخوان المسلمين، وبات شبه مضمون، أن يعود رئيس هيئة الكتاب المقال إلى منصبه فيستأنف الحصول على مكافآت مالية نظير إعادة نشر بعض إصداراته في مشروع «مكتبة الأسرة»، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، فسرعان ما تجمد مشروع مكتبة الأسرة لجفاف منابع تمويله.
هذا الناشر وشلته التي ارتبطت به لم يتوقف عن الضغط، استنادًا من قبل إلى معارضة شكلية للنظام، ثم الادعاء باحتضان ثورة 25 يناير وشبابها، وركوب موجة 30 يونيو التي ادّعت الشلة إياها أنها كانت وَقُودَها، ومن ثم زعمت أنها صاحبة الفضل في إزاحة الإخوان من الحكم، وإعادة الوزير صابر عرب الذي لم يتأخر في تلبية طلبهم، وتنظيم مؤتمر حاشد بالمجلس الأعلى للثقافة ليحددوا فيه أولويات المرحلة الجديدة، بما فيها من جوائز ومناصب. وما إن لاحت فرصة لتعديل وزاري حتى انبروا في الهجوم على الأسماء المرشحة من خارج دائرة نفوذهم، وتلميع أسماء أخرى محسوبة على تلك الدائرة لضمان استمرار المكاسب الشخصية وليذهب الصالح العام إلى الجحيم.
هؤلاء وغيرهم ممن يشكلون جماعات ضغط ثقافية باتوا منتشرين في مواقع صحافية وعبر الفيسبوك، وضغطهم تجاوز المؤسسة الثقافية الرسمية ليطاول مجالس أمناء الجوائز ولجان تحكيمها داخل مصر وخارجها، جريًا دائمًا وراء مكاسب شخصية بعضها يحسب قيمته المادية بملايين الجنيهات.
كاتب مصري.
أحمد فاضل: التحكم في المشهد الثقافي
لا يخفى على كل مهتم بالثقافة دور جماعات الضغط التي ترفع شعارها بتأثيرها الكبير فيها سواء أكان ذلك على المستويين المحلي أو الخارجي. وقد عرفت هذه الجماعات طريقها ليس على الواقع الثقافي فحسب بل على فروع أخرى بحسب أهميتها، وهي الآن من أهم وأكثر التكتلات البشرية التي تؤثر في سياسات المؤسسات والشركات حتى على السياسات العامة لدول كثيرة، ما يهمنا هنا هو هذه الأيديولوجيات والأفكار التي يحملونها، وغايتهم الحفاظ على مراكزهم وتمرير سياساتهم لتثبيت منافعهم الشخصية، مع تقديمهم للقليل من المنجزات إن وجدت ذرًّا للعيون، وهؤلاء تدفعهم انتماءاتهم الحزبية والطائفية، ويتحكمون بقوة في المشهد الثقافي على الرغم من وجود هيئات ومنظمات أدبية مستقلة تعمل بجهد استثنائي وبإمكانات خجولة غايتها خدمة الثقافة والمثقفين.
كاتب عراقي.

محمود خيرالله
محمود خيرالله: عواطلية الثقافة
في مصر لدينا مجموعتان ممن يُمكن أن نطلق عليهم «عواطلية الثقافة» -لا جماعات ضغط، والفارق بين الأمرين كبير- المجموعة الأولى حفنة من الأدباء المنضوين -بإرادتهم الحرة- تحت لافتة «أدباء الأقاليم»، وتتلخص حركتهم في الداخل المصري، بين مؤتمرات شهرية وأخرى سنوية، تقام ضمن أنشطة «الثقافة الجماهيرية»، وهؤلاء مدعوون دائمًا للمشاركة في كل «مؤتمر أدباء أقاليم»، وهم أنفسهم من يُكَرَّمُون فيه سنويًّا، تحت أسماء مختلفة، حيث يقام المؤتمر في محافظة مختلفة سنويًّا، وهي فرصة ليتبادل الجميع الكراسي والنياشين والعطايا ذاتها، وهم فئة من الموهوبين في «النشر الإقليمي» -مشروع «نشر محدود» يقوم بطباعة نحو 500 نسخة من كل عمل أدبي «رواية أو ديوان شعر أو مجموعة قصصية» لأديب إقليمي متميز- كما أنهم أصحاب أيادٍ طولى في مشاريع النشر التابعة لوزارة الثقافة، ستجدهم أيضًا نافذين في مشروع النشر في الهيئة المصرية العامة للكتاب، ولعلك ستطالع أسماء بعضهم، في أول الصفوف في ندوات «معرض القاهرة الدولي للكتاب»، بين شاعر وقاص وناقد، وبات عندنا أيضًا داخل هذه الفئة ما يمكن أن نسميه ظاهرة «الناقد الإقليمي»، على الرغم من أن مواهبهم جميعًا محدودة، وهؤلاء هم الفئة الأولى من «العواطلية». أما المجموعة الثانية، فهي تلك الفئة من الشعراء، التي وُلِدتْ فجأة، من «فتات مائدة» شاعر كبير وشهير إبان معركته التي لا تنتهي، مع قصيدة النثر، إنهم يحصدون جوائز الدولة التشجيعية في الشعر لمجرد أنهم يقلدون قصيدته، إنهم يحصدون السفريات ويستطيعون الوصول إلى «منح التفرغ» وغيرها، إنهم لا يظهرون سوى في المناسبات التي تتطلَّب وجود منشدين وكومبارس.
كاتب مصري.
بسمة الخطيب: شلل متشابكة

بسمة الخطيب
واجهت النخب الثقافية التنويرية العربية ظروفًا صعبة، على مدار تاريخها، أجبرت غالبيتها على الهجرة، ولم يبقَ سوى قلة تقاوم وتناهض يُراوِح مصيرها بين التهميش والسجون، وهو ما حال دون أن تلعب النخب دورها التنويري الطليعي في توعية الرأي العام وقيادته نحو حلول عملية فعَّالة لمشاكله الاجتماعية والسياسية والثقافية، ومساعدته في الانخراط المباشر في معالجة قضاياه. غياب النخب الثقافية خلف فراغًا ملأته الشلل المتشابكة المصالح، فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين السلطة من جهة ثانية… وأنا أتوقّع أن تتمكن النخب الثقافية المهاجرة أو تلك المحبطة من إعادة بناء نفسها، وبناء خطابها لتتصدى لتلك الشلل الانتهازية المرتهنة بمصلحة السلطة وليس بمصلحة المجتمع.
كاتبة لبنانية.
شربل داغر: حملات فيسبوكية
لا يمكن للجواب أن يتوافر بصورة سليمة إلا إذا توقفنا عند مسألة «الشرعية» في بلادنا ومجتمعاتنا، من جهة، وعند مسألة العلاقات بين الدول والمجتمعات، من جهة ثانية. فما ينظم حياتنا الوطنية والثقافية محكوم بقوانين وأعراف وسلوكيات لا يمكن القول فيها إنها تقر بقيام «جماعات ضغط»، في أي شأن كان، ولا في الثقافي نفسه. فكثير من الحكومات لا يقرُّ بأن يكون لغيره من قوى المجتمع وتشكلاته فعلٌ مباشر على قوى المجتمع نفسها وعلى معتقداتها ومواقفها. فالحكم يعمل، في أحوال كثيرة، على التحكم التام بأي حراك في المجتمع، بما فيه نشوء جمعية أو نادٍ في قرية بعيدة… هذا لا يمنع أن هناك جمعيات نشأت بصور ملتوية أو مقرة في أحوال معدودة، وأنها تقوم بأدوار ومبادرات نشطة وحيوية، من دون أن نحسن قياس فاعليتها وتأثيرها. وهي جمعيات لا تجد عونًا لها عند قيامها، لا من السلطة ولا من غيرها. يضاف إلى ذلك أن هذه الجمعيات –إن نعمت بدعم مادي من خارج مجتمعاتها– تُتهم سلفًا بالخيانة والتبعية وغيرها من التهم الشنيعة والقاتلة.
قد يُفسر كلامي هذا على أنه «يختصر» العلاقة في المسألة المطروحة بين قوى في المجتمع وبين السلطة الحاكمة، فيما أعتقد أن العلاقة واقعة أيضًا بين هيئات المجتمع وأفراده أنفسهم. فانفصال أفراد عن بيئتهم وجماعاتهم، وانضمامهم الحر والطوعي إلى جمعيات خارج الولاءات المتبعة، ليس بالأمر المقبول في التقاليد والأعراف الاجتماعية، وهو ما يجعل منهم جمعيات «نخبوية» جدًّا ومن ثم ضعيفة التواصل مع بيئاتها.
لهذا فإنني أعتقد أن انتظام وسائل التواصل الاجتماعي قد يعوِّض ويحلُّ محل «جماعات الضغط» المذكورة. وهو ما يلحظه المتابع من قيام «مجموعات ضغط» تلتقي في هذا الشأن أو ذاك، من دون أن تحتاج إلى رخصة (التي تصدرها وزارة الداخلية وحدها)، أو إلى اجتماع (المهدد بعدم قيامه)، أو إلى ميزانية وتمويل وغيرها… هذه الحملات «الفايسبوكية» التلقائية أظهرت بعض الجدوى والفاعلية، إلا أنها لا تعوض بأي حال عن تفتح المجتمعات بقواها الحيوية وإبداعية أفرادها، وباندفاعهم صوب ما يرونه صالحًا وحيويًّا ومنشطًا لبلادهم ومجتمعاتها.
شاعر ومترجم وناقد لبناني.
رفعت سلام: أمراض الوسط الثقافي
حين عُيِّن الشاعر فتحي عبدالسميع رئيسًا لتحرير إحدى سلاسل الهيئة العامة للكتاب هاجم تعيينه مجموعةٌ من المثقفين، فأجَّل رئيس الهيئة تسليمه مهام عمله شهورًا عدة بسبب دعاوى غير صحيحة، وهذا مثال للدور السلبي الذي من الممكن أن تلعبه جماعات الضغط الثقافي، وهو ما ترتَّب عليه توقف السلسلة وليس استبدال رئيس التحرير. على الجانب الآخر، حين يتحدث الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل عن قضية عامة ويتنادى المثقفون لاتخاذ موقف ما، فإن السلطة تتراجع عنه، كما حدث مع مشروع قانون إهانة الرموز التاريخية.
ويمكننا القول: إن الحالة الثانية هي مثال للضغوط الإيجابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يجبر الصحافة المكتوبة على اتخاذ الموقف نفسه الذي تبنَّاه الفيسبوك وغيره، أما النوع الأول فهو مثال للشِّلَلِيَّة وأمراض الوسط الثقافي والجماعات الصغيرة التي تبحث عن التساند من أجل المصالح، وهؤلاء أخذوا شكل الجماعات القديمة سواء «أصوات» أو «إضاءة» أو غيرهما، وأفرغوهم من المضمون الذي كان يقوم بالأساس على أن هناك مشروعًا شعريًّا أو إبداعيًّا، وأنه للدفع بهذا المشروع إلى الواقع الثقافي كي يحتل مكانه اللائق فلا بد من تكوُّنِ جماعة ضغط ثقافي، وبمجرد أن يتحقق الهدف الثقافي من هذه المجموعة فإنها تنتهي؛ لأن ما جَمَعَها هو هدف ثقافي.
أما جماعات المصالح الراهنة فإن ما يجمعها ليس الشأن الثقافي، ولكن المصالح الصغيرة، وبالتالي لا نجد منذ سنوات مشروعًا إبداعيًّا لجماعة من المبدعين، وإنما كلها جهود فردية، أما التجمع فإنه يتم على أساس سياسي وشِلَلِي، نحن نتساند على أساس النمط الثقافي، ليس لتحقيق هدف ثقافي، ولكن لتحقيق حماية لأفراد ومصالح الشِّلَّة، وإذا ما حاولت شِلَّة أخرى الهجوم على أحد، فإن الجميع يرد عليها، فأصبحت الحياة الثقافية أقرب لأن تكون ميليشيات إنكشارية، وليست جماعات تدافع عن مشاريع ثقافية عامة.
شاعر مصري.
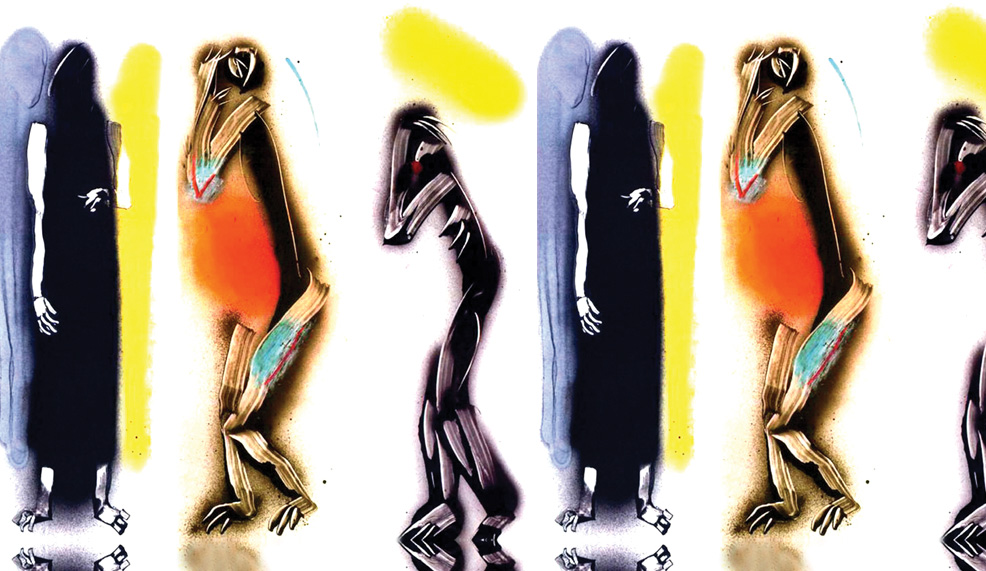
بواسطة صبحي موسي - صحافي مصري | سبتمبر 3, 2018 | تشكيل, فنون
الذين يعرفون الفنان التشكيلي عمر جهان يدركون كم يعيش حياة الراهب في صومعة الفن، كانت شقته بحي الدقي بمنزلة مركز ثقافي متعدد الأنشطة، بدءًا من اجتماعات شعراء جماعة إضاءة (حلمي سالم، وجمال القصاص، ورفعت سلام، ومحمد عيد إبراهيم وغيرهم)، وصولًا إلى لقاءات الفنانين التشكيليين المصريين في صومعته، تلك التي تعرفها من على الباب، حيث الرسومات التي تستقبلك عليه، والدلاية التي تهتز بمجرد أن يفتح الباب ويطل عليك بلحيته الطويلة بعض الشيء، وشعره المنفوش دائمًا، وابتسامته الوديعة كصوفي في محراب، ما أن تدخل بأقدامك حتى تصدم بتماثيل من الخردة القديمة التي أحالها إلى حالات فنية مدهشة، ووجوه إفريقية استعارها من الصحراء الليبية كي تكون جزءًا من عالمه في القاهرة، ستجد الحوائط وقد تحولت إلى معرض استعادي كبير لكل أعماله، وتجد الأرضيات بمنزلة ورشة مليئة بالجرائد والأوراق الكوشيه البيضاء التي يجري عليها تجاربه، ستجد الألوان المائية والأحبار بمختلف ألوانها أمامك، ستجد نفسك تندفع لتصبح فنانًا تشكيليًّا على غرار عمر جهان في طريقته في الحياة والفن.

عمر جهان
لم يكن عمر مجرد فنان حط رحاله في القاهرة، لكنه كان ظاهرة تشكيلية تبث الروح الإيجابية في كل من حولها، تمدهم بالأفكار والمعارف، وتحيل طاقة الغضب لديك إلى سخرية عارمة من كل شيء. جاء إلى المحروسة في منتصف السبعينيات، ورحل عنها عقب رحيل القذافي عن ليبيا، عاد إلى مسقط رأسه مصراتة، لكنه ما زال بروحه في مصر مع أهلها وفنانيها ومثقفيها، حتى الآن لا يبدو أنه قادر على التأقلم مع واقعه الجديد. في هذا الحوار مع «الفيصل» نتعرف مع صاحب معارض «أقنعة»، و«كهفيات»، و«الحبر والشمع» و«لوبيات»، على محطات في تجربته، وعلى سؤال الفن وما يعنيه بالنسبة له، وكيف يتعايش الفنان المغترب بداخله مع الوطن الذي تركه أربعين عامًا ثم عاد إليه.
● بعد سبعة وثلاثين عامًا من الإقامة في القاهرة؛ كيف تفاعل الفنان التشكيلي مع واقعه الجديد؟
■ بعد سبع وثلاثين سنة زمن الإقامة في القاهرة بعيدًا من وطن أراد له الطغاة طمس اسمه الجميل رسمًا ولفظًا… ليبيا… ها أنذا أجرّب العودة إلى البيت وأرسم منذ انتفاضة السابع عشر من فبراير عام 2011م، رسوماتي المتواترة تحت عنوان واحد: «قريبًا سيكون لنا وطن»؛ لأن الطريق إلى الحرية أطول من الطريق إلى الثورة؛ ولأن الطريق إلى الوطن الذي ينعم فيه الإنسان بالعدل والمساواة والتحرر الاجتماعي لا يزال شاقًّا وطويلًا، ربما يومئ هذا المعنى إلى ما رسمته في بعض الأعمال كاللوحتين اللتين أشارك بهما في المعرض المقام بقاعة المريخية بدولة قطر وبدعوة نبيلة من المشرفين على المعرض. لوحتان لا تعبران عن الفرحة العارمة في الشوارع والميادين الليبية، لكنهما يوحيان ويشيران إلى تذكر العذاب والسلوى لمعاناة الليبيين شيبًا وشبابًا رجالًا ونساءً وأطفالًا. حاولت اختزال ما لا يمكن اختزاله من عذابات واستحضار آلامهم وآمالهم وهم يرزحون تحت نير الطغيان، ويقاومون العسف والجور، ويصنعون مستقبلهم الذي كان غامضًا ومجهولًا متطلعين إلى شمسهم؛ وطنهم ليبيا الذي قد تغرب شمسه لكن سرعان ما تُشرق من جديد.
تجدني أحاول أن أمزج بين أقنعة إفريقية مجهولة ورسومات خارجة من كهوف تادرارت أكاكوس إلى جانب الأسطح الخشنة في رسوماتي المسماة «سراب الرمل» كأني أحاول الابتعاد من لغتي القديمة دونما جدوى، كأني أحاول الانفلات من لوحات الأقنعة وكهفيات والحبر والشمع ولوبيات، أظن أن المسألة تحتاج إلى تجارب جديدة، وسفر آخر، ورئات أخرى، وأفق مفتوح؛ لذلك حاولت ألا أقف عند الرصد، رصد العلاقة بين الجزء والكل، بين القديم والجديد، بين الواقع والخيال، بل جرّبت أن أعقد مزاوجة تتحرك بين طرفين مختلفين: ثقيل، خفيف. تجريد، تشخيص. لوحتي سيرة ذاتية لا تستدعي خرافة ما، ولا تذهب إليها حيثما تكون بل تحاول أن تخلق ذاكرتها البصرية عن طريق اللعب على مستويين: مستوى الرؤية الذي يتبنى الحذف والمحو والنسيان. ومستوى البديهة الذي يتبنى الاختراق إلى الداخل، الاختراق النزق لحاجز سكونية العقل وصرامة المنطق. كان الفشل حليفي في كثير من الأعمال وصادفت نجاحًا ولياقة فنية في بعض منها. ستظل تجربتي المتواضعة، هي منفاي الاختياري وثورتي الخاصة لمعانقة الزمن الآتي رفضًا للاستعباد. وسيظل فعل التحرر متجددًا لأنّ القيود والعوائق الموروثة، أوسع من مفهوم السلطة والمؤسسة، وسيظل السؤال الذي يشير إلى استكناه علاقة الفن بالواقع الطبيعي والسياسي والاجتماعي والتاريخي قائمًا؛ لأنه يستدعي مناخًا عامًّا لا ينفصل فيه البحث في وحدة الشيء المرئي، وعلاقة الكل بالجزء وصياغات العناصر الفنية عن البحث في حرية الفنان وعلاقاته بوصفه كائنًا اجتماعيًّا بالسلطات العامة: النقاد، وتجار الفن، وقبل ذلك وبعده صلة الفنان بالمتلقِّي والجمهور، وستظل الصورة أخطر في تأثيرها في شخصية الإنسان وثقافته، وأعمق مما يتصور رجالات التربية والمشتغلون بعلم النفس والسياسيون، واللوحة في شتى تحولاتها لا تستمد قيمتها من كونها جميلة شكلًا أو عميقة موضوعًا، إنما تستمد قيمتها من ذلك المخزون المعرفي والأرشيف النفسي الممزوجين بالتقنية. قيمة فنية لا يمكن الوصول إليها بواسطة ما عداها. لكن كيف يتمثل الفنان مصادره البصرية، ويجعلها تمر من فلتر الروح وتفك شفرة الإحساس، وتعيد إنتاج الإدراك؟ ليس لديّ إجابات خارج العمل الفني.
الأزمة ليست فنية فقط
● كيف ترى مسيرة الفن في ليبيا الآن؟
 ■ قافلة الأدب والفن في ليبيا تسير، والأزمة الفنية ليست فنية فقط. إن عقلية متحجرة أفرزت منظومة من القوانين والآراء النمطية المضادة للتجديد والابتكار، كانت الثقافة في ليبيا تحت وطأة النظام الدكتاتوري مصابة بعطبين لا براءَ منهما: أولهما أسبقية الأيديولوجيا الزائفة عن الثقافة، وثانيهما غياب مفهوم التساوق داخل الحركة الثقافية ذاتها.
■ قافلة الأدب والفن في ليبيا تسير، والأزمة الفنية ليست فنية فقط. إن عقلية متحجرة أفرزت منظومة من القوانين والآراء النمطية المضادة للتجديد والابتكار، كانت الثقافة في ليبيا تحت وطأة النظام الدكتاتوري مصابة بعطبين لا براءَ منهما: أولهما أسبقية الأيديولوجيا الزائفة عن الثقافة، وثانيهما غياب مفهوم التساوق داخل الحركة الثقافية ذاتها.
● الواقع السياسي الليبي، متى سيتكشف عن دولة مدنية؟
■ الطريق إلى تكوين دولة مدنية في ليبيا طويل دونه خرط القتاد، وهذا القتاد المعادي للدولة المدنية قوامه ثلاث فئات لكل منها ثقافتها المتجذرة في النسيج الاجتماعي والواقع المعيش بنسب متفاوتة، الفئة الأولى: أتباع النظام الدكتاتوري السابق، والفئة الثانية: المنحرفون اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، أولئك الوالغون في المال العام والدم الحرام والأفكار القبلية والجهوية، أما الفئة الثالثة فهي: الجماعات الدينية المتشددة، تجد الفئات الثلاث متفرقة كما تجدها متحالفة. لقد عانينا التشوهات التي صنعتها السلطة الدكتاتورية ببلادنا ليس في نفسية الشعب المقهور فحسب بل في النسيج النفسي لأولئك السلطويين أنفسهم… إذ يفقد الواحد منهم شروطه الإنسانية شيئًا فشيئًا منقلبًا إلى ما يُشبه الآلة الباردة الصلدة، والانسان كما نعتقد أيًّا كان أشرف وأقدس من أن يتحول إلى مجرد شيء استعمالي تافه.
● هل توجد حركة ثقافية فاعلة في مدينة مصراتة التي تقيم بها الآن؟
■ هناك بعض الأنشطة المتناثرة، المتكلسة على مستويين: أولهما المستوى الرسمي المحكوم بالشللية والموسمية ومنظومة الفساد القديمة، أما المستوى الثاني فيظهر بين الحين والآخر في صورة مقاولات، ويتصف العمل فيه بالقطعة وبالجملة أيضًا. لا تعرف له مكانًا محددًا وفي الأغلب يكون الوكلاء القائمون عليه في الظل ولا يظهرون في الصورة. هناك مستوى ثالث مأمول يجتهد في وضع آليات يتلافى بها العيوب، ويؤسس لبنية تحتية للثقافة تعالج تلك الأمراض الموروثة، هذا المستوى الثالث من دون المستويين السابقين، وهو المستوى المجهض دائمًا وباستمرار. ومن هنا يجب أن نوضح أن الحرب ليست بالسلاح فقط، ولا بد من مواجهة ثقافة العنصرية والجهوية والتعصب.. ثقافة المؤتمرات واللجان والميليشيات.
● في هذا الوضع، علامَ يمكن المراهنة؛ على اتحاد للفنانين التشكيليين أم على ميليشية تشكيلية؟
■ أتمنى أن أشاهد اتحاد التشكيليين في مصراتة وقد أصبح فرعًا من اتحاد التشكيليين الليبيين، وصار له مقر دائم وجمعية عمومية وانتخابات ولائحة داخلية وآليات أخرى تنظم العمل وتساهم في فعاليات ثقافية، وذلك من أجل الأهداف البعيدة لنشر الثقافة البصرية وإثراء الحركة التشكيلية نقدًا وإنتاجًا وتذوقًا، والمساهمة في تفكيك وبناء العلاقة الملتبسة بين الفن والمؤسسة الدينية والسياسية والاقتصادية المتمثلة في آليات السوق ورأس المال… بدلًا من الاكتفاء بصفحة افتراضية أو اجتماعات شللية على قارعة طريق فرعي أو مقهى (مُنزَوٍ) واجترار معارك دنكيشوتية وأحقاد صغيرة لا تؤدي إلا إلى شيء واحد كريه… أتمنى أن أرى مؤسسة تنشر رسالة الفن والحب والسلام بدلًا من ميليشيات الثقافة المستشرية كالتقرحات والدمامل داخل الجسد الليبي العليل وعلى سطحه. أو كما قيل: الفن لن ينقذ العالم… الفن في العالم يجب إنقاذه.
 ● لمَ لم ترسم للأطفال؟
● لمَ لم ترسم للأطفال؟
■ في تصوري كثير من أعمال بعض الفنانين تلائم مخيلة الأطفال، فيستجيبون لها ويستمتعون بها، وإن لم ترسم لهم مباشرة أعمال بول كلي مثلًا وبعض أعمال خوان ميرو، وأغلب رسومات الفنانين التلقائيين، وكثير من رسومات جورج البهجوري.. أما أنا فقد ظل هاجس الرسم للأطفال يراودني ويقضّ مضجعي خلال تجربة «كهفيات» و«الحبر والشمع»، وأيضًا في مجموعة «موتيفات عابرة» لكنني لم أقدم على هذه التجربة الصعبة مباشرة، وتركتها تتسلل وتسري في كثير من أعمالي دونما قصدية مباشرة، وأنا أزعم أن أعمالي تنهل من ثلاثة مصادر رئيسية: رسومات الكهوف وغريزة اللعب عند الأطفال، والطبيعة التي تحب التخفي بلغة هيدغر، والشعر بوصفه تأسيسًا وتشكيلًا، لا توصيفًا وتعبيرًا.
وفيما أظن أن بعض أعمالي وبخاصة «كهفيات» و«الحبر والشمع» كانت مثيرة لدهشة الأطفال الذين شاهدوها. أتمنى للأطفال أن يظلوا أطفالًا، لكي تظل الوعود التي أعيشها في طفولتي، هي ذاتي الأخرى الغامضة التي تمنحني اللوحة وتهبني الدلالة والرمز.

بواسطة صبحي موسي - صحافي مصري | يوليو 1, 2018 | تحقيقات
نشأ مصطلح أدباء المهجر في القرنين التاسع عشر والعشرين، عندما هاجر كثير من الشوام إلى الأميركتين، ولمعت أسماء كتاب عاشوا وكتبوا وتكيفوا مع أحوال وثقافات البلدان التي هاجروا إليها. وكانت أغلبية المهاجرين وقتها تسعى إلى تنفس الحرية في بلدان العالم الجديد، هربًا من قسوة القبضة التركية على بلدانهم. كان ذلك في الماضي البعيد، لكن لاحقًا بعد عقود وبسبب الأنظمة السياسية هذه المرة، فر عدد كبير من الأدباء والمثقفين إلى المنفى بحثًا عن الحرية وأيضًا سعيًا إلى حياة كريمة من ناحية العيش. مرحلة أخرى، شهدت هجرة أدباء ومثقفين عرب كانت في أعقاب ثورات الربيع العربي، بعد أن ظهرت على السطح ميليشيات راديكالية في مختلف تنظيماتها وتحالفاتها. ليعاود مصطلح «أدباء المهجر» إلى الظهور من جديد. أدباء وكتاب ومثقفون يعيشون اليوم في أوربا وأميركا وسواهما من بلدان العالم، باحثين عن فرص أفضل للحياة والحرية والأمن، ناظرين بأعين دامية إلى بلدانهم غير المستقرة على الجانب الآخر من البحر المتوسط، فكيف يعيشون؟ وكيف ينظرون إلى ما جرى في بلدانهم؟ وما الذي يحلمون به؟ وكيف اندمجوا في الثقافات الجديدة؟ تساؤلات تطرحها «الفيصل» ويجيب عنها عدد من هؤلاء المهاجرين.
وليد خليفة: باريس لا تتسع لمبدعيها فكيف بالغرباء؟

وليد خليفة
هي ليست نفسها، باريس كما رأيتها في أغاني، جاك بريل، وأديت بياف، وسيرج غينسبور، ولا تلك التي قرأتها في قصائد بودلير ورامبو وجاك بريفير، ولا تلك التي لمستها في كتابات زولا وهوغو وكامو وسارتر ورفيقته سيمون، ولا تلك التي مر فيها طه حسين وتوفيق الحكيم وعاش فيها هنري ميلر وهمنغواي؛ إنها صورة عن ذلك الزمن الذي كلما نطقت اسم باريس بالفرنسية كما ينطقها أهلها تراءت لك التي لا تشبه ما هي عليه الآن، التي يتقاسم واجهات مكتباتها ومقاهي سان جيرمان دي بري وسان ميشيل، فيها برنار هنري ليفي ومرافقوه من أدباء يلبسون نظارات السياسة ويخلطون الفلسفة بالحروب.
إذا كانت حال باريس للفرنسيين على ذلك النحو الذي وصفه ألبير كامو «كل شيء يبدو غريبًا لي، كل شيء، لا شخص يبدو قريبًا بالانتماء إليّ، لا مكان يبرئ كل هذه الجروح؛ ما الذي أفعله هنا؟ ما جدوى هذه الابتسامات وهذه الإيماءات؟ أنا لست من هنا ولا من مكان آخر، أصبح العالم بأكمله مكانًا يتكئ فيه قلبي على عدم، على اللاشيء»، فكيف تكون الحال بكاتب العربية، لعلنا نعثر في شوارعها على الروائي السعودي أحمد أبو دهمان، أو على المصري يحيى إبراهيم، أو السوري أدونيس، أو الجزائري واسيني الأعرج، لكنها أسماء غريبة على المدينة وأهلها، وإذا استثنينا السوري أدونيس، فلن نجد أثرًا للآخرين، الأدباء العرب المقيمون في المهجر الفرنسي، الهاربون من أهوال بلدانهم ليسوا أكثر من عابرين في مكان لا يتسع لمبدعيه فكيف بحالها مع الغريب. ثمة حالة للأسماء العربية التي تكتب بالفرنسية، حالة تترسخ كل يوم بعلو قامة، يحضر هنا أسماء مثل: كمال داوود، وياسمينة خضرا وبو علام صنصال وأمين معلوف، وأمام لمعان مثل هذه الأسماء تبهت أسماء كتاب العربية باللغة الأم مثل خفوت أنوار المراكز والمعاهد الثقافية العربية التي هي واجهات بلا مضامين كما حال معهد العالم العربي الذي يتحول رويدًا رويدًا إلى متحف للعجائز وعلاقاتهم العامة ويغادرها جمهورها المفترض نحو واحات لا تحتاج توصية الآباء.
ما زال الإبداع العربي الباريسي في مرحلة الأبوة، فرض الأبوة على القارئ، مفاهيم الولاء للزعيم والشلّة، ما زالت المراكز العربية ودور النشر القليلة والمهملة من جمهور القراء والتابعة في أغلبيتها لعواصم التأثير السياسي والمرتهنة للصراعات السياسية بين العواصم العربية والإقليمية، حالها كحال المبدعين العرب، ما زالت تراهن على منطق أزمنة أصبحت في متاحف الزمن، ما زالت وما زالوا يصرون على استعادة البرهة التي مضت، وهنا لا يبقى إلا أمثال كمال داوود وبو علام صنصال الذين لم يجدوا بعدُ طريقهم إلى الترجمة باللغة التي يفكرون بها ولا يتقنون الكتابة بها، هكذا يعبر داوود في جلسات خاصة: إنها اللغة التي سمعت أبي يصلي بها، فيما يقترح صنصال على الفرنسية حميميةً لم تخطر على بال بودلير. ثمة فقر في المكتبة العربية في فرنسا، فقر مدقع لا يوازيه إلا فقر الخيال في المشهد الإبداعي بالعربية هنا الآن، وفقر ضواحي العرب حول المدن الفرنسية، حيث أحزمة الفقر التي تنطق بعربية مكسرة تصرخ فيهم زعيمة اليمين الفرنسي، مارين لوبان: عودوا إلى بلادكم.
شاعر وكاتب سوري مقيم في فرنسا.
محمد ميلود غرافي: أنا مندمج ومتوازن

محمد ميلود غرافي
يتوقف الاندماج في ثقافة عن أخرى على المعنى الذي نعطيه لمصطلح اندماج. فهو مصطلح يحرق الرأس كثيرًا في بلاد المهجر، لأن كل الناس من سياسيين وغير سياسيين، ديمقراطيين وعنصريين، يرددونه كلما دار الحديث عن وضعية العرب والمسلمين في أوربا، وكل طرف يضع في الكلمة ما شاء من محتوى توجهه السياسي. بكل بساطة إذا كان المقصود بالاندماج هو أن يعيش المرء حياته في المهجر في احترام تام لثقافة وقوانين البلد الذي استضافه فأنا أعتبر نفسي مندمجًا من دون أي عقدة وفي توازن تام مع ثقافتي الأصلية وثقافة البلد الذي أعيش فيه (فرنسا)، مع مرور الوقت، يتكيف المرء مع ثقافة وعادات وطقس بلد المهجر، ربما بشكل متفاوت ومختلف من شخص إلى آخر. أعرف كُتابًا عربًا يعيشون ما يسمونه أزمة الهوية، ولا يكفون عن الشكوى من مسألة الاغتراب.
أعتقد أني شخصيًّا قد تجاوزت هذه المعضلة منذ بداية إقامتي في فرنسا التي دخلتها طالبًا، واخترت الإقامة بها في آخر المطاف، ولعل ذلك راجع إلى أني استوعبت منذ البداية أن أفضل سلاح لمواجهة ما يسمى بالاغتراب هو عدم السقوط في عقدة الذات والدونية أمام الآخر.
أن يعيش الإنسان العربي في أوربا، مهما كانت معتقداته وتوجهاته الثقافية والسياسية، لا يستطيع أن ينكر وهو يقيم المقارنة بين بلده الأصلي وبلده الثاني أن الفرق شاسع جدًّا، وأن العالم العربي في ركود تام، بل في تقهقر تاريخي لا مثيل له. العالم العربي يعيش الآن خارج التاريخ ثقافيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا وتكنولوجيًّا وعلميًّا… حتى إنني أكاد أفقد الأمل في المستقبل، لكني أطمح مع ذلك وآمل أن نخرج رأسنا من المستنقع والرداءة والركود.
شاعر ومترجم مغربي مقيم في فرنسا.
فاتنة الغرة: أكثر التجارب حظًّا السورية والفلسطينية

فاتنة الغرة
أعتقد أننا لو أردنا أن نكون منهجيين أكثر يمكننا أن نضع المثقفين والأدباء في قائمتين؛ قائمة تخص من جاء إلى أوربا قبل الربيع العربي، وقائمة تضم من جاؤوا بعدها، والملاحظ أن أغلبية الذين قدموا قبل الربيع العربي كانت مشاريعهم الثقافية خاصة وذاتية، حيث التقاطع مع الوسط الثقافي الأوربي تقاطع خجول ومقطوع، وقلما تقف على تجربة أسهمت في الحياة الثقافية الأوربية انطلاقًا من ثقافتها العربية، غير أن الذين قدموا بعد ما يسمى الربيع العربي كانوا ذوي حظوظ أوسع، ربما بسبب تركيز العالم على البلدان التي جاؤوا منها؛ بسبب ما يحدث فيها، وما له من تأثيرات في مجرى الحياة الدولية. ولذا ترى أكثر التجارب التي أخذت مكانة في الأوساط الأدبية والثقافية هي تجارب سورية فلسطينية تنوعت بين الشعر والموسيقا والمسرح، سواء هنا في بلجيكا أو غيرها من البلدان الأوربية إلا أن الوجود الأكبر لحركة الشعر السوري تحديدًا تراه في ألمانيا، وذلك بسبب وجود كثير من الأسماء الشعرية الجيدة من أجيال مختلفة، سواء كانوا سوريين أو من فلسطينيِّي سوريا. كما أن الحركة المسرحية والموسيقية العربية في أوربا تحديدًا صار لها روادها الشغوفون بالاطلاع على هذه الثقافة؛ لأنها قادمة إليهم من بلاد ينظرون إليها على أنها في أسفل سلم الحضارة الإنسانية، غير أننا لا نستطيع تجاوز حضور المسرح العراقي في بلجيكا أو في غيرها من البلدان الأوربية، وهو الأمر الذي يشكل امتدادًا لحركة المسرح في العراق، التي تعوض عن وجود الدراما الغائبة عن الحضور العربي، وإن كانت من أول البلدان التي شهدت صناعة الأفلام السينمائية، والحقيقة أنني تعمدت عدم ذكر أي من الأسماء الناشطة في المجال الثقافي لتفادي أي حساسية من أي شخص غفلت عن ذكر اسمه.
كاتبة وصحافية فلسطينية تقيم في بلجيكا.
أحمد يماني: مستويات فردية متفرقة

أحمد يماني
فيما يخص تأثير الثورات العربية في المثقف العربي في إسبانيا تحديدًا فلا بد من الإشارة بداية إلى ندرة النخب الثقافية العربية في إسبانيا، فلا يمكن قياس الحضور الثقافي العربي في إسبانيا بنظيره في فرنسا وإنجلترا وألمانيا على سبيل المثال، وعلى هذا فإن تأثيرًا من هذا النوع لا يمكن قياسه على مستوى جماعي بل على مستويات فردية متفرقة لا تشكل في مجملها حركة بعينها. على أن ثمة ظاهرة يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي عمل بعض الجاليات على تكوين كيانات وتجمعات بعد أن أعادت الثورات العربية صياغة علاقاتها ببلدها الأم، وكما في مثل هذه الأحوال فإن الاستقطابات السياسية أدَّت في النهاية إلى تشرذم تلك التجمعات. يمكن أن يكون هذا الملمح هو الأكثر بروزًا. على مستويات أخرى فردية، ولندرة هذه النخبة المثقفة كما أسلفت، فإن الضوء يصبح مسلطًا بشكل ما على القليلين من فنانين وكتّاب ممن يعيشون في إسبانيا وقد تم الاستعانة ببعض منهم للحديث عن تلك الثورات، سواء في وسائل الإعلام المكتوبة أم المرئية والمسموعة وكذلك في منتديات ولقاءات نظمتها بعض الجامعات والمعاهد والجرائد الكبرى، لكن هذا الانتباه سرعان ما ابتعد بعد سنوات قليلة وعادت النخبة الثقافية لما كانت عليه، أي العمل بشكل فردي. لكن يمكن أن نرى كذلك أن من تأثيرات الثورات العربية حدوث اهتمام نسبي في مجال الترجمة، ترجمة بعض من الأدب العربي إلى الإسبانية، وإن لم يتم الأمر بشكل موسع، لكن هذا أفاد على الأقل في تحريك عجلة الترجمة بشكل ما. أعتقد أن المثقف العربي لم يكن بعيدًا عما يحدث في بلاده وإن كانت المشاركة في الحدث الثوري مختلفة عمن شارك فعليًّا في الحدث، ولكن الكثير ممن يعيشون في الغرب قد شاركوا فعليًّا. وأما ما يتمناه المثقف العربي في الخارج فمثل ما يتمنى المثقف العربي في الداخل، ربما يكون الأمر أكثر إيلامًا لمن يعيش في الغرب، حيث يحيا بنفسه حياة المجتمعات المتقدمة على مستويات عدة منها السياسي والاجتماعي والعلمي والفكري والأدبي والفني، وجل ما يتمناه أن يرى بلاده على تلك المستويات، ولا شك أن الثورات العربية قد منحت أملًا كبيرًا للجميع كي يتحقق كل ذلك.
شاعر ومترجم مصري مقيم في إسبانيا.

هادي الحسيني
هادي الحسيني: أنظر إلى وطني بعيون دامية
البلدان الأوربية توفر كل وسائل العيش الكريم للإنسان ومن ضمنها التعليم والعمل، الناس بمساواة وعدالة ونظام منقطع النظير، لا أحد يموت من الجوع هنا كما في بلداننا العربية! ولا أحد يتميز عن الآخر إلا بمثابرته وتفوقه وإخلاصه للعمل، فتبدو الحياة مملوءة من الفراغ، إن وُجد الفراغ بالنسبة للعاطلين عن العمل الذين تتكفل مكاتب ودوائر البلديات بإيجاد العمل المناسب لهم، أو تصرف لهم رواتب الإعانة الاجتماعية.
شخصيًّا كعراقي أنظر إلى وطني بعيون دامية من منفاي البعيد وأتحسر على فترات السبعينيات الذهبية التي عاشها العراق كأي بلد مستقر ينشد العلم والتطور، لكن بداية الحرب العراقية الإيرانية عام 1980م كانت القشة التي قصمت ظهر البعير! وما زال مسلسل الحروب والموت اليومي المجاني يرافق العراق المذبوح من الوريد إلى الوريد!
الغربة الطويلة متعبة وتفطر القلب لكن على المثقف أن ينخرط ويندمج مع هذه المجتمعات الغربية ما دام يعيش بينهم ومفتاح الدخول لهم والتعرف عليهم هي اللغة، بمجرد أن تعرف اللغة سوف يمكنك أن تحشر أنفك فيما بينهم لتعرف كيف يفكرون وكيف يتعلمون حتى كيف يقرؤون ويأكلون! وقد نجح الكثير من العرب في بلدان الغرب في أوربا وأميركا وغيرها أن يحصلوا على مكانة مرموقة في عالم الأدب بشكل خاص، وقد حصدوا العديد من الجوائز العاليمة، وأنا أحد هؤلاء الذي فازوا بجائزة الشعر العالمية في أميركا قبل سنوات.
اليوم لدينا أدباء وكتاب يكتبون الشعر والرواية والمقالة في لغة البلد الذي يعيشون فيه ويتفوقون على أهل البلد، المثقف العربي من المحيط إلى الخليج لديه إمكانيات فهو مبدع ومتألق في داخل بلده بالرغم من العوز والحاجة لكنه في المنفى يبدع أكثر.
شاعر وكاتب عراقي مقيم في النرويج.
صفاء فتحي: لغة مختلفة وانغماس يائس

صفاء فتحي
ليس هناك نمط واحد لكيفية الوجود فيما تسميه بلاد المهجر، فهو مصطلح قادم من القرن التاسع عشر. شعراء المهجر وما إلى ذلك، كما أنه ليس هناك مهجر واحد. أعتقد أن الاسم ينطبق أكثر على الأميركيتين أكثر مما ينطبق على أوربا. ففيما يخصني أنا أتنقل عمومًا بين عدة بلدان أوربية بشكل منتظم باريس/ مدريد/ برلين. هناك من لا يسافرون وهناك من يسافرون من وقت لآخر وهناك من يعملون في التدريس، في الترجمة، في الصحافة… إلخ. بشكل عام هذه المهن مكملة لمهنة الكتابة التي غالبًا لا تمكّن الكتاب من أكل العيش باعتبارك استخدمت مفردة كيف يعيش! ويصعب الحديث بشكل عام عن الانخراط في الثقافات الجديدة، فالأمر يعتمد على اللغة التي نكتب بها، فمن يكتبون بالعربية فقط أعتقد أنهم يتحركون في أوساط عربية وهي كثيرة في أوربا، ومن يكتبون بلغة الثقافة التي يعيشون فيها بجانب العربية يتحركون في أوساط أكثر اندماجًا مع هذه الثقافات، وعمومًا أعتقد أن هناك حركة خفية، قوية في كثير من الثقافات؛ لأن الدوائر تنغلق ولا تتسع، لأن كل وسط ينفصل عن الآخر، وتظل هناك نقاط تقاطع صغيرة تتمركز عادة حول عملية الترجمة. في فرنسا مثلًا الأكثر انخراطًا هم من كانت اللغة الفرنسية هي اللغة الإدارية لدولهم في أثناء عصور الاحتلال.
للأسف المثقفون السوريون يعيشون في مأساة لا يمكن لها أن تقارن بأخرى، حتى المثقفون العراقيون أو اليمنيون. أما الربيع العربي الساخن! إذا كنا نعني به الثورة في مصر، فأنا شاركت فيها، وكتبت عنها نظريًّا، وكتبت عنها مجموعة شعرية، وصورت أحداثًا عدة في مسارها، منها احتلال التحرير مثلًا 18 يومًا كما أصبح من الدارج تسميته. كما أني سجلت أهم منتوج جمالي لها، ذلك المتمثل في الجداريات. وهذا سؤال إجابته كتاب كامل. ولك أن تسألني: ما هي طموحاتي للمستقبل؟ وهو سؤال غاية في الصعوبة لأنه ينطوي على السؤال الأهم وهو: أي مستقبل؟ إذ إن مستقبلي الشخصي متقاطع ومسكون بمستقبل مصر/ أوربا/ التغير المناخي/ البشرية نفسها التي تمتحن في جوهرها، أي في إمكانية أن يكون لها مستقبل على الإطلاق. هل تعني مشاريع الكتابة؟ عندها من الممكن الرد بنعم، هناك مشاريع للكتابة مختلفة عما كتبت من قبل، بلغة أيضًا مختلفة، وبانغماس يائس.
شاعرة مصرية تقيم في فرنسا.
رزان مغربي: أحلم بجسر ثقافي يكسر صقيع المنفى

رزان مغربي
منذ ما يقارب ثلاثة الأعوام اخترت المنفى، وانضممت إلى عدد كبير من كتاب وصحافيين وفنانين ومثقفين في المهجر كما التسمية القديمة، ولو أني أعترض على كلمة المهجر فهي تنزاح لمعني هجرة اقتصادية، أكثر منها غربة ومنفى، لأسباب لا تخفى عن الجميع، وأعتقد أنه بدأت هذه الموجات من اختيار المنافي لكثير من المبدعين منذ الحرب العراقية، ومن ثم جاءت موجة أخرى للمثقفين والمبدعين السوريين اليوم، وأعتقد أن مكان إقامتي هولندا، فضله العراقيون أكثر من غيره، في حين نجد خارطة الأدباء السوريين، الغالبية، في ألمانيا، ثم السويد وفرنسا وهولندا، أما بقية الجنسيات من اليمن وليبيا ومصر وتونس فهم لا يشكلون جالية أو لنقل أسرة من الكتاب والفنانين بسبب قلة عددهم.
أعتقد أن ملاحظتي الأولى عن الحياة الثقافية في المنافي، وما شعرت به أيضًا، هناك تشكل لجزر ثقافية معزولة نوعًا ما بعضها عن بعض، هناك نشاطات تأسست سابقًا من مثقفين عراقيين لهم نشاطات، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من العلاقات للتعرف عليها. شخصيًّا أتلقى دعوات من الجميع مؤخرًا، ولكني أعتقد أن إقامة الأمسيات من قراءات وموسيقا واحتفاءات صغيرة لن تشكل حياة ثقافية حقيقية.. لهذا كان لدي حلم شخصي وهو إقامة منتدى يصبح مع مرور الزمن شبكة تضم الجميع مستقبلًا، فيها مكتبة كبيرة وأمسيات ثقافية دورية، ومعرض مصغر سنوي، إضافة إلى دار نشر تهتم بترجمة الأعمال من اللغة العربية وإليها، واستضافة الكتاب الذين لا يزالون في الأوطان، وهو ما يسهم في كسر صقيع المنفى، حتى تتصل الجزر الثقافية ببعضها ببعض، فلا بد من بناء جسر جديد يقوم على تبني هذا المشروع، أعتقد أنه يحتاج إلى تمويل ضخم، لكنه حلم.
كاتبة ليبية تقيم في هولندا.
















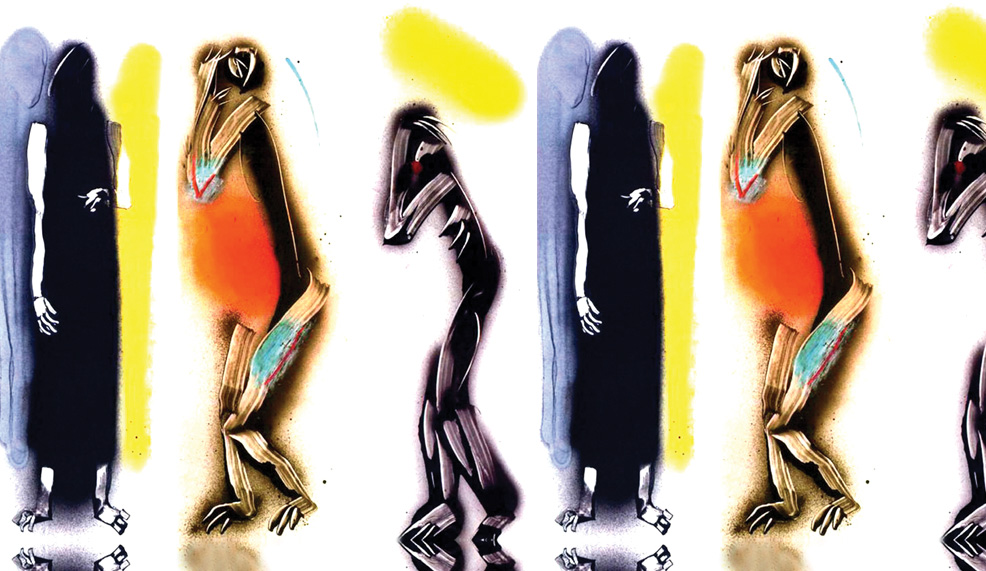

 ■
■








