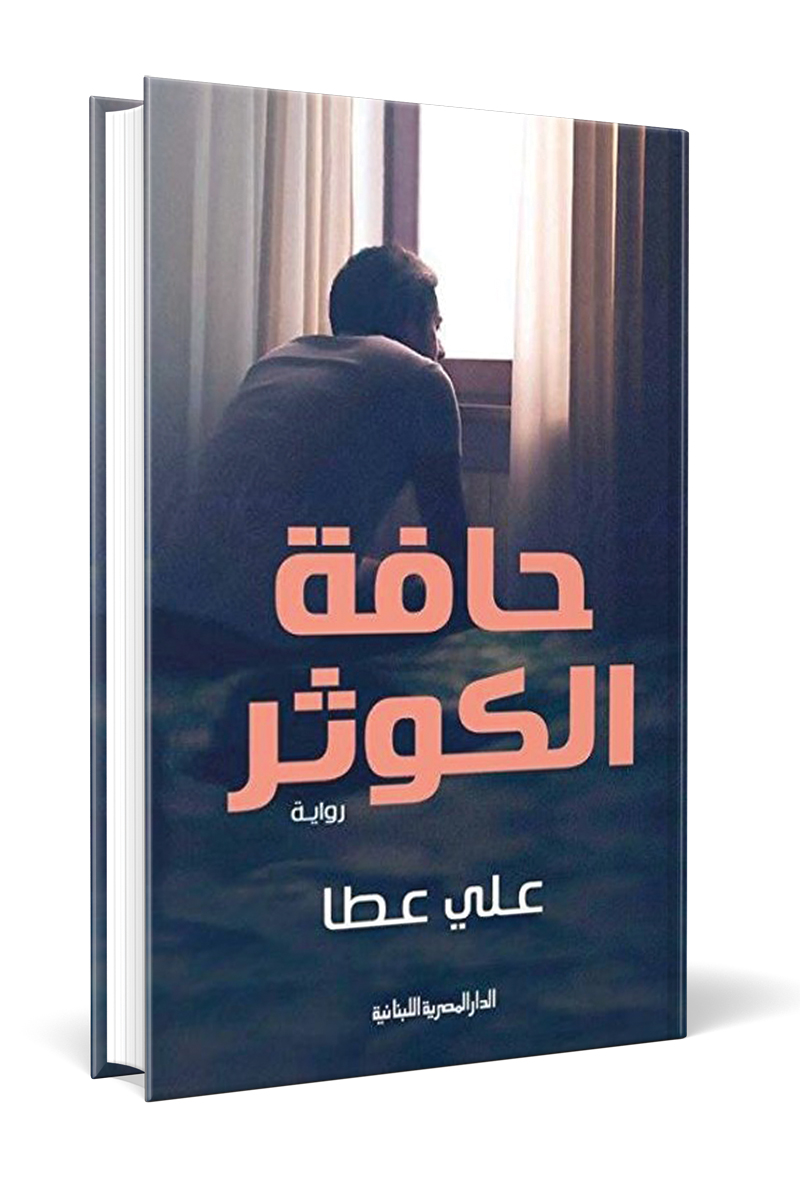
«حافة الكوثر».. أحزان ليست عابرة
تحتوي رواية «حافة الكوثر» لـعلي عطا على تمثيل مناسب للضغوط النفسية والاجتماعية والأسرية والمادية أو اجتماعها معًا داخل إنسان واحد وعبر حياته، فالسارد الرئيس يُدعَى حسينًا، وهو يعاني هنا ضغوطًا اجتماعية شتى مصدرها الأساس علاقاته بزوجته الأولى (دعاء) ثم زوجته الثانية (سلمى) ثم بنته (حنان) كما أنه بعد أن انتابته نوبة الاكتئاب الأولى، لأسباب عدة، شعر بأن الآخرين يراقبونه ويتحدثون عنه، عبر الفيسبوك وفي الحياة.

علي عطا
الزوجة الأولى، كما جاء وصفها في الرواية زوجة مسيطرة جدًّا، باردة جدًّا، مستحوذة جدًّا، وفي الرواية أيضًا وصف لحالة دعاء (زوجته الأولى) بعد أن أخبرها بزواجه الثاني، فقد كانت تظل مستيقظة ولا تنام حتى يستغرق في النوم وذلك كي تراقبه وتمنعه من الاتصال بسلمى زوجته الثانية. وهناك إشارات أيضًا لذلك السأم الذي أصابه من الحياة بشكل عام، سياسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وإنسانيًّا، وإشارات كذلك إلى أنه قد فقد الشغف بشكل عام كلية وشغفه في علاقته بزوجته الأولى دعاء بشكل خاص «ذلك الشغف لم يعد له وجود يا دعاء، ولذلك أستثقل إجباري على تصنعه ليجاري شغفًا يلازمك على مدار الساعة، ما دمنا غير متخاصمين».
ويتجلى فقدانه للشغف أيضًا في أحلامه، ومنها ذلك الحلم الذي رأى نفسه فيه، بينما كانت دعاء تنام بجواره، إنه غير قادر على الوصول إليها، كي يفي بوعد ما، على الرغم من أنه يحفظ رقم هاتفها وبيتها الذي جاء في الحلم، إنها تنتظره فيه منذ سنوات بعيدة، وهو حلم تزداد حيرته في تفسيره. لكنه في رأي حلم يدل على رغبته الخاصة في الحرية والتحرر، وهي رغبة كانت كامنة في أعماق لا شعوره، عبَّر عنها في أحلامه هكذا كان يشعر بضغوط متواصلة تلاحقه من كل صوب وحدب، وقد كان يحتاج ككاتب للحرية، لكنه كان محاصرًا في كل وقت، بل في كل لحظة، في بيته، وفي عمله، حتى في عالمه الافتراضي، وكذلك في عدم قدرته على كتابة ما يريد، فهو في الأصل مبدع، لكنه ضاع أو استنفد جهده في عمله الصحافي وفي متاهات الحياة، ومن ثم فقد كان ينتابه شعور دائم بأن روحه ضائعة وهائمة، وأنه قد تأخر كثيرًا في العثور عليها.
حنين إلى الماضي
هكذا انتابه أيضًا نوع من الحنين إلى الماضي، تجلى في صحوه وتجلى أيضًا في أحلامه، ازداد شوقه لبيتهم القديم، لعالم طفولته، وشارع شمس الدين وكذلك حنينه للأشياء والأماكن والبشر وكل ما لم يعد له وجود الآن، وقد تزايدت مشاعره هذه مع زيادة الاضطرابات في المجتمع، حرق الكنائس وقتل المتظاهرين ومشاعر الخوف العام وعدم الأمن، هكذا يزداد حنينه لمظاهر الريف التي تتلاشى شيئًا فشيئًا، للشوارع والمدارس والأسواق والطواحين والساحات الشعبية والمحلات وتمثال أم كلثوم، ولرموز مدينة المنصورة (بديع خيري – السنباطي- علي محمود طه- أنيس منصور- كامل الشناوي… إلخ) وبقايا عبق ذلك الماضي الذي لم يزل موجودًا هكذا يقول: «أماكن الطفولة تناديني ولا تكف عن اقتحام ذاكرتي».
لقد أسهمت المدينة، بكل ما عاناه فيها من تزايد شعوره بالغربة والاغتراب، ومن ثم كان يزداد شوقه واشتياقه لتلك اللحظات التي كانت الأشياء فيها شبه مؤكدة وشبه يقينية، في حين أنه فقد الآن الثقة وفقد اليقين، بالنسبة لذاته وبالنسبة للآخرين وبالنسبة للحياة بشكل عام. هكذا وقع في براثن ما يمكن تسميته بالاكتئاب المديني، فالاكتئاب بطبيعته مرتبط بالضغوط، والضغوط تفاقمت مع الحداثة، ومع زيادة المطالب الاستهلاكية للبشر، مع المظاهر والسطح والبريق والاستعراض.
ويتفاقم شعوره بالغربة هذا حتى بعد أن دخل إلى المصحة، يشعر بأنه غريب في مكان غريب بين أناس غرباء. ويزداد شعوره بالغربة والاغتراب مع تذكره لتاريخ عائلته لأبيه الذي دفن في مقابر الصدقة بالمنصورة، وكذلك جدته وأمه على الرغم من وجود مقابر لهم في المنصورة، ولتصوره أنه سيدفن أيضًا غريبًا في مقبرة خاصة به على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.
يصف حسين في هذه الرواية نوبات الاكتئاب العنيفة التي تهاجمه، وغالبًا ما تبدأ معه مصحوبة بشعور متزايد بالضجر مع صدور تأوهات عالية يسمعها من يحيط به، وكذلك كيف أنها تأتي إليه فجأة حتى لو كان موجودًا وسط جمهور غفير من البشر كتلك النوبة التي هاجمته حينما كان موجودًا في المسرح الكبير في الأوبرا في مؤتمر ملتقى الرواية ذات عام. أما ما بعد النوبات، فهناك شعور عام بالضجر أيضًا والإحباط والعجز إلى حد الاقتراب من الانتحار، مع فقدان للشهية الخاصة بالطعام والحب وكل شيء.
وفي الرواية وصف لطقوس الاستيقاظ والنوم وتناول الطعام والدواء ومشاهدة التلفزيون والزيارات في مصحة الكوثر، ووصف كذلك لتحول الناس الراشدين الناضجين إلى حالة تشبه الأطفال في كلامهم وسلوكهم واستسلامهم لقدرهم، في الكوثر هناك صغار وكبار، رجال ونساء، مسلمون ومسيحيون، أدباء ومحامون وضباط شرطة ومستشارون، وأساتذة جامعات ومديرو شركات وموظفون، الفئات والأعمار والمستويات كافة، وكأن الكوثر هنا مجتمع صغير فيه انطوى المجتمع الأكبر، أو كأنها مرآة ينعكس فيها حالة مجتمع يقف كله على حافة الكوثر أو حافة المرض والاكتئاب والانهيار، في المستشفى ذهانيون فصاميون وعصابيون وسواسيون واكتئابيون، وهناك أيضًا ضحايا حالات جرائم غامضة يشار إليها عبر الرواية على نحو صريح حينًا، وعلى نحو غامض خفي سريع أحيانًا أخرى.
غياب عن الوجود
يصف حسين حالته في الكوثر فيقول: «الأيام هنا مملة، ومع ذلك أحن إليها، وعندي ما يشبه اليقين أنني سأستعيدها يومًا، وإنني حتمًا سأعود إلى الكوثر، وقد يطول بي المقام فيها، مقارنة بالمرات السابقة». في الرواية سرد لأحلام حسين، أحلامه في حالات اليقظة، وأحلامه في حالات النوم يقول: «أحلم نائمًا ومستيقظًا» ويقول أيضًا: «الحلم هو بداية كل شيء عندي» وتصوير للاكتئاب على أنه نوع من الغياب، غياب عن الوجود وعن الوطن وعن الإحساس، بل عن الواقع الافتراضي أيضًا، غياب بالأدوية، أو بالوجود في مستشفى، أو في عالم النت الافتراضي، أو بالهجرة خارج الوطن وإشارات إلى الاكتئاب بأنه «لئيم لا تعرف متى يهاجمك، وعلى أي درجة من الضراوة سيكون، وإلى أي مصير يمكن أن يدفعك». وإشارات أيضًا إلى حالات المبدعين والفنانين الذين أصابهم الاكتئاب وانتحروا؛ صلاح جاهين، وسعاد حسني، وداليدا… إلخ.
في الرواية رصد للأحداث الكبرى في مصر منذ عام 1963م (تاريخ ميلاد السارد والكاتب) حتى تفجيرات المنصورة وثورة 30 يونيو 2014م، وهزيمة 1967م، وحرب أكتوبر 1973م، واغتيال السادات 1980م، وثورة 25 يناير 2011م. هكذا حتى الآن في الرواية تأكيد على قيمة الصداقة والتواصل حتى لو كان ذلك مع صديق واحد غائب أو افتراضي، وتأكيد كذلك على قيمة الكتابة والإبداع كوسيلة وأداة مواجهة للكآبة والاكتئاب والحزن بمصادرهم الخاصة والعامة أيضًا.

