
بواسطة سعيد بوكرامي - كاتب و مترجم مغربي | أغسطس 31, 2017 | ثقافات

 تقدم الأعمال المترجمة للروائي الياباني كنزابورو أوي من اليابانية إلى اللغة الفرنسية الصادرة مؤخرًا خدمة أدبية جليلة للقارئ عمومًا. فترجماتها رصينة وانتقاؤها دقيق، ترصد حياته وأدبه على مدار عقود عدة. ولا ينحصر اهتمام دور النشر العالمية بنشر أعماله فحسب، بل يأتي الاهتمام أيضًا من كونه شخصية ثقافية مثيرة للجدل في اليابان. فهو يحتل اليوم واجهة الإعلام الياباني بحكم معارضته الشرسة للاستخدامات النووية العسكرية والمدنية. ولد كنزابورو أوي في عام 1935م في قرية شيكوكو من مقاطعة إيهايم باليابان، وحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1994م، وهو واحد من الشخصيات الأكثر نشاطًا ثقافيًّا وأدبيًّا وسياسيًّا. ألف كتابًا مؤلمًا عن هيروشيما، نشر في عام 1965م (أعيد إصداره مؤخرًا ضمن سلسلة كتاب الجيب)، وقد منحته الكارثة البيئية والإنسانية في فوكوشيما الفرصة لتوسيع نطاق هذا الالتزام برفض الطاقة النووية المدنية من دون التخلي عن إنعاش الذاكرة الجماعية، منبِّهًا إلى نتائج مأساة هيروشيما وناغازاكي، وفي هذا الصدد كتب كثيرًا من المقالات وأجرى عددًا من المقابلات، كما التمس من رئيس الوزراء التخلي عن الطاقة النووية وجمع أكثر من سبعة ملايين توقيع تؤيد موقفه.
تقدم الأعمال المترجمة للروائي الياباني كنزابورو أوي من اليابانية إلى اللغة الفرنسية الصادرة مؤخرًا خدمة أدبية جليلة للقارئ عمومًا. فترجماتها رصينة وانتقاؤها دقيق، ترصد حياته وأدبه على مدار عقود عدة. ولا ينحصر اهتمام دور النشر العالمية بنشر أعماله فحسب، بل يأتي الاهتمام أيضًا من كونه شخصية ثقافية مثيرة للجدل في اليابان. فهو يحتل اليوم واجهة الإعلام الياباني بحكم معارضته الشرسة للاستخدامات النووية العسكرية والمدنية. ولد كنزابورو أوي في عام 1935م في قرية شيكوكو من مقاطعة إيهايم باليابان، وحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1994م، وهو واحد من الشخصيات الأكثر نشاطًا ثقافيًّا وأدبيًّا وسياسيًّا. ألف كتابًا مؤلمًا عن هيروشيما، نشر في عام 1965م (أعيد إصداره مؤخرًا ضمن سلسلة كتاب الجيب)، وقد منحته الكارثة البيئية والإنسانية في فوكوشيما الفرصة لتوسيع نطاق هذا الالتزام برفض الطاقة النووية المدنية من دون التخلي عن إنعاش الذاكرة الجماعية، منبِّهًا إلى نتائج مأساة هيروشيما وناغازاكي، وفي هذا الصدد كتب كثيرًا من المقالات وأجرى عددًا من المقابلات، كما التمس من رئيس الوزراء التخلي عن الطاقة النووية وجمع أكثر من سبعة ملايين توقيع تؤيد موقفه.
أعمال هذا الكاتب الكبير المترجمة إلى العربية، للأسف قليلة. لا تقدم الكاتب بصورة واضحة وشاملة للقارئ العربي، ولا أعلم سبب تهرب المترجمين من أعماله على الرغم من أنها أكثر أدبيةً وعالميةً من أعمال غيره من الروائيين اليابانيين، خصوصًا الشباب. من رواياته التي ترجمت إلى العربية: «علمنا أن نتجاوز جنوننا» (دار الآداب) بترجمة كامل يوسف حسين، و«مسألة شخصية» (مؤسسة الأبحاث العربية) ترجمة وديع سعادة، و«الصرخة الصامتة» (دار المدى) ترجمة سعدي يوسف.
وفي أحد أيام هذا الصيف القائظ تلقى كنزابورو أوي وهو محاط بزوجته يوكاري وابنه هيكاري، عشرات الكتب والصفحات المسودة وضعت فوق طاولة منخفضة وسط بهو منزله. كانت تلك الأوراق تجسد تاريخًا من الفكر النشيط والكلمة اليقظة المتنقلة بين الأدب والالتزام الاجتماعي. تأملها النوبلي كنزابورو أوي مبهورًا، فقد بلغ عدد الصفحات أكثر من 1300 صفحة قامت بترجمتها دار غاليمار الفرنسية عن أعماله. منها القصة القصيرة والرواية والمقالات الأدبية. كبداية لخطة نشر أعماله الكاملة في حلة تليق بهذا الكاتب الفريد.
يبلغ اليوم كنزابورو أوي 82 عامًا، ولا يزال آخر عمالقة الرواية في اليابان يعيد النظر بصبر وعمق في طفولته وحياته الفريدة ككاتب وأب لطفل معاق ومثقف ملتزم بقضايا مصيرية تهم بلاده ومستقبل العالم. على هامش هذا الحدث الأدبي المهم أجرى مراسل صحيفة ليبراسيون الفرنسية في اليابان الكاتب والصحافي أرنو فولران مؤخرًا حوارًا مهمًّا مع كنزابورو أوي، هنا ترجمة له من الفرنسية.
الرواية بضمير المتكلم
■ كنزابورو أوي: فوجئت كثيرًا عندما قيل لي: إن 1300 صفحة من أعمالي نُشرت في دار غاليمار، وما زلت متأثرًا بذلك. ولعل هذه هي أعظم هدية في حياتي، خصوصًا ضمن سلسلة «كوارتو»؛ لأنها تضم أعمالًا كلاسيكية. أشعر حقًّا أن الأمر يتعلق بكتاب وبصورة كاتب، لكن كنت أعتقد أنها تمثل أيضًا حياتي. إنه شيء خاصّ جدًّا بي. أنت تعلم أن في اليابان، نحن نتحدث «الوتاكوتشي شوسيتسو»، «الرواية بضمير المتكلم» لكن هذا لا يعكس حياة الفرد. هذه الرواية، التي تكتب بضمير المتكلم وشخصيتها الأساسية هي تخص الكاتب الذي يعيش عادة في طوكيو، ليست سيرة ذاتية. في هذا النوع من الرواية اليابانية، تروى بالأحرى تفاصيل الحياة
● أرنو فولران: لكنك لا تنتمي إلى هذه المدرسة.
■ كنزابورو أوي: لم أكن أنوي أن أكتب رواية بضمير المتكلم؛ لأن عملي يستند إلى نقد هذا النوع من الرواية. على سبيل المثال، ناويا شيغا [1883-1971م] أصبح معروفًا ونال التقدير لأنه كتب بضمير المتكلم. عندما نقرأ رواياته، نكتشف أخيرًا الصورة الشخصية الحقيقية للكاتب. إن الذين اشتغلوا على هذا النوع من الرواية يعطوننا انطباعًا بأنهم يقومون بالتقاط صور عن حياتهم وتحويلها إلى كلمات. لكن في وقت ما بعد الحرب حاول الكُتاب أن يجدوا ويحللوا الإنسان الذي يكتب للتمعن في أين يمكن أن نذهب بالتفكير في كيفية حياته وموته، وهذا ما حاولت أن أقوم به. انطلاقًا من قراءتي للأدب الأوربي، بدا من المهم تطوير الكتابة للنظر إلى العالم بطريقة أكثر شمولية واتساعًا. لقد بدأت بكتابة قصص قصيرة حول موضوعات أصيلة. ثم ولد هيكاري بإعاقة [ولد الطفل الأول لكنزابورو أوي في 1963م بإعاقة ذهنية] فغيرت تمامًا مشروعي. فقلت في نفسي: «ستكون حياتي معه هي موضوع كتابتي». هذا الوضع الأصيل الذي بحثت عنه في قصصي وجدته في حياتي الخاصة. وهذا ما سمح لي حقيقة بأن أكتب عندما قررت صحبة زوجتي القبول والعيش رفقة هذا الطفل. وهكذا قُبِلتُ ككاتب وسرَّني كذلك أن المختارات من أعمالي اتخذت سمة التأريخ للكتاب والإنسان.
● أرنو فولران: لكن، على كل حال، هل أنت سعيد؟
■ كنزابورو أوي: لو قيل لي: إن هذا المصير جيد لي، سأرغب دائمًا في أن أقول: لا. أشعر ببعض الأشياء. الآن عمر هيكاري 53 عامًا (يعمل مؤلفًا للموسيقا، وقد عُزفت سيمفونيته في ألمانيا منذ شهور – المترجم)، منذ ثلاث سنوات، وأنا أشعر أنه أصبح أكثر قتامة. من قبل كان يتحدث طوال اليوم كطائر. وكان مثل الطفل يستمتع بأسرار اليقظة، وأعتقد أنه في يوم من الأيام سيموت مبكرًا أو عجوزًا، لكنه سيموت بروح طفل. وأظن إلى جانب هذه الحياة السعيدة رغم كل شيء، عشت حياتي مع تجارب صعبة، لحظات مفجعة؛ لذلك بدأت الكتابة عن هذه الحياة في رواياتي، فمن الواضح أني أقدم تجارب حياة ليست دائمًا مرحة. هناك دائمًا في معظم رواياتي شكل من أشكال الفكاهة وهي تأتي من هيكاري، ومن علاقتنا. لقد عشت وأنا لا أفعل شيئًا غير الكتابة، فتمكنت من أن أذهب إلى الجامعات، وتقديم المحاضرات. عشت حياة أخرى غير حياة المدرِّس. من خلال كل ذلك، تحدثت أيضًا عن قريتي وطفولتي. أعتقد أن هذا هو أيضًا السبب في أن بعض القراء يُبدون اهتمامًا بكتاباتي.

 ● أرنو فولران: كنت في الثانية والعشرين عندما نشرت عملًا غريبًا؛ هل كنت تشعر أنك كاتب؟
● أرنو فولران: كنت في الثانية والعشرين عندما نشرت عملًا غريبًا؛ هل كنت تشعر أنك كاتب؟
■ كنزابورو أوي: لا. كنت أقرأ كثيرًا من الروايات، كنت قادمًا من القرية أشبه شابًّا بين الأطفال. تُوفي والدي مبكرًا جدًّا [في عام 1944م، وربما بسبب نوبة قلبية]، لكني لم أكن على علاقة بكبار القري
ة، كما لم أشعر بأني أنتمي إلى دائرة الأطفال. كنت أقرأ فقط. ثم جئت للدراسة في طوكيو، التقيت كازو واتانابي، وهو مدرس، خبير ومترجم رصين لرابليه. إذا كنا نتحدث عن الالتزام تجاه المجتمع الذي نعيش فيه، فمن شأن العمل بالكتابة أن يدفعك بالضرورة إلى التساؤل عن اليابان، والتساؤل أيضًا عما إذا كنت عارضًا، عوضًا عن أن أكون ملتزمًا، ثم شعرت أن الأدب الذي كنت أكتبه لا يمكن أن يكون محدودًا، وأنه يجب أن ينفتح على اليابان وآسيا.
● أرنو فولران: في هذه المختارات نجد المجموعة القصصة «سبعة عشر» التي لم يسبق نشرها في فرنسا، تحكي قصة مراهق ممزق بين دوافعه الغريزية
والسياسية والوجودية. كانت هذه المجموعة القصصية التي تتكون من 90 صفحة مثيرة للجدل في الستينيات؛ ما مكانتها بين منجزك؟
■ كنزابورو أوي: إنها عمل مهم لي؛ لأن الأمر يتعلق بشاب يعيش في المجتمع المدني الياباني. احتلت هذه الشخصية العادية التي قامت بعمل إرهابي مكانة مهمة في تفكيري. بكتابة هذهالقصة، بدأ شيء ما يتغير بداخلي، إنها نقطة البداية.
أب وحياته مع ابنه في طوكيو

كنزابورو مع ابنه سنة 1935م
● أرنو فولران: في «نشيد الذكرى» القصيدة الجميلة، تكتب «ما زلت لا أعرف ماذا سأقول للشاب الذي كنته» نشعر بكثير من الفشل في هذه الجملة.
■ كنزابورو أوي: تحدثت للتو عن الانفتاح على العالم، لكن كتابتي لا تزال في إطار محدود، عن أب وحياته مع ابنه في طوكيو. لا أكتب وفي ذهني تصور كي أكون موضع تقدير أو فهم في الخارج. إنه لمن دواعي سروري أن أُقرأ وأُترجم، لكن هذا لن يملأ حياة أو يجعلني أفكر في أني سأموت مرتاح البال. أعتقد أني سأعيش خمس سنوات أخرى ولمدة سنتين أو ثلاث سنوات أخرى سيكون نشاطي الفكري طبيعي إلى حد ما. من يومين أدركت أنني لم أمارس رياضة الجري منذ عام. لهذا ارتديت بذلة رياضية وركضت لمدة عشر دقائق. عندما نركض، هناك لحظة نرتفع فيها، وأنا أحب هذه اللحظة القصيرة جدًّا التي نرتفع فيها عن سطح الأرض. لقد أدركت أنه حتى في سن متقدمة، يمكن أن نركض. وهذا منحني شعورًا بالفرح والوضوح في حياتي. الإنسان هو ذلك الشخص الذي يسمو عن سطح الأرض. وبهذه الطريقة عدت مرة أخرى بشريًّا.
● أرنو فولران: أنت معارض للنظام الإمبراطوري منذ وقت طويل. ومع ذلك، عبرت عن رضاك من دعوة السلام المعروضة من الإمبراطور أكيهيتو، في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية؟
■ كنزابورو أوي: عندما كنت طفلًا، كل صباح في المدرسة، كنا نسجد في الهيكل للإله الإمبراطور. هل كنت أومن بذلك؟ لا أعرف. على كل حال، كان لديّ انطباع أني أعرف، أن هناك شخصًا مقدسًا فوق الجميع. لم نفكر قط في أن نعطي قيمة لما يقوله الإمبراطور، أو النظر فيما إذا كان جيدًا أم لا. الإمبراطور الإله صاحب السلطة المطلقة تركناه خلفنا جميعًا، لقد انتهى في عام 1945م. وتوفي، ولم يعد إلهًا. عشت على عدم الاهتمام بما يمكن أن يفكر فيه الإمبراطور. وأيًّا كان النظام الإمبراطوري، لا بد من إزالته من الدستور. أنا أنتقد بشدة حكومة شينزو آبي الذي ينوي تغيير الدستور، وألا يبقى البلد مسالمًا لا يستخدم الحرب كأداة ضد بلدان أجنبية.
● أرنو فولران: هل ستصبح اليابان «دولة طبيعية» وفقًا للرغبة التي عبّر عنها شينزو آبي؟
■ كنزابورو أوي: بالفعل تملك اليابان جيشًا يسمى قوات الدفاع الذاتي، وهناك جيش أميركي لديه قنبلة نووية مزروعة في اليابان. ويبدو هذان الأمران مخالفين للدستور. إذا آبي، أو رئيس الوزراء المقبل، تمكَّن من تعديل الدستور بموافقة الشعب، سيكون من السهل جدًّا تحويل جيش قوات الدفاع الذاتي الحقيقي وأن يصبح لليابان سلاح نووي على الفور. في كوريا، هناك نقاش حول هذا الموضوع، وبطبيعة الحال، أنا أعارض. يمكن أن تصبح المنطقة قريبًا مكانًا لحرب نووية. إذا تغير الدستور، لن نكون في عالم يمكن أن نحقق فيه السلام. ستكون هذه هي نهاية اليابان إذا كان هناك استفتاء، وقرر الشعب الياباني دعم مواقف «آبي». وأنا على استعداد للنزول كل يوم إلى الشوارع لمعارضة ذلك.
سعيد بوكرامي – كاتب ومترجم مغربي
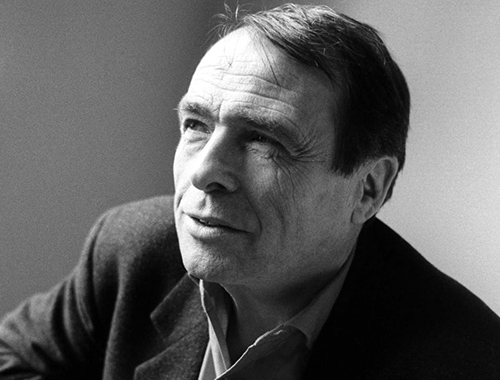
بواسطة سعيد بوكرامي - كاتب و مترجم مغربي | نوفمبر 6, 2016 | ثقافات

سعيد بوكرامي
لا ينتمي كتاب «بيير بورديو: بنيوية بطولية» للسوسيولوجي الفرنسي «جان لويس فابياني» إلى كتب السيرة الفكرية المتعارف عليها، التي تنحاز غالبًا إلى التوثيق والتأريخ وهذا ما يعلي من قيمة هذا الكتاب فكريًّا ويضعه في صدارة المراجع التي كتبت عن «بيير بورديو» المفكر والإنسان (1930 – 2002م).
جاء الكتاب نتيجةَ مرافقةٍ لبورديو دامت سنوات طويلة، ووفق إنصات عميق لمعنى علاقة حميمة جمعت الباحث بالمفكر وبفكر أشهر عالم اجتماع معاصر. كما يشكل خلاصة تعلق أكاديمي بعالم وإنسان لم يكن يبخل على مريديه بالفكرة الراجحة، والموضوع الناجح والمعرفة الثقافية والاجتماعية، التي تتجاوز المجتمع الفرنسي إلى مجتمعات أخرى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قدم لنا «فابياني» نتائج مراقبته لكيفية كتابة «بورديو» لعلم اجتماع متجدد ومبتكر، ولصيرورة تشكُّل فكري وثقافي وسياسي غيرت مفهومنا عن العلوم الإنسانية والاجتماعية.
يشكل الكتاب الصادر حديثًا عن دار سوي الفرنسية إضافة نوعية وفارقة إلى مجموعة غزيرة من الأبحاث البارزة التي أنجزت حول «بيير بورديو»؛ لأنه يقترح إعادة قراءة المفاهيم المركزية لعلم الاجتماع «البورديوي» على ضوء الممارسات الممكنة عمليًّا ونظريًّا، ثم لأن المؤلف يستخدم الشبكات الفكرية وطرائق التحليل التي حددها «بورديو» تدريجيًّا، أضف إلى ذلك الوضع الشخصي والأكاديمي لفابياني الذي كان يتوافر على الشروط الذاتية والموضوعية للنجاح في مقاربته الفكرية.
مثقف بطل من نوع جديد
يواجهنا في الصفحات الأولى من الكتاب سؤال محوري ومنهجي: «هل يمكننا اليوم الحديث بهدوء عن بورديو؟». هذا هو السؤال العام الذي يسعى «جان لويس فابياني» للإجابة عنه، باستخدام منهجية تستهدف تحليل المفاهيم الأساسية لنظرية علم الاجتماع. وقسم الباحث كتابه إلى ثلاثة أقسام: يهدف القسم الأول إلى تحليل الحقل المفاهيمي، والهابيتوس: «المظاهر الاجتماعية» ورأس المال الثقافي والرمزي. وهذه مفاهيم مركزية في البناء النظري لبيير بورديو، التي- كما يذكرنا «جان لويس فابياني»- صُممت أصلًا للعمل بشكل شمولي. أما القسم الثاني فيتناول التصميم المنهجي والسردي الموظف من عالم الاجتماع. وأما في القسم الثالث فيهتم على نطاق واسع بصورة «بيير بورديو» من خلال مفاهيمه السياسية، ثم يتحدث عن معاناة «بورديو» وشغفه بموضوعات بحثه. وأخيرًا يرسم الملامح النهائية لـ«بطل مثقف من نوع جديد».
 حاول الباحثُ- (استنادًا إلى قراءة قريبة جدًّا من أعمال «بورديو» جنبًا إلى جنب مع أدبيات «بورديو» السوسيولوجية الوفيرة، مع العلم أن رصيد بيير بورديو ثلاثون كتابًا ومئات الدراسات والمقالات) تحليلَ «تاريخانية» التطورات المتلاحقة التي عرفتها المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع. وهذا مكّن «جان لويس فابياني» من تسليط الضوء على التطور التدريجي لها عند «بورديو» منذ عام 1960م، إضافة إلى بعض التناقضات المتنامية الميّالة إلى التعميم، كما مكّن هذا التحليل المفصل للمفاهيم الثلاثة المؤلفَ بدرجة أكثر أو أقل من التوصل إلى تفكيك أهم المفاهيم.
حاول الباحثُ- (استنادًا إلى قراءة قريبة جدًّا من أعمال «بورديو» جنبًا إلى جنب مع أدبيات «بورديو» السوسيولوجية الوفيرة، مع العلم أن رصيد بيير بورديو ثلاثون كتابًا ومئات الدراسات والمقالات) تحليلَ «تاريخانية» التطورات المتلاحقة التي عرفتها المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع. وهذا مكّن «جان لويس فابياني» من تسليط الضوء على التطور التدريجي لها عند «بورديو» منذ عام 1960م، إضافة إلى بعض التناقضات المتنامية الميّالة إلى التعميم، كما مكّن هذا التحليل المفصل للمفاهيم الثلاثة المؤلفَ بدرجة أكثر أو أقل من التوصل إلى تفكيك أهم المفاهيم.
وهكذا، فيما يتعلق بالحقل الاجتماعي الموصوف لدى «بورديو» بـ«النظرية المستحيلة»، يوضح «فابياني» أن «بورديو لا يتردد في اللجوء إلى مفهوم الغموض عندما يفتقر إلى المصادر التحليلية». وخلال تحليل الهابيتوس يشير «بيير بورديو» إلى أنه: «مثل كل نظريات التنشئة الاجتماعية يمكث على نطاق واسع صندوقًا أسودَ»، بمعنى من المعاني فعلم الاجتماع لديه لا يملك أجوبة حاسمة إنما تعترضه ثغرات وصعوبات يستحيل ترميمها أو حلها. وأبسط هذه الأمور حضور ذات المفكر السوسيولوجي وشروط اشتغاله العلمي، ونجد هذه التوضيحات في كتابه «الإنسان الأكاديمي» حينما تحدّث عن تأثير التاريخ الشخصي لعالم الاجتماع في عمله الأكاديمي؛ إذ تتدخل الذات المفكرة في ممارسته العلمية وتُبلبل رؤيته للمجتمع، وفي غالب الأحيان دون وعي منه.
وأخيرًا: يتناول المؤلف بالتحليل مفهوم «رأس المال الرمزي»، الصنف الأبرز من جميع أشكال رأس المال الذي أبدعه ونظر له «بورديو». ويشير الكاتب إلى أنه: «لا يمكن أن نمنع أنفسنا من التفكير في المفهوم الرمزي، الذي يحتفظ بنصيب من الغموض، حتى عندما نعيد القراءة بعناية دقيقة للمفاهيم، التي صاغها «بورديو» وجمعها مبكرًا خلال مسيرته العلمية». ويضرب مثالًا بمفهوم رأس المال الرمزي الذي يُحَدد من سمات الفرد المشكّلة من مظاهره الاجتماعية التي تختلف من فرد إلى فرد ومن مجتمع إلى مجتمع، لكنها تتوحد في سمات مشتركة مثل الشرف والهيبة والسلوك الحسن والسمعة وغيرها.
في القسم الثاني: يستمر هذا البحث «التاريخاني»، مع التركيز هذه المرة ليس على المفاهيم ولكن على المسالك المنهجية والسردية التي وظفها «بيير بورديو». وفيما يتعلق بالأولى فإن «جان لويس فابياني» يهتم بتفاصيل علاقة «بورديو» بالإحصاءات والأدب والتاريخ، موضحًا أن التحليل الهندسي كان ثمرة تعاون مع الإحصائيين، بدأه «بورديو» في الفترة الجزائرية، ويبدو أنه حمله معه خلال دراساته الاجتماعية للحفاظ على تماسكٍ بنيوي، مراعيًا بصرامة التغيير الاجتماعي.

جان لوي فابياني
تنوع أنظمة الكتابة
وفيما يتعلق بالمسالك السردية فإن الحجة الرئيسة للمؤلف التي واجهت المهتمين بدراسة أعمال «بورديو»، هي تنوع «أنظمة الكتابة» لديه؛ إذ لاحظ المؤلف أن أعماله يختلط فيها العلمي بالفلسفي، والنفسي بالأدبي؛ فهناك تحول مذهل في الأساليب والتخصصات لكنها تكون دائمًا تحت سماء علم الاجتماع بشروطه العلمية.
وفي القسم الأخير: يعرض «فابياني» بطريقة شاملة صورةَ عالم الاجتماع واقفًا ضد التصورات المقولبة التي وضعت مرارًا وتكرارًا صورةً عن «بورديو» الخجول سياسيًّا والملتزم ثوريًّا في الجزء الأخير من حياته. بينما هو في الواقع يدافع بشكل جدلي عن صورة المثقف والمفكر المنتقد والمندد، والمجدد لأنماط التفكير الثقافي والسياسي والسلوك الاجتماعي، جنبًا إلى جنب مع صديقه المفكر الفرنسي «بيار فيدال- ناكي». ومن ثَمَّ يرى الباحث أهمية ما مارسه «بورديو» من تأثير في الحياة الاجتماعية، الذي أشار إليه «بورديو» نفسه خلال ممارسته وإنتاجه.
هذا الاهتمام هو في الواقع، حسب المؤلف، موجود في أشكال عدة هي: أولوية الجسد في العلاقة العملية بالعالم التي بُلورت في الأعمال الأنثروبولوجية في موضوعات تتجسد في موضوعَي: المعاناة، والشغف.
وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، نلاحظ أن تحليل «فابياني» يبدو كأنه وصل بشأن هذه المفاهيم إلى طريق مسدود: «العلاقة بالتحليل النفسي هي إحدى النقاط الأصعب في البنيوية التوليدية، وبورديو لم يساعد القراء ولم يمهّد الطريق للتفسير».
في الفصل الأخير: سنصل إلى المقاصد السامية للكتاب التي تتجلى في إضاءة منهج «بورديو» انطلاقًا من سيرة حياته الذاتية والفكرية، وأيضًا في إبراز أهم المشاكل التي اعترضت ممارسته العلمية على نطاق أوسع. ومن هنا تبدو أطروحة الكتاب واضحة: إن عالم الاجتماع اتبع نمطًا مميزًا من الحياة اتسم في مجمله بـ«البطولة» التي كانت وقودًا فعالًا في مساره الاجتماعي، ودفعه إلى مضاعفة مجهوداته وزيادة إنجازاته العلمية. وبناء عليه يحدد «فابياني» الطابع الاستثنائي لهذا البطل المتمثل في قدرته الانعكاسية على نقد ذاته وتجاوز عثراته والإصرار على مواقفه الثقافية والسياسية مهما كلفه ذلك من تضحيات. والنتيجة: أن «بورديو» تمكن في سنوات حياته الأخيرة من تأسيس نظام سوسيولوجي نظري وتطبيقي شمولي كان قد سهر على تشييد صرحه بجهد ذاتي وفكري استثنائي.
استعادة مفاهيم «بورديو» وتعقيداتها
تكمن القوة الحقيقية للكتاب -كما أعتقد- في الثراء المعرفي ودقة المفاهيم في قراءة منجز «بورديو»، وقد شكل هذا الاستعراض التحليلي فرصة للتعرف إلى مهارة باحث وُفِّق في استعادة مفاهيم «بورديو» وتعقيداتها، لكن أيضًا هشاشة التوضيحات النظرية لدى «بورديو». وبهذا المعنى يبدو أن المؤلف يقف حقًّا على أسس عمل تجريبي مهم سمح بالانفلات من «المواجهة العقيمة» التي عاناها «بورديو» وصنفته تصنيفات مُجْحِفة.
لكن الباحث، للأسف، لم يطور هذه النقاط إلا قليلًا، مشيرًا في سياقات متعددة إلى أنه يسعى إلى «تطبيق النظام المفاهيمي الخاص ببورديو، على بورديو نفسه» وهذا يبدو إشكاليًّا؛ لأن «فابياني» حاول خلال تحليله أن يبين التناقضات ومختلف الاستخدامات التي قام بها «بورديو». ويمكن الشعور بهذه الفجوة في البناء الكلي للكتاب؛ إذ لا تتوافر فصول الكتاب على أقسام فرعية أو تنصيص من متون أخرى للاستدلال والمقارنة، إنما كُتبت الفصول دفعة واحدة. كما يصعب أحيانًا فهم الترابط الداخلي على نحو سلس ومنطقي؛ ما يفقد بعض الفقرات تماسكها. كما تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن العمل الذي اقترحه «فابياني» هو في رأينا مصدر قيم للغاية؛ لأنه يمكننا من شحن التفكير النقدي وتجريب منهجية اجتماعية وفرها لنا «بيير بورديو» من خلال أعماله الغنية والجدلية.
حاول «فابياني» إذن أن يجد معنًى لعمل «بيير بورديو» الشاق بأنْ منحه صفة «البطولة»، منبها إلى أن «بورديو» عاش اجتماعيًّا وعلميًّا بهذه الروح الشغوفة بالتحدي والرغبة في التغيير إلى ما هو أفضل محليًّا ودوليًّا. وتجلى ذلك في اختلافه الدائم مع أنماط التفكير السائدة التي تستغل الإنسان وتجرده من قيمه الثقافية والإنسانية؛ لهذا يجب على المثقف أن يكون مناضلًا ليجعل المؤسسات المهيمنة في وضع غير مريح. إن «بورديو» -كما يقول «فابياني»-: «هو أول ثوري رمزي قادم من الشعب»، لكن «فابياني» لا يخفي خيبة أمله؛ إذ يعتقد أن «بورديو» استسلم في نهاية المطاف لغطرسة المؤسسات المهيمنة، التي حاربها طوال حياته. وهذا لا ينتقص من عظمة المساهمة العلمية التي قدمها «بورديو»، التي تظهر من خلال مؤلفاته ومواقفه الشجاعة.

بواسطة سعيد بوكرامي - كاتب و مترجم مغربي | يوليو 5, 2016 | تحقيقات

سعيد بوكرامي
الثقافة هي في الأساس تكوين الإنسان، ونشر المعرفة البشرية وبناء الدولة. وبلا شك، فإنها وسيلة خلاص الدول التي تطمح إلى التقدم. ولكن من يجب أن يقوم بدور «نقل الثقافة»؟ من المؤكد أن الدولة هي المسؤولة بسياساتها الثقافية ووسائلها التنفيذية من أجهزة ومؤسسات، ولكن هل الثقافة حقًّا من الضروريات الأساسية للحياة البشرية؟ إن التخلي عن دور الثقافة في بناء المجتمع والطموح إلى فكر مستنير يفتح الباب على مصراعيه أمام الأفكار الظلامية والعدمية وبالتالي الاضمحلال.
وما يمكن ملاحظته اليوم في المغرب تهميش المجتمع المغربي للمثقفين وإنتاجهم الثقافي الحقيقي، في المقابل ينصرف الاهتمام إلى الثقافة الترفيهية والسياحية، التي تجد عوامل مساعدة من المؤسسات الرسمية والفاعلين في قطاع الإنتاج الثقافي الذين ينجحون في تمرير وتكريس مجموعة من أنواع التصورات الكاذبة والأفكار الخاطئة. ومن هنا كانت هجرة المثقفين المغاربة بكثافة إلى أوربا وتحديدًا إلى فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولاندا وإيطاليا، بل وتوطينهم لثقافتهم ولغتهم ثقافة ولغة أخرى ساقتهم مباشرة إلى نوع من التغريب والاغتراب، لكن لحسن حظهم أن منجزهم الأدبي والفكري لاقى نجاحًا وإقبالًا وجوائز مهمة بوّأتهم تدريجيًّا مكانة مرموقة في جغرافية الأدب العالمي. ونذكر من الرعيل الأول الذي حط الرحال في أوربا خلال السبعينيات من القرن الماضي: مصطفى النيسابوري، والطاهر بن جلون، وإدريس الشرايبي، وعبداللطيف اللعبي وغيرهم، ومن الرعيل الجديد الذي أصبحت أقلامهم تنطق اللغات جميعها، نذكر فؤاد العروي، وعبدالله الطايع، وفؤاد الساخي، وليلى العلمي، وحفيظ بوعزة وغيرهم.
إذا كانت هجرة المثقفين إلى أوربا حديثة وجاءت خلال الاستعمار أو بعده، فإن رحلة المثقفين إلى بلاد المشرق، متغلغلة في جذور التاريخ، ونجد صداها في كتابات المغاربة قديمًا وحديثًا. هجرة الأقلام المغربية إلى المشرق ليست حديثة العهد، كما ذكرنا، لكن حضورها بالأمس واليوم وتوهجها بكثافة عددية ونوعية وحصولها على جوائز مهمة، يطرح أكثر من سؤال عن سبب هذه الهجرة الحديثة. عدد من الكتاب تناولوا هذه الإشكالية في تحقيق لـ«الفيصل».
أصوات تنتقد

أبو يوسف طه
يقول القاص أبو يوسف طه: «من الواضح أن التقاطبات الحزبية، واختلاف المنظور، والاسترفاد مما هو سائد في الثقافات الغربية من منازع فكرية، وأيديولوجيات، وطّأ لصراعات حادة في المجال الثقافي الذي ينضفر في جدائل مع المجال السياسي؛ ما أنشأ دوائر مغلقة (نتذكر هنا ثنائيات الشيخ والمريد، والفقيه والعامي، والزعيم والتابع، ثم الطائفة والزاوية إلخ. وهذه تستبد بلاوعي منتسبي حتى المؤسسات الحديثة)، ووضحت اصطفافات المعارضة والموالاة، وبحكم التطورات الخارجية، تباينت المواقف، وهو ما انعكس سلبًا على تماسك الوضع الثقافي (مع غياب فعال لمبادئ وأسس الحوار) حيث بتنا نسمع مفردات من مثل الإقصاء، والتهميش، … إلخ».
ويتطرق أبو يوسف طه إلى دور اتحاد كتاب المغرب الذي لعب، ضمن هذا الفضاء المتشنج، «دورًا رياديًّا لبلورة اتجاه ثقافي إيجابي، واكبته صحف ومجلات. لم تكن هذه الجوانب وحدها هي المؤثرة، فهناك جوانب ذات تأثير نفسي، تتلخص في جنوح بعض الأفراد إلى تأكيد وضعهم الاعتباري بالسير فوق أجساد غيرهم، ومن باب الإيضاح الإشارة إلى تباين حوافز المنتسبين إلى المجال الثقافي بين ذاتية صرف، وذات طابع رسالي (الاشتغال على مشروع). في يقيني أن الأعطاب تنحصر وتتجلى في قاعدة الهرم ووسطه، وتتسم بالفجاجة والابتذال. وهنا بؤرة البؤس الثقافي. بينما لا يمكن نكران الصراع بين التوجهات والأفكار، ونشدان الهيمنة على الحقل الثقافي وتوجيهه، وهو واقع يستوعب الأفراد ويتخطاهم. وتحضرني واقعة الولي عبدالعزيز التباع الذي حسم خلافه مع غريمه الولي رحال الكوشي قائلًا: «لا يمكن لثعبانين أن يسكنا في جحر واحد» مما حدا بهذا الأخير إلى مغادرة مراكش مُكرهًا نحو أحواز السراغنة – زمران، وإقامة رباطه هناك. وهو الأمر نفسه الجاري بأوجه متعددة الآن، وهو ما يحول دون حظو مثقفينا، في الحقيقة والجوهر، بما يجب من احتفاء خالص. وإذا رأينا احتفاء بالأموات منهم، فإنما وفق قاعدة غريبة (الميت لا يشكل منافسًا).
ويرى طه أن الصورة ليست قاتمة بالمطلق، «نحن أمام رجة قوية في القيم، وأمام سيادة البراغماتية، وأمام تداخل وتشابك القضايا والمسارات، ومع ذلك، وباتساع التواصل بات الفساد والإفساد يرتد على مقترفيه، وما حضور الإنتاج الثقافي المغربي الوازن في المشرق العربي وبأجناسه المختلفة، ومن خلال الترجمة أيضًا، إلا دلالة اعتراف بتميزه، وخصوصيته النوعية؛ لأنه يحمل اجتهادًا، ونكهة. إن انفتاح منتجي الخيرات الرمزية من المغاربة على اللغات والثقافات يتبدى فيما ينتجون، ومع مرور الوقت، وعودة الاتزان إلى الحياة الثقافية، ووضوح المرامي الحقيقية للفعل الثقافي، وتطور الحاضنة الثقافية، ستبقى النصوص متكلمة على الدوام بصرف النظر عما أحاط بها، وبأصحابها من تعويق».
الإحساس بالدونية

مراد الخطيبي
أما المترجم والأديب مراد الخطيبي فيرى أن المتتبع والمهتم بالشأن الثقافي المغربي «يستشعر غياب سياسة ثقافية واضحة المعالم من لدن الدولة المغربية. تزداد خيبته ويعظم الإحساس لديه بالدونية والتهميش عندما يتم الاهتمام بمجالات أخرى لا تنتج إلا الرداءة، ولا تحقق إلا إفساد الذوق والتفاهة». ويقول: إن المثقف أصبح «معزولًا ومنبوذًا ولا تتحدث عنه الدولة إلا عندما يموت أو ينخر المرض جسمه. هذا ناهيك عن أعماله التي يطالها النسيان إلا من قراء حقيقيين وباحثين يعيدون النبش في مخطوطاته ويخلقون تواصلًا متجددًا معها.
وغالبا ما يتم اختزال الجانب الثقافي من طرف الدولة بكل أجهزتها، وكذا من بعض وسائل الإعلام في الفن، وحبذا لو كان فنًّا جميلًا ويحمل كل المقومات الفنية والجمالية المتعارف عليها. هو فقط شكل من أشكال التزييف وتكريس ثقافة الرداءة. وخير توصيف لهذه الحقيقة هو قلة البرامج التلفازية المخصصة للثقافة الجادة بالمقارنة مع البرامج المكرسة للرداءة». ويلفت الخطيبي إلى دور الأحزاب، «الأحزاب، وهنا أتكلم عن الأحزاب الحقيقية مع الأسف، تراجع دورها التاريخي، وأصبح الشأن الثقافي لا يحتل المكانة الأساسية ضمن برامجها. ويبقى في غالب الأحيان عنوانًا عامًّا وفضفاضًا لا يحمل رؤية إستراتيجية، ولا يضع آليات علمية لتنفيذه. أكثر من ذلك تحس بأنه برنامج انتخابي تنسخه أغلب الأحزاب فقط لتأكيد حضور الشأن الثقافي ضمن برنامجها الأيديولوجي. مع الأسف تنازلت غالبية الأحزاب عن دور المثقف الحقيقي المتمثل في الكاتب والشاعر والفيلسوف والفنان التشكيلي والمفكر وغيرهم، وانزاحت نحو استقطاب أصحاب المال من أجل «انتصار انتخابي» مؤقت ما انعكس ذلك سلبًا في الأخير على المثقف ولكن على الحزب بدرجة أكبر. أمام هذا الوضع أصبح الكاتب مثلًا منبوذًا لا يحضر لقاءاته إلا القلة، وأصبح الكتاب قابعًا في رفوف المكتبات».
ويؤكد الخطيبي أن المغرب يزخر بأسماء لامعة في مجالات الفكر والأدب والترجمة والفلسفة وغيرها «ولا يلتفت إليها بل ويطالها نسيان غير مفهوم، بينما يتم تكريمها في المشرق، ويتم التنويه بها وبأعمالها في مختلف المحافل الثقافية والعلمية التي تحضرها. أكثر من ذلك بعض المغاربة يحصدون جوائز مهمة عن جدارة واستحقاق؛ لأن هذه الدول تؤمن بثقافة الاعتراف، وتولي أهمية خاصة للجانب الثقافي، وتشجع المجتهد. وفي المغرب لا نتذكر رموزنا الفكرية والأدبية إلا عندما يواريهم التراب مع الأسف».

جمال الموساوي
على حين عدّ الشاعر جمال الموساوي أن البؤس الثقافي «الذي يرين على واقعنا جزء من البؤس المجتمعي العام. لنقل إن البؤسَ وجه من أوجه المزاج العام لهذا المجتمع الشكاء البكاء. بهذا نكون إزاء صورة نمطية تلقي بالمسؤولية دائمًا على الآخرين. الآخرون الذين يفترض أن يشكلوا ذلك «الجمهور» الذي يحلم به المثقف وتسعى الثقافة (في مفهوم ضيق) لاستقطابه، كما تفعل مجالات أخرى مثل كرة القدم. والحال أن المشتغل بالثقافة إذ يصدر هذا النوع من الأحكام، فهو يتهرب من نصيبه من المسؤولية فيما آل إليه المشهد من ابتذال. إن الابتذال هنا، ليس حكمًا على الإنتاج الثقافي، بل توصيفًا لوضعية المشهد الثقافي العام، الذي من سماته اختفاء السؤال النقدي الذي يتطلب جهدًا فكريًّا خلاقًا والاكتفاء بالجاهز. لهذا مثلًا تحصل أغنية رديئة على إقبال «فظيع»، وتكتفي رواية أو أي كتاب أدبي أو فكري ببيع بضع عشرات من النسخ».
ويقول الموساوي: إن المشهد الثقافي «أصبح مليئًا بالنفاق، وبمظاهر التزلف، وأحيانًا بنوع من الناس الذين يعتقدون أنهم يمتلكون الحقيقة كاملة، وأنهم وحدهم الحاملون لمفاتيح المستقبل، وهذا لا يختلف عما لدى الكثير من الناس والجماعات السياسية والدينية والعرقية حيث لا مجال لطرح الأسئلة. إنه في هذا الأمر لا يكاد يختلف من يأتيه اعتراف من المشرق، أو يحاول أن يكرس نفسه انطلاقًا من موقعه هنا. لنتأمل المشهد ونعدد بعض الظواهر التي باتت لصيقة به، وتضفي عليه مسحة بئيسة. هناك تقريبًا في كل مدينة مهرجان ثقافي وأحيانًا أكثر بين الشعر والقصة والسينما والمسرح والموسيقا وغير ذلك من الأنشطة الثقافية، وهذه الكثرة ليست بالضرورة علامة صحية. ثم هناك أمر قريب من هذا، وهو غزارة في الإنتاج من الكتب والكتابات (دون مقارنة مع الآخرين)، لكن ليس هناك تطور مماثل في حجم القراءة وعدد القراء، فيظل هذا الإنتاج كاسدًا، بمساعدة ظروف محيطة، منها غياب إعلام ثقافي حقيقي بالرغم من الجهد الذي يبذله الأصدقاء المشرفون على الصفحات الثقافية في الجرائد اليومية، ومنها كذلك تراجع دور بعض المؤسسات كاتحاد الكتاب الذي غرق في أزمة نتيجة تضخم في بعض «الأنوات» وغلبة الطموحات الشخصية على العمل الثقافي لهذه المؤسسة».
ويرى الموساوي أنه لتحقيق هذه الآمال وإعادة إحياء الثقافة المغربية داخليًّا «لا بد من النظر إلى الشأن الثقافي نظرة واضحة، وأن يتم تقبل الثقافة كجزء لا يتجزأ من حياته، فهو على المستوى الباطني (لا يمتلكها ولا يستخدمها بحكمة) وعلى المستوى الخارجي ( الثقافة ليس لها وجود فعليّ واضح في حياته اليومية(. في الحالة الأخيرة، فإن المواطن المغربي لديه ميل لإعفاء نفسه من تعقيدات الأمور، وأن يصبح متفرجًا على محيطه وبيئته المباشرة، دون السعي إلى تعميق وعيه الثقافي وتوسيع مداركه المعرفية، وهذا ما دفع مجموعة من المثقفين المغاربة إلى العزوف عن الحراك الثقافي الداخلي. والانخراط في الحراك الثقافي الخارجي. أعتقد أن الوقت حان لإعداد ميثاق ثقافي وتأسيس مجلس أعلى للثقافة يدبر المجال الثقافي ويرسم الإستراتيجيات، ويضع البرامج ويمهد للتواصل والتفاعل بين المثقفين فيما بينهم داخل المغرب الذي يشهد فيه المثقفون انغلاقًا وانكماشًا، وبالمقابل هناك تفاعل مع المثقفين في الخارج خصوصًا مع المشرق؛ إذ نلاحظ حضورًا حيويًّا وانفتاحًا وتألقًا يتوج بجوائز ومكاسب ثقافية مهمة. كما ينبغي تفعيل دور وزارة الثقافة، التي لا تتحمل مسؤوليتها في خلق دينامية ثقافية؛ إذ تنحصر أنشطتها في الإشراف على بعض الأنشطة؛ كمعرض الكتاب، أو رعاية بعض الندوات أو المهرجانات دون السعي إلى إنتاج ثقافة والبحث عن أسباب إنتاج ثقافي».
سعيد يقطين : واقعنا الثقافي تفككت أوصاله
حساسيات تكونت في أوج الصراع الأيديولوجي

سعيد يقطين
متى يمكن أن تظهر الإمكانيات والطاقات في بلد ما؟ الجواب بسيط: عندما يكون المناخ الذي تعيش فيه سليمًا، ومشجعًا. ولكن عندما تنتفي هذه البيئة، فإن من يعمل على البحث عن تلك الطاقات والإمكانيات سيعثر عليها في المكان الذي لا يعترف بخصوصيتها. وينطبق هذا بصورة كبيرة على ما يجري في بلدنا ومكوناته الإعلامية والثقافية. إنهم يبحثون عن الطاقات والإمكانيات خارج فضائهم الخاص غير ملتفتين إلى ما يتحقق داخل مجالهم. وما يصدق في هذا المضمار على المؤسسات المختلفة، يسري مع الأفراد. وكل ما تسمعه عن «ثقافة الاعتراف» و«المصالحة مع الذات» ليس سوى لغو يوظف لأغراض ذاتية ومكاسب خاصة. إن واقعنا الثقافي لا تزال تُفكك أوصاله، تقاليد وحساسيات تكونت في أوج الصراع السياسي والأيديولوجي لحقبة ما بعد الاستقلال.
ورغم تغير الظروف والشروط نسبيًّا لا تزال تلك الذهنية التي هي وريث تلك الحساسيات هي السائدة والمتحكمة. لذلك لا غرو أن نرى تقييم الأعمال والأفراد تحكمه العلاقات والولاءات والانتماءات، وأخيرًا الانتهازية. وكلما كان تقدير العطاءات مؤسسًا على مثل هذه الأحكام والمواقف، يكون البحث في الخارج أو من داخل الحلقة، مع العمل على إقصاء وإلغاء من لا ينخرط في تلك العلاقات أو لا يقيم لها وزنًا.
بالنسبة إلي لا يغيظني هذا الواقع من وسائل الإعلام، ولا من المؤسسات الثقافية، ولا من بعض الزملاء. بل إني لا أفكر فيه ولا أهتم به. أشتغل وأعمل، لأني أعدّ هذا قدري الذي اخترته عن وعي، ولا تهمني ردود الأفعال، ولا أبحث عن موقع ولا كرسي. وحتى في خضم انخراطي في العمل السياسي والثقافي لم تكن وراء ذلك أي رغبة في تحصيل منفعة أو الحصول على مكاسب معينة. وعندما أنشر كتابًا جديدًا، لا أرغب في تعليق ملصق عنه في ردهات الكلية، ولا أخبر به أحدًا من الناس. لقد انتهى عملي بإصدار الكتاب، أو نشر المقال، وعليه أن يبحث عن موقعه بنفسه. وعندما يلقى ما أكتب الترحيب في كل الوطن العربي، ومن لدن الصادقين من المغاربة، أعدّ ذلك خير عزاء. ولكن مع ذلك، يحزّ في نفسي أحيانًا، أن أرى زامر الحي المغربي لا يطرب. وأقصد هنا كتابًا ومفكرين وفنانين آخرين غيري.
ناقد
—————————————————–
شعيب حليفي: نحن نعيش بؤسًا متعددًا

شعيب حليفي
مفارقات المشهد الثقافي المغربي هي من مفارقات المجتمع وما يحياه من تقلبات اجتماعية واقتصادية وسياسية. وأعتقد أن الثقافة المغربية عرفت صدمة قوية لا يزال أثرها جليًّا وسلبيًّا بشكل من الأشكال حينما شعر المثقفون بأن بعض أحلامهم بالتغيير، التي هي أحلام المجتمع، ستتحقق مع تجربة التناوب في المغرب، والتي يمكن أن تكون قد نجحت نسبيًّا على المستوى السياسي، ولكنها فشلت ثقافيًّا، وأفرزت بالتزامن مع ثورة معلوماتية وسيادة ثقافة البذخ والواجهة والجوائز ثقافات أخرى ومثقفين آخرين، كما تحولت الثقافة من فعل نضالي، بحكم وضعنا وحقيقتنا، إلى فعل اقتصادي أفرز نخبة من المثقفين «الخبراء» في مجالات الخطاب عامة، والبقية الباقية بقيت في مربعها «الطاهر» وسط أسوار تعلو يومًا بعد يوم، وتخفي بصيص تلك الأحلام.. فلا يجدون للقفز نحو تلك الأحلام إلا زانة مكسورة تزيد الوضع صعوبة.
إننا فعلًا نعيش حالات من التحول ومن التعايش مع ما استجد وما يستجد للإفاقة من الصدمة إفاقة صحية. فنحن نعيش بؤسًا متعددًا في ابتعاد المثقف من دوره التاريخيّ إنْ على المستوى الفعلي في الواقع أو فيما يُكتب من زخارف تقزم المعرفة والتخييل القادر على محاورتنا وتفكيك عَطبنا. وفي السياق ذاته، نحن جزء من عالمنا العربي الذي يسبقنا في انتصاراته وانتكاساته. فها نحن أمام تزايد هجرة المثقفين الجامعيين إلى الجامعات العربية والأوربية مما يُفرغ جامعاتنا ويهددها. والحال أن طلبتنا في أمسّ الحاجة إليهم لتطوير البحث العملي والبيداغوجي. كما بات العديد من دور النشر العربية متخصصًا في اقتناص التأليفات المغربية في شتى الأبواب. أتساءل بصيغة أخرى: هل كل هذا سلبي أم أنه مرحلة سيأتي ما بعدها؟ فما يقلقني اليوم هو استسلام المثقف المغربي وانعدام حماسه لأحلامه وأحلام الذين يكتب بأصواتهم.
ناقد وروائي



 تقدم الأعمال المترجمة للروائي الياباني كنزابورو أوي من اليابانية إلى اللغة الفرنسية الصادرة مؤخرًا خدمة أدبية جليلة للقارئ عمومًا. فترجماتها رصينة وانتقاؤها دقيق، ترصد حياته وأدبه على مدار عقود عدة. ولا ينحصر اهتمام دور النشر العالمية بنشر أعماله فحسب، بل يأتي الاهتمام أيضًا من كونه شخصية ثقافية مثيرة للجدل في اليابان. فهو يحتل اليوم واجهة الإعلام الياباني بحكم معارضته الشرسة للاستخدامات النووية العسكرية والمدنية. ولد كنزابورو أوي في عام 1935م في قرية شيكوكو من مقاطعة إيهايم باليابان، وحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1994م، وهو واحد من الشخصيات الأكثر نشاطًا ثقافيًّا وأدبيًّا وسياسيًّا. ألف كتابًا مؤلمًا عن هيروشيما، نشر في عام 1965م (أعيد إصداره مؤخرًا ضمن سلسلة كتاب الجيب)، وقد منحته الكارثة البيئية والإنسانية في فوكوشيما الفرصة لتوسيع نطاق هذا الالتزام برفض الطاقة النووية المدنية من دون التخلي عن إنعاش الذاكرة الجماعية، منبِّهًا إلى نتائج مأساة هيروشيما وناغازاكي، وفي هذا الصدد كتب كثيرًا من المقالات وأجرى عددًا من المقابلات، كما التمس من رئيس الوزراء التخلي عن الطاقة النووية وجمع أكثر من سبعة ملايين توقيع تؤيد موقفه.
تقدم الأعمال المترجمة للروائي الياباني كنزابورو أوي من اليابانية إلى اللغة الفرنسية الصادرة مؤخرًا خدمة أدبية جليلة للقارئ عمومًا. فترجماتها رصينة وانتقاؤها دقيق، ترصد حياته وأدبه على مدار عقود عدة. ولا ينحصر اهتمام دور النشر العالمية بنشر أعماله فحسب، بل يأتي الاهتمام أيضًا من كونه شخصية ثقافية مثيرة للجدل في اليابان. فهو يحتل اليوم واجهة الإعلام الياباني بحكم معارضته الشرسة للاستخدامات النووية العسكرية والمدنية. ولد كنزابورو أوي في عام 1935م في قرية شيكوكو من مقاطعة إيهايم باليابان، وحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1994م، وهو واحد من الشخصيات الأكثر نشاطًا ثقافيًّا وأدبيًّا وسياسيًّا. ألف كتابًا مؤلمًا عن هيروشيما، نشر في عام 1965م (أعيد إصداره مؤخرًا ضمن سلسلة كتاب الجيب)، وقد منحته الكارثة البيئية والإنسانية في فوكوشيما الفرصة لتوسيع نطاق هذا الالتزام برفض الطاقة النووية المدنية من دون التخلي عن إنعاش الذاكرة الجماعية، منبِّهًا إلى نتائج مأساة هيروشيما وناغازاكي، وفي هذا الصدد كتب كثيرًا من المقالات وأجرى عددًا من المقابلات، كما التمس من رئيس الوزراء التخلي عن الطاقة النووية وجمع أكثر من سبعة ملايين توقيع تؤيد موقفه.
 ● أرنو فولران: كنت في الثانية والعشرين عندما نشرت عملًا غريبًا؛ هل كنت تشعر أنك كاتب؟
● أرنو فولران: كنت في الثانية والعشرين عندما نشرت عملًا غريبًا؛ هل كنت تشعر أنك كاتب؟

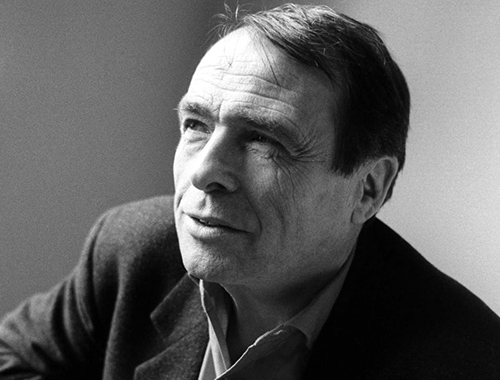

 حاول الباحثُ- (استنادًا إلى قراءة قريبة جدًّا من أعمال «بورديو» جنبًا إلى جنب مع أدبيات «بورديو» السوسيولوجية الوفيرة، مع العلم أن رصيد بيير بورديو ثلاثون كتابًا ومئات الدراسات والمقالات) تحليلَ «تاريخانية» التطورات المتلاحقة التي عرفتها المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع. وهذا مكّن «جان لويس فابياني» من تسليط الضوء على التطور التدريجي لها عند «بورديو» منذ عام 1960م، إضافة إلى بعض التناقضات المتنامية الميّالة إلى التعميم، كما مكّن هذا التحليل المفصل للمفاهيم الثلاثة المؤلفَ بدرجة أكثر أو أقل من التوصل إلى تفكيك أهم المفاهيم.
حاول الباحثُ- (استنادًا إلى قراءة قريبة جدًّا من أعمال «بورديو» جنبًا إلى جنب مع أدبيات «بورديو» السوسيولوجية الوفيرة، مع العلم أن رصيد بيير بورديو ثلاثون كتابًا ومئات الدراسات والمقالات) تحليلَ «تاريخانية» التطورات المتلاحقة التي عرفتها المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع. وهذا مكّن «جان لويس فابياني» من تسليط الضوء على التطور التدريجي لها عند «بورديو» منذ عام 1960م، إضافة إلى بعض التناقضات المتنامية الميّالة إلى التعميم، كما مكّن هذا التحليل المفصل للمفاهيم الثلاثة المؤلفَ بدرجة أكثر أو أقل من التوصل إلى تفكيك أهم المفاهيم. 








