
بواسطة تركي الحمد - كاتب سعودي | مارس 1, 2021 | مقالات
مثلما «إرادة الحياة» لدى أرثر شوبنهور (1788- 1860م)، أو إرادة «العقل المطلق» لدى جورج فيلهلم هيغل (1770- 1831م)، تشكل المحور الرئيس الذي تدور حوله فلسفاتهما، فإن «إرادة القوة» هي المحور الرئيس الذي تدور حوله فلسفة فريدريك نيتشه (1844- 1900م). فالقوة هي مهماز حركة التاريخ، والعامل الذي يقف وراء قيام الحضارات وسقوطها، وذاك هو قانون الطبيعة في اصطفاء «الجيد» ونبذ «الرديء»، وفق تعبيرات نيتشه، بعيدًا من مقولات الخير والشر السائدة.
ليس الغرض هنا عرض لفلسفة نيتشه عامة، ولكن فلسفته الأخلاقية هي التي نحاول أن نلقي عليها بعض الضوء، وبخاصة في ظل أوضاع العالم المعاصرة، ومحاولة تفسير بعض أحداث العالم من خلالها. في استعراض نيتشه لتاريخ الأخلاق في هذا العالم، ومصدرها وأثرها، يفرق في النهاية بين صنفين من الأخلاق: أخلاق السادة وأخلاق العبيد، أو الأخلاق التي كان منبعها الممتازين من البشر، وتلك التي كان مصدرها الرعاع والطبقات المنحطة، وفق تعبيره.
أخلاق السادة تقوم على القوة، والقوة وحدها، فالسيد الأرستقراطي همه السيطرة و«البطولة»، ومن أجل ذلك فهو يسحق ويدمر ويشتت ويفترس كالأسد، من دون مراعاة لتلك القيم التي مصدرها «العبيد» غير القادرين على المنافسة في حلبة القوة، مثل العطف والرحمة والإنسانية، التي هي مجرد رد فعل بائس عاجز عن قوة واستبداد «الأسياد»، والأخلاق الأرستقراطية.
أخلاق السادة هي أخلاق أسد لا قيد يمنعه من ممارسة الافتراس، وأخلاق العبيد هي أخلاق دودة زاحفة على الأرض لا حول لها ولا قوة؛ لذلك أفرزت أخلاقًا للمقاومة، وصمت ما يفعله السيد بالشر، وما تدعو إليه هو الخير، بينما الحقيقة، وفق فلسفة نيتشه، أنه لا خير ولا شر، بل هناك جيد ورديء، فما يتوافق مع قانون الانتخاب أو الاصطفاء الطبيعي هو الجيد، وما يحاول عرقلة هذا الاصطفاء هو الرديء.
من هذا المنطلق، كان نيتشه رافضًا للمسي حية واليهودية، التي يرى أنها أول من دشن أخلاق العبيد، بل كل الأديان والمذاهب والفلسفات التي تمجد أخلاق العبيد من رحمة وإنسانية وغيرها من قيم هي ضد طبيعة الحياة وقانونها الأوحد، أي القوة. ويلخص نيتشه فلسفته الأخلاقية بالقول بأن تاريخ البشرية كله يمكن إيجازه بعبارة «روما ضد يهوذا، ويهوذا ضد روما»، والصراع الأزلي بين روما ويهوذا، هو المحدد لمصير الإنسان.
مصداقية تاريخية
بعيدًا من الاتفاق أو الاختلاف مع نيتشه في فلسفته الأخلاقية، فإننا نجد الكثير من المصداقية التاريخية في نظرته وتحليله. نشوء الدول والحضارات العظمى كان دائمًا على أيدي نخب (أرستقراطية) لم تكن تكترث لا كثيرًا ولا قليلًا بأخلاق «العبيد»، من رحمة وشفقة وحقوق إنسانية معينة، وفي تاريخنا العربي الإسلامي أمثلة عديدة، ناهيك عن بقية العالم، على تلك الأخلاق النيتشوية السامية، لعل من أبرزها مقولة زياد بن أبيه (623- 673م) في خطبته البتراء: «وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى، والمقيم بالظاعن، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، والصحيح منكم بالسقيم، حتى يلقى منكم الرجل أخاه فيقول:« انجُ سعدُ، فقد هلك سعيد».
أو مقولة المؤسس الثاني للدولة الأموية، عبدالملك بن مروان (646- 705م)، حين بشر بالخلافة بعد وفاة أبيه مروان بن الحكم (623- 685م)، وكان يقرأ القرآن بجوار الكعبة، فقال قولته الشهيرة: «هذا آخر العهد بك»، في انتقال كيفي من أخلاق العبيد إلى أخلاق السادة، «فالملك عضوض»، كما قال حين قتل ابن عمه الطامع في الخلافة، وبناء الدول لا يحتمل إلا ممارسة قيم السادة، وأرستقراطية لا تعترف بغير ذاتها وقيمها.
ولذلك حين جاء عمر بن عبدالعزيز (682- 720م)، قتل مسمومًا لأنه حاول الخروج من دائرة أخلاق السادة، وبذلك أصبح لا ينتمي فعليًّا إلى تلك النخبة الأرستقراطية من السادة. أما في أوربا، فلعل أبرز مثال على الأخلاق النيتشوية هو رودريغو بورجيا (1431- 1503م) الذي أصبح فيما بعد البابا ألكسندر السادس، ولكن ذلك لم يمنعه من ممارسة أي شيء وكل شيء في سبيل السلطة، وفي سبيل إعادة بناء روما وتوحيدها.
بدأ اضمحلال الإمبراطورية الرومانية، ثم سقوطها في نهاية المطاف، حين غزتها «أخلاق العبيد»، مجسدة في المسيحية، فكانت لقمة سائغة للقبائل الجرمانية، وسقطت نهائيًّا عام 476م. كانت روما وكانت الإمبراطورية في أوج عزها وقمة مجدها، حين كانت الأخلاق الوثنية، أخلاق الآلهة المتصارعة، أو أخلاق السادة، هي التي تحكمها، وانهارت حين التحول إلى أخلاق العبيد المهادنة والمستكينة، كما يرى نيتشه.
ولماذا نذهب بعيدًا وأمامنا ما يحدث في الولايات المتحدة، فالبعض يرى أن أميركا اليوم في حالة انحدار، وأن الدولة الأميركية لم تعد بتلك القوة وذاك البريق الذي كانت في الماضي، نتيجة التغيرات الاجتماعية والثقافية التي أحدثته الهجرة الجديدة إليها من دول ومناطق مختلفة ثقافيًّا واجتماعيًّا وأعراق غير أوربية المنشأ. بمعنى آخر، بدأ الانحدار الأميركي، أو لنقل أفول القوة الأميركية، حين بدأ التخلي التدريجي عن الثقافة الأنغلوسكسونية البروتستانتية البيضاء، وهيمنتها على كل ذرة في المجتمع الأميركي، وفق رأي بعض المحللين.
فأميركا الأربعينيات والخمسينيات ومعظم الستينيات، كانت في أوج قوتها حين كانت بيضاء الثقافة، حتى بدأت حركة الحقوق المدنية مع مارتن لوثر كينغ جونيور، ومالكوم إكس وغيرهما، ثم جاءت الهجرات الجديدة من مناطق غير أوربية، فبدأت السيادة الأنغلوسكسونية البيضاء في الانحسار، مع ما رافق ذلك من أفول، أو بداية أفول، للهيمنة الأميركية العالمية.
مثل هذا التحليل يصب في قلب الفلسفة الأخلاقية النيتشوية، حتى لو لم يدرك المحلل أنه نيتشوي الهوى. فأخلاق «السادة» هنا هي التي حددتها الثقافة الأنغلوسكسونية البيضاء، التي أجهزت على السكان الأصليين لأميركا واجتثت ثقافاتهم المحلية، وجلبت العبيد السود من ساحل إفريقيا الغربي، ثم حين تحرروا جزئيًّا، حرموا من حقوقهم المدنية كمواطنين في دولة تصف نفسها في نشيدها الوطني بـ«أرض الأحرار، وموطن الشجعان».
أما أخلاق «العبيد»، فهي كل تلك التي طالبت بها منظمات وحركات الحقوق المدنية، وفئات الشعب غير البيضاء، من مساواة وحرية ونبذ للعنصرية بكل أشكالها. لم تعد أميركا في العقود الأخيرة دولة تجسد النموذج النيتشوي في أخلاق السادة، بل أصبحت تميل أكثر إلى نموذج العبيد، ولذلك فإن الصين مثلًا تهدد سيادتها العالمية؛ لأنها، أي الصين، أكثر قربًا من أخلاق السادة النخبوية.
لَعِبٌ في الوقت الضائع
وعندما وصل ترمب إلى سدة السلطة الأميركية، كان يحاول حقيقة أن يعيد أميركيا إلى حقبة الهيمنة الأنغلوسكسونية، من خلال شعاره «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، سواء أدرك ترمب أنه نيتشوي الإيحاء أو لم يدرك، ولكنه حقيقة كان يلعب في الوقت الضائع، فالمجتمع الأميركي أصبح متعدد الأعراق والثقافات بشكل أكبر بكثير مما كان عليه، وهذا مما سيكون له أثر كبير في توجهات الولايات المتحدة مستقبلًا.
أما النموذج الأنقى للأخلاق النيتشوية فهو ألمانيا النازية (1933- 1945م)، حيث كانت هناك نخبة سياسية تؤمن بجلاء بقيم السادة السامية، وقيم العبيد المنحطة. ففي كتاب «كفاحي» لأدولف هتلر (1889- 1945م)، حتى قبل أن يصل إلى السلطة في عشرينيات القرن العشرين، كان قد فرق بين الأعراق من حيث السمو والدونية، فكان العرق الآري هو أرقى الأعراق، والمحرك للتاريخ، بينما العرق السامي (اليهود) في ذيل قائمة الأعراق، وسم الأفعى في التاريخ لكافة الشعوب، أما العرب، فكان هتلر يعدُّهم أرقى من اليهود والسود، ولكنهم لا يصلون إلى مستوى الشعوب البيضاء والصفراء.
وحين وصل حزبه إلى السلطة، بدأ بتنفيذ ما وعد به هتلر، من تصفية للأعراق الدنيئة (اليهود والغجر خاصة)، إضافة إلى أولئك الذين لا يستحقون الحياة، وفقًا للنظرة النازية النيتشوية، من خَدِيجِين ومصابين بأمراض عقلية أو جسدية لا شفاء لهم منها. لقد كانت «إرادة القوة» هي المحرك الأول والأخير للسياسة النازية، كما كانت لب فلسفة فريدريك نيتشه عامة.
أنا شخصيًّا، لست مؤمنًا إيمانًا مطلقًا بفلسفة نيتشه الأخلاقية، بقدر ما أميل إلى فكرة إيمانويل كانط (1724- 1804م)، حول «الواجب الأخلاقي»، التي منها نستقي قيمنا حول الإنسانية والحرية والشعور بالتعاطف مع الآخرين؛ إذ ما معنى الحياة إذا كانت القوة وحدها هي المؤطر لعلاقاتنا، فأين الجمال وأين الحب، وأين تلك العاطفة التي نرى فيها طفلًا جائعًا أو مريضًا يتألم.
الحياة تفقد الكثير من جمالها حين تسود قيم «السادة» فقط؛ إذ تصبح جافة لا ماء فيها، حتى الماء يفقد مأوه. قد تكون تلك القيم، أي قيم السادة النيتشوية، ذات صلاحية معينة في العلاقات بين الدول، ولكنها حتمًا غير صالحة في العلاقات بين البشر.
كخاتمة لمقال لا أريد له أن يطول، هنالك حكاية صغيرة لا بد أن تروى. في أخريات أيامه، وعندما أصيب نيتشه بذاك المرض الذي أودى به إلى الجنون، ويقال: إنه السِّفِلِس، لم يجد نيتشه من يعتني به سوى أمه ثم أخته، وهو العاجز شبه المشلول، فما هو الدافع لسلوكهما ذاك، قطعًا ليست أخلاق السادة، بل هو الحب والشعور بالواجب، ولعل في ذلك أبلغ رد عملي على فيلسوف «الإنسان الأعلى» فريدريك نيتشه.

بواسطة تركي الحمد - كاتب سعودي | يناير 1, 2021 | مقالات
في طرفة تراثية، يقال إن أحدهم مر بباب الجامع ذات يوم، فوجد فقيهًا معروفًا يبكي بحرقة، فاستغرب ذلك، ودفعه الفضول للاقتراب منه وسؤاله عما يبكيه، فقال له الفقيه ما معناه أنه ومنذ ثلاثين عامًا وهو مؤمن بقضية ما، واليوم اكتشف بطلان تلك القضية، فقال له الرجل إنه يجب أن يكون سعيدًا لهذا الاكتشاف لا أن يبكي! فرد عليه الفقيه قائلًا إنه لا يبكي من أجل ذلك ولكنه يبكي خشية أن تكون القضية الجديدة التي يؤمن بها باطلة أيضًا، ويدركه الموت دون أن يكتشف ذلك.
وليس منا اليوم من لا يعرف قصة «دون كيخوته»، أو دون كيشوت في الترجمات العربية، أو «دون كيخوتي دي لا ما نشا» في أصلها الإسباني، لمؤلفها الأديب الإسباني ميغيل دي سيرفانتس (1547 ـ 1616م). بطل هذه الرواية الخالدة هو: «ألونسو كيكانو»، العجوز الثري الذي يقضي وقته في قراءة سير الأبطال وقصص مغامراتهم، وبخاصة سير فرسان العصور الوسطى، حتى تملكه حب أولئك الفرسان وأصبح مسكونًا بهم، فأراد أن يكون واحدًا منهم، وفي عصر لم يعد فيه وجود للفرسان وأخلاقياتهم. وتحت وطأة الهاجس، أو لنقل الهوس، فقد امتطى «ألونسو كيكانو» صهوة جواد، وحمل رمحًا كذاك الذي كان يحمله فرسان العصور الوسطى، وأخذ يحارب طواحين الهواء من حوله، متخيلًا أنها تنانين جبارة، وإلى جانبه كان يسير تابعه «سانشو» الساذج والمسلوب الإرادة. تنتهي هذه «الملحمة»، أو الكوميديا السوداء، باكتشاف دون كيخوته وهو على فراش الموت، أنه كان على ضلال طوال حياته، وأن كل عمره المنصرم كان قائمًا على وهم، أو سلسلة مترابطة من الأوهام، وأن «الحقيقة» كانت على مقربة منه، بل تحيط به من كل اتجاه، ولكنه كان غافلًا عنها بأوهام عقل مضطرب، أو مشوش في أفضل الأحوال.
وفي الفلم الأميركي المتميز «التاريخ الأميركي إكس» بطولة ممثل الأدوار الصعبة والمعقدة «إدوارد نورتون»، الذي يقوم فيه بدور «ديريك»، الأميركي النازي المتحمس، وإلى جانبه شقيقه الأصغر «داني» (إدوارد فورلونغ)، الذي يرى في شقيقه الأكبر قدوة حياة، فيسير على دربه في فكره وسلوكه، نرى كيف أن ديريك يقتل شخصين أسودين كانا يحاولان سرقة سيارته بدم بارد، ودون أن يكون هناك مبرر للقتل بعد إيقاف اللصين، ولكنه الحقد العنصري، فيدخل ديريك السجن، وهناك يتحول تحولًا جذريًّا، فتتغير قناعاته لدرجة أن يصبح له صديق أسود.
يخرج ديريك من السجن شخصًا جديدًا، ولكن شقيقه داني باقٍ على أفكاره النازية، وعضو في منظمة نازية، فيحاول ديريك أن يغيره وينجح في ذلك، ولكن داني يقتل في النهاية في المدرسة، على يد مراهق أسود كان له موقف مع داني في السابق، وينتهي الفلم بكوميديا سوداء أيضًا، حيث يُقتل داني وقد تحول عن معتقده العنصري.
ما الذي يربط بين هذه القصص الثلاث، وغيرها كثير؟ وفي هذا المجال، أذكر أنه كان لي صديق شيوعي، وفق التفسير السوفييتي، أو الماركسي اللينيني، لم يستطع أن يصدق أن الاتحاد السوفييتي قد سقط عام 1991م، وأن الشيوعية السوفييتية قد انتهت بلا رجعة، وبقي على هذه الحال لعدة سنوات وهو يعتقد أن الأمر كله عبارة عن مؤامرة أميركية، وأن السوفييت عائدون بهذا الشكل أو ذاك في يوم من الأيام نتيجة إرادة شعبية. نعود إلى السؤال المطروح آنفًا: ما الذي يربط بين كل هذه القصص المختلفة؟ الجواب بكل بساطة هو الوهم.
وهم الماضي وجمالياته
فالفقيه الذي كان يبكي على باب الجامع، كان مسكونًا بوهم «الحقيقة» التي اعتقد أنه حصل عليها أخيرًا، فإذا بها تتكشف في النهاية عن وهم لم يلبث أن انجلى. ودون كيخوته كان مسكونًا بوهم الماضي وجمالياته، وفق ما يظن، فإذا الأمر يتكشف عن حقيقة أن الماضي قد ولى وانتهى، وما انتهى لا يعود مهما أحببناه وحاولنا نفخ الروح فيه.

ميغيل دي سيرفانتس
وديريك اكتشف في النهاية أن التفوق العرقي، مهما كانت دوافعه ومبرراته، ليس إلا أكذوبة مصطنعة، فالناس في النهاية سواسية يرجعون إلى عرق واحد لا ثاني له، هو العرق الإنساني، وما حكاية التفوق العرقي والقول به إلا وهم لا يلبث أن ينجلي، طال الوقت أم قصر. بطبيعة الحال، فإن كل وهم من هذه الأوهام، وأوهام الحياة عديدة ومختلفة، له خلفياته وأسبابه التي يمكن إدراكها في النهاية، ولكن كل ذلك لا ينفي أن كثيرًا من الأوهام تسير حياتنا، وتصيغ نظرتنا إلى طبيعة الأشياء والعلاقات، وتشكل مفاهيمنا في هذه الحياة وعنها، فالأشياء والعلاقات وشؤون الحياة لا معنى لها دون أن نسبغ نحن، أفرادًا وجماعات، عليها المعنى.
والحقيقة، إن كان هناك حقيقة، أنه من أصعب الأمور على المرء أو الجماعات أن تكتشف وهم حياتها في هذه اللحظة أو تلك من الزمان، ولذلك بكى ذلك الفقيه، لا لخوفه من الوقوع في وهم الحقيقة ثانية، كما قال للسائل عن سبب بكائه، ولكن لسقوط وهم حياته الذي يضفي المعنى على هذه الحياة. وموت دون كيخوته في النهاية ليس إلا بسبب فقدان معنى الحياة بالنسبة له، بعد أن سقطت كل أوهامه، أما ديريك، فلا أشك في أنه سيقضي بقية حياته في حالة ندم شديد على تلك الأيام من عمره، التي لوثت فيها العنصرية نظرته للحياة ومعانيها، والتي أدت في النهاية إلى مقتل شقيقه المحبوب.
وأوهام الحياة ليس بالضرورة أن تكون فردية بحتة، كما في قصصنا الثلاث، بل قد تكون أوهامًا جماعية، وذلك وهم التفوق العرقي الذي ساد ألمانيا إبان الفترة النازية، أو وهم العظمة الذي ساد إيطاليا إبان الحقبة الفاشية، أو شعب الله المختار لدى اليهود، أو وهم خير أمة أخرجت للناس لدى المسلمين.
وهي أوهام لأنها تسكن عقول معتنقيها والقائلين بها، دون أن يكون لها سند من واقع معيش، وذلك مثل أوهام دون كيخوته وطواحين الهواء. والوهم الجماعي أشد خطرًا في أثره وآثاره من الوهم الفردي، فالوهم الفردي أثره ونتائجه لا يتعدى دائرة الشخص الواحد، أما الوهم الجماعي فدائرته هي كل الجماعة، مجتمعًا كانت تلك الجماعة أو دولة أو أمة.
ثمالة الوعي الجماعي
وحتى بعد الإفاقة من ثمالة الوهم الجماعي، يكون الضرر الكارثي قد وقع. فوهم تفوق العرق الآري النازي، أدى في النهاية إلى دمار أمة كاملة هي الأمة الألمانية، وإلى كارثة عالمية هي الحرب العالمية الثانية، وضحاياها من البشر والشجر والحجر. ووهم خلق جنة الله على الأرض، ذلك الوهم الشيوعي الذي كان أثيرًا لدى كارل ماركس، أدى إلى إفقار دول مثل الاتحاد السوفييتي السابق، والصين وغيرها حتى أفاقت من الوهم، ولكن بعد أن سالت الدماء أنهارًا من أجل وهم ولا أقول حلم، وشتان بين الوهم والحلم، فالحلم طموح والوهم توهان.
ولماذا نذهب بعيدًا ولدينا في عالم العرب والمسلمين أمثلة صارخة على تحكم أوهام جماعية بالعقل الأسير، فما الرسالة الخالدة والمهمة التاريخية لأمة العرب، في الخطاب القوموي العربي، أو التمكين في الأرض والإثخان فيها في الخطاب الإسلاموي، إلا غيض من فيض أوهام تكبل العقل العربي والمسلم من الإسهام الحضاري في هذا العالم.
بل إن سياسة مثل سياسة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، القائمة على وهم إعادة الخلافة والسلطنة العثمانية البائدة، أو سياسة ملالي قم وطهران بتمهيد الأرض وتهيئتها لعودة الإمام الغائب، الذي سيملأ الأرض عدلًا بعد أن امتلأت جورًا، هو نوع من أوهام جماعية لا شك عندي في أنها سوف تدمر إيران وتركيا معًا، فنتائج الوهم دائمًا مدمرة، هكذا يقول التاريخ.
وسواء كان الوهم فرديًّا أو جماعيًّا، فإن الإفاقة من ثمالته وخدره ممكنة، بعد معاناة وكوراث بطبيعة الحال، كما في الحالة الألمانية مثلًا، ومحاولة إصلاح ما أفسده الدهر ممكنة أيضًا، ولكن ما لا يمكن تداركه أو إصلاحه هو المكابرة في الأمر، أو قاعدة «فأخذته العزة بالإثم»، وبذلك أعني أن تتكشف الحقيقة المعيشة للفرد أو الجماعة، فيذوي الوهم ويتلاشى، ومع ذلك يتمسك به صاحبه وهو يعلم أنه وهم.
ولعله يكون معذورًا في ذلك، فوهمه يشكل معنى حياته، ولا معنى للحياة بدونه إن لم يكن هنالك بديل، ولكن تفهم الوضع البائس لصاحب الوهم المكابر، لا يعني أن الحياة ستتوقف عنده وعند أوهامه، بل إنها تسير، ويسحق هامته دولابها، ولعل هذه هي حالة كثير من العرب والمسلمين وجماعات أخرى في هذا العالم.
خلاصة القول في موضوع يبدو أنه طال، هو أنه ليس من الخطيئة أن يكون لدينا أوهام حياة، بل ربما كانت الحياة كلها مجرد وهم، ولكن الخطيئة كل الخطيئة ألا نفيق من تلك الأوهام.

بواسطة تركي الحمد - كاتب سعودي | نوفمبر 1, 2020 | مقالات
منذ القرن الخامس الميلادي حتى القرن الخامس عشر، أي منذ سقوط الدولة الرومانية الغربية حتى إرهاصات عصر النهضة الأوربية، عاشت القارة الأوربية ظلامًا معرفيًّا وفكريًّا دامسًا لمدة ألف عام من الزمان، ولذلك أطلق على هذه الحقبة من التاريخ الأوربي «العصور المظلمة».
خلال هذه الحقبة، تجمدت الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، في طول أوربا وعرضها، فسادَ الإقطاع في الأرض، وحكم الأباطرة المقدس، وهيمنة الكنيسة ورجال الدين من الإكليروس، وتحكم الخرافة في العقول، وفوق ذلك كله، وهو موضوعنا هنا، جمود وتبلُّد العقل القروسطي على مقولات ثابتة تدور في فلك الدين ولا شيء غيره، وتعتمد على منهج ينتج حقيقته وفق آليات فكرية لا تتعداها، هي آليات «القياس والاستنباط» لنصوص ثابتة من الكتاب المقدس لا تتعداها، ثم من نصوص منتقاة من فلسفة أرسطو، للتوفيق بينها وبين نصوص الكتاب المقدس، أو محاولة التوفيق بين الوحي والعقل، وفق تصورهم، وهو الأمر الذي بلغ مداه مع الفيلسوف توما الأكويني، الذي كان متأثرًا كثيرًا بكتابات القاضي ابن رشد (أفيروس) في الأندلس.
هذا النهج الذي يعتمد القياس والاستنباط، كطريق وحيد «للحقيقة»، يسمى «المدرسية» أو «السكولاتية» و«أهم الصفات التي يتميز بها هذا التعليم ارتباطه بعلم اللاهوت، وتوفيقه بين الوحي والعقل، واعتماده في البحث على طرق القياس البرهاني، وعلى تفسير النصوص القديمة، ولا سيما نصوص أرسطو» (المعجم الفلسفي، الدكتور جميل صليبا، الجزء الثاني، دار الكتاب اللبناني، 1982م، ص 369).
بمعنى أن هذه المدرسة الفكرية لا تستقي معلوماتها من الواقع المتغير كمرجعية، بل يكون النص الثابت، والمقدس في أكثر الأحيان، هو المرجعية الوحيدة لكل أنواع المعارف، فيشرع ويقسم ويُؤَوّل ويفسر استنباطًا وقياسًا وتفريعًا وفق منطق معين، حتى لو كانت «الحقائق» المستنبطة تتعارض مع أبسط وقائع الحياة، بل أحيانًا مع البديهيات الملموسة والمَعِيشة، فلا يناقش «الثالوث المقدس» مثلًا، بوصفه منافيًا للعقل وطبيعة الحياة وقوانينها الطبيعية، بل كأصل ثابت، ومرجعية معينة، وما على الباحث إلا محاولة إثبات هذا الأصل وفق آلية استنباطية معينة، أو «قياس فرع على أصل»، وهو الثالوث المقدس في مثالنا، للوصول إلى «حقيقة» معينة.

طه حسين
مثل هذا «الباراديم»، أو النموذج الإبستمولوجي (المعرفي) الذي يؤطر لطرق الوصول إلى الحقيقة، أبقى أوربا والفكر الأوربي أسيرًا في شرنقة من التخلف الفكري، ضمن دائرة مفرغة لا نهاية لها من الإعادة وإعادة الإعادة، حتى بزوغ عصر النهضة، وحقبة التنوير، التي أعادت العقل النقدي إلى الثقافة الأوربية، وحررته من الشرنقة الفكرية المدرسية، وسمحت لفراشة المعرفة أن تحلق من جديد.
مع ديكارت كانت البداية للعقل الأوربي الحديث، وبطبيعة الحال لا نعني أسماء مثل سبينوزا وكانت وفولتير وديدرو وبقية فلاسفة الموسوعة، ولكن ديكارت له قَصَبُ السَّبْقِ والريادة في هذه المجال، حيث إنه بدأ من الصفر حين ألغى كل فكر سابق، وفق «الكوجيتو» المنسوب إليه. يقول رينيه ديكارت: «أنا أفكر، إذن أنا موجود»، جملة في غاية البساطة، ولكنها زلزلت كيانًا فكريًّا بقي مهيمنًا، ولا كيان غيره،
لمئات السنين.

زكي نجيب محمود
منهجية الشك هذه ألغت كل ما هو متعارف عليه من معرفة سابقة غير يقينية تمام اليقين، أو «قطيعة معرفية»، كما حددها «غاستون باشلار»، ولا يبقى شيء يقيني إلا «الأنا»، فطالما أنا أشك، فلا بد يقينًا أنني موجود؛ إذ لا يعقل أن يوجد شكٌّ من دون وجود شاكٍّ. جعل ديكارت من هذه «الأنا» الشاكّة، حجر زاوية لفلسفة، زلزلت الكيان الفكري الأوربي لسنوات كثيرة قادمة، وكانت إرهاصًا للأزمنة الحديثة. وبهذه المناسبة، فقد حاول طه حسين أن يطبق المنهجية الديكارتية في كتابه «في الشعر الجاهلي»، ولكن الإكليروس الديني الإسلامي ثار ضدَّه، فاضطر إلى التراجع لاحقًا.
مع ديكارت وصحبه التاريخيين من فلاسفة النهضة والتنوير، ترك العقل الأوربي منهجية القياس والاستنباط المدرسية كمرجعية وحيدة لاستشفاف «الحقيقة»، من خلال نص لا يأتيه الباطل من أمامه أو من خلفه، وفتحوا كتاب الطبيعة والحياة المَعِيشة بكل تفاصيلها وأفعالها وانفعالاتها، وفي ذلك يقول فيلسوف الوضعية المنطقية،
الدكتور زكي نجيب محمود: «لقد كان العامل الأول في النهضة الأوربية هو تحول الناس من حالة الاكتفاء بما كتب الأقدمون، إلى كتاب الطبيعة المفتوح لكل من أراد منهم أن يقرأ علمًا جديدًا… (تجديد الفكر العربي، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الخامسة، 1978م، ص 54)».
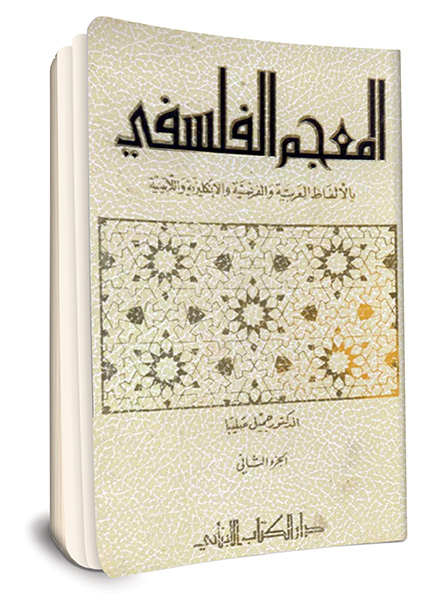 بالانتقال إلى ثقافتنا العربية والإسلامية، بل بالانتقال إلى مجمل حياتنا، السياسي منها والاجتماعي حتى الاقتصادي، نجد أنها في مجملها قائمة على آلية القياس والاستنباط، والبحث عن الأصل لإلحاق الفرع به لاتحاد العِلّة، وفق تعبير الإمام الشافعي، ووفق مقولة: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»، وهذه المقولة في حدّ ذاتها قياس.
بالانتقال إلى ثقافتنا العربية والإسلامية، بل بالانتقال إلى مجمل حياتنا، السياسي منها والاجتماعي حتى الاقتصادي، نجد أنها في مجملها قائمة على آلية القياس والاستنباط، والبحث عن الأصل لإلحاق الفرع به لاتحاد العِلّة، وفق تعبير الإمام الشافعي، ووفق مقولة: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»، وهذه المقولة في حدّ ذاتها قياس.
حين جعل الإمام محمد بن إدريس الشافعي من القياس مصدرًا من مصادر التشريع، بعد القرآن والسنة والإجماع، في كتابه «الرسالة»، ربما لم يكن يعلم أنه قد حدد الأطر التي لا تتجاوزها الحياة العربية في مختلف المجالات، وليس في مجال «استنباط» الأحكام الشرعية في الفقه فقط، فأصبحت الحياة العربية، ولا أستثني العديد من بلاد المسلمين، مجرد إلحاق فرع بأصل، رغم أن هذا لم يكن هو الوضع قبل الشافعي، بل قبل نشوء المذاهب الفقهية الكبرى، فكلنا يعرف اجتهادات عمر بن الخطاب التي عطل فيها نصوصًا من الكتاب والسنة، وكانت مرجعيته في ذلك المصلحة العامة للجماعة، وليس القياس، وإلحاق فرع بأصل.
بل كلنا يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، المؤكّد أن مرجعية أحكام المعاملات الدنيوية، أو القوانين التي تنظم أمور الحياة البشرية في هذا المجال، هي الحياة ومتغيراتها، وليس نصوصًا ثابتة، قد يكون هنالك سياق خاص بها حياتيًّا، أو ظروف تنزيل معينة، أو قصد بها التخصيص وليس التعميم، أما أمور العبادات والماورئيات، فهذه يحكمها النص الثابت، حين يصح ثباته، ولكن آفة الفكر الفقهاء وقياساتهم التي ألغت مرجعية وآلية كل واقع، وأبقت آلية القياس والاستنباط كي لا يكون في الساحة غيرهم، عدا نفر قليل منهم، وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة النعمان، صاحب مدرسة الرأي في تاريخنا الفقهي، رغم أن تلامذته حوّلوا فقهه إلى نصوص يقاس عليها،
ونسوا المرجع الأول الذي استند إليه أبو حنيفة، ألا وهو الواقع المتغير.
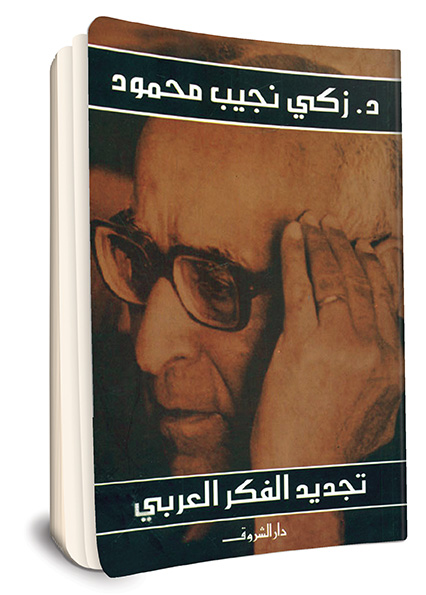 اليوم انظر حولك في واقعنا العربي، فكرًا واجتماعًا وسياسة، فكل شيء قائم على القياس، سواء كانت المرجعية نصًّا مكتوبًا أو حادثة تاريخية معينة جعلت نموذجًا يقاس عليه. في تجاهل نسبي للمتغيرات الموضوعية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار أو ذاك، ولكنها سلطة القياس في العقل العربي.
اليوم انظر حولك في واقعنا العربي، فكرًا واجتماعًا وسياسة، فكل شيء قائم على القياس، سواء كانت المرجعية نصًّا مكتوبًا أو حادثة تاريخية معينة جعلت نموذجًا يقاس عليه. في تجاهل نسبي للمتغيرات الموضوعية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار أو ذاك، ولكنها سلطة القياس في العقل العربي.
بل حتى في الاكتشافات العلمية، يأتي أصحاب «مدرسة» الإعجاز العلمي في القرآن، ليقولوا لنا: إنها ليست اكتشافات، فهي مذكورة في القرآن، من كروية الأرض حتى غزو الفضاء، استنادًا إلى نص هنا أو نص هناك، يفسر ويُؤَوَّل حسب الحاجة وحسب الغرض، المهم هو وجود نص يشرعن للاكتشاف.
حقيقة الأمر في النهاية، نحن اليوم بحاجة إلى ديكارت عربي، وكوجيتو عربي، وقطيعة كاملة مع تراكمات المعرفة القياسية، والفكر الاستنباطي في تراثنا، فهل يكون ذلك؟

بواسطة تركي الحمد - كاتب سعودي | نوفمبر 1, 2019 | مقالات
في تغريدة لي في «تويتر» قلت: «الباحث عن الحقيقة في كتب التراث، كالباحث عن إبرة في كومة من القش»، وما هذا المقال إلا توسع في تلك التغريدة واستجلاء لها. ولكن قبل الاستطراد، يجب أن نحدد ما هي «الحقيقة» المتحدَّث عنها هنا. فوفقًا لأبي حامد الغزالي (1058 – 1111م)، فإن الباحثين عن الحقيقة لا يتعدون هذه الفئات الأربع: المتكلمون، والباطنية، والفلاسفة، والصوفية، والحق (الحقيقة) لا يعدو أن يكون من نصيب إحدى هذه الفئات.
بطبيعة الحال فإن الغزالي لم يذكر الحقيقة العلمية، القائمة على العقل والتجريب؛ إذ إن هذه الحقيقة لا وجود ولا اعتراف كامل بها في تراثنا الفكري ولدى المشتغلين فيه، اللهم إلا لدى فئة قليلة كانت توصف بالكفر، أو الزندقة على أقل تقدير، مثل ابن سينا والرازي وغيرهما. أن لا تهتم الثقافة التراثية التقليدية بالحقيقة العلمية كثيرًا، أمر لا يضيرها، فلكل ثقافة أو حضارة مفهوم مركزي محوري يحدد مجال البحث فيها واتجاهاته، وطبيعة «الحقيقة» في هذه الثقافة أو الحضارة، والمفهوم المركزي في ثقافتنا التقليدية والتراثية هو العلاقة بين الإنسان والله، وحول هذا المحور تدور الثقافة، أما المفهوم المركزي للثقافة المعاصرة فهو العلاقة بين الإنسان والطبيعة، والإنسان والإنسان، وفي ذلك يقول زكي نجيب محمود، في كتابه «تجديد الفكر العربي» (دار الشروق، القاهرة وبيروت، 1978م): «إن هذا التراث كله بالنسبة إلى عصرنا قد فقد مكانته؛ لأنه يدور أساسًا على محور العلاقة بين الإنسان والله، على حين أن ما نلتمسه اليوم في لهفة مؤرقة هو محور تدور عليه العلاقة بين الإنسان والإنسان» (110). ويستطرد زكي نجيب محمود بالقول في الكتاب نفسه: «إني لأقولها صريحة واضحة: إما أن نعيش عصرنا بفكره ومشكلاته، وإما أن نرفضه ونوصد دونه الأبواب لنعيش تراثنا… نحن في ذلك أحرار، لكننا لا نملك الحرية في أن نوحد بين الفكرين…» (189).
ولكنني أعلق على ما يقوله فيلسوفنا الكبير بالقول: إنه حتى في هذه، أي أننا أحرار في الاختيار بين التراث والمعاصرة، فإننا في الحقيقة لسنا أحرارًا، والأصح أن نقول: إما أن نعيش عصرنا بفكره ومشكلاته، وإما هو الاندثار إذا كان التراث وفكره وثقافته هو الاختيار، كما حدث لأمم ومجتمعات درست وأصبحت أثرًا بعد عين، حين تشبثت بتراثها وفكره، في وجه أعاصير التغير والتحول.
وبنظرة فاحصة، أو نحاول أن تكون فاحصة، إلى تراثنا وفكره وأمهات كتبه، سواء في التاريخ أو الفقه، الذي نفتخر بغناه وثرائه، أو حتى الأدب، نجد أنه في مجمله مجرد جمع ولصق وشروحات مستفيضة لقول هنا أو مقولة هناك قابعة في أعماق التاريخ، وفي النهاية نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا. وإذا خرجنا من هذا السياق، سياق اللت والعجن وشروحات النص، وشروحات الشروحات، لا نجد حقيقة، إلا ما ندر من شاردة هنا أو واردة هناك، إلا أساطير، أو حقائق مدعاة لا تمت إلى الحقيقة العلمية بأي وشيجة أو صلة، أو قداسة مزعومة لا علاقة لها بأي قدسية أو تنزيه.
خذ مثلًا أمهات كتب في تراثنا، وهي تلك التي تعتبر نصوصًا يستفاض بها في الشروحات والهوامش، مثل «تاريخ الرسل والملوك» للطبري، أو «البداية والنهاية» لابن كثير، أو «الكامل في التاريخ» لابن الأثير، أو «الطبقات الكبرى» لابن سعد، أو «أنساب الأشراف» للبلاذري، أو «سير أعلام النبلاء» للذهبي، وغيرها كثير، هذا غير شروحاتها وهوامش الشروحات التي شكلت تراثنا لمئات السنين، تجد أنها في النهاية لا تعدو أن تكون لتًّا وعجنًا وتكرارًا فيما لا طائل من ورائه، أو فرض قداسة على أشخاص وحوادث من حوادث الدنيا لا علاقة لها بما هو ما ورائي، أو أساطير وخرافات قدمت على أنها حقائق لا غبار عليها، وغيبيات لا يدرى من أين جاد بها من سطرت أقلامهم تلك الكتب.
كان من الممكن أن يبدأ نقد التاريخ في ديارنا انطلاقًا من مقدمة ابن خلدون (1332 ـ1406)، لكتابه الموسوعي في التاريخ، التي قال فيها بضرورة الاعتماد على مقاربة أخرى للتاريخ، مقاربة ناقدة، تقوم على أساس الملاحظة العلمية بما يجري في عالم الواقع، وليس ذلك العالم الافتراضي المليء بالأسطرة والمبالغة وعنعنة الرجال والمبلغين، الذين تتحكم فيهم الأهواء والميول، فلا يعودون قادرين على التمييز بين ما هو حقيقي، وبين ما هو مجرد خيال أو مبالغة تأباها نواميس الطبيعة، والقوانين التي تسير المجتمعات، لا فرق بين مجتمع وآخر في هذا المجال. نحن اليوم فخورون بابن خلدون بصفته مؤسس علم الاجتماع الحديث، سابقًا بذلك أوغست كونت (1798 – 1858م) بأربعة قرون تقريبًا. قد يكون ذلك صحيحًا، ولكن مقدمة ابن خلدون لم تجد لها قبولًا في وقتها لهيمنة ثقافة الغيبيات والأسطورة من ناحية، ولمصادمتها «البارادايم» المعتمد لدى الباحثين والمؤرخين في ذلك الوقت، وغاب ابن خلدون ومقدمته عن ثقافتنا، حتى اكتَشف أهميةَ طرحِه علماءُ الغربِ في العصر الحديث.
ولكن، ورغم اقتناعنا بما جاء في «المقدمة»، بل رغم أننا نعيش في ظل الحضارة المعاصرة، ونستورد منتجاتها، فإن العقل الجمعي والثقافة المهيمنة ما زالت تراثية الجذور، تقليدية المحتوى. فأي سلوك أو فكرة لا بد لها من سند تراثي يبررها ويشرعنها، وإلا فهي أمر مرفوض، رغم أن الإبداع، وهو مهماز الحضارة، تكمن شرعيته وتبريره في ذاته، بل إن الإبداع هو التحرر من أسر التقليد. نقد التراث، وما يحتويه من فكر ليس له علاقة بالعقل الخلاق، هو الخطوة الأولى في عودة المسلم إلى الوعي الحضاري، ذلك الوعي الذي يمكنه من الإسهام في صنع حضارة العصر، بدل أن يكون مستهلكًا لمنتجاتها رافضًا لعقلها، وذلك كما فعلت أوربا حين استهلت يقظتها في القرن الخامس عشر، بنقد الثقافة المدرسية الكنسية القروسطية التي جعلتها راكدة ركود المياه الآسنة لأكثر من ألف من السنين، وصدق فيلسوفنا الرائد زكي نجيب محمود حين قال: «لقد كان العامل الأول في النهضة الأوربية هو تحول الناس من حالة الاكتفاء بما كتب الأقدمون، إلى كتاب الطبيعة المفتوح لكل من أراد أن يقرأ علمًا جديدًا…» (ص 5٤،5٣). وهذه في الحقيقة زبدة الموضوع.
يرى بعض أن النهضة إنما تكمن في التراث والتقليد، والعودة إلى نجاحات الماضي بصفتها نماذج لنجاحات المستقبل، وأنه لن يصلح حال الأمة إلا بما صلح به أولها، وهذا قول مردود عليه حقيقة، إذ إن لكل جماعة من الناس بيئتها الاجتماعية التي تحدد مجالات الفكر والثقافة فيها، وغالبًا ما تكون ملائمة لظروف تلك الجماعة واحتياجاتها في الزمان والمكان. ولكن المكان متغير، والزمان متحول، ومن الخطأ، بل من الخطيئة، أن يجمد ما كان صالحًا لزمان ومكان معينين، ثم فرضه على كل الأزمنة والأمكنة، باسم قداسة مفترضة، أو أصالة مزعومة، بغير ذلك فإن الفناء هو المآل، فالنهر العريض لا يغير مجراه خضوعًا لرغبات ذاتية، فإما أن تتكيف مع مسار النهر، وإلا فإن التيار جارفك في النهاية.

بواسطة تركي الحمد - كاتب سعودي | يوليو 1, 2019 | الملف
قال ابن إسحاق، أول مؤرخ لسيرة رسول الله: «واجتمعت قريش يومًا في عيدٍ لهم عند صنم من أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له.. فخلص منهم أربعة نجوا وهم: ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى، وعبيدالله بن جحش، وعثمان بن الحويرث، وزيد بن عمرو بن نفيل.. فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله ما قومكم على شيء.. يا قوم التمسوا لأنفسكم، فوالله ما أنتم على شيء..». لم يتغير الوضع كثيرًا منذ ذلك الزمان في زمننا الحاضر، تغيرت الأصنام وأسماؤها، والأوثان وصفاتها، ولكن المضمون واحد: «فوالله ما أنتم على شيء». تشرذمت قريش في ذاك الزمان إلى شيع وأحلاف وأحزاب عشائرية وغير عشائرية، كما يصف ابن هشام في تاريخه للسيرة النبوية، وجدت نفسها في حالة تنافس يصل إلى حد الصراع أحيانًا، وهو ما يحدث ذاته اليوم في عالم العرب وبقاع أخرى من عالم المسلمين. جاء الإسلام ووحَّد كلمة العرب وأصبح لهم «مرجعية» واحدة، وصار القوم على شيء، ولكن ذلك لم يدم طويلًا؛ إذ عاد التشرذم والتحزب والتعنصر القبلي والطائفي والإقليمي، وما زلنا نعيش ذلك حتى اليوم، لدرجة أن بعضًا وصل إلى قناعة بأن العرب قوم يستعصون على الاتحاد، فديدنهم هو التشرذم والفُرقة، ولكن هذا تعميم غير علميّ وبالتالي غير صحيح، فهم، أي العرب، بشر مثلهم مثل غيرهم من شعوب العالم، تجري عليهم السنن والقوانين، ويتأثرون بالظروف ويؤثرون فيها.
وهنا يأتي السؤال الوجودي في حياة العرب وهو: لماذا كان هذا هو حال العرب؟ لماذا كان التشرذم هو عنوان تاريخهم في معظم المراحل، لولا قبسات من نور الاتفاق في هذه المرحلة أو تلك؟ الجواب ببساطة هو: هيمنة الدين على مختلف جوانب الحياة العربية، ماضيًا وحاضرًا، ولكن هذا الجواب يحتاج إلى نوع من الاستفاضة في الشرح والتعليل.
فمنذ ظهور الإسلام في ديار العرب، كان الدين هو المتحكم في الحياة العربية، اجتماعيًّا وسياسيًّا، سواء في إسباغ الوحدة على الكيان السياسي، ومن ثم فرض التجانس الثقافي والاجتماعي على الكيان محل الدراسة، أو من خلال التمردات والثورات التي ترفع الشعارات الدينية. فالدين أعطى ويعطي مشروعية للنظام السياسي المهيمن، وفي الوقت ذاته للحركات المناوئة لهذا النظام. فالخوارج مثلًا، الذين أعلنوا الثورة على علي بن أبي طالب في أول أمرهم، كانوا يرفعون شعارًا دينيًّا، «إن الحكم إلا لله»، ضد سلطة تطرح نفسها على أنها خلافة للرسول، وهنا تكمن شرعيتها. والذين قتلوا عثمان بن عفان نقموا عليه لأسباب اجتماعية واقتصادية، ولكن ذلك كان مؤطرًا بغلاف ديني، ناهيك عن ثورات الشيعة عبر التاريخ العربي وغيرهم، وكلها تحمل المضمون الديني ذاته.
المضمون الديني
نحن نعلم أن كل تلك الثورات كانت لأسباب اجتماعية حين تحليل موضوعها سوسيولوجيًّا، ولكنها لا تستطيع أن تطرح نفسها على هذا الأساس؛ إذ لا بد من مضمون أيديولوجي لها يتخذ الدين شعارًا، وبغير المضمون الديني فإنه لن يُكتَب لأي ثورة أو تمرد النجاح. بل حتى السلطات الحاكمة إنما تقمع هذه التمردات والثورات في ظل تفسير ديني مختلف، وشعار ديني مناوئ، وبنصوص دينية أُعطِيت تفسيرًا معينًا، وهو ذاته ما كان يفعله المتمردون، بل انبثق عن ذلك مذاهب دينية مختلفة خلال مراحل التاريخ العربي الإسلامي. فالإرجاء كان مذهب الدولة الأموية، والقدرية، ومنها الاعتزال، كان مذهب الدولة العباسية حتى خلافة المتوكل، الذي جعل مذهب أهل الحديث هو المذهب الرسمي للدولة. والصراع الصفوي العثماني كان في ظاهره دينيًّا، بينما هو في حقيقته صراع على النفوذ أولًا وآخرًا، وعلى ذلك يمكن القياس.
المراد قولُه هنا هو أن الدين عامل رئيس، وربما الأهم، في الثقافة والحياة العربيتين، ولا يمكن الوصول إلى قلب العربي البسيط وعقله، أو العامة من الناس، من دون أن يكون للخطاب الديني دور في ذلك. بل إنه حتى في الأيديولوجيات التي ترفع شعار العلمانية والدولة المدنية، تجد أن هنالك رجوعًا إلى الدين من أجل إثبات مقولة ما، أو «التسويق» للفكرة لدى العامة، وذلك مثل القول بأن أبا ذر الغفاري هو أول اشتراكي في الإسلام، حين كانت الاشتراكية هي الموجة السائدة، أو القول بأن الديمقراطية هي الشورى الإسلامية ذاتها، أو أن عمر بن الخطاب هو نموذج المستبدّ العادل، وهكذا. من هنا تنبع ضرورة نشوء خطاب ديني جديد يبشر بقيم جديدة تركز على قيم التسامح والسلام والثقافة العلمية ضمن قيم أخرى. خطاب يعيد تفسير النصوص وتأويلها، فالنص فضاء مفتوح، في مقابل الخطاب المتطرف اليوم، خطاب داعش والقاعدة وغيرهما، الذي ينذر بالعنف وسفك الدماء وتكفير الآخر. الخطاب المتطرف والمحرض على العنف هو في النهاية خطاب يستند إلى نصوص مقدسة، فداعش أو القاعدة لم يأتيا بنصوص من عندياتهما، ولكن زاوية القراءة لهذه النصوص تختلف، ومن هنا تنبع ضرورة إعادة قراءة الدين من زاوية أخرى، بعد أن أحرقت القراءة المتطرفة الحرث والنسل، ودمرت البشر والحجر، وعاقت التنمية، ودمرت الإنسان، وهو مفهوم لا تعرفه هذه القراءة. وهناك قراءات متعددة للنص الديني خلال الحقب التي مر بها تاريخ الإسلام، ولكن يمكن القول: إنها كانت وما زالت، إلا بعض محاولات هنا وهناك، مثل قراءة محمد أركون للنص الديني ومحاولة فهمه من خلال آليات ومنهجيات جديدة، ولكن جُلّها كان يركز على إعادة قراءة النص من خلال المنهجيات التقليدية التي لا تخرج في معظمها عن القواعد الأساسية التي نظَّرَ لها الشافعي في كتابه «الرسالة»، بينما المطلوب اليوم هو قراءة النص بنظرة فلسفية، واستكناه معانٍ جديدة تدور حول قيم مختلفة، ليس من الضروري الرجوع فيها إلى اجتهادات «السلف الصالح»، أيًّا كان ذاك السلف.
إعادة الاعتبار للإنسان
بإيجاز العبارة، إن المحور الذي يجب من خلاله إعادة قراءة الدين هو «أنسنة» الدين، وإعادة الاعتبار للإنسان فيه، بعد أن اختطف تاريخيًّا، وبدلًا من أن يكون النص الديني عبئًا على الإنسان، يعود ليكون عونًا له على ممارسة إنسانيته من دون إحساس بذنب أو خطيئة أو تضحية ما أنزل الله بها من سلطان. الخطاب الديني المعاصر ملغم بالكراهية والبغضاء ونفي الآخر والعنف، والحديث هنا عن الخطاب الديني الإسلامي الذي يجد قبولًا واسعًا لدى معظم المسلمين، سواءٌ الخطاب الذي ينذر بالويل والثبور علانية، أو ذاك الذي تستتر البغضاء ومن ثم العنف، في تلافيفه من دون إعلان صريح؛ إذ إن الجميع يستندون إلى مرجعية واحدة. وفي هذا المجال، يطرح بعضٌ العودة إلى بعض طروحات مدارس إسلامية معينة من أجل الخروج من دائرة العنف، وأزمة الخطاب الإسلامي المعاصر، المجاهر بالكراهية والمخفي لها بين ثنايا النصوص، من أجل خطاب إسلامي جديد، ولا أظن أن هذا هو الحل.
يطرح بعضٌ العودةَ إلى الصوفية كأساس لخطاب جديد، حيث إن مبادئ الصوفية تحمل قيم التسامح والسلام ونبذ العنف، ولكن الصوفية في النهاية هي تجربة ذاتية فردية لا يمكن لها أن تكون أساسًا لخطاب سياسي واجتماعي عام. فعلى الرغم من تعدد تعريفات الصوفية وتطوراتها عبر القرون، من الزهد البسيط في بداية أمرها، إلى التصوف الفلسفي، وانتهاءً بالتصوف الرث (تصوف الدراويش)، أو تصوف العامة، فإن بنيتها وجوهرها في تناقض وجودي مع نهر الحياة. فهي بحث عن السعادة الروحية الذاتية، وتختلف تجارب البحث عن السعادة هذه من فرد لآخر. والتصوف، وفق تعريف أبي الحسن الحصري، وهو التعريف الذي أجد أنه الأقرب لمعناها العميق، هو: «قطع العلائق، ورفض الخلائق، واتصال بالحقائق». ورغم وجود مدارس وزوايا صوفية شاركت في الحياة العامة، كالسنوسية والمهدية مثلًا، فإن ذلك لا يمنع من التعميم والقول بأن الصوفية لا يمكن أن تكون محور خطاب ديني عام، فبينها وبين زخم الحياة بون شاسع، وإن حدث ذلك، أي تحولها إلى خطاب عام، فإنه لا يكون إلا في حالة ضعف الدولة وبؤس المجتمع، كنوع من اكتفاء ذاتي خارج الدولة والمجتمع.
الخلاصة لحديث أرى أنه قد طال، أن تحديث الخطاب الديني هو ضرورة ملحّة في عالم العرب والمسلمين، إن كان لهم أن يتحرروا من أسر الماضي، وقيود التراث، وتحكم الأموات بالأحياء. خطاب ديني جديد تكون نقطة ارتكازه هي الإنسان، والإنسان فقط..







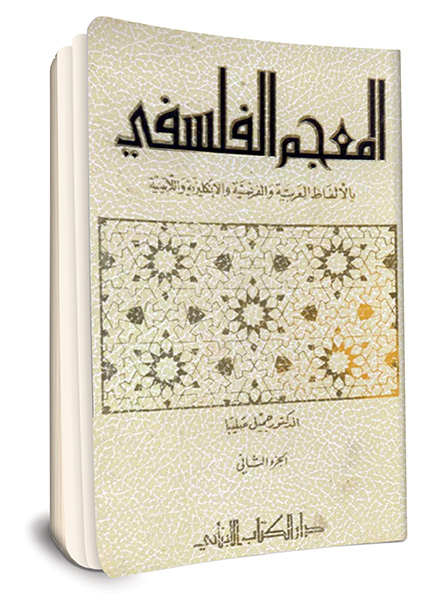 بالانتقال إلى ثقافتنا العربية والإسلامية، بل بالانتقال إلى مجمل حياتنا، السياسي منها والاجتماعي حتى الاقتصادي، نجد أنها في مجملها قائمة على آلية القياس والاستنباط، والبحث عن الأصل لإلحاق الفرع به لاتحاد العِلّة، وفق تعبير الإمام الشافعي، ووفق مقولة: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»، وهذه المقولة في حدّ ذاتها قياس.
بالانتقال إلى ثقافتنا العربية والإسلامية، بل بالانتقال إلى مجمل حياتنا، السياسي منها والاجتماعي حتى الاقتصادي، نجد أنها في مجملها قائمة على آلية القياس والاستنباط، والبحث عن الأصل لإلحاق الفرع به لاتحاد العِلّة، وفق تعبير الإمام الشافعي، ووفق مقولة: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»، وهذه المقولة في حدّ ذاتها قياس.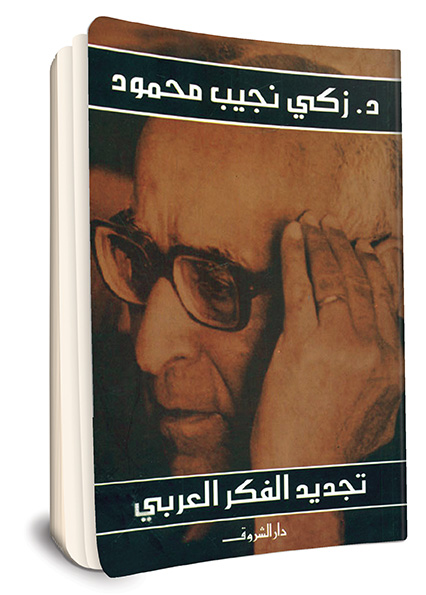 اليوم انظر حولك في واقعنا العربي، فكرًا واجتماعًا وسياسة، فكل شيء قائم على القياس، سواء كانت المرجعية نصًّا مكتوبًا أو حادثة تاريخية معينة جعلت نموذجًا يقاس عليه. في تجاهل نسبي للمتغيرات الموضوعية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار أو ذاك، ولكنها سلطة القياس في العقل العربي.
اليوم انظر حولك في واقعنا العربي، فكرًا واجتماعًا وسياسة، فكل شيء قائم على القياس، سواء كانت المرجعية نصًّا مكتوبًا أو حادثة تاريخية معينة جعلت نموذجًا يقاس عليه. في تجاهل نسبي للمتغيرات الموضوعية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار أو ذاك، ولكنها سلطة القياس في العقل العربي.

