
بواسطة أحمد الصغير - ناقد مصري | مارس 1, 2023 | كتب
يحرث الشاعر أحمد الشهاوي في أرض السرد العربي محاولًا الدخول في عالم الرواية، بوصفها النوع الأدبي الأكثر رواجًا وحضورًا في الساحة الأدبية العالمية في وقتنا الراهن. عرفتُ أحمد الشهاوي شاعرًا من جيل الثمانينيات الشعري في مصر، لكنه قبل نهاية 2022م يدهشنا بروايته الأولى «حجاب الساحر» (الدار المصرية اللبنانية، القاهرة) وفيها يستمد الشهاوي السارد من الشاعر روح المغامرة والكشف والغياب والحضور، لتمثل «حجاب الساحر» متنًا سرديًّا صوفيًّا في نتاج أحمد الشهاوي، مفتونًا باللغة ومكتشفًا أفانينها وألاعيبها النصية محاولًا الدخول بها في مساحات تركيبية مجهولة، ومغامرًا بها وكاسرًا لقوانينها الصارمة.
يطرح الشاعر أحمد الشهاوي في روايته عالمًا أسطوريًّا تنبثق منه أرواح التصوف، والحب، والغوص في أرواح الحياة، فتبدو صورة العالم الجواني الذي تعيش فيه شخصية شمس حمدي، الشخصية المركزية في الرواية، تلك الشخصية المركبة التي يحاول الراوي العليم الحديث عنها، وعن سيرتها الذاتية. جاءت الرواية لتمثل مساحة جديدة وجريئة في كتابات أحمد الشهاوي، امتزجت لغتها السردية بالحضور الصوفي والشعري، والمعرفي. ارتكز الشهاوي على المعرفة الجوانية، فيحفر بشكل واسع في طرح مفاهيم جوهرية عن التصوف، والتاريخ، وطقوس الفراعنة، وأعمال السحر، والخروج عن المألوف، وبناء عالم ممتد وواسع يطرح كثيرًا من المسكوت عنه في الواقع. والشهاوي بهذا يتخذ من «حجاب الساحر» حجابًا/ قناعًا فنيًّا ليقول من خلاله رؤاه في الحياة الواقعية.
تمثل شخصية شمس حمدي في الرواية محورًا لافتًا؛ فتدور أحداثها ورحلاتها حول شطحات هذه الشخصية المركبة، فهي إحدى المعشوقات اللواتي يستمد الشهاوي منهن روح المحبة واستعادة الحنين، والتاريخ. تكشف الرواية عن صورة أحمد الشهاوي السردية، فتمثل السردية وجهًا متجددًا من وجوه الشهاوي المتداخلة، والمتناقضة في الوقت نفسه؛ لأن يقبض على أرواح اللغة وفتنتها، فينسج أزمنة قديمة متضامّة، وأمكنة مركبة. كما أعتقدُ أنه صاحب اللغة ومخترعها، فهو مفتون بابتكار سياقات متجددة في التراكيب اللغوية التي تتفجر عنها طاقات عرفانية، تتوالد بعضها من بعض؛ لتتشكل عنها بنى سردية ذات رموز صوفية تحفر في أعمال الجوهر الإنساني.
جاءت رواية «حجاب الساحر» في (334) صفحة، من القطع المتوسط، مسبوقة بإهداء دالّ يجتره الشهاوي في جل مؤلفاته ودواوينه فيقول: «إلى نوال عيسى. بسبب الرحيل أذهب إلى فراشي وأنا خائف من غدي». يطرح صورة الابن المتعلق بثياب أمه وهو يبكي، خائفًا من الغد الذي لم يأت بعد، خائفًا من لحظات الحب التي لا يمكن لها أن تستمر، وربما تأتي بلا عودة؟ إن نوال عيسى لم تعد امرأة فحسب بل صارت رمزًا فنيًّا موغلًا في نتاج الشهاوي الشعري والنثري. إنها نوال عيسى التي تركت الشهاوي يتيمًا وهو طفل في سن السادسة أو الخامسة من عمره، فعاش محرومًا من حنان الحب ومن رحمة القلب الذي يغفر كل ذنوب وخطايا الابن الشقي المتمرد على حياته. الأم التي تدعو وتكره من يُؤَمِّنُ على دعائها، فهو دعاء المُحِبّ الذي يتمنى السعادة لحبيبه. إنها العاطفة التي يبحث الشهاوي عنها في كل امرأة يقابلها فلا يجدها سوى في نوال عيسى الحاضرة الغائبة في الوقت نفسه في قلب الشهاوي وجوانحه.
صورة الراوي
جاءت صورة الراوي في حجاب الساحر في شكل مركب، حيث يستمد الراوي معارفه من الحب طريقة للدخول فيقول: «لن أذهب إلى نظرية ما لأكتبها أو أحكي قصتها، فالشكل الكتابي أمر فضفاض وواسع، وأنا أحب ألا أكون مملًّا، أو أجعل من يقرؤني يلتفت عني من فرط الملل والاستطراد والاستغراق في الدقائق والهوامش الصغيرة المغرية لأي كاتب أو قارئ، فالتفاصيل كثيرة والأسرار أكثر». تبدو صورة الذات الساردة مباشرة في علاقتها السردية بالآخر المتلقي، فتكشف عن أسباب فنية للدخول في الكتابة، فهو لا يفضل الدخول في التفاصيل الدقيقة، فتنفرط روح المتلقي، بل يحاول استقطابه وتشويقه، وإمتاعه من خلال الفعل القرائي للسرد. يقول: «لم أدخل إلى الكتابة إلا لإدخال البهجة على نفسي أولًا، ليمتلئ قلبي مسرة وفرحًا، فمثلي يبتهج بالتأمل، والنظر عميقًا نحو ما لا يراه الآخرون، ساعيًا نحو تسجيل أو خلق عالم موازٍ لحياة شمس حمدي، التي هي من أحسن النساء، ولم تأت امرأة منذ حواء أفتن منها وأجمل، وحفظ تاريخها من الاندثار والنسيان». تبدو مبررات الكتابة عند الشهاوي بوصفها مقدمة لا بد منها للولوج في عالم شمس حمدي وعلاقتها بالساحر الأكبر عمر الحديدي الذي يبذل طرقًا معرفية وسحرية لعلاج شمس من مس السحر الذي أصابها من زوج أختها الحقود على شمس.. محاولًا تشويهها والنيل منها.
الشخصية الأسطورة
تدور رواية «حجاب الساحر» حول سيرة شمس حمدي، فيتحدث عنها السارد العليم ملمًّا بتفاصيل حياتها وآلامها وتناقضاتها ومعاناتها الذاتية. يقول الراوي العليم: «حياة شمس حمدي خصبة، وثرية في تنوعها، فهي امرأة تظهر كل ليلة، وكل نهار في شأن، إنها نساء عديدات، وليست امرأة واحدة تكرر نفسها، إذ هي تامة تعجب كل أحد، تأخذ بصرك جملة، وقد تعلمت منها أن الإنسان إذا ما أراد إزالة جبل ضخم، سيزيله بفضل ثقته فيمن يحب». تبدو صورة شمس حمدي شخصية ذات أجنحة مختلفة، هي ليست كنساء العالمين بل يدرك الراوي أنه أمام رمز لمرموزات كثيرة في الحياة، فهي تتنوع بتنوع الحياة نفسها، فهي تامة المبنى والمعنى، هي الحكمة، العلم، الفتنة، الحقيقة، والإيمان. إنها شمس المعارف الكونية وحمد اللقيا والمحبة الخالدة، بل تمثل هذه الشخصية الأسطورية مساحة معرفية وصوفية في رحلة الشهاوي نفسه مع الكتابة بأشكالها النورانية الواسعة، فمن الملحوظ أن الشاعر الروائي أحمد الشهاوي يكتب السرد بروح الشاعر المفتون بشخصيات القصيدة الصوفية الممزوجة بالعشق والمحبة والمناجاة الروحية الصافية.
اتكأ الشهاوي على طرح أمكنة متنوعة في رواياته وأسفاره، فقد كتب هذه الرواية عبر تنقلاته وأسفاره في بلاد الدنيا من مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية، ثم مصر مرة أخرى، فيطوف السارد بنا عبر أمكنة أخرى متخيلة في جزر اليمن السعيد والهند، وغيرها، ذات العوالم المتشابكة، والأمكنة السحرية التي تخلص الإنسان المسحور من الجن وعلامات السحر.
يعتمد الكاتب على مزج الرواية بالمعرفة؛ فالمعرفة ربانية في تصورها وحقيقتها الكونية. يحدثنا الشهاوي عن «كتاب الموتى»، و«الخروج إلى النهار»، ومتون الأهرام، وتمتزج شمس حمدي بشخصيات فرعونية قديمة، مثل: (إيزيس، وسخمت) فهي إلهة جاءت، لتخلص الناس من الشرور والآثام. وأعتقد أن الروح المعرفية التي يستمد منها الكاتب علاقتها بالحياة، جاءت لتركز على انصهار السرد في الشعر، وكأن الشعر هو الأسطورة الكبرى التي تتشكل منها كل الأنواع الأدبية الأخرى. فنلحظ صورة الثقافة الفرعونية، والصوفية واللغوية، وعلاقة الجن والعفاريت في الثقافة الشعرية، واستعادة الموروث الشعبي والثقافي في الريف المصري، ومدى تعلق الفقراء بهؤلاء السحرة الذين يوهمون الناس بأنهم يمتلكون قدرة على صياغة الحزن والتعاسة والفرح والسعادة.. فتكشف الرواية عن طرق العلاج النوراني والخلاص من كل أدران الحياة والبشر.

بواسطة أحمد الصغير - ناقد مصري | يناير 1, 2020 | دراسات
تتأسس الشعرية في نصوص الشعراء على بنى معمارية متنوعة منها القصيدة الطويلة، والقصيرة، والمقطوعة الشعرية. وقد طرح الشعر العربي الحديث كثيرًا من تلك القصائد التي تفتقت منها أنواع شعرية جديدة مثل قصيدة التوقيعة، والإبيجراما، والومضة، واللقطة…. إلخ.
يروم الشاعر أن يكون منتجًا فنيًّا بالأساس؛ لتتحقق لديه صورة العالم الذي يحلم به متجسدًا داخل القصيدة، سواء أكانت قصيرة أم طويلة. تجلى ذلك في قصائد الشاعر عز الدين المناصرة (1946ــ) فهو من الشعراء العرب الكبار الذين أسسوا لفن الإبيجراما الشعري في الشعر العربي الحديث، فقد أصدر في مطلع الستينيات تحديدًا في (1964م) من القرن الفائت، قصائد شعرية، تحتفي بشكل واسع بقصيدة قصيرة مارقة وحادة المغزى، موجزة العبارة، أو فيما يسميه المناصرة، بالتوقيعات، ذلك الفن الشعري الذي تخلل قصائد الشعراء في العصر العباسي الأول والثاني، ولم يلتفت إليه منظرو الأدب في تلك الحقبة القديمة.
أنتج المناصرة، قصيدة «التوقيعات» عام 1964م، وفي ذهنه التوقيعات النثرية في العصر العباسي، مستدعيًا من ذاكرته الشعرية وثقافته الأوروبية أيضًا مفهوم الإبيجراما اليوناني القديم، وهي القصائد التي كتبها شعراء اليونان منقوشة على الأواني والأحجار، وعلى شواهد القبور. وقد تأثر الشاعر عز الدين المناصرة بهذين اللونين «التوقيعة النثرية، والإبيجراما الشعرية» تأثرًا واضحًا في بنية إبيجراماته الشعرية، وتوقيعاته المفارقة التي جاءت تعبيرًا عن أفق العالم المخنوق الذي تعيشه الذات العربية بشكل عام، والذات الفلسطينية بشكل خاص. وفي حقيقة الأمر أجدني أكثر ميلًا إلى عنونة القصائد التي كتبها عز الدين المناصرة في مطلع الستينيات بقصائد الإبيجراما، لأنها جاءت قريبة من الناحية الفنية فيما عُرِفَ بالإبيجراما اليونانية، وقد تجلى ذلك في مواضع عدة، من خلال التكثيف/الإيجاز، والقصر الشديد، والصدمة الإدراكية في نهاية كل نص. إضافة إلى أنه مصطلح شائع في الشعرية اليونانية القديمة والأوروبية، وبخاصة عند الشعراء الميتافيزيقيين في أوروبا إبان عصر النهضة، أمثال جون دن.. وغيره في ذلك التاريخ الشعري في القرن السابع عشر الميلادي. وقد جاءت إبيجرامات عز الدين المناصرة دليلًا دامغًا على هذا التأثر الواضح من خلال الرؤية والتشكيل الفني، مرتكزًا على المفارقات بأنواعها كافة داخل المتن الشعري، وهذا يجعلنا نقول: إن المناصرة من الشعراء العرب الرواد الذين أنتجوا قصائد الإبيجراما الشعرية في أدبنا العربي، وإن كان قد سبقه طه حسين في كتابتها نثرًا، فأنتج كتابه النثري، جنة الشوك «دار المعارف 1944م». وعليه ستطرح هذه الدراسة مقاربة فنية لمصطلح الإبيجراما في الأدبين العربي والأوروبي، معرجًا على مفاهيم المفارقة، وأشكالها المختلفة في النقد الأدبي. مشفوعًا ذلك كله بالدرس التطبيقي على نصوص وإبيجرامات الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة.
مفهوم الإبيجراما
تنوعت مفاهيم الإبيجراما في الأدب العالمي، بوصفها نوعًا أدبيًّا له سماته ومعاييره الفنية فقد جاء تعريف طه حسين للإِبيجراما في مقدمة كتابه «جنة الشوك» واضحًا ودقيقًا، منظرًا لظاهرة أدبية مهمة في الشعر العالمي، فيقول: «ويجب أن أعترف بأني لا أعرف لهذا الفن من الشعر في لغتنا العربية اسمًا واضحًا متفقًا عليه، وإنما أعرف له اسمه الأوروبي؛ فقد سماه اليونانيون، واللاتينيون «إبيجراما» أي نقشًا، واشتقوا هذا الاسـم اشتقاقًا يسـيرًا قريبًا من أن هذا الفن قد نشـأ منقوشًا على الأحجار؛ فقد كان القدماء ينقشون على قبور الموتى وفي معابد الآلهة، وعلى التماثيل والآنية والأداة البيت، أو الأبيات من الشعر». ومن الملحوظ أن طه حسين، هو أول من قدَّم مفهومًا واضحًا عن الإِبيجراما في الأدب العربي؛ وكذلك فقد جاء تعريف عز الدين إسماعيل للإِبيجراما معتمدًا على ما طرحه طه حسين من قبل، وأضاف أنها قصيدة شعرية قصيرة. فيقول: «إن كلمة إبيجراما نفسها كلمة مركبة في اللغة اليونانية القديمة من كلمتين هما (graphein، epos) ومعناها الكتابة على شيء. وفي البداية كانت تعني النقش على الحجر في المقابر، إحياءً لذكرى المتوفى، أو نحت تمثال لأحد الشخوص.
المفارقة الدرامية
تعد المفارقة الدرامية من أنواع المفارقات التي اشتملت عليها نظرية المفارقة في النقد الأدبي، وهذه المفارقة الدرامية إنما تنبع من البنية العميقة للنص الأدبي بعامة والشعري بصفة خاصة، لأنها تمثل جوهر النص، وروحه، وغايته التي خُلِقَ من أجلها هذا النص في الحياة، كما تنبثق المفارقة الدرامية من ذلك الصراع الذي ينشأ من طريق الحوار المخادع بين متحاورين، يتجاذبان أطراف المفارقة للإيقاع بالضحية التي تقع عليها المفارقة، ونجد لها تعريفًا مقاربًا لمفهومنا الذي توصلنا إليه، فإن معجم تاريخ الأفكار يعرف المفارقة بأنها ذلك «التصارع بين معنيين يوجدان في البنية الدرامية المميزة لذاتها: بداية؛ المعنى الأول هو الظاهر الذي يقدم نفسه بوصفه حقيقة واضحة، لكن عندما يتكشف سياق هذا المعنى، سواء في عمقه أو في زمنه، فإنه يفاجئنا بالكشف عن معنى آخر متصارع معه، هو في الواقع في مواجهة المعنى الأول الذي أصبح الآن، وكأنه خطأ، أو معنى محدود على أقل تقدير، وغير قادر على رؤية موقفه الخاص».

طه حسين
وارتبطت المفارقة الدرامية منذ نشأتها بالمسرح، ومنها اتكأت الأنواع الأدبية الأخرى على الإفادة من المفارقة المسرحية إلى الدخول في عوالم أدبية أخرى كالمفارقة الشعرية والروائية والقصصية، وقد أشار دي ــ سي ــ ميويك إلى المفارقة الدرامية، فيقول: «ارتبطت المفارقة الدرامية بالأساس بالمسرح، فهى متضمنة بالضرورة في أي عمل مسرحي، لكن هذا لا يعني عدم وجودها خارج المسرح، وهي تكون أبلغ أثرًا عندما يعرف المراقب ما لا تعرفه الضحية». ويضرب ميوك مثالًا على ذلك من قصة يوسف وإخوته. «ونلحظ يوسف الذي يستضيف إخوته في مصر، وهم لا يعرفونه، وربما أصبحت المفارقة فيها أقل أثرًا لو لم يكن يوسف يعرف إخوته في حين أن القارئ يعرف». كذلك تتحقق المفارقة الدرامية عندما يعرف المراقب ما لا تعرفه الضحية. وهذا النمط من المفارقة متداخل بشكل أو بآخر مع ما يعرف بمصطلح مفارقة الأحداث. ولكي يفرق ميوك بينهما يضرب مثلًا بالمدرس الذي رَسَّبَ طالبًا في الامتحان، في الوقت الذي ظل فيه الطالب يعلن بيقين تام، أنه أدى الامتحان بشكل جيد، وأنه يتوقع النجاح دون شك، فالحالة هنا تمثل حالة مفارقة، ولا يوجد بالنسبة للآخرين شيء من هذه المفارقة إلا بعد أن تظهر نتيجة الطالب. ولا يختلف تحديد مفهوم المفارقة عما قدمه معجم أكسفورد أن مصطلح IRONY مشتق من الكلمة اللاتينية IRONIA التي تعني التخفي تحت مظهر مخادع، أو الادعاء والتظاهر بالجهل، وتستخدم الكلمة بشكل خاص للإشارة إلى ما يسمى بـ المفارقة السقراطية من خلال ما عُرف بفلسفة السؤال، وكان سقراط يستخدمها ليدحض حجة خصمه. وعليه يمكن لنا أن نخلص من هذه المفاهيم المتعلقة بالمفارقة بعامة والمفارقة الدرامية بخاصة إلى أن المفارقة الدرامية، هي نتاج إنساني محض، وإبداعي صرف؛ أي أن صانع المفارقات يريد أن يتخفى وراء أقواله وأفعاله حتى يصبح المتلقي في حيرة من أمره أمام النص المقروء، أو المسموع أو المشَاهَد. ومن النماذج الشعرية التي تجلت فيها المفارقة الدرامية بشكل واسع في إبيجرامات الشاعر عز الدين المناصرة إبيجراما بعنوان: سرقوا مني الخفين. فيقول:
«رجعتُ من المنفى
في كفي خفُّ حنين
حين وصلت إلى المنفى الثاني
سرقوا مني الخفين».
تتجلى في الإبيجراما الفائتة، مفارقة درامية موجعة من خلال الحديث عن المنفى الإجباري الذي اضطر الشاعر إلى أن يفر إليه من جراء تجريف العدو الإسرائيلي البيوت والأراضي العربية في فلسطين، فيعتمد الشاعر على بنية مفارقة درامية حزينة تشي بالوجع العربي، هذه المفارقة التي يغلب على طابعها السخرية الموجعة، من خلال الانتقال من منفى إلى منفى آخر، حتى جنود الاحتلال لم تترك له خفه الوحيد. وكأنَّ الذات الفلسطينية لم تجد قلبًا يجبر كسرها في ظل التخبطات الثقافية والتفكك السياسي الملحوظ. ويقول في إبيجراما أخرى بعنوان «أنت أمير»:
«أنت أمير!!
وأنا أمير!!
فمن يا ترى يقود هذا الفيلق الكبير!!».
ترتكز الإبيجراما السابقة على بنية المشهد المفارق بين سخرية الذات من نفسها وتناقضاتها الإنسانية، حيث تستدعي المثل الشعبي الشائع «أنت أمير وأنا أمير، من سيقود الحمير». وتبدو صور المعنى الشعري الذي يسكن وراء البنية الشعرية واسعة الدلالة لدى المتلقي الذي يصطدم بهذا المعنى الجوهري في تعدد الأمراء وفشل الرعية في وقت واحد. ويقول في إبيجراما موت الأحباب:
«زرعوا الأحجار السوداء
أكلوا ذهب الغيَّاب
وزرعنا عنبًا.. وهضاب
فلقينا موت الأحباب».
يستدعي الشاعر عز الدين المناصرة في الإبيجراما السابقة صورة المحتل الإسرائيلي الذي غرس كل الأحجار السوداء والمتاريس، ليمنع الشعب الفلسطيني من زيارة دياره وأهله وذويه. وفي صورة أخرى تتقابل مع هذه الصورة الأولى، نلحظ صورة الأمل المغروس من خلال «الفعل الماضي: زرعنا عنبًا ــ وهضاب ـ فلقينا موت الأحباب»، وتنتج من هذه الصورة المتقابلة مفارقة درامية نتيجة التصارع اليومي بين أصحاب الأرضي والمحتل. ويقول في إبيجراما بعنوان المقوقس:
«أمر على الدروب.. فتزدريني
ويطلبني المقوقس للمحاكم
وأبكي حين أذكر أهل بيتي
فقد تركوا النجوم مع السوائم».
انشغل عز الدين المناصرة في التوقيعة/الإبيجراما السابقة بصورة الشاعر العربي قيس بن الملوح العاشق المجنون الذي أحب ليلى، فغاب عقله تيهًا وعشقًا، وكلما مرَّ على أطلالها بكى واستبكى الأصحاب والعشيرة، وفي قصيدة المناصرة تلك الروح العربية المحزونة التي كلما مرت على الدروب أنكرته هذه الدروب مجبرة، فنلحظ الصراع الأقوى الداخلي بين الشاعر وذاته مرة والشاعر والحاكم مرات عدة.
ويقول في إبيجراما بعنوان الفعل الناقص:
«كلمني يا مولاي الفارسْ
حتى أحظى بالرؤية حين نموت
قبل تمام الفعل الناقص».
ارتكز عز الدين المناصرة في بناء الإبيجراما الفائتة على اللعب اللغوي المتناقض، فهو يستدعي صوتًا خارجيًّا، ليحاوره داخل النص الشعري، مبديًا صوتًا عربيًّا قديمًا، ومن ثم فإن الفارس هو رمز لكل مجاهد في فلسطين يدافع عن عرضه وأرضه، مجابهًا الموت المحقق على أيدي المحتل الإسرائيلي، فالشاعر يتمنى أن يحظى برؤية فلسطين الوطن الغالي قبل الموت/الفعل الناقص على الاكتمال والتحقق، وعليه فإن التوقيعة السابقة تلهمنا الحياة أفعالها الناقصة. ويقول في إبيجراما بعنوان يا صاحبة الهودج:
«يا صاحبة الهودج
أمي عرجاء
وأبي أعرج
وأنا أضحك من حزني».
اتكأ المناصرة في الإبيجراما السابقة على مفارقة درامية موغلة في الحزن، بل هي تلخص حجم المأساة التي تمر بها الأراضي العربية، فأصبحت الأم العرجاء رمزًا للأمة العربية التي تمشي برجل مريضة، فلا تحقق نصرًا أو تسهم في تحرير الأراضي العربية المحتلة، ومفردة الأب التي يرمز الشاعر من خلالها إلى الفارس العربي الذي تجرد عنه سلاحه، وأصبح أعزل، فلا سيف ولا حرب، والذات الشاعرة التي تصنع مفارقة قوية، وصادمة تكمن في الضحك من شدة الحزن على الذات نفسها التي تمثل نموذجًا للذات الجمعية في الوطن العربي، لأن ذات الشاعر هي كيانه وملامحه، بل تمثل مكنون أفكاره وجوارحه التي لا تستطيع الفكاك من واقع مظلم، فرضته الكائنات الأخرى عليها.
المفارقة التصويرية
صحيح أن المفارقة التصويرية نوع من أنواع المفارقات في النقد الأدبي الحديث، وقد أشرنا إليها، فيما سبق في المبحث النظري، حول المفارقة، ومفهومها، وخصائصها، الفنية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية وأنواعها ومواضعها في القصيدة الشعرية بعامة والإبيجراما بخاصة.
يشير الدكتور علي عشري زايد في كتابه عن بناء القصيدة العربية الحديثة، إلى أن المفارقة التصويرية، «تكنيك فني، يستخدمه الشاعر المعاصر؛ لإبراز التناقض بين طرفين متقابلين، بينهما نوع من التناقض، وقد يمتد هذا التناقض ليشمل القصيدة بأكملها، ليس في جملة أو بيت كما في الطباق والمقابلة، ويرى أيضًا أن التناقض في المفارقة التصويرية فكرة تقوم على استنكار الاختلاف والتفاوت بين أوضاع كان ينبغي أن تتفق وتتماثل». ومن ثم فقد تباينت مناطق المفارقة التصويرية في شعر الدكتور عز الدين المناصرة بعامة وتوقيعاته/إبيجراماته بصفة خاصة. وقد اجتزأت من مختارات بعض إبيجرامات عز الدين المناصرة، لأنه أفرد لها ديوانًا كاملًا، بعنوان مختارات من إبيجرامات عز الدين المناصرة فيقول في إحدى إبيجراماته:
«أسير ﻓﻲ الشوارعْ
محدقًا ﻓﻲ الموت والخرابْ
أسدُّ أنفي بدمي
وأطرد الذباب عن فمي
لكنّه يعود للسردابْ
من يمنع الذباب أن يمرّ ﻓﻲ فمي
من يمنع الذباب؟!!».
ارتكز الشاعر عز الدين المناصرة في التوقيعة السابقة على تصوير المشهد المفارق الواقع على الذات نفسها، فقد طرح الشاعر المشهد المؤلم الذي بالغ في تصويره من خلال رحلته في الحياة وصراعه مع الذباب الذي يمر في فمه، وهو يرمز إلى الاحتلال الاسرائيلي الذي أجبر الفلسطيني على الرحيل عن أرضه وأهله، وقد لجأ الشاعر إلى الاستغاثة الممزوجة بالتساؤل في قوله: «من يمنع الذباب أن يمر في في فمي؟ من يمنع الذباب؟!»، وكأن هذا الذباب/ المحتل لا يجد قوة تمنعه من المرور على أجساد الإنسانية في الأراضي العربية المحتلة. فهذا السؤال يوقظ كثيرًا من المفردات الغائبة في حياتنا، بل يستفز الأرواح المسكونة بالألم كي تدافع عن حقها في العودة، والرغبة في الاستقرار الإنساني البسيط. ويقول الشاعر نفسه في توقيعة أخرى:
«ﻓﻲ قلبي آلاف الأشياء
لا أحكيها، إلا للحيطان الصمَّاءْ
أحكيها لحمام الأسرار على الهَضَبةْ
أرفض أن أحكيها للسيف المسلول على الرّقَبَةْ
أرفض أن أحكيها للغولْ
ذلك أنَّ لساني يا أحبابي، مشلولْ».
في الإبيجراما السابقة، يمكننا أن نلحظ مشهدين متناقضين صنعتهما المفارقة التصويرية وهما المشهد الأول صورة الحيطان الصماء التي لا تسمع بكاء الشاعر وصراخه ضد المحتل الذي يقتل الأطفال والنساء والعجائز ويسجن الشباب في معتقلاته محطمًا بيوتهم ومزارعهم، والمشهد الثاني يتمثل في لسان الذات المشلول الذي لا يستطيع البوح بما يضمر أو يختزن من آلام وأوجاع. حيث حاول الشاعر أن يجمع في توقيعاته بين الحكي في مواجهة الحيطان الصماء، وبين حديث اللسان الذي أصيب بالشلل عن الكلام. فالمشهدان يمثلان تناقضًا واضحًا بين الرغبة في الحياة من خلال التعبير عن أوجاع مسكونة في الروح، وبين الصمت الذي يؤدي إلى الموت والقتل وفقدان الحياة، يتمثل هذا كله في صياغة الشاعر للحياة المتناقضة التي تجبر الذات الشاعرة على اللجوء إلى الحديث إلى نفسها أو إلى الحمام الذي يسكن الهضاب، خوفًا من الذبح والتمثيل بجثته على أرضه المغتصبة. ينسج الشاعر عز الدين المناصرة توقيعاته، من رحم الواقع الممزوج بالخيال الأليم الذي ارتبط بأرضه فلسطين، محاولًا طرحها من خلال السخرية المريرة، والصدمة الإدراكية الواقعة على قلوب الملايين من الشعب العربي، فجاءت توقيعاته، لتسجل المواقف العربية إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، ومدى الأثر الذي تتركه في نفوس الشعب الفلسطيني نفسه من آلام وأحزان ومشاعر متناقضة. وقد حاولتُ في دراستي طرح رؤية الشاعر عز الدين المناصرة حول قصيدة الإبيجراما، مستكشفًا المناطق البلاغية التي صنعها النص من خلال المفارقة بأنواعها المختلفة، لافتًا أنظار الباحثين العرب إلى دراسة الإنتاج الشعري للشاعر المناصرة، ودراسة إبيجراماته الشعرية.

بيت الثقــافـــة والفنون في الأردن يكرم المنـــاصرة بصفته رائــدًا و «الجامع المشترك»
الفيصل عمان
احتفى مثقفون وأدباء في العاصمة الأردنية عمان بالشاعر الفلسطيني الكبير عز الدين المناصرة، في أمسية ثقافية تكريمية احتضنها «بيت الثقافة والفنون».
وفي المناسبة شارك عدد من الأكاديمين الأردنيين، مثل: الدكتور عماد الضمور (جامعة البلقاء)، والدكتور حسين البطوش (الجامعة الإسلامية الدولية)، والدكتور علي غبن (الأونروا)، ووصف هؤلاء المناصرة بـ«الجامع المشترك» بين فلسطين والأردن، شارحين خصائص عدة في شعر المناصرة وشخصيته، (الشاعر، الناقد، البروفيسور، المناضل)، وغيرها. ومما أجمع عليه هؤلاء الأكاديميون: أولا: قدرته المبكرة منذ النصف الثاني من الستينيات على توظيف المورث العربي في شعره، ببراعة، مثل: (قناع امرئ القيس، 1967) – (شخصية زرقاء اليمامة، ديسمبر 1966)، «التي قلدها الشاعر المصري أمل دنقل بعد ذلك بعامين (مارس 1968)». – كذلك شخصية أبي محجن الثقفي و(جفرا الفلسطينية، 1976) و(حيزية الجزائرية 1986) التي نقلها المناصرة من محليتها إلى عالميتها، كما أشار الباحثون.
ثانيًا: ابتدع الشاعر المناصرة «فن التوقيعة الشعري»، وأطلق عليه «النوع الشعري الخامس» بعد الشعر العمودي، وشعر الموشحات، وقصيدة النثر، والشعر الحر التفعيلي، وذلك منذ عام (1964)، وألحق به، فن (الهايكو العربي)، في العام نفسه 1964.
ثالثًا: تميز عن زملائه (شعراء المقاومة) في الستينيات، بابتداعه (الشعر الرعوي الكنعاني المقاوم)، بالحفر عن جذور الحضارة الفلسطينية، وأضاف (عنصر الكنعنة) إلى عناصر الهوية الفلسطينية، حيث كان هذا العنصر مقموعًا.
رابعًا: هو الشاعر الفلسطيني الوحيد الذي حمل السلاح في المرحلة اللبنانية للثورة الفلسطينية، ضد (إسرائيل والمتأسرلين)، وخاض غمار ثلاث معارك عسكرية دفاعًا عن المخيمات الفلسطينية، والجنوب اللبناني، هي: (معركة كفر شوبا، 1976) – (معركة المطاحن، 1976م) – (ومعركة المتحف، 1982م). وعاش حصار بيروت 1982م. وكان قد انتمى إلى منظمة التحرير الفلسطينية منذ العام الأول لتأسيسها (1964م) في القدس، حيث كان عضوًا في (الاتحاد العام لطلبة فلسطين- فرع القاهرة). وكان عضوًا عام 1966م في (المؤتمر التأسيسي لاتحاد كتاب فلسطين) في قطاع غزة، بترشيح من الشاعر (أبو سلمى)، والروائي (غسان كنفاني). وتلقى دورة عسكرية في جامعة القاهرة، صيف 1967م، ودورة عسكرية أخرى في بيروت (دورة الكرامة، 1976م).
خامسًا: يُعد الشاعر المناصرة من أبرز النقاد العرب، خصوصًا في مجال (النقد المقارن)، و (النقد الثقافي المقارن)، وله كتب عديدة تعد من أهم المراجع العربية، وقد تميز أكاديميًّا بالإبداع النقدي، والتميز في التدريس، حيث لعب دورًا مركزيًّا في تأسيس الرابطة العربية للأدب المقارن. وعمل في التعليم الجامعي في (خمس جامعات عربية) طيلة (34 عامًا)، هي:
(جامعة قسنطينة – جامعة تلمسان) في الجزائر، وأسس قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة القدس المفتوحة (1991- 1994م)، وعمل عميدًا لكلية العلوم التربوية في الأونروا بعمان، عام 1995م. أخيرًا، عمل أستاذًا في (جامعة فيلادلفيا الأردنية، 1995 -2017م)، لكنه أحيل إلى التقاعد الإجباري في (1/9/2017م)، بذريعة تجاوزه سن السبعين. ويقول الروائي الطاهر وطار حرفيًّا: «عز الدين المناصرة … لا يقل أهمية عن زميله وصديقه محمود درويش في الشعر، ولا يقل أهمية عن مواطنه إدوارد سعيد في النقد الثقافي المقارن». وحصل (المناصرة) على رتبة بروفيسور عام 2005م في جامعة فيلادلفيا، بعد أن حصل على درجة الدكتوراه في (الأدب المقارن) في (جامعة صوفيا)، عام 1981م التي تخرج فيها الناقدان البلغاريان (تودوروف وكريستيفا) قبل هجرتهما إلى باريس.
سادسًا: وصفه عدد من النقاد بأنه (شاعر عالمي)، ومنهم: (الدكتور غسان غنيم – جامعة دمشق) والباحثة الإيرانية (مريم السادات مير قادري) – والفرنسي (كلود روكيه)، الذي قال في حفلة تكريم المناصرة في مدينة (بوردو الفرنسية، 29/5/1997م): «الشاعر المناصرة، بعد أن قرأت له كتابه الشعري المترجم إلى الفرنسية (رذاذ اللغة) – أعلن أنه لا يقل أهمية عن شعراء فرنسا العظام في النصف الثاني من القرن العشرين».
سابعًا: وكان الدكتور عماد الضمور، قد أشار إلى خاصية مهمة في شعر المناصرة، تميز بها عن أقرانه هي (تفصيح العاميات) في شعره. كذلك طريقته الخاصة في إنشاد الشعر التي يسميها (الطريقة الاحتفالية)، والتي بدأها منذ عام 1981م في بيروت.
وكان الناقد فيصل دراج ذكر في أحد مقالاته التي ينشرها في «الفيصل» (بتاريخ 28/1/2018م) قائلًا: «سألت محمود درويش: من هو أفضل شاعر فلسطيني، فقال بلا تردد: هو إبراهيم طوقان: كان شاعرًا لا يتكلف في شعره، وكانت موهبته تفيض على ما كتب. وحين وصل درويش إلى الجيل المعاصر له، قال: أفضل شاعر، هو عز الدين المناصرة، فهو شاعر متميز لا يعرف قيمته الشعرية». ويضيف فيصل دراج: «وأنا أعلم أن عز الدين المناصرة، إنسان جميل، وشاعر موهوب».
واختتمت مديرة بيت الثقافة والفنون الدكتورة هناء البواب حفلة التكريم بتسليم الشاعر المناصرة الذي أصدر عددًا مهمًّا من الكتب، شعرًا ونقدًا، أمام حضور حاشد «درع التكريم».
– كادر

بواسطة أحمد الصغير - ناقد مصري | مايو 1, 2019 | دراسات
تبدو الشعرية العربية في الخليج العربي أكثر انفتاحًا على العالم المحيط مما قبل، فقد أنتجت لنا أصواتًا نسائية متنوعة في شعر الحداثة العربية، لتؤسس بذلك شعرية أنثوية ذات ملاح فنية تحمل رؤى شعرية بخصوصية مائزة، تعبر هذه الظاهرة الشعرية عن قضايا المرأة في الخليج عامة وقضايا المرأة في الإمارات العربية بصفة خاصة، وقد طرح شعر المرأة في الثقافة العربية صورة الأنثى وقضاياها «القومية، والاجتماعية، والثقافية»، فيقوم على أكتافها بناء العقول والقلوب معًا، ومحاولة التعبير عن وجدانات الأمة العربية وطموحاتها اللانهائية من ناحية التقدم والرقي على المستويات الإنسانية كافة. وقد انتقيت مجموعة من النماذج الشعرية المتحققة على المستويين الإبداعي والثقافي، لما لها من دور وأثر في الحراك الشعري والأدبي في الإمارات. ومن هذه الأصوات المبدعة الشاعرة: «ميسون صقر، وظبية خميس، ونجوم الغانم، وأسماء بنت صقر القاسمي، وخلود المعلا». وغيرهن من الشاعرات اللواتي قدمن طرحًا شعريًّا مغايرًا في الساحة الثقافية العربية، وانتصرن لقيمة اللغة النسوية في مقابل سيطرة الثقافة الذكورية قديمًا على الساحتين الأدبية والثقافية.
ميسون صقر: جماليات الذات والآخر
ولدت في إمارة الشارقة/ الإمارات العربية المتحدة، شاعرة وفنانة تشكيلية، تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، أصدرت الكثير من الدواوين الشعرية «هكذا اسمي- جمالي في الصور- رجل مجنون لا يحبني- أرملة قاطع طريق – تشكيل الأذى». تبدو عناوين الدواوين الشعرية لدى الشاعرة ميسون صقر رموزًا للذات الشاعرة والآخر الذي تحاول الشاعرة أن تسمو به من خلال نصوصها الشعرية، مما يغلب الطابع الذاتي الخالص على ديوانها الأحدث في مسيرتها الشعرية «جمالي في الصور» (دار العين/ القاهرة 2012م) وهي تقتنص لحظات شعرية قوية، تحاول الذات أن تعلن عن جماليات الذات الشاعرة في أقنعتها المتعددة، وثرائها الدلالي والمعرفي، كما يومئ عنوان الديوان إلى مدى تماهي الذات في عالمها المجازي، فـ«جمالي في الصور» يجعل الخطاب الشعري عند ميسون صقر خطابًا داخليًّا منكفئًا على ذاته، ومرتكزًا على طرح المجازي الجمالي بديلًا عن الحقيقي الواقعي، وكأن الجمال يكمن في الصور التي نلتقطها في لحظات المحبة، أو لحظات الحنين والحزن الماضيين. فتقول الشاعرة في ديوانها «جمالي في الصور»:
«أترك الأيام الماضية تتدلى
رطبًا جنيًّا
في نخلة عالية
أسميتها في السر وطنًا عالي المقام
علقتها أملًا فوقنا
حين أغوتنا البلاد
عاودنا تركيب حلمنا
بعدما فقدنا الوثوق في الطلوع إليها».
إن صورة الذات الشاعرة التي يتحدث عنها النص الشعري ذاتٌ تمتلك سلطة التشكيل الحياتي، عندما تتحدث عن غربة داخلية عن الماضي الذي تلتحم به الذات ولا تستطيع الفرار دونه، فتعبر عن روح هذا الوطن بالنخلة العربية السامقة القوية في وسط الصحراء القاسية، وكأن النخلة هي رمز للوطن في عزته وصبره وقوته وتقدمه في آن واحد. وهي بمثابة رمز للأمل المشحون بالمحبة والصمود في لحظات الغياب عن أوطاننا العربية؛ كي نرجع إليها حالمين بسموها ورفعتها بين الأمم الأخرى. هكذا يبدو صوت ميسون صقر الشعري، صوتًا نقيًّا مغلفًا بالوطنية والاحتماء بروح الوطن ومجده وخلوده. وتقول أيضًا في قصيدة أخرى من الديوان نفسه:
«أزرع شَكِّي صَبَّارًا
أزرع الارتباك في ملامحي
أسير في الطريق إلى الملل
الملل مشبوب بحواس نائمة
أزرع الصبار
لأصبو… لأكون
بستانية الحواس الغريبة
حيلة لا تنطلي عليَّ».
تتكئ القصيدة السابقة على ثيمة الشك الإنساني المعجون بمذاق الصبار المرير، فعلاقة الشك بالصبار علاقة إنسانية خالصة. وفي ظني أن هذا التشبيه يحمل دلالات نفسية كثيرة عن الذات الإنسانية بكشل عام، فالشك يولد الحيرة والقلق النفسي البغيض، كما الصبار تمامًا في مذاقه وحياته ووخزاته وجنونه. وتستولد الشاعرة رمزًا مهمًّا مرتبطًا بالشك والصبار وهو الملل والضيق النفسي وهو ما يجعل الذات الشاعرة بعامة في صراع دائم بينها وبين هذا الثالوث المربك المخاتل في الوقت نفسه. وتكمن الدلالة الكلية لهذا النص في رغبة الذات الشاعرة القوية في تحطيم هذه الحواجز المريرة، وتحطيمها لدى بني الإنسانية، حتى تستمر الحياة في ألقها المعرفي وعطائها اللانهائي.
ظبية خميس: إشارات عرفانية
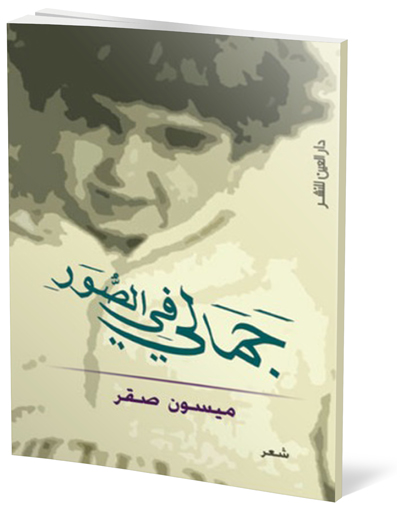 الشاعرة ظبية خميس من الشاعرات اللاتي يؤمنَّ بوحدة وطنها مخلصة ومحبة، كنساء وطنها الكبيرات. تمتلك تجربة شعرية مائزة منفتحة على عوالم الشعر في الغرب والشرق، كما أنها تطرح الصوفي والأسطوري والمعرفي والثقافي والاجتماعي في نصوصها المتنوعة. ومن أهم أعمالها الشعرية «خطوة فوق الأرض 1981م – الثنائية: أنا المرأة الأرض كل الضلوع 1982م – صبابات المهرة العمانية 1985م – قصائد حب 1985م – السلطان يرجم امرأة حبلى بالبحر 1988م – انتحار هادئ جدًّا 1992م – جنة الجنرالات 1993م- موت العائلة 1993م». وتطرح في ديوانها الأحدث «مقام الإعرابية الرائية/ اتحاد كتاب وأدباء الإمارات- 2015م» جوانب معرفية، وصوفية، ولغوية كثيرة، مرتبطة بدلالات الحروف وآلياتها ورموزها المتنوعة، ومن ثم فإن اختيار الشاعرة لحرف الراء في بناء ديوانها الشعري لا يخلو من دلالات صوفية وفنية، مفادها أن الشاعرة اختارت حرف الراء؛ لأن الراء روح ورحمة، وروح الشاعرة ظبية تهيم في الطبيعة المنسوبة للرحمن، تشاركها في ذلك التجلي الشعري روح في الطرف الآخر من الوجود، اخترقت كل الحجب والأسرار، وقفلت عائدة؛ لترتوي من الإيقاع اليومي الحر. وفي ظني أن الشاعرة ظبية خميس قد اختارت هذا العنوان لديوانها ليدل بشكل قوي على حال ومقام الصوفية الكبار في تراثنا العربي الواسع، لما له من أبعاد تناصية فنية متنوعة داخل النص الشعري، متخذة من جوهر الصوفية تسامحها ومحبتها وقربها من الرحمن عز وجل، كما نلاحظ أيضًا أن ظاهرة شعرية مهمة تتجلى في نصوص ظبية خميس، وهو الاستدعاء الجلي للنص الصوفي القديم، برموزه ومحبته وعشقه، فتقول:
الشاعرة ظبية خميس من الشاعرات اللاتي يؤمنَّ بوحدة وطنها مخلصة ومحبة، كنساء وطنها الكبيرات. تمتلك تجربة شعرية مائزة منفتحة على عوالم الشعر في الغرب والشرق، كما أنها تطرح الصوفي والأسطوري والمعرفي والثقافي والاجتماعي في نصوصها المتنوعة. ومن أهم أعمالها الشعرية «خطوة فوق الأرض 1981م – الثنائية: أنا المرأة الأرض كل الضلوع 1982م – صبابات المهرة العمانية 1985م – قصائد حب 1985م – السلطان يرجم امرأة حبلى بالبحر 1988م – انتحار هادئ جدًّا 1992م – جنة الجنرالات 1993م- موت العائلة 1993م». وتطرح في ديوانها الأحدث «مقام الإعرابية الرائية/ اتحاد كتاب وأدباء الإمارات- 2015م» جوانب معرفية، وصوفية، ولغوية كثيرة، مرتبطة بدلالات الحروف وآلياتها ورموزها المتنوعة، ومن ثم فإن اختيار الشاعرة لحرف الراء في بناء ديوانها الشعري لا يخلو من دلالات صوفية وفنية، مفادها أن الشاعرة اختارت حرف الراء؛ لأن الراء روح ورحمة، وروح الشاعرة ظبية تهيم في الطبيعة المنسوبة للرحمن، تشاركها في ذلك التجلي الشعري روح في الطرف الآخر من الوجود، اخترقت كل الحجب والأسرار، وقفلت عائدة؛ لترتوي من الإيقاع اليومي الحر. وفي ظني أن الشاعرة ظبية خميس قد اختارت هذا العنوان لديوانها ليدل بشكل قوي على حال ومقام الصوفية الكبار في تراثنا العربي الواسع، لما له من أبعاد تناصية فنية متنوعة داخل النص الشعري، متخذة من جوهر الصوفية تسامحها ومحبتها وقربها من الرحمن عز وجل، كما نلاحظ أيضًا أن ظاهرة شعرية مهمة تتجلى في نصوص ظبية خميس، وهو الاستدعاء الجلي للنص الصوفي القديم، برموزه ومحبته وعشقه، فتقول:
«طيف من هذا الذي يلح عليَّ
في صورة غرامية
مكتملة وناقصة
روح، أم رجل
فكرة، أم عشق ؟؟»

ظبية خميس
تتجلى في المقطع السابق صورة التناص الإشاري الواضح من خلال الأسلوب الشعري «طيف من هذا» لنستدعي من الذاكرة الشعرية بيتًا شعريًّا من قصيدة البردة للإمام البوصيري حيث يقول:
«نعم سرى طيف من أهوى فأرقني.. والحب يعترض اللذات بالألم»
فرمز الطيف هنا لا يخلو من إشارات شعرية تتعلق بالتصوف، والعشق الذي لا ينتهي، وتستمد الشاعرة تلك الروح من زهد المتصوفة وحنينهم إلى المحبة الخالصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما نلاحظ أن ديوان خميس ينطلق من روح الصوفية الخاشعة المؤمنة بحقيقة العبادة لله عز وجل، كما تبدو صورة الذات الشاعرة حائرة ما بين الفكرة الإنسانية والعشق الروحي المرتبط بحقيقة الحياة. وتقول أيضًا في القصيدة نفسها:
«أحيانًا يموت العالم بالنسبة لك
وتموت بالنسبة له
ومع أنه يراك
وتراه
لا يرى أحدكما الآخر أبدًا».
تتحدث الشاعرة عن الموت المعنوي الذي أصاب روح الذات الشاعرة في واقعها اليومي المعيش، فيحدث موت بالتبادل بين الذات والعالم الميت أيضًا، وتقع المفارقة في وجع الذات وتناقضاتها إزاء هذا العالم المخنوق الذي نراه ويرانا وينكر كل منا الآخر. إن العمق الفلسفي الذي ينبثق من خلال المقطع الشعري السابق يومئ إلى متاهة الذات في البحث عن حقيقتها الأرضية وكيانها ووجودها المادي والمعنوي في آن. وكأن القصيدة التي كتبتها ظبية خميس قصيدة تبحث في العدمية وكأن الكون نهايته العدم والتلاشي، في ظل صراعات إنسانية ممجوجة، تسيطر على رغبات البشر من دون الالتفات إلى الهدف الأسمى وراء الوجود الكوني لبني البشر. فعندما تنغلق العقول على نفسها لن ترى الآخر الذي يخاطبها أو تخاطبه. بل يصل الأمر إلى غياب الصورتين معًا؛ الذات والآخر.
نجوم الغانم: شعرية التمرد
الشاعرة نجوم ناصر الغانم من مواليد مدينة دبي، الإمارات العربية، شاعرة ومخرجة سينمائية، صدر الديوان الأول لها بعنوان «مساء الجنة- 1989م» وقد صدر لها بعد ذلك خمسة دواوين شعرية هي «الجرائر- 1999م. رواحل- 1996م. منازل الجلنار- 2000م. لا وصف لما أنا فيه -2005م. ملائكة الأشواق البعيدة- 2008م». تنتمي الشاعرة نجوم الغانم إلى جيل شعراء قصيدة النثر في الإمارات العربية. تمتلك الغانم خصوصية شعرية مائزة ومخاتلة في كتابتها لقصيدة النثر من خلال تمردها وانقلابها على عادات اجتماعية قديمة كانت المرأة في أثنائها تابعة ومقهورة تحت ثقافة ذكورية بالية، فقد سجلت الشاعرة نجوم الغانم في قصيدتها النثرية لحظات انكسار الذات الأنثوية في الخليج العربي وعدم تحقيق طموحها الثقافي والفني، ورغبتها في صياغة واقع جديد، يعبر عن طموحات الأنثى في الإمارات بشكل عام، وخروجها على سلطة الرجل وثقافته القديمة الموروثة الجامدة، حتى يصبح لها كيان لغوي ثقافي متحرك خاص بها وحدها من بنات جنسها. فتقول في قصيدة «أسقط من نفسي»:
«نعبر مثل ظلال على حجر الطريق
تتعقبنا انكساراتنا الشقية
ويفرقنا سيف الفصول
نمضي
نقبض على التنهيدة الهاربة
من صدورنا كي لا ينتبه إليها أحد»

نجوم الغانم
تبدو صورة الذات المنكسرة في النص الفائت مسيطرة على عملية بناء النص من خلال رصد وقائع هذه الانكسارات وتعقبها لممرات الذات ودروبها الإنسانية، وعلى الرغم من الفراق الذي يعقب تلك الانكسارات فإن الذات الشاعرة تقبض على تنهيدة هاربة خوفًا عليها من الموت والانهيار. وقد يصبح صوت المرأة جليًّا من خلال الإحساس بالخوف من قهر المجتمعات وسلطتها على أفكار المرأة العربية، فقد يحاسب المجتمع المرأة على تنهداتها وأنفاسها من خلال سيف العادات والتقاليد الذي يمتهن المرأة ولا يمنحها حقها في التفكير، وهذه مبالغات شعرية واسعة، ترمز إلى أزمنة بالية مر بها المجتمع العربي بأسره. وتقول نجوم الغانم أيضًا:
«نترك خطواتنا على الرمل
على الثلج
على الماء
يا إلهي.. كيف أننا لم ننتبه أبدًا
في أي الاتجاهات كنا نترك أقدامنا ؟».
يعتمد النص الفائت على شعرية الأسئلة المفارقة التي تصف مشهدًا مأساويًّا تمر به الذات الأنثوية من خلال حديثها عن ضبابية الرؤية واغتراب الذات عن نفسها وأرضها. فلم تعد تدرك أين كانت ملامحها الحقيقية، فلم تدرك ماهية الاستقرار، بل كان الرحيل من مكان إلى آخر هو الاستقرار المتحرك أو تناقضات الإقامة والرحيل. فعندما يترك الإنسان نفسه للحياة من دون أن يحدد لها هدفًا ما، تصبح حائرة ومتسائلة عن مصيرها الذي لا تعرف نهايته. وهو تعبير عن التمرد الذي سيطر على قوى الفكر الأنثوي، رغبة في سعي الذات الأنثوية لتحقيق ذاتها وأهدافها وطموحاتها، من أجل بناء وطنها ونهضة بلادها العربية.
أسماء بنت صقر القاسمي: العدمية وانهيار الذات
الشاعرة أسماء القاسمي من مواليد إمارة الشارقة «الإمارات العربية المتحدة»، وهي شاعرة تصنع أسطورتها من رحم ثقافتها الواسعة، لها عدة دواوين شعرية، منها: «شذرات من دمي» ترجم إلى اللغة الإسبانية، «معبد الشجن»، و«صلاة عشتار»، و«شهقة عطر»، و«طيرسون الحنين»، و«بوتقة المسك». تقول الشاعرة أسماء القاسمي:
«أنا الأنثى
أرض الأرض وبقية الكون
وقيامة ثانية
ألفُّ الزمن المشتعلَ على
أصابعي
وأخرق جدار الصمت من غير
كلفة».

أسماء صقر القاسمي
تبدو صورة الذات الشاعرة في القصيدة السابقة صورة سلطوية حيث إنها اعتمدت على ضمير المتكلم «أنا الأنثى» وهو تصدير يشي بالكثير من الرمز والدلالات المفتوحة من خلال مجابهة الذات لسلطة أخرى/ المجتمع؛ حيث إنها ارتكزت على صياغة أسطورة حقيقية مفادها أن الأنثى هي أصل الأشياء، وأرض الأرض وبــقيــــة الكون. إن هذا الإصرار الأنثوي على الحياة ورغباتها الجامحة في صياغة ثقافة أنثوية تعبر عن آلامها وأفكارها ومعاناتها التي لن تستطيع ثقافة ذكورية ما على الحديث عنها بطريقة مباشرة تصل إلى عمق مكنونها وجراحاتها اليومية. فتمنح ذاتها النسوية سلطة علوية تتشكل من خلالها الحياة التي نعيش فيها، وتقول أيضًا:
«لا شيء هنا
أو هناك
يغري بالبقاء.
بالرحيل،
يوم يتابع ظل يوم
وأعوام تكنس أعوامًا».
إن الصورة الرمزية للحزن أو العدمية الكونية التي لجأت إليها الذات الشاعرة في المقطع الفائت صورة مشبعة بالألم اليومي الذي سيطر على قلوب البشرية، فالشاعرة ترى أن العالم لم يعد هدفًا في حد ذاته بل صار حملًا ثقيلًا على كاهل البشر الذين يعيشون داخل حجراته وأركانه الإنسانية المنزوية. وكأن الذات الشاعرة تحاول الخروج من هذا العالم للدخول في عوالم مجازية موازية للطموحات النسوية التي تحلم بتحقيقها والعيش من خلالها. فلم يعد ما يغري بالرحيل أو البقاء، فالأيام متشابهة والأعوام تكنس بعضها بعضًا. إن هذا المشهد الشعري الممزوج بالدرامية يومئ إلى صورة درايمة عدمية تتصارع فيها الأشياء من أجل الرحيل أو البقاء، لا شيء سوى أن تنتصر العدمية في نهاية الرحلة الإنسانية. كما تبدو صورة الذات الأنثوية جريحة، حزينة، مقهورة؛ لأنها لم تجد صدى لصوت آلامها وقضاياها.
خلود المعلا: صور متعددة للحياة
حصلت خلود المعلا على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ثم الماجستير في إدارة المشروعات من بريطانيا، ثم درجة الليسانس في اللغة العربية من جامعة بيروت. قدمت المعلا عددًا من الدواوين الشعرية منها: «هنا ضيعت الزمن 1997م، وحدك 1999م، هاء الغائب 2003م، ربما هنا ٢008م، دون أن أرتوي 2010م، أمسك طرف الضوء 2013م، وأكتفي بالسحاب 2017م». خلود المعلا شاعرة مخلصة لقصيدتها النثرية التي تكتبها في الخليج العربي، بل شرخ صوتها حاجز الصمت الكلاسيكي «الموغل في زخارفه اللغوية المباشرة»، لتكون حاضرة من خلال قصائدها في الوطن العربي، والشعرية العالمية في وقتنا الراهن. فلم تكترث بتابوهات القصيدة التقليدية، وخرجت من محيطها، لتعلن أنها وجدت روحها الحقيقية من خلال قصيدة النثر، تلك القصيدة التي جابهت كل الجبروت الكلاسيكي لزحزحتها عن مكانتها في ملاحقة الشعرية الإنسانية بعامة.
تطرح المعلا في ديوانها «ربما هنا- الفارابي للنشر» صورًا متعددة للحياة التي نعيشها من خلال التقاء الثنائيات الضدية التي تحدث عنها الشاعر القديم بصورة مباشرة، ولكن المعلا تطرح هموم الذات الشاعرة المرتبطة بالأنثى في الكون الواسع الذي تلتقي فيه الحضارات وتتصارع فيما بينها من ناحية، وتتلاقح من ناحية أخرى، رغم أن الشاعرة ارتكزت على شعرية البوح والقلق والحيرة من خلال عنوان الديوان «ربما هنا» الذي جمع ما بين اليقين واللايقين في جملة واحدة، فـ «ربما» تفيد اللايقين اللاحقيقي، وهنا تشير إلى المكان المتوهم الذي يمكن أن يحوي صورة الذات وبحثها عن مكان آمن تلوذ به من الغياب المتحقق الذي يعدو خلفها من ترحال إلى ترحال لا يستقر، فتقول في تصدير مباشر يمثل عتبة من عتبات القصيدة:
«ما زلت أستند إلى محبتهم
والطريق التي تأخذنا إلى بعضنا
كم صارت بعيدة».
 إن الحديث عن المحبة المتوهمة التي لا تجد طريقًا تسير فيها أو تتلبسه صار بعيدًا لا يجيء، وكأن الذات تعيش على الحلم الذي يمكن أن يتحقق في يوم ما، فيخفي النص وراءه حزنًا دفينًا، ذلك الذي اختبأ بغياب الأحبة الذين يلهمون الذات الطمأنينة في هذا العالم، وتقول في قصيدة بعنوان لا يسمعني أحد من الديوان نفسه:
إن الحديث عن المحبة المتوهمة التي لا تجد طريقًا تسير فيها أو تتلبسه صار بعيدًا لا يجيء، وكأن الذات تعيش على الحلم الذي يمكن أن يتحقق في يوم ما، فيخفي النص وراءه حزنًا دفينًا، ذلك الذي اختبأ بغياب الأحبة الذين يلهمون الذات الطمأنينة في هذا العالم، وتقول في قصيدة بعنوان لا يسمعني أحد من الديوان نفسه:
«أحتاج الليلة إلى صوت فيروزي.
أُسرِّبُه إلى الجدران لتتسع قليلًا
بيتي لا يشبه البيوت
نوافذي تنفتح على أرض تكتظ بالتائهين
كلما هبت نسمة كونية
هربت من ظلي
وطرتُ نحو أولئك المحزونين».
تبدو صورة الذات الشاعرة التي صنعتها خلود المعلا ذاتًا حزينة نقية مخلصة للكون الذي يضم الأشياء التي تسري في أبداننا من دون أن نشعر، فاستدعاء صوت السيدة العظيمة فيروز لا يخلو من دلالات رمزية مهمة من خلال صوتها الدافئ الذي ينشر البهجة والمحبة في نفوس المحزونين الذين تتكلم عنهم الشاعرة في النص السابق، من خلال الحديث عن التائهين في هذا العالم الأرضي الواسع، هؤلاء هم المطحونون في الغياب، والباحثون عن ذواتهم في قلوب تخلصت من بقايا مادية الحياة، بمعنى آخر الحياة في صورتها الأولى العاشقة للإنسانية في براءتها المعهودة الكامنة في قلوب الأبرياء الذي تخلصت منهم الحياة المادية، وأسهمت في تهميشهم واستبعادهم من ملكوتها المادي، فانزووا إلى أنفسهم وبدا الحزن وجهًا مشتركًا بين ضلوعهم الحانية.
خلاصة القول: إن شكول الذات النسوية في شعر المرأة الإماراتية شكول متناقضة من حيث الوصول واللاصول، الحقيقة واللاحقيقة، وهنا في ظني تكمن قضية المرأة في بحثها عن القبض على ثقافتها التاريخية الطويلة، ومحو كل ما كان يغطي ملامح عقلها الناضج المثقف، ليقف مجابهًا ثقافة الفحولة وهيمنتها على صياغة رؤى الأنثى وحياتها.






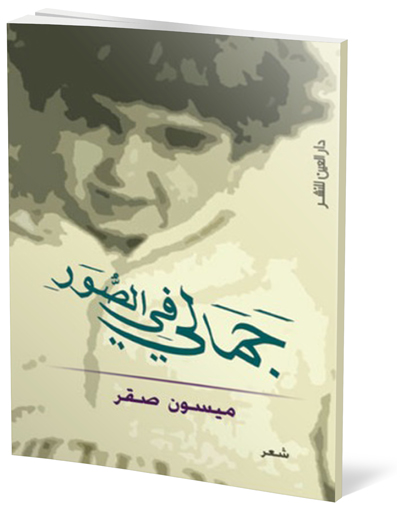 الشاعرة ظبية خميس من الشاعرات اللاتي يؤمنَّ بوحدة وطنها مخلصة ومحبة، كنساء وطنها الكبيرات. تمتلك تجربة شعرية مائزة منفتحة على عوالم الشعر في الغرب والشرق، كما أنها تطرح الصوفي والأسطوري والمعرفي والثقافي والاجتماعي في نصوصها المتنوعة. ومن أهم أعمالها الشعرية «خطوة فوق الأرض 1981م – الثنائية: أنا المرأة الأرض كل الضلوع 1982م – صبابات المهرة العمانية 1985م – قصائد حب 1985م – السلطان يرجم امرأة حبلى بالبحر 1988م – انتحار هادئ جدًّا 1992م – جنة الجنرالات 1993م- موت العائلة 1993م». وتطرح في ديوانها الأحدث «مقام الإعرابية الرائية/ اتحاد كتاب وأدباء الإمارات- 2015م» جوانب معرفية، وصوفية، ولغوية كثيرة، مرتبطة بدلالات الحروف وآلياتها ورموزها المتنوعة، ومن ثم فإن اختيار الشاعرة لحرف الراء في بناء ديوانها الشعري لا يخلو من دلالات صوفية وفنية، مفادها أن الشاعرة اختارت حرف الراء؛ لأن الراء روح ورحمة، وروح الشاعرة ظبية تهيم في الطبيعة المنسوبة للرحمن، تشاركها في ذلك التجلي الشعري روح في الطرف الآخر من الوجود، اخترقت كل الحجب والأسرار، وقفلت عائدة؛ لترتوي من الإيقاع اليومي الحر. وفي ظني أن الشاعرة ظبية خميس قد اختارت هذا العنوان لديوانها ليدل بشكل قوي على حال ومقام الصوفية الكبار في تراثنا العربي الواسع، لما له من أبعاد تناصية فنية متنوعة داخل النص الشعري، متخذة من جوهر الصوفية تسامحها ومحبتها وقربها من الرحمن عز وجل، كما نلاحظ أيضًا أن ظاهرة شعرية مهمة تتجلى في نصوص ظبية خميس، وهو الاستدعاء الجلي للنص الصوفي القديم، برموزه ومحبته وعشقه، فتقول:
الشاعرة ظبية خميس من الشاعرات اللاتي يؤمنَّ بوحدة وطنها مخلصة ومحبة، كنساء وطنها الكبيرات. تمتلك تجربة شعرية مائزة منفتحة على عوالم الشعر في الغرب والشرق، كما أنها تطرح الصوفي والأسطوري والمعرفي والثقافي والاجتماعي في نصوصها المتنوعة. ومن أهم أعمالها الشعرية «خطوة فوق الأرض 1981م – الثنائية: أنا المرأة الأرض كل الضلوع 1982م – صبابات المهرة العمانية 1985م – قصائد حب 1985م – السلطان يرجم امرأة حبلى بالبحر 1988م – انتحار هادئ جدًّا 1992م – جنة الجنرالات 1993م- موت العائلة 1993م». وتطرح في ديوانها الأحدث «مقام الإعرابية الرائية/ اتحاد كتاب وأدباء الإمارات- 2015م» جوانب معرفية، وصوفية، ولغوية كثيرة، مرتبطة بدلالات الحروف وآلياتها ورموزها المتنوعة، ومن ثم فإن اختيار الشاعرة لحرف الراء في بناء ديوانها الشعري لا يخلو من دلالات صوفية وفنية، مفادها أن الشاعرة اختارت حرف الراء؛ لأن الراء روح ورحمة، وروح الشاعرة ظبية تهيم في الطبيعة المنسوبة للرحمن، تشاركها في ذلك التجلي الشعري روح في الطرف الآخر من الوجود، اخترقت كل الحجب والأسرار، وقفلت عائدة؛ لترتوي من الإيقاع اليومي الحر. وفي ظني أن الشاعرة ظبية خميس قد اختارت هذا العنوان لديوانها ليدل بشكل قوي على حال ومقام الصوفية الكبار في تراثنا العربي الواسع، لما له من أبعاد تناصية فنية متنوعة داخل النص الشعري، متخذة من جوهر الصوفية تسامحها ومحبتها وقربها من الرحمن عز وجل، كما نلاحظ أيضًا أن ظاهرة شعرية مهمة تتجلى في نصوص ظبية خميس، وهو الاستدعاء الجلي للنص الصوفي القديم، برموزه ومحبته وعشقه، فتقول:


 إن الحديث عن المحبة المتوهمة التي لا تجد طريقًا تسير فيها أو تتلبسه صار بعيدًا لا يجيء، وكأن الذات تعيش على الحلم الذي يمكن أن يتحقق في يوم ما، فيخفي النص وراءه حزنًا دفينًا، ذلك الذي اختبأ بغياب الأحبة الذين يلهمون الذات الطمأنينة في هذا العالم، وتقول في قصيدة بعنوان لا يسمعني أحد من الديوان نفسه:
إن الحديث عن المحبة المتوهمة التي لا تجد طريقًا تسير فيها أو تتلبسه صار بعيدًا لا يجيء، وكأن الذات تعيش على الحلم الذي يمكن أن يتحقق في يوم ما، فيخفي النص وراءه حزنًا دفينًا، ذلك الذي اختبأ بغياب الأحبة الذين يلهمون الذات الطمأنينة في هذا العالم، وتقول في قصيدة بعنوان لا يسمعني أحد من الديوان نفسه: