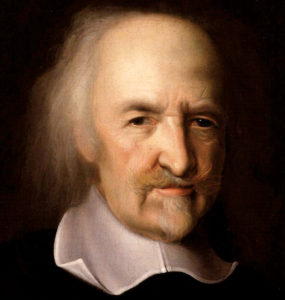الشعبوية الأوربية الانعزالية… طريق إلى الردة الحضارية
هل باتت أوربا على موعد مع أزمنة التفكيك والتفخيخ، العزل والإقصاء عوضًا عن الوحدة والتجميع، اللقاء والاتفاق، بعد أن حلق الحلم الكبير، حلم الاتحاد الأوربي، لنحو عقدين من الزمن في الآفاق؟ قبل وفاته مؤخرًا تحدث شاعر فرنسا الكبير «إيف بونفوا» إلى مجلة Monde des Religions الفرنسية عن حال العالم عامة، وأوربا خاصة بالقول: «أرى كيانات دولية تقترب من الانهيار، وبات يسيطر عليها شعور القيامة الغامض، ذلك الشعور الذي يمكن رؤيته بالعين في تهدم المناخ، وارتكاس الأراضي، وتفوق السكان على المصادر في الماء بنوع خاص، والانتشار الفوضوي، والصور غير المسؤولة، وحركات الانفصال الاجتماعي، ورايات الانعزالية الفوقية، وجميعها تربك العقل، وتخنق الضمير، وتشل الحركة، ما سيجعل البشرية قبل نهاية القرن الحادي والعشرين، تكاد أن تفقد مكانها على الأرض، وتذوب في حروب البشر، وانفجار غضبة الطبيعة».
في هذه القراءة يعنّ لنا أن نتوقف مع مفردة من مفردات الفزع الإنساني المعاصر، إن جاز التعبير، التي تحدث عنها «بونفوا» ألا وهي فكرة الانعزالية والشعبوية، وليكن الحديث عن أوربا، رائدة التنوير في العالم القروسطي، تحديدًا، وما يحتاجها اليوم من ردة حضارية تتعالى فيها أصوات القوميات المتعصبة، وتنتشر بين ثناياها وحناياها رايات الهويات العرقية والدينية القاتلة.
الشعبوية طريق الانعزالية: ما الذي نقصده بداية حين نتحدث عن فكرة أو لفظة الشعبوية؟ باختصار غير مخلٍّ، تذهب الحركة الشعبوية الأوربية إلى التركيز على هموم الناس العاديين، أولئك الذين يضحون «شعبويين» عند ممارستهم مهام حياتهم ولا سيما في إطار العمل السياسي حول العالم. والثابت أن جوهر الشعبوية كما يذهب الكاتب الألماني «بان فيرنر مولر»، يكمن عند البعض في الموقف المعارض للمؤسسة الحاكمة، لكنه يرى أن التعريف على هذا النحو ناقصًا؛ إذ يجب علاوة على معاداة النخبة، إضافة عنصر آخر هو المتمثل في معاداة التعدد، وعليه تظهر الانعزالية في أسوأ صورها، ذلك أن ما يمثل جوهر كل الشعبويين يكمن في التعبير عنه تقريبًا كالآتي: «نحن ونحن فقط من يمثل الشعب الحقيقي».
والشاهد أن الحركات الانعزاية الشعبوية حول العالم اليوم، تعكس خلافات سياسية في الكفاح من أجل ما تطلق عليه «الأفق الشعبوي»، ذاك الذي يتمثل في فكرة يوتوبية طهرانية، «البلد الموعود»، و«محو الذنوب»، عطفًا على عودة الشعب إلى نقائه الأصلي والأمر هنا لا يتعلق بالحاجز فقط، بل هو نتاج أفكار سريالية ماضية، ولا سيما فكرة الكفاح الأبوي للخير ضد الشر، وحتمية الانتصار التاريخي للطهرانية، وإن كلف ذلك المرء الكفر بالواقع، بل محاولة تعديله واستبدال أدوات عنيفة به.
الانعزالية وأخطاء الليبرالية: ما الذي فتح الباب واسعًا لعودة الشعبويين، أصحاب الدعوات الانعزالية أول الأمر وآخره، وهل للأمر علاقة بإخفاقات الليبرالية في العقود التي تلت الحرب الكونية الثانية بنوع متميز؟
في عددها الصادر في يونيو/ حزيران 2018م، خصصت مجلة «الفورين بوليسي» الأميركية ذائعة الصيت ملفًّا بأكمله عنوانه: «انهيار النظام العالمي المعتدل»، قدمت فيه نقدًا آنيًّا واعيًا لأحوال الليبرالية والمآسي التي جرتها حركاتها المغرقة في التطرف الأيديولوجي على العالم من خلال التطبيقات الخيالية، عطفًا على مآلات الدمقرطة القسرية، تجاه الآخرين حول العالم، والغلو والتطرف فيها في الداخل الأوربي والأميركي عامة.
القراءة الرصينة للفورين بوليسي، تراجع أخطاء الليبرالية الذين أسرفوا في الحديث عن مبادئها واتجاهاتها ونسوا أو تناسوا هويات الأمم، وروح الشعوب، وفات المروجين لطرح الليبرالية أن شيوعها وذيوعها يعتمد على التزام واسع وعميق بالقيم الأساسية للمجتمعات الليبرالية، وفي مقدمتها التسامح، والمواطنة والإخاء والعدالة، وهي معايير لا يمكن فرضها بالطائرات بدون طيار أو بالجيوش الجرارة، وأدوات العنف الأخرى، ولهذا باتت صحوة القوميات، وعودة القبليات وكارثية الأصوليات وصولًا إلى الانعزالية، واقع حال يغني عن السؤال، وأضحت إخفاقات الليبرالية الطريق المؤدي إلى تمكين الانعزاليين من الترويج لبضاعتهم والنتيجة الحتمية هي أن الديمقراطية الغربية باتت اليوم معرضة لحالة الاختطاف من جانب القوميين والانعزاليين وفي أوربا على نحو واضح.
أوربا الشعبية… مخاوف قومية: هل تنشأ الانعزالية من رحم الخوف؟ عند البروفيسور فرانسوا دوبيه أستاذ علم الاجتماع في جامعة بوردو الفرنسية، أن التيار الشعبوي هو جماعة قومية، وهوية يزعم القوم أنها مهددة يتهددها انعدام الأمن أو «اللا- أمان» وبخاصة «عدم الأمان الثقافي، ومهاجرو ما بعد الاستعمار والغرباء والأجانب، فالشعب هنا هو أمة متجانسة ثقافيًّا، «بيضاء»، قد تكون مؤمنة، أو غير مؤمنة، ولكنها من الطائفة الكاثوليكية (الحديث عن فرنسا) وهي شعب قومي مهدد في فن العيش الذي يعيش، وفي عوائده، وهويته، حتى لو كانت هوية متخيلة، أي فكرة «نحن في ديارنا»، وفي هذه الثلمة تتغلغل أو من هذه الثغرة تلج أطروحة «الإحلال الكاسح، أو الاستبدال الكبير»، أي استبدال المهاجرين بالشعب، وحلولهم محله، هل الخوف من الآخر إذن هو السبب الرئيسي في تنامي الانعزاليين الجدد، وتصاعد الشعبويين القدامى والمحدثين؟
لقد رأينا نجاحات -ولو سلبية- لعدد من زعماء اليمين الأوربي المتطرف في الأعوام الماضية، صعدوا إلى مراكز الحكم المتقدم في ألمانيا وهولندا، وعدد من الدول ذات مستوى الحياة المتميز «الإسكندنافية»، بل هو الذي دفع البريطانيين إلى مسار البريكست، والنأي عن الاتحاد الأوربي.
إشكالية الحقيقة المطلقة: حتى نضع أيادينا على بعض أعماق الظاهرة الشعبوية الانعزالية القاتلة في أوربا، ولا سيما تلك التي تدّعي التمثيل السياسي الأخلاقي والحصري، أي مُلَّاك الحقيقة المطلقة، أو هكذا يدعون بالقول أنهم يمثلون «المئة في المئة»، لا بد لنا من أن نطرح سؤالًا أكثر دقة وتحديدًا: «كيف لنا أن نعرف الانعزاليين والشعبويين بدقة؟ وأين تمر الحدود الفاصلة بين الشعبوية والظواهر السياسية الأخرى؟ يمضي علماء الاجتماع الألمان بنوع خاص إلى القول: إن الشعبوية ليست مطلبًا لطبقات واضحة المعالم وليست قضية عاطفية، كما أن قيمة العروض السياسية لا تكفي للقياس، إذا كان شيء ما شعبويًّا. وعليه فإن بعضًا منهم يخلص إلى أن الانعزالية الشعبوية تصوُّرٌ سياسيٌّ محدد، يرى أن شعبًا خالصًا ومنسجمًا يقف دائمًا ضد نخب غير أخلاقية، فاسدة وطفيلية، ويرى أن هذه النخب لا تنتمي البتة إلى الشعب. من أمثلة ضيق المسار الانعزالي للانعزاليين الأوربيين تحديدًا، ما جرى ويجري في دولة مثل فنلندا، وكيف بات هناك سباق وسياق للتفريق بين «الشعب الحقيقي» و«الشعب العادي» الأمر الذي نراه منعكسًا، وبقوة في أسماء الأحزاب، فالحزب الفنلندي ومعنى اسمه «الفنلنديون العاديون»، كان يريد أن يترجم إلى اللغات الأخرى بـ «فنلنديو القاعدة»، و«الفنلنديون الحقيقيون»، والآن يريد الحزب أن يترجم اسمه فقط إلى «الفنلنديين».
هنا تظهر على السطح إشكالية أخرى، فالنخب وبخاصة في تصور الشعبويين الانعزاليين من اليمينيين، تدخل في تحالف مشؤوم مع ما يطلقون عليهم «الطبقات الفقيرة الطفيلية» التي لا تنتمي إلى الشعب الحقيقي، ويمكن أن نلاحظ مثالًا على هذه الرؤية اليوم في شرق أوربا، حيث يُدعَم الضجر، في الرؤية الانعزالية الشعبوية، من طرف نخب ما بعد الشيوعية المناصرة لأوربا.
الانعزاليون والشعبويات اليمينية
هل كان ظهور الانعزاليين الأوربيين بطبعتهم الشعبوية قدرًا مقدورًا في زمن منظور؟ الشاهد وكما يقودنا البروفيسور «مارك لازار» مدير مركز التاريخ في معهد العلوم السياسية في باريس في تحليله لحديث شعبويات اليمين وشعبويات اليسار في أوربا، أن القرن العشرين أوربيًّا كان قرن المواجهات بين التوتاليتاريات والديمقراطيات، وانتهى بظفر الأخيرة، بتدعيمها بعد عام 1945م خصوصًا في الجزء الغربي من القارة العجوز، وبخاصة بعد إنشاء الاتحاد الأوربي.
أما القرن التالي (الحادي والعشرين) فيبدأ وكأنه قرن عودة القوميات وصعود نجم الشعبويات وظهوره وسطوعه. هذه الظاهرة المزدوجة، التي بدأت اعتبارًا من سنوات 1980م، عادت فتنامت وكبرت بعد سقوط الأنظمة الشيوعية في أوربا الوسطى والشرقية، ثم في روسيا، وهذا في الحين الذي بدأت تقوم فيه عولمة جديدة، ثم تعاظمت بعد 11 أيلول/ سبتمبر 2001م، أي بعد ذلك «الحدث العالمي» الذي انعكست آثاره على أوربا، لجهة تركيز السجال حول الإسلام.
وأخيرًا بدأت المرحلة الأخيرة في عام 2008م مع الأزمة المالية، ثم الاقتصادية التي ضربت العديد من البلدان الأوربية، ثم تبعها بعد ذلك بسنوات، دفق من المهاجرين الوافدين من الشرق الأوسط ومن إفريقيا جنوب الصحراء، واعتداءات إرهابية ادعتها القاعدة ثم داعش. هل كانت العوامل المتقدمة طريقًا مؤكدًا للانعزاليين الأوربيين براياتهم الشعبوية والقومية، التي يمكن لها أن تجرف أوربا التنوير إلى مسارات ظلامية؟
لا يمكن القطع بأن الانعزاليين الأوربيين قد دانت لهم أوربا عن بكرة أبيها بعد، فعلى الرغم من انطلاقتهم القوية والمثيرة للملاحظة، فإن الأحزاب والحركات التي تنتمي إلى هذا التصنيف تمر في تقلبات وتأرجحات، فتقدمهم الانتخابي المفاجئ قد تتبعه أحيانًا تراجعات تُراوِح بين التراجع المباغت والتقهقر غير المتوقع، وهو ما سيجعل خصومهم، ومعهم العديد من المعلقين يقولون عنهم: إنهم مجرد «نوبة حمى عابرة». والحال هو أنه خلافًا لاندفاعات الماضي التي كانت عابرة إلى هذا الحد أو ذاك، فإن الانعزالية المعاصرة تمثل طابعًا غير مسبوق نتيجة تعمم حضورها وديمومته. وهي تستقى بقوة في قلب أغلبية المجتمعات الأوربية، وتقلب نظم الأحزاب رأسًا على عقب، وتعدل ولا ريب من أسس الديمقراطية الغربية.
في ملامح الانعزاليين الأوربيين: لعل المتابع لتطورات المشهد السياسي الأوربي في الأعوام الأخيرة، يستطيع أن يرصد كيفية تحقيق العديد من شعبويي اليمين معدلات انتخابية مرتفعة على نحو خاص، في فرنسا وفنلندا، وفي إيطاليا وهولندا والنرويج، وعطفًا على ذلك، رأينا صعودًا موازيًا في ليتوانيا والسويد وألمانيا أيضًا، وهذه هي كلها أوضاع تولدت عن شبكة واسعة من العلل والأسباب. يعنُّ لنا في هذا السياق التساؤل: «هل من رابط عام يحمل ويجمل معالم وملامح تلك الشعبوية الانعزالية المحدثة في قارة التنوير الأصلي؟
الثابت أن شعبويات وانعزالي اليمين، تشترك في العديد من النقاط، فهي تطرح مجمل النخب القيادية (وليس الطبقة السياسية وحدها) أو بقية الأحزاب السياسية المهتمة بمصادرة الديمقراطية، وهي تبدي بدرجات مختلفة حذرها من العولمة، وتؤكد على ضرورة السيادة الوطنية، التي تعلو ولا يجوز أن يعلى عليها، وهي غالبًا ما تدعو إلى «الأفضلية الوطنية».
والمقطوع به كذلك أن أساس قومية هذه الانعزاليات الشعبوية ومعتقداتها، التي تقوم عليها، هو تصور للأمة مبني على العرق والهوية، وعلى هذا فإنهم يرفضون الأجانب والمهاجرين، كافة، ويخلطون عامدين، بين الهجرة النظامية والهجرة غير الشرعية، وبين الهجرة الثابتة والهجرة العابرة، وهم لا يترددون في تضخيم عدد هؤلاء السكان على أراضيهم، وإظهار القلق من فكرة الإحلال والاستبدال، أي من حلول هؤلاء الأجانب والمهاجرين محلهم في بلادهم، ويرون أن هذا هو جار وقيد البحث في زعمهم، وهم مجمعون على التنديد بالديانة الإسلامية التي يرونها مهددًا للإرث الثقافي الأوربي… ماذا عن تلك الجزئية تحديدًا؟
الإحلال الكبير وأسلمة أوربا
حين نتناول بالقراءة المعمقة إشكالية النزعات الانعزالية التي تجتاح أوربا، يبقى فرض عين علينا أن نتوقف مع الرايات الفاقعة التي تعزو تنامي هذا التيار إلى ما يعرف بالإسلاموفوبيا أو إرهاب الإسلام، والمخاوف التي يمكن لها أن تدعم وتزخم الانعزاليين الجدد. تحتاج قضية «أسلمة أوربا» إلى قراءات معمقة قائمة بذاتها، غير أن منطلقها الرئيس هو فكرة «الاستبدال العظيم» أو بالفرنسية Le grand remplacement التي تذهب إلى أن السكان الفرنسيين الكاثوليك البيض في فرنسا كمثال، والسكان الأوربيين المسيحيين البيض عمومًا، يستبدل بهم بشكل منتظم غير الأوربيين، وبخاصة السكان العرب والبربر والشرق أوسطيين والإفريقيين من خلال الهجرة الجماعية، والنمو السكاني وجميع هؤلاء وأولئك مسلمو الديانة، وبذلك ستأتي لحظة بعينها تتحول فيها كفة الديموغرافيا لصالح المسلمين في أوربا. صاحب هذا الطرح الكاتب والناشط السياسي الفرنسي رينو كامو، الذي أصبحت آراؤه تمثل ركنًا أساسيًّا وجوهريًّا في أبجديات تفكير اليمين الأصولي الأوربي بنزعته الشعبوية الانعزالية بنوع متميز.
يتساءل «فرانسوا بورغا» الباحث الفرنسي الشهير في مجال عالم الإسلام السياسي مؤخرًا… هل الإسلاموية مجرد فكرة شعبوية انعزالية أم ماذا في الأمر؟ ضمن سياقات التحليل لفهم أبعاد الظاهرة الشعبوية يرصد المرء بعض الآراء التي تتناول فكرة ردود أفعال الخوف من الآخر وهو هنا تحديدًا العربي أو المسلم، ورغم انفتاح القارة الأوربية على العالمين العربي والإسلامي منذ قرون بعيدة، فإن ظاهرة المد الأصولي في العقود الأخيرة قد ولدت ردود أفعال أبرزت من دور وحضور الأحزاب الشعبوية الانعزالية في القارة الأوربية.
أحسن كثيرًا جدًّا البرفيسور يورغا، حين أشار إلى أن مقارنة الإسلاموية بالشعبوية توفر فرصة مفيدة ولو لم تكن سهلة لمحاولة الإحاطة بجذور وتعابير الظاهرتين اللتين باتتا اليوم كُلِّيَّتَيِ الحضور في المشهد السياسي العالمي، حيث يظل تنوع الزائدات التي نمت عليهما وتبعت عنهما، يعاني سوءَ المعرفةِ بها وسوءَ فهمها، وفي أغلب الأحيان سوءَ قبولِها. والتعبئات والتحشيدات الأخيرة التي شهدتها الإسلامويات وجرت تحت تسميات مختزلة، وكان مجالها كامل الطيف السياسي في العالم الإسلامي.
أما الباحث الإيطالي توماس فيرجلي، مدير البرامج في المؤسسة الأوربية للديمقراطية في إيطاليا، فيرى أن أحد أخطر الأوتار التي عزف عليها الانعزاليون الأوربيون كان ذلك المقابل لفكر الأصولية الجامع المانع، وغير القابل للآخر، حتى بين أوساط المجتمعات الإسلامية عينها، وعنده أن الأيديولوجيات الشمولية على اختلافها تقوم على الولاء المطلق، مقابل الخوف من الآخر، وغياب التنوع بأي صورة من الصور. وتزيد هذه الأيديولوجيات التي تنتشر وتتمدد أكثر وأكثر من تفشي التطرف. يتساءل فيرجلي: لماذا يُتجاهَل التهديد الذي تمثله بعض جماعات التطرف الإسلاموي، -ولا نقول الإسلامي- في بعض الأحيان؟ يلفت الباحث الإيطالي إلى جزئية تستحق التأمل وهي أن بعض جماعات الإسلام السياسي، وفي مقدمته حاضنة الكل، أي الإخوان المسلمين، تمكنت من تصوير نفسها كمعبر وممثل عن التيار الإسلامي المعتدل، فيما يرى آخرون أن بعض الجماعات الإسلامية في أوربا اليوم كانت سببًا مباشرًا في دفع الشعبويات للأمام؛ إذ إن بعضها يتخذ من فكر «التقية الشيعي»، وإن كانوا من أهل السنة، منطلق للحياة في الداخل الأوربي، فيكفون ظاهريًّا عن استخدام العنف البدني، أو الحديث بعنف لفظي، من أجل كسب تعاطف واستقطاب مزيد من المؤيدين لهم، وفي الوقت ذاته يحتفظون في صدورهم وقلوبهم بذات الأفكار الأحادية والاستبدادية.
ولا ينسى المنظرون في واقع الأمر للشعبويين الأوربيين الوقوف أمام مشهد مهم للغاية، وهو العمليات الإرهابية البشعة التي جرت في السنوات الفائتة، على الأراضي الأوربية، ودفعت قطاعات عريضة من الأوربيين المصنفين في خانة المعتدلين للتصويت لصالح الشعبويين. لكن السؤال: «هل تبرر أفعال هذه القلة، حالة الهوس الديني للانعزاليين جهة الإسلام والمسلمين في أوربا، أم إن الأخبار السيئة كما يقال إعلاميًّا هي التي يعتد بها، وهي بذات القدر القادرة على استيلاد المزيد والمزيد من نغمات السؤال الذي لا يقل أهمية: هل يجد التيار الانعزالي الشعبوي الأوربي مددًا من الجانب الآخر من الأطلسي أي من قلب الولايات المتحدة الأميركية؟
أميركا ويمين الانعزاليين
أحد الأسئلة المثيرة للجدل التي طالما طرحت على موائد النقاش؛ هل أميركا دولة علمانية كما يذهب دستورها أم هي دولة دينية كما يبين هواؤها إن جاز التعبير؟ باختصار غير مُخلٍّ، أميركا دولة علمانية الهوية، لكنها غارقة في الهوى الديني وهذا غالبًا ما يكون الأقرب للتيارات المحافظة، المنادية بحفظ النوع ونقاء السلالة، وبأفكار أميركا الأولى، صاحبة الاستثنائية المميزة، تلك القريبة بدرجة أو بأخرى من فكر «ألمانيا الآرية».
سؤال الانعزالية تزايد في الأعوام الماضية ولا سيما مع وصول الرئيس «دونالد ترمب» إلى سدة الحكم، فالرجل مهموم ومحموم بإشكالية عودة بلاده للقبض على مجريات الشأن الدولي، وتوسيع الفجوة مع روسيا والصين، حين يبقى لها قصب السبق كما يقال في إطار الصراع القطبي. الرئيس ترمب يرى أن بلاده لا يتوجب عليها أن تكون شرطي العالم أو شريفه، وللرجل في ذلك الحق، أن يختار لبلاده النسق السياسي الذي يلائمها، غير أن تأثيراته وأفكار مستشاريه الذين أوصلوه إلى البيت الأبيض، ولا سيما مستشاره الخاص «ستيف بانون» كان لها رجع صدى لا يتلكأ ولا يتأخر في الداخل الأوربي، الذي ارتحل العام الماضي ليقدم خلاصة خبراته للانعزالين من الأوربيين، وليضيف إلى الشعبويين الأوربيين الكثير من أفكار الفوقية الإمبريالية.
ولعل الأصوات التي تحذر من الانعزالية، ومخاوف تنامي الشعبوية في الداخل الأميركي، قد ألقت بالمزيد من الضوء على خطورة ما يجري في القارة الأوربية العجوز؛ ولهذا لم تحقق التيارات اليمينية الانعزالية الشعبوية الأوربية، النتيجة التي كانت تصبو إليها في انتخابات البرلمان الأوربي في مايو/ أيّار الماضي… ماذا عن أهم تلك الأصوات؟
يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سرد جميعها؛ لذا نختار عملية فقط من الأعمال الفكرية المهمة للسيدة «مادلين أولبرايت»، وزيرة الخارجية الأميركية، في زمن إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون. عمل أولبرايت الأول عنوانه: «إمبراطورية الخوف»، وفيه تتحدث عما جرى لبلادها في إدارة جورج بوش الابن، وكيف أن زراعته للخوف بعد 11 سبتمبر 2001م، قد ولد تيارات انعزالية، وأعطى قُبْلة الحياة لجماعات شعبوية يمينية، ما أنزل الله بها من سلطان، يقول بعض: إنها قد تعود إلى تفكيك الاتحاد الأميركي المعروف حاليًّا خلال عقد أو عقدين على أكثر تقدير… لماذا؟ لأن بوش الابن وصحبه، قد تلاعبا على المتناقضات وصعدا من وتيرة الانعزاليين الأميركيين حين ضخوا وأشاعوا مشاعر الخوف من الآخر في جنبات الحياة الأميركية، غير أن هذا العزف النشاذ ارتدّ سلبًا على المجتمع الأميركي، ذاك الذي بات يعاني حالةَ تمزقٍ في نسيجه بصورة غير مسبوقة.
تقول أولبرايت: «إذا كان الأميركيون عاجزين عن الخروج من مملكة الخوف، فسيضلون الطريق، وبما أن الخوف يتعلق بالإدراك لا بالواقع؛ لذا يستطيع الإرهابيون الفوز دون إطلاق طلقة واحدة»، والنتيجة الحتمية هي أن من ينادون بالانعزال والتمترس وراء محيطين سيكونون هم أصحاب الصوت الأعلى في الحال والاستقبال.
أما العمل الثاني الذي صدر لها في إبريل 2018م، فكان تحت عنوان «الفاشية… تحذير»، وفيه تتساءل عن مصير الديمقراطية، وتقلقها أوضاع المواطنة الدولية، وتطرح السؤال الصريح غير المريح: «هل نحن بصدد عودة مقنعة للفاشية السياسية التي خبرتها أوربا في نصف القرن الماضي بنوع خاص؟ تساؤل وزيرة الخارجية الأوربية الأصل، حيث إنها ولدت في تشيكوسلوفاكيا في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، يقودنا والأوربيون معنا إلى مخاوف جدية من أن تكون الشعبوية المحدثة، الوجه الآخر لعملة الانعزاليين الجدد، أمام استحقاقات كارثية لتنامي العنصرية والأصولية، مخاوف تتبدى الساعة من خلال عودة تيارات كالنازيين الجدد في ألمانيا، وحزب النجوم الخمسة في إيطاليا وبقية الجماعات التي تشكل البنية الهيكلية للانعزاليين الأوربيين.
تضع أولبرايت الأوربيين والأميركيين معًا أمام حقيقة مخيفة، وهي أن المحافظين الأوربيين في ثلاثينيات القرن الماضي ولا سيما في إيطاليا وألمانيا، قد اعتقدوا أنهم قادرون على السيطرة على الفاشية، ولكنهم فشلوا في ذلك فشلًا ذريعًا، وكانت كارثة الحرب العالمية الثانية، والآن ومنذ نهاية التسعينيات يندفع المحافظون الأميركيون في طريق مشابه، وإنْ تَوارَوْا عن الأنظار لبعض الوقت في زمن باراك أوباما.
الكارثة أن بِذار الشعبوية اليمينية الأميركية، يكاد حصادها يظهر بقوة في معسكرات اليمين الانعزالي الأوربي، عبر صور حياتية متباينة ثقافية ودينية، عرقية واجتماعية، وهو ما يعني أن طريق الشوك الأوربي سوف يجرح الكثيرين في الداخل، قبل أن يمتد أثره السلبي على العالمين العربي والإسلامي، حيث الجيران الأقرب جغرافيًّا، والنسيج الإنساني المتلاحم ديموغرافيًّا تاريخيًّا،…
ما الذي يتبقى قبل الانصراف
السؤال الأخير… ما مستقبل الانعزاليين الأوربيين؟ قد يصعب الجواب في الحال، ولا سيما في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تنتاب العالم من جهة، ولحظة ولادة أقطاب دولية جديدة من ناحية أخرى، لكن وفي كل الأحوال يمكننا القول: إن الديمقراطيات الغربية أمام استحقاق تاريخي ومفصلي، فإما التمسك بالأنساق الإنسانوية التنويرية، الديمقراطية الليبرالية، رغم سلبياتها النسبية، أو ترك الساحة فارغة للشعبويين والانعزالية الذين يدعون أنهم وحدهم القادرون على الوفاء بالوعد الأصلي للديمقراطية والمتمثل لتحقيق «الأتونوميا» الجمعية (الاستقلال الذاتي)… وهم عاجزون عن ذلك.