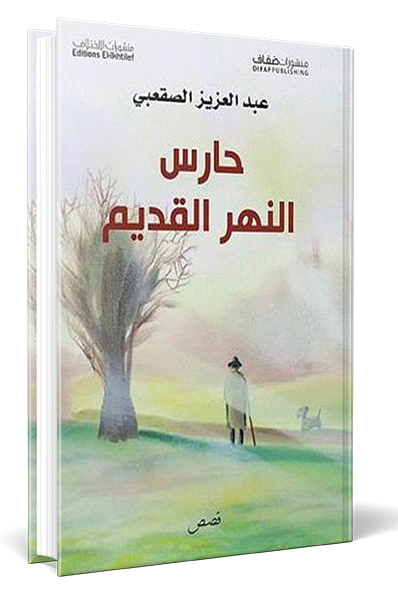في غياب الموهبة: مصنع لتفريخ الأدباء!
يتزايد في الغرب تيار انفتاح أبواب الفنون والآداب للكتابة دون شروط أو قواعد أو مؤهلات محددة، ما يتيح لأفراد يتخذون قرارًا أو يرغبون -بحسب كليشهات الدعاية- في أن يصبحوا كتابًا، أن ينتظموا في دورات أو معاهد أشبه بمصانع لتفريخ الأدباء وفق نصائح وتطبيقات ساذجة، كالوصفات السريعة لتعلم اللغات في سبعة أيام من دون معلم.
يتزامن ذلك مع صعود موجات ما بعد الحداثة أو بسببها في الأحرى، وبتأثير النزعة الشعبوية التي تستهدف تسطيح الفن والثقافة عمومًا، بدعوى جعلها جماهيرية وانتزاعها من نخبويتها وانغلاقها، والاعتقاد بإمكان توليد المهارات والمواهب من دون استعداد نفسي سابق أو تهيئة ذاتية؛ لذا انتشرت في الغرب مدارس ومواقع لتعليم الشعر والفن خارج الأهداف أو البرامج البيداغوجية التي تعتمد تعليمًا منظمًا، يساعد في تمكين الموهوبين وتقوية قدراتهم بدراسات منظمة شاملة، وتزويدهم بعدة الفن والأدب التي لا تعني بالضرورة أن يكونوا أدباء أو فنانين.
والمفارقة الكبرى تكمن في اختلاط تلك المقترحات الشعبوية مع الدعوة النظرية لمناهج ما بعد الحداثة لإعلاء الهوامش والمهمشين: سواء أكانت فنونًا كتابية أو صنفًا من الكتّاب – النساء مثلًا كجنس، والسيرة الذاتية كنوع أدبي- وإذ نقرّ بضرورة نبذ التهميش ونشارك في الاهتمام المستحق لأدب الهوامش المقصاة اجتماعيًّا بسبب الهيمنة التقليدية، ونؤمن بتنشيط الفنون المقصاة لأسباب معروفة كالكتابة السيرية، فنحن لا نقرّ بأن يغدو ذلك مبررًا لإلغاء شرط الموهبة الفردية، أو التقليل من شأنها في الكتابة الإبداعية والفنون عامة. ولا تقنعنا بجدوى تلك المصانع التي يراد لها أن تفرخ الكتاب والفنانين بإخضاعهم لبرنامج زمني، وعبر مواد يتصور واضعوها أنها كافية للخلق والإبداع، فيصفون قوالب وأطرًا معينة توقع مقلديها في البساطة والهشاشة، ويصبحون مستنسخين للنماذج المتصورة، يذكروننا بكتب الرسائل الجاهزة للمناسبات، التي يقتدي بها المراهقون وأنصاف الأميين للتعبير عن مشاعرهم من خلال تلك الوسائط الجاهزة. والأخطر هو ما تبع ذلك من ازدراء الموهبة، والحديث عنها كما لو كانت تهمة أو نقصًا في المبدع، أو كأنها المقابل العدائي للثقافة.
جابر عصفور والترويج لبضائع متنافرة
أذكر استطرادًا أن الدكتور جابر عصفور كان يناديني بالناقد الموهوب كلما جمعنا لقاء. وكتب ذلك بخطه وهو يهديني أحد كتبه. كنت أعلم أن ذلك الوصف- في المسكوت عنه من خطاب الدكتور عصفور- هو أنني لا أعبأ بالجانب النظري مثله وبعض الزملاء الآخرين. وذلك يعني أنه يربط جهدي النقدي بدافع واحد هو الموهبة التي تقف من وجهة نظره بمقابل أو بمعاداة النظرية التي يضمر تقسيمه هذا انتماءه إليها. والحق أن صلة الدكتور عصفور بالنظرية هو دور تعريفي. أي أنه يقدم خلاصاتها للقراء ويعرّف بروادها وكتبهم وما تقوم عليه نظرياتهم من منطلقات فكرية وممارسات نقدية في لغاتهم وبأدب بلدانهم نموذجًا للتطبيق أو الإجراء؛ لذا لم ينعكس ذلك في دراساته ومقالاته التي تقوم على حرية منهجية كافية لتقديم مقاربة للموضوع أو النص قيد الدرس أو النقد. أما كتبه ذات الحمولة النظرية وأكثرها ترجمة فهي والقليل المؤلف في التنظير ليست إلا انحباسًا تامًّا فيما تقوله تلك النظريات دون حوار ندّي معها، يرفض ويقبل أو يقوم بتكييفها لتلائم مادة الدرس النقدي العربي. وهذا جانب تشكو منه بعض كتابات الزملاء المعرَّفين بالنظرية دون إسقاطها على النصوص أو الموضوعات والظواهر؛ لتجربتها عبر إجراءات منهجية تفضي إلى تحليل مدروس وتأويل مقنع. كنت أجد لهؤلاء شبهًا بمن يصف عمل آلة كهربائية أو أجزاءها بدقة، استنادًا إلى تعليماتها المصاحبة لها. ثم يتركها دون تشغيل؛ لذا نجد في كتبهم تناقضات منهجية كأنهم مروِّجو بضائع متنافرة، فيكتبون عن البنيوية والواقعية والأسلوبية في كتب متتالية من تأليفهم. وهذا الهوس النظري يرادف النظر للنقد والشعر بكونهما حرفة تُعَلَّم، أو (صنعة) بتعبير المصطلح النقدي العربي القديم الذي وضع وصايا وقواعد لصناعة الشعر وكتابته مثلًا، لكنها تنتج نظّامين في الواقع يسبكون أشعارهم بطرائق تقليدية متشابهة، حين لا يمتلكون موهبة تمييز المفردة وتركيب العبارة، ولا يمتلكون الخيال المطلوب والمؤثر الشعوري لقول الشعر.
وأعتقد أن هذه القضية- موهبة الناقد أو ثقافته- مُرحَّلة من الشعر خاصة، إذ ناقش النقاد العرب قديمًا وحديثًا مدى حاجة الشعراء للموهبة والثقافة. وكانوا معتدلين غالبًا في طلب توفر الأمرين. فالموهبة تتمثل في قدرة الناقد على التذوق والاختيار والفهم ثم الحكم على النصوص، فيما تعضد الثقافة عمل الموهبة ودورها، فتكون عدة الناقد لغوية وعروضية وبلاغية، وهي أمور تطلب استعدادًا خاصًّا وتعلمًا ودراية؛ لذا قرنوا ثقافة الناقد بالنصوص ذاتها التي ترتبط بدورها بشروط الصناعة التي استخدموها للتدليل على أهمية المعرفة العلمية في نظم الشعر، أي التوفر على عدة لغوية وبلاغية وعروضية بجانب المقدرة الخيالية والتصوير العاطفي.
وقد تنبه المنظّرون الحداثيون ومن تلاهم إلى ذلك؛ فأكدوا ضرورة التثقف والتزود بالمعرفة، بما يشبه صناعة الشعر العربية. ولكن إغفال دور الموهبة أو الملكة الأولية أضر كثيرًا في عافية الشعر والنقد معًا.
الشعر والموهبة
وقد قيل في السياب: إنه يتوفر على موهبة فحسب، دون ثقافة كافية، وإن مصادره الثقافية محدودة وقراءاته لا تشي بمؤثر معرفي. وهذا الرأي ومن أبرز دعاته الشاعر العراقي الستيني سامي مهدي تعرض لنقاش مطول وردود. من بينها ما فصل فيه الناقد والمترجم الدكتور عبدالواحد لؤلؤة إذ قال في معرض التنبيه على ما قدمه السياب في مجال الرمز والأسطورة مبكرًا: «يرتبط تطويع الإشارة الثقافية إلى صيغ محلية، لا يقوى عليه سوى صاحب موهبة كبرى». في إشارة لما أخذه السياب من إديث سِتويل في قصيدته «أنشودة المطر».
ومستندًا إلى مقالة إليوت ذات الشهرة والأهمية «التراث والموهبة الفردية» حيث تعرض لضرورة تجديد الموروث بقراءته وتحديثه، بالاستعانة بالموهبة الفردية للشاعر. حتى حين يدعو مسترسلًا إلى قراءة القصائد الخالدة منذ هوميروس حتى المعاصرين فإنه يشترط بجانب تلك الثقافة المتحصلة من القراءة أن تتوفر لدى الشاعر الموهبة. ويذكرنا الدكتور لؤلؤة بأن السياب «كانت موهبته الشعرية أكبر بكثير مما تعلمه من الشعر الإنجليزي» رغم ما قيل عن ثقافته بسبب دراسته في قسم اللغة الإنجليزية في دار المعلمين العالية ببغداد في الأربعينيات، تلك الموهبة هي التي رأى إليوت أن أمثالها قادرة على تجديد التراث وإعادته حيًّا معاصرًا. وكذلك فعل السياب إذ توفر على الرموز التراثية ولم يكتفِ بمراجعها العالمية، بل اتخذ من واقعه ومحيطه وثقافته العربية كثيرًا من رموز المنطقة وإشاراتها الثقافية. فالموهبة أعانته على التقاط تلك القيمة الشعرية للموروث شعبيًّا أو دينيًّا أو أسطوريًّا. موهبة ارتقت بشعره وأهَّلته لفتح كبير في الشعرية العربية.
وليكن! فالسياب موهوب في كيفية امتصاص المرجع الثقافي. كتاب واحد أعاره إياه جبرا إبراهيم جبرا هو «الغصن الذهبي» جعله ينصرف إلى الأساطير والرموز ويكيّف الفكرة عراقيًّا؛ ليعود بكنز من رموز العراق القديم بجانب ما أدخله في شعره من التراث العربي والعالمي؛ فارتبطت باسمه أسطورة تموز وعشتار. وكذلك رموزه الأثيرة كأيوب والمسيح وبروميثيوس وسيزيف وغيرها. وقريبًا من أمثولة التحديث والفعل الشعري تأثرًا بمصدر واحد مع استثمار الموهبة ما ذكره إليوت في مقالته تلك من أن (صاحب موهبة مثل شكسبير أفاد من كتاب واحد ترجمه نورث بعنوان: «مشاهير الإغريق والرومان» أكثر مما أفاد كثيرون من مكتبة المتحف البريطاني برمتها).
٭ ٭ ٭
ولا أحسب تلك المصانع الوهمية قادرة اليوم على أن تصنع موهبة تلتقط بحساسية ورهافة تلك المعارف الساندة لشعرية النص أو للخطاب النقدي اللصيق بالنصوص والمقبل عليها بدقة وحس، تعضدهما المعرفة اللازمة.