
بواسطة سعيد مصلح السريحي - ناقد سعودي | نوفمبر 1, 2017 | كتاب الفيصل, مقالات
نتحدث في حياتنا اليومية كي نقضي حاجاتنا فتنقضي تلك الحاجات غير أن كلامنا تذهب به الريح، يتطاير كما يتطاير الرماد، يفنى بمجرد أن تنقضي تلك الحاجات، غير أننا حين نكتب شعرًا فإننا إنما نكتبه كي تبقى أصواتنا حية حين نرحل، يبقى شيء منا لا يموت، كأنما أنتم أرواح الأجيال المقبلة هي أرواحنا الخالدة التي لا تموت، تتنقل بين الأجيال وتبقى ما بقي أحد يذكر بعضًا مما قلناه ذات يوم.
والحقيقة التي لم تفت وعي الإنسان منذ القدم إنما هي حقيقة أنه كائن يتهدده الموت، كائن فانٍ يعرف من سيرة من سبقوه ويتوقع من سيرة من سيأتون بعده أن الحياة طويلة جدًّا وعمره قصير جدًّا، وأدرك كذلك كيف يطوي النسيان كثيرًا من الناس بعد موتهم حتى كأنما لم يولدوا ولم يعيشوا على هذه الأرض، يطويهم النسيان حتى لا يعود أحفاد أحفادهم يتذكرون أسماءهم، فمن منا يتذكر أكثر من خمسة أو ستة من أجداده إذا ما راح يتذكر نسبه.
محنة النسيان لم تكن بأقل مأساوية من محنة الموت، النسيان موت مضاعف، فناء مركب، محو كامل للحياة، موت الموت، مقبرة للمقبرة، حتى قبورنا تختفي معالمها، ولو نبش الأرض نابش بعد بضعة عقود من الزمن فلن يجد شيئًا منا، أو يجد خيطًا من رماد. وحين عرف الإنسان أنه كائن هش يتهدده الموت ويطويه النسيان، أخذ حجرًا أو إزميلًا وراح ينقش على الصخر من حوله رسمًا أو حرفًا أو اسمًا أو كلماتٍ، مستمدًّا من الصخر صلابة تقاوم الموت والنسيان معًا، حرفًا أو اسمًا أو كلمةً أو نقشًا تتوارثه الأجيال ويقف شاهدًا على أن هناك من عاش هنا وحين رحل ترك بصمة لا ترحل.
ذلك هو الأساس الذي انبنى عليه الشعر؛ صرخة ضد الموت، صمود في وجه الفناء، محاولة للتشبث بالخلود قدر المستطاع، واكتشف الإنسان بتدرجه وترقيه في عتبات الوعي أن الكلمات التي يتركها خلفه تكتسب حياتها وخلودها بقدر ما تتوافر فيها قيمتان: أولهما البعد الإنساني المعبر عن الإنسان في كل زمان ومكان، والبعد الجمالي الذي يجعل من تلك الكلمات إضافة لما يحيط بالإنسان من جمال العالم من حوله، إنسانيًّا يجد فيه الإنسان ما يجول في نفسه من أحاسيس وعواطف، من حزن وفرح، من سعادة وشقاء، وجماليًّا يرتقي بذوق الإنسان ويكشف له عن أن عليه أن يستمتع بالحياة التي وهبها الله إياه وألَّا يترك ما قد يخالط هذه الحياة من قبح يقف سدًّا بينه وبين جمالها حين يتجلى في هسهسة أوراق الشجر، وشقشقة عصفور يغرِّد، ولون وردة تتفتح، ولمعة الضوء على وجه ماء يترقرق.
الشعر يخلد ويخلد به الإنسان بقدر ما يكون إنسانيًّا، وبقدر ما يكون جميلًا، وبقدر ما يمثل المثل العليا التي تحفظ للمجتمع تماسكه وتعاونه وتشيع روح التعاون والمحبة والتسامح بين أفراده، وبقدر ما يتمتع به من جمال الفكرة وجمال التعبير عن الفكرة، وبقدر ما يرسمه من صور لا تلتقط من العالَمِ أجملَ ما فيه إنما تضيف إلى جمال العالَم جمالًا وبهائِه بهاءً. الشعر بذلك عمر ثانٍ للإنسان يخلد فيه الإنسان بقدر خلوده، إنه باب من أبواب الذكر الذي قال عنه أحمد شوقي إنه عمر ثانٍ للإنسان:
الناس جارٍ في الحياة لِغايةٍ
ومضلّلٌ يجري بغير عنانِ
المجدُ والشرفُ الرفيعُ صحيفةٌ
جعلتْ لها الأخلاقُ كالعنوانِ
دقَّاتُ قلبِ المرءِ قائلةٌ له:
إن الحياةَ دقائقٌ وثواني
فارفعْ لنفسِك بعد موتِك ذِكْرَها
فالذِّكْرُ للإنسان عمرٌ ثاني

بواسطة الفيصل | يونيو 30, 2017 | إصدارات, كتب
في البدء لا بد من التنويه بأنني لا أنظر إلى محيي الدين ابن عربي في «موت صغير» للروائي محمد حسن علوان، الفائز بجائزة الرواية العربية «البوكر» إلّا كشخصيةٍ مُتَخَيَّلةٍ تُولَدُ وتحيا وتموت في عالمٍ تخييلي، لا علاقةَ لها بابن عربي الكائن الصوفي الحقيقي التاريخي. من هذه الفكرة المبدئية تنطلق محاولتي تحليل التقنية السردية في الرواية، بدءًا بتفحص السلوك السردي لابن عربي كأنا/ ذات ساردة، لغايةِ التعرف على شخصيته ومَوضِعِه في تصنيفات النظرية السردية للرواة، ثم النظر إلى طبيعة العلاقة بينه كذات ساردة وكأنا/ ذات مسرودة في عالم التجربة التخييلي في الرواية- وتقصي تأثير تلك العلاقة في تمثيله وتشكيل صورته.
في أثناء سرده قصة حياته، لا يظهر ابن عربي قط وهو يواجه، ولو للحظة خاطفة، أية موجة من الشك واهتزاز الثقة في تذكره للأحداث التي يرويها من قبل ولادته إلى ما بعد مماته؛ ولا يتوقف ثانيةً ليحكّ رأسه كيما يستحث محتوى ذاكرته على الانثيال، أو يقف مرتبكًا ومتلعثمًا بسبب ضبابية أو عتمة غَشَت ركنًا من ذاكرته، وحفرت فجوة في تتابع الأحداث، ليواجه بالتالي ضرورة التفكير في تجسير تلك الفجوة بشيء من الظن، أو التخمين، أو الاحتمال ليربط ما قبل تلك العتمة أو الضبابية بما بعدها. لا شيء من هذا القبيل يحدث، فابن عربي ساردٌ يحملُ في رأسه ذاكرةً ذات قوة غير عادية، حتى كأنما الأحداث التي يرويها كانت قد نَحَتَتْ نَفْسَها في ذاكرته نحتًا لا يطوله الانمحاء والتآكل مع تقادم الزمن به.
تكشف ذاكرةُ ابن عربي قوتها ونشاطها، على نحو خاص، في التقديمات المشهدية للحوارات بين الشخصيات التي يبسطها أمام أعين القارئ، كأنه سارد كلي المعرفة يخفي وجهه بقناع السارد بضمير المتكلم. ابن عربي ساردٌ بضمير المتكلم بَيْد أنه يختلف عن نظرائه بصفات وامتيازات السارد كلي المعرفة؛ لهذا السبب يختلف على سبيل المثال عن نظيره هاني محفوظ -الشخصية الساردة- الذي جاوره في رواية محمد عبد النبي «في غرفة العنكبوت» على قائمتي البوكر العربية الطويلة والقصيرة. هاني محفوظ سارد بضمير المتكلم ابتكره عبد النبي بمهارة إبداعية عالية على نموذج السارد بضمير المتكلم في التخييل السردي الواقعي التقليدي، فجاء متفقًا ومتسقًا في معرفته حجمًا وعمقًا مع مُحدِّدات ومواضعات السرد الواقعي؛ إذ ينحصر سرده في حدود ما يتهيأ له معرفته عبر تجربته الشخصية، وما يقع في مدار إدراكه، أو ما تسنح له فرصة معرفته عن طريق آخرين.
وزيادة في الإيضاح أضيف أن ابن عربي لا يشبه، مثلًا، ديفيد كوبرفيلد في رواية تشارلز ديكنز «ديفيد كوبرفيلد»، الذي يعزو كلَّ ما تحويه حكايته إلى دقة ملاحظته كطفل وإلى قوة ذاكرته. يُستشَفُّ من خلال تنويه ديفيد كوبرفيلد حرص ديكنز على تعزيز البعد المحاكاتي الواقعي لحكاية ديفيد ولضمان استمرار التزام القارئ بعقد «إيقاف عدم التصديق». وعلى الرغم من احتمال خروج ابن عربي من «المعطف» لنيكولاي غوغول، فإنه غير مسكون بالخشية من خذلان ذاكرته مثل السارد فيها حين يروي تاريخ ميلاد «بطلها»: «وهذا ما حصل: ولد أكاكي أكاكيفيتش في ليلة 22 مارس، إن لم تخني ذاكرتي» (ت. الخزاعي، 11). إن ابن عربي سارد غير عاديّ، وصوت من الأصوات السردية «الشاذة» والمتجاوزة للنمطين التقليديين (السارد بضمير الغائب، والسارد بضمير المتكلم)؛ تلك الأصوات التي يسميها برايان ريتشاردسون اصطلاحًا «أصواتًا غير طبيعية» في كتابه «أصوات غير طبيعية» (2006م). في هذا الكتاب، يتناول ريتشاردسون تنظيرًا وتحليلًا ما يُمَثِّلُ من زاويةِ رؤيتِهِ إحدى الخصائص الأكثر أهمية للسرد الحداثي المتأخر والطليعي وما بعد الحداثي: خاصية خلق الأصوات السردية، وتشظيها، ثم تركيبها (أو تكوينها) من جديد. بتعبير آخر، يُعنَى ريتشاردسون في «أصوات غير طبيعية» بتقصي تحولات السارد، وتحولات أدواره ووظائفه.
ابن عربي السارد في «موت صغير» مُرَكَّبٌ من السارد بضمير الغائب والسارد بضمير المتكلم؛ له وجهُ الأخير ولسانُه، ومعرفةُ الأول، وامتيازُ سردِ أحداثٍ لا يكون شاهدَ عيانٍ لها، كما لا يوجد في المتن الحكائي أدنى ما يوحي بأن أخبارها وصلت إليه عن طريق آخرين. بهويته المزدوجة غير الطبيعية هذه، يلتقي ابن عربي مع ما سميتها الساردة المركّبة في رواية بدرية البشر «غراميات شارع الأعشى»، التي تسرد بضمير المتكلم في خمسة من فصول الرواية، وتنفذ إلى أعماق الشخصيات ووعيها، كما ينفذ السارد العليم، لتُحَدِّثَ عمّا يَعْتَمِلُ في داخلها. إنها صوت سردي غير طبيعي، هي الأخرى، في ضوء تنظير ريتشاردسون؛ وربما هي كابن عربي، ممن خرجوا من «معطف» غوغول.
وتمثل العلاقة بين ابن عربي ساردًا ومسرودًا موضعًا تتجلى فيه سمة أخرى من سماته كصوت غير طبيعي؛ إذ يظهر في بعض المواقف السردية كسارد «غير ثقة» أو «غير جدير بالثقة»، وهو ما يستدعي الحذر وعدم الانخداع في بعض ما يقول. ومنشأ هذه الخاصية حالة التماهي والاتفاق شبه المطلق بين الذات الساردة والذات المسرودة. إن حالة التماهي هذه، تَحُولُ، إلا في مواقف قليلة، دون تشكل مسافة بين الذاتين تتيح للذات الساردة تأمُّلَ نظيرتها في عالم الرواية، وتقويمها، والحكم على تصرفاتها. إن انعدام هذه المسافة النقدية، إذا صح التعبير، واقترانها بحالة التناغم ورضا الخارج عن الداخل أدَّيَا إلى ظهور مفارقات وتناقضات بين تلفظات الذات الساردة وتصرفات وابن عربي وأفعاله في الداخل، إضافة إلى لجوء ابن عربي في الخارج إلى تبرير وتمويه بعض ما يحدث في الداخل. في هذا السياق أرى أن قصة زواج ابن عربي من مريم بنت عبدون وانهيار زواجهما مثال مهمّ ومناسب للبرهنة على تأثير العلاقة بين الخارج والداخل في السلوك السردي للأنا الساردة، وبالتالي في تشكل صورة ابن عربي كذات مسرودة.
الخروج من الخطاب السردي
بعد قرار مريم بنت عبدون الرجوع إلى بجاية (المغرب) من مكة، يُعلق السارد أن الحب أو بعضه لا ينمو في أي بلاد، محملًا بالتالي مكة المسؤولية عن افتراقهما «وهكذا أرادت لنا مكة»، من دون أن يفكر في التوقف لحظةً ليتساءل، مثلًا، عن دور موت ابنتها في فتور العلاقة بينهما، وعن دور عوامل أخرى مثل إدراك مريم أنها أقل أهمية في حياة زوجها من أوتاده، زوجها الذي كان ابتهاجه بحملها بزينب مضاعفًا لما وجد فيه ذريعة للسفر من إشبيلية إلى مراكش بمفرده، مرغمًا زوجته، رغم رغبتها في السفر معه، على البقاء من أجل الاعتناء بفاطمة بنت المثنى. لا يكتفي السارد بمكة سببًا للجفوة بين مريم وابن عربي، بل يتهم مريم بسحب حبها «مريم تسترد حبها وترحل بعيدًا»، ويوسّع دائرة الإسقاط لتشمل القدر «هكذا شاء الله». لا مناص من دور المشيئة الإلهية في الحدث، لكن السارد نفسه هو من يُخرِجُ مريم من الخطاب السردي ليضعها وراء ظهره. فبعد حديثه عن الوداع الخالي من القبلات، وغياب ناقة مريم وراء خط الأفق، يقفز السارد إلى المستقبل ليروي أنها ماتت بعد ست عشرة سنة في بجاية: «استأنفت الناقة سيرها بعد قليل وغابت في الأفق. ولم أرَ مريم بعد ذلك إلا في المنام. عادت إلى بجاية وأقامت مع أهلها ست عشرة سنة ثم ماتت وجاءني من يعزيني بها بعد أشهر طويلة».
بهذا الاستباق، يُفْرغ السارد مستقبلَ الخطاب السردي من مريم ومن موتها باستدعاء خروجها من الحياة إلى حاضر السرد ليتزامنَ ويتجاورَ في الخطاب مع خروجها من حياته كذات مسرودة. بكلمات أخرى، تتعرض مريم للكنس إلى خارج الخطاب ليخلو وجه السارد لنظام بنت زاهر والحديث عنها. يغيّب الأفقُ مريم، ويُخْرجُها السارد عبر الاستباق من الخطاب في لحظات. لا يستمر السارد إلى أن يصل في سرده إلى موتها في موقعه في التسلل الزمني/الكرونولوجي للأحداث، بل ينتزعه من سياقه ويجره إلى الحاضر ليروي عنه في سطور قليلة، لتصبح مريم بعد ذلك نسيًا منسيًّا إلا طيفًا في الحلم: «ولم أرَ مريم بعد ذلك إلّا في المنام».
قبل زواجهما، كان السارد يهيئ القارئ لحياة غنية أدبيًّا وعلميًّا بين فردين متوائمين بوصفه مريم على لسان فاطمة بنت المثنى بأنها «أديبة خلوقة عالمة أريبة، وأيضًا جميلة». بيد أن الحياة الغنية المثرية أدبيًّا وعلميًّا للطرفين على السواء لم تتحقق إطلاقًا. فما يتحقق بالفعل هو غياب مريم الأديبة والعالمة الأريبة، وحضور مريم، المرأة الجميلة والمهملة التي تسافر لمسافة طويلة بصحبة ابنتها وعبد سابق وآخر جديد إلى زوجها البعيد في مكة، وتفجع بموت ابنتها في الطريق؛ أو تحضر جسدًا يتغنى زوجها بجماله: «أحببت مريم. ذقنها الحاد وعيناها الوثابتان وجسدها المائل للامتلاء، وكفّاها السمينتان اللتان كانت تخجل منهما»، «ما أجمل جسد مريم وما أنعمه وأصفاه…جسمها ريّان بسمنة خفيفة». وبعد الْتِمام شملهما في مكة، وفي أول خلوة بينهما بعد انتهاء العزاء بموت زينب، يكون جسم مريم هدفًا لعيونه المتفحصة: «خلوت بها أخيرًا فإذا بها تغيرت علي. زادت شحومها وكأنها لم تسافر ولم تثكل». والكلام عن مريم خاتمة الكلام في هذه المقاربة التي ربما أصابت بعض النجاح في تحليل التقنية السردية في «موت صغير» واستكشاف طبيعة ابن عربي ساردًا، وتبيان خصائص أسلوبه السردي، وتأثير علاقته بالذات المسرودة في تشكيل صورة الأخير، وتحديد الملامح الفنية لسرده.

بواسطة سعد البازعي - ناقد سعودي | يونيو 30, 2017 | مقالات
استوقفتني عبارة للمفكر الفرنسي جان بودريار وردت في كتابه «كرب القوة». العبارة ستفاجئ البعض وتحزن البعض الآخر. هي عبارة تتضمن شكوى لم نألفها وترفًا لم يمر بنا: ترف الحرية. هكذا سيراه من يبحث عن فتات من تلك المحلوم بها أبدًا، الحرية، تمامًا كما هو شعور الجماهير تحت نافذة القصر الإمبراطوري التي يقال: إن ماري أنطوانيت أطلَّت منها لتقول عبارتها الشهيرة: لِمَ لا يأكلون كعكًا، أو كما قالت. فماذا قال بودريار؟
قبل إيراد العبارة من الضروري معرفة السياق. جاءت العبارة ضمن مناقشة بودريار لما وصفه بالانتقال في تاريخ العالم الغربي من مرحلة السيطرة (domination) إلى مرحلة الهيمنة (hegemony)، الأولى هي مرحلة العبودية أو السيطرة المباشرة التي سادت في الماضي، والثانية هي مرحلة الخضوع غير المحسوس والمشاركة في عملية الإخضاع نفسها. وهذه الثانية هي المرحلة الحالية التي يسيطر فيها اقتصاد السوق والعولمة أو عملية التبادل التجاري الطاغي على كل شيء. ثم يشير إلى أن مرحلة العبودية أدّت في ذروتها إلى حركة تحرر سواء أكان سياسيًّا أم جنسيًّا أم غير ذلك، لكنها اتسمت بأفكار واضحة وقادة مرئيين، أما الثانية فلا تسمح، كما يقول، بالثورة عليها، وقبل إيضاح السبب وراء ذلك يلزم القول بأن الواقعين سواء تحت السيطرة أو الهيمنة ليسوا محصورين، كما قد يظن لأول وهلة، في أهل العالم غير الغربي، شعوب آسيا وإفريقيا… إلخ، الذين استُعمروا ونُهبوا طوال قرون، ليسوا أولئك فقط، إنما هم أيضًا الشعوب الغربية نفسها التي ظلت محكومة أيضًا بقوى سياسية واقتصادية واجتماعية، وبأوضاع من التفاوت الطبقي وعدم القدرة على تغيير شيء، مع أنها استفادت من الاستعمار والنهب الذي مارسته حكوماتها، وإن لم يشر بودريار إلى ذلك.
حروب التحرر
ذلك كله يقف وراء النتيجة التي توصل إليها المفكر وعالم الاجتماع الفرنسي حين قال: «كل حروب التحرر من السيطرة لم تزد على أن مهدت الطريق للهيمنة، أي عهد التبادل العام – التي لا مجال للثورة عليها؛ لأن كل شيء بات محرَّرًا». التبادل العام هو اقتصاد السوق حيث تبادل السلع والأفكار وغيرها، السوق التي تعولمت ولم يعد ممكنًا السيطرة عليها، بل التي باتت هي، حسب بودريار تسيطر على الناس. في تلك السوق لم يعد مجال لثورة لأنه لم يعد هناك متسلط واضح يمكن الثورة عليه.
لكن هذا لن يبدو مقنعًا لشعوب كثيرة حول العالم تعرف المتسلطين، شعوب ما زالت في مرحلة تسبق تلك التي رأى بودريار أن العالم وصل إليها، مرحلة يهيمن فيها فرد مستبدّ أو عسكر، أو أقلية أو مجموعة من المتزمتين أو المؤدلجين أو أو. بالنسبة لأولئك سيبدو كلام بودريار ترفًا لا معنى له. ثمة أولويات تسبق العولمة. غير أن المشكلة لن تقف عند ذلك الحد. ستبدو المشكلة مضاعفة حين تكتشف تلك الشعوب أن ما يقوله المفكر الفرنسي لا يخلو من صحة، أن العولمة من خلال اقتصاد السوق وهيمنة الاستهلاك قوة طاغية أيضًا. صحيح أن بودريار لم يلتفت إلى تلك السلطة المضاعفة لكن ذلك ليس متوقعًا منه، فالالتفات هنا هو ما يجب على مفكِّري العالم غير الغربي فِعله.
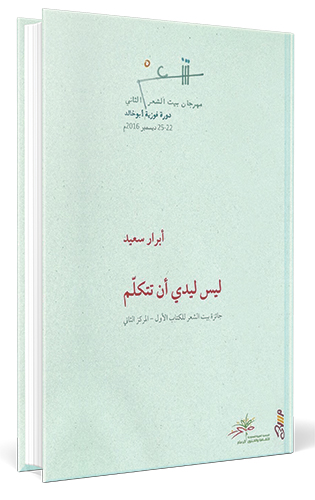
بواسطة عبدالله السفر - شاعر سعودي | مايو 2, 2017 | كتب
تبدو كتابة أبرار سعيد مشدودةً بين قطبين متنافرين وعلى الضد، يعكسان حالة التوتر والاضطراب والتردّد والحيرة. الشاعرة جوّابةُ جهاتٍ ومواقع، لا تفتأ تجد نفسها بين الساخن والبارد، إن على مستوى حضور الذات في الجسد الاجتماعي أو على مستوى معاينة الكتابة ودورها. تمسك نغمةُ هذه الحركة من النَّوَسان بروح كِتابها «ليس ليدي أن تتكلم» (جمعية الثقافة والفنون بالدمام – ٢٠١٧م، توزيع: دار مسعى) وتطبعه بأثرٍ بارز لا تذهب عنه عين القارئ.
القفص بطائره المحبوس. الطائر المعتقل بين الصفحات. السمكة المشكوكة إلى صِنَّارة الصيّاد. السمكة التي ترتطم بجدران الداخل. النافذة المشرفة على الحياة والمحجوبة عنها. الحلقة المحكَمة الإقفال. العجلة الدائرة بغير هدى ولا نهاية. بناءاتٌ مكافِئة تنجزها الشاعرة تعبيرًا عن الحصار المضروب حول المرأة وليس بمقدورها أن تخرج عليه وتتخلّص منه (هنالك قوّةٌ ما/ صنَّارةٌ عالقةٌ بين الصخور، أتدلّى من رأسها/ وأرفرف كسمكةٍ لا تحاول الطيران).. (ماذا عنّا؟/ عن هذا الطير الذي يرفرف في الداخل؟).. (النافذة مغلقة/ لأنّ السماء وجوهٌ وعيونٌ وشهوات/ لأنّ العصفور يضربُ السجين بإلحاح/ لأنّ بعوضةً كانت تحاول أن تذهب أبعدَ من عضّةٍ على الجلد/ ولأن السيّد كان دَبِقًا وتَعِبًا).
صوت يتسلق الصور
 من إهاب المقاومة والاحتجاج تشحذ الشاعرة حنجرتها وتطلق صوتها يتسلّق السور وتدفع بهوائها، وإن يكن شحيحًا، إلى عناق الأفق؛ تطلبُ شمسَه وأحلامه؛ تبذرُ أجنحةً تحملها نحو شغفها بضفافه المترعة؛ تمسُّ المستحيل بأصابع من دم وحنجرةٍ من لهب. تقرع. تتّقد. تدفع. تضطرم؛ فالهاجسُ المرفوعُ هالةً يجذبها بدواره الشديد وسطوعه في العروق؛ نداءً يمضي بها إلى تصريف إرادتها وتعميق وعيها بقصد أن تعلو على تاريخٍ موشومٍ بالقيد والخذلان وبمزيدٍ من الخسارات المتراكمة.. بقصد أن تقطّر صوتها في «جسومٍ كثيرة»؛ فالطيور التي لم تحلّق؛ ينبغي لها أن تسعى إلى رحلتها (أريد أن أكون بساطًا سحريًّا أو/ طائرًا/ أريد كلَّ ما يظنّونه جنونًا/ أن أتخلّصَ من كلِّ ما يحنّطُني/ لستُ لأيِّ فكرة محدّدة/ إنني بأفكارٍ ملتمعةٍ كالنصال).. (من السخرية أن يقول الطبيب إنني أعاني ضيقًا في الأوردة/ أنا أعانيه أصلًا، أعاني الضيق من كل جانب/ ولكن، أليست هذه إشارة؟/ داخلي يطلبُ تمرّدًا أيضًا،/ رفْسَ الجدران واختلاقَ أيِّ نافذة).. (في قلبِ هذا الهدير/ أنا جذوةٌ/ تطفو فوقَ هزائمها).. (أُطعِمُ صوتي/ لفمِ كلِّ امرأةٍ يعلو الوجع في نبرتِها)
من إهاب المقاومة والاحتجاج تشحذ الشاعرة حنجرتها وتطلق صوتها يتسلّق السور وتدفع بهوائها، وإن يكن شحيحًا، إلى عناق الأفق؛ تطلبُ شمسَه وأحلامه؛ تبذرُ أجنحةً تحملها نحو شغفها بضفافه المترعة؛ تمسُّ المستحيل بأصابع من دم وحنجرةٍ من لهب. تقرع. تتّقد. تدفع. تضطرم؛ فالهاجسُ المرفوعُ هالةً يجذبها بدواره الشديد وسطوعه في العروق؛ نداءً يمضي بها إلى تصريف إرادتها وتعميق وعيها بقصد أن تعلو على تاريخٍ موشومٍ بالقيد والخذلان وبمزيدٍ من الخسارات المتراكمة.. بقصد أن تقطّر صوتها في «جسومٍ كثيرة»؛ فالطيور التي لم تحلّق؛ ينبغي لها أن تسعى إلى رحلتها (أريد أن أكون بساطًا سحريًّا أو/ طائرًا/ أريد كلَّ ما يظنّونه جنونًا/ أن أتخلّصَ من كلِّ ما يحنّطُني/ لستُ لأيِّ فكرة محدّدة/ إنني بأفكارٍ ملتمعةٍ كالنصال).. (من السخرية أن يقول الطبيب إنني أعاني ضيقًا في الأوردة/ أنا أعانيه أصلًا، أعاني الضيق من كل جانب/ ولكن، أليست هذه إشارة؟/ داخلي يطلبُ تمرّدًا أيضًا،/ رفْسَ الجدران واختلاقَ أيِّ نافذة).. (في قلبِ هذا الهدير/ أنا جذوةٌ/ تطفو فوقَ هزائمها).. (أُطعِمُ صوتي/ لفمِ كلِّ امرأةٍ يعلو الوجع في نبرتِها)
لكن.. أن تطرق وتطرق بلا نتائج.. أن تدوي بالصرخة بلا طائل.. أن تجوب باعتراضاتك طولًا وعرضًا بلا فائدة. ليس ثمة من رجْعٍ ولا مجيب. المكان مصمت. لا ينفذ منه الصوت. لا تمرّ منه الرسائل، وإن مرّت جرى عليها كتابُ المحو فورًا. جميع محاولات التململ والرفس. كل الركض واللهاث؛ تبوء بالمحصلة ذاتها من الخواء وفراغ اليدين ومن التسمّر عند الخطوة نفسها. كأنما الحركة ليست حركة. الوهمُ زيّنها وطار بها غير أنها فقاعة سرعان ما تنفثئ وتتلاشى. ماذا يحصل من فشلٍ يتوالى؟.. ماذا ينجم عن جهودٍ تطيش؟.. ماذا يترتَّب على أفعالٍ تكرارية تتعثَّر كل مرة؛ فهي في المكان نفسه والزمان بتحولاته يسبق ويسبق؟.. النير لا يُرفع. والبوابة يبدو أن مفتاحها ضائع ولا سبيل إلى استرجاعه. نقرأ في كتاب علم النفس عن «العجز المكتسب» الذي يصل إليه الفرد أو يرتطم به عندما لا يتغيّر شيء لا في البيئة ولا في الظروف من حوله مهما يصدر عنه من محاولاتٍ للتجاوز والانتقال والتحوّل. تتكرّر أمامه صورة واحدة. يعود إليها دائمًا. عندها يحدث الاستسلام والقبول في أبشع وجهٍ له؛ خضوع الضحية وانقيادها لما هو مرسومٌ لها؛ انسحاقها بلا رغبة ودون رجاء إلى درجة الاستعذاب الماسوشية (أكتب جثّة/ تحت السياط، لا شيء يؤلم/ لا شيءَ حي).. (لم أعد أهتمّ كثيرًا بالوصول/ أو دفْع الأيام أكثر مما تحتمل/ لديّ ما يكفي من الوخز الذي لا أريد من أجله هذه اليقظة).. ( أصابعي تطرق/ كالمناقير اللحوحة، وأدرك أن لا شيء/ إذ إن دائرةً واحدةً تدور، وإن الحلقة هي نفسها الفراغ).. (تدور في المشهد/ تدور/ بلذّةِ فأرٍ يلاعب عجلة).
ذات مذبذبة بين ركنين
تقوم أبرار سعيد بإنزال مختبر الكتابة لديها ضمن ذلك التقاطب الذي يتوزّع الذات مُذبذَبةً بين ركنين يدفع أحدهما الآخر، فيأتي المختبر مرآةً جامعةً يتلامحُ فيها الضددان عبر وسيطٍ آخر هو الكلمة التي تختزن كلَّ مقامٍ.. وكلَّ حالةٍ وتعيد إنتاجها بشكل جمالي متخفٍّ لكنه لا يبرح يشير إلى منشئه ومبرّر وجوده؛ الحدّ الاختباري لبزوغ لغةٍ واصفة تتعدّى مشغلها الذي يدور حولها ويناور قريبًا منها، فتصبح جزءًا من عُدّةٍ وظيفية تنخرط في إجلاء التوتر المزدوج بوضوحٍ على فضّة المرآة؛ الانعكاس الموّار المتبدّل بالتماعاته شأن بحرٍ في دولاب مدّه وجزره (اقرأ الشعر/ اقرأْ هذه الجلبة الميتة).. (أشعرُ بتفاهة الكلمة/ هي لا تفعل شيئًا، هي لا تتحرّك/ لا تنطق أو تصرخ/ لا تقول احترسْ أو تمهَّلْ على الأقل/ إنّها ببطءٍ تسحبُ جذرًا من الأعماق/ تسحبُ أعماقًا إلى الخارج/ وتتركُ بئرًا/ تتركُ فمًا/ حفرةً لضحايا آخرين).. (أضيق داخل شرنقة/ وأكتب قصيدةً لن تخرجني/ فراشةً حالَ اكتمال أطواري)…. (أفتح شرياني المخنوق حتّى آخره/ بحافةِ كلمةٍ مسنّنة/ أضمّها كخنجرٍ/ تحت لساني).. (الكلمة أصابع في العين/ أصفادٌ تنبح في اليدين/ ولهبٌ يُصَبُّ فوقَه الزيت).. (تمرّ الفكرة بي/ تمرُّ بي/ بفتنةِ/ مَن قطعوا أصابعهم ولم ينتبهوا إلى الدم الذي يلطّخُ الثمار).. (في فمي كلمة/ في فمي زجاجة/ في فمي شلّالُ دمٍ ينهمر) وهنا – في هذا المقطع – غير خافٍ التناص مع جلال الدين الرومي: «إنّ الدم ليتفجّرُ من فمي مع الكلمات».
في بينيّةٍ هاصرةٍ منذ العنوان حتى آخر نصٍّ في الكتاب عن وردةٍ مطلّةٍ «خلف السياج»؛ تسعى الشاعرة أبرار سعيد. تقطع أشواطًا، وكلّما فدح بها اليأس لاذت بحائطٍ ما؛ تتشيّأ معه، تصنع عزاءً مؤقَّتًا كرفّةِ نسيانٍ صغيرة. ربما تصبح -عندما تنفلت عائدةً- ذات منظورٍ مغايرٍ يعني المثابرة وحدها. المسعى الذي لا يتبدّل رغم النهايات المحسومة سلفًا.. «روحي طلاءٌ يقطُرُ ولا يجفّ». فطوبى لـ«قلب يشمُّ الضوء ولا يراه».

بواسطة حسن النعمي - ناقد سعودي | مارس 1, 2017 | مقالات
ساد شعور عام لدى النخب الثقافية والأدبية أن التفات الشعراء في المملكة لكتابة الرواية والقصة حدث جديد، وهو شعور مبرر في ظاهره، إذ ركز الإعلام الثقافي على ظاهرة كتابة الرواية والقصة من جانب شعراء كبار بحجم القصيبي والدميني، وهو ما جعل الأمر يشبه الاحتفالية من ناحية، والتساؤل من ناحية أخرى، تساؤل وصل إلى حد اتهام الشعر بفقدان دوره في الحياة الأدبية. وهو استنتاج متعجل تنقصه القراءة المتعمقة سواء في مستواها التاريخي أو الظاهراتي.
هنا سأحاول استكشاف الظاهرة، ظاهرة كتابة شعراء الجيلين الأول والثاني في المملكة العربية السعودية للقصة بعد أن استقرت أدواتهم الشعرية، وعُرفوا بعطائهم الشعري الذي استحقوا به لقب شاعر. وعليه فإني لست معنيًّا هنا بما قدمه شعراء العقدين الأخيرين من مغامرة في كتابة الرواية والقصة، بل سأعود بالقراءة إلى بدايات الأدب في المملكة، وبخاصة في مرحلة الجيلين الأول والثاني، لنرى محاولة اقتراب الشعراء من القصة في زمن لم يكن للقصة شأن يذكر، بل لا حظ من الشهرة لمن يكتبها مثل ما للشعراء من حظ وحظوة. فما الأسباب التي جعلت من القصة تجربة يحرص الشعراء على كتابتها؟! وقبل مقاربة الأسباب أرى أنه لزامًا إثبات الظاهرة، ثم استخلاص ما يبدو من أسباب ثقافية أو فنية.
في بدايات نهضة الأدب كان الاهتمام بالشعر، وهو اهتمام يتجاوز قول الشعر إلى مواكبته دراسة ونقدًا ، بل تخصيص صفحات الجرائد للقصائد الطوال، إضافة إلى ما ينشره الشعراء من دواوين مستقلة، أو يلقونه في المنتديات. أما ما سوى ذلك من الكتابات فيأتي في مرتبة متأخرة من حيث الاهتمام.
إذن ما واقع القصة ومن يكتبها في تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الأدب السعودي؟ كانت القصة، في مطلع نهضة الأدب السعودي، نوعًا أدبيًّا حديث الولادة في ثقافة شعرية بامتياز. فجلّ ما كُتب من القصص والروايات في الأدب السعودي حتى مطلع الثمانينيات الميلادية قليل ولا يقاس عليه. ويفتقر في الغالب للتطور الفني الذي يؤكد إحداثه لاختراقات فنية. وكل الجهود في كتابة القصة التي قدمها الأنصاري والسباعي والمغربي وعزيز ضياء وحتى دمنهوري والناصر ورضا حوحو وعالم الأفغاني وغيرهم كانت تتلمس طريقًا غير مطروقة، وتسعى لتأسيس موقع داخل خارطة الأدب السعودي. إضافة إلى ذلك، فإن هؤلاء الكتاب كانت لهم انشغالات أخرى إلى جانب كتابة القصة، ومعظم ما يكتبون يُدرج في باب النثر لا السرد. وتلك حكاية أخرى. وعليه، فالاهتمام العام كان موجهًا للشعر والحظوة كانت للشعراء. وفي ظل هذا الواقع، واقع حضور الشعر، وخفوت صوت القصة، ما الذي يغري الشعراء بكتابة القصة؟!
تعبيرية شعرية
 من محددات هذا المقال أنه لا ينظر في إنتاج من غلبت عليه جوانب تعبيرية أخرى غير شعرية، بمعنى أن الشعر هو موجب النظر في تجربة من يكتب القصة. فمن بين هؤلاء الشعراء يأتي محمد حسن عواد، وحسن عبدالله القرشي، وسعد البواردي، وأحمد عبدالغفور عطار، وحسين سرحان، ومحمد حسن فقي، وغيرهم، وهؤلاء جميعهم كتبوا القصة، بل بعضهم أصدر مجموعة أو مجموعتين، لكنهم ظلوا محتفظين بلقب شاعر، ولم تغلب عليهم صفة القاص!
من محددات هذا المقال أنه لا ينظر في إنتاج من غلبت عليه جوانب تعبيرية أخرى غير شعرية، بمعنى أن الشعر هو موجب النظر في تجربة من يكتب القصة. فمن بين هؤلاء الشعراء يأتي محمد حسن عواد، وحسن عبدالله القرشي، وسعد البواردي، وأحمد عبدالغفور عطار، وحسين سرحان، ومحمد حسن فقي، وغيرهم، وهؤلاء جميعهم كتبوا القصة، بل بعضهم أصدر مجموعة أو مجموعتين، لكنهم ظلوا محتفظين بلقب شاعر، ولم تغلب عليهم صفة القاص!
فالعواد نشر قصة «الباب المغلق»، ومحمد حسن فقي نشر قصص «سكين، وفيلسوف، وجيل»، وحسين سرحان نشر قصص «حياة ميت، ورجل من الناس، والعودة، والصياد والسمكة، والأحلام لا تعود». وحسن عبدالله القرشي نشر «أنات الساقية»، وأحمد عبدالغفور عطار أصدر «أريد أن أرى الله». وسعد البواردي نشر قصص «أغنية العودة، وشبح من فلسطين، وفلسفة المجانين، وأجراس المجتمع». هذه عينة لإسهام الشعراء في كتابة القصة بطريقة تبدو هامشية في خضم إنتاجهم الشعري، لكن يبقى سؤال حضور القصة في أدبهم قائمًا!! بل يستحق النظر.
السؤال الآن، ماذا يعني أن تكون قاصًّا أو روائيًّا وليس شاعرًا؟
سؤال ربما يختصر ولع الشعراء بمغازلة القصة. وبخاصة إذا عرفنا أنه ربما يندر أن نجد قاصًّا أو روائيًّا متمكنًا حاول كتابة الشعر بعد أن استقرت أدواته القصصية، لكن العكس صحيح، إذ قد يتسلل الشاعر لخيمة القصة مستظلًّا بفيئها، ومحاولًا نسج منظوره للحياة بطريقة محاكاة العالم. فهل الشاعر مهما علا شأنه يبقى مشدودًا تجاه تجارب خارج فضائه التقليدي؟ أو أن الشاعر يظل مشدودًا لإغراء القصة بوصفها نصًّا يتحاور مع العالم بطريقة يبدو العالم معها أكثر رحابة وإنسانية.
القصة حوار بين الذات والعالم، أما القصيدة فصوت الذات الإنسانية في صبواتها وإنسانيتها، ومرارة تجربتها، وهذا لا يقلل منها ومن شعرائها، بل هي تجربة تقارب الحلم. لكن قد يلتبس على بعض قصائد الحكم والمناسبات وقصائد الموضوعات الاجتماعية التي يحاول فيها الشاعر أن يبدو مفكرًا أو حكيمًا أو ناقدًا، أو أن قصائده تمثل ربطًا بين الشعر والواقع، أو أن قصائده تعكس إسهامه في المشاركة في قضايا مجتمعه. والحقيقة أن هذا ليس دور الشعر ولا الشاعر. دور الشاعر الحلم بحياة أفضل دون أن يدخل في مقاربات مباشرة للحياة من حوله. الشعر إن لم يكن رمزيًّا إيحائيًّا فهو أقرب للنظم مهما جلجلت موسيقاه وحسنت قوافيه.
تأسيس عوالم افتراضية
ذكرت أن القصة حوار بين الذات والعالم، وعليه، فالقاص مشغول بتأسيس عوالم افتراضية يجري نحو نشدان الفضيلة على نحو إيحائي. فالقصة بطبعها لا تعالج مشكلة ولا تحلها، بل تعيشها تجربة افتراضية لكيفية الوصول للأجمل والأبهى في الحياة. فالقاص يعيش تجربة خلق العوالم الموازية التي تجعل القارئ جزءًا من التجربة الإنسانية. وقد يحتج بعض بظهور قسمات الواقع جلية في القصة أو الرواية، وهذا أمر طبيعي، لكنها تُحمل دائمًا على المجاز. فظهور أسماء الأماكن، مثلًا، لا يعني أنها نفسُها في الواقع مهما بدت جلية في مشابهتها الواقع.
السؤال، ما الذي دفع الشعراء إلى كتابة القصة في زمن كانت فيه أقل تقديرًا؟ هل لرغبة في توسيع دائرة التعبير، أم أنهم يرون أن كتابة القصة فضيلة لا يجب أن تفوتهم؟! الراجح عندي أنهم رأوا فيها بدائل تعبيرية لا يمكن للشعر أن يملأها. وهذا دال على ذكاء هؤلاء الشعراء. فالقصة لها خصوصية مقاربة الواقع على سبيل المشابهة، وعلى سبيل تأسيس واقع موازٍ يُعمِل فيه الكاتب فرضياته.
يقف الشاعر بين القصيدة والقصة باحثًا عن عالم مختلف. ففي القصيدة يُطرب نفسه، وفي القصة يتحاور مع العالم. وبين غنائه وحواره تكتمل متعته بالشعر، ويكتمل اتصاله بالعالم عندما يكتب القصة. من هنا فحاجته للقصة ليست مجرد حالة استثنائية، بل حالة وجودية، تظهر أكثر عند الشعراء الذين يرون العالم أبعد من مجرد صوت داخلي. القصة تتيح للشاعر ما لا تتيحه القصيدة. من هنا فمحاولته تأكيد أبلغ على رغبته في فهم أكبر للعالم.
مرة أخرى هذه الفرضيات يفسرها اقتراب الشعراء من عالم القصة أكثر من القصاص الذين لا يجدون حاجة للبحث عن صوت داخلي لتجربتهم، إذ القصاص يغنون ويتحاورون في قصصهم عبر خلق عوالم افتراضية يعيشون تفصيلاتها، وينشدون فيها جمال العالم. إن القصاص لديهم القدرة على خلق شعرائهم داخل نصوصهم، وهو ما لا يستطيع مثله الشاعر في خلق قاص في تجربته الشعرية دون أن يسعى لكتابة القصة بوصفها جزءًا من حاجته التعبيرية في فهم العالم.




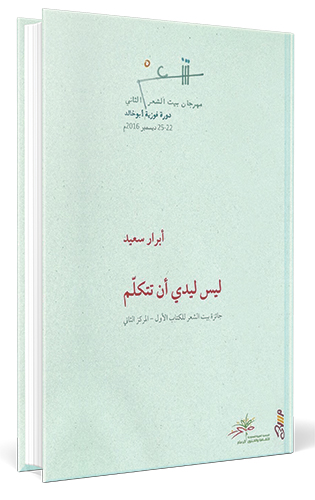
 من إهاب المقاومة والاحتجاج تشحذ الشاعرة حنجرتها وتطلق صوتها يتسلّق السور وتدفع بهوائها، وإن يكن شحيحًا، إلى عناق الأفق؛ تطلبُ شمسَه وأحلامه؛ تبذرُ أجنحةً تحملها نحو شغفها بضفافه المترعة؛ تمسُّ المستحيل بأصابع من دم وحنجرةٍ من لهب. تقرع. تتّقد. تدفع. تضطرم؛ فالهاجسُ المرفوعُ هالةً يجذبها بدواره الشديد وسطوعه في العروق؛ نداءً يمضي بها إلى تصريف إرادتها وتعميق وعيها بقصد أن تعلو على تاريخٍ موشومٍ بالقيد والخذلان وبمزيدٍ من الخسارات المتراكمة.. بقصد أن تقطّر صوتها في «جسومٍ كثيرة»؛ فالطيور التي لم تحلّق؛ ينبغي لها أن تسعى إلى رحلتها (أريد أن أكون بساطًا سحريًّا أو/ طائرًا/ أريد كلَّ ما يظنّونه جنونًا/ أن أتخلّصَ من كلِّ ما يحنّطُني/ لستُ لأيِّ فكرة محدّدة/ إنني بأفكارٍ ملتمعةٍ كالنصال).. (من السخرية أن يقول الطبيب إنني أعاني ضيقًا في الأوردة/ أنا أعانيه أصلًا، أعاني الضيق من كل جانب/ ولكن، أليست هذه إشارة؟/ داخلي يطلبُ تمرّدًا أيضًا،/ رفْسَ الجدران واختلاقَ أيِّ نافذة).. (في قلبِ هذا الهدير/ أنا جذوةٌ/ تطفو فوقَ هزائمها).. (أُطعِمُ صوتي/ لفمِ كلِّ امرأةٍ يعلو الوجع في نبرتِها)
من إهاب المقاومة والاحتجاج تشحذ الشاعرة حنجرتها وتطلق صوتها يتسلّق السور وتدفع بهوائها، وإن يكن شحيحًا، إلى عناق الأفق؛ تطلبُ شمسَه وأحلامه؛ تبذرُ أجنحةً تحملها نحو شغفها بضفافه المترعة؛ تمسُّ المستحيل بأصابع من دم وحنجرةٍ من لهب. تقرع. تتّقد. تدفع. تضطرم؛ فالهاجسُ المرفوعُ هالةً يجذبها بدواره الشديد وسطوعه في العروق؛ نداءً يمضي بها إلى تصريف إرادتها وتعميق وعيها بقصد أن تعلو على تاريخٍ موشومٍ بالقيد والخذلان وبمزيدٍ من الخسارات المتراكمة.. بقصد أن تقطّر صوتها في «جسومٍ كثيرة»؛ فالطيور التي لم تحلّق؛ ينبغي لها أن تسعى إلى رحلتها (أريد أن أكون بساطًا سحريًّا أو/ طائرًا/ أريد كلَّ ما يظنّونه جنونًا/ أن أتخلّصَ من كلِّ ما يحنّطُني/ لستُ لأيِّ فكرة محدّدة/ إنني بأفكارٍ ملتمعةٍ كالنصال).. (من السخرية أن يقول الطبيب إنني أعاني ضيقًا في الأوردة/ أنا أعانيه أصلًا، أعاني الضيق من كل جانب/ ولكن، أليست هذه إشارة؟/ داخلي يطلبُ تمرّدًا أيضًا،/ رفْسَ الجدران واختلاقَ أيِّ نافذة).. (في قلبِ هذا الهدير/ أنا جذوةٌ/ تطفو فوقَ هزائمها).. (أُطعِمُ صوتي/ لفمِ كلِّ امرأةٍ يعلو الوجع في نبرتِها)
 من محددات هذا المقال أنه لا ينظر في إنتاج من غلبت عليه جوانب تعبيرية أخرى غير شعرية، بمعنى أن الشعر هو موجب النظر في تجربة من يكتب القصة. فمن بين هؤلاء الشعراء يأتي محمد حسن عواد، وحسن عبدالله القرشي، وسعد البواردي، وأحمد عبدالغفور عطار، وحسين سرحان، ومحمد حسن فقي، وغيرهم، وهؤلاء جميعهم كتبوا القصة، بل بعضهم أصدر مجموعة أو مجموعتين، لكنهم ظلوا محتفظين بلقب شاعر، ولم تغلب عليهم صفة القاص!
من محددات هذا المقال أنه لا ينظر في إنتاج من غلبت عليه جوانب تعبيرية أخرى غير شعرية، بمعنى أن الشعر هو موجب النظر في تجربة من يكتب القصة. فمن بين هؤلاء الشعراء يأتي محمد حسن عواد، وحسن عبدالله القرشي، وسعد البواردي، وأحمد عبدالغفور عطار، وحسين سرحان، ومحمد حسن فقي، وغيرهم، وهؤلاء جميعهم كتبوا القصة، بل بعضهم أصدر مجموعة أو مجموعتين، لكنهم ظلوا محتفظين بلقب شاعر، ولم تغلب عليهم صفة القاص!