
بواسطة عبدالسلام بن عبدالعالي - كاتب مغربي | نوفمبر 1, 2017 | كتاب الفيصل, مقالات
لنبدأ بهذا السؤال: هل يمكن تصور كتاب في الفلسفة، مهما كانت لغته، لا يتضمن كلمات أجنبية؟ لا أعتقد أن الجواب عسير؛ إذ يكفي تصفح أيّ كتاب في هذا المضمار تأكيدًا الجواب. وبطبيعة الحال، الأمر يصدق بالأَوْلى على النصوص المكتوبة بلغة الضاد. لا أعني فحسب نصوصنا الحالية، إنما أيضًا المتون الكلاسيكية. علينا إذًا أن نتساءل: لماذا تَعْلق اللغة المنقولة بالنص المترجِم؟ لماذا لا تكف الكتابة الفلسفية عن التعلّق بلغة الأصول عندما تنقلها؟ ما سر المصاحبة الدائمة للّغة المنقولة للنّص الناقل؟
ما دمنا قد تحدثنا عن المتون الكلاسيكية، لنتساءل: ما العلاقة التي أقامتها الفلسفة العربية الكلاسيكية بالنصوص التي نقلتها؟ سنلتمس الجواب الذي يفسر عجز اللغة الناقلة عن نقل نهائي لمعاني الأصل من نص مأخوذ من المناظرة المشهورة التي نقلها أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة، وجرت بين المنطقي مَتَّى بن يونس والنحوي أبي سعيد السيرافي، حيث يقول هذا الأخير: «أنت إذًا لست تدعونا إلى علم المنطق، إنما تدعو إلى تعلم اللغة اليونانية وأنت لا تعرف لغة يونان، فكيف صرت تدعونا إلى لغة لا تفي بها؟ وقد عفَت منذ زمان طويل، وباد أهلها وانقضى القوم الذين كانوا يتفاوضون بها، ويتفاهمون أغراضَهم بتصاريفها. على أنك تنقل عن السريانية، فما تقول في معانٍ متجوّلة بالنقل من لغة يونان إلى لغة أخرى سريانية؟ ثم من هذه إلى لغة أخرى عربية؟
قال مَتَّى: يونان وإن بادت مع لغتها فإن الترجمة حفِظت الأغراض وأدّت المعاني وأخلصت الحقائق. قال أبو سعيد: إذا سلمنا أن الترجمة صدقت وما كذبت، وقوَّمت وما حرَّفت… ولا أخلَّت بمعنى الخاص والعام، ولا بأخصّ الخاص ولا بأعمّ العام، وإن كان هذا لا يكون وليس في طبائع اللغات ولا في مقادير المعاني، فكأنك تقول: لا حجة إلا عقول يونان، ولا برهان إلا ما وضعوه، ولا حقيقة إلا ما أبرزوه. قال مَتَّى: لا، ولكنهم من بين الأمم أصحابُ عناية بالحكمة، (…) وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر وانتشر ما انتشر من أنواع العلم، ولم نجد هذا لغيرهم. قال أبو سعيد: أخطأت وتعصَّبت ومِلت مع الهوى، فإن علم العالم مبثوث في العالم بين جميع من في العالم».( أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، تحقيق أحمد أمين وآخرين، المكتبة المصرية، بيروت 1953م، ص116).
طبائع اللغات
يعتمد هذا النص تأويلين يُفسران عجز النسخة المترجِمة عن نقل «أمين» للأصل، أو، لكي نبتعد من مفهوم الأمانة، عجزها عن التحرّر مما سيسميه التوحيدي «الإخلال بالمعاني»، أقول يعتمد هذا النص تأويلين لذلك: تأويلًا يقف عند التوسط اللغوي والزمني، وما يسميه التحوّل بالنقل من لغة إلى أخرى، وتأويلًا آخر لا يظهر جليًّا في هذا النص، ويمرّ مع جملة اعتراضية يُرجع فيه التوحيدي الإخلال إلى ما يسميه «طبائع اللغات ومقادير المعاني». ولعل نصًّا للمؤلف نفسه غير هذا الذي بين أيدينا مأخوذ، هذه المرة من المقابسة 63، يوضح توضيحًا أكثر هذه المسألة. يقول التوحيدي: «على أن الترجمة من لغة يونان إلى العبرانية، ومن العبرانية إلى السريانية، ومن السريانية إلى العربية، قد أخلّت بخواص المعاني في أبدان الحقائق، إخلالًا لا يَخفَى على أحد. ولو كانت معاني يونان تهجس في أنفس العرب مع بيانها الرائع وتصرفها الواسع، وافتتانها المعجز، وسعتها المشهورة، لكانت الحكمة تصل إلينا صافيةً بلا شوب وكاملةً بلا نقص، ولو كنا نفقه عن الأوائل أغراضهم بلغتهم كان ذلك أيضًا ناقعًا للغليل، وناهجًا للسبيل، ومُبلّغًا إلى الحد المطلوب. ولكن لا بد في كل علم وعمل من بقايا لا يقدر الإنسان عليها، وخفايا لا يهتدي أحدٌ من البشر إليها». بهذا المعنى تغدو حكمة يونان منطوية على خفايا لم تغب عن الذين نقلوها إلى لغتهم فحسب، إنما غابت عن يونان أنفسهم. هذا ما يؤكده التوحيدي نفسه: «إنا لا نظنّ أن كل من كان في زمان الفلاسفة بلغ غاية أفاضلهم، وعرف حقيقة أقوال متقدميهم». فكأن الإخلال بالمعاني من صميم المعاني حتى قبل أن تُنقل إلى لغة أخرى.
لعل هذا النصّ يُبرز بشكل أكثر وضوحًا التأويلين اللذين أشرنا إليهما لتفسير تعلّق النص الناقل بالنص المنقول، ومصاحبة لغة النص الأصلي للّغة المترجِمة. التأويل الأول هو ما يمكن أن نطلق عليه بلغتنا المعاصرة التفسير التاريخاني، بمقتضاه تعجز الترجمة عن نقل المعاني بخواصّها لكون تلك المعاني مرغمة على أن تهاجر، وتستغرق الزمن، وتُقحَم في مسلسل التاريخ، وتُنقل عبر وسائط متعدّدة ومتنوعة. وربما لإبراز هذا العامل يصرّ التوحيدي هنا على الوقوف على المسافة الزمنية التي قطعتها حكمة يونان، وذكْر مختلف المحطات التي استقرت بها، والقنوات التي مرت عبرها كي تصل إلى اللغة العربية، مما حال دون حلول حكمة يونان في جسم البيان العربي، وما ترتب عن ذلك من إخلال بخواص المعاني حرَم اللغة العربية من أن تصلها الحكمة «صافية بلا شوب، وكاملة بلا نقص».
كثافة ذاتية
يردّ هذا التفسير إذن ضياع المعنى إلى تعدّد الوسائط، بحيث لو كان في استطاعتنا أن «نفقه عن الأوائل أغراضهم بلغتهم»، من غير قطع كل تلك المسافة الزمنية والانتقال عبر توسّطات، لكنّا بلغنا «الحدّ المطلوب» ونهجنا الطريق الصحيح من غير تيهٍ ولا ضلال و«إخلال» بالمعاني. بيد أن التوحيدي لا يبدو مقتنعا بهذا التأويل «التاريخي»؛ إذ سرعان ما ينتقل إلى تأويل آخر هو الذي يهمّنا هنا لأنه لا يفسر ضياع المعاني بـ«السقطة» التاريخية، إنما بردّه إلى طبيعة المعنى بما هو كذلك. ما يحول دون بلوغ المعنى «كما هو»، ما يحول دون بلوغ «خواصّ» المعاني في هذا التأويل الثاني، ليس هو التوسّط واللامباشرة، إنما المباشرة ذاتها. هنا ينطوي المعنى على كثافة ذاتية تحول بيننا وبين الوقوف على خواصّه جميعِها، تحول بيننا وبين الإحاطة بمضامينه. حينئذ لا يكون التوسّط هو سببَ الضياع، ما دام في كل علم «بقايا لا يقدر الإنسان عليها، وخفايا لا يهتدي أحد من البشر إليها». بهذا المعنى تغدو حكمة يونان منطويةً على خفايا غابت عن يونان أنفسهم: «إنا لا نظن أن كل من كان في زمان الفلاسفة بلغ غاية أفاضلهم، وعرف حقيقة أقوال متقدميهم». الظاهر إذًا أنه إن كان للتوسط مساوئُه، فإن للمباشرة عيوبَها ونواقصَها. هنا يغدو الإخلال بالمعاني، ولا يقول التوحيدي خيانتها، من صميم المعاني حتى إن كانت مباشرة، وسنقول نحن اليوم، مع من يُدْعون بفلاسفة التوجس les philosophies du soupçon، خصوصًا إن كانت مباشرة.
لن يرجع تستّر المعنى، والحالة هذه، بالأساس إلى أخطاء المترجم ولا إلى عجزه عن إدراك ما يجول بذهن المؤلف، وعدم تمكّنه من بلوغ نواياه، والوقوف على مقاصده، إنما إلى ما يسميه التوحيدي بالبقايا التي ينطوي عليها كل علم وعمل. كل علم يَدَع شيئًا ما يفلت من يديه، كل نصّ ينطوي على كثافة سيميولوجية تجعل حتى صاحبَه عاجزًا أن يحصرها من غير انفلات «بقايا لا يقدر عليها». فلا سبيل إلى استرجاع تامّ للنص الأصلي. ولا تسعف المباشرةُ المؤلفَ نفسه حتى يتمكن من بسط سلطته على النصّ لحصر معانيه وضبطها، والتحكّم في المتلقي مهما تنوّعت مشاربه اللغوية والثقافية. إنها ترسّب بقايا تنفلت من كل رقابة شعورية، وتجعل النصّ يفلت من قبضة صاحبه، وتجعل المعنى ينفلت ويمتد في اختلاف عن ذاته، لا يحضر إلا مبتعدًا منها مباينًا لها، خصوصًا إن كان مرغمًا على التنقل بين الأحقاب والتجوّل بين اللغات.

بواسطة عبد الرحيم الرحوتي - كاتب مغربي | مايو 2, 2017 | كتب
وجهت عالمة الاجتماع الفرنسية من أصل تركي نيلوفر غول اهتمامها، في الكتاب الذي أصدرته حديثًا وعنوانه «المسلمون في الحياة اليومية: بحث ميداني أوربي عن الجدل حول الإسلام» ( صادر عن La Découverte) لرصد المعيش اليومي للمسلمين في مختلف البلدان الأوربية من زاوية الجدالات التي يثيرها الإسلام بين الحين والآخر. باستثناء الفصل الأول الذي تناولت فيه المؤلفة الأدبيات السوسيولوجية المرتبطة بالعداء للإسلام في أوربا، فإن بقية فصول الكتاب خصصت بالكامل لعرض نتائج بحث ميداني دارت أطواره في بلدان أوربية مختلفة، بهدف قياس حجم ردود الأفعال عن الجدالات القائمة حول الإسلام: الصلاة في الشارع العام، وصوامع المساجد، والرسوم الساخرة من شخصية الرسولﷺ، ومسألة الحجاب، والتمسك بتعاليم الشريعة الإسلامية.
تقوم المنهجية المتبعة في البحث على توجيه أسئلة للمسلمين ولغير المسلمين في أماكن كانت مسرحًا لمواجهات مرتبطة بحضور الإسلام في أوربا. بدلًا من إعادة إنتاج الخطاب السياسي والإعلامي الرائج، فضلت نيلوفر غول توجيه اهتمامها لإبراز صورة المسلمين في معيشهم اليومي كما يرسمونها هم أنفسهم عبر آرائهم ومواقفهم، وفتح المجال لسماع أصوات أناس ليس لهم اهتمام بالإسلام لكنهم يرون أنفسهم معنيين بالجدل القائم حوله، ويرغبون في التعبير عن رأيهم فيه، وكذلك تمكين أولئك الذين يشعرون بأن أصواتهم غير مسموعة من الإفصاح عما لديهم من آراء وأفكار.
فصول الكتاب التي خصص كل واحد منها لمعالجة أحد أنواع الجدل التي عرفتها الفضاءات العمومية الأوربية، سمحت بإبراز أهمية هذه المنهجية وملاءمتها لموضوعها بتوفيرها المجال للتركيز على التعرية الضرورية للواقع التي تأتي بها النظرة السوسيولوجية. بعد تناول معنى ظاهرة دينية مرتبطة بالإسلام، تعمد نيلوفر غول إلى وصف الحدث العمومي الذي قاد إلى جدل محلي أو وطني مهم، ثم تقوم بحصر التصورات الخاصة والعامة التي وردت عند المستجوبين. إذا اتخذنا صلاة الجماعة التي تتناولها الكاتبة في الفصل الثالث مثالًا على ذلك، يمكن القول بأن الصلاة في الإسلام تمارس في أي مكان، على انفراد أو جماعة، باستثناء صلاة الجمعة التي يشترط فيها أن تقام بشكل جماعي. هذه الصورة الجماعية للصلاة هي التي تركز عليها وسائل الإعلام الأوربية، وتستغلها أحزاب اليمين المتطرف كدليل على تعارض الإسلام مع القيم الغربية القائمة على الفردانية. إذا كانت صورة الصلاة الجماعية هذه، قد شكلت أكثر من مرة موضوع مشادات في ألمانيا وفي فرنسا خلال العشرية الأولى من الألفية، فقد أثارت جدلًا واسعًا كذلك في إيطاليا، سنة 2009م. عند انتهاء أطوار مظاهرة لدعم الفلسطينيين في غزة بمدينة بولونيا، قرر بعض المتظاهرين إقامة صلاة الجماعة في عين المكان، أي في الشارع العام، على مرمى حجر من كاتدرائية القديس بيترونيو. في الأيام اللاحقة عبر بعض السياسيين ومواطني المدينة عن غضبهم بسبب ما عدوه انتهاكًا لفضاء مسيحي خالص، وتعبيرًا عن إرادة سياسية لأسلمة القارة الأوربية.
دينامية الفضاء العمومي
ستة أشهر بعد حصول هذه الأحداث، قصدت نيلوفر غول مدينة بولونيا لمعاينة ما إذا كانت دينامية الفضاء العمومي تعكس الحقيقة الاجتماعية. شكلت هذه المبادرة المحاولة الأولى في فضاء عمومي تجريبي. شارك في النقاش أحد عشر شخصًا: ثلاث فتيات من الجالية المسلمة، ورجلان مسلمان اعتنقا الإسلام حديثًا، وثلاثة ناخبين من الحزب اليميني المتطرف، رابطة الشمال، ثم ثلاثة من سكان بولونيا. سمحت النقاشات باستخلاص دروس مختلفة توزعت على مختلف فصول الكتاب. عبر المسلمون الحاضرون عن مواقف مختلفة عن بعضها، وهي إشارة واضحة إلى أن الممارسة الدينية تختلف باختلاف المعيش الفردي، كما كانت وجهات نظرهم متباينة بخصوص إقامة صلاة الجماعة في الشارع العام. الشيء نفسه تكرر عندما تعلق الأمر بمواجهة الاعتداءات اللفظية لناخبي رابطة الشمال؛ إذ فضلوا التزام الهدوء وتلافي المواجهة. خلافًا للتصورات التي يروج لها الإعلام، فإن المسلمين في أوربا، لا يشكلون جماعة تشتغل وفق منهجية معينة، ولا هم ملتفون على رأي واحد، ولا تنطبق عليهم صورة الجماعة العدوانية والشرسة التي تروج لها بعض الأطراف.
لحظت المؤلفة خلال الجلسات أن بعض المشاركين يلتزمون الصمت في أثناء النقاش، وهو ما يفتح المجال واسعًا أمام أعضاء رابطة الشمال للترويج لخطابهم القائم على كراهية الإسلام والمسلمين، وهي الصورة التي تهيمن بصفة عامة على الميدان الإعلامي. أخيرًا، يتسم خطاب المنتمين لرابطة الشمال بنبرة تروم التهجم على المسلمين الحاضرين، كما أنهم يكثرون من التعليقات المجانبة للصواب، ويقطعون كلام المشاركين الآخرين، ويعاكسونهم بحيث يمنعونهم من التعبير عن آرائهم بشكل ملائم. ترى المؤلفة في هذا السلوك تجسيدًا لإستراتيجية الأحزاب اليمينية المتطرفة الجديدة المتمثلة في العمل على ملء الفضاء العمومي، ومنع الآخرين من ولوجه، ولو أدى ذلك إلى التهجم والاعتداء الجسدي والقدح في حق من يرون أنهم أجانب، ويسعون لكي يظلوا كذلك. بالتالي، إذا كان المسلمون يتعرضون لهجمات متكررة مع ارتفاع في حدتها، فلأنهم صاروا اليوم مرئيين أكثر بالنظر لعددهم، بالإضافة إلى جيل جديد حامل لجنسية بلد الإقامة، ولأنهم باتوا يحتلون فضاءات عمومية، ومواقع اجتماعية لها مكانتها، وطوروا قدراتهم على استعمال الوسائل المشروعة لإسماع صوتهم والتعبير عن مطالبهم. بعبارة أخرى، إذا كان المسلمون اليوم يتهمون بعدم قدرتهم على الاندماج، فذلك لأنهم بالضبط مندمجون تمامًا في مجتمعاتهم.
أخيرًا، الجانب الأكثر إثارة للجدل في الكتاب يتمثل في العينات المستجوبة، وفي طرائق انتقائها؛ فالكتاب يهدف إلى رصد التصورات الاجتماعية للمسلمين حول ديانتهم، والرابط الذي يربطهم بالحياة في المجتمعات الأوربية، وهي تصورات اختارت الجدالات العامة مدخلًا لتناولها. بالتالي، فإن المنهجية المتبعة قامت على مقابلات عقدت مع عدد محدود نسبيًّا من الأفراد. جرى الاتصال بهؤلاء غالبًا في أعقاب جدالات عامة، أو من خلال النسيج الجمعوي. عندما ننظر إلى خصائصهم الاجتماعية نجد أن أعمارهم تُراوِح بين 19 و45 سنة، ويمارسون المهن التالية: صناع تقليديون – تجار – أرباب مقاولات – أطر – مهن فكرية عالية – لكن لا يوجد بينهم عمال أو مستخدمون، علمًا بأن هذه الشرائح تشكل نسبة كبيرة من الساكنة النشيطة. المسلمون المستجوبون هم مسلمون لكن ليسوا عاديين بالشكل المعلن عنه، ولا يمثلون مختلف شرائح الساكنة الإسلامية الأوربية.

بواسطة رشيد بوطيب - كاتب مغربي | مارس 1, 2017 | كتاب الفيصل, مقالات
«ليليث وشياطين الرأسمال: الاقتصاد على سرير فرويد»، صدر عن دار هانزر، لتوماس سيدالشيك وأوليفر تانسر. أحدهما تشيكي، عمل لسنوات في القطاع البنكي، إلى جانب تدريسه الاقتصاد في الجامعة التشيكية، وحصوله على عضوية المجلس الأخلاقي لمنتدى الاقتصاد العالمي، والثاني صحفي نمساوي، يعمل في الصحافة اليومية، وعمل لسنوات مراسلًا للإذاعة والصحافة المكتوبة النمساوية لدى الاتحاد الأوربي. كلاهما سيبحر في مغامرة لم يسبق لغيرهما أن قام بها، تطبيق منهجية التحليل النفسي على نظام اقتصادي، أضحى يشكل مشكلًا للسياسة والمجتمع عامة، بل كما يقولان، لطريقتنا في التفكير. «إن طوطم عصرنا هو الاقتصاد، وسنضع الاقتصاد على سرير المحلل النفسي ونصغي إليه؛ لنعرف ما الذي يقوله؟ ما الذي يأمل أو يحلم به؟ عن أي شيء يفضل الحديث؟ وما الذي يكبته في الأعماق؟.. إلخ». يبدو كما لو أن الاقتصاد يعاني اليوم اضطرابًا ثنائي القطب: الهوس الاكتئابي. وينتج عن ذلك الفوضى. إن الفكر الاقتصادي نتاج للنفعية الفردانية التي تتعامل مع كل القيم الأخرى بسخرية، وحتى إذا ما دخل الاقتصاد كعلم في علاقة بالتخصصات الأخرى، تراه لا يسعى إلى تعلم شيء جديد، إنما للسيطرة عليها وفرض منطقه.
يهتم التحليل النفسي تقليديًّا بالأفراد وحيواتهم، لكن الباحثين يسعيان إلى تطبيقه على مستوى أكبر، وبحث إن لم تكن تلك السلوكيات المنحرفة التي نجدها عند الأفراد، حاضرة بشكل جمعي لدى المجتمع. وهما يعتقدان أنهما ربما يصلان عبر ذلك إلى علاج للاقتصاد، علاج جمعي، أو «علاج الحضارة» كما أسماها الكاتب والمحلل النفسي الإيطالي Luigi Zoja.
لقد اعتدنا على تحليلات تهم «جسد» الاقتصاد، أي الاقتصاد الواقعي، المادي، الوظيفي، الذي يمكن حسابه، والصناعة، وعالم الإنتاج والاستهلاك.. إلخ لكن ما ندر القيام به برأي الباحثين هو دراسة «روح» الاقتصاد. فداخل تلك الروح، أي داخل الاقتصاد كعلم، تتموقع معتقداته، ومخاوفه وآماله، وفعلنا السياسي، وأيضًا تصوراتنا عن الحرية والمراقبة، على الرغم من أنها تعبر عن نفسها بداية في «جسد» الاقتصاد، في الاقتصاد الواقعي. وكما الحال عند الإنسان وأمراضه النفسية، فإن جسد الاقتصاد وروحه ملتحمان.
اقتصاد يعاني اضطرابات نفسية
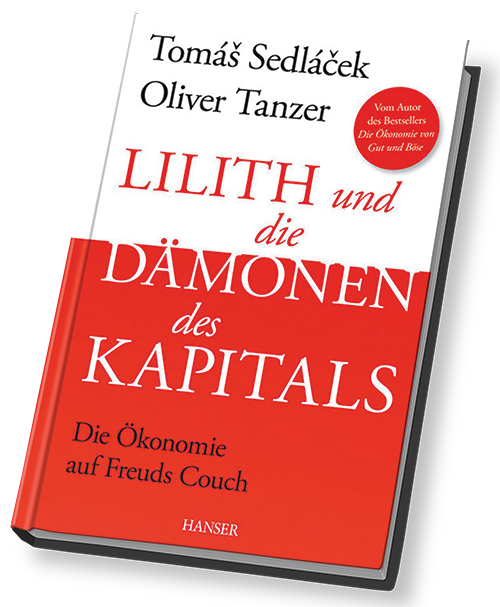 يسجل الباحثان وجود خمسة أنواع من الاضطرابات النفسية في الاقتصاد المعاصر، لا تمثل فقط جزءًا منه، بل تسيره بالطريقة التي تريد. أولًا: اضطراب في معرفة الواقع: ويريان ذلك نتيجة لمبدأ اللذة الذي يطالب باستمرار بمزيد من الإنتاج والاستهلاك. ثانيًا: اضطرابات ناتجة عن الخوف. وهي ما يدفعنا للنظر إلى الواقع بشكل سلبي، ويقود إلى سلوكيات غير عادية، وخصوصًا في مراحل الأزمة. ثالثًا: اضطرابات لها علاقة بالوضع النفسي، أو ما يسمى بالاضطرابات العاطفية، وهنا ستتم دراسة دورات الهوس الاكتئابي، التي تتعلق بالتطورات المتصلة بالطفرات والأزمات الاقتصادية. رابعًا: اضطرابات تتعلق بالسيطرة على الدوافع، وهنا ستتم دراسة نموذجين للسلوك: إدمان اللعب الذي نلحظه لدى البنوك الاستثمارية، والسلوك الثاني المرتبط بإدمان السرقة «الكليبوتوماني»؛ إذ من المثير للانتباه أن ذلك الذي يحقق نجاحًا داخل هذا النظام الاقتصادي، ويملك العمل والسلع والرأسمال، هو الذي لا يقدم شيئًا مقابل ذلك. خامسًا: اضطرابات الشخصية: من أجل المحافظة على النظام الذي يقوم على العنف والمنافسة، يتوجب على المشاركين فيه أن يتلقوا تكوينًا مناسبًا لطبيعته، يصنع منهم أشخاصًا أنانيين وعنيفين، بعيدًا من كل إحساس بالإنسانية والغيرية، وبعيدًا من كل حس سليم. إنهم مجرد أدوات في نظام لم يعد يخدم مَن صنعه، بل استولى بنفسه على السلطة. إن هذا لا يعني أن المشاركين في النظام أناس سيئون، بل إن النظام من يرغم خَدَمهُ على الاضطلاع بأدوار باثولوجية.
يسجل الباحثان وجود خمسة أنواع من الاضطرابات النفسية في الاقتصاد المعاصر، لا تمثل فقط جزءًا منه، بل تسيره بالطريقة التي تريد. أولًا: اضطراب في معرفة الواقع: ويريان ذلك نتيجة لمبدأ اللذة الذي يطالب باستمرار بمزيد من الإنتاج والاستهلاك. ثانيًا: اضطرابات ناتجة عن الخوف. وهي ما يدفعنا للنظر إلى الواقع بشكل سلبي، ويقود إلى سلوكيات غير عادية، وخصوصًا في مراحل الأزمة. ثالثًا: اضطرابات لها علاقة بالوضع النفسي، أو ما يسمى بالاضطرابات العاطفية، وهنا ستتم دراسة دورات الهوس الاكتئابي، التي تتعلق بالتطورات المتصلة بالطفرات والأزمات الاقتصادية. رابعًا: اضطرابات تتعلق بالسيطرة على الدوافع، وهنا ستتم دراسة نموذجين للسلوك: إدمان اللعب الذي نلحظه لدى البنوك الاستثمارية، والسلوك الثاني المرتبط بإدمان السرقة «الكليبوتوماني»؛ إذ من المثير للانتباه أن ذلك الذي يحقق نجاحًا داخل هذا النظام الاقتصادي، ويملك العمل والسلع والرأسمال، هو الذي لا يقدم شيئًا مقابل ذلك. خامسًا: اضطرابات الشخصية: من أجل المحافظة على النظام الذي يقوم على العنف والمنافسة، يتوجب على المشاركين فيه أن يتلقوا تكوينًا مناسبًا لطبيعته، يصنع منهم أشخاصًا أنانيين وعنيفين، بعيدًا من كل إحساس بالإنسانية والغيرية، وبعيدًا من كل حس سليم. إنهم مجرد أدوات في نظام لم يعد يخدم مَن صنعه، بل استولى بنفسه على السلطة. إن هذا لا يعني أن المشاركين في النظام أناس سيئون، بل إن النظام من يرغم خَدَمهُ على الاضطلاع بأدوار باثولوجية.
يؤكد الكاتبان أنهما سينهجان طريق التحليل النفسي. فليس هدفهما إصدار أحكام واتهامات، لكن الإصغاء لما يقوله الاقتصاد. فهذا الكتاب لا يجب عدّه كتابًا ضد اقتصاد السوق الرأسمالي، البنوك والأسواق المالية. إنهما يريان النظام الاقتصادي الحالي خطوة في مسار تقدم البشرية، جعل من حياة الإنسان على الأرض أفضل مما كانت عليه من قبل. لكنهما يؤكدان أيضًا أن ذلك لا يجب أن يمنعنا من انتقاد انحرافات النظام، وتوصيف أمراضه، وبحث سبل علاجه. إن أسطورة «ليليث» العبرية، التي اختير اسمها عنوانًا لهذا الكتاب، تلخص بنظر الباحثين، حقيقة الاقتصاد الرأسمالي. إن ليليث، وفقًا للرواية العبرية، أول امرأة لآدم. لقد خلقت هي الأخرى مثله من طين، وكانت تشبهه في كل شيء. بل إن تمسكها بهذه المساواة بينها وآدم، هو ما جعلها تدخل في صراع معه. إنها رمز لأول كائن بشري طالب بالحرية. ومن أجل ذلك هرب من جنة عدن وحقت عليه لعنة الرب. ستتحول إلى شيطان يقوم بقتل المواليد الجدد وامتصاص دمهم. ومن هذه الطاقة التي ستحصل عليها، ستضع شياطين جددًا، مئة كل يوم، لتقوم بعدها بقتلهم أيضًا. وسبب كل هذه الثورة، هو أنها وجدت في الوضع الجنسي، أن تتمدد تحت جسد آدم خلال المضاجعة، رمزًا للقمع والحط من كرامتها. إن سلوك ليليث يقوم على مبدأين: الاستهلاك والتدمير. ولهذا هي تشبه في كثير الاقتصاد الذي يقوم على التدمير. إنها ماكينة استهلاك، لا تتوقف عن الإنتاج كما لا تتوقف عن التدمير. إنها رمز للحياة والموت، للإنسانية والسمو، وفي الآن نفسه للبدائية والتوحش، جوع لا يشبعه شيء. فمبدأ عصرنا، كما يؤكد الباحثان، ليس سد رمق الجائع، بل إشباع الشبعان. وهو ما يشكل في حد ذاته مشكلة كبيرة. فالإشهار، على سبيل المثال لا الحصر، لا يقوم بشيء آخر أكثر من «إيقاظ جوعنا غير الحقيقي بشكل ليبيدي». إننا أمام «دونجوانية اقتصادية»، لا تتحقق إلا كاستهلاك مستمر، وكما يستهلك الدونجوان نساءه، يستهلك الاقتصاد العالمي السلع والموارد. وهناك حيث يعجز عن الاستهلاك، يحل الركود وتسيطر الكآبة. إننا نقف أمام نظام اقتصادي واقعي لا يتورع عن إنتاج المرض من أجل تسويق الدواء، وفي هذا السياق يسجل الباحثان أنه «كلما ازداد الناس سمنة، كلما ازداد الاقتصاد نموًّا». إن هذا الاستنتاج لا يدخل في باب النكتة أو السخرية السوداء. إن الأرقام والإحصائيات في الدول الغربية تؤكد ذلك.
إضافة إلى ذلك، فإن مبدأ النمو المستمر الذي يقوم عليه الاقتصاد المعاصر، دفع الإنسان إلى تسويق كل شيء، بل إلى تسويق أجزاء من شخصيته. أما الشخصية التي يحبذها الاقتصاد المنفلت من عقاله، فهي سادية، نرجسية، عدوانية، وكلما ازدادت عدوانيتها، زادت أرباحها. يشير الباحثان إلى مئة مقابلة أجراها كل من عالم النفس الكندي روبيرت هار والمستشار الاقتصادي الأميركي بول بابياك، التي تظهر بأن عدد المرضى النفسيين في المناصب الرئيسة لدى الشركات الكبرى يتجاوز ثلاث مرات عددهم في المجتمع العادي.
نقرأ في الكتاب: «منذ آلاف السنين والبشر يفكرون في سبل توزيع السلع بشكل عادل بين البشر. منذ أفلاطون وأرسطو إلى سينيكا وتوما الأكويني والسكولائية حتى آدم سميث ودافيد ريكاردو، وكارل ماركس، وكينز وميلتون فريدمان. فموضوع تاريخ الاقتصاد كان دومًا توزيع السلع والاتجار بها. وكيفما كانت الاختلافات بين المدارس المتعددة أفلاطونية، كلاسيكية، اشتراكية، طوباوية، كينزية، بروتستانتية أو نيو كلاسيكية، لم يسبق أن وجدت مدرسة تدعو إلى السرقة كأفضل السبل إلى السعادة الإنسانية» (ص138). لكن اقتصاد الشركات الكبرى اليوم، والمنافسة المحتدمة بين الفاعلين الماليين تؤكد أن من يجني الأرباح، ليس هو من يحسن لعبة الأخذ والعطاء، ولكن ذاك الذي لا يعطي شيئًا ويأخذ كل شيء. إننا أمام «تحول في الباراديم» يقول الباحثان، في تاريخ الاقتصاد الإنساني. وهنا تكمن المشكلة في رأيهم. فالحرية الاقتصادية والاجتماعية تشكل ربحًا للجميع، متى ارتبطت بقدرة البشر على التحلي بالمسؤولية. أما ما نعيشه اليوم، فهو حرية العدوانية وبطلها «الكليبتومان» الذي تصفه السيكولوجيا كشخص يعاني اضطرابات في التحكم بنوازعه. يعتقد «الكليبتومان» الذي يجد نفسه مضطرًّا للسرقة، لسبب نفسي وليس لسبب خارجي كالفقر مثلًا، وعانى في الأغلب الأعم تجارب صادمة كالعنف وزنا المحارم، ويرى أنه، عبر السرقة، يتجاوز رهابه واكتئابه، لكنه لا يزيد في الواقع إلا من استفحالهما.
التحرر من أحلام اليقظة
يقوم الاقتصاد العالمي اليوم على إشباع رغبات الدول المتقدمة على حساب الدول المتخلفة والفقيرة. اللذة من جهة، والألم من جهة أخرى. سلوك سادي وعدوانية استقلت بنفسها، لم يعد هدفها التقدم، ولكن التدمير الذاتي. لكن إضافة إلى «الكليبتومانية»، يؤدي الخوف دورًا مركزيًّا في هذا السياق. «إن الخوف، كما كتب عالم الاجتماع الألماني نيكلاس لومان، هو المبدأ الذي يستمر بالعمل حين تتوقف كل المبادئ الأخرى». ولقد تحول إلى أداة بيد السياسيين والاقتصاديين كما كان بالأمس القريب أداة بيد رجال الدين، فرجال السياسة يمكنهم التأثير في الملايين وهم يستعملون الخوف، وينشرون الحقد ويشعلون الحروب، وما الحروب على الإرهاب إلا نموذج بسيط عن ذلك، أما رجال المال والاقتصاد، فيعيشون على صناعة الخوف وتسويقه وتقديم أجوبة عن تلك المخاوف التي صنعوها، من المجالات الأمنية والصحية والغذائية حتى المجال المالي، تمامًا كما كانت تفعل الكنيسة الكاثوليكية وهي تبيع الخلاص الروحي للمؤمنين. لم يبالغ سلافو جيجيك حين أكد «أن خلق المخاوف مكون للذاتية المعاصرة. إن للخوف حظوظًا جيدة في أن يتحول إلى الأيديولوجية التي تحدد كل شيء داخل الرأسمالية المعولمة». إن الخوف إذن، برأي الكاتبين، هو رديف الحرية في السوق الحرة.
«إن الرأسمالية قادرة على التطور، لكن نقدها أصابه التكلس». يكتب المفكر الألماني فولف لوتر في كتابه، «الرأسمالية المدنية». ربما يأتي هذا الكتاب، على الرغم من ثغراته، والغضب الذي يخضب كلماته، محاولة لتجاوز هذا التكلس الذي أصاب «نقد الرأسمالية». إن التحليل النفسي لا يهدف إلى العلاج، لكنه يمنحنا الوعي بوضعنا، فهو يحررنا من أحلام اليقظة ليربطنا بالواقع. ولربما يكون الوعي بالمرض أهم من وصفات العلاج السحرية التي لا تسهم سوى في استمرار تكلس النقد، ومنها خصوصًا تلك البكائيات الدينية المعاصرة التي لا تفعل بنقدها المتهاوي سوى تأبيد سلطة الرأسمال. «لقد حاولنا إعطاء صوت للاستلاب الذي يعانيه الإنسان الغربي المعاصر، وتوضيح عناصر هذا الاستلاب»، هذا ما نقرؤه في الفصل الأخير من الكتاب. لكن، وعلى أطراف الإمبراطورية الاقتصادية العالمية، هذه الأطراف التي تجد نفسها مرغمة على استيراد، ليس فقط السلع التي ينتجها المركز، بل أزماته أيضًا، فإن هذا الاستلاب يعبر عن نفسه في سلوكيات استهلاكية أكثر دموية، ليس أقلها الحروب الإثنية والمذهبية.

بواسطة مهدي حميش - كاتب مغربي | ديسمبر 27, 2016 | كتاب الملف

برهان غليون
يعيد المفكر برهان غليون في كتابه «المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات» (الذي كان قد نشر عام 1979م عن دار الطليعة، في نسخة صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات) قراءة الواقع الطائفي، وكيف كانت وما زالت مسألة التطاحن الطائفي بما تفرزها من تفاعلات، تؤثر سلبًا في لحمة المجتمعات وخصوصًا العربية أو القريبة من العربية، بما في ذلك ما تعانيه الأقليات فيها، بدءًا من مشكلات كعنصرية مصطلح «أقلية»، ومرورًا وختامًا بعدد من الجزئيات التي قد لا تغادر إشراك فئة «الأقلية» في سلطة الدولة، وكذلك تذويبها ثقافيًّا وفكريًّا في إطار «الأغلبية».
يرى المؤلف أن مشكلة الأقليات في المنطقة العربية لا تقتصر فقط على كون هذه الأقليات دينية فقط؛ لأن المشكلة تمتد إلى الأقليات الأقوامية كذلك، بل تزداد سُوءًا عندما تصبح هذه الأقليات دينية وأقوامية وثقافية في الوقت نفسه، وهو ما يدفع بتلك الأقليات إلى مسألة «تأكيد الذاتية»، وهو ما يدفع أيضًا ببعض هذه الأقليات التي استطاعت توثيق تمايزها الذاتي، إلى الانصهار في الجماعة الكبرى، والأرمن والشركس هنا أصدق مثال.
لكن في المقابل، وعندما تفشل جماعة أقلية في تثبيت تمايزها الذاتي، فإن القضية قد تنحرف إلى قضية قومية يصعب معها التحكم في المشكل، الذي ينهل في الغالب من نظرية القومية التي أفرزتها الحالة الأوربية في القرنين الثامن العشر والتاسع عشر.
يستعرض غليون في الفصل الأول من كتابه المعنون بـ«الأمة: الأقلية والأغلبية» جملة من الأفكار والتحليلات المعتمدة على البحث في العمق التاريخي لمشكلة الأقليات في الوطن العربي، وينبه إلى أنه من غير الصواب الخلط بين «الأقليات الدينية» و«الأقليات الأقوامية الكبرى»، حيث يرى أن الفئة الأولى أكثر صعوبة في تناول خصوصيتها، ويستدل على ذلك بتاريخ الحروب التي نشبت في عدد من المحطات بين طوائف دينية عربية، أو حتى بين دول عربية وبعض أقاليمها، أما الفئة الثانية فتبقى مشكلاتها غالبًا حبيسة «المفهوم السائد للأمة وللقومية».
تكون أساسات المشكلة
 ويستمر الباحث في عرض أساسات تكون مشكلة الأقليات وخصوصًا الدينية في الفضاء العربي، حيث يرى أن ما زاد من تفاقم الأمر لم يكن سوى «تحويل الموضوع إلى محرمات يمنع الحديث عنها»، إضافة إلى تأطيرها ومحاصرتها، حتى يتم تناولها فقط من خلال ما أسماها الكاتب «مرآة الصراع السياسي»، بعيدًا عن أي نقاش يحللها من وجهة نظر فكرية ثقافية، وهو الأمر الذي ذهب بالقضية إلى غياهب عميقة أصبح فيها الصراع محصورًا بين الحداثة والتقليد، أو بين دولة علمانية وأخرى دينية، وهو ما جعل كذلك دفاع الأقليات عن نفسها ينجرف إلى محاربة إسلامية الدول وحتى عربيتها، قبل أن تبتكر الدولة لنفسها مفهوم الدولة العلمانية، علها تنجح في نفي الذاتية عنها كما حدث لدى الأقليات، وهو ما جعل مشكلة الأقليات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمسألة السياسية، بعدما كانت في الأصل مسألة ذاتية، منحصرة في إنكار تمايز الجماعة الكبرى، وجماعة الأقلية.
ويستمر الباحث في عرض أساسات تكون مشكلة الأقليات وخصوصًا الدينية في الفضاء العربي، حيث يرى أن ما زاد من تفاقم الأمر لم يكن سوى «تحويل الموضوع إلى محرمات يمنع الحديث عنها»، إضافة إلى تأطيرها ومحاصرتها، حتى يتم تناولها فقط من خلال ما أسماها الكاتب «مرآة الصراع السياسي»، بعيدًا عن أي نقاش يحللها من وجهة نظر فكرية ثقافية، وهو الأمر الذي ذهب بالقضية إلى غياهب عميقة أصبح فيها الصراع محصورًا بين الحداثة والتقليد، أو بين دولة علمانية وأخرى دينية، وهو ما جعل كذلك دفاع الأقليات عن نفسها ينجرف إلى محاربة إسلامية الدول وحتى عربيتها، قبل أن تبتكر الدولة لنفسها مفهوم الدولة العلمانية، علها تنجح في نفي الذاتية عنها كما حدث لدى الأقليات، وهو ما جعل مشكلة الأقليات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمسألة السياسية، بعدما كانت في الأصل مسألة ذاتية، منحصرة في إنكار تمايز الجماعة الكبرى، وجماعة الأقلية.
لقد أدى هذا الأسلوب في معالجة قضية الأقليات حسب المؤلف غليون، إلى استهانة كبرى من طرف الممارسة السياسية بالذاتية الثقافية، ما جعل هذه الذاتية الثقافية قاعدة في اللعبة السياسية بين الأطراف، فصار إثبات القوة في الممارسة السياسية مبنيًّا على حفاظ المتنافسين على ذاتيتهم، وضرب الذاتية الثقافية للآخر، وهو ما جعل السياسة المحلية مبنية حسب توصيف الكاتب على «غش متبادل»، ما دفع بالأغلبية والأقلية على حد سواء إلى إنتاج ردود فعل عنيفة لحظة الإحساس بأنها قد خدعت، وهو ما يجعل الوطن الواحد الذي اختار أعضاؤه نكرانًا متبادلًا للذاتية، في مهبّ قضية قومية تهدد سلامة البلد واستقراره سياسيًّا، وكذلك وحدته التي تنعدم قيمتها فيما بعد، لتصير شكلية ليس إلا، «مضمونها تخلي الجماعة عن كل هوية قومية». وهذا الصراع هو ما يخلف اليوم حسب المؤلف استلابًا للغرب وتقديسًا لثقافته من أجل ملء الفراغ الذي يشكله الصراع الذاتي، ليصبح الجميع في الوطن الواحد متعلقًا بالثقافة الأجنبية وباللغة الأجنبية السائدة، التي أضحت لغة النخبة والدولة والإدارة.
وأمام كل ما سبق، تطفو على السطح دعوات -بحسب غليون- إلى العودة إلى الهوية القومية، لكنها لا تنجح بسبب تكوّن نظرة الرجعية والنكوص حولها داخل المجتمع، خصوصًا عندما تشعر أقليات دينية داخل المجتمع الواحد بأن العودة الكثيفة لدى الأغلبية إلى الذاتية الإسلامية الموسومة دائمًا بالسلفية، ستهدد المكتسبات العصرية العلمانية للدولة الحديثة، فتلجأ لمواجهتها بالمعتقدية العلمانوية التي تنادي بنزع الدين عن الدولة، ما يسهم في تأجج التحدي والصراع والتعصب ورفض الحوار بين أطراف المجتمع. ويضيف الكاتب تبسيطًا للفكرة، أنه حتى الأقليات الدينية التي باتت تميل لمسألة الانتصار للدولة العلمانية، باتت ترى أن هذه الأخيرة ليست دولة مساواة بين الأديان، وحتى لو كانت هناك مساواة فإنها تبقى شكلية في مضمونها، ولا تؤدي أي دور سياسي في تحديد مكانة الجماعات والأفراد اجتماعيًّا، وفي أفضل حالاتها فإنها تبقى كبديل ثقافي للذاتية الدينية أي مجرد نفي للذاتية القومية.
لقد ساهم هذا الصراع، حسب المؤلف غليون، في التمكين للإسلام المُستعاد من أن يدخل الحلبة السياسية العصرية كمقاتل من أجل الديمقراطية والمساواة الغائبة عن نموذج الدولة العلمانية، وهو ما ساهم بالتالي بزيادة تعقيد الوضع، خصوصًا عندما يظهر هناك توافق بين سعي الأقليات لدعم دولة علمانية، ورغبة النخبة في إبعاد الجمهور عن السياسة والسلطة، وهو ما تتهم فيه الأغلبية الدينية داخل الوطن الأقلياتِ بالتحالف مع الخارج أو مع السلطة العصرية المحلية.
يستعرض غليون أيضًا في كتابه مفهومًا آخر عن الأقلية، وهو ذلك الذي يتأثر وينتج من التوسع الاقتصادي والثقافي للنظام الاجتماعي، ويعتمد بالأساس في تشكله على الاقتراب التدريجي نحو نموذج حياة واحدة لدى مختلف الجماعات، أقليات وأغلبيات، حيث مع بدء فقدانها لتاريخيتها وتضامناتها الذاتية، تنشأ هناك عملية إعادة تقسيم المجتمع تقسيمًا أفقيًّا يجعل المطالب تتركز حول تعديل الفروقات الاجتماعية وتعميم النموذج السائد لدى الطبقة العليا، بخلاف ما كانت عليه المطالب الثقافية الذاتية، التي هي تقسيمات عمودية تأخذ صيغ صراعات عصبوية طائفية أو إقليمية أو أجناسية، ما يساهم بالتالي في تأسيس نظام مستقر يسمح ببداية الاندماج الاجتماعي الموسع داخل الوطن الواحد.
مشكلة الأغلبية
لا يخفي برهان غليون في كتابه أن مشكلة الأقليات في درجة أولى، مشكلة متعلقة بالأغلبية قبل أن تكون مشكلة لدى الأقليات نفسها، من أجل تحقيق ذاتيتها وتمايزها؛ لأن هذا المطلب لدى الأقليات هو طموح تاريخي ومنطقي بالنهاية، غير أنه بالمقابل وعندما تصبح تلك الأقلية «قناة للسلطة»، فإن الأغلبية تتجه لرفض تلك الجماعة وتمايزها بدواعي النتائج السياسية التي تفرزها الأقلية، متهمة إياها بالتحالف مع الخارج للإطاحة بالأغلبية.
يرى المؤلف أن أهم الحلول التي يمكنها أن تحل مشكلة الأقليات في الوطن العربي، لا تغادر مسألة التخلي عن الاعتقاد السائد الذي يرجع الطائفية إلى التمايز الثقافي أو الديني في المجتمع؛ لأن هذا التمايز حسب غليون، والذي يوجد في كل بلد، لو حسن توظيفه إيجابيًّا صار أساسًا للغنى الثقافي والانصهار، بخلاف لو أُخذ بمنظور ذاتي منفصل، فسيصبح معول هدم ينخر المجتمعات بدافع الانتصار الشخصي لذاتية الطائفة، وهويتها القومية المنفصلة عن الأخرى.
الأقليات خارج العلمانية والدين
يوصي برهان غليون في كتابه أيضًا، بعدم الانصياع وراء فكرة ضرورة سير كل مجتمعاتنا في الطريق التي سارت عليها المجتمعات الغربية، لإنهاء مشكلة الانقسام الطائفي والأقليات؛ لأن الاعتقاد بأن هناك خطًّا واحدًا للتاريخ يسير بالجماعات من العبودية إلى الإقطاع إلى الرأسمالية إلى العقلانية إلى الحرية وإلى الديمقراطية والحرية، سيأخذنا إلى الفشل في الوصول إلى إجماع قومي وإلى وحدة قومية من أي نوع كانت. ويضيف غليون، أنه لا يمكن البحث عن حل للنزاعات الطائفية في الدعوة العلمانية التي تدعو للمساواة، أو في الدعوة الدينية التي تؤكد التسامح، ولا حتى في القوانين التي تحدد الحقوق والواجبات؛ لأن كل هذه الوصفات استعملت وما زالت من دون نتائج مبهرة، وذلك لأن القضية ببساطة ليست متجسدة لا في دعوة ولا في قضية أيديولوجية شكلية، إنما هي قضية سلطة متجسدة في علاقة الأفراد بالدولة، أضف إلى ذلك أن الواقع يفرض اليوم على المفكر العربي أن يجهد في سبيل توضيح الأفكار والمفاهيم، وفي نقد الممارسات السائدة، حتى يزول التشويش الذهني الذي يمنع فهم حقيقة الخلاف وجوهره، ويعيق بذلك إمكانية الوصول إلى إجماع سياسي يتجاوز الخلافات المذهبية من دون أن يلغيها.
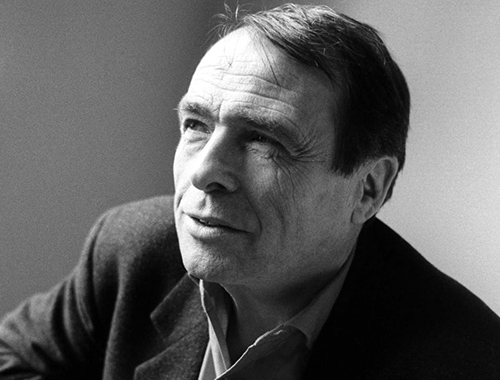
بواسطة سعيد بوكرامي - كاتب و مترجم مغربي | نوفمبر 6, 2016 | ثقافات

سعيد بوكرامي
لا ينتمي كتاب «بيير بورديو: بنيوية بطولية» للسوسيولوجي الفرنسي «جان لويس فابياني» إلى كتب السيرة الفكرية المتعارف عليها، التي تنحاز غالبًا إلى التوثيق والتأريخ وهذا ما يعلي من قيمة هذا الكتاب فكريًّا ويضعه في صدارة المراجع التي كتبت عن «بيير بورديو» المفكر والإنسان (1930 – 2002م).
جاء الكتاب نتيجةَ مرافقةٍ لبورديو دامت سنوات طويلة، ووفق إنصات عميق لمعنى علاقة حميمة جمعت الباحث بالمفكر وبفكر أشهر عالم اجتماع معاصر. كما يشكل خلاصة تعلق أكاديمي بعالم وإنسان لم يكن يبخل على مريديه بالفكرة الراجحة، والموضوع الناجح والمعرفة الثقافية والاجتماعية، التي تتجاوز المجتمع الفرنسي إلى مجتمعات أخرى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قدم لنا «فابياني» نتائج مراقبته لكيفية كتابة «بورديو» لعلم اجتماع متجدد ومبتكر، ولصيرورة تشكُّل فكري وثقافي وسياسي غيرت مفهومنا عن العلوم الإنسانية والاجتماعية.
يشكل الكتاب الصادر حديثًا عن دار سوي الفرنسية إضافة نوعية وفارقة إلى مجموعة غزيرة من الأبحاث البارزة التي أنجزت حول «بيير بورديو»؛ لأنه يقترح إعادة قراءة المفاهيم المركزية لعلم الاجتماع «البورديوي» على ضوء الممارسات الممكنة عمليًّا ونظريًّا، ثم لأن المؤلف يستخدم الشبكات الفكرية وطرائق التحليل التي حددها «بورديو» تدريجيًّا، أضف إلى ذلك الوضع الشخصي والأكاديمي لفابياني الذي كان يتوافر على الشروط الذاتية والموضوعية للنجاح في مقاربته الفكرية.
مثقف بطل من نوع جديد
يواجهنا في الصفحات الأولى من الكتاب سؤال محوري ومنهجي: «هل يمكننا اليوم الحديث بهدوء عن بورديو؟». هذا هو السؤال العام الذي يسعى «جان لويس فابياني» للإجابة عنه، باستخدام منهجية تستهدف تحليل المفاهيم الأساسية لنظرية علم الاجتماع. وقسم الباحث كتابه إلى ثلاثة أقسام: يهدف القسم الأول إلى تحليل الحقل المفاهيمي، والهابيتوس: «المظاهر الاجتماعية» ورأس المال الثقافي والرمزي. وهذه مفاهيم مركزية في البناء النظري لبيير بورديو، التي- كما يذكرنا «جان لويس فابياني»- صُممت أصلًا للعمل بشكل شمولي. أما القسم الثاني فيتناول التصميم المنهجي والسردي الموظف من عالم الاجتماع. وأما في القسم الثالث فيهتم على نطاق واسع بصورة «بيير بورديو» من خلال مفاهيمه السياسية، ثم يتحدث عن معاناة «بورديو» وشغفه بموضوعات بحثه. وأخيرًا يرسم الملامح النهائية لـ«بطل مثقف من نوع جديد».
 حاول الباحثُ- (استنادًا إلى قراءة قريبة جدًّا من أعمال «بورديو» جنبًا إلى جنب مع أدبيات «بورديو» السوسيولوجية الوفيرة، مع العلم أن رصيد بيير بورديو ثلاثون كتابًا ومئات الدراسات والمقالات) تحليلَ «تاريخانية» التطورات المتلاحقة التي عرفتها المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع. وهذا مكّن «جان لويس فابياني» من تسليط الضوء على التطور التدريجي لها عند «بورديو» منذ عام 1960م، إضافة إلى بعض التناقضات المتنامية الميّالة إلى التعميم، كما مكّن هذا التحليل المفصل للمفاهيم الثلاثة المؤلفَ بدرجة أكثر أو أقل من التوصل إلى تفكيك أهم المفاهيم.
حاول الباحثُ- (استنادًا إلى قراءة قريبة جدًّا من أعمال «بورديو» جنبًا إلى جنب مع أدبيات «بورديو» السوسيولوجية الوفيرة، مع العلم أن رصيد بيير بورديو ثلاثون كتابًا ومئات الدراسات والمقالات) تحليلَ «تاريخانية» التطورات المتلاحقة التي عرفتها المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع. وهذا مكّن «جان لويس فابياني» من تسليط الضوء على التطور التدريجي لها عند «بورديو» منذ عام 1960م، إضافة إلى بعض التناقضات المتنامية الميّالة إلى التعميم، كما مكّن هذا التحليل المفصل للمفاهيم الثلاثة المؤلفَ بدرجة أكثر أو أقل من التوصل إلى تفكيك أهم المفاهيم.
وهكذا، فيما يتعلق بالحقل الاجتماعي الموصوف لدى «بورديو» بـ«النظرية المستحيلة»، يوضح «فابياني» أن «بورديو لا يتردد في اللجوء إلى مفهوم الغموض عندما يفتقر إلى المصادر التحليلية». وخلال تحليل الهابيتوس يشير «بيير بورديو» إلى أنه: «مثل كل نظريات التنشئة الاجتماعية يمكث على نطاق واسع صندوقًا أسودَ»، بمعنى من المعاني فعلم الاجتماع لديه لا يملك أجوبة حاسمة إنما تعترضه ثغرات وصعوبات يستحيل ترميمها أو حلها. وأبسط هذه الأمور حضور ذات المفكر السوسيولوجي وشروط اشتغاله العلمي، ونجد هذه التوضيحات في كتابه «الإنسان الأكاديمي» حينما تحدّث عن تأثير التاريخ الشخصي لعالم الاجتماع في عمله الأكاديمي؛ إذ تتدخل الذات المفكرة في ممارسته العلمية وتُبلبل رؤيته للمجتمع، وفي غالب الأحيان دون وعي منه.
وأخيرًا: يتناول المؤلف بالتحليل مفهوم «رأس المال الرمزي»، الصنف الأبرز من جميع أشكال رأس المال الذي أبدعه ونظر له «بورديو». ويشير الكاتب إلى أنه: «لا يمكن أن نمنع أنفسنا من التفكير في المفهوم الرمزي، الذي يحتفظ بنصيب من الغموض، حتى عندما نعيد القراءة بعناية دقيقة للمفاهيم، التي صاغها «بورديو» وجمعها مبكرًا خلال مسيرته العلمية». ويضرب مثالًا بمفهوم رأس المال الرمزي الذي يُحَدد من سمات الفرد المشكّلة من مظاهره الاجتماعية التي تختلف من فرد إلى فرد ومن مجتمع إلى مجتمع، لكنها تتوحد في سمات مشتركة مثل الشرف والهيبة والسلوك الحسن والسمعة وغيرها.
في القسم الثاني: يستمر هذا البحث «التاريخاني»، مع التركيز هذه المرة ليس على المفاهيم ولكن على المسالك المنهجية والسردية التي وظفها «بيير بورديو». وفيما يتعلق بالأولى فإن «جان لويس فابياني» يهتم بتفاصيل علاقة «بورديو» بالإحصاءات والأدب والتاريخ، موضحًا أن التحليل الهندسي كان ثمرة تعاون مع الإحصائيين، بدأه «بورديو» في الفترة الجزائرية، ويبدو أنه حمله معه خلال دراساته الاجتماعية للحفاظ على تماسكٍ بنيوي، مراعيًا بصرامة التغيير الاجتماعي.

جان لوي فابياني
تنوع أنظمة الكتابة
وفيما يتعلق بالمسالك السردية فإن الحجة الرئيسة للمؤلف التي واجهت المهتمين بدراسة أعمال «بورديو»، هي تنوع «أنظمة الكتابة» لديه؛ إذ لاحظ المؤلف أن أعماله يختلط فيها العلمي بالفلسفي، والنفسي بالأدبي؛ فهناك تحول مذهل في الأساليب والتخصصات لكنها تكون دائمًا تحت سماء علم الاجتماع بشروطه العلمية.
وفي القسم الأخير: يعرض «فابياني» بطريقة شاملة صورةَ عالم الاجتماع واقفًا ضد التصورات المقولبة التي وضعت مرارًا وتكرارًا صورةً عن «بورديو» الخجول سياسيًّا والملتزم ثوريًّا في الجزء الأخير من حياته. بينما هو في الواقع يدافع بشكل جدلي عن صورة المثقف والمفكر المنتقد والمندد، والمجدد لأنماط التفكير الثقافي والسياسي والسلوك الاجتماعي، جنبًا إلى جنب مع صديقه المفكر الفرنسي «بيار فيدال- ناكي». ومن ثَمَّ يرى الباحث أهمية ما مارسه «بورديو» من تأثير في الحياة الاجتماعية، الذي أشار إليه «بورديو» نفسه خلال ممارسته وإنتاجه.
هذا الاهتمام هو في الواقع، حسب المؤلف، موجود في أشكال عدة هي: أولوية الجسد في العلاقة العملية بالعالم التي بُلورت في الأعمال الأنثروبولوجية في موضوعات تتجسد في موضوعَي: المعاناة، والشغف.
وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، نلاحظ أن تحليل «فابياني» يبدو كأنه وصل بشأن هذه المفاهيم إلى طريق مسدود: «العلاقة بالتحليل النفسي هي إحدى النقاط الأصعب في البنيوية التوليدية، وبورديو لم يساعد القراء ولم يمهّد الطريق للتفسير».
في الفصل الأخير: سنصل إلى المقاصد السامية للكتاب التي تتجلى في إضاءة منهج «بورديو» انطلاقًا من سيرة حياته الذاتية والفكرية، وأيضًا في إبراز أهم المشاكل التي اعترضت ممارسته العلمية على نطاق أوسع. ومن هنا تبدو أطروحة الكتاب واضحة: إن عالم الاجتماع اتبع نمطًا مميزًا من الحياة اتسم في مجمله بـ«البطولة» التي كانت وقودًا فعالًا في مساره الاجتماعي، ودفعه إلى مضاعفة مجهوداته وزيادة إنجازاته العلمية. وبناء عليه يحدد «فابياني» الطابع الاستثنائي لهذا البطل المتمثل في قدرته الانعكاسية على نقد ذاته وتجاوز عثراته والإصرار على مواقفه الثقافية والسياسية مهما كلفه ذلك من تضحيات. والنتيجة: أن «بورديو» تمكن في سنوات حياته الأخيرة من تأسيس نظام سوسيولوجي نظري وتطبيقي شمولي كان قد سهر على تشييد صرحه بجهد ذاتي وفكري استثنائي.
استعادة مفاهيم «بورديو» وتعقيداتها
تكمن القوة الحقيقية للكتاب -كما أعتقد- في الثراء المعرفي ودقة المفاهيم في قراءة منجز «بورديو»، وقد شكل هذا الاستعراض التحليلي فرصة للتعرف إلى مهارة باحث وُفِّق في استعادة مفاهيم «بورديو» وتعقيداتها، لكن أيضًا هشاشة التوضيحات النظرية لدى «بورديو». وبهذا المعنى يبدو أن المؤلف يقف حقًّا على أسس عمل تجريبي مهم سمح بالانفلات من «المواجهة العقيمة» التي عاناها «بورديو» وصنفته تصنيفات مُجْحِفة.
لكن الباحث، للأسف، لم يطور هذه النقاط إلا قليلًا، مشيرًا في سياقات متعددة إلى أنه يسعى إلى «تطبيق النظام المفاهيمي الخاص ببورديو، على بورديو نفسه» وهذا يبدو إشكاليًّا؛ لأن «فابياني» حاول خلال تحليله أن يبين التناقضات ومختلف الاستخدامات التي قام بها «بورديو». ويمكن الشعور بهذه الفجوة في البناء الكلي للكتاب؛ إذ لا تتوافر فصول الكتاب على أقسام فرعية أو تنصيص من متون أخرى للاستدلال والمقارنة، إنما كُتبت الفصول دفعة واحدة. كما يصعب أحيانًا فهم الترابط الداخلي على نحو سلس ومنطقي؛ ما يفقد بعض الفقرات تماسكها. كما تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن العمل الذي اقترحه «فابياني» هو في رأينا مصدر قيم للغاية؛ لأنه يمكننا من شحن التفكير النقدي وتجريب منهجية اجتماعية وفرها لنا «بيير بورديو» من خلال أعماله الغنية والجدلية.
حاول «فابياني» إذن أن يجد معنًى لعمل «بيير بورديو» الشاق بأنْ منحه صفة «البطولة»، منبها إلى أن «بورديو» عاش اجتماعيًّا وعلميًّا بهذه الروح الشغوفة بالتحدي والرغبة في التغيير إلى ما هو أفضل محليًّا ودوليًّا. وتجلى ذلك في اختلافه الدائم مع أنماط التفكير السائدة التي تستغل الإنسان وتجرده من قيمه الثقافية والإنسانية؛ لهذا يجب على المثقف أن يكون مناضلًا ليجعل المؤسسات المهيمنة في وضع غير مريح. إن «بورديو» -كما يقول «فابياني»-: «هو أول ثوري رمزي قادم من الشعب»، لكن «فابياني» لا يخفي خيبة أمله؛ إذ يعتقد أن «بورديو» استسلم في نهاية المطاف لغطرسة المؤسسات المهيمنة، التي حاربها طوال حياته. وهذا لا ينتقص من عظمة المساهمة العلمية التي قدمها «بورديو»، التي تظهر من خلال مؤلفاته ومواقفه الشجاعة.




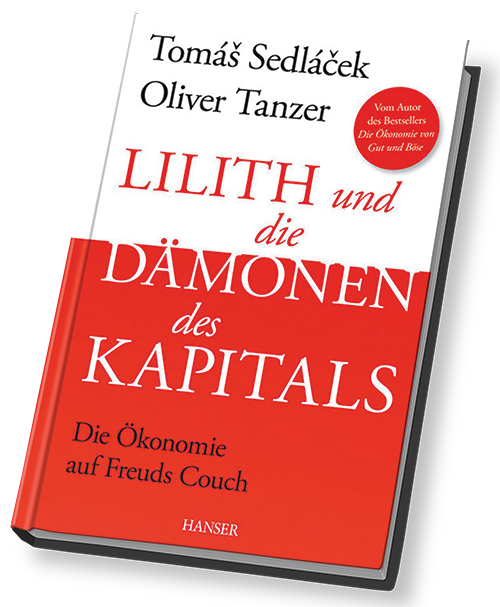 يسجل الباحثان وجود خمسة أنواع من الاضطرابات النفسية في الاقتصاد المعاصر، لا تمثل فقط جزءًا منه، بل تسيره بالطريقة التي تريد. أولًا: اضطراب في معرفة الواقع: ويريان ذلك نتيجة لمبدأ اللذة الذي يطالب باستمرار بمزيد من الإنتاج والاستهلاك. ثانيًا: اضطرابات ناتجة عن الخوف. وهي ما يدفعنا للنظر إلى الواقع بشكل سلبي، ويقود إلى سلوكيات غير عادية، وخصوصًا في مراحل الأزمة. ثالثًا: اضطرابات لها علاقة بالوضع النفسي، أو ما يسمى بالاضطرابات العاطفية، وهنا ستتم دراسة دورات الهوس الاكتئابي، التي تتعلق بالتطورات المتصلة بالطفرات والأزمات الاقتصادية. رابعًا: اضطرابات تتعلق بالسيطرة على الدوافع، وهنا ستتم دراسة نموذجين للسلوك: إدمان اللعب الذي نلحظه لدى البنوك الاستثمارية، والسلوك الثاني المرتبط بإدمان السرقة «الكليبوتوماني»؛ إذ من المثير للانتباه أن ذلك الذي يحقق نجاحًا داخل هذا النظام الاقتصادي، ويملك العمل والسلع والرأسمال، هو الذي لا يقدم شيئًا مقابل ذلك. خامسًا: اضطرابات الشخصية: من أجل المحافظة على النظام الذي يقوم على العنف والمنافسة، يتوجب على المشاركين فيه أن يتلقوا تكوينًا مناسبًا لطبيعته، يصنع منهم أشخاصًا أنانيين وعنيفين، بعيدًا من كل إحساس بالإنسانية والغيرية، وبعيدًا من كل حس سليم. إنهم مجرد أدوات في نظام لم يعد يخدم مَن صنعه، بل استولى بنفسه على السلطة. إن هذا لا يعني أن المشاركين في النظام أناس سيئون، بل إن النظام من يرغم خَدَمهُ على الاضطلاع بأدوار باثولوجية.
يسجل الباحثان وجود خمسة أنواع من الاضطرابات النفسية في الاقتصاد المعاصر، لا تمثل فقط جزءًا منه، بل تسيره بالطريقة التي تريد. أولًا: اضطراب في معرفة الواقع: ويريان ذلك نتيجة لمبدأ اللذة الذي يطالب باستمرار بمزيد من الإنتاج والاستهلاك. ثانيًا: اضطرابات ناتجة عن الخوف. وهي ما يدفعنا للنظر إلى الواقع بشكل سلبي، ويقود إلى سلوكيات غير عادية، وخصوصًا في مراحل الأزمة. ثالثًا: اضطرابات لها علاقة بالوضع النفسي، أو ما يسمى بالاضطرابات العاطفية، وهنا ستتم دراسة دورات الهوس الاكتئابي، التي تتعلق بالتطورات المتصلة بالطفرات والأزمات الاقتصادية. رابعًا: اضطرابات تتعلق بالسيطرة على الدوافع، وهنا ستتم دراسة نموذجين للسلوك: إدمان اللعب الذي نلحظه لدى البنوك الاستثمارية، والسلوك الثاني المرتبط بإدمان السرقة «الكليبوتوماني»؛ إذ من المثير للانتباه أن ذلك الذي يحقق نجاحًا داخل هذا النظام الاقتصادي، ويملك العمل والسلع والرأسمال، هو الذي لا يقدم شيئًا مقابل ذلك. خامسًا: اضطرابات الشخصية: من أجل المحافظة على النظام الذي يقوم على العنف والمنافسة، يتوجب على المشاركين فيه أن يتلقوا تكوينًا مناسبًا لطبيعته، يصنع منهم أشخاصًا أنانيين وعنيفين، بعيدًا من كل إحساس بالإنسانية والغيرية، وبعيدًا من كل حس سليم. إنهم مجرد أدوات في نظام لم يعد يخدم مَن صنعه، بل استولى بنفسه على السلطة. إن هذا لا يعني أن المشاركين في النظام أناس سيئون، بل إن النظام من يرغم خَدَمهُ على الاضطلاع بأدوار باثولوجية.

 ويستمر الباحث في عرض أساسات تكون مشكلة الأقليات وخصوصًا الدينية في الفضاء العربي، حيث يرى أن ما زاد من تفاقم الأمر لم يكن سوى «تحويل الموضوع إلى محرمات يمنع الحديث عنها»، إضافة إلى تأطيرها ومحاصرتها، حتى يتم تناولها فقط من خلال ما أسماها الكاتب «مرآة الصراع السياسي»، بعيدًا عن أي نقاش يحللها من وجهة نظر فكرية ثقافية، وهو الأمر الذي ذهب بالقضية إلى غياهب عميقة أصبح فيها الصراع محصورًا بين الحداثة والتقليد، أو بين دولة علمانية وأخرى دينية، وهو ما جعل كذلك دفاع الأقليات عن نفسها ينجرف إلى محاربة إسلامية الدول وحتى عربيتها، قبل أن تبتكر الدولة لنفسها مفهوم الدولة العلمانية، علها تنجح في نفي الذاتية عنها كما حدث لدى الأقليات، وهو ما جعل مشكلة الأقليات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمسألة السياسية، بعدما كانت في الأصل مسألة ذاتية، منحصرة في إنكار تمايز الجماعة الكبرى، وجماعة الأقلية.
ويستمر الباحث في عرض أساسات تكون مشكلة الأقليات وخصوصًا الدينية في الفضاء العربي، حيث يرى أن ما زاد من تفاقم الأمر لم يكن سوى «تحويل الموضوع إلى محرمات يمنع الحديث عنها»، إضافة إلى تأطيرها ومحاصرتها، حتى يتم تناولها فقط من خلال ما أسماها الكاتب «مرآة الصراع السياسي»، بعيدًا عن أي نقاش يحللها من وجهة نظر فكرية ثقافية، وهو الأمر الذي ذهب بالقضية إلى غياهب عميقة أصبح فيها الصراع محصورًا بين الحداثة والتقليد، أو بين دولة علمانية وأخرى دينية، وهو ما جعل كذلك دفاع الأقليات عن نفسها ينجرف إلى محاربة إسلامية الدول وحتى عربيتها، قبل أن تبتكر الدولة لنفسها مفهوم الدولة العلمانية، علها تنجح في نفي الذاتية عنها كما حدث لدى الأقليات، وهو ما جعل مشكلة الأقليات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمسألة السياسية، بعدما كانت في الأصل مسألة ذاتية، منحصرة في إنكار تمايز الجماعة الكبرى، وجماعة الأقلية.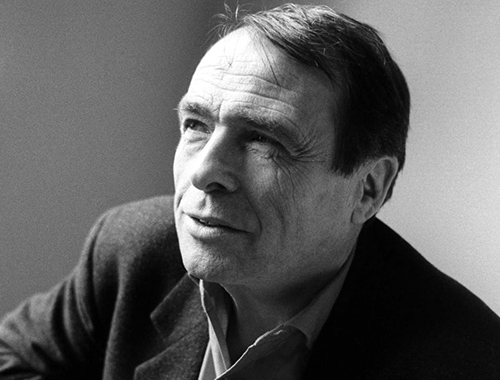

 حاول الباحثُ- (استنادًا إلى قراءة قريبة جدًّا من أعمال «بورديو» جنبًا إلى جنب مع أدبيات «بورديو» السوسيولوجية الوفيرة، مع العلم أن رصيد بيير بورديو ثلاثون كتابًا ومئات الدراسات والمقالات) تحليلَ «تاريخانية» التطورات المتلاحقة التي عرفتها المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع. وهذا مكّن «جان لويس فابياني» من تسليط الضوء على التطور التدريجي لها عند «بورديو» منذ عام 1960م، إضافة إلى بعض التناقضات المتنامية الميّالة إلى التعميم، كما مكّن هذا التحليل المفصل للمفاهيم الثلاثة المؤلفَ بدرجة أكثر أو أقل من التوصل إلى تفكيك أهم المفاهيم.
حاول الباحثُ- (استنادًا إلى قراءة قريبة جدًّا من أعمال «بورديو» جنبًا إلى جنب مع أدبيات «بورديو» السوسيولوجية الوفيرة، مع العلم أن رصيد بيير بورديو ثلاثون كتابًا ومئات الدراسات والمقالات) تحليلَ «تاريخانية» التطورات المتلاحقة التي عرفتها المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع. وهذا مكّن «جان لويس فابياني» من تسليط الضوء على التطور التدريجي لها عند «بورديو» منذ عام 1960م، إضافة إلى بعض التناقضات المتنامية الميّالة إلى التعميم، كما مكّن هذا التحليل المفصل للمفاهيم الثلاثة المؤلفَ بدرجة أكثر أو أقل من التوصل إلى تفكيك أهم المفاهيم. 
