
الحداثة وما قبلها
نحن في عصر الحداثة، هذا بالتأكيد من حيث الشكل، حيث إن أحدث المخترعات والمنتجات تصل إلينا ونتملكها، ما يُنتَج في أميركا أو أوربا أو أي بقعة في العالم. فالعالم واحد في أمور كثيرة، فهو مفتوح للسلع والتكنولوجيا والترحال. ولقد جعلَنا الإنترنت والفضائيات الإعلامية «مواطنين» في هذا العالم الموحد. لنبدو في أبهى صور الحداثة وأرقاها. بمعنى أن الحداثة باتت «في متناول اليد»، بالتالي يمكن أن نحصل على كل منتجاتها بيسر وبلا تعقيد.
لكننا في الواقع نبدو حداثيين، لكن بدون حداثة. حيث إن كل هذه «الحداثة» هي «بناء خارجي» تحقق نتيجة استيراد ما يُنتج في البلدان الرأسمالية المتطورة، التي صنعت الحداثة وعاشتها بشكل فعلي، وبات فلاسفتها يتحدثون عن «ما بعد الحداثة»، في حين لا يمكن أن نقول عن حالنا سوى أننا في وضع «ما قبل الحداثة». وما يظهر إنْ هو إلا امتداد خارجي، فنحن نستهلك منتوجات الحداثة بعد أن بات العالم لا يمكنه العيش بدونها بعد أن باتت «من ضروريات الحياة»، بعد أن أصبحت سلعًا لازمة لا إمكانية للعيش من دون الحصول عليها. لقد صنعت أوربا الحداثة التي قامت على الصناعة واعتمدت على تطور العلوم، والأفكار والبنى والسياسة. لقد ارتقت علميًّا وفكريًّا لكي تحقق الحداثة. ونحن نتابع نتاجات الحداثة ونتكيَّف معها، وباتت ضرورية لنا، لكننا لا نستطيع أن نؤسس البيئة التي أنتجتها، ولهذا ما زلنا في «عصر ما قبل الحداثة» حيث الوعي المجتمعي والبنى والمؤسسات ما زالت سابقة للحداثة، ويمكن أن نقول: إنها ما زالت كما تشكلت في القرون الوسطى، المرحلة التي شهدت انهيار الحضارة العربية، ومن ثم هي لا ترقى إلى هذه الحضارة، هي تعبير مشوّه عنها فقط. وكل ما يبدو حداثيًّا فيها هو قشرة خارجية.
إننا في «عصر ما قبل الحداثة» بالضبط لأننا لم ننتج حداثتنا. وليس يعني ذلك أننا يجب أن نعود إلى «نقطة الصفر» التي أوصلت إلى الحداثة، بعيدًا من كل التطور العالمي، بل يعني أن «نتحدث»، أن نصبح حداثيين. وما دمنا من حيث «العقل» والبنى في عصر سابق، لا بدّ من أن نتلمس طريق الحداثة، ونلمس «النقطة صفر» التي نحن فيها.
الاتجاه المعاكس
ولا شك في أن الحداثة «الغربية» ليست بعيدة من تاريخنا، بل إنها امتداد له، أوصل إلى الحداثة هناك، وسرنا نحن في «الاتجاه المعاكس». لنعيد إنتاج انهيارات القرون الوسطى، التي أوصلت إلى سيادة شكلية مفرطة، وإغراق في الماضوية. فأصبح الفكر هو تفسير المعنى اللغوي لنص، وتطبيق النص الذي نشأ في واقع قديم. وإذا كان تطور العلم والحرفة والفلسفة قد وصل إلى مرحلة متقدمة نهاية الدولة العباسية، فقد فقدنا ذلك لمصلحة «النقل» بعد أن جرى «تدمير الفلسفة» (أي العقل). لكن ورثت أوربا كل ذلك، وكان في أساس انطلاقتها الفلسفية والعلمية والحرفية كذلك. فقد اعتمدت على منتوجنا وهي تعيد صياغة ذاتها، وتتجاوز تخلفها وهيمنة الكنيسة عليها. في الفلسفة منذ القرن الثالث عشر، وفي العلوم والحرف والزراعة منذ القرن السادس عشر/ السابع عشر. وبالتالي ليس من الممكن ألا نرى أن الحداثة هي امتداد لنا، حيث كنا مرتكزها.
من هذا المنظور يمكن تلمّس كيف نشأت الحداثة، فهذا هو طريق الحداثة الأوربية. وإذا كان القرن الحادي عشر هو قمة الصراع الفكري بين تيارات متعددة في إطار الإمبراطورية العربية، فإن «أنضجه» هو الذي وصل أوربا. لقد تصارع الإيمان مع الإلحاد، وتصارع العقل مع النقل، والدين مع الفلسفة، وخلاله أُنضجت الفلسفة اليونانية، وظهر التمايز بين الدين والفلسفة. فقد عمل أبو حامد الغزالي على «تدمير الفلسفة» لأنها تقود إلى الشك، وأسَّس «علوم الدين»، مظهرًا عمق التناقض بين الدين والفلسفة. لكن رد ابن رشد رسم الحد الفاصل بينهما، حيث اعتبر أنهما طريقان لحقيقة واحدة، مضفيًا كل «الشرعية» على الفلسفة، ومساويًا بين العقل والنقل. هذه المسألة كانت في صلب الضرورة في أوربا القرون الوسطى، حيث تهيمن الكنيسة. ومنها تقدمت الفلسفة، وكانت في أساس انتصار العقلانية الأوربية، التي شكّلت الفكر المثالي، الفكر الذي يعتبر العقل هو صانع التاريخ. لقد انتصرت العقلانية إذًا، وبات العقل حرًّا في البحث والتفكير. وكان هذا هو الأساس الذي جعل الإنسان في مركز الكون، ومركز الفاعلية، حيث إنه هُدِيَ عقله. لقد انتقل الأمر من «شرائع» ملزمة يقوم العقل بنقلها أو تفسيرها وفق ضوابط صعبة، إلى عقل مطلق بات مع هيغل هو صانع الواقع، حيث إن صيرورة العقل هي التي تحدِّد صيرورة الواقع. وهي نقلة جعلت الإنسان صانع تاريخه.
إذًا، كان الانحكام للعقل، واعتبار الإنسان هو مركز الكون، مفصليين في الوصول إلى الحداثة. لقد ساوى ابن رشد بين العقل والنقل، الدين والفلسفة، لكنه اعتبر العقل/ الفلسفة في طبقة أعلى، هذه الطبقة الأعلى باتت هي أساس الحداثة، حيث نهضت الفلسفة وتطور العلم، طبعًا في صراع مع الكنيسة التي كانت (كما في الشرق) تحرِّم الفلسفة والعقل. وإذا كانت الحداثة هي الاقتصاد والبنى الحديثة التي تشكلت مع الرأسمالية، فقد كان جذرها هنا. ومنها جرى اشتقاق (أو بلورة، أو تأسيس) منظومة فكرية متكاملة، تخص الدولة والمجتمع. ولأن العقل أسس للفردانية فقد بات الفرد مواطنًا مترفعًا عن كل التحديدات السابقة (القبيلة والمنطقة والدين والطائفة)، وباتت الدولة هي «من صُنع الشعب»، حيث إن «إرادة الشعب» هي التي تقر دستورية تنظيم الدولة وعلاقتها بالمجتمع، وكذلك شرعيتها. وترفعت الدولة عن أن تنحكم لدين مع حمايتها لحرية المعتقد (الديني وغير الديني). وبات الكلام مباحًا، والنقد كذلك. وأصبحت الكفاءة هي معيار العمل والوظيفة. والتعليم بات علميًّا. فتأسست قيم مطابقة لواقع جديد أساسه المجتمع الصناعي.
تعليم قروسطي
كل هذه الأفكار التي توضع تحت عباءة الحداثة، وغيرها، هي ما أصبح يشكّل وعيًا مجتمعيًّا في البلدان الرأسمالية. ولم يكن لها أن تنجح من دون أن تكون مجتمعاتها قد أصبحت صناعية. فالصناعة والحداثة صِنْوان، رغم أن هناك من ينظِّر للمجتمع ما بعد الصناعي. ولهذا نحن نستورد منتوج الصناعة، ونفرض تعليمًا قروسطيًّا، ونكرّس وعيًا متقادمًا، وبِنى هي من الماضي، وسلطة مستبدة. بالتالي نعيش وعيًا وبِنًى «مفوّتة» كما أسماها ياسين الحافظ، ونُظمًا تزيد في «تفويتها»؛ لأن مصالحها تحتاج إلى كل هذا التخلف في الوعي والبنى.
كيف نصل الحداثة؟ ربما سؤال صعب، لا لأنْه ليس من تصور نظري، بل إنه يرتبط بتكوين مجتمعي يحتاج إلى إزالة، رغم أن هناك من يحرص على استمراره، وهو يمتلك السيطرة. دون أن يكون ذلك مستحيلًا لا بد من ثورة في الفكر تطيح بكل الموروث المتقادم، وإذا كان التطور عالميًّا لا بد من الإفادة من كل التطور العلمي والفكري الذي جرى إنتاجه في «الغرب»، كما فعلوا هم حينما تطوروا، وأول الأمر القطع مع النقل، والعودة إلى العقل.
كتبت مرة: ربما نحتاج إلى ديكارت، حيث الشك، حيث إن اليقين سميك بشكل لا حدود له، وهو منغرس في كل التيارات الفكرية. ربما بدأ العقل من الشك الذي دمّره الغزالي لكي نعود مع ابن رشد إلى طريق الحداثة. طبعًا، وكما أشرت، مستفيدين من كل التراث الفكري والعلمي والعملي الذي وُلد في «الغرب»، حيث إن الحداثة ضرورة في عالم حداثي، أو نبقى في أسفل قائمة التخلف والفقر والتفتت.


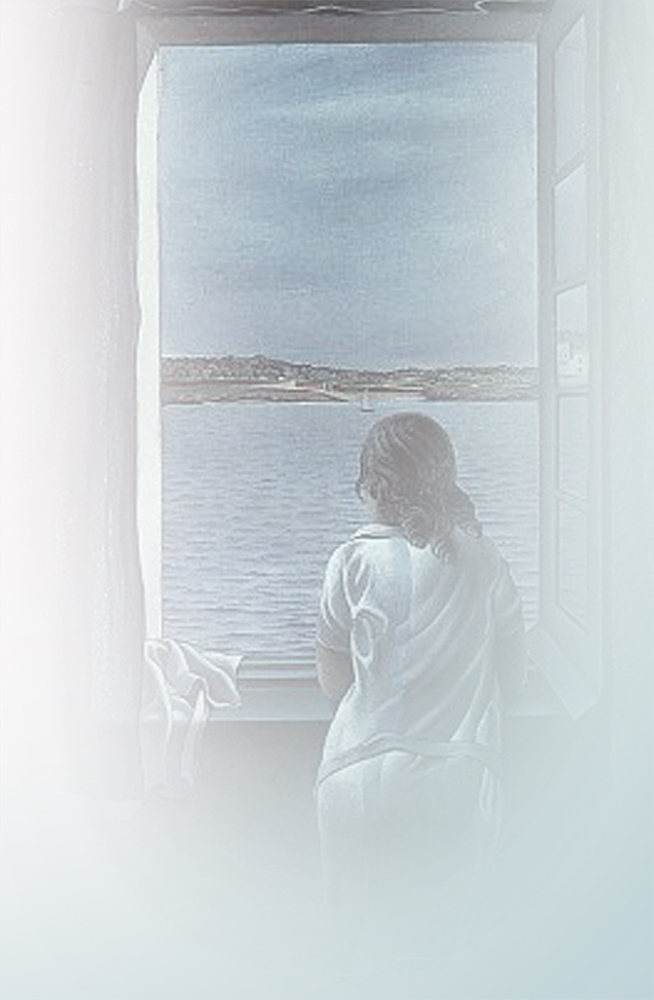 رأيناهما معًا، هو والمرأة. في يده دفتر سميك، وهي تسير إلى جواره بخطوات واثقة.
رأيناهما معًا، هو والمرأة. في يده دفتر سميك، وهي تسير إلى جواره بخطوات واثقة.