
عن مستقبل قصيدة النثر العربية
لم أسأل يومًا، بالرغم من أنني أحد شعرائها، الذين قضوا جل حياتهم يكتبونها، ويدافعون عنها، ويبشرون بها: «ما مستقبل قصيدة النثر العربية؟» إلّا وأبديت بعض التردد، لدرجة أبدو بها كأني غير راغب بالإجابة. ولكن، مرة، وأنا أحاول التهرب كعادتي، بحجة أني لست الشخص المناسب لتقديم الجواب الشافي على هذا السؤال، واجهني صديقي الشاعر عباس بيضون بسؤال آخر، من النوع الذي يحار المرء مهما بلغت حجته كيف يرد عليه: «لماذا لا؟». حقًّا، لماذا لا؟! وها أنذا أفعل. ولكن ذلك لن يحول دون ذكري الأسباب التي كانت تدفعني للتردد، وهي مثلها مثل كل شيء نبرر به ما نفعله وما لا نفعله، تنقسم إلى، أسباب خاصة، داخلة بي، وأسباب أخرى خارجة عني، عامة، داخلة في الموضوع نفسه:
الفرح ليس مهنتي.. والنقد كذلك: أولًا، مشيرًا إلى ظاهرة، أن عامة المشتغلين في نقد الشعر عندنا، هم الشعراء أنفسهم. عملًا بالقول الجاري: «أهل مكة أدرى بشعابها»، فذلك يستدعي أول ما يستدعي السؤال: ما إذا كان الشعراء حياديين عند الحكم على أنفسهم أو على نتاج أقرانهم؟ أو ما إذا كانوا مؤهلين؟ أو هل يمتلكون الحق؟! ولا أظن التذكير بمكانة ص. ت. كولريدج كناقد، أو شارل بودلير، أو بول فاليري أو ت. س. إليوت، أو أرشيبالد ماكليش صاحب كتاب «الشعر والتجربة»، وغيرهم من الشعراء الذين عُرفوا بكتاباتهم التنظيرية والنقدية عن الشعر والشعراء، يصلح كإجابة داحضة لهذه التساؤلات. ذلك أنهم، كانوا أقرب إلى المنظرين لمدارس ومناهج ورؤى شعرية جديدة، منهم إلى نقاد مختصين. كما أنهم أقرب لأن يشكلوا ظاهرة لافتة وليس قاعدة عامة.
وفي المقابل لم أجد عند الشعراء العرب، قديمًا وحديثًا، من أعطى شعر الآخرين ما يكفي من الوقت والجهد، للحد المطلوب من الناقد. فأدونيس رغم الحجم الكبير لدراسته في «الثابت والمتحول» والعديد من كتبه حول الشعرية والحداثة وغير ذلك، لم يقم بأي دراسة نقدية لشاعر، إلا بعض المقدمات لعدد من المختارات الشعرية، كمختاراته من قصائد يوسف الخال إصدار دار مجلة شعر 1962م. فجوهر عمل أدونيس حول الشعر تنظيري استشرافي أكثر منه نقدي. وكذلك، بطريقة ما، الدكتور كمال أبو ديب. وعشرات الشعراء العرب الذين إذا كان لهم مساهمات نقدية نظرية أم تطبيقية، فهي لا تزيد عن كونها اجتهادات جاءت لتملأ الفراغ النقدي الذي يشكو منه الجميع. أما بالنسبة لي، أنا الذي يحاول الآن معرفة المآل الذي ستمضي إليه قصيدة النثر في المستقبل، فيومًا لم أَتَنَطَّع لأكون دارسًا لحركة شعرية ما، أو لجيل شعري محدد! ويومًا لم أعمل على جمع مقدمات، أو معطيات، أستطيع أن أستنتج بواسطتها خلاصة ما. وكنت دائمًا أفتقد القدرة على إصدار أحكام، فلطالما آمنت ببراءة الجميع، وصدقت بما يسوقونه من مبررات وأدلة غياب. أما عن كوني، مثلي مثل الكثيرين، قد كتبت عددًا من المراجعات النقدية لمجموعات ولتجارب شعرية كنت أعرفها عن قرب، بطريقة أو بأخرى، فهذا شيء، والقدرة على تقديم خلاصات أو تعميمات، شيء آخر.
ثانيًا- كنت أهزأ، من بين الأشياء الكثيرة التي كنت أهزأ منها، من أن للشعر ملكة التنبؤ بالمستقبل، كتشبه الشعراء بزرقاء اليمامة أو كاهنة معبد دلفي، ومن أنهم يتمتعون بقدرة سحرية على رؤية ما سيأتي في الغد، وأشياء أخرى من هذا القبيل. فيومًا لم أقرأ شاعرًا عربيًّا أو غير عربي بلغ به الخبل لأن يقول: «سوف يحدث كذا، وتنبهوا من كذا، في المكان كذا، والزمان كذا». ذلك أني لا أصدق أن إنسانًا عاقلًا، شاعرًا كان أم غير شاعر، يمكنه أن يدعي بأنه كائن استثنائي، خرافي، يملك المقدرة على معرفة الغيب.. ما أستطيع الادعاء أني أعرفه، هو ما مضى، ما عبَر من أمامي وتنبَّهت له، فقد كنت أردد قولًا، لا أذكر من قاله: «لا أكتب إلَّا عمّا رأيت وسمعت». وهو قول أصلح للقصاصين والرواة منه للشعراء.
ثالثًا- يحتاج البحث في مستقبل قصيدة النثر العربية، متابعة حثيثة، ومن ثم معرفة واسعة، للأنسال الجديدة التي تدخل مضمار قصيدة النثر في البلاد العربية وخارجها، الأمر الذي شُفيت منه وما عاد شغلي الشاغل منذ زمن، فما أقوم بفعله اليوم هو أكثر ما يعنيني إن لم أقل كل ما يعنيني، أما عن حرصي على الاطلاع على ما يكتبه الآخرون؛ الأسماء التي أتابع تجاربها لأهميتها المؤكدة، والأسماء التي يتناهى لي بعض التصفيق لها وهي تدلف الساحة، الشعراء الجدد الذين يتواصلون معي، فلم يكن يومًا بدافع المقارنة والحكم. وقد يستغرب المرء كيف له أن يجد مفرًّا من إجراء المقارنات والتوصل إلى، إن لم يكن إلى أحكام، فليكن إلى آراء، إلا أنني في الحقيقة أفعل هذا لمنفعتي الشخصية، وبوجوه عدة، أهمها، أني أغذي به ذلك المزاج الذي أحتاجه للاستمرار والمتابعة.
مفرد بصيغة الجمع.. وجمع بصيغة المفرد
أولًا- ليس فقط لأني شفيت من حمّى قراءة كل شيء، بل لأنه أصلًا لا يتوافر بين يدي ما يكفي لألقي نظرة متفحصة ولتكوين فكرة صحيحة عن واقع قصيدة النثر العربية. وهذا ما يمكن له أن يجعل من الكتابة في هذا الموضوع، إن لم يكن قفزة في الظلام، فهو وقوع في السياج الشائكة الكثيرة التي تقيمها الكتابة باللغة العربية التي ينطق بها ما يقارب ثلاث مئة مليون إنسان، ولكن بنسبة أمية عالية، ونسبة قراءة متدنية لدرجة كارثية، يتوزعون على عشرين بلدًا، يتصل بعضها ببعض على شكل سلسلة ذات حلقات مغلقة. فما يكتب في الأردن لا يتخطى الأردن، فلا كتب ولا مجلات ولا صحف أردنية تدخل بلدًا متاخمًا له كسوريا، وأغلب ما يكتب في سوريا لا يُعرَف إلا في سوريا. حتى في داخل سوريا، البلد الذي اتصف بالاستقرار لعقود سنين طويلة، ذي التطور الاجتماعي والتقاليد الثقافية الفاعلة، نجد أن شعراء مدينة حلب، حتى أصحاب المجموعات الشعرية منهم، مجهولون في اللاذقية وحمص وأيضًا في العاصمة دمشق حيث يفترض أن يصبّ فيها كل شيء، إلا إذا حدث وانتقل أحدهم على نحو شخصي، وبخاصة بعد أن تعففت دور النشر المهمة عن طباعة كتب الشعر إلا للأسماء المستطيرة! وصار الشعراء يطبعون على حسابهم عددًا ليس كبيرًا من النسخ، تضاءل في العقدين الأخيرين من ألفي نسخة إلى ألف، ثم إلى خمس مئة، ثم إلى لا أكثر من مئتي نسخة!! يوزعها الشاعر على أصدقائه وأقاربه وعلى شعراء مدينته، وأحيانًا على الشعراء الذين يستطيع الوصول إليهم في مدن أخرى ضمن بلده؛ الأمر الذي يضطره أحيانًا للسفر بنفسه، وغالبًا ما يكون من المتعذر عليه أن يقوم بذلك لإيصالها إلى شعراء بلد عربي مجاور، فكيف إلى بلد عربي يأتي في السلسلة على بعد خمس حلقات!!

وأحسب أنه قد حدث للعديد من الشعراء أن اجتمعوا في مهرجان ما مع شعراء عرب آخرين من جيلهم أو من جيل سبقهم، وهم لم يسمعوا بمجرد أسمائهم، ثم إن كانوا قد سمعوا بهم سماعًا، فهم ليسوا على أي اطلاع على نتاجهم. فأول مرة سمعت باسم علاء خالد مثلًا كان عند لقائنا في مهرجان كافالا في اليونان عام 2002م، أما جرجس شكري، المصري الآخر فقد عرفته فقط في مهرجان جرش عام 2004م. ولا أخجل إن قلت في ذلك المهرجان عرفت لأول مرة أن رئيس اتحاد الكتاب في المغرب هو الشاعر حسن نجمي، ولم أستطع أن أحدد ما إذا كنت قد سمعت باسمه في السابق أم لا.. في سوريا لا تستطيع أن تحصل على المجموعات الشعرية المهمة التي تميزت بها دار الجديد البيروتية، في الثمانينيات والتسعينيات، فكيف لك أن تحصل على أعمال لشعراء تونسيين أو جزائريين أو يمنيين، يومًا لم تقع عيناي لا في المكتبات السورية ولا اللبنانية على كتاب سوداني أو تونسي أو ليبي، والسؤال هو: ألا يطبعون كتبًا في السودان وتونس وليبيا والجزائر والصومال واليمن وقطر والبحرين على الإطلاق؟! وهذا لا يقتصر على الشعر وحده، بل أيضًا الروايات والقصص القصيرة حتى الكتب المترجمة، أما ما يصلنا من مجلات ودوريات ثقافية، لا أدري إن كانت توزع في أنحاء الوطن العربي كافة أم لا، فإنك حتى إن قرأت قصائد لشاعر ما، فإنك سرعان ما سوف تنساه، وذلك لكثرة الأسماء، الداخلة الخارجة في ساحة الشعر. وهذا ما حدث لي عندما كتبت عن الشاعر العراقي الراحل رعد عبدالقادر، فقد ظننت أن قصيدته التي قمت بدراستها في ردِّي على ما كتبه سعدي يوسف عنها أول عمل أقرؤه له، مع أن عددًا من قصائده كان منشورًا منذ مدة ليس بعيدة، على الصفحة المقابلة لقصائد لي في مجلة نزوى العمانية.
ثانيًا- هناك الآن، لا بد من الاستدراك، مصادر أخرى متاحة للاطلاع والمتابعة، إذا كان لدى المرء الرغبة والوقت وجهاز كمبيوتر موصول بشبكة الإنترنت. مواقع ثقافية مثل موقع «جهة الشعر» الذي يشرف عليه الشاعر البحريني قاسم حداد، وموقع «كيكا» بإشراف، لا أدري بماذا أصفه، الشاعر والروائي والناشر العراقي صموئيل شمعون، وموقع عراقي آخر هو «الإمبراطور» يشرف عليه شاعر عراقي آخر هو أسعد الجبوري وهناك أيضًا عدة مواقع سورية جديدة مثل: «الجدار» و «ألف» و«أبابيل» و«أوكسجين» هذه كلها يغلب فيها النتاج الشعري، إلا أن موقعًا كـ«قصيدة النثر المصرية» الذي يشرف عليه الشاعر المصري عماد فؤاد يسمح على نحو استثنائي بالاطلاع الوافي على حال هذه القصيدة في بلد عربي كبير تأخر فيه ظهورها نسبيًّا عن لبنان والعراق وسوريا، حيث يتضمن ملفًّا عن كل من سبعة وستين شاعرًا وشاعرة من الأجيال الثلاثة الماضية للقرن المنصرم. كما أنه يتوافر على صفحات «الفيسبوك» عشرات المواقع الفردية لشعراء من كافة البلدان العربية.
ثالثًا- ما يربك هنا هو، ليس الكثرة والتنوع فحسب، بل أيضًا مستوى النتاج، التراكم الكمي الذي يبدو كأنه استطاع الهروب من حتمية أن التغير الكمي يؤدي إلى تغيير نوعي، وكأن ما يأتي لاحقًا لا يقوم على محو ما أتى سابقًا، أو كأن كلَّ شيء يبدأ بنفسه على نحو ما، ذلك أني التقيت شعراء شبابًا كثيرين يكتبون قصيدة النثر، لا يعرفون توفيق الصايغ ولا شوقي أبي شقرا ولا عصام محفوظ ولا حتى أنسي الحاج، أما في سوريا فسليمان عواد الأب الروحي لـمحمد ماغوط شبه نكرة، وإذا كان عواد شاعرًا ظهر في الخمسينيات، فماذا يقال عن شاعر سوري آخر هو بدوره شبه مجهول في بلده، مثل نوري الجراح الذي أصدر أعماله الشعرية بمجلدين سميكين منذ ثماني سنوات؟ رغم ما يعرف عني من حرص على رؤية الأشياء من الزاوية الجيدة، وتصديقي بأن الرسامين والشعراء والموسيقيين يشتهرون بفضل عددٍ من أحسن أعمالهم وليس بأعمالهم كلها، ورفضي لفكرة القراءة بهدف إصدار الأحكام والبحث عن أدلة، وذلك لحرصي بالمقابل على الاستمتاع بهذا الفن الذي وصم حياتي، أجدني غارقًا بشعور معاكس تمامًا، أقرب للشعور بهدر الوقت وإضاعة الجهد والأحاسيس، منه للمتعة والفائدة، وصولًا إلى الشعور بالإحباط والخيبة.
أسماء كثيرة، ومجموعات شعرية كثيرة كثيرة، وقصائد كثيرة كثيرة كثيرة، نستطيع قراءتها هنا وهناك، لا تصنع سوى ذلك التراكم الذي لا يحتاجه أحد، وقليلها يستحق أن يتوقف المرء عنده، ويعيد قراءته محاولًا أن يبقيه في ذاكرته. ولكن، ولكن، يأتيني صوت، وسؤال: «أليس هذه هي الحال دائمًا، أليس دائمًا هناك تلك القلة التي يُعوَّل عليها بأن تقوم بصناعة الفرق؟!».
رابعًا- أحسب أن أي محاولة تبصرية لمعرفة مستقبل حركة أدبية ما، تحتاج إضافة لاجتهاد صاحبها، وقدراته، أن يتوافر لديه بعض المراجع والدراسات التي سبق وقدمت تصورًا، صغيرًا أو كبيرًا لموضوع البحث. وهنا مرة أخرى، تعترضنا إعاقة قاسية في بدن الحركة الشعرية العربية الحديثة، وهي عدم مواكبتها بحركة نقدية حقيقية، نظرية وتطبيقية. مع اعترافي بأنه يساورني قدر كبير من الشك ما إذا كان الشعر العربي اليوم يدين، سلبًا أم إيجابًا، لهذا الغياب النقدي، حيث أكتفي بترجمة بعض المراجع والمنطلقات النظرية التي مهَّدت لقصيدة النثر عالميًّا، مع محاولة بسيطة وساذجة لتأصيلها، بوصف النص القرآني والسرديات العربية بأنواعها، جذورًا لها. أما تطبيقيًّا فلم يزد الأمر عن عدة كتب نقدية تطرقت للرواد على نحو أساسي، فقد رافقتهم حركة نقدية لافتة بالمقارنة مع من جاء بعدهم، أولئك الذين لم يحظوا في أفضل الأحوال سوى بمتابعات لمجموعاتهم الشعرية في الصحف والدوريات التي تصدر هنا وهناك، تجمع أحيانًا في كتاب، وغالبًا ما تهمل. ولكن منذ فترة وجيزة، نتيجة لهذا النقص وهذه الحاجة بدأت تظهر بعض المحاولات لرصد حركة الشعر العربي الحديث، ومن الغرابة أن ما اتفق على تسميته أنطولوجيات شعرية صدرت كلها بلغات أجنبية.

ماضي الأيام التي لن تأتي
انطلاقًا مما ذكرت، يمكن أن يرسل المرء نظره إلى مستقبل قصيدة النثر في اتجاهين مختلفين، الأول: هل سيكون لقصيدة النثر مستقبل؟ والثاني: ماذا ستكون عليه قصيدة النثر في المستقبل؟ كيف ستكتب؟ وبأية أشكال ستوجد؟ وأحسب أن البحث في كلا الأمرين على تكاملهما الصوري، يشبه حقًّا الرجم بالغيب، وبخاصة في بلاد كبلادنا، لا أحد، حتى المنجمون، يستطيع أن يخمن مستقبلها، التي لم تجد في بحثها عن نقطة انطلاق إلا أن تعود القهقرى لما وراء نقطة الصفر. وإذا اعتبرت أن مستقبل قصيدة النثر العربية هو مستقبل الشعر العربي، أو جزء من مستقبل الشعر العربي، فكثيرًا ما قرأت، أن مستقبل هذا الشعر، يتوقف أساسًا على مستقبل الإنسان العربي نفسه، الناطق باللغة العربية. ثم يأتي ذلك الاستنتاج، الذي لا تعيبه عموميته بالقدر الذي تعيبه شاعريته، بأنه ما دام هناك عرب سيكون هناك لغة عربية، وما دامت هناك لغة عربية فسيكون هناك شعر عربي؟! ولكن ما نعدّه اليوم شعرًا ونفكر فيما يمكن أن يكون مستقبله، قد يختلف لدرجة يصير بها فنًّا من جنس آخر، باختلاف كبير في الطرائق والأدوات كما في الأغراض والمآرب، لا بل قد يأتي يوم ليس بهذا البعد كما يبدو، تزداد به عزلة الشعر وتزداد هامشيته، حتى ينقرض. عندها يمد رأسه ذلك السؤال الصفيق: «ومن قال: إن البشر، لا يستطيعون الحياة بدون الشعر؟». ففي العالم اليوم، يولد ويحيا ويموت الملايين من البشر، عربًا وغير عرب، محرومين أم مرفّهين، متخلفين أم متحضرين، أكلة كافيار أم نابشي حاويات قمامة، دون أدنى اعتبار لوجود الفن التشكيلي أو المسرح أو… الشعر. وبخاصة بعد أن دفع بالأخير أصحابه الشعراء، لسبب أو بدون سبب، ليصير إلى هذه النصوص المربكة التي يتعذر فهمها وتقديرها إلا من قبل أهل الكار أنفسهم، أي أولئك الذين بدوافع جيدة أو سيئة هم الأقل مصلحة في هذه العملية.
ماء إلى حصان العائلة المتروك وحيدًا
لا بد من الاعتراف بذلك الشوط الذي قطعته قصيدة النثر العربية، من الخواطر الشعرية والنثر العاطفي إلى قصيدة تبدو كأنها أصيلة متجذرة تنبت فروعًا متعددة وثمارًا متنوعة، من الاتِّهام والعداء والتحريم إلى الاعتراف والقبول والإباحة، وربما… الانتصار. هذا الانتصار الذي تبدَّى على عدة أصعدة؛ منها انتقال العديد من الشعراء الرواد لكتابتها، كما فعل يوسف الخال وأدونيس وشوقي أبي شقرا وعصام محفوظ في الستينيات، ثم تبعهم في السبعينيات شعراء كانوا مؤسسين على القواعد العروضية مثل: نزيه أبو عفش، وبندر عبدالحميد، وقاسم حداد على سبيل المثال لا الحصر. بعد هذا صارت قصيدة النثر الاختيار الأول لأفضل المواهب الوافدة إلى حقل الشعر. وبسبب انتشارها الشديد فتحت لها أبوابها أكبر حصون الشعر العمودي والتفعيلة، بعد حرب استنفدت فيها كل مخزونها من الذخائر الثقيلة. ومن اللافت أنه قد حدث هذا على نحو تنازلي، أي من الأعلى إلى الأدنى فالأدنى، فمن اتهام كُتَّابها بالتخريب والخيانة، إلى الاكتفاء بتعييرهم بالتقليد والنقل، ثم لفتح الأبواب على مصراعيها لقصائدهم. حتى إن لم تتوافر تلك القدرة على تمييز الجيد منها من الضحل. فاتحاد الكتاب العرب في سوريا، الذي كان، حتى الأمس القريب، يرفض، عند ممارسة دوره كرقيب، الموافقة على طبع المجموعات الشعرية النثرية، ولو على حساب أصحابها، بات يصدر ضمن منشوراته ما هب ودب من هذه المجموعات. ومجلات كمجلة الآداب مثلًا، أو مجلة العربي الواسعة الانتشار ذاتها التي كانت تتحف قراءها بمخلفات القصيدة العمودية، صارت تقبل القصائد النثرية وتنشرها مع رسوم ملونة لأزهار وفراشات ووجوه نساء على صفحاتها، وصار المرء يقع على دوريات أدبية وملاحق ثقافية لا تنشر سوى قصائد نثرية. فعندما سأل جوزيف عيساوي عباسَ بيضون في برنامج «قريب جدًّ»: «لماذا تطغى قصيدة النثر لهذه الدرجة على الصفحات الثقافية لجريدة السفير؟».. أجاب عباس بما معناه: «ماذا أفعل إذا كان لا يصلني سوى قصائد نثرية؟». وكذلك ما قاله حسن طلب: «بأنهم باتوا في مجلة إبداع لا ينشرون سوى نصوص قصيدة النثر». أما تلك الأنطولوجيات الشعرية التي ذكرت، إذا لم تكن مقتصرة على الشعراء النثريين، وتحاول بحيادية أن تعطي صورة واقعية عن تنوع الشعراء الذين يحتلون الواجهة الشعرية العربية المعاصرة، فإن عدد شعراء النثر بينهم قد يصل إلى نسبة 75%. ولولا الرغبة في إظهار بعض الاعتدال، وورود عدد من شعراء التفعيلة يقلّ عن أصابع اليد الواحدة بين ثمانية وثلاثين شاعرًا تضمنتهم أنطولوجيا الشعر اللبناني الحديث التي أعدتها الشاعرة جمانة حداد باللغة الإسبانية، لأطبق عليها النثارون دون أدنى ديمقراطية.
إلَّا أن هذا الانتصار السريع لقصيدة النثر، الذي جاء بعد حرب عُصابية بامتياز، لم تستغرق أكثر من عقدين من السنين، هو الشبهة الخطيرة التي تحوم حول هذه القصيدة. حيث لم ينقضِ من الوقت ما يتيح لقصيدة التفعيلة، الابنة الشرعية للقصيدة العمودية التي عاشت قرونًا، أن تأخذ كامل أبعادها، أو فقط لأن تصل إلى نقطة قريبة، ما يكفي، من نهايتها. ذلك ما أدى إلى عدم حسم السؤال حول شرعية قصيدة النثر، وأحقيتها، وهل جاءت ضمن السياق الطبيعي للشعر العربي أم أقحمت إقحامًا؟ وربما ببعض الظن، جيء بها لضرب هذا السياق وتقويضه! أو هل أنها استجابة لحاجة حقيقية، أي منعكس لواقع حي معيش؟ الأمر الذي، رغم كل الاعتراضات، يمكن أن يفسر ويبرر انتشارها، أم مجرد تقليد أعمى لمنتوج حضاري غربي يكتسحنا مع ما يكتسحنا من أفكار ونظريات ومخترعات؟ لا دور لنا فيها سوى دفع كلفتها عشرات الأضعاف والإصابة بعسر الهضم بعد استهلاكها. أو أنها في الحقيقة، مثلها مثل الأيديولوجيات التي راجت عند النخبة العربية كالماركسية والوجودية والليبرالية، تعبير عن تغريب هذه النخبة، وشكل من أشكال القطيعة والعداء بينها وبين محيطها!؟ فبقدر ما تفشت قصيدة النثر بين الشعراء بقدر ما انحسرت بين الناس. حتى صار يقال: إن جمهور الشعر اليوم لا يزيد عن عدد الشعراء أنفسهم، أو ربما أقل! أي أنه قد تم الوصول إلى حالة يقتصر فيها استهلاك الشعر على منتجيه، سقاة يبيعون الماء في حي السقاة!! فأي بائعين وأي مشترين إذن؟! وهكذا صار يتضاءل عدد حضور الأمسيات الشعرية في المهرجانات الثقافية، التي صار بعضها يقتصر على مشاركة شعراء النثر، بوصفهم الأكثر لمعانًا هذه الأيام، إلى أعداد مخزية بالفعل، توازي ما ذكرناه عن أعداد النسخ القليلة التي باتت تطبع وتباع من كتبهم. وهكذا تبدو الأمور كأنها تدور في مكانها، أو في حلقة أوسع قليلًا لكنها مغلقة… شعر نخبوي، يخرج عن السائد ويقطع بصورة حادة مع الذائقة العامة، متخطِّيًا مقدرة بقايا الطبقة الوسطى المتعلِّمة على فهمه، فينفرط عقد جمهوره حوله، ويبتعدون منه للحد الذي تنعدم فرصته في الوصول إليهم، رغب بهذا أم لم يرغب، ترفَّع عنه، أم قدم له ما أمكنه من تنازلات، حتى راح هذا الانتصار يبدو كأنه القمة التي ليس بعدها إلا الانحدار منها، وبقدر ما يكون الصعود سريعًا بقدر ما يكون الهبوط سريعًا، وربما، بمساعدة جاذبية الماضي، جاذبية الموت، أسرع.

نقد الألم.. الذي هو الشعر
اليوم ما عادت قصيدة النثر تمردًا أو ثورة أو مواجهة مع السائد وخروجًا على التقاليد، نعم فقدت قصيدة النثر هذا التميز، هذا الشرف، صار هناك أناس يكتبونها دون أن يفكروا بالخروج عن شيء، صارت قصيدة النثر، مثل ما كانت عليه قصيدة العمود وقصيدة التفعيلة، تكتب اتباعًا وتقليدًا، صارت بدورها سائدًا أدبيًّا. والمشكلة هنا تكمن في أنها صارت تقليدًا ليس له تقاليد، وسائدًا ليس له في الأصل مكانة! منقبات يكتبن قصيدة النثر، هذا ما قرأته في مقالة عن ملتقى الشعر العربي الثاني الذي أقامته وزارة الثقافة اليمنية في صنعاء، بحضور أكثر من 300 شاعر شاب عربي. حيث أهدى وزير الثقافة اليمني، الملتقى إلى روح الشاعر الكبير محمد الماغوط، محققًا بذلك، كما أعلن، ما طمحت إليه اللجنة المنظمة من هذا المهرجان، وهو: «الاحتفاء بالقصيدة العربية الجديدة، قصيدة النثر تحديدًا». والغريب أن ما نافس قصيدة النثر في هذا الملتقى هو القصيدة العمودية والمدائح النبوية والبيانات الرسمية!! وهكذا وسط هذا الهرج الشديد، أشعر أنه صار محتّمًا علينا جميعًا، وعليَّ بالتحديد، أن أعيد التفكير بما سبق وأطلقته من أحكام، كما حين قلت: إن أفضل المواهب الشعرية الجديدة تختار لنفسها كتابة قصيدة النثر، فالأصح الآن، أنه ليس أفضل المواهب فقط تختار قصيدة النثر، بل أيضًا أكثر هذه المواهب تواضعًا وشحوبًا باتت تكتب قصيدة النثر، حيث يصح أن الكم التراكمي ذا الآلية المعطلة ذاك، هو من عمل أولئك الذين يكتبونها لظنهم أن تحررها من الضوابط والقيود لا غاية له إلا سهولة كتابتها. وهذا، ربما أحد أقرب التفاسير لرأي الكثيرين في غلبة الرداءة على المشهد الشعري العربي الراهن.
ولكن هل هذا يعني أن الشعر العربي، في مسيرته الشكلية، إذا سمحنا لأنفسنا في تقسيمها إلى الأربع مراحل التالية: من البحور الكاملة والقافية الموحدة، إلى البحور المنقوصة والقافية المتنوعة، إلى البحور الخافتة الإيقاع وعدم الحرص على القافية، قد وصل بسياق طبيعي، إلى محطته الأخيرة وهي قصيدة النثر، غير الموقعة وغير المقفاة. أحسب أن أي جواب على هذا السؤال، يحتاج إلى أن يأخذ في حسبانه عدة تهيؤات إشكالية، يمكن أن تصل إلى مرتبة الحقائق المؤكدة في ميدان الأدب:
أولًا- لم يصل أي نشاط إنساني، علمي أو فلسفي أو فني، إلى ما يمكن تسميته المحطة الأخيرة. وأحسب أن القبول بتلك الفرضية اليوم، هو مجاراة شكلية للأحكام التي درجت مؤخرًا، بنهاية الفلسفة، أو نهاية التاريخ، أو حتى نهاية العالم. الأمر الذي من الصعب على البشر الحياة على أساسه، والقبول به كحتمية.
ثانيًا- هناك قاعدة معروفة في الفن، وهي عودة القوالب المحددة، ولو بأشكال مختلفة، بعد كل مرة تُحطَّم ويُطاح بها. أي أنه بعد كل تحرر تأتي قوانين جديدة ضابطة للعملية الفنية. فكما أن هناك ميلًا غريزيًّا عند البشر للحرية والانفلات هناك حاجة بشرية مُلِحَّة للانضباط والواجب.
ثالثًا- بغض النظر عما إذا كان يجب أن نهلل، نحن شعراء قصيدة النثر، لكونها المحطة الأخيرة للشعر العربي، الآن أم لاحقًا، بحيث يصدق وعدنا بأنها تمثل مستقبل هذا الشعر، فإن قصيدة النثر اليوم ما عادت قصيدة واحدة، وما عادت نثريتها جنسًا شعريًّا بحد ذاتها. فقد تباينت وتفرقت لأنواع عديدة من القصائد، كل منها له اتجاهات ومعايير فنية مختلفة، فمن القصيدة اليومية ذات اللغة المباشرة وغير المنمقة إلى القصيدة الذهنية ذات اللغة المجردة، ومن القصيدة الحسية المادية إلى القصيدة التأملية والفلسفية، ومن القصيدة السردية التي تروي وتصف، إلى القصيدة المكثرة من البديع والمحسنات، ومن قصيدة ذات وحدة موضوعية إلى قصيدة تبدو كأنها بلا موضوع…
رابعًا- لا يدل النتاج الشعري الجديد، على بذل الجهد اللازم في حقل كتابة الشعر اليوم. وكأن قصيدة النثر، كأختها قصيدة التفعيلة، وبفترة زمنية تعادلها قصرًا، قد اقتربت من، إن لم أقل وصلت، إلى مرحلة استنفاد أدواتها وأساليبها. بعد أن عُممت هذه الأدوات والأساليب، لتنتج قصيدة غير شخصية على الإطلاق، ذات مواصفات موحدة ومعروفة؛ مما أفقدها ذلك التنوع المثير الذي كانت قصيدة النثر، في تحررها من التقاليد المنهكة في الشعر، تعد به. و بات من غير المتوقع، إلا بدائرة الاستثناءات، أن يحظى المرء بتجربة ذات خصوصية لافتة، في نتاج الأجيال الجديدة لهذه القصيدة. أما الأسماء المكرسة، من الجيل الثاني والثالث فقد بدأت بنشر أعمالها الشعرية الكاملة، كإيذان بقرب إكمالها لدورتها الإبداعية. فلا تجارب جديدة تطرأ في مختبر قصيدة النثر، وتلك السردية التي هي الآن السمة الأشد حضورًا في قصيدة النثر اليوم، وكثيرًا ما عُدَّت المطب الأخطر لقصيدة النثر، ما هي إلا عودة إلى أصول قصيدة النثر الأولى، ومن السهولة بمكان أن يجدها المرء في النتاج الشعري الباكر للرواد. وكأن بعضًا قد تنبه الآن فقط، إلى أن اختيار النثر لكتابة الشعر، كان منذ البداية اختيارًا لخصائص النثر المعروفة والمتفق عليها بين الجميع، كالسرد والوصف والحوار، وإن غاية التحرر من الوزن والقافية وأنواع البيان والبديع كانت ولا تزال لإحكام اللغة وللسدادة في انتقاء الكلمات والدقة في تأدية المعنى.
الخروج من المدار المغلق
بعد كل هذا يبقى التساؤل الأخير.. ما العمل؟ هل يمكن مواجهة حالة انحسار، انكفاء، تراجع، الشعر، بالطلب من الشعراء إجراء تسويات بينهم وبين الناس الذين يكتبون الشعر لأجلهم، أو بتعبير أكثر مباشرة، الناس الذين يطالبونهم بتصديقهم، وبشراء كتبهم، وقراءة قصائدهم. أقصد، إجراء ما ينبغي من تغييرات في كتاباتهم، كل منهم حسب ما يلائمه، وحسب ما يجده صوابًا، أقصد حلولًا، تساعد على زيادة تقبل الناس للشعر عمومًا، وللشعر الحديث خصوصًا، ولقصيدة النثر بالذات؟! والسؤال: كم من الشعراء سيرضى بذلك؟! كم منهم من سينظر إلى طلب كهذا بوصفه حلًّا مقبولًا وليس تنازلًا وإقرارًا بالهزيمة؟! ومن جهة أخرى، هل يساعد على انتشار الشعر وعودته لاحتلال مكانته عندنا، القيام بالمبادرات المتنوعة لتعريف الجمهور الأوسع من الناس، على ماهية الشعر، وأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه في حياتنا؟ كتقديم قراءات شعرية خارج القاعات والمنابر التقليدية، مثل الحدائق والمقاهي، وبطرق مبتكرة تجنب الجمهور الضجر الذي ينتابه من طريقة القراءة المعروفة. الاحتفاء بالشعراء وإطلاع الناس على نتاجهم وسِيَرهم الحياتية بطرق غير نخبوية، التأكيد على حضور الشعر الجديد في المناهج المدرسية منذ المراحل الأولى، زيادة الحضور الشعري في وسائل الإعلام المرئية خاصة، تشجيع نشر كتب الشعر وتوزيعها واقتنائها… ولكن السؤال هذه المرة: كم يجدي ذلك كله في سياق ثقافي واجتماعي يمضي دون أن يلوي على شيء، في الاتجاه المعاكس؟
* لا أظنه يخفى على أحد من المهتمين بهذا الموضوع، أن جميع العناوين الداخلية مقتبسة من عناوين مجموعات شعرية معروفة:
1- «الفرح ليس مهنتي» محمد ماغوط (1970م).
2- «مفرد بصيغة الجمع» أدونيس (1977م).
3- «ماضي الأيام الآتية» أنسي الحاج (1965)م.
4- «ماء إلى حصان العائلة» شوقي أبي شقرا (1962م) الفائز بجائزة مجلة شعر.
5- «نقد الألم» عباس بيضون (1974م).
6- «المدار المغلق» جبرا إبراهيم جبرا (1964م).

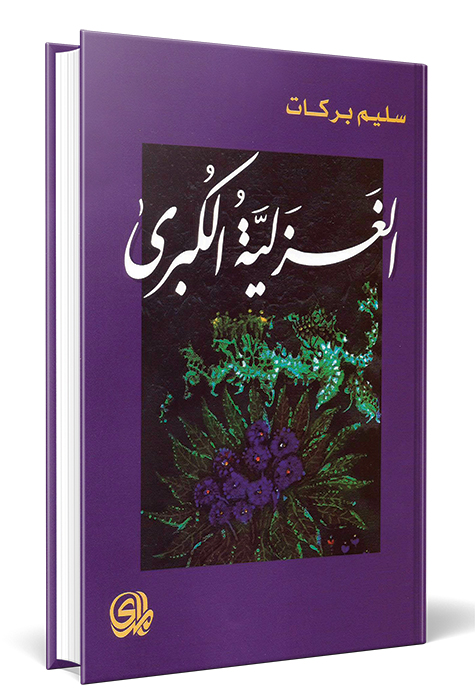


 «ما رأيك لو تنام عندي هذه الليلة؟» سألني. «لا مكان آخر لدي» أجبت. مغارة البدوي بندر عبدالحميد، حيث قضينا السهرة، باتت مدخنة. ورغم أن الساعة قد تجاوزت الثانية بعد منتصف الليل، فقد ذهبنا سيرًا على الأقدام، أقدام الروح ربما، يا للشاعرية! لأن أيًّا منّا لم يبال بالمسافة البعيدة التي تفصل بين مغارة بندر والوكر الذي آل إلى (رياض)، في حي الديوانية، بعد انتقال فواز الساجر منه – بدوره شدّ الرحال باكرًا – من يصدق أنني أعيد الآن كتابة ما كتبته منذ /35/ عامًا! في ذلك الحيّ الترابي الذي سكنت فيه يومًا عائشة أرناؤوط وصخر فرزات – هو الآخر مات – الحيّ الذي كثيرًا ما استحال عليَّ تذكر اسمه، ولا موقعه، ولا كيف مضينا إليه. كنت سعيدًا، وكان سعيدًا، لا أعرف (رياض الصالح الحسين)، وأرجو ألا يخيب هذا ظن بعضكم، إلا سعيدًا! طوال الطريق كان ينطّ أمامي وخلفي وعلى جانبيّ، وهو يردّد ضاحكًا: «إنها حياة جميلة.. إنها حياة حلوة.. إنها حياة لذيذة»، بصوته الذي لم أستطع وصفه من قبل، أمّا الآن، وقد توضّح كل شيء، فإنه صوت رجل عاش سنواته كلها يلفظ، أو ربما، يلتقط، أنفاسه الأخيرة.
«ما رأيك لو تنام عندي هذه الليلة؟» سألني. «لا مكان آخر لدي» أجبت. مغارة البدوي بندر عبدالحميد، حيث قضينا السهرة، باتت مدخنة. ورغم أن الساعة قد تجاوزت الثانية بعد منتصف الليل، فقد ذهبنا سيرًا على الأقدام، أقدام الروح ربما، يا للشاعرية! لأن أيًّا منّا لم يبال بالمسافة البعيدة التي تفصل بين مغارة بندر والوكر الذي آل إلى (رياض)، في حي الديوانية، بعد انتقال فواز الساجر منه – بدوره شدّ الرحال باكرًا – من يصدق أنني أعيد الآن كتابة ما كتبته منذ /35/ عامًا! في ذلك الحيّ الترابي الذي سكنت فيه يومًا عائشة أرناؤوط وصخر فرزات – هو الآخر مات – الحيّ الذي كثيرًا ما استحال عليَّ تذكر اسمه، ولا موقعه، ولا كيف مضينا إليه. كنت سعيدًا، وكان سعيدًا، لا أعرف (رياض الصالح الحسين)، وأرجو ألا يخيب هذا ظن بعضكم، إلا سعيدًا! طوال الطريق كان ينطّ أمامي وخلفي وعلى جانبيّ، وهو يردّد ضاحكًا: «إنها حياة جميلة.. إنها حياة حلوة.. إنها حياة لذيذة»، بصوته الذي لم أستطع وصفه من قبل، أمّا الآن، وقد توضّح كل شيء، فإنه صوت رجل عاش سنواته كلها يلفظ، أو ربما، يلتقط، أنفاسه الأخيرة. «الرجل مات
«الرجل مات وعندَ هذا الشهيق
وعندَ هذا الشهيق