
«ربيع الغرب» وتحوّلاته
ليس للعرب وحدهم «ربيعهم» الدامي شبه المتمادي اليوم، بل للغرب المتقدم أيضًا. غير أن «ربيع الغرب» وإن ترجم نفسه في الساحات والميادين على نحو أقل عنفًا ودمًا وسخطًا واعتقالًا تعسفيًّا ومدى زمانيًّا ومكانيًّا، إلاّ أنّ ثقافة هذا «الربيع» رَسَخت أكثر في ذاكرة مفكّري هذا الغرب وأدبائه وشعرائه وفنّانيه، وبخاصة في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوربية، ممن تأثر في البداية «بالثورات العربية»، ونقل تأثره إلى نيويورك، حيث اشتعلت هناك الاحتجاجات الصاخبة منذرة، من خلال حركة «احتلوا وول ستريت» (عصب المركز المالي الأميركي)، بالأسوأ على الصعيد الأميركي، ومنه على صعيد العالم بأسره، إذ تعاظمت الاحتجاجات لتغطّي ما تعداده 1564 مدينة حول العالم، من بينها 103 مدن أميركية، تتقدّمها واشنطن بوصفها عاصمة سياسية ونيويورك بوصفها عاصمة للمال والاقتصاد. كان ذلك بدءًا من 15 أكتوبر 2011م، حيث انتشرت ظاهرة الاعتصامات والتخييم ليل نهار في الساحات المركزية وبعض الحدائق العامة مثل متنزه «زوكوني» الشهير في مانهاتن قبل أن تستأصلها الشرطة عن بكرة أبيها.
المجرّة المتغيّرة العناصر
 قبل أن نتطرّق إلى أبرز الخطابات الفكرية والأدبية والفنية التي نتّجها حراك «الربيع الغربي»، خصوصًا في الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوربي، لا بدّ لنا وبإيجاز من سرد هذي الوقائع التاريخية لمزيد من التضوئة على الموضوع. افتتح الحراكان الشعبيان، التونسي والمصري في عام 2011م، موجة واسعة من التعبئات والاسـتنفارات. كان المتوقع لمثل هذه «الانتفاضات الثورية» أن تنتشر، وإنْ بوتائر مختلفة، في بلدان المشرق والمغرب العربيين؛ غير أن كثيرًا منها أفضى إلى حروب أهلية دمويّة، كما حدث في سوريا وليبيا، مثالًا لا حصرًا، ومن ثمّ صار له وظيفة تحريضيّة على مستوى القارات. في السنغال الإفريقية، مثلًا، سـرّعت حركة «طفح الكيل» بسقوط نظام عبـدالله واد. بعد ذلك بأسابيع، وتحديدًا في منتصف شـهر مـايو 2011م، تظاهر بضعة آلافٍ من الإسبان ضد سياسة «شدّ الحزام»، كما سمّتها صحيفة «إلباييس» الإسبانية التي اعتمدتها حكومة بلادهم، وقرّروا المـرابطة في إحدى سـاحات مدريد الرئيسة: «لابويرتا دل سول». كان هؤلاء الآلاف يسـتلهمون مباشرة تجـربة «ميدان التحـرير» في القاهرة، أي الاحتلال المدني، ليلًا ونهـارًا، لحـيِّزٍ عمومي، كتعبير عن التصميم الجماعي على الخلاص من سياسات غير عادلة.
قبل أن نتطرّق إلى أبرز الخطابات الفكرية والأدبية والفنية التي نتّجها حراك «الربيع الغربي»، خصوصًا في الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوربي، لا بدّ لنا وبإيجاز من سرد هذي الوقائع التاريخية لمزيد من التضوئة على الموضوع. افتتح الحراكان الشعبيان، التونسي والمصري في عام 2011م، موجة واسعة من التعبئات والاسـتنفارات. كان المتوقع لمثل هذه «الانتفاضات الثورية» أن تنتشر، وإنْ بوتائر مختلفة، في بلدان المشرق والمغرب العربيين؛ غير أن كثيرًا منها أفضى إلى حروب أهلية دمويّة، كما حدث في سوريا وليبيا، مثالًا لا حصرًا، ومن ثمّ صار له وظيفة تحريضيّة على مستوى القارات. في السنغال الإفريقية، مثلًا، سـرّعت حركة «طفح الكيل» بسقوط نظام عبـدالله واد. بعد ذلك بأسابيع، وتحديدًا في منتصف شـهر مـايو 2011م، تظاهر بضعة آلافٍ من الإسبان ضد سياسة «شدّ الحزام»، كما سمّتها صحيفة «إلباييس» الإسبانية التي اعتمدتها حكومة بلادهم، وقرّروا المـرابطة في إحدى سـاحات مدريد الرئيسة: «لابويرتا دل سول». كان هؤلاء الآلاف يسـتلهمون مباشرة تجـربة «ميدان التحـرير» في القاهرة، أي الاحتلال المدني، ليلًا ونهـارًا، لحـيِّزٍ عمومي، كتعبير عن التصميم الجماعي على الخلاص من سياسات غير عادلة.
ثـم إن «الساخطين» مـا لبثوا أن ألهمـوا بدورهم «احتلالات» كثيرة أُخرى. وسرعان مـا امتدت حركتهم لتشمل مجمل إسـبانيا والبرتغال؛ ثـمّ لتجـد صدًى لها في اليونان، إذ جاءت تعزّز وتكمّل التعبئات النقابية. وهكذا فإن «احتلال» سـاحة «سينتاغما» في قلب أثينـا، كان يشـرِك النقابات والأفـراد القريبين من دوائر «الساخطين»، في مجابهة غالبًا ما تكون متوترة. وفي الخـريف كانت الحـركة تمتـد وتتجدّد في الوقت عينه، مع احتلال متنزه «زوكوتي» في جنوب مانهاتن الأميركية، وهـو «الاحتلال» الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة. كانت الحركة تمتـدّ عبر حركة «احتلوا وول سـتريت» بدءًا من 17 سبتمبر 2011م، ومنها إلى العالم الأنغلو- ساكسوني بشكل مركّز. وهكـذا فإن عدد مخيمات «الاحتلال» في خريف عام 2011م، كان يصل إلى بضع مئات، موزّعةٍ على أكثر من ثمانين بلـدًا مختلفًا. غير أن عمر الواحد من الغالبية العظمى من هذه التخييمات، لم يطل أكثر من بضعة أسابيع. وفي ليلة باردة من ليالي أواسط نوفمبر 2011م، طـرد البوليس آلاف الأشـخاص الذين كانوا يخيّمون على بضع خطوات من بورصة نيويورك. أما الساخطون فإنهم، من جهتهم، كانوا قـد قرّروا وقف مخيّماتهم منـذ شهر يونيو. وهكذا فإن قلّةً من «الاحتلالات» اسـتطاعت أن تتواصل إلى ما بعد عام 2011م، باستثناءٍ «احتلال» واحد مرموق، هـو الذي شهدته مدينة هونغ كونغ الكبرى واستمر متواصلًا حتى أغسطس من عام 2012م. غـير أن نهـاية «الاحتلالات» لم تكن تعني نهاية الدينامية الفكرية والسياسية عمومًا التي ولَّدتها سلسلة تلك الحراكات. فلقـد واصلت هذه الانتفاضات التمرديّة توسّـعها عبـر العالم، لتندلع في كيبيك (كندا)، وفي تركيـا، وفي البوسنة، وتجد كذلك صداها يتردّد في تعبئاتٍ ذات شكل مختلف في التشيلي، أو حتى في البرازيل. ثم إن «حراك هونغ كونغ»، اسـتؤنف على نحـوٍ أوسع وأكثف في عام 2014م، أي بعد ثلاثة أعوام كاملة من يوم انطلاقة حركة «احتلوا وول ستريت»، بحيث إنهـا لا تتجاوزه بيوم ولا تستبقه بيوم. غير أن عام 2015م بدا كأنّه يسجّل تغيّرًا مـا؛ ذلك أن الانتصارين الانتخابيين اللذين حققهما حـزبا سـيريزا في اليونان، وبوليموس في إسـبانيا، سيضعان جملة الممارسات والمطالبات المنبثقة عن هـذه المجـرّة المتغايرة العناصر، تحت امتحان السلطة واختبار السلطان؛ وينبغي القول: إن قدرة هذه الحركات على أن تزن بوزنها وتنيخ بثقلها على نحـوٍ مستديم، سياسيًّا واجتماعيًّا، هـو أمـرٌ يبعث على التساؤل والاستفهام.
نعوم تشومسكي وتعاليمه
أول المفكّرين والفلاسفة الأميركيين البارزين الذين آزروا حراك «الربيع الأميركي»، ممثلًا بحركة «احتلوا وول ستريت»، كان نعوم تشومسكي (مواليد 1928م) الذي رأى أن حركة «احتلوا»، تشكّل تطورًا مثيرًا جدًّا، «إذ لم يسبق أن حدث أمر مشابه يمكن أن يخطر على بالي. وإذا أمكن تعزيز الروابط والاتحادات الناتجة عن هذه الأحداث المميزة، في سياق المدة الطويلة والقاسية أمامنا، فسيتبيّن أنها لحظة تاريخية حقًّا، وذات دلالة بالغة في التاريخ الأميركي». وفيما يشبه النداء السياسي الموشّح بأسلوب أدبي، نقرأ على غلاف الكتاب الذي صدر لتشومسكي في بيروت تحت عنوان: «احتلوا.. تأملات في الحرب الطبقية والتمرد والتضامن» (شركة المطبوعات الشرقية): «استيقظوا وخَرَجوا إلى الشوارع.. سدّوا الجسور وأقفلوا المرافئ.. عسكروا في الريح والمطر والثلج.. وواجهوا الغازات المسيّلة للدموع ورذاذ الفلفل والقنابل الصاعقة والأصفاد والسجون». وفي هذا الكتاب الذي نفدت نُسَخُه من المكتبات اللبنانية، ويجري طبعه حاليًّا للمرة الثانية، يجيب تشومسكي عن الأسئلة الملحّة من خلال محادثات ومناقشات مع أنصار حركة «احتلوا»: لماذا يحتج الناس؟ كيف يؤثر واحد في المئة من المواطنين في 99 في المئة؟ كيف يمكن فصل المال عن السلطة؟ ما حقيقة الانتخابات الديمقراطية؟ كيف تتحقق المساواة؟ ومن ينقذ أميركا من حيتان الاحتكار؟ مقطع القول، يَعُدّ تشومسكي «احتلوا» حركة عظيمة؛ لكونها امتدت في العمق الأميركي، وحظيت بكثير من التعاطف مع أهدافها وغاياتها. وهي تحتل، في الواقع، مراتب عليا في استطلاعات الرأي؛ لكن عليها –في رأيه– «أن تصبح أكثر فأكثر جزءًا من حياة الناس اليومية، لا لشيء إلّا لأنها تحمل همومهم وطموحاتهم المستقبلية في المزيد من العدالة والحقوق المدنيّة على اختلافها».
ويعتقد أن واحدًا من الإنجازات الحقيقية لحركة «احتلوا»، هي في تنميتها لمظهر مجتمعي غيري، إيثاري بامتياز. فالناس المنخرطون في الحراك، لا يقومون بذلك من أجل أنفسهم، بل من أجل بعضهم، ومن أجل المجتمع الأكبر والأجيال المقبلة. وتحوّل تشومسكي إلى عرّاب رائد في نصح الأجيال «الربيعية» الأميركية الجديدة، يرشدهم، حتى في المسائل الأمنية والإجرائية على الأرض. سأله أحد أفراد الحراك: ماذا يسعني أن أفعل إذا ما تعرّضت لعملية توقيف؟.. أجابه: «اكتبْ رقم هاتف النقابة على معصمك أو على رسغ قدمك، واتصل به إذا ما تعرضت للتوقيف، أو شاهدت عملية توقيف. احمل في جيبك أرباعًا مالية معدنية لإجراء المكالمات، وبطاقة هاتفية للاتصالات البعيدة». وعن سؤال: «ماذا أفعل إذا ما أُوقِفتُ فعلًا؟» أجاب: «أنصحك بأن تعلن بوضوح: سألتزم الصمت.. أريد التحدث مع محامٍ فقط. كرّر الأمر لأي ضابط يستجوبك. لا تصدّق كل ما تقوله الشرطة، فمن المشروع للشرطة أن تكذب عليك لدفعك إلى الكلام». ويسأله سائل: «ماذا لو لم أكن مواطنًا أميركيًّا وأوقفتني الشرطة؟»، فيردّ تشومسكي: «يحمل الأمر هنا مخاطر أكبر. تحدّث مع المحامي قبل النزول إلى الاحتجاج؛ واحمل معك دائمًا اسم أحد محامي الهجرة ورقم هاتفه. واحمل معك أيضًا أي أوراق هجرة قد تملكها، مثل البطاقة الخضراء، أو تأشيرة «آي – 94» أو إجازة العمل». وفيما يرى تشومسكي في حركة «احتلوا وول ستريت» ردًّا كبيرًا على ثلاثين عامًا من إطباق السوبر أغنياء على الفقراء، في حرب طبقية لا مثيل لها في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، يخلص إلى أن هذه الحركة «لن تموت، بل ستظلّ هاجس الجميع في الولايات المتحدة، من سياسيين واقتصاديين ومفكرين وأدباء وفنانين، ولعلّها تشكّل فاصلة زمنية ذات طاقة فلسفية إيحائية برعت في إحلال الرؤية محلّ الأداة التي شكّلتها». كما يرى أنها تشكّل تحوّلًا فكريًّا وسوسيولوجيًّا داخل أميركا والغرب كله، وعلى علماء الاجتماع الثقاة تلقفه، وتحليل نتائجه في العمق.
خطيب «الثورات» مايكل مور
أما الكاتب الأميركي جاك هيلبور ستيم، فيرى أن حركة الاحتجاجات الأميركية الكبرى في وول ستريت وواشنطن ولوس أنجلس وبوسطن، كانت نتيجة تراكميّة لما سبقها من انتفاضات في ضواحي لندن في الثمانينيات من القرن الفائت، التي تخللتها أعمال نهب وحرق وتخريب للممتلكات العامة والخاصة؛ لكن التأثير الكبير لحركة «احتلوا» بانتفاضات تونس ومصر كان أقوى، واكتسب أبعادًا أخلاقية وثقافية مغايرة، بحيث تحوّل المنتفضون الأميركيون إلى ناشطين سلميين، لا يتوخّون إلّا العدالة الاجتماعية، وتصحيح السياسات الضريبية وبأساليب قانونية، جذبت عموم أنظار الجمهور الأميركي. وخلص إلى أن الثورات الحقيقية، حتى لو لم تنجح، هي التي تعترف تلقائيًّا بغيرها، بوصفها حافزًا لها على التكامل. وهذا ما حاولت فعله الانتفاضات الأميركية محاكاة لميادين تونس ومصر. ويخلص هذا المفكّر الأميركي إلى أن الاحتجاجات في الولايات المتحدة والعالم على توحّش رأس المال، غيّرت من أفكار الجميع، وخصوصًا السياسيين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع، إضافة إلى الأدباء والشعراء والفنانين. ومن فرط هذا التغيّر الحاصل، بات لا أحد في أميركا يجرؤ على مناهضة المحتجّين الساخطين، بل تقاطر  الجميع إلى تأييدهم، حتى رجال الدين؛ فهناك، مثلًا، أكثر من 350 رجل دين أميركي أعلنوا تأييدهم «للربيع» الأميركي، واستطرادًا الغربي كله.
الجميع إلى تأييدهم، حتى رجال الدين؛ فهناك، مثلًا، أكثر من 350 رجل دين أميركي أعلنوا تأييدهم «للربيع» الأميركي، واستطرادًا الغربي كله.
يعدّ مايكل مور نجم حركة «احتلوا وول ستريت» وخطيبها الجريء في حديقة «زوكوني» النيويوركية؛ إذ أعلن انضمامه إلى صفوف المحتجّين و«المضي معًا لصناعة التاريخ الجديد». فلقد حان الوقت من وجهة نظر مايكل مور، المخرج السينمائي الكبير، والحائز جائزة الأوسكار، «إلى ضرورة إحداث التغيير، ورفض الاحتكارات الكبرى، ممثلة ببنوك وول ستريت، وبعض الشركات الكبرى، ممن لها التأثير الكبير في توجيه بعض السياسات الكبرى للـ«الإستبلشمنت» الأميركية». ومما قاله مايكل مور في مخيم الاعتصام الشعبي لحركة «احتلوا أوكلاند»: «الشعوب هي التي تنتفض الآن، رافعة لافتات تشكر تونس ومصر. فما يجري في العالم اليوم، ليس ثورات متعدّدة، بل ثورة واحدة ممتدة عبر مختلف القارات. ويجب ألّا نستهين بهذا الذي يجري، فهو أكبر مما نتصوّر، وأوسع مما ندرك. إنه دعوة جادة لنسف ما هو قائم، ورفض كل سياسات العداء بين الشعوب التي تستغلها فئة قليلة، لا ترى إلّا مصالحها فقط». ويردف مشيرًا إلى فضل الانتفاضات العربية بعد: «أرى هنا ضرورة أن ندرك أننا في وسط حراك عالمي لا عربي فقط، وإن كان للعرب فضل البدء به على هذا النحو غير المسبوق في التاريخ الحديث».
أحد المارة من جانب الخيمة الإعلامية في حديقة زوكوني، سأل أحد الناطقين الإعلاميين من حركة «احتلوا وول ستريت»: ما أهدافكم؟ ماذا تريدون؟ فكان الجواب: «نحن ندافع عن أميركا ومستقبل أميركا. أميركا هي لمواطنيها جميعًا». وأجاب ناطق إعلامي آخر عن السؤال عينه: «أجل لن نتوقف عن «احتلال» اقتصادنا. نحن الشعب، والاقتصاد الذي ينظّم حياة هذه البلاد هو اقتصادنا. هو اقتصادي واقتصادك واقتصاد الجميع، بمن فيهم الذين يخرّبونه من جماعة البنوك؛ ونحن نريد أن نردعهم؛ لأنهم يخرِّبون، ليس اقتصاد أميركا فقط، إنما أميركا نفسها. ليس من حق أحد أن يتّهمنا بالسعي لتخريب الأمن والاستقرار في بلادنا. نحن من يدعم، بحراكنا هذا، استقرار أميركا وأمنها ورفاه شعبها».
الملياردير الفيلسوف و«ربيعه» المفتوح

جورج سوروس
بالتأكيد يختلف «ربيع الغرب» عن «ربيع العرب»، الذي تحوّل (أي هذا الأخير) إلى كابوس دموي في نظر كثرة كاثرة من النخب العربية، ومن بعض الأحزاب والتيارات والتكتّلات الشعبية العربية، التي باتت تتمنّى أن تتجاوز عتمته الراهنة إلى غير ما رجعة؛ فيما «الغرب النيوليبرالي»، وبحسب المفكر والناشط الأميركي المعروف كورنل وست (اعتقلته الشرطة الأميركية ثم أطلقت سراحه) سيستفيد من دروس «ربيعه الخصوصي»، وإن ببطء، حتى لا ينغلق زمن بدايات تصدّعه عليه من الداخل، ويخنقه، حتى وهو في عزّ قوته وجبروته. غير أن هذا لا يعني، وفق استنتاج كورنل وست نفسه، أن أميركا ليست مهدّدة من داخلها، أو أن مستقبلها آمن في ظلّ استمرار السيطرة المطلقة لأباطرة التروستات المالية الضخمة ومنظّريهم من الليبراليين الجدد، الذين هم موضع شكوى، حتى من كبار المليارديريين الأميركيين، من طراز رجل الأعمال الكبير جورج سوروس (يحمل شهادة دكتوراه في الفلسفة)، ومغنّي الراب كانييه ويست، الذي تتجاوز ثروته الـ90 مليون دولار، والممثلة سوزان ساراندون، التي تفوق ثروتها المئة مليون دولار، وقد زاروا جميعًا جمهور حركة المعتصمين في نيويورك وواشنطن ولوس أنجلس (كلّ على حدة طبعًا) وأعلنوا تضامنهم معهم، وحذّروا السلطة المركزية الأميركية، على المديين القريب والبعيد، من عدم تلبيتهم لمطالبهم، وقال جورج سوروس بالحرف الواحد: «أنقذوا الحرية في أميركا التي يشوّهها بعض مدّعيها من جماعة الكارتيلات المالية الضخمة، الذين لا ينشغل ذهنهم العام، ويدور، إلّا على هاجس المال والربح كيفما اتفق، حتى لو تهدّم الهيكل عليهم هم قبل غيرهم.. أميركا بحاجة الى رأسمالية متوازنة، منفتحة وعادلة، تعطي الحقوق للآخرين قبل أن تأخذ هي حقها، وتحافظ، بالتالي، على استمرارية هذا الحق».
والطريف أن جورج سوروس، الذي صنّفته مجلة «فوربس» الأميركية في المرتبة الـ27 لأغنى أغنياء العالم عن السنة 2014م، وتقدّر ثروته بـ26 مليار دولار، هو الذي تصدّى ويتصدّى لتوحّش زملائه الأثرياء، ليس في الولايات المتحدة فقط، إنما في العالم أجمع؛ ولقد أعطاهم، ويعطيهم كل يوم الدروس تلو الدروس، خصوصًا لجهة إنفاق المال الوفير على أعمال الخير المختلفة، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، تخصيص منح للطلاب المعوزين داخل الولايات المتحدة وخارجها. وتقدّر شبكة التلفزة الأميركية pbs مجموع ما أنفقه جورج سوروس على أعمال الخير حتى الآن، بحوالى الـ3 مليارات دولار. من جهة أخرى، كان سوروس، ولا يزال، يستخدم لعبة المال السياسي، وبشكل علني في الولايات المتحدة؛ فلقد أنفق، مثلًا، وبحسب أكثر من وسيلة إعلامية أميركية، ملايين الدولارات للحيلولة دون إعادة انتخاب جورج بوش الابن لولاية رئاسية ثانية في عام 2004م (وقتها أمام المرشح الديمقراطي جون كيري)، وهو اليوم يُعَدّ أحد أبرز الذين وقفوا وراء الاحتجاجات التي عمّت شوارع المدن الأميركية الكبرى عشية فوز دونالد ترمب بكرسي البيت الأبيض. وقد وجّهت لسوروس التهم العلنيّة والمباشرة، بأنه هو وراء هذا الحراك الشعبي الأميركي الساخط.. تخطيطًا وتمويلًا وتحريضًا. أما لماذا؟ فلأنه وجد ويجد في رئاسة ترمب خطرًا على حاضر الولايات المتحدة ومستقبلها، وبخاصة لجهة آخر ما تبقى لها من حيّز ريادي للعالم، الذي لا يزال ماثلًا على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية حتى اليوم.
ولقد انطلق الملياردير الفيلسوف سوروس من أفكار وتحليلات شخصية تلخّص رؤيته للأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية حوله، ودَمَج، هكذا، خلاصاتها في رؤية ذات أبعاد فلسفية، تقرّ بأن المعرفة، واقتصاد المعرفة، هما وحدهما يشكّلان القوة الحقيقية لثبات الأمم، وذلك إذا ما أرادت الأمم القوية أن تستمر وتحيا بثبات مع الزمن. ولا غرو، فسوروس الذي وصف نفسه بـ«الفيلسوف» و«صانع السياسة العالمية»، كان قد ألّف العديد من الكتب، من أبرزها: «كيمياء المالية القديمة»- 1988م، و«خرق النظام السوفييتي»- 1990م، و«المجتمع المفتوح: إصلاح الرأسمالية العالمية»- 2000م، و«تصحيح إساءة استخدام القوة الأميركية»- 2005م، و«عواقب الحرب على الإرهاب»- 2006م … إلخ. وهو من المعجبين جدًّا بالباحث والمفكّر الأميركي بيتر فردناند دراكر، الذي يميل إلى تقطيع الصيرورة التاريخية، حيث يشير في كتابه: «مجتمع ما بعد الرأسمالية» (صدر في عام 1993م) إلى أنه تقريبًا في كل خمسين أو ستين سنة، يحدث في سياق التاريخ الغربي انفصال يصل إلى حدّ تغيير النظرة إلى العالم، وتبديل القيم الأساسية والنظم الاجتماعية والآداب والمؤسّسات فيه، إلّا في الولايات المتحدة التي لا تعرف، حتى الآن بنظره، سوى أن تعيد إنتاج تغوّل رأسماليتها الجشعة على نحو مُنفِّر وطارد للمشروعيات على اختلافها، وأنه آن الأوان لواشنطن أن تحسن قراءة المنعطفات الكبرى في التاريخ وتستفيد من انهيارات الأمم الكبرى التي سبقتها، وإلّا فإن السقوط الكبير ينتظرها وبأسرع مما يُتصوّر.
الثورات العربية والغرب
هكذا سيظلّ عام 2011م بطبيعة الحـال، عامـًا مميّزًا في تاريخ الصراعات الاجتمـاعية: من تونس إلى الولايات المتحدة، مـرورًا بإسـبانيا والبرتغال واليونان، وكذلك آيسـلندا والتشيلي. فهو يسجّل في الواقع العودة الكاسـحة للشقاق والتنـازع الاجتماعي؛ غير أن العصف المنبعث من التعبئات والاسـتنفارات التي سارعت بـ«فسطاطي» بن علي ومبارك، دام واستمر بدلًا من أن يخمد. بعد ذلك بخمس سنوات، عرفت هذه التجارب مصاير مختلفة. فبعد الانتصارات الانتخابية التي حققها حزبا سيريزا في اليونان وبوديموس في إسبانيا، التي نتجت عن التعبئات والاستنفارات التي ظهرت بعد الأزمة المالية الأميركية – 2008م و«الثورات العربية»، فإن عام 2015م، كان عام انتقال هذه الحركات إلى مراكز المسؤولية المؤسّساتية، وقد مهّدت إلى ذلك كله، ورافقته خطابات فكرية وأدبية وفنية لا تحصى، سمّاها الناقد الإيطالي جوليانو دي بينو بـ«الإبداع الفوري الحر والمتحرّر من تقليد كل المرجعيات الأدبية والنقدية التقويمية السائدة».
وعلى الغرب، وبالتحديد الولايات المتحدة أيضًا.. وأيضًا – كما نستنتج من جورج سوروس- أن يشكر في المحصلة «الثورات العربية» في براءتها الأولى في تونس ومصر؛ لأنها شكّلت جرس إنذار له؛ كي يراجع، وجذريًّا، سياساته الاقتصادية (وبخاصة المحليّة منها) الآيلة إلى ضربه هو من داخل، قبل أي عامل آخر. وما الأزمة المالية التي عصفت بأميركا في عام 2008م إلّا الشاهد الأبلغ على ذلك، ثم جاءت حركات الاحتجاج الصاخبة في عام 2011م لتضع هذا البلد الأول في الغرب والعالم على المحكّ الخطير، ومن ثَمَّ تدفعه للعودة إلى المنطق الديكارتي الذي أسّس لسياسات الغرب العقلانية في حدودها الصارمة والقصوى.


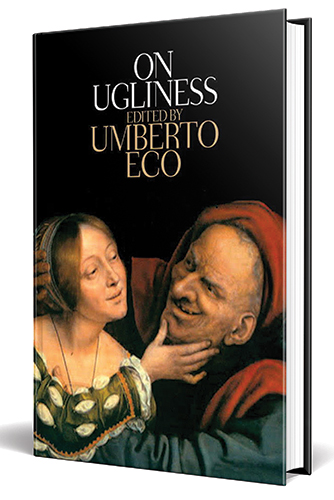 ويستطرد إمبرتو إيكو معلقًا: «إن من يستقي الاستنتاجات الخاطئة من مقدمة منطقية مقبولة إلى حد ما، ليس مجرد «رفيق أخطأ التفكير»؛ وإذا قال أحد رفاقي في الفصل الدراسي: إن الشمس تدور حول الأرض، أو إن اثنين زائد واحد يساويان خمسة، فلن أعده رفيقًا أخطأ التفكير، بل سأعُدّه غبيًّا». وبخصوص مصطلح «المؤامرة» الذي كان على ما يبدو سائدًا في الأدبيّات السياسيّة القديمة، مثلما هو سائد في الأدبيّات السياسيّة الحديثة، فلقد تناوله إمبرتو إيكو في مقالة ساخرة نشرتها الـ«نيويورك تايمز» في عام 2008م. ورد فيها أنه، وبعد تصفّحه موقعًا للإنترنت باللغة الفرنسية، واسمه «عالم اليسوعيين المريض» لـ«جويل لابرويير»؛ وكما يوحي به العنوان، يقدم هذا الموقع مراجعة واسعة للأحداث كافة، التي انطلقت من مؤامرة عالمية رسمها أعضاء جماعة اليسوعيين الدينية. فلطالما «جهد اليسوعيون نحو تأسيس حكومة عالمية عبر التحكّم بالبابا وبعدد من الأمراء الأوربيين. ومن خلال جماعة المتنوّرين من إقليم بافاريا الألماني، حاولت «جماعة يسوع» الدينية إسقاط الأمراء الذين حظروا وجودها. ليس هذا كل شيء، يتابع إيكو: «فأعضاء جماعة اليسوعيين الدينية هي من أغرق سفينة «تيتانيك»؛ لأنه بداعي هذه الحادثة تمكنوا من تأسيس مصرف الاحتياط الفدرالي الأميركي وبوساطة من فرسان مالطا». ويشدد محرِّرو موقع «العالم المريض» على أن غرق سفينة «تيتانيك» لم يؤدّ بالمصادفة إلى وفاة اليهود الثلاثة الأغنى في العالم: جون جاكوب آستور الرابع، وبنجامين غوغنهايم، وإيزيدور شتراوس، الذين عارضوا في ذلك الوقت تأسيس المصرف. وبالعمل من خلال الاحتياطي المركزي، تمكّن اليسوعيون من تمويل الحربين العالميتين اللتين صبّتا في مصلحة الفاتيكان دونما شك.
ويستطرد إمبرتو إيكو معلقًا: «إن من يستقي الاستنتاجات الخاطئة من مقدمة منطقية مقبولة إلى حد ما، ليس مجرد «رفيق أخطأ التفكير»؛ وإذا قال أحد رفاقي في الفصل الدراسي: إن الشمس تدور حول الأرض، أو إن اثنين زائد واحد يساويان خمسة، فلن أعده رفيقًا أخطأ التفكير، بل سأعُدّه غبيًّا». وبخصوص مصطلح «المؤامرة» الذي كان على ما يبدو سائدًا في الأدبيّات السياسيّة القديمة، مثلما هو سائد في الأدبيّات السياسيّة الحديثة، فلقد تناوله إمبرتو إيكو في مقالة ساخرة نشرتها الـ«نيويورك تايمز» في عام 2008م. ورد فيها أنه، وبعد تصفّحه موقعًا للإنترنت باللغة الفرنسية، واسمه «عالم اليسوعيين المريض» لـ«جويل لابرويير»؛ وكما يوحي به العنوان، يقدم هذا الموقع مراجعة واسعة للأحداث كافة، التي انطلقت من مؤامرة عالمية رسمها أعضاء جماعة اليسوعيين الدينية. فلطالما «جهد اليسوعيون نحو تأسيس حكومة عالمية عبر التحكّم بالبابا وبعدد من الأمراء الأوربيين. ومن خلال جماعة المتنوّرين من إقليم بافاريا الألماني، حاولت «جماعة يسوع» الدينية إسقاط الأمراء الذين حظروا وجودها. ليس هذا كل شيء، يتابع إيكو: «فأعضاء جماعة اليسوعيين الدينية هي من أغرق سفينة «تيتانيك»؛ لأنه بداعي هذه الحادثة تمكنوا من تأسيس مصرف الاحتياط الفدرالي الأميركي وبوساطة من فرسان مالطا». ويشدد محرِّرو موقع «العالم المريض» على أن غرق سفينة «تيتانيك» لم يؤدّ بالمصادفة إلى وفاة اليهود الثلاثة الأغنى في العالم: جون جاكوب آستور الرابع، وبنجامين غوغنهايم، وإيزيدور شتراوس، الذين عارضوا في ذلك الوقت تأسيس المصرف. وبالعمل من خلال الاحتياطي المركزي، تمكّن اليسوعيون من تمويل الحربين العالميتين اللتين صبّتا في مصلحة الفاتيكان دونما شك.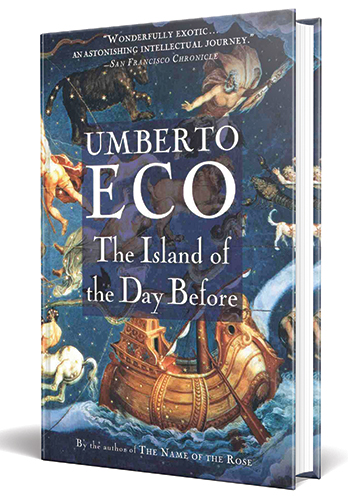 أما بخصوص إسرائيل، فإن إمبرتو إيكو، وإن كان ينتقد بعض سياساتها، خصوصًا لجهة قوله، وأكثر من مرة: إن مصطلح «معاداة السامية» مملوء بالتناقضات، إلا أنه في حقيقة الأمر، كان حتى آخر يوم من حياته، من أشد المدافعين الأذكياء عن إسرائيل. وقد استفزّ الكثير من قرائه العرب، وبخاصة الفلسطينيين منهم، عندما أصرّ على المشاركة في «معرض القدس للكتاب» في عام 2011م، ملبِّيًا دعوة بلدية الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة، وذلك بعدما ضرب عرض الحائط بكل مناشدات قوى المقاطعة الثقافية والأكاديمية للدولة العبرية، التي طلبت منه عدم تلبية هذه الدعوة.
أما بخصوص إسرائيل، فإن إمبرتو إيكو، وإن كان ينتقد بعض سياساتها، خصوصًا لجهة قوله، وأكثر من مرة: إن مصطلح «معاداة السامية» مملوء بالتناقضات، إلا أنه في حقيقة الأمر، كان حتى آخر يوم من حياته، من أشد المدافعين الأذكياء عن إسرائيل. وقد استفزّ الكثير من قرائه العرب، وبخاصة الفلسطينيين منهم، عندما أصرّ على المشاركة في «معرض القدس للكتاب» في عام 2011م، ملبِّيًا دعوة بلدية الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة، وذلك بعدما ضرب عرض الحائط بكل مناشدات قوى المقاطعة الثقافية والأكاديمية للدولة العبرية، التي طلبت منه عدم تلبية هذه الدعوة.
