أعني بالأصالة الفاعلية المنبثقة عن ذات فردانية نقية، خالصة، صافية، مستعدة لإنجاز أفعال فكرٍ أو عملٍ مشخصة موافقةٍ لأحوالها القاعدية العميقة المتفردة، المتواصلة مع منابع وعناصر الإثارة الخارجية المختلطة المعززة لتركيب متجاوز مبدع. والأصالة تفترض، فيما فوق مواضعات الامتثال الاجتماعية، التعبير القوي عن حقيقتها الذاتية الباطنة العميقة بأمانة وحقيقة وصدق ومسؤولية. وحين تُجري الأصالة أحكامها خارج حدود القيود والشروط القسرية الوضعية، وحين تنقل (الذات القاعدية) ملكاتها من القوة إلى الفعل تولّد ما ندعوه «الإبداع»، أي «ما هو فذ». إذ الإبداع مقترن ضرورةً بهذا «الفذ»، أي بالأصالة؛ لكنه ليس الأصالة نفسها. وحين تفتقر الذات الفردانية إلى القدرة على الفعل، أو تتلبسها أحوال وعوارض «غير نقية» وتستبد بها عوامل الهدم الداخلي أو رياح الخارج الضاربة، تقع في الاستلاب وفقد القيمة والمعنى والتكرار والضحالة، وتصبح «عادية»، «تافهة»، مؤذنة بالاضمحلال والبوار.
تكشف الأصالة عن نفسها في الأفعال أو الأعمال الجديدة المخترعة، وفي المبدعات الروحانية الفذة، وفي الإسهام المشخص في فعل (التقدم) الحي الروحي والمادي والصناعي والعلمي والتقني والإداري..، وفي إثراء الكينونة الإنسانية، الفردية والجمعية، بالمعرفة، والمتعة، والفائدة، والحركة، والنشاط والتغير الواعد. والأصالة تتقوم بالحرية؛ إذ هي خروج عن المألوف القائم، المتداول، المبذول، واقتران بالإبداع والتجديد والكشف والإقدام، وتوليد للدهشة والانبهار، وللرائع، والمبدع والسامي.
في التجربة العربية التاريخية التي نعرفها، وفي أشكالها السارية في الفكر والدين والسياسة والفن والأخلاق والعلم – النظري والتطبيقي والأداتي – نلتقي نماذج لا عد لها ولا حصر من وجوه الأصالة الكاشفة عن وضع حضاري حي، لكننا نلتقي أيضًا وجوهًا من «مضادات الأصالة». جسدت «الظاهرة القرآنية» وما اقترن بها من «ثورة ثقافية» فعلًا أصيلًا من أفعال «الأنا الفردية» المتضافرة مع «الأنا الجمعية». الانقلاب السياسي الأموي قبالة (عصر النبوة والخلافة) كان فعلًا أصيلًا من وجه، بائسًا مجسدًا للأنا القبلية المشبعة بالإغراءات الدنيائية الخائنة للإيتوس الأخلاقي – الديني، من وجه آخر. في الحقل الفكري الاعتقادي أعلنت الأصالة عن نفسها في (ثورة العقل) على التقليد والاتباع وفي فتوحات الحرية والاستقلال الفكري التي تبلورت في مبدأ (العدل) الاعتزالي، وفي استئناف الفاعلية العقلية والعلمية الهلّينية والهلّنستية في الحركة الفلسفية. ومع أن هذه الحركة في الإسلام تمد جذورها القوية في التراث الإغريقي وتكاد توهم بأنها لم تضف شيئًا ذا بال إليه، إلا أن النظر المدقق يُبين إبانة قاطعة عن مظاهر الإبداع الفلسفي الإنساني الأصيل في ثلة من قضايا الوجود والأخلاق والنفس، فضلًا عن التطورات الجليلة التي حفل بها (العلم العربي).
وفي الفضاءات الأدبية يدهشنا التجديد الشعري في العصر العباسي، وتبهرنا النظريات النقدية والشعرية والإعجاز.. في المشرق وفي المغرب (إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب). وكذلك يثير إعجابنا الشديد في حقل الفقه وأصوله نجوم «نظرية المقاصد». وفي أقصى مراحل الانهيار والأفول يستنبط ابن خلدون فلسفته المبتكرة في العمران البشري. فلسفة وضعية عظيمة، أصيلة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ ودلالات، تنجم في «العصر السحريّ» المضاد للعلم والعقل والإبداع، المستغرق في النارنجيات والطلسمات والمكرور من الشروح والتصانيف.. قد جفت الدماء في العروق وانطفأت الأنوار وساد العقم… أي «اللا- أصالة»، بعد أن كانت الأصالة قد أعلنت عن تفجّرات حقيقية امتدت طيلة عصور الحضارة العربية الكلاسيكية.
تلك أمثلة ووجوه شاردة ودالة أسوقُها لأتحول منها إلى التنبيه على ما طال «مثال الأصالة» في التجربة العربية الراهنة. حتى لا يكون القول مرسلًا بلا حدود، سأنحصر، في حدود هذا القول، في الإبانة عن حال «الأصالة» في أكثر القطاعات التصاقًا واقترانًا بالفعل الثقافي؛ لأن هذا المفهوم يطول قطاعات كثيرة أخرى: في السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والعلم، والتقنية، والإدارة.. أقول: إنني سأنحصر في حدود «الثقافي»؛ لأنه يمثل الأسس القاعدية لجملة البنى والنظم التي تتقوم بها (المدينة) و(المجتمع) و(الدولة)، و(الحضارة)، وفوق هذا كله، وقبله وبعده: الإنسان.
مضادات الأصالة

جيل دولوز
لكن الإبانة عن «مضادات الأصالة» تظل ضرورية من أجل تقييم أحوال «الأصالة» التي أطلب وأقدّر أن هذا القول يمثل «دعوة» أريد أن أراها جارية في منتجاتنا الثقافية القابلة، و«مديحًا» أريد أن أسبغه على هذه «الفضيلة» الركنية التي سأقول: إنها باتت غائضة الملامح إن لم أقل مفقودة أو شاردة ضائعة. ثلاثة أعراض رئيسة تحدد في اعتقادي ما أعدّه «مضادات للأصالة»، هي: التقليد، والتكرار، والتفاهة، تتضافر لمقاومة «الفذ» «أي الذي لا مثيل له». وحيث يشخص أي عرض من هذه الأعراض أقول: إننا في حالة مضادة للأصالة. يمثّل التقليد، من وجه أول، استبداد الاتباع والانقياد والسكون والجمود. ويشخص التكرار بما هو مراوحة في المكان أو جهد مجاني عابث لا معنى له ولا قيمة، معوق لحركتي التقدم والتطور الضروريين لحياة المجتمع ومعناه وقيمته في التاريخ. وتشخص التفاهة بما تحمله من «تَدلٍّ أخلاقي» أكثر الأعراض «المرضية» القاتلة للحرية والمعنى والإبداع والقيمة. حين «تتضافر» مضادات الأصالة هذه في جسم الثقافة وروحها لا يتبقى للثقافة وأهلها أي مقوّم من مقوّمات الوجود الحي الجدير بالتقدير والاحترام والتكريم.. والحياة.
الفكر والمعرفة والأدب واللغة والفن والقيم هي الوجوه المركزية للثقافة التي تتجلى فيها أو تضمحل أعلام الأصالة ورسومها «الروحية». وبقدر ما تكون هذه الرسوم جليّة، قوية، حيّة، فاعلة في الاجتماع البشري، تكون قواعد هذا الاجتماع العلمية والتقنية والإدارية والتنظيماتية والاقتصادية والاجتماعية والمادية.. قوية، حيّة، معززة لأسباب التقدم ودواعيه. إطاري المرجعي التاريخي، في عدِّي هذه الوجوه من الحياة الثقافية العربية، يمتد، بقدر عظيم من التجريد والتكثيف – وفق ما تقتضيه حدود هذا القول – ما بين الفضاء الذي ندعوه (عصر النهضة) العربي الحديث، وبين هذه العقود المتأخرة التي نحياها في الفضاءات العربية الممتدة المتباينة الشاهدة.
المعرفة والفكر أولًا
وفي حدود معاني ومقومات «مثال الأصالة»، أعني: الفاعلية الذاتية القاعدية «الطّبْعِية»، والإبداع، والحرية، والاستقلال والقيمة، والتمظهرات «الفذّة»، المجاوزة للمتداول وللاتباعيّ..، ما هو تقديرنا – وبتحديد أدق ما هو تقديري.. لحالة الأصالة في هذا الحقل، حقل المعرفة والفكر؟ حين ننعت (عصر النهضة) بأنه عصر «نهضة» فإننا نقرّ، بكل تأكيد، أننا قبالة مثقفين ومفكرين وإصلاحيين تمدنيين وأخلاقيين وأدباء وكتاب بذلوا الوسع من أجل الخروج من التقليد ومن «القائم المستقر»، المتدلّي، بحسب مصطلحهم، وإدراك حالة «الرقي» أو «التقدم». ثمة في جملة أعمالهم، من التركيب بين «المدنيّة الإسلامية» وبين «المدنية الغربية»، ما يشي بقدر ملموس من «التجديد» أو من «الإصلاح» أو من طلب «التميّز النوعي» أو الذاتي الذي يقترن بكل تأكيد بمعنى «الأصالة»، المعززة للترقي وذلك على الرغم من التأثيرات الغربية التي أريد لها أن تشكّل تركيبًا تدخل فيه أفهام «حديثة» للتجربة المعرفية والعلمية العربية – الإسلامية. الفاعلية الذاتية في هذه الجهود بارزة، والحرية تمارس نشاطها بقدر ملموس، والاستقلال الفكري ذو قيود، والاتباعيّ لا يزال حاضرًا بقدر.. أي أن مواضعات الامتثال الاجتماعية لا تزال فاعلة. إننا قبالة أصالة، لكنها «أصالة مقيّدة».
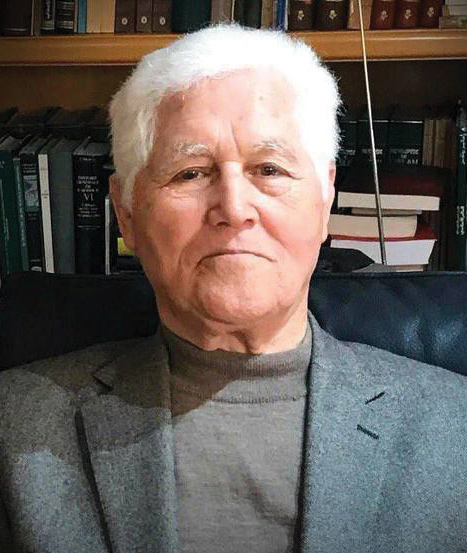
عبدالله العروي
حين نتجاوز عصر النهضة المبكّر ونعبر أعتاب القرن العشرين وعقوده المتتالية تزداد الأحوال والأعراض والرسوم وضوحًا وتميُّزًا ودخولًا في «زمن الأصالة»، وتحولاتها الضاربة في «اللا-أصالة». من المؤكد أن فضاءات المعرفة اتسعت على نحو مذهل، وذلك للتواصل البشري الحديث و«العبور الغربي» وفعل (الحداثة)، والحركة الاستعمارية بأشكالها المختلفة، وفي المرحلة المتأخرة: العولمة. بيد أن «المعرفة» التي تعاظمت وانتشرت في كل الآفاق ظلت رهينة «المبدعات الغربية»، ولم ترقَ إلا بمقادير هزيلة لكي تدرك ناصية الأصالة. لم يظهر ذلك واضحًا جليًّا في فضاءات العلوم الطبيعية والتقنية فقط، إنما تجاوز ذلك إلى عالم الفكر، الذي كانت «المحاولات الفلسفية» أبرز رسومه وتجلياته. ويثير الانتباه والنظر ههنا أن التجربة الفلسفية العربية الحديثة، أعني منها تلك التي تبلورت منذ أواسط القرن العشرين وامتدت إلى أيامنا هذه، تبدو في علائقها مماثلة إلى حد بعيد لتلك التي شهدتها التجربة العربية الكلاسيكية، حيث اقترنت إسهامات الكندي والفارابي ويحيى بن عدي ومسكويه وابن سينا وفلاسفة المغرب إلى ابن رشد، بفلاسفة الإغريق: أفلاطون، وأرسطو، والرواقيين، والأفلاطونية المحدثة، وبدت الأعمال الفلسفية المعاصرة امتدادات للفلسفات الغربية الحديثة: يوسف كرم يتابع التوماوية الجديدة؛ عبدالرحمن بدوي ينسب فلسفته المبكرة إلى هايدغر والوجودية؛ زكريا إبراهيم يمتح من الوجودية الإيمانية؛ محمد عزيز الحبابي يتبنى شخصانية (مونييه) ويحولها إلى شخصانية إسلامية؛ فؤاد زكريا يأخذ بالعقلانية الطبيعية؛ زكي نجيب محمود يتقلد الوضعية؛ حسن حنفي يتمثل أصول الفقه، فينومينولوجيًّا؛ عبدالله العروي يغادر إلى هيغل والتاريخانية.. أركون يتمنطق بمفاهيم العلوم الإنسانية والاجتماعية ويحاول استخدامها في ما يسميه (الإسلاميات التطبيقية)؛ والجابري لا يبتعد كثيرًا من نهجه.. والطيب تيزيني يتقمص الماركسية بعجرها وبجرها… وفوكو ودريدا وجيل دولوز وآخرون ينتشرون في «محاولات» المثقفين «المتجمّلين» بالبنيوية والتفكيكية والهرمينوطيقا وما بعد الحداثة.. ولا يكاد يخرج من هذه الدوائر إلا قلة من المفكرين الذين ينشدون الأصالة الذاتية المستقلة، كناصيف نصار، أو يستأنفون التقليد الفلسفي العقلاني الراديكالي، كعادل ضاهر، أو ينشدون تركيبات فلسفية دينية إسلامية تطلب التفرد كطه عبدالرحمن في نزعته الضاربة في التصوف، أو نصر حامد أبو زيد في توظيفه للتأويلية.
قد تشي هذه المقاربة بأنني أريد أن أذهب إلى إنكار تشخص فلسفات عربية حقيقية، أعني فلسفات عربية أصيلة، في المجال العربي المعاصر؛ وذلك موضع احتجاج؛ إذ يوهم بأنني أفترض أن الأصالة تعني بإطلاق إقصاء كل العناصر «الخارجية» الضاربة في التجربة الأصلية الخاصة، أعني التجربة ذات الطبيعة والأعراض «العربية»! وليس الأمر كذلك؛ لأنه لا ينبغي أن نفترض أن «الأصالة» تنكر مبدأ «التأثر» أو «التواصل» أو «التفاعل» مع العناصر الضاربة من خارج في «قلعة الذات». إنني أعي ذلك كل الوعي، وأعلم أن أصالة أرسطو لم تجبّ تأثير أفلاطون، وأن أصالة ديكارت لم تبدد تأثير القديس أنسلم أو القديس أوغسطين، وأن أصالة توما الأكويني لم تُقصِ تأثير ابن رشد، وأن هايدغر نفسه كان مستغرقًا في الأنطولوجيا اليونانية. لكن الذي أرى أن ما كانت تفتقر إليه أغلبية «المحاولات الفلسفية» العربية المعاصرة، هو أنها لم تقدم، في نهاية المحاولة، ما يتجاوز خالص التركيب «الشكلاني» السكوني، التكراري، إلى رؤى أو منظورات أو تصورات شاملة مبتكرة أو إبداعية خاصة، أي أن «مثال الأصالة» والاستقلال الذاتي الحر المبدع ظل غائض المعالم والرسوم. بتعبير آخر، لا أملك إلا الإقرار بأننا، خلا حالات قليلة جدًّا، نلمس بوضوح أن الفكر الفلسفي العربي المعاصر يفتقر افتقارًا شديدًا إلى «الاستقلال الفلسفي»، الذي شدد عليه من قبل ناصيف نصار. وذلك يعني أنه يفتقر إلى «الأصالة الحقيقية» ولا يحقق منها إلا قدرًا محدودًا.
هل ينسحب هذا التقدير على ما يسمى (الفكر العربي المعاصر)؟ ليس سرًّا أن هذا المصطلح يقال على المنجزات الفكرية التي تمتد من أواسط القرن التاسع عشر إلى زمننا الحالي، وأنه يشار إليه عادة بالتعبير (فكر النهضة). هو فكر، من حيث إنه «نظر إنساني» في مشكلات العالم العربي الثقافية والاجتماعية والسياسية، قبل أي وجه آخر. والمحور الرئيس لهذا الفكر لا يتعلق بقضايا الفلسفة الكلاسيكية كالمعرفة والوجود والإلهيات والطبيعيات، لكنه يدور على قضايا التمدن والترقي أو التقدم والحرية والعدالة والشورى والديمقراطية والأخلاق والتجديد والإصلاح الديني والتحرر من الاستبداد والاستعمار والدفاع عن جملة حقوق الإنسان.. والمواطنة.. والمرأة.. وغير ذلك مما حفلت به أعمال تمتد من خير الدين التونسي ورفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وقاسم أمين وشبلي شميل وفرح أنطون وطه حسين.. إلى مجموعة من المفكرين الفلاسفة أو المتفلسفة الحاليين الذين وجهوا قدرًا من اجتهاداتهم إلى حقل «الفعل الثقافي» الذي يطلب التغيير أو الإصلاح أو الثورة (كتابي: أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث، ط5).
والحقيقة أننا لا نملك أن ننسب هذه الأعمال إلى «القول الفلسفي»، على الرغم من أن هذا (القول) يتدخل فيها من حيث إنه يطلب قدرًا من «العقلنة» التي تضفي على «القول الثقافي» – الجدليّ أو الظني الاحتماليّ وفق المعنى الأرسطي – ضربًا من المشروعية والقبول.
هل توصف هذه الأعمال بما يدور عليه هذا القول؟ أعني: هل هي أعمال «أصيلة»؟ في حدود معاني الاستقلال الفكري، وحرية القول، وصدقية المشاريع المطروحة، وارتباط هذه المشاريع بفاعليات فردانية ذاتية نقية تتوجه إلى ظواهر الوقائع بالتأمل الحر والنظر المدقق والتحليل والعرض والاستشراف والاقتراح، وطلب حلول «إبداعية»، أو «فذة» للقضايا العربية العويصة الشاهدة، في حدود القدرات المعرفية والعملية المتوافرة لدى هؤلاء «المفكرين» أو «المثقفين»، وفي سياق معرفي مُسَيّج بفاعليات ذات روابط عضوية عميقة بالرغبة أو الشهوة أو الإرادة أو المنفعة البراغماتية.. في هذه الحدود جميعًا لا نملك إلا التسليم بأن الماهية والغائية اللتين تقوّمان فكر النهضة العربية الحديثة والمعاصرة، وعلى الرغم من التأثيرات – التي لا مناص ولا مفر منها – الآتية من الرياح الخارجية، أعني من الثقافة الغربية ومتعلقاتها، هما – أي الماهية والغائية – تمدان جذورهما القوية في «مثال الأصالة». ليس أمرًا ضروريًّا أو قطعيًّا أن تكون هذه الأصالة مطلقة، ولا أن تكون خارقة للحدود والآفاق – إذ هي مقترنة دومًا بشروط وضعية نسبية متفاوتة – لكن يكفي أنها تحقق هذا الضرب من الفاعلية الذاتية الفردانية، الممتدة في «الجمعيّ»، التي تطلب اجتراح حلول «خارقة» لأوضاع ومشكلات صدئة قاتلة، ومخارج إبداعية جديدة مجدية لعالم يشكو من آلام القرون المبرحة ويطلب البُرْء من أمراض مزمنة لم تعد أنماط التفكير الاتباعية السكونية الجاهزة قادرةً على أن تقدم له الدواء الشافي.. في هذه الاستحقاقات أستطيع أن أقول: إن تجليات (الفكر العربي الحديث والمعاصر) هي تجليات أصيلة بمقادير متفاوتة، وإنها في جميع الأحوال، وبرغم القصور الذي يعتوِرها، ضرورية حتمية وتستحق الثناء والمديح.
الآداب ولغتها ثانيًا

محمد أركون
تحتل صناعتا الشعر والنثر مكانة أساسية في الظاهرة الثقافية العربية الحديثة، مثلما أنهما يحتلان المكانة العظمى في الثقافة العربية الكلاسيكية. والمكرور من القول هو أن «الشعر ديوان العرب» والمعبّر الحقيقي عن الأصالة العربية في ميدان الأدب، وأن النثر «المبين» قد تجلّى بأنواره الفذة في أدبي الجاحظ والتوحيدي مثلًا، وأن «الخلق» العلمي في مقاربة الشعر والنثر قد أعلن عن نفسه في الفلسفات التحليلية العميقة المستحدثة لنظريات النقد الأدبي الثرية العميقة الجديدة، أي «الأصيلة»: محمد بن سلام الجمحي، والآمدي، وقدامة بن جعفر، والحاتمي، وابن جنّي، والقاضي الجرجاني، والباقلاني، وابن رشيق، وابن شرف القيرواني، وحازم القرطاجني، وآخرون كثيرون. هؤلاء جميعًا أسبغوا على الأدب واللغة والشعر، فقهًا وتحليلًا وتنظيرًا ونقدًا، وهو ما حمل اللغة وآدابها إلى أسمى المراقي والتجليات الفذة. لم يحدث شيء من هذه الآفاق البعيدة والأعماق الثرية في حياة اللغة والأدب الحديثة. ولم ترقَ الجهود النظرية التي بذلت في هذا الحقل إلا بأقدار محدودة من مراتب الإبداع، وذلك على الرغم من أن الحركة الأدبية العربية الحديثة التي تجسدت، على وجه الخصوص، في صناعات الشعر والرواية والنقد، قد بلغت في حالات عدة أقدارًا طيبة من الثراء والجودة والخَلْق.
بيد أن الخشية العظمى هنا تأتي من أن المناهج والمفاهيم الفنية والأدبية والنقدية الغربية باتت توجه وتحكم وتستبدّ بطرائق وأحكام النظريات والمذاهب الأدبية والفنية والنقدية العربية المعاصرة. أي أن «مثال الأصالة» مهدد في الصميم، وأن المنخرطين في الفنون الأدبية واللغوية يبدون عاجزين عن إبداع المناهج الذاتية الحاكمة لفنونهم وآدابهم العربية.
على أن هذا الوجه من القول العارض في أمر الأدب وفنونه، لا ينبغي أن يمضي من دون التنبيه على حال اللغة العربية بما هي أداة للتعبير والاستخدام والإبداع، حيث تقرع أجراس الخطر الحقيقية في شأن لغتنا العربية وما يساق من إشارات ودلائل على مظانّ التهديد الحقيقي لوجودها ولمستقبلها، قبالة الانتشار الواسع الهجوم للغة الإنجليزية في جملة القطاعات الثقافية والفكرية والأكاديمية، فضلًا عن الإقصاء المتعاظم لاستخدامها لدى الصغار والكبار في الحياة اليومية وفي الشوارع والأسواق والمعارض وأسماء المحال التجارية، والإعلانات والنشرات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.. ناهيك عن الإخلال الفاضح بنحوها وصرفها في المذياع والتلفاز، وعن الدعوات الآثمة إلى تحويل التدريس الجامعي في العلوم الاجتماعية والإنسانية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. إننا نفقد يومًا بعد يوم أسباب وآليات الضبط والسيطرة على حياة هذه اللغة، ونشهد، على أنحاء صارخة مروعة، مظاهر الانسحاب والاضمحلال والضعف التي تطولها، ولا نفهم ما الذي يثوي خلف هذا الصمت المريب واللامبالاة الفاجرة التي تبدو صارخة في غياب كامل لدور «الدولة العربية الوطنية»، المزعومة، في حماية هذه اللغة والدفاع عنها وإنقاذها من المصير الكارثي الذي ينتظرها وينتظر متعلقاتها المعرفية والثقافية والعلمية.. والوطنية!
الفن والقيم أخيرًا، وبقول وجيز

فيروز
الحق والجمال والخير، قيم أزلية أبدية أصيلة. نعرف هذا منذ أفلاطون وأرسطو. ونعرف أن كل الحضارات الفذة تعلقت بهذه القيم. ونحن من بين الذين بذلوا الوسع قديمًا في تمثّلها. ومن المؤكد أننا لا نزال على هذا العهد، أو أن علينا أن نظل متعلقين به.
الحق صنو المعرفة والعلم. وقد مر أن نصيبنا اليوم من المعرفة متعلق بمدى ما يأتينا من الغرب على وجه الخصوص، وأن إسهامنا في التقدم العلمي صفرٌ صارخ. وفي علائقنا بما ينعت بمجتمع المعرفة نبدو كالواقفين على الأبواب. مستهلكون مستنزفون غير فاعلين وغير منتجين. نحن (خارج السياق)، ولا يبدو أن أوضاعنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية و… تَعِدنا بأداء دور مشخص في هذا القطاع، على المدى المنظور. أما الجمال، الذي نقرنه عادة بتعبير (الزمن الجميل) الشائع، الذي نفترض أن الفن هو الذي يجسده أحسن تجسيد، فقد طالته في العقود الأخيرة كل رسوم «الانحطاط». منذ الأربعينيات حتى أواسط الستينيات من القرن المنصرم، وفي مصر ولبنان على وجه التخصيص، حيث مثّل هذان القطران واقع الفنون العربية الحديثة: السينما، والموسيقا والغناء، والمسرح – أدركت هذه الفنون مراتب عالية – أصيلة – من الصدق، والمعنى والفتنة والسحر، والجمال، والرقي، والنقاء. محمد عبدالوهاب وليلى مراد وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ في الغناء، ونجيب الريحاني ويوسف وهبي في المسرح، فيروز والرحباني ووديع الصافي وسمير يزبك و… في الغناء والمسرح الغنائي.. إلخ. الأفلام الاجتماعية والغنائية الباكية والضاحكة الساخرة، الكلاسيكية والفولكلورية، السارّة اللّاذة الممتعة، الباعثة على البهجة والأمل والحياة. تحولات عميقة طالت هذا كله. انسحبت الأصالة الذاتية وانحدرت فنون الغناء والسينما انحدارًا مذهلًا. غزت أعراض التفاهة والسخف والعبث مظاهر الفن المختلفة. وبدا كأن حِلفًا قد انعقد بين «المدرسة الغنائية المصرية الجديدة»، الموغلة في التفاهة وفي التجاوزات والإيحاءات الجنسية المرذولة، وبين «مدرسة لبنانية جديدة مماثلة تتجاوز في التفاهة والانحطاط قرينتها المصرية. وأدت قنوات (أرابيكا) و(مزيكا) و(روتانا)، وبدرجة أقل (وناسة) أدورًا «مرموقة» في إشاعة الأنماط «المبذولة» من فن الغناء، الذي هو أكثر الفنون شيوعًا وطلبًا لدى فئات الجمهور الواسعة. بكل تأكيد ذلك لا يعني أن عُصبةً من الفنانين لم تظل أمينة على «الفن الأصيل الجميل»، وأنها لم تحرص على التعلق بفن نقيّ جذاب راقٍ لا تطوله نزعات المنفعة والغنى الفلكية. فذلك واقع مشهود يقطع بأن الفن الأصيل لم يرضخ لطغيان وإغراءات الفن الهابط المرذول، وبأن رموزًا فنية نبيلة ما زالت تَعَضُّ بالنواجذ على جمال الفن ونقائه وأصالته، وتتابع في المشرق وفي المغرب رسالة الفن الملتزمة بالقيمة والمعنى والمتعة والأصالة، وتكافح في وجه ما يبدو أنه «إستراتيجية» سياسية صارخة في «إفساد الذائقة» العربية!
ويظل القول عندي في (القيم) أكثر الأقوال جوهرية وخطورة. وليس ينبغي أن يكون محل قول عابر وجيز. عرضت للموضوع مرارًا، قديمًا وحديثًا، وأفردت له، على وجه الخصوص، بحثًا معمقًا أزعم أنه يدخل في باب الأصالة الحقيقية المنشودة («أولية القيم.. والعدل»، في كتابي: مرافعة للمستقبلات العربية الممكنة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2016، ص411-467). لذا آذن لنفسي بأن أوجه القارئ إلى هذا البحث الذي من شأنه أن يشد أزري في دعوتي في هذا القول إلى أن ألهج، بالمديح والثناء، على الأصالة، وإلى أن أنبّه بقوة على أنها المعيار القاطع في تقييمنا لكل عمل ثقافيّ.









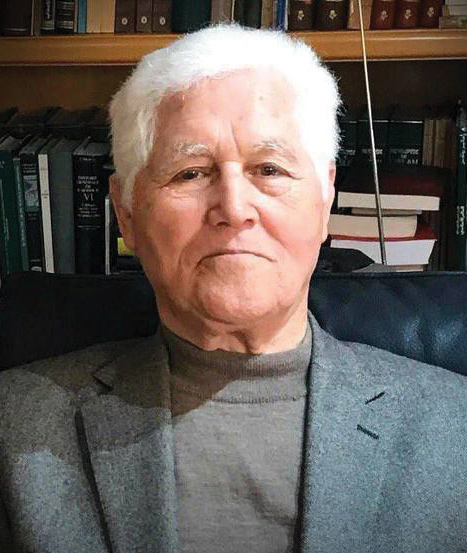





0 تعليق