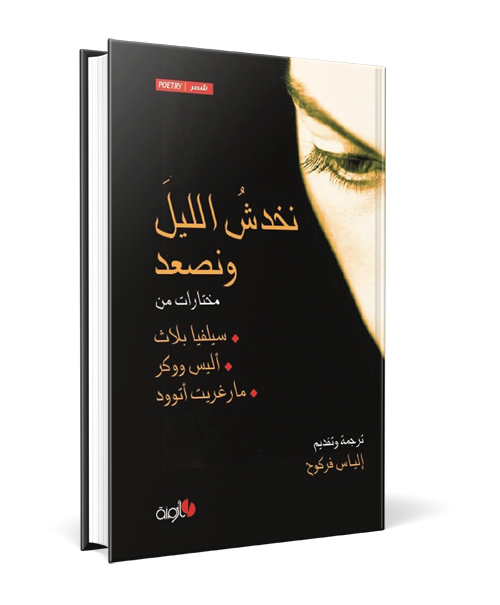ووكر إيفانز.. سعى إلى رؤيةٍ شعريّة مكثفة للعالم
ووكر إيفانز أحد أكثر الفنانين تأثيرًا في القرن العشرين. عملت صوره الفوتوغرافيَّة الرائعة المنشورة، النقيّة كالكريستال، والمعبِّرة، على إلهام أجيال عدة من الفنانين، بداية من هيلين ليفيت (1) وروبرت فرانك (2) وصولًا إلى ديان آربوس (3)، ولي فريدلاندر (4)، وبيرند وهيللا بيتشر (5). بالنظر إلى السابقين عليه في التصوير الفوتوغرافي التوثيقي الأميركي، امتلك إيفانز القدرة الاستثنائيّة على رؤية الحاضر كأنه الماضي، وترجمة تلك الرؤيا المعرفية وتحويلها تاريخيًّا إلى فنّ خالد. كان موضوعه الرئيس التعبير عمّا هو رائج وشائع ومحلي الذي بمقدور الناس العثور عليه متمثّلًا في الشواخص على جوانب الطُّرُق، والمقاهي الرخيصة، والإعلانات، وغُرف النوم البسيطة، والشوارع الرئيسة للبلدات الصغيرة. خلال خمسين عامًا، بداية من أواخر العشرينيات إلى بدايات السبعينيات، قام إيفانز بتسجيل المشهد الأميركي برهافة شاعر، ودِقّة جَرَّاح، خالقًا بذلك كشفًا موسوعيًّا مصوَّرًا لأميركا الحديثة في تحوّلها.
وُلِدَ ووكر إيفانز عام 1903م في سانت لويس، ميسوري، متجهًا للرسم في طفولته، ثم جامعًا للصور المطبوعة على البطاقات البريدية، وملتقطًا صورًا لعائلته وأصدقائه بواسطة كاميرا كوداك Kodak صغيرة. بعد سنة واحدة أمضاها في Williams College، ترك المدرسة وانتقل إلى مدينة نيويورك، عاثرًا على عمل جزئيّ في متاجر بيع الكتب، وموظفًا في مكتبة نيويورك العامة، حيث امتلك فيها حرية إطلاق العنان لشغفه في قراءة تي. إس. إليوت، ودي. إتش. لورنس، وجيمس جويس، وكذلك شارل بودلير، وغوستاف فلوبير. وفي عام 1927م، بعد أن أقام في باريس سنة لتحسين لغته الفرنسية، وكاتبًا لقصص قصيرة ومقالات غير أدبية، عاد إلى نيويورك عازمًا أن يصبح كاتبًا. وإلى جانب هذا، واظب إيفانز على حمل الكاميرا موجهًا بالتدريج حافزه الجَماليّ لإظهار عناصر الأدب في صوره، كالغنائيّة، والسخرية، والوصف الحاد، والبناء السردي، ليكون ذلك كلّه جزءًا من فن التصوير الفوتوغرافي.
أظهرت معظم صور إيفانز المبكِّرة تأثيرات الحداثة الأوربية، وبخاصة تمسكها بالشكل وتشديدها على بنيات التخطيط الطباعي الحيوي في حركته. لكنه سرعان ما تحوَّل تدريجيًّا مبتعدًا من هذا الأسلوب المريح جدًّا، ليطوِّرَ أسلوبًا خاصًّا به يتسم بالتنبيه والإيقاظ إنما بواقعية صامتة، أو قليلة الإفصاح، وبإيلاء دور للمشاهِد في قراءة الصورة، وبالأصداء الشِّعريّة للموضوعات العادية. ولقد كانت سنتا الكساد العظيم (*) (1935- 1936م) أكثر مراحل إيفانز وفرةً في الإنتاج وتميّزًا في الإنجاز. وفي يونيو 1935م، قبلَ وظيفة مؤقتة عرضتها عليه وزارة الداخلية لتصوير تجمعات حكومية بُنيَت لإسكان عمّال المناجم العاطلين في فيرجينيا الغربية؛ فما كان منه إلّا أن قام بتحويلها بسرعة إلى عمل دائم بوصفه «متخصصًا إعلاميًّا» في إدارة المستوطنات (أمن المزارع فيما بعد)، وهي وكالة مستحدثة في قسم الزراعة.
روح الحياة الأميركية
تحت إشراف روي سترايكر(6)، عمل إيفانز على توثيق حياة البلدات الصغيرة وإظهار كيف كانت الحكومة الفيدرالية تحاول تحسين ظروف التجمعات الريفية خلال فترة الكساد العظيم، وذلك ضمن فريق من المصورين: دوروثيا لانغ (7)، وآرثر روثستاين (8)، وراسل لي. (9) لكنه لم يولِ اهتمامًا كبيرًا بالأجندة الأيديولوجية ليوميات الرحلة المقترحة، وبدلًا من ذلك استجابَ لحاجته التركيز على روح الحياة الأميركية المتبدية فيما هو بسيط وعادي. ولقد عكست صوره للتشكيلات المعمارية على جوانب الطُّرُق احترامًا كبيرًا لعادات الرجل العادي المهملة، وكذلك للكنائس النائية، وحَلّاقي البلدات الصغيرة، والمقابر، كما ضَمِنَ بذلك صيته بوصفه المصوِّر التوثيقيّ الأميركي الأبرز. ومنذ نشر تلك اللقطات لأوّل مرّة في المجلات والكتب أواخر الثلاثينيات، كان أن دخلَت وعيَ الناس الجمعي كأيقونات مباشرة، وباتت الآن راسخة في تاريخ الأمة المصوَّر الخاصّ بمرحلة الكساد العظيم.
في صيف 1936م نال إجازة ليسافر إلى الجنوب، رفقة صديقه الكاتب جيمس آجي (10)، الذي تعاقد مع مجلة Fortune من أجل كتابة مقالة عن المزارعين من غير أصحاب الأراضي، بينما يكون إيفانز هو المصوِّر. وعلى الرغم من أن المجلة رفضت نصّ آجي الطويل عن ثلاث عائلات في ألاباما في النهاية، فإنّ ناتج ذلك التعاون كان كتاب «دعونا نُمَجِّد الرجال المشهورين» الذي نُشر عام 1941م، وهو عبارة عن رحلة مثيرة للمشاعر صوب أقصى حدود التأمل المباشر. ففي صفحاته الخمسمئة من الكلمات والصور مزيجٌ متفجِّر من الوصف التوثيقي والموضوعية العميقة، حتى إنه شكّلَ كتابةً سِيَريَّة ظلَّت واحدة من النَّوَيات الأولى في الأدب الأميركي للقرن العشرين. إنَّ صور إيفانز في الكتاب إظهارٌ صادق للوجوه، وغُرف النوم، وملابس الأفراد المزارعين الذين يعيشون في تلالٍ جافة تبعد سبعة عشر ميلًا شمال غرينزبورو، ألاباما. وإذا عايناها متسلسلةً، فإنها تبدو توضيحًا لكامل مأساة الكساد العظيم، في حين تشكِّلُ كلُّ واحدة منها حالة حميمية، وبارعة، وإشكالية. وإنها، في نظر الكثيرين، قمة ما بلغه إيفانز في عمله الفوتوغرافي.
في سبتمبر 1938م، افتتحَ متحف الفنّ الحديث «ووكر إيفانز: صُورٌ أميركية»، كمعرضٍ استعادي لالتقاطات حقبة إيفانز الأولى، وكانت أوّل مرّة يخصص فيها المتحف عرضًا لفنان بمفرده. ولقد نشر المتحف في الوقت نفسه كتابًا حمل العنوان نفسه – لا يزال حتّى الآن دليل اهتداء لعدد كبير من الفنانين بالمقابل من جميع ما خلصت إليه الأبحاث المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي. يبدأ الكتاب بوصف ملامح المجتمع الأميركي من خلال الأفراد: مزارعو القطن، وعمّال المناجم، وخبراء الحرب، وكذلك المؤسسات الاجتماعية، الوجبات السريعة، ودكاكين الحلّاقين، وثقافة السيارات. بعدها ينتهي بتقريرٍ شامل عن البلدات الصناعية، والإعلانات المرسومة بخطّ اليد، والكنائس الريفية، والبيوت البسيطة – المواقع والآثار التي تشكِّل التعبير المادي والملموس عن طموحات الأميركيين، ويأسهم، وعاداتهم.
وجوه أكثر عريًا
بين عاميْ (1938 -1941م) أنجزَ ووكر إيفانز سلسلة صور مهمة لوجوهٍ التقطها في قطار أنفاق نيويورك. ظلّت تلك الصور من غير نشر لمدة خمس وعشرين سنة، حتى عام 1966م، عندما أصدرت هوغتون ميفلن (11) كتابًا أسماه «كثيرون المُنادى عليهم»، يتضمن ثمانيًا وتسعين صورةً، مع تقديم كتَبَه جيمس آجي عام 1940م. فبواسطة كاميرا صغيرة ماركة Contax ألصقها بصدره، في حين ثبّت عدستها بين زِرّين من أزرار معطفه الشتائيّ، استطاع إيفانز أن يلتقطَ صورًا للمسافرين من حوله وأمامه من دون أن يلحظوا ذلك، وعن قُرب كبير. وبالرغم من أنّ المحيط الذي تحرك فيه كان الفضاء العام، فإنه وجد في وجوه الذين صوَّرهم استغراقَهم العفوي الكامل في أفكارهم، وتقلبات أمزجتهم المستمرّة، وفضولهم، وسأمهم، وضحكهم، وقنوطهم… وجوهًا حالمة وأخرى نَكِدَة. «الحِرْصُ سقطَ والقناعُ زال»، كتبَ ملاحظًا، «حتى داخل غُرف النوم المنعزلة (حيث هناك مرايا)؛ فإنَّ وجوه الناس في أنفاق القطار أكثر عُريًا».
بين عامي (1935- 1965م)، ساهم ووكر إيفانز بأكثر من أربعمئة صورة فوتوغرافيّة مصاحبة لخمس وأربعين مقالة نُشرت في مجلة Fortune. لقد عمل لدى هذه المجلة المترفة كمحرر فوتوغرافي خاصّ، من عام 1945م إلى عام 1965م، ليس مبتكرًا لحافظات الوثائق والحقائب الخاصّة بها، ومنفذًا للصور، ومصممًا لصفحاتها فقط؛ لكنه كان يكتب النصوص المرافقة لتلك اللقطات. طُبِعَت موضوعاته بالأسود والأبيض وبالمواد الملونة بما فيها رموز وإشارات شركة الخطوط الحديدية، وأدوات العمل المستعملة، ومنتجعات الصيف الفندقيّة القديمة، ومشاهد لأميركا كما بدت من نافذة قطار. مستخدمًا الصيغة الصحفية المعتمَدَة للقصة التي تصاحبها الصورة؛ مزجَ إيفانز اهتمامه بالكلمات والصور، مجترحًا سردًا متعدد الأبعاد غير مألوف وبسويّة عالية. كانت الأساليب الفنيّة الكلاسيكيّة المتروكة، تلك المقالات الموقعة باسمه، إنما هي حِرفة إيفانز طوال عشرين سنة.
منذ عام 1965م أصبح أستاذًا محاضرًا للتصوير الفوتوغرافي، قسم التصميم الغرافيكي، في جامعة ييل للفن.
بدأ عام 1973م العمل مستخدمًا الكاميرا المبتكرة Polaroid SX-70، وبإمداد للأفلام غير محدود من الشركة. ولقد تناسبَت الكاميرا تمامًا مع أبحاثه الساعية إلى رؤيةٍ شعريّة مكثفة للعالم: كانت طباعتها الفورية، لمصوِّرٍ فوتوغرافي متردد في السبعين من عمره، قد ساعدته على قصقصة الورق وقطعه ليخرج بما يشبه أعمال الفنان الفرنسي ماتيس في شيخوخته. كانت طباعة الصور الملتقطة بواسطة هذه الكاميرا الفريدة آخر أعمال الفنان وذروة اشتغاله على امتداد نصف قرن. ومن خلالها عادَ إلى موضوعاته الأثيرة العديدة – وأكثرها أهمية تمثلت في اليافطات، والملصقات، وتحويلاتها اللامحدودة، وأشكال الحروف نفسها.
المصدر
محطّة كوبيّة مبكِّرة
في شهريْ مايو ويونيو من عام 1933م، عملَ ووكر إيفانز على التقاط مجموعة صور في كوبا بتكليف من ناشر كتاب كارليتون بيلز (12) «جريمة كوبا»، المتضمن وصفًا حادًّا لدكتاتورية جيراردو ماتشادو. وهناك اعتاد إيفانز مشاركة إرنست هيمنغواي الشراب ليليًّا، وهو مَنْ أقرضه المال لتغطية مصاريف إقامته أسبوعين إضافيين. كانت صوره توثيقًا لحياة الشوارع، وحضور رجال الأمن الطاغي، والمتسولين، وعمّال الموانئ بأسمالهم، ومشاهد أخرى لواجهة المدينة المائية. كما أنه ساعد هيمنغواي في الحصول على صورٍ من أرشيف الصحيفة التي قامت بتوثيق بعض أعمال العنف السياسي التي وصفها في روايته «أن تأخذ وأن لا تأخذ» عام 1937م. وخشية من احتمال مصادرة السلطات الكوبية للصور التي التقطها، والتي تشهد على انتقاده لها، ترك عند هيمنغواي 46 صورة مطبوعة. لكنه لم يتعرض لأيّ صعوبات عند عودته إلى الولايات المتحدة، لتظهر فيما بعد 31 صورة من صوره في كتاب بيلز. اكتُشِفَت الصور المطبوعة المخبأة المتروكة عند هيمنغواي في هافانا عام 2002م، وأُقيم معرض لها في «كي ويست». (13)
المصدر
هوامش
(1) Helen Levitt: (1913- 2009م)، مصورة فوتوغرافية أميركية. أولت اهتمامها بـ«فوتوغرافيا الشوارع» في مدينة نيويورك. أُطلق عليها «أكثر الفوتوغرافيين المحتفى بهم وأكثرهم ذيوعًا في زمنها».
(2) Robert Frank: (1924- )، مصور فوتوغرافي سويسري- أميركي، وصانع أفلام وثائقية. اشتهر بكتاب عنوانه «الأميركيون» نُشر عام 1958م.
(3) Diane Arbus: (1923- 1971م)، مصورة فوتوغرافية أميركية، عُرفت بتصويرها للذين يعيشون على هامش المجتمع؛ الأقزام، العمالقة، مزدوجي الجنس، العُراة، أصحاب الاستعراضات في السيرك، وسواهم ممن يُنظر إليهم كشخصيات قبيحة وغريبة الأطوار.
(4) Lee Friedlander: (1943- )، مصور فوتوغرافي وفنان أميركي. أنشأ في الستينيات والسبعينيات لغة مرئية عبر الصور تحاكي كلّ ما هو مديني «فضاء اجتماعي»، بالاشتراك مع عدد كبير من زملائه.
(5) Bernd& Hilla Beacher: فنانان ومصوران فوتوغرافيان تبنيا التصوير «المفاهيمي»، وعملا معًا كزوجين على نحوٍ تعاوني. بيرند (1931- 2007م)، هيللا (1961- 2007م).
(6) Roy Stryker (1893- 1975م): رجل اقتصاد أميركي، وموظف حكومي، ومصوّر فوتوغرافي. ترأس فرع المعلومات في إدارة أمن المزارع خلال حقبة الكساد العظيم، وأسس حركة التصوير الوثائقي.
(7) Dorothea Lange: (1895- 1985م)، مصورة فوتوغراف وثائقي وصحافي، عُرفت بأعمالها عن حقبة الكساد العظيم، عندما عملت لصالح إدارة أمن المزارع.
(8) Arthur Rothstein: (1915- 1985م)، مصور فوتوغرافي أميركي. اشتهر بصوره المتميزة للصحافة كواحد من الأفضل. عمل طوال خمسة عقود على تصوير الأميركيين في شتّى أحوالهم.
(9) Russell Lee: (1903- 1986م)، مصور فوتوغرافي صحافي أميركي. عمل مع إدارة أمن المزارع، وركّز في أعماله على تصوير فئات المجتمع الأميركي بأصولها ومنابتها كافة.
(10) James Agee: (1909- 1955م)، روائي، وصحافي، وشاعر، وكاتب للنصوص السينمائية، وأحد أكثر النقّاد السينمائيين تأثيرًا في الولايات المتحدة في الأربعينيات من القرن الماضي. كتب للسينما: «الملكة الإفريقية» عام 1951م، و«ليل الصيّاد» عام 1955م. ومن رواياته: «موت في العائلة» عام 1957م، نال عليها جائزة بوليتزر، و«مراقبة الصباح» عام 1951م.
(11) Houghton Mifflin: واحدة من كبريات دور النشر.
(12) Carleton Beals: (1893- 1979م)، صحافي، ومؤلف، ومؤرخ، وناشط سياسي أميركي، صبّ اهتمامه على قضايا أميركا اللاتينية. أبرز نجاحاته مقابلته مع الثائر النيكارغوي «أوغستو ساندينو» في فبراير 1928م. من كتبه: «جريمة كوبا»، و«متاهة مكسيكية»، و«ذهب الموز».
(13) Key West: مدينة في جزيرة بالاسم نفسه تابعة للولايات المتحدة، وهي جزء من أرخبيل فلوريدا كيز، تبعد 90 ميلًا شمالي كوبا.
(*) Great Depression: شكّل الكساد العظيم أسوأ انكماش اقتصادي في بلدان العالم الصناعي، امتد من عام 1929م إلى عام 1939م . بدأ إثر إفلاس البورصة في أكتوبر 1929م، وهو ما أدّى إلى شلل «وول ستريت، سوق السندات المالية» فحطّم ملايين المستثمرين، مسببًا هبوطًا حادًّا في الصناعة والوظائف تجلّى في إفلاس الشركات وصرف العمّال. وفي عام 1933م، عندما وصل الكساد العظيم أوجه، باتَ أكثر من 15 مليونًا من الأميركيين بلا عمل (ما يزيد على 20 بالمئة من سكّان الولايات المتحدة آنذاك)، وإفلاس نحو نصف بنوك البلاد.









 ولِمَ لا يكون شَرَكًا ليصطادَ إجابةً واحدةً، فقط واحدة، تسعفني (أنا الخط الخيطي في حالاتي شبه الهَبائيّة) في تبرير حضوري الشَّبَحي هذا وسط الخواء إلّا من ظلّي الواهن؟ غير أنَّ ظِلّي لا يراه غيري. ظِلّي في داخلي، وداخلي يكاد يكون موجودًا ـ إذ أكادُ أنا أن أكون! حضوري فَحْميٌّ سرعان ما سوف يتطاير غبارُ رماده إنْ هَبّ نسيمٌ نسيناه، فثمة حياة أولى كانت، أو ثالثة لا أعرف متى ستكون! لماذا أنا أصلًا، ولماذا باتَ قَحْطُ العالم فضاءً مصمتًا تُركتُ فيه ألوكُ سؤالي كأنما هو قَدَري المرسوم، ومصيري المحتوم؟ ألا ترون هذا الـ«جياكوميتي» كيف يجعلُ من عينيَّ، في تخطيطاته بالأسود والأبيض ولوحاته الملونة، تجويفين مليئين ببياضٍ قد يكون أبديًّا (ألأنه أزليٌّ أيضًا؟) لا يمتلئان سوى باللون الذي ينبغي عليَّ أنا أن أجعله فيهما؟ أن أدلقه داخلهما؟ لكنني لا أستطيع الحَراك من مكاني، حتّى وإنْ كنتُ أمشي أو ألتفتُ صوبكم! لا أستطيع في كل حالاتي: إنْ كنتُ خطًّا، أو خيطًا، أو برونزًا بسُمْك الحبل، أو رجلًا جالسًا يحدّق في عدسةٍ خفيّة، أو وجهًا خُططَ بأصابع هذا الجياكوميتي العصبيّة المتوترة! كيف لي أن أجيب عن سؤالي إذا ما بقيتُ واقفًا في قحطٍ أصمّ، وأبكم، انتُزِعَت منه السماءُ، فلا شمس ولا هواء، لا ليل ولا قمر؟ أو منتصبًا كالمسلّة في خواءٍ لا يحملُ في خوائه سوى خوائي إلّا من سؤالي الأرفع مني والأنحل من شبك العنكبوت؟
ولِمَ لا يكون شَرَكًا ليصطادَ إجابةً واحدةً، فقط واحدة، تسعفني (أنا الخط الخيطي في حالاتي شبه الهَبائيّة) في تبرير حضوري الشَّبَحي هذا وسط الخواء إلّا من ظلّي الواهن؟ غير أنَّ ظِلّي لا يراه غيري. ظِلّي في داخلي، وداخلي يكاد يكون موجودًا ـ إذ أكادُ أنا أن أكون! حضوري فَحْميٌّ سرعان ما سوف يتطاير غبارُ رماده إنْ هَبّ نسيمٌ نسيناه، فثمة حياة أولى كانت، أو ثالثة لا أعرف متى ستكون! لماذا أنا أصلًا، ولماذا باتَ قَحْطُ العالم فضاءً مصمتًا تُركتُ فيه ألوكُ سؤالي كأنما هو قَدَري المرسوم، ومصيري المحتوم؟ ألا ترون هذا الـ«جياكوميتي» كيف يجعلُ من عينيَّ، في تخطيطاته بالأسود والأبيض ولوحاته الملونة، تجويفين مليئين ببياضٍ قد يكون أبديًّا (ألأنه أزليٌّ أيضًا؟) لا يمتلئان سوى باللون الذي ينبغي عليَّ أنا أن أجعله فيهما؟ أن أدلقه داخلهما؟ لكنني لا أستطيع الحَراك من مكاني، حتّى وإنْ كنتُ أمشي أو ألتفتُ صوبكم! لا أستطيع في كل حالاتي: إنْ كنتُ خطًّا، أو خيطًا، أو برونزًا بسُمْك الحبل، أو رجلًا جالسًا يحدّق في عدسةٍ خفيّة، أو وجهًا خُططَ بأصابع هذا الجياكوميتي العصبيّة المتوترة! كيف لي أن أجيب عن سؤالي إذا ما بقيتُ واقفًا في قحطٍ أصمّ، وأبكم، انتُزِعَت منه السماءُ، فلا شمس ولا هواء، لا ليل ولا قمر؟ أو منتصبًا كالمسلّة في خواءٍ لا يحملُ في خوائه سوى خوائي إلّا من سؤالي الأرفع مني والأنحل من شبك العنكبوت؟ * * *
* * *