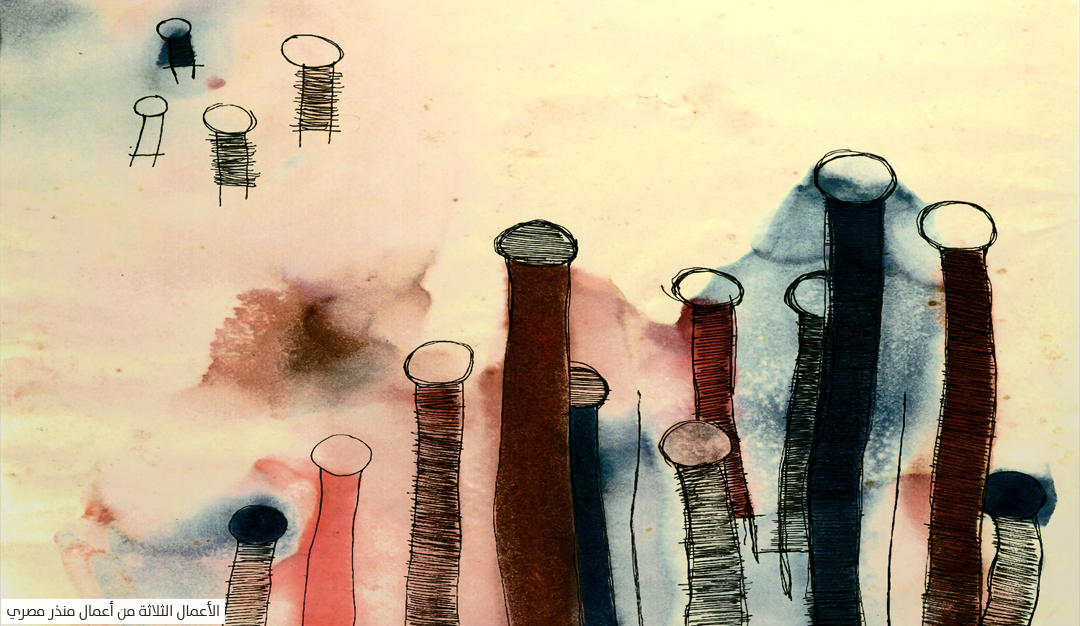
بواسطة منذر مصري - شاعر و كاتب سوري | مارس 1, 2023 | مقالات
في الصَّيفِ تكنُس
فتُشوِّبُ وتتعرَّق
وفي الشِّتاءِ تشطُف
فتبرُدُ وتبكي.
الأرضُ طِفلة
أحضرَها أبوها لتعملَ عندنا
خادِمة..
(1973)
إذا بدأت بالذكرى التي أوحت لي بهذه الاستعارة القاسية لأختم بها قصيدتي الباكرة أعلاه، فإنني سأكون قد بدأت، ليس من البداية، كما من المفترض، ليأتي سردي بعدها متسلسلًا حسب التقدم الزمني، وليس أيضًا من النهاية ليأتي السرد معكوسًا، على طريقة (فلاش باك) وترجمتها غير الموفقة، الارتجاع، أيّ، أن تبدأ بالنهاية وتنتهي بالبداية، كما في كثير من الروايات والأفلام السينمائية! فالطفلة (مروة) التي أحضرها أبوها لتعمل عندنا خادمة، ليست أول ولا آخر خادمة عملت في بيتنا. إلا أنها أيضًا، الآن أنتبه، ليست من كانت «في الصيف تتعرَّق وفي الشتاء تبرد» كما في المقطع الأول من القصيدة. تلك كانت (فريدة) وهي أول خادمة أتذكّرها، لا بل أتذكرها جيدًا، على رغم أني لم أكن حينذاك أكثر من طفل صغير.
كان ذلك في أول أعوام عقد الخمسينيات من القرن الماضي، عائلة لاذقانية متوسطة الحال، يعيلها أب ذو لكنة غريبة، من مواليد طرابلس، وخريج مدرسة (اللاييك) بطرطوس: (شكيب مصري)، موظف بسلك الأمن العام، سرح من عمله أول عام 1956م، بعد قضائه ثلاثة أشهر، «ضيفًا عزيزًا مكرمًا»، كما كتب لأبيه، في سجن المزّة، بشبهة كونه عضوًا في الحزب القومي السوري، الحزب الذي أتّهم بتدبير وتنفيذ عملية اغتيال عدنان المالكي في 22/4/1955م، ومنع كلّ من ينتسب إليه من العمل لدى مؤسسات ودوائر الدولة! وأمّي: (خالدية نحلوس) التي، بسبب حاجة عائلتها المادية، أضافت إلى عمرها عامين، لأجل أن تعين معلمة رياضة في المدارس الابتدائية الحكومية.
وكنا نسكن، في بيت تعود ملكيته لأناس آخرين، نصعد إليه بواسطة درج حجري مكشوف، يتألف من غرفتين، واحدة بسرير عريض نسبيًّا لنوم أبي وأمّي، والثانية بطقم كنبات، منجّد بقماش من المخمل الخمري لاستقبال الضيوف، وسريرين مفردين، الأوّل لنوم خالي (غاندي) إلى حين انقضاء مدة عزوبيته، والثاني لنوم جدتي وأنا، حفيدها الأول والأثير! وصالون واسع بنافذتين عاليتين، كنا نحتاج أن نقفز أو نتسلق كرسيًّا لنمسك بقضبانهما ونطل على حديقة كبيرة، أو بالأصح بستان غير معتنى به صار أقرب إلى غابة كثيفة باسقة الأشجار، تمنع عنّا رؤية نوافذ بيت شريتح الأقرب إلى قصر، ومطبخ بالغ الضيق، تقلّ مساحته عن مترين مربعين، تحتله طاولة صغيرة ونملية طعام خشبيتان، وذلك قبل استبدالها عام (1958) بأول برّاد (فريجيدير) دخل للحارة. نهبط منه بدرجة واحدة إلى غرفة بدون نافذة، يأتيها النور فقط من بابها، بأرضية حجرية تزيد مساحتها عنه قليلًا، نستخدمها، أو الصحيح، تستخدمها جدّتي، لعمليات غلي الثياب وغسلها، وجلي الطناجر والصحون، والحمّام بواسطة تنكة ماء ساخن لدرجة الغليان فوق بابور الكاز، بجانب تنكة ماء باردة على الأرض، لمزج الماء الساخن بالبارد بالقدر المطلوب.
أما المرحاض فهو يقع في الزاوية الشرقية للمنور الواسع غير المسقوف الذي يفصل الباب الخارجي عن مدخل الصالون. نعم جدّتي، ذات الخمسين عامًا، حينها، لا أمّي، من كانت تقوم بكلّ هذا، فقد كان البيت الذي أصفه، في الأصل، بيتها الذي كانت تسكنه مع أولادها الثلاثة، أمي وأخويها (خالد) و(غاندي). ولسبب مادّي غالبًا، رغم رخص أثمان البيوت وإيجاراتها حينذاك! عشنا فيه جميعنا، منذ زواج أبي وأمّي عام (1948) وحتّى انتقالنا منه عام (1960). البيت الذي ولدت فيه، أنا الابن الأوّل، في 27/5/1949م، وتبعني أخوتي الثلاثة (ماهر) و(مرام) و(منى) خلال ما لا يزيد على ستة أعوام. القائم بسطحه القرميدي، في منتصف ما يطلق عليه حيّ الصباغين الغامض الحدود، كان وما يزال، حتّى بعد أن هدمت أغلب المعالم القديمة لتلك المنطقة الشعبية من المدينة، عقب أحداث الثمانينيات الدامية في سوريا، والتي كان للاذقية فيها نصيب معتبر!
ذلك الزاروب الضيق الذي يصعد من سوق الداية شمالًا ليهبط إلى القبة الحجرية فوق دكان (الحميمي) لبيع الدخان والتنبك، التي كانت تشكل بوابة حيّ الشحّادين، شرقًا. والذي يتوسّطه، مقابل بيتنا تمامًا، الباب الغربي لساحة جامع (المشاطي)، وتطلّ على بيوته المتلاصفة مأذنته القصيرة! بعده انتقلنا، وأحسب السبب المباشر لذلك، عودة خالي (خالد نحلوس) لاعب كرة القدم الشهير، بشكل نهائي من دمشق واستقراره في اللاذقية، إلى بيت آخر في حي جديد، يشكل توسع اللاذقية جنوبًا، ولكن بدل أن يطلقوا عليه اسمًا خاصًّا به، أسموه: (مشروع تجميل الصليبة)! البيت الذي في عام (1962)، وبعد ولادة أختي الصغرى (منى) بسبعة أعوام، ولد فيه أخي الأصغر، بعد أن انتظر أبي وفاة جدّي، حسب الأعراف الطرابلسية، حتّى يطلق عليه اسمه: (رفعت).
(فريدة) ضاحكة في أغلب الأوقات
أوّل خدّامة أعرفها، رغبت باستخدام صيغة الفاعل المشددة، ولو لمرّة واحدة فقط، كما اعتدت سماعها، بدل خادمة، فكلتاهما فصيحتان، وكلتاهما محقّرتان اجتماعيًّا. قلت سماعها، ولم أقل نطقها، فقد كان من المحرّم في بيتنا التلفّظ بأيّ منهما! ولكنهن كانوا خادمات، في واقع الأمر، قبلنا بهذا أو أنكرناه! لم يكن لدينا خادمة قبلها، لا أعرف لقب عائلتها! كما لا جواب لدي عن كيف جاءت إلى بيتنا؟ كلّ ما أعرفه هو أنها (قرباطية)، وهذه صفة أخرى اكتسبت وقعًا مهينًا اجتماعيًّا، وأنه كانت لها قريبة، ابنة عمّ على ما أذكر، اسمها (حميدة)، سآتي على ذكرها في السياق، تخدم عند بيت خالتي.
ذكرياتي عن (فريدة) كثيرة، على رغم أنها تركتنا وأنا في عمر السادسة أو السابعة، كانت في أواسط العشرينيات من العمر، سمراء، بقدّ مكتنز، متوسّطة الطول والامتلاء. بعاهة ظاهرة بإحدى عينيها، “فريدة العورة.. آه يا سلام” كان أولاد الحارة يهتفون إذا نهرتهم، لسبب أو لآخر، في أثناء خروجها من البيت لمهمات طارئة، فقد كان أبي المسؤول عن إحضار أيّ شيء نحتاجه، كما عندما ترسلها أمّي لتوصل أو تحضر شيئًا من مكان ما، أو لمواعيد غامضة لم يتوضّح لنا سرّها إلا لاحقًا. أذكرها ضاحكة في أغلب الأوقات، تغني وهي تزحف على أطرافها الأربعة عند مسحها الأرض! تاركة لي فرصة اعتلاء ظهرها، طوال عملية المسح! مشكلات جدّتي وأمّي معها كانت تبدأ بتباسطها وتلهيها بالوقوف مع شباب الحارة والبائعين في سوق الداية، حتّى إنها كانت تضيفهم من الشوكلاته والسكاكر التي كانت أمّي ترسلها لتحضرها من محلّ (النحاس) الواقع مقابل سينما الشرق في الشارع المؤدي لحي القلعة، في حال زيارة زميلاتها المعلمات لبيتنا الشديد التواضع، ولا تنتهي بمغادرتها البيت دون أن تخبر أحدًا وغيابها لساعات طويلة، في البدء اكتشف أهلي العلاقة بين مرور الفرقة الموسيقية العائدة لسلاح البحرية، وسماعنا صوت أبواقها وصنوجها، وبين اختفاء أيّ أثر لفريدة في رمشة عين! بعدها عرفنا أنها على علاقة غرامية مع قارع الطبل في الفرقة، وكان قرباطيًّا مثلها. تأكّدنا من ذلك، عندما جاء إلى بيتنا، لأول وآخر مرة، وأخذها معه!

(هدى) لم تكن خادمة بأي معنى
لم تذهب (فريدة) دون أن تأتي لنا بفتاة بديلة، في الثالثة عشرة من عمرها، سمراء حنطية مثلها، وتشبهها، على أنها ابنة أختها، لتحل محلها. انتقلت (هدى) معنا إلى بيتنا الجديد، في مشروع تجميل الصليبة، كما سبق وذكرت، حارة (الدعبول) أصحاب آخر قافلة جمال، كانت تستخدم لنقل البضائع من مرفأ اللاذقية إلى المدن السورية القريبة والبعيدة، كما كانوا أصحاب الفرن الوحيد ودكان السمانة الوحيدة في المنطقة. لم تكن (هدى) خادمة بأي معنى للكلمة، كأنها لم تكن تعلم ماذا تفعل عندنا، ولم يكن لها القدرة لأن تفهم لماذا يجب عليها بالذات أن تقوم بتلك الأعمال المنزلية الشاقة، من كناسة ومسح وجلي واعتناء بأخوتي الصغار، عوض الذهاب إلى المدرسة وارتداء الثياب الجميلة والوقوف أمام المرآة. حتّى إنها راحت تتعارك وتتضارب مع أخي ماهر، الذي كان يقاربها بالعمر، وكانت السبب في وقوعه من حافة النافذة إلى حديقة الطابق الأرضي، وحمله إلى المشفى الوطني القريب، لحسن الحظ، مغشيًّا عليه! صامتة دائمًا، لا تتكلم ولا تجيب سوى بنظرات من عينيها الغائمتين. عزيزة النفس، اتهمها مرة أحد أقاربنا بسرقة خاتم زوجته، تبين بعد ذلك براءتها. بقيت معنا ما يقارب الستة أعوام، حتى جاء أهلها وأخذوها، لكنها هربت منهم وعادت إلينا مساء اليوم ذاته، فما كان من أبي إلا أن أمسك بيدها وأخذها بنفسه وسلمها لهم.
(حميدة) و(سكّر)
خادمتا بيت خالتي (فكرية قدور)، ابنة خالة أمّي، كنا ندعوها خالتي بسبب العلاقة الأخوية بينهما، فقد تربيتا معًا من طفولتهما بعد الوفاة الباكرة لكلا أبويهما، وكانت بدورها مديرة مدرسة ابتدائية، لكونها خريجة الدفعة الأولى لدار المعلمين التي أنشأتها السلطات الفرنسية في اللاذقية أواخر ثلاثينيات القرن المنصرم. عمل زوجها (يحيى عنتابلي) موظفًا في مديرية المالية حتى تقاعده، الذي لم يحيا بعده سوى أعوام قليلة. أي أنهم كانوا على ذات مستوانا المتوسط ماديًّا واجتماعيًّا، وقد انتقلوا من بيت ذي حديقة في حي (الكاملية) إلى بيت بالقرب منا، أول مشروع تجميل الصليبة. سمعت مرة عمي (ابو مصطفى) يقول: «أفضل شيئين فعلتهما في حياتي، زواجي من (فكرية) وشرائي هذا البيت».
الأولى (حميدة) ابنة عم (فريدة) قرباطية وسمراء وذات قدٍّ متوسط الطول والامتلاء مثلها، ولكن بعينين سليمتين، وآثار ماثلة على خدها، نتيجة إصابتها في صغرها بحبّة (حلب). عاشت في بيت خالتي، وكأنها إحدى بناتها، إلا أنها أقامت علاقات متشابكة مع سكان الحي المتنوعي الهوية (أرمن وأكراد ومسيحيين أرثوذوكس وموارنه وعلويين، بين الأغلبية السنية)، مما أتاح لها أن تلعب دورًا مهمًّا في حالات الحب والخصام بينهم! إلى أن تزوجت من معلم إكساء (مليّس) وأنجبت منه أولادًا عدّة. لكن القدر الغاشم لم يشأ أن يكمل معها حظّها الجيد، فتوفّيت عقب خطأ جراحي في أثناء ولادتها لابنها الثالث، في عيادة طبيب نسائية، ثقب بمبضعه جدار الرحم، ولم يستطع إغلاق الجرح وإيقاف تدفّق الدم، فنزفت حتى ماتت! الثانية (سكر)، وكانت للغرابة مسيحية الدين، بيضاء وذات شعر فاتح تغطيه عند خروجها من البيت بإشارب. لم تكن من سكّان اللاذقية ولا ريفها، بل ربما كانت لبنانية من قرية قريبة من مدينة (تلكلخ) الحدودية! لا أدري كيف جاءت لعند بيت خالتي وعاشت بينهم وكأنها واحدة منهم، متلائمة كل التلاؤم مع البيئة الدينية المعتدلة التي كانوا عليها. ما أعرفه أن بعض المسيحيين الذين علموا بأمرها، استنكروا كونها خادمة عند عائلة مسلمة، فعملوا على أن تترك بيت خالتي وتعود لأقارب لها، يسكنون في بيروت.
(جملو) كلما قالت شيئًا تتبعه “بلا معنى”
بسيطة لحدّ السذاجة، مع اعتداد شديد بالنفس، من الطبيعي ألا أنسى اسمها، الذي، قالت إن أباها سمّاها به تيمنًا بالأغنية الشعبية (الله الله يا جملو)، ومن الطبيعي أيضًا ألا أتذكّر لقب عائلتها، فلا شيء كان يدعونا للحرص على معرفة ذلك، على رغم كونها ذات مكانة معتبرة في قريتها (سناكرو) على حدّ قولها، ترتدي، شتاء وصيفًا، ثيابًا من أقمشة ملونة ومزخرفة فوق بعضها، فضفاضة وطويلة تصل لحذائها، فيصير من المتعذّر، أن يحزر المرء، ما إن كانت ممتلئة أم نحيلة! (جملو) أول خادمة دخلت بيتنا من ريف اللاذقية، وأيضًا بعين بيضاء، إثر جرح سبّبه دخول طرف فرع زيتون في عينها اليمنى وضعوا له كريم (نيفيا) بقصد شفائه، مما أحال بؤبؤ العين إلى بياض مائل للصفرة، وعماها بصورة نهائية. «يكفي الإنسان عين واحدة»، كانت تقول، اختارت أن تنام على فراش فوق أرض المطبخ. ذات ليلة، طاف البيت، وعام الفراش وسط الماء، ولم تستيقظ إلا بعد أن راحت أمي تهزها وتصيح بها. أذكر دعوات أمي ليرسل الله شمسًا ساطعة تجفّف سجّادة الصالون التبريزية التي كان أبي قد ابتاعها مؤخّرًا، بعد نشرها، والماء يزرب منها، بمساعدة (جملو) على طرف شرفة البيت!
كانت (جملو) ترى نفسها جميلة الجميلات، اسمًا على مسمّى! تستنكر أكل النساء الفليفلة والبهار الحار! عالق على لسانها عبارة: “بلا معنى”. فكلّما تقول شيئًا، تتبعه بـ “بلا معنى”: “دخل، بلا معنى”، “واسع بلا معنى”، “طويل بلا معنى”، “يوجعني بلا معنى”! إلى آخره، أذكر أنه في إحدى زيارات صديق أبي ورفيقه في الحزب والنضال، عضو المجلس الأعلى، الأمين (فؤاد شواف)، الذي أُطلق عليه يومًا لقب: “قديس الحزب القومي السوري”، وكان قد خرج منذ أسابيع قلائل من سجن المزّة، بعد قضائه فيه ثمانية أعوام وبضعة أشهر، (إذا لم يكن هذا دقيقًا، أرجو أن يصحّحه لي من يعلم) بتهمة المشاركة في الإعداد لعملية اغتيال عدنان المالكي! وذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة، بعرف أبي. بغاية التعرف على إحدى زميلات أمي في التعليم (ليلى حميدان). و(جملو)، تدخل وتخرج من الغرفة وتسأله أمام الإنسانة التي يبذل كل ما بمقدوره لإقناعها بالزواج منه.
وهذا ما حصل فعلًا: “أهلًا وسهلًا، بلا معنى”، “تحب قهوة حلوة أو مرّة بلا معنى”، “تفضّل بلا معنى”، “هل أغلق الشباك، بلا معنى”! فصاح القديس بضيق صدر: “بلا معنى بلا معنى بلا معنى؟” وطبعًا لم تستطع (جملو) أن تشرح له، فقط، نظرت إلى خطيبته وضحكت! تزوجت (جملو)، بعد إقامتها عندنا أعوامًا ليست كثيرة، بقريب لها، يعمل كآذن في مدرسة الحرس القومي، شرق حي العوينة، ويعيش في غرفة صغيرة فيها، حيث عاشت وأنجبت عددًا من الأولاد، مبقية على صلة وطيدة معنا، تزورنا من حين لآخر، وتحضر معها بعض منتجاتها من اللبن والزبدة لتبيعنا إياها، إلى أن تزوجت إحدى بناتها من ضابط شاب، وتطوّع كلا ابنيها في الجيش، وبات، لا يليق بها شيئًا كهذا.
(مروة) أقرب ما تكون إلى ظل
لم نطل السكن في حارة (الدعبول)، خمسة أعوام أو ستة على الأكثر، انتقلنا بعدها، عام (1965-1966م) إلى بيت آخر أفضل وأوسع يقع في مشروع تجميل الصليبة نفسه، الذي سنحيا فيه، أنا وأخوتي الأربعة، حتّى بعد أن تفرقنا، إثر زواج أبي بعد أربعة أعوام من وفاة أمي، وانتقاله لبيت آخر يبعد كثيرًا منا، ليعيش كل منا في بيته الخاص مع عائلته الخاصة، حتّى اليوم. ما عدا أختي مرام، التي سافرت، منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، إلى فرنسا عندما تزوجت من ابن جيران لنا لديه منحة دراسية في إحدى جامعات باريس. لحق بها، أخي الأصغر رفعت، الذي كان أول طلائع الشباب اللاذقانيين المهاجرين إلى السويد، في العام الأول من القرن الجديد، وكل منهما بقي عالقًا في مكانه وإن لأسباب مختلفة.
وكان ذلك البيت يقع في بناء عجيب أشبه بمستعمرة تجمع شتى أصناف الناس، مكوّنًا من ثلاث كتل معمارية، على شكل نجمة ثلاثية الأضلاع، تتشارك في نقطة التقائها، درجًا واحدًا، يطلق على هذا كله، جزافًا: بناية العقيد (كاظم زيتونة)، الشخصية العسكرية المهمة فيها. وكان من بين جيراننا، عائلة علوية، سيدتها، أخت ضابط من أهم ضبّاط سوريا حينها، دون أن يؤثر هذا أدنى تأثير في علاقات الجيرة بينها وبين العائلات الأخرى، وذلك لأنها، ومعها جميع أفراد الأسرة، كانوا آخر من يظهر ذلك. علموا بحاجة أمي المعلمة ذات الخمسة أولاد، إلى فتاة تساعدها في البيت، فاتفقوا مع والد الفتاة التي كانت تخدم في بيتهم، على احضار ابنته الثانية لعندنا. أذكر جيدًا ذلك اليوم الذي جاء فيه هذا الرجل، ومعه (مروة) النحيلة المنحنية الرأس، وقد بدت أصغر مما قيل لنا عمرها. أذكره جالسًا مع أمّي في غرفة القعود، يقول إنه ما كان ليضع ابنته عندنا لولا توصية السيد (أبو ابراهيم) جارنا، ولولا معرفته كم أننا عائلة محترمة! كما لا أنسى تكذيبه واستنكاره الشديدين للخبر الذي كان يشغل العالم آنذاك، وهو هبوط الأميركيين على القمر، الذي لم أفهمه، إلا بعد أن عرفت، وكان هذا بعد سنين كثيرة، أن ذلك كان يتعارض، بظنّه، مع عقيدته!
عاشت (مروة) معنا، أقرب ما تكون إلى الظلّ! رقيقة وصامتة، بالكاد يسمع لها صوت. تشارك أختي قصصهما وأسرارهما، دون أن يظهر عليها أي رغبة بالقيام بأي دور مشابه، كأنها كانت تعلم أن هذا ليس لها. ولكن عندما أبدت اهتمامًا عاطفيًّا بأحد شباب الجيران، اختارت أجملهم على الإطلاق، دون أن تخبره، ودون أي محاولة للتواصل معه! لدينا صورة وحيدة لها، جالسة تقلّب صفحات مجلة ما، حليقة الشعر! وذلك بسبب إصابتها بالقمل، لا ندري من أين جاءتها. فكانت أول وآخر فتاة تعمل لدينا، قصصنا لها شعرها. غادرتنا لتتزوج، كما قيل لنا، من مساعد في الجيش، بعد هذا سمعنا عنها أخبارًا متفرّقة ومتباعدة، بأنها أنجبت أولادًا صاروا بدورهم ضبّاطًا، وأنها باتت امرأة ذات اعتبار. غير أنها، أو أيًّا من أبنائها، لم يتواصلوا معنا أبدًا، كما أني، وبعد سنين عديدة، خلال زيارة عمل لي لقريتها، أبديت رغبتي في لقائها، فأُخبرت بأنه من الممكن ألا يكون هذا مستحبًّا على الإطلاق. ولليوم، وأنا أكتب هذه الكلمات، أشعر برغبة صادقة في رؤيتها!

(بهيجة) كأنها سيدة البيت
(بهيجة) ماذا؟ كالعادة ما كان يهمّنا أن نعرف! معها ذهبت مرحلة الخادمات، وجاءت مرحلة اللاجئات! أختان صبيتان من دمشق، حكم لهما قاضي الأحوال المدنية، بالابتعاد من أبيهما، المتهم بالتحرش، واللجوء إلى خالة لهما تحيا في اللاذقية. إلا أنهما بعد مكوثهما عند هذه الخالة أيامًا معدودات غادرتاها. الصغيرة، ذات الجمال الصاعق، عادت لدمشق، و(بهيجة) المتوسطة الجمال والبالغة من العمر (25) عامًا، لم تجد أحدًا تستنجد به سوى الاتحاد النسائي، فما كان من أمي أمينة سرّ فرع الاتحاد في اللاذقية حينذاك، إلا أن جاءت بها إلى بيتنا، على أن تقيم معنا، حتى تجد حلًّا ما لمشكلتها. كانت (بهيجة) فتاة ذات تربية شامية بكل معنى الكلمة، بأيام قليلة برهنت على أنها طباخة ممتازة، وخياطة تكاد تكون محترفة، تخيط لأختي تنانير وفساتين، فتركتها أمي تتصرف وكأنها سيدة البيت. إلى اليوم الذي أخذت فيه حقيبتها وغادرتنا دون أن تُعلم أحدًا، فلم نرها أو نسمع عنها، حتّى ذلك اليوم، الذي دخلت البيت، مع رجل، أحمر الوجه، وكثير الجلبة، يحمل بين يديه علبة حلويات طرابلسية، وهو يصيح ضاحكًا: «أين هو شكيب مصري هذا، الذي تهدّدني زوجتي (بهيجة) به؟».
اسمه (حمود سلالم)، عضو مجلس الشعب السوري آنذاك. صديق شخصيات سياسية وعسكرية مهمة، كتبت أسماءهم ثم محيتها، وكذلك مع العديدين من الكتاب والشعراء، كحنا مينه، وشوقي بغدادي، وممدوح عدوان، وعلي الجندي وسواهم. الذين كان يلتقيهم في دمشق ويستضيفهم، آكلين شاربين نائمين، في مطعمه (عين النبع) في جبلة. كلّ هذا أدى لقيام صداقة عائلية جميلة بيننا وبين عائلة (بهيجة) الجديدة، وصار عندنا عادة أسبوعية أن نمضي بسيارتنا البيجو الستيشن الذهبية إلى جبلة، مع جدتي وأحيانًا خالي (خالد) للعشاء والسهر عندهم، أنجبت (بهيجة) طفلين قبل أن يموت (حمود سلالم) بسكتة قلبية مفاجأة، ذلك الرجل الكريم، وذو النخوة، الذي سمعته يقول بداية أحداث الثمانينيات في سوريا: «سأفرح لو ينتصرون، ولا يهمني بعدها إن قتلوني». لن أنسى هذا ما حييت!
(زهيدة) ناقمة على العالم
اللاجئة الثانية، بقصة شبيهة، أبوها من عائلة سنّية معروفة في المدينة، تزوج، عن كبر، امرأة (علوية) وأنجب منها ثلاثة أولاد، ابنتين وصبي، ثم توفي! بعد وفاته تزوجت أرملته من رجل قريب لها، اشترط عليها هجر أولادها الثلاثة، ففعلت مضطرة، بعد أن سلمتهم لأقرباء زوجها الراحل. لكن العم الذي تكفّل برعاية (زهيدة) لم يستطع معها صبرًا أكثر من أشهر، فتركت بيته مطرودة من قبل زوجته، لتلتجئ إلى بيتنا مباشرة، بعد أن وصل إلى مسامعها أن أمي تساعد مثيلاتها دائمًا. وهذا ما حصل، دخلت (زهيدة) بيتنا، عمرها يزيد على العشرين، وعقلها يقل عن العاشرة! وفي قلبها نقمة لا حدود لها على كل شيء في العالم! قصيرة، ولولا القليل لكانت ذات ملامح قزمية!
أذكرها واقفة على المرآة تقول بصوت مرتفع: «لماذا يا الله لم تعطني عشرة سنتمترات طول؟» لم تكن تعرف تأدية أي من أعمال البيت، ما عدا الكناسة، التي كانت تقوم بها، كيفما اتفق، وهي تتمتم وتلعن حظها! تخرج من البيت دون أن تعلم أحدًا، لا إلى أين ولا متى ستعود. مسبّبة لنا مشكلات كثيرة مع جيراننا ومعارفنا، حتى إنها كادت توقع بيني وبين صديقي الشاعر (محمد سيدة)، لولا أنه بدوره وقع في مشكلة مع جيرانه بسببها. كانت تضع في جيبها أي شيء تطاله يدها، مهما يكن، باعتبار أنها تستحقه، حتى خاتم جدتي الذي ضاع ولم نعلم أين، إلا بعد أن أعاده لنا أحد أولاد الجيران الذي أعطته الخاتم.
مرة، بعد غيابها أكثر من أسبوع، جاءت الشرطة لتسألنا عن علاقتها بنا، فقد ألقوا القبض عليها مع مجموعة من الشبان والفتيات، في إحدى شاليهات المدينة السياحية، للاشتباه بممارسة أعمال غير أخلاقية. ولحسن الحظ، ما إن عرف الشرطيان المكلفان بالتحقيق أني ضابط مجنّد أخدم على الجبهة، حتى اكتفيا ببعض أقوالي وذهبا. وقصص كثيرة أخرى، لا أظن ذكرها يفيد أحدًا. ولكن (زهيدة) في النهاية استطاعت أن توقع في غرامها شابًّا طيبًا وتتزوّج منه، لتنجب أطفالًا في منتهى الجمال، كانت تأتي بهم إلى بيت أختي (منى) التي كانت على خلاف دائم معها، حتى إنها يومًا صفعتها صفعة لم تنسها أختي أبدًا، وأحيانًا نادرة إلى بيتي، لأنّ زوجتي الغريبة عنها، بعد زيارة أو زيارتين، راحت تعطيها ما تطلب عند الباب، دون أن تدخلها البيت. البارحة، وبعد كل هذه السنين، لا أقل من أربعين سنة و(زهيدة) لم تقطع علاقتها بنا، مرّت على محلّنا لبيع الأحذية، والتقطت أغلى حذاء معروض على الواجهة، وحملته من دون أن تستأذن أحدًا، حتى العاملة فيه، على أنها ستقدمه هدية لحفيدها، فهي، كما قالت، مسافرة لقضاء مدة أعياد الميلاد ورأس السنة، عند ابنتها المتزوّجة من عامل سوري يشتغل في بيروت!
(شفيقة) جنية حقيقية
اللاجئة الثالثة والأخيرة.. فتاة لم تتجاوز الرابعة عشرة، نحيلة، بثياب أقرب للأسمال، اقتحمت حافية، بوابة مدرسة السادس من تشرين الابتدائية التي كانت أمي مديرتها، هاربة من تحرشات أبيها في حي (الغراف) آخر حي الرمل الجنوبي، بعد خلو بيتهم بسبب سفر أمها وأختها الكبيرة إلى لبنان لإجراء عملية إجهاض غير شرعية للأخت. فكان على أمي الاتصال بالشرطة وإعلامهم. وبعد التحقيق وكتابة محضر الضبط، جاءت بها، على رغم معارضة بعضنا، إلى البيت. وما إن استيقظت (شفيقة) في اليوم التالي، حتى تبين أنها جنّية حقيقية قادرة على فعل أي شيء، تنظيف الطوان وترتيب الأغراض المتكوّمة فوقه منذ أعوام، تعزيل المطبخ وتنظيف فرن الغاز والبرّاد، توضيب الثياب في الخزن، الشتوي على حدة، والصيفي على حدة، جمع فردات الجرابات وتستيفها في الأدراج! مسح الغبار عن سطح كل شيء وجعله يتلألأ، كناسة وشطف ومسح أرض ودرج البيت، بهمة وسعادة ظاهرتين!
استوعبت خلال أيام كل شيء ما عدا أننا لا نعرف التكلم بالتركمانية مثلها، هي القادرة على التكلم بالعربية مثلنا! ولكن هذا لم يستمر أكثر من عام أو عامين، مرضت حينها أمي، لأول مرة في حياتها، وماتت بعد ثلاثة أشهر من المعاناة الصامتة. كنت خلالها خارج البلد. عدت، كابن ضال، ولم أجد أمي ولا (شفيقة). علمت أنها بعد مغادرتها لنا تنقلت لبيوت عدة، منها بيت خالي (غاندي) القريب من بيتنا، وكذلك بيت صاحب الملحمة التي تقع في الحي المجاور، وكان من أصول تركمانية مثلها، ثم تزوجت شابًّا كرديًّا، كما أخبرتني أختي وأنا أحاول التأكد بعض ذكرياتي الغائمة عنها، وسكنت في إحدى قرى جبل الأكراد، غير البعيدة، وصارت تفلح وتزرع الأرض وتقطف الزيتون، بالقدرة والهمة ذاتهما اللتين نعرفهما فيها. لاحقًا وصلنا من أخبارها، أنها ولدت أطفالها الثلاثة بنفسها، دون مساعدة أحد، وأن آخرهم هبط من بطنها وهي تعمل في الحقل، فقطعت حبل المشيمة بالحجر! زارتنا مرات قليلة مع أطفالها ذوي العيون التركمانية الجميلة المبطنة، التي ورثوها من أمهم، قوية ومنطلقة كما نعرفها. ثم ذابت كما يذوب الجميع، أسيادًا وخدمًا، رجالًا ونساء، آباء وأمهات وأبناء، في المجرى الهادر لنهر الحياة الجارف.
(ندى) خادمة العالم
كنت أستطيع، ببعض الجهد، أن أختم سرديتي هذه، بخلاصة ذات عبرة ما. إلا أني كما يجب على الأدب والفن بمختلف أنواعهما، ما عدا التلقيني، وقد يشمل هذا البريختي، سأدع استخلاص ذلك، للقرّاء أنفسهم، ليقوم كل منهم بالوصول إلى الاستنتاج الذي يراه من خلال معرفته وثقافته، وربما أيضًا، وهذا ما لا مهرب منه كما يبدو، سرديته الخاصة. بكل ما يمكن أن تختزنه من عاطفة، وألم، ومظلومية، يؤدي غالبًا إلى تفتق جراح شخصية، ومن الممكن جماعية، دامية. وها أنذا، كما بدأت بقصيدة، أنهي بقصيدة، ولكن ليست لي هذه المرة، بل للشاعرة السورية (ندى منزلجي)، من مجموعتها الأخيرة “بقع داكنة على ظاهر الكفّ” (2022)، وقد كتبتها بلسان خادمة أو خادمات عرفتهن الشاعرة، متلبّسة التفاصيل الدقيقة لأحوالهن وأحاسيسهن. فهي أيضًا، من عائلة لاذقانية محدودة الدخل، عملت عندها خادمات عديدات، كنّا قد قرأنا عنهن في أكثر من رواية من تأليف أمّ الشاعرة، الروائية المعروفة (ناديا شومان)، وأخصّ بالذكر روايتها الثانية: “خُطى كُتبت علينا” (1997)، التي تقدّم بدورها سرديّتها الإنسانية والخاصّة في آن، عن تلك العين البيضاء وهذا الجرح الممضّ:
خادمةُ العالم
أسكنُ هنا منذُ زمنٍ بعيد
هنا.. مكانٌ ما!
لا وقتَ لَدي للتُرّهاتِ
عملي أكنسُ القذاراتِ
ألمّعُ المخازي فتبدو كأنها ارتُكبَتْ للتوّ
أفتحُ مصارفَ البيت لتجرفَ مزيدًا من صرخاتِ الألم
أمسحُ الواجهاتِ الكبيرةِ من بصماتِهم
أزيلُ آثارَ الوجوهِ اللزجَة عن الزجاجِ
لديّ وظيفتي
أنا خادمةُ العالمِ
أعملُ ليلَ نهارَ
أسترُ نفسي بأثوابٍ واسعةٍ تصدّقت بها سيداتي الكثيراتُ
أرتدي واحدَها فوقَ الآخرِ
ثوبٌ مفتوحٌ من الخلفِ فوقَ ثوبٍ مفتوحٍ منَ الأمامِ
كيما تضيعَ التفاصيلُ
لا أعرّي جسدي المنكوبَ ولا أغتسلُ
أحتفظُ بما رأيتُ وسمعتُ
الأوساخُ تاريخٌ رديفٌ للعالمِ
جزّوا شعري المتلبِّدَ مثلَ ليفةٍ قديمةٍ
واستسلمتُ
كما أفعلُ دائمًا
لستُ أدري ما الذي خافوا منهُ
وأغرَقوه بالكاز؟
أرواحي الطفيليةُ مكتومةُ القيدِ
لا تمتصُّ دمَ سواي.
(اللاذقية 25/12/2022)
اضطررت، كارهًا، لتبديل بعض الأسماء التي ذكرتها في النص، لأسباب لا تُخفى على أحد. إلا أن بعضها الآخر صحيح حرفيًّا.

بواسطة منذر مصري - شاعر و كاتب سوري | يوليو 1, 2021 | فضاءات
كانوا، رجال أقوال، رجال معانٍ، رجال عهود، كانوا يضعون نصب أعينهم مقاصد، مقاصد بعيدة، لا يرونها غالبًا، ولكنهم كانوا يغذون السير إليها، حاملين، بأيديهم، على أكتافهم، في رؤوسهم، في قلوبهم، ما يثقل خطاهم، وينبت لهم أجنحة ويطيرهم، في آن.
كانوا، رجال دروب، دروب جديدة، دروب ليس عليها لافتات أو إشارات مرور، ولكنهم كانوا، كلما قطعوا مسافة أو غيروا اتجاهًا، ينصبون لافتاتهم ويضعون إشاراتهم. دروبهم لم تكن دروب من سبقهم؛ لأنهم لم يولدوا ليمضوا خلف أحد! أحدهم عصام محفوظ.
منذ ما يقارب، أو بالتحديد في 26/8/1974م، هكذا أرخت على صفحته الأخيرة، قرأت «الموت الأول» الصادر عام 1973م عن مؤسسة بدران وشركاه، بيروت- لبنان، للشاعر عصام محفوظ. وكتبت تحت التاريخ حينها: «أحببت موته الأول والأخير، ولكني لم أفهم العنوان، إنه لا يشبه صاحبه ولا ما احتوى بداخله»، وبقيت خمسًا وأربعين سنة، كلما عدت، إلى الكتاب، أستغرب عنوانه.
حينًا، كنت أفكر أن، كلمة (الموت)، (الموت) كمفردة، كانت إحدى المفردات الشديدة الدارجة تلك الأيام، وكذلك (الموت) كمعنى، (الموت) كموضوع، كان الأثير لدى شعراء وصفوا بأنهم تموزيون، يؤمنون بفكرة الموت والانبعاث، مثل جبرا إبراهيم جبرا: «تموز في المدينة» 1959م، وتوفيق الصايغ: «من الأعماق صرخت لك: يا موت» 1960م، ورياض نجيب الريس «موت الآخرين» 1962م، وبعدهم بول شاوول «أيها الطاعن في الموت» 1974م، وآخرين، أولئك، رجال الأقوال ذاتهم، رجال الدروب ذاتهم. من مضينا خلفهم، ونحن نسمعهم يغنون: «لم نخلق لنمضي خلف أحد». كتبوا قصائد كثيرة، وكتبًا كثيرة، كان الموت يحتلّ عناوينها، كنت أفكر أن هذا، ربما، ما جعل من «الموت الأول» عنوانًا. وحينًا آخر كنت أفكر، أن عصام محفوظ الذي جمع في كتابه هذا، مختارات من مجموعاته الشعرية الثلاث «أشياء ميتة» إصدار دار مجلة شعر 1956م، «أعشاب الصيف» دار مجلة شعر 1961م، و«السيف وبرج العذراء» دار مجلة شعر أيضًا 1963م، إضافة إلى ديوان كامل لم ينشر سابقًا، كتبت قصائده من عام 1963م إلى عام 1967م، وهو القسم الرابع من الكتاب، عنوانه «الموت الأول»، وقد سمى كل كتابه، بهذا العنوان.
وكان كلا التفكيرين، الظنين، يدعم ويساند الآخر لفهم وقبول العنوان، إلّا أنّني بقيت لا أرتاح له، ربما لكوني لم أحب مفردة الموت يومًا، واستخدامي المتكرر لها، لا يعني العكس، وربما لأنني كنت أشعر، في الوقت نفسه، بأن هناك شيئًا فيه يتخطّى علاقتي بالموت، حبي وكرهي له، كمفردة أو كموضوع، شيئًا لا أراه، ولكنه موجود. غير ظاهر، ولكني أُحسُّه.. يلمسني. الآن وبعد كل هذه السنين، أعود إليه، للمرة التي لا يجدي تعدادها. وفجأة، وبينما كنت لا أفكر في شيء، رأيته، أبصرته، المعنى الذي بكل وضوح كانت تحمله هاتان الكلمتان، هذا المعنى الذي كنت أنظر إليه، العين بالعين، ولا أراه، وها أنذا أفكر، كم كنت غبيًّا؛ لأني احتجت كل هذه السنين لأدركه، هذا المعنى الذي كان يجب علي، منذ البدء، وأنا أعرف أي صنف من الشعراء كان عصام محفوظ. أن، بكل سهولة وبساطة، التقطه.
«الموت الأول» يعني أن عصام محفوظ يعلن موته الشعري. يعني أن شاعرًا يقف في الصف الأول للشعراء الطليعيين العرب، شاعرًا من أربعة أو ستة شعراء يحتلون أهم واجهة شعرية عربية تلك الآونة، أعلن، ليس موته كشاعر فحسب، وهذا لا أظنه بقليل، بل موت الشعر، كل الشعر، وبأنه تحول إلى: «وسيلة أشد تأثيرًا وأشد نجاعة في مواجهة، التفاعل مع، تغيير، واقع»، واقع دفعه مرّة لقول، يبدو الآن في غاية البراءة، إن لم أقل في غاية السذاجة: «من هنا تأكيدي أن الشعراء الحقيقيين في هذه المرحلة هم الشهداء»، ولكن هذا القول أيضًا يحمل معنى آخر، ربما بدوره يتفتح ويتكشف لي الآن، وهو ليس كما فهمت أول الأمر، من السياق الكلام لا من تدرجه، بأنه يجعل الشهداء، شهداء الجسد والدم، هم الشعراء الحقيقيون، بل العكس، أي أن الشعراء الحقيقيين، هم الشهداء، شهداء الكلمة والمعنى.. هكذا يفهم إعلانه موته كشاعر.. استشهاده، ولا أجد في هذا التعبير أي مبالغة، إذا حصرنا الكلام بالشعر الحقيقي والشاعر الحقيقي.
… هكذا كان على عصام محفوظ أن ينتحر! ولكنه كان أيضًا أشد وعيًا وصلابة من أن ينتحر كإنسان، كحياة، فقط انتحر كشاعر، مختارًا حياةً أخرى، ووسيلة أخرى للبقاء والرفض والمواجهة. و«بغية إيصال صوته إلى الغير»، المسرح الذي رأى أنه بوضوحه ومباشرته لا يشكل، كالشعر حصرًا، حاجزًا يمنع رؤية الخنجر الموجه إلى الصدر، بل يجعلنا نراه بشكل أشد جلاء.
هجرة الشعر إلى المسرح

بدر شاكر السياب
ما يهمني في الكتابة عن عصام محفوظ، ليس ما آلت إليه أفكاره ولا تجربته المسرحية والنقدية، لأنني وبكل بساطة، على الرغم من إعجابي الشديد بقدرته على توجيه مصيره، فلا أوافقه إطلاقًا على ما ذهب إليه. وليس لديّ دليل أفضل على خطل قراره، سوى ما هي عليه مكانة الشعر والشعراء بالمقارنة مع مكانة المسرح والمسرحيين في الواقع العربي اليوم. الواقع المتبدل الذي يفرض تبدله علينا، على حد تعبير عصام، تبديل الوسائل والأدوات؛ ذلك أن هذا الواقع بكل تحديداته قد لفظ المسرح، وبخاصة الجاد منه، إلى أبعد هوامشه وأقلها تأثيرًا. أقول ما يهمني في الكتابة عن عصام محفوظ، ما دفعني، بعد كل هذه السنين، إلى الكتابة عنه، هو شعره، شعره فحسب، هو كونه شاعرًا، شاعرًا حقيقيًّا، وهو الأمر الذي لا يذكره إلا القلة القليلة، حتى من جانب رفاق الطريق، الذين، وهم يستعيدون ذكرياتهم، مرارًا وتكرارًا، نادرًا ما يأتون على ذكره شاعرًا! حتى إني، رغم بحثي الشديد في المواقع الشعرية أو الأدبية أو الثقافية العامة، لم أجد قصيدة واحدة له منشورة في عالم الإنترنت، هذا الذي مجانًا يحتوي على كل شيء! لماذا؟ أنا لا أظن نسيانه سهلًا إلى هذا الحد!
وها أنذا أجد الفرصة لأن أقول، ما رغبت مرارًا أن أقوله عن هذا الكتاب، وعن التجربة الشعرية لعصام محفوظ، أو حتى عن مجموعات هي مفاصل مهمة في تجارب شعراء كبار أمثال بدر شاكر السياب، وتوفيق الصايغ، وجبرا إبراهيم جبرا، أو يوسف الخال، وأنسي الحاج، وشوقي أبي شقرا، أو حتى أدونيس، ومحمد الماغوط، في أنه، مرّة يهولك، الشعر العظيم فيه، ومرّة، تقلّبه بين يديك طويلًا، ولا تجد فيه ما يستدعي التوقف عنده. ثم في مرة ثالثة، تعود وتكتشف أن فيه قصائد كتبت على نحو يخلو من أي نقيصة. وهكذا مرة تحب الكتاب، ومرة، ربما، تكرهه. إلى أن يأتي يوم ما، كما حدث لي هذه المرة، ويتكشف لك الكتاب، وكأنك لم تقرأه من قبلُ. وكأن كل تلك الأحاسيس المتضاربة التي قرأت بها كلماته وسطوره وقصائده، لم تكن لتحط على إحساس شبه أخير مختلف لدرجة أنك نفسك تندهش له!
تصفية حساب نهائية مع التجربة
من مجموعة «أشياء ميتة» 1959م، إلى «الموت الأول» 1973م، مرورًا بـ«أعشاب الصيف» 1961م، و«السيف وبرج العذراء» 1963م، الثلاث الأولى منها إصدار دار مجلة شعر، هناك شاعر حقيقي ذو مسيرة تستحق أن تدرس كنموذج له دلالاته في الشعر العربي المعاصر. فمن الرومانسية الظاهرة شكلًا ومضمونًا في القصائد الأولى، إلى رؤيوية تموزية مشوبة باهتمامات دينية وإنسانية، ومن ثم إلى أفق مفتوح على مضامين متنوعة، غنية، تكاد لا يمكن تأطيرها. مع ما يتطلبه هذا التنوع الغني من أساليب في القول الشعري، هجر بها عصام محفوظ الإيقاع والقافية اللذين بدأ بهما في كتابه الأول، وتابع بتطوير لافت في الأداء، حتى بداية المرحلة الأخيرة، حيث افتتح القسم الرابع من «الموت الأول» بقصيدة من ثلاثة أسطر، ينزع فيها النقطتين من فوق التاء المربوطة، بعنوان «نهاية»:
«نهايتي بارده
مهجورةٌ
مثل بقايا المائده» (ص95).
وكأنه يودّع بها أسلوبه القديم، بشيء غير قليل من الأسى. متجهًا، وعلى نحو لا تردد فيه، إلى نثرية، أدهشني أنها لم تحتج منه، في نتاجه المنشور على الأقل، أي مقدمات تمهيدية للنضوج والخصوصية في آن. ففي قصيدة «تعب في الثاني والثلاثين من كانون» التي تتلو قصيد «النهاية»، ومنذ سطورها الأولى يظهر بوضوح التركيب النثري للكلام، وبخاصة في السطرين الأخيرين من المقطع:
«تركت على بابِكَ كلَّ شيء
جنياتِ الدارِ والمزامير
طائراتٍ ومراكبَ من الورق
تركت على بابِكَ كلَّ شيء
أمس عندما تركتُكَ».
ولكن السؤال: هل صحيح أن نهاية عصام محفوظ، نهايته الشعرية، مهجورة وباردة؟ أم أنه مجرد إحساس شاعري حزين أراد أن يبادرنا بقوله، ليصادر رأينا بما آلت إليه تجربته الشعرية، التي حكم، هو بالذات، عليها بالموت! مبررًا ذلك بظروف عامة لم تدفع بغيره إلى ذات القرار، ولم تمنع من ولادة المزيد من الشعراء؟ هل صحيح أنها مثل بقايا مائدة قام عنها المدعوون، منذ زمن كافٍ لتصير باردة، أم إنها، بالعكس مائدة لا تنضب، مثل الوليمة التي أَوْلَمَ بها السيد، فأكل أربعة آلاف رجل، ومن معهم من النساء والأطفال، حتى شبعوا.. من سبعة أرغفة؟ ولكن «الموت الأول» يدعونا إلى وليمة بأطباق كثيرة، وأحسب أنه نادرًا ما يتوافر لدينا نحن العرب كتاب يقدم، بهذه الطريقة، الحصيلة الإبداعية لأي شاعر عربي.
أمّا «الموت الأول» فليس فقط مختارات قام بها الشاعر نفسه، وأضاف إليها العديد من المقالات النقدية التي كتبت عنه وعن قصائده، بل هو أشبه بتصفية حساب نهائية، على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام في آن، لتجربة شاء صاحبها أن يغلقها تمامًا. إنه كتاب يرينا، كالقصص المصورة، خطوات الشاعر في طريقه إلى الهاوية، هاوية الصمت، ثم إلقائه بنفسه. هكذا وكأنه يقوم بعمل بطولي، في حضن هذه الهاوية العميقة لدرجة لا يسمع بها صوت ارتطام في القاع. هذه الخطوات التي أستطيع أن أراها تمضي في بادئ الأمر، صعودًا حتى القمة، ثم لا أدري ماذا رأى الشاعر من عليائه. أو لأقل: لا أدري ماذا كان يتوقع أن يرى، فنظر وحدّق ولم يجده.

أدونيس
فما كان منه إلا أن ألقى بحمولته من هذه القمة وهبط. وفي نيته أن يصعد إلى قمة أخرى لاحت له. ولكن بعيدًا من هذه التلميحات والتشبيهات، بعيدًا من كل هذه العموميات والأحكام، السؤال هو: «إلامَ انتهت تجربة عصام محفوظ الشعرية؟ هل ما كتبه في «الموت الأول» يقدم الدليل على شعرية حقيقية؟ شعرية استطاعت الوقوف، جنبًا إلى جنب، مع شعرية يوسف الخال، وأدونيس، وشوقي أبي شقرا، وأنسي الحاج، متساوية القامة معهم، ومتفردة وخاصة مثلما هم متفردون وخاصون؟ الجواب: لا ريب… نعم.
وهذا ما دفع عباس بيضون إلى أن يقول لشاعر شاب قدم له دراسة عن الجسد في الشعر اللبناني: «أين عصام محفوظ؟ كيف تكتب عن الشعر اللبناني ولا تذكر شاعرًا بقامة عصام محفوظ؟» إلا أنه كان للشاعر الشاب وجهة نظر أخرى، وهي أن استمرار أي شاعر في الوجود في الساحة الشعرية، يقتضي منه متابعة كتابة الشعر، ومتابعة نشر قصائده، وإصدار مجموعة شعرية، كل عدد من السنين. فتعيد أعماله الجديدة ذكره، وتزيد من الاهتمام به. وكان عصام محفوظ وقتها قد توقف عن كتابة الشعر منذ ما يقارب أربعة عقود. أي ربما قبل أن يولد هذا الشاب ومعه جيل كامل أو جيلان من الشعراء الجدد. أي أن عصام محفوظ ما عاد شاعرًا حاضرًا، وأن شعره، نتيجة حتمية التغير والتطور، بات قديمًا و… ميّتًا.
الإبداع لا يموت
قلت هذه وجهة نظر الشاعر الشاب ذاك، وأزيد وأقول: إنها ربما وجهة نظر السوق الأدبية عامة؛ إلا أنه لم يكن صحيحًا البارحة، وليس صحيحًا اليوم، ولن يكون صحيحًا غدًا، أن الزمن بكل أسلحته قادر على محو، قتل، إبادة، الشعر. وليس قهر الزمن حكرًا على الفن فقط، بل حتى في المجالات والحقول التي يرى بعضٌ أن جديدها يقتل قديمها، وينهال عليه بتراب الماضي. ففي حقول الفلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية، حتى في الجغرافيا؛ كل خطوة، كل درجة، كل حلقة، كانت حاجة وضرورة. حتى الخطوات الخاطئة، والدرجات المكسورة، والحلقات المفقودة، كان لا بد منها لمعرفة الصواب والحقيقة، وكان لا بد منها للتقدم. فما بالك في الشعر، وفي الرسم، والمسرح، في الفن الذي لا يفرق بين الخطأ والصواب، بين الحاجة والشهوة، الفن الذي لا يعترف بتأخر أو بتقدم. مَنْ يعرف الكثير مِنْ فلاسفته، لا يتوسل فكرة التطور؛ لأنه في جوهره لا يعترف بالزمن، لا يعترف بذلك التسلسل الوهمي من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل.
الفن في جوهره الأعمق، في حقيقته العليا، يريد ويفعل كل شيء لأن يكون خارج هذه الدائرة المغلقة، التي لا تنفك تلف، تدور، كدولاب المطحنة، جاعلة كلّ شيء طحينًا. هذا الجهد المشتعل بالرغبة والتوق الذي بدأه البشر منذ أن وجدوا، منذ بدايتهم كبشر، فردًا فردًا، جماعةً جماعةً، حضارة حضارة، للتغلب على الزمن وقهره، وللتغلب على الموت، والبقاء في ذاكرة من سيأتي بعدهم. أي في حياة، في روح، من سيأتي بعدهم. وإذا كان هناك نتاجات أدبية، ولم يجد فيها البشر ما يبقيها حية وخالدة في ذاكرتهم وفي وجدانهم، فرموها، أو أضاعوها، فالسبب أنها في الأصل لم تكن فنًّا، لم تكن إبداعًا، لم تكن خطوة، حلقة. الحقيقة التي أرى أن كل شيء يخضع لها، هي أن الإبداع لا يموت.
تعب في الثاني والثلاثين من كانون
فلنعد، مرة أخرى إلى بيت القصيد، إلى موت عصام محفوظ الأول، وإلى السؤال: هل هو حقًّا موت؟ أم هو موت حي لا يموت؟ من دون اعتذار لكثرة استخدامي هذه الكلمات الإنشائية والصفات الثقيلة؛ لأن عصام محفوظ، من يدفعني إليها! هو المتواري خلف ظهرانينا، متظاهرًا بأنه لا يعرف ماذا فعل؟ ولنعد أيضًا إلى قصيدة «تعب في الثاني والثلاثين من كانون» (ص 97) مبتدئين بنهاية المقطع الأول منها:
«تركت على بابِكَ كلَّ شيء
أمس عندما تركتُكَ». (ص99).
حيث يبادرنا الشاعر، كما ذكرت سابقًا، بكلام يخلو من أي افتعال أو تزويق في اللغة، لا في الكلمات ولا في التركيب، ليقدم لنا بكلام شبه تقريري، معنى عميقًا على الصُّعُد كافة، الشخصي منها والعام، الشعوري والفكري؛ لأنه، كيف يترك المرء كل شيء حين يترك أحدًا؟ مَنْ هذا الذي يترك المرء كل شيء على بابه إذا تركه؟ ثم ماذا يفعل تارك كل شيء بعد ذلك؟ إلى أين يمضي؟
«كلَّما توغلت
لمحتُ ظلَّكَ ورائي» (ص100).
فعلى الرغم من تركه له بالأمس، وتركه كل شيء على بابه، فإنه يلحق به، كلّما توغّل، ليس بعظمه ولحمه، لأنه ربما ليس من عظم ولحم، بل بظله! فيصير ظلُّ التارك ظلَّ المتروك، أو ربما يصير التارك هو المتروك نفسه!
ولأخطو الآن إلى بداية الفقرة الثالثة من القصيدة:
«ثِمارُ الشتاءِ والصيفِ بينَ عَيني
الشمسُ والخريفُ بينَ عَيني» (ص 100).
كلام كهذا، بالتأكيد، ليس قابلًا لا للتحليل ولا للتحلُّل! عصيّ إلا على الشعور. وإذا أردت الكتابة عنه، فأنا لا أقوم إلّا بوصفه وطرح الأسئلة حوله. فثمار الشتاء والصيف ليس بين يديه، بل بين عينيه! وكذلك الشمس والخريف، مبدلًا الربيع بالشمس بين عينيه والخريف أيضًا، ثم يتابع:
«وذهبُ العالمِ كلُّه
وأنا وأنت» (ص 100).
من دون أن يضطره شيء لاستخدام أي فعل، أو ضمير منفصل، ليقيم بينها الرباطات اللازمة، أو التي يخيل لنا أنها لازمة، إلا أنه من دونها نجد النص يزيد من ترابطه حتى كأنه يلتحم، كأوصال جسم، كلحم. أما في الفقرة التالية، فهو يحدد ما يفرق وما يجمع (أنا) و(أنت):
«بيني وبينَكَ علامة
مسرحٌ مُتنقِّل
سيفٌ من فِضَّة
غرابٌ ضائع» (ص 101).

شوقي أبي شقرا
يبدو جليًّا هنا قدرة صاحب هذا الكلام على أن يحضر من خزانته ما ليس مطروحًا في الطريق، حسب مقولة الجاحظ الشهيرة، وملقى به بين أيدي الناس أجمعين. وقدرته أيضًا على إثارة الدهشة عند قارئه، بطزاجة وطرافة إحضاراته. فالعلامة الأولى: «مسرح متنقل» مع غرابة ذلك وغناه، تبعه بشيء لا ندري من أين جاء به، ربما من ذكرى خاصة: «سيف من فضّة»، بالتأكيد لا يصلح كسلاح. ثم يحطّ على النص، من حيث لا يتوقع أحد، أكثر ما أحببته في النص: «غراب ضائع»!
أما في المقطع الخامس، فهو بدوره يبدؤه بجملة تقريرية، إخبارية، لكنها بالتأكيد تقبض على ما هو جوهري في كلِّ فن، ألا وهو المعنى الشعري:
«أحباؤك كثر ولا يعرفونني» (ص 101).
إنه يقول لنا: إن أحباء (أنت) كثر، لكنه غريب عنهم، ولا يعرفونه، بل ربما ينكرونه أيضًا، بينما:
«وأنا أرى وأنسى» (ص 101).
تتوالى على مدى القصيدة لغة مشغولة بحرص زائد على أدواتها ودلالاتها، متقشفة للحد الأقصى، متعففة عن كل زركشة وافتعال، إلا أنها وفي الوقت ذاته تعمل بكل أدوات الشعر الحقيقية لتصوغ معانيها القريبة منها والنائية:
«عندما أضع يدي
على يدي
على يدي
وعندما أغرقُ في المرآة
أراكَ.
/
عندما يمسكني الغناء
أحسُّ لهاثَك.
/
أسابقُكَ مع الداخلين
أسابقُكَ مع الخارجين
…
أخونكَ في الساحاتِ
في المقاهي
في الدكاكين والأسواق
مع الناس ومن دون الناس
مقابل شيءٍ مقابل لا شيء
فتغفر لي» (ص 102-106).
تنتهي القصيدة بإشارة إلى طرف إصبعكَ المقدسة. إنها إذن عن ذلك الذي لا يحتاج لأكثر من طرف إصبعه ليقوم بأي شيء! طرف الإصبع المقدسة ذاتها التي لمس (أنت) بها (أنا) في لوحة مايكل أنغلو (خلق آدم 1508 -1512م) المرسومة على سقف كنيسة سيستين.
الزمانان الضائعان
القصيدة الثانية من الموت الأول عنوانها: «التفتيش عن الزمن الضائع» (ص 109)، الذي لا يمكن إلا وأن يذكرنا بعنوان رواية مارسيل بروست الشهيرة «البحث عن الزمن الضائع»، وهي مثلها مقسمة إلى سبعة مقاطع. إلا أنه إذا تخطينا قصيدة «فاصل احتفالي»، فإننا سنعود إليها بعد إضافة كلمة واحدة إلى العنوان «العودة إلى التفتيش عن الزمن الضائع»، ولكنها هذه المرة من خمسة مقاطع، رقّم أولها (IIX)، فتبدو كأنها منتقاة من بين مقاطع أكثر عددًا من كلتا القصيدتين، أرى أن عصام محفوظ يبلغ بها مداه الأبعد في الاختلاف والتميز عن تلك الكوكبة التي ينتمي شعره إليها. خالصًا، باستيعابه الجلي لإنجازات الشعر العربي الحديث حتى ذلك التاريخ، وأخص بالذكر شعراء مثل أدونيس (أغاني مهيار الدمشقي 1961م)، وتوفيق الصايغ (معلقة توفيق الصايغ 1963م)، وجبرا إبراهيم جبرا (المدار المغلق 1964م)، ولا بد أن نذكر اسم أنسي الحاج (ماضي الأيام الآتية 1965م)، إلى صياغة شعرية، بمقدار ما هي خلاصة عامة لتلك الإنجازات، بقدر ما هي خلاصة شديدة الخصوصية به. ومرّة ثانية، سأقوم بإثبات ذلك بعيّنات متسلسلة من هاتين القصيدتين.
* * *
«أنام
أتألق
في ذاكرتي بقيةُ صيف أخير
دموعٌ متساقطةٌ وتمتمات
أستطيعُ موازاةَ أظافري بحدودِ جبلِ الموت
أسمع أيضًا الصوت
يشق الطريق عبر أغصانِ الصفصافِ المائل» (ص 112).
أول ما يمكن ملاحظته، كيف أنه يقوم بتراكم نوعي لا كمي في الصورة، فهو لا يقول: «أنام… أفيق» أو «أنام.. أموت»، بل «أنام.. أتألق» تألق الدموع المتساقطة في ذاكرة صيف أخير. فيصير باستطاعته، حينها، موازاة أظافره بحدود جبل الموت! الصورة الغريبة التي توحي لنا أنه في حلم، تتبعها صورة حلمية أخرى، سماعه صوتًا يشقُّ الطريقَ عبرَ أغصانِ الصفصاف المائل!
* * *
«منسيَّةٌ كرمة الأحاسيس
منطفئةٌ على الماء
لكن من الجالسُ بجانبي
العين المهجورة مفتوحةٌ على الدهاليز
لكن لمن تلك العين
…
حيث الكلسُ المتفتِّتُ يرسمُ في الجدران
رؤوسًا بشريةً
مشدودة الشعرِ بمجاذيفَ ومراكب مقلوبة» (ص 115-116)
 فبعد أن يخبرنا أنهم «حوشوا الكروم كلها» (ص 114)، يستدرك «كرمة الأحاسيس المنطفئة على المياه» التي لم ينتبه لها أحد، فنسوها وتركوها. ولا أدري هنا، إن كان يقول هذا تحسّرًا عليها، أم إنه مغبوط بعدم حواشهم لها؟ أولئك الذين حوشوا البلاد كلها، بلحمها وعظمها، وأحلامها وكوابيسها، فينتبه إلى أن أحدًا، لا يدري من؟ يجلس بجانبه، على طرف سريره، والعين (عين الماء) المهجورة مفتوحة، لا على البساتين والحقول، بل على الدهاليز! ليعيدنا مرة ثانية إلى لوحة أخرى لمايكل أنغلو «الحساب الأخير» حيث كلس الجدران قد رسم بتفتته رؤوسًا بشرية مشدودة الشعر بمجاذيف ومراكب مقلوبة.
فبعد أن يخبرنا أنهم «حوشوا الكروم كلها» (ص 114)، يستدرك «كرمة الأحاسيس المنطفئة على المياه» التي لم ينتبه لها أحد، فنسوها وتركوها. ولا أدري هنا، إن كان يقول هذا تحسّرًا عليها، أم إنه مغبوط بعدم حواشهم لها؟ أولئك الذين حوشوا البلاد كلها، بلحمها وعظمها، وأحلامها وكوابيسها، فينتبه إلى أن أحدًا، لا يدري من؟ يجلس بجانبه، على طرف سريره، والعين (عين الماء) المهجورة مفتوحة، لا على البساتين والحقول، بل على الدهاليز! ليعيدنا مرة ثانية إلى لوحة أخرى لمايكل أنغلو «الحساب الأخير» حيث كلس الجدران قد رسم بتفتته رؤوسًا بشرية مشدودة الشعر بمجاذيف ومراكب مقلوبة.
* * *
«الطائر يمرُّ
فوق أزهار المتعةِ الجافة
وأنا أجمعُ الأمورَ السالفةَ في المرآة
…
لا ألمحُ أنفَكَ المُضيء» (ص 118).
لا أعتقد أن شعرًا كهذا من الممكن أن يُتَخَطَّى من أي جهة، وبأي طريقة، لا بل أظنه بذلك الجمع للمعاني والأحاسيس، للصور والمشاهد، يقدم نموذجًا لأسلوب يكاد أن يخلو من أي نقص يفسده. وذلك حتى في استخدام أشد أدوات الشعر صعوبة، ولنأخذ مثلًا في متناول اليد على استخدام الصفة، التي كان جبرا إبراهيم جبرا كناقد يشدد على تجنبها ما أمكن في الشعر الحديث: «أزهار المتعةِ الجافة» (ص 117). فهو أولًا ينبتُ للمتعة أزهارًا وهي استعارة حسية واضحة، ثم يُطلِق صفة (جافة)، فلا نعرف ما إذا كان يقصد، الأزهار؟ أم المتعة؟ ولكنه، بكلا الاحتمالين، يحافظ على طبيعة الأشياء بكون الأزهار تجف، وعلى طبيعة الأحاسيس، بكون المتعة أيضًا قابلة للجفاف. أما صفة (السالفة) فهي صفة نوعية أخرى، أي أنه ليس سواء أن يأتي الكلام بها أو بدونها، أو أن حذفها يريح النص ويحسنه. بل هي هنا، رغم غرابة صورة جمع الأمور في المرآة، أقرب ما تكون إلى الكلمة السديدة التي يتكلم عنها تي. إس. إليوت. ثم وعلى نحو ثالث تأتي صفة (المضيء)، وهي هذه المرة صفة مشهدية، بصرية، ولكنها أيضًا انتقائية! ففي عتمة حجرة الاعتراف، لا يفتقد الخاطئ المعترف بذنبه، لمعة عين الكاهن ولا فمه، بل لمعة أنفه.
* * *
«لم تترك الريح حصى على الممرات
…
أيْ مليكي
كلُّ الثواني تدلت أجراسًا
النجمةُ تتأرجحُ على رؤوسِ الملوكِ الثلاثة
مُحمَّلينَ بالمرِّ واللبان
للطفلِ الميِّتِ في المذود
…
الأمُّ التي لا تظهر
تبكي بلا نشيج» (ص 122).
وكأن الشاعر هنا يطيل النظر في صورة ما، لمنظر ما، فيرى أن الريح قد أخذت، ليس الأوراق والتراب، بل حتى الحصى التي كانت على الممرات. ما يأتي بعد هذا يعلمنا أن الصورة التي يحدق بها الشاعر، هي مشهد قدوم ملوك المجوس الثلاثة مستدلين بنجمة بيت لحم إلى المغارة التي ولد فيها السيد المسيح!
* * *
«الرجلُ المقبلُ عبر غمامتين
يدندنُ النشيدَ العسكري!» (ص 123)
نستطيع أن نعُدّ هذين السطرين من المقطع السادس، دليلًا على ذكره المخرج جلال خوري، بأن العسكر هو دائمًا المستهدفون في أعمال عصام محفوظ. ولكنه هنا، ببساطة يبين لنا خيبته بمجيء المخلص! حيث إن الرجل المقبل عبر غمامتين، يدندن، بكل بلادة، نشيدًا عسكريًّا!
* * *
«الظلُّ يضمحل
يلتصقُ بمملكةِ الأشياء الأليفة
…
قلبي يقطر بالمر
وأنا وأنت
نستعيدُ الصلواتِ الأولى
وبقية الأشكالِ المترائية من بابٍ نصفِ مفتوح
نمزجُ كلَّ آتٍ بعسلِ العينِ المُطبقة
…
أي مليكي
أتبعكَ بين الأوراق المتساقطة
تحت سماء الأشياء الغامضة
والمزق الململمة
…
لكن أين أنت
..
تقذفني إذن بالمجمرة
وبقية الرماد» (ص 126).
وكأن هذا المقطع، مجزوء، أو متمم لقصيدة «تعب في الثاني والثلاثين من كانون»، يعود به الشاعر إلى مخاطبة (أنتَ)، متابعًا مزجه للذهني والحسي في كأس واحدة، أو لأقل شبكه البصري والمعنوي في ضفيرة واحدة! ففي «بقية الأشكالِ المترائية من بابٍ نصفِ مفتوح – نمزجُ كلَّ آتٍ بعسلِ العينِ المُطبقة»، ومن حيث لا ينتبه له إلا ذو العين المحدقة بالكلمات، يتبادل الباب وضعية المطبق مع العين نصف المفتوحة! وذلك ليكون من الممكن مزج كل ما هو آت، المرّ الذي يقطر من قلبه، بعسل هذه العين. فماذا يكون جواب (أنت) على هذه الصلوات غير أن يقذفه بالمجمرة!
لكن ما لا يجب غض النظر عنه، وكأنه كان تبشيرًا بالقطيعة التي قام بها عصام محفوظ للشعر ولجوئه لخشبة المسرح كخشبة خلاص، أنه في القصيدتين اللتين لم آت على ذكرهما في «الموت الأول»، إلا عرضًا: الأولى: «الفاصل الاحتفالي»، والثانية والأخيرة من الكتاب: (القصيدة ذات الصوتين)، هو استخدام عصام محفوظ الباكر للحوار فيهما. بين الولد والأهل في الأولى (الفاصل…)، حيث لا يجد الأهل المتعطشون للدماء ما يردّدونه سوى جملة «نريد ذبيحة»:
«الولد:
لأجلِ ألا يموت الموت
وتظلّ الكلماتُ ستارًا ومعجزة.
الأهل:
نريد ذبيحة» (ص 133).
وبين الصوتين في القصيدة الثانية، حيث بدوره يردّد الصوت الثاني دائمًا، وعلى نحو تصاعدي: «أسرع.. أسرع أسرع.. أسرع أسرع أسرع» مسبوقة أحيانًا بملاحظة مقتضبة عمّا يقوله الصوت الأول! وهو يتنقل من صورة إلى أخرى ومن معنى إلى آخر. فإذا رغبنا في حذف تدخلات الصوت الثاني وأوامره بالإسراع من سياق القصيدة الراكض المقذوف إلى الموت، لصار لدينا:
«مفتوحة الرحم تنتظرُ في جوارِ الأبدية
ضفيرتاها صراخُ البراكين
مقاعدُ مقتلعةٌ
وحزنٌ أبيضُ كالليل
آه..
عندما أخرجتُها من ضلعي ذلكَ النهار
جبلتُها بيديّ
جعلتُ فمَها أعجوبة
كنا نصطلي
الأيامُ ممدَّدةٌ إلى جانبي
وأنا أغذُّ السيرَ
بعينينِ نصفِ مغمضتين
الأرضُ متروكةٌ للذئاب
كنتُ أمضغُها
أهيئها لزمنِ الغفران
طرفُ اسمِها عالقٌ بأسناني
واسمي مقوسٌ على فخذِها
فككتُ اسمَها
ربطتُ بهِ جسدي
ربطتُ بهِ الكواكب
قويٌّ على ذهبِ العالمِ كلِّه
العالمُ ذو الحراشفِ
الذي ينزلقُ من
أصابعي» (ص 155- 159).
وأحسب أن فكَّ أسرار هذه القصيدة، هو أفضل ما يمكن أن أختم به قراءتي المتأخرة لذلك الموت.. الحي، الذي كأنني سمعته، وأنا بين اليقظة والنوم، في نشرة الأخبار الصباحية هذا اليوم.
اللاذقية 2006 – 2021م

بواسطة منذر مصري - شاعر و كاتب سوري | نوفمبر 1, 2019 | نصوص
1- مَرثيةُ اللامُبالي
(لا يهمُّني أيّ نوعٍ من الطيورِ سأكون، سئمتُ الالتصاقَ بالأرض).
هذا ثالثُ عُصفور
أو خامسُ عصفور
أو عاشرُ عصفور
أو
في الحقيقة
لا أذكرُ عددَ العصافيرِ الَّتي رأيتُها
تموتُ في هذا المكان.
/
ودائمًا
بسببِ حالةٍ مَرضيّةٍ غامضة
يدَّعي صديقُنا
أنْ لا يدَ لهُ فيها ولا حيلةَ
بل بالعكس
فلطالما كانَ همُّهُ الأوَّلُ انقاذَها
تموتُ عصافيرُهُ
عصفورًا
عصفورًا.
/
العصافيرُ كائناتٌ هشَّة
ما إن يُصيبَها عارضٌ ما
حتّى تتكوَّمَ وتموت
ولَطالما سمِعتُهُ يُردِّدُ: «العصافيرُ تموتُ
داخلَ الأقفاصِ وخارجَها
ولا أحدَ غيرَ اللهِ
يدري لماذا؟».
/
«إذا ماتَ هذا العصفور
فسوفَ أُحطِّمُ أقفاصي كلَّها
وسيكونُ
أُقسمُ أمامَكم
آخرَ عصفورٍ أبتاعُهُ في حياتي».
/
في مناسبةٍ كهذه
لا يجدُ المرءُ شيئًا خاصًّا ليقولَهُ
سوى بعضِ التمتماتِ مع هزِّ الرأس
إلاّ أنّي اكتشفتُ أمرًا هامًّا
يستحقُّ أن أطلعَكم عليه
هوَ أنَّهُ بقدرِ ما يُحزِنُنا ويُحطِّمُ قلوبَنا
موتُ العصافير
بقدرِ ما نستعجلُ التغلُّبَ سريعًا
على أحزانِنا
عائدينَ بعدَ دقائقَ قليلةٍ إلى مشاغلِنا
وكأنَّ شيئًا لم يكُن.
/
الطيورُ بمُختلفِ أنواعِها
ومُختلفِ أحجامها
لم تُخلق لتحيا في الأقفاص
هذهِ حقيقة
لا أدري أيَّ عماءٍ أصابَ البشر
حتّى لا يرَوها
ومن ثَمَّ يدعوها وشأنَها.
/
خُلِقت الطيورُ (يُخرجُ كلتا يديه من جيبي بنطاله، ويمدّ ساعدَيه على مداهما ويخفقُ بهما عدّةَ خفقات، وهو واقفٌ في مكانه)
لتطير
وتطير
وتطير
ليسَ صُدفةً
وليسَ عبثًا
أنَّ اللَّهَ وهبَ لها
أجنحة..
* * *
2- مرثية الصيّاد:
(ليس البشر، سوى طيورٍ بلا ريش)
لا تُطعِمهُ سوى كَسراتِ الخُبز
هذا ما قُلتُهُ لهُ مِرارًا
ولم يفعل
ويا لَها من حُجَّةٍ واهية
تلكَ التي تذرَّعَ بها
وهو يحشو له بطنَهُ بأيِّ شيءٍ يتوفَّرُ لديه
وكأنَّه وجدَ به مصرفًا
للطعامِ البائتِ
الَّذي يتبقّى ممّا يطبخونَهُ في البيت
أو مما يأتونَ بهِ من المطاعمِ
وذلكَ بدلَ رميهِ في الزبالة
مردِّدًا:
(إذا لم يأكُل.. فسيموتُ بأيَّةِ حال).
/
وبِما أنَّ كُلَّ شيءٍ في الطبيعة
يختلطُ بصورةٍ عشوائية
لذا وجدت القوانين
فأنتَ لا تتركُ الأعشابَ
تنمو وتنتشر
بينَ المزروعات
كيفما اتفَّقَ
كما لا تستطيعُ أن تترُكَ
الكلاب
تسرحُ وتعوي وتعضُّ مَن تشاء
في الشوارع
فهذه الطيورُ تحسَبُ أنَّه لا عملَ لها
سوى أن تمضي محلِّقةً في السماء
من هُنا إلى هُناك
قاطعةً الأرضَ
من غربِها إلى شرقِها
ومن شَمالِها إلى جنوبها
أو بالعكس
غيرَ مباليةٍ بحدودٍ أو مخافر
ودائمًا باتّجاهِ غايةٍ من غاياتِها
لم تُبدِّل أيًّا منها
رُغمَ كُلِّ التغيُّراتِ والكوارث
الَّتي أصابت عالمَنا الضائع
وقد حملت في مناقيرِها
قَشَّةً
أو عُشبةً
أو دودةً
فإنَّ حجرًا ما
سَهمًا ما
طلقةً ما
سوفَ تنفُضُ الريش
وتؤذي اللحم.
/
الطيورُ لم تُخلق للأقفاص
اتَّفقنا على هذا
الطيور.. أقولُ لكم
(يرفع يدَيه لمستوى أنفه، ويميل إلى اليمين قليلًا بوجهه، ثم يغمض إحدى عينَيه ويسدّد نحو الحضور فوّهة بندقية وهمية مسنودة على كتفه):
خُلِقت للصيد..
* * *
3- مَرثيةُ صاحبِ الأقفاص:
(أحضري لي ما تلتقطينه من عصافير، أنا من لديه الأقفاص)
لستُ أنا مَن قال:
«لا يحتاجُ الإنسانُ لأجلِ أن يحيا سعيدًا
لأكثرَ من كوخٍ على الشاطئ
وأصيصِ قُرنفلٍ
وعصفورٍ في قفص»
بل السيدُ (نيكوس كازنتزاكيس)
صاحبُ رواية: «الحريّةُ والموت»
نفسُه.
/
غيرَ أنَّ حياةَ العصافيرِ قصيرة
الكُلُّ يعلم
ومَن لا يضعُ هذهِ الحقيقةَ في اعتبارِه
ولا يستطيعُ تقبُّلَ
-في يومٍ ما ليسَ ببعيدٍ-
موتِ عصفورِهِ المحتم
فمهما اشتدَّت بهِ الوحدةُ
ومهما بلغت حاجتُهُ
لروحٍ رقيقةٍ صادحةٍ بجوارِه
عليهِ أن ينأى بنفسِهِ
أبعدَ ما يستطيعُ
عن رفقةِ العصافير.
/
سيموتُ لا مَحالةً
كنتُ أعلم
وأعترفُ أنَّها ليست المرَّةَ الأولى
الَّتي يحصُلُ معي شيءٌ كهذا
لكنّي هذهِ المرَّة
في الحقيقةِ
ما كنتُ أحسَبُهُ
على هذهِ الدرجةِ من التسرُّع.
/
تلكَ الأيامُ القائظةُ ذاتُ البريق
لم ينتظرها
رُبَّما لم يكُن يُصدِّقُ أنَّها ستأتي
فقد كانَ صُداحُهُ
أشبهَ بنُباحِ جروٍ صغيرٍ
مربوطٍ من رقبتِه
ببابِ زريبة.
/
نعم.. كانَ يكرهُني
فكُلَّما اقتربتُ منهُ
كان ينفشُ ريشَهُ
ويفتحُ منقارَهُ صاويًا
لإخافتي
مُبديًا استعدادَهُ الكاملَ
لخوضِ معركتِهِ اليوميةِ ضدّي
وبدلَ أن ينقُرَ
ما كنتُ أقدِّمُهُ لهُ بيدي
كانَ همُّهُ أن ينقُرَ يدي
وفي حينِ كنتُ أبذلُ قصارَ جهدي
ليُبدِّلَ مشاعرَهُ نَحوي
ويبدأَ بقبولِ أنَّ حياتَهُ تتعلُّقُ برضائي عنه
فينصاعُ لأوامري
كما يأملُ كلُّ من يربّي حيوانًا ما
كلبًا أو حصانًا
أو طفلًا
أو امرأة
ولكن.. دونَ جدوى.
/
كُنتُ أتساءلُ عن السبب؟
اليومَ توضَّحَ لي
كانَ يعلمُ أنّي سأقتلُه.
/
في النهايةِ
كُلُّ ما بقيَ منهُ
ذِكراهُ وجثَّتُه
وهذا عادةً كُلُّ ما يبقى منّا
نحنُ أيضًا
ماذا أكثر؟!
الذِّكرى (يعبّر بوجهه وبحركةٍ من يدَيه عن حيرته)
لا أدري ما النفعُ منها
والجُثَّةُ
إمّا أن أحشُرَها في كيسِ القمامة
مع قُشورِ البرتقالِ والبصل
وفوارغِ الأطعمةِ المعلَّبة
والمحارمِ الورقيَّةِ المُستهلَكةِ في الحمّام
وأتخلَّصَ منها جميعها
في أقربِ حاويةِ قمامة
وإمّا أن أرمي بها
إلى حديقةِ الجيران
لتنهشَها القِطط..
* * *

بواسطة منذر مصري - شاعر و كاتب سوري | يوليو 1, 2019 | شخصيات
سألتُه، وقد أطال الوقوف أمام إحدى رسومي مكتّفًا ساعديه ومائلًا قليلًا، ما إذا كان يحتاج أن أشرح له شيئًا؟ أجابني: «شكرًا، سمعتك وأنت تشرح للزوار، أريد أن أفهم الرسوم كما أراها أنا لا أنت». وبعد صمت قصير: «ولا أحد آخر» أضاف مبتسمًا! كان ذلك في معرضي الأول – 1971م، في المركز الثقافي العربي في اللاذقية، وكان الرجل الذي توقّف عند كلّ لوحة على حدة، مصادفة، يشغل منصب مدير المركز! بعد انتهاء المعرض بأيام فوجئت بزيارته الأولى لبيتنا بصحبة صديق له قريب لأمّي (ج.ع). استقبلتهما (خالدية) في غرفة الضيوف، فهكذا زيارات كانت تخصّها. ما لا أنساه من تلك الزيارة أنّه عندما قال (جلال) لأمّي ضاحكًا: «ما رأيك أن نضمّ (منذر) إلى حزبنا؟». أجابت بضحكة مقابلة: «لمَ لا.. إن كان يرغب!».
«لمَ لا!.. أمّي!. إنّهما شيوعيّان!، وأنت تعلمين معنى هذا؟ ثمّ هل نسيت أنّ أبي قوميّ سوري!». بعدها، وعلى مدى صداقة امتدّت ما يقارب نصف القرن، سنواتها الثماني عشرة الأخيرة، صداقة كل يوم، بل كل ساعة، لم يُبدِ (عبدالله هوشة) أيّ رغبة بضمّي لحزبه. وكأنّه منذ وقفته الطويلة المائلة أمام رسومي تلك، عرف أنّني لا أملك طينة الحزبيين، وبالتأكيد، طينة المناضلين السياسيين.
آخر زياراتي له في مكتبه في زاوية قاعة المكتبة المركزية لجامعة تشرين، التي قام، هو خريج جامعة القاهرة، قسم المكتبات والوثائق عام 1964م، بتأسيسها وتوسيعها على مدار السنوات الخمس التي كلّف بالعمل مديرًا لها، كانت في أواخر عام 1980م. استغربت، ليس لطفه، فقد عرفت هذه الصفة الغالبة عليه منذ زمن، بل حرصه الزائد، كأنّه كان ينتظر الفرصة، لأن يشرح لي وجهة نظر في الظرف العام للبلد، كنت قد سمعتها منه في لقاء سابق جمعنا في بيت (إلياس مرقص) حيث ظهر وقتها خلاف ما، وهو الأمر الذي لم أفهمه إلّا عندما وصلني خبر ملاحقته وتخفّيه.
تخفّيه، تخفّيه لمدة تزيد على عشرين عامًا، وأين؟ في بلد الألف فرع أمن ولا أمن، والمليون عنصر أمن ومخبر، المنتشرين في كلّ مدينة وبلدة وقرية، من شمال سوريا إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، لا ينامون -عين الأمن لا تنام- ولا يكلّون ولا يملّون. تخفّيه الذي استحق وصفه بالمستحيل. ولكن ليس بالنسبة لي!..ذلك لأنّي، رغم زياراتي النادرة لدمشق، فقد حدث ورأيته، أكثر من مرّة، يمشي الهوينى – كيف لي الآن، أن أتصل به، كما اعتدت أن أفعل كلّ هذه السنين، وأسأله: أيّهما الأصح، أن أكتب الهوينى أم الهوينا؟ في شوارعها، أو يقف متأملًا أمام واجهات محلاتها، إحداها كانت في (الصالحية)، قلب العاصمة الصاخب! عند باب صيدلية (القنواتي)، من يصدق؟! هو نفسه صعق لرؤيتي، آخذًا إيّاه بالأحضان. في حين أن بعضًا من معارفه، كما روى لي، كان يتجنبه، إذا التقاه، في مصادفة مماثلة، مجرّد التعرف إليه وإلقاء التحية، وكان هو أوّل من يعذرهم.
وفي زيارة أخرى لي للعاصمة، ربما في أواسط التسعينيات، اتصلت، بصديقي اللاذقاني (م.ك). ومن لديّ من أبناء بلدياتي فيها سواه؟ لأخبره أنّني قادم لبيته. فقد كان يطيب لي الغداء، من طبيخ زوجته (و.ع) بنت اللاذقية بدورها، كلّما سافرت إلى دمشق وتوفّر لي بعض الوقت. فما كان منه إلّا أن استمهلني قليلًا، على غير عادته، ليعود ويقول لي جوابه المعتاد: «تعال.. ماذا تنتظر!». وعندما وصلت، عرفت مباشرة سبب ذلك التردد، (عبدالله هوشة) بلحمه وعظمه وربطة عنقه يجلس عندهم على مائدة الطعام. فعرفت أنّ (ميشيل) قد سأله: ما إذا لديه مانع من مجيئي، فللمُلاحَقُ دائمًا ظروفه وحساباته، أجابه (عبدالله): «والله، مشتاق لمنذر كثيرًا».
لا أدري كيف، بعد ظهوره للعلن، وعودته للحياة في اللاذقية، وجدت نفسي منذ عام 2002م صديقًا حميمًا له. لا أذكر الآن التفاصيل، ولا ريب أنّه كان هناك أكثر من دافع، وصرنا نبدو للآخرين كثنائيّ لا يفترق الواحد عن الآخر، معًا دائمًا، أينما ذهبنا، ومع من كنّا، وفي حال مصادفة أحدنا وحده في مكان ما، فالسؤال الجاهز كان: «أين صاحبك؟»، الذي تطور مع السنوات وصار عند بعض الأصدقاء المقربين: «أين غريمك؟» الصفة التي سجّل (أبو يوسف) اعتراضه الرسمي عليها، حتّى إن كانت تقال مزاحًا، إلّا أنّني أنا (منذورة) الاسم الذي يطيب له مناداتي به، لم أعترض!. لأنّه إضافة لابتعادي التام عن مشاغله الحزبية، وتأكيدي، المرّة تلو الأخرى، بأنّ اهتمامي بالشأن العام، وكتابتي عن إشكاليات العلاقة القائمة بين المجتمع والسلطة في سوريا، يأتيان من الثقافة أولًا والثقافة أخيرًا، باذلًا كل الجهد لأن أحصرهما، إمّا تحت خطّ السياسة، أو فوق خطّ السياسة، فقد زادت مع الأيام نقاط خلافي مع النهج السياسي الذي كان يتبعه حزبه، أو لأقل بدقيق العبارة، الذي كانت تتبعه قيادة الحزب وتجرف كلّ أعضائه وراءها.
لكن ذلك لم يمنعه من تبنّي اقتراح لي باسم جديد لهذا الحزب، ليقدمه في مؤتمر الحزب السادس، أخبرني، لاحقًا، أنّهم لم يوافقوا عليه – لفقر مخيلتكم السياسية، قلت له- كما رافقته مع العديد من الأصدقاء، إلى اللقاء العلني، لأوّل مرة في تاريخ الحزب، الذي عقد في (حرستا – دمشق)، مايو 2005م، وأعلن فيه (عبدالله هوشة) أمينًا أوّل للحزب، بحُلَّته الجديدة وباسمه الجديد (حزب الشعب الديمقراطي). وللأسف، تبيّن بعد مدة زمنية ليست بطويلة، أنّ كلّ هذا، وليس منصب الأمين الأوّل فحسب، كان شكليًّا وفارغًا أكثر منه حقيقيًّا وواقعيًّا. كما أوضح (عبدالله) بقلمه وبكلماته، في رسالته بتاريخ 10/6/2007م التي أعدُّها وثيقة تاريخية لا مثيل لها في الأدبيات السياسية السورية: «تصويب أوّلي لما ورد في تصريح الأمين الأوّل التاريخي الرفيق العزيز(ر.ت)». التي وجّهها: «إلى جميع الرفاق في الحزب والمتعاطفين معه وإلى القوى الحليفة والصديقة، وإلى الرأي العام أيضًا». ناقدًا وناقضًا الأساليب الفردية التي استمر (ر.ت) في ممارستها، داخل الحزب وخارجه: «ما دام الأمين الأول التاريخي مصرًّا على أسلوبه في العمل، وعلى إخضاع اللجنة المركزية لآليات عمل مخالفة لروح المؤتمر السادس ولوثائقه التي حملت طموحًا كبيرًا لتجديد الحزب بكلّ المعاني، الفكرية والسياسية والتنظيمية، ولتحويله إلى مؤسّسة لا تتحكّم فيها شخصية واحدة أو فرد واحد، أيّا كانت تلك الشخصية ومن كان هذا الفرد». السؤال الآن: أيّ درس؟!
أذى على جميع الأصعدة
كنت من القلة الذين شهدوا وعاينوا مقدار الألم الذي عاناه (عبدالله هوشة) إثر تلك الطعنة، والأذى الذي تلقّاه على جميع الأصعدة. ومع ذلك تراه يخاطب طاعنه، بـ«الرفيق العزيز»، «الرفيق الغالي»، وإذا أراد تكذيبه في نقطة ما، فهو يستخدم تعبير: «جانبت الصواب»! أو لأكون صريحًا؛ طاعنيه. فقد كان يشعر بمرارة شديدة، حاول، دائمًا إخفاءها، حرصًا منه على إخلاصه لحزبه، تجاه عدد غير قليل من الرفاق، الذين تعاملوا مع (الأزمة)، بحيادية كما ادعوا، ولكن بسلبية وصمت كما الحقيقة، هو القائل في مقدمة الرسالة: «حين يصبح الصمت موقفًا غير أخلاقي». تاركوه، وحده، بعد كل هذه السنين التي كرسها للحزب والرفاق، ينزع شوكه بيده، ويخيط ضفّتي جرحه بمسلته.
في العام ذاته، أصابه السرطان لأوّل مرّة في رئته اليسرى. ولا آتي بهذا، كدليل على ما أقوله إطلاقًا، ولكن ذلك ما حدث! ولحسن الحظّ هذه المرّة، اكتشف الورم وهو ما زال طفلًا! بل جنينًا، أقصد صغيرًا جدًّا. وهنا، لم يتوانَ رفاقه في الحزب في القيام بواجبهم الرفاقي على أكمل وجه، وأخذ كلّ شيء على عاتقهم، مقدمين كلّ أنواع الدعم، المادي والمعنوي. هو بنفسه روى لي، في أكثر من مناسبة، وبامتنان عميق، ما فعلوه لمساعدته وكيف زاروه جميعًا في المشفى، ومن بينهم الرفيق العزيز (ابن العم) وكأنّ شيئًا لم يكن. عاش من حينها (عبدالله هوشة) معلّقًا، كرسالته التي لم يجب عليها الأمين الأوّل التاريخي وكذلك اللجنة المركزية، على الجدران الصامتة للحزب، فليس هو خارجًا عنه وليس هو عضوًا فيه، حتى بدأت.. (الثورة).
بالنسبة لنا، نحن أصدقاءه، كانت المظاهرات التي تمرّ من أمامنا، لحظة خرافية، لحظة لم نكن نصدق أنّنا سنحيا ونشهدها، إلّا أنّها بالنسبة لـ(عبدالله هوشة) كانت تعني شيئًا أكثر من خفقان القلب وذرف الدموع ونحن نراهم يتدفقون في الشارع حاملين لافتاتهم ومرددين شعاراتهم: (سوريا منحبك) (واحد واحد.. الشعب السوري واحد) (بالروح بالدم نفديكي يا درعا)، يضحك ويبكي (أبو يوسف) «من أين للوادقة هذا التعاطف الوطني!». (الثورة) كانت بالنسبة له، المعنى الحقيقي لحياته كلّها، بل، دون أدنى مبالغة، كانت حياته كلّها. ما تعلّم وناضل وأحبّ وصادق وعادى ولُوحِقَ وتخفَّى وخاف وعاش «تحت الأرض» وفوق الأرض، لأجلها.
نعم، فعلت (الثورة) بنا ما فعلت. الآن سيأتي أحد ويقول: «لا، ليست الثورة من فعلت بنا هذا، بل النظام، بل روسيا وإيران، بل قطر وتركيا، بل أميركا.. بل العالم برمته!» ولن أنسى من سيقول: «نحن، نحن من فعل هذا بأنفسنا» وطبعًا، موضوعنا الآن ليس هذا، رغم تأثيره الطاغي فينا كبشر وفي حياتنا الطبيعية، التي ما عادت طبيعية، وعيشنا اليومي المحفوف بالمخاطر، والمليء بالمذلات، الذي بات لحظيًّا وآنيًّا، فقد أنهت الخلافات في الرأي، والتبدّلات في المواقف والاصطفافات السياسية، التي نجمت عن الوقائع الجديدة للبلد، صداقات تاريخية كان يخال أنّها ستدوم مدى الحياة، وفرّقت رفاقًا وأصحابًا كانت توثقهم ذكريات نضالية مشتركة، وروابط فكرية وإنسانية مسلّم بها. نعم، ريح صرصر شديدة البأس، كنّا، (أبو يوسف) وأنا وأصدقاؤنا جميعًا من دون استثناء، في مهبّها وفي دوامتها. فقد وجدت نفسي، رغم موافقتي لحدّ التطابق لأغلب الآراء والأفكار، بالتأكيد ليس كلّها، التي كان (أبو يوسف) بتجربته النضالية ومتابعته الحثيثة للأحداث قادرًا على استخلاصها، كما لا يستطيع أحد منّا أن يفعل، على خلاف معه في عدّة قضايا، اثنتين منها، يمكن لي الآن عدّهما رئيسيتين؛ الأولى، عامة، فاجأني أنّه تعامل معها كأنّها تمسّه شخصيًّا، وهي أن المعارضة السورية، (التقليدية) حسب بعض التصانيف، التي يرسم (التجمع الوطني الديمقراطي-1980م)، ووليده (إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي-2005م) إلى حدّ ما، أفضل صورتين لها، هي برأيي، معارضة أخلاقية، مبدئية، مثالية، وأيضًا، لو بمبالغة أظنّها في محلّها، كما وصفتها يومًا في مقال سابق لي: (تم القضاء على المعارضة السورية.. انبسطوا- صحيفة السفير 24/4/2007م)، «طهرانية».
وكانت حجّتي على هذا، ليس فقط ما تردّده المعارضات السورية منذ نشأتها، بداية السبعينيات إلى اليوم، بكلّ بياناتها وتصاريحها، بأن النظام الشمولي السوري قد ألغى السياسة في المجتمع، وصحّره، إن لم يكن قد ألغى المجتمع نفسه. بل أيضًا الأداء السياسي والإعلامي المخيّب لرموز هذه المعارضة بعد 2011م. ورغم قبول (أبو يوسف) بهاتين الفكرتين، فكثيرًا ما سمعته يردّدهما أمامي وأمام الجميع، لكنه كان يرى أن النضال والتضحيات الكبرى التي قدمتها أحزاب هذه المعارضة كافة، عملًا سياسيًّا بامتياز، «شئت أم أبيت يا منذر» وأن غضّ النظر عن هذه التضحيات وتجريد هذا النضال من مضمونه السياسي، وتحميل المعارضة أيّ مسؤولية في ما أوصل سوريا والشعب السوري إلى هذه الكارثة، عمل لا أخلاقي أكثر منه أيّ شيء آخر.
دور بارز في تجميع القوى
أمّا القضية الثانية، التي لم أكن أفاتحه بها إلّا بخجل ومواربة، لأنها أقرب لأن تكون تدخلًا في قراراته الحياتية، وسلامته الشخصية، من قبل شخص تصل معرفته بهذه الأمور إلى درجة الجهل التام، كما تبيّن لي لاحقًا، وهي أنه بما يعرف عنه من قدرة تنظيمية، وخبرة قيادية في أصعب الظروف، وذلك الاحترام والتقدير الذي يكنّه الجميع لاسمه ولتجربته، فإنه يستطيع أن يلعب دورًا بارزًا في تجميع القوى الوطنية المعارضة في اللاذقية وتوجيهها على نحو منظم فعال هي في أشدّ الحاجة إليه. وما أظنه جوابًا مفحمًا عن سؤالي ذاك، ستجدونه في نهاية ما سأقصه عليكم لتوّي. فقد اصطحبني (أبو يوسف)، لا أذكر تمامًا في أيّ عام، ربما خلال الأزمة التي وقع فيها النظام السوري بعد اغتيال (رفيق الحريري) وخروج الجيش السوري من لبنان، وتلويح الولايات المتحدة بوضع سوريا في دول محور (الشر)، وما أدراك ما محور الشر، لاجتماع عقد في بيت أحد المعارضين السياسيين، غايته المعلنة إنشاء تجمع وطني، يعمل أعضاؤه على تمكين الوحدة الوطنية، والحفاظ على السلم الأهلي، تجنّبًا لاحتمال نشوء نزاعات طائفية أو مناطقية في المستقبل، وبالرغم من أهمية الهدف، وكثرة الشخصيات المعروفة التي وُجدت في الاجتماع، والجو الوطني الذي ساد فيه، فقد كان الانطباع الذي خرج به (عبدالله) عند نهاية الاجتماع في غاية السلبية. وقتها علّلت هذا، بيني وبين نفسي، بالحزبية الضيقة التي تربّى عليها، وبالشعور بالريبة والشك الذي عاشه طوال مدة تخفّيه. ولكن بعد انقضاء ما يقارب الخمسة عشر عامًا، وبعد رحيل (عبدالله هوشة) بأيام لا أكثر، يخبرني أحد مؤسّسي هذا التجمّع بأنّه تمّ بناء على طلب أحد فروع الأمن؟!
أمّا مقالي، الذي أثار، ضدّي ومعي، تلك الزوبعة، حتّى غدوت، أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، صاحب 18 كتابًا، منها كتابان في الشأن السوري العام والخاص، إضافة لمئات المقالات قي شتى ضروب الكتابة، لا أعرف سوى به: (ليتها لم تكن)، فلم ينبس بحرف حوله، كما أنّي لم أسأله قط. قلت: إنّ (الثورة) السورية كانت تعني لـ(عبدالله هوشة)، ما لم تكن تعنيه لأيّ منا، مهما صدقناها ومهما بلغ انحيازنا لها. فقد كان مصرًّا عن سابق عزم وتصميم ألّا يدير لها ظهره، مهما تبدلت أحوالها، ومهما تراجعت مكتسباتها. أو بالعكس، كان، كلّما أصابها عجز، ووقعت بها هزيمة، يزيد اندفاعه نحوها، ويزيد إيمانه بانتصارها. ولكن مع تراكم الأخطاء واستفحال الانحرافات، ومع اكتساح الحرب لكلّ معطيات الثورة وأهدافها، وكثرة التدخلات والارتهانات والاحتلالات، وارتفاع تكلفة الثورة من الخراب والموت والتشريد، راح يظهر على ملامح وجهه تعابير ألم حاد، وراحت نبرة صوته تنمّ عن قلق لم نعهده فيه من قبل، لا على الثورة فحسب، بل على السوريين كبشر وكشعب، وسوريا كدولة وكبلد وكوطن. وأحسب أنّه من وقتها بدأ يشعر بتسلل الهزيمة إلى روحه، كما بدأ يطفو فوق كلامه بيننا، يأسٌ أشبه ببقعة زيت كامدة، تترقرق كلّما ألقى أحدهم حجرًا عليها، وهو الأمر الذي آلمنا جميعنا، مع أنّنا من دون استثناء كنا قد سبقناه منذ زمن لذلك. كنت أصيح به، وإن بمزاح: «يحقّ للجميع أن يقدموا المراجعات، ويعترفوا بالأخطاء، ويحقّ لهم أن يندموا، ويردّدوا (ليتها لم تكن)، ما عدا أنت! أنت خلقت للثورة كما خلق المسيح للصلب!». غير أنّ هذا ما عاد يكفي أن يتكلّف (المعلم المتألم) رسم الابتسامة على فمه!
عاد لينتقم
قبل معرفته بعودة السرطان إليه، وهذه المرّة، عاد لينتقم، وقبل وفاة شريكة حياته في السراء والضراء، السرّاء القليلة والضراء الكثيرة، قبل كلّ هذا بأشهر عديدة، ولم يكن الألم الذي بدأ من جانبه الأيمن قد اشتدّ بعد، أسرّ لي، وهو يصعد بجانبي في السيارة، متنهّدًا، بدل جملته المعتادة التي حملها معه من أيام دراسته في مصر: «يامنتا كريم يا رب»، تلك التنهيدة الطويلة: «إنني أموت يا (منذر)». أجبته: «بعيد الشر عنك (أبو يوسف)، ألف بعيد الشر، عارض ويزول». غير أنّني، أقسم، كنت أرى ملاك الموت يحوّم فوق رأسه، ثم يطلّ من عينيه الزيتونيتين. حتى إنّه بعد عيادتنا لصديق، في حيّ (الزراعة)، (شيكاغو) اللاذقية كما يطلقون عليه، أخطأت وعبرت بسيارتي تقاطع نيران محلي، كان هادئًا حينها، فرموا علينا، ونحن يا غافل لك الله، قنبلة يدوية، سقطت على مسافة نصف متر من سيارتنا، مخترقة بشظاياها كامل الجانب الأيمن للسيارة، ومحطّمة زجاج نافذة المقعد الأمامي، حيث كان يجلس (أبو يوسف). وقد استطعت التحكم بأعصابي والسيارة بآنٍ، وابتعدت بها من ساحة المعركة، إلى حيث من الممكن أن نتوقف وننظر إلى ما آل إليه حالنا، وحال سيارتي الصينية الجديدة. فإذا بالدماء تسيل من أذن (أبو يوسف) اليمنى، إضافة لخدوش صغيرة على وجهه نتيجة نثرات الزجاج التي انقذفت في كلّ صوب داخل السيارة. تصوّروا، مجرد تصوّر، لو أصابتنا تلك القنبلة إصابة مباشرة، وأدّت إلى انفجار السيارة أو تحطّمها! ماذا كان سيحصل لنا؟ وماذا كان سيقال وسيكتب في حال موتنا! أيّ خبر عاجل سيحتل شريط الأخبار. إلّا أنّه، رغم نجاتنا من هذه الواقعة، ما كان هناك مهرب من الموت أمام (أبو يوسف)، فالإصابة الثانية بالسرطان كانت تنتظره، ولا يكتشفها، إلّا وهي تغطّي رئته اليمنى على نحو شبه كامل، مع انتقال الورم إلى قصبات الصدر اليمينية، وبعض فقرات الظهر خلف الورم مباشرة، مسببًا، من الجهتين، آلامًا لا تطاق، لم تقدر أقوى المهدئات، التي كانت تصيبه بالدوار والغثيان، سوى على تخفيفها قليلًا ولمدة زمنية قصيرة. قال لي، وهو يشيح بنظره عن شاشة التلفاز، وكان قد اضطرته خطورة إصابته، أن يبطل اهتمامه، كلّ يوم وكلّ ساعة، بما يجري من أحداث: «والله.. إنه عالم لا يندم الإنسان على مغادرته».
صباح السبت 8/12/2018م، عند الساعة الثامنة صباحًا، غادرت روح (عبدالله هوشة) جسده التعب، بعد أن أشبعته عذابًا وألمًا. فحمله أهله وأصدقاؤه إلى مقبرة (الروضة)، شرق مدينته اللاذقية، حيث غمروه بالتراب وأودعوه بطن أمّه الأرض.
«جميعنا يا (عبدالله) طعام للأرض. سقتنا وأطعمتنا طوال حياتنا. لنموت، ونقوم بردّ جميلها، أو سداد دينها، بأن نطعمها أجسادنا. من هنا يأتي حرصنًا أن نسرع بدفن موتانا، لتكون دافئة وطازجة ما أمكن». خطر لي هذا وأنا أتنقل بين القبور المتزاحمة، ريثما ينتهون من طقوس الدفن. بالنسبة لي، بتّ أعرف من أسماء أصحاب هذه القبور أكثر ممن أعرف أسماءهم بين الأحياء. إلّا أنّ ما هالني، وهو ما لم أكن قد تنبهت له من قبل، أنّه بين كلّ قبرين أو ثلاثة، قبر (ملازم شرف) شهيد الوطن، أو ربما قبر واحد لأخوين شهيدين.. ولكن ماذا لو كانت هنا أيضًا قبور باقي الشهداء، أولئك الذين دفنوا بلا ضريح ولا اسم؟ ترى، تحسّبًا لكلّ هذا، سُمِّيتْ هذه المقبرة.. (الروضة)! أمّا أنا فقد حرصت أن أكون آخر مودعيه، لأمسك بيده وأهمس بأذنه: «مع السلامة أبو يوسف». وليشدّ على يدي ولأسمعه يجيب: «الله يسلمك، منذورة».
اللاذقية 15/1/2019م

بواسطة منذر مصري - شاعر و كاتب سوري | يناير 1, 2019 | كتب
«كلُّ الأبواب موصدة
حتّى باب الكنيسة ردّوه في وجهي
فأين أبيت هذه الليلة
ومغارة بيت لحم
احتلّها المراؤون والفريسيون»
لا أدري من أين ولا كيف حصلت على هذا الديوان، مع أني نادرًا ما أنسى طريقة حصولي على كتاب كان له هذا الوقع عليّ، فعمل ذاكرتي الحصري هو في أمور كهذه، ولأني عادة أكتب هذا في الزاوية العليا للصفحة الأولى من الكتاب؟!
«جنازة كلب» للشاعر إبراهيم سلامة، لم أكتب عليه أيّ تاريخ أو أيّ معلومة تساعدني على التذكر، فقط، على الصفحة الأخيرة، كتبت: (11/ 6/ 1977 منذر)، وهو ما يفيد بتاريخ قراءتي له لا أكثر. لكن حالة الكتاب كما ترون من صورة غلافه البالي المرفقة، تدل على أنني لم أحصل عليه من مكتبة السائح في طرابلس، ولا من أي مكتبة في مكتبات بيروت قرب الجامعة الأميركية، التي ابتعت منها كتب الشعر النادرة التي أتباهى بها. تلك الكتب التي لم تصل إلى المكتبات السورية لأسباب لا مجال الآن لذكرها.
جنازة كلب: أولًا، إصدار دار الطليعة- بيروت، التي تعففتْ، ككثير من دور النشر من أن تورد تاريخ الإصدار، لكني عرفتُ من البحث في شبكة الإنترنت، أنه توجد طبعتان للكتاب؛ الأولى: سنة 1963م أو 1965م، وهي الطبعة التي بين يدي، والثانية: سنة 1980م، وأحسب أنه من اللافت أن تكون لكتاب غير تجاري كهذا طبعتان، رغم شكّي بذلك، فالمعلومات التي نأخذها من شبكة الإنترنت غالبًا غير مؤكّدة. ثانيًا، كتاب من الحجم المتوسط، لا يتجاوز عدد صفحاته 64 صفحة، لا يتوافر فيه أي تعريف بالمؤلف، مع الإشارة إلى أنه قد صدر له «قصائد من خشب»، وتحت الطبع مسرحية «صاحب أوتيل»، لم أعثر على أي إشارة تدل على صدورها.
ثالثًا، مع مقدمة من ثلاث صفحات، بقلم الصحافي المصري المعروف أنيس منصور بعنوان: «شخص واحد ونصف مليون ظل»!. وهو ما أثار تساؤلي: «… متى كان المصريون يقدمون للشعراء اللبنانيين؟!»، لكن معرفة أنها مقالة من مقالات منصور في جريدة أخبار اليوم عام 1963م اختيرت لتكون مقدمة للكتاب، تُقدِّم الجواب الوافي عن هذا التساؤل. وتبين أن منصورًا سبق أن كتب عن ديوان سلامة الأول (قصائد من خشب-1962م): «فقد أحسست أن في هذا الشاب شيئًا جديدًا، وأدركت العلاقة الرائعة المريعة التي تربطه بالحياة إنها علاقة الفزع… شاعر جديد يدبدب بعواطفه في شوارع بيروت، يضرب رأسه في جدران بنوكها وفنادقها». ولكن بعد أن عرفه من قرب تبين له: «عندما كان يمطّ شفتيه بين السطور بحركة اشمئزاز عابرة، كان (يبصق على المعاني السلبية التي في أعماقه) كما يقول الشاعر أراغون». وإن مشكلته كباقي أبناء القرى الذين يهبطون من الجبال ويحطّون في المدن، هي أنهم يكتشفون: «بيروت مدينة شيطانية.. منزوعة العواطف.. كل شيء فيها للبيع.. فلا يوجد مجتمع وإنما أناس يحيون فرادى…»، فلا يكون في مقدور سلامة الشاب الثائر ومن هم على شاكلته سوى «الصراخ معًا».
رابعًا، تتضمن المجموعة 14 قصيدة، وثلاث مسرحيات قصيرة. يتبدى بها اهتمام سلامة بتفاصيل الواقع الموحل، كقصيدة «ماريكا» بيت البغاء المعروف في بيروت، وكذلك قصيدة «عميل» المهداة «إلى طقم لا بأس به من رجال السياسة عندنا». التي أحسب أنها كتبت بتأثير عمل صاحبها كصحافي. بقدر اهتمامه بالكليّات الجوهرية كالعلاقة بين الله والفيلسوف في مسرحية «جنازة كلب» التي عنون بها الكتاب.
خامسًا، ما زلت أذكر انطباعي الأول عند قراءتها، عداك عن متعتي وأعجابي بها، بأنه لا يمكن إلا أن يحضرك الشاعر السوري محمد الماغوط وأنت تقرأ القصائد والمسرحيات القصيرة التي تضمنتها «جنازة كلب». وبخاصة إن كنت ممن مرّوا به ووقعت في شراكه، إن من حيث المواضيع والمعاني (شاعر ريفي يشعر بالضياع والسخط وهو يتسكع في شوارع المدينة) وإن من حيث الأسلوب وطريقة التعبير: ص17: «نفسي أبيعها للزبالين/ مع قذارات الشارع». ص23: «اليوم على قبر سقراط/ اشتريت امرأة بعشر ليرات». ص 24: «وطني لا يعرفني». ص25: «… الجنة/ تركتها للبسطاء/ فقد حجزوا فيها جميع التذاكر». ص47: «يا رب أنزل صاعقة على (ستاركو)/ ودمّر البناية التي أنام على أدراجها/ حياتي خمس عشرة سنة/ تدوسها أقدام الساهرين هنا بأحذيتهم الموحلة».
وغير ذلك كثير. لكن المعلم الأول، كما يخال لي، أكثر حصافة في انتقاء كلماته، ففي المثال الذي جاء في ص25، لكان سيختار كلمة: المقاعد، والسبب في هذا أن التذاكر تنفد، في حين المقاعد تحجز. أما مثال ص47، فمن المستغرب أن تكون أحذية الساهرين في ستاركو موحلة؟! وكذلك في استخدامه، ولو بدرجة أقل، إحدى ثيمات الكتابة الماغوطية؛ حرف التشبيه (ك)، ص9: «اسمك مرفوع كعلم أمريكي في المحيط الهادي». ص29: «لترتمي تحت قدميك كامرأة مستسلمة مزقت قناعها وخلعت قميص نومها». ص58: «يا بني أتظنني غبارًا- كدخان معامل الكلسات». كما يمكن لي القول: إن قصائد سلامة أكثر شعبوية، صحفية، أو حتى سوقية، بالمعنى الإيجابي للكلمة، يتجلى هذا في انتقائه لمواضيعه وأيضًا لكلماته: «أنا تيس مثقف.. صاحب الجلالة… ترامواي بيروت» وربّما أكثر في طرق تفكيره وتعابيره، كأن يطلق على كتابه: «جنازة كلب» مستهلًّا إياه بالمثل الشعبي: «جنازة حامية والميت كلب». أقول أكثر شعبوية… من قصائد شاعر، تكشَّفت ذروة شعبويته وسوقيته في أعماله المسرحية المعروفة مثل: «ضيعة تشرين»، و«كاسك يا وطن»، و«غربة». إلّا أن كليهما، واسمحوا لي بهذه الصفة، شاعر ثوري رومانسي من الطراز العالي.

إبراهيم سلامة
كلّ هذا، ولا يوجد في مقدمة أنيس منصور، الأمر الذي يمكن تبريره، بحجّة أن منصور المصري قد لا يكون مطلعًا على تجربة الماغوط السبّاقة، وكذلك في مقالة بول شاوول المطّلع والعارف، عن كتاب إبراهيم سلامة الثالث: «دموع التماسيح»، أي ذكر أو مقاربة لهذا التأثير الماغوطي، وبخاصة أن ديوان الماغوط الأول «حزن في ضوء القمر» كان قد صدر عن مجلة شعر في بيروت عام 1958م، وبعده بسنتين ديوانه الثاني «غرفة بملايين الجدران» الذي يتوافر لديَّ بطبعة مكتبة النوري دمشق 1960م، لا بطبعة مجلة شعر كما يذكر أحيانًا، التي لم أرها ولم أعرفها في حياتي، عداك عن قصائده التي كانت تنشر في مجلة شعر غالبًا، وهذا يعني أنّ اطّلاع صاحب «قصائد من خشب» الصادر عام 1962م على شعر الماغوط أقرب للمحتم.
سادسًا، على الوجه الثاني للغلاف، يكتب إبراهيم سلامة نفسه موضِّحًا، أو قلْ مؤكِّدًا، نظرته الساخرة والجارحة للواقع: «… ليس هذا الكتاب «جنازة كلب» بل جنازة الإنسان في زمن عزَّ فيه الكلبُ على الإنسان».
قصائد من خشب
في عام 1990م أصدرت دار رياض الريس للكتب والنشر، ضمن سلسلتها الشعرية الثانية، كتابًا أنيقًا ذا 162 صفحة من الحجم الوسط، جامعًا كلتا مجموعتي إبراهيم سلامة، اللتين أصدرهما تباعًا، ثم صام عن الشعر: «قصائد من خشب» 1962م، المتضمن 23 قصيدة، و«جنازة كلب» 1963م. وجامعًا أيضًا لثلاث مقدمات عن صاحبها، إضافة إلى مقدمة أنيس منصور، هناك مقدمة فواز طرابلسي المكتوبة على ما يبدو للكتاب خاصة حيث إنها مؤرخة، عام 1988م، أي قبل إصداره بسنتين، وهي في رأيي أهم المقدمات الثلاث، ولكن بالتأكيد ليس أطرفها؛ لأن ذلك من حق مقدمة سلامة نفسه المذيلة: «بيروت 20 حزيران 1962» التي يدلّ تاريخها ومضمونها أيضًا على أنها كانت مقدمته لديوانه الأول، غير المتوافر عندي بطبعته الأصلية.
إبراهيم سلامة بقلمه:
وكأنه يرغب بمصادرة رأينا قبل أن نقوله، يبدأ سلامة مقدمته لديوانه الأول: «هذا ليس بالشعر وليس بالنثر، ولا.. ولا.. إنما هذه خواطر، خواطر وليست أكثر. كتبت… في البارات والنوادي الليلية وفي الترامواي…خواطر إنسان كفر بكل القيم، وثار على كل المفاهيم؛ الحرية، العدل، الديمقراطية، الشرف، الأخلاق»، وينهيها: «عفوك قارئي العزيز… هذا رأيي في نفسي قبل أن يسبقني أحد ويقوله». مع أنه هو من أطلق عليها صفة «قصائد» في العنوان، كما أنه هو من يقول مفسِّرًا ومبرِّرًا: «أعرف سلفًا أن في هذا الشعر طباقات وتناقضات…قوة وركاكة…عمق وسطحية…فلسفة وسخافة.. صورة إنسان اليوم «غاغارين» و«التويست»… هذا (الشعر المخشب) ليس له قواعد؛ لأن الكون ليس له قواعد ولا ناموس ولا نظام، ولا موسيقا…».
متحف الفراديس:
تميزت مقدمة فواز طرابلسي برسم خلفية اجتماعية وسياسية لتجربة الشاعر، رغم وجود مشتركات معينة بينها وبين مقدمة أنيس منصور، واضعًا إياها ضمن إشكالية فهم وتقييم (الأعجوبة البيروتية) خاصةً، والتجربة اللبنانية عمومًا. ولا أظن أحدًا ممن يعرفون كتابات الطرابلسي يتوقع منه أن يكون أحد الرومانسيين الحالمين بالفردوس اللبناني الضائع؟! فيأتي بعجالة ظاهرة على ذكر تجربة النزوح من الريف للمدينة، ونقطة التصادم بين عالمي المرأة والمال، ضامًّا صديقه سلامة إلى تلك الكوكبة من الشعراء، بدءًا من جبران إلى شعراء الجنوب مرورًا بـإلياس أبي شبكة… وخليل الحاوي. وإن قارئ سلامة لن يجد صورًا برَّاقة عن العصر الذهبي الذي كان يعيشه لبنان، وعن بيروت كإحدى الفراديس العربية المفقودة. وهو بعد أن يبدد أسطورة بيروت باعتبارها الشواذ الذي قتلته القاعدة العربية، مستشهدًا بقول لمحمود درويش: «لولا هذه الدول اللقيطة لم تكن بيروت ثكلى». ينتهي بالقول: «لا المزاج السوداوي ولا التشاؤم المجسّم ما يسود صفحات هذا الكتاب، إنه صدى إنذارات لم تسمع حينها. فوراء هذا الاستهتار قلق وخوف…».
مقاطع مختارة:
«قصائد من خشب» – ص23: أنا بائع الكلمة/ التي كانت في البداية إلهًا/ وتحولت اليوم إلى نقطة سوداء/ على صفحة بيضاء/ أبيعها بليرة.. بليرتين/ بصحن فول/ بكرافات… أنا تاجر.
ص35: أنا مثقف/ دكتوراه حقوق/ اختصاصي في الأكل/ في الشرب/ في تعليك الكلام/ لا أبتسم إلا بالغرامات…مغرور/ متأله/ أحتقر البشر… مخشب القلب… أنا تيس. ص50: في الليلة الأولى يا خاطئة التقينا/ أين؟/ في البار القديم المغطى بستار شفاف/ حيث كنتِ تترصدين كالحية. ص67: كلما حل مساء تشرين/ خلت أن نهاية البشرية قد اقتربت/ وأن الحرب واقعة غدًا وليس بعد غد… أنا بدوري فزعت إلى غرفتي الصغيرة/ التي ليس فيها سوى سرير وطاولة وسبعة كتب… رباه لي طلب واحد/ أن تعطني الموت دفعة واحدة… لأشعر بالسعادة في موتي. ص72: أنا تحت.. في قبو صغير/ فوقي بثلاثة أمتار البشرية… سينمات/ مَلَاهٍ/ سيدات/ جرائد/ مشاكل العالم/ أخبار الأمم المتحدة/ نزع السلاح… أنا تحت كل شيء… تحت القانون/ تحت المحبة/ تحت النظام/ تحت الدولة… كل ما أراه وأسمعه/ قادم أو ذاهب-إلى تحت.
«جنازة كلب».. يلاحظ في بداية الديوان إضافة قصيدة بعنوان «روما تحترق» لم تكن موجودة في طبعة دار الطليعة 1963م، ومن المرجح أن ذلك كان بسبب تجاوزها للخطوط الحمر، حيث تتضمن، وعلى نحو غير مسبوق، هجاءً شديدًا قاذعًا للمجتمع اللبناني ورجال الحكم فيه بآن. ما يذكرنا بخلاصة فواز طرابلسي: «إنذارات لم تسمع حينها». ص101: أهل بلادي على الشاطئ/ أخذوا من السمك عاداته/ كبيرهم يبلع صغيرهم/ قويهم يأكل ضعيفهم/ غنيهم يدوس فقيرهم… الجمال قبح… الباطل ناموس… الصدق شعوذة… الإنسانية بهمنة… الرزيلة فضيلة… السرقة أمانة… اللصوصية شرف… تضليل الناس وطنية… بثّ السموم زعامة… بلادي روما تحترق/ وغدًا سيعبق دخانها. ص105: (ماريكا) يا أشهر امرأة في لبنان!/ بيتك تاريخ لم يكتب/ والتاريخ سجّل نصف حضارة الإنسان/ وجبن أن يسجل الباقي/ فتركه نقوشًا على حيطان بيتك. ص112: نفسي أبيعها للزبالين. ص115: مقبرة الجبل الصغيرة/ أربعة أمتار منسيّة/ بين الصنوبر منعزلة/ برأسها عمود صغير/ أصفر بلون الموت/ كشاعر..في داخلها ماذا؟/ لا شيء.. ذكريات إنسان/ من تراب مرّ على تراب./ سيارة صغيرة تمرّ قربها/ متمهلة/ في داخلها رجل وامرأة/ يغازلان التراب… ويمتصان شفاه بعضها/ كما تمتص المقبرة الصغيرة/ عظام الميت…/ مقبرة الجبل الصغيرة… مصطافة.. لا تأكل ولا تشرب/ تمثال شقاء الإنسان/ صليبه ضاع في البراري والوديان/ ولقيه دونما موعد. ص117: على قبر سقراط/ اشتريت امرأة بعشر ليرات/ لم تقل لي من أنت؟/ ومن أين أتيت؟/ ولم أقل لها: ما اسمك وماذا تعملين؟
دموع التماسيح
شيء محبط ألّا تجد أيًّا من صور أو قصائد أو مقالات بقلم أو عن إبراهيم سلامة، كأنه وجد واختفى قبل عصر التدوين الإلكتروني. أو كأنه ما إن جاء عالم الإنترنت حتى هرب منه، هو الذي يقول: «مارست الهروبين الجغرافي والتاريخي، وسقطت أسير لعبة الفرار الدائم»، إلا مقالتين كتبتا بمناسبة صدور الطبعة الثانية من كتابه الثالث «دموع التماسيح» 2012م. واحدة في صحيفة «السفير» المحتجبة، فلا يمكن معرفة من كتبها ولا ما كتب فيها سوى بعض الأسطر من بدايتها تشير إلى أسلوب سلامة المشهور بسخريته المريرة، كتقسيمه تاريخ العرب إلى ثلاث مراحل: «مرحلة العزّ، ومرحلة الهزّ، ومرحلة الطزّ المستمرة حتى أيامنا». حيث برأيه: «تبهدلت كل الأيديولوجيات العالمية، ماركس انتهى ضابط شركة».
أما المقالة الثانية فقد نشرت بصحيفة «المستقبل» بتاريخ 26/ 4/ 2012م، بقلم الشاعر بول شاوول. وهي بمجملها أقرب لشهادة مجروحة: «… من كبار الكتاب الصحافيين والمهنيين، وأهل التجارب والتاريخ… عمل ركنًا أساسيًّا ومؤسسًا في جرائد ومجلات عدة… الصوت المميّز، حتى (النشاز)… استقلاليته مقدّسة وكذلك مزاجيته، خصوصًا سخريته السوداء… دائمًا على حدة… في الداخل وفي الخارج… لم يألف الصالونات ولا أصحاب الشأن، ولا الحاشية، ولا السلاطين، ولا الشِّلَل، ولا الاستزلام، ولا الشحاذة، ولا البلاطات، ولا المجاملات، ولا الاسترقاق… يكتب دائمًا كما يشاء، لا كما يشاء هذا أو ذاك… الثائر والمتمرد، بلا حساب ولا مقابل. بل مقابل صحافيين انحازوا إلى الأنظمة الساقطة، وزمن المجرمين… بعدما أمطرونا بشعارات التمرّد، والخراب الجميل، وجنون الحرية، وحرية الجنون، فإذا بهم، عندما جاء الخراب… انصرفوا إلى مهنة المتاجرة بالصحافة والضمائر».
قلت: شيء محبط، ولكنه كان السبب في اهتمامي واستعادتي الطارئة لهذا الشاعر الطارئ، على الشعر وعلينا.. الغامض.. المتوار.. اليائس من العالم ومن الجنس البشري ومنّا.. إبراهيم سلامة، الذي أيضًا لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا، لا قدر الله، قد دخل الغيبة الكبرى. أم أنه، كما نتمنّى، ما زال حيًّا في مكان ما، يترصّد ما يحدث في العالم، وما يحلّ من مآسٍ ونكبات في فردوسه البيروتي المحطّم، وعالمه العربي، وأي عالم وأي عربي صار إليه، وأظنّه شيئًا رائعًا أن يقرأ ما كتبته عنه، لا لأهميته ولا لطرافته، بل لمقدار ما فيه من تأسٍّ وعاطفة، ليس أكثر.
اللاذقية 10/ 9/ 2018م
يمكن لي القول: إن قصائد سلامة أكثر شعبوية، صحفية، أو حتى سوقية، بالمعنى الإيجابي للكلمة، يتجلى هذا في انتقائه لمواضيعه وأيضًا لكلماته
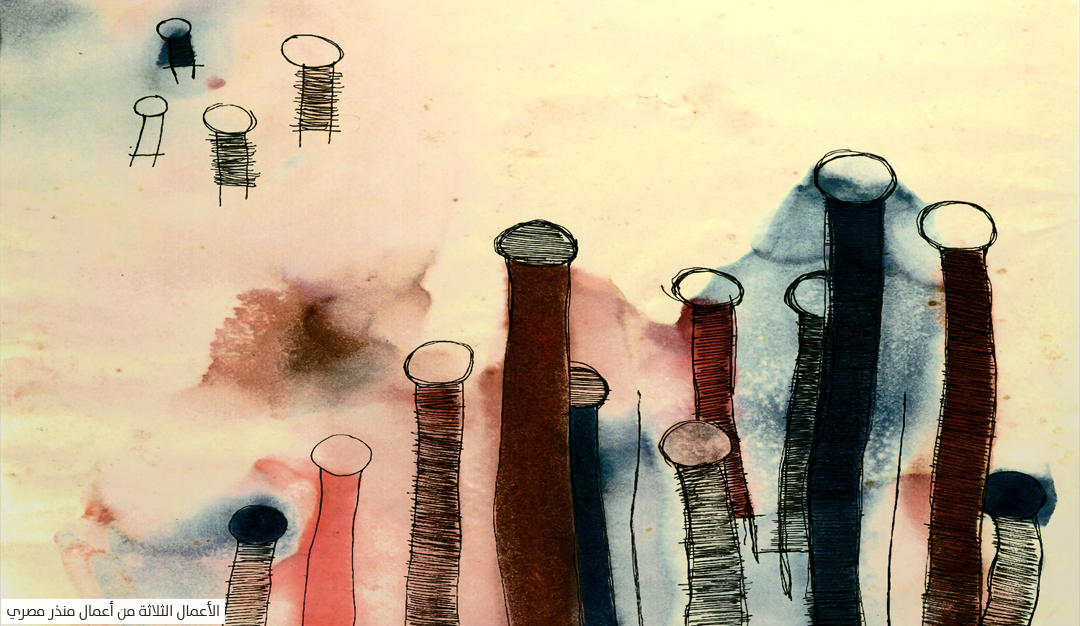







 فبعد أن يخبرنا أنهم «حوشوا الكروم كلها» (ص 114)، يستدرك «كرمة الأحاسيس المنطفئة على المياه» التي لم ينتبه لها أحد، فنسوها وتركوها. ولا أدري هنا، إن كان يقول هذا تحسّرًا عليها، أم إنه مغبوط بعدم حواشهم لها؟ أولئك الذين حوشوا البلاد كلها، بلحمها وعظمها، وأحلامها وكوابيسها، فينتبه إلى أن أحدًا، لا يدري من؟ يجلس بجانبه، على طرف سريره، والعين (عين الماء) المهجورة مفتوحة، لا على البساتين والحقول، بل على الدهاليز! ليعيدنا مرة ثانية إلى لوحة أخرى لمايكل أنغلو «الحساب الأخير» حيث كلس الجدران قد رسم بتفتته رؤوسًا بشرية مشدودة الشعر بمجاذيف ومراكب مقلوبة.
فبعد أن يخبرنا أنهم «حوشوا الكروم كلها» (ص 114)، يستدرك «كرمة الأحاسيس المنطفئة على المياه» التي لم ينتبه لها أحد، فنسوها وتركوها. ولا أدري هنا، إن كان يقول هذا تحسّرًا عليها، أم إنه مغبوط بعدم حواشهم لها؟ أولئك الذين حوشوا البلاد كلها، بلحمها وعظمها، وأحلامها وكوابيسها، فينتبه إلى أن أحدًا، لا يدري من؟ يجلس بجانبه، على طرف سريره، والعين (عين الماء) المهجورة مفتوحة، لا على البساتين والحقول، بل على الدهاليز! ليعيدنا مرة ثانية إلى لوحة أخرى لمايكل أنغلو «الحساب الأخير» حيث كلس الجدران قد رسم بتفتته رؤوسًا بشرية مشدودة الشعر بمجاذيف ومراكب مقلوبة.



