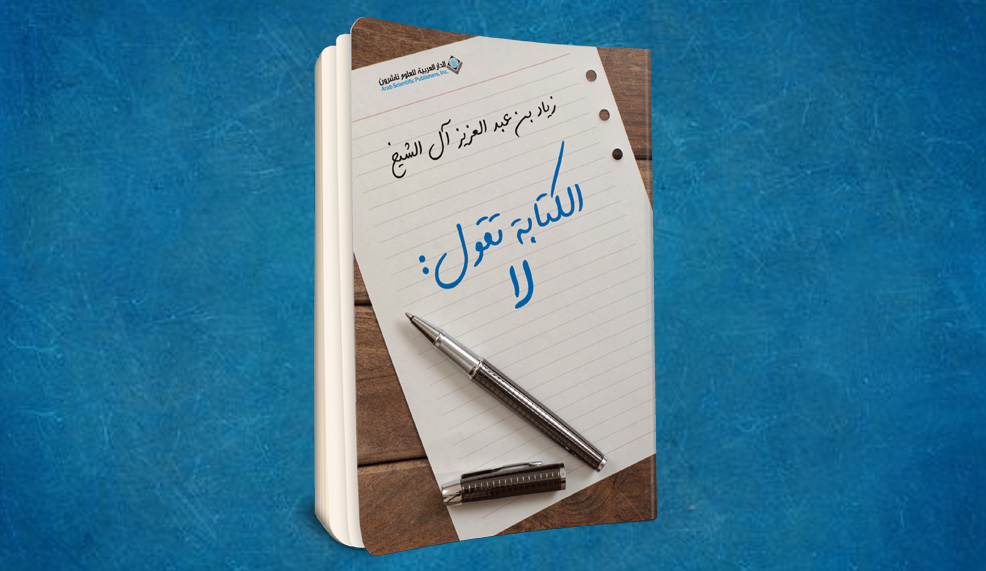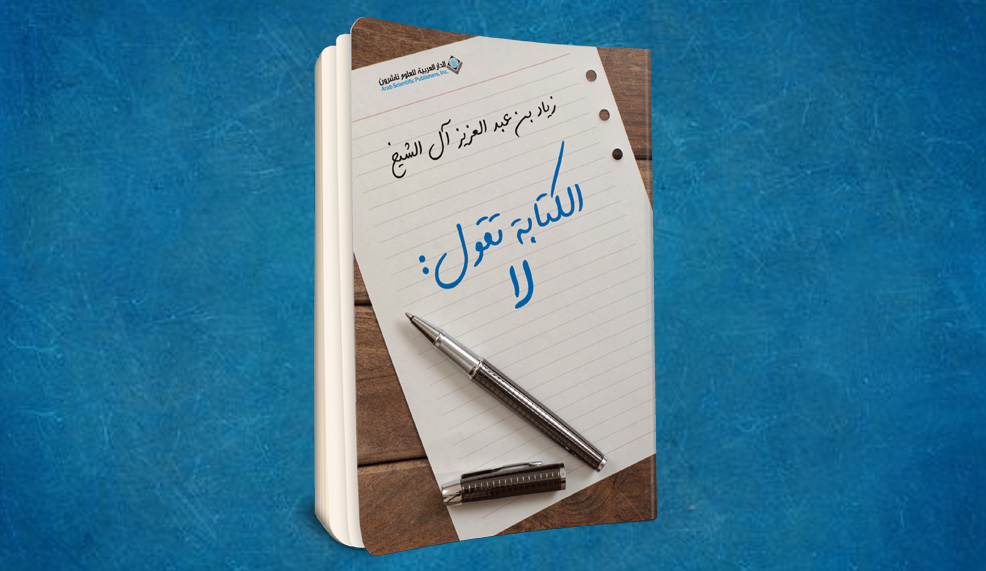
بواسطة سارة ضاهر - كاتبة لبنانية | سبتمبر 1, 2018 | كتب

زياد آل الشيخ
«الكتابة تقول: لا» (الدار العربية للعلوم ناشرون) للكاتب السعودي زياد آل الشيخ، المتخصّص في علم البرمجيات، وكاتب الأدب على أنواعه. صدرت له أربع مجموعات شعرية ومقالات علمية محكمة عدّة. جاء عمله الأخير على مثاله؛ أسلوب في الكتابة يشبه صاحبه على قاعدة «قُل كلمتك وامشِ». أسلوب في الكتابة لا يخوّلك أن تختار، أو أن تقف وسطًا بين أن تحبّ فكرة أو تحتار في أخرى؛ فإما أن تحبّ أو لا تحبّ، أبيض أو أسود، لا حلول وسطيّة، ولا شعور حائر أو متقلّب. عناوين عدّة طرحها الكاتب، بدءًا من «عادات نيرون اليومية»، و«في وصف المأساة»، و«في انتظار الباص رقم 8»… ختامًا بـ«أين أينك الآن؟». نصوص مليئة بالآنيّة وإعلاء قيمة اللحظة، كما تمتلئ بالرموز الهادفة إلى إحداث تغيير ما في توجّه أشخاص، أو حتى مجتمعات، اعتادت ما تتلقَّاه واتّخذته نهجًا دون أن تسعى إلى زلزلة هذه الأفكار والعادات وغربلتها واختيار الصالح منها.
يقدّم الكاتب عمله تحت عنوان «الكتابة تقول: لا» في محاولة لخلق نص حداثي متحرّر من التعقيد والقوانين المتبعة في الكتابة، مضفيًا بعضَ المرونة والحيوية، وطارحًا عددًا من التساؤلات التي تمنح القارئَ الحقَّ في إبداء الرأي واتخاذ القرار وإعادة النظر في قضايا عدّة تتحكّم في نظرتنا إلى الواقع؛ فعرض لقضايا مثيرة للجدل، ولم يلجأ إلى تصفية الحسابات، بل جاءت الكتابة بحدّ ذاتها بمنزلة «إنهاء» للأنا التقليديّة السائرة على غير هدى؛ لتبرز في أعمال آل الشيخ محاولات على قدر عالٍ من الجديّة لتغيير «الأنا»، ولوم الإنسان الخاضع والمستسلم. وما يعزّز هذه الفرضيّة هو: ذهاب الكاتب في هذا الاتجاه على طول نتاجه الأخير. وصلت الرسالة بوضوح، وإن كانت مغلّفة بطابع كتابة هادئ قد يتعارض مع القضية المطروحة نفسها، التي لا تتحدد بلون أو شكل، بل بفكرة، لكنّها قادرة في الوقت نفسه على الوجود والتميّز ككيان، أو ربما كفرد، ما دامت تطول الكثيرين.
يبدأ الكاتب بسرد قصة صغيرة عمادها تفاصيل دقيقة تنذر بالسوء؛ قصة نيرون وحياته اليومية، حياة يرسمها البطل لوحةً جميلة في مخيلته لتضيء كل الأشياء من حوله. أشياء تظهر لنا واقعًا سوداويًّا محزنًا من جهة، ومحاولة الإنسان التأقلم معه، بل تجميله، من جهة أخرى، كأنْ يتخيّل الذباب فراشات؛ ما يعكِس واقعًا يعيشه أغلب الأشخاص، كما يدلّ على تجذُّر المعاناة في بيئات عدّة تعيش هذه الحياة. وهكذا، يستمر الكاتب حتى الأسطر الأخيرة في تصوير حالة من الخوف؛ خوف من زمان يأخذ معه كل ما هو جميل، زمان أصبحت فيه الخيانة مشروعة حقيقةً ومجازًا «أخ يقتل أخاه، وسكين يجرح نفسه، وحرف يخون الوزن والقافية».
تستمرّ قراءتنا لنصوص أخرى أجاد الكاتب فيها وصْفَ المعاناة بكل أشكالها وتجلِّياتها، وصولًا إلى حالٍ ليست بأقل من الهلاك، حين وصف ما يعيشه طفل وامرأة ذاقا مرارة العذاب. ومن الموضوعات الأخرى: استرجاع ذكرى شعراء خلّدتهم موهبتهم، مثل امرئ القيس الذي وصفه الكاتب بـ«الشاعر الخصم». وعن حب الوطن، نتذكر كل تفصيل صغير عشناه في وطننا، يعيد لنا الأمل ببنائه، ويزيدنا حبًّا وتعلُّقًا به، يخاطبنا بأسلوبٍ رفيع يلمس كلّ حسّ انتماء في عروقنا، إضافة إلى موضوعات أخرى مرتبطة، سواء بحياتنا أم حتى بيومياتنا، بأسلوب سلس لا يعرف تعقيدًا أو غموضًا، شأنه في ذلك شأن قضايا نصوصه، عمل فريد ذو نكهة خاصة.
وبذلك يكون الكاتب قد طرح في نتاجه الأخير قضايا عدّة: سياسيّة، واجتماعيّة، معاصرة، ومتنوّعة ذات عناوين مختلفة، ارتفعت بالنص فوق التزاماته الخاصّة. قضايا يعرفها الكاتب جيدًا، نذكر منها حديثه عن الثورات والبيئة والحروب ومآسيها، الفن والعمارة، الحب والغربة، وموضوعات أخرى، تطرّق إليها بشكل عام دون الإشارة إلى أشخاص أو أماكن بعينها. وأتت عباراته ذاتَ تراكيب سلسة شملت في محتواها أدقَّ التفصيلات، تفصيلات زمان أو مكان أعطت النصوص واقعية جذبت القارئ ليتفاعل مع كل شخصية طُرحت ضمن إطار معيّن، سواء الفقر أم الظلم أم التعاسة أم المحبة… وغير ذلك من القصص التي تركت صدًى يحفز الإنسان كي يبتعد من الظل، ويرفض أن يحدّ نظرته إلى الأمور بالأبيض والأسود… كما رفض الكاتب أن يكون جزءًا من هذا التقليد.
تنوّعت أفكار كاتبنا مستحدثًا مضامينها، أفكار تجدّدت بشكل فاعل، وتأسّست من خلاله هذه السطور والموضوعات. «الكتابة تقول: لا» هي صوت مواطن مفكّر، وكاتب حسّاس، يأخذ الكتابة إلى مساحة أوسع، تكون فيها حرّة وربيعيّة، تقوم بدورها في نشر الضوء والأكسجين والخضرة، وكل ما من شأنه أن يجمّل حياة الإنسان ويعيده إلى طبيعته الأولى حرًّا طليقًا مبدِعًا، أن يعود ليكون الضد، قبل أن تروّضه الأحزاب والأديان والعادات وتكبّله بحبالها. فهل وصلت الرسالة؟
سيكون من الأسهل أن نختم ببضع كلمات، والكلمة الأبرز التي تتبادر إلى الذهن هي تميُّز هذا العمل، الذي أظهر كثيرًا من الجودة و«الوفرة» في استكشاف قلب الإنسان؛ إذ تظهر في النصوص طاقة جبّارة ورغبة حقيقيّة في التغيير، سواء بالحوار أم بالمشاجرات، بحيث أقام الكاتب المواقف المتباينة دون التزام أيٍّ من الجانبين. ولعلّ أحد الدروس المهمة من هذا الكتاب هو: كل ما يحدث لنا في حياتنا يأتي على شكل سرد يروي لنا قصص حياتنا ليحرّرنا من خيالنا. وإن لجأ الفن إلى الخيال في مواقع كثيرة، إلا أنه يكسر قبضته ليقودنا إلى رؤية الحقيقة، إلى تمزيق الستار؛ لنقف في النهاية أمام كاتب حرّرتْه الكلمة، فحلّق خارج حدوده، ليعالج همومًا أشمل؛ لأنه يدرك بوعي الباحث ومنطق العلم أنها هموم مشتركة مع كل إنسان.

بواسطة سارة ضاهر - كاتبة لبنانية | نوفمبر 5, 2017 | كتب
لعلّ الجنون الذي رمز إليه عبده وازن في روايته الجديدة «البيت الأزرق» (منشورات ضفاف – والاختلاف)، هو النهاية الحتمية لمَن يعيش في عالمنا الراهن، عارفًا الحقيقة كاملة، حقيقة عبثيّة الوجود من جهة، وواقع الخوف والظلم والنفاق الذي نحياه من جهة ثانية. أماكن كثيرة تنقّل فيها بطل وازن، المنطوي على ذاته، المشرّد، المشّاء، اليتيم، المحبَط، الرقيق، وآخرها المظلوم، الصامت والمنتحِر. أماكن كثيرة سكنها، إلا أنّ الكاتب آثَر وضع «البيت الأزرق» عنوانًا، وهو المكان الذي يوضَع فيه المسجون، ذو الحالة النفسيّة أو العصبيّة المريضة، ثم لا يلبث أن يتحوّل في نظر المجتمع إلى مجنون منسي، وقد يموت من دون أن يأتي أحد من ذويه لتسلم جثته ودفنها.
نبدأ من أسلوب عبده وازن الروائي المتقدّم جدًّا، انطلاقًا من إدخال القارئ، منذ الصفحات الأولى للرواية، أجواء الكاتب، حتى أشعرنا أنه صديق يتحدّث إلينا عن هواجسه ويوميّاته، متسائلًا أمامنا، طالبًا نصيحتنا، انتقالًا إلى احترافه تقنية التشويق، وعرض الحدث تلو الحدث، حيث لا ملل ولا نفور، ولا سعي إلى تقليب صفحات الرواية بسرعة. بل يهتم القارئ بمعرفة التفاصيل، والشخصيات المثيرة للجدل، التي غلب عليها طابَع الشذوذ. وقد بدا واضحًا ميل الراوي إلى أنسنة هذا السلوك، من دون أن يصدر حكمًا مباشرًا. قصة تنبعث من مثيلتها، وشخصية من أخرى، وظاهرة من ظاهرة. من شأنها كلّها أن تطرح موضوعات اجتماعيّة قديمة حديثة، بدءًا من الفساد الديني والسياسي والأمني، كذلك الدعارة، والمشاكل العائليّة، والمثليّة الجنسيّة، والحرية، والحب والجنس…
خرس إرادي

عبده وازن
بدأت مأساة بطل وازن، في القسم الأول، منذ طفولته، ووفاة والدته وهجرة والده. هجرة أثّرت كثيرًا في ذات بول، الذي لم يراسله والده سوى مرّات قليلة ثمّ انقطع عن التواصل معه. هذا الإهمال الذي لم يمح أثره اهتمام خالته التي أوكلت إليها مهمة تربيته، ولا حتى العثور على حبيبة. فالخالة ما لبثت أن توفيت والحبيبة هجرت. إلا أنّ اللجوء إلى الخرَس الإرادي، ربما دليل على إدراك بول لعدم جدوى الكلام، وعلى الشعور بالنقص، وانعدام الثقة بالذات. فعلى الصعيد الاجتماعي، لم يكن ينقصه أي شيء: حنان خالته، منزل وأراضٍ كثيرة، شهادة جامعيّة رفض تسلمها، أو المضي في الدراسة لنيلها. لذلك، وبتحليل بسيط، نجد أنّ بول يستسلم قبل حصوله على مبتغاه بمدّة قصيرة، سواء في حال الحب، أو الدراسة أو حتى الصداقة. صداقته للراهب التي أدرك أنّها نوع من الغرام، لا تناسب مبادئه، ولا حتى إحساسه، حب من طرف الراهب، الأب ألبير. وصداقة جاره، ثم صداقات في السجن. ربما لم يحاول مرة أخرى، لانعدام ثقته بعودة الماضي.
غدر بعد آخر، يعود إلى غدر الأب منذ البداية. والسير على الطرقات. طريق تقود إلى مسار، ربّما في محاولة للوصول إلى ذلك الوالد المهاجِر. والد اختفى وما زال وازن يبحث عنه منذ «غرفة أبي»، فتحوّل مناجاة ومشاعر تتحرّك، تتخللها محاولات تركزت على إعادة بناء ملامح شخصيّة ضاعت. شخصيّات الرواية كثيرة، لكنّ القليل منها سويّ. وأغلب الإشكال يقع بسبب الهوية الجنسيّة الشاذة، في مجتمع، ما زال يطالب بحقوق المرأة، ويسعى للحصول على أبسط حقوقه بألف وسيلة ووسيلة. وكانت نهايات هذه الشخصيات، إمّا السجن وإمّا الهجرة. إنها شخصيات، بالكاد تتّسع لها صفحات رواياتنا، فما بالك بمجتمعاتنا!
من ناحية أخرى، بات اللجوء إلى الغرب، للشعور بالحرية والراحة، مطلب الكتّاب العرب، كمخرَج يحافظ على الفكر المتفتّح لشخصيّة ما، بالتوازن مع عادات مجتمعنا الشرقي وقيَمه. يتيح لنا هذا «البيت الأزرق» اكتشاف عبده وازن الكاتب من جديد. ثقافته واضحة في أجزاء كثيرة، إذا ما حلّلنا النظريات الفلسفية؛ مفردات السجن، اللون الأزرق، عادة المشي، الصمت، البكم، الانتحار… يشارك قارئ «البيت الأزرق» في فك النص، فلا يرضى له وازن أن يكون متلقيًا سلبيًّا إنما قارئًا متفاعلًا مع الأحداث المتشعبة داخل نسيج روائي محكم. هذه الرواية المتطوّرة، والمرتبطة بصيانة المنظورات والهياكل المحافظة في آنٍ، تغطي مجموعة واسعة من الممارسات الروائية المختلفة جدًّا، من القرن السابق إلى القرن الحالي. في القسم الثاني، يفتح الراوي الأول (الكاتب) المغلّف الذي يضمّ مخطوطات بول. يقرأ فيها أنّ الشخصية التي أسرته وحرّضته على ترك روايته الأصلية والمضي في البحث عن حقيقتها من معارفه وأقاربه، لم يكن أخرسَ، لكنّه اختار الخرس علامةً على انسحابه من هذا العالم الذي لم يشعر يومًا أنه ينتمي إليه.
مأساة رهيبة
ثم يعود وازن، بدءًا من هذه المأساة الرهيبة، ليتحدث مرة أخرى عن المثليّة الجنسيّة. لكنّ المسرح الروائي تغيّر وصار السجن الذي يُمثّل بيئة ملائمة جدًّا لتعزيز هذه الواقعة. هكذا تبدو معظم الموضوعات داخل السجن كأنها تدور حول مشاهد الجنس، وإن بنظرةٍ وجودية. وبالعودة إلى شخصية بول، نتساءل: إذا طلب أحدهم منك تفقد الذاكرة الخاصة بك، هل يمكنك أن تذكر ماضيك؟ أو أنك تترك الأمور تسير وحدها لإعادة بناء اللغز في حياتك، وأنت تتخطّى أجزاء معينة منها لتحيا؟ هذا ما لم يقوَ عليه كل من بول وجولييت، وإن كانت الحكايتان منفصلتين.
يستيقظ بول على اليأس. في ذاك الوقت، كان الشاب أخفق في بناء علاقة قوية مع حبيبته. في لحظة، وجد أنّه فقد كلّ شيء، وهو ما أدّى إلى زعزعة الاستقرار داخله، وسرعان ما استسلم. الحياة لم تترك له فرصة ثانية، أو ربما لم تعد الحياة محطّ ثقة، فلم يدافع عن نفسه في قضيّة قتل سامية، وهو بريء. أمّا جولييت، المرأة الأربعينية، بطلة رواية الكاتب/ الراوي، هي أيضًا معادل أنثوي مُتخيّل لشخصية بول، وإن كانت تختلف في تفاصيلها، باعتبار أنّ معاناتها نتيجة عجزها عن خيانة حبيبها لها.
أفضل ما فعله عبده وازن أنه قام بدفن بطله، أو بطلَيهِ؛ بول وجولييت، سواء تعدّدت النهايات، والأساليب حول طريقة الموت انتحارًا بتناول جرعات كبيرة من الدواء، أو بالقفز من على سطح البناية، أو بقطع الشرايين، صباحًا أو ظهرًا أو مساءً. الأوقات جميعها ملائمة لاتخاذ هذا القرار! أو حتى ترك النهاية مفتوحة أمام القارئ؛ لأنّ عادات المجتمع كفيلة بالقضاء على الشخصية الضعيفة بدلًا من دعمها. المهم النتيجة، هي الموت، الموت لشخصيّة عاشت على هامش الحياة، ولم تدرك كيف تقول نعم أو لا، لا تعرف كيف ترفض، أو تقبل، كيف تعبّر، ادّعَت الخرس في وقت الحاجة إلى الكلام، ولجأت إلى اللامكان، وأبواب البيت مشرعة.

بواسطة سارة ضاهر - كاتبة لبنانية | نوفمبر 1, 2017 | كتب
لعلّ الجنون الذي رمز إليه عبده وازن في روايته الجديدة «البيت الأزرق» (منشورات ضفاف – والاختلاف)، هو النهاية الحتمية لمَن يعيش في عالمنا الراهن، عارفًا الحقيقة كاملة، حقيقة عبثيّة الوجود من جهة، وواقع الخوف والظلم والنفاق الذي نحياه من جهة ثانية. أماكن كثيرة تنقّل فيها بطل وازن، المنطوي على ذاته، المشرّد، المشّاء، اليتيم، المحبَط، الرقيق، وآخرها المظلوم، الصامت والمنتحِر. أماكن كثيرة سكنها، إلا أنّ الكاتب آثَر وضع «البيت الأزرق» عنوانًا، وهو المكان الذي يوضَع فيه المسجون، ذو الحالة النفسيّة أو العصبيّة المريضة، ثم لا يلبث أن يتحوّل في نظر المجتمع إلى مجنون منسي، وقد يموت من دون أن يأتي أحد من ذويه لتسلم جثته ودفنها.
نبدأ من أسلوب عبده وازن الروائي المتقدّم جدًّا، انطلاقًا من إدخال القارئ، منذ الصفحات الأولى للرواية، أجواء الكاتب، حتى أشعرنا أنه صديق يتحدّث إلينا عن هواجسه ويوميّاته، متسائلًا أمامنا، طالبًا نصيحتنا، انتقالًا إلى احترافه تقنية التشويق، وعرض الحدث تلو الحدث، حيث لا ملل ولا نفور، ولا سعي إلى تقليب صفحات الرواية بسرعة. بل يهتم القارئ بمعرفة التفاصيل، والشخصيات المثيرة للجدل، التي غلب عليها طابَع الشذوذ. وقد بدا واضحًا ميل الراوي إلى أنسنة هذا السلوك، من دون أن يصدر حكمًا مباشرًا. قصة تنبعث من مثيلتها، وشخصية من أخرى، وظاهرة من ظاهرة. من شأنها كلّها أن تطرح موضوعات اجتماعيّة قديمة حديثة، بدءًا من الفساد الديني والسياسي والأمني، كذلك الدعارة، والمشاكل العائليّة، والمثليّة الجنسيّة، والحرية، والحب والجنس…
خرس إرادي

عبده وازن
بدأت مأساة بطل وازن، في القسم الأول، منذ طفولته، ووفاة والدته وهجرة والده. هجرة أثّرت كثيرًا في ذات بول، الذي لم يراسله والده سوى مرّات قليلة ثمّ انقطع عن التواصل معه. هذا الإهمال الذي لم يمح أثره اهتمام خالته التي أوكلت إليها مهمة تربيته، ولا حتى العثور على حبيبة. فالخالة ما لبثت أن توفيت والحبيبة هجرت. إلا أنّ اللجوء إلى الخرَس الإرادي، ربما دليل على إدراك بول لعدم جدوى الكلام، وعلى الشعور بالنقص، وانعدام الثقة بالذات. فعلى الصعيد الاجتماعي، لم يكن ينقصه أي شيء: حنان خالته، منزل وأراضٍ كثيرة، شهادة جامعيّة رفض تسلمها، أو المضي في الدراسة لنيلها. لذلك، وبتحليل بسيط، نجد أنّ بول يستسلم قبل حصوله على مبتغاه بمدّة قصيرة، سواء في حال الحب، أو الدراسة أو حتى الصداقة. صداقته للراهب التي أدرك أنّها نوع من الغرام، لا تناسب مبادئه، ولا حتى إحساسه، حب من طرف الراهب، الأب ألبير. وصداقة جاره، ثم صداقات في السجن. ربما لم يحاول مرة أخرى، لانعدام ثقته بعودة الماضي.
غدر بعد آخر، يعود إلى غدر الأب منذ البداية. والسير على الطرقات. طريق تقود إلى مسار، ربّما في محاولة للوصول إلى ذلك الوالد المهاجِر. والد اختفى وما زال وازن يبحث عنه منذ «غرفة أبي»، فتحوّل مناجاة ومشاعر تتحرّك، تتخللها محاولات تركزت على إعادة بناء ملامح شخصيّة ضاعت. شخصيّات الرواية كثيرة، لكنّ القليل منها سويّ. وأغلب الإشكال يقع بسبب الهوية الجنسيّة الشاذة، في مجتمع، ما زال يطالب بحقوق المرأة، ويسعى للحصول على أبسط حقوقه بألف وسيلة ووسيلة. وكانت نهايات هذه الشخصيات، إمّا السجن وإمّا الهجرة. إنها شخصيات، بالكاد تتّسع لها صفحات رواياتنا، فما بالك بمجتمعاتنا!
من ناحية أخرى، بات اللجوء إلى الغرب، للشعور بالحرية والراحة، مطلب الكتّاب العرب، كمخرَج يحافظ على الفكر المتفتّح لشخصيّة ما، بالتوازن مع عادات مجتمعنا الشرقي وقيَمه. يتيح لنا هذا «البيت الأزرق» اكتشاف عبده وازن الكاتب من جديد. ثقافته واضحة في أجزاء كثيرة، إذا ما حلّلنا النظريات الفلسفية؛ مفردات السجن، اللون الأزرق، عادة المشي، الصمت، البكم، الانتحار… يشارك قارئ «البيت الأزرق» في فك النص، فلا يرضى له وازن أن يكون متلقيًا سلبيًّا إنما قارئًا متفاعلًا مع الأحداث المتشعبة داخل نسيج روائي محكم. هذه الرواية المتطوّرة، والمرتبطة بصيانة المنظورات والهياكل المحافظة في آنٍ، تغطي مجموعة واسعة من الممارسات الروائية المختلفة جدًّا، من القرن السابق إلى القرن الحالي. في القسم الثاني، يفتح الراوي الأول (الكاتب) المغلّف الذي يضمّ مخطوطات بول. يقرأ فيها أنّ الشخصية التي أسرته وحرّضته على ترك روايته الأصلية والمضي في البحث عن حقيقتها من معارفه وأقاربه، لم يكن أخرسَ، لكنّه اختار الخرس علامةً على انسحابه من هذا العالم الذي لم يشعر يومًا أنه ينتمي إليه.
مأساة رهيبة
ثم يعود وازن، بدءًا من هذه المأساة الرهيبة، ليتحدث مرة أخرى عن المثليّة الجنسيّة. لكنّ المسرح الروائي تغيّر وصار السجن الذي يُمثّل بيئة ملائمة جدًّا لتعزيز هذه الواقعة. هكذا تبدو معظم الموضوعات داخل السجن كأنها تدور حول مشاهد الجنس، وإن بنظرةٍ وجودية. وبالعودة إلى شخصية بول، نتساءل: إذا طلب أحدهم منك تفقد الذاكرة الخاصة بك، هل يمكنك أن تذكر ماضيك؟ أو أنك تترك الأمور تسير وحدها لإعادة بناء اللغز في حياتك، وأنت تتخطّى أجزاء معينة منها لتحيا؟ هذا ما لم يقوَ عليه كل من بول وجولييت، وإن كانت الحكايتان منفصلتين.
يستيقظ بول على اليأس. في ذاك الوقت، كان الشاب أخفق في بناء علاقة قوية مع حبيبته. في لحظة، وجد أنّه فقد كلّ شيء، وهو ما أدّى إلى زعزعة الاستقرار داخله، وسرعان ما استسلم. الحياة لم تترك له فرصة ثانية، أو ربما لم تعد الحياة محطّ ثقة، فلم يدافع عن نفسه في قضيّة قتل سامية، وهو بريء. أمّا جولييت، المرأة الأربعينية، بطلة رواية الكاتب/ الراوي، هي أيضًا معادل أنثوي مُتخيّل لشخصية بول، وإن كانت تختلف في تفاصيلها، باعتبار أنّ معاناتها نتيجة عجزها عن خيانة حبيبها لها.
أفضل ما فعله عبده وازن أنه قام بدفن بطله، أو بطلَيهِ؛ بول وجولييت، سواء تعدّدت النهايات، والأساليب حول طريقة الموت انتحارًا بتناول جرعات كبيرة من الدواء، أو بالقفز من على سطح البناية، أو بقطع الشرايين، صباحًا أو ظهرًا أو مساءً. الأوقات جميعها ملائمة لاتخاذ هذا القرار! أو حتى ترك النهاية مفتوحة أمام القارئ؛ لأنّ عادات المجتمع كفيلة بالقضاء على الشخصية الضعيفة بدلًا من دعمها. المهم النتيجة، هي الموت، الموت لشخصيّة عاشت على هامش الحياة، ولم تدرك كيف تقول نعم أو لا، لا تعرف كيف ترفض، أو تقبل، كيف تعبّر، ادّعَت الخرس في وقت الحاجة إلى الكلام، ولجأت إلى اللامكان، وأبواب البيت مشرعة.